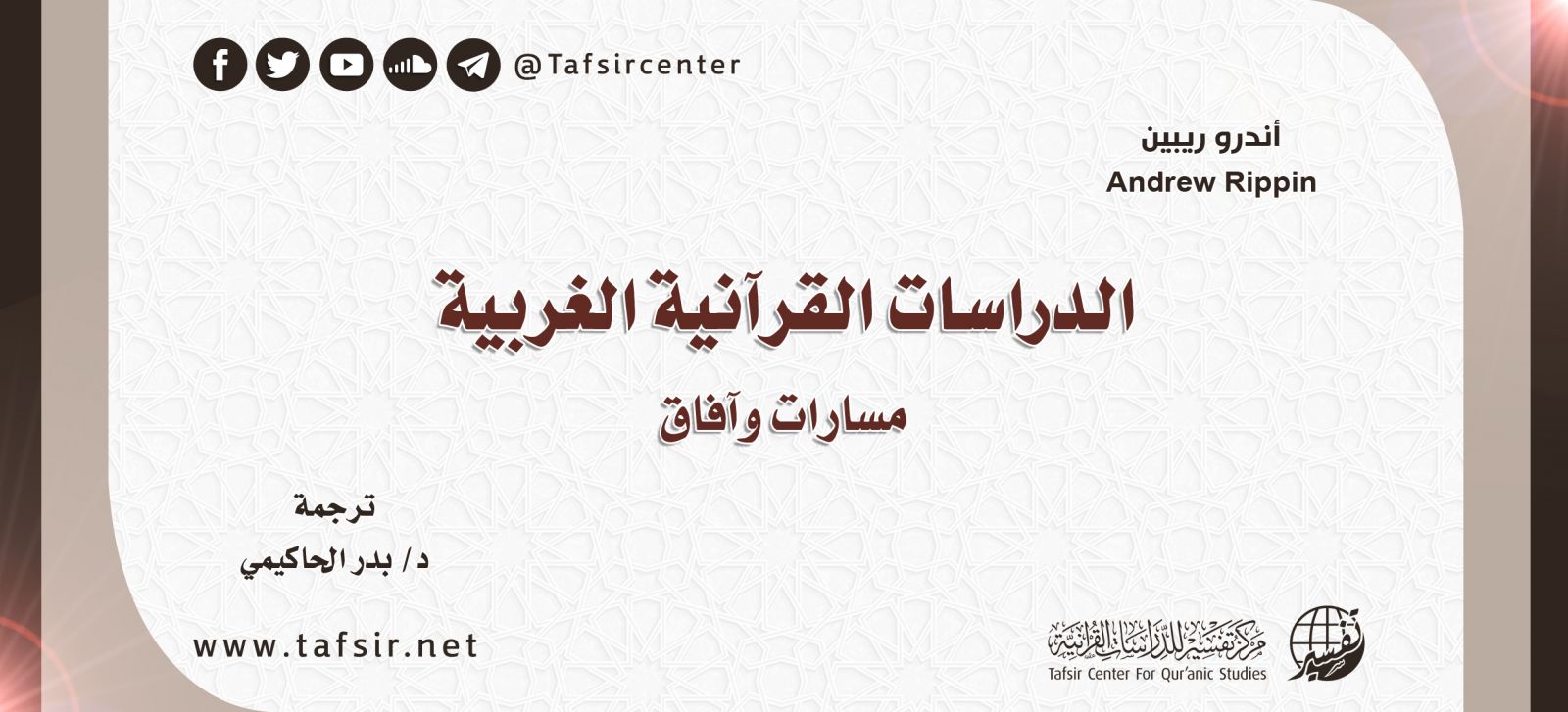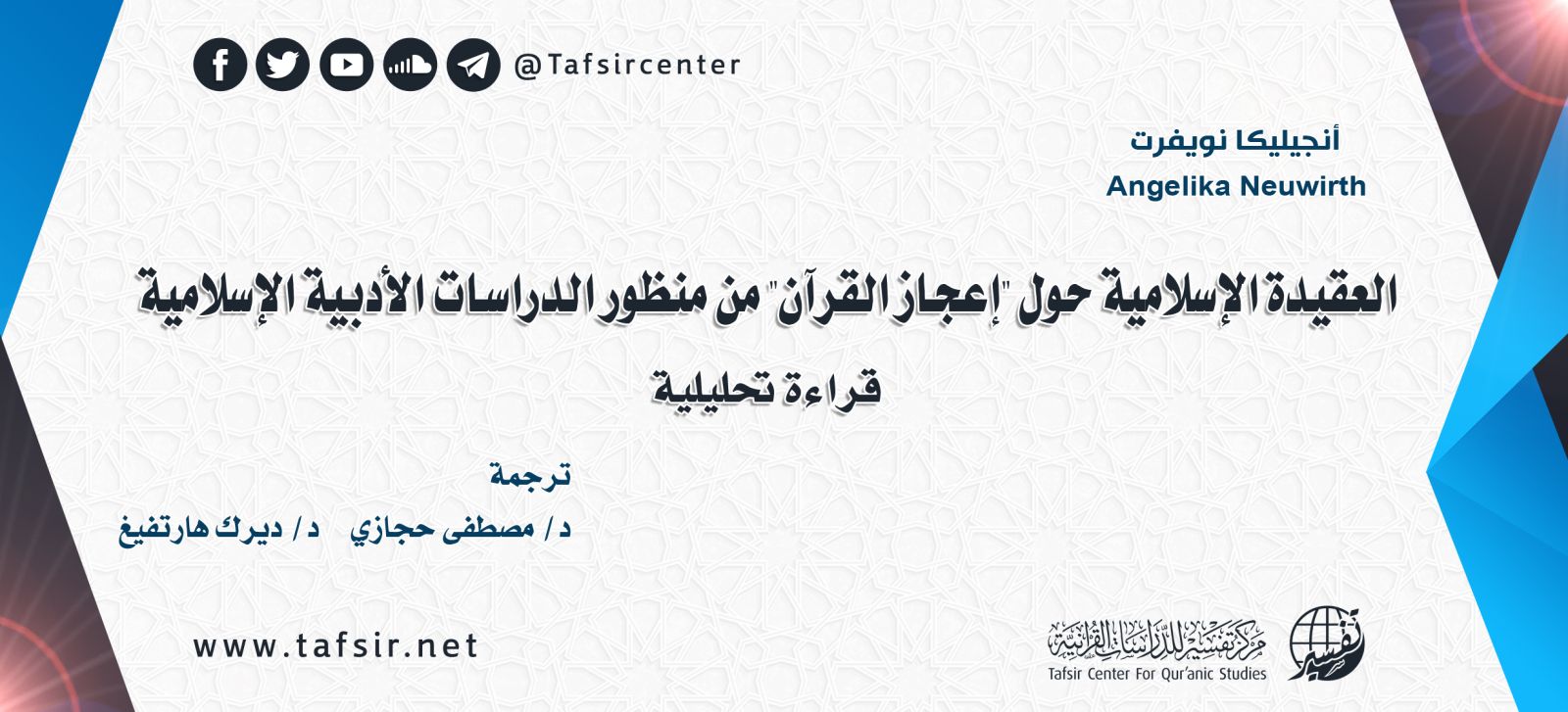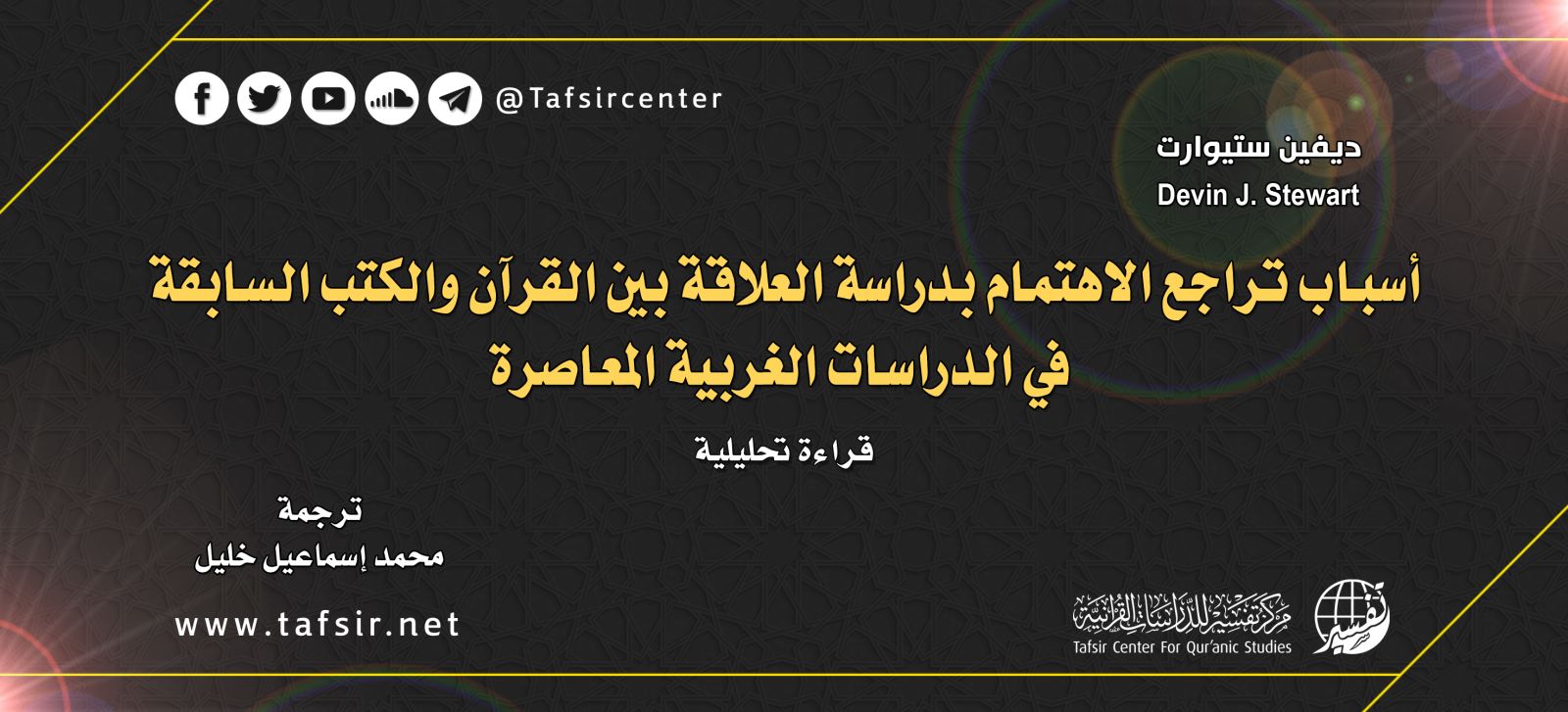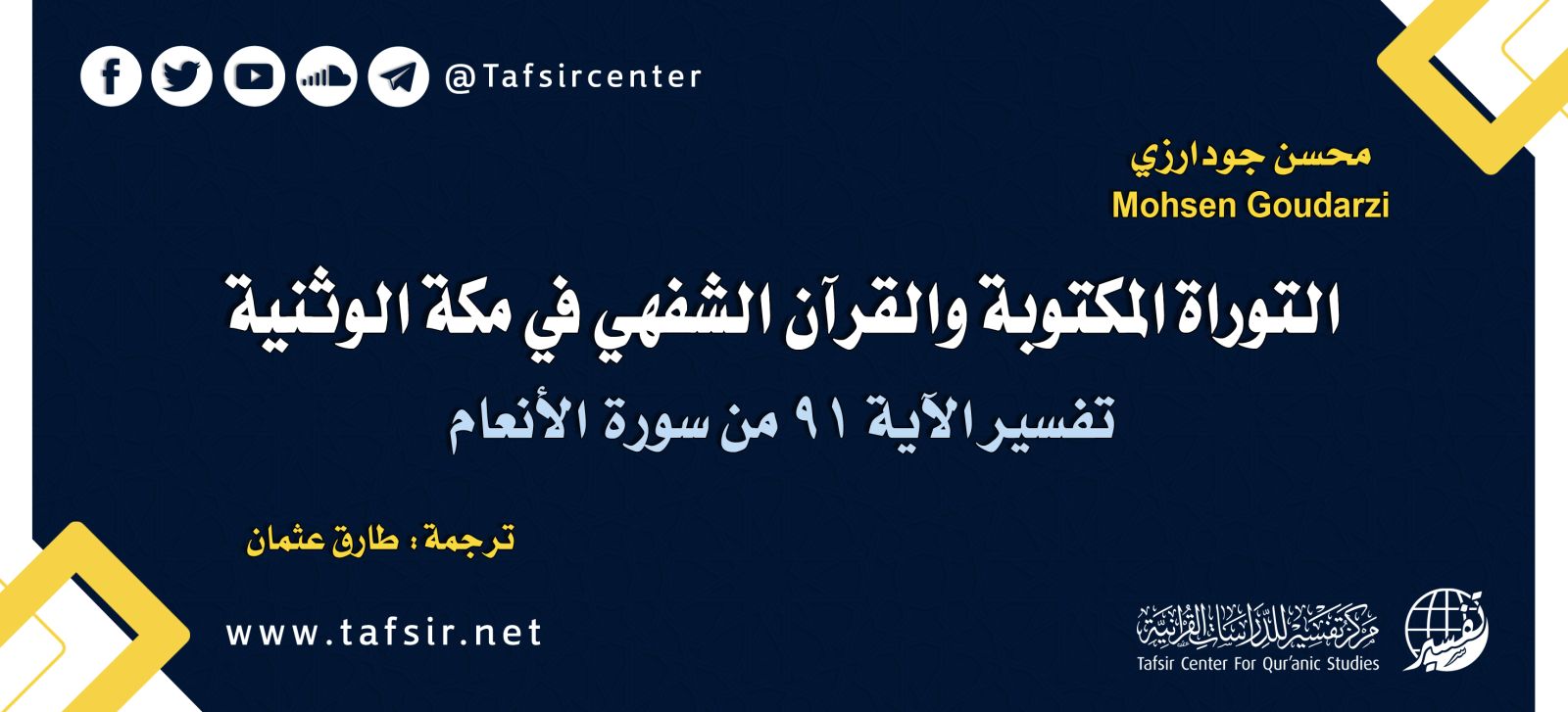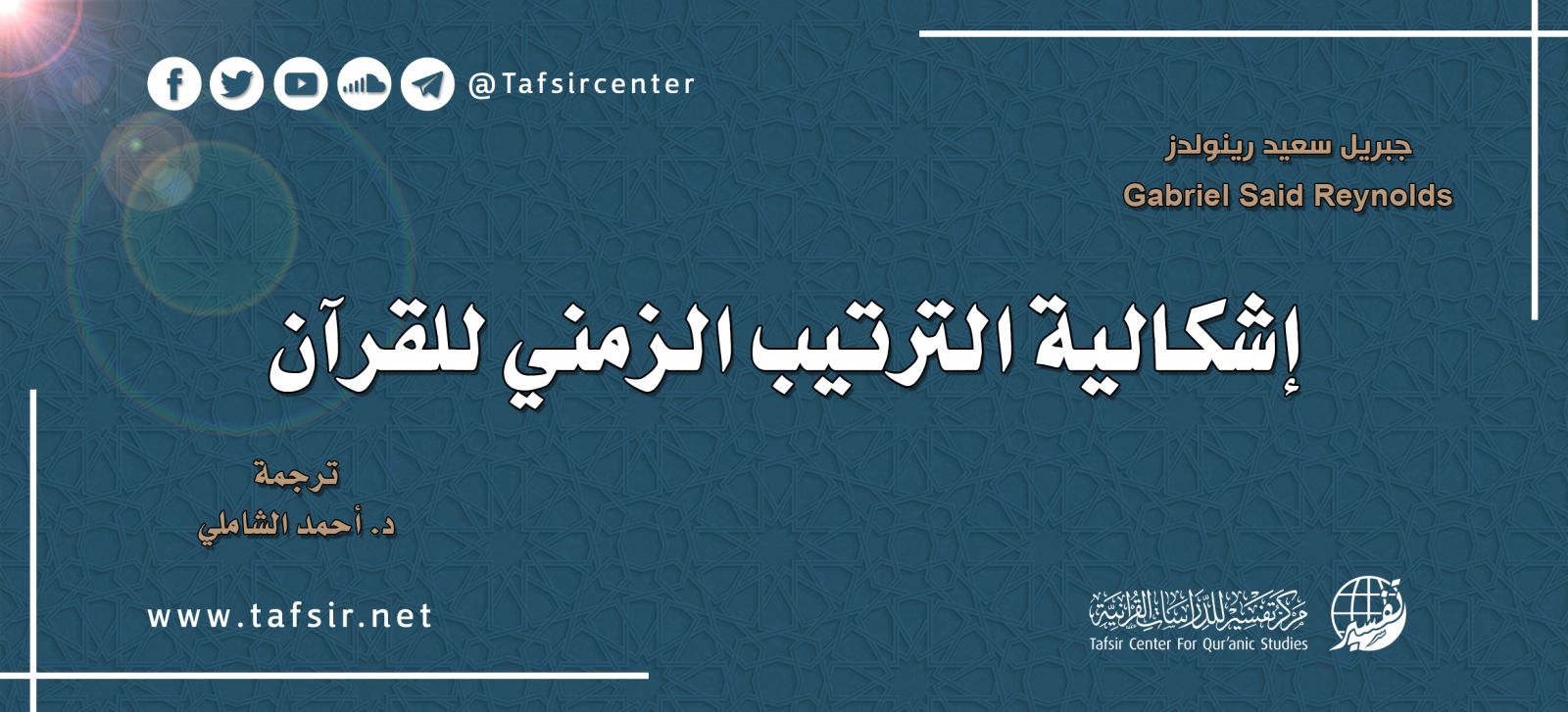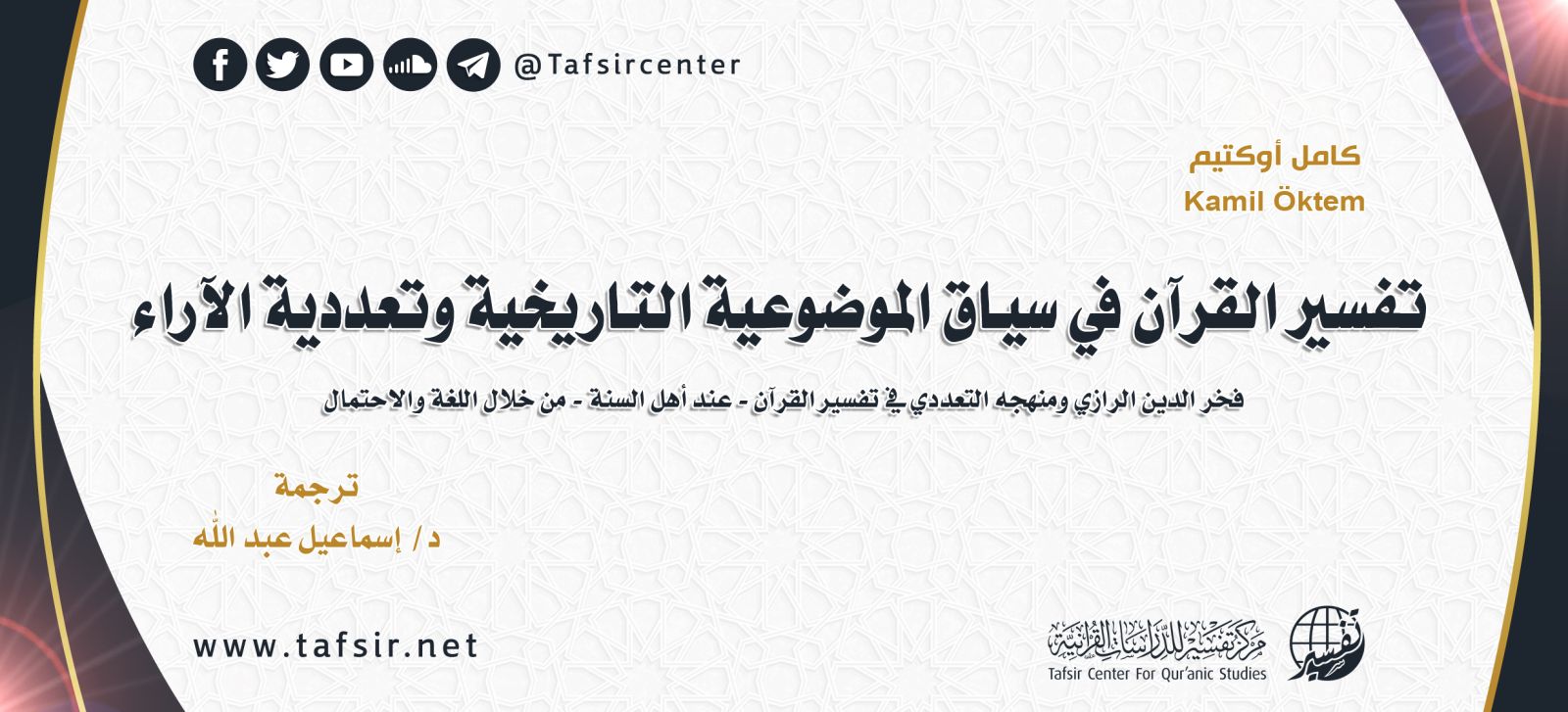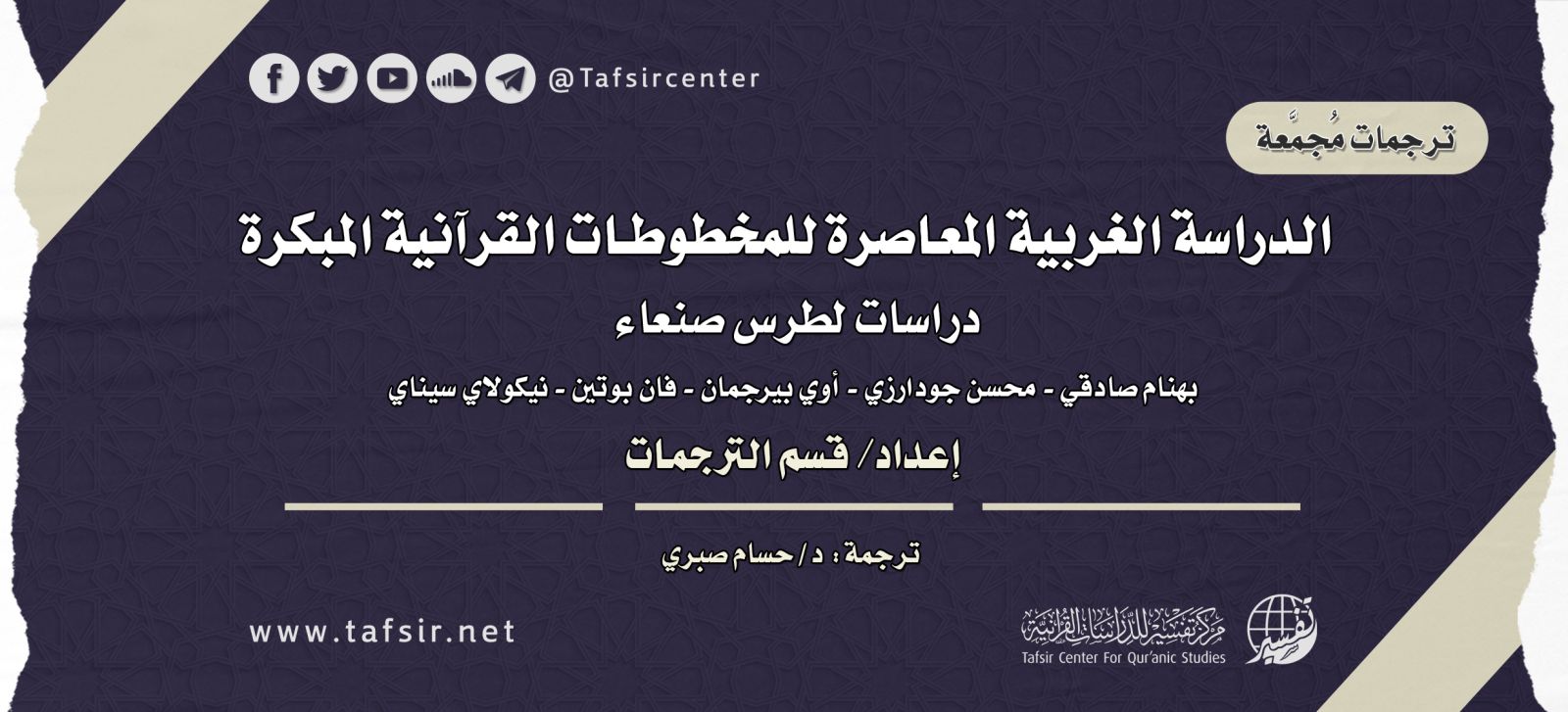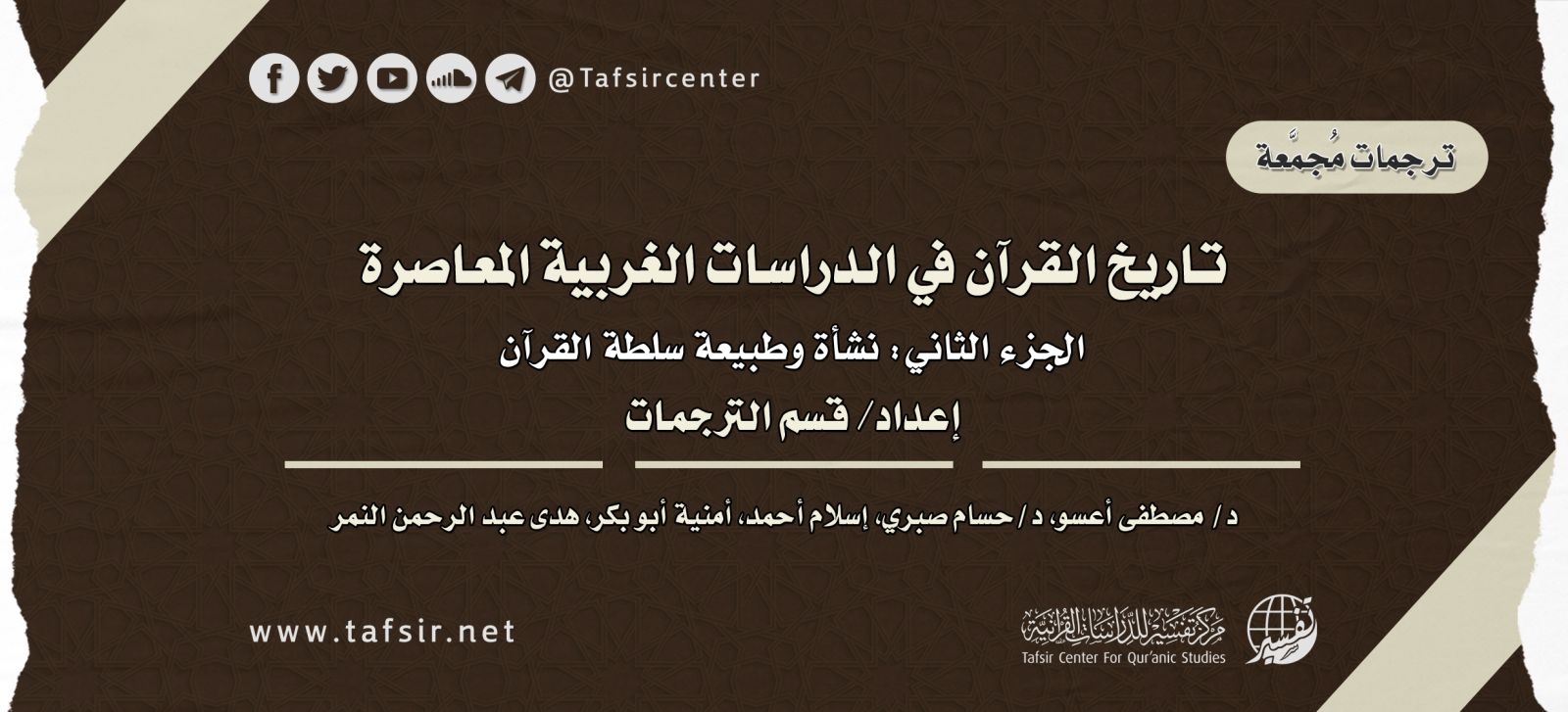تعريفات الزُّرُوع المِقرائية في مرآة تفاسير القرآن
تعريفات الزُّرُوع المِقرائية في مرآة تفاسير القرآن
الكاتب: زوهار عمّار - Zohar Amar
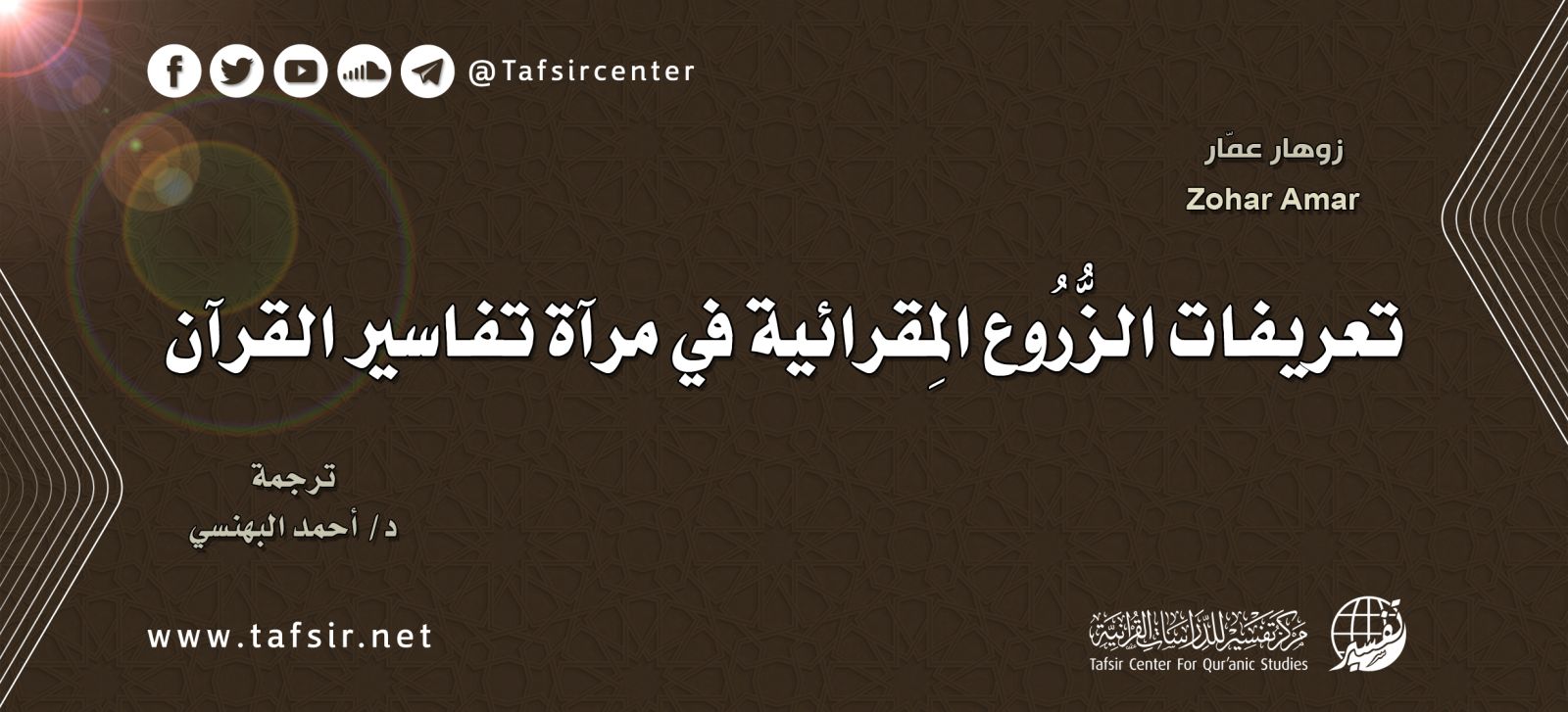
تعريفات الزُّرُوع المِقرائية في مرآة تفاسير القرآن[1][2]
على خلاف الزروع في المِقرا[3] التي حظيتْ بالكثير من الأبحاث، لم تُعَدّ أبحاثٌ منهجيةٌ وشاملةٌ لمحاولة الوقوف على تعريفات الزّروع المذكورة في القرآن[4]. ويَعتزم كاتب هذه السطور، الذي اشتغل على هذه القضية، أن يضع أمام القارئ العِبري جزءًا من هذا البحث، الذي يتناول الزروع المذكورة في قصص المِقرا، ومذكورة أيضًا في القرآن وتفاسيره.
كما هو معروف، فإنّ تعريف الزروع المذكورة في المِقرا أمرٌ شائع في المصادر العبرية القديمة، بداية من فترة المِشنا والتلمود، مرورًا بتفاسير العصر الوسيط وحتى وقتنا الحالي. كما أنّ تعريفات هذه الزروع بالمِقرا أمرٌ شائع جدًّا في الأدب النصراني على مرّ الأجيال. ورغم ذلك فإنّ الكثير من الزروع لم يتمّ تحديد هُويّتها بدقة، وتم تفسيرها بتفسيرات متنوّعة ومتناقضة في آنٍ.
غير أنّ هذه الزروع لم تُذكر إلا قليلًا في المصادر الإسلامية والتراث المتعلّق بالقرآن والأدب التفسيري الإسلامي (تفاسير) على مرّ الأجيال. فعلى غرار تفاسير المِقرا اليهودية، تطوّر على مدار سنوات عديدة، أدبٌ قرآنيٌّ كبيرٌ في حجمه، سنذكر من بينه تفاسير العصر الوسيط البارزة، مثال: الطبري (839- 923)، الطوسي (995- 1067)، الزمخشري (توفي 1144)، ابن الجوزي (1116- 1200)، الرازي (1149- 1209)، البيضاوي (توفي 1286)، ابن كثير (القرن الرابع عشر)، جلال الدين المحلِّي (توفي 1459)، وتلميذه جلال الدين السيوطي (توفي 1505)، واللذَيْن أُطلق على اسميهما التفسير الشعبي الصغير (تفسير الجلالَيْن)[5]. كما أنّ جلال الدين السيوطي كتب كتابًا حول الزروع المذكورة في التراث المتعلق بالقرآن[6].
ينتشر في التفاسير القرآنية تراث قديم جدًّا، وفي جزء منه -فيما يبدو- يوجد تراث يهودي أصيل اختفى مع مرور الزمن، غير أنّه مع تبلور الأدب التفسيري الإسلامي بالعصر الوسيط، ظهرت شواهد تدلّ على التأثير الإسلامي على التفاسير اليهودية[7]، وخاصّة على فرقة القرّائين[8].
وقد التفتَ باحثو القرآن إلى الأُسس اليهودية والنصرانية، وربما الفارسية أيضًا، الموجودة في القرآن[9]. وفي الواقع فإنّ البشارة التي جاء بها محمد تعدّ إنتاجًا انتقائيًّا ومركّبًا من مصادر ثقافية مختلفة، استوعبها خلال سنوات حياته[10]. فقد مزج كاتب القرآن[11] وضَمَّن معلومات مع إضافات مِن قِبَلِه بشكلٍ يُناسِب احتياجاته.
يشير التحليل العميق للنصّ القرآني إلى الصِّلة القوية -بشكل خاصّ- بالمصادر اليهودية، التي أساسها -فيما يبدو- كان يهودية شبه الجزيرة العربية، إبّان فترة نشاط محمد[12]. ووفقًا لرأي حافا لازروس يافيه[13] كانت هذه -فيما يبدو- ديانة يهودية ممزوجة بثقافة يهودية أصيلة «والتي أنتجت أدبًا مِدراشيًّا خالصًا، فُقِد كلّه مع ضياع يهودية شبه الجزيرة العربية، لكنه حُفظ في القرآن»[14].
استحضرت لازروس نموذجًا محتملًا لهذا الإنتاج الأصيل، وذلك في قصة يوسف والأُتْرُجّ[15]: فيُحكى أن زوجة بوطيفار سمعت أنّ نساء المدينة تَذْكُرْنَ أنها عشقَت يوسف الجميل، فاستَدعتهنَّ لمقر إقامتها، وأعطت كل امرأة سكينًا و(ثمرة)، وقالت (ليوسف): ﴿اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ﴾. وحينما رأَيْنَه أكبرنه وأُعجبن به وقطّعن أيديهنَّ وقُلْنَ: «حاشا لله أن يكون هذا بشرًا، إِنْ هذا إلا مَلاك أصيل»[16].
يُفسِّر معظمُ مفسِّري القرآن هذا الموضع بأن المقصود هنا بالثمرة هي ثمرة الأُتْرُجّ[17][18]؛ ونظرًا لأن الأُتْرُجّ لم يكن معروفًا على الإطلاق في شبه الجزيرة العربية، عشية ظهور الإسلام، فإنّ هذا يعدّ بالضرورة مصدرًا يهوديًّا قديمًا[19].
من الجدير الإشارة إلى أنّ هذه القصة وردَت بتغييرات بسيطة في مِدراش تنحوما[20][21]، ويبدو أن كاتب القرآن عَرَف أو سمع بهذا المِدراش اليهودي وأدخله إلى النصّ. كما من المحتمل جدًّا أنه كان هناك تراث يهودي أصلي آخر تمّ نسيانه مع مرور الوقت، لكنه ظهر في التراث الإسلامي، إلا أنّ محاولات تَتبُّعِه تعدّ عملًا صعبًا، وإمكانية استعادته تعدّ أمرًا مشكوكًا فيه.
من أمثلة التأثير اليهودي- النصراني في القرآن أيضًا، استخدام حبة الخردل كوحدة وزن صغيرة جدًّا، ومع ذلك يمكن القول بأنّ هذا مصطلح عالمي، منتشر في ثقافات مختلفة. فمن الناحية الفيلولوجية يوجد تشابه بين المصطلحين العِبري والعربي؛ فالخردل مذكور في القرآن باسمه العربي (خردل): ﴿يَا بُنَيَّ إِنَّهَا إِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ﴾ [لقمان: 16].
وكما هو معروف فإنّ التعبير (حبة خردل) كوحدة وزن صغيرة، منتشر في المصادر اليهودية والنصرانية القديمة، مثلًا في المِشنا يرِد: «وحتى حبة خردل وأقلّ من ذلك» (ה. ב: השווהלבבלי, ברכותלאע״א). كما أنّ هذا المصطلح وردَ عدة مرات في العهد الجديد باسم «حبة من خردل» (מתייג 31, יז 20: לוקסיג 19,יז 6). وقد استُخدمت بذرةُ الخردل رمزًا لأنها «الأصغر مِن بين البذور التي على الأرض» (מרקוסד 31).
شجرة المعرفة:
اتّباعًا للقصة المِقرائية يُحكى في القرآن أيضًا عن التحريم الذي فُرض على آدم وحواء بعدم الأكل من شجرة المعرفة: ﴿وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ﴾ [البقرة: 35].
لم يصرِّح القرآن باسم الشجرة المُحرَّم الأكل من ثمارها، لكنّ المفسِّرين المسلمين يذكرون عدّة أسماء، ومن بين التفاسير الأكثر شيوعًا أنها: الحِنطة (البابونج أو البُرّ)، أو الكَرْم، أو التين، أو كلّ شجرة تؤكل ثمارها[22].
كلّ هذه المقترحات لتفسير وتعريف (شجرة المعرفة) معروفة بالفعل في الأدب الخارجي[23][24] والتلمودي[25]. ووفقًا لهذا الطرح فإنّ جنة عدن هي مكان أرضيّ، وشجرة المعرفة هي إحدى الزروع الأساسية بها[26].
بالإضافة إلى التوصيفات اليهودية الشائعة في تفاسير القرآن، فإنّ هناك أشجارًا أُخرى يَرِدُ ذِكْرها لتحديد شجرة المعرفة، فيذكر الطبري مصدرًا وحيدًا يَرِدُ فيه أنها شجرة الزيتون. وهناك مَن نسبوا شجرة المعرفة لنباتات عطرية نادرة؛ مثل نبات النرد (سنبله)[27]، و(الكافور)[28].
التجلِّي لموسى من الشجرة (الشُجيرة المُشتعلة):
تُذكَر القصة المِقرائية حول تجلِّي الربّ لموسى من الشجيرة المشتعلة بالقُرب من جبل سيناء (الخروج، 3/ 1- 4) في القرآن أيضًا: ﴿فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَى * إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى﴾ [طه: 11- 12]. وعلى غرار الوصف الضبابي لشجرة المعرفة بالمِقرا، فإنّ توصيف الشجيرة المشتعلة بالقرآن جاء غير واضح أيضًا. وقد طُرحت الكثير من التفسيرات لهذا النوع من الزروع[29]، وكذا عدد من التوصيفات الإسلامية. في حين أنّ التوصيفين الأوّلين الآتيين هما الأكثر قبولًا، وهما:
أ) (العوسج): وهو صفة عربية لشجيرة الشوك (Lycium)، أو شجرة الزعرور البري (Rhamnus). ويذكر التراث الإسلامي القديم بالتفصيل أنّ بعضًا من (أهل الكتاب) (اليهود والنصارى) يقولون إنها العوسج[30][31]. كما أنّ (الفاسي) المُفسِّر القرَّائي من القرن العاشر يُفسِّر الشجيرة المشتعلة بأنها (العوسج)[32]. ويبدو أنّ المقصود هو وصفٌ يهودي، لكنّ (الفاسي) في كتاباته اللغوية أكثَرَ من استخدام المصادر الربَّانية[33].
ب) (العُلِّيق)[34]: وهو التوت المُقدَّس (Rubus sanctus)[35].
ج) (العِنَّاب): وهو العِنَّاب المزروع (Ziziphus jujuba)، الشبيه للسِّدر (Ziziphus spina- christ). وهذا الوصف شائع فقط في التفاسير المتأخرة[36].
وفقًا للتفسيرَيْن الأوّلين فإنّ المقصود هو شجيرة شوكية غير مُفيدة، وهو ما يتوافق مع أوصاف الشجيرة المشتعلة في المِدراشيم اليهودية[37][38]. أمّا التفسير الثالث فمتأخّر، ويمثِّل -فيما يبدو- توصيفًا إسلاميًّا أصيلًا.
الخضراوات:
توجد القصة التي تصف شكاوى بني إسرائيل بالصحراء (التثنية 12/ 5) في القرآن وفقًا للرواية الآتية:
"משה קצה נפשנו לאכל מאכל אחד קרא לנו אל אלהיך והוצא לנו מאשר תצמיח הארץ מחצירה וקשואיה ושומיה ועדשיה ובצליה"، «يا موسى لقد سَئِمْنَا من طعامٍ واحد، فَلْتَدْعُ لنا إلهكَ ليُخرج لنا مما تُنبت الأرض من دريسها وقثائها وثومها وعدسها وبصلها»، وهذه الفقرة أخذناها من ترجمة ريفلين للقرآن، لكن الفحص للمصدر العربي يُظهر أن ترجمة ريفلين لم تكن دقيقة، وأنه كان متأثرًا بالصُّوَر الواردة في النصّ المِقرائي ومن التفاسير الإسلامية المتأخرة؛ ففي النصّ الأصلي تُذكر خمسة أنواع من الخضراوات، وهي كالآتي:
أ) (البقل): وهو اسم عامّ للخضراوات أو لكلّ نبات أخضر يؤكل. وتوجد به فوائد طبية كذلك؛ مثل النعناع والكرفس و(الكُرَّاث) (كُرَّاث الثوم – Allium porrum)[39]. وهذا الزرع الأخير يشبه فيما يبدو (الدريس) المِقرائي (التثنية 12/ 5)[40].
ب) (قثاء) (Cucumis melo var.chate): وفي هذا المصطلح يمكننا أن نجد تشابهًا مع مصطلح الـ(קשואים الكوسة) بالمِقرا (التثنية 12/ 5)[41].
ج) (الفوم): وهذا المصطلح طُرحت حوله عدّة فرضيات: الحِنطة (البابونج أو البُرّ): الخبز، أو بذور الحِنطة التي يُعَدّ منها الخبز أو الثوم[42]، وهذا الوصف الأخير يتوافق مع الرواية المِقرائية.
د) (عدس): ويبدو أنّ هذا وصف أصيل في القرآن، والذي جاء بديلًا لـ(البطيخ) المذكور في الرواية المِقرائية.
هـ) (البصل): مثلما وردَ في الرواية المِقرائية.
على غرار ما وردَ في المِقرا؛ فإنّ الوصف المُفصَّل في القرآن لأنواع الخضراوات هذه يرِد في هذه الفقرة فقط. ومن الصعب أن نعرف ما هو مصدر التغييرات في النصّ القرآني المقابل للتوراة: فهل -وفقًا لكاتب القرآن- الحِنطة والعدس يتناسبان أكثر مع هذه القصة باعتبار أنهما مأكولات أكثر أهمية من الفوم والبطيخ؟ أم أنّ الكاتب وَفَّق ونَوَّع كلماته وفقًا لما كان شائعًا لدى الجمهور من سِلال الخضراوات في هذه المنطقة؟
يونس واليقطين:
وردَت قصة يونس في القرآن بتغييرات بسيطة: «وكان يونس من المُرسلين... فالتقمه الحوت... وألقيناه إلى (الشاطئ) العراء وكان سقيمًا وأنبتنا عليه زروعًا غليظة» (الآيات: 139- 146).
وردَ في المصدر العربي: ﴿وَأَنْبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِنْ يَقْطِينٍ﴾ [الصافات: 146]. وقد تُرجم هذا المصطلح إلى العبرية "קיקיון"[43] وفقًا للتفسير اللاتيني لسفر يونان[44]. أمّا المصطلح (يقطين) فيُنسب -بشكل عام- إلى الدُّبَّاء (Lagenaria vulgaris)، المعروف باسمه الشعبي (الدُّبَّاء- القرع الطويل) الذي استُخدم في الثقافات القديمة لإنتاج أدوات متنوعة، ومن بينها أوعية الطعام[45].
غير أنّ مفسِّري القرآن طرحوا عدّة آراء متنوّعة لشرح معنى المصطلح (يقطين)؛ فالطبري ومِن بَعْدِه بقية المفسِّرين قال إنه عند العرب المقصود هو مصطلح عام يشمل «كلّ زرع يمتدّ على وجه الأرض وليس له جذع؛ مثل: البطيخ، والقِثّاء، والحنظل، وما شابه ذلك»[46]. كما توجد توصيفات أخرى لهذا المصطلح، مثل: «كلّ زرع نما ويموت بعد ذلك في السَّنَة نفسِها» (سنويّ)[47]. أو «كلّ شجرة ليس لها جذع وتظلّ ما بين الشتاء إلى الصيف (نبات صيفي)... النبات الذي ينمو بالقُرب من سَكَنِ الإنسان... أو النبات العشوائي غير المُشرش في الأرض مثل التمر والزيتون... أو كلّ شجرة لها أوراق عريضة وكبيرة»[48].
نَسب غالبيةُ المفسّرين اليقطين إلى القرع (القرع أو الدُّبَّاء)[49]. وبالنسبة للرِّبي موسى بن ميمون، الذي كان فقيهًا بالأدب العربي، فقد وصف اليقطين بهذه الصفات نفسِها في كتابه حول أسماء الأدوية، فحول القرع كتبَ: «القرع: هو الدُّبَّاء، والشعب المصري يعرفه باسم اليقطين». وأضاف: «أنّه من الزروع التي لا ترتفع فوق جذع، وهي دائرية تمامًا أو شبه دائرية؛ مثل: الحنظل والبطيخ والقرع والفواكه الشبيهة لذلك، فكلّ هذه تُسمَّى (يقطين)»[50].
وقد أضافوا بدايةً من القرن التاسع عشر لهذه الأوصاف التينَ والموزَ اللذَيْن استظلّ بهما يونس، وجلس تحت أغصانهما، وكسر صومه بالأكل من ثمارهما[51]. أمّا نسبة الموز لليقطين، فلا شك أنه أمرٌ متأخّر؛ لأنّ هذا النوع من الزروع انتشر في كلّ أنحاء المشرق عقب دخول المسلمين فقط.
إجمالًا، فإنّ غالبية التفاسير والتوصيفات المختلفة التي طُرحت لتعريف اليقطين -القرع القرآني- توجد بها مضامين مشتركة؛ فالمقصود هو زرع عشبي يفتقر للأنسجة الداعمة المتقدّمة، أو نبات متسلّق، وله أوراق كبيرة وعريضة يُستظلّ بها، وينمو بسرعة، وفترة نموّه وازدهاره قصيرة خاصّة بالصيف. وهذه الأوصاف تتوافق مع الزروع من عائلة القرع والموز، وبشكل محدود مع شجرة التين التي تعدّ شجرة نفضية في الخريف[52] وذات أوراق كبيرة.
وهنا يجب أن نُرسي قاعدة عامة، وهي تلك المعروفة لكلّ من يشتغل بمجال البحث في توصيف الزروع في المصادر؛ إِذْ إنه لكلّ توصيف للزروع، حتى لو كان يبدو غريبًا أو مشكوكًا فيه، منطق معيّن يتعلّق بتعليل هذا التوصيف المذكور في النصوص المكتوبة. وفي هذه الحالات سابقة الذِّكْر تتوافق الزروع المختلفة المذكورة، سواء مع ما ورد في النصّ المِقرائي أو مع ما هو مكتوب بالقرآن وفي التفاسير المتأخرة جدًّا حول قصة يونس والقرع.
وحول ماهية القرع تحديدًا كزرع ينمو سريعًا وله أوراق كبيرة يُستظلّ بها من الشمس الحارقة، يمكننا أن نجد في مِدراش يونا (כת״ידירוסי) : «وماذا فعلَ الربّ؟ أنبتَ قرعًا فوق رأس يونا ليلًا بينما هو نائم، وفي الفجر أورقَت فوقه مائتان وستٌّ وسبعون ورقة، كلّ ورقة تساوي مساحة كفّ اليد الواحدة، ويمكن لأربعين شخصًا أن يناموا بظلّ هذا القرع للاحتماء من الشمس»[53].
هناك رأيان حول تعريف القرع؛ الأول: وهو الأكثر شيوعًا في المصادر اليهودية المنتشرة اليوم، يُعرِّفونه على أنه شجرة الخروع (Ricinus communis)[54] المعروف بالاسم العربي (خروع)[55]، وهو تعريف غير مقبول في التراث الإسلامي.
أمّا الرأي الثاني فيُعرِّف القرع على أنه زرع من عائلة القرع شائع في الترجمة السبعينية باسم Kolokynthe. وهو من الزروع المألوفة في العالم الهلينيستي- الروماني. وهذا التراث احتفظ به القرآن وكان شائعًا أكثر في العالم الإسلامي. وعلى خلفية ذلك يمكن فَهْمُ لماذا اختار القرَّاؤون المعروفون بصِلَتهم بالشريعة الإسلامية أن يُعرِّفوا القرع على أنه اليقطين؛ فـ(يافث بن عليّ)، أحد كبار المفسرين القرَّائين، والذي عاش في النصف الثاني من القرن العاشر بأرض إسرائيل [فلسطين "المترجم"]، ترجم للعربية مصطلح (قرع) المذكور في سفر يونا إلى لفظة (قرعة)[56].
في مقابل ذلك، فإنّ (دانيال القومسي) الذي عاش في أرض إسرائيل [فلسطين "المترجم"] نهاية القرن التاسع وبداية القرن العاشر[57] وكان معروفًا بصِلَته بالإسلام، فسَّر «قرع - خروع»[58].
يشير هذان التعريفان المختلفان إلى أنّ المفسّرين القرَّائين نهلوا من التأثير الإسلامي وحده أكثر من التفاسير الربَّانية التي كانت منتشرة في عصرهم. إلا أنه في فترة متأخرة جدًّا أصبحت التفاسير القرَّائية أكثر استقلالًا، وأصبح المصطلح «קיקיון قرع» يظهر دائمًا مرتبطًا بالقرع. فعلى سبيل المثال (يهودا هداسي القرَّائي) (منتصف القرن الثاني عشر)، يذكر في كتابه حول وصف الأديان بالعالم أنّ «فرقة القرعية»[59] هم القرعيون، «الذين يستخدمون القرع للطهارة»[60]. في حين أنّ كاتبًا قرَّائيًّا آخر وهو إلياهو بشييتسي (توفي 1490) صاحب كتاب (فرائض القرَّائين)، كتب يقول ضِمن موضوع تحريم التهجين: «القرع يُطلق عليه קיקיון، وبلغة أخرى (قرا)، وبالعربية القرع... أمّا القرع اليوناني فهو القرع الموجود بمناطقنا...»[61].
كما نَسب عددٌ من المفسِّرين والمعجميين اليهود بالعصر الوسيط، الذين كانوا على دراية جيّدة بالأدب العربي، "הקיקיון" إلى (القرع)، ولربّما أنّ ذلك عائد إلى أنّ الأدب القرَّائي هو الذي استُخدم كعنصرِ وصلٍ ووسيط بين الثقافتين العربية والعِبرية[62]. فـ(ابن عزرا) (1090- 1164 تقريبًا)، في تفسيره لمصطلح "הקיקיון" (يونا 4/ 6) يقول: «يقول حاخامات إسبانيا إنه القرع، ولا داعٍ لمعرفة ما هو». وقد كان من المعروف تلك الانتقادات التي وجّهها ابن عزرا للتفاسير القرَّائية[63]، ولربّما حمَلَت طيّات كلامه إشارات نقدية على الأوصاف التي كانت شائعة في التفاسير القرَّائية حول هذا المصطلح.
على أيّة حال، فإنه في فترة متأخرة جدًّا، ذكر الكثير من اللغويين الربَّانيين الآخرين، غالبيتهم من إسبانيا، هذا الوصف السابق، غير أنه بدايةً من القرن الثالث عشر خفتت، إلى حدٍّ ما، حِدّة الخلافات بين القرَّائيين والربَّانيين، وهو ما سهَّل مِن تسللِ التفاسير القرآنية - القرَّائية بشكل بارز إلى التفاسير اليهودية.
من جانبه أوردَ تنحوم اليورشليمي (عاش في القرن الثالث عشر) في معجمه، وأيضًا في تفسيره لسفر يونا رأيين مقبولين لتعريف "הקיקיון"، وهما: (الخروع)، و(اليقطين) (قرع)[64]. كما وردَ في قاموس آخر من العصر الوسيط، أنه: «קיק־קיקיון[65]... وهناك مَن يُفسِّرُه أنه القرع، وهناك من يفسِّرون أنه نوع من الفاكهة التي يُصنَع الزيت من بذورها»[66]. وكذلك كتبَ سعديا بن ميمون بن دنان (النصف الثاني من القرن الخامس عشر)، واقترح «الخروع... وهناك من يقولون القرعة»[67].
أمّا الحاخام بِحيي بن إشر بن حلاوة (توفي 1340 تقريبًا)، فقد أوردَ في كتابه (קדהקמח جرّة الدقيق) حول "הקיקיון" تعريفًا على أنه القرع فقط. وقال: «وهو شجرة القرع ذات الأوراق العريضة والظلّ الوارف. فقد وردَ مكتوبًا: "وأنبتَ الربُّ الإلهُ من الأرض كلَّ شجرة شهية" (التكوين 2/ 9)؛ إِذْ فعلَ في هذه الشجرة مثلما فعلَ بأشجار جنة عدن التي خُلقت كبيرة الجسم والقامة»[68].
وربما تكون الصِّلَة الظاهرة بين صورة "הקיקיון" وأشجار جنة عدن، تمثِّل تفسيرًا لماذا نَسبه المفسِّرون المسلمون للزروع ذات الأوراق العريضة مثل التين أو الموز. فكما ذكرنا سابقًا فإنه في التراث اليهودي ومِن بعدِه التراث الإسلامي كانت شجرة التين إحدى الأشجار المقترحة لشجرة المعرِفة بجنة عدن. أمّا في العصر الوسيط تم الربط بين شجرة الموز وقصص جنة عدن.
على سبيل المثال، كتب الحاخام مناحم دي لونزانو من القرن السادس عشر، حول الموز: «الموز: فاكهة معروفة بسوريا ومصر، وبالعربية تُنطق موز، وبالأجنبية تفاح جنة عدن». وبالنسبة لاسمي الموز: (موز)، و(تفاح جنة عدن)، فهما مصدر اسمه العلمي باللاتينية: "Musa paradisiaca".
كما أنّ مصدر هذا الاسم يوجد في المعتقدات الشعبية التي نشأت حوله من طرف أشخاص بالعصر الوسيط، مثلما أشار الحاج النصراني فليكس بفري من القرن الخامس عشر: «حول هذه الشجرة، فكلّ النصارى الشرقيين، وعبدة الأصنام (المسلمين)، واليهود؛ يؤمنون أنه بسبب هذه الفاكهة لم يَنْصَعْ آدم وحواء بجنة عدن (للأمر الإلهي بعدم الأكل من ثمر شجرة المعرفة)»[69].
الخلاصة:
لُوحظ تأثير التفاسير اليهودية على التفاسير الإسلامية حول الزروع المِقرائية المذكورة في القرآن، مثال ما ذُكر حول (شجرة المعرفة)، أو (الشجيرة المشتعلة)، هذا إلى جانب وجود تفاسير إسلامية أصيلة ومستقلّة. ومؤخرًا، وعَقِب ازدهار الأدب العربي، أصبح بإمكاننا تمييز وجود مسيرة تأثير عكسية، تتمثّل في تأثُّرِ التفاسير اليهودية بالتفاسير الإسلامية.
كما مكَّنَنا تعريف "הקיקיון" على أنه (يقطين)، أو (قرع) مِن تتبُّعِ إحدى مراحل التفاسير المِقرائية؛ ففي الحالة سابقة الذِّكْر استُخدمت التفاسير القرَّائية كحلقة وصل وسيطة بين التفاسير الإسلامية والتفاسير اليهودية[70].
[1] كتب هذه المقالة، البروفيسور زوهار عمّار، الأستاذ بقسم دراسات أرض إسرائيل والأركيولوجيا بجامعة بار إيلان الإسرائيلية.
[2] نشرت هذه المقالة في دورية (בית המקרא)حول أبحاث المِقرا وعالمها، المجلد الأول، مؤسسة بياليك، القدس، يونيو 2018، الصفحات: 67- 77، وترجم المقال، د/ أحمد صلاح البهنسي، أستاذ الديانة اليهودية والأديان المقارنة بقسم اللغات الشرقية بكلية الآداب بالقاهرة، له عدد من المؤلفات المنشورة.
[3] مصطلح ديني يهودي يشير إلى (الشريعة المقروءة) أي: العهد القديم، ويقابله (الشريعة الشفوية) أي: التلمود. (المترجم)
[4] حول الزروع في القرآن بشكل مختصر. انظر:ע׳לעף׃I.Low, Die Flora der Juden, IV, Vienna- Leipzig 1934, pp 66- 68.
[5] מוחמדבןג׳ריראלטברי. ג׳אמעאלביאןעןתאוילאלקראן. מצרים 1954.(להלן׃טברי). מחמדבןמחמדבןג׳עפראלטוסי.תפסיראלתביאניפיתפסיראלקראן. נג׳ף 1957- 1963 (להלן: טוסי). אבןאלקאסםמחמודאלזמח׳שרי.אלכשאףעןחקאיקאלתנזיל. מצרים 1972. (להלן: זמח׳שרי). עבדאלרחמןאלעליאבןג׳וזי. זאדאלמסירפיעלםאלתפסיר. בירות 1964- 1965. (להלן: אבןג׳וזי).פח׳ראלדיןאלראזי. אלתפסיראלכביר. בירות 1990..(להלן: ראזי). עבדאאלהבןעמראלביצ׳אוי .תפסיראלקאדר (מהדורתFleischer H. O) .אוסנבריק (גרמניה) 1968.(להלן: ביצ׳אוי). אבןכת׳יר. תפסיראלקראןאלמעט׳ם.בירות 1970. (להלן: אבןכת׳יר). תפסיראלג׳לאלין، בירות 1967 (להלן: ג׳לאלין).
[6] ג׳לאלאלדיןאלסיוטי.מקאמאתאלסיוטי.בירות 1986 (להלןסיוטי).
[7] انظر على سبيل المثال: א׳שלוסברג. "השפעותאסלאמיותעלפרשנותהמקראשלימי- הבינים".מחניים (סדרהחדשה)، 1 (תשנ״ב)، עמ׳ 92- 105: מ׳צוקר، עלתרגוםרס״גלתורה، ניו- יורקתשי״טעמ׳ 229 ואילך: י׳בלאו، "ביןערביתיהודיתלקוראן". תרביץ. מ (תשל״א) עמ׳ 512- 514.
[8] فرقة يهودية ظهرت في بغداد إبّان حكم العباسيين، وتأثرت كثيرًا بالإسلام والقرآن، وتمرّدت على اليهودية التقليدية برفضها التلمود، ويقابلها (الربَّانيون) الذين يتمسكون بالتلمود. (المترجم)
[9] حول ملخّص آراء الباحثين عن مصادر القرآن، انظر: ש״דגויטין. "מיהיורבותיוהמובהקיםשלמחמד؟"، תרביץ، כג (תשי״ב). עמ׳ 146- 159: א״יכץ، היהדותבאיסלאם، ירושליםתשי״זעמ׳ 1- 10: ח׳לצרוסיפה،פרקיםבתולדותהערביםוהאסלאם.הוצאתרשפים 1984 עמ׳47- 49. وحول التراث الإسلامي اليهودي الإسلامي المشترك أيضًا، انظر: ח׳שוארצבאוםממקורישראלוישמעאל، יהדותואסלאםבאספקלריתהפולקלור.תל- אביב 1975: א״שזאוי. מקורותיהודײםבקוראן، ירושליםתשמ״ג. حول الوجه التشريعي، انظر:ח׳לצרוסיפה،"ביןהלכהביהדותלהלכהבאסלאם" תרביץ. נא (תשמ״ב) עמ׳ 207- 225.
[10] י״יגולדציהר، הרצאתעלהאסלאם.ירושליםתשי״א. עמ׳ 10- 11.
[11] ينطلق الكاتب هنا مما درج عليه معظمُ الدارِسين الغربيين للقرآن، من كون القرآن له مؤلِّف بشري، قام بجمع النصوص السابقة والتأليف بينها لإنتاج القرآن، وهو ما يخالف الرؤية الإسلامية التي تنظر للقرآن ككتاب موحَى من الله، وجدير بالذِّكْر أن فرضية المؤلِّف ذاتها تخضع للنقد في بعض الدراسات المعاصرة، حيث إنها -وفق بعض الدارِسين- تهمّش دراسة القرآن ذاته إلى حساب دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. (قسم الترجمات)
[12] ח״זהירשברג، ישראלבערב.תלאביבתש״ו. עמ׳ 203- 241.
[13] مستشرقة إسرائيلية معاصرة لها كتابات حول الإسلام والقرآن، وخاصة مخطوطات القرآن بالعصر الوسيط. (المترجم)
[14] ח׳לצרוסיפה، האסלאם، ספריתהאוניברסיטההמשודרת، תל- אביבתש״מעמ׳ 12- 13 (להלן: לצרוס).
[15] نوع من الثمار الحمضية. (المترجم)
[16] אלקראן, בתרגום י"י ריבלין, תל־אביב תשמ"ז.في ترجمة ريفيلن للقرآن، فإنّ تقسيم الآيات في فصول القرآن (سور أو سورة) توجد به تغييرات وفقًا للتراث والنصوص المختلفة بالإسلام، وهنا اقتبسنا الأصل وفقًا لترجمة ريفلين حول سورة يوسف بالقرآن، انظر: נ. ברושי, סיפורי התנ"ך בציורהמוסלמי, ירושלים תשנ"ב, עמי 29.
[17] انظر على سبيل المثال: טברי יב עמי 202: טוסי, ו עמי 131: זמח'שרי ב עמי 316: אבן ג'וזי ד עמי 217- 216: ראוי יח 102: ביצ'אוי א עמי 458: סיוטי עט' 53- 50.
[18] لم ترد في تفسير الطوسي كما ذكر المؤلّف في هامش النصّ. (المترجم).
[19] לצרוס עמי 13- 12; ב"ש גרסיאל, "מחזור סיפורי יוסף במקרא ובקוראן", בית מקרא, קמט (תשנ"ח), עמי 170- 153.
[20] מדרש תנחומא (ילמדנו), מהדורת ח' וונדל, ירושלים תשכ"ט, פרשת וישב, ה (עמי מז). وفي طبعة בובר, ניו־יורק תש"ו, לא، لم يظهر هذا الجزء.
[21] مجموعة من الشروح والتأويلات لأسفار التوراة. (المترجم)
[22] טברי א עמי 233- 231; זמחישרי א עמי 273; אבן ג'ווי א עמי 66; ראזי ג עמי 7- 6; ביד'אוי א עמי 52: ג'לאלין. وحول هذه الفقرة: «لم يقل ما إذا كانت (شجرة)، وهل هي القمح أو الكَرْمة (الكَرْم) أو خلافهما؟».
[23] انظروا الكتب الخارجية ר (מהדורתא' כהנא) ירושליםתש"ל: شجرة المعرفة هي الكَرْمةחזון ברוך בי,ד, ה ואילו בفي كتاب حانوخ 12, 23/ 4 قيل: «تشبه هذه الشجرة في علوّها التنوب [شجرة شوكية "المترجم"] وأوراقه تشبه ورق الخروب، وثمره يشبه الكرمة، وريح هذه الشجرة تُشَمّ من بعيد».
[24] المتعلق بالأسفار غير القانونية. (المترجم)
[25] انظر على سبيل المثال: בבלי, ברכותמע"א: סנהדריןעע"א- ע''ב.بالإضافة لذلك تنتشر في مصادرنا أيضًا الأترج منسوبًا إلى شجرة المعرفة. انظر: מדרשבראשיתרבה, פרקטו, מהדורתי' תיאודורוחיאלבק, א, ירושליםתשכ''ה, עמי 142- 139: פסיקתאדרבכהנא, פרקכ, מהדורתש' בובר, ניו־יורקתשייטעמיקמ''ב: פסיקתארבתי, פרקמב, מהדורתאיש־שלום, תל־אביבתשכ"געמיקע״ה. وقد رأوا أن شجرة الجوز هي شجرة المعرفة، وصدى ذلك يمكن أن تراه، ربما، في: בסדור רב עמרם השלם(מהדורת א' פרומקין), ירושלים תרע"ב, בהקשר לברכת ארוסין ונשואין: "ברוך אתה ה' אמ"האשר צג אגוז בגן עדן".
[26] انظر أيضًا: י' הורוביץ, גןהעדןבקוראן, כתביהאוניברסיטהוביתהספריםבירושלים, ירושליםתרפ"ג: ז' עמר, "החיטהכעץהדעת — הגיונושלזיהוי", סיני, (בדפוס).
[27] טבריאעמי 233- 231: אבןג'וזיאעמי 66: ראזיגעמי 7- 6. حول التعريف بالخزامي، انظر: רבינו משה בןמימון, שרה אסמאא אלעקאר, מהדורת M.Meyerhof, קהיר 1940. תרגום לעברית יצא על־ידיז' מונטנר, ביאור שמות הרפואות, ירושלים תשכ"ט, מספר 265, עמי 77. [להלן: הרמב"ם ביאור(.
[28] אבןג'וזיאעמי 66. يبدو أن المقصود قرفة الكافور (Cinnamomum camphora).
[29] انظر: י' פליקס, "סנה, עצי שטים ומן", בתוך: גבירצמן ואחרים (עורכים), סיני, א, הוצאת משרדהבטחון, תשמ"ז, עמי 535- 533.
[30] טברי כ עמי 71: ראזי כד עמי 211: אבן כתייר ה עמי 278.
[31] لم ترد في تفسيري الرازي وابن كثير كما ذكر المؤلّف في هامش النصّ. (المترجم)
[32] דוד בן אברהם אלפאסי, כתאב ג'אמע אלאלפאט', ב, (מהדורת S.L. Skoss), פילדלפיהתרצ"ו- תש"ה, עמי 335. [להלן: אלפאסי).
[33] انظر: א' טאובר, "המקורות הרבניים לפירושו של הקראי אלפאסי לתורה", ספר חמ"י גבריהו,החברה לחקר המקרא בישראל (ב"צ לוריה עורך), ירושלים תשמ"ט, עמי 378- 367.
[34] טברי כ עמי 71; אבן כתייר ה עמי 278: אבן מנט'ור, לסאן אלערב, י, ערך יעלקי, ביירות 1956, עמי 265. حول أحجار الشجيرة المشتعلة (عليق) في التراث الإسلامي، انظر أيضًا ملاحظتي: (الأحجار العجيبة من جبل سيناء), קתדרה, 52 (תשמ"ט), עמי 182- 181.
[35] لم تَرد عند ابن كثير كما ذكر المؤلّف في هامش النص. (المترجم)
[36] ג'לאלין לסורה כח 30. על צמחים אלה, ראה י' פליקס, כלאי זרעים והרכבה, תל־אביב תשכ"ז,עמי 105- 103.العنّاب المعروف بأسمائه المختلفة: سدر، دوم، نبق. ذُكر بالتفصيل بالقرآن باسم (السدر). وفي الترجمة العبرية للقرآن لريفلين تظهر هذه الشجرة باسم بلّوط.
[37] حول (السنية)[الشجيرة المشتعلة "المترجم"] كشجرة شائكة. انظر مثلًا: בשמותרבהב: פרקירביאליעזרפרקמי. وهو اسم يناسب جدًّا وصف نبات العُلِّيق المقدَّس.
[38] مجموعة من الخطب والمواعظ والتفاسير اليهودية. (المترجم)
[39] انظر، مثلًا: זמח'שרי א עמי 285- 284.
[40] انظر: י' פליקס, עולם הצומח המקראי, רמת־גן 1968, עמי 175- 174. [להלן: פליקס עולם).
[41] انظر: פליקס עולם עמי 168- 166, השווה אלפאסי ב עמי 579.
[42] טברי א עמי 312- 310: טוסי א עמי 275: זמחישרי א עמי 285- 284: ראזי ג עמי 93: ביצ'אוי א עמי62:אבן כתייר א עמי 176.
[43] مصطلح عبري يشير إلى القرع. (المترجم)
[44] Biblia Sacra Polyglotta, London 1657.
[45] انظر:ש' אביצור, "כלי דלעת", טבע וארץ, ה (תשכ"ג), עמי 32- 27.
[46] טברי כג עמי 103- 102; טוסי זז עמי 530; זמח'שרי ג עמי 353; אבן ג'וזי ז עמי 89- 88; ראזי כועמי 145- 144: סיוטי עמי 26- 21.
[47] טברי כג עמי 103- 102.
[48] טוסי ח עמי 530.
[49] טברי כג עמי 103- 102: טוסי ח עמי 530; זמח'שרי ג עמי 353; אבן ג'וזי ז עמי 89- 88; ראזי כועמי 145- 144: ביצ'אוי ב 178; אבן כתייר ו עמי 37- 36; אבן אלקים אלג'וזיה, אלטב אלנבוי, קהיר1987, עמי 445.
[50] הרמב"ם ביאור, מספר 332, עמי 94.
[51] זמח'שרי ג עמי 353; ביצ'אוי ב עמי 178.
[52] أي: تسقط أوراقها خلال الخريف وتورق في الربيع. (المترجم)
[53] 38 י"ד איזנשטיין, אוצר המדרשים, ניו־יורק תרפ''ח, א עמי 222.
[54] حول هذا التعريف، انظر: פליקס עולם, עמי 138- 136.
[55] انظر: הרמב"ם, ביאור מספר 396.
[56] יפת בן עלי, תרגום ערבי לנביאים(יונה ומלאכי), כתב־יר לונדון מספר 288. במכון לתצלומי כתביד, הספריה הלאומית בירושלים, סימן 6065, עמי 17 ע"ב- 18 ע"א.
[57] حول فترة حياة دانيال القومسي، انظر: ח' בךשמאי, "שרידי פירוש דניאל לדניאל אלקומסי כמקורהיסטורי לתולדות ארץ־ישראל", שלם, ג(תשמ"א), עמי 307- 295.
[58] דניאל אלקומסי, פתרון שנים עשר, פירוש לתרי עשר(מהדורת י"ד מרקון), ירושלים תשי"ח, עמי 42.
[59] فرقة دينية يهودية أُطلق عليها هذا الاسم لاستخدامها القرع في الطهارة، أو لأنهم يُنسبون إلى يوحنان بن قِرَح الذي هاجر من فلسطين إلى مصر زمن النبي أرميا. (المترجم)
[60] ר' יהודה הדסי, אשכול הכופר (מהדורת גוזלוון), 1836, בפרק צו וכן ראה במבוא עמי ג ע"ד.
[61] אליהו בשייצי, אדרת אליהו, ישראל 1966, עמי 394, אות ד' וכן שם עמי 396 באות קי.
[62] حول هذا الموضوع، انظر: ר' דרורי, ראשית המגעים של הספרות היהודית עם הספרות הערבית במאההעשירית, תל־אביב 1988.
[63] انظر أمثلة عند: ע"צ מלמד, מפרשי המקרא, ב, ירושלים תשל"ח, עמי 595- 592. حول حرب ابن عزرا ضد القرّائين، انظر بشكل خاص: פ"ר וויס, "אבן עזרא והקראים בהלכה", מלילה, א(1944) עמי 53- 35; ב (1946), עמי 134- 121; ג- ד (1950), עמי 203- 188.
[64] ה' שי, 'אלמרשד אלכאפי לר' תנחום בר' יוסף הירושלמי', חיבור לשם קבלת תואר רוקפורלפילוסופיה, האוניברסיטה העברית, ירושלים תשל"ה, ערך קיק: הנ"ל, פירוש תנחום בן יוסףהירושלמי לתרי־עשר, ירושלים תשנ"ב, עמי 125- 124.
[65] آثرنا إبقاء هذا اللفظ العِبري؛ لأنه ليس له مقابل واضح في اللغة العربية. (المترجم)
[66] 177 ..1987, p Un Diccionario Hebreo de Provenza (siglo xiii) (A.Saenz - Badillos ed.), Granade
[67] סעדיה בן מימון אבן דנאן, מילון שרשים, כתב־יד אוכספורד- בודליאנה מספר 1492 .Bodl. or612). במכון לתצלומי כתב־יד, הספריה הלאומית בירושלים, סימן 16411.
[68] כתבי דבינו בחיי(מהדורת ח"ד שעוואל), ירושלים תש"ל, עמי רכא.
[69] J.Masson, Voyage en Egypte de Felix Fabri 1483, III, Alexandrie 1975, p. 902.
[70] جدير بالإشارة أن المادة كانت مذيّلة بعدد من اللوحات، والتي تم حذفها هنا حيث لا تمثّل ارتباطًا وثيقًا بالمادة. (قسم الترجمات)
كلمات مفتاحية
الكاتب:
مواضيع ذات صلة
((المعلومات والآراء المقدَّمة هي للكتّاب، ولا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع أو أسرة مركز تفسير))