التوراة المكتوبة والقرآن الشفهي في مكة الوثنية
تفسير الآية 91 من سورة الأنعام
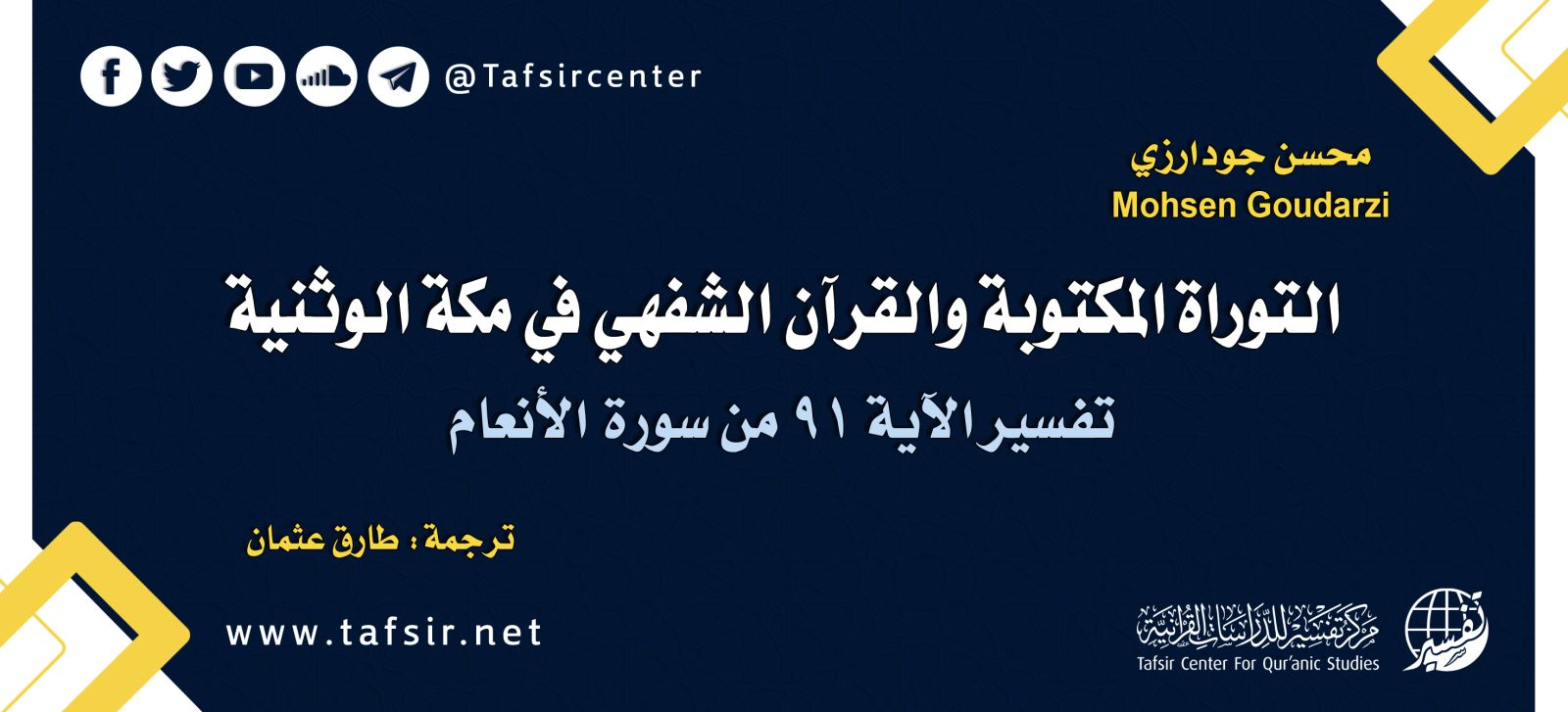
التوراة المكتوبة والقرآن الشفهي في مكة الوثنية
تفسير الآية 91 من سورة الأنعام[1][2]
محسن جودارزي[3]
مقدّمة:
حينما شرع العلماء الأوروبيون -في صدر الزمن الحديث- في وضع أُسُس دراسة القرآن دراسةً مُفصّلةً باللّغات الأوروبية، اعتمدوا اعتمادًا كبيرًا على كُتُب التفسير التراثية. على سبيل المثال، استشهد المستشرق الإيطالي لودڤـيكو مرتشي (1612- 1700م) في تحقيقه وترجمته اللاتينية الرائدة للنصّ القرآني، بغزارة بتفاسير كثيرة، منها: تفسير ابن أبي زمنين (ت: 1008م)، وتفسير الثعلبي (ت: 1035م)، وتفسير الزمخشري (ت: 1144م)، وتفسير البيضاوي (ت: حوالي 1300م)، وتفسير الجلالين لجلال الدين المحلي (ت: 1459م) وجلال الدين السيوطي (ت: 1505م)[4]. لكن على مدار القرنَيْن الثامن عشر والتاسع عشر، تخلّى العلماء الغربيون تدريجيًّا عن اتخاذ كتب التفسير دليلًا يهتدون به في فهم النصّ القرآني. ويمكن إرجاع ذلك إلى عوامل شتّى؛ أولًا: أصبحت مصادر المفسِّرين -ككتب النحو والمعاجم، ومصنفات الحديث والشِّعْر، وكتب التاريخ- في متناول يدِ العلماء الأوروبيين، على نحو متزايد؛ ولذلك راحوا يَنْهَلون منها مباشرة بدلًا من الاعتماد على كتب التفسير[5]. وثانيًا: بفضل تطوّر فقه اللغات الساميّة، ونَشْر الكثير من النصوص الكتابية غير المعتمدة والنصوص الدينية اللاحقة على الكتاب المقدّس المعتمد، صار من الممكن دراسة القرآن باستعمال مناهج ومصادر لم تكن متوفّرة عمومًا بين أيدي المفسِّرين. وثالثًا: أدّى تراكم الدراسات الغربية عن القرآن في القرن التاسع عشر إلى تنحية كتب التفسير جانبًا، إِذ اتُّخِذ من هذه الدراسات المتزايدة مرجعًا معتمدًا جديدًا للدراسات اللاحقة عن القرآن في الأكاديميا الحديثة[6]. ونتيجة لذلك، تُعْرِض الدراسات القرآنية الغربية الأدبية والتاريخية عن درس المصنّفات الإسلامية الكثيرة المكتوبة عن القرآن درسًا مفصّلًا وشاملًا[7]. وإذا ما درستْ كتب التفسير والقراءات (وغيرها من علوم القرآن)، فإنها تدرسها بغرض رسم ملامح تاريخ علم التفسير والفكر الإسلامي في المقام الأول، دون أن تتخذها دليلًا لاستكشاف معاني القرآن، إلا في أضيق الحدود. وهكذا، أعطتْ كتبُ التفسير دفعةً لحقل الدراسات القرآنية الأكاديمية في مراحل نشأته الأولى، لكن لم يَعُد لها مكانٌ كبيرٌ في مراحله التالية.
ومع ذلك، تحتوي مدوَّنة علوم القرآن الهائلة -وخاصّة كتب التفسير والحواشي الكثيرة وكتب القراءات- على فوائد جمّة، يمكن لدارِسِي القرآن في الأكاديميا الغربية أن يستفيدوا منها. فلقد بُنِي هذا الصَّرْح على يدِ علماء ضالعين في الأدب العربي، ومنغمِسِين في دراسة القرآن، وقرّاء مدقِّقين له، قضوا سنين في تدبّره. ولقد أسفرت جهودُهم الجماعية عن هذا المستودع التحليلي الضخم، الذي يحوي كثرة من الأقوال ووجهات النظر في كلّ آية من آيات القرآن. ومن خلال دراسة آية محدّدة، يبيّن هذا البحث أنّ تحليل كتب التفسير التراثية من شأنه أن يُثري دراسات القرآن الغربية، وأن ينبهنا إلى حلول جديدة للإشكالات التي تقابلنا أثناء سعينا لفهم القرآن. ولذلك، ينبغي -كقاعدة منهجية- لأيّ دراسة مفصّلة للنصّ القرآني أن تحلّل التفاسير التراثية بتمعّن، ليس بالنظر في قلّة من التفاسير الشهيرة، وإنما بالنظر في طيفٍ واسعٍ منها يُظهر شيئًا من التنوّع المذهبي والمنهجي والتاريخي في هذا الفنّ.
الإشكال:
يُروى في أحد الأخبار أنّ حبرًا من يهود المدينة، يُسمَّى مالك بن الصيف[8]، قد خرج مع نفر إلى مكة معانِدين ليسألوا النبيَّ محمدًا عن أشياء، وقد كان اشتغل بالنّعم، وترك العبادة، وسَمِن. فأتَى رسولَ الله ذات يوم بمكة، ولأنّ النبيّ على عِلْمٍ بمقصده الـمِرائيّ بادره سائلًا: «أَنشُدُك الله، أمَا تجد [مكتوبًا] في التوراة أنّ الله يُبْغِض الحبر السمين؟»[9]، فأجاب مالك بـ«نعم»[10]. فقال له النبيّ: «فأنت الحبر السمين، قد سمنت من مأكلتك»[11]. فضحك به القوم وخجل مالك، وقال: «ما أنزلَ اللهُ على بشرٍ من شيء!»، فبلغ ذلك اليهود فأنكروا عليه، فقال: «إنه قد أغضبني»، فقالوا: «كلّما غضبت قلت بغير حقّ وتركت دينك؟!» فأخذوا الرياسة منه وجعلوها إلى كعب بن الأشرف[12].
لا شيء يبدو أشد تحييرًا من حبر يهودي ينكر نزول التوراة على موسى، لكن هذه القصة قد استُعملت لتفسير آية قرآنية محيّرة أيضًا، وهي الآية 91 من سورة الأنعام. هذا هو نصّ الآية، مجزّءًا، بقراءة حفص عن عاصم:
أ. وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِنْ شَيْءٍ
ب. قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى نُورًا وَهُدًى لِلنَّاسِ
ج. تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ تُبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا
د. وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ
هـ. قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ
تبدأ الآية بالنكير على من قالوا: ﴿مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِنْ شَيْءٍ﴾، ويبدو هذا القول متلائمًا مع خصوم النبيّ المشركين (أو الوثنيين). لكن لدحض هذا الزعم، تستشهد الآية بسابقة نزول التوراة، ﴿الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى﴾، وتُذَكِّر المخاطبين أصحاب هذا الزعم بأنهم يجعلون هذه التوراة قراطيس يبدونها لكن يُخفون كثيرًا منها. ويشير هذا التفنيد إلى أنّ الآية تخاطب اليهود؛ نظرًا لأنّ التوراة المكتوبة تحتلّ مقامًا رفيعًا في التعلُّم والتعبُّد اليهوديَّيْن. لكن كيف يمكن لأهل التوراة أن يُنكروا إمكانية الوحي الإلهي؟ تقدِّم قصةُ المواجهة بين مالك والنبي محمد جوابًا واضحًا على هذا السؤال: مَن أنكر ذلك هو شخص بعينه، في نوبة غضب، ولقد وبّخه القرآنُ وقومُه على تفوُّهه بهذا القول الكُفري.
والحال أنّ المفسِّرين قد أَوْرَدوا روايات أخرى لهذه القصة -أو قصص أخرى- لتفسير سبب نزول هذه الآية من سورة الأنعام. ووفقًا لإحدى هذه القصص، لم تقع المواجهة بين مالك والنبيّ محمد وإنما بَيْنه وبين عمر بن الخطاب. ولم تقع في مكة وإنما في المدينة. ولم تنصبّ على ذمّ التوراة للحَبر الأَكُول الشَّرِه وإنما على ذِكْرها للنبي محمد. فحينما خاصمه عمر في أنّ النبيّ مكتوب في التوراة، غضب مالك وقال: «ما أنزل اللهُ على أحدٍ كتابًا»[13]. ووفقًا لخبر آخر، خصيم النبيّ الذي زعم أنّ اللهَ «مَا أنزلَ على بشرٍ مِن شيء» هو يهودي اسمه فنحاص (بن عازوراء)[14]. وعَزَتْ أخبار أخرى هذا القول إلى اليهود عمومًا، أو إلى اليهود والنصارى[15].
هذه قصص شائقة بلا شكّ، لكن يبدو أنها مختلَقة لتفسير الآية 91 من سورة الأنعام وليست وقائع تاريخية[16]. بل للمرء أنْ يشكّ أنَّ مالكًا شخصية أدبية وليس شخصية حقيقية؛ وذلك لأنّ المصادر لم تتفق على تفاصيل حياته الأساسية[17]. وعليه، تظلّ هذه الآية مُشكِلة؛ إِذ الظاهر أنها تخاطِب المشركين واليهود معًا. لم يلتفت بعضُ الباحثين إلى هذا الإشكال، وقالوا إنّ الآية تخاطب اليهود ببساطة، استنادًا إلى أنّ الشواهد التي تدلّ على ذلك أقوى من التي تدلّ على أنها تخاطِب المشركين. وتحديدًا، شدّد أنصار هذا القول على أنّ إشارة الآية إلى التوراة المكتوبة تستبعد، على ما يظهر، احتمالية أن يكون المشركون هم المخاطبين بها[18]. وبناءً على أنّ انتقاد القرآن لليهود يناسب السياق المدني وليس المكي، قال هؤلاء الباحثون: إنّ الآية 91 آية مدنيّة مُدرجة في سورة الأنعام المكية[19]، يقتضي هذا الحل (تقطيع) السورة، بعبارة تشارلز توري الموفقة[20].
وعمد آخرون إلى تقطيع السورة على نحوٍ أدقّ، وقالوا: إنّ الآية كلّها ليستْ إدراجًا مدنيًّا وإنما جزء محدّد منها فقط، وهو الجملة التي تخاطب اليهود على ما يظهر. على سبيل المثال، يرى ريتشارد بيل أنّ جملة: ﴿تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ تُبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا﴾ لم تكن جزءًا من الآية الأصلية، وإنما أُدرجت فيها لاحقًا بعد «تمام القطيعة مع اليهود»[21]. وتبنّى ريجيس بلاشير رأيًا مشابهًا، إِذْ قال: «إنّ جُملة: ﴿قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى نُورًا وَهُدًى لِلنَّاسِ﴾ لا بدّ أنها كانت متبوعَة مباشرة في الأصل بجوابها: ﴿قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ﴾»[22]. ووفقًا لهذا القول، تخاطب الآيةُ المشركين المكيّين المنكِرين للوحي في الأصل، لكن أُضيف إليها لاحقًا استنكار النبيّ لطريقة تعامل يهود المدينة مع التوراة[23][24].
يوجد قول آخر يرى أنّ الآية بأجمعها تخاطب خصوم النبيّ المشركين. ولقد دافعت باتريشا كرون[25] عن هذا القول في واحدة من آخر دراساتها، وفيها نجد أشمل تحليل لهذه الآية، في حدود عِلْمي[26]. ترى كرون أنّ التناقض الظاهر في هذه الآية نابع من تصوّرنا الخاطئ عن معتقدات المشركين الذين يخاطبهم القرآن. فخصوم النبيّ (المشركون) لم يكونوا عبَدة أوثان ينكرون الحياة الآخرة، وإنما كانوا موحِّدين عندهم عِلْم بالكتاب المقدّس، ويؤمن الكثير منهم بالبعث والحساب. واتخذت كرون من الآية 91 من سورة الأنعام حُجّة أساسية لتأييد نظريتها؛ لأنها تبيّن أنّ المشركين «كانوا يَنسخون [وحيًا موسويًّا] على برديات»[27]. وقالت إنّ الآية تتّهم المشركين بالتضارب أو النفاق؛ إِذْ يكفرون بالنبيّ بزعم أنّ الله «مَا أنزل على بشرٍ من شيء»، على الرغم من أنهم يؤمنون بالوحي الذي أُنزل على موسى. وعلى ذلك، خلصت كرون إلى القول: «إنه لا شك في أنّ المشركين كانوا -أو كان بعضهم على الأقلّ- من أتباع موسى»[28]. هذا التصوّر عن المشركين الذي خلصتْ إليه كرون مختلف جذريًّا عن التصوّر الشائع عنهم، ومع ذلك، استأنسَتْ بعض الدراسات الحديثة المهمّة بتحليلها لهذه الآية وباستنتاجاتها أو قَبِلَتْه قبولًا تامًّا[29].
الحل:
وهكذا، نجد أنفسنا أمام ثلاثة أقوال إشكالية في تفسير الآية 91 من سورة الأنعام؛ أولًا: تخاطب الآية اليهود لكنها تصفهم -على سبيل المغالاة في الهجوم السجالي- بأنهم منكرون للوحي. ثانيًا: تخاطب الآيةُ المشركين باستثناء جملة واحدة تخاطب اليهود: ﴿تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ تُبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا﴾ أُضيفت إليها لاحقًا دون مراعاة لاتساق النصّ. ثالثًا: تخاطب الآيةُ المشركين وبذلك تبيِّن أنهم كانوا ضليعين في النصوص الكتابية. لكن يوجد قول رابع، أراه أقوى من هذه الثلاثة، سأتوجّه الآن إلى مناقشته.
السبب الأساسي للقول أنّ الآية -في كلّيتها أو في جزء منها- تخاطب اليهود، هو جملة: ﴿تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ تُبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا [منها]﴾، التي تبدو موجَّهة إلى مخاطبين يهود على الأرجح. لكن توجد قراءة أخرى محتملة لهذه الجملة، وهي قراءة أفعالها المضارعة الثلاثة بصيغة الغائب وليس المخاطب: (يجعلونه قراطيس يبدونها ويخفون كثيرًا). والحقّ، أننا نجد هذه القراءة مرويّة في كتب القراءات عن عدد من القراء، منهم اثنان من أصحاب القراءات السبع المعتمدة، وهما: ابن كثير المكّي (ت: 120هـ)، وأبو عمرو بن العلاء البصري (ت: 154هـ)[30]. وتزيل هذه القراءة التحوّل الظاهر في المخاطبين بالآية، وتجيز لنا حمل الآية على أنها كلّها تخاطب المشركين[31]، وذلك على النحو الآتي: تنتقد الآيةُ المشركين على إنكارهم نزول الوحي الإلهيّ على البشر، وتستشهد بالكتاب المنزّل على موسى كمثال شهير على هذا الوحي، ثم تذكر أنّ الذين عُهِد إليهم بحفظ هذا الكتاب، أي التوراة، يكتبونها في صحف متفرِّقة. ولعلّ المقصود من هذا القول الأخير هو النصّ على أنّ التوراة -في شكلها المعاصر [للمشركين]، ولأغراض عملية على الأقل- متفرِّقة (في صحف أو لفائف منفصلة؟)، وليست متاحة لغير أهلها؛ ولذلك ليست أفضل حالًا من الوحي الشفهيّ المتفرِّق الذي ينزل على محمد.
والحال أنَّ المضمون العام لسورة الأنعام يؤيّد القول أنّ الآية كلّها تخاطب المشركين. فكما ذكرنا آنفًا، تُعَدّ هذه السورة مكية عمومًا؛ وذلك لأنها تركّز إجمالًا على نقد معتقدات المشركين وأعرافهم وسلوكهم تجاه النبي. على سبيل المثال: تستنكر السورةُ شهودَ المشركين أنَّ مع الله آلهةً أخرى [آية: 19]، ووصفهم تعاليم النبي بأنها أساطير الأوّلين [الآية: 25]، وإنكارهم البعث [الآية: 29]، وطلبهم معجزة من النبي [الآية: 37]، واستهزاءهم بالذين مَنّ الله عليهم باتّباع النبي [الآية: 53]، وردّهم الوحي المنزَّل على النبي، قبل كلّ ذلك بالطبع[32]. في المقابل، ترفع السورة من شأن أهل الكتاب على المشركين، وتوازن موقف المشركين من القرآن بموقف أهل الكتاب. على سبيل المثال: تذكر السورة أنّ الذين أوتوا الكتاب: ﴿يَعْرِفُونَهُ [أي: القرآن] كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمُ﴾ [الآية: 20]، وتثبِّت النبيَّ قائلةً أنّ الذين أوتوا الكتاب ﴿يَعْلَمُونَ أَنَّهُ [أي: القرآن] مُنَزَّلٌ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ﴾ [الآية: 114]، وتحضّه على أن يقتدي بهدى الذين هداهم اللهُ وآتاهم الكتاب [الآيات: 89- 90][33]، ولا تتضمّن السورة سوى إشارة قادحة واحدة إلى أهل الكتاب، وهي أنّ اللهَ قد فرض تحريمات طعامية صارمة على اليهود جزاءً على بغيهم [الآية: 146]. لكن حتى في هذا الموضع، لا يستهدف النقد اليهود، وإنما يرمي إلى نقض التحريمات الوثنية المشابهة. وهكذا، يترجّح من المضمون العام للسورة أنّ خطاب القرآن في الآية 91 موجّه إلى المشركين لا إلى اليهود[34].
قُلْ: ﴿مَنْ أَنزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى﴾؟
الإشكال الأبرز في الآية 91 من سورة الأنعام هو الاستدلال بالتوراة على ثبوت نزول الوحي الإلهي على البشر، على الرغم من أنّ المشركين غير مؤمنين بها أصلًا. لكن ليس من العسير دفع هذا الإشكال، وذلك على النحو الآتي: لعلّ الآية تستشهد بالتوراة للردّ على أحد الانتقادات التي وجّهها المشركون إلى النبيّ فيما سلف. ويشير صدر السورة إلى هذا النقد، على ما يبدو؛ إِذْ تقول الآية السابعة: ﴿وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ﴾[35]. فالظاهر من هذه الآية أنَّ المشركين قد حاولوا دحض النبيّ محمد بالإشارة إلى أنّ طريقة دعوته مختلفة عن طريقة الدعوة التي نسبها هو نفسه إلى الرُّسُل السابقين؛ إِذْ إنَّ الوحي الذي أتى به شفهي ومفرّق، بينما الوحي الذي أتى به الرُّسُل السابقون -خاصّة التوراة- كان مكتوبًا وجملة واحدة، بنصّ القرآن نفسه (الآية: 145 من سورة الأعراف: ﴿وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِن كُلِّ شَيْءٍ﴾). بل حكى القرآن في موضع آخر أنّ الكافرين قد قالوا: ﴿لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً﴾ [الآية: 32 من سورة الفرقان]. ويبدو أنّ الآية السابعة من سورة الأنعام تردّ على هذا النقد بالتأكيد على أنّ الكافرين لن يؤمنوا بالنبيّ محمد حتى لو نزّل اللهُ عليه كتابًا ملموسًا كما يسألون، ولقالوا إنه ليس كتابًا من عند الله حقًّا وإنما سحر مبين. وعلى ذلك، قد يكون هذا السِّجَال بين النبيّ والمشركين خلفية للآية 91 من السورة التي تنكر على المشركين إنكارهم لنزول الوحي الإلهي على البشر، بالإشارة إلى أنّ التوراة -التي استشهدوا بها فيما سَلَف للانتقاص من القرآن لشفهيته وتفرّقه- هي نفسها وحي أنزله اللهُ على بشرٍ.
ولتأييد القول أنَّ المشركين قد يحتجّون بالتوراة، على نحوٍ نفعيّ، أي من دون أن يؤمنوا بها، بغرض الانتقاص من القرآن، يمكننا أن نستشهد بالآية 48 من سورة القصص. تحكي هذه الآية أنّ بعض الذين كفروا بمحمد قد قالوا: ﴿لَوْلَا أُوتِيَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ مُوسَى﴾، ولعلّ مقصدهم من ذلك أنّ موسى قد تلقّى ألواحًا مكتوبة من الله، أمّا محمد فيزعم أنه يتلقّى وحيًا شفهيًّا[36]. وعلى ذلك تجيب الآية بالقول: ﴿أَوَلَمْ يَكْفُرُوا بِمَا أُوتِيَ مُوسَى مِن قَبْلُ قَالُوا سِحْرَانِ تَظَاهَرَا وَقَالُوا إِنَّا بِكُلٍّ كَافِرُونَ﴾. وهكذا، يريدون الجمع بين الحسنيين: الكفر بالقرآن بحُجّة أنه ليس كتابًا منزلًا من السماء، كالذي أتَى به موسى، مع الكفر أيضًا بهذا الكتاب الذي أتَى به موسى؛ إِذْ قالوا: ﴿سِحْرَانِ [أي: القرآن والتوراة] تَظَاهَرَا وَقَالُوا إِنَّا بِكُلٍّ كَافِرُونَ﴾[37]. وعليه، إنّ السبب الحقيقي لكفر المشركين بالوحي هو مضمونه وليس شَكْله (مكتوبًا أو شفهيًّا) أو طريقة نزوله (جُمْلة واحدة أو مفرَّقًا).
يمكن الاعتراض على هذا الحلّ بالقول: حتى لو قارن المشركون القرآن بالتوراة بغرض الانتقاص من القرآن، فإنهم لم يكونوا يوقّرون التوراة حقًّا؛ ولذلك لم يكن من المناسب للآية 91 من سورة الأنعام أن تستشهد بها كسابقة تثبت نزول الوحي الإلهي على البشر. لكن هذا الاعتراض يغفل عن طبيعة الخطاب السجالي، الذي لا يرمي إلى طرح حُجَج منطقية مُحكمة إحكامًا تامًّا وإنما إلى طرح ردود مفحِمة. فإذا كان المشركون يستطيعون أن يحتجُّوا بالتوراة من دون الإيمان بها، فإنَّ القرآن يستطيع، يقينًا، أن يقلب هذه الحُجّة عليهم. علاوة على ذلك، قد يستشهد القرآن بالتوراة لا لأنّ المشركين يؤمنون بها، وإنما لأنها تتمتّع بمهابة ومقام اجتماعي جليل بفضلِ إيمان اليهود والنصارى بها كوحي مُنزّل من عند الله. وفي هذه الحالة يكون القصد من الاستشهاد بالتوراة هو بيان أنّ النبيّ لم يأتِ ببدع من القول حينما قال أنه يوحَى إليه من عند الله[38]. فهو لا يسألهم أن يؤمنوا بشيء مُحْدَث أو غريب بل بشيء يؤمن بمثله الكثير من الأقوام الأخرى. ولذلك، فإنَّ كفر المشركين بالتوراة وبنزول الوحي الإلهي على البشر هو الأمر الغريب والمختلف، وليس الإيمان بالوحي الذي نُزِّل على محمد[39].
والحقّ، إنَّ القرآن يوضّح بجلاء أنَّ كُلًّا من النبيّ والمشركين قد ادّعى أنه يتّبع السبيل المسلوكة واتهم الآخر بالضلال والانحراف. على سبيل المثال: رفض المشركون دعوة النبيّ إلى التوحيد الخالص بالقول: ﴿مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ إِنْ هَذَا إِلَّا اخْتِلَاقٌ﴾ [الآية السابعة من سورة ص]، والراجح أنَّ المقصود بالملّة الآخرة هنا هو النصرانية وعقيدة التثليث. ولا يلزم أن يكون المشركون على دين النصارى حتى يحتجّوا بهذه الحُجّة. وفي المقابل، يشدّد القرآن عادة على أنَّ رسالة محمد ليست أمرًا مبتدعًا أو غريبًا، وذلك بروايته لقصص الأنبياء السابقين وما لاقَوه من أقوامهم. وكما تقول الآية التاسعة من سورة الأحقاف: ﴿قُلْ مَا كُنتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ﴾. وكفرُ المشركين بهذه القصص التي يرويها القرآن، أو عدم تصديقهم أنّ الله قد أهلك الأُمم السابقة لكفرها برُسُله، لا يجعل رواية القرآن لهذه القصص أمرًا عديم المغزى. فما يهمّ هنا هو أنَّ الكثير من الناس -أغلبية سكان الشرق الأدنى- يؤمنون بالقصص الكتابية ويوقّرون أبطالها، وهذا من شأنه أن يؤيّد رسالة النبيّ محمد والوحي المُنزَّل عليه.
﴿يَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ﴾:
بعد مناقشتنا لاحتجاج القرآن بالتوراة في جداله مع المشركين، يجدر بنا تحليل وصف الآية للتوراة بأنها ﴿قَرَاطِيسَ يُبْدُونَهَا [أي: القائمون عليها] وَيُخْفُونَ كَثِيرًا [منها]﴾. يبدو أنَّ هذا القول يكمل تأكيد الآية السابعة من السورة على أنَّ المشركين لن يؤمنوا بالنبيّ حتى لو نَزَّل اللهُ عليه كتابًا من السماء ولمسوه بأيديهم. فبه تجيب السورة على انتقاص المشركين من القرآن لشفهيته ونزوله مُفرَّقًا مقارنة بالتوراة التي نُزِّلَت مكتوبة وكاملة على موسى. ولو صحّ ذلك، يمكن القول: إنَّ الآية 91 تقدِّم جوابًا إضافيًّا على مقارنة المشركين للقرآن بالتوراة قائلة: على الرغم من أنَّ التوراة قد أُعطيت لموسى جملة واحدة، فإنها مُفرّقة الآن وغير متاحة بالكامل لغير أهلها. إنها ليست قرطاسًا واحدًا (كما هو مذكور في الآية السابعة)، بل قراطيس كثيرة، وفوق ذلك ليست متاحة بالكامل؛ لأنّ القائمين عليها يُبدون بعض هذه القراطيس ويُخفون الكثير منها. وعليه، قد يحتجّ قوم النبي محمد بالتوراة في جدالهم معه، كما يشاؤون، لكنها، في واقع الأمر، غير متاحة لهم حقًّا[40]. وفي مقابل ذلك، أتاح اللهُ لهم نفس العِلْم الإلهي الموجود في التوراة من خلال الوحي الذي ينُزِّله على النبيّ: ﴿وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ﴾[41].
لم تَرِد كلمة (قرطاس) بصيغتي المفرد والجمع إلا في هذين الموضعين من القرآن، الآية 7 والآية 91 من سورة الأنعام، وفي ذلك تأييد لقولنا بوجود ارتباط وتكامل بين الآيتين؛ إِذْ يمكن عدّ الآيتين ضربتين سجاليتين متتاليتين ضدّ المشركين. تقول الأولى، إنَّ تنزيل كتاب مثل ألواح موسى على النبيّ محمد لن يجدي نفعًا مع المشركين؛ لأنهم سيصرّون على كفرهم حتى لو لمسوه بأيديهم. وتقول الثانية، إنَّ التوراة لم تَعُد كما كانت في الأصل، أي: كتابًا تامًّا ومتاحًا بالكامل؛ وذلك لأنها أضحتْ محفوظة في قراطيس مُفرَّقة، أكثرها مخفاة عن غير أهلها كالمشركين[42].
قد يكون المغزى العام لتعليق الآية 91 بشأن التوراة سهل الفهم، لكن معناها الدقيق أقلّ وضوحًا، فما الذي تعنيه الآية بوصف التوراة بأنها قراطيس؟ وما المغزى من قولها أنَّ القائمين عليها يُبْدُون هذه القراطيس لكن يُخفون كثيرًا منها أيضًا؟ كلمة قرطاس مشتقّة في الأصل من كلمة (خارطيس) اليونانية (وانتقلت إلى العربية عبر الآرمية أو السريانية: "قارطيسا")، التي تَعني بردية أو رَقّ، أو تدلّ عمومًا على الصحيفة المكتوب عليها نصّ[43]. هذا هو المعنى التأثيلي لكلمة قرطاس، لكن بأيّ معنى تحديدًا يستعملها القرآن؟ هل يشير إلى مادة محدّدة (جلد، أو بردي)، أم إلى شكل محدّد (ورقة، أو لفيفة، أو مُجَلَّد)، أم إلى الصحف عمومًا بغضّ النظر عن خصائصها المادية والشكلية؟ ولا يسعنا في هذا الصدد إلا أن نفترض استنادًا على ما بين أيدينا من أدلة، ولهذا الغرض ينبغي علينا أن نأخذ في حسباننا الشكل المادي للكتاب المقدّس في أواخر العصر القديم.
الشكل المفضَّل لتدوين أسفار الكتاب المقدّس عند الجماعات اليهودية القديمة هو اللفائف الجلدية [(مِجِلوت)، جمع (مِجلّة) بالعبرية]. وفيما يخصّ التوراة تحديدًا (البنتاتوخ، أي: الأسفار الخمسة: التكوين، الخروج، العدد، اللاويين، التثنية)، فالظاهر أنها كانت تُقسّم حينئذٍ على خمس لفائف أو على أكثر من واحدة على الأقلّ[44]. على سبيل المثال، كانت الطريقة المتَّبعة في قُمران هي تجزئة التوراة على أكثر من لفيفة[45]. توجد قِلّة من الأدلة الوثائقية عن الكتاب المقدّس اليهودي في أواخر العصر القديم. لكن اللفيفة التي عُثر عليها في كنيس عين الجدي الأثري، والتي تعود إلى القرن الثالث أو الرابع الميلادي، تبدأ بالآية الأولى من سفر اللاويين. أيْ أنها لم تكن تتضمّن سفري التكوين والخروج قطعًا، سواء تضمّنت في الأصل سفري العدد والتثنية أم لا؛ ولذلك لم تكن تتضمّن التوراة كاملة[46]. والراجح أنَّ هذه اللفائف الجزئية -التي يمكن تداولها لقرون- كانت موجودة في محيط القرآن[47]. وعلى ذلك، لو فسّرنا كلمة (قرطاس) بلفيفة، يمكن القول إنَّ الآية 91 من سورة الأنعام تشير إلى كتابة أسفار التوراة على لفائف منفصلة وليس في لفيفة واحدة. لقد كانت هذه اللفائف ناقصة لأنها لا تحتوي إلا على جزء من التوراة؛ ولذلك عندما كانت تُنشر للقراءة لم تكن تتيح التوراة بأكملها، بما أنَّ أجزاءً أخرى منها كانت مخزونة بعيدًا في لفائف أخرى وبذلك ظلّت غير متاحة. ولعلّ هذا هو مقصد الآية من وصف القائمين على كتاب موسى بأنهم: ﴿يَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ [أي: لفائف] يُبْدُونَهَا وَيُخْفُونَ كَثِيرًا﴾[48].
لكن لو فسّرنا كلمة (قرطاس) ببردية أو رَقّ، يمكن حمل جُمْلة: ﴿يجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ﴾ [أي: صحفًا من البردي أو الجلد]. على أيٍّ من هذه المعاني الثلاثة؛ أولًا: تشير الجملة إلى الكثرة المتأصّلة في اللفائف الكبيرة (سواء أكانت تحتوي الواحدة منها على التوراة بأكملها أم على جزءٍ منها)؛ لأنها تتألّف من عدد من الصُّحف المجموعة بالخياطة أو نحو ذلك. وعلى هذا المعنى، لا تكون هذه الجملة استنكارية، وإنما خبر غرضه التشديد على تجزئة اللفيفة التي تبدو كاملة بلا انقطاع في الظاهر. ولو صح ذلك، فإنَّ جملة: ﴿يُبْدُونَهَا وَيُخْفُونَ كَثِيرًا﴾ قد تشير إلى أنَّ قراءة التوراة من لفيفة في الكنيس لا تتضمّن نشر هذه اللفيفة بأكملها. بل يظلّ أغلبها ملفوفًا، لا يبدو منها إلا جزء صغير -قلّة من الأعمدة التي تقع في صحيفة واحدة أو بضع صحف على أقصى تقدير[49]. علاوة على ذلك، في غير أوقات القراءة منها، تحفظ اللفائف تحت طبقات من الحماية- إِذْ تُلَفّ غالبًا في حجاب أو وشاح ("مابّاخا"، بالعبرية)، وتوضع في تابوت، يوضع في مشكاة التوراة داخل الكنيس[50]. ولعلّ هذه الجملة من الآية تشير إلى هذه التدابير، وبذلك تصف اليهود بأنهم مفرِّطون في حفظ كتابهم المقدّس وإخفائه.
ثانيًا: لعلّ الآية تنطوي على نقد مُضْمَر للمُجَلَّد لأنه مفرَّق وغير موثوق، مقارنة باللفيفة الواحدة. أي أنَّ جملة: ﴿يجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ﴾ قد تشير إلى تدوين التوراة في شكل المُجَلَّد، الذي يتألّف من عدد من الـمَلزمات المنفصلة في الأصل. تصفح المجلَّد أيسر من تصفح اللفيفة، لكنه أشدّ تفرّقًا منها، وعُرضة للتحريف، خاصّة إذا لم تُربط ملزماته ربطًا نهائيًّا. وعلى ذلك، قد تشير جملة: ﴿يُبْدُونَهَا وَيُخْفُونَ كَثِيرًا﴾، إلى أنَّ المجلَّد الذي يُقدّم في الكنيس على أنه التوراة كاملة ليس كذلك في واقع الأمر؛ لأنّ الكثير من صحفه مفقودة[51].
ثالثًا: لعلّ الآية تتحدّث عن تدوين تعاليم الربانيين [المشناه، التلمود، المدراش، ونحو ذلك] في مجلّدات للاستعمال الخاصّ. إِذ قيّد الربانيون علمهم بكتابته على الرغم من تأكيدهم على طبيعته الشفهية، مسمِّين إياه التوراة الشفهية (في مقابل التوراة المكتوبة، الأسفار الخمسة). لكن يبدو أنهم فضّلوا تدوين هذه التوراة الشفهية في مجلدات، تحديدًا بغرض تمييزها عن التوراة المكتوبة التي تدوّن على لفائف[52]. وعلى ذلك، قد تشير جملة: ﴿يُبْدُونَهَا وَيُخْفُونَ كَثِيرًا﴾ إلى ميل الربانيّين إلى عدم مشاركة مجلدات التوراة الشفهية علانية[53].
التفاسير:
لقد بيّنت أنَّ الإشكال الموجود في الآية 91 من سورة الأنعام يمكن حلّه بقراءة الأفعال المضارعة الثلاثة في وسط الآية بصِيغة الغائب وليس المخاطب، وهي قراءة مروية في كتب القراءات، لكنَّ الدارِسين المُحدَثين، وكما بيّنتُ فيما سبق، يَقبلون قراءة صيغة المخاطب، بل إنَّ معظمهم -فيما يبدو- لا يعلمون بوجود قراءة صيغة الغائب أصلًا، على الرغم من أهميتها لتحديد المخاطبين بهذه الآية وتحديد معناها. فمِن بين جميع الدارِسين الذين عرضنا أقوالهم فيما سبق، لم يذكر قراءة صيغة الغائب إلا ريجيس بلاشير وباتريشا كرون، لكنهما ضعّفاها؛ إِذْ قال بلاشير، من دون أيّ تحليل: «إنَّ هذه القراءة ناتجة عن توفيق صيغة أفعال وسط الآية مع صيغة الأفعال التي في صدرها»[54]، وقالت كرون إنَّ هذه القراءة بلا معنى؛ إِذْ «كيف يمكن الاحتجاج على المشركين بموسى؟»[55]، أو بعبارة أخرى، إذا كانت الآية تجادل المشركين، فما الذي يجعلها تحتجّ عليهم بالتوراة؟ والاستثناء الوحيد في هذا الصّدد هو كتاب القرآن المفسّر: ترجمة وتفسير جديدان [56]، الذي يأخذ -بحكم طبيعته- النقاشات التفسيرية في حسبانه. ففي حاشية موجزة، رجّح أنَّ الآية تخاطب المشركين، ورجّح قراءة صيغة الغائب[57]. وفي حدود علمي، هذا هو كلّ ما قيل عن هذه القراءة في الدراسات القرآنية الحديثة.
يكشف عدم دراية معظم الدارسين المُحدَثين بقراءة صيغة الغائب، ونبذ بلاشير وكرون لها، عن القطيعة العامة بين الدراسة الأكاديمية الحديثة والدراسة الإسلامية التراثية للقرآن. فعلى عكس الدراسات الأكاديمية التي استشهدت بها، تُورد تفاسير القرآن قراءة صيغة الغائب بانتظام. بل إِنَّ الكثير من هذه التفاسير قد حلّل بالتفصيل أوجه قوّة وضعف قرائتَي صيغة المخاطب والغائب، ودرس جوانب الآية الأخرى من منظورات شتّى؛ نحوية، وأدبية، وتاريخية، وفقهية، وعقدية (لاهوتية)، وفلسفية. ومن شأن هذه التبصرات أن تثري الدراسة الأكاديمية الحديثة لهذه الآية، وتفتح الباب لنقاشات جديدة متنوّعة. ولذلك سأتوجّه الآن إلى عرض ما أوردته التفاسير في تأويل هذه الآية.
أورَدَت التفاسير أربعة أقوال في المخاطبين بالآية؛ الأوّل: الآية موجَّهة إلى شخص يهودي أو جماعة يهودية. والثاني: الآية موجَّهة إلى المشركين. والثالث: الآية موجَّهة إلى اليهود والمشركين كليهما. والرابع: التوقّف في المسألة. وبالإضافة إلى تبنّي قول من هذه الأقوال، قدّم المفسِّرون ملاحظات ثاقبة عن شتى جوانب الآية.
أحد هذه الجوانب هو تحديد المعنى الدقيق لقول: ﴿مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِنْ شَيْءٍ﴾. كما ذكرنا سلفًا، تعزو الكثير من الأخبار المبكّرة هذا القول إلى يهودي (يُسمَّى مالك بن الصيف، غالبًا) أو مجموعة من اليهود، من خصوم النبيّ. لكن بعض المفسِّرين لا يجدون هذه الأخبار مقنعة على ما يبدو. على سبيل المثال، شكّك فخر الدين الرازي (ت: 606هـ= 1209م) في أنّ الله قد يردّ على ما قاله مالك وهو ذاهل العقل من شدّة الغضب بآيات تُتلى إلى أبدِ الدهر:
أنَّ مالك بن الصيف كان مفتخرًا بكونه يهوديًّا متظاهرًا بذلك، ومع هذا المذهب يستحيل أن يقول: ﴿مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِنْ شَيْءٍ﴾ إلا على سبيل الغضب المدهش للعقل... ومثل هذا الكلام لا يليق بالله -سبحانه وتعالى- إنزال القرآن الباقي على وجه الدهر في إبطاله.
وفي مقابل هذه الرواية التي تقول أنّ مالكًا قد أنكر الوحي بالكلية بسبب غضبه، يرى الرازي أنه لو وقعت حقًّا مناظرة بين مالك والنبيّ فالراجح أنها وقعت على هذا النحو:
لعلّ مالك بن الصيف لمّا تأذّى من هذا الكلام طعن في نبوّة الرسول -عليه الصلاة والسلام- وقال: ما أنزل الله عليك شيئًا البتة، ولستَ رسولًا من قِبَل الله البتة، فعند هذا الكلام نزلَت هذه الآية، والمقصود منها أنك لمّا سلَّمت أنَّ الله تعالى أنزل التوراة على موسى عليه السلام، فعند هذا لا يمكنك الإصرار على أنه تعالى ما أنزل عليَّ شيئًا لأنِّي بشر، وموسى بشر أيضًا، فلمّا سلَّمت أنّ الله تعالى أنزل الوحي والتنزيل على بشر امتنع عليك أن تقطع وتجزم بأنه ما أنزل اللهُ عليَّ شيئًا، فكان المقصود من هذه الآية بيان أنّ الذي ادّعاه محمد -عليه الصلاة والسلام- ليس من قَبِيل الممتنعات[58].
وقدّم جار الله الزمخشري (ت: 538هـ= 1144م) تفسيرًا آخر. لقد أنكر اليهود الوحي المنزّل على محمد فقط، لكنهم قالوا هذا القول المعمّم على سبيل المبالغة، في خضمّ السجال، فوبّخهم القرآن على هذا التعميم، وذكّرَهم بأنهم أهل التوراة، وهي وحي إلهيّ أُنْزِل على بشر:
وإنما قالوا ذلك مبالغة في إنكار إنزال القرآن على رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فألزموا ما لا بدّ لهم من الإقرار به من إنزال التوراة على موسى عليه السلام[59].
أمّا الطباطبائي (ت: 1981م)، فيدفع الاعتراض القائل أنّ اليهود لم يَكُ يتأتَّى لهم أن يقولوا ما أنزلَ الله على بشرٍ من شيء، بالقول:
أن يكون ذلك مخالفًا للأصل الذي عندهم لا يمنع أن يتفوّه به بعضهم تعصّبًا على الإسلام أو تهييجًا للمشركين على المسلمين، أو يقول ذلك عن مسألة سألها المشركون عن حال كتاب كان النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- يدّعي نزوله عليه من جانب الله سبحانه، وقد قالوا في تأييد وثنية مشركي العرب على أهل التوحيد من المسلمين: هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلًا[60].
وإجمالًا، يبدو أنَّ أغلب المفسِّرين يرون أنَّ الآية تخاطب فردًا أو جماعة من اليهود[61]. (وبالمثل، قراءة صيغة المخاطب هي الشائعة في مخطوطات القرآن المبكّرة)[62]. لكن الذين يرجّحون هذا التأويل، يذكرون أيضًا التأويل الآخر القائل أنَّ الآية تخاطب المشركين، ومعه قراءة صيغة الغائب، من دون نقده أو تضعيفه غالبًا[63]. علاوة على ذلك، يُورد الكثير من المفسِّرين التأويلَيْن من دون ترجيح أحدهما على الآخر. ومنهم، الثعلبي (ت: 427= 1035)[64]، والحكيم (والحاكم... هذا اسمه وليس الحكيم... فهل نحتاج ننظر الأصل أم نعدل مباشرة)، الجشمي (ت: 494= 1101)[65]، وابن عطية (ت: 541= 1147)[66]، والطبرسي (ت: 548= 1153- 1154)[67]، والرازي[68]، والقرطبي (ت: 971= 1272)[69]. بينما رأى قِلَّة من المفسِّرين أنَّ الآية -أو بدايتها على الأقل-موجّهة إلى المشركين واليهود كليهما، لتعاونهما ضد النبي[70].
وأخيرًا، قال عددٌ من المفسِّرين أنَّ الآية تخاطب المشركين. ويُعزى هذا القول، مع قراءة صيغة الغائب المرتبطة به، إلى التابعي المكّي مجاهد بن جبر (ت: حوالي 102= 720). ولذلك، يمكن القول أنَّ ابن كثير المكّي (120= 737)، قد قرأ أفعال الآية في صيغة الغائب اتباعًا لتأويل مجاهد[71]. ولقد رجّح أبو جعفر الطبري هذا القول وهذه القراءة[72]. ورَوى الطوسي (ت: 460= 1067) في تفسيره، أنَّ شيخ المعتزلة أبا عليّ الجبائي (ت: 303= 916)، قد رجّح هذا القول أيضًا[73]. ووافق الطوسي نفسه الجبائي والطبري على ذلك[74]. ورجّحه أيضًا، ابن كثير (ت: 774= 1373)، وسيد قطب (ت: 1966)، استنادًا إلى الطبري[75].
وساق الطبري الحجج الآتية لتأييد هذا القول: الآية واردة في سياق الخبر عن المشركين وليس اليهود؛ إنكار الوحي ليس مما تدين به اليهود؛ لا يوجد خبر صحيح متصل السند يفيد أنَّ قائل: ﴿مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِنْ شَيْءٍ﴾ كان رجلًا من اليهود؛ ولم يُجمِع أهل التأويل على أنَّ ذلك كذلك. وبناءً على ذلك، رجّح الطبري أيضًا قراءة صيغة الغائب[76]. وذكر ابن كثير هاتَيْن الحجّتَيْن لتأييد هذا القول: هذه الآية مكية[77]، واليهود لا ينكرون إنزال الكتب من السماء، أمّا قريش والعرب قاطبة فكانوا ينكرون إرسال محمد لأنه من البشر، كما وردَ في مواضع أخرى من القرآن (الآية الثانية من سورة يونس، والآية 94 من سورة الإسراء)[78].
ونختم هذا الجزء من الدراسة بالتأويل المبدع الذي أتَى به محمد رشيد رضا (ت: 1935م). يرى رضا أنّ النبيّ خاطب المشركين بالآية في مكة، وقرأ أفعالها في صيغة الغائب، لكن في المدينة، خاطب بها اليهود مباشرة، وقرأ أفعالها في صيغة المخاطب. في مكة، أرسلت قريش إلى المدينة مَن يسأل اليهود عن رسالة النبي[79]، وهذا يبيِّن «أنَّ كون التوراة كتابًا من عند الله لليهود خاصّة كان معروفًا عند مشركي قريش، وأنهم لهذا أرسلوا وفدًا إلى أحبار اليهود فسألوهم عن النبي. وبذلك يكون الاحتجاج عليهم بالتوراة في هذه السورة التي أُنزلت في محاجّتهم في جميع أصول الدِّين احتجاجًا وجيهًا». وبعد الهجرة إلى المدينة، ظلّت الآية تُقرأ هكذا (بصيغة الغائب) إلى أَنْ «أخفى أحبار اليهود حُكم الرجم بالمدينة، وأخفوا ما هو أعظم من ذلك وهو البشارة بالنبي وكتمان صفاته عن العامة وتحريفها إلى معانٍ أخرى للخاصّة، وإلى أن قال بعضهم: ﴿مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِنْ شَيْءٍ﴾، كما قال المشركون من قبلهم (إِنْ صحّت الروايات في ذلك)، فلمّا كان ذلك كلّه، كان غير مستبعد ولا مخلّ بالسياق أن يلقِّن الله تعالى رسوله أن يقرأ هذه الجُمَل في المدينة على مسمع اليهود وغيرهم بالخطاب لهم، فيقول: ﴿تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ تُبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا﴾»[80]. أي أنّ القراءة المدنيّة لم تَنسخ القراءة المكية، وإنما أضحت الآية أشبه بطِرس نَصّي له مستويان خطابيان؛ إِذ تردُّ على خصوم النبي المشركين وخصومه اليهود في الوقت نفسه.
خاتمة:
في كتابه الرائد Beyond the written word، شدّد وليام جرهام على أهمية الشفهية في شتى التقاليد الكتابية. وفيما يخصّ السياق الإسلامي تحديدًا، قال جرهام، بنظر ثاقب، أنَّ «الوحي القرآني كان في الأصل نصًّا شفهيًّا بالكلية، يُراد له أنْ يُتلى وتُعاد تلاوته، على لسان النبي محمد أولًا، ثم على لسان المؤمنين. فالله لم ينزل عليهم ﴿كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ﴾ [الآية السابعة من سورة الأنعام]»[81]. وبإشارته إلى هذه الآية من صدر سورة الأنعام، أبرز جرهام الصدام الذي وقع بين النبي وخصومه حول طريقة نزول القرآن الشفهية والمفرَّقة. ولقد سبرت في هذه الدراسة معالم هذا الصدام من خلال تحليلٍ مفصَّل للآية 91 من سورة الأنعام. وبيّنت أنّ هذه الآية مرتبطة بالآية السابعة من السورة ودفاعها عن الشكل الذي ينزل به القرآن. وكما أنَّ الآية السابعة (وسورة الأنعام ككلّ) تخاطب المشركين، تخاطب الآية 91 بأكملها المشركين أيضًا. ولذلك، ينبغي قراءة الأفعال المضارعة الثلاثة في وسطها في صيغة الغائب، أي: كخطاب عن اليهود ﴿يَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ يُبْدُونَهَا وَيُخْفُونَ كَثِيرًا﴾، وليس في صيغة المخاطب، أي: كخطاب إلى اليهود ﴿تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ تُبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا﴾. ويتقوّى هذا التأويل بالمكسب السجالي الذي يمكن للنبيّ أن يحقّقه من وصف التوراة بأنها قراطيس يبديها القائمون عليها ويخفون كثيرًا منها في جداله مع المشركين. فالمشركون قد انتقصوا مِن قَدْرِ القرآن لأنه شفهي ومفرَّق -ولذلك، هو أدنى منزلة من التوراة- وعلى هذا الانتقاص تردُّ الآية 91 بأنَّ التوراة في الحاضر مفرَّقة، من الناحية العملية، وغير متاحة بالكامل لغير أهلها. بل يمكن القول أنَّ تشديد الآية على الشكل المادِّي للتوراة المكتوبة والقيود الملازمة له، فيه امتداح ضِمني لشفهية القرآن. فبتلاوتها شفهيًّا، تُتاح آيات القرآن لجميع السامعين فورًا؛ ولذلك هي أقلّ عرضة لأن تُخْفَى أو تُحَرَّف. ووفقًا لهذا التحليل، لا ينبغي عدّ إشارة الآية إلى التوراة مجرّد جملة اعتراضية ترمي إلى انتقاد اليهود، وإنما جزء أساسي من حجاج السورة مع المشركين للدفاع عن النبي والقرآن الذي جاء به.
رأى عدد من المفسِّرين المؤثّرين أنَّ هذه الآية تخاطب المشركين، لكن رأى أغلبهم أنها تخاطب اليهود، ورجّحوا قراءة الأفعال المضارعة الثلاثة في وسط الآية بصيغة المخاطب، كما تشهد كتب التفسير، وكتب القراءات، ومخطوطات القرآن المبكِّرة. فما تفسير رواج هذه القراءة وهذا التأويل (المرجوح في نظري)؟ أولًا: الأفعال المضارعة الثلاثة واردة بين جملتَيْن تخاطبان خصوم النبيّ مباشرة: ﴿قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى نُورًا وَهُدًى لِلنَّاسِ﴾، و﴿وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ﴾؛ ولذلك، بَدَتْ قراءة هذه الأفعال في صيغة المخاطب أيضًا، أكثر سلاسة، على الرغم من الإشكال الناجم عنها. ثانيًا: قد أسهم وجود الخبر الذي يعزو سبب نزول الآية إلى واقعة التخاصم بين الرجل اليهودي والنبي (أو عمر بن الخطاب) في تعزيز هذا التأويل. فلو أنّ أحد القُصّاص المتقدّمين رَوى قصة أخرى لنزول هذه الآية يخاصم النبيَّ فيها رجلٌ من المشركين، لكان من الممكن أن يحظى التأويل الآخر وقراءة صيغة الغائب بالرواج. ونحن في غنى عن القول أنَّ هذين السببين (جعل الآية سلسة من جهة التركيب والنحو، أو اختلاق Sitz im Leben، أو سبب نزول[82]، يتضمّن اليهود)، لا يضعفان الحجج التي طرحتها في هذه الدراسة للدفاع عن التأويل الذي يحمل الآية على أنها تخاطب المشركين، وعن قراءة أفعال الآية الثلاثة بصيغة الغائب.
بيّنت في هذه الدراسة أيضًا أنَّ كتب التفسير التراثية تحتوي على نقاشات مفصّلة لهذه الآية: سبب نزولها، والمخاطبين بها، وخصائصها الصرفية والتركيبية والبلاغية، والدلالة الدقيقة لجُمَلها، وقراءاتها. وتتضمّن هذه النقاشات الكثير من الفوائد التي يمكن للدارسين المُحدَثين الاستفادة منها. وعلى وجه التحديد، كان من الممكن للدراسات الحديثة السابقة في هذه الآية أنْ تستفيد من قراءة صيغة الغائب المذكورة في الكثير من التفاسير. لكن بالطبع لا تقتضي الدراسة الجادّة للتفاسير قبول مقدّمات المفسِّرين أو أقوالهم أو استنتاجاتهم. وكذلك لا تقتضي قبول الرأي القائل أنَّ المفسِّرين «أقدر على تحديد المعنى الأصلي لآيات القرآن»[83]. فعلى سبيل المثال، أعربتُ في هذه الدراسة عن شكوكي في القصة التاريخية التي يُعزى إليها نزول هذه الآية في التفاسير. لكن لا ينبغي لمثل هذه الاعتراضات أن تصرفنا عن الانتفاع بكتب علوم القرآن؛ لأنَّ فيها كنوزًا من التدبّر في شتى وجوه النصّ القرآني من قِبل أولئك الذين كرّسوا حياتهم له[84]. قد يميل دارسو القرآن المحدثون إلى التوكيد على استقلالهم عن العلوم التراثية، ومع ذلك، لا يزال بإمكانهم تحصيل الكثير من الفوائد من الدراسة المنهجية لهذه التصانيف والنهل من مواردها الثرية.
[1] عنوان المقالة باللغة الإنجليزية هو :Mohsen Goudarzi, “The Written Torah and the Oral Qurʾan in Pagan Mecca Towards a New Reading of Q 6:91,” وقد نُشرت في: Bruce Fudge et al. (eds.) Non Sola Scriptura Essays on the Qur’an and Islam in Honour of William A. Graham (London & New York: Routldge, 2022), 3- 22.
[2] ترجم هذه المقالة، طارق عثمان، باحث ومترجم، له عدد من الأعمال المبطوعة.
[3] محسن جودارزي Mohsen Goudarzi: أستاذ مساعد في كلية أصول الدِّين بجامعة هارفرد.
[4] Reinhold F. Glei and Roberto Tottoli, Ludovico Marracci at Work: The Evolution of his Latin Translation of the Qurʾān in the Light of his Newly Discovered Manuscripts, with an Edition and a Comparative Linguistic Analysis of Sura 18 (Wiesbaden: Harassowitz, 2016), 32.
وللمزيد عن أهمية ترجمة مرتشي، انظر:
Alastair Hamilton, “After Marracci: The Reception of Ludovico Marracci’s Edition of the Qur’an in Northern Europe from the Late Seventeenth to the Early Nineteenth Centuries,” Journal of Qur’anic Studies 20/ 3 (2018): 175–192.
[5] تجلّى هذا التغير في أعمال تيودور نولدكه وألويس شبرنجر الرائدة:
Theodore Nöldeke, Geschichte des Qorâns (Göttingen: Verlag der Dieterichschen Buchhandlung, 1860); Aloys Sprenger, Das Leben und die Lehre des Moḥammad: nach bisher grösstentheils unbenutzten Quellen, 3 vols. (Berlin: Nicolaische Verlagsbuchhandlung, 1861–65).
[6] تجلّى هذا التوجه، على نحوٍ نموذجيّ، في كتاب دراسات قرآنية ليوسف هوروڤتز:
Joseph Horovitz, Koranische Untersuchungen (Berlin: Walter De Gruyter & Co., 1926).
[7] غالبًا ما تقتصر الدراسات الغربية على النظر في قلّة من التفاسير المشهورة (كالطبري، أو الزمخشري، أو الرازي، أو الجلالين)، لا تعبّر قط عن سعة حقل التفسير وثرائه.
[8] يَرِد اسم أبيه مُعرَّفًا: الصيف، ومُنكَّرًا: صيف، في مختلف المصادر، ويَرِد فيها أحيانًا باسم الضيف أو ضيف، بالضاد المعجمة، كما ذكر ابن هشام في السيرة النبوية، تحقيق: مصطفى السقا وآخرين، مجلدان، الطبعة الثانية (القاهرة: مصطفى البابي الحلبي، 1955)، (1: 514).
[9] ترِد عبارة: «أَنشُدُك الله» في أخبار أخرى تحكي عن مواجهات النبي مع يهود يثرب. انظر، على سبيل المثال: السيرة، ابن هشام (1: 543، 1: 545- 546، 1: 565).
[10] يذكّرنا هذا النقل المزعوم من التوراة بالآيات (27- 31) من المزمور 78، والتي تحكي عن أنّ الله قد أطعم بني إسرائيل في الصحراء، لكنهم كفروا النعمة، فغضب عليهم، وقتل السمان منهم (ميشمانيهم) [تترجِم معظم الترجمات الإنجليزية -باستثناء الملك جيمس- والعربية هذه الكلمة العبرية، «مِن - شمان - يهم» -من الجذر شمن المناظر لسَمِن في العربية، أي: دهن أو شحم- بالأقوياء أو وافري الصحة، مما يخفِي المعنى الحرفي الذي يعنينا هنا]. وانظر أيضًا الآية 15 من سفر التثنية 32، التي تنتقد بني إسرائيل بهذه الألفاظ: «لقد أكَلَ يعقوبُ [أي: بنو إسرائيل] حتى التخمة، لقد سَمِن العبد المستقيم [بنو إسرائيل، على سبيل التهَكُّم] ورفس، سَمِن وغلظ وأثقله الشحم». وترِد مسألة السمنة في التلمود أيضًا، وتحديدًا في شأن الرباني إليعاز بن الرباني شمعون، والرباني إسماعيل بن الرباني يوسي [تصغير يوسف]. إِذْ يُروى أنهما كانَا سمينَيْن إلى هذا الحد: «حينما يقفان وجهًا لوجه يمكن لثور أن يمرّ من بينهما [أي: من تحت بطنيهما] من دون أن يمسّهما» (b. Bava Metsia 84a). ولقد استنكر عليهما تعاونهما مع السلطات الرومية بتسليمهما اليهود المتهربين من دفع الضرائب. وللمزيد عن تضارب الآراء في هذين الشخصين، ودلالة حجم جسديهما، انظر:
Daniel Boyarin, “Literary Fat Rabbis: On the Historical Origins of the Grotesque Body,” Journal of the History of Sexuality 1/ 4 (1991): 551–584.
تتضمّن هذه الدراسة ترجمة لـ Bava Metsia 83a- 85a، في الصفحات (579- 584). وأشكر شيري لوين على لفت نظري إلى هذا المرجع.
[11] وفقًا لأحد الأقوال التفسيرية؛ كان رؤساء اليهود في المدينة يجبون ضريبة دينية من رعيتهم تسمى المأكلة. ولقد كانت خشيتهم مِن فَقْدِ هذه الضريبة أحد أسباب معارضتهم للنبيّ. وللمزيد عن ذلك انظر: مرتضى كاريمي نيا، «مأكلة اليهود السنوية: تحليل قول تفسيري في المصادر الشيعية والسُّنية القديمة» (بالفارسية)، مجلة بحوث في القرآن والحديث 44/ 2 (2011- 2012): (119- 140). وعن معنى المأكلة، انظر الحاشية رقم 2 في صفحة 121 وما بعدها.
[12] تفسير السمرقندي المسمَّى بحر العلوم، أبو الليث السمرقندي، تحقيق: عليّ محمد معوض وآخرين، ثلاثة مجلدات (بيروت: دار الكتب العلمية، 1993)، (1: 500- 501).
[13] لهذه الرواية، انظر: تفسير مقاتل، مقاتل بن سليمان، تحقيق: عبد الله محمود شحاتة، خمسة مجلدات (بيروت: دار إحياء التراث العربي، 2002)، (1: 574- 575). ونصّت هذه الرواية أيضًا على أنّ مالكًا قد خسر رياسته بسبب قوله هذا: «وكان ربانيًّا فِي اليهود فعزلته اليهود عن الربانية».
[14] جامع البيان عن تأويل آي القرآن، أبو جعفر الطبري، تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي، 26 مجلدًا، (الجيزة: دار هجر، 2001)، (9: 394). ولمواجهات أخرى مع فنحاص، انظر: السيرة، ابن هشام (1: 558- 559). [فنحاص أو فنحاس بن اليعازر بن هارون (أخو موسى)، رمز الحمية الدينية في بني إسرائيل. ورَد في سفر العدد (25: 10- 13) أنّ الرب غضب على بني إسرائيل بعدما عبدوا بعل فغور مع نساء مؤاب، فغضب فنحاس لغضبه، وقتل إسرائيليًّا ومديانية برمحه، فرضي الرب منه ذلك، وسكت عنه الغضب، وجعل الكهانة فيه وفي ذريته].
[15] جامع البيان، الطبري (9: 395- 396).
[16] اعتبار مرويات النزول مختلَقة لاحقًا لغرض تفسير بعض الآيات هي نظرة تكثر في أطروحات المستشرقين، وبغضّ النظر عن ما قد يوجّه أحيانًا لبعض روايات النزول من نقد في الأسانيد أو مخالفة سياق الآي أو مصادمة الوقائع التاريخية، وغير ذلك مما نجده لدى بعض المفسِّرين تبعًا لمسوّغات يذكرونها، إلا أنّ هذه النظرة الاستشراقية لمرويات النزول تظلّ مشكلة في أصلها على هذا النحو وغير مبرّرة وغير مفيدة في التعامل أصلًا مع هذه المرويات التي هي مورد تفسيري مهمّ، وقد حاول بعض الدارِسين الغربيين المعاصرين الاستفادة من مرويات النزول في فهم بنية ومقاصد بعض السور والآيات. راجع: أنواع الكلام وتفسير القرآن، ديفين ستيوارت، ترجمة: محمد إسماعيل خليل، موقع تفسير. (قسم الترجمات)
[17] على سبيل المثال: ذكر ابن إسحاق أنّ مالكًا من بني قينقاع (السيرة، ابن هشام، 1: 514)، لكن نَسَبَه خبر مروي عن عكرمة، في تفسير الطبري، إلى بني قريظة (جامع البيان، 9: 394)، بينما نسَبَه خبر مرويّ عن عكرمة أيضًا، في تفسير السمرقندي، إلى بني النضير (بحر العلوم، 1: 440، وعند تفسير الآية 45 من سورة المائدة). علاوة على ذلك، يقوم مالك في كتب التفسير بدور الخصيم اليهودي النموذجي، الذي كانت معارضته العنيدة للنبيّ سببًا لنزول عدد من آيات القرآن؛ إِذْ أورد ابن إسحاق أنّ هذه الآيات: الآية 100 من سورة البقرة، والآية 68 من سورة المائدة، والآية 30 من سورة التوبة، قد نزلت في شأن مالك أو جماعته من اليهود (انظر: السيرة، ابن هشام [1: 547- 548، 1: 568، 1: 570]، على الترتيب). وذكر مقاتل مالكًا في سبب نزول عدد أكبر من الآيات: الآيات 1- 5 من سورة البقرة (تفسير مقاتل، 1: 84)، الآية 76 من سورة البقرة (1: 118)، الآيات 100- 101 من سورة البقرة (1: 126)، الآية 135 من سورة البقرة (1: 141)، الآية 23 من سورة آل عمران (1: 268)، الآية 72 من سورة آل عمران (1: 284)، الآية 78 من سورة آل عمران (1: 286)، الآية 110 من سورة آل عمران (1: 295)، الآية 46 من سورة النساء (1: 377)، الآية 18 من سورة المائدة (1: 464)، الآيات 41- 48 من سورة المائدة (1: 475- 483)، الآية 55 من سورة الأنفال (2: 122)، الآية السابعة من سورة يوسف (2: 319)، الآية 11 من سورة الحشر (4: 280)، الآية الأولى من سورة الإنسان (4: 522). وكذلك، الآية 183 من سورة آل عمران (بحر العلوم، 1: 270)، والآية 51 من سورة المائدة (الكشف والبيان، الثعلبي، 4: 75).
[18] انظر:
Theodor Nӧldeke and Friedrich Schwally, Geschichte des Qorāns (Leipzig: Dieterich, 1909), 1:161.
ونجد ملاحظات نولدكه وشڤالي مكررة عند تلمان ناجل ونيكولاي سيناي:
Tilman Nagel, Medinensiche Einschübe in mekkanischen Suren, 24; Nicolai Sinai, Fortschreibung und Auslegung, 113.
وقارن بـ: تفسير بسيط لسورة الأنعام، بروانه كريم زاده [بالفارسية] (طهران وقم: دار الفكر، 2004)، 106- 108.
[19] انظر المراجع الثلاثة المذكورة في الحاشية السابقة.
[20] يقول: «القرآن أشبه بجسد مهين، لا يبالي أيّ أحد بتعرّضه للتقطيع، مهما بلغ مداه. ولقد كان العرب أنفسهم أشرس مَن قطّعه»:
Charles Cutler Torrey, The Jewish Foundation of Islam (New York: Jewish Institute of Religion, 1933), 92.
ولا حاجة إلى القول أنّ توري لم يكن مغرمًا بارتكاب هذا الضرب من العنف النصِّي.
[21] Richard Bell, A Commentary on the Qur’ān, ed. C. E. Bosworth and M. E. J. Richardson, 2 vols. (Manchester: The Victoria University of Manchester, 1991), 1:197.
[22] Régis Blachère, Le Coran (Paris: G.- P. Maisonneuve & Larose, 1966), 162 n. 91.
وبالمثل، قال محمد البهي أنّ ما بين السؤال والجواب في الآية يخاطب اليهود (تفسير سورة الأنعام، دار الفكر، 1974، 83- 86). لكنه لم يقل إنّ هذه الجملة إدراج لاحق، وإنما قال إنها جملة معترضة، أي مثالٌ على توجّه القرآن بالخطاب إلى اليهود في أثناء مخاطبته للوثنيين (ص86). ورأى أن جملة: ﴿وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ﴾ تشير إلى التوراة. في حين رأى بيل، على ما يبدو، أنها تشير إلى الوحي الذي نزل على أنبياء بني إسرائيل بعد موسى، بينما رأى بلاشير أنه من المحتمل أنها تشير إلى تعاليم التلمود.
[23] وضد هذا القول، رأى رودي باريت أنّ الآية «تبدِي ترابطًا عامًّا -وإن لم يكن ترابطًا منطقيًّا صارمًا- بحيث لا يصح القول أنها مجرّد تجميع لأجزاء متفرّقة». ويسلّم باريت بأنه من العسير تحديد المخاطبين بالآية، ولم يُدْلِ في ذلك برأي قاطع.
Rudi Paret, Der Koran: Kommentar und Konkordanz (Stuttgart: Kohlhammer, 1993), 147.
[24] هذه التحليلات التي يذكرها المؤلِّف لريشتارد بيل وريجيس بلاشير هي تحليلات تصدر عن نظرة استشراقية تستشكل نَظْم القرآن وتتّهم القرآن بعدم الاتساق وترى به حذوفات وإقحامات وإضافات لاحقة من قِبَل الكُتّاب والمحرِّرين، وتتعامل مع القرآن بالأساس من خلال المنهج التاريخي النقدي، وهذه النظرة تصادم ما يعتقده المسلمون في القرآن الكريم وأنه وحي من الله تعالى وليس به أيّ زيادات لاحقة، وكذلك فإن هذه النظرة باتت تستشكلها بعض الدراسات الغربية الحديثة في نظم القرآن لا سيما أعمال ميشيل كويبرس. (قسم الترجمات)
[25] باتريشيا كرون (1945م- 2015م)، هي مستشرقة أمريكية من أصل دانمركي، وتعدّ أهم روّاد التوجه التنقيحي، وصاحبة أفكار ذائعة الصيت حول تاريخ الإسلام المبكّر وتاريخ الإسلام؛ حيث تشكّك في كون القرآن الذي بين أيدينا يعود إلى القرن السابع الميلادي، كما تشكّك في كون الإسلام قد نشأ في مكة الحالية، لها عدد من الكتب المهمّة، على رأسها الهاجريزم مع مايكل كوك (1977م)، وهو مترجم للعربية، حيث ترجمه: نبيل فياض، بعنوان: (الهاجريون: دراسة في المرحلة التكوينية للإسلام)، وصدر عن المركز الأكاديمي للأبحاث، بيروت، 2015م، وكتاب: تجارة مكة (1987م)، وهو مترجم للعربية أيضًا، حيث ترجمته: آمال محمد الروبي، وصدر عن المركز القومي للترجمة، مصر، 2005م. وقد أثارت كتُبها انتقادات كبيرة من مستشرقين ومؤرخين، الذين اعتبروا إقصاء المصادر العربية تمامًا في كتابة تاريخ الإسلام هو أمرٌ في غاية التعسّف، ومن الكتب العربية التي صدرت في سياق النقاش المنهجي مع هذا التوجه كتاب آمنة الجبلاوي، «الإسلام المبكر والاستشراق الأنجلوساكسوني الجديد، باتريشيا كرون ومايكل كوك نموذجًا»، منشورات الجمل، كولونيا، ألمانيا، بغداد، 2008. (قسم الترجمات).
[26] يرى طه جابر العلواني أيضًا أنّ الآية تخاطب المشركين. ويبدو أن أرثر جيفري يرى الرأي نفسه. لكن لم يشرح العلواني ولا جيفري كيف يمكن للآية أن تتّهم المشركين المكيّين بكتابة التوراة وبإخفائها، انظر: تفسير سورة الأنعام، طه جابر العلواني (القاهرة: دار السلام، 2012)، (96- 98)، وانظر:
Arthur Jeffery, The Qur’ān as Scripture (New York: R. F. Moore, 1952), 28.
[27] Patricia Crone, “Angels versus Humans as Messengers of God: The View of the Qurʾānic Pagans,” in The Qurʾānic Pagans and Related Matters: Collected Studies in Three Volumes, ed. Patricia Crone (Leiden & Boston: Brill, 2016), vol. 1, 111.
وقالت كرون أنّ هذا الوحي الموسوي قد يكون «كتابًا قياميًّا أو كشفيًّا (أبوكاليبس) منسوب إلى موسى» سعى المشركون إلى إخفاء أكثره «لأنه علم باطني». ولقد بنتْ هذا الزعم على فرضية حجّي بن شمّاي القائلة أنّ كلمة صحف في القرآن ترجمة مستعارة لاسم صِنف الكتابات الأبوكاليبسية (القيامية، الكشفية):
Haggai Ben- Shammai, “Ṣuḥuf in the Qurʾān—a Loan Translation for ‘Apocalypses’,” in Exchange and Transmission across Cultural Boundaries: Philosophy, Mysticism and Science in the Mediterranean, ed. H. Ben- Shammai et al. (Jerusalem: Israel Academy of Sciences and Humanities, 2013), 1–15.
لكن حجّي بن شمّاي يقصد تحديدًا الصحف المنسوبة إلى موسى (وإبراهيم) -﴿إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَى * صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى﴾، و﴿أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى * وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى﴾- وليس الكتاب الذي جاء به موسى، المذكور في الآية 91 من سورة الأنعام، والذي يشير إلى التوراة على الأرجح.
[28] “Angels versus Humans,” 114.
في دراسة لاحقة، قالت كرون أنَّ «النبيّ وخصومه المشركين كانَا من الأُمّيين المستهودين (God- fearers)»؛ وذلك لأنهما يؤمنان بإله الكتاب المقدّس، ويحترمان مرجعية المؤمنين به من السابقين، وتحديدًا اليهود:
“Pagan Arabs as God- Fearers,” in Hanna Siurua (ed.), The Qurʾānic Pagans and Related Matters, 3 vols. (Leiden: Brill, 2016), 315–339, at 338.
لكنني أرى أنّ هذا التهوّد أليق بطائفة الصابئين الملغزة الواردة في القرآن (البقرة: 62، المائدة: 69، الحج: 17). لأنّ اسمها قريب من اللفظ اليوناني sébas، الذي يعني الخوف أو الرهبة، أو من تركيبات، مثل: theosebeis أو sebòmenoi، التي تعني: (الخائفون من الله). ومن الجدير بالذِّكْر، أنّ لفظ sébas قد دخل، على ما يبدو، إلى حقل المفردات الدينية في جنوب الجزيرة العربية في أواخر العصر القديم، كما تشهد الأدلة النقشية، انظر:
Christian Robin, “The Judaism of the Ancient Kingdom of Ḥimyar in Arabia,” in Gavin McDowell et al. (eds), Diversity and Rabbinization: Jewish Texts and Societies Between 400 and 1,000 CE (Cambridge, UK: Open Book Publishers, 2001), 224–5.
[29] على سبيل المثال، قال نيكولاي سيناي ما يأتي في معرض مناقشته للفظ مشركين: «كما بيّنت باتريشا كرون، بعض الآيات القرآنية تفترض، على ما يبدو، أنّ المشركين يقرّون بوجود رُسل مرسَلة من عند الله وبوجود كتاب منزّل على موسى (انظر الآيتين 91 و124 من سورة الأنعام)»:
The Qur’an: A Historical- critical Introduction (Edinburgh: Edinburgh University Press, 2017), 69.
وبالمثل، في مناقشته للآية 91 من سورة الأنعام، لخّص جبريل رينولدز لُبّ تحليل كرون، ثم قال: «تفيد الإشارة إلى أنّ خصوم محمد كانوا يبدون (صحفًا) مكتوبًا فيها وحي منزَّل على موسى، إنهم لم يكونوا وثنيين وإنما يهود على الأرجح»:
The Qurʾān and the Bible: Text and Commentary (New Haven, CT: Yale University Press, 2018), 235.
لكنه أضاف، مقتديًا برودي باريت، أنّ هذا القول يناقض صدر الآية «الذي يبدو أنه يخاطب أولئك الذين ينكرون إمكانية الوحي بالكلية» (نفسه). وقارن بمناقشة رينولدز لهذه الآية في:
Coran des historiens, ed. Mohammad Ali Amir- Moezzi and Guillaume Dye, 3 vols. (Paris: Les éditions de Cerf, 2019), 2:253.
[30] معجم القراءات، عبد اللطيف محمد الخطيب، 11 مجلد (دمشق: دار سعد الدين، 1422هـ، 2: 484). ولأنَّ هذه القراءة ضمن القراءات السبع المعتمدة، لا ينبغي عدّها تصويبًا لرسم المصحف. لكن سواء خالفت القراءة التي يرجّحها المرء القراءة السائدة أم لم تخالف، تظلّ قواعد ترجيح قراءة على قراءة (أو قراءات) أخرى ثابتة. وللمزيد عن تصويب رسم المصحف، انظر:
Devin J. Stewart, “Notes on Medieval and Modern Emendations of the Qur’ān,” in The Qur’ān in Its Historical Context, ed. Gabriel S. Reynolds (London & New York: Routledge, 2008), 225–248; Behnam Sadeghi, “Criteria for Emending the Text of the Qurʾān,” in Law and Tradition in Classical Islamic Thought: Studies in Honor of Professor Hossein Modarressi, ed. Michael Cook et al. (New York: Palgrave Macmillan, 2013), 21–41.
[31] كما سيوضّح المؤلِّف لاحقًا، فإنّ اعتبار الآية خطابًا لليهود هو ما عليه كثير من المفسِّرين، وأمّا اعتبارها خطابًا للمشركين فهو ما رجّحه الطبري وابن كثير. (قسم الترجمات)
[32] لتحليل بنية السورة، انظر:
Neuwirth, Studien zur Komposition der mekkanischen Suren (Berlin: Walter de Gruyter, 1981), 290f.
[33] بيّنت في موضع آخر أنّ هذه الآية تقصد بني إسرائيل ككلّ وليس أنبياءهم فحسب:
“The Second Coming of the Book: A Reconsideration of Qur’anic Scripturology and Prophetology” (PhD dissertation, Harvard University, 2018), 181–182.
[34] ومن الجدير بالذِّكْر أيضًا، أنّ عبارة: ﴿مَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ﴾ لم تَرِد إلا في موضعين آخرين من القرآن (الآية: 74 من سورة الحج، والآية: 67 من سورة الزمر)، وكِلا الموضعين يتحدثان عن إشراك المشركين آلهة أخرى مع الله. أمّا إنكار نزول الوحي على البشر، فمنسوب في موضع آخر إلى أحد الأقوام السابقة (الآية: 15 من سورة يس).
[35] وبالمثل، تنتقد الآية 124 المشركين قائلة: ﴿وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ﴾، وانظر أيضًا الآيتين: 109 و111.
[36] يبدو أنّ المشركين قد توسّلوا هنا بالحُجّة العقلية التي سمّاها علماء الكلام لاحقًا حجة الإلزام: نقض موقف الخصم بناءً على مقدّمة يلتزم بها. يلتزم النبي محمد بهذه المقدّمة: الشبه بين دعوته ورسالته ودعوة موسى ورسالته. وبناءً على هذه المقدّمة، يبطل موقفه كرسول من عند الله؛ وذلك لأنه لم يأتِ بوحي كالذي جاء به موسى، أي: وحي مكتوب وجُمْلة واحدة، وإنما بوحي شفوي ومُفرَّق.
[37] ترى كرون أنّ من قال: ﴿سِحْرَانِ تَظَاهَرَا وَقَالُوا إِنَّا بِكُلٍّ كَافِرُونَ﴾ ليسوا خصوم محمد المكيّين وإنما خصوم موسى المصريين. “Angels Versus Humans”, 112. لكن هذا قول معلول لأسباب عدّة، أقواها هو الآية التالية (التي لم تتطرّق إليها كرون): ﴿قُلْ فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَى مِنْهُمَا [أي: التورة والقرآن] أَتَّبِعْهُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾. فمن الجليّ، أنّ هذا ردّ على وصف التوراة والقرآن بأنهما سِحْران في الآية السابقة؛ ولذلك لا بد من أن يكون هذا الوصف على لسان خصوم النبي محمد. ويلزم عنه أنهم كانوا كافرين بالتوراة.
[قرأ ابن كثير وأبو عمرو وغيرهما: ﴿ساحران﴾؛ ولذلك نجد نوعين من الأقول في تفسير هذه الآية: الأول مبنيّ على قراءة ساحران: موسى وهارون، أو موسى ومحمد، أو محمد وعيسى. والثاني مبنيّ على قراءة ﴿سِحران﴾: القرآن والتوراة، أو القرآن والإنجيل، أو التوراة والإنجيل].
[38] قال ابن عطية: «مَنْ قال إنّ المراد كفار العرب فيجيء الاحتجاج عليهم بقوله: ﴿مَنْ أَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى﴾ احتجاجًا بأمر مشهور منقول بكافة قوم لم تكن العرب مكذّبة لهم، ومن قال إنّ المراد بنو إسرائيل فيجيء الاحتجاج عليهم مستقيمًا؛ لأنهم يلتزمون صحة نزول الكتاب على موسى عليه السلام» المحرر الوجيز، (2/ 320)، وذكر ابن عاشور أن المراد بـ﴿شَيْءٍ﴾ في قولهم: ﴿مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِنْ شَيْءٍ﴾ هو من الوحي، ثم قال: «ولذلك أَمَر اللهُ نبيّه بأن يفحمهم باستفهام تقرير وإلجاء بقوله: ﴿مَنْ أَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى﴾ فذكَّرهم بأمر لا يستطيعون جَحْده لتواتره في بلاد العرب، وهو رسالة موسى ومجيئه بالتوراة وهي تدرس بين اليهود في البلد المجاور لمكة، واليهود يتردّدون على مكة في التجارة وغيرها، وأهل مكة يتردّدون على يثرب وما حولها وفيها اليهود وأحبارهم، وبهذا لم يذكّرهم اللهُ برسالة إبراهيم -عليه السلام- لأنهم كانوا يجهلون أنّ الله أنزل عليه صحفًا فكان قد يتطرّقه اختلاف في كيفية رسالته ونبوءته. وإذا كان ذلك لا يسع إنكاره كما اقتضاه الجواب آخر الآية بقوله: ﴿قُلِ اللهُ﴾ فقد ثبت أنّ الله أنزل على أحد من البشر كتابًا فانتقض قولهم: ﴿مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِنْ شَيْءٍ﴾ على حسب قاعدة نقض السالبة الكلية بموجبة جزئية». التحرير والتنوير (7/ 363). ويراجع كذلك كلام الرازي في تفسيره.
[39] تطرح مواضع قرآنية أخرى أسئلة على خصوم النبيّ (وتجيب عليها أحيانًا)، من دون الإشارة إلى أنّ الخصوم يقبلون هذه الأجوبة -على سبيل المثال: الآية 32 من سورة الأعراف: ﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾، والآية 24 من سورة سبأ: ﴿قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ﴾- ومقصد هذه المواضع، فيما يبدو، هو وضع الخصوم بين المطرقة والسِّنْدان: إمّا قبول الجواب القرآني، وبذلك لا بد لهم من الإقرار بخطأ أقوالهم أو أفعالهم السابقة، أو رفض الجواب القرآني، وبذلك ينكرون حقًّا جليًّا أو مقبولًا قبولًا عامًّا. وفي الآية 91 من سورة الأنعام، هذا الحقّ هو مقام التوراة كوحي إلهي مُنزّل على موسى.
[40] يقول ابن عاشور: «القراطيس: جمعُ قرطاس... وهو الصحيفة من أيّ شيء كانت؛ مِن رَق أو كاغد أو خرقة. أي: تجعلون الكتاب الذي أُنزل على موسى أوراقًا متفرّقة؛ قصدًا لإظهار بعضها وإخفاء بعضٍ آخر. وقوله: ﴿تُبْدُونَها وَتُخْفُونَ كَثِيرًا﴾ صفة لقراطيس، أي: تبدون بعضها وتخفون كثيرًا منها، ففُهِم أنّ المعنى: تجعلونه قراطيس لغرض إبداء بعضٍ وإخفاء بعض. وهذه الصفة في محلّ الذم؛ فإنّ اللهَ أنزل كُتبه للهدى، والهدى بها متوقف على إظهارها وإعلانها، فمَن فَرَّقها ليُظهِر بعضًا ويخفِي بعضًا فقد خالف مراد الله منها. فأمّا لو جعلوه قراطيس لغير هذا المقصد لَمَا كان فعلهم مذمومًا، كما كتب المسلمون القرآن في أجزاء منفصلة لقصد الاستعانة على القراءة، وكذلك كتابة الألواح في الكتاتيب لمصلحة». التحرير والتنوير (7/ 365).
[41] قارن بالآية الثالثة من سفر التثنية 8، التي يكلّم فيها موسى بني إسرائيل عن نعمة المَنّ «التي لم تعرفوها أنتم ولا آباكم».
[42] يذكرنا هذا التقييم لحال التوراة بنقد يوحنا ذهبي الفم للتوابيت التي تُحفظ فيها التوراة في الكُنُس: «أيّ شأن للتوابيت التي عند اليهود في أيامنا هذه، حيث لا نجد تكفيرات، ولا ألواح التوراة، ولا قدس الأقداس، ولا حجاب، ولا كاهن أعلى، ولا بخور، ولا محرقة، ولا قربان، ولا غير ذلك من الأشياء التي خلعت الجلال والهيبة على التابوت العتيق».
Against the Jews 6.7.2 = Patrologia Graeca 48.914
مُستشهد به ومدروس في:
Shaye J.D. Cohen, “Pagan and Christian Evidence on the Ancient Synagogue,” in The Synagogue in Late Antiquity, ed. Lee I. Levine (Philadelphia: American School of Oriental Research, 1987), 159–181, at 164.
[43] انظر:
Arthur Jeffery, The Foreign Vocabulary of the Qur’ān (Baroda: Oriental Institute, 1938), 235–236; G.W.H. Lampe, A Patristic Greek Lexicon (Oxford: Clarendon Press, 1961), 1519 (column b); Michael Sokoloff, A Dictionary of Jewish Palestinian Aramaic of the Byzantine Period (Ramat- Gan: Bar Ilan University Press, 1990), 269 (s.v. karṭīs/ qarṭīs); idem, ADictionary of Jewish Babylonian Aramaic of the Talmudic and Geonic Periods (Ramat- Gan: Bar Ilan University Press, 2002), 1039 (s.v. qarṭāsā); J. Payne Smith, A Compendious Syriac Dictionary: Founded upon the Thesaurus Syriacus of R. Payne Smith (Oxford: Clarendon Press, 1903), 519 (s.v. qarṭīsā).
[44] في الأصل، تشير كلمة (تيخوس) اليونانية (الشطر الثاني من مصطلح "بنتاتيخوس" أي: بنتاتوخ) إلى الصندوق أو الأسطواني الذي توضع فيه اللفائف، ثم أصبحت تشير إلى محتواه، أي: اللفائف نفسها. وبذلك أضحت كلمة(بنتاتيخوس) تعني: الأسفار الخمسة أو بالأحرى اللفائف الخمسة (الشطر الأول: "بنتا-"، يعني خمسة)، انظر:
Jean Louis Ska, Introduction to Reading the Pentateuch (University Park, PA: Eisenbrauns, 2006), 1.
[45] انظر:
Emanuel Tov, Scribal Practices and Approaches Reflected in the Texts from the Judean Desert (Leiden and Boston: Brill, 2014), 75ff.
[46] انظر:
Michael Segal et al., “An Early Leviticus Scroll from En- Gedi: Preliminary Publication,” Textus 26/ 1 (2016): 29–58, esp. 33–34.
[47] نقرأ الآتي في الملخص الإنجليزي لهذه الدراسة المكتوبة بالعبرية:
Menahem Haran, “Torah and Bible Scrolls in the First Centuries of the Christian Era” (Hebrew), Shnaton: An Annual for Biblical and Ancient Near Eastern Studies 10 (1990): 93–106.
«أغلب لفائف التوراة في الحقبة التلمودية كانت ذات حجم صغير؛ إِذْ كانت تتضمّن سِفرًا واحدًا من الأسفار الخمسة»، وقال المؤلِّف أيضًا: «لم تَغْدُ القراءة من لفيفة كبيرة تتضمّن التوراة كاملة عملًا سائدًا في الكُنُس إلا بعد اكتمال التلمود البابلي [حوالي سنة 500م]». ونجد نصًّا على أفضلية اللفيفة التي تتضمّن التوراة كاملة في التلمود البابلي (b. Bava Batra, 13b–14a; Gittin 60a)، وكذلك في هذه الرسالة اللاحقة على التلمود: Soferim، خاصّة في الفصل الثالث منها.
[48] طرح التلمود البابلي (Gittin 60a) هذا السؤال: هل ينبغي نقل التوراة بنفس الشكل الأصلي الذي نقلت به من لدن موسى؟ وقدَّم جوابين: الأول، لقد نُقلت التوراة من موسى إلى بني إسرائيل لفيفة لفيفة ("مِجلة مِجلة"، بالعبرية)، أي أنَّ موسى كان يكتبها سِفرًا بعد سِفر. والثاني، لقد نُقلت التوراة من موسى إلى بني إسرائيل بأكملها ("ختوماه" بالعبرية، أي: مختومة) مرّة واحدة. وذكر التلمود عددًا من الأقول المحتملة هنا لكنه لم يقطع بأيٍّ منها.
[49] نقرأ في رسالة Sefer Torah. 3: 7: «قد لا تُنشر أكثر من أربعة أعمدة من لفيفة التوراة [مرة واحدة في أثناء جلسة التلاوة]»، انظر:
The Minor Tractates of the Talmud, translated into English with notes, glossary, and indices under the editorship of A. Cohen, 2 vols (London: Soncino, 1965), 2:638.
وللمزيد عن تعبّد اليهود بتلاوة التوراة في أواخر العصر القديم، انظر:
Daniel Picus, “Reading Regularly: The Liturgical Reading of Torah in its Late Antique Material World,” in Material Aspects of Reading in Ancient and Medieval Cultures: Materiality, Presence and Performance, ed. Anna Krauß et al. (Berlin and Boston: De Gruyter, 2020), 217–232.
[50] للمزيد عن بعض المناحي المعمارية للكُنُس القديمة، انظر:
Rachel Hachlili, “Torah Shrine and Ark in Ancient Synagogues: A Re- evaluation,” Zeitschrift des deutschen Palästina- Vereins 116/ 2 (2000): 146–183.
وفقًا للمشناه (Megillah 3: 1)، أقدس ما في الكنيس هو لفيفة التوراة، ثم غيرها من الأسفار المقدّسة، ثم الحجاب، ثم التابوت، ثم مبنى الكنيس نفسه.
[51] لقد كانت اللفيفة (ولا تزال) الشكل السائد الذي تُتلى منه التوراة في الكُنُس. ومع ذلك، في وقت معيّن، شرع اليهود في تدوين التوراة في شكل مجلدات. ومن أمثلتها الباذخة مجلد حلب [وهو المخطوطة المازوراتية الأساسية، بالإضافة إلى مخطوطة سان بطرس برج] الذي يعود إلى العصر الوسيط. ويرى ديفيد سترن أنَّ هذا التقليد قد بدأ «في أواخر القرن السابع أو في صدر القرن الثامن الميلادي» [أي: في وقت لاحق على القرآن]:
David Stern, The Jewish Bible: A Material History (Seattle and London: University of Washington Press, 2017), 65.
لكن لعلّ هذا التقليد كان مسبوقًا بتدوين التوراة (أو أجزاء منها) في صحف للدراسة أو التلاوة أو الصلاة الفردية. علاوة على ذلك، لم تنص الآية 91 صراحة على أنّ القائمين على التوارة كانوا يهودًا؛ ولذلك من المحتمل أنها تقصد جماعة من النصارى، اعتمدت شكل المجلد في تدوين التوراة في وقتٍ أبكر.
[52] انظر:
Saul Lieberman, Judaism in Hellenistic Palestine: Studies in the Literary Transmission, Beliefs and Manners of Palestine in the I Century B.C.E.—IV Century C.E. (New York: The Jewish Theological Seminary of America, 1962), 203–208, esp. 204–205.
[53] يقول ليبرمان: لقد ظلّت التوراة الشفهية تدوَّن على لفائف ومجلّدات سرية (أي: خاصة). فهي تتألّف غوامض أحكام الربّ التي لا ينبغي نشرها بين بني إسرائيل إلا شفاهة. ولقد أدّى تداول مجلداتها سرًّا إلى جعلها أشبه بالعلم (اللوجس) الهرمسي (الباطني) السري، المُهذِّب والمُحيي، الذي ينبغي كتمانه»:
Judaism in Hellenistic Palestine, 208 (التشديد منّي)
[54] ولذلك شدّد بلاشير على أنَّ هذا الجزء من الآية «مضاف بعد الهجرة إلى المدينة»:
Le Coran, 162 n. 91
[55] “Angels versus Humans,” 111.
[56] نشرنا عرضًا لهذا الكتاب، بعنوان "دراسة القرآن أم "القرآن المفسّر" قراءة في كتاب (القرآن المفسّر: ترجمة وتفسير جديدان"، بروس فودج، ترجمة: إسلام أحمد، منشور ضمن الكتاب المجمع "التفسير في الدراسات الغربية المعاصرة، الجزء الثالث: دراسة المعنى التفسيري"، قسم الترجمات.
[57] Seyyed Hossein Nasr et al., eds., The Study Quran: A New Translation and Commentary (New York: HarperOne, 2015), s.v.
ولعرض مُفصّل لهذا الكتاب بالِغ الأهمية، انظر:
Bruce Fudge, “Study the Quran or The Study Quran?” Journal of the American Oriental Society 138/ 3 (2018): 575–588.
[58] تفسير الرازي (13: 80). قد يكون الرازي مَدِينًا بهذا الفهم للغزالي الذي اتخذ من هذه الآية مثالًا على القياس الشرطي الاقتراني، انظر: القسطاس المستقيم، تحقيق: محمود بيجو (دمشق: المطبعة العلمية، 1993)، (32- 33).
[59] القرآن مع تفسيره الكشاف عن حقائق التنزيل، تحقيق: وليام ناسو ليز وآخرون، مجلدان (كلكتا: مطبعة الليثي، 1856- 1859)، (1: 414).
[60] الميزان في تفسير القرآن، السيد محمد حسين الطباطبائي، 20 مجلدًا (قم: مكتب النشر الإسلامي التابع لجامعة مدرّسي الحوزة العلمية بقم، 1417هـ)، (7: 271).
[61] من أنصار هذا القول: مقاتل بن سليمان: تفسير مقاتل (1: 574- 575)؛ وأبو الليث السمرقدني: بحر العلوم (1: 500- 501)؛ وأبو إسحاق الزجاج، الذي يرى أنّ الآية قد نزلَت في «جماعة من اليهود من منافقيهم... وكان سِمَتهم سِمَة الأحبار... وكانوا يتنعّمون ولا يتعبّدون»: معاني القرآن وإعرابه، تحقيق: عبد الجليل عبده شلبي، 5 مجلدات (بيروت: عالم الكتب، 1988)، (2: 270)؛ والماتريدي، الذي يرى أنَّ الآية نزلَت في بعض أهل الكتاب الذين أنكروا الرسل لأنهم كانوا أهل نفاق: تأويلات القرآن، تحقيق: أحمد وانلي أوغلي وآخرون، 18 مجلدًا (إسطنبول: دار الميزان، 2005- 2011)، (5: 138- 142)؛ والزمخشري: القرآن مع تفسيره (1: 414). وأفضى التأثير الكبير الذي تمتع به الزمخشري على مَن جاء بعده من المفسِّرين إلى انتشار هذا القول؛ إِذْ نجد تعليقاته مكرّرة أو مفصلّة في الكثير من التفاسير التالية عليه، مثل: تفسير البيضاوي، وتفسير أبي السعود، وتفسير الشوكاني. انظر، على سبيل المثال: إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، أبو السعود العمادي الحنفي، تحقيق: عبد القادر أحمد عطا، 5 مجلدات (الرياض: مكتبة الرياض الحديثة، 1971)، (2: 247- 250).
[62] استنادًا على صور المخطوطات المتاحة على موقع: كوربس قورنيكم، حروف أفعال الآية معجمة في صيغة المخاطب في كثير من المخطوطات المبكرة، منها: مخطوطة Wetzstein II 1913(تبدونها، لكن الإعجام غير واضح في الفعلين الآخرين). ومخطوطة جامعة برمنجهام Islamic Arabic 1572 (تجعلونه، وتخفونه، لكن يبدونها على ما يبدو). ومخطوطة Topkapı Sarayı Medina 1a (الأفعال الثلاثة في صيغة المخاطب). ومخطوطة BNF Arabe 334 (j) (في الأصل، الأفعال الثلاثة في صيغة المخاطب، لكن أُضيف إليها لاحقًا ضربان من الإعجام، أحدهما باللون الأخضر الداكن في صيغة المخاطب، والآخر باللون الأحمر في صيغة الغائب). لكن الكثير من المخطوطات المبكّرة الأخرى خالية من الإعجام عند هذا الموضع؛ ولذلك لا تحدد صيغة الأفعال الثلاثة، على سبيل المثال: مخطوطة Codex Parisino- Petropolitanus = BNF Arabe 328 (a)(الفعلان الأول والثاني بلا إعجام والثالث غير واضح)، ومخطوطتا BNF Arabe 328 (e) وArabe 367 (b) (الأفعال الثلاثة غير معجمة)، انظر: corpuscoranicum.de/handschriften/index/sure/6/vers/91
(زرت الموقع في تاريخ: 5/ 6/ 2021).
[63] من اللافت للنظر، أنَّ قلّة من المفسِّرين قالوا إنَّ قراءة صيغة الغائب لا تستبعد أن يكون المخاطبين بالآية هم اليهود. إِذْ يمكن حمل التحوّل إلى صيغة الغائب في مخاطبتهم على أنه التفات، غرضة التوكيد على أهمية أو خطورة الموضوع محلّ النزاع. فالتحوّل من مخاطبة اليهود مباشرة في الآية إلى الحديث عنهم بصيغة الغائب يعبّر عن شدة غضب الله من إنكارهم للقرآن. انظر: نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، برهان الدين البقاعي، 22 مجلدًا (حيدر أباد: مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية، 1969- 1984)، (7: 186). وفتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب وهو حاشية الطيبي على الكشاف، شريف الدين الطيبي، تحقيق: محمد عبد الرحمن سلطان العلماء وآخرون، 17 مجلدًا (دبي: جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، 2013)، (6: 158).
[64] الكشف والبيان عن تفسير القرآن، تحقيق: أبو محمد بن عاشور، 10 مجلدات (بيروت: دار إحياء التراث العربي، 2002)، (4: 167- 169).
[65] التهذيب في التفسير، تحقيق: عبد الرحمن بن سليمان السالمي، 10 مجلدات (القاهرة: دار الكتاب المصري، بيروت: دار الكتاب اللبناني، 2018- 2019)، (3: 2316- 2320).
[66] المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، تحقيق: الرحّالة الفاروق وآخرين، 8 مجلدات، الطبعة الثانية (دمشق: دار الخير، 2007)، (3: 415- 417). يقول: «وقرأ جمهور الناس: ﴿تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ تُبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ﴾ بالتاء من فوق في الأفعال الثلاثة، فمَن رأى أنّ الاحتجاج على بني إسرائيل استقامَت له هذه القراءة وتناسقَت مع قوله: ﴿وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا﴾، ومَن رأى أنّ الاحتجاج إنما هو على كفار العرب فيضطر في هذه القراءة -إذ لا يمكن دفعها- إلى أن يقول: إنه خرج من مخاطبة قريش في استفهامهم وتقريرهم إلى مخاطبة بني إسرائيل بتوبيخهم وتوبيخ أفعالهم» (3: 416). وهذا القول يشبه قول محمد البهي، المذكور في الحاشية رقم 22.
[67] مجمع البيان في تفسير القرآن، 10 مجلدات (بيروت: دار العلوم، 2005- 2006)، (4: 82- 83). ولدراسة مفيدة جدًّا لهذا التفسير، انظر:
Bruce Fudge, Qurʾānic Hermeneutics: Al- Ṭabrisī and the Craft of Commentary (London and New York: Routledge, 2011).
[68] في تفسيره المفصّل لهذه الآية، أشار الرازي أنَّ التأويلَيْن (الآية تخاطب المشركين، أو الآية تخاطب اليهود) وجيهان، ومن العسير الترجيح بينهما. وأحصى الاعتراضات على كلٍّ منهما، وطرق دفعها. انظر: تفسير الرازي (13: 78- 81).
[69] الجامع لأحكام القرآن، تحقيق: أحمد عبد العليم البردوني وآخرين، 20 مجلدًا، الطبعة الثانية (القاهرة: دار الكتب المصرية، 1964)، (7: 36- 38).
[70] ومنهم، المفسر الشيعي المبكِّر عليّ بن إبراهيم القمي (ت: حوالي 330= 941)، في تفسير القمي، تحقيق: السيد طيب الموسوي الجزائري، مجلدان، الطبعة الثالثة (قم: دار الكتاب للطباعة والنشر، 1404هـ)، (1: 210). وانظر أيضًا: البقاعي، نظم الدرر، (7: 184).
[71] جامع البيان، الطبري (9: 396- 397).
[72] جامع البيان، الطبري (9: 397).
[73] التبيان في تفسير القرآن، تحقيق: أحمد حبيب العاملي، 10 مجلدات (بيروت: دار إحياء التراث العربي، بلا تاريخ)، 4: 198- 200.
[74] نفسه.
[75] تفسير القرآن العظيم، تحقيق: سامي بن محمد السلامة، 8 مجلدات (الرياض: دار طيبة، 1999)، (3: 300- 301)؛ في ظلال القرآن، 6 مجلدات (بيروت: دار الشروق، 2003)، (2: 1145- 1147).
[76] جامع البيان (9: 397- 398).
[77] هذا محلّ خلاف، كما تشير إحدى روايات قصة مالك بن الصيف التي تجعل القصة في المدينة وليس مكة، كما ذكرنا سلفًا.
[78] تفسير القرآن العظيم (3: 300).
[79] للخبر بتمامه، انظر: السيرة، ابن هشام (1: 300- 302).
[80] تفسير القرآن الحكيم المشهور بتفسير المنار، محمد رشيد رضا، 12 مجلدًا (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب)، (7: 513- 514).
[81] William A. Graham, Beyond the Written Word: Oral Aspects of Scripture in the History of Religion (Cambridge: Cambridge University Press, 1987), 88.
[82] مصطلح الـ Sitz im Leben، وضعه عالم التناخ، ورائد مدرسة النقد الشكلاني (form criticism) في الدراسات الكتابية، هرمان جونكل (ت: 1932). وقد استعاره في الأصل من عالم الاجتماع جورج زيمل. وقد وضعه في سياق نقده لِمَا يُعرف في الدراسات الكتابية بالـ"documentary hypothesis"، وهي النظرية الشهيرة للغاية التي تقول أنّ محرِّري النسخة المعتمدة من أسفار التوراة (التكوين والخروج والعدد واللاويين والتثنية) قد اعتمدوا على مصادر عِدّة مكتوبة (المصدر G، المصدر E، المصدر H، المصدر P، المصدر D). ففي مقابل التركيز على هذه المصادر المكتوبة، يرى جونكل أن نصوص التوراة كانت موجودة في شكل شفهي قبل أن تقيّد في هذه المصادر المكتوبة، وهذا الشكل الشفهي للنصوص هو ما ينبغي أن نركّز عليه في دراستنا بدلًا من البحث عن هذه المصادر المكتوبة. لكن النصوص الشفهية لكي تتداول وتحفظ وتنقل لا بد من أن يكون لها وظيفة معينة في حياة الأمّة، هي التي بررت حفظها وتناقلها، وهذه الوظيفة هي ما يسمّيه بالـSitz im Leben، والذي يعني حرفيًّا «المكان في الحياة»، مكان النصّ في الحياة. أي: وظيفة النصّ (كأَنْ يُستخدم في الليتورجيا، أي: التعبد بتلاوته، أو يُستخدم كقصة وعظية، أو كدليل على رأي فقهي، أو لتفسير نصّ مقدّس)، التي استدعتْ تصنيفه وتبليغه وتداوله وحفظه ونقله. وأقرب مصطلح تراثي لمصطلح Sitz im Leben هو مصطلح «سبب النزول». (المترجم)
[83] انتقد جبريل سعيد رينولدز هذه الفكرة. وحاجج ضد «قراءة القرآن بعيون المفسِّرين»:
The Qur’an and Its Biblical Subtext (London and New York: Routledge, 2010), 12, 17.
لكن سهام نقده موجهة في الأصل إلى عادة ربط مواضع قرآنية محدّدة بوقائع محدّدة واردة في كتب السيرة. ويطرح المفسِّرون هذه الارتباطات يقينًا، لكن نقاشاتهم تمضي إلى ما هو أبعد من مجرد ربط القرآن بالسيرة. وأرجو أن أكون بيّنت ذلك من خلال هذه الدراسة.
[84] طرح إسلام دية فكرة مماثلة:
Islam Dayeh, “Al- Ḥawāmīm: Intertextuality and Coherence in Meccan Surahs,” in The Qurʾan in Context: Historical and Literary Investigations into the Qurʾānic Milieu, ed. Angelika Neuwirth et al. (Leiden and Boston: Brill, 2010), 461–498, at 494.
مواد تهمك
-
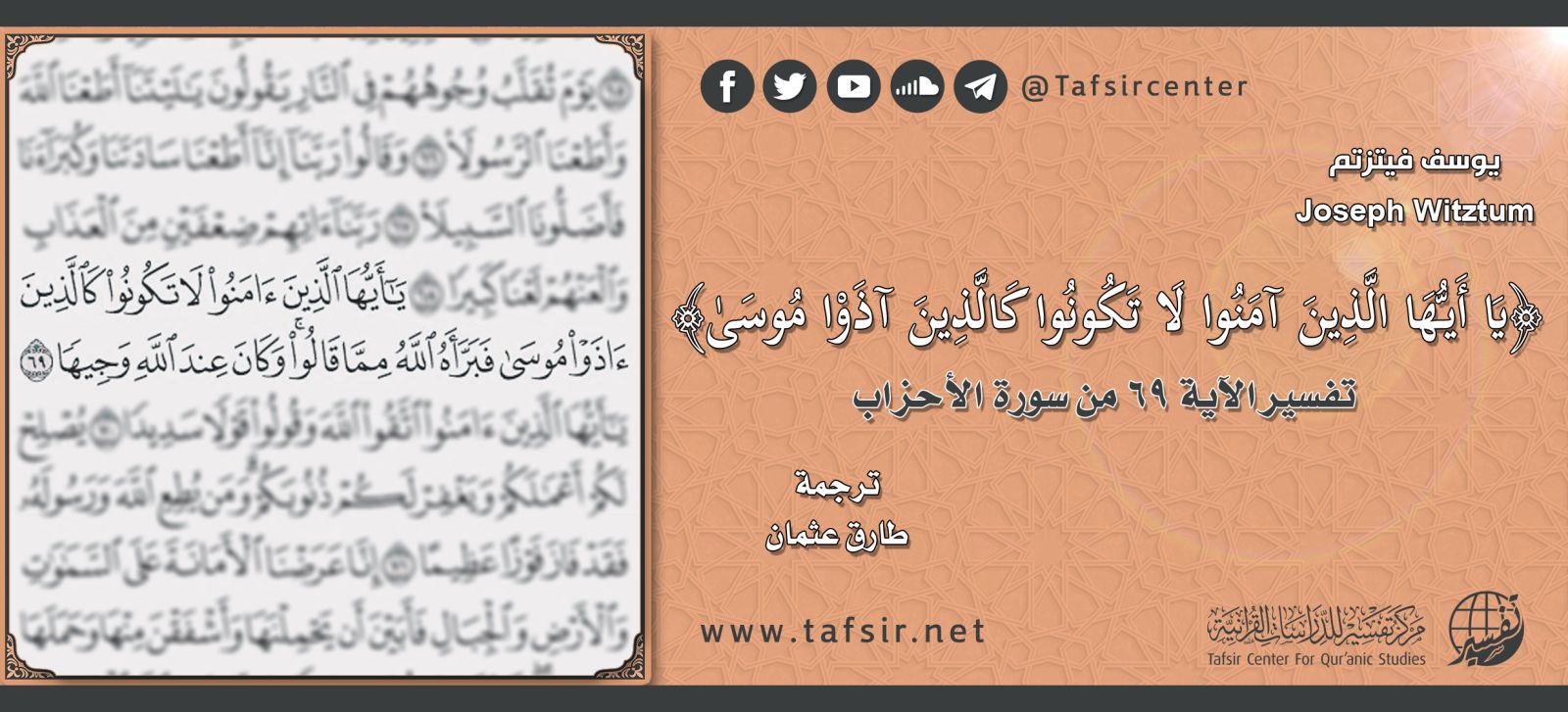 ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَى﴾ تفسير الآية 69 من سورة الأحزاب
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَى﴾ تفسير الآية 69 من سورة الأحزاب -
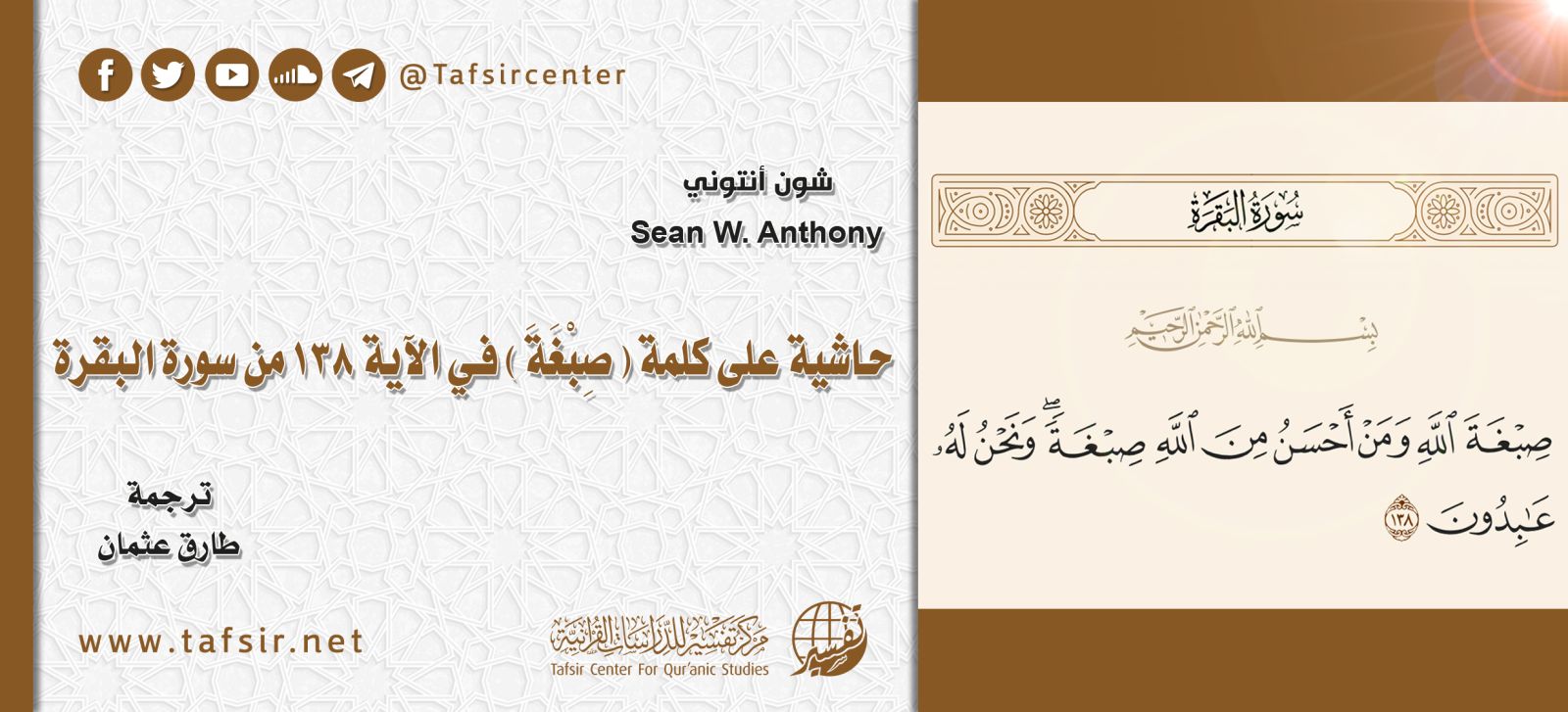 حاشية على كلمة ﴿صِبْغَةَ﴾ في الآية 138 من سورة البقرة
حاشية على كلمة ﴿صِبْغَةَ﴾ في الآية 138 من سورة البقرة -
.jpg) سورة مريم: سلوى وعزاء للنبي؛ قراءة في البناء الموضوعي لسورة مريم
سورة مريم: سلوى وعزاء للنبي؛ قراءة في البناء الموضوعي لسورة مريم -
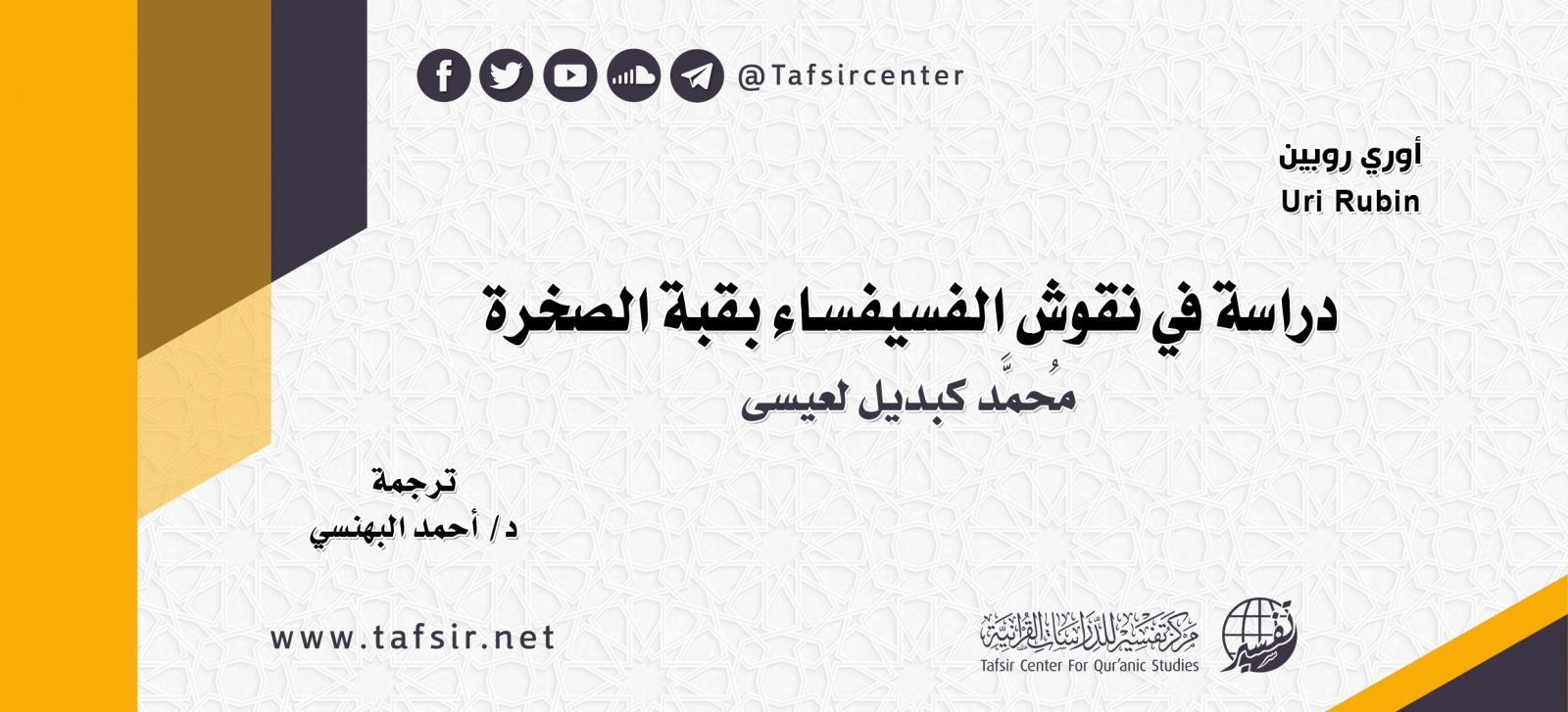 دراسة في نقوش الفُسيفساء بقبة الصخرة؛ مُحمَّد كبديل لعيسى
دراسة في نقوش الفُسيفساء بقبة الصخرة؛ مُحمَّد كبديل لعيسى -
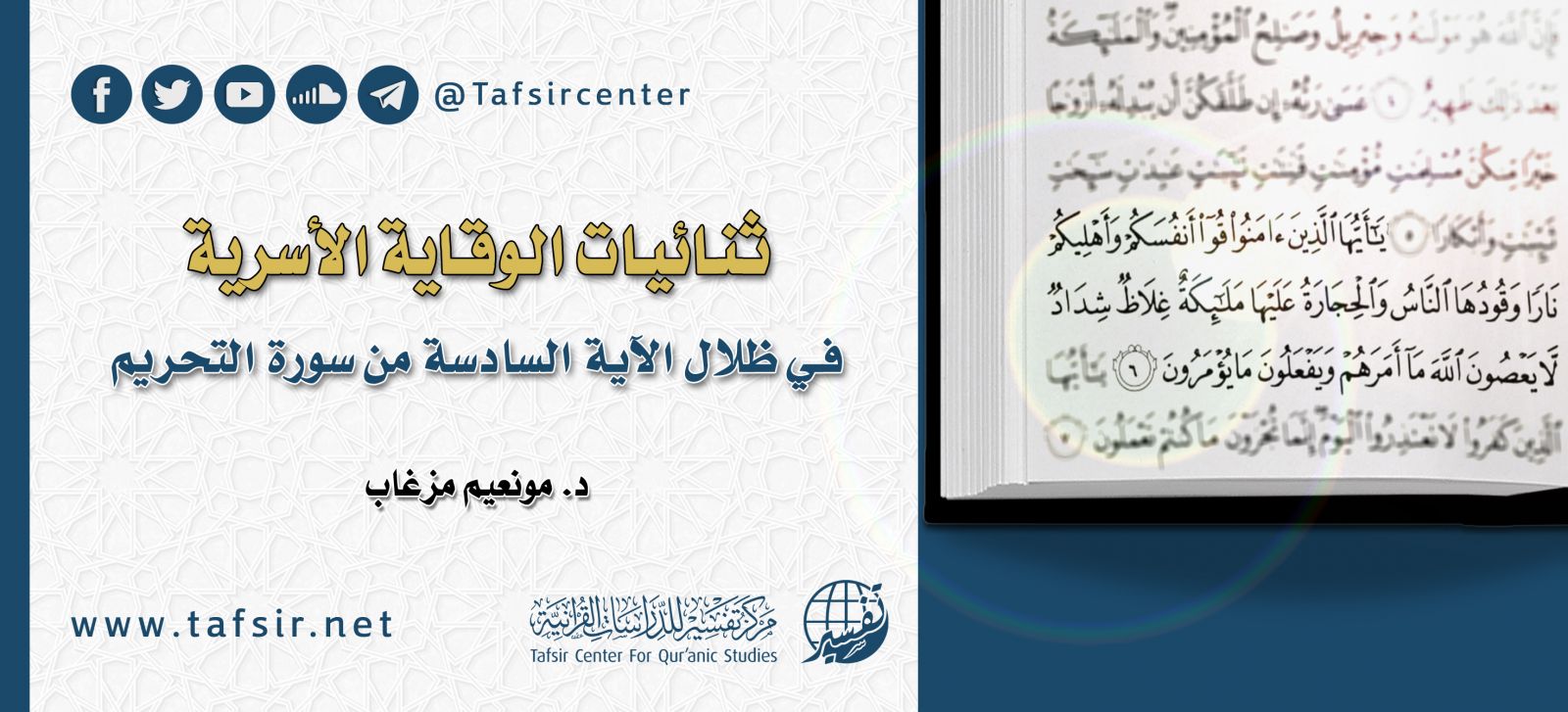 ثنائيات الوقاية الأُسريّة في ظلال الآية السادسة من سورة التحريم
ثنائيات الوقاية الأُسريّة في ظلال الآية السادسة من سورة التحريم -
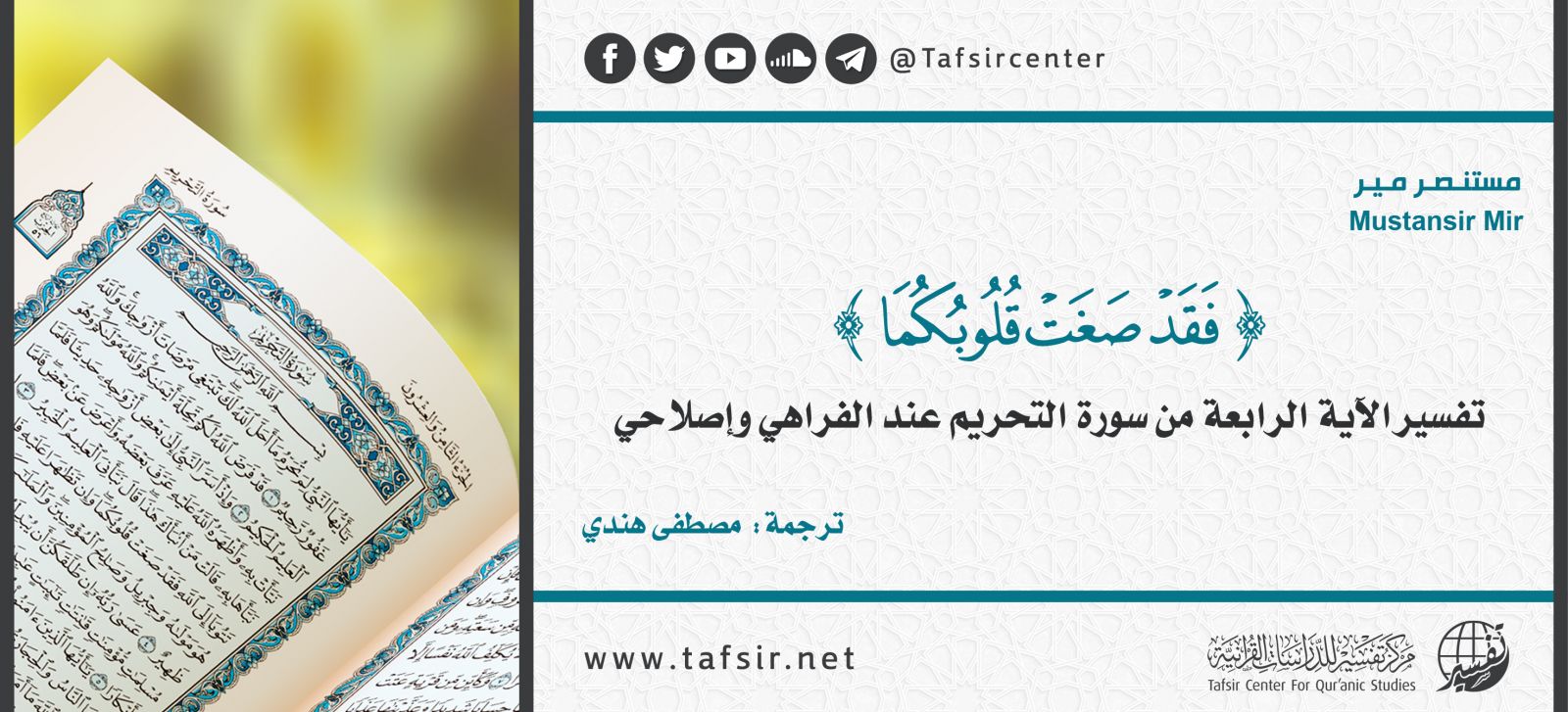 {فَقَد صَغَت قُلوبُكُما} تفسير الآية الرابعة من سورة التحريم عند الفراهي وإصلاحي
{فَقَد صَغَت قُلوبُكُما} تفسير الآية الرابعة من سورة التحريم عند الفراهي وإصلاحي


