الصحابة والقراءة بالمعنى
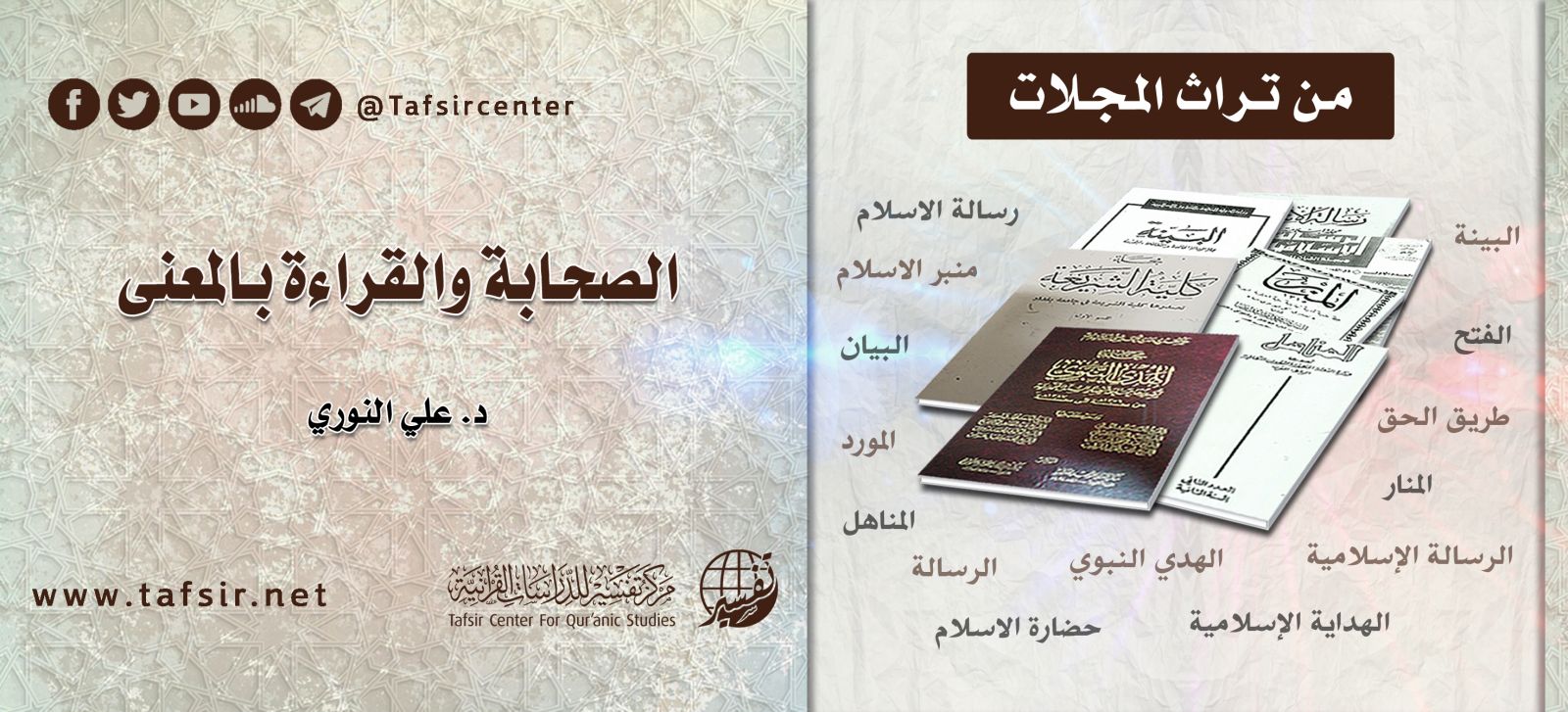
الصحابة والقراءة بالمعنى[1]
نَسبت بعض المصادر إلى كلٍّ من أبي الدرداء (32هـ)[2]، وابن مسعود (32هـ)[3]، وابن عباس (68هـ)[4] -رضي الله عنهم- نصًّا بعينه استُدِلّ به علی أنهم يجيزون القراءة بالمعنى دون نقل.
هذا النصّ يتعلّق بتلقِين رجلٍ قوله تعالى: ﴿إِنَّ شَجَرَتَ الزَّقُّومِ * طَعَامُ الْأَثِيمِ﴾ [الدخان: 43- 44].
ولكن تعذَّر عليه النطق السليم بلفظةِ ﴿الْأَثِيمِ﴾ لِلَكنةٍ فيه، فكان كلّما رُوجع لا يقولها إلّا «اليتيم»[5]، أو «اللئيم»[6]، ولم أجد الأخيرة في غير تفسير الإمام الرازي (606هـ).
مما يجعلني أرى أنها مصحّفة عن الأُولى (اليتيم)؛ إِذْ لم يذكرها أحد غيره من المتقدّمين عنه، ولا من المتأخِّرين. ولمّا أعيَا هذا الرجلُ بخطئه معلِّمَه، أحد هؤلاء الصحابة الثلاثة -رضي الله عنهم- الذين نُسبت لهم الحادثة، قال له ضَجِرًا منه، ويأسًا من صوابه، وتقريبًا لمعنى اللفظة بما يرادفها: «قل: إنّ شجرةَ الزقومِ طعامُ الفاجِر»[7].
والنظر في نِسبة هذه الحادثة إلى الصحابة الثلاثة -رضي الله عنهم- يُفضي إلى ملاحظة ما يأتي:
أ- أنّ حدوثها معهم جميعًا أمرٌ محتمل، على جهة تكرارها مع كلّ واحد منهم منفردًا، واتفاقهم كلّهم في استبدال لفظة «الفاجر» بلفظة «الأثيم» على سبيل التفسير وتقريب المعنى، سواء كان ذلك من باب توارد الخواطر، أو من باب اقتداء اللاحق منهم بالسابق.
ولكن إذا صحّ هذا الاحتمال مع أبي الدرداء وابن مسعود كليهما؛ لأنّهما متعاصران، وتِرْبان، وتصَدَّر كلاهما للإقراء في جهته في زمنٍ واحد تقريبًا[8]، وتُوفّيَا في سنة واحدة (32هـ)، فإنه لا يكاد يصحّ مع ابن عباس لصِغَرِه، وتلقِّيه حروفًا عن ابن مسعود نفسه[9].
وإذا اتّفقت الحادثة في نصّ التعليم [الدخان: 43- 44] مع ثلاثتهم، فإنّ احتمالَ أن يكون الملقِّن رجلًا واحدًا بعينه معهم جميعًا أمرٌ يكاد يكون مستبعدًا جدًّا.
ب- أنّها (الحادثة) يمكن أن تكون حدثتْ فعلًا مع واحدٍ منهم، ولكنها نُسبت خطأ إلى الآخرين، وهو احتمال قوي يكاد يرجح بالاحتمال السابق.
وإذا علم -مع ما تقدّم الآن- أنّ أحدًا لم ينسب هذه الحادثة إلى ابن عباس -رضي الله عنهما- غير الراغب الأصفهاني (502هـ) في كتابه (محاضرات الأدباء) -كما مرّ-؛ إِذْ يحتمل أن يكون الراغب واهمًا في ذلك، استبعدت نسبة هذه الحادثة إلى ابن عباس -رضي الله عنهما- وهو ما أَميلُ إليه.
ج- أنه إذا اتُّهم ابن مسعود -رضي الله عنه- كما اتُّهم صاحباه، بتجويز القراءة بالمعنى من غير نقل في بعض المصادر -كما سيأتي- بناء على هذه الحادثة، إنْ صحّت نسبتها إليه، أو بناء على سواها؛ فإنني لم أجد هذه الحادثة معزوّة إليه عند غير الرازي (606هـ)، والقرطبي (631هـ)، والزركشي (794هـ) -كما مضى آنفًا- وكلُّهم متأخِّرون.
ولم أتبيّن إلى الآن ما مصدرهم في ذلك ممن تقدّمهم، اللهم إلا ما جاء في (البرهان) من أنها رواية ابن وهب (197هـ)، عن مالك بن أنس (179هـ) -رحمه الله- وأنه استفتاه عن القراءة بذلك، فقال: «نعم، أرى أنّ ذلك واسع».
وقد وجّه ابن عبد البر (463هـ) هذه الفُتيا إلى جواز القراءة بذلك في غير الصلاة؛ لأنّ مالكًا لا يرى الصلاة وراء من يَقرأ بحرف ابن مسعود وغيره من الصحابة مما يخالف المصحف[10].
ومفاده أنّ هذا الحرف «الفاجر» بدل «الأثيم» في هذا الموضع من سورة الدخان قراءة شاذّة تُنسب لعبد الله بن مسعود، وليست على المعنى من غير نقل، وشتان ما بين الأمرين.
ولكن على الرّغم من ذلك، يظلّ في النفس من نِسبة هذه الحادثة إلى ابن مسعود شيء، فهي وإن احتملت نسبتها إلى الرَّجُلَيْن جميعًا -كما أسلفت- إلا أنّ الأرجح نسبتها -كما في جُلّ المصادر- إلى أبي الدرداء رضي الله عنه.
بل إنّ تفسير «الأثيم» بـ«الفاجر» في هذا الموضع لم يعز في الغالب إلا إليه استنادًا إلى هذه الحادثة[11].
ومَن ذكرَ التفسير ولم ينسبه إلى أبي الدرداء، فإنما استفاد من هذه الحادثة، وأسقط روايتها درءًا لتوهُّم أن تكون قراءة، أو أن تكون نصًّا في تجويز القراءة بالمعنى من غير إسناد[12] -كما فهمه بعضهم[13]- على ما سيأتي.
بل إنّ أبا حيان الأندلسي (745هـ) أسقط روايتها، وأعرض عن تفسير «الأثيم» بـ«الفاجر» أصلًا، حتى لا يستدعيه ذلك إلى ذِكْرِها أو الإشارة إليها، وفسره بـ«المشرك»[14]، وهذا غاية في التحفّظ ودرء الشبهات.
فالذين رووا هذه الحادثة أو أشاروا إليها ينقسمون إلى أصناف:
منهم من رواها شاهدًا على تفسير «الأثيم» بـ«الفاجر» كابن جرير الطبري[15] (310هـ) دون أدنى إشارة إلى أنّ ذلك وجه مقروء أو أنّ فيها دليلًا على تجويز القراءة بالمعنى.
ومنهم من روى عبارة «طعام الفاجر» مكان «طعام الأثيم» منسوبة إلى صاحبها، ليدلّل على أن ذلك ليس وجهًا مقروءًا، وإنما هو من قَبِيل التفسير؛ كأبي جعفر النحاس (338هـ)، حيث قال: وعن أبي الدرداء قال: طعام الفاجر «وهذا تفسير وليس بقراءة؛ لأنه مخالف للمصحف»[16].
والواقع أنّ في ردّ أبي جعفر -رحمه الله- بعض نظر. فإذا اتضح معنى التفسير في هذا الوجه، فليس ذلك بكافٍ لنفي القراءة به، إن ثبت هذا الحرف بإزاء قراءة شاذة، وليس من شرط القراءة الشاذة أن توافق رسم المصحف العثماني.
أجَلْ، قد يكون أبو جعفر عَنى بذلك أنها ليست قراءة الجمهور، أو أنها ليست قراءة صحيحة لأن السواد لا يحتملها، ولكن ليس في ذلك أيضًا ما يبيح له أن ينفي عن هذا الوجه صفة القراءة مطلقًا، وكتابه مليء بالشواذ.
وإذًا، فتجريد هذا الوجه من صفة القراءة عمومًا بسبب مخالفة المصحف العثماني أمر لا يكاد يستقيم ما لم ينهض لذلك دليل غير المخالفة المذكورة.
ومنهم من روى هذه الحادثة ليستدلّ بها على أمرين معًا:
على تفسير «الأثيم» بالفاجر الكثير الآثام.
وعلى أنّ إبدال كلمة مكان كلمة أخرى جائز في القراءة إذا أدّت معناها.
وقد جاء بهذا الاستدلال الثاني -فيما تبيّنت- جار الله الزمخشري (538هـ)[17].
والواقع أنّ هذا الصحابي حين قال للرجل الذي لا يقدر أن ينطق بلفظة الأثيم، وهو يعلِّمه، قل: «طعام الفاجر»، فإنه إنما ضجر منه فقال له ذلك، وهو لا يعتقد أنه يجيز له القراءة، فذلك على وجه البيان، أخبره أنه طعام الفاجر ليظهر له أنه الأثيم، فكأنّه يقول: اعقل ما يقال لك، إنما هو الفاجر الأثيم، ليس اليتيم وإن كانت اللغة لا تؤدي إلى «اليتيم» موضع «الأثيم»[18].
وليس استدلال الزمخشري هذا بشيء عند جُلّ العلماء[19] وهو في غاية الضعف، على ما هو معلوم في أصول الفقه[20].
ولا حُجّة في هذه الحادثة للجهّال من أهل الزيغ أنه يجوز إبدال الحرف من القرآن بغيره لأنّ ذلك إنما كان تقريبًا للمتعلم وتوطئة منه للرجوع إلى الصواب واستعمال الحقّ والتكلّم بالحرف على إنزال الله وحكاية رسول الله صلى الله عليه وسلم[21].
وانبنى على هذا النحو من الاستدلال أيضًا ما نُسب إلى الإمام أبي حنيفة (150هـ) -رحمه الله- من تجويز القراءة بالفارسية على شريطة أن يؤدّي القارئ المعاني على كمالها من غير أن يخرم منها شيئًا.
وقيل: إنّ هذه الشريطة تشهد أنها إجازة كَلَا إجازة.
وعلى أيّة حال، فقد صحّ عن أبي حنيفة الرجوع عن ذلك[22].
وبعد، فما المانع أن تكون هذه الحادثة قد وقعتْ في زمن العمل برخصة القراءة على أيٍّ من الأحرف السبعة التي أُنزل القرآن بادئ الأمر عليها، تيسيرًا على الأمّة، أي: قبل أن يجمع الخليفة عثمان بن عفان (35هـ) -رضي الله عنه- الناس على مصحف واحد وحرف واحد[23].
وأن يكون هذا الحرف «الفاجر» بدل «الأثيم» في هذا الموضع مما جاءت به الرُّخْصة خصوصًا، وقد تمثّلت في الرجل الملقّن الأسباب الداعية إلى العمل بها، أعني اللكنة والعجز عن النطق السليم. وهو أمر محتمل جدًّا، ولعله يكون الاحتمال الوحيد الذي ينبغي أن توجّه عليه هذه الحادثة -إن صحّت- دون أن نُغْرِب في الاستدلال بها على أنّ من الصحابة -رضي الله عنهم- من يجيز القراءة بالمعنى -كما فعل الزمخشري- وهُم من هذه التهمة براء.
وكيف لقائل أنْ يقول ذلك «مع العلم بما كانوا عليه من المثابرة على نقل القرآن على ما سمعوا، وشدة تحاميهم في ذلك وكثرة الروايات فيه... فأنت ترى تحفّظهم على النصب والرفع على سهولته، فكيف تبديل الكلمة بما هو بمعناها؟»[24].
وإذا كان الصحابة كذلك، فمَن بعدهم لحُسْن التلقي عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وصِدْق الرواية، وأمانة النقل، وورع الأداء؟!
ومَن بَعْدَهم لحفظ ألفاظ الكلام العزيز كما أُنزلت، وهم أعلم الناس بغرض التعبّد بها بأعيانها لا بما يقوم بمعانيها؟! فمَن يزعم إذًا أنّ من الصحابة -رضي الله عنهم- من كان يجيز القراءة على المعنى دون اللفظ من غير نقل فزعمه باطل، واستدلاله داحض، وحجّته واهية، والمتقوّل بذلك كاذب لا محالة[25].
ومنهم مَن رَوى هذه الحادثة ليدفع الاستدلال بها -كما مضى آنفًا- على ما نُسب إلى بعض الصحابة -رضوان الله عليهم- من تجويز القراءة بالمعنى دون رواية، وما نُسب إلى بعض الفقهاء من تجويز القراءة بلغة أخرى غير العربية كالفارسية ونحوها؛ ومن هؤلاء صاحب نكت الانتصار[26]، والراغب الأصفهاني (502هـ)[27]، والإمام فخر الدين الرازي (606هـ)[28]، والقرطبي (631هـ)[29].
ولا يفوتني في هذا الصّدد أن أُلاحظ أمرين مهمّين:
أحدهما: أنّ صاحب (النكت) مالَ إلى التشكيك في صحة هذه الحادثة أصلًا، حيث قال: «...والأحرى أن يكون هذا الحديث لا يصح»[30].
والآخر: أنّ أحدًا لم يرو هذا الحرف «الفاجر» بدل «الأثيم» في هذا الموضع، على أنه قراءة صحيحة منسوبة إلى أبي الدرداء، وابن مسعود جميعًا، دون أدنى تحفّظ غير القرطبي[31].
ترى، هل تعمّد بذلك أن يردّ على أبي جعفر النحاس الذي نفى أن يكون هذا الوجه قراءة -كما تقدّم- والذي يكثر القرطبي من النقل عنه ناسبًا أو غير ناسب؟
أمّا ابن جني (392هـ) -رحمه الله- فقد جاء في (محتسبه) بثلاث روايات عن الصحابي الجليل: أنس بن مالك (91هـ) -رضي الله عنه- ثنتين من طريق الأعمش (148هـ)، وواحدة من طريق أبان بن تغلب الربعي (141هـ).
وكلّهن يحتملن ما نحن بصدده على ما سيأتي تفصيله:
أوردَ أبو الفتح قراءة أنس -رضي الله عنه- التي رواها الأعمش، حيث قال: سمعت أنسًا يقرأ: «لَوَلَّوْا إليه وهم يجمزون»[32]، قيل له: وما يجمزون؟ إنما هي «يجمحون»، فقال: يجمحون ويجمزون ويشتدون، واحد[33].
قال أبو الفتح: ظاهر هذا أن السَّلَف كانوا يقرؤون الحرف مكان نظيره من غير أن تتقدّم القراءة بذلك، لكنه لموافقته صاحبه في المعنى، وهذا موضع يجد الطاعن به إذا كان هكذا على القراءة مطعنًا، فيقول: ليست هذه الحروف كلّها عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كانت عنه لَمَا ساغ إبدال لفظٍ مكان لفظ؛ إِذْ لم يثبت التخيير في ذلك عنه، ولَمَا أنكر أيضًا عليه «يجمزون»[34].
ولو سكت أبو الفتح عند هذا الحدّ لكان كلامه في غاية الخطورة أن يتّهم الصحابة بارتجال القراءة، على ما يجوز في العربية من غير تلقٍّ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبذلك يلفُّ الشّك كثيرًا من الأوجه التي جاءتنا على هذا النحو من الترادف.
ولكنها المقدِرة على الجدال والمهارة في الإقناع، واللباقة في الذَّوْد عن الأصحاب -رضوان الله عليهم- كلّ ذلك جعل ابن جني -رحمه الله- يبسط القضية أوّلًا بلسان المعترض المغرض، ثم يعود بعد ذلك ليدفع الاتهام ويدحض الاعتراض؛ إِذْ قال: إلّا أنّ حُسْن الظنّ بأنسٍ يدعو إلى اعتقاد تقدّم القراءة بهذه الأحرف الثلاثة التي هي: «يجمحون، يجمزون، ويشتدّون»، فيقول: اقرأ بأيّها شئت فجميعها قراءة مسموعة عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ لقوله عليه السلام: (نزل القرآن بسبعة أحرف، كلّها شافٍ كافٍ).
فإن قيل: لو كانت هذه الأحرف مقروءًا بجميعها لكان النقل قد وصل إلينا، قيل: أوَلَا يكفيك أنس موصلًا لها إلينا؟ فإن قيل: إنّ أنسًا لم يحكمها قراءة، وإنما جمع بينها في المعنى، واعتلّ في جواز القراءة بذلك، لا بأنه رواها قراءة متقدمة، قيل: قد سبق مِن ذِكْر حُسن الظنّ ما هو جواب عن هذا»[35].
فبرخصة القراءة على أيٍّ من الأحرف السبعة، وبحُسْن الظنّ؛ دفع أبو الفتح عن هذا الصحابي -رضي الله عنه- توهُّم القراءة بما يسوغ في العربية من غير تلقٍّ عن النبي.
ونعوذ بالله أن يركب سوءُ الظنّ للنَّيْل من رجال اصطفاهم اللهُ -عزّ وجل- صحابةً لرسوله وحَمَلَة لدينه.
ب- أورد ابن جني أيضًا رواية الأعمش عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- أنه قرأ: ﴿وَأَقْوَمُ قِيلًا﴾ [المزمل: 6]، و«أصوب قيلًا» فقيل له: يا أبا حمزة، إنما هي ﴿وَأَقْوَمُ قِيلًا﴾، فقال أنس: إنّ «أقوم»، و«أصوب»، «وأهيَأ»، واحد[36].
وقد نسب الطبري[37] مثل هذا أيضًا إلى مجاهد (103هـ)، وإن كان أورد ما روى عن الرجلين شاهدًا على تفسير «أقوم» بـ«أصوب» وما في معناها.
ونسبه الكرماني أيضًا إلى الصحابي أُبيّ بن كعب[38] (35هـ) -رضي الله عنه-.
على حين ذكر أبو حيان الأندلسي (745هـ) «أصوب» في قول مجاهد وقتادة (117هـ) على جهة التفسير[39] كالطبري، كأنّه أنِف أن ينقل ذلك قراءة، على الرغم من اعتماده كثيرًا على الكرماني؛ لأنه حرف احتمل التفسير في رأيه، وما كان كذلك فلا يعدّ عنده قراءة.
ولم أجد أحدًا قد ذكر القراءة بـ«أهيَأ» مكان «أقوَم» صراحة، غير ما يحتمله كلام ابن جني والكرماني من أنها قراءة أنس بن مالك وأُبيّ بن كعب، رضي الله عنهما[40].
وليت أبا الفتح سكت هاهنا، واكتفى بعرض الرواية عن التعليق عليها بما يكاد يوهم أنها قراءة مرتجلة دون إسناد.
وبذلك يوشِك أن ينقض على نفسه ما كان احتجّ به لأنس -رضي الله عنه- في الموضع السابق، من حُسْن الظنّ به، بما يدفع مثل ذلك التوهّم عن القارئ وحرفه جميعًا.
ولكنه أَبَى إلا أن يقول: «هذا يؤنس، بأنّ القوم كانوا يعتبرون المعاني، ويخلدون إليها، فإذا حصلوها وحصنوها، سامحوا أنفسهم في العبارات عنها»[41]، بألفاظ مختلفة في المباني متفقة في أداء تلك المعاني.
وسامح اللهُ أبا الفتح عن هذه العبارة، فإنها تصلح أن تكون أصلًا عامًّا من أصول العربية على نحو ما ذكره في (الخصائص) وعقد له بابًا سمّاه: «إيراد المعنى المراد بغير اللفظ المعتاد»[42]. وهو حاصل جائز في كلام العرب شعرًا ونثرًا، أمّا في القرآن الكريم فَلا.
وإذا كان من العرب مَنْ يتسامحون في التعبير عن المعنى الواحد بألفاظ مختلفة في كلامهم، فليس في ذلك دليل على أن نقَلة القرآن هم أيضًا يتسامحون في التعبير عن معانيه بألفاظ غير متلقّاة ولا مروية ترادف ألفاظه.
وإذا كان القرآن الكريم يتعبّد بلفظه ومعناه، فليس لأحد أن يستبدل بألفاظه ألفاظًا أخرى، وإن أدّت المعنى المراد. والصحابة -رضي الله عنهم- أفقه لهذا وهم أخشى لله، وأحرص على كتابه، وأورع من أن يتخيروا القراءة على ما يجوز في العربية دون تلقٍّ عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أو رواية.
وإنما حقّهم علينا حُسْن الظّن بهم بما لا يدع مجالًا لاستنقاصهم أو تثريبهم.
ج- ذكر ابن جني رواية أبان بن تغلب الربعي[43] (141هـ) أيضًا عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- أنه قرأ: «وحططنا عنك وزرك»[44]، قال: قلت: يا أبا حمزة «ووضعنا»، قال: وضعنا، وحللنا، وحططنا عنك وزرك؛ سواء، إنّ جبريل أتى النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فقال: «اقرأ على سبعة أحرف، ما لم تخلط[45] مغفرةً بعذاب أو عذابًا بمغفرة»[46].
وقد جاءت القراءة بـ«وحللنا عنك وِقرك» عن عبد الله بن مسعود (32هـ) أيضًا[47].
وهنا يأوي أبو الفتح -رحمه الله- إلى ركن القضية، ليجد عِلّة انتشار هذه القراءات الموهمة بأنها متخيرة بلا رواية، حيث قال: «قد سبقتْ مثل هذه الحكاية سواء عن أنس»[48]. «وهذا ونحوه هو الذي سوّغ انتشار هذه القراءات، ونسأل اللهَ توفيقًا»[49].
وإذا أمكن حمل عبارات ابن جني التي تقرّ -في ظاهرها- بارتجال القراءة دون نقل، على هذا الركن، وعلى حُسْن الظنّ، كان في ذلك وجه إعذار لأبي الفتح -رحمه الله تعالى-.
وعليه، فإذا تعدّدت الألفاظ المختلفة لتفيد معاني متّفقة جازت القراءة بأيٍّ منها بشرط أن تتصل روايته برسول الله صلى الله عليه وسلم.
ولكن يبدو لي أنّ هذا كان في زمن الترخيص بالقراءة على الأحرف السبعة أفشى منه فيما بعده.
غير أنّ من العلماء المتقدّمين على أبي الفتح أبا بكر الأنباري (328هـ)، منع أن يؤخذ برواية الأعمش (148هـ)، عن أنس (91هـ) -رضي الله عنه- من قِبَل أنّ الأعمش رأى أنسًا ولم يسمع منه، فروايته عنه مقطوعة وليست متصلة.
وقد جاء حديث الأحرف السبعة في بعض رواياته وأوجهه عن الأعمش عن أنس[50]، وكذلك ما مضى الآن في هذا البحث من القراءة على سبيل الترادف.
وإذا لم تصح -كما رأيت- رواية الأعمش عن أنس -رضي الله عنه- فرواية أبان عنه أبعد من الصحة؛ لأنّ أبان هو نفسه قرأ عن الأعمش.
فكلاهما روايته عن أنس مقطوعة.
وهكذا يصير الكلام على قضية القراءة بالمعنى دون إسناد، بناء على هذه الأوجه القليلة عند الصحابة -رضوان الله عليهم- لا أساس له.
ولكن التساؤل هنا: كيف احتجّ ابن جنّي -رحمه الله- في (محتسبه) لأوجه لا تصحّ روايتها أو يُشَكّ -على الأقل- في اتصال سندها؟
والجواب عن هذا في غاية اليسر -إن شاء الله- ذلك أن التساؤل قد حدّد في أثنائه، القراءة الشاذة، وهي التي جاءها الشذوذ من قبل الرواية أو من قبل العربية أو من قبل الرسم.
وإنما أسّس أبو الفتح (محتسبه) على الاحتجاج لهذه الشواذ من جهة العربية، وإذا لم تثبت رواية فكيف يتم الاحتجاج بها من جهة العربية لا من جهة النقل، يُقال لابن جنّي: أثبت العرش، ثم انقشه، لا من جهة النقل، وقد رأيتَ قريبًا كيف نقد أبو بكر الأنباري رواية الأعمش عن أنس، وهو ما لم يفعله ابن جنّي -رحمه الله- وإن اعتمد القراءة في (محتسبه)؛ لأنّ ذلك لم يكن قصده، ولكلِّ فنٍّ أهله.
[1] نُشرت هذه المقالة في مجلة (كلية الدعوة الإسلامية) بالجماهيرية الليبية، العدد الحادي عشر، سنة 1994م، ص9 وما بعدها. (موقع تفسير)
[2] انظر: تفسير الطبري، حلبي (25/ 78)، إعراب النحاس (4/ 134)، نكت الانتصار، ص325، «وفيه: ابن أبي الدرداء، وقد مرّ على المحقق هكذا، فبحث في ترجمة هذا الصحابي الجليل، أبي الدرداء، فوجدت أنّ له ولدًا يدعى: بلالًا، أخذ القراءة عن والده، ولكنه لم يشتهر بالإقراء، ولم يترجم له في كتب طبقات القراء بحيث يبعد أن تكون هذه الحادثة التالية وقعت مع الابن»، وانظر: الكشاف (3/ 506)، تفسير القرطبي (16/ 149).
[3] انظر: تفسير الرازي (27/ 252)، تفسير القرطبي (16/ 149)، البرهان (1/ 222).
[4] انظر: محاضرات الأدباء (4/ 434).
[5] انظر: تفسير الطبري، حلبي (25/ 78)، نكت الانتصار، ص325، تفسير القرطبي (16/ 149)، البرهان (1/ 222).
[6] انظر: تفسير الرازي (27/ 252)، كذا.
[7] انظر: تفسير الطبري، حلبي (25/ 78)، إعراب النحاس (4/ 134)، نكت الانتصار، ص325، الكشاف (3/ 506)، محاضرات الأدباء (4/ 434)، تفسير الرازي (27/ 252)، تفسير القرطبي (16/ 149)، البرهان (1/ 222).
[8] أبو الدرداء في الشام، وابن مسعود في الكوفة.
[9] انظر: طبقات القراء (1/ 426).
[10] انظر: البرهان (1/ 222).
[11] انظر: تفسير الطبري، حلبي (25/ 78)، إعراب النحاس (4/ 134)، نكت الانتصار، ص325، الكشاف (3/ 506)، تفسير القرطبي (16/ 149).
[12] انظر مثلًا: معاني الفراء (3/ 43).
[13] انظر: الكشاف (3/ 506).
[14] انظر: البحر (8/ 39).
[15] انظر: تفسير الطبري، حلبي (25/ 78).
[16] إعراب النحاس (4/ 134).
[17] انظر: الكشاف (3/ 506).
[18] نكت الانتصار، ص325.
[19] انظر: محاضرات الأدباء (4/ 34).
[20] انظر: تفسير الرازي (27/ 252).
[21] تفسير القرطبي (16/ 149).
[22] انظر: نكت الانتصار، ص337 وما بعدها، الكشاف (3/ 506)، القواعد والإشارات في أصول القراءات للحموي، ص28، البرهان (1/ 465).
[23] في هذه المسألة رأيان؛ أحدهما هذا، وعليه الطبري (310هـ)، والطحاوي (321هـ)، وابن عبد البر (463هـ). والآخر: أنّ المصاحف العثمانية حوَتْ من الأحرف السبعة ما احتمله الرسم ووافق العرضة الأخيرة، وعليه أبو الفضل الرازي (454هـ)، وأبو شامة (665هـ)، وابن الجزري (833 هـ)، وهذا الثاني أوفق عندي، والله أعلم.
[24] نكت الانتصار، ص328- 329.
[25] انظر: القواعد والإشارات، ص27- 28، النشر (1/ 32).
[26] انظر: نكت الانتصار، ص325- 327، وقد نسبها المحقق د. محمد زغلول سلام للباقلاني (403هـ)، والصواب أن كتابه هو الانتصار لنقل القرآن و(النكت) مختصر له، من عمل الشيخ أبي عبد الله الصيرفي. وانظر: نكت الانتصار نفسه، ص50- 51.
[27] انظر: محاضرات الأدباء (4/ 434).
[28] انظر: تفسير الرازي (27/ 252).
[29] انظر: تفسير الطبري (16/ 149).
[30] نكت الانتصار، ص325.
[31] انظر: تفسير القرطبي (16/ 149).
[32] وانظر هذه القراءة أيضًا في البحر (5/ 55).
[33] انظر: مختصر الشواذ، ص175.
[34] المحتسب (1/ 296).
[35] المحتسب (1/ 296).
[36] المحتسب (2/ 336)، وانظر: تفسير الطبري، شاكر (1/ 52)، نكت الانتصار، ص324- 325، وفيه: وإن كانت سائغة بالنون أيضًا إلا أن المصادر المتقدمة على صاحب النكت والمتأخرة عنه لم تذكرها إلا بالياء. وانظر: الكشاف (4/ 176)، تفسير القرطبى (19/ 41).
[37] انظر: تفسير الطبري، حلبي (29/ 83).
[38] انظر: شواذ القراءة (مخ)، ص252.
[39] انظر: البحر (8/ 363).
[40] انظر: المحتسب (2/ 336)، شواذ القراءة (مخ)، ص252.
[41] المحتسب (2/ 336).
[42] انظر: الخصائص (2/ 466- 469).
[43] وهذا قرأ على عاصم وأبي عمرو الشيباني وطلحة بن مصرف والأعمش، انظر: طبقات القراء (1/ 4).
[44] مكان «ووضعنا...» [الشرح: 2].
[45] المراد بالخلط هنا أن يوضع اللفظ الدالّ على المغفرة في موضع اللفظ الدالّ على العذاب، والعكس.
[46] المحتسب (2/ 367)، وانظر: مختصر الشواذ، ص175، شواذ القراءة (مخ)، ص267، الكشاف (4/ 266)، تفسير القرطبي (20/ 105).
[47] انظر: معاني الفراء (3/ 275)، مختصر الشواذ، ص175، وما بعده من المصادر الواردة في الحاشية السابقة.
[48] انظر: المحتسب (1/ 296)، و(2/ 336)، وقد مضى النصان جميعًا في هذا البحث.
[49] المحتسب (2/ 367).
[50] انظر: تفسير القرطبي (19/ 41- 42).


