المنشورات الحديثة في المجلات العلمية الغربية المتخصّصة في الدراسات القرآنية
ملخصات مترجمة
الجزء التاسع والثلاثون
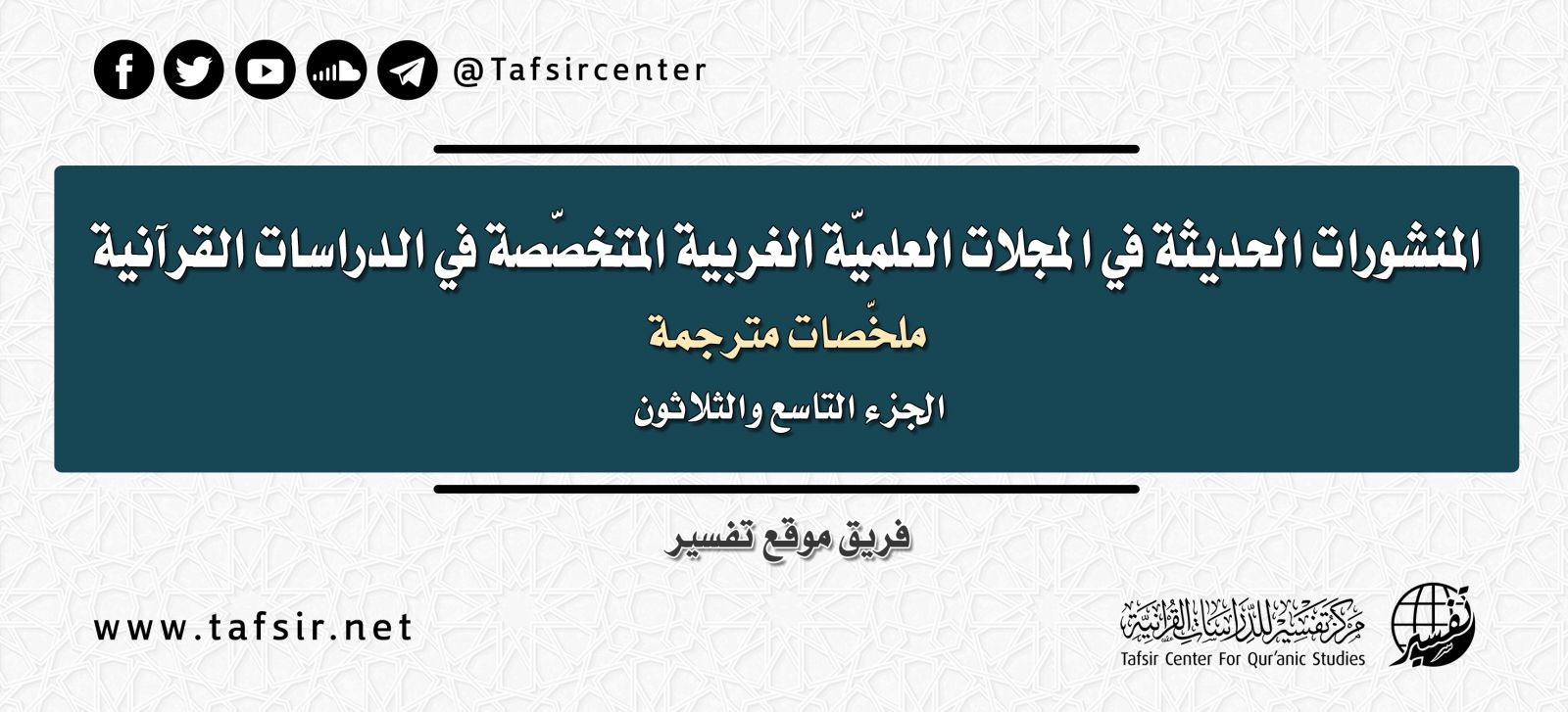
هذه المقالة هي الجزء (39) من ترجمة ملخَّصات أبرز الدراسات الغربية المنشورة حديثًا[1]، والمنشورة في بعض المجلات الغربية، والتي نحاول من خلالها الإسهام في ملاحقة النتاج الغربي حول القرآن الكريم ومتابعة جديدِهِ بقدرٍ ما، وتقديم صورة تعريفية أشمل عن هذا النتاج تتيحُ قدرًا من التبصير العامّ بكلِّ ما يحمله هذا النتاج مِن تنوُّع في مساحات الدَّرْس.
1- Advancing Gender Equality in Muslim Leadership: Women's Representation in Ulama Bodies in Post-Apartheid South Africa
Fatima Essop
African Journal of Gender and Religion, Vol. 30, No. 2 (December 2024)
تعزيز المساواة بين الجنسين في القيادة الإسلامية: تمثيل المرأة في هيئات العلماء في جنوب إفريقيا ما بعد الفصل العنصري[2]
فاطمة إيسوب
في ظلِّ مرحلةِ ما بعد الفصل العنصري في جنوب إفريقيا، لا يزال الوعد الدستوري بالمساواة يُشكِّل تحديًا لهياكل السلطة التقليدية، لا سيّما داخل المؤسّسات الدينية. تُلقي هذه المقالة نظرةً نقديةً على الاستبعاد المنهجي للنساء من الأدوار القيادية في هيئات علماء المسلمين، على الرغم من التقدُّم الكبير في التعليم الديني والإنجازات العلمية للنساء المسلمات.
وتُجادل الدراسة بأنّ استبعاد النساء من هيئات علماء المسلمين ليس مُبرّرًا لاهوتيًّا ولا يُمكن الدفاع عنه عمليًّا. وبالاستناد إلى التفسيرات المُساواتية للتقاليد الإسلامية، والأمثلة التاريخية على إسهامات المرأة العلمية في الإسلام، والممارسات العالمية المُعاصرة للقيادة الدينية للنساء، يُواجِه البحث التفسيرات الأبوية المُتجذِّرة التي تُقيِّد أدوار المرأة.
وتستكشف هذه الدراسة، على وجه التحديد، السياق التاريخي للمجتمع الإسلامي في جنوب إفريقيا، والتكوين الحالي لهيئات علماء المسلمين، والإنجازات العلمية الواسعة للنساء المسلمات.
يُسلِّط البحثُ الضوءَ على كيفية تمتّع هذه الهيئات بسُلطة كبيرة في مسائل الزواج والطلاق والميراث وإصدار الفتاوى الشرعية، مع أنها لا تزال تحت سيطرة الرجال فقط. ويكشف أنّ النساء المسلمات في جنوب إفريقيا يتمتّعن الآن بمستوى تعليمي واسع في العلوم الإسلامية، وقادرات تمامًا على تَولِّي مناصب قيادية. ومن خلال الدعوة إلى التنوع بين الجنسين في القيادة الدينية، يقترح البحث مسارًا نحو حَوْكَمَة دينية أكثر شمولًا وتمثيلًا وإنصافًا، تتماشَى مع المبادئ الإسلامية والقِيَم الدستورية لجنوب إفريقيا المتعلّقة بالمساواة بين الجنسين.
2-FINDING THE QUR’AN IN IMITATION: CRITICAL MIMESIS FROM MUSAYLIMA TO FINNEGANS WAKE
William Sherman
ReOrient, Vol. 9, No. 1 (Autumn 2024)
إيجاد القرآن في المحاكاة: المحاكاة النقدية من مسيلمة إلى فينيجانز ويك
وليم شيرمان
تُولِي بعضُ صياغات الفقه الإسلامي وزنًا كبيرًا لمبدأ إعجاز القرآن، أي: الاستحالة الإعجازية لتقليد القرآن. ومع ذلك، لم يفهم الكثير من المسلمين وغير المسلمين عقيدة الإعجاز على أنها استحالة لا نهائية للتلقيد، بل تعامل هؤلاء بجرأة مع القرآن بطُرق تُفلت من العادات الأكاديمية التقليدية في تصنيف العلوم القرآنية.
باختصار، هناك العشرات من محاولات تقليد النصّ القرآني عبر التاريخ الإسلامي، وتجادل هذه المقالة بأنها ليست مجرّد استفزازات، بل تُمثّل جهودًا مُتنوّعة للمشاركة في الوحي الإلهي، وتجسيد القرآن مع إفناء الذات، وإعادة فتح اللحظة المُسيحانية للتواصل اللغوي المباشر بين الله والبشرية.
وفي الختام، تَتَتَبّع هذه المقالة نماذج من تقليد القرآن الكريم لتطوير تأويل أدبي للقرآن الكريم يمكننا من خلاله قراءة القرآن الكريم في مختلف النصوص الأدبية والفلسفات اللغوية.
3- EARLY MEDINAN SURAS: THE BIRTH OF POLITICS IN THE QUR’AN
Walid Saleh
ReOrient, Vol. 9, No. 1 (Autumn 2024)
السور القرآنية المبكّرة، ميلاد السياسة في الإسلام
وليد صالح
يتمحور هذا المقال حول ربط مسائل التسلسل الزمني في القرآن الكريم بإشكاليات أكبر تتعلّق بعمليات تشكيل الهوية في صدر الإسلام. وبشكل أكثر تحديدًا، يقترح المقال تقسيمًا جديدًا للفترة القرآنية المدنية. من خلال تحليلٍ مُفصَّل لسورة النحل (١٦)، يُبيِّن هذا المقال أنها نزلت في المدينة المنورة بعد الهجرة وقبل غزوة بدر، على عكس الرأي السائد الذي يَعتبر هذه السورة وغيرها من السور المدنية المماثلة (بما في ذلك سورة الأعراف وسورة العنكبوت) تأليفًا مكيًّا وتعديلًا مدنيًّا. يُظهر التحليل في هذا المقال أنّ اعتبار سورٍ مثل سورة النحل تأليفًا زمنيًّا ليس ضروريًّا ولا مبررًا له.
في محاولتها لإعادة توجيه فهمنا للتسلسل الزمني للقرآن الكريم، تحاول هذه المقالة فتح آفاق جديدة في كيفية تصوّرنا لحدود الهوية الإسلامية خلال هذه اللحظة الانتقالية بالغة الأهمية في حياة النبيّ والقرآن والإسلام.
4- QUR’ANIC ORALITY AND TEXTUAL EPISTEMOLOGIES OF THE HUMANITIES
Lauren Osborne
ReOrient, Vol. 9, No. 1 (Autumn 2024)
الشفاهية القرآنية والإبستمولجي النصِّي للعلوم الإنسانية
لورين أوبسبرن
يجادل هذا المقال بأنّ القرآن الكريم يُقدِّم نظرية معرفية تُعيد تركيز الفئات التي تُشَكِّل أساس الفهم الحديث للدِّين والمعرفة. ويتمّ ذلك من خلال دراسة دور الشفهية، والنصِّية، والكتابة، والاستماع في علاقتها بالقرآن الكريم.
يتكوّن المقال من جزأين؛ أولًا: يُقدِّم توليفًا ومقاربةً للبحث حول بناء التصنيف الحديث للدِّين، مع مناقشة الطرق الحديثة للمعرفة. ثانيًا: يجادل بأنّ زيادة الاهتمام بالشفهية والصوت والاستماع في علاقة القرآن الكريم تُفسد الحياد المفترض لفئات المعرفة والذاتية المرتبطة بالتصنيف الحديث للدِّين.
يكشف المقال عن الافتراضات الضمنية لفئات الشفهية والنصّية التي تدعم التصنيف الحديث للدِّين، والذي يقدِّم له القرآن نظرية معرفية تتشابك فيها الشفهية والنصّية وتتداخلان في فئات وطرق للمعرفة والتجربة، وليست فئات منفصلة كما يُفترض غالبًا.
[1] يمكن مطالعة الجزء السابق على هذا الرابط: tafsir.net/paper/84.
[2] تعريب عناوين المقالات والبحوث هو تعريب تقريبي من عمل القِسْم. (قِسم الترجمات)


