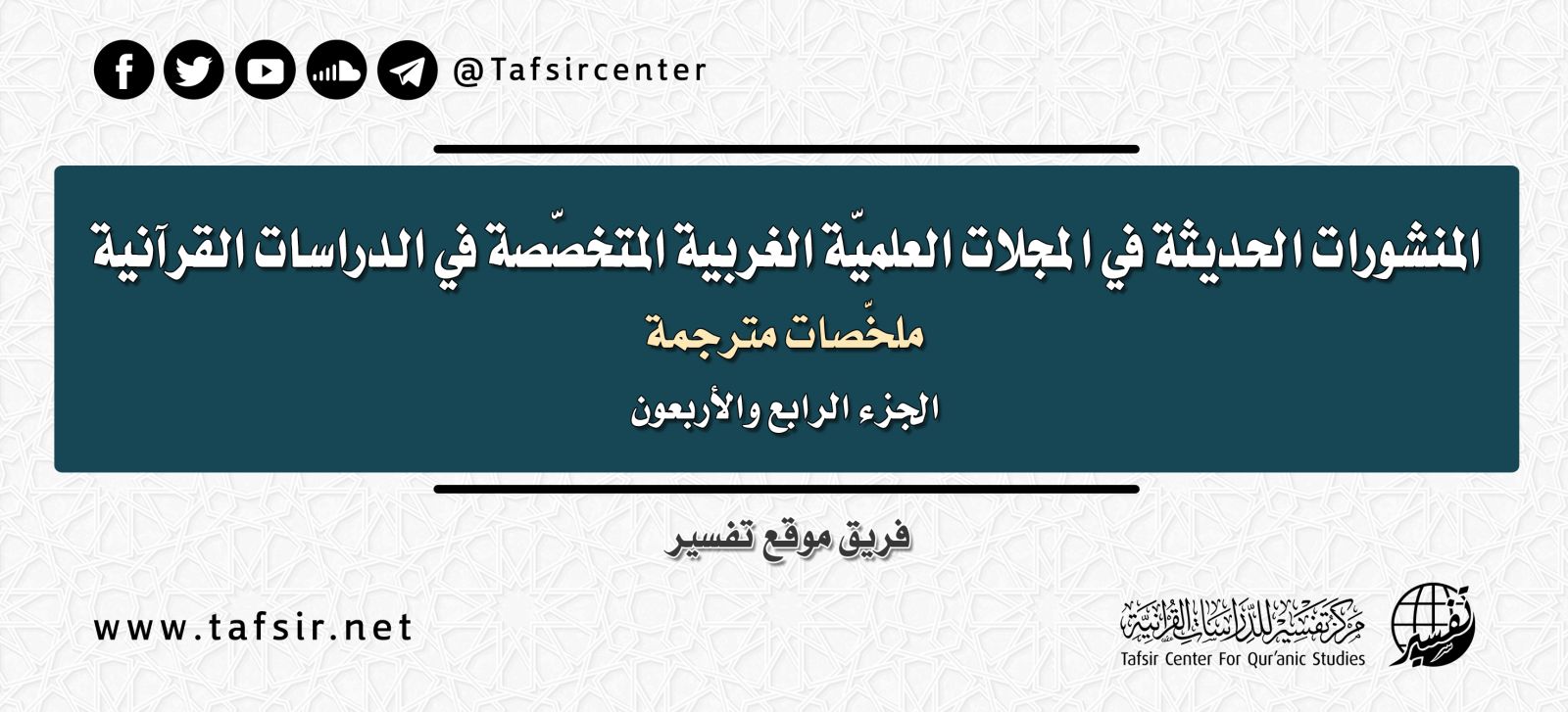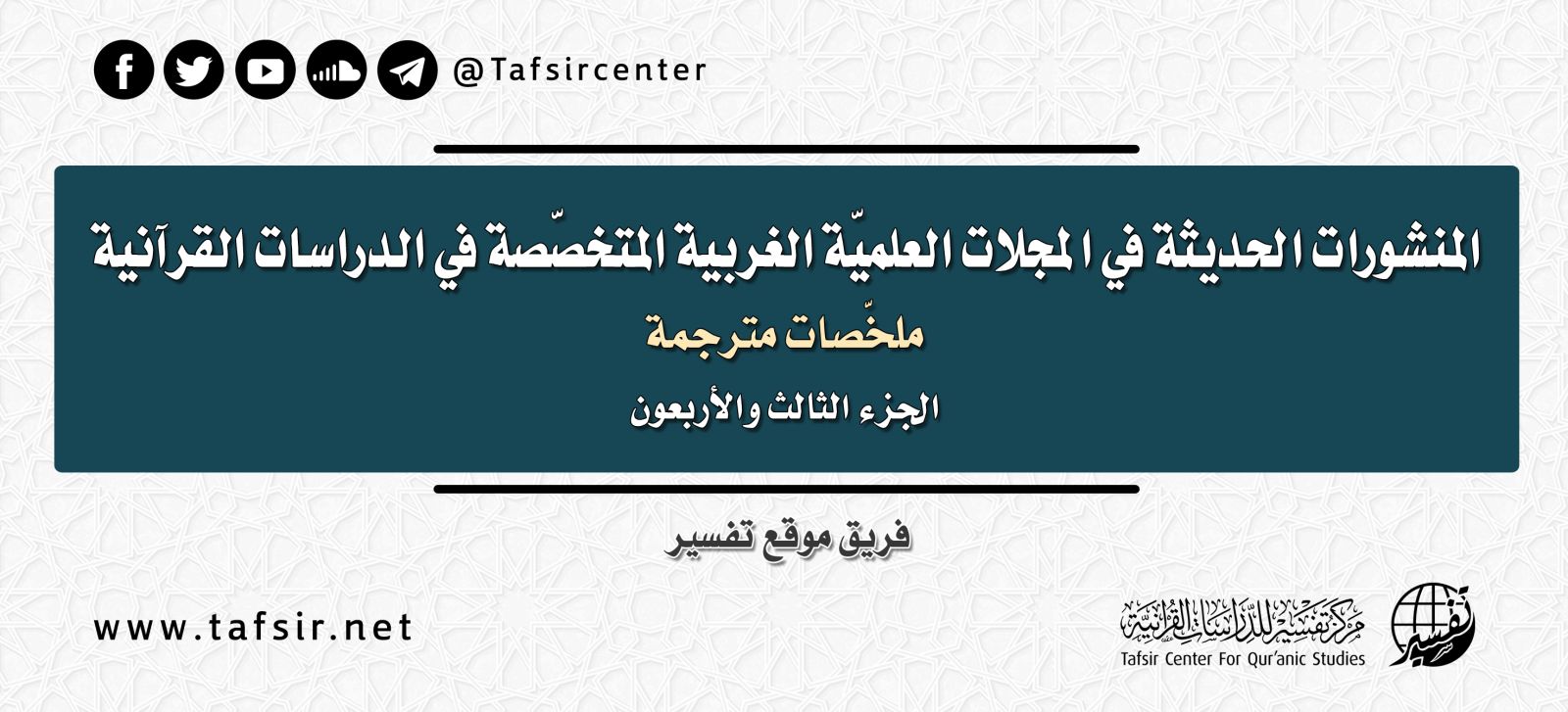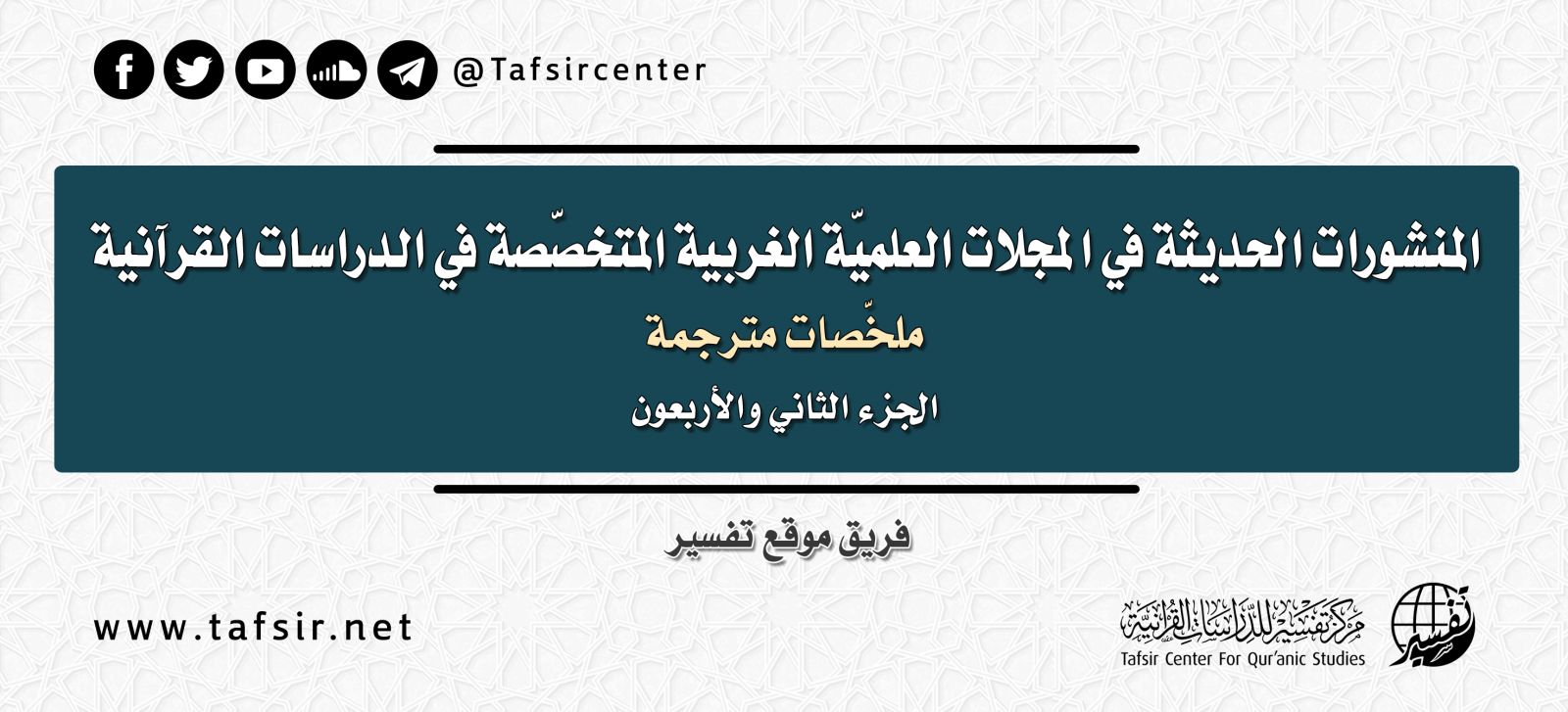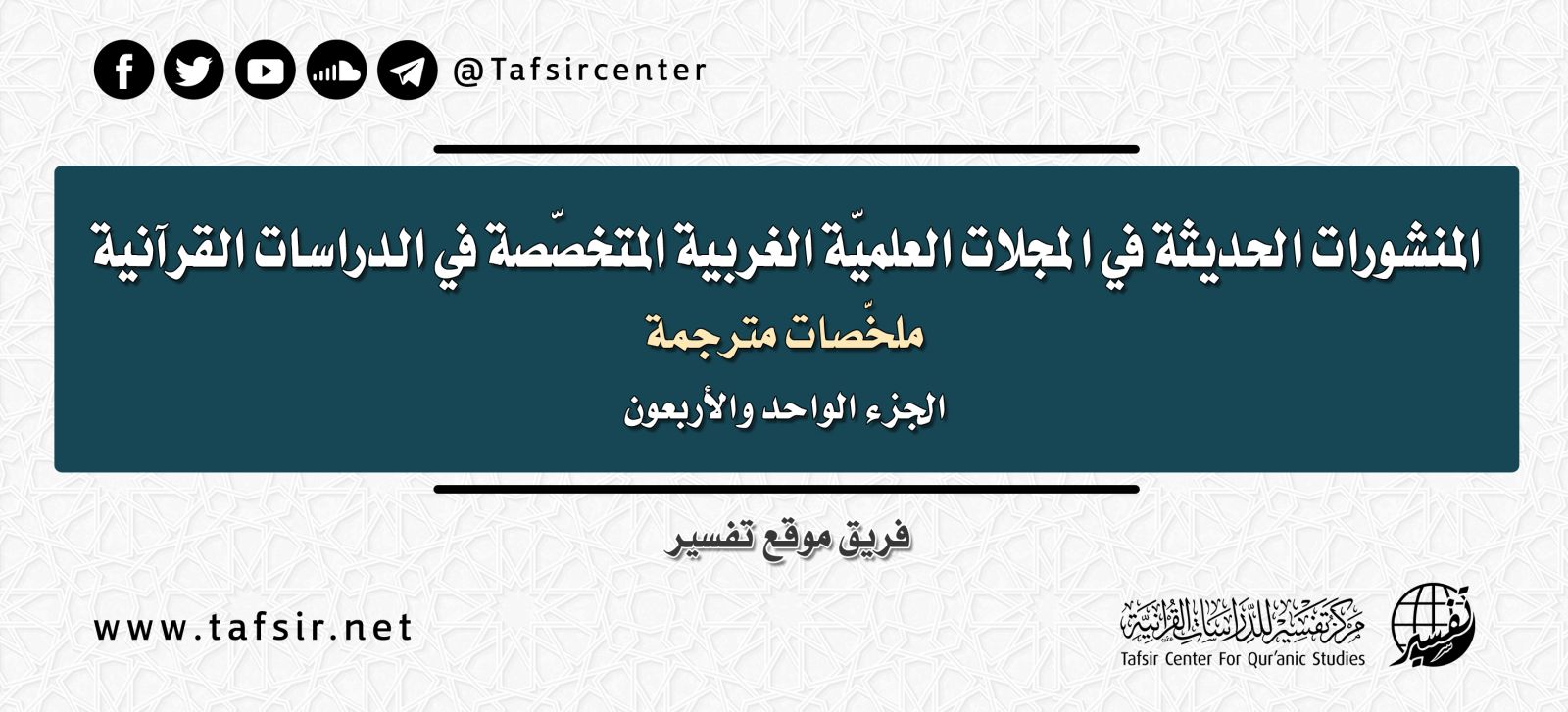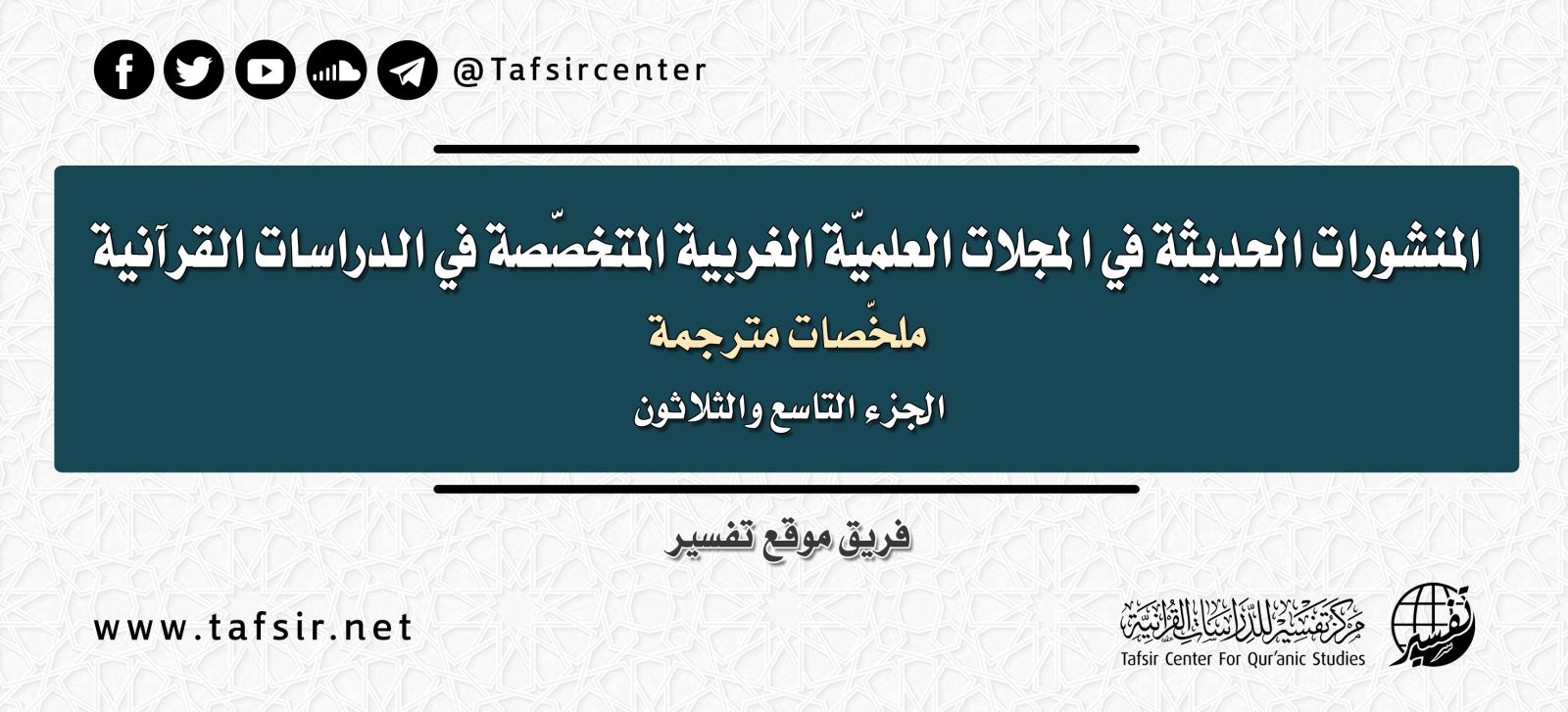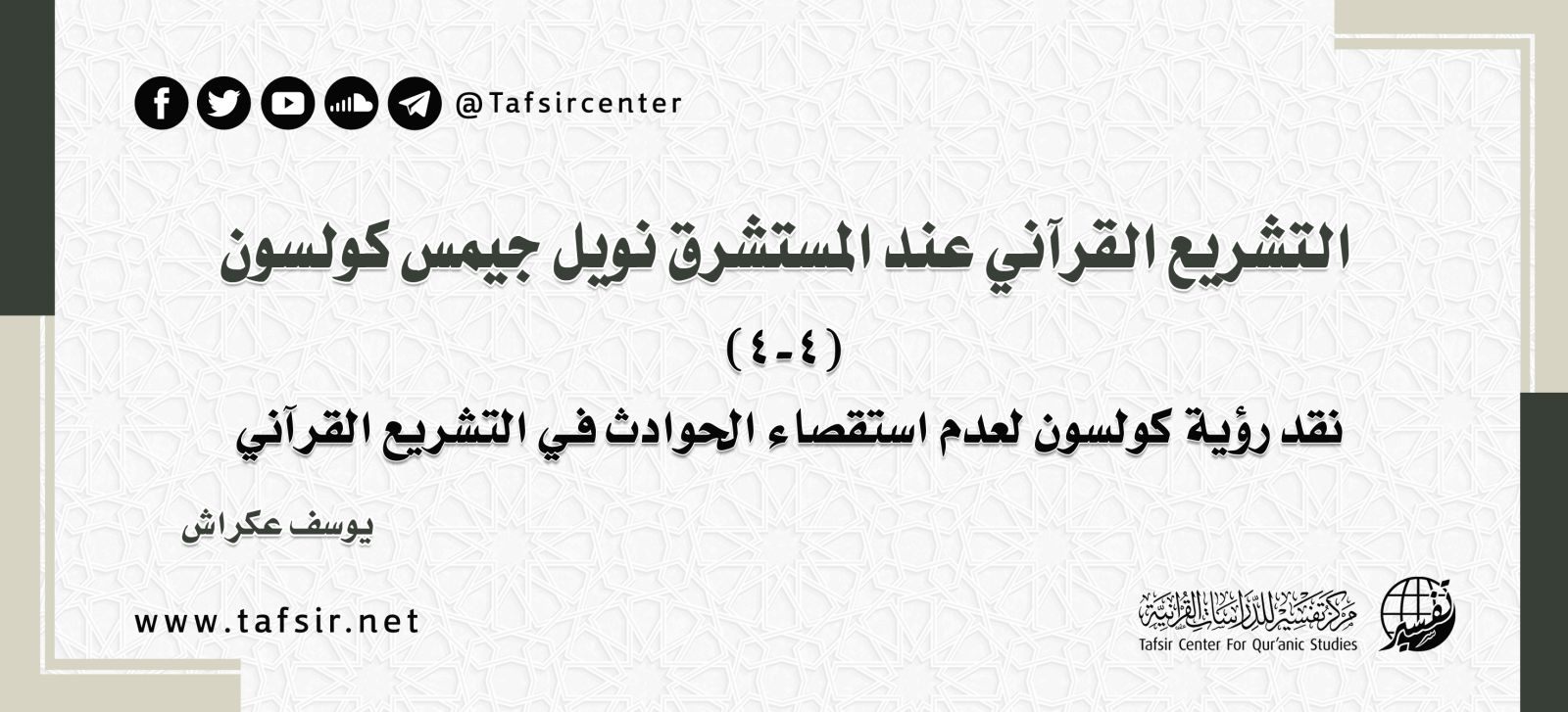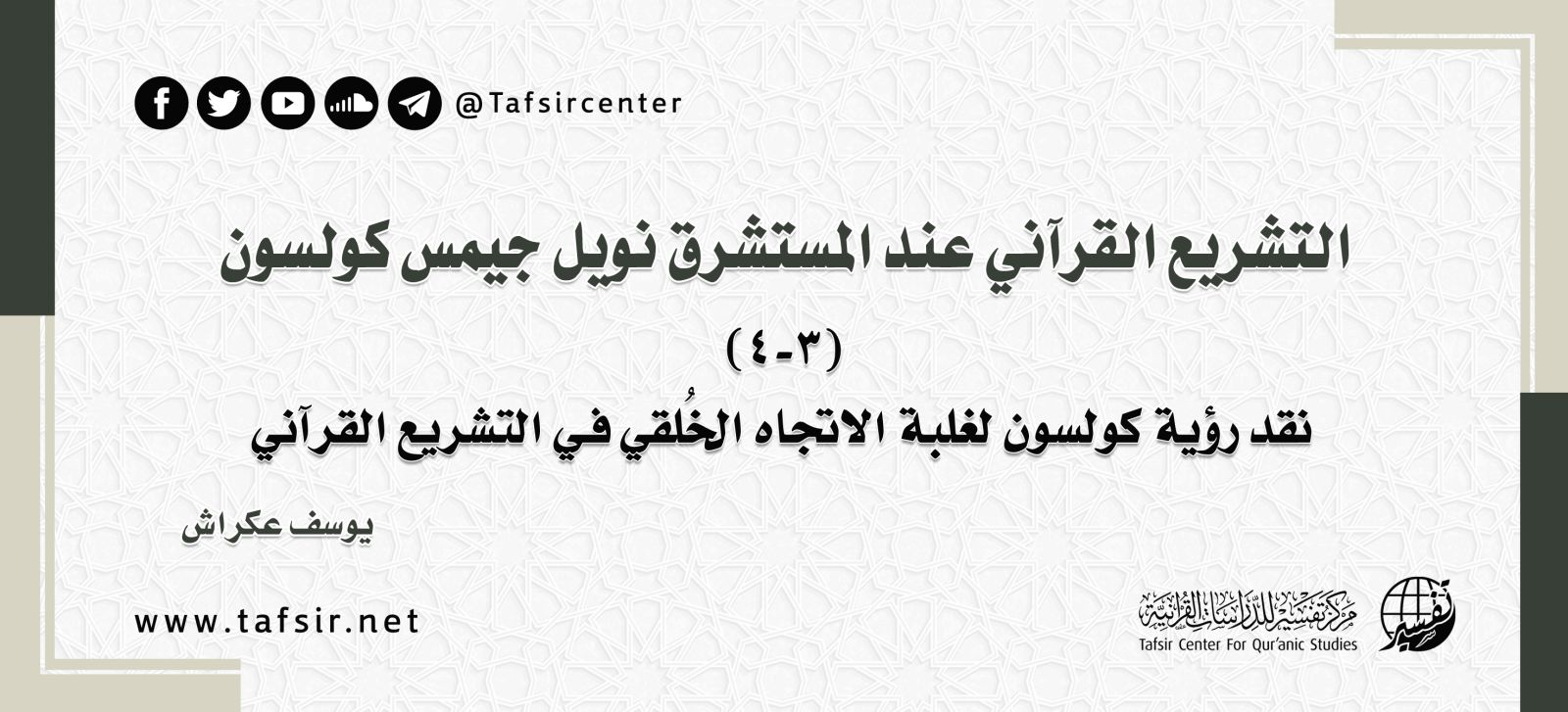كتاب: (تشكُّل التفسير الكلاسيكي؛ تفسير القرآن للثعلبي) للدكتور/ وليد صالح؛ عرض وتقويم
للدكتور/ وليد صالح
عرض وتقويم
الكاتب: خليل محمود اليماني

يعاني حقل الدراسات القرآنية الغربية من إهمالٍ بَيِّن في دراسة التفسير الإسلامي، حيث لا يبرز في كتابات هذا الحقل كبيرُ بحوثٍ تشتغل بدراسة التفسير ومصنّفاته ومناهجه... إلخ، وكذلك نلحظ أيضًا في هذا الحقل إهمالًا وضعفًا في الإفادة من التفسير الإسلامي في دراسة القرآن الكريم التي ينشط فيها الدرس الغربي نشاطًا كبيرًا[1]، وإنْ كان هذا الحال بدأ في التحسّن مؤخّرًا، وصِرْنا نلمس حضور بعض الكتابات الغربية التي تهتمّ بدراسة التفسير لا سيما تاريخ التفسير ومؤلَّفاته، وغير ذلك. ويعدُّ الدكتور/ وليد صالح من أهمّ الكُتَّاب الغربيّين المعاصرين المشتغلين بدراسة التفسير، ويُعتبر كتاب (تشكُّل التفسير الكلاسيكي؛ تفسير القرآن للثعلبي "ت: 427هـ = 1035م")[2] أحد أهم وأبرز كتاباته التفسيرية، حيث اعتنى فيه بدراسة تفسير الثعلبي من خلال جُملة من الأمور والمعاقد، وأثار عددًا من النتائج والأفكار. وفي ضوء أهمية الكتاب وأهمية التثاقف مع الكتابات الغربية ومناقشتها، فقد جاءت هذه المقالة لتشتبك مع هذا الكتاب وتعمل على تقويم طرحه، وستأتي المقالةُ على قسمين؛ أحدهما لعرض الكتاب ومحتوياته والتعريف بمؤلّفه، والآخر لنقد الكتاب وبيان مزاياه وإبداء أهمّ الملحوظات حوله.
القسم الأول: كتاب (تشكُّل التفسير الكلاسيكي)؛ مؤلِّفه ومحتوياته:
هذا الكتاب للأكاديمي الغربي/ وليد أحمد صالح، أستاذ الدراسات الإسلامية ومدير معهد الدراسات الإسلامية بجامعة تورنتو بكندا. وقد تحصّل وليد صالح على شهادة الباكالوريوس في اللغة العربية وآدابها من الجامعة الأمريكية ببيروت، ونال شهادتَي الماجيستير والدكتوراه في الدراسات الإسلامية من جامعة ييل بالولايات المتحدة الأمريكية. تتركّز اهتماماته البحثية على دراسة القرآن الكريم والتفسير الإسلامي، وبخلاف كتابه بين أيدينا (تشكّل التفسير الكلاسيكي) فله عدّة بحوث أخرى مترجَمة تتعلّق بالتفسير؛ منها: تفاسير القرآن: تاريخها، مناهجها، وظائفها، واقع دراستها في الأكاديميا الغربية[3]، ابن تيمية وصعود الهرمنيوطيقا الراديكالية: دراسة تحليلية لمقدّمة التفسير[4]، تفسير البيضاوي (أنوار التنزيل): قراءة في تاريخ هيمنته وانتشاره في العمل التفسيري[5]، مداخلات أولية حول الكتابات المؤرّخة للتفسير باللغة العربية: مقاربة مبنية على تاريخ الكتاب[6]، التأريخ الفكري من خلال الحواشي: حواشي الكشاف[7]، تفسير القرآن في العصر الوسيط: العصر الذهبي لعلم التفسير[8]، التفسير المعاصر: ظهور التكلّم القرآني[9].
وكما هو بَيِّن فللدكتور وليد صالح اهتمام بالتفاسير وتاريخ التفسير، وهذا الاهتمام بتاريخ التفسير لا يتعلّق بالناحية الإبستمولوجية والأسئلة الخاصّة بها كسؤال التصنيف وبيان وضعية العلم ضِمن أصناف العلوم الأخرى، وسؤال التحقيب والتعرّض للمراحل التي مَرّ بها العلم، وسؤال العوائق الإبستمولوجية للعلم والأزمات الخاصّة به، وغير ذلك؛ ولكنه يرتبط بالتاريخ الخارجي للتفسير، أيْ: تتبُّع مدارس التفسير ومؤسّساته عبر الزمن، وتسليط الضوء على التفاسير المحورية وأسباب هيمنة واعتماد بعضها في العمل التفسيري، وغير ذلك.
وأما كتاب (تشكُّل التفسير الكلاسيكي) فيقع في (335) صفحة شاملة الفهارس، وقد استُهِلّ بمقدّمة المترجِم ومقدّمة المؤلِّف للترجمة العربية للكتاب التي أشار فيها المؤلِّف لبداية قصته مع تفسير الثعلبي، وتوجيه الشُّكْر لبعض المؤسّسات والأشخاص، وبيان كيف أنه عمل على تفسير الثعلبي حين كان هذا التفسير لم يزل مخطوطًا، وكذلك كانت بعض التفاسير الأمهات كذلك؛ كتفسير الماتريدي، والبسيط للواحدي، وأيضًا الإشارة لسوء سُمْعة تفسير الثعلبي في العصر الحديث بسبب تبنِّي النقد الذي وجّهه له ابن تيمية وأنه اعتبره حاطب ليل، وكيف أنّ حال هذا التفسير لم يكن كذلك في التراث، وأنه كان أحد أهمّ كتب السنّة في التفسير، وغير ذلك مما ذكره المؤلِّف.
يترتّب الكتاب بالأساس في مقدّمة وسبعة فصول، أمّا المقدّمة فجاءت بعنوان: (تفسير القرآن في التاريخ والدراسات العلمية)، وهي مقدّمة طويلة جاءت في (25) ورقة، أشار فيها المؤلِّف لضخامة التَّرِكة التفسيرية وأنّ التفسير جدير بعناية مؤرِّخي الفكر الديني، لا لضخامة تصانيفه فحسب وإنما لدوره المحوري في التاريخ الديني الإسلامي؛ إذ نجد في التفسير تعبيرًا عن مشاغل كلّ جيل من العلماء، وكذلك أشار للنقص الحاصل وعدم الحضور لتاريخٍ شامل للتفسير؛ وأن هذا ليس بمفاجئ لكثرة الصعوبات التي تعترض مثل ذلك الغرض، وأشار أيضًا للتطوّرات والنشاط الحالي المتصاعد للاشتغال التفسيري في الدوائر الغربية، ثم أخذ في الحديث عن موضوع الكتاب وأنه محاولة لإلقاء الضوء على واحد من أهمّ مصادر التفسير في التاريخ، وأنّ الكتاب هو في الحقيقة بمثابة بحث في تاريخ تشكُّل التفسير الكلاسيكي، وتكلّم على أهمية تفسير الثعلبي في فهم تاريخ تشكُّل التفسير، ثم انتقل للحديث عن فصول الكتاب وما قام به في كلٍّ منها.
تكلّم المؤلِّف بعد ذلك عن بعض الاعتبارات والفروض النظرية التي يتبنّاها وينطلق منها بإزاء التفسير الكلاسيكي؛ وهي اثنتان:
الأول: أنّ تراث التفسير الكلاسيكي تراث جينالوجي (نَسَبِي)، أي أنّه توجَد «علاقة جدلية معيّنة بين كلِّ تفسير جديد، ومن ثم كلّ مفسِّر، وتراثِ التفسير السابق عليه»[10].
الثاني: أنّ التراث التفسيري يتألّف من صنفين فرعيين رئيسَيْن: التفسير الموسوعي والتفسير المدرسي، وأنه «لكلّ صنف منهما قواعده الخاصّة لكيفية القيام بالتفسير وتصنيف كتاب فيه»[11]، وفصّل المؤلِّف في هذين القسمين، وإِنْ أشار في خاتمة الكتاب لقسم ثالث هو الحواشي ما يجعل تقسيمه ثلاثيًّا وليس ثنائيًّا، ونقَدَ المؤلِّف بطبيعة الحال تقسيم التفاسير لرأي ومأثور، وكذلك تقسيمات جولدتسيهر للتفاسير إلى نحوية وعقدية ومذهبية وصوفية وحديثة.
وختم كلامه في المقدمة بعنوان: (التفسير وانتصار المذهب السنّي)، وتكلّم تحته عن توسُّع الثعلبي في المادة التفسيرية وإيراده للشِّعْر والأدب، وأنّ مردَّ ذلك هو رؤية الثعلبي للقرآن بأنّه يمثِّل التعبير الأساسي عن التجربة الإسلامية المثالية وأنّ كلَّ شيء كامنٌ فيه، وأشار لانعكاس هذا التوسّع عند الثعلبي على غيره من المفسِّرين فيما بعد كالرازي والقرطبي، وكيف أنّ تفسير الثعلبي كان ضِمن التركيبة التي أفضَتْ لذيوع المذهب السُّنّي.
جاء الفصل الأول في الكتاب بعنوان: (حياة الثعلبي)، وعرّج فيه على الأوضاع السياسية والاجتماعية في بلد الثعلبي، وبعد أن بَيَّن المصادر التي اعتمد عليها في الترجمة للثعلبي (ترجمة الواحدي "ت: 468هـ" الذي هو أبرز طلاب الثعلبي- ترجمة عبد الغافر الفارسي "ت: 529هـ") =أخذ في عقد هذه الترجمة والحديث عن الثعلبي من أكثر من جانب؛ كالثعلبي المقرئ والحافظ، والواعظ، والأديب، وموثوقية الثعلبي في الحديث، والثعلبي المفسِّر، وغير ذلك، ثم تكلّم على مشايخ الثعلبي ومذهبه، وتلامذته ومؤلَّفاته.
وأمّا الفصل الثاني: (الثعلبي والتصوّف)، فعالج فيه صِلَة الثعلبي بالتصوّف، وأشار لِما هو حاضر في الدراسات الغربية من رسوخ وصف الثعلبي بأنه كان صوفيًّا، وبعد أن عرّج على ترجمة الثعلبي في المصادر الغربية والدلائل التي اعتبرت الثعلبي من أجلها صوفيًّا، انطلق في نقاش تلكم المسألة، فبيَّن الأسباب التي يجري من خلالها نسبة الشخص للتصوّف، وقسمها لأسباب رئيسة حاصلها أن تصف الشخصَ المصادرُ بذلك، أو نجد له ترجمة في طبقات الصوفية. وأسباب ثانوية كأنْ يتلقّى الشخص الخرقة من شيخ أو يكون مارَسَ الذِّكْر أو السّماع، أو يكون هو شيخًا صوفيًّا، وبيَّن عدم انطباق كلّ هذا على الثعلبي، وقدّم تحليلًا لكتاب الثعلبي (قتلى القرآن) أشار فيه لعدم إمكان اعتبار الثعلبي صوفيًّا بسبب كتابته لهذا الكتاب كما زعم بعض الدارِسين الغربيين.
جاء الفصل الثالث بعنوان: (تفسير الثعلبي؛ المصادر والبنية)، وعالج فيه مصادر تفسير الثعلبي (الكتب والمادة الشفوية التي لم تكن مدوَّنة في شكل كتاب: الأحاديث النبوية التي أخذها الثعلبي عن شيوخه، والمادة غير النبوية كالأشعار وآراء بعض المفسِّرين الذين لم يخلفوا تفاسير كاملة)، وقدّم وصفًا إجماليًّا في ورقة واحدة لبنية هذا التفسير (وصف للمقدّمات وأقسامها والعناصر التي ينطلق منها الثعلبي في التفسير).
وبالنسبة للفصل الرابع: (المنهج الهرمنيوطيقي النظري عند الثعلبي)، فتناول فيه هرمنيوطيقا الثعلبي من خلال تحليل موسّع لِما ذكره الثعلبي في مقدّمة تفسيره، ثم تكلّم عن النظرية الهرمنيوطيقية للثعلبي وبعض الأمور الخاصّة بها؛ ككون التفسير عند الثعلبي أكثر من مجرّد شرح للآي، وأنه يشمل جميع أبواب العلوم الإسلامية، وكيف أنّ الثعلبي أسهم في إرساء تقليد جديد في التفسير هو التفسير الموسوعي، وغير ذلك.
وفيما يتعلّق بالفصل الخامس فجاء بعنوان: (من النظرية إلى التطبيق: الموضوعات والمحاور)، وفيه تناول منهج الثعلبي من خلال التطبيق العملي للثعلبي في تفسيره، وبَيَّن أنه لن يلجأ لاستعمال مصطلحات وانسبرو في وصف التفاسير وأنّ منها تفاسير هاجادية وماسورتية وهلاخية[12]، باعتباره يرى أنّ هذه المصطلحات «لم تَعُد تضيف -في سياق الدراسات القرآنية- أيّ شيء إلى فهمنا لتراث التفسير»[13]، وأنه -عوضًا عن ذلك- سيستخدم مصطلحات تطوّرت على إثر قراءته الاستنباطية لتفسير الثعلبي، وأنه بذلك يتجنّب خطر التحديد المسبق لتحليله. وأشار المؤلِّف بعد ذلك لأنه سيدرس منهج الثعلبي من خلال تفسيره للجزء الأخير من القرآن، إضافة لأمثلة مختارة بعشوائية من بقية التفسير، وبَيَّن أنّه في هذا الفصل والتالي له لن يحلّل جميع خصائص هرمنيوطيقا الثعلبي، وإنما سيركّز «على تلك التي تدلّ على التحوّل الذي حدث لفنّ التفسير»[14]، وأنه كذلك تجنَّب عمدًا «القصص القرآنية وكيفية تعامل الثعلبي معها؛ لأنّ دراسة تفسير الثعلبي للقصص القرآني تقع خارج نطاق هذا الكتاب»[15]، وجاءت رؤوس العناصر التي عالجها كالآتي: أحاديث فضائل السور، القرآن والمؤمنون: الكتاب الخلاصي، الفيلولوجيا والتفسير، الطبيعة التجميعية لتفسير الثعلبي.
وأمّا الفصل السادس: (من النظرية إلى التطبيق: التوجّهات والمسارات)، فاستكمل فيه المؤلِّف التحليل الذي قام به في الفصل السابق، ورصد التحوّلات التي جرتْ في التفسير الكلاسيكي على يد الثعلبي، فتناول كيف جعل الثعلبي التفسير علمًا تكامليًّا، يمكن تنميته وتطويره عن طريق إدماج العلوم الأخرى فيه، من أجل تحقيق أغراضه الخاصّة. وجاءت رؤوس العناصر التي عالجها كالآتي: التأويلات الصوفية وتعدّدية معاني النصّ القرآني، التأويلات السردية الخيالية (المادة التفسيرية أو التأويلات ذات الطبيعة السردية أو القصصية، والتي ليس لها أيّ أساس في الآيات محلّ التفسير)، الخطاب الوعظي والتفسير: هرمنيوطيقا وظيفية، التأويلات السياسية، التفسير والحديث النبوي، التنظيم والمدرسية في تفسير القرآن.
وأمّا الفصل السابع والأخير: (تلقِّي تفسير الثعلبي)، فتناول فيه تلقّي تفسير الثعلبي في التراث التفسيري السنّي، وبَيَّن فيه أنّ المادة التفسيرية السابقة على تفسير الطبري جُمعت مرّة على يد الطبري وأخرى على يد الثعلبي، وأكّد أنّ المفسِّرين صاروا يعتمدون على هذه التفاسير الموسوعية (الطبري والثعلبي) في الوصول لتلكم المادة، وأنّ اعتماد العلماء كان على تفسير الثعلبي في ظلِّ تراجعٍ لحضور تفسير الطبري، وأنّ ابن تيمية هو مَن سعى لإعادة ترتيب الهرمية القائمة بين التفاسير، وعمل على تصعيد تفسير الطبري وإِنْ بقي التراث التفسيري غير مبالٍ بسعيه هذا لفترة طويلة من الزمان. ورصد المؤلِّف قوّة تأثير تفسير الثعلبي على التفاسير اللاحقة عليه، وختم الفصل بالحديث عن السِّجَال السنّي- الشيعي ونشأة الهرمنيوطيقا الراديكالية.
وأنهَى المؤلِّف كتابه بخاتمة، وتذييل وملاحق وقائمة المراجع، وتكلّم في التذييل على طبعة شيعية ظهرت لتفسير الثعلبي بعدما أنهَى هو كتابه هذا عن الثعلبي، وهذه الطبعة نُشِرت في بيروت بتحقيق أحد رجال الشيعة هو عليّ عاشور، وبَيَّن المؤلِّف ضعف قيمة هذا التحقيق. وأمّا الملاحق فكانت ثلاثة؛ اختصّ أوّلها بوصف مخطوطات تفسير الثعلبي، وتناول ثانيها قائمة شيوخ الثعلبي حسب القائمة الواردة في كتاب (المنتخب)، وأمّا ثالثها فكان قائمة بالمصادر غير الموجودة المستخدمة في تفسير الثعلبي.
القسم الثاني: كتاب (تشكّل التفسير الكلاسيكي)؛ نقد وتقويم:
في هذا القسم سنحاول الإشارة لبعض الجوانب الإيجابية التي حفل بها كتاب (تشكّل التفسير الكلاسيكي)، وكذلك نُورد أهمّ ما بدَا لنا من ملحوظات ومؤاخذات عليه.
أولًا: كتاب (تشكُّل التفسير الكلاسيكي)؛ أهمّ المزايا:
-تسليط الضوء على أحد التفاسير التراثية بالغة الأهمية (تفسير الثعلبي)، في وقت كان الاهتمام فيه بهذا التفسير يُعَاني من ضعف وعدم حضور.
- اهتمام المؤلِّف بدراسة كيفيات تلقّي تفسير الثعلبي وبيان مكانة هذا التفسير في التفسير التراثي وموقعه المؤثر فيه، وغير ذلك مما يسهم في نماء الوعي بقيمة هذا التفسير وبتاريخ تشكّل التفسير التراثي، وهذا النوع من البحوث التي تركّز على فهم تشكّل التفسير يعاني ضمورًا بالغًا في واقعنا العربي رغم أهميته في حُسْن الوعي بالتراث التفسيري، وهو مجال اهتمام مركزيّ للدكتور/ وليد صالح، وقدَّم فيه عددًا من البحوث الأخرى المهمّة حول تفسير البيضاوي، وغير ذلك.
- قيام المؤلِّف بنقد التصنيفات الشائعة للتفاسير، حيث نقَدَ تقسيم التفاسير لرأي ومأثور، وكذلك نَقَدَ التصنيفات الشهيرة للتفاسير التي طرحها جولدتسيهر في كتابه الشهير (مذاهب التفسير الإسلامي)، وهذا النقد الذي قدّمه المؤلِّف مهمّ وله وجاهته في بيان إشكالات هذه التصنيفات، كما أنّ المؤلِّف حاول طرح تصنيف جديد للتفاسير، وهي محاولة مهمّة في ذاتها بغضّ النظر عن التوافق مع ما أتى به المؤلِّف فيها من عدمه، كون هذه المحاولات تسهم في إثراء البحث في تصنيف التفاسير، هذا الموضوع الذي يعاني ضمورًا في التشاغل به، رغم فرط أهميته في حُسن الوعي بالتراث التفسيري وتفهّم مسارات اشتغاله.
- ابتعاد المؤلّف وتحرّره من استعمال الاصطلاحات التي روّجتها بإزاء التفاسير دراسةُ المستشرق الأمريكي الشهير جون وانسبرو، وبيانه لعيوب هذه الاصطلاحات وأنها لا تفيد في حُسْن الوعي بالتفاسير، وهذا نقد مهمّ وله وجاهته، ويسهم في تطوير الدراسات القرآنية الغربية في مجال التفسير، وحفزها للانخراط في مسارٍ أفضل في دراسة التفاسير.
- تنبه المؤلّف لنقاط مهمة في تشكل التفسير الكلاسيكي؛ كبيانه لضعف حضور تفسير الطبري في مدوّنات التفسير الكلاسيكي، وهذا كلام صحيح، وقد رصده المؤلِّف ودلّل عليه، على أنّنا نرى أن ما يجلي هذا الضعف لحضور الطبري في مدوّنة التفسير ويجعلنا نقطع به، هو ما نلحظه من عدم عناية التفاسير بعد الطبري بهذا الجهد الهائل الذي قطعه الطبري في مناقشة الأقوال والمستندات التي أبداها في التصحيح والتضعيف للمعاني، حيث لا نظفر بتفاعل هذه التفاسير -لا سيما التفاسير المحرّرة للمعنى- مع هذا الجهد، بخلافِ الحضورِ الطاغي مثلًا لتفسير الكشاف في هذه التفاسير، وحرصِ أربابها على إيراد كلامه والتفاعل معه نقدًا أو إيجابًا. وهذه الغَيبة لتفسير الطبري تحتاج لبحث في أسبابها، وهي من الأمور السلبية، وإلا فالنقاش الذي قطعه الطبري في تَركة المعاني كان حضوره سيُسهم بقوّة -بلا شك- في ثراء النقاش حول المعاني في مدوّنة التفسير.
ثانيًا: كتاب (تشكّل التفسير الكلاسيكي)؛ أهمّ الملحوظات:
كتاب (تشكّل التفسير الكلاسيكي) فيه جهدٌ واسعٌ حول تفسير الثعلبي، وبه تحليلات ونظرات عديدة في أكثر من جانب وسياق، وفي ضوء طبيعة المقالة ومحدوديتها، فإنّنا سنهتمّ في هذه الملحوظات التي سنذكرها بإثارة بعض الإشكالات المركزية والمنهجية في الكتاب، وسنقسمها لإشكالات ترتبط بمعالجة الكتاب لتفسير الثعلبي، وإشكالات منهجية عامة، وإِنْ بقي الكتاب بحاجة لاشتغال تقويمي موسَّع.
أولًا: إشكالات تتعلّق بمعالجة الكتاب لتفسير الثعلبي:
1- التشوش في ضبط منهج الثعلبي في التفسير:
اهتمّ الدكتور صالح بتتبّع منهج الثعلبي وبيان الهرمنيوطيقا الخاصّة بالثعلبي في تفسيره، وخصّص لذلك ثلاثة فصول: (الفصل الرابع والخامس والسادس)، والناظر في محصول اشتغاله فيها يجده قدّم عناصر كثيرة في اتجاهات متعدّدة؛ فيحلّل أولًا عناصر مقدّمة تفسير الثعلبي، إِذْ يعتبرها بمثابة الفهم النظري للتأويل عند الثعلبي، ثم ينتقل للممارسة العملية للثعلبي ويتكلّم على عدد من الأمور ويحلّلها؛ كأحاديث فضائل السور التي يُوردها الثعلبي في مستهلّ تفسيره لكلّ سورة، وبيان رؤية الثعلبي للقرآن بأنّه كتاب خلاصي وأنها كانت توجّه عمله في التفسير، وموقف الثعلبي من الفيلولوجيا، والطبيعة التجميعية لتفسير الثعلبي، وبعد ذلك يتابع في بيان كيف أنّ الثعلبي جعل التفسير علمًا تكامليًّا وأنه فسّر القرآن بالعلوم التي أنتجتها الثقافة التي أوجدها القرآن، ويذكر إيراد الثعلبي للتأويلات الصوفية وأثرها في تيار التفسير عمومًا، وعناية الثعلبي بالتأويلات السردية الخيالية، والخطاب الوعظيّ في تفسير الثعلبي والتأويلات السياسية، وغير ذلك. وهكذا نجد أنفسنا أمام شتات من العناصر بلا خيط نَاظِم وبلا تراتبية تتكامل في نقطة محدّدة، فلا يبرز لنا من خلال هذا السّبح الذي قدّمه الكتاب توصيفٌ واضح للمسلك العام للاشتغال التفسيري المؤطّر لعمل الثعلبي في التفسير، ولا بيانٌ محدّد لطبيعة المنهج الذي قام عليه تفسير الثعلبي في هذا المسلك والعناصر الرئيسة لهذا المنهج وطبيعة مكوّناته ومحدداته... إلخ، والسبب في ذلك برَأْيِنَا أنّ كتاب صالح تجاوز أصلًا الزمام المؤطّر لاشتغال تفسير الثعلبي والانطلاق منه في بناء منهج الثعلبي وضبط مكوّنات هذا المنهج، فالتفاسير متنوعة في مسالك اشتغالها[16]؛ فمنها ما يهتمّ بإنتاج المعاني، ومنها ما يهتمّ بالموازنة بين المعاني، ومنها ما يهتمّ باختصار المعاني، وغير ذلك، وبناء منهج المفسِّر يكون في ضوء طبيعة مسلك عمله؛ فإِنْ كان يوازن بين المعاني صِرْنَا في بحث منهجه لتأمّل طريقته في هذه الموازنة وكيفياتها والقواعد التي ينطلق منها في إجرائها، وهكذا. وتفسير الثعلبي ليس بالذي ينتج المعاني كما نجده عند ابن عباس ومجاهد والسدّي وغيرهم، ولا هو بالذي يحرّر المعاني ويوازن بينها كما الحال عند التفاسير التي تهتمّ بهذا المشغل كتفسير الطبري وابن عطية، ولا هو بالذي يختصرها كالإيجي والجلالين، ولكنه تفسير جامع للمعني، وهذا هو أساس عمله وخطّ الاشتغال التفسيري العام الذي ينخرط فيه بالأساس كما يشير لذلك وليد صالح نفسه في بعض المواضع، وفي ضوء أنّ هذا صُلْب عمل تفسير الثعلبي كما هو ظاهر وبَيِّن جدًّا لمن ينظره ويطالعه، فكان الأحرى في بيان منهج الثعلبي أن يجري إبراز هذا الخطّ والمسار العام لاشتغال تفسيره، ثم الانطلاق في دراسة منهج الثعلبي في هذا المسار، أي بيان ما يتّصل بمسلك الثعلبي في الجمع والإشارة لمفهوم التفسير عند الثعلبي وطبيعة مفهوم المعنى الذي انطلق منه الثعلبي، وبيان طريقته في التعامل مع المصادر التي جَمَع منها وما أخذ منها وما ترك ومنهجيته في ذلك، وموقفه من تبويب المعاني وطريقة فهمها؛ دمجًا وتفريقًا، وكذلك المقارنة بينه وبين غيره من التفاسير الجامعة بعده (النكت والعيون للماوردي، وزاد المسير لابن الجوزي)، وبيان وجوه الالتقاء والافتراق بينه وبين هذه التفاسير في العمل الجَمْعي، وغير ذلك مما يرتبط بالعمل الجمعي وتفاصيله وجدليّاته في كتاب الثعلبي. إنّ بناء منهج الثعلبي في ضوء مَعقد الاشتغال التفسيري للثعلبي الخاصّ بجمع المعنى يجعلنا تلقائيًّا أمام بؤرة واضحة في النظر لاشتغال الثعلبي نبحث مسالك الثعلبي وإجراءاته في القيام بها، ومن ثم ينضبط بحث المنهج ويتراتب في خدمة هذه البؤرة ويحفظ من التشوّش وطرح نقاط مبعثرة من هناك لا يبرز من خلالها منهج محدّد للثعلبي وهو الحاصل في كتاب صالح.
إنّ تجاوز كتاب الدكتور/ صالح بناءَ منهج الثعلبي في ضوء مَعقد الجمع للمعنى الذي ينخرط فيه تفسير الثعلبي =جعل الكتاب ليس فحسب عاجزًا عن تقديم رؤية بنائية محدّدة نستطيع بها فهم عمل الثعلبي، ولكنه جعل دراسة صالح كلّها لهرمنيوطيقا الثعلبي -رغم أنها من أهم ما ينتظر من الكتاب- تبتعد عن مسّ العصب الرئيس لعمل الثعلبي ولا تشتبك معه وتحرّر معالمه وركائزه، وتنشغل ببحث أمور -بغضّ النظر عن تقييم المعالجة فيها- تظلّ بعيدة عن صُلب اشتغال الثعلبي، وبالتالي صار منهج الثعلبي بهذه الصورة غير مدروس أصلًا في هذه الدراسة، وصحيح أنّ كتاب وليد صالح قد تعرّض لبيان أمور لها تعلّق بفكرة الجمع والمعنى كبيان سعة مفهوم التفسير عند الثعلبي وإدراجه لتفسيرات الصوفية والطبيعة التجميعية لتفسير الثعلبي، لكن هذا لا يأتي بصورة مركّزة في سياق يُعنى بالتدقيق في الاشتغال الجمعي للمعنى الذي قام به الثعلبي وتفكيك هذا الجمع وتحليله بصورة منهجية محرّرة.
كما يلاحظ في دراسة صالح لمنهج الثعلبي أنه كثيرًا ما يتعامل مع الثعلبي كما لو كان الثعلبي يتعاطى تفسير القرآن بنفسه لا أنه يجمعه، ومن ثم ينزع الكتاب لذِكْر تحليلات تبرز تقصُّد الثعلبي لبيان الصوت الخلاصِي للقرآن، وبيان موقفه من الفيلولوجيا وأنه يستخدم تقنيات فيلولوجية «لإثبات صحة تأويلات قديمة غير فيلولوجية أو لطرح تأويلات جديدة من شأنها أن تلطّف من آيات محرجة من الناحية العقدية»[17]، وغير ذلك مما في كثير منه تعسّف وتحميل لتفسير الثعلبي ما لا يحتمل حال مراعاة فكرة أنّ الثعلبي جامعٌ للمعنى بالأساس، وصحيح أن طريقة عرض المعاني عند المفسِّر الجامع للمعنى وما يقدّمه وما يؤخّره وما يأتي به وما يسقطه وما يشير لرجحانه أحيانًا =قد تعبِّر أحيانًا عن نفَسٍ ورأي تفسيري خاصّ به، لكن هذا يكون بقَدَر، وهو لا يجعلنا بحالٍ أمام مفسِّر كالذي يتعاطَى التفسير بنفسه؛ ولهذا فإن انطلاق الكتاب من وجود هرمنيوطيقا للثعلبي واستخدامه لهذا الاصطلاح في بحث منهج الثعلبي فيه تجوّز كبير، إِذْ يصدّر رؤية وحمولة ليست هي الحاصلة أصلًا في كتاب الثعلبي في ضوء النظر للمسلك العام لاشتغاله القائم على الجمع، فضلًا عن أننا نرى أنّ أصحاب المنهج التأويلي من المفسِّرين هم المختصّون فحسب بالعمل الإنتاجي للتفسير، وما عداهم فمناهجهم لا ترتبط بذات التفسير وإنما بالتفسير المنتج وتترتّب في ضوء طبيعة عملهم على هذا التفسير؛ فإِنْ كان المفسِّر يوازن فيدرس منهجه في الموازنة، وإن كان يختصر فيدرس منهجيه في الاختصار، وهكذا كما بينّاه مفصّلًا في بحثنا حول المدارس التفسيرية للمفسِّرين[18].
2- تجاوز الكتاب لنقاط من المهمّ بَحْثها في سياق العمل على تفسير الثعلبي:
اكتفى صالح بعد تحليله لهرمنيوطيقا الثعلبي بالحديث عن تلقِّي تفسير الثعلبي في التراث السنّي، ولم يدرس أثر هذا التفسير بشكلٍ مستقلّ، في حين أنّ بيان هذا الأثر كان من الأمور المهمّة والمفيدة جدًّا في الوقوف على مدى مركزية هذا التفسير، وقد أشار صالح في ثنايا معالجاته لإشارات مهمّة تتعلّق به لا سيما في جانب توسعة مفهوم التفسير، لكن كان الأَوْلى أن يجعل ذلك في حديث مستقلّ يركّز فيه القول ويستجليه ويجمع أطرافه ويعمّق البحث فيه، وكان من أَوْلَى الأمور في ذلك بيانه لموضوع الممارسة التفسيرية نفسها وطبيعة قضيّتها، فمفهوم التفسير رغم أهميته لكنه تبع لتصوّر الممارسة التفسيرية نفسها وحدودها وطبيعة الموضوع الذي يجب أن تنشغل به والثمرة التي يجب أن تتولّد عنها، وهذا المسار لو انشغل به صالح لاتّجه للنظر في موضوع الممارسة التفسيرية قبل الثعلبي وكيف كان، وموضوعها عند الثعلبي وكيف أنه لم يتوقّف بها عند حدود المعنى كما كان قبله، بل جرّها لمعالجة أمور مما فوق المعنى كالأحكام وغيرها، وبيان هل ثَـمّ أثـرٌ أحدثه رواج الكتاب فيما تكرس بعدُ من انشغال العمل التفسيري بما فوق المعنى، وهو أثر حريّ بالبحث وأبعد مدى بكثير في أهميته -إن ثبت- مما رصده صالح في تلقِّي تفسير الثعلبي وبيان اهتمام المفسِّرين بعد الثعلبي بتفسير الثعلبي واعتمادهم عليه في الرجوع لتفسير السَّلَف واختصارهم له.
وكذلك فإنّ كتاب صالح لم ينشغل بتقويم تفسير الثعلبي أو بعض جوانب اشتغاله؛ كعدم اهتمام الثعلبي بتبويب المعاني وغير ذلك، رغم أهمية ذلك في سياق تكامل النظر حول تفسير الثعلبي وموقعه ضمن خارطة التفاسير الجامعة للمعنى، وأيضًا لم يهتمّ ببيان الموقف المنهجي مما رصده من توسّع الثعلبي في مفهوم التفسير وأثر ذلك على الممارسة التفسيرية بشكلٍ عامّ وهل كان في صالحها أم لا، لا سيما وأن هذا التوسّع هو صنيع مشكل أفضَى برأينا لتشوّش موضوع الممارسة التفسيرية وعدم انضباط قضيّتها، ومن ثم أفقدها أن تكون لها ثمرة موحّدة، وأن يكون هناك مفهوم محدّد لهذه الثمرة (مفهوم التفسير)، وأن يكون للقائم بها دور محدّد، وغير ذلك من الإشكالات التي طالت الممارسة التفسيرية مما بينّاه في سياق آخر وجعلها بحاجة لإعادة ضبط وتأسيس[19].
3- الانطلاق في النظر لتفسير الثعلبي من نظرة غير دقيقة للتفسير التراثي بشكلٍ عامّ:
تنطلق كثير من المقاربات الاستشراقية للتفسير من أنّ التفسير التراثي يعدّ نشاطًا ونوعًا أدبيًّا حاملًا للفكر الديني، ومن ثَـمّ يمكن من خلاله فهمُ هذا الفكر عبر التاريخ وتحليله واستجلاء معاركه وتحدياته وصراعاته... إلخ، وهذه النظرة حاضرة عند وليد صالح؛ حيث يقول مثلًا: «فنّ التفسير جدير باهتمام مؤرِّخي الفكر الديني لا لضخامة تصانيفه فحسب، وإنما للدور المحوري الذي لعبه في التاريخ الديني الإسلامي كذلك؛ فتفسير القرآن بمنزلة واسطة العقد بين ما ألّفه المسلمون في أيّ عصر من العصور. وفيه يجد المرء تعبيرًا عن مشاغل كلّ جيل من علماء المسلمين»[20]، وهو كذلك يتعامل من خلال هذه النظرة مع التفسير ودراسته له، وتظهر بشكلٍ عمليّ واضح في بعض تحليلاته في الكتاب، حيث يرى مثلًا في بيانه لموسوعية تفسير الثعلبي أنّ ذلك كان محاولة من الثعلبي «لحلّ الصراع الثقافي المحتدم داخل المجتمعات الإسلامية الرفيعة في جميع أنحاء العالم الإسلامي في العصر الوسيط، خلال الفترة ما بين القرنين الرابع والسادس للهجرة»[21]، وبحسب صالح فهذا الصراع يتمثّل في صعود عدّة أمور مثّلَت تهديدًا لمركزية القرآن في عملية التعليم، وهي الأدب ومصنّفاته الموسوعية باعتبارهما تجسيدًا لِما يجب على الفرد المتعلّم معرفته والاعتزاز به، وكذلك التصوّف «بمزاعمه عن فهمِ الوضع البشري وتقديم العلاج لعِلَلِه»[22]، وأيضًا التشيع والتقدّم الذي أحرزه مفكّروه في أنحاء العالم الإسلامي وتقويضهم في كلّ مكان للأُسس الفكرية لأهل السنّة والجماعة، وفي ضوء ذلك يرى صالح «أنّ الثعلبي هو من ينبغي أن ننسب إليه الفضل في الارتقاء إلى مستوى التحدي الذي فرضه كلّ من الأدب، والتصوف، والتشيع، بإعادة التوكيد على مركزية القرآن المفسّر سنيًّا في حياة المسلمين المتعلمين. وفي ضوء ذلك، يتعين علينا أَنْ نفهم أنَّ إدراج الثعلبي للتأويلات الصوفية والشيعية في تفسيره، وهو فعلٌ جريء كان في صميم المصالحة التي عقدها الثعلبي في تفسيره بين القرآن والأدب والتصوّف والتشيع، والتي مكّنَت المذهب السنّي من التغلُّب على خصومه»[23].
إنّ هذه النظرة التي ينطلق منها صالح في نظره للتفسير وتحليله لتشكّل مؤلّفاته هي نظرة فيها إشكال برأينا[24]، فالعمل التفسيري هو انخراط في ممارسة عِلْمية بالأساس لها إطارها وتقاليدها ومسارات للعمل بداخلها تفرضها ضرورات علمية بالأساس داخل الممارسة؛ فالممارسة التفسيرية استمرّت قرونًا طويلة وهي مشغولة بتبيين المعاني، ما أدّى بطبيعة الحال لوجود تراكم معرفي ظاهر في هذا المشغل، سواء على مستوى الإنتاج للمعاني أو جمع المعاني أو الموازنة بين هذه المعاني أو اختصارها؛ فتوليد المعاني مثّل مشغلًا ظاهرًا جدًّا خاصّة عند المفسِّرين الأوائل من السَّلَف، وأمّا الاهتمام بالموازنة بين المعاني وكذا جمع المعاني واختصارها فمثّل إطارًا لعمل المفسِّرين فيما بعد ذلك، ومِثْل هذا أمر متفهَّم جدًّا؛ فالممارسة لا تنشأ إلا بالفعل الإنتاجي أولًا، وعليه تتجه الأنظار في بداية الممارسة ومهدها لهذا الفعل وهو توليد المعاني هاهنا، ثم تأتي الجهود العلمية في الممارسة كاستجابة لضرورات يفرضها واقع التعامل مع هذه المادة؛ ففي ضوء وجود معاني منتَجة في مظانّ متعدّدة فقد اقتضى الأمر -حفاظًا على هذه الثروة العلمية- ضرورة جمع هذه المعاني في مدوّنات وتصانيف، وكذا الموازنة بين هذه المعاني لبيان صحيحها من ضعيفها كما نجده عند الطبري والماتريدي. ومع استمرار اندفاعة عملية التبيين ذاتها وولادة معاني جديدة من قِبَل بعض المفسِّرين، فكان لا بدّ من ظهور مدوّنات تهتمّ أيضًا بفعل الجمع للمعاني والموازنة كما نجده مثلًا عند الثعلبي والماوردي وابن عطية وابن الجوزي، وفي ضوء الرغبة في تقديم مادة مختصرة تصلح للاشتغال الدرسي للتفسير ظهرت المختصرات التفسيرية كالبيضاوي والإيجي والجلالين[25]، وبهذا نرى اختلاف مشاغل المفسِّرين كناتج عملي طبيعي بسبب الانخراط في ممارسةٍ علمية بالأساس.
وكذلك ما نجده من تباينات واختلافات في هذه المشاغل بين المفسِّرين في المسلك الواحد فهو أمر يرجع لأنظار علمية داخل الممارسة؛ ففي ضوء رؤية بعض المفسِّرين لعدم جواز الإحداث في التفسير وضرورة التقيّد في العمل التفسيري بالوارد على المأثور، فإننا نجد تفاسيرهم تقتصر فحسب على الوارد عن السَّلف؛ كما الحال عند الطبري الذي يوازن بين المعاني التي ذكرها السَّلَف، في حين من لا ينطلق من هذا النظر فإنّ تفاسيرهم تأتي بما ذكره السَّلَف وغيره؛ كما نجده عند الماتريدي والزمخشري وابن عطية والرازي والقرطبي وأبي حيان والآلوسي وابن عاشور، وذات الحال نجده عند المفسِّرين الجامِعين؛ فمنهم من يقتصر في مادة المعاني التي يجمعها على المأثور كتفسير الدر المنثور، ومنهم من لا يقتصر على المأثور كتفسير الثعلبي والماوردي وابن الجوزي، وأيضًا بسبب الخلاف في مفهوم المعنى الداخل في العمل التفسيري فهناك من لا يأتي بالتفسيرات الصوفية في تفسيره باعتبارها معاني وجدانية بالأساس وغير مرتبطة بالظاهر أصلًا؛ كالطبري والماوردي والزمخشري وابن عطية وابن الجوزي، وهناك من يأتي بمعاني الصوفية ويذكرها كالثعلبي والآلوسي، وأيضًا بسبب الخلاف في موضوع الممارسة التفسيرية نفسه، فهناك من يقتصر على المعنى فحسب كالطبري، وهناك من يتوسّع عن المعنى فيأتي بأمور أخرى كالأحكام وبيان وجه التناسب وذِكْر الهدايات والمواعظ... إلخ، مما يتنوّع بحسَب مقاصد المفسِّرين.
والغرض أنّ النظر البحثي المرتبط بالتفسير وتحليله وتحليل تاريخه وفهم مدوّناته يجب أن يصدر بالأساس عن أنّ التفسير ممارسة علمية، فهذا هو السبيل اللاحب الذي يمكّننا من فهمِ التفسير ومختلف تشكّلاته التطبيقية واختلافاته بصورة لها أسبابها ونواميسها العلمية الواضحة، وإلا وقع التحليل في أغلاط وإشكالات شديدة، وهو ما نلحظه في بعض التحليلات التي يذكرها صالح في كتابه جرّاء انطلاقته التي ذكرنا؛ فقد مَرّ معنا قبلُ كيف فسّر صالح موسوعية الثعلبي وكيف سوّغها برغبة الثعلبي في إعادة مركزية القرآن في سياق التعليم في ضوء صعود مهدّدات لهذه المركزية كالأدب والتشيّع والتصوّف، هذا التحليل الذي فضلًا عن أنَّ صالحًا يقدّمه بلا تأسيس علمي أصلًا، أنه يصعب جدًّا مسايرة صالح في النظر لتلكم التهديدات بهذه الصورة التي يذكرها وأنها مثّلَت تشغيبًا على مركزية القرآن في داخل مجتمعٍ مسلمٍ مرجعيته محسومة، وأنّ مجابهتها بالصورة التي يذكرها كانت همًّا لمفسّرٍ جامعٍ للمعنى كالثعلبي، فإنّ هذا التحليل فيه تكلّفات وتعسّفات لا تخفى، وتبتعد عن الواقع الحقيقي الأقرب لسياق تشكّل تفسير الثعلبي حال استحضرنا فكرة أنّ التفسير ممارسة تفرض ضرورات اشتغال؛ كجمع المعاني الذي رأى الثعلبي أهميته ومن ثَـمّ ألّف تفسيره (الكشف والبيان).
إنّ الاهتمام بالتاريخ الخارجي للتفسير يلجأ بحكم طبيعته للنظر في عوامل اجتماعية وسياسية وثقافية... إلخ حتى يتمكّن من تحقيق غاياته وفهم بيان عِلل انتشار وانحسار فهم معين لآي القرآن أو تفسير من تفاسيره، أو مدرسة من مدارسه وغير ذلك[26]، إلا أنّ الاشتغال بالتاريخ الخارجي/ البراني لأيّ ممارسة علمية أو لأحد تآليفها يجب برأينا أن يرتكز بالأصالة على استيعاب معطيات التأريخ الداخلي والإبستمولوجي لهذه الممارسة، ويؤسِّس في ضوء ملاحظته له وهضمه لطبيعة الممارسة وقضاياها وخلافاتها العلمية الخاصّة بها، وينطلق في تحليلاته وقراءاته في ضوء ذلك، فبهذا يمكن أن يقدّم لنا هذا التأريخ -من خلال طبيعة اشتغاله- تحليلات مفيدة وتوضيح أسباب وخلفيات وبواعث ما لقضايا قد لا يلتفت إليها من خلال التأريخ الداخلي للتفسير، وأمّا انفلات الاشتغال بالتاريخ الخارجي من حقيقة أننا بإزاء ممارسة علمية، والانطلاق في القيام بهذا الاشتغال من خلال نظرة أخرى مختلفة تمامًا كالتي ينطلق منها صالح، فإنّ هذا يجعل الدرس ينصرف عن الاشتباك مع الواقع العلمي القائم وتقديم عوامل جديدة شارحة له ومسهمة في تشكيله، ومن ثم يفقد الدرس جدواه بصورة كبيرة في أن يكون أداة مفيدة في تكميل إضاءة هذا الواقع بما لا يطاله التأريخ الداخلي، كما أنه يجعل الدرس يحلّق في افتراضات مشكلة تبتعد كثيرًا عن الموضوع قيد الدرس ولا تكون ذات صِلَة ظاهرة به، كما الحاصل في بعض تحليلات كتاب صالح، كالتي مرّت معنا.
إنّ تفسير الثعلبي يدور على المعنى، ولكنه تقع عنده توسّعات بالفعل؛ كأن يشير لأحكام الآية وغير ذلك مما لم يكن مألوفًا في العمل التفسيري قَبْله الذي كان يقتصر على معالجة المعنى، وقد أكّد صالح على توسّع الثعلبي في مفهوم التفسير وإيراده مثلًا لبعض المواد الأدبية والوعظية... إلخ مما ليس له صِلة مباشرة بالمعنى، وأرجع السبب في علة عدم حضور هذه التوسّعات قبل الثعلبي بأنّ «القراء المستهدفين كانوا مأسورين بما يقرؤون؛ فمَن كان يقرأ التفسير يقرأ ذلك بدافع ديني، ومن ثَـمّ لم يكن عرضة للمَلل (أو على الأقلّ لم يكن من المقبول أن يقول المرء إنه يشعر بالملَل أثناء قراءة القرآن وتفسيره). ولم يكن نهج مصنِّفي التفسير قبل الثعلبي سهلًا على القارئ قط. لكن الثعلبي... كان عازمًا على تغيير هذا الوضع»[27]. وفي تحليله لعلّة إيراد الثعلبي لهذه التوسعات يربط صالح الأمر برؤية الثعلبي للقرآن بأنّه يمثِّل التعبير الأساسي عن التجربة الإسلامية المثالية، وأنّ كلّ شيء كامن فيه، وأنّ التفسير يجب أن يؤدي وظيفة عملية وهي وعظ المؤمنين، وأنه يجب أن يظهر فيه الجانب الأخلاقي... إلخ. وهذه التحليلات التي يقدّمها صالح تظلّ قاصرة إلى حدّ كبير عن إضاءة حالة التحوّل الحاصل في الممارسة التفسيرية عند الثعلبي وفي التراث التفسيري بشكلٍ عامّ، لا سيما وتفسير الثعلبي تفسير جامع للمعنى يذكر كلّ ما قيل ولا يرجّح بين المعاني كالطبري مثلًا، والجمهور المستهدف به هو جمهورٌ علمي بالأساس مما يضعف تفسير ظاهرة التوسّع فيه من خلال اللجوء لأمور كعدم الشعور بالمَلل أثناء قراءة التفسير... إلخ، ولو أنّ كتاب صالح كان متحررًا من نظرته التي ذكرنا للتفسير، ومنطلقًا من عِلمية الممارسة التفسيرية بالأساس، وقابضًا على معطيات التأريخ الداخلي للتفسير وخلافات الممارسة التفسيرية =لَمَا وقع في هذه التحليلات المشكلة، ولركّز في بحثه على بلورة مفسّرات علمية وبواعث لها ارتباط أظهر بالعمل التفسيري في الحقبة التي تصدّى لدراستها، وتكون قادرة على الإسهام الجاد في فهم تشكّلات التفسير في تلكم الحقبة وعند أحد رجالها المبرزين وشرح حالة التوسّع الحاصلة عند الثعلبي وفي التفسير بعده.
4- القطع بتأثّر الثعلبي بتفسير كرّامي دون تقديم دلائل فاصلة:
رتَّب الثعلبي كتابه على معالجة أربعة عشر نحوًا: البسائط والمقدمات، العدد والتنزيلات- القصص والنزولات... إلخ، في سياق محاولته الكشف عن خلفيات وجِهات تأثّر الثعلبي في هذه النواحي، رجّح صالح رجوع ذلك لمصدر كرامي، اعتمادًا على مخطوطة لكتاب تفسير يعود إلى أوائل القرن الخامس الهجري، أظهرها كتاب فان إس (نصوص كرامية مهملة: مجموعة من المواد)، حيث رصد صالح أنّ هذه المخطوطة تحدّثَت عن سبعِ نواحٍ في تفسير الآية، وتأتي خمسٌ منها في شكل أزواج، ولغتها تشبه لغة الثعلبي، وأربعٌ من أزواجها تشبه ما عند الثعلبي، وكذلك اعتمد على أنّ أحد شيوخ الثعلبي وهو ابن حبيب كان كراميًّا، وأنّ الثعلبي كان مهتمًّا كالكرامية بالأمور العددية في القرآن، ومن ثَـم رأى: «أنّ الثعلبي كان يستخدم وينقّح طريقة تفسير كانت سائدة في المدرسة الكرامية في خراسان. وإذا كان الأمر كذلك، فسيكون تفسير الثعلبي أحد الأمثلة القليلة على تفسير سنّي متأثر بشكلٍ كبيرٍ بالمدرسة الكرامية»[28]، والإشكال في تحليل صالح أنه يقطع بحضور التأثر عند الثعلبي ويرجّحه في حين أنه لا يبرز دلائل تعضد ذلك؛ كإثبات مطالعة الثعلبي لهذا التفسير الكرامي واتصاله به ومعرفته به أو نقلِه عنه... إلخ، وغاية ما أورده من تشابهات وغيرها يؤسّس لاحتمالات في حضور التأثر لا أكثر؛ إِذْ يمكن للثعلبي أن لا يكون متأثرًا بهذا المصدر أصلًا، وأن تكون هذه العناصر وصياغتها من كيس الثعلبي نفسِه، كما أن هذا التأثر -لو قلنا به- فغايته أن يكون في أمر شكلي تنظيمي للمادة التفسيرية وليس في صُلْب المادة ذاتها.
ثانيًا: إشكالات منهجية عامة:
1- عنوان الكتاب غير معبِّر بصورة مباشرة عن حقيقة اشتغال الكتاب:
فالكتاب في ضوء عنوانه قد يُفهم منه بصورة أو بأخرى أنه يُناقش مسألة تشكّل التفسير الكلاسيكي من خلال تفسير الثعلبي[29]، ولكن الكتاب في حقيقته لا يفعل ذلك، فهو لا يرتّب القول وينظّمه وفق عناصر وموضوعات معيّنة ترتبط بتشكّل التفسير الكلاسيكي نفسه ويتخذ من تفسير الثعلبي أنموذجًا يعالج من خلاله هذه الموضوعات، ولكنه يعالج القول رأسًا في تفسير الثعلبي، فيتتبّع سيرته ومنهجه وتلقِّيه، ويدير فصول الكتاب على ذلك كما مَرّ قبلُ في عرضِنا لمحتويات الكتاب، ولهذا فإنّ عنوان الكتاب أوسع برأينا كثيرًا من نطاق البحث القائم في الكتاب ويَعِد بتوقّعات لا يلبّيها مضمون الكتاب. إنّ صالحًا بصورة أو بأخرى يشير في ثنايا كلامه لارتباط دراسته ببحث تشكّل التفسير الكلاسيكي، حيث يبين أنه «مع ظهور الأبعاد الكاملة لتفسير الثعلبي، أضحت الدراسة بحثًا في تاريخ تشكّل التفسير الكلاسيكي ككلّ»[30]، ولكن حاجة الباحث لفهم التفسير الكلاسيكي حتى يمكنه دراسة تفسير كلاسيكي محدّد هو متقيّد به (تفسير الثعلبي) لا تجعل دراسته أبدًا بحثًا في تشكّل التفسير الكلاسيكي نفسه وإنما تظلّ خاصّة بالتفسير الذي تدرسه، كما أنّ ما يَرِد في ثنايا المعالجة وذِكْر أثر الثعلبي في تشكيل التفسير الكلاسيكي، فهذا بصورة ثانوية تابعة، ومن ثَـمّ فكان الواجب برأينا في العنوان أن يُصاغ مباشرة عن الثعلبي وسيرته ومنهجه وتلقّيه، ليكون معبرًا عن مضمون الكتاب ولا يعد بأكثر مما يقدّمه هذا المضمون.
2- إشكال الفروض التي انطلق منها الكتاب:
فأمّا الفرض الأول الذي انطلق منه فيمكننا القول بصحّته وأنّ التفسير جينالوجي فعلًا، وهذا برأينا أمرٌ طبيعي في ضوء أن العمل التفسيري هو ممارسة علمية، وهيمَنَ عليها لقرون طويلة موضوعٌ محدَّد هو تبيين المعنى، وقد انحكمت بهذا الموضوع وحده ردحًا من الزمان ثم حدث توسّع فصار المفسِّرون يشتغلون بتبيين المعاني وغيرها، وهذا أوجدَ بطبيعة الحال نقطةً مركزية للعمل التفسيري (تبيين المعنى) من الطبيعي أن تتوارد عليها جهود المفسِّرين ويتفاعل كلّ مفسِّر مع جهود مَن سبقه، وإن كان القول بأنّ التفسير جينالوجي ليس في الحقيقة على إطلاقه، فمِن خلال تحقيبنا للممارسة التفسيرية أثبَتْنَا وجود قطيعة معرفية في مرحلتها الأخيرة المعاصرة التي تركت التشاغل بالمعنى الذي هو نقطة أساسية في تاريخ الممارسة السالف واهتمَّت بمعالجة ما فوق المعنى من مضامين[31].
وأمّا الفرض الثاني لصالح فكان انطلاقه من أنّ التفاسير تنقسم بحسب الوظيفة والشمول، لثلاثة أقسام: موسوعية، ومدرسية، وحواشٍ، وهذا الفرض يَرِد عليه أنّ صالحًا يعرض تصنيفَه للتفاسير بصورة إجمالية وموجَزة، ولا يفصّل في طبيعة المعيار الذي اعتمده في هذا التصنيف وبيان وجه كفاءته في النظر للتفاسير وقُدرته على إضاءتها وتيسير فَهْمِها، كما أنّ تصنيفه أدخل في التفاسير الحواشي التي هي شروح وتعليقات على كتب التفسير وليست تفاسير، وهذا إشكال بيِّن في التصنيف، وأيضًا فإنّ التقسيم لموسوعيّ ومدرسيّ هو تقسيم شكلي في نهاية الأمر، ولا يفيد كثيرًا في التعرّف الداخلي على التفاسير ولا فهمِ مسالك اشتغالها على التفسير ولا طبيعة هذه المسالك وتنوّعاتها... إلخ، وقد تتبّعنا هذا التصنيف لصالح وفصّلنا في نقدِه ضِمن تقرير نقدي موسَّع رصد التصنيفات الغربية للتفاسير وبَيَّن الموقف منها[32]. كما أنّ معيار الوظيفة والشمول الذي أَسس عليه صالح هو معيار شكلي جدًّا ولا يفيد كثيرًا في إضاءة النظر للتفاسير كما بينّا في التقرير المشار إليه.
3- الغلط في فهم الموقف من إشكال الفيلولوجيا في مدوّنة التفسير:
تكلّم صالح كثيرًا في مسألة الفيلولجيا والتفسير، وذكرَ أنّ الفيلولوجيا بحلول القرن الرابع الهجري تطوّرت فصارتْ علمًا مكتمل الأركان في السياق الإسلامي، وأنّ كثيرًا من التفسير المأثور هو تفسير عقدي لا أساس له من الصحة لغويًّا، وأنّ المفسِّر كان عليه إمّا أن يتخلّى عن التفسير المأثور أو يبتكر تقنيات تصالحية تكيِّف التراث التفسيري مع الفيلولوجيا، ويبين مستنكرًا أنّ الأوائل رفضوا إخضاع القرآن للفيلولوجيا، ويستدلّ لذلك بأنّ كتب معاني القرآن لم يُنظر لها ككتب تفسير، وأنها ظلّت على الهامش[33]. وهذا تحليل مشكل جدًّا، فما ذكره في شأن التفسير المأثور لا يمكن قبوله بحال، فالمعاني التي تركها السَّلَف هي الثروة التفسيرية الأبرز في كتب التفسير وما عليه المدار فيها، وقد تعاور المفسِّرون المحرّرون للمعاني كالطبري وابن عطية وغيره على نقاشها، وأدنى نظر في هذا النقاش والمستندات التي يذكرها المفسِّرون لتصحيح بعض المعاني وتضعيف بعضها =يبين بجلاء أنها معانٍ مؤسّسة علميًّا ولها دلائلها وحُججها، وليست أبدًا كما يزعم المؤلِّف، وأمّا فكرة رفض إخضاع بيان معاني القرآن للفيلولجيا فلا إشكال فيها البتة؛ فالممارسة التفسيرية ممارسة خاصّة وتحتاج لعدد من الموارد في تقرير المعنى، واللغة وإن كانت من الموارد الرئيسة والثابتة في العمل التفسيري؛ إِذْ لا يمكن للمفسِّر الفكاك منها، ولكن تَعاطِي التبيين من خلالها فحسب لا يدخل العمل التفسيري في إشكالات كثيرة، ولكنه تصور غير واقعي أصلًا؛ إذ لا يمكن عند الارتكاز على اللغة تقديم تأويلية متكاملة للقرآن، فتقديم ذلك سيحتاج حتمًا للجوء للموارد الأخرى؛ كمرويات النزول والمغازي والإسرائيليات وغيرها كما بينّاه في غير هذا الموضع[34]، وعليه فرفضُ المفسِّرين للانطلاق من اللغة وحدها في التفسير هو رفض منطقي جدًّا، وهو الصواب والمناسب لطبيعة العمل التفسيري باعتباره ممارسة خاصّة أصلًا، وإلا فلو كان المعنى التفسيري هو اللغوي لَمَا كان هناك وجهُ حاجة للعمل التفسيري بالأساس.
وعلاوة على ما ذكرنا فإنّ الكتاب به تحليلات جزئية مشكلة في بعض المناحي، فيرى صالح مثلًا أنّ ابن تيمية أسّس لصعود الهرمنيوطيقا الراديكالية، وفي بيانه لنقد ابن تيمية لتفسير الثعلبي ذكر أنّ الفيلولوجيا ليس لها «أيّ دور على الإطلاق في نظرية ابن تيمية التأويلية؛ فأحسن طرق التفسير، تفسير القرآن بالقرآن، وبالسنّة، وبأقوال الصحابة، وبأقوال التابعين[35]. يتوجّب على المعتقد -إذًا- أَنْ يلتهم الفيلولوجيا إذا أراد أن يعيش»[36].
إنّ ابن تيمية يقع ضمن الخط الرافض للإحداث في التفسير الذي يرى ضرورة التقيّد بطلب التفسير من خلال الوارد عن السَّلَف فحسب كما بينّاه في غير هذا الموضع[37]، ورجال هؤلاء التيار يمنعون الاتّكاء على اللغة أو غيرها من بقية الموارد التفسيرية في الإحداث في التفسير والإتيان بمعانٍ خارجة عن أقوال السَّلَف، ولكنهم لا يمانعون أبدًا من اللجوء للّغة في الموازنة بين المعاني الواردة عن السلف، بل هم يستعملونها كثيرًا في هذا السياق؛ لمركزيتها الشديدة في موارد التفسير بالأساس، كما نجد ذلك جليًّا في تحليلات ابن تيمية نفسه الخاصّة بالمعاني وكذلك عند الطبري في تفسيره.
خاتمة:
قمنا في هذه المقالة بتقديم عرض تقويمي لكتاب (تشكُّل التفسير الكلاسيكي؛ تفسير الثعلبي) للأكاديمي الغربي/ وليد صالح، فعرضنا لمحتويات هذا الكتاب، وكذلك بيان أهمّ مزاياه، وذكرنا بعض الملحوظات الواردة عليه، ويبقى هذا الكتاب -برغم ما ذكرنا- من الكتب المهمّة والمفيدة للمهتمِّين بالدرس التفسيري والدراسات القرآنية الغربية ومطالعة نتاجها، ويظلّ الكتاب بحاجة كذلك لكتابات تقويمية أخرى تركّز الضوء على جوانب أخرى مما لم نتناوله، كما أنّ الدكتور/ وليد صالح له إسهامات متعدّدة في تاريخ التفسير وهي إسهامات حَريّة بتسليط الضوء عليها ومناقشتها؛ نظرًا لأهميتها وأهمية الإطار الذي تنشغل بمعالجته وهو تاريخ تشكّل التفسير، حيث تعاني الكتابات العربية ضعفًا في معالجة تلكم القضايا، على أننا نؤكد هاهنا على أَنْ تقوم دراسة التاريخ الخارجي لتشكّل التفسير على استحضار أنّ التفسير ممارسة علمية، وأن تمتح من معطيات التأريخ الداخلي الإبستمولوجي للتفسير، وتكون على وعي بمسائل الخلاف المنهجي المؤثّر في تشكّل التفسير عند المفسِّرين وفهمِ خارطة الاشتغال العملي للتفاسير في التفسير، وغير ذلك مما يعدّ أرضية معرفية لازمة لهذا التاريخ تمكّنه بعد من القيام بدوره وتحقيق غاياته، والله الموفِّق.
[1] يراجع في بيان وجهة نظر غربية شارحة لعلّة عدم إفادة الدراسات القرآنية الغربية من التفسير الإسلامي في بناء معنى القرآن: التوراة المكتوبة والقرآن الشفهي في مكة الوثنية؛ تفسير الآية 91 من سورة الأنعام، محسن جودارزي، ترجمة: طارق عثمان، ترجمة منشورة على موقع تفسير للدراسات القرآنية.
[2] الكتاب من ترجمة الأستاذ: محمد إسماعيل خليل، وهو صادر عن مركز نماء للبحوث والدراسات، 2022م. وقد قدَّم المترجم ترجمة عربية رائقة وسلسة للكتاب.
[3] هذه الترجمة للأستاذ/ طارق عثمان، وهي منشورة على موقع تفسير.
[4] ضمن كتاب (ابن تيمية وعصره) لمجموعة من المؤلِّفين، تحرير يوسف روبوبورت- شهاب أحمد، ترجمة: محمد بوعبد الله، الشبكة العربية للأبحاث والنشر، ط: الأولى، 2018، ص147-187.
[5] هذه الترجمة للأستاذ/ مصطفى هندي، وهي منشورة على موقع تفسير.
[6] هذه الترجمة للأستاذ/ يوسف مدراري، ضمن مجلة "التفاهم"، عدد 69، صيف 2020 م-1441ه، ص447.
[7] هذه الترجمة للدكتور: أحمد شكري مجاهد، ضمن دورية "نماء"، المجلد الثامن، العدد الأول، مارس 2024م.
[8] ضمن: مرجع أكسفورد في الدراسات القرآنية، تحرير: محمد عبد الحليم- مصطفى شاه، ترجمة: د. حسام صبري - مصطفى الفقي، مراجعة وتقديم: د. عبد الرحمن حللي، مركز نهوض، 2024م، ص1271.
[9] ضمن: مرجع أكسفورد في الدراسات القرآنية، تحرير: محمد عبد الحليم- مصطفى شاه، ترجمة: د. حسام صبري - مصطفى الفقي، مراجعة وتقديم: د. عبد الرحمن حللي، ص1323.
[10] تشكّل التفسير الكلاسيكي، وليد صالح، ص50.
[11] تشكّل التفسير الكلاسيكي، وليد صالح، ص52.
[12] يهتم وانسبرو بالأساس بقضية نشأة النصّ القرآني وتطوّره، ويرى للمفسِّرين والنحاة دورًا في هذا التطوّر، ومِن ثم يتّجه لدراسة التفسير باعتباره عملية متعلّقة بنشأة النصّ القرآني نفسه والإسهام في بنائه وتطوّره، وفي ضوء رؤيته الخاصّة هذه قسمَ التفاسير المبكّرة إلى خمسة أنواع: هاجادية، هلاخية، ماسورية، بلاغية، مجازية. وقد شرحنا هذه المصطلحات في تقريرنا: تصنيفات التفاسير في الدراسات الغربية للتفسير؛ رصد وتقويم، تقرير منشور على مرصد تفسير، ص12-13.
[13] تشكّل التفسير الكلاسيكي، وليد صالح، ص147.
[14] تشكّل التفسير الكلاسيكي، وليد صالح، ص148.
[15] تشكّل التفسير الكلاسيكي، وليد صالح، ص148.
[16] معيار المعنى هو المعيار الناجع في ضبط تصنيف التفاسير وبيان الخرائط العامة لاشتغالها التفسيري، وقد بينّا ذلك وشرحنا كفاءة هذا المعيار في تصنيف التفاسير، وقدّمنا تصنيفًا عمليًّا في ضوئه، حيث قسمنا التفاسير لتفاسير غير مشتغلة بالمعنى وأخرى مشتغلة المعنى، والمشتغلة بالمعنى تنقسم لتفاسير منتجة للمعنى وتفاسير محرّرة للمعنى وتفاسير جامعة للمعنى وتفاسير مختصرة للمعنى. يراجع: تصنيف التفاسير تفسيريًّا؛ قراءة في التصنيفات المعاصرة، مع طرح تصنيف جديد، ضمن كتابنا: تأسيس علم التفسير؛ مقاربة تأسيسية مقترحة، مركز نماء، 2024م، ص123 وما بعدها.
[17] تشكل التفسير الكلاسيكي، وليد صالح، ص177.
[18] يراجع: مدارس التفسير عند المفسِّرين؛ تصور منهجي لبناء المدارس التفسيرية للمفسِّرين، خليل محمود اليماني، ضمن كتابنا: تأسيس علم التفسير؛ مقاربة تأسيسية مقترحة، ص206 وما بعدها.
[19] يراجع: علوم القرآن؛ نقد العلمية ومقاربة في البناء، خليل محمود اليماني، مركز نماء، 2023م، ص285 وما بعدها.
[20] تشكّل التفسير الكلاسيكي، وليد صالح، ص36.
[21] تشكّل التفسير الكلاسيكي، وليد صالح، ص55.
[22] تشكّل التفسير الكلاسيكي، وليد صالح، ص56.
[23] تشكّل التفسير الكلاسيكي، وليد صالح، ص56.
[24] قد يفيد مؤرّخ الفكر الديني في اشتغاله من النظر للتفاسير، لكن الكلام هاهنا على درس قضايا التفسير انطلاقًا من أن التفسير هو نشاط أدبي حامل للفكر الديني.
[25] في السياقات المعاصرة صار مسلك المختصرات التفسيرية يهدف لتيسير التفسير وتقريب المعنى لعموم المسلمين.
[26] يراجع مثلًا: الرِّق، والمكاتبة، والحرية: تفسير (آية المكاتَبة) في الإسلام المبكِّر، ريمون هارفي، ترجمة: مصطفى الفقي، ترجمة منشورة على موقع تفسير.
[27] تشكّل التفسير الكلاسيكي، وليد صالح، ص185.
[28] تشكل التفسير الكلاسيكي، وليد صالح، ص134.
[29] هذا العنوان الذي ظهر به الكتاب في الترجمة العربية للكتاب ليس من وضع المترجم، وإنما هو ترجمة مباشرة للعنوان الذي وضعه المؤلِّف نفسه لكتابه.
[30] تشكل التفسير الكلاسيكي، وليد صالح، ص39.
[31] يراجع: تحقيب الممارسة التفسيرية؛ قراءة في التحقيب المعاصر، وتحقيب معياري مقترح، ضمن كتابنا: تأسيس علم التفسير؛ مقاربة تأسيسية مقترحة، مركز نماء، 2024م، ص59 وما بعدها.
[32] يراجع: تصنيف التفاسير في الدراسات الغربية للتفسير؛ رصد وتقويم، خليل محمود اليماني، ص14 وما بعدها.
[33] يراجع: تشكل التفسير الكلاسيكي، وليد صالح، ص175 وما بعدها.
[34] يراجع: تأسس علم التفسير؛ مقاربة تأسيسية مقترحة، خليل محمود اليماني، ص223 وما بعدها.
[35] كلام ابن تيمية عن أحسن طرق التفسير لا يعبّر عن نظريته بالأساس في التفسير، حيث ينطلق ابن تيمية من وجود تفسير نبوي لكامل القرآن نقَلَهُ السلف؛ ولذا يرى ضرورة التقيّد في التفسير بالوارد عن السلف، ما يجعل كلامه في أحسن طرق التفسير مشوشًا لنظريته ومعارضًا لها، فضلًا عن ما يحمله هذا الكلام ذاته من إشكالاته. وقد فصّلنا ذلك في كتابنا: حجية تفسير السلف عند ابن تيمية؛ دراسة تحليلية نقدية، مركز تفسير للدراسات القرآنية، 1442هـ= 2021م، ص85 وما بعدها، وهناك نشرة صدرت مؤخرًا لمقدّمة ابن تيمية -بتحقيق: سامي بن محمد بن جاد الله- شكّكَت في القطع بنسبة آخر فصلَين في المقدّمة لابن تيمية -وفيهما يقع كلام ابن تيمية على أحسن طرق التفسير- وأنهما يحتمل أن يكونَا لابن كثير.
[36] تشكّل التفسير الكلاسيكي، وليد صالح، ص269- 270.
[37] يراجع: حجية تفسير السلف عند ابن تيمية؛ دراسة تحليلية نقدية، خليل محمود اليماني، مركز تفسير للدراسات القرآنية.
الكاتب:

خليل محمود اليماني
باحث في الدراسات القرآنية، عضو هيئة تدريس بجامعة الأزهر، له عدد من الكتابات والبحوث المنشورة.
مواضيع ذات صلة
((المعلومات والآراء المقدَّمة هي للكتّاب، ولا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع أو أسرة مركز تفسير))