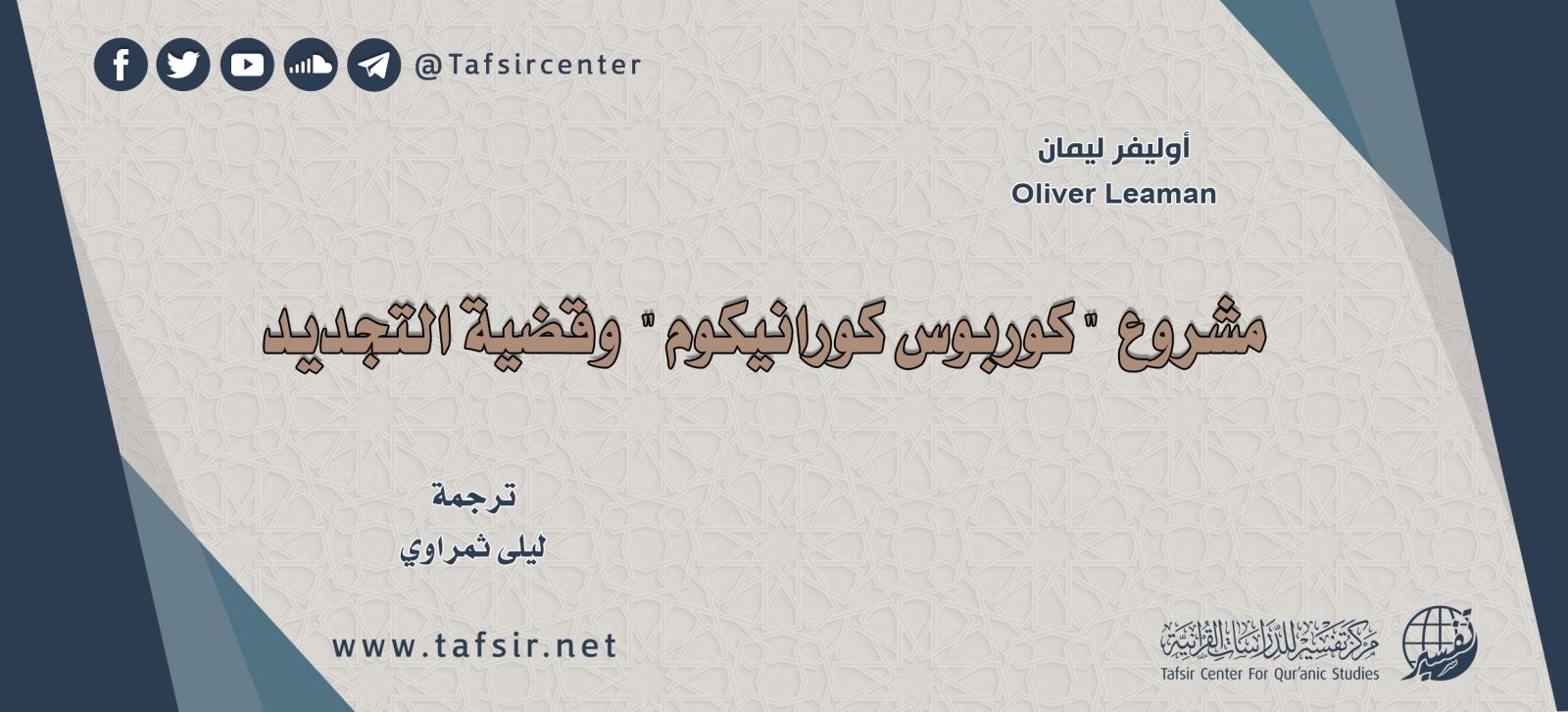
مشروع الموسوعة القرآنية (Corpus Coranicum)
وقضية التجديد[1][2][3]
تميل المناهج العِلْمية في دراسة الدِّين إلى الانقسام إلى اتجاهَيْن واسعَيْن. فالدِّين نفسه غالبًا ما يضع طرقًا خاصّة به لتحديد كيفية الوصول إلى فهمٍ دقيق للنصّ والسياق الأصلي له، كما أنّ الأديان أيضًا تميل إلى استخدام طرقها الخاصّة لتحديد النُّسخة الموثوقة لكتبها المقدَّسة. بالإضافة إلى ذلك، ظهرت العديد من المناهج التي تتعامل بشكلٍ تشكيكي مع التقاليد المتجسّدة في الدِّين، والتي تشير إلى تلك النصوص. تظهر مثل هذه المناهج المختلفة بوضوح في الدراسات الإسلامية والقرآنية، حيث يميل الباحثون من خلفيات مختلفة إلى اتّباع إستراتيجيات متباينة تمامًا لفهم القرآن وتحديد الصورة النهائية التي تشكَّل عليها. انطلق أحدث مشروع بحثي مثير للإعجاب حول القرآن في أوروبا، مشروع الموسوعة القرآنية (Corpus Coranicum) في ألمانيا[4]، تحت إشراف أنجيليكا نويفرت (Angelika Neuwirth)، الذي تم تقديمه في كتابها الصادر مؤخرًا (القرآن كنصّ من أواخر العصور المتأخّرة: مقاربة أوروبية). يهدف هذا المشروع إلى إنتاج طبعات نهائية للمواد القرآنية الأساسية، كما يشرح كيفية ارتباط القرآن بفترة العصور القديمة المتأخِّرة وأوروبا. من بين الادّعاءات الرئيسة التي يطرحها المشروعُ أنه يقوم بشيء جديد ومختلف. لكن النتيجة في الواقع هي إنتاج منهج علمي لفهم القرآن، مشابه للمنهج التأويلي (الهيرمينوطيقي) الذي تم اتّباعه في الدراسات التي سبقته، ولا يقدِّم شيئًا جديدًا. وهذا لا يعني أنّ هناك شيئًا خاطئًا في المشروع، لكنه يثير تساؤلات حول صحة ما يدّعيه من محاولته لتقديم شيء مختلف. وبما أنّ المشروع من المحتمل أن يكون المصدر الرئيس للنصوص القرآنية الأكاديمية لفترة من الزّمن، فإنه من المهم توضيح السياق الفكري الذي يتمّ فيه.
إنّ الهدف الرئيس من المشروع هو توثيق جميع النماذج التي يمكن العثور عليها من القرآن الكريم كوثيقة مكتوبة. ويتضمّن جانبًا جديدًا ومهمًّا في هذا المشروع وهو استخدام صور فوتوغرافية لمخطوطات قديمة التقطها الباحثان برجستراسر (Bergstrasser) وبريتزل (Pretzl) قبل الحرب العالمية الثانية. واللّافتْ للنظر في هذا الشأن أنه كان يُعتقد أنّ هذه المخطوطات دُمِّرت خلال القصف زمن الحرب، بينما تمّ إخفاؤها، وتمّ إظهارها مجددًا لدراستها وتحليلها. يؤكّد منظمو المشروع على أنّ القرآن لم يظهر من فراغ، وهذا يعني ضرورة مراعاة السياق الذي نشأ فيه. ستقوم الموسوعة القرآنية بربط المخطوطات بالنصوص المنقولة شفويًّا. كما ستعمد إلى ربط القرآن بعدد من النصوص الأخرى، سواء تلك التي سبقته أو التي كانت معاصرة له. وأخيرًا، من أبرز أهداف المشروع إعداد تفسير مفصّل للغاية، أشبه بتعليق موسّع، يتناول وجهات نظر متنوعة حول معاني النصّ القرآني. ولن يقتصر هذا التعليق على التفسيرات التقليدية وطرق فهمها للقرآن، بل سيشملها ضمن مقاربة تفسيرية أوسع، ليقدِّم بذلك فهمًا شاملًا للقرآن الكريم.
أصبح مشروع الموسوعة القرآنية حدثًا إعلاميًّا بارزًا في ألمانيا، حيث غالبًا ما يتمّ عَرْضه كما لو أنه يقدِّم أفكارًا جذرية جديدة حول القرآن، مما قد يؤدِّي إلى نفور المزيد من المسلمين الألمان، ومع ذلك، فإن هذه المناقشة تهدف إلى توضيح أنّ المشروع ككلّ ليس فيه شيء جديد أو ثوري، بل يقوم على أُسس منهجية أكاديمية مألوفة في التحليل التاريخي والسياقي.
تُعتبر تأويلات النصوص الدينية (الهيرمينوطيقا) في الغالب موضوعًا مثيرًا للجدل، والممارسون لدينٍ معيَّن عادةً ما يرفضون تدخُّل الغرباء أو حتى المقرّبين منهم في تحديد كيفية فهم تلك النصوص، خاصّة إذا كانت هذه الشروحات تتعارض مع الفهم التقليدي الذي تطوّر مع الزمن. لكن هل هناك طريقة للتعامل مع النصوص الدينية بشكلٍ علمي وموضوعي، بالرغم من التحديات المتعلّقة بفهم هذه المصطلحات، دون أن يُظهِر هذا التعامل نقدًا للطرق التفسيرية الداخلية التقليدية لفهم تلك النصوص؟ غالبًا ما ينتقل النقاش من نقد الطرق التقليدية لفهم الدِّين إلى نقد ما يتعامل معه التقليد نفسه، الدِّين نفسه. فبالرغم من الطابع النظري للنقاشات الأكاديمية، لم تغبْ أبدًا شكوك المجتمعات المسلمة حول الدوافع المشبوهة للمشروع، مما دفع القائمين عليه إلى تكثيف جهود الإقناع.
قد يبدو أن هذه قضية عامة تؤثِّر على جميع الأديان، على الأقلّ الأديان التي تستند إلى حدّ ما على وقائع تاريخية. تم اعتماد إستراتيجية عامة لنزع الطابع الأسطوري في تحليل الدِّين في الدراسات المعاصرة، وسيكون من المثير للاهتمام التنبؤ بما إذا كانت هناك أسباب معيَّنة تجعل هذا المنهج أكثر أو أقلّ فعالية عند التعامل مع الإسلام مقارنة بالأديان الأخرى. يروّج مشروع الموسوعة القرآنية بشكلٍ أساسي لفكرة إنشاء (علم للإسلام) (Wissenschaft des Islams) متماشٍ مع المحاولات السابقة لبعض اللاهوتيين للتمييز بوضوح بين الادّعاءات التي تقدِّمها الأديان عن نفسها وما يحقّ لها بالفعل قوله. وفي الوقت ذاته، يقترح المشروع أنّنا لسنا مضطرّين لقبول فكرة هذا الانقسام بين التوافق مع التقليد واتّباع المنهج العلمي.
من المهم الإشارة هنا إلى أنّ هذا التحليل موجَّه لوصف المشروع لنفسه، وليس للمشروع ذاته، ويجب أن تكون هذه التفرقة واضحة. فمشروع الموسوعة القرآنية نفسه يحمل كلّ الدلائل على كونه إسهامًا مثمرًا وذا أهمية كبيرة في الفهم التاريخي للقرآن، قد تكون الأبرز حتى الآن. لكن المسألة المطروحة هي ما إذا كان المشروع يحقّق بالفعل شيئًا جديدًا بشكلٍ ملحوظ، حيث هذا ما يدّعيه المشروع بالفعل. على العكس من ذلك، سيتمّ الدفاع هنا عن أن المشروع يتبع بدقّةٍ ما أصبح يُعرف بالمنهج العلمي، وهو سِمة مألوفة في الدراسات الغربية -وخاصّة الدراسات الألمانية- عند دراسة النصوص.
يَعتبر هذا المنهج أنّ السؤال الأول الذي يجب حَسمه هو تحديد (ما هو النصّ تحديدًا)، وبعد ذلك يمكننا المضيّ قدمًا لمناقشة (ما الذي يعنيه)؛ لكن بالنسبة للعديد من المؤمنين بالمصدر الإلهي للنصّ القرآني، فقد تمّت بالفعل الإجابة على هذا السؤال الأول، ويعدّ مجرّد طرحه بحدّ ذاته إشارة إلى موقف خاطئ ومُعادٍ تجاه الدِّين. وقد بذل منظّمو مشروع الموسوعة القرآنية -بطريقة خاصّة- جهودًا كبيرة لتهدئة الشّكوك لدى المجتمع الإسلامي من خلال التصريح بأنّ المشروع يقوم بشيء جديد. ولكن، هل هو فعلًا كذلك؟
العلم والإيمان في تحليل الدِّين:
هل يمكننا اتّباع منهجٍ علميّ في التعامل مع النصّ مع احترام الطريقة التي يرى بها النصّ نفسه؟ يقدّم القرآن سردًا عن نفسه يعكس مزاعمه كنوع محدّد من النصوص (بأنه النصّ الذي هو عليه)؛ فهو يعرض رواية عن جَمْع الوحي الذي تلقّاه النبي على مدى فترة طويلة من الزمن. ويُعتقد على نطاق واسع أنّ هناك مصحفًا أو مجموعة من هذه المصاحف كانت موجودة في عهد عثمان بن عفان، الخليفة الثالث للنبي (وفقًا لغالبية المسلمين)، بوصفه قائدًا للجماعة الإسلامية، وهذا هو النصّ الذي وصلنا اليوم. هذه الرواية تختلف تمامًا عن تلك التي تقدّمها المناهج العلمية لدراسة القرآن، والتي تشير غالبًا إلى أنّ محتويات النصّ قد تعود لفترة زمنية أخرى أو ربما لمكان مختلف، وأن تنظيمها كان موضع جدل لفترة من الزمن، ومن الواضح أنّ هذا الجدل له تأثيرات على فهم النصّ ككلّ وعلى فهم آياته الفردية أيضًا. نحن نميل إلى الاعتقاد بأنه لا يمكن فهم النصّ حقًّا إلا عندما نضعه في سياقه، ومن الواضح أنّ السياق هنا أمر جوهري. فإذا كان السياق هو سلسلة الوحي المقدّمة للنبي عن طريق جبريل في مكة والمدينة، فسيكون لدينا نصّ مختلف تمامًا عمّا لو اعتبرناه مجموعة غير متجانسة من الآيات المتفرّقة التي جُمِعَتْ من مصادر متنوّعة. من الصعب، إن لم يكن مستحيلًا، أن نقوم بتجميع لوحة بدون صورة واضحة عن المنتج النهائي. إنَّ فهمنا لنوع النصّ يحدّد ماهيته، ورغم أنّنا قد نغيّر رأينا أثناء دراسته، فإنّ هذا الفهم يوفر نموذجًا لكيفية التعامل مع النصّ وما يمكننا استنباطه منه.
تتم المقارنة بين الدراسات القرآنية والكتابية غالبًا بطريقة تميل إلى التقليل من الأُولى. فمنذ فترة طويلة، تضافرتْ جهود جادّة لفهم الكتاب المقدّس العِبري أو المسيحي، باستخدام مجموعة واسعة من الضوابط التأويلية، بغية فهم مسألة السياق. أمّا بالنسبة للأناجيل، تم تحديد مؤلِّفِين مختلفِين بناء على تخمينات. وقد نشأت مكتبة ضخمة تفسّر الأجزاء المختلفة من الكتاب المقدّس، وغالبًا ما تكون هذه التفاسير تحديًا كبيرًا للطريقة التي يرى بها اليهود والمسيحيون نصوصهم.لقد دعت كلّ من (فيسنشافت ديس يودنتومز) (Wissenschaft des Judentums) (علم اليهودية) و(النقد التاريخي) إلى فهم جديد للنصوص اليهودية والمسيحية الأساسية. وأمّا القرآن فيهدف مشروع الموسوعة القرآنية إلى تجنّب اتخاذ ذاك النوع من المنهج تجاهه، بينما يسعى في الوقت نفسه إلى تحرير القرآن من التفسير التقليدي في الإسلام. كما يحاول المشروع إقامة رابط مع أوروبا بالقول أنّ القضايا التي كانت تُثَار في شبه الجزيرة العربية خلال القرن الأول/ السابع الميلادي كانت مماثلة لتلك التي جرتْ في منطقة البحر الأبيض المتوسط، وبالتالي ستربط القضايا الإسلامية بالأوروبية في نهاية المطاف. إنها حُجة غريبة تنتهي بالقول -بشكلٍ صحيح- أنّ القرآن مرتبط بالعصور القديمة المتأخّرة، ويستخدم هذا لادّعاء أنه جزء من الإسهام الذي قدّمته هذه العصور لأوروبا.
قبل أن يُنظر إلى القرآن على أنه النصّ النهائي للإسلام، وفقًا لنويفرت، بدأ كصدى لنقاش داخل مجتمع يستجيب لقضايا أُثيرت في العصور القديمة المتأخّرة. وتقول إنه لا ينبغي النظر إلى الكتاب كعمل لمؤلِّف واحد يسعى إلى تعريف المجتمع الإسلامي بشكلٍ نهائي، بل هو نتيجة جهد تعاوني تُسْمَع فيه مجموعة متنوّعة من الأصوات. من الواضح أنها تتبّعت عن كثب منهج نولدكه (Noldeke)، الذي أسّس تقليدًا قويًّا في تحليل القرآن من حيث أسلوبه، والجمهور الذي يستهدفه، وكيف سعى إلى تعزيز المجتمع وتشكيله، وأخيرًا محاولته وضع بعض القواعد الدينية. ترى نويفرت أن التفسير التقليدي الإسلامي للقرآن غير مناسب؛ لأنه لا يقدِّم -في نظرها- تفسيرًا مقبولًا لسياق النصّ. وهكذا لدينا هنا ادّعاءان كبيران؛ الأول: هو أنّ القرآن مصنَّف جُمِع على مدى زمن طويل، ولم يؤلَّف مِن قِبَلِ مؤلِّف واحد، والثاني: أنّ فئة كبيرة من مفسّري الإسلام التقليدي بعيدة كلّ البُعد عن فهم الكتاب كما ينبغي. هذه الادّعاءات ليست جديدة؛ فهي شائعة في المناهج الأوروبية -وخاصّة الألمانية- لدراسة القرآن، ويعتقد الكثيرون أنها معقولة ومنتجة للغاية في البحث حول النصّ. قد تكون هذه الادّعاءات صحيحة، لكنها بالتأكيد ليست جديدة.
مسألة السياق:
لا تتمّ النقاشات حول النصوص الدينية في فراغ، وقد أوضحتْ نويفرت أنها والمشروع الذي تعمل عليه لديهما أجندة سياسية تهدف إلى تقريب المسلمين وغير المسلمين في أوروبا بعضهم من بعض. فهي تسعى لإظهار أنّ القرآن نصّ مهمّ لكلتا المجموعتَيْن، وبهذه الطريقة سيكون لهما ارتباط لا مفرّ منه. وتوضح أنّ القرآن لم يكن بطبيعته نصًّا خاصًّا بالمسلمين فقط؛ لأنه قبل وجوده لم يكن هناك مسلمون بمعناهم الحالي، بل جمهور يمكن وصفهم بأنهم من المثقّفين في العصور القديمة المتأخّرة. يناقش القرآنُ القضايا اللاهوتية والميتافيزيقية الرائدة في تلك الفترة، مثله مثل الديانتَيْن التوحيديتَيْن الأُخريين في البحر الأبيض المتوسط في ذلك الوقت، اليهودية والمسيحية، ويأتي بعد العهد الجديد الذي يُعَدّ استمرارًا للعهد العِبْري. والمقترح هنا هو أنّ القرآن، شأنه شأن تلك النصوص، له أهمية تتعلّق بطبيعة أوروبا، ومع ذلك، ليس من الصحيح القول إنه لم يكن هناك مسلمون قبل القرآن؛ إِذْ يذكر القرآن وجود مسلمين كُثُر قبل النبي محمد بوصفهم موحِّدين، حيث إنّ الإسلام دين الفطرة. وعلى أيّ حال، فإنّ ارتباط القرآن بأوروبا يبدو غامضًا؛ لأنّ الروابط بينهما كانت قليلة حتى ما يُعرف في أوروبا بالفترة الوسطى، باستثناء بعض الغزوات التي كان أساسها غالبًا معلومات مضلّلة وعدائية، وبالتالي لا يمكن الاعتماد عليها بشكلٍ كبيرٍ.
وتصف نويفرت بدقّة الفرق بين المنهج التقليدي الإسلامي للقرآن والمناهج العلمانية التي أصبحت شائعة فيما يُعرف بـ(الغرب). يبدو أنَّ علمنة القرآن أمرٌ لا مفرّ منه إذا تم التعامل معه تاريخيًّا بطريقة معيّنة، حيث يُصور غالبًا كإعادة تنظيم (مربكة إلى حدّ ما) لمواد كتابية أصلية. يتمّ فحص أسلوب القرآن وبنيته ومقارنته بالنصوص الدينية الأقدم التي يُشار إليها في الكتاب، ويتمّ تأطيره ضمن سياق ديني تاريخي بدلًا من كونه مرتبطًا بأيّ بُعدٍ متعالٍ. في المقابل، يميل المسلمون غالبًا إلى اختيار سياق حياة النبي لتفسير الوحي. تجادل نويفرت بأنّ هذين المنهجَيْن المختلفَيْن على ما يبدو يمكن الجمع بينهما ويمكن اعتبارهما مكمّلين، وتعلّق مرارًا بأن هناك في القرن الحادي والعشرين سياسة إيجابية متزايدة في أوروبا تهدف إلى دمج المجتمعات المسلمة الأوروبية مع المجتمع الأوسع ومؤسّساته الأكاديمية، بحيث يكون هناك فهم حقيقي لطبيعة الأديان المختلفة التي تزدهر الآن في القارة. ومن ثم، في ألمانيا نفسها، سيتمّ إضافة أقسام اللاهوت الإسلامي إلى أقسام اللاهوت الكاثوليكي والبروتستانتي في الجامعات، حيث يعمل الأكاديميون باللغة الألمانية ويسهمون في النقاش من خلال منظور علمي حقيقي.
قد يستغرق تعداد ما يمتاز به عمل نويفرت بعض الوقت، ولكنه يستحقّ ذلك؛ فقد أثرى إنتاجها العلمي بأكمله هذا المجال بشكلٍ كبيرٍ، والكتاب الذي يصف انطلاق مشروع الموسوعة القرآنية يُعَدّ رائعًا من حيث نطاقه وخاصّة من حيث النقاش التفصيلي لآيات القرآن الفردية. وكلمة (ضخم) غالبًا ما تُستخدم بشكلٍ خاطئ، لكنها مناسبة هنا، وحقيقة أن المشروع مموَّل حتى عام 2025 دليل على الدعم الجادّ من الدولة الألمانية. إن الرغبة في تقريب المسلمين وغير المسلمين بعضهم من بعض جديرة بالثناء، ومن المحتمل أن تؤدِّي إلى نتائج مفيدة تمامًا.
لا يسعنا إلّا أن نشيد بالمشروع والطريقة التي يتمّ تنفيذه بها. ولكن، أنا متأكد أن القارئ قد توقّع أن هناك تحفّظًا قادمًا، فإنّ الأساس الفكري للمشروع ربما ليس جديدًا بقدر ما يَعتبر نفسه. إنّ المشكلة الرئيسة ليست في ما تحاول نويفرت تحقيقه؛ إِذْ يتماشى ذلك مع ما حاول العلماء الأوروبيون تحقيقه في الماضي، ولا في كيفية محاولتها تحقيقه؛ إِذْ يقع ذلك أيضًا ضمن التقاليد العامة لفهم الدِّين. تكمن المشكلة في كيفية تقديم المشروع وتوصيفه، مما يجعله مضلّلًا بشكلٍ أساسي. من المقلق أن يتمّ تقديم مشروع على أنه يقدِّم شيئًا جديدًا في حين أنه في الواقع لا يفعل ذلك. لا بدّ أن خيبة الأمل ستأتي لاحقًا.
جمهور القرآن:
يتحدّث المشروع عن نفسه وكأنه يختلف كثيرًا عن المشاريع السابقة، فيُقدَّم على أنه شيء جديد ومثير في الدراسات القرآنية، لكن الواقع بعيد عن ذلك. فالمشروع يتماشى بشكلٍ كبيرٍ مع ما يمكن وصفه بـ(المنهج التقليدي غير التقليدي) في دراسة القرآن. يمكن اختصار الجدلية المطروحة بشأن القرآن منذ فترة طويلة، وهي أنَّ فهم النصّ يعني فهم سياقه وتحديده، وهذا السياق يتمثّل في سكان شبه الجزيرة العربية وخلفيتهم الثقافية. لذا، يُفترض أنّ المصدر الجيّد لفهم القرآن ليس في كتب المفسِّرين واللاهوتيين التقليديين الذين أتوا لاحقًا ولم يفهموا السياق التاريخي المناسب، بل يجب النظر إلى جمهور القرآن كالسكّان المحليين بما فيهم (أهل الكتاب)، مما يعني ضرورة الرجوع إلى الكتاب المقدّس لليهود والمسيحيين، وأيّ معلومات متوفّرة عن الاتجاهات الثقافية السائدة في ذلك الزمان والمكان عند دراسة القرآن.
غير أن المشكلة الكُبرى تكمن في أنّ الخلفية التوراتية والمحلية واسعة جدًّا ومتنوعة، بحيث يمكن العثور بسهولة على ما يتصل بآية من القرآن، وغالبًا ما تكون هناك أكثر من مرجعية واحدة متوافقة معها. يمكن للمرء أن يلجأ لأيّ آية قرآنية ويجد في الأدبيات التوراتية العامة ما يتوافق معها، لكن هذا لا يعني بالضرورة وجود صِلَة بينها. ربما تكون هناك صِلَة، ولكن مجرّد وجود هذا النوع من التشابه لا يُثْبِت الكثير. النقطة المهمّة هنا هي أن ذلك لا يحدّد السياق بالفعل. تُقدِّم نويفرت حُجّتين، إحداهما أقلّ طموحًا من الأخرى. الأُولى، وهي الأضعف، تفترض إمكانية إثبات وجود أساس في الثقافة المحلية لمجموعة من القضايا التي تظهر في القرآن والتي صُمّمت لجذب السكان المحليين، وأعتقد أن هذا صحيح؛ فالقرآن يشير إلى هذا الأمر بوضوح في عدّة مناسبات، وقد تطرّق المفسِّرون المسلمون التقليديون إلى هذا الموضوع بتفصيلٍ كبيرٍ. أمّا الحجة الأقوى فتقول إنه يمكننا استخدام هذه الخلفية التي حدّدناها لشرح ما يحدث في القرآن وحلّ بعض المشكلات المتعلّقة بتحديد الشخصيات والموضوعات. بالمقارنة مع هذا النهج، يبدو أن التفسير التقليدي مرتبك وغير قادر على تحديد الخلفية التاريخية لِما يُقال في القرآن. ومن المؤكّد أن الكتاب المقدّس والنصوص المعاصرة الأخرى يشكلون أحد النصوص الضمنية، لكنها بلا شك واحدة بين نصوص ضمنية أخرى كثيرة، وحقيقة وجود شيء في الخلفية الأدبية لا يُثْبِت شيئًا سوى أن هناك شيئًا قد يكون حاضرًا في ذهن المستمعِين للقرآن، وقد لا يكون كذلك. وربما كان لدى المستمعِين موسوعة واسعة من الأدب الديني، هذا ممكن، لكن كانت هناك أيضًا قبائل بدوية يُفترض أنهم لم يحملوا مكتبات معهم، والغرض من الدِّين هو مخاطبة الجميع، وليس فقط من يتمتّعون بخلفية فكرية ومستوى تعليمي معيَّن. وقد أشار الفلاسفةُ المسلمون -مثل الفارابي وابن رشد- مرارًا إلى هذا الأمر؛ إِذْ تعبّر الفلسفة والدِّين عن الحقيقة ذاتها، إِذْ لا توجد سوى حقيقة واحدة، لكنهما يقدِّمانها بطرق مختلفة؛ فالفيلسوف لديه الوقت والقدرة والالتزام لفهم الحقيقة بطريقة تبرز حالتها العقلانية الكاملة وصِلاتها بكلّ شيء آخر، أمّا كثير من أفراد المجتمع فلا يمتلكون الوقت أو الرغبة أو القدرة لفهم الأساس العقلاني لما يؤمنون به، والدِّين بالنسبة لهم هو الطريق الأساسي نحو الحقيقة. الغرض من الدِّين هو التعبير عن الحقيقة بطرق تتماشى مع أوسع جمهور ممكن، وقد اعتبر الفلاسفة القرآن مناسبًا بشكلٍ خاصّ لهذا الاتجاه؛ إِذْ يخاطب الناس بطرق متنوّعة، كلّ منها مناسب لجمهور معيَّن، وبذلك ينجح في نقل الرسالة الإلهية بأوسع شكلٍ ممكن.
وغالبًا ما يمكن التوصّل إلى نتائج مذهلة من فرضيات خاطئة، وعلى الرغم من أننا قد نشكّك في كلٍّ من المنهج العلمي لدراسة النصوص الدينية وكذلك في مناهج المفسِّرين التقليديين، إلا أنَّ كليهما يتمكّن من تقديم تعليقات كاشفة للغاية حول النصوص التي يدرسونها. وعلى وجه الخصوص، لا يمكننا التقليل من الجهد الهائل الذي بذله المفسِّرون التقليديون في فهم لغة القرآن، وهو جهد قيّم للغاية رغم المسافة الزمنية والمكانية التي فصَلَت بينهم وبين وقت نزول النصّ، بغضّ النظر عن كيفية رؤية هذا النزول. من المفاجئ أنّ نويفرت لم تجد في أعمالهم الشاملة بهذا المجال ما يستحقّ الاهتمام. هذه الكلمات التحذيرية بشأن منهجهم في التعامل مع القرآن تهدف إلى توضيح أن التفكير في العثور على حلّ نهائي لفهمه قد يكون إشكاليًّا، كما لو كانت التحقيقات اللاهوتية مجرّد حلّ لغز. لا شك أنّ هذه الجهود البحثية مؤثِّرة، وستكون نتائج المشروع المستقبلية مثيرة للاهتمام، لكن النهج ليس جديدًا[5].
[1] عنوان الدراسة بالإنجليزية:
The Corpus Coranicum Project and the Issue of Novelty
(Journal of Qur'anic Studies 15.2 (2013): 142-148, Edinburgh University Press, https://doi.org/10.3366/jqs.2013.0100, © Centre of Islamic Studies, SOAS, www.euppublishing.com/jqs).
[2] كاتب المقال هو أوليفر ليمان (Oliver Leaman)، وُلد سنة 1950م، أمريكي الأصل، أستاذ الفلسفة والدراسات الدينية في جامعة كنتاكي منذ 2000م، عمل سابقًا في جامعة ليفربول جون مورس. يعتبر متخصّصًا في الفلسفة اليهودية والإسلامية والآسيوية. ألَّف العديد من الكتب المتعلقة بذات المجالات، بما في ذلك أحدث إصداراته: (دليل روتلدج لطقوس اليهود وممارساتهم)، و(دليل روتلدج لطقوس الإسلام وممارساته)، سنة 2022م. المترجمة.
(philosophy.as.uky.edu/users/oleaman)، (tafsir.net/author/3491).
[3] ترجم هذه المقالة، ليلى ثمراوي.
[4] كتب لنا الدكتور ديرك هارتفيغ -أحد الباحثين- في المشروع مقالاً موسعًا حول المشروع وأهدافه، بعنوان: مشروع "كوربوس كورانيكوم": عرض وتعريف، ترجمة: د/ مصطفى حجازي، ديرك هارتفيغ، موقع تفسير، ويمكن مطالعته على هذا الرابط: tafsir.net/translation/155. (قسم الترجمات).
[5] تم الانتهاء من هذا المقال خلال فترة زيارتي كباحث زائر في فلسفة الدِّين العالمية في جامعة برمنغهام.
مواد تهمك
-
.jpg) الاستشراق والدراسات القرآنية (2-2) الدراسات القرآنية الغربية
الاستشراق والدراسات القرآنية (2-2) الدراسات القرآنية الغربية -
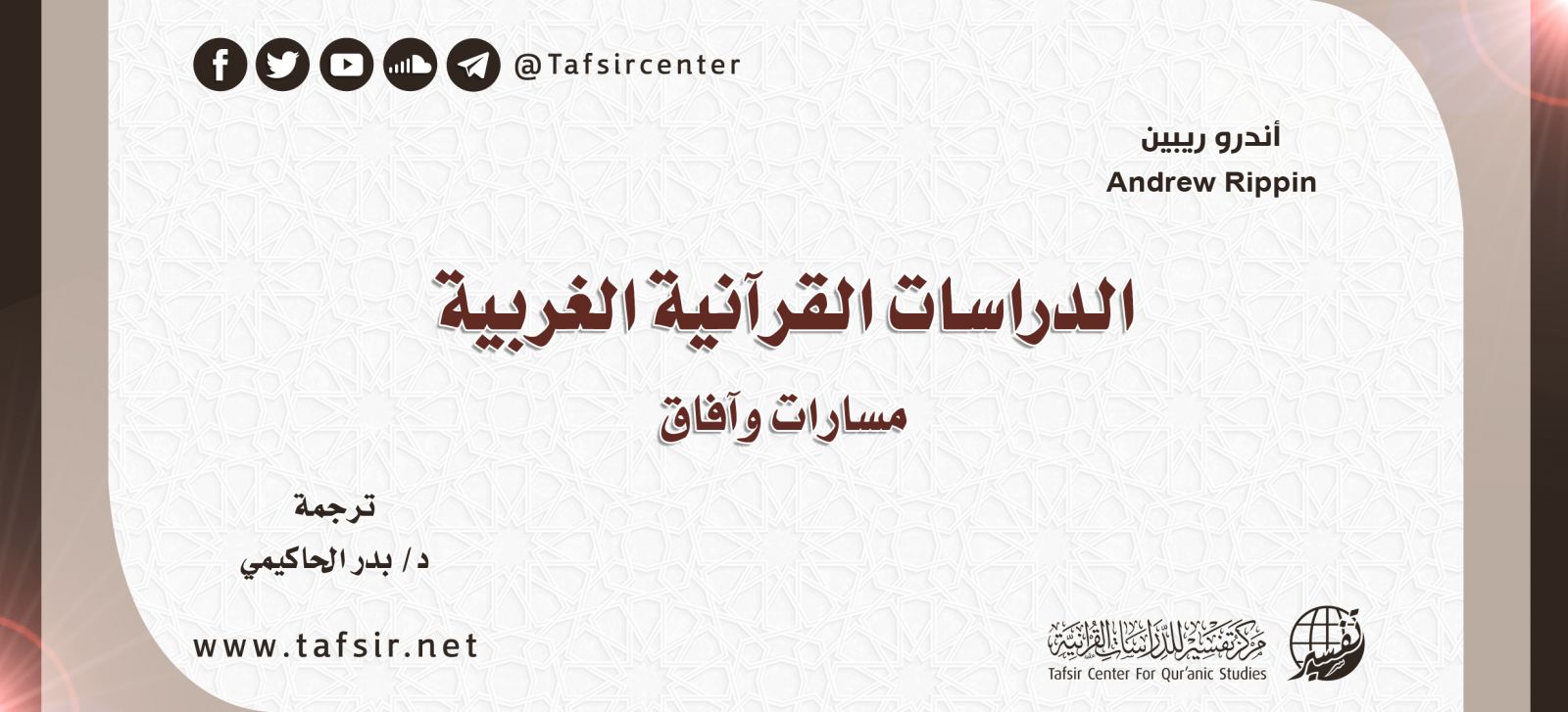 الدراسات القرآنية الغربية؛ مسارات وآفاق
الدراسات القرآنية الغربية؛ مسارات وآفاق -
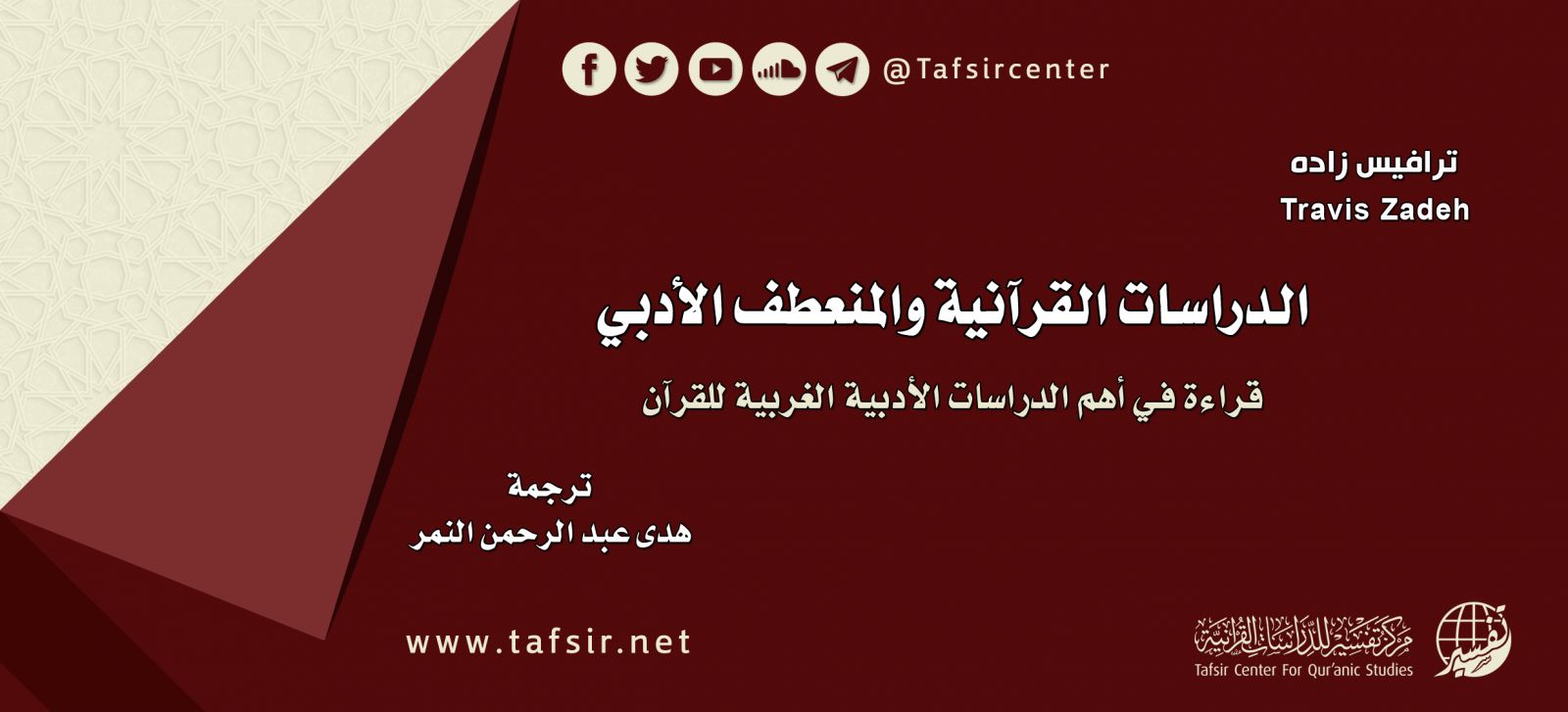 الدراسات القرآنية والمنعطف الأدبي؛ قراءة في أهم الدراسات الأدبية الغربية للقرآن
الدراسات القرآنية والمنعطف الأدبي؛ قراءة في أهم الدراسات الأدبية الغربية للقرآن -
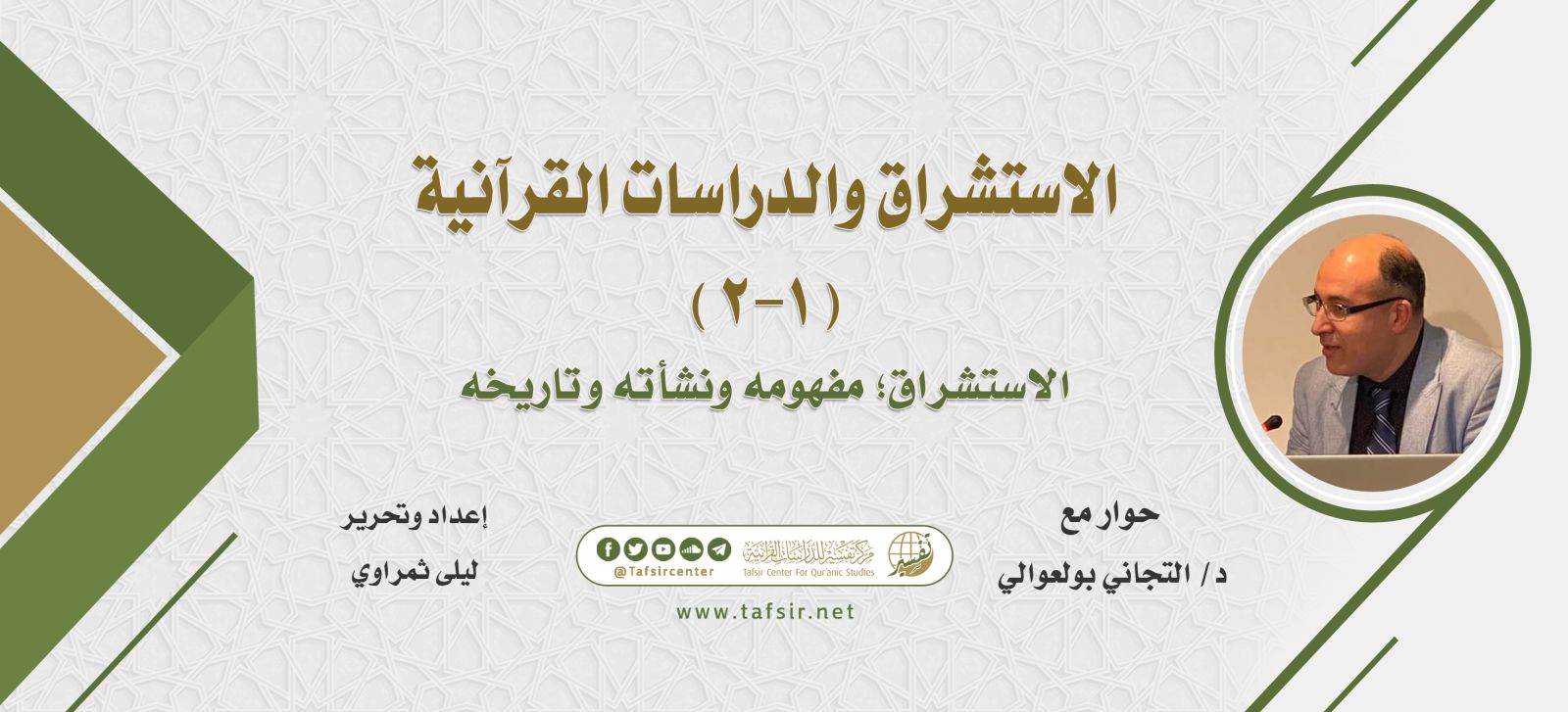 الاستشراق والدراسات القرآنية (1- 2) الاستشراق؛ مفهومه ونشأته وتاريخه
الاستشراق والدراسات القرآنية (1- 2) الاستشراق؛ مفهومه ونشأته وتاريخه -
 النصّ المقدّس، الشعر، وصناعة المجتمع: قراءة القرآن كنصٍّ أدبي. لأنجيليكا نويفرت
النصّ المقدّس، الشعر، وصناعة المجتمع: قراءة القرآن كنصٍّ أدبي. لأنجيليكا نويفرت -
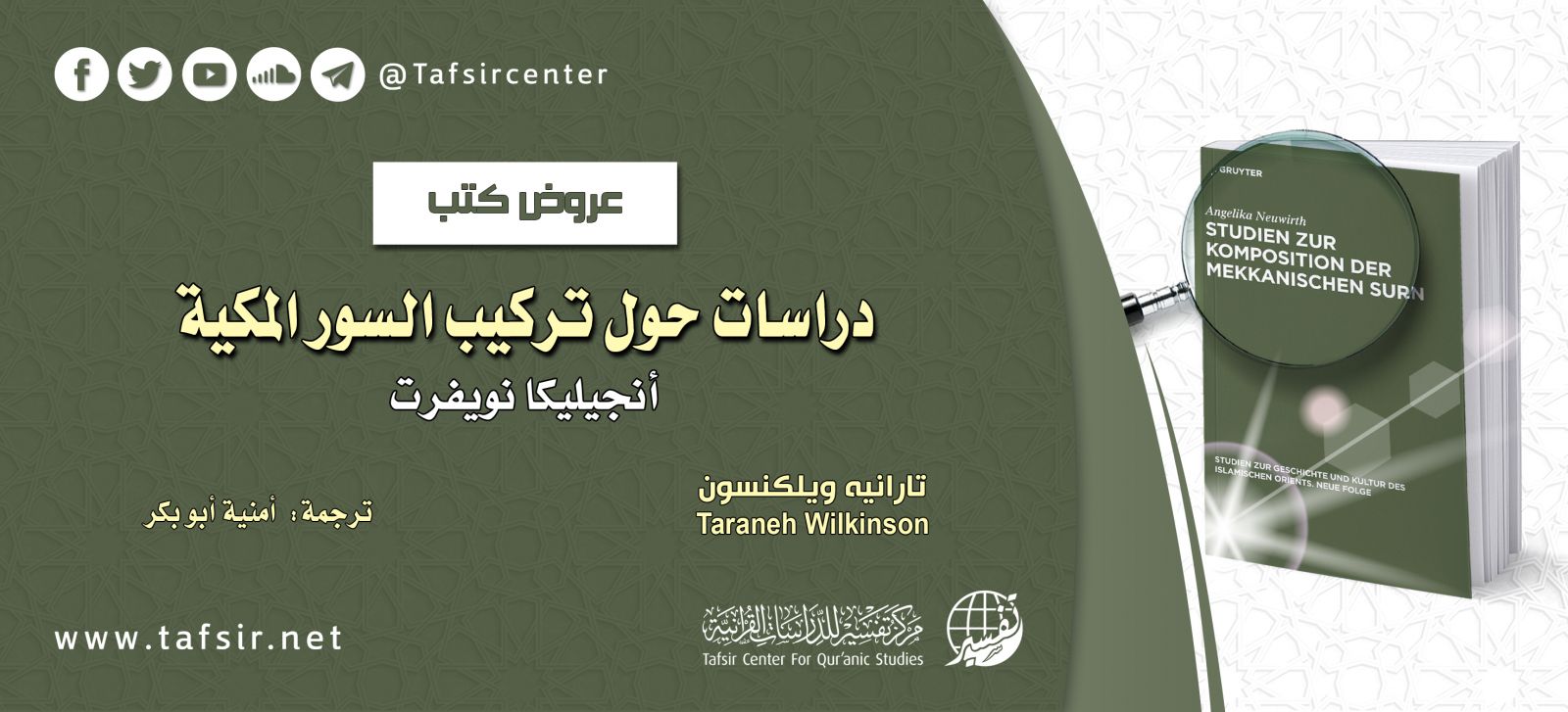 دراسات حول تركيب السور المكية، أنجيليكا نويفرت
دراسات حول تركيب السور المكية، أنجيليكا نويفرت


