الصِّلَة في القرآن الكريم
دراسة نحوية
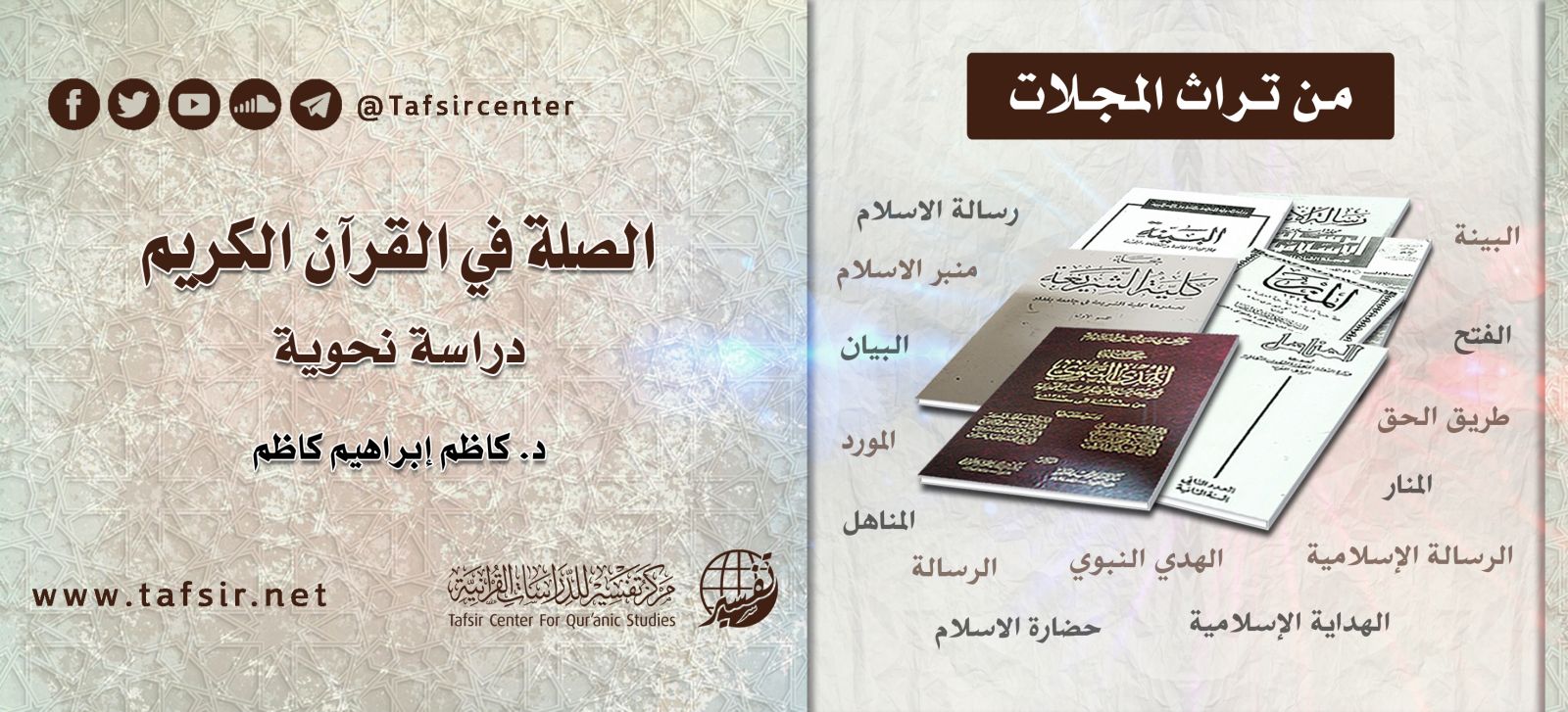
الصِّلة في القرآن الكريم
دراسة نحوية[1]
لا ريب أنّ قضايا القرآن النحوية قد تعدّدت دراستها في بحوث حتى إنّ الموضوع الواحد قد عُولج في أكثر من بحث. وهذا إنْ دلّ على شيء، فإنّما يدلّ على عَظمة القرآن نفسه، وأنه المعجزة الخالدة، وهو ما يدعو إلى تجديد بحوثه، ودراسته على مرّ الزمن والعصور؛ لاستنباط معالم المعرفة والهداية من مكنونه، وليست دراسته مقصورة على فترة من الزمن، وإنما هي مستمرة، طالما بقي القرآن موضوع كلّ عِلْم، ونبراس كلّ مهتدٍ، ومتراس كلّ مقتدٍ.
ولا يخفى على أحد ما للدرس النحوي من أثر على استيعاب النصّ القرآني، فكانت هذه الدراسة كسابقاتها من الدراسات النحوية التي كان موضوعها القرآن، فهي لا تقلّ أهمية عن غيرها، وبخاصة إذا علمنا أنّ موضوع (الصلة في القرآن) لم ينل ما نالته أبواب النحو الأخرى في أن يُفرد له باب، وربما يكون السبب هو أنّ الزائد لم يكن محصورًا في أحد أقسام الكلمة؛ إِذْ نجده في حروف المعاني، ووجوده في الأفعال والأسماء موضوع خلاف.
والنحاة تعرّضوا لهذا الموضوع من خلال تفسير بعض النصوص القرآنية، غير أنها لم تشكل دراسة مستقلّة شاملة لما صح أن يكون زائدًا. وهناك إشارات نحوية في كتب النحو، ورَدَ فيها الحديث عن زيادة بعض الحروف؛ كالذي جاء في كتاب سيبويه، وما تضمّنه مغني اللبيب، ومَن نحا نحوهم في هذا، وما جاؤوا به لم يفِ بالمعنى الذي تتضمّنه الزوائد، كما لم يكن شاملًا ومدروسًا كما هو الحال لأبواب النحو الأخرى.
وليس غريبًا أن يُقال إنّ أول آية في القرآن، وهي البسملة -على رأي مَن ذهب إلى أنها مِن أُمّ الكتاب- قد وردَت فيها زيادة الباء، وأنّ السورة نفسها قد تضمّنت زيادة (لا) في قوله تعالى: ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾ [الفاتحة: 7]، على أنها تفيد توكيد النفي، وهو قول البصريين[2].
ونشير إلى أنّ هناك خلافًا في بعض ما قيل فيه إنه زائد، كما أنّ النحاة قد قصروا قولهم على بعض الحروف، وقَلّ ذلك في الأفعال والأسماء. وهم في هذا قد تركوا كثيرًا من الأساليب التي هي في مفهومنا قد تضمّنت الزائد، وهذا القول يوجب الوقوف عليها لبيان ما لهذا الزائد من معنى، فكان لنا أن نضمّ إلى البحث زيادة بعض ما تضمّنته هذه الأساليب من الزائد مما لم يُقَلْ به صراحة.
وجاء البحث في تعريف لما استُخدم من مصطلحات في هذا الموضوع، وثلاثة مباحث، تنَاوَلْتُ في الأول منها الزيادة في الحروف، والثاني الزيادة في الأفعال، والأخير الزيادة في الأسماء، وختمتُ البحث بخاتمة.
المصطلحات التي استُخدمت:
إنّ المراحل التي مَرَّ بها الدرس النحوي قد أثَّرَت في ما استُخدم من مصطلحات نحوية؛ ولذا فإن إيضاح أيّ موضوع في النحو، والسعي إلى الكشف عن قضاياه ودراستها= يتوقف على بيان ما استُخدم من مصطلح فيه؛ ليتمكّن الدارس من استيعاب الموضوع، ووضوح الرؤية فيه؛ لذا وجدتُ الأهمية في التعريف بالمصطلحات التي استُخدمت في هذا الموضوع استكمالًا للبحث، ولست هادفًا من هذا إلى بيان التطور الذي مرَّ به المصطلح.
1- الزائد: وهو أشهر المصطلحات استخدامًا في هذا الموضوع، حيث نقف عليه في كتب النحو والتفسير، وغيرها من المصادر التي تعرَّضَت لهذا، ويُطلق على ما صرّح بمعناه وما لم يصرّح بذلك، وذكر ابن هشام أنّ الكوفيين أطلقوه على ما صرّح بمعناه[3].
2- صلة: وهو من المصطلحات الكوفية، وهو أقلّ شهرة من الأول، وقد استخدمه الفرّاء غير أنه لم يكن دقيقًا فيه؛ لأنه أطلقه على أكثر من معنى، إذ أراد به الزائد، كما أطلقه على الصفة، والحال، وغيرهما[4]، وشاع استخدامه في كتب النحو والتفسير، وبخاصّة إذا كان الرأي الذي ينقل كوفيًّا، وآثرنا أن يكون هذا المصطلح عنوانًا للبحث.
3- لغو: وهو من استخدامات الخليل وسيبويه، وهو أقلّ شهرة[5].
4- حشو: وهو من استخدامات سيبويه، والأخفش، وهو كسابقه أقلّ شهرة[6].
5- الفضل: بالضاد المعجمة، وهو من استخدام الفرّاء، غير أنه لم يطّرد عنده[7].
6- فصل: بالصاد المهملة، وقد أُطْلِق على ضرب من الزائد، وهو محصور استخدامه على الضمير الذي يتوسّط معرفتين، أو ما أصلهما معرفتان[8].
7- عماد: وهو من استخدام الكوفيين، وقد أطلقه الفرّاء على ضمير الفصل الذي يتوسّط معرفتين، وعلى ضمير الشأن، وعلى الألِف واللام الداخلة على خبر المعرفة إذا توسطهما ضمير الفصل[9].
8- ملغاة: ويطلق على ما أُلغي عمله من الأدوات.
9 - كافة: ويطلق على (ما) إذا كَفَّت أداة عن العمل، كما هو في (إنما) و(ربما) وغيرهما.
هذه المصطلحات هي التي استُخدمت لهذا المعنى، وتكاد تكون غير محصورة عند طائفة من النحاة والمفسِّرين، فقد نجد الدارس للنصّ القرآني يستخدم أكثر من مصطلح في القضية نفسها؛ كاستخدام مصطلح (زائد) و(صِلَة) معًا، أو قد يستخدم (زائد) في موضع و(صلة) في موضع آخر. كما نشير إلى أنّ بعضها محصورة على ضرب من الزائد، كمصطلح (فصل)، وبعضها لم يستقرّ على معنى كمصطلح (عماد)، وبعضها الآخر لم تكتب له الشهرة كمصطلح (فضل).
الزيادة في الحروف:
الزيادة في الحروف أكثر منها في الأفعال والأسماء، وذلك نابع من أن الفعل أو الاسم يشكِّل أحد أركان الجملة، ولا يمكن أن يكون أحدُهما زائدًا ما دامت دلالة النصّ تتوقّف على أركانه، حتى إننا نجد أنّ الإضمار غالبًا ما يكون فيهما مع قلّته في الحروف.
وحين نطلق مصطلح (الحروف) فإننا نريد به حروف المعاني، وهذا يعني أنها تأتي لمعنى، سواء أكانت عاملة أم غير عاملة ملغاة أم زائدة، غير أنّ دلالتها تختلف باختلاف النصّ الذي تتضمنه الجملة، فقد تخرج هذه الأداة عن معناها الذي وُضعت له إلى أسلوب آخر، ودلالة أخرى، وقد تكون بمعناها الذي اكتسبته نقيضًا لما كانت عليه عند استخدامها الأول. وهذا ما سيتضح جليًّا من خلال ما نعرض له من أساليب.
فالحروف الزوائد منها ما صُرِّح بمعناها، ومنها ما لم يُصَرِّح بعض النحاة بمعناها، وسنحاول الوقوف على النمط الأول، ومن ثَمَّ نعرض إلى ما لم يصرّح بمعناها للكشف عمّا تضمنته من دلالة، وعلاقتها بالنصّ.
أمّا النمط الأول من الحروف الزوائد فإنها تفيد توكيد ما تضمّنه النصّ من معنى، وهذا الغرض يختلف باختلاف الزائد؛ فمنه ما يتحقّق بزيادة حرف واحد، ومنها ما لا يتحقق إلا بزيادة حرفين، وبعضها الآخر يتحقّق بواحد ويؤتى بالحرف الآخر تأكيدًا للأول. وعلى هذا فهناك صور عدّة تضمنها النصّ القرآني في زيادة الحروف.
ومما هو عامل، فيلغي عمله بزيادة حرف، وعندها يفيد مع الحرف الزائد معنى آخر هو الحصر: (إنْ) و(ما) المشبهتان بـ(ليس) فهما يفيدان النفي، وإذا ما دخلت الأداة (إلّا)، أو (لمّا)، أو اللام المفتوحة غير الجارة على خبر الجملة الاسمية تغيّر المعنى، وانتقض من النفي إلى الإثبات والحصر، وأصبحت فيه (إنْ)، أو (ما)، وما كفّهما عن العمل ملغاة[10]. من ذلك قوله تعالى: ﴿وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ﴾ [آل عمران: 144]، ومنه قوله تعالى: ﴿إِنْ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ﴾ [طه: 63]، ومنه قوله تعالى: ﴿إِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ﴾ [الطارق: 4]، ومنه قوله تعالى: ﴿وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ﴾ [العنكبوت: 18].
فكلٌّ من (إِنْ)، و(ما)، و(إلّا)، و(لمّا)، و(اللام) زوائد، أفادت الحصر، ولو جردنا النصوص التي مَرَّت من هذه الأدوات لما تغيّر المعنى سوى أنها تخلو من أسلوب التوكيد، أمّا إعرابها فلم يتغيّر في كلتا الحالتين، سواء اقترنت هذه الجُمَل بهذه الأدوات أم لم تقترن.
وقد تزاد (مِن) الجارة على بعض الأساليب المتقدّمة، وليست مطّردة في كلّ ما تقدّم من أدوات، منه قوله تعالى: ﴿وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ﴾ [آل عمران: 62]، ومنه قوله تعالى: ﴿وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا إِلَهٌ وَاحِدٌ﴾ [المائدة: 73]، ومنه قوله تعالى: ﴿وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ﴾ [فاطر: 24]، فالصور التي تقدّمت في زيادة (مِن) مقصورة على أن يكون مجرورها نكرة؛ إِذْ لا تزاد إذا كان المجرور بها معرفة، واختلف النحاة في زيادتها في الموجب[11].
وهذه الزوائد المتقدّمة قد تُزاد في الجملة الفعلية، وتفيد ما أفادته من معنی التوكيد. ونؤكد بأنها ليس لها أثر على الإعراب بقوله تعالى: ﴿وَإِنْ وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ﴾ [الأعراف: 102]، وقوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً﴾ [النساء: 92]، ومنه قوله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ [النساء: 64]، ومنه قوله تعالى: ﴿إِنْ نَظُنُّ إِلَّا ظَنًّا﴾ [الجاثية: 32].
ويُضمّ إلى ما تقدَّم زيادة (لا) النافية إذا أفادت مع (إلّا) الحصر، منه قوله تعالى: ﴿قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ﴾ [النمل: 65]، وقوله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: 286].
فالآيات التي سبق ذِكْرُها تختلف بعضها عن بعضها الآخر باختلاف المحصور وغرضه، أمّا الأدوات التي أفادت هذا المعنى البلاغي فكلّها زائدة، وليس لها أثرٌ على الإعراب.
ويلحق بهذا الضرب من الزائد (هل) التي تفيد معنى (ما) النافية في باب الحصر[12]، منه قوله تعالى: ﴿هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ﴾ [فاطر: 3]، ومنه أيضًا قوله تعالى: ﴿فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ﴾ [الأحقاف: 35].
ومما هو عامل فيلغى بزيادة حرف آخر (إِنَّ) المكسورة الهمزة المشدّدة النون، فإنها إذا ما دخلت عليها (ما) الكافة تُلغى، ويكونان حرفًا واحدًا[13]، يفيد الحصر، ولا أثرَ له على الإعراب، منه قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا﴾ [الأحزاب: 33]، وقد نصّ سيبويه عن الخليل بأنّ (إنما) بحكم الفعل الملغَى[14]، ونضمّ إلى هذا دخول (ما) على حرف الجر (رُبَّ)، والطريف في هذه الزيادة هو أن (رُبَّ) حرف مختص بالأسماء، وإذا أريد معناه في جملة اسمية كانت أم فعلية زادوا عليها (ما)، منه قوله تعالى: ﴿رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ﴾ [الحجر: 2].
والزيادة في الحروف ليست مقصورة على الحروف العاملة؛ إِذْ وَرَدَتْ في غير العاملة، وقد أفادت معنى. هذا، وقد مَرَّت شواهد على زيادة (إلّا) و(لمّا)[15]، واللام التي تضمّنت معنى (إلّا)[16]. ونضمّ إليها زيادة (أَنْ) المفتوحة الهمزة المخففة النون غير العاملة في الفعل، على أنّ زيادتها تتم وفق شروط أوردها بعضُ النحاة، وأنها تفيد معنى التوكيد[17]، نذكر منها قوله تعالى: ﴿وَلَمَّا أَنْ جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ﴾ [العنكبوت: 33]. هذا، وقد نصّ سيبويه والمبرّد على زيادتها، وأنها تفيد المعنى المتقدّم، غير أنهما لم يستشهدَا بالقرآن على ذلك، كما أنهما لم يوضحَا المؤكد، ونوع التوكيد[18].
والذي جعل النحاة يقولون بهذا المعنى في (أَنْ) هو أنهم وجدوا الأداة التي تسبقها لا يصلح دخولها على الجملة الاسمية، وليس لهم أن يقدّروا فعلًا لعدم اتساق المعنى. ولو أمكن ذلك لجاءت (أَنْ) مخففةً من الثقيلةِ، واسمها ضمير الشأن محذوفًا، وهذا الذي عَسَّرَ على النحاة أن يجدوا تفسيرًا لـ(أَنْ) سوى أن يقولوا بزيادتها على أنها تفيد التوكيد. ولو كان هناك توسّع في استيعاب مفهوم هذا النصّ وغيره من النصوص من دون اللجوء إلى ما قُنِّنَ مِن قواعد نحوية لأمْكَنَ أَنْ يُقال: إن (لمّا) اسم يفيد الظرف، والمصدر المؤول بعدها مضاف إليه، ويكون المعنى: سِيءَ بالرّسل عند مجيئهم، والظرف قد عمل فيه الفعل (سِيء)، والجملة تحمل معنى الشرط وليست شرطية، وهذا التفسير يخرجنا من القول بالزائد الذي يفيد التوكيد من دون تفسير له، ونشير هنا إلى أنّ مِن النحاةِ من قال بظرفيتها؛ منهم ابن السراج، وأبو عليّ الفارسي، وابن جنّي، وجماعة[19].
ومن الزائد غير العامل لام الابتداء، سواء أدَخَلت على المبتدأ أم على غيره، ومن الأول قوله تعالى: ﴿لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَى أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ...﴾ [يوسف: 8]، واللام فيها تفيد توكيد مضمون جملة. أمّا زيادتها على غير المبتدأ، فستأتي إليه من خلال الكلام عن زيادة (إنَّ)[20].
وهناك نمط آخر في زيادة الحروف وهو زيادتها بين العامل ومعموله كزيادة (ما) بين الجار والمجرور، كما هو في قوله تعالى: ﴿فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ﴾ [آل عمران: 159]، ومنه قوله تعالى: ﴿عَمَّا قَلِيلٍ لَيُصْبِحُنَّ نَادِمِينَ﴾ [المؤمنون: 40]، فـ(ما) عند كثير من النحاة منهم سيبويه والمبرد زائدة، تفيد التوكيد، وهي عند ابن هشام استفهامية تعجبية[21].
ويضمّ إلى هذا الضرب زيادة ما بين التابع ومتبوعه، منه قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَا بَعُوضَةً...﴾ [البقرة: 26]، على أنها تفيد التوكيد، وهو قول البصريين غير أنهم لم يصرحوا بنوع (ما) هذه[22]. وذهب بعض النحاة إلى أنّ (ما) اسم مجرور، ويُعرب ما بعده بدلًا منه، وهو قول ابن كيسان والنحاس. وهذا القول يتفق مع ما قيل في زيادة (ما) على (رُبَّ) الجارة بأنها مجرورة بها، منه قوله تعالى: ﴿رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ﴾ [الحجر: 2]، وهو أحد قولي الأخفش[23].
إنّ ما تقدم كان الزائد فيها غير عامل، أو كان عاملًا فأُلغي، وما سنذكره هنا لا يختلف عما تقدّم من حيث الغرض من زيادته غير أنه يختلف عنه بأنه عامل، ولا يؤثّر على المعنى إلا بقدر ما أفاده من توكيد، من ذلك زيادة (إِنَّ) المكسورة الهمزة المشدّدة النون أو المخفّفة العاملة الداخلة على الجملة الاسمية، منها قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللهَ بَالِغُ أَمْرِهِ﴾ [الطلاق: 3]. ومن المخفّفة من الثقيلة قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ﴾ [هود: 111]، على قراءة النصب[24] والتخفيف.
وقد تزاد اللام التي تفيد التوكيد مع (إنَّ)، وتعطي المعنى توكيدًا آخر، كما تقدّم في قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُلًّا لَمَّا...﴾. ومن الداخلة على خبر الثقيلة قوله تعالى: ﴿وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ﴾ [الروم: 8]، ومنها قوله تعالى: ﴿إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ﴾ [الفرقان: 20]، وقوله تعالى: ﴿إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾ [يوسف: 8].
أمّا زيادة (أَنَّ) المفتوحة الهمزة المشدّدة النون فإنها لا تختلف عن المكسورة من أنها تفيد التوكيد، غير أنها لا يمكن الاستغناء عنها كما هو الحال في (إِنَّ)؛ وذلك لأنّ لها غرضًا آخر أبعد من التوكيد وهو تمكين ما قبلها مما بعدها، مما يحمله من معنى، كتمكين الفعل من فاعله أو مفعوله إذا كان جملة، وتمكين أفعال اليقين أو الرجحان من مفعولها، وكذا القول في (أَنْ) المفتوحة الهمزة المخففة النون الداخلة على الجملة الاسمية أو الجملة الفعلية، إلا فيما ذهب إليه الأخفش في (أَنْ) المصدرية الناصبة في جواز زيادتها[25]، وهذا ما سنقف عليه بعد.
وبعض النحاة أجاز أن تكون (أَنَّ) زائدةً تفيد التوكيد على الرغم من كونها عاملة، وذلك يكون إذا كانت مكرّرة، وجعل منها قوله تعالى: ﴿أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَنْ يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ﴾ [التوبة: 63]، فقد نسب المبرّد إلى أبي الجرمي أنه ذهب إلى زيادة (أَنَّ) في الآية[26]. وهذا القول لا يختلف في معناه عن قول سيبويه والفرّاء من أَنَّ (أَنَّ) الثانية بدل من الأولى؛ لأنّنا لو أمعنّا النظر في الآية لوجدنا أن جملة جواب الشرط قد تضمنت جملة فعل الشرط، وأن اسم (أَنَّ) الأولى هو ضمير القصة، وقد فُسِّرَ بـ(أَنَّ) الثانية، وتقدير الآية: مَنْ يحادِد الله ورسوله فإنّ له نارَ جهنم. والفاء واقعة في جواب الشرط، وهو تفسير يبعدنا عن الخلاف الذي دَبَّ بين النحاة في تفسير زيادة (أَنَّ)[27]، وهذا التقدير يخلو من (أَنَّ) التي تفيد التوكيد لعلة عدم جواز اجتماع أداتي توكيد من دون فاصل، وهذا يوضح لنا الصورة لعلّة التفريق بينهما.
والزيادة في الحروف لم تقتصر على تأكيد مضمون جملة، فهناك أسلوب آخر، وهو أنها تفيد توكيد أحد أركان الجملة، منفية كانت أم مثبتة، من ذلك زيادة الكاف في قوله تعالى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ [الشورى: 11]، فإنه يفيد توكيد نفي التشبيه به سبحانه وتعالى، ومنه زيادة الباء في قوله تعالى: ﴿وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ﴾ [الحج: 10].
والشواهد القرآنية في ذلك كثيرة غير أن الخلاف يكمن في تفسير بعض الحروف، مما أدى إلى الخلاف في تقنين بعض القواعد في الحروف الزائدة؛ كالخلاف في زيادة (مِن) الجارة، فقد ذهب الكوفيون والأخفش إلى جواز زيادتها في الموجب[28]، منه قوله تعالى: ﴿يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ﴾ [الأحقاف: 31]، وذهب غيرهم، منهم البصريون، إلى أنها لا تُزاد إلّا في النفي وشبهه. ونصّ سيبويه على أن زيادتها تفيد التوكيد[29]، والشواهد تقدّمت في ذلك.
جاز فيما تقدّم من شواهد حذف الزائد من الحروف في غير القرآن، وهناك أساليب أُخر لا يرجح فيها حذف الحرف الزائد، ويطلق على هذا الضرب الشبيه بالزائد؛ كزيادة الباء على فاعل الفعل (كَفَى) الذي يتضمن دلالة صيغة (افتعل)، منه قوله تعالى: ﴿قُلْ كَفَى بِاللهِ شَهِيدًا﴾ [الرعد: 43]، على أن الزيادة تفيد التوكيد[30] وهذه الزيادة لا نقف عليها في الفعل نفسه إذا جاء على صيغته ومعناه، كما هو في قوله تعالى: ﴿وَكَفَى اللهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ﴾ [الأحزاب: 25].
ونستطيع أن نضمّ إلى هذا الضرب زيادة (مِن) الجارة المسبوقة بالنفي الداخل على الجملة الاسمية، كما هو في قوله تعالى: ﴿وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللهُ﴾ [آل عمران: 62]، إِذْ تفيد (ما مِن) في تركيبها هذا معنى (لا) النافية للجنس، وإلى هذا المعنى أشار الزمخشري، وأوضح أنها مع (إلّا) تفيد الحصر[31].
والزيادة في حروف الجر غير مقتصرة على أحد أركان الجملة؛ إذ جاءت زيادتها في غير ذلك، وهو واقع في النصّ القرآني، سوى أنّ الخلاف يكمن في تفسير الزائد؛ فمن النحاة مَنْ قال به في موضع، ومنعه في موضع آخر، وهذا لا حصر له، نذكر منه ما ذهب إليه الفرّاء في زيادة اللام في قوله تعالى: ﴿قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ﴾ [النمل: 72]، وأشار إلى أنها تفيد التوكيد[32].
نشير إلى أنّ ما تقدّم من زيادة في الحروف قد صُرِّح بمعناه، وسنتناول هنا ما لم يُصرَّح بمعناه، وهذا لم يكن مطّردًا عند من اهتم بدراسة النصّ القرآني، وإنما هو مقصور على أقوال بعض النحاة، وأخذ به بعض المتأخرين. وسنسعى إلى إلقاء الضوء على استنباط ما يتضمّنه الزائد من معنى اعتمادًا على أقوال من منح هذا الزائد معنى، أو ما نستطيع أنْ نضمّنه.
ومن هذا الزائد (أَنْ) المصدرية الناصبة، إِذْ إنّنا نجد أنها على الرغم من كونها عاملة، فقد أجاز الأخفش زيادتها في قوله تعالى: ﴿وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ [البقرة: 246]، وقال: «فـ(أَنْ) ها هنا زائدة كما زيدت بعد (قلَّما)، و(لمّا)، و(لو)، فهي تُزاد في هذا المعنى كثيرًا، ومعناه: ما لنا لا نقاتلُ، فأَعمَل (أَنْ) وهي زائدة، كما قال: ما أتاني من أحدٍ، فأَعمَل (مِن) وهي زائدة»[33]. فالأخفش قد حَدَّ زيادة (أَنْ) في أسلوب الشرط الواقع بالأدوات التي تضمنها النصّ. وهذا الذي اشترطه قد خلت منه الآية، وهو ما يدعو إلى القول بأنه قد خلط بين (أَنْ) الزائدة غير العاملة، والتي تفيد معنى، والتي تقدّم الكلام عنها، وبين (أَنْ) المصدرية الناصبة. وما لم نقف عليه في النصّ هو أنّ الأخفش لم يصرِّح بمعنى هذه الزيادة، وأنه حاول أن يقرِّب المعنى من خلال كلامه عن زيادة (مِن) الجارة. ولم يوفق في ذلك لأنّ (ما مِن) تفيد استغراق نفي الجنس. فليس هناك رابط بين زيادة (أَنْ) وزيادة (مِن). والخلاف في دلالتهما وعملهما واضح.
والذي جعل الأخفش يذهب إلى هذا القول هو ما وجده من صعوبة في تأويل المصدر المؤول بالصريح، إذ دعاه ذلك إلى القول في زيادة (لا)، ويكون المعنى: ما لنا المقاتلة؟ وهذا التفسير بعيد كلّ البُعد عن المعنى الذي أوْلَتهُ الآية، ونُذَكِّر هنا بأنّ الآية لم تُقرأ إلّا نصبًا.
وهناك أقوال أُخر في الآية لم تصرِّح بزيادة (أَنْ)[34]، منها قول الفرّاء، إِذْ جعل معنى الآية كمن قال: ما مَنَعَكَ أنْ تُقَاتِلَ[35]. وقول الفرّاء هذا إنْ صَحّ من حيث المعنى، فإنه قد جَرَّدَ المصدر عن معنى الامتناع، وذلك بحذفه (لا) عند تقديره، وعوض عنه بفعل (مَنَعَ) وهذا مما يؤخذ عليه، والذي حَدَا به إلى ذلك هو الصعوبة في تأويل المصدر، وهو مقرون بـ(لا)[36].
ولنا أن نقول في هذا الخلاف، وهو لا يبتعد عما أورده الفرّاء من معنى، غير أنه يختلف عنه بأن لا يستوجب أن نذهب إلى تأويل الآية بالمصدر الصريح. فـ(لا) على معناها من النفي، و(أَنْ) على عملها، وغير زائدة. وبهذا يكون المصدر المؤول بحكم الصريح المنفي، ويكون بمنزلة الاسم المنفي بـ(لا)، وليس ضرورة أن يؤول هذا المصدر بالصريح، وقد نصّ بعض النحاة على ذلك، وجعل منه: أنت خليق أن تفعل، فلا يجوز تأويله بالصريح، إِذْ لا يُقال: أنت خليق الفعل، وجاز ذلك إذا ما دخلت عليه الباء الجارة[37]. وأضمّ إلى ذلك المصدر من (أَنْ) المخفّفة المفتوحة الهمزة، والتي اسمها ضمير الشأن محذوفًا، كما هو في قوله تعالى: ﴿وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى﴾ [النجم: 39]، فليس هناك مصدر يضمّ هذا المعنى تحت لواء المصدر الصريح. ومن ذلك كثير.
وسيتّضح هذا المعنى في الآية أكثر من خلال الكلام عن زيادة (لا)، فهناك موارد ذكرَ النحاة زيادة (لا) فيها، وفي بعضها لم يصرّح بمعناه، والأول تحدثنا عنه، ونعرض إلى الثاني، وهي في هذا لم تقتصر زيادتها على نمط من الأنماط، فإنها تزاد في الجملة المثبتة والمنفية والقسَم وبين العامل ومعموله، وهي في كلّ هذا موضع خلاف النحاة. من ذلك زيادتها في قوله تعالى: ﴿وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ﴾، وهذا أحد أقوال وردت في الآية، وقد قدّمنا أنه لا يمكن تجريد النفي عن الآية، مما دعا بعض النحاة إلى تقدير فعل يتضمّن هذا المعنى، ونضيف إلى ما تقدّم من تعليل هو أنّ (لا) ليس لها أن تتصدر (أَنْ) المصدرية لتعلّق الأخيرة بما قبل (لا)، وأنها لا تصلح أن تكون في الآية نافية للجنس، أو من المشبهات بـ(ليس)؛ لأنها تفيد نفي الفعل الذي تضمنه المصدر المؤول، فهي في غرضها الدلالي لا تختلف عن التي زِيدت في قوله تعالى: ﴿وَأَدْعُو رَبِّي عَسَى أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا﴾ [مريم: 48]، فـ(لا) على الرغم من زيادتها من حيث اللفظ، فهي أفادت معنى النفي، ولا يمكن الاستغناء عنها.
ومما قيل في (لا) إنها زائدة غير أنها تختلف عن سابقاتها قوله تعالى: ﴿لِئَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ﴾ [الحديد: 29]، فقد ذهب بعض النحاة منهم الأخفش والمبرد إلى زيادتها ولم يصرحوا بمعناها[38]، وكذا النحاس غير أنه صرح بأنها تفيد التوكيد، ولم يُشر إلى نوع التوكيد أو المؤكّد[39]، وهو قول سيبويه[40].
وحاول الفرّاء أن يكون أكثر وضوحًا في زيادة (لا) في الآية، وبيان ما تضفيه الزيادة من معنى، حيث قال: «والعرب تجعل (لا) صلة في كلام دخل في آخره الجحد، فجعلت (لا) في أوّله صلة، وأمّا الجحد السابق الذي لم يصرح به، فقوله عز وجل: ﴿مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ﴾»[41]. والمراد بقوله: «بما لم يصرح به»، هو الفعل الذي يتضمّن معنى النفي.
وما جاء به في توضيح زيادة (لا) لم يطرد في كلّ مورد زِيدت فيه (لا)، من ذلك قوله تعالى: ﴿لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ﴾ [البقرة: 150]، ولنا أن نقول: إنه ينطبق عليه القول إذا قدَّرْنا: فلا حُجّة لهم. أو يكون النفي متقدّمًا في قوله تعالى: ﴿فَلَا تَخْشَوْهُمْ﴾، ومثل هذا التقدير نفتقده في قوله تعالى: ﴿لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ﴾ [النساء: 165]، كما أنّنا لم نقف عليه في زيادتها في الآية: ﴿وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ﴾، والتي تقدّم الكلام عنها، إلا إذا اعتبرنا أَنّ الاستفهام في الآية إنكاري. وبذا نستطيع القول فيما تقدّم أنّ (لا) تزاد في الموجب، وتفيد النفي، كما أنها تزاد في النفي المصرح به وغير المصرح به، وتفيد التوكيد.
وقد تزاد (لا) في أول الكلام، وقد نسب الفرّاء هذا القول إلى كثير من النحويين، جاء ذلك في قوله تعالى: ﴿لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ﴾ [القيامة: 1]، قال: «كان كثير من النحويين يقولون لا صِلَة، قال الفراء: ولا يبتدأ بجحد ثم يجعل صِلَة يراد به الطرح؛ لأنّ هذا لو جاز، لم يعرف خبر فيه جحد من خبر لا جحد فيه»[42]. إنّ ما تضمّنه النصّ واضح فيه أنّ الفرّاء يرفض أن تكون (لا) زائدة، خوفًا من اللبس بين الخبر المنفي من الخبر المثبت.
وذهب عليّ بن سليمان والنحاس إلى زيادتها في أول السورة على قول أنّ القرآن كلّه بمنزلة سورة واحدة[43]، وردّ ابن هشام على مَن أجاز زيادتها على التوكيد؛ لأن ذلك لا يكون في صدر الكلام[44]، وهو في هذا يتفق مع ردّ الفرّاء، وذكر أقوالًا أُخر أعطت (لا) معنى، وأنها غير زائدة[45].
لعلّ أرجح الأقوال في (لا) المتقدّمة الكلام هو ما ذهب إليه الفرّاء من أنها غير زائدة، فهي عنده تفيد النفي، ردًّا على من أنكر البعث والجنة، وهذا القول محصور في زيادتها في القَسَم.
ومن الزائد الذي لم يصرح بمعناه ما قيل في بعض حروف الجر، من ذلك ما نُسب إلى أبي عبيدة في قوله تعالى: ﴿فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ * بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ﴾ [القلم: 5- 6]، فالباء عنده زائدة[46]، ونسب النحاس هذه الزيادة إلى قتادة[47]، وهو قول الأخفش[48]، ومن النحاة من خالفهم بأنْ قال بمعناها أو ضمّنها معنى (في)[49].
ونسب زيادة (عن) في قوله تعالى: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ﴾ [النور: 63]، إلى الأخفش وأبي عبيدة، ولم يصرح بمعناها[50] وقد يكون معناها في الآية المجاوزة[51].
ومما قيل فيه إنه زائد، ولم يصرح بمعناه هو اللام في قوله تعالي: ﴿لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ﴾ [الأعراف: 154]، وهو قول الكوفيين[52]. ولا ريب أن اللام في الآية تفيد التوكيد لتقدّم المفعولية على عامله.
ومما قيل فيه إنه زائد، وهو غير عامل: (الفاء)، فقد ذهب الأخفش في قوله تعالى: ﴿أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَنْ يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ﴾ [التوبة: 63]، إلى أَنَّ الفاء شبه زائدة[53]، والذي جعله يقول بهذا الأسلوب من دون أن يصرّح بزيادتها هو أن (أنَّ) الثانية بدل من الأولى، فلم يجد جوابًا لهذه الفاء، فقال بهذا. وقد قدمنا الكلام عن هذه الآية، وأوضحنا أن جملة جواب الشرط قد تضمّنت جملة فعل الشرط، وليست الفاء بزائدة لأنها واقعة في جواب الشرط، ووظيفتها تمكن ما بعدها من أن يكون كذلك.
ويُقال مثل هذا فيما ذهب إليه الزجاج في قوله تعالى: ﴿هَذَا فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمٌ﴾ [ص: 57]، بأن الفاء زائدة[54]، وليس كذلك، لأن خبر المبتدأ ﴿هَذَا﴾ قوله: ﴿حَمِيمٌ﴾، وجملة: ﴿فَلْيَذُوقُوهُ﴾ معترضة، وهو أحد قولي الفراء[55].
ومن الزائد غير العامل (الواو)، وفي زيادتها خلاف بين البصريين والكوفيين؛ فقد أجازها الكوفيون والأخفش، ومنعها البصريون[56]. وقد ذهب الأخفش إلى أن زيادة الواو والفاء كثيرة في القرآن، غير أنه لم يصرح بنوع هذه الزيادة[57].
والفراء نَصَّ على زيادة الواو، وحصرها في جواب الشرط الواقع بالأدوات (حتى إذا)، (إذا)، (لمّا)[58]، وحصرها بهذه الأدوات يشير إلى أنها زِيدَت لمعنى، وهو تمكين ما بعدها من أن يكون جوابًا لهذه الأدوات، شأنه شأن الفاء. والشروط التي أوردها الفرّاء نجدها في الآيات التي أوردها أبو البركات بن الأنباري في احتجاج الكوفيين على زيادة الواو[59]، غير أنّ القرطبي نسب إليهم الزيادة في غير ذلك، فقد جاء في قوله تعالى: ﴿وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ﴾ [ص: 44]، أن الواو عند الكوفيين زائدة[60]، ولم أقف على هذا عند الفرّاء[61]، وأوَدُّ أن أُشير إلى أن هذه الواو عند الكوفيين والأخفش حرف عطف[62]. والخلاف يكمن في التفسير، وليس في الواو في الآية المتقدمة.
ومما قيل فيه إنه زائد ولم يصرح بمعناه وهو غير عامل (ما)، فقد قيل بزيادتها في أكثر من موضع، وسبق أن تعرّضنا إلى هذه الشواهد، وأشرنا إلى ما تضمنته (ما) من معنى غير أن بعض النحاة قد ذهبوا إلى زيادتها من دون أن يصرّحوا بمعنى لها، من ذلك قوله تعالى: ﴿فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ﴾ [آل عمران: 159]، فقد ذهب الفرّاء في أحد أوجه الإعراب التي أوردها في الآية أنّ (ما) زائدة، وكان تقديره لها هو: فبرحمةٍ[63]. وهو قول النحاس[64]، وذهب الأخفش إلى ذلك في قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَا بَعُوضَةً...﴾ [البقرة: 29]، وتقديره لها: (مثلًا بعوضة)[65]. وليس لنا هنا من تعليق لتقدّم الكلام عنها.
ومما قيل فيه إنه زائد، ولم يصرح بمعناه غير أنه يمكن أن يعتبر كالجزء مما زيد عليه هو (الألف واللام)، فقد ذهب الأخفش إلى أن الألف واللام في (اللات) في قوله تعالى: ﴿أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى﴾ [النجم: 19]، زائدة غير أنها لا تسقط[66]. ومن ذلك ما جاء في قوله تعالى: ﴿وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ﴾ [الأنعام: 86]، فقد ذهب المهدوي إلى أن الألف واللام في (الْيَسَع) زائدة، غير أنه يختلف عن الأخفش في أنه استطاع أن يفسّر زيادتها على الإتباع، وأنها تفيد التوكيد[67]، هذا إذا قرئت بلام واحدة[68]. وذهب مكيّ بن أبي طالب في (الْيَسَع) إلى أنه فعل يدلّ على الاستقبال، ثم نُكِّرَ، فَعُرِّف بالألف واللام، وعلى هذا فهي عنده غير زائدة[69]، وهذا التوجيه لزيادتها يكاد يكون محصورًا في (الْيَسَع) ولم يفسّر في غيره.
ويضمّ إلى ذلك زيادتها في (الآن)[70]، وفي الأسماء الموصولة، فإنها لا تسقط عنها[71]، وقد قُرِئَ شذوذًا قوله تعالى: ﴿صِرَاطَ لذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ﴾ [الفاتحة: 7].
مبحث الزيادة في الأفعال:
لم أقف على نحويّ قال بزيادة الأفعال وهي تفيد معنى سوى الفعل (قَلَّ). ومن خلال استقرائنا للنصّ القرآني وجدنا أن من الأفعال ما تفسّر زيادتها بالمعنى الذي تقدّم الكلام عنه في أسلوب الحصر؛ إِذْ تفيد مع الأداة (إلّا) ما أفادته (ما) و(إلّا) في الحصر. وهذا ما سنسعى إلى بيانه، ومن ثَمَّ سنقف على أفعال لم يصرّح بمعناها.
إنّ الحصر بالأفعال وأداة الحصر يكاد يكون محصورًا بفعلين لا ثالث لهما. وهما (ليس)، و(يأبَى)، لإفادتهما معنى النفي؛ ولذا فسنقف على هذين الفعلين لإيضاح الحصر بهما وبيان كونهما زائدين.
(ليس): فعل ناسخ يفيد معنى النفي، ويمتاز عن الحروف المشبهة به أنه إذا ما دخلت عليه أداة الحصر لا يُلغى عمله غير أنه يفيد معنى آخر غير النفي، وهو الحصر مع أداة الحصر، وبمعنى أدقّ أنه يعمل لفظًا، وينتقض نفيه بـ(إلّا)، أي: ليس هناك نفي، وهو في ذلك لا يختلف في غرضه عمّا تؤديه (ما) مع (إلّا) من معنى الحصر، علمًا بأن (ما) ملغاة في هذا الأسلوب من التوكيد.
وهذا الذي قدّمناه هو الذي يجعلنا نقول بزيادة (ليس) على الرغم من عمله لفظًا، غير أن هذه الزيادة جاءت لغرض، والشواهد القرآنية صريحة بهذا المعنى، منها قوله تعالى: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ﴾ [هود: 16]، فالفعل (ليس)، والأداة (إلّا) أفادَا الحصر، وليس لهما وظيفة أخرى غير هذا المعني. كما أن الفعل (ليس) قد انْتَقَضَ معناه، وهو النفي، وتضمّن مع (إلّا) دلالة أخرى، وهي حصر اسم (ليس).
ومنه قوله تعالى: ﴿وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ﴾ [البقرة: 267]، فالآية تتضمن معنى الحصر، أي: الأخذ لا يتمّ إلا بإغماضِكم أعينَكم. وهذا التفسير يقترب مما أورده الفرّاء في الآية نفسها إلا أنه أعطاها معنى الشرط. وتفسيره لها هو: (إن أغمضتم بعض الإغماض أخذتموه)[72]. وما نلمسه من النصّ هو أنه جرد الجملة من الفعل (ليس)، والمعنى الذي ذكرناه أقرب لخلوّه من الشرط؛ لأنّ (إِنْ) الشرطية ربما يتحقّق ما بعدها، أو لا يتحقّق. أمّا معنى الحصر، فهو واقع، ولا يتمّ المعنى إلا بهذه الحالة التي خصّها القرآن.
(يأبَى): استُخدم هذا الفعل في القرآن في أسلوبين؛ أحدهما في جملة خلَت من أسلوب الحصر، والآخر أفاد الحصر مع أداة الحصر؛ ومن الأول قوله تعالى: ﴿فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ﴾ [البقرة: 34]، فالفعل (أبَى) على معناه، وهو الإباء والامتناع.
وهذا المعنى في الفعل قد ينتقض إذا ما دخلت أداة الحصر على معموله، وهذا هو الأسلوب الثاني، منه قوله تعالى: ﴿وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ﴾ [التوبة: 32]، فالفعل (يأبَى) على الرغم من أنه قد استوفى فاعله ومفعوله فإنه من حيث دلالته قد انتقض معناه بدخول أداة الحصر (إلّا)، فاللهُ متمّ نوره ولو كره الكافرون، وما أفاده الفعل (يأبَى) مع الأداة (إلّا) هو المعنى الذي أفادته (ما) مع (إلّا)، وهو الحصر.
ونقض معنى النفي منه لا يتعارض مع بقاء عمله، كما هو الحال في الفعل (ليس) إذا ما انتقض نفيه بأداة الحصر، وعلى هذا التفسير فإنّ الفعل (يأبَى) زِيد لمعنى.
وهناك نكتة يجدر الإشارة إليها، وهي أنّ الفعل (يأبَى) لا يمكن تجريده وأداة الحصر من النصّ الذي تضمّنه، فإذا ما صحّ ذلك في الفعل (ليس) وأداةَ الحصر، أو (ما) وأداةَ الحصر، فإنه لا يصح في هذا الفعل لتعلق الفاعل والمفعول به؛ فهو الزائد الذي لا يمكن حذفه، ويمكن أن يتمّ إلى ما أُطلق عليه بالشبيه بالزائد، وإني لأَفهم من كلام الأخفش أنه قد أعطى هذا الفعل هذا المعنى من دون أن يصرِّح بالزيادة، حيث قال: (كأنه: يأبَى الله إلا إتمامَ نوره)[73]. ولو قدّرنا المصدر المؤول باسم الفاعل، لجاز في غير الآية أن نقول: الله متم نوره، وفيه لم يذكر الفعل (يأبَى)، وإذا أردنا حصر الخبر، نقول: ما الله إلا متمّ نوره، أمّا المصدر المؤول في الآية، فإنه متعلق بالفعل.
وليس هذا التفسير الذي قدّمناه في الفعل (يأبَى) محصورًا فيه، إِذْ هناك لفظتان تفيدان معنى (ما) النافية؛ إحداهما فعل، وهو (قَلَّ) والأخرى اسم، وهو (أَقَلَّ)، وذلك مشروط بدخول أداة الحصر (إلّا). ومن الأول قولهم: قَلَّ رَجلٌ يقولُ ذاك إلّا زيدٌ، ومن الثاني قولهم: أَقَلَّ رجُلٌ يقول ذاك إلّا زيدٌ، وهما على معنى: ما رجل يقول ذاك إلا زيد. وممن صرح بهذا المعنى سيبويه والمبرد[74]. وضَمّ إليهما أبو علي الفارسي (قلَّما)[75].
إنّ ما تقدم في زيادة الفعلين (يأبَى) و(ليس) لم يقل به نحويّ، وإنما وقفنا عليه من خلال أساليب تقدَّم ذكرها. وهذا لا يعني أن بعض النحاة لم يقولوا بزيادة بعض الأفعال، فهناك من قال بهذا ولم يصرح بمعناه. وهذا القول إنْ كان له وجود فيكاد يكون محصورًا في الفعل (كان) وهو موضع خلاف بين النحاة فيما ذكر من شواهد قرآنية. كما أن هناك آيتين ذكر فيهما الدكتور إبراهيم رفيدة زيادة الفعل، ونسبه إلى الفراء، وسنقف عليهما بعد الوقوف على ما جاء في زيادة (كان).
ومما قيل فيه (كان) زائدة قوله تعالى: ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا﴾ [هود: 15]، فقد ذهب الفرّاء إلى زيادة (كان) ولم يصرح بما يفيده من معنى[76]. وخالفه الأخفش وغيره، فقد ذهب إلى أن (كان) في موضع جزم[77].
ولو أعدنا النظر في الآية لوجدنا أن الفراء قد أجاز زيادة (كان) في الجملة الشرطية، وجعل الفعل (يريد) فعل الشرط من دون أن يتأثر بأداة الشرط الجازمة (مَن) علمًا بأن الزيادة لو حصلت لتأثّر الفعل (يريد)، كما هو الحال في قول الفرزدق:
فكيفَ إذا مررت بدار قومٍ ** وجيرانٍ لنا كانوا كرامِ
فـ(كرامِ) تابع لـ(جيرانٍ)، ولم يتأثر إعرابه بزيادة (كانوا).
ومن هذا أيضًا ما نُسب إلى أبي عبيدة في قوله تعالى: ﴿قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا﴾ [مريم: 29][78]. ولم يُقبل هذا القول من بعض المفسِّرين والنحاة، فقد ذكر القرطبي ردّ أبي بكر بن الأنباري على أبي عبيدة بكيفية إمكان أن يكون (كان) زائدًا، وقد انتصب به (صبيًّا)[79]، ولم أقف على ما نُسب لأبي عبيدة في هذه الآية غير أنه قال به في موضع آخر[80]، ويردّ عليه بالاحتجاج نفسه الذي اعتمده أبو بكر بن الأنباري.
وردُّ أبي بكر بن الأنباري هذا يُقال فيمن رجح زيادة (كان) في قوله تعالى: ﴿إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا﴾ [مريم: 44]، وكذا في قوله تعالى: ﴿وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا﴾ [الجن: 4]، فقد ذكر القرطبي الزيادة فيهما، ولم ينسبه لأحد، كما أنه لم يصرح بما تفيده هذه الزيادة من معنى[81].
وممن قال بزيادة الفعل (كان) النحاس، إِذْ أجاز في قوله تعالى: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ﴾ [آل عمران: 110]، أن يكون (كان) زائدًا، علمًا بأنه يعمل لفظًا[82]، ويُرَدُّ قولُ النحاس بقول ابن جنّي بأنه منع زيادة (كان) في أول الكلام[83].
والقول فيمن ذهب إلى زيادة (كان) ممن لم يصرّح بما تفيده من معنى إنه يستبعد تحقّق هذا في القرآن الكريم؛ لأن ما جاء به الذين ذهبوا إلى هذا النمط من الزيادة، جاز لـ(كان) فيها أن تعمل لفظًا ومعنى، يضاف إلى ذلك، أن بعض المواضع كان تأثيرها الإعرابي واضحًا على خبرها، غير أن بعضها الآخر تعذر ظهور الحركة الإعرابية على خبرها؛ لأنه جملة، أضف إلى ما تقدّم أن لـ(كان) من الدلالة ما يمكنها من أن تتفق والنصوص التي تضمنتها من حيث المعنى. وعليه فليس هناك ما يدعو إلى القول بالزائد، ولو استعرضنا الآيات التي تقدّمتْ لوجدنا أن لـ(كان) أثرًا على الإعراب والمعنى.
ولنأخذ قول الفرّاء الذي أجاز فيه زيادة (كان) في الجملة الشرطية، وجعل الفعل (يريد) فعل الشرط من دون أن يتأثر هذا الفعل بأداة الشرط الجازمة (مَن). وهو مردود؛ لأنه لو تحقّقت هذه الزيادة لتأثر الفعل (يريد). كالذي في قول الشاعر:
فكيفَ إذا مررت بدار قومٍ ** وجيرانٍ لنا كانوا كرامِ
فـ(كرامِ) تابع لـ(جيرانٍ)، ولم يتأثّر بزيادة (كان)[84].
وربما يكون الدافع الذي دفع النحاة إلى القول بزيادة (كان) هو أنهم وجدوا أن المعنى يتمّ من دونها، وزيادتها لا تؤثّر على المعنى. وهذا لا يؤخذ به؛ لأنهم في علمهم أن لـ(كان) قدرة التوافق مع النصّ من حيث المعنى والزمن، والشواهد القرآنية خير مثل على ذلك، كمجيء (كان) بمعنى (صار)، أو دلالتها على استمرارية خبرها من حيث الزمن وإن دلّت على الماضي.
وأهمّ ما يمكن أن يُقال في (كان) وأخواتها أنها تختلف عن غيرها من الأفعال بأن معانيها تتمّ بأخبارها، و(كان) أخصّ من أخواتها بأنها لا تعطي معنى بنفسها؛ ولذا فإنها إذا ما جاءت تامة فإن معناها يختلف عما لو كانت ناقصة.
أمّا أخواتها فإنهن يعطين المعنى الزماني، ويتم هذا المعنى بأخبارهن، وإن جئنَ تامات لا تختلف معانيهن كثيرًا عما لو كنّ ناقصات، وهذا موضوع يحتاج إلى دراسة موسّعة، ليس هذا البحث مجالًا لها. والذي نريد أن نقوله من هذا كله هو أن الاستغناء عن (كان) باعتبارها زائدة، معناه الاستغناء عن منصوبها أيضًا للترابط بينهما، وهذا لا يمكن أن يُقال فيما تقدّم، وبخاصة أنها قد عملت فيما بعدها على أنهن أخبارٌ لها.
ومما قيل بزيادته من الأفعال، ولم يصرح بمعناه؛ ما أوقفنا عليه الدكتور إبراهيم رفيدة، فقد ذكر آيتين ذهب فيهما الفراء إلى زيادة الفعل، ولم يحاول الدكتور إبراهيم الكشف عمّا لهذين الفعلين من أثر على النصّ؛ إِذْ إنه اكتفى بسرد ما جاء به الفرّاء، وربما كان ذلك منه لتوخّيه منهجًا يغنيه عن الاستطراد، والآيتان هما:
الآية الأولى: قوله تعالى: ﴿قَالَ مُوسَى أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَكُمْ أَسِحْرٌ هَذَا﴾ [يونس: 77]، فمما قال فيها الفرّاء: «ويكون على أن تجعل القول بمنزلة الصِّلَة؛ لأنه فضل في الكلام، ألا ترى أنك تقول للرجل: أتقول عندك مال؟ فيكفيك أن تقول: ألك مال؟ فالمعنى قائم، ظهر القول، أو لم يظهر»[85].
ولإيضاح هذا أقول: إننا لو عُدْنا إلى النصّ المتقدِّم، لا يمكننا أن نحكم بزيادة هذا الفعل عند الفرّاء في مثل هذا المورد، وهو الاستفهام، وإن صرّح الفرّاء بأن الفعل أنزل منزلة الصِّلَة، وأنه فضل في الكلام، فقد أراد بهذا كله أن يقرّب مسألة دخول همزتي الاستفهام في الآية الكريمة: ﴿أَتَقُولُونَ... أَسِحْرٌ هَذَا﴾، وقد استُغني عن ذكر الفعل في ﴿أَسِحْرٌ هَذَا﴾ لوضوح أنه مقول القول، وهكذا في كلّ موطن كانت الجملة فيه مقول القول، فلنا أن نذكر الفعل أو لا نذكره، وخاصّة إذا كانت تلك الجملة محكية عن قائل، فذكره لا يعني أنه زائد، وإنما يمكن أن يُستغنى عنه ويدلّ عليه المعنى.
الآية الثانية: قوله تعالى: ﴿يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ * ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً﴾ [الفجر: 27- 28]، قال الفرّاء: «وأنت تقول للرجل: فمن أنت؟ فيقول: مضري، فتقول: كن تميميًّا أو قيسيًّا، أي: أنت من أحد هذين، فيكون (كن) صلة، كذلك الرجوع يكون صلة؛ لأنه قد صار إلى القيامة، فكأنّ الأمر بمعنى الخبر، كأنه قال: يا أيتها النفس أنت راضية مرضية»[86].
لقد فسّر الدكتور إبراهيم قول الفرّاء هذا بأنه يذهب إلى زيادة الفعل والفاعل في ﴿ارْجِعِي﴾، وإني أخالفه الرأي؛ لأمرين: أحدهما أنه ليس في كلّ موطن اصطلح فيه الفرّاء مصطلح (صلة)، أراد به الزائد، فقد أطلقه على النعت وغيره، كما هو في قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَا بَعُوضَةً﴾ [البقرة: 26]، فقد أجاز أن تعرب (ما) نكرة و(بعوضة) نعتًا لـ(ما)، قال: «وتجعل (ما) اسمًا، و(بعوضة) صِلَة، فتعربها بتعريب (ما)، وذلك جائز في (مَن)، و(ما)؛ لأنهما يكونان معرفة في حال ونكرة في حال...»[87].
وكذا القول في هذه الآية ﴿يَا أَيَّتُهَا...﴾ فإنه أراد أن يقرّب معنى الجملة الطلبية بما تفيده الجملة الخبرية، دليلنا في ذلك قوله: (فكأنّ الأمر بمعنى الخبر).
والأمر الآخر: هو أنَّ ﴿رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً﴾ متعلّقان بالفعل ﴿ارْجِعِي﴾، ولو كان الفعل والفاعل زائدين لكانت الزيادة حاصلة فيما تعلّق بالفعل أيضًا، وهذا لم يصرح به الفرّاء، وإنما فسّر الجملة الطلبية بقوله: (أنت راضية مرضية) أي: أفادت الإخبار، وليس هناك زيادة في الآية.
مبحث الزيادة في الأسماء:
الزيادة في الأسماء موضع خلاف بين النحاة، وقد ذكر ابن هشام جواز زيادتها عند الكوفيين، وما أورده كان محصورًا في بعض الشواهد الشِّعْرية، وحقيقة ذلك هو أن الكسائي أجاز زيادة (مَن) في بعض الأبيات الشِّعْرية، وردّ عليه الفرّاء برواية أخرى، وأجاز النحاس ذلك في الأسماء والظروف[88].
وما وقفنا عليه مما قيل فيه: إنه زائد منه ما صرح بمعناه، ومنه ما لم يصرح بمعناه، وسنقف على الضرب الأول، ومن ثم نعرض إلى الثاني للوقوف على ما يفيده من معنى.
فإنه على الرغم من أن أغلب النحويين منعوا الزيادة في الأسماء إلا أنهم اتفقوا على مجيء الضمائر في مواطن تكون لا محلّ لها من الإعراب، منها ضمير الفصل الذي يتوسّط معرفتين، أو ما أصلهما معرفتان، فقد أجمع النحاة على إنه لا محل له من الإعراب[89]، سوى ما نسب إلى الكوفيين والفرّاء بأنهم أعربوه[90]، وقد استعظم الخليل أن يكون (هو) زائدًا بين المعرفتين[91].
فضمير الفصل زائد، يؤتى به لمعنى، وأنه جاز أن يعرب على ألّا يوصف بأنه ضمير فصل، ومن الشواهد القرآنية قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ [غافر: 20]، ومنه قوله تعالى: ﴿أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾ [البقرة: 27].
وذِكْر هذا الزائد أرجح من حذفه، وقد حذف على قراءة نافع وأبي عامر لقوله تعالى: ﴿فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ﴾ [الحديد: 24]، إِذْ قرأها بحذف الضمير[92].
ومن الزائد في الأسماء التي يؤتى بها لغرض التوكيد -الضمير المنفصل- وهو من حيث إعرابه على نوعين؛ أحدهما يعرب بإعراب المؤكد، وذلك إذا أفاد توكيد ضمير متصل، منه قوله تعالى: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ [الحجر: 9]، فالضمير (نحن) له وجهان من الإعراب؛ أحدهما أنه في موضع نصب، ومؤكد للضمير المتصل في (إنَّا)، والآخر أنه مرفوع على الابتداء، وما بعده خبر له[93]. ومنه أيضًا قوله تعالى: ﴿إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مَالًا وَوَلَدًا﴾ [الكهف: 39]، فـ(أَنَا) توكيد لياء المتكلّم[94].
أمّا النوع الآخر من الضمير الزائد، وهو الذي ليس له محلّ من الإعراب، فهو مقصور على العطف على الضمير المستتر في حالة الرفع لتوكيده، منه قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ﴾ [البقرة: 249]، فالضمير (هو) لا محلّ له من الإعراب يفيد توكيد الضمير المستتر، ومنه قوله تعالى: ﴿اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ﴾ [البقرة: 35][95]، فالضمير (أنت) كالذي تقدّم زائد يفيد التوكيد. وعلى هذا نقول: إن زيادة الضمير تفيد التوكيد، سواء أكان معربًا أم غير معرب.
وننتقل إلى نمط آخر من زيادة الأسماء، وهو زيادة (من) الاستفهامية. فهي تفيد مع الأداة (إلّا) الحصر، منه قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ﴾ [آل عمران: 135]، ومنه قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ﴾ [الحجر: 56]، فغرض (مَن) فيما تقدّم لا يختلف عن (ما) النافية التي تفيد الحصر مع أداة الحصر (إلّا) غير أن (مَن) هنا اسم، وليس للأسماء أن تفيد النفي إذا كانت معارف؛ ولذا فتُفَسَّر (مَن) تفسير (ما) التي انتقض نفيها بـ(إلّا).
ويؤكّد ما ذهبنا إليه من أن (مَن) بمنزلة (ما) نفسها، وليست بمعناها فقط، هو مسألة إعرابها؛ إِذْ لا يصحّ أن تعرب (مَن) مبتدأ، خبرها جملة: ﴿يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ﴾؛ لأنّ جملة: (يغفر...) مثبتة، فلا يصح بها هذا الإعراب، وجاز فيها إذا كانت غير مثبتة، وعلّة ذلك هو أنّ لفظ الجلالة مرفوع على الفاعلية، أو البدلية، وهذا يدعو أن تكون جملة: (يغفر...) مسبوقة بالنفي، أو شبهه، ومن هنا أنزلنا (مَن) منزلة (ما)، وإذا كانت كذلك امتنع أن يُطلق عليها اسم؛ لأنه إذا كان كذلك صارت معرفة، وليس لاسم المعرفة أن يفيد النفي إذا كان كذلك.
ويؤكّد قولي هذا تصريح بعض النحاة بهذا المعنى لـ(مَن) غير أنه لم يوضح إعراب (مَن)، منهم الفرّاء؛ إِذْ أشار له في قوله: (ما يغفر الذنوب أحد إلا الله)[96]، وقدّرها النحاس: (ليس أحد...)[97]، على أن لفظ الجلالة بدل من (أحد).
ومن الأسماء الزائدة لمعنى: (غير)، فإنها تزاد إذا كانت بمعنى (إلّا) في الحصر أيضًا، وتعرب بإعراب الاسم الواقع بعد (إلّا)، منه قوله تعالى: ﴿هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ﴾ [فاطر: 3]، فهي بحكم (إلّا) في زيادتها في أسلوب الحصر، وهذا لا غبار عليه، فقد نصّ النحاة على معناها هذا، سواء أكان في الاستثناء، أم في الحصر[98].
أمّا الزائد الذي لم يصرح بمعناه فسنحاول الوقوف على ما يفيده من معنى، ومنه ما نسب إلى الأخفش في قوله تعالى: ﴿فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ﴾ [الأنفال: 12]، ذكر ذلك عنه النحاس، وأورد رَدَّ المبرد عليه بأنّ الأسماء والظروف لا تزاد[99]، ونُذكِّر بأنّ النحاس نفسه أجاز الزيادة في الأسماء والظروف إذا كانت تفيد معنی[100].
ونسب القرطبي الزيادة في الآية إلى بعض المفسِّرين، وهما: الضحاك وعطية[101]، ونعود إلى ما نسب إلى الأخفش فإننا لو عدنا إلى كتابه: (معاني القرآن)، لوجدنا أنه أعطى الظرف (فوق) في الآية معنى يفيد التوكيد، جاء ذلك من خلال تفسيره لها ببعض الأساليب النحوية حيث قال: «معناه: اضربوا الأعناق، كما تقول: رأيت نفس زيد، تريد زيدًا»[102]، واضح من النصّ أن نفس زيد هو زيد، وإنما جاء بـ(نفس) يريد بها التأكيد على أن المرئي هو زيد، لا غيره، وكلّنا يعلم أنّ حقّ التوكيد المعنوي أن يتأخّر، والمؤكّد يتقدّم. وجاز في مواضع تقدّمه، دليلنا في ذلك قوله تعالى: ﴿كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلًّا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِه﴾ [آل عمران: 93]، والأخفش جعل (فوق) بمنزلة (نفس)، فهي تفيد معنى، والآية تأمر ضرب الأعناق، و(فوق) جيء بها للتأكيد على مكان الضرب، وقد يكون (فوق) بمعنى (على)، أي: على الأعناق.
وفي زيادة (فوق) أيضًا ما نسبه النحاس إلى مَن لم يُسَمِّهم في قوله تعالى: ﴿فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ﴾ [النساء: 11]، بأنّ (فوق) زائدة، وردَّ هو عليهم بأنّ الزيادة في الظروف يؤتى بها لمعنى[103]. وقد يكون معنى الآية: اثنتين فما فوق. والدليل على ذلك ما بعدها، وهو قوله تعالى: ﴿فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ﴾؛ إذ الضمير (هُنّ) في ﴿فَلَهُنَّ﴾ يعود على ﴿فَوْقَ اثْنَتَيْنِ﴾، كما أنَّ ﴿فَوْقَ اثْنَتَيْنِ﴾ خير للنساء؛ فأَوْلَى به أن يتضمن معنى الجمع، والحكم في الآية لاثنتين فأكثر، وقد يعود الضمير (هنّ) على النساء، والله أعلم.
ومما جاء في زيادة الظروف أيضًا ما ذهب إليه أبو عبيدة في قوله تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً﴾ [البقرة: 30]، من أن (إِذ) زائدة[104]، وأنكر عليه هذا القولَ الزجاجُ والنحاس[105].
ومن الزائد الذي لم يصرّح بمعناه في الأسماء ما ذهب إليه الأخفش في قوله تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ﴾ [المائدة: 4]، من أن (ذَا) في أحد قوليه زائدة[106]، وإلى مثل هذه ذهب الرضي في قوله تعالى: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ﴾ [البقرة: 255]، إِذْ جعل (ذَا) زائدة[107].
وذهب غيرهما من النحاة إلى أن (ذَا) من (ماذَا) اسم موصول، أو جعل (ماذَا) كلمة واحدة[108].
ومثل هذا الزائد ناقشناه في مجيء (مَن) زائدة في أسلوب الحصر في قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ﴾ [آل عمران: 135]، وأوضحنا أنها بمنزلة (ما). وعلى هذا فـ(ذَا) فيما تقدّم ليست بزائدة، وإنما الزيادة في (مَن)، وإذا ما جردناها وأداة الحصر في غير الآية لكان المعنى: (هذا الذي يشفع عنده بإذنه).
أمّا الردّ على مَن ذهب إلى زيادة (ذَا) في (ماذَا) فواضح مما ذهب إليه أكثر النحاة في جعلها غير زائدة، وكذا القول في (إِذ)؛ لأنها ظرف.
الخاتمة:
نحاول في هذه الخاتمة أن نلقي الضوء على ما يمكن أن نستخلصه من قضية الزائد في القرآن.
لقد ثبت مما تقدم أن موضوع الزائد هو الكلمة بأقسامها الثلاثة، علمًا بأنّ لكلّ منها مدلوله الخاصّ به، فقد عُرِّف الاسم بأنه الدالّ على معنى بنفسه، وكذلك الفعل، ويزيد عليه بأنه يقترن بالزمان، أمّا الحرف فهو ما دلّ على معنى بغيره. وهذا التقسيم يثير -من حيث المدلول- التساؤل الآتي، وهو: هل القول بزيادة الكلمة يعني تجريدها عن معناها، وتتضمّن معنى آخر، أم بقاءها على معناها، أم أنها أصبحت لفظًا مهملًا؟
والجواب يختلف باختلاف الزائد نفسه وغرضه؛ فمنه ما يؤكّد معناه بإضافته لما بعده الذي يحمل معناه، وهو يشبه في هذا إضافة الشيء إلى نفسه، كما هو الحال في إضافة (فوق) إلى (الأعناق). ومنه ما يفيد الفصل بين الخبر والنعت كما الحال هو في زيادة ضمير الفصل.
ومنه ما ينتقض معناه ويتضمّن معنى آخر بدخول أداة عليه كـ(مَن) الاستفهامية، و(غير) في الحصر. وكذا الحال في الفعل (ليس) و(يأبَى)، ومثل هذا في بعض الحروف كزيادة (ما) و(إِنْ) النافيتين.
ومنه ما يبقى على معناه، ويضفي على الجملة الخبرية معنى، وهو إخراجها من كونها خبرية تحتمل الصدق والكذب إلى كونها مؤكّدة بما تحمله من معنى كما هو الحال في زيادة (إِنَّ)، واللام على الجملة الاسمية.
أمّا الجواب عن الشقّ الثالث من السؤال، وهو احتمال أن يكون مهملًا فمرفوض؛ لأنه يدعو إلى تجريد الكلمة عن معناها. وهذا يناقض تعريف أيٍّ من التقسيمات الثلاثة للكلمة؛ لأنه -كما نعلم- ليس هناك من النحاة من يذهب إلى أن الكلمة تدلّ على معنى في موضع ولا تدلّ على معنى في موضع آخر، وإنما تواترت النصوص على تضمينها دلالة، وهي مفردة، سواء أكان ذلك بنفسها أم بغيرها؛ كالقول في (إِنَّ) تفيد التوكيد، و(ليس) ناسخ، و(على) حرف استعلاء، أم تضمينها معنى آخر كـ(مَن) الاستفهامية، أو (غير)، أو (يأبَى)، فليس لنا أن نجرّد هذه المفردات عن معانيها، وهي في تركيب جملة، كما أنَّ لكلٍّ من هذه الزوائد قوّته في المعنى، وليس لنا أن نستبدل أداة بأخرى تعمل عملها، وتتضمّن معناها.
[1] نُشرت هذه المقالة في مجلة (كلية الدعوة الإسلامية) بالجماهيرية الليبية، العدد التاسع، سنة 1412هـ = 1992م، ص356، (موقع تفسير).
[2] انظر: إعراب القرآن، للنحاس (1/ 116)، (1/ 25).
[3] انظر: مغني اللبيب، لابن هشام، ص38، 322، وانظر: معاني الأخفش، ص53، المقتضب، للمبرد (1/ 188)، شرح القصائد السبع، لأبي بكر الأنباري، ص459، تفسير القرطبي (2/ 54).
[4] انظر: معاني الفراء (1/ 21)، (1/ 409)، (3/ 14)، (3/ 207)، شرح القصائد السبع، ص353، تفسير القرطبي (4/ 248).
[5] انظر: الكتاب (2/ 76)، (2/ 152)، (4/ 221).
[6] انظر: الكتاب (2/ 210)، معاني الأخفش، ص295، شرح القصائد السبع، ص353، مغني اللبيب، ص32، 329.
[7] انظر: معاني الفراء (2/ 403)، (1/ 474).
[8] انظر: الكتاب (2/ 392)، المقتضب (4/ 103)، شرح المفصل، لابن يعيش (3/ 110)، شرح الكافية، للرضي (2/ 24).
[9] انظر: معاني الفراء (1/ 51)، إعراب القرآن، للنحاس (1/ 133)، تفسير القرطبي (1/ 181).
[10] جاز لـ(ما) أن تعمل عمل (ليس)، وهي لغة أهل الحجاز، وجاز إهمالها، وهي لغة بني تميم، وقد تتساوى اللغتان إذا ما دخلت على خبر المبتدأ (إلَّا)، انظر: الكتاب (1/ 57- 58)، المقتضب (4/ 188- 189)، معاني الفراء (2/ 43- 44). أمّا (إنْ) فهي: عند البصريين على ضربين؛ أحدهما مخففة من الثقيلة ملغاة، وقد تدخل اللام على خبر المبتدأ وتسمى باللام الفارقة، والثانية هي المشبهة بـ(ليس) وتلغى إذا ما دخل على خبر المبتدأ (إلّا). والكوفيون يذهبون في (إِنْ) هذه إلى أنها واحدة تفيد النفي وتلغى إذا دخل على خبر المبتدأ (إلّا)، أو اللام التي بمعنى (إلّا) عندهم في إفادة الحصر، انظر: الكتاب (2/ 139)، معاني الأخفش، ص270، معاني الفراء (2/ 395)، اللامات للزجاجي، ص119، مجمع البيان، للطبرسي (1/ 224)، شرح المفصل، لابن يعيش (3/ 129- 130)، الاستثناء في التراث النحوي والبلاغي، ص75- 81.
[11] معاني الأخفش، ص99، مغني اللبيب، ص428، شرح ابن عقيل (2/ 17).
[12] انظر ما جاء في (هل) بمعنى (ما): معاني الفراء (1/ 164)، (2/ 316)، المقتضب (4/ 410)، إعراب القرآن، للنحاس (2/ 684).
[13] انظر: معاني الفراء (2/ 100)، معاني الأخفش، ص200.
[14] انظر: الكتاب (3/ 130)، وانظر في ذلك أيضًا: المقتضب (2/ 360).
[15] مجيء (لمّا) بمعنى (إلّا) في الحصر موضع خلاف بين النحاة، وممن أجازها الفرّاء، وذكرها الأخفش عمّن لم يسمّهم. انظر: معاني الفراء (2/ 376)، معاني الأخفش، ص473، البيان في غريب إعراب القرآن، لابن الأنباري (2/ 30)، شرح المفصل، لابن يعيش (2/ 95)، مغني اللبيب، ص369.
[16] اللام بمعنى (إلّا) في الحصر قول الفراء، انظر: معانيه (2/ 395)، ونسبه الزجاجي إلى الكوفيين، انظر: اللامات، ص119، كما نُسب إلى الكسائي، والزجاج، انظر: مجمع البيان (1/ 224)، وانظر في هذا المعنى: البيان في غريب إعراب القرآن (1/ 126)، شرح المفصل، لابن يعيش (3/ 129).
[17] انظر: معاني الأخفش، ص114، مغني اللبيب، ص50- 51.
[18] انظر: الكتاب (3/ 53)، (4/ 222)، المقتضب (1/ 188)، (2/ 359)، وانظر ما جاء في زيادة (أن): معاني الأخفش، ص114 180، مغني اللبيب، ص50.
[19] انظر: مغني اللبيب 369.
[20] انظر: إعراب القرآن للنحاس (2/ 125)، مغني اللبيب، ص300.
[21] انظر: الكتاب (3/ 76)، (4/ 221)، المقتضب (1/ 186)، مغني اللبيب، ص394.
[22] انظر: مغني اللبيب، ص413.
[23] انظر: معاني الأخفش، ص250، وانظر أيضًا: إعراب القرآن للنحاس (2/ 290).
[24] وهي قراءة عاصم في رواية أبي بكر، إذ قرأها مخففة النون مشددة الميم. انظر: السبعة في القراءات، لابن مجاهد، ص339.
[25] انظر: معاني الأخفش، ص180، وانظر أيضًا: مغني اللبيب، ص51.
[26] انظر: المقتضب (2/ 354).
[27] انظر: إعراب القرآن، للنحاس (2/ 28- 29) فيما جاء من خلاف.
[28] انظر: معاني الأخفش، ص99، الإنصاف في مسائل الخلاف، ص376، تفسير القرطبي (15/ 287)، (3/ 336)، مغني اللبيب، ص428.
[29] انظر: الكتاب (4/ 225).
[30] انظر: مغني اللبيب، ص144، وانظر ما جاء في زيادة الباء: الكتاب (4/ 225).
[31] انظر: الكشاف، للزمخشري (2/ 17).
[32] انظر: معاني الفرّاء (2/ 299- 300)، وانظر ما قيل فيه إنه زائد: معاني الأخفش، ص505، إعراب القرآن، للنحاس (1/ 641)، مغني اللبيب (284- 289)، وهناك شواهد كثيرة في ذلك.
[33] معاني الأخفش، ص180.
[34] انظر: إعراب القرآن، للنحاس (1/ 277)، مغني اللبيب، ص51.
[35] انظر: معاني الفراء (1/ 163).
[36] ليس غريبًا زيادة (لا) إذا كانت مسبوقة بالفعل (منع) على أنها تفيد توكيد النفي، كما هو في قوله تعالى: ﴿مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ﴾ [الأعراف: 12]، بالنصب غير أن الزيادة في هذا الموطن تختلف عما تقدّم في قوله تعالى: ﴿وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ﴾؛ لأنه لم يُسبق بالنفي، وإنما جاءت مسبوقة بالاستفهام الإنكاري، ولسنا بحاجة إلى تقدير فعل من هذا المعنى.
[37] انظر: معاني القرآن وإعرابه، للزجاج (2/ 56)، إعراب القرآن، للنحاس (2/ 36)، تفسير القرطبي (8/ 231- 232).
[38] انظر: معاني الأخفش، ص495، المقتضب (1/ 186).
[39] انظر: إعراب القرآن، للنحاس (3/ 369).
[40] انظر: الكتاب (1/ 390)، (4/ 222).
[41] معاني الفراء (3/ 137)، وانظر: معاني القرآن وإعرابه، للزجاج (1/ 209).
[42] انظر: معاني الفراء (3/ 207).
[43] انظر: إعراب النحاس (3/ 552).
[44] انظر: مغني اللبيب، ص328- 329.
[45] انظر: معاني الفراء (1/ 207).
[46] انظر: تفسير القرطبي (19/ 329).
[47] انظر: إعراب القرآن، للنحاس (3/ 482).
[48] انظر: معاني الأخفش، ص505.
[49] انظر: معاني الفراء (3/ 173)، وإعراب القرآن، للنحاس (3/ 482).
[50] انظر: تفسير القرطبي (12/ 323).
[51] انظر: معاني (عن) مغني اللبيب، ص196- 200.
[52] انظر: إعراب القرآن، للنحاس (1/ 164)، تفسير القرطبي (7/ 293)، مغني اللبيب، ص284- 289.
[53] انظر: معاني الأخفش، ص184.
[54] انظر: مغني اللبيب، ص220.
[55] انظر: معاني الفراء (2/ 410)، وانظر أيضًا: إعراب القرآن، للنحاس (2/ 801).
[56] انظر: الإنصاف في مسائل الخلاف، المسألة (64)، مغني اللبيب، ص473- 474، ونسب ابن يعيش زيادتها إلى البغداديين. انظر: شرح المفصل (8/ 93)، وأعتقد أنه أراد بهم الكوفيين.
[57] انظر: معاني الأخفش، ص141، 457.
[58] انظر: معاني الفراء (3/ 249- 250).
[59] انظر: الإنصاف في مسائل الخلاف، ص456- 457.
[60] انظر: تفسير القرطبي (15/ 114).
[61] انظر: معاني الفراء (2/ 406).
[62] انظر: الإنصاف في مسائل الخلاف، المسألة (64).
[63] انظر: معاني الفراء (1/ 21).
[64] انظر: إعراب القرآن، للنحاس (1/ 374)، (3/ 369).
[65] انظر: معاني الأخفش، ص53.
[66] انظر: معاني الأخفش، ص11، وشرح ابن عقيل (1/ 179).
[67] انظر: تفسير القرطبي (7/ 33)، وانظر أيضًا: مغني اللبيب، ص75.
[68] انظر: السبعة في القراءات، لابن مجاهد، ص362.
[69] انظر: مشكل إعراب القرآن، لمكي بن أبي طالب (1/ 275).
[70] انظر: الإنصاف في مسائل الخلاف، ص523، شرح ابن عقيل (1/ 179).
[71] انظر: شرح ابن عقيل (1/ 179).
[72] انظر: معاني الفراء (1/ 178).
[73] انظر: معاني الأخفش، ص330، ونُذكِّر أن الزجّاج منع أن يفيد الفعل (يأبَى) معنى النفي. انظر: معانيه (2/ 249)، وذهب المرزوقي إلى أن الفعل (يأبَى) بمعنى لم يرضَ. انظر: ديوان شرح الحماسة، ص824، 1344.
[74] انظر: الكتاب (2/ 315)، المقتضب (4/ 404)، شرح الكافية، للرضي (1/ 231).
[75] انظر: شرح الكافية، للرضي (1/ 231).
[76] انظر: معاني الفراء (2/ 5- 6).
[77] معاني الأخفش، ص351، إعراب القرآن، للنحاس (2/ 82).
[78] انظر: إعراب القرآن، للنحاس (2/ 313).
[79] انظر: تفسير القرطبي (11/ 102).
[80] انظر: مجاز القرآن، لأبي عبيدة (2/ 7).
[81] انظر: تفسير القرطبي (11/ 111)، (5/ 151، 19/ 9).
[82] انظر: إعراب القرآن، للنحاس (1/ 357)، (2/ 313).
[83] انظر: الخصائص، لابن جني (1/ 290)، (1/ 316).
[84] انظر: الكتاب (2/ 53)، المقتضب (4/ 116- 117).
[85] معاني الفراء (1/ 474)، وانظر: النحو وكتب التفسير، للدكتور إبراهيم عبد الله رفيدة (1/ 247).
[86] معاني الفراء (3/ 263)، وانظر: النحو وكتب التفسير، للدكتور إبراهيم عبد الله رفيدة (1/ 247).
[87] معاني الفراء (1/ 20).
[88] انظر: معاني الفراء (1/ 12)، شرح القصائد السبع، ص353، مغني اللبيب، ص434، وانظر أيضًا: إعراب القرآن، للنحاس (1/ 669).
[89] انظر: الكتاب (2/ 392)، المقتضب (4/ 103)، معاني الأخفش، ص321، إعراب القرآن، للنحاس (1/ 133)، شرح المفصل، لابن يعيش (3/ 110)، شرح الكافية (2/ 204)، مغني اللبيب، ص641- 642.
[90] أحاول هنا أن أذكر أنّ بعض النحويين نسب إلى الكوفيين أنهم أجازوا أن يقع ضمير الفصل أول الكلام، وكان هذا لبسًا منهم؛ لأن الفرّاء أطلق على ضمير الشأن مصطلح (عماد)، وقد أوضحنا هذا مفصلًا في بحث تحت عنوان: (ضمير الفصل بين البصريين والكوفيين)، وقد نشر في مجلة التواصل اللساني، المجلد الثالث، العدد الثاني، سنة 1991.
[91] انظر: الكتاب (2/ 397).
[92] انظر: معاني الفراء (3/ 133)، السبعة في القراءات، لابن مجاهد، ص627، وتفسير القرطبي (17/ 260).
[93] انظر: إعراب القرآن، للنحاس (2/ 191)، تفسير القرطبي (6/ 10).
[94] انظر: الكتاب (2/ 239)، معاني الفراء (2/ 145).
[95] انظر: الكتاب (2/ 385)، إعراب القرآن، للنحاس (1/ 139).
[96] انظر: معاني الفراء (1/ 234).
[97] إعراب القرآن، للنحاس (1/ 365).
[98] انظر: ما جاء في (غير) بمعنى (إلّا): الكتاب (2/ 343)، معاني الفراء (2/ 366)، معاني القرآن وإعرابه، للزجاج (1/ 61)، شرح الكافية، للرضي (1/ 245)، الاستثناء في التراث النحوي والبلاغي، ص108- 110.
[99] انظر: إعراب القرآن، للنحاس (1/ 669)، وانظر أيضًا: تفسير القرطبي (5/ 63).
[100] انظر: إعراب القرآن، للنحاس (1/ 398)، وتفسير القرطبي (5/ 63).
[101] انظر: تفسير القرطبي (7/ 378).
[102] انظر: معاني الأخفش، ص319.
[103] انظر: إعراب القرآن، للنحاس (1/ 398)، تفسير القرطبي (5/ 63).
[104] انظر: مجاز القرآن، لأبي عبيدة (1/ 37)، تفسير القرطبي (1/ 262)، (1/ 291)، (4/ 65).
[105] انظر: معاني القرآن وإعرابه، للزجاج (1/ 75)، إعراب القرآن، للنحاس (1/ 156).
[106] انظر: معاني الأخفش، ص253.
[107] انظر: شرح الكافية، للرضي (2/ 58).
[108] انظر: البيان في غريب القرآن، لابن الأنباري (1/ 164)، التبيان في إعراب القرآن، للعكبري (1/ 193)، مغني اللبيب، ص432، وقيل في زيادة (ذا) في غير القرآن في (ماذا). انظر: شرح الكافية، للرضي (2/ 60).


