مفهوم المبالغة في المعاني القرآنية
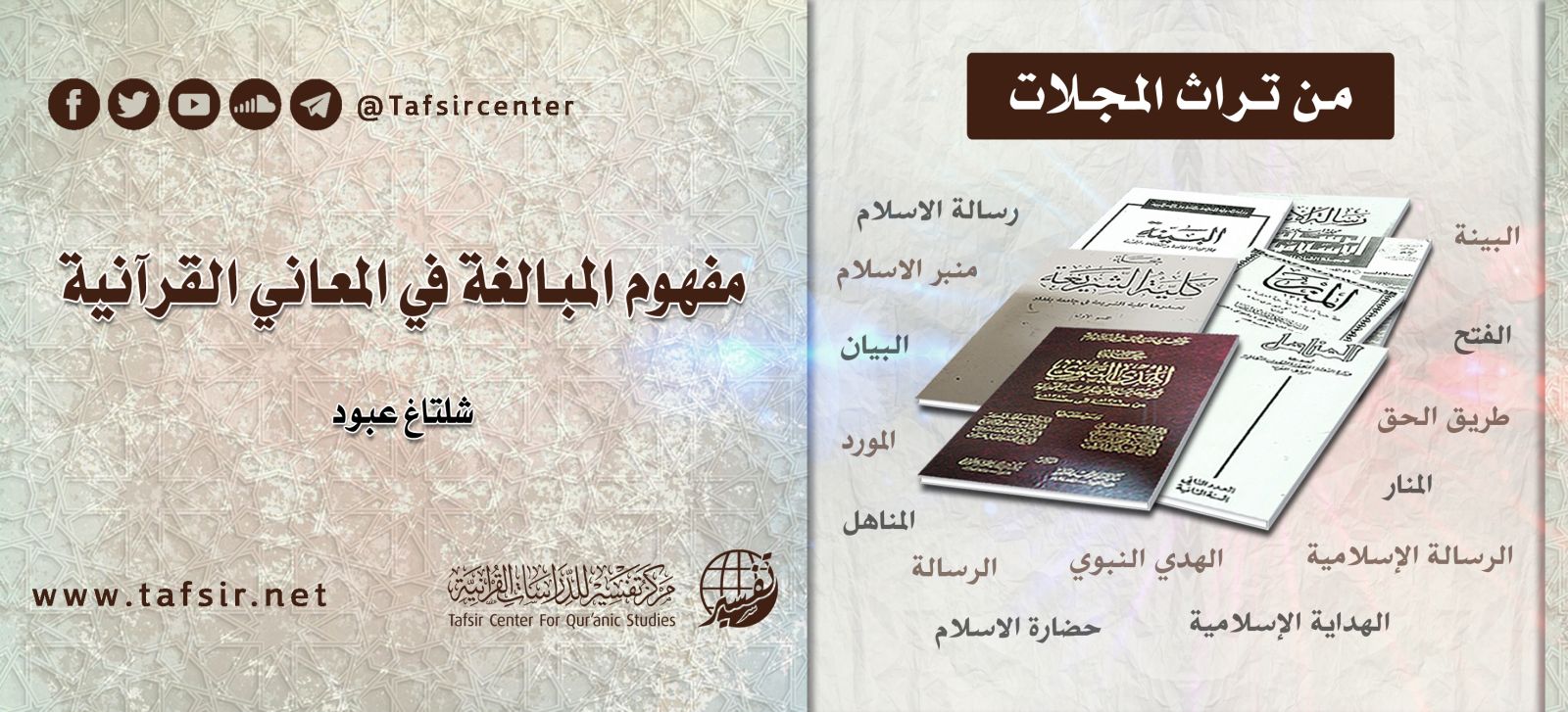
مفهوم المبالغة في المعاني القرآنية[1]
تُدرس المبالغة في الكتب البلاغية ضِمْن موضوعات البديع، وضِمْن المحسّنات المعنوية منه بشكلٍ خاصّ، والمتأمّل في النصوص التي تدرس من خلالها المبالغة يجد أنها تشتمل على الصور البيانية التي يتفاوت الشعراء في درجة واقعيّتها أو خياليّتها، وفي قُرْبِها من الحقيقة أو بُعْدِها منها، وفي صِدْقها أو كَذِبها. كما تشتمل تلك النصوص على موضوعات من عِلْم المعاني. وبما أنّ المبالغة ترتبط بالمعنى فهي غير خاضعة لجانب واحد من علوم البلاغة المعروفة (البيان، والمعاني، والبديع).
ولهذا فدراستها في إطار المحسّنات البديعية المعنوية تضييقٌ لمجالها، وإشعارٌ بأنها من نمط (المحسّنات). ومن المعلوم أنّ النظر إلى البديع قد شابَهُ شيءٌ من الازدراء في العصر الحديث خاصّة، لما كان فيه من تكلُّف وتنطُّع طبَع المرحلة السابقة لهذا العصر بطابعه.
وسوف نُخْرِج المبالغة بهذا البحث عن إطارها الضيق ذلك إلى مجالٍ هو أقرب إلى مجال الصورة الفنية، وإلى مجال المعنى الفني بشكلٍ عام.
تعريف المبالغة:
قال أبو هلال العسكري: «والمبالغة أن تبلغ بالمعنى أقصى غاياته وأبعد نهاياته، ولا تقتصر في العبارة عنه على أدنى منازِلِه، وأقرب مراتبه»[2]، وقال السكاكي في تعريفها: «أن يُدَّعى لوصفٍ بلوغه في الشدّة أو الضعف حدًّا مستحيلًا أو مستبعدًا لئلّا يُظنّ أنه غير متناهٍ»[3].
وهذا غير بعيد عن المعنى اللغوي للمبالغة، فهي أن تبلغ في الأمر جهدك، وتنتهي إلى غاياته[4].
وهذا مجال يتفاوت فيه الأدباء على ضوء رغبتهم في تثبيت معانيهم في نفوس السامعين. فهناك من المعاني التي لم تبلغ مبلغها من النفس، فتظلّ تتطلّع إلى مزيد وربما اعتبر هذا عنصر ضعف أو خَلل في المعنى الذي أراد الأديب إبلاغه. وهذه الفكرة تُذَكِّرُنا بأَضْرُب الخبر التي عُنِي بها علماء المعاني. على ضوء حالات المخاطب الذي يكون خاليَ الذهن من الحُكْم، أو مترددًا في الحكم شاكًّا فيه، أو منكرًا لحُكْم الخبر[5]. فتكون معرفتك بالحال التي عليها السامع وسيلة لقدرتك على إبلاغه ما تريد، بل غاية ما تريد أن تُحْدِث في نفسه من استجابة وتأثير. وباستطاعتك بناءً على معرفتك بنفسية المتلقِّي وحاله أن تضخِّم الصورة أو المعادل الرمزي للمعنى لكي تجعل المعنى نفسه أشدّ ولوجًا إلى النفس، وأكثر إثارة لكوامن النفس.
ولم تقف المبالغة عند هذا المعنى، بل قسمها علماء البلاغة إلى ثلاثة أقسام: التبليغ، والإغراق، والغلو. فإذا كان الوصف المدَّعَى ممكنًا عقلًا وعادةً فهو التبليغ، وإذا كان ممكنًا عقلًا لا عادةً فهو الإغراق، وإن كان ممتنعًا عقلًا وعادةً فهو الغلوّ[6].
وهذا يعكس درجات المبالغة من حيث قبولها واستنكارها. وقد أوردوا أمثلة شِعرية ونثرية لهذه الأنواع، ووقفوا عند المستساغ منها وعند الذي ينبو عن الذَّوْق.
فمن أمثلة التبليغ قول المتنبّي:
إذا صُلْتُ لم أَترُكْ مصالًا لصائِلِ ** وإن قُلْتُ لم أَترُكْ مقالًا لقائِلِ
وهو معنى بلغ به الشاعر غايته بحيث لم يدع مجالًا لمزيد. وعلى هذا أغلب الشِّعْر الجاهلي والإسلامي والأُموي، ولكن شعراء العصر العباسي أوغلوا في هذا الطريق من المبالغة حتى خرجوا به عن الحدّ المقبول، ومن هؤلاء الشعراء المتنبّي نفسه. ومن أمثلة الإغراق قول عمير التغلبي:
ونُكْرِمُ جارَنَا ما دامَ فِينا ** ونُتْبِعُهُ الكرامةَ حيثُ مَالا
وهو ما ينطبق عليه تعريف السكاكي السابق من حيث كونه ممكنًا عقلًا لا عادةً، فإكرام الجار مدّة إقامته أمر مستحسن ووارد في العقل والعادة، ولكِنْ جعلُ الكرم تابعًا له أينما حَلّ وأقامَ أمرٌ غير مقبول عادةً، وإن كان لا يمتنع عقلًا.
أمّا الغلوّ فهو السَّيْر بالمبالغة إلى أقصى غاياتها المستحيلة، وهو الممتنع عقلًا وعادةً. وقد سمّاه القاضي عبد العزيز الجرجاني بالإفراط والإحالة[7]، وقد تبارَى في ميادينها شعراء العصر العباسي، من أمثال أبي نواس وأبي تمام والمتنبي حتى خرجوا عن قِيَم الذَّوْق والعقل والدِّين؛ إرضاءً لنزعة الترف والتفنّن والزّلفى من الحكّام، ومن أمثلة قول أبي نواس في مدح الرشيد:
وأخَذْتَ أهلَ الشركِ حتى أنّه ** لَتَخافُكَ النُّطَفُ التي لم تُخْلَقِ
وقول ابن هانئ الأندلسي مخاطبًا المعزّ لدين الله:
ما شِئتَ لا ما شاءَتِ الأقدارُ ** فاحكُم فأنتَ الواحدُ القهارُ
وقول المتنبي في مدح سيف الدولة:
تجاوَزْتَ مِقدارَ الشجاعةِ والنُّهَى ** إلى قولِ قومٍ أنتَ بالغيبِ عالِـمُ
وقوله في الغزل:
يترشَّفْنَ من فَمِي رشفاتٍ ** هُنَّ فيه أغلَى من التوحيدِ
فأنت تلاحظ هذا الغلو الذي تكون معه الاستحالة والإفراط والخروج على الأحاسيس الدينية إلى الدرجة التي توهم بكُفْر قائله، وما هو بكافر. ولكن الجري وراء الهوى والخيال الشِّعْري الذي لا يقف عند حدّ يزيِّن للشعراء هذا المنحى الذي يثبتون به براعتهم وتفوّقهم على أقرانهم في حلبة المنافسة والصراع الدنيوي.
ومن الضروري هنا الإشارة إلى أنّ البلاغيين استحسنوا من الإغراق والغلوّ ما إذا دخل عليه أو اقترن به ما يقرّبه إلى الصحة والقبول بنحو: قد، ولو، ولولا، وكاد، وما أشبه ذلك من أدوات التقريب[8]. ومن أمثلة هذا الغلوّ المقبول قول الفرزدق في عليّ بن الحسن بن عليّ بن أبي طالب:
يكادُ يُمسِكُهُ عرفانَ راحَتِهِ ** ركنُ الحطيمِ إذا ما جَاءَ يَستَلِمُ
وقول البحتري في مدح المتوكِّل:
ولو أنّ مشتاقًا تكلَّف فوقَ ما ** في وُسْعِهِ لسَعَى إليكَ المِنْبَرُ
وبعد هذه الوقفات السريعة عند تعريفات المبالغة لدى البلاغيين وأقسامها وأنواعها وأمثلتها في الشِّعْر العربي، نحاول أن نتأنّى في وقفتنا عن مفهومها في القرآن الكريم، فهل هي نفسها كما وردت لدى الأدباء، أم أنّ لها طابعًا متميّزًا باعتبار أنّ كلام الله ليس كمثل كلام البشر. والحقّ أن المقاييس التي نتّبعها في هذا المجال لا ينبغي أن تكون هي المقاييس ذاتها التي نقيس بها كلام البشر، فالبَوْن شاسع والمصادر متباينة على الرغم من أنّ القرآن الكريم قد نزل بلغة البشر أنفسِهم، وبالأساليب التي درج عليها البيان العربي في جزيرة العرب قبل الإسلام، ولكن -مهما يكن- فللقرآن الكريم خصوصياته الربانية، ودلالاته ومعانيه التي لا تصدق معها المقارنة بالأدب الأرضي البشري. كما سنلاحظ.
صور المبالغة في القرآن الكريم:
اختلف العلماء في قبول وجود المبالغة في المعاني القرآنية، وقد أنكرَ بعضُهم أن تكون المبالغة من محاسن الكلام، ولكن الذي عليه أغلب العلماء أنها واردة في كتاب الله في مواضع متعدّدة[9]. والذي ينكرونه إنما هو الغلوّ فيها، «ولو بطلَت المبالغة كلّها وعِيبت؛ لبطل التشبيه وعِيبت الاستعارة، إلى كثير من محاسن الكلام»[10].
والحقّ أنه على الرغم من أنّ القرآن الكريم كتابُ تشريع ودستورُ هداية، إلا أنه كتابُ أدبٍ عالٍ، وأنه ينبغي أن يُفهم على ضوء المقاييس الأدبية مع الاحتراز من أن تكون هذه المقاييس هي مقاييس الأدب الأرضي، بل هي مقاييس خاصّة بكلام الله، وإِنْ تشابهَتْ من بعض الوجوه مع هذا الكلام البشري.
ولهذا رأى الزمخشري في مقدّمة الكشاف أنّ مَن أراد أن يتصدّى لفهم كتاب الله يجب أن يكون بارعًا في عِلْمَي البيان والمعاني، فهما العدّة التي لا تستقيم بدونها الدلالات واللطائف والإشارات، وأنه لا يكفي المفسِّر أن يكون عالمًا بالفقه والنحو وعلم الكلام والقصص والأخبار[11].
ونحن نستهدي بهذا الرأي، ونحاول أن نقف عند الصور الأدبية التي تنحو منحى المبالغة وإن كانت مبالغة من نوع خاصّ. ولنتأمّل معًا نماذج المبالغة في القرآن الكريم، قال تعالى: ﴿يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ﴾ [الحج: 2].
قال أبو هلال العسكري: «ولو قال: تذهَلُ كلُّ امرأة عن ولدها لكان بيانًا حسنًا وبلاغةً كاملةً، وإنما خصّ المرضعة للمبالغة، لأنّ المرضعةَ أشفَقُ على ولدها لمعرفتها بحاجته إليها، وأشغَفُ به لقُربه منها ولُزومه لها، لا يفارقها ليلًا ولا نهارًا، وعلى حسب القُرب تكون المحبة والإلف»[12].
والمبالغة تحسن من خلال صيغة (المرضعة) بالتأنيث، مع أنه يُقال للمرأة (مُرضِع).
قال الرازي: «فإن قيل: لِـمَ قال: مرضعة دون مُرضِع؟ قلت: المرضعة هي التي في حال الإرضاع، وهي ملقمةٌ ثَدْيَها الصبيَّ، والمرضِع شأنها أن ترضع، وإن لم تباشِر الإرضاع في حال وَصْفِهَا به. فقيل: (مرضعة)؛ ليدلّ على أنّ ذلك الهول إذا فُوجئت به هذه وقد ألقَمَت الرضيعَ ثَدْيَها نزعته من فِيه لِمَا يلحقها من الدهشة»[13].
هذه وقفاتٌ ذكية من لدن العلماء في فهم أسرار الأسلوب القرآني، ومنها المبالغة في التعبير عن المعنى، فهي مبالغة توصل المشهد إلى الذِّهْن وتجعل الحدثَ ماثلًا أمام عينيك، فهولُ يوم القيامة لا يُذهِل الأمّ عن الولد عمومًا بل عن الرضيع، وليس الرضيع عمومًا، بل الرضيع الذي ينكبّ على ثديها.
فالمبالغة -كما ترى- واقعية تصوّر حالة واقعة، وهي حالة قد لا تشبه حالة نشهدها في حياتنا الدنيا فإنه من الصعب أن تتخلّى المرضعة عن رضيعها في حوادثِ الدنيا المشهودة، ولكنها حوادث يوم القيامة التي لا تشبه شيئًا مما نرى هنا، ونسمع هنا.
إذًا، فهي مبالغة بالقياس إلى الأحداث المشهودة في حياتنا ومألوفاتنا وأحاسيسنا في هذه الحياة. ولو قال أديب إنّ امرأة ذهلتْ عن رضيعها في حادثة ما من الحوادث الدنيوية، لقلنا إنّ في كلامه مبالغة؛ لأنه ليس من المألوف عادةً أن تتخلَّى المرضعة عن رضيعها مهما كانت المصيبة والصدمة. فالكلام هنا باصطلاح البلاغيين ممكن عقلًا، وغير ممكن عادةً وهذا ما يسمونه بـ(الإغراق). بينما الموضع في مشاهد يوم القيامة يصحّ أن يُقال إنه ممكن (عادةً) و(عقلًا)، فالمقاييس اضطربت؛ فلا العادة هي العادة، ولا العقل هو العقل!
المبالغة بالمفهوم القرآني ذات طابع ديني، والأمور من خلالها تجري وفق المنطق الديني، فما يصدر من ربّ الكون وباري النفوس، الخالق الجبار المتكبِّر، شيء؛ وما يصدر من هذا الإنسان شيء آخر. فكيف يحقّ لنا أن نساوي بين المصدرين والقدرتين؟!
فحين نسمع إنسانًا يقول إنه يعلم جهرنا وسرّنا، وما نُخفِي وما نُعْلِن في ضوء النهار وظلام الليل، نقول عن كلامه هذا إنه مبالغة وإفراط واستحالة وغلوّ، بل وكفر! أمّا حين يقول الله سبحانه: ﴿سَوَاءٌ مِنْكُمْ مَنْ أَسَرَّ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَّيْلِ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ﴾ [الرعد: 10]، فإنه وإن كان على صورة المبالغة ولكن «هي بالنسبة إلى المخاطَب (بفتح الطاء) لا إلى المخاطِب (بكسر الطاء)، معناه أن عِلْم ذلك متعذِّر عندكم، وإلا فهو بالنسبة إليه سبحانه ليس بمبالغة»[14]. فما هو مبالغة هناك، ليس مبالغة هنا بالمعنى الديني، بل المبالغة تكمن في القدرة البشرية المحدودة التي يصعب عليها تصوّر هذا العلم الرباني البالغ.
ومن صور المبالغة التي وقف عندها علماء البلاغة والمفسِّرون قوله تعالى: ﴿قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا﴾ [الكهف: 109]، وقوله: ﴿وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ﴾ [لقمان: 27].
قالوا: «والمراد بـ﴿قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ﴾ أنّ كلماته تعالى لا تنفد إطلاقًا... والمعنى: لو فُرض أنّ البحار بكاملها حِبْر يُكتب به کلمات الله، لانتهى الحِبْرُ وبقيت كلماته إلى ما لا نهاية»[15]. وقالوا: «وليس المراد بكلمات الله هنا الألفاظ المؤلَّفة من الحروف الهجائية، ولا الأمر الفعلي الذي عبارة عن قوله: كُنْ فَيَكُونُ، إنما المراد بكلماته هنا القدرة على إيجاد الكائنات متي شاء... وهذه القدرة لا آخر لها ولا نهاية. أمّا البحار والأشجار، ومثلها معها فهي متناهية، وكلّ متناهٍ إلى نفاد»[16].
وظاهر الأمر أن لا مبالغة هنا؛ لأنّ كلمات الله لا تنفد وقدرته لا نهاية لها، في حين أن البحار والشجر إلى نهاية ونفاد. ولكننا إزاء صورة أدبية في كتاب الهداية الربانية. إنّ الأمر هنا يتعلّق بتقريب الفكرة إلى أفهام البشر وإدراكهم، فالبحر الذي يمدّه سبعة أبحر غاية ما يتصوّره الإنسان لو كان حِبرًا تُكتب به (كلمات)، والشجر المنتشر في بقاع الأرض كافة لو صُنعت منه الأقلام، لَمَا كان بعده غاية في الكثرة.
إنها مبالغة بحدود إدراك البشر وتصوّره لِمَا يحيط به من محسوسات، ولكنها وفقًا للقدرة الإلهية ومقدار عِلْم الله ليست مبالغة. وما دام هذا الكلام الإلهي موجهًا للبشر فباستطاعته أن يقيسه على ما عهده من كلامه، وفي البيئة التي نزل فيها هذا القرآن.
ومن الجدير بالملاحظة أنّ العدد (سبعة) في لغة العرب وأساليبهم في العصر الجاهلي كان يدلّ على الكثرة، ولا يعني الحصر بالعدد ذاته في الغالب، ومثله العدد سبعون. ومن هذا نستطيع أن نفهم عبارة: ﴿سَبْعَةُ أَبْحُرٍ﴾، فقد تعني أكثر من سبعة للدلالة على الكثرة الكاثرة.
وباستطاعتنا أن نتذكّر قوله تعالى: ﴿إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ﴾ [التوبة: 80]، فليس العدد هو المطلوب، بل الدلالة على الكثرة غير المحدودة. وهذه صورة من صور المبالغة أيضًا. ثم إن المسألة تتخذ طابع الفرض كما قال الشيخ مغنية، بمعنى أننا لو فرضنا أن البحار تكون مدادًا، والأشجار أقلامًا لما كانت قادرة على إملاء أوامر الله وعِلْمه وقدرته. كما أننا لو فرضنا أنك استغفرت سبعين مرة فلن يكون ذلك سبيلًا لمغفرة الله لأولئك الكفار والمنافقين.
وهذا الفرض هو الذي يجعل المبالغة القرآنية في غاية الحُسن كما يعبّر القدماء، وهي التي تجعل السامع أو القارئ يتجاوب مع الدلالة دون شكّ في أنها حقيقة واقعة، وأنها أبعد ما تكون عن التضخيم الذي ليس وراءه طائل، وأبعد ما تكون من الرغبة في إظهار الذات وحُبّ التفوق على الأقران، كما نشهده في الأدب الإنساني أو الأرضي، وما ينبغي لنا أن نأتي هنا بنماذج بشرية من المبالغة الممجوجة؛ لأنّ هذا يكون مقارنة مع الفارق؛ إِذْ كيف لنا أن نقارن بين كلام البشر وكلام خالق البشر؟! وقديمًا كان علماء اللغة والبلاغة يستعينون بالشِّعْر العربي لفهم مفردات القرآن الغريبة وصُوَرِه غير المألوفة، ولم يكن عملهم هذا من قَبِيل المقارنة أو المفاضلة البتة.
إنّنا في صور الفرض السابقة نقترب من مقولة البلاغيين التي أثبتناها في أول الحديث عن المبالغة في الشِّعْر. حيث قالوا: إنّ الإغراق أو الغلوّ إذا دخلته لو أو لولا أو يكاد أو ما شابه ذلك تجعلهما إغراقًا أو غلوًّا مستساغًا أو مستحسنًا. وهو يكون كذلك على الرغم من امتناع المعنى عادة، كما في الإغراق، وامتناعه عقلًا وعادةً كما في الغلوّ.
وهذا يعني أنّ الإغراق والغلوّ موجودان في القرآن الكريم، ولكن بدلالتَيْن اثنتين؛ أُولاهما ما أشرنا إليه من فارق بين صدور الفعل من الإنسان، وبين صدوره من الله. فمع الفعل البشري يكون الامتناع عقلًا أو عادةً، ولكن مع الفعل الإلهي لا يكون امتناعٌ في العادة أو العقل، كما لاحظنا من الأمثلة السابقة.
وثانيهما أنّ الإغراق والغلوّ يرفقان بأدوات التقريب سالفة الذِّكْر، وهي الأدوات التي تجعل المبالغة مقبولة ومستحسنة؛ لأنها تكون من قبيل الفرض. وقد تتحقّق الدلالتان في مثال واحد، كما في قوله تعالى: ﴿لَوْ أَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ﴾ [الحشر: 21]. فبإمكانك أَنْ تحمِل المعنى على الدلالة الأُولى، وهي قدرة الله على إحداث الحياة والإحساس في الجبل وجعله متأثرًا بمواعظ القرآن وهديه. وحتى في هذه الدلالة يمكن أن نستشعر المبالغة على الرغم من صدور الفعل من الله، ولكنها المبالغة التي تعني تمام التوصيل للفكرة بما لا يدع مجالًا للشّك فيها أو التفكير في عدم كونها واقعة حقًّا.
إنما على الدلالة الثانية، وهي سبيل الفرض والتمثيل خاصّة وأن الله سبحانه عقَّب على الآية بقوله: ﴿وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾ [الحشر: 21]، فالمبالغة متحقّقة؛ لأنّ المعنى من قَبِيل ما قالوا عنه أنه ممتنع عقلًا وعادةً؛ إِذْ إنّ الجبل لم يُعرف عنه عادة التأثر والخشوع، ولا يمكن تصوّر خشوعه وتأثّره وفق المقاييس المادية البشرية. ومع ذلك فقد استُحسنت هذه المبالغة؛ لأنّ (لو) أدخَلَتْهَا في باب الفرض، وهي التي يقول عنها النحاة بأنها حرف امتناع.
ولعلّ من المستحسن أن ننقل فهم الشيخ محمد جواد مغنية لهذه الآية بقوله: «هذا مجرّد فرض دلّت عليه كلمته (لو)، والغرض منه بيان عظمة القرآن وأن له من قوة التأثير ما لو نزل على جبل لخشع ولانَ على قساوته، وتصدّع وتهاوَى خوفًا من الله على صلابته. إذن فما للإنسان الذي تؤلمه البقة، وتقتله الشرقة وتُنتِنُه العرقة -كما قال الإمام علي رضي الله عنه- ما بال هذا الضعيف ﴿يَسْمَعُ آيَاتِ اللَّهِ تُتْلَى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا كَأَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا﴾ [الجاثية: 8]... فهل قلبه أقسى من الجبل وأشد تمكُّنًا؟!»[17].
وهذا الفهم هو الذي استهدينا به.
ومن الصور الأخرى التي تحتمل الدلالتين: دلالة واقعية الفعل لأنه صادر من الله الذي أنطق كلّ شيء، ودلالة الفرض والتمثيل: قوله تعالى: ﴿ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ﴾ [فصلت: 11]، وقوله تعالى: ﴿يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ﴾ [ق: 30].
يؤكّد بعض المفسِّرين أنّ حديث السماء والأرض ونار جهنم من باب التمثيل وتقريب المعنى. قال الزمخشري: «وسؤال جهنم وجوابها من باب التخييل الذي يُقصد به تصوير المعنى في القلب وتثبيته»[18]. وهذا هو الفهم الأدبي لكتاب الله، وهو ليس بعيدًا عن تحقيق المقاصد القرآنية إذا استُخدم بحذر وحيطة وصِدق نيّة، والمبالغة هنا في هذه الصورة المتخيلة للجماد الناطق من سماء وأرض ونار، وهو من باب الاستعارة التي تشخّص الأشياء وتجسِّمها، وهي باب من أبواب المبالغة ومدخل من مداخلها، كما سنشير.
ومرة أخرى نقول: إننا لو لم نوافق أهل التمثيل والتخييل، وذهبنا إلى القول بأن الأرض والسماء والنار تحدّثت وأحسّت، حديثًا حقيقيًّا وإحساسًا حقيقيًّا، كما روى ابن كثير في تفسيره عن الحسن البصري قال: (لو أبَيَا عليه أمره لعذبهما عذابًا يجدان ألَمَه)[19]، أقول: لو أننا اعتقدنا بحيوية الأرض والسماء والنار؛ فالصورة ذات الدلالة على الطاعة الكاملة من لدن هذه الموجودات لبارئها وخالقها صورةٌ تَشِي ببلوغ الهدف وتحقيق الفكرة في نفس المتلقِّي بخضوع الكون كلّه لله بلا استثناء، وهذه صورة من صور المبالغة.
وقد قيل بأنّ أحد طرق المبالغة «أن يُستعمل اللفظ في غير معناه لغةً، كما في الكناية والتشبيه والاستعارة من أنواع المجاز»[20]. وما من شكّ في أنّ منحی الآيتين السابقتين منحى مجازي.
صورة فنية للمبالغة:
مَرّ علينا أنّ المعاني القرآنية التي تكون الأفعال فيها صادرة من الله سبحانه تُفَسَّر فيها المبالغة على نحو خاصّ؛ فهي من جانبٍ لا مبالغة فيها لأنها صادرة من خالق الأفعال، ومن جانب آخر فإنّ القارئ يجد فيها معنى المبالغة من حيث كمال الصورة ودقّة توصيل المعنى الذي يستعصي على الفهم البشري إلا من خلال الإيضاح الذي يسلكه القرآن.
وقد أشرنا إلى أن بعض المفسِّرين والبلاغيين تعاملوا مع تلك الأنماط من المبالغة على أنها صور مجازية لا تتعلّق بقضية قدرة الله سبحانه على مَنْح الحياة للأشياء في الوجود.
وفي هذه الفقرة نريد الوقوف عند صور فنية للمبالغة نتناولها من جانبها الفني، وليس من جانب كون أفعالها صادرة من الخالق سبحانه.
قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ﴾ [الأعراف: 40].
هناك فكرة أراد الله سبحانه إبلاغها للبشر، وهي أنّ المشركين لا يدخلون الجنة أبدًا. ولكنه لو جاء التعبير بهذه الصورة التقريرية المباشرة الخالية من تقريب المعنى بالمحسوسات وشحنه بعنصر الإثارة المعتمدة على التجربة الإنسانية، لَمَا قلنا إنّ المعنى بلغ أقصى غاياته وأبعد نهاياته، كما قال أبو هلال العسكري في تعريف البلاغة، وأشرنا إليه في بداية البحث.
فإيصال المعنى بالدرجة التي يأخذ على النفس أقطارها، ويشدّها إلى المقصد الذي يُراد استدراجها إليه؛ هو الذي يُراد من معنى المبالغة، وهي المبالغة الهادفة الموظّفة إلى خدمة المعنى وتوصيله، وما تلك التي يغالَى فيها بما لا طائل وراءه في خدمة المعنى إلا نوعًا من (الشطارات) والفذلكات البديعية في عصور الفراغ من حياة البشر.
ونعود إلى المبالغة في الآية، فنقول: إنّ المعنى في الآية تعلّق بمُحال، أو إنّ الصورة الحسية المعبّرة عن المعنى تعلّقت بمُحال، وما يعلَّق بمحال فمحال، كما قال الشيخ مغنية[21]. والعرب تضرب المثل لما لا يكون، بقولهم: لا أفعله حتى يشيب الغراب!
ففكرة استحالة دخولهم للجنة معضودة في الآية ببيّنة مادية كحُجّة صاحب الدعوى المقامة على دليل مادي؛ «لأنه جعل ولوج الجَمَل في السمّ غاية لنفي دخولهم الجنة، وتلك غاية لا توجد، فلا يزال دخولهم الجنة منتفيًا»[22].
هذا نمط من المبالغة يشبه كلام البشر، ويمكن الاستعانة على فهمه بما يتعارف عليه البشر من مواضعات تعبيرية، وهذا النمط -كما قلنا- لا يتعلّق بالأفعال الإلهية التي تؤدي بنا إلى فهم خاصّ للمبالغة، وهو الفهم المرتبط بالتفسير الديني والعقدي.
ومن هذا النمط قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ * أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُجِّيٍّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ سَحَابٌ ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ﴾ [النور: 39 - 40].
إنّنا أمام صورتَيْن حسّيتين تتخذان طابع المثل، يُضرب في الآية الأُولى لخيبة الكافر في الآخرة، ويُضرب الثاني لعقائد الكافرين. وهذا ما قرّره الإمام الرازي[23].
فالكافر لا يجد من عملِه إلا كما يجد الظمآن من السراب؛ إِذْ لم يجد إلا حسرة بعد الحاجة واللّهفة، وحسرته يوم القيامة أكبر. أمّا عقائد الكافرين فهي ظلماتٌ في ظلمات، كشأن البحر العميق المُظْلِم، فإذا ترادَفَت عليه الأمواج ازداد ظُلْمة، وإذا كان ثمة فوق هذا سحاب بلغت الظُّلْمة مبلغها، فلا يستطيع معها الرائي أن يرى حتى يده!
وهذا التعاقب في الصفات والأحوال المظلمة تصرُّف في أداء المعنى على وجه المبالغة بما لا يدع فرصة إلا أن يطمئن القلب إلى جهالة أولئك الكفار وعماهم، وهو المعنى الذي أراد التعبير القرآني أن يقودنا إليه. وتلك -لعمري- مبالغة في الإحاطة بالمعنى والبلوغ به غايةً ما بعدها غاية.
ومع ذلك فالتعبير مرفق بأداة التقريب (كاد)، حيث قال تعالى: ﴿لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا﴾، وهذا هو القانون الذي استنبطوه من استقصاء الكتاب الكريم، ومن نماذج الشعر العربي القديم.
ومقياسنا ليس وجود (كاد) أو عدم وجودها، بل بلوغ «المعنى أقصى غاياته وأبعد نهاياته» دونما إفراط أو إحالة أو الخروج من التعبير بدون طائل.
خذ مثلًا قوله تعالى: ﴿وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ﴾ [الأحزاب: 10]، سواء قلنا بتقدير كاد أو لم نقل فإن القلوب قد بلغت الحناجر! ولكننا نفهم هذا البلوغ فهمًا نفسيًّا عن طريق الإيحاء الأدبي والتصوير البياني وليس عن طريق البلوغ الحقيقي، حيث قيل: «إن الخوف والروع يوجب للخائف أن تنفتح رئته ولا يبعد أن ينهض بالقلب نحو الحنجرة»، كما رَوى الزركشي عن الفرّاء[24].
وهذا مُحَال، فليس هناك حياة لو أنّ القلب خرج من موضعه ووصل الحنجرة حقيقةً!
إنّ السياق الذي وردت فيه ﴿وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ﴾ هو: ﴿إِذْ جَاءُوكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ...﴾، وكان ذلك في حصار الأحزاب، فقد جاؤوا المدينة من كلّ قطر يعضدهم من الداخل اليهودُ، بما لدى أولئك وهؤلاء من سلاحٍ وعددِ رجال، وبما لأولئك وهؤلاء من فُرسان مشهورين. وكانوا إزاء ذلك كلِّه قِلّة مع ضعف عُدّة وسلاح، فبلغ الخوف فيهم مبلغه، حتى كأنّ قلوبهم من اضطرابها ووجيبها قد بلغت الحناجر منفذًا للهروب!
وهو تعبير نلجأ إليه نحن البشر حين نقول عن بعض المواقف: (مات فلان هلعًا)، وما هو بميت. والتعبير القرآني هنا شبيه بالتعبير البشري، مع الفارق في المصدر.
فعلى الرغم من المصدر الإلهي للحديث القرآني، فإنّنا نستطيع ألّا نحمله محمل التعبير الحقيقي، بل التعبير الذي يُقصد به ما وراء دلالته الظاهرية، فتكون ﴿وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ﴾ إنها بلغت من الرعب والخوف والهلع ما يكون بدرجة خروجها من نياطها وشرايينها وأعصابها إلى حيث أيّ منفذ!
وهذه هي المبالغة القرآنية التي تراعِي الجانب النفسي والمواضعات التعبيرية للبشر، لتبلغ هدفها ومقصدها إلى الدرجة التي ما وراءها درجة. وما هي الدرجة التصويرية للخوف أكثر من بلوغ القلوب الحناجر؟!
ونريد أن نختم هذا النمط التصويري من المبالغة بهذه الصورة الفنية العجيبة، قال تعالى: ﴿وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ﴾ [الحج: 31].
ونستأنس بتفسير الزمخشري ووقوفه عندها، قال: «مَن أشرك بالله، فقد أهلك نفسه إهلاكًا ليس بعده نهاية، بأَنْ صوّر حاله بصورة مَن خرّ من السماء، فتخطفه الطير، فتفرق مزعًا في حواصلها، أو عصفت به الريح حتى هَوَت به في بعض المطارح البعيدة»[25].
وفي الآية من الإيحاءات والدلالات الكثيرة التي تنتهي بك إلى التسليم بأنّ خسارة المشرك ما بعدها خسارة، وعاقبته ليس كمثلها عاقبة! فأيّة سماءٍ هذه في البُعد؟ وأيّة بقعةٍ تحت سطح الأرض في السُّحق هذه التي خرّ منها الإنسان وانتهى إليها؟!
وهذه مبالغة تبلغ بالصورة ما تشمئز معها النفوس من الشِّرْك، وترتعب من مآله، وتبتعد عن مقدّماته وصوره بعد أن اقترنت بصورة معاينة بالحسّ والوجدان.
ومن المفيد الإشارة إلى أنّ المتابع لصور المبالغة في القرآن يجدها تتوزّع بين الموضوعات البلاغية الكثيرة، فقد تجد المبالغة في التشبيه أو التشبيه المقلوب. قال الأستاذ عليّ الجندي: «إنّ التشبيه على السنن المألوف لا يخلو من المبالغة»[26]، وقال الدكتور عبد العزيز عتيق: «ومن مقاصد التشبيه إفادة المبالغة؛ ولهذا قلّما خلا تشبيه مصيب عن هذا القصد»[27]، وقد تجدها في الكناية والاستعارة والمجاز العقلي والمجاز المرسل، وفي المجاز عمومًا[28]. كما تجدها بالحذف وتكرار اللفظ للتهويل والتعظيم الذي يقوم مقام الأوصاف المتعدّدة، مثل قوله تعالى: ﴿الْحَاقَّةُ * مَا الْحَاقَّةُ﴾ [الحاقة: 1- 2][29]. وقد تجدها فيما يُسمّى بالتتميم والتكميل في علم البديع، كما في قوله تعالى: ﴿وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا﴾ [الإنسان: 8]، حيث يكون قوله تعالى: ﴿عَلَى حُبِّهِ﴾ من باب إيفاء المعنى وإعطائه حقّه من بلوغ الهدف[30].
وهذه السّعة في المجالات التي تَرِد منها المبالغة تؤكد قولنا في بداية هذا البحث أنه من غير الصحيح حصر موضوع المبالغة في البديع، بل هو موضوع أشمل من هذا بكثير خاصّة في القرآن الكريم. ولهذا كان من الضروري أن تفهم المبالغة على وجوهها المتعدّدة من البيانية المتعدّدة.
كما أنه من الضروري أن يُعاد النظر في فهم المبالغة القرآنية من حيث أن مقاييسها ليست دائمًا هي المقاييس التي نتبعها في فهم الأدب البشري، بل لها مقاييس خاصّة أحيانًا، ومقاييس مشابهة لهذا الأدب في بعض الأحيان. وهذا ما حاوَلْنا إيضاحه بإيجاز في الصفحات السابقة، ونرجو أن نكون قد وُفِّقْنا إليه.
[1] نُشرت هذه المقالة في مجلة (كلية الدعوة الإسلامية) بالجماهيرية الليبية، العدد الحادي عشر، سنة 1994م، ص305 وما بعدها. (موقع تفسير)
[2] كتاب الصناعتين، تحقيق: عليّ محمد البجاوي، ومحمد أبو الفضل إبراهيم، ص378.
[3] شرح التلخيص، للشيخ أكمل الدين بن محمد البابرتي، ص643.
[4] ينظر: لسان العرب، لابن منظور، مادة: بلغ.
[5] علم المعاني، د. عبد العزيز عتيق، ص55.
[6] شرح التلخيص، ص643.
[7] الوساطة بين المتنبي وخصومه، ص40.
[8] علوم البلاغة، أحمد مصطفى المراغي، ص403، وينظر: الإيضاح في علوم البلاغة، الخطيب القزويني (1/ 517).
[9] البرهان في علوم القرآن، الزركشي، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم (3/ 55).
[10] العمدة في صناعة الشعر ونقده، ابن رشيق (2/ 50).
[11] الكشاف، دار المعرفة، بيروت، (المقدمة)، ص16.
[12] كتاب الصناعتين، ص378. وعلم البيان د. عبد العزيز عتيق، ص28.
[13] التفسير الكبير، التزام عبد الرحمن محمد (23/ 4).
[14] البرهان، الزركشي (3/ 53)، وينظر: مختصر تفسير ابن كثير (3/ 237).
[15] التفسير الكاشف، محمد جواد مغنية (5/ 166).
[16] التفسير الكاشف، محمد جواد مغنية (6/ 167).
[17] التفسير الكاشف، محمد جواد مغنية (7/ 294).
[18] الكشاف (2/ 163) وينظر: الفنّ القصصي في القرآن، د. محمد أحمد خلف الله، ص149، وكتابنا: أثر القرآن في الشعر العربي الحديث، ص111.
[19] مختصر تفسير ابن كثير (3/ 258).
[20] البرهان في علوم القرآن (3/ 55).
[21] التفسير الكاشف (3/ 328).
[22] البرهان (3/ 47).
[23] التفسير الكبير (24/ 9، 27).
[24] قال صاحب البرهان عن قوله تعالى: ﴿يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ﴾ [النور: 43] ما يأتي: «فإنّ اقتران هذه بـ(يكاد) صرفها إلى الحقيقة فانقلبت من الامتناع إلى الإمكان» (3/ 53).
[25] الكشاف (3/ 12).
[26] فن التشبيه (1/ 156).
[27] علم البيان، ص124.
[28] البرهان (3/ 55).
[29] البرهان (3/ 55).
[30] علم البديع، د. عبد العزيز عتيق، ص120، وينظر: كتاب الصناعتين، ص389.


