من مظاهر الإعجاز القرآني
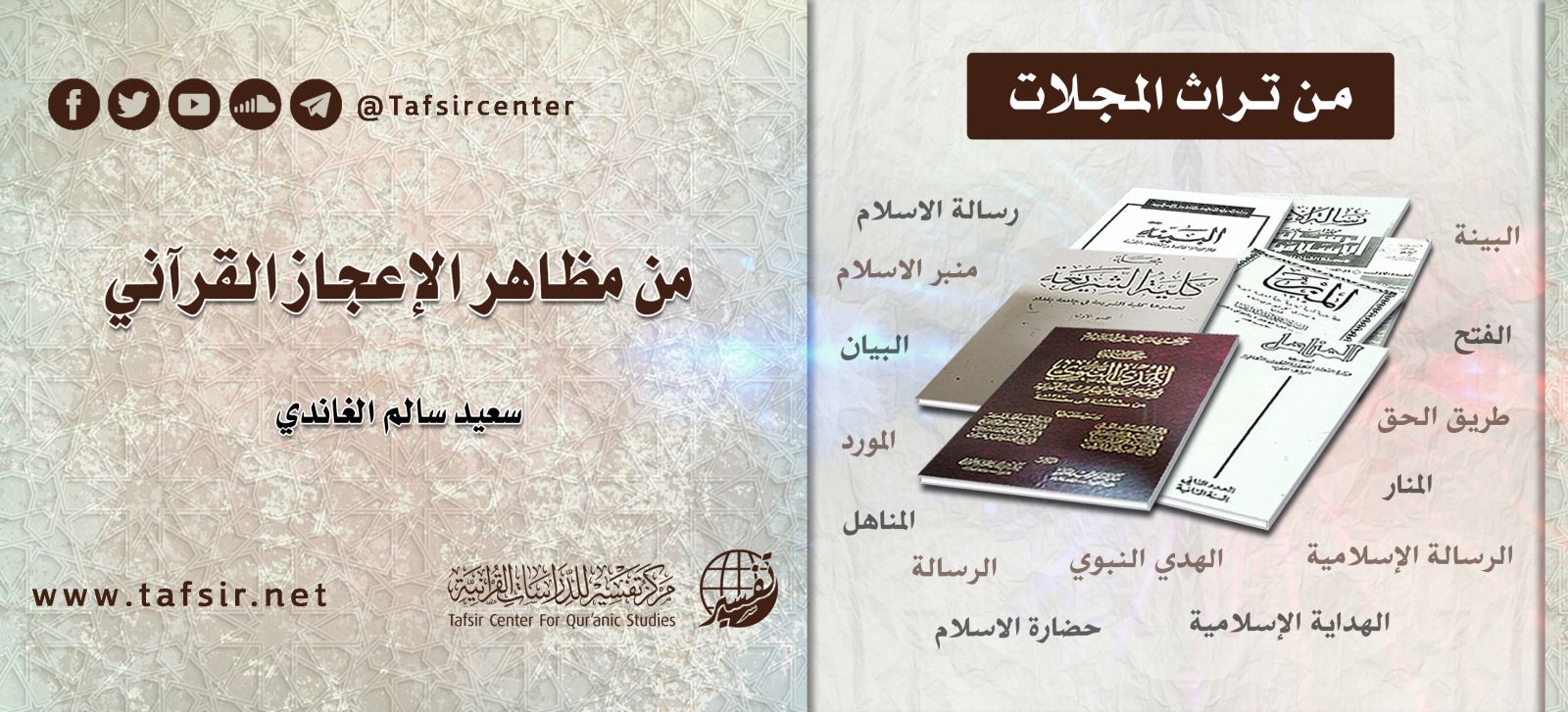
من مظاهر الإعجاز القرآني[1]
لئن كانت آيات القرآن الكريم ناطقة بالإعجاز، في كلّ كلمة من كلماتها، بل في كلّ حرف من حروفها، فإنّ استجلاء مظاهر ذلك الإعجاز يحتاج إلى تأمّل العقل الثابت، وصفاء الشعور المؤمن، وأن السرّ الكامن في خصوبة الجوانب البلاغية وإعجاز القرآن الكريم يرجع إلى أنه مغمور بالجمال البياني والدقّة العلمية غمرًا، حتى تسابقت الألباب إلى حَصْر أوجه إعجازه وأضرب تفوّقه على سائر الكلام.
وسنتناول في هذا البحث بعض الأسرار البلاغية التي تضمّنتها آيات تشابهَتْ بتكرار كلماتها، ثم قُدِّم بعض من تلك الكلمات في موضع وأُخِّر في موضع آخر؛ لتحقيق معنى بلاغيّ بعد تحقّق المعنى الأصلي المستفاد من مفهوم الآية في الموضعَيْن.
فلا نقصد في بحثنا هذا التقديم والتأخير في الجملة الواحدة؛ كالتقديم والتأخير بين المسند والمسند إليه، ولا بين الفعل ومتعلّقاته. بل نقصد نوعًا من أنواع التقديم والتأخير الداخل في تركيب العبارة وهو ما يسمَّى بالتقديم والتأخير في الذِّكْر، الذي يراعَى فيه غرض الترقِّي أو السببية، أو الأكثرية أو الاهتمام بالمتقدِّم أو تشريفه، أو التدرُّج من الأعجب إلى الأقلّ عجبًا[2] أو بالعكس، أو الانتقال من الأهمّ إلى المهمّ، إلى غير ذلك من الأغراض التي تُدْرَك من سياق الكلام، وتتكشّف بالتذوّق الفني، ونخصّ المواطن القرآنية التي تكرّرت آياتها بتطبيق هذا التقديم والتأخير في الذِّكْر ونَظْم العبارة، ومعلوم أنّ التقديم والتأخير قسمٌ من أقسام عِلْم المعاني في البلاغة؛ ولذلك فللموضوع أهميته الإعجازية، حيث إنه تأكيد لِمَا تميز به القرآن الكريم من بلوغ الذروة في مراعاة مقتضى الحال.
تكلّم المفسِّرون وأعلامُ القرآن في الآيات المختلفات بالتقديم والتأخير واختلاف مقاماتها ومقتضى غاياتها، وإن جاء كلامهم مقتضبًا في بعض المواضع مبسوطًا في مواضع أخرى؛ فهذا الزمخشري يقارن بين قوله تعالى من صدر سورة النمل: ﴿طس تِلْكَ آيَاتُ الْقُرْآنِ وَكِتَابٍ مُبِينٍ﴾، وبين قوله تعالى في سورة الحجر: ﴿الر تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ وَقُرْآنٍ مُبِينٍ﴾، فيرى أنه من باب تعداد أوجه الكلام واختلاف أساليبه: «فإن قلتَ: ما الفرق بين هذا -يقصد قوله تعالى: ﴿تِلْكَ آيَاتُ الْقُرْآنِ وَكِتَابٍ مُبِينٍ﴾-، وبين قوله تعالى: (يذكر مفتتح سورة الحجر)؟ قلتُ: لا فرق بينهما إلا ما بین المعطوف والمعطوف عليه»[3] من التقدّم والتأخّر.
ويشير عميد البيان العربي عبد القاهر الجرجاني إلى أنّ لذلك الاختلاف سرًّا بلاغيًّا، يقول في دلائل الإعجاز: «فأمّا أن يجعله -التقديم والتأخير- بين بين، فيزعم أنه للفائدة في بعضها وللتعرّف في اللفظ من غير معنى في بعض، فمنحى ينبغي أن يُرْغَب عن القول به»[4]، كما يقول في موضع آخر من الدلائل: «وقد وقع في ظنون الناس أنه يكفي أن يُقال إنه قدّم للعناية، ولأنّ ذِكْره أهمّ، من غير أن يذكر من أين كانت تلك العناية، ولِـمَ كان أهمّ، ولتخيلهم ذلك صغر أمر التقديم والتأخير في نفوسهم وهوَّنوا الخَطْب فيه»[5]، فهو يعترض على مَن استصغر أمر التقديم والتأخير في البلاغة.
ويقول الطبرسي صاحب تفسير (مجمع البيان) في تفسير الآيتين السابقتين اللتين تعرّض لهما الزمخشري: «وصَفَه بالصفتين؛ ليفيد أنه مما يظهر بالقراءة ويظهر بالكتابة»[6]. غير أنه وإن تعرّض لسرّ إطلاق وصف الكتاب ووصف القرآن، لم يتعرض لسرّ تقديم كلّ منهما على الآخر في موضعين مختلفين، فيأتي الشيخ محمد الطاهر بن عاشور لیبیِّن سرد ذلك التقديم والتأخير، فيقول: «فأمّا تقديم الكتاب على القرآن في الذِّكْر فلأنّ سياق الكلام توبيخ للكافرين، وتهديدهم بأنهم سيجيء وقت يتمنون فيه أن لو كانوا مؤمنين، فلما كان الكلام موجَّهًا إلى المنكرين ناسب أن يستحضر المنزَّل على محمد -صلى الله عليه وسلم- بعنوانه الأعمّ، وهو كونه كتابًا»[7]، قال ذلك في تفسير قوله تعالى: ﴿تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ وَقُرْآنٍ مُبِينٍ﴾ [الحجر: 1]. وقال في سرّ سبق القرآن للكتاب في سورة النمل على عكس الآية السابقة: «وإنما قدّم في هذه الآية القرآن وعطف عليه ﴿وَكِتَابٍ مُبِينٍ﴾؛ لأنّ المقام هنا مقام التنويه بالقرآن ومُتَّبِعِيه المؤمنين؛ فلذلك وُصف بأنه: ﴿هُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ [النمل: 1]»[8].
ولدينا شهادة من مفسِّر قديم اضطلع بهذا العلم وألَّفَ فيه (غرائب القرآن ورغائب الفرقان) وهو النيسابوري، فقد أحسّ بهذا التقصير الذي وقع فيه المفسِّرون، فقال عند تفسيره لأول سورة الواقعة: ﴿فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ * وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ * وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ * أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ * فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ﴾ [الواقعة: 8- 12]: «واعلم أنه سبحانه ذكَرَ في تفضيل الأزواج الثلاثة نسقًا عجيبًا وأسلوبًا غريبًا؛ وذلك أنه لم يُورد في التفضيل إلا ذِكْر صنفين: أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة، ثم عمد إلى بيان حال الثلاثة»، فهو يتساءل: لماذا ذكر اللهُ في أول السورة أصحاب اليمين وأصحاب الشمال بتفضيل الأولين، ثم عند التفضيل قدّم السابقين، وهم جزء من أصحاب اليمين لم يذكروا في بداية السورة، ثم ثنَّى بأصحاب اليمين، أقلّ مرتبة من السابقين، ثم ختم بأصحاب الشمال، وهم المغضوب عليهم والموعودون بالعذاب؟
ثم يجيب عن ذلك مشيدًا بهذا النوع من التقديم والتأخير: «هذا كلام موجَز معجِز فيه لطائف غفلت التفاسير عنها؛ منها أنه طوى ذِكْر السابقين في أصحاب الميمنة لأنّ كلًّا من السابقين ومن أصحاب اليمين أصحاب اليُمْنِ والبركة، كما أن أصحاب الشمال أهل الشُّؤم والنكَد»[9].
وقد وجدت أن أكثر مَن كتب في هذا النوع هو العلّامة بدر الدين الزركشي صاحب كتاب (البرهان في علوم القرآن) عند كلامه عن المقدَّم والمؤخَّر من القرآن في الجزء الثالث من برهانه، وذكر السيوطي في (الإتقان) أنّ العلّامة شمس الدين بن الصائغ ألّفَ كتابًا مستقلًّا في مقدّم القرآن ومؤخّره، فلعلّ هذا النوع حظي بدراسته، واسم الكتاب كما أورده السيوطي: (المقدِّمة في سرّ الألفاظ المقدَّمة)، وقد اقتبس منه السيوطي ما جاء في (الإتقان) تحت عنوان: «النوع الرابع والأربعون»[10].
وتختلف الدواعي البلاغية للتقديم والتأخير باختلاف المقام وسياق الكلام وطبيعة الموضوع الذي تعالجه الآيات، وسأعرض نماذج من الآيات التي احتوت على هذا النوع الدقيق من المقدّم والمؤخّر القرآني، مستعينًا بما جاء في بعض التفاسير وكتب علوم القرآن، وواقفًا في بعض الآيات على حدّ الاستنباط، فإِنْ وُفّقتُ فمِن الله، وإِنْ أَخفَقتُ فمِن نفسي.
فقد يقدّم القرآن كلمة أو جملة في آية ويؤخّرها في آية أخرى؛ مراعاة لِما يناسب كلّ آية في سياقها المنتظم مع بقية الآيات، كما قدّم القلوب على السمع في قوله تعالى: ﴿خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ﴾ [البقرة: 7]، وقدّم السمع على القلب في قوله تعالى: ﴿أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً﴾ [الجاثية: 23].
يقول عمر السلامي في تعليل ذلك: «إنّ الغرض من تقديم القلب على السمع في الآية الأولى هو إثبات صفة الختم على القلوب، وأنها مقفلة مغلقة لا تعي ولا تدرك، وإن سياق الآية يثبت هذا، فالآية التي قبلها صريحة في انغلاق القلوب»[11]. والآية السابقة عليها هي قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ [البقرة: 6]، ويقول السلامي في سرّ تقديم السمع على القلب في آية الجاثية: «فكأنه اتخذ هواه آلهة شتى يعبد كلّ وقت واحدًا منها، فإلهه متنوّع على حسب هوى النفس. وههنا نلاحظ أن السمع عادة يسبق الفهم؛ ولذلك قدّم السمع على القلب، وأنّ هوى النفس يتبع السمع أولًا»[12].
وكذلك نظر الأستاذ السلامي في تقديم القتل على الموت في قوله تعالى: ﴿وَلَئِنْ قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ﴾ [آل عمران: 157]، وفي تقديم الموت على القتل في قوله تعالى من نفس السورة في لحاق الآية السابقة: ﴿وَلَئِنْ مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ﴾ [آل عمران: 158]. يقول الأستاذ السلامي: «فالأولى في سياق تأكيد القتال في سبيل الله على حسب ما تشير إليه الآية التي قبلها وما تؤكده خاتمة نفس الآية: ﴿لَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ﴾ [آل عمران: 157]، والثانية في سبيل تأكيد أن الجميع يحشرون إلى الله، والحشر يلجه كلّ مخلوق»[13]، ثم يقول: «والموت الطبيعي عُرف قبل الموت عن طريق القتال».
ومن هذا الضرب تقديم وصف العبودية للنبي -صلى الله عليه وسلم- في سورة الكهف، وتأخير لفظ الكتاب، وتأخير ذلك الوصف وتقديم الفرقان في سورة الفرقان، حين قال في مفتتح الكهف: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا﴾ [ الآية: 1]، وقال في مفتتح الفرقان: ﴿تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا﴾ [الآية: 1]، بسبب سبق ذِكْر وصف العبد بالفعل ﴿أَنْزَلَ﴾ الذي يقتضي نزول القرآن دفعة واحدة، فناسب أن تُذكر الجهة الـمُنزَل عليها وهي جهة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي آية الفرقان ذكر الفعل ﴿نَزَّلَ﴾ وأردف بصفة الكتاب ﴿الْفُرْقَانَ﴾؛ لِـمَا يدلّ عليه التضعيف في الفعل من التتابع والتنجيم، فناسب أن يُذكر ﴿الْفُرْقَانَ﴾ بعده ويسند إليه الفعل، ثم يُذكر النبيّ -صلى الله عليه وسلم- موصولًا به غير منفصل عنه بفاصل.
ومِن أجلِ التناسب في السياق، فقدّم وصف الضرّ وتأخّر الرّشَد في قوله تعالى: ﴿قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا﴾ [الجن: 21]؛ لتقدّم نفي الشرك في الآية التي قبلها، فناسبه نفي أن يكون النبيّ -صلى الله عليه وسلم- يملك لهم ضرًّا عقابًا على مخالفة التوحيد. وكذلك تقدّم نفي أن يملك الكفار لأنفسهم ضرًّا على نفي امتلاكهم النفع لها في سورة الفرقان؛ لأنه سبقه ذِكْر اتخاذهم آلهة من دون الله: ﴿وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا﴾ [الفرقان: 3]، كما أنه ذكر عدم امتلاكهم للموت والحياة ترتيبًا على الضر والنفع، فقال في تتمة الآية: ﴿وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا﴾ [الفرقان: 3]، ولكنه خالف هذا النسق في آخر الفرقان، فقدّم النفع وأخّر الضر لمناسبة الآية السابقة، حيث قال: ﴿وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا﴾ [الفرقان: 54]، فتلك نعمة الخلق والمصاهرة تعلّقت بها قدرة الله، فوافق أن يقدّم بعدها النفع على الضر؛ ولذا قال تعالى في الآية التالية: ﴿وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا﴾ [الفرقان: 55].
ولـمّا أردف ذِكْر الشفاعة -وهي لا تكون إلا عند اشتداد الأمر يوم القيامة- لاءمها أن تُسبق بتقديم نفي الضرر على نفي النفع، فقال -جلّ وعلا- في سورة يونس الآية 18: ﴿وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ﴾، وعندما عدّد إبراهيم -عليه السلام- نِعَم ربّه عليه من الخَلْق والإطعام والسقاية والشفاء ناسَب ذلك أن يحتجّ على قومه المشركين بقوله في تبكيت عبادتهم للأصنام: ﴿هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ * أَوْ يَنْفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ﴾ [الشعراء: 72- 73]، وإِنْ فصل بينهما بآيات أربع فالحديث متصل، حيث قال تعالى على لسان إبراهيم -عليه السلام-: ﴿فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ * الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ * وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ﴾ [الشعراء: 77 - 79].
والأصل في القرآن أن تقدّم صفة المغفرة على صفة الرحمة عندما تُذَيَّل بها الآيات؛ «لأنّ المغفرة سلامة والرحمة غنيمة، والسلامة مطلوبة قبل الغنيمة»[14]، ولكنه قدّم الرحمة على المغفرة في سورة سبأ: ﴿يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ﴾ [سبأ: 2]، «لأنها منتظمة في سلك تعداد أصناف الخلق من المكلفين وغيرهم... فالرحمة شملتهم جميعًا، والمغفرة تخصّ بعضًا»[15]، وهذا ما جرى في دعاء بني إسرائيل حين ندموا على عبادة العجل فقالوا: ﴿لَئِنْ لَمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ [الأعراف: 149]، فقد اقترفوا ذنبًا لا يُمْحَى إلا برحمة الله تعالى، فقدّموا الرحمة لعمومها، فقد خرجوا من الإيمان وها هم يعودون إليه، والمغفرة لا تكون إلا للمؤمنين في حال إيمانهم.
ومع أنّ من منهج القرآن الكريم تقديم الموت على الحياة مراعاةً للرتبة؛ حيث إنّ العدم يسبق الوجود في المخلوقات، إلا أنه في معرض الحديث عن إنزال آدم من الجنة يقدّم الحياة على الموت بعد قوله: ﴿وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ * قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ﴾ [الأعراف: 24- 25]، فالمقام مقام الحثّ على تعمير الأرض وعبادة الله فيها يُناسِب أن يُقدَّم فيه الإحياء وتُؤخَّر فيه الإماتة، ولكن انظر في مقام معاتبة الكافرين على كفرهم والامتنان عليهم بنعمة الخَلْق بعد العدم: ﴿كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ [البقرة: 28]، فقد قدّم الإماتة على الإحياء، ومما لُوحظ فيه نَظْم السياق ما جاء في قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ﴾ [المائدة: 8]، بتقديم لفظ الجلالة وإسناد القوامة له، وتأخير لفظ القسط، وتعلق الشهادة به، «ووجه ذلك أنّ الآية التي في سورة النساء، وردَت عقب آيات القضاء في الحقوق»، يقصد قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ﴾ [النساء: 135]، فكان الأهمّ فيها (العدل في الشهادة)، وأمّا آية سورة المائدة «فهي واردة بعد التذكير بميثاق الله، فكان المقام الأول للحضّ على القيام لله»[16].
وقد يأتي التقديم والتأخير للتنبيه على الكثرة في موضع من المواضع، كما في افتتاح الحديث عن حال المؤمنين والكفار يوم القيامة بقوله: ﴿يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ﴾؛ واختتامه بذِكْر حال بيض الوجوه تنبيهًا على أن إرادة الرحمة من الله أكثر من إرادة الغضب[17]، فقد قال تعالى: ﴿وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ * يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ * وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ [آل عمران: 105- 107]، وكذلك تقديم الرحمة على العذاب في مواطن كثيرة من القرآن، وقد يقدّم العذاب في بعض المواضع القليلة لغير التنبيه على الكثرة بل لأغراض أخرى، كما في آخر سورة المائدة حين قال تعالى: ﴿إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ [المائدة: 118]؛ لأنهم سبق عليهم القول بالكفر، فالحديث عن مشهد من مشاهد يوم القيامة يصوِّر فيه الله تعالى حوارًا بينه وبين عيسى -عليه السلام-، حيث يسأله سبحانه: ﴿أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ [المائدة: 116]، فناسب أن يقدّم العذاب؛ لأنّ عیسی -عليه السلام- يعلم مصيرهم الأليم وقد أشركوا بالله، ولكن مجاراة للمحاورة، قال: ﴿وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ﴾ [المائدة: 118]، وهذا ما يعلّل كذلك تذييل الآية بصفتَي العزة والحكمة دون المغفرة والرحمة.
ومن تقديم العذاب على الرحمة خروجًا عن الكثرة ومراعاةً لمقام الكلام، ما جاء في دعاء موسی -عليه السلام- وإجابة ربّه له بقوله: ﴿عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ﴾ [الأعراف: 156]؛ لأنّ موسى قال قبلها متذرِّعًا: ﴿أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا﴾ [الأعراف: 155]، وكذلك في قوله تعالى في ختام الأنعام، السورة التي عالجت ظاهرة الشرك، وصحّحت كثيرًا من معتقدات الجاهلية: ﴿إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [الأنعام: 165].
ومما جرى على مراعاة الكثرة، ما تقدّم من بيان ذِكْر الموت قبل القتل في قوله تعالى: ﴿وَلَئِنْ مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ﴾ [آل عمران: 158]، فالموت بغير قتال أكره من الموت بالقتل.
ومن المواضع القرآنية التي رُوعي فيها جانب الكثرة، تقديم إسناد الزِّنَى للمؤنث على إسناده للمذكّر في آية النور 2، وتأخير إسناد السرقة للمؤنث على إسنادها للمذكر في آية المائدة 38، حيث قال تعالى في الأولى: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾، وقال في الأخرى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾، فالنساء أكثر إغراء على الزنى، والسرقة في الذكور أكثر منها في الإناث[18].
وقد قُدّمت الأنعام لكونها أكثر من الناس في قوله تعالى: ﴿تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ﴾ [السجدة: 27]، مع مناسبتها لذِكْر الزرع المتقدّم عليها في قوله: ﴿فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا﴾، وأخّرت الأنعام في قوله تعالى: ﴿مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ﴾ [النازعات: 33]، تشريفًا للناس على الأنعام. وتقدّم ذِكْر الشمس في القرآن حيث وقع؛ لأنها أكثر ضياء من القمر، بل هي مصدر نوره، إلّا في قوله تعالى: ﴿خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا * وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا﴾ [نوح: 15- 16]، وقد حاول السيوطي تعليل ذلك فلم يفلح، فقال تارة: لمراعاة الفاصلة -أي: ختام الآية-، وقال تارة أخرى: لأنّ انتفاع أهل السماوات العائد عليهن الضمير به أكثر[19]، ولا دليل على ما تقدّم من قوله، ولعلّ السر في ذلك هو أنّ القرآن في حكايته عن نوح -عليه السلام- ودعوته في قومه قال: ﴿رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا﴾ [نوح: 5]، قال ذلك في مستهلّ حديثه عند دعوة قومه، فناسب بعد ذلك تقديم القمر على الشمس لتقدّم الدعوة بالليل على الدعوة بالنهار، والقمر آية لليل كما أن الشمس آية النهار، والله أعلم بأسرار كلامه. وكثر في القرآن تقديم البرّ على البحر، والليل على النهار، والسماء على الأرض، والظلمات على النور، والأرض على الجبال، والعشيّ على الإبكار؛ مجاراةً لكثرة الاستعمال عند الناس، مع أنه بدأ أحيانًا بما أخّره في تلك المذكورات؛ مراعاةً لأغراض بلاغية أخرى.
ومن مرامي التقدّم والتأخّر في كتاب الله اتّباع الترتيب السببي أو الشرَفي أو الزمني؛ فيتقدّم السبب على المسبب، والسابق زمنًا على اللاحق، والأشرف على الأقلّ شرفًا، وهذا كثير في القرآن: كتقديم العزيز على الحكيم؛ لأنّ الله تعالى عزّ فحَكَم، وتقديم العليم على الحكيم؛ لأن الإحكام ناشئ على العلم، وقد يخالف القرآنُ هذه القاعدة مراعاةً للسياق، كما في قوله تعالى: ﴿وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَى أَزْوَاجِنَا وَإِنْ يَكُنْ مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ﴾ [الأنعام: 139]، قدّم الحكيم على العليم؛ لأنّ الآية واردة في مقام تشريع الأحكام. وفي مقام الفصل في الأحكام قدّم صفة الحكمة على العلم، كذلك عند امتنانه سبحانه على داود وسليمان بما رزقهما من هاتين الصفتين في قوله: ﴿وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا﴾ [الأنبياء: 79]، بعد قوله: ﴿إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ﴾ [الأنبياء: 78].
ولأنّ الإيمان بالله والرسول أصلٌ وسببٌ في الإيمان ببقية المعتقدات من ملائكة وكتب ويوم الآخرة، فقد قدّمه القرآن في كثير من آياته؛ كقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ﴾ [النساء: 136]، وفي الآية نفسها خالف الترتيب بعد ذلك مراعاةً لمرتبة النزول من معرفة الخالق إلى معرفة الخلق[20]، فثنّى بالملائكة والكتب ثم الرُّسل واليوم الآخر، فقال في تتمة تلك الآية مبينًا مصير من ضيَّع الإيمان: ﴿وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا﴾ [النساء: 136]، فتأخّر ذِكْر الرُّسُل ولم يقترن بلفظ الجلالة كعادته، وقال تعالى مقدِّمًا الإيمان بالله والرسول: ﴿وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا﴾ [النور: 47]، وقال تعالى في تقديم طاعته لأنها أصل في طاعة الرسول وأولي الأمر: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾ [النساء: 59]، فتأخّر الإيمان بالله واليوم الآخر في هذه الآية؛ لأنه صار غايةً وشرطًا في الطاعة المتقدّمة.
وقد يختلف اللفظ بالتقديم والتأخير باختلاف السبب الذي دعا إليه الخطاب في الآية، مثل قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ﴾ [الأنعام: 151]، حيث قدّم كفالة رزق الآباء المخاطَبين على كفالة رزق الأبناء المقتولين؛ لأنّ سبب قتل الآباء لأولادهم في هذه الآية هو الفقر الواقع عليهم؛ لقوله: ﴿مِنْ إِمْلَاقٍ﴾، بينما يقدّم الأبناء على الآباء في سورة الإسراء (31) فيقول سبحانه: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ﴾؛ لأن الدافع إلى القتل ليس الفقر الواقع عليهم، بل هو خوف وقوعه في المستقبل، بدليل قوله: ﴿خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ﴾.
وقدّم التجارة لأنها سبب في اللهو وترك الصلاة فيمن تركوا النبي -صلى الله عليه وسلم- قائمًا، ثم أخّر التجارة عن اللهو لقصد التشنيع عليهم في تلبّسهم بذلك اللهو؛ تعريضًا بإهمالهم لخطبة النبي -عليه السلام-، وقد اجتمع ذلك التقديم والتأخير في آية واحدة هي آخر سورة الجمعة الآية 11: ﴿وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ﴾.
ولما كانت السُّكنى سببًا إلى الأكل من القرية قُدّمت في قوله تعالى: ﴿وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ﴾ [الأعراف: 161]. وقُدّم إحياء البلدة بالماء على سقي الأنعام الذي قُدّم على سقي الناس؛ لأنّ كلًّا منها سبب في الآخر، قال تعالى: ﴿وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا * لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا﴾ [الفرقان: 48- 49].
وقد يراعي القرآن السبق الزمني في ترتيب ذِكْر الأفراد أو الأشياء بعضها مع بعض، كما جرى في نسقِ ذِكْر الأنبياء في قوله تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ﴾ [الأحزاب: 7]، غير أنه تقدّم ذِكْر النبيّ -عليه السلام- المشار إليه بضمير الخطاب في هذه الآية تشريفًا له واهتمامًا بشأنه، ومن التقديم الزمني في أولوية ذِكْر الأنبياء وآلِهِم في قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ﴾ [آل عمران: 33]، وها هو في موضعٍ آخر يرتّبهم على حسب بيئاتهم وأنسابهم، حين قال في سورة الأنعام بعد حديثه عن إبراهيم مع قومه: ﴿وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ * وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِنَ الصَّالِحِينَ * وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ﴾ [الأنعام: 84- 86].
وقد يرتّبهم على حسب أحوالهم وطبيعة دعواتهم، كما في سورة النساء الآية 163: ﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا﴾، فقد تقدَّم ذِكرُ عيسى، وقرن يونس بهارون، وتقدّم سليمان على داود الذي هو والده.
وكثر في القرآن الكريم تقديم ذِكْر الليل على النهار، مجاراة لعادة العرب في تقديم الليالي في الحساب على الأيام، ومنه قوله تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا﴾ [الفرقان: 62]، وقوله تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ﴾ [الأنبياء: 33]، وقوله: ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ...﴾، ثم قوله: ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ﴾ [القصص: 71- 72]. ولكنه قدّم الصبح -وهو جزء من النهار- على اللّيل، في قوله تعالى: ﴿وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ * وَبِاللَّيْلِ﴾ [الصافات: 137- 138]؛ مراعاةً لِمَا يقتضيه السياق من أنّ مشاهدة الآثار بالنهار أوضح للمارِّين من مشاهدتها بالليل.
كما قدّم الإصباح على اللّيل في سورة الأنعام؛ لأنها في سبيل تعداد النّعم، ونعمة الصبح أعظم في حياة الناس، فقال تعالى: ﴿فَالِقُ الْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا﴾ [الأنعام: 96]، وقدّم اللهُ في كتابه الإنس على الجنّ مراعاةً للرُّتبة الشرفية، وأخّر الإنسان عن الجنّ في مواضع معدودة؛ مراعاةً لتقدُّم خلقِ الجِنّ عن الإنس وسعة قدرتهم، فالتكليف منوط بالإنس بالدرجة الأولى؛ لقوّة عقولهم وعمق تدبرهم، بخلاف الجنّ الذين هُم أضعف عقولًا من الإنس؛ ولذلك ذكرَ اللهُ الإنسان وحده في مقام الأمانة الشرعية، فقال: ﴿إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ﴾ [الأحزاب: 72]، ولم يذكر الجانّ في هذا الاختيار، وللسبب نفسه تقدّم لفظ الإنس في مقام التحدي بالقرآن: ﴿قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ﴾ [الإسراء: 88].
وقَدَّم اللهُ الجنَّ على الإنسِ عند مراعاة الرُّتبة الزمنية فهم أقدم خَلْقًا، فقد قال تعالى: ﴿وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ﴾ [الحجر: 27]، بعد ذِكْر خلق الإنسان من صلصال من حمأ مسنون، ومن الآيات التي تقدّم فيها ذِكْر الجنّ، قوله تعالى: ﴿يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ﴾ [الأنعام: 130]، وقد قال قبلها بنفس النسق: ﴿وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُمْ مِنَ الْإِنْسِ﴾ [الأنعام: 128]. وعندما تحدث القرآن عن قوّة سليمان قَدّم الجنّ على الإنس لتفوّقهم في ذلك، فقال: ﴿وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ﴾ [النمل: 17]، ومن مواقف القوّة التي استدعت تقديم الجنّ على الإنس، قوله تعالى في سورة الرحمن: ﴿يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوا لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ﴾ [الرحمن: 33]، فالمقام مقام التحدّي الإلهي للثقلَيْن، ولا شكّ أنّ الجنّ أقدر على اختراق الأجسام من الإنس، فبدأ بهم، وهذا من الدلالات البلاغية التي تبطل قول بعض المعاصرين من علماء الطبيعة ممن تصدّروا لتفسير بعض الآيات الكونية في القرآن الكريم، فقد زعموا أنّ الآية تدلّ على اهتداء الإنسان إلى غزو الفضاء، وهذا الاستدلال يُذْهِب بلاغة القرآن، وهو استنباط سقيم جاء على حساب اللغة والبلاغة؛ لأن الله يقول هذه الآية: ﴿سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَ الثَّقَلَانِ﴾ [الرحمن: 31]، فالله يتحدّى الإنس والجنّ على صعيد واحد وبقوّة مجتمعة على أن ينفذوا من أقطار السماوات والأرض، وإن حاولوا النفوذ، كمحاولة الجنّ في استراق السمع وهم لا يزالون في السماء الدنيا، يرسل عليهم الشواظ، فحفظ السماء من كلّ شيطان مارد وإنسيّ متطاوِل، قال تعالى: ﴿يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِنْ نَارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرَانِ﴾ [الرحمن: 35].
فالله يقول: ﴿فَلَا تَنْتَصِرَانِ﴾، وعلماء الطبيعة يقولون: إنّ الإنسان ينتصر بسلطان العلم، والسلطان المذكور في الآية هو القانون الإلهي الذي جعل محمدًا -صلى الله عليه وسلم- يخترق السماوات في رحلة المعراج؛ ﴿وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى * عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى * عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى﴾ [النجم: 13- 15].
ورُوعيت الرُّتبة الزمنية في سرد الكتب السماوية في بعض الآيات القرآنية، كقوله تعالى: ﴿وَأَنْزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ * مِنْ قَبْلُ هُدًى لِلنَّاسِ وَأَنْزَلَ الْفُرْقَانَ﴾ [آل عمران: 3- 4]، ومن ذلك قوله عزّ وجل: ﴿وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ﴾ [التوبة: 111]، وقد يراعي القرآن في موضع آخر الرتبة الشرفية، فيقدّم القرآن على غيره، كقوله: ﴿وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ﴾ [آل عمران: 199]، فقدّم القرآن الـمُنزَل على المخاطبين المسلمين على ما أُنزِل على أهل الكتاب، «منبهًا على فضيلته فضيلة المنزَل إليهم»[21].
وكثيرًا ما يلتزم القرآن بالترتيب العددي، وإن لم يلتزمه فلغرض بلاغي مقصود بترك التدرّج من العدد الأدنى إلى الأعلى، فقد التزم الانتقال من الأقلّ إلى الأكثر في قوله: ﴿مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ﴾ [النساء: 3]، وكذلك في قوله: ﴿مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ﴾ [المجادلة: 7]، وأمّا في قوله تعالى: ﴿قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَى وَفُرَادَى ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا﴾ [سبأ: 46]، «فوجب تقديم المثنى؛ لأنّ المعنى حثّهم على القيام بالتضحية لله وترك الهوى، مجتمعين متساوين أو متفرّدين متفكّرين، ولا شك أن الأهمّ حالة الاجتماع؛ فبدأ بها»[22].
ومن أغراض التقديم والتأخير الاهتمام بالمتقدّم، وعلى هذا النّسق جاء تقديم ذِكْر أقصى المدينة على ذِكْر الرجل الساعي بالدعوة الإيمانية في سورة يس، لـمّا قال عزّ من قائل: ﴿وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى﴾ [يس: 20]، يقول ابن عاشور في تحريره: «وفائدةُ ذِكْر أنه جاء من أقصى المدينة الإشارةُ إلى أنّ الإيمان بالله ظهر في أهل ربض المدينة قبل ظهوره في قلب المدينة»، ثم يقول معقِّبًا: «وبهذا يظهر وجه تقديم ﴿مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ﴾ على ﴿رَجُلٌ﴾؛ للاهتمام بالثناء على أهل أقصى المدينة»[23].
وقد جاءت الآية رقم (20) من سورة القصص بعكس ذلك؛ مراعاةً للأصل في الترتيب: ﴿وَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَى﴾؛ «إذ كان الرجل ناصحًا ولم يكن داعيًا للإيمان»[24].
غير أن الزركشي في (البرهان) يرى أنّ سرَّ تقديمِ أقصَى المدينة على الرجل في سورة يس مراعاةُ السياق، حيث قال: «لاشتمال ما قبله من سوء معاملة أصحاب القرية الرسل، وإصرارهم على تكذيبهم، فكان مظنّة التتابع على مجرى العبارة بتلك القرية ويبقى مخيلًا في فكره: أكانت كلّها كذلك، أم كان فيها على خلاف ذلك. بخلاف ما في سورة القصص»[25].
وقد يكون التخريجان متحقِّقَيْن في الآية، فلا تصادم بين رأي ابن عاشور ورأي الزركشي، فالقرآن الكريم أشمل من أن تحدّ آفاقه، وتحبس كلماته.
وفي قوله تعالى: ﴿لَقَدْ وُعِدْنَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا هَذَا مِنْ قَبْلُ﴾ [المؤمنون: 83]، اهتم القرآن بتقديم ضمير ﴿نَحْنُ﴾ وأخّر اسم الإشارة ﴿هَذَا﴾؛ لأنهم لم يُـمْعِنوا هنا في نكران البعث، فقد قالوا قبلها: ﴿أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ﴾، وفي سورة النمل قدّم اسم الإشارة ﴿هَذَا﴾ وأخّر ﴿نَحْنُ﴾؛ لشدّة نكرانهم، حيث لم يتدرّجوا في نكران البعث بذِكْر الموت قبل صيرورتهم ترابًا وعظامًا كما في سورة المؤمنون، حيث قال تعالى مصوّرًا فظاعة نكرانهم لبعثهم وبعث آبائهم: ﴿أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا وَآبَاؤُنَا أَئِنَّا لَمُخْرَجُونَ * لَقَدْ وُعِدْنَا هَذَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ﴾ [النمل: 67- 68]، وليؤكّد القرآن على وجوب اهتمام بني إسرائيل بدعاء الله في طلب المغفرة ومحو الذنوب على كلّ حال كانوا عليها، قدّمها تارة وأخّرها أخرى، فقال: ﴿وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ﴾ [البقرة: 58]، وقال: ﴿وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا﴾ [الأعراف: 161]، فهم قبل الدخول وعنده وبعده يجب أن يكونوا داعين ضارعين، وهم مأمورون بترديد تلك العبارة على أيّ منقلب، ولا معنى لِمَا قاله صاحب (البرهان)[26]، إنّ ذلك تفنُّن في الفصاحة، وإخراج الكلام على عدّة أساليب؛ لأنّ تلك الأساليب كلّ منها متميّز عن الآخر بفائدة بلاغية زيادة على وروده بوجه يخالف الأسلوب السابق تقديمًا وتأخيرًا، وإلا كان التفنّن تكرارًا لفظيًّا لا يليق بكلام الله المعجز، وقد وقع السيوطي فيما وقع فيه الزركشي عندما قال بهذا الغرض الذي يُساق على حساب معاني القرآن، فقال متكلمًا عن أغراض تقديم اللفظ في موضع وتأخيره في آخر، فجاء في (الإتقان): «وإمّا لقصد التفنّن في الفصاحة وإخراج الكلام على عدّة أساليب»[27]، ويستشهد بالآية السابقة، وبقوله تعالى: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ﴾ [المائدة: 44]، وقوله: ﴿قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى نُورًا وَهُدًى لِلنَّاسِ﴾ [الأنعام: 91]، كما أنه لا معنى لقولهم: إنّ التقديم والتأخير قد يأتي لغرض مراعاة التناسب بين الآي في نهاية الفواصل، فمراعاة صورة الألفاظ لا تكون على حساب أغراض المعاني، ومثلوا لذلك بقوله تعالى: ﴿فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَى﴾ [طه: 67]، وكلمة موسى التي زعموا أنها جاءت لمراعاة الفاصلة المختومة بالألف المقصورة في السورة، جاءت هنا لترفع التباسًا واقعًا في ذهن السامع بدون ذِكْر الكلمة، وهو أن الخائف قد يكون هارون وقد يكون فرعون وقد يكون موسى؛ فذكر اسم موسى ليدفع تلك الاحتمالات ويتحقّق للسامع أن الذي خاف وكتم خوفه هو موسى عليه السلام.
وكذلك الحال في الآيات الأخرى المشابهة يراعَى فيها المعنى قبل تناسب الفواصل، فالمضمون أَوْلَى بالعناية من الشَّكْل، ولا سيّما في القرآن المتفجر بالبلاغة والفصاحة، وما دمنا قد أشرنا إلى أمنِ اللّبس المتوهَّم في الآيات، فالأحرى أن نتكلّم عنه كغرض مقصود من أغراض التقديم والتأخير في القرآن الكريم بين آياته المتشابهة، وتلمّس ذلك جليًّا في المقارنة بين قوله تعالى من سورة المؤمنون: ﴿وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ الْآخِرَةِ وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ [المؤمنون: 33]، وبين قوله تعالى قبلها في نفس السورة: ﴿فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ﴾ [المؤمنون: 24]، فيذكر الزركشي سبب هذا الاختلاف قائلًا: «بتقديم الحال ﴿مِنْ قَوْمِهِ﴾ على الوصف ﴿الَّذِينَ كَفَرُوا﴾، ولو تأخّر: لتوهّم أنه من صفة الدنيا؛ لأنها ههنا اسم تفضيل من الدنوّ وليست اسمًا، والدنوّ يتعدّى بمِن»، وبين وجه الاشتباه في تأخير الحال: «وحينئذ يشتبه الأمر في القائلين أنهم من قومه أم لا؟»[28].
وفي الآية الأخرى أُمِنَ اللبسُ المتوهَّم في الآية التي أوردنا كلام صاحب (البرهان) فيها، فلم يكن هناك داعٍ إلى تقديم الجار والمجرور ﴿مِنْ قَوْمِهِ﴾، فجرى الأسلوب على الأصل.
ومن هذا النوع تأخير ﴿الْكِتَابَ﴾ عن الجار والمجرور في صدر سورة الكهف: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا﴾ [الكهف: 1]؛ لئلا يتوهّم أنّ نفي العِوَج متعلّق بالرسول المذكور بوصف العبودية، وعندما أُمِنَ هذا اللبسُ في مفتتح الفرقان لم يتقدّم الجار والمجرور، بل تأخّر على الأصل، فقال تعالى: ﴿تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا﴾ [الفرقان: 1]، كما أنّ ختام الآية متعلّق بالنبي عليه الصلاة والسلام، حيث إنه نزل عليه القرآن مِن أجلِ الإنذار.
ولذات السبب أخّر القرآنُ عبارة: ﴿مِمَّا كَسَبُوا﴾ في موضع وقدّمها في موضع آخر: ﴿لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِمَّا كَسَبُوا﴾ [البقرة: 264]، ﴿لَا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَى شَيْءٍ﴾ [إبراهيم: 18]، فكان تأخير الكسب في البقرة لردّ الخطأ المتوهَّم في قوله تعالى في ختام الآية ﴿وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ﴾ [البقرة: 264]، متعلّق بعدم القدرة في قوله: ﴿لَا يَقْدِرُونَ﴾ بل المتعلّق بها هو قوله: ﴿عَلَى شَيْءٍ﴾، وأخّر الجار والمجرور على شيء في سورة إبراهيم لكي لا يتوهّم السامع أنّ قوله: ﴿ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ﴾ [إبراهيم: 18] في ختام الآية مقتصر على الكسب وحده، بل يشمل وصف الكفر كذلك المتقدّم في الآية.
ولردّ الخطأ المتوهَّم قال تعالى: ﴿فَقَالُوا أَبَشَرًا مِنَّا وَاحِدًا نَتَّبِعُهُ﴾ [القمر: 24]، فقدّمت صفة البشرية -كما يقول علماء البلاغة- «لردّ الخطأ في التعيين، أو لردّ الخطأ في الاشتراك حسب ما يقتضي سياق الكلام»[29]، أي: إنّ الإنكار واقعٌ على المفعول به المقدّم وليس على وصف الوحدانية، أو لكونه منهم لا من غيرهم، يؤيده قوله تعالى على لسان الكفار في الإسراء الآية (94): ﴿أَبَعَثَ اللهُ بَشَرًا رَسُولًا﴾.
وبعد: فلا ندّعي بأننا وقفنا على جميع أغراض التقديم والتأخير في الآيات المتشابهات بالتكرار، بل إنّ للعقول في القرآن مجالًا أرحب، وطريقًا أطول، فما نقلناه من أعلام التفسير والبيان، وما ارتأيناه على حسب قدرتنا المحدودة ما هو إلا غيض من فيضِ منابع بلاغة القرآن، وقد يكون للآيات التي أوردناها تأويلات أخرى أَوْلى بالاتّباع، وأغراض أُخر أَوْلى بالقبول، فعلينا جميعًا أن نجتهد في كشف الجوانب الإعجازية للبلاغة القرآنية، ولعلّ القرائح الموهوبة المهذّبة ستأتي في هذا الميدان بما يبهر القلوب وينير الأذهان.
[1] نُشرت هذه المقالة في مجلة (كلية الدعوة الإسلامية) بالجماهيرية الليبية، العدد التاسع، سنة 1402هـ/ 1992م، ص170. (موقع تفسير)
[2] انظر: دلالات التركيب، د/ محمد حسنين أبو موسى، ص279.
[3] الكشاف، للزمخشري (3/ 135).
[4] دلائل الإعجاز، ص82.
[5] دلائل الإعجاز، ص135.
[6] مجمع البيان (19/ 97).
[7] التحرير والتنوير (14/ 8).
[8] التحرير والتنوير، محمد الطاهر بن عاشور (19/ 218).
[9] تفسير النيسابوري (27/ 91).
[10] انظر: الإتقان (2/ 17 و18).
[11] الإعجاز الفني في القرآن، عمر السلامي، ص118.
[12] الإعجاز الفني في القرآن، عمر السلامي، ص118.
[13] الإعجاز الفني في القرآن، عمر السلامي، ص117.
[14] البرهان، للزركشي (3/ 249).
[15] التحرير والتنوير، محمد الطاهر بن عاشور (6/ 174).
[16] التحرير والتنوير، محمد الطاهر بن عاشور (6/ 174).
[17] انظر: تفسير النيسابوري (4/ 36).
[18] انظر: الإتقان، للسيوطي (2/ 20).
[19] انظر: الإتقان، للسيوطي (2/ 19).
[20] انظر: أضواء على متشابهات القرآن، خليل ياسين (1/ 179).
[21] البرهان (3/ 245).
[22] البرهان (3/ 246).
[23] التحرير والتنوير، محمد الطاهر بن عاشور (22/ 365).
[24] التحرير والتنوير، محمد الطاهر بن عاشور (22/ 266).
[25] البرهان (3/ 284).
[26] البرهان (3/ 287).
[27] الإتقان (2/ 21).
[28] البرهان (3/ 234).
[29] من أسرار اللغة، د. إبراهيم أنيس، ص333.


