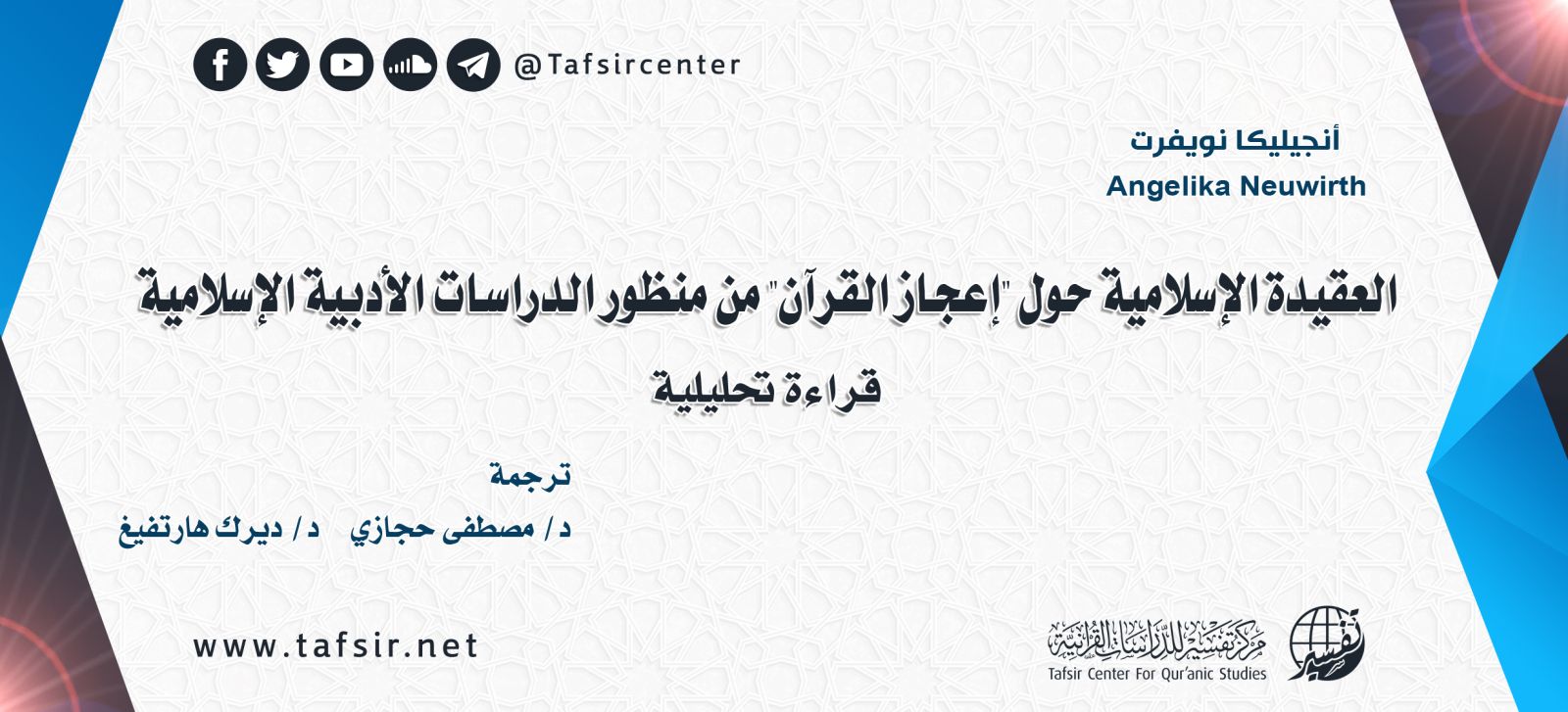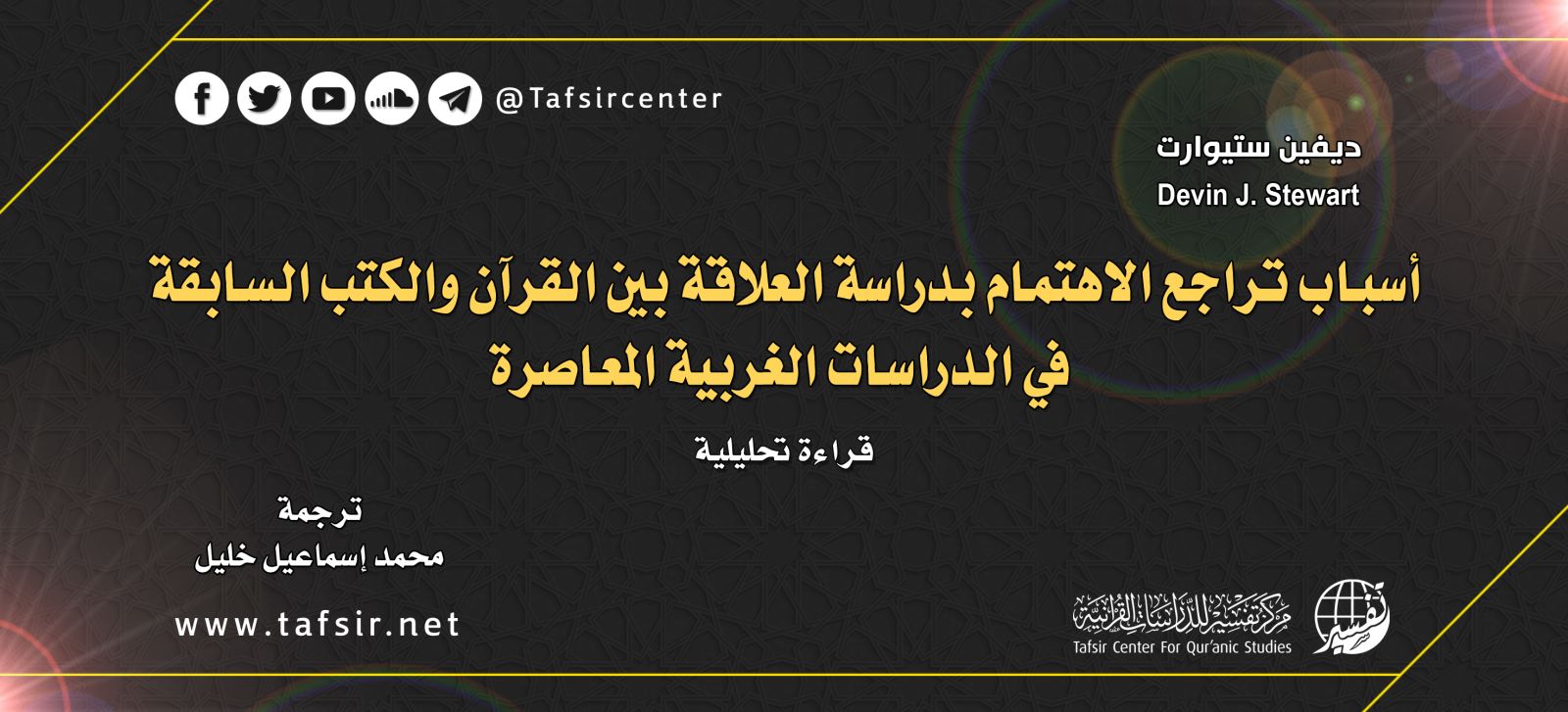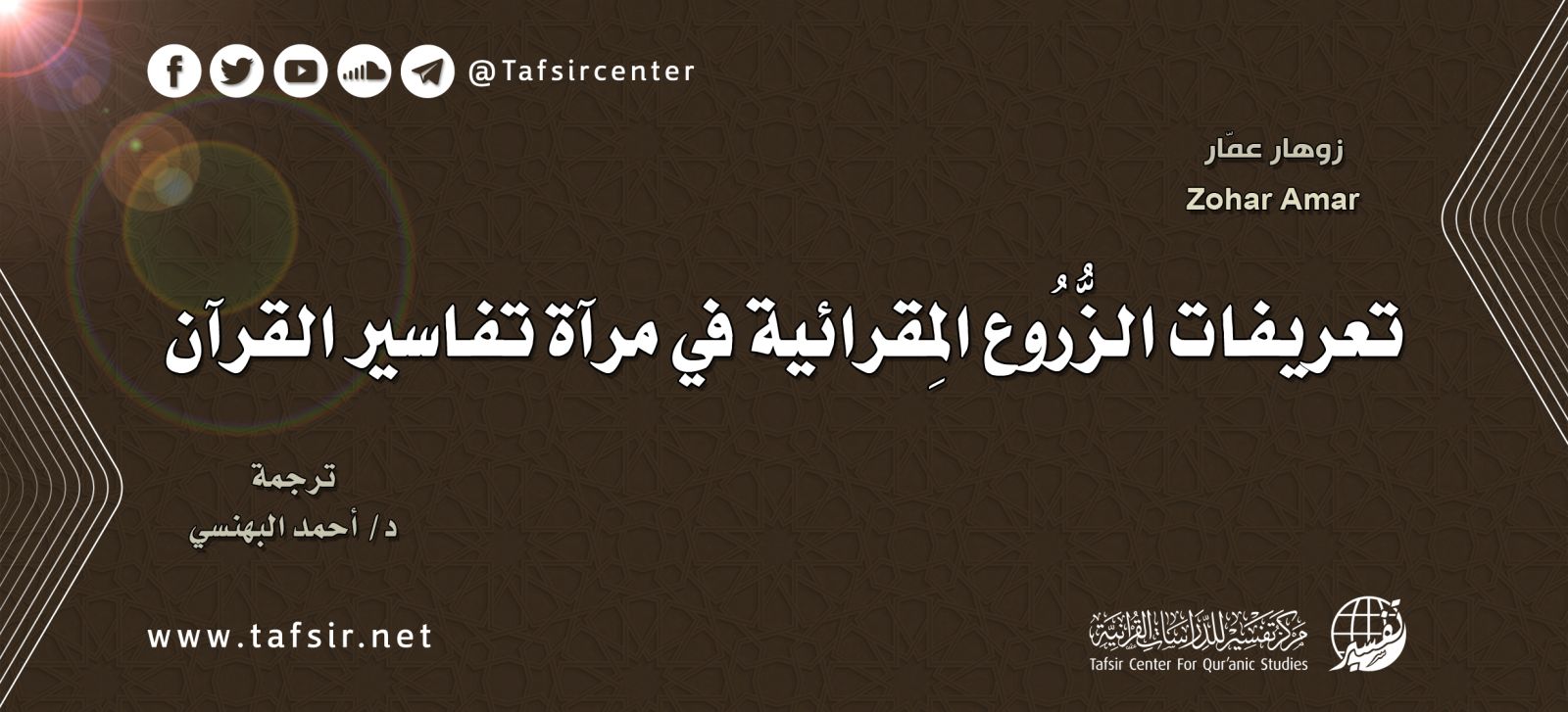القرآن والكتاب المقدّس؛ إطلالة على بعض الدراسات المعاصرة حول العلاقة بينهما
إطلالة على بعض الدراسات المعاصرة حول العلاقة بينهما

القرآن والكتاب المقدس
إطلالة على بعض الدراسات المعاصرة حول العلاقة بينهما [1][2][3]
ريفين فايرستون[4]
في عام 1988، بلغ عدد الجماعات الدينية داخل الولايات المتحدة التي صنّفها معهد دراسة الدين الأمريكي 1667 جماعة دينية مختلفة؛ 836 منها مصنّفة على أنها «ديانات غير تقليدية»، منها ما لا يقلّ عن 500 ديانة نشأت بدايةً من منتصف القرن [العشرين][5]. ومع أنّ الولايات المتحدة منذ نشأتها مثّلَت أرضًا خصبة لنمو وظهور الحركات الدينية الجديدة، إلا أنّ العالم بأسره قد شهد موجةً غير مسبوقة من ابتداع ديانات ونِحَل جديدة، والمسارعة في الانتماء إلى مختلف الحركات الدينية خلال فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية، وربما لا يمكننا رصد موجة مماثلة في التاريخ سوى ما شهدته الإمبراطورية الرومانية خلال القرن الأول بعد الميلاد[6]. وبالطبع، اندثرت معظم تلك الديانات الجديدة القديمة -مثل الميثرائية أو اليهودية الهلنستية- ولم يبقَ منها سوى عدد قليل فقط مثل المسيحية واليهودية الحاخامية. لحُسْن الحظ، كان انتشار الحركات الدينية الجديدة في الولايات المتحدة بمنزلة مختبر لباحثي سوسيولوجيا الدِّين؛ ومن بين القضايا التي حظيت بقدر من الدراسة هو سؤال: ما الذي يجعل دِينًا جديدًا، قادرًا على البقاء والانتشار؟
طوال العقدين الماضيين، حظي كتاب رودني ستارك Rodney Stark ولورانس إناكوني Laurence Iannaccone وويليام سيمز بينبريدج William Simms Bainbridge بنصيب الأسد من التأثير على الأجوبة المقدَّمة على هذا السؤال وغيره من المسائل المتعلقة بالديانات الناشئة[7]. يرى ستارك أنّ الدِّين أو النِّحْلة الجديدة لكي تنجح يجب أن تحافظ -من بين أمور أخرى- على استمرارية ثقافية مع النُّظُم الدينية للمجتمعات التي تظهر فيها، وفي نفس الوقت تحافظ على مستوى معيّن من الشدِّ والجذب مع البيئة المحيطة بها[8]. يمكن للمرء أن يلاحظ بسهولة هذا الشدّ والجذب مع ظهور الدين الكتابي اليهودي والمسيحية؛ فقد احتفظ كلاهما بجوانب من الثقافات الدينية التي كانت قائمة آنذاك، وفي نفس الوقت اختطّ كلٌّ منهما لنفسه برنامجًا معقّدًا لمراجعة تلك الثقافات وتنقيحها وإعادة تفسيرها، وهذا ما حدث مع الطقوس والتقاليد الدينية الكنعانية في حالة الدين الكتابي اليهودي، والواقع الديني التوراتي واليوناني الروماني في حالة المسيحية.
علاوة على ذلك، فلكي ينجح دينٌ جديد، يجب أن يُعَدّ أصيلًا، وهو ما يحدث عادةً من خلال دمج واقع مألوف من الأديان السابقة. ولكن إذا كان الدين الجديد لا يعدو كونه نسخة من دين قائم بالفعل، فإنه سيفشل في تمييز نفسه عن الأديان الأخرى، وبالتالي لن يكون له جاذبية خاصّة. وكما قال ستارك؛ يجب أن يكون خارجًا عن المألوف، ولكن بدرجة لا تجعله شاذًّا جدًّا. بمعنى أن هذا الدِّين الجديد يجب أن يُثبِت صحّته من خلال مشابهته للدِّين الأصيل، ولكن في نفس الوقت يجذب الأتباع من خلال إثبات فرادته وتميّزه عنه. وأكثر ما تتضح فيه هذه العملية هو الكتاب المقدّس، حيث تظهر اللغة والسرد والموضوع والأسلوب والحِكَم الخاصّة بالنصوص الدينية السابقة بأشكال وسياقات جديدة في النصوص المقدّسة للأديان الناشئة.
يمكننا أن نلاحظ من تجربتنا الخاصّة أنّ الأديان الجديدة تظهر في بيئة جدلية؛ بمعنى أنّ الأديان الرسمية/ الراسخة تقف بالمرصاد للتهديد الذي يمثّله الدين الجديد، وتحاول نزع الشرعية عنه، في حين أنّ الدين الناشئ حديثًا يتنبأ باندثار الدِّين (أو الديانات) الرسمية، ويؤكّد على عجزها عن تلبية الاحتياجات الروحية أو الاجتماعية للجيل الجديد. وباختصار؛ لا يمكن للأديان الرسمية/ الراسخة أبدًا قبول ظهور حركات دينية جديدة؛ ولذا فإنّ تلك الديانات ستحاول حتمًا التخلّص من النِّحَل الجديدة. يمكن للحركات الدينية الجديدة أن تنجح فقط عندما تدمج العديد من العناصر المركزية للأديان الرسمية في نفس الوقت الذي تتنبأ فيه باندثار التقاليد ذاتها التي اكتسبت منها العديد من سماتها الأساسية. ومرة أخرى، يمكن ملاحظة هذه العلاقة الجدلية في الكتاب المقدّس، الذي يسجّل بشكلٍ واضح التوترات التي نشأت بين الدِّين الجديد الذي يمثّله والدِّين (أو الأديان) الرسمية التي نشأ منها، بشكل مباشر أو غير مباشر. ومن الواضح أيضًا أنّ الكتاب المقدّس العِبري لا يكفّ عن الإشارة إلى شرور وأهواء الكنعانيين وديانتهم[9]، ويشجب العهدُ الجديد مرارًا وتكرارًا غَدْرَ وخِسَّة اليهود والرومان اليونانيين ودياناتهم[10].
ليس القرآن استثناءً في هذا الأمر؛ إذ يعرض هو الآخر نفس الشدّ والجذب الموصوف هنا. في الواقع، يحتوي القرآن على العديد من أوجه الشَّبَه مع الكتاب المقدّس العبري والعهد الجديد، لدرجة أنه لا يمكن تصور وجوده بدون سلفٍ مِن شِقّي الكتاب المقدّس التي تمثِّل بالنسبة له نصوصًا حاضرة في الخلفية (نصوصًا ضمنية). والقرآن نفسه يعترف بتلك السِّمة من خلال ما اتسم به مِن طابع إحالي ظاهر؛ فمثلًا؛ كلمة ﴿وَإِذْ﴾ المنتشرة في كلّ موضع يقدِّم أجزاءً سردية، أصبح مفهومها لدى المخاطبين بالقرآن هو «اذكُر ما كان»[11]. ومِن ثَم؛ فكما هو الحال مع الكتاب المقدّس العبري والعهد الجديد، تكشف الطبيعة الجدلية للعديد من الإحالات القرآنية المقصودة للكتب التي سبقته عن البيئة الجدلية التي خرج فيها الإسلام[12].
وكما حدث في حالة اليهودية والمسيحية؛ لم يتوقّف الجدل بعد تثبيت دعائم الدِّين الجديد. ففي عالم اضطلع فيه الدينُ برسم معالم الإمبراطوريات، وغالبًا ما كان مسؤولًا عن رسم الحدود المحلية أيضًا، وحيث كان أتباع الديانات المختلفة على اتصال دائم بسبب القُرب الجغرافي وعمليات التبادل التجاري والسياسة الدولية =لم يكن ثَمّ بدّ من استمرار النقاش والجدل؛ وقد تضمّن الخطاب الجدلي بدوره فحصًا نقديًّا للكتب المقدّسة الخاصّة بالأديان القريبة.
تفاعل المفكّرون الغربيون[13] مع أوجه الشَّبه المذهلة بين القرآن والكتاب المقدّس منذ المرة الأولى التي احتكُّوا فيها بالوحي الإسلامي. ولكن حتى القرن العشرين، نادرًا ما تجاوزت اهتماماتهم الأغراض الجدلية إلى شكلٍ قريبٍ نوعًا ما مما نعتبره اليوم منهجًا موضوعيًّا أو علميًّا. (مع التأكيد على أن مساعي جيلنا الحالي قد تتعرّض لنقد مماثل من الأبحاث والدراسات المستقبلية). لقد أصاب النجاحُ العسكري والسياسي السريع للإسلام العالَـم المسيحي بصدمة هزّت أركانه، ويجب أن نضع في اعتبارنا أنّ المساعي الفكرية فيما قبل الحداثة التي خرجت مما نشير إليه اليوم عادة باسم «الغرب» كلّها تقريبًا قد أنجزها مفكرون دينيّون ذكور، قدّموا تلك الإسهامات تحت رعاية الكنيسة. وإنّ نجاحات الإسلام المستمرة على مستوى الفنون والعلوم، وكذلك على مستوى السياسة والجيش =قد هددت هؤلاء القادة، وانعكس هذا التهديد على قراءاتهم للقرآن.
لم تكن الروح الدفاعية الغربية مجرّد شأن فكري؛ وذلك أنّ الجيوش الإسلامية كانت تهدّد أوروبا من جميع الجهات تقريبًا لما يقرب من ألف عام. فقد مثّل المسلمون المور في إسبانيا تهديدًا للإمبراطورية الرومانية المقدّسة التي تزعّمها شارلمان ونسله حتى بعد هزيمة المسلمين على يد شارل مارتل عام 732م. كما استطاعوا الاحتفاظ بناربون مثلًا حتى 759م، وظلّ نموّهم واتساع رقعة نفوذهم في شمال إفريقيا وجنوب إيطاليا خطرًا لعدّة قرون بعد ذلك. من ناحية أخرى، فإنّ برَكَة خان -حفيد الزعيم المغولي جنكيز خان، وزعيم القبيلة الذهبية (الدولة المغولية) الذي غزا أكثر أجزاء روسيا وأوروبا الشرقية في القرن الثالث عشر- اعتنق الإسلام جاعلًا قبيلة الخانية أُمّةً مسلمة. أمّا التتار -وهو الاسم الذي عُرف به الشعب التركي والمغولي المختلط في السجلات الأوروبية- فقد هاجموا أقصى الشمال والغرب الأوروبي وهو ما يمثّل اليوم بولندا وليتوانيا. كما تمكَّن السلاجقة ثم الأتراك العثمانيون من انتزاع معاقل المسيحيين في الأناضول، والاستيلاء على بلغراد وبودا، قبل أن يُحكِموا قبضتهم على القسطنطينية، ومنها هدّدوا فيينّا نفسها في عامي 1529م و1683م. علاوة على ذلك، انطلقت الأساطيل الإسلامية من مختلف موانئ شمال إفريقيا للإغارة على أراضي أوروبا الغربية المطلة على البحر الأبيض المتوسط، ووصلت معارك أساطيلها البحرية حتى المحيط الأطلسي. وفي أواخر القرن السابع عشر، قام قراصنة مما يُعرف اليوم بالجزائر والمغرب بمداهمة جنوب إنجلترا وأيرلندا، حتى إنّ هجماتهم وصلت عام 1627م إلى أيسلندا[14]. في ظِلّ مناخ جيوسياسي كهذا، ليس من المفاجئ أن تتسم القراءات الغربية ما قبل الحديثة للقرآن بالطابع الجدلي.
بيدَ أنّ خوف أوروبا من الإسلام وبُغضها له كان وجوديًّا بقدر ما كان ماديًّا؛ إِذْ إنّ جذور مأزق المسيحية الوجودي كانت قد ترسخت حتى قبل ولادة النبي محمد. فقبل ذلك بحوالي خمسمائة عام، وجد المسيحيون أنفسهم في منافسة شديدة مع اليهود على المستقبل الديني للعالم اليوناني الروماني. فعندما اتّضح أنّ الأنظمة الدينية الوثنية القديمة لم تَعُد قادرة على تلبية الاحتياجات الروحية لمختلف الشعوب والطبقات في العالم؛ ظهرت حركات دينية جديدة، بيدَ أنها وجدت نفسها في منافسة شرسة فيما بينها على حيازة المقعد الديني للإمبراطورية. كان المتنافسان الأكثر نجاحًا هما اليهودية الحاخامية والمسيحية، واستطاعت المسيحية في نهاية المطاف تحصيل قبول أوسع بين الجماهير، لتصبح بذلك الدين الرسمي للإمبراطورية. وعلى إثر ذلك، حُظرت معظم الديانات الأخرى، لكن اليهودية ظلّت ديانة معترَفًا بها رسميًّا لأسباب قانونية ودينية على حدّ سواء. وبتحوّل الديانة المسيحية المنتصرة إلى الدِّين الرسمي للإمبراطورية الرومانية، رأى بعض المفكرين الدينيين والمدافعين عن المسيحية أنّ انتصارها هذا كفيلٌ بإثبات أنها الدِّين الحقّ؛ إذ كان الفهم السائد أنّ الله قد تدخل في التاريخ لإثبات حقيقة المسيحية، ليس فقط في مواجهة النظام الوثني للإمبراطورية القديمة، بل أيضًا في مواجهة سَلَفها المناوئ؛ ألَا وهو اليهودية. ولكن عندما انتصر الإسلام بعد ذلك على الإمبراطورية الرومانية المسيحية في القرن السابع، مستحوذًا على أغلى أراضيها وأماكنها المقدّسة، حتى هدّد القسطنطينية نفسها =تحطمت عقيدة التدخل الإلهي في التاريخ، ووقع أتباعها في مأزق شديد. في الواقع، طبّق المسلمون المنطق نفسه على عقيدة الجهاد الناشئة، حيث فُهِمَت فتوحات المسلمين على أنها إثبات لصحة الإسلام والدعم الإلهي لحملاته المستمرة. على إثر ذلك، قسّم الفكر الإسلامي السائد العالم إلى قسمين: «دار الإسلام»، وهي الأراضي التي يكون فيها الإسلام هو النظام الديني السياسي الحاكم، و«دار الحرب»، وهي الأراضي التي لم يصبح فيها الإسلام بعدُ هو النظام الديني المهيمن[15].
كان ردّ فعل العالم المسيحي على ذلك النجاح الهائل للإسلام هو تشويه سمعة ذلك الدين وكتابه المقدّس. لا تشير الكتابات التاريخية مِن حقبة ما قبل الحداثة إلى المسلمين بمصطلحات دينية بل عرقية؛ فهي لا تسمِّيهم مسلمين، بل تشير إليهم بالسارسن Saracens، أو الموريين Moors، أو الإسماعيليين، أو الأتراك، أو التتار، أو ببساطة تنعتهم بالكفّار[16]؛ وكلّ ذلك لتخفيف وقع الحقيقة المؤلمة أنّ أبناء الله قد لحقت بهم هزيمة نكراء من جماعة دينية أخرى. لقد كان ردّ المسيحيين أنّ الإسلام ليس الدِّين الحقّ، وأنّ محمدًا ليس نبيًّا صادقًا، وأنّ القرآن ليس وحيًا حقيقيًّا.
كان التصوّر السائد بين العلماء المسيحيين في العصور الوسطى هو أنّ القرآن ليس سوى مجموعة عشوائية من الوثائق البشرية التي ابتدعها محمد من عند نفسه، ثم جُمعت بعد وفاته، وزُعِم أنها كلمة الله[17]. ربما تأثّر هذا الرأي برسالة العربي المسيحي عبد المسيح الكندي[18]، التي يرجع تاريخها إلى أوائل القرن العاشر أو ما قبله، والتي أثبت فيها الصعوبات التي واجهها المسلمون خلال الفترة الإسلامية المبكّرة في جمع النص المعياري/ المعتمد للقرآن. كما تأثّرت آراء مسيحيّي العصور الوسطى عن القرآن أيضًا بالتمسّك المدرسي بالترتيب والنظام وتأكيد الاتجاه المدرسي على ضرورة أن تُبنى الأعمال المكتوبة وفق خطّة تنظيمية صارمة، وهو ما يتعارض مع ترتيب القرآن الذي بدا بالنسبة لهم عشوائيًّا.
ثم في أواخر العصور الوسطى وأوائل العصر الحديث ذهب الأوروبيون أيضًا إلى النظر إلى القرآن عبر مجموعة من الاعتبارات شكّلتها قراءاتهم الشخصية لكتابهم المقدّس. وهكذا مثلًا؛ اصطدم الوعد القرآني بالجنة المادية بالمفهوم المسيحي عن الحياة الروحية في الآخرة. وعلى الرغم من أنهم لاحظوا أوجه الشبه العديدة بين القرآن والكتاب المقدّس، إلا أنهم اعتبروا تلك المتوازيات شاذة وغريبة من الناحية الأدبية والمفاهيمية واللاهوتية. وغنيٌّ عن القول أنّ الجدل القرآني الموجَّه ضد المسيحيين (واليهود) وتأكيد القرآن على تحريف الشكل الموجود من الكتب السابقة =يستدعي ردودًا جدلية. هذه الملاحظات والعديد غيرها -مثل ما يبدو أنه تناقضات داخلية في القرآن، إلى جانب تناقضه مع الافتراضات الأخلاقية والعلمية السائدة التي شكّلت أساس الحياة الأوروبية في العصور الوسطى- أضيفت إلى الإدانة المسبقة للقرآن التي صاغها العلماء المسيحيون من العصور الوسطى. ومن هنا، لم يكن لدى معظم الأوروبيين في العصور الوسطى فضولٌ تجاه شيء غريب ويمثّل تهديدًا مثل القرآن، كما أن النظرة الأوروبية السائدة للعالم فيما قبل عصر التنوير قد قطعت على العلماء كلّ طريق للنظر في القرآن سوى طريق العداء والكراهية.
على عكس المسيحيين؛ لم يكن لدى اليهود الكثير ليقولوه عن الإسلام أو القرآن؛ إِذْ بسبب كونهم جماعة تفتقر إلى الاستقلالية السياسية منذ قرون قبل صعود الإسلام، لم يكن الإسلام يمثّل لليهود نفس التهديد الوجودي الذي مثّله للمسيحيين. بل في الواقع تبدو ردود الفعل اليهودية المبكّرة على الفتوحات الإسلامية إيجابية؛ لأنها على ما يبدو قد اعتبرت النجاحات العسكرية للمسلمين بمنزلة تصحيح إلهي للهيمنة المسيحية الظالمة[19]. ولكن بمجرد أن حلَّت الهيمنة الإسلامية -وما نتج عنها من دنوّ درجة اليهود- محلّ النظير المسيحي السابق، قدّم اليهود أيضًا تقييماتٍ للإسلام والقرآن لا يمكن القول إنها كانت مجامِلة أو غير منحازة. ولكن بسبب موقفهم الحساس، كانت الكتابات اليهودية أكثر تحفّظًا وحذرًا من نظائرها المسيحية[20].
تطلّب الأمر الانتظار حتى القرن التاسع عشر لتبدأ محاولات قراءة القرآن من خلال التطبيق الجادّ للأساليب النقدية غير الجدلية. شارك بضع عشرات من الباحثين الذين كتب معظمهم بالألمانية والفرنسية والهولندية والإنجليزية في هذا النوع من الأبحاث خلال الـ175 عامًا الماضية، وجميعهم تقريبًا وجدوا أنفسهم يشتغلون على المحتوى «الكتابي» الموجود فيه. ونظرًا لكثرة وتعقيد تلك الدراسات والمسائل التي طرقْتُها، سوف يقتصر هذا المقال على عدد قليل من الدراسات العلمية الأكثر أهمية، والتي يسهل الوصول إليها، والتي كُتبت بالإنجليزية أو توجد لها ترجمات إنجليزية.
إبراهام جيجر:
كان إبراهام جيجر (1810- 1874) من أوائل الدارسين الذين أحدثوا ثورة في دراسات الكتاب المقدّس والقرآن. نشأ جيجر يهوديًّا، وتلقّى التعليم الديني التقليدي الشامل، وقد تأثّر بشدة بروح التنوير وكان رائدًا في «الدراسات اليهودية Wissenschaft des Judentums»؛ وقد كانت آنذاك مجال بحث جديد ذا توجه تاريخي في دراسة الدين والشعب اليهودي[21]. بيدَ أنّ نطاق اهتماماته تجاوَز اليهودية، ففي سن الثانية والعشرين شارك ببحث باللاتينية في مسابقة برعاية كلية الفلسفة بجامعة بون تدعو الباحثين إلى تقديم أوراق بحثية حول موضوعات القرآن المستمدة من اليهودية. استطاع البحث الذي قدّمه جيجر -وتُرجِم لاحقًا إلى الألمانية بعنوان: ماذا أخذ محمد عن اليهودية؟- الفوز في المسابقة، وقُبِل لاحقًا باعتباره أطروحة للحصول على درجة الدكتوراه في جامعة ماربورغ[22]. واصَل جيجر دراساته عن اليهودية بنشاط، ولكن هذه الدراسة الرائدة تمثّل عمله الوحيد المخصّص للإسلام.
وكما هو واضح من عنوان تلك الدراسة، اعتقد جيجر أن القرآن هو كتابٌ بشريّ، وليس وحيًا إلهيًّا، وأن الشقّ الأكبر منه لا يعدو كونه إعادة تشكيل لعناصر مقتبَسة من اليهودية. لا يمكن القول إن شِقّيْ هذه الفرضية -أي أنّ القرآن ليس وحيًا إلهيًّا بل ابتداع بشري، وأنه مشتقّ إلى حدّ كبير من الكتب والأفكار التوحيدية السابقة- هي الجديد الذي أتى به جيجر. ولكن الجديد الذي فارق به جيجر أسلافه، هو أنه اشتغل على تلك النظرية المعرفية من الناحية النظرية والعلمية، وليس بالمصطلحات الدينية والجدلية. ورغم الاستحسان الذي نالته تلك الدراسة من كلّ المستعربين ودارسي الإسلام العظماء في عصره (والأجيال اللاحقة)، فقد انتقده بعض الباحثين بسبب قوله بأنّ محمدًا كان زعيمًا دينيًّا ذا حماسة صادقة. في مقدّمته للترجمة الإنجليزية لكتاب جيجر، والتي أُعيدت طباعتها عام 1970م، أشار موشيه بيرلمان Moshe Pearlman إلى أنّ المستعرب الفرنسي الشهير أنطوان إسحاق سيلفستر دي ساسي (1758- 1833) كتب أنّ آراء جيجر تتناقض مع آرائه القائلة بأنّ محمدًا كان «محتالًا بارعًا، عازمًا على كلّ ما قام به، ولا يردُّه شيء عن كلّ ما يمكن أن يخدم ويضمن نجاح مشاريعه الطموحة»[23].
لم يكن الهدف من مشروع جيجر هو تشويه سُمعة الإسلام، أو إضفاء المصداقية على اليهودية، بل الوصول إلى «الحقيقة»(وقد تعرّضت دراساته حول اليهودية لنقد مماثل). ولكنه يبدو لباحث اليوم ساذجًا ومسرفًا في إطلاق الأحكام إلى حدّ ما؛لأنه يعكس الوثوقية الفكرية الكبيرة التي كانت جزءًا من البيئة الفكرية التي عاصرها. تمكَّن جيجر من اطّراح عبء الحاجة إلى الدفاعيات الدينية، بيدَ أنه لم تكن له دراية بدقائق الدراسات الأنثروبولوجية الحديثة في التراث الشفوي ونقل الآثار، أو النظريات الأدبية الحديثة وما بعد الحداثية في التأليف والقراءة. بالنسبة لجيجر، فإنّ أوجه التشابه الأدبية واللغوية والمفاهيمية والطقوسية/ الفقهية التي يمكن ملاحظتها بوضوح بين الكتاب المقدّس والتقاليد اليهودية والقرآن -الذي ظهر بعدهم بقرون- تثبت التأثير الواضح للأُوَل على الأخير. ولكن حتى تلك الملاحظة بذاتها لم تكن جديدة؛ الجديد في مساهمة جيجر هو مقاربة إشكالية تلك العلاقة والتعامل معها من الناحية المفاهيمية وليس من باب الجدل والردّ، وبشكلٍ متماسك ومنهجي بدلًا من المقاربات العشوائية والمتهافتة منطقيًّا.
حدّد جيجر بوضوح في مقدّمته الموجزة المعايير التي سيعتمدها في بحثه، إِذْ كتب:
«وهكذا تنقسم هذه الرسالة إلى قسمين؛ على الأول منهما أن يجيب على الأسئلة الآتية: هل كان محمد يرغب في الاستعارة من اليهودية؟ هل كان بإمكان محمد أن يستعير من اليهودية؟ وإذا كان الأمر كذلك، فبأيّ وسيلة كانت تلك الاستعارة ممكنة له؟ وهل كانت الاستعارة من اليهودية متوافقة مع خطّته؟ أمّا القسم الثاني فيُقدّم الوقائع التي تثبت تلك الاستعارة، والتي قيل بوقوعها بناءً على أُسس عامة. وفقط بهذه الطريقة يمكن لبرهان فردي من النوع المشار إليه اكتساب قيمة علمية؛ باعتباره يسلِّط الضوء على طبيعة خطّة محمد من ناحية، وبإظهار الضرورة الجوهرية للحقيقة وأهميتها الفعلية بحكم ارتباطها مع وقائع أخرى من حياة محمد وعصره من ناحية أخرى»[24].
تألّفت طريقة جيجر من تحديد أوجه التشابه بين النصّ القرآني والأدب التوراتي والحاخامي الذي يمكن الوثوق بأنّ تاريخه يعود إلى ما قبل القرن السابع الميلادي، معتبِرًا تلك المتوازيات اللغوية والأدبية والمفاهيمية دليلًا على أن النصّ اللاحق قد استعارها من سابقه. كما ذهب جيجر إلى أن تلك الاستعارة كانت مباشرة؛ إِذْ نادرًا ما كان هناك وسطاء، كما عزا الاختلافات إلى وقوع أخطاء، وعادةً ما تكون تلك الأخطاء من جانب الجماعة التي تستعير، ولكنه في بعض الأحيان يعزوها إلى الجماعة الأقدَم (يهود المدينة غير المتعلِّمين). كما عزا بعض الاختلافات إلى التشويه المتعمّد من الزعماء المسلمين الجُدد للتقاليد/ المعرفة الدينية.
يتعامل جيجر مع فكرة أنّ محمدًا -وليس الله تعالى- هو مصدر القرآن باعتبارها أمرًا بدهيًّا مسلّمًا به في بحثه كلّه؛ فهذا القرآن هو «قرآن محمد»[25]، ومع ذلك ينسب جيجر إليه حماسة دينية صادقة. وفي نظر جيجر، اعتقد محمد أنه مرسَل من الله حقًّا؛ ومن ثم لم يجد حرجًا في وضع وتأليف كتاب مقدّس يمكن أن يخدم شعبه العربي، تمامًا مثلما خدمَت الكتب المقدّسة السابقة الموحِّدين السابقين[26]. يحاول جيجر -دون وعي- أن يدخل إلى ذهن مؤلِّف هذا الكتاب المقدّس، وتعكس نتائج تلك المحاولة نفس نتائج عمل ستارك وبينبريدج حول ظهور حركات دينية جديدة؛ فقد استعار محمد من اليهودية لكي يكون دينه الجديد معروفًا ومقبولًا لسكان الجزيرة العربية[27]، كما أتاح وجود الرموز والموضوعات الدينية المألوفة في دينه السلطة اللازمة لمشروعه[28]. من ناحية أخرى، لم يستطع محمد التوسّع في الاستعارة من اليهودية خشية اتهامه بالفشل في الإتيان بنظام ديني جديد[29]؛ إِذْ يجب أن تكون النتيجة النهائية لتلك العملية تركيبة دينية فريدة[30]، ومن ثَم كان مجبرًا على الحطّ من قَدْرِ التقاليد السابقة التي انبثق عنها دينه الجديد. وعلى الرغم من أن هذه الأخيرة هي ركنٌ من أركان الدين الناشئ، أصرّ جيجر (باعتباره ممثلًا حقيقيًّا لليهودية الليبرالية في القرن التاسع عشر) على أنّ محمدًا كان يُكِنّ احترامًا كبيرًا لليهود، على الرغم من عداوته تجاههم في نهاية المطاف[31].
وفقًا لجيجر، لم تقتصر استعارة محمد على اليهودية؛ فقد كانت التقاليد العربية والمسيحية قبل الإسلام بمنزلة المصادر الإضافية لقرآنه، لكن جيجر آثر الاقتصار على اليهودية فقط. يرى جيجر أنّ بعض الأفكار والقيم اليهودية قد خدمَت محمدًا جيّدًا، وأُدمجت في الإسلام كما هي؛ بينما في حالات أخرى، لاحظ جيجر بعناية الاختلافات الظاهرة -والخفية- بين المقاطع المتشابهة التي يستشهد بها. وقد فسّر هذه الاختلافات بطرق ثلاث: في بعض الحالات، اعتبر جيجر أنّ محمدًا شوّه أو حرّف التعاليم اليهودية عمدًا من أجلِ جعلِها تتناسب مع السياقات التاريخية والثقافية والطقسية والأخلاقية للبيئة التي كان يعمل فيها[32]. وفي حالات أخرى، لم يغيّر المعلومات التي تلقّاها من مخبريه، لكن الجماعة اليهودية غير المتعلمة في المدينة لم تكن تعرف ما تخبره به على وجهه الصحيح، وهو ما تسبب في وقوع التناقض. وأخيرًا، في بعض الحالات، سجّل محمدٌ المعلومات بشكلٍ غير صحيح؛ إمّا لأنه أخطأ فهمها، أو لأنه تلقّاها بصورة شفهية وليست مكتوبة، مما زاد من فُرص وقوع خطأ أكبر[33].
تجدر الإشارة إلى أنّ جيجر لم يعتبر أنّ مجرّد وقوع التشابه كافٍ لإثبات استعارة القرآن من اليهودية، إِذْ أدرك أن جميع الديانات التوحيدية تشترك في بعض الموضوعات؛ ولذا حصر بحثه في المفاهيم والأفكار والمصطلحات التي يمكن دراستها باستخدام الأدوات الفيلولوجية والأدبية والتاريخية التي كانت متاحة له. ففي فحصه لكلمة التابوت على سبيل المثال؛ هذا اللفظ القرآني مستعمل للإشارة إلى تابوت العهد (كما في سورة البقرة: 248)، وكذلك الصندوق الذي وَضَعَت فيه أُمّ موسى رضيعها (كما في سورة طه: 39، وانظر: سفر الخروج 2: 3)، لاحظ جيجر أنّ النهاية (وت) هي لاحقة غير طبيعية/ غير مألوفة في اللغة العربية، وأرجع أصلها إلى الآرامية اليهودية، مستشهدًا بشبيهها العبري: تيبوتا (têbûtâ) مع ملاحظة وجود تلك اللاحقة أيضًا في الآرامية المسيحية. وإلى جانب هذا الفحص الفيلولوجي، لاحظ جيجر الاستخدام الغريب للمصطلح القرآني الذي جمع في دلالته بين الصندوق العائم مع نظيره التوراتي (teebâ) والتابوت المقدّس الذي يُشار إليه كتابيًّا بـ(arôna). ولكن في اللغة العبرية في مرحلة ما بعد الكتاب المقدس، فإنّ المصطلح الشائع للتابوت في الكنيس -وهو نفسه مشتقّ من تابوت العهد الموجود في خيمة الاجتماع، ولاحقًا في الهيكل- هو(teebâ)، وهذا يشي باستعارة اللفظ من سياق الأدب العبري الحاخامي، وليس من الكتاب المقدّس العبري.
إنّإلمام جيجر الموسوعي بتفاصيل الآداب اليهودية (قبل ظهور فهارس جيدة، فضلًا عن قواعد البيانات باستعمال الحاسوب) أمرٌ مذهل. لقد كان منهجه بالتأكيد وضعيًّا واختزاليًّا، لكنه في هذا الصدد ليس سوى انعكاس لنمط الفكر في عصره، والذي كان يفحص الأصول النصّية والأيديولوجية الرئيسة التي تُبنى عليها النصوص من أجلِ الكشف عن مصادرها.
تبدو بعض افتراضات جيجر متناقضة تمامًا مع كثيرٍ مما نعاني تجاهه اليوم من حساسية بالغة، ولعلّ الأكثر وضوحًا في ذلك هو ثقته الهائلة بأنه يستطيع الكشف بصورة قاطعة عن الحقيقة البسيطة الكامنة وراء سؤال التناص بين القرآن والكتاب المقدّس. والثاني هو رأيه في وضع القرآن، والذي ينسبه كلَّه -بثقة- مباشرةً إلى محمد. لاحظ جاكوب لاسنر مؤخّرًا كيف أن طريقة جيجر؛ على الرغم من أنه استبق عصره من نواحٍ كثيرة، إلا أنها استندت إلى افتراضَين مشكوك فيهما، ولكن أفضل مستشرقي عصره كانوا يؤيدونهما: «الأول أنّ نقل النصوص الأدبية الإبداعية بدأ بوعي وجرت برمجته بعناية بواسطة المسلمين. والثاني أنّ تلك النصوص نفسها كانت دائمًا واضحة ومميزة بالنسبة لمن استعاروها. وإنّ أيًّا منهما لا يعكس التفاعل المعقد للثقافات المرتبطة ارتباطًا وثيقًا، خاصّة في المراحل المبكّرة والسائلة من هذا الاتصال»[34].
رغم كلّ مثالبه، يمثّل عمل جيجر بداية جديدة للدراسة المقارنة النقدية للقرآن والكتاب المقدّس. ولا تزال دراسته الصغيرة تلك، وذات التأثير الهائل -رغم أنه قد مَرّ عليها ما يقرب من قرنين من الزمان- نقطة انطلاق لكثير من الباحثين المهتمِّين بسبر العلاقة المعقَّدة بين الكتاب المقدّس والقرآن.
ريتشارد بيل:
كتب الإسكتلندي ريتشارد بيل أعظم وأهمّ أعماله بعد قرن من كتاب جيجر، وخلال ذلك القرن، شهدت الدراسات القرآنية والكتابية الكثير من التطوّرات. في أواخر ثلاثينيات القرن الماضي ظهر كتاب «القرآن مترجمًا مع إعادة ترتيب نقدي للسور The Qur’an Translated, with a critical re- arrangement of the Surahs» في مجلّدين[35]، ولكن بسبب سِعره الباهظ في الولايات المتحدة[36] واندلاع الحرب العالمية الثانية لم يكن له في البداية تأثير يُذْكَر على الحقل العلمي. والآن -بعد أكثر من نصف قرن- لا يزال منهج بيل واستنتاجاته حاضرة ومؤثّرة على الدراسة النصّية النقدية للقرآن، ولكن ذلك لم يخلُ من بعض الجدل (انظر ما يلي). كانت خطّة بيل في الأصل تقضي بنشر ملاحظاته المسهبة التي دوَّنها أثناء كتابة ترجمته، ولكن حالت تكاليف الطباعة بينه وبين تنفيذ خطته، لتُطبع تلك الملاحظات وحدها بعد حوالي أربعين عامًا من وفاته في عام 1991 تحت عنوان: تعليقٌ على القرآنA Commentary on the Qur’an .[37].
كانت أكبر إسهامات بيل هي «محاولته المفصّلة... تحديد وتأريخ الوحدات الأصلية المكوّنة للوحي القرآني»[38]. منذ أقدم الدراسات القرآنية والمحاولات جارية حتى الآن لإعادة ترتيب ما يبدو أنه ترتيب عشوائي لسور القرآن. وفقًا للسيوطي[39]، فقد صنّف العلماء المسلمون السور القرآنية إلى مكية ومدنية، وذلك التقسيم يعود إلى فترة ابن عم النبي محمد: ابن عباس (ت: 688م)، وقد اشتمل هذا التصنيف على اعتبار وجود عدد قليل من الآيات المدنية ضمن السور المكية، والعكس؛ وهذه غايةُ ما وصل إليه تصنيف المسلمين لسور القرآن. حاول الباحثون الغربيون استكشاف التسلسل الزمني للسور بمزيد من التفصيل، لكنّ كلًّا من الدراسات الإسلامية التقليدية والغربية النقدية افترضت أنّ السور كانت وحيًا متصلًا إلى حدّ كبير[40]. بيّن بيل أن السور أكثر تعقيدًا مما يفترض عادة، وأن الشّكل الحالي للقرآن هو نتيجة التحرير الدقيق، والمراجعة، وأحيانًا استبدال المقاطع. كانت نتيجة بحثه عبارة عن ترجمة منشورة مُرتبة في الصفحة وفقًا لنظام من الأعمدة والمربعات، تتخللها خطوط منقطة بغرض عمل تعبير مرئي عن شيء من عملية التنقيح المعقدة. ليست فقط الآيات (التي قد تتكون من عدّة جُمَل) هي التي ترتبط بعضها ببعض في الصفحة، ولكن أيضًا الجُمَل المستقلّة أو حتى العبارات موضوعة بهذه الصورة، مصحوبة فقط ببعض الهوامش والمقدّمات الموجزة لكلّ سورة. وهكذا فإنّ ترجمته للقرآن التي كتبها في مجلدين تمثّل نتائج دراسته النصية، أمّا تعليقه المكوّن من مجلدين فيشرح معنى بحثه من خلال فحص مفصّل للنصّ القرآني وتناصّه الداخلي المعقَّد.
يرى بيل أن التغيير المفاجئ في طول الآيات، أو التباين في استعمال المفردات، أو التغييرات المفاجئة في أنماط القافية، أو التحوّلات غير المبرّرة في الضمائر الشخصية، أو الانقطاع المفاجئ في تسلسل الفكرة =هي كلّها علامات على وقوع التحرير والتنقيح[41]. ويرى أنّ أقوى سبب لهذه التحوّلات النصّية هو تزايد معرفة محمد وفهمه للمسيحية واليهودية، الأمر الذي فرض إعادة معالجة وإعادة كتابة أو إعادة صياغة سياق النصوص التي كُتبت سابقًا. ومن ثَم، أصبح إدراك محمد المتزايد وفهمه للتقليد التوحيدي السابق هو المحور الذي يدور حوله وحيه المستمر، وقد أجرى محمد نفسُه معظم تلك التنقيحات، ولكن العمل عليها استمر إلى حدٍّ ما بعد وفاته.
أثار ادّعاء بيل بأنّ محمدًا تعامل مع الآيات والأجزاء المكوّنة لها بآلية القص واللصق -وهي عملية لا تختلف كثيرًا عن تلك التي قام بها بيل نفسه في ترجمته- ردّ فعل قوي من كلٍّ من المسلمين التقليديين والباحثين الغربيين؛ أمّا المسلمون فقد كان ردّ فعلهم سلبيًّا بسبب جرأته على التلاعب بترتيب ونظام سُوَر الوحي، ومن ثم خلخلة معانيه (بالإضافة إلى افتراضه أنّ محمدًا فعل الشيءَ نفسَه)، بينما كان ردّ فعل الباحثين الغربيين مختلطًا تجاه كلٍّ من افتراضاته المنهجية والتاريخية ونتائجه الجزئية. ومهما يكن من أمر، فلا شك في أنّ عمل بيل التاريخي الرائد والمبني على نقد الشكل (form- critical) قد أثّر بشكل مباشر أو غير مباشر تقريبًا على جميع الدراسات النقدية المعاصرة حول القرآن.
تطوّرت مقاربة بيل للقرآن أثناء تحضيره لسلسلة من المحاضرات لتقديمها للقساوسة وطلاب الكهنوت في قاعة اللاهوت بجامعة إدنبرة في ربيع عام 1925. رأى بيل أن الدراسات السابقة قد ركّزت على إظهار تقارب القرآن الوثيق نصيًّا ولغويًّا مع اليهودية، مع عدم إيلاء اهتمام كافٍ للمساهمة المسيحية في ظهور الإسلام. ومن هنا، عرضَت محاضراته السبع وجهة نظره للعلاقة بين الاثنين من خلال استكشاف المسيحية وتأثيرها على شبه الجزيرة العربية قبل ولادة محمد، ثم موضعة مهمّة محمد النبوية ليس فقط من حيث علاقتها باليهودية العربية، ولكن أيضًا من حيث علاقتها بالمسيحية العربية. ثم قام بمراجعة تلك المحاضرات والزيادة عليها حتى وصلت إلى كتاب من سبعة فصول نُشر في العام التالي باسم: أصل الإسلام في محيطه المسيحي The Origin of Islam in Its Christian Environment[42].
رغم أنّ نيّته في الأصل كانت استكشاف طبيعة اتصال محمد بالمسيحية قبل تلقّي الوحي، اكتشف بيل أنّ «القرآن نفسه يحتوي على سجلِّ جهوده للوصول إلى معرفة ضئيلة بالدّين العظيم الذي أحاط بالجزيرة العربية»[43]؛ وانطلاقًا من هذا الأساس، شرع بيل في دراسة مكثفة للقرآن تبيّن علاقته بالمسيحية، وفي سياق التاريخ التقليدي المقبول عمومًا لأصول رسالة محمد النبوية وتطوّرها اللاحق.
وعلى غرار جيجر، سلّم بيل بالمصداقية العامة للتاريخ الإسلامي التقليدي لأصول مهمة محمد النبوية وتطوّرها اللاحق، ولم يستشكل منه فقط سوى بعض التفاصيل. يقسم بيل مسيرة محمد النبوية إلى ثلاث فترات[44]؛ تمثّل أقدمها بدايات مهمّته في مكة. وخلال تلك الفترة، تسود «الإشارات/الآيات» وتمجيد الله، ويحمل الوحي شعورًا عميقًا بالامتنان للإله الواحد الأعلى، وفي نفس الوقت لا تظهر أيّ علامة تشير إلى وعيٍ من أيِّ نوع بدين يسمّى المسيحية. بيدَ أن هذا لا يعني أن المسيحية لم يكن لها تأثير غير مباشر على التوحيد الذي ظهر في تلك المرحلة المبكّرة؛ فكما يرى بيل، يكشف القرآن عن وعيٍ بالمجتمعات المسيحية في شبه الجزيرة العربية. ثمة إشارات غامضة إلى مسيحيي الجنوب العربي نراها في لفظ «الصابئين»، في مقابل «النصارى» (من المحتمل أنها تشير إلى الناصريين Nazarenes) الذين يمثّلون المسيحيين أو ربما بعض المجتمعات اليهودية المسيحية في الشمال والتي تختلف عقائدها عن المسيحية التقليدية. كما ترتبط «الحنيفية» قبل الإسلام بـ«تصور غامض غير متجسّد عن إله أسمى»، وقد بدأ بعضُ الأفراد الذين تُصَوِّرهُم التقاليد على أنهم «حنفاء» حياتَهم مسيحيين أو ماتوا على المسيحية (مثل: ورقة بن نوفل، وعبيد الله بن جحش، وزيد بن عمرو بن نفيل)[45]. وعلى الرغم من عدم وجود مجتمع مسيحي في مكة، إلا أن الأفكار المسيحية كانت منتشرة في جميع أنحاء المدينة؛ وعلى هذا «أنكون قد جانبنا الصواب تمامًا إذا ظننّا أن محمدًا قد حصل على معلوماته من عبد مسيحي (ربما حبَشي) في مكة، وبها استطاع بناء قرآناته؟»[46]. أحد الأمثلة التي قدّمها بيل على التأثير المسيحي هو فكرة الشفاعة، التي يرى أنها مستمدة من المفهوم المسيحي لشفاعة القدّيسين، وكلّ ذلك غير موجود في اليهودية. لم يدرج محمد الشفاعة يوم القيامة في القرآن، لكنه أضاف بعد ذلك: ﴿إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ﴾[47].
ولكن رغم كلّ نوايا محمد الصالحة، إلا أن رسالته تعرّضت للرفض خلال تلك الفترة، واستمر سكان مكة في تكذيبه. وهنا تبدأ الفترة الثانية، أو ما يسمّيها بيل بالفترة القرآنية، والتي استمرت حتى معركة بدر عام 2هـ (624م). تتميز آيات تلك الفترة بالاستخدام المتكرّر نسبيًّا لمصطلح القرآن، على الرغم من استخدام مصطلحات أخرى مثل الصُّحُف. كما تؤكّد تلك الفترة على فكرة وقوع العذاب على جماعات غير مؤمنة بعينها، والمعنى الضِّمني بالطبع هو كفّار مكة.
لدى بيل وجهة نظر متعاطفة مع نبوّة محمد، لكنه في الوقت نفسه لا يمكنه قبول إمكانية أن يكون محمد قد تلقّى بالفعل وحيًا إلهيًّا:
لقد ادّعى أنه نبي عربي؛ وقد كان كذلك بالفعل، وإننا رأيناه يستعير بوعي من ديانات أخرى، وإنه صريح تمامًا بشأن ذلك. لكن المواد التي يستخدمها، على الرغم من أنها قد تُذَكِّرُنا مرارًا وتكرارًا بالعبارات والأفكار اليهودية والمسيحية، هي في الواقع مواد عربية. وربما كانت مشتقة في الأصل من خارج شبه الجزيرة العربية، لكنها أصبحت بحلول زمن محمد جزءًا من العقل العربي[48].
قد تبدو الجملة الأخيرة مثيرة للفضول، خاصّة بالنظر إلى وجهة نظر بيل بأنّ محمدًا كان لديه أشخاص يمدُّونه بالمعلومات ويتواصل معهم بشكلٍ مباشر. لكن قصد بيل هنا ليس أن الأفكار الكتابية قد اخترقت الحدود الثقافية الهشّة في شبه الجزيرة العربية بشكلٍ عامّ[49]، بل قصد ببساطة أن العقل العربي الأكثر «بدائية» (وإن لم يكن أقلّ ذكاءً) لم يكن قادرًا على فهم تعقيد ما يمكن أن يُطلق عليه التصوّرات والأفكار «الثقافية العالية» للمسيحية[50].
بحلول فترة نبوّته الثانية، أصبح محمد على دراية بالعديد من موضوعات الكتاب المقدّس، ويمكن للمرء أن يلاحظ هذه الموضوعات في المقاطع التي يصنِّفها بيل على أنها مكية؛ ومن أبرزها الروايات العديدة لقصص موسى، والتي كان بصدد تنقيح معظمها وإعادة موضعتها في وقتٍ لاحقٍ خلال الفترة الأخيرة له في المدينة[51]. بالنسبة لمحمد، كانت هجرته من مكة إلى المدينة بمنزلة خروج موسى ببني إسرائيل، كما كانت إشارته المتكرّرة إلى موسى هي طريقته في العمل طوال حياته النبوية وسط العداء والمعارضة التي لقيها من الكثيرين من ذوي الزعامة (من بين الأمثلة العديدة على ذلك قصة قورح). تتضمّن طريقة بيل إعادة البناء النفسي لمحمد وكيف مارس مهمّته، كما أن إعادة بناء بيل لترتيب القرآن هي أيضًا إعادة بناء لترتيب ظهوره (الوحي) من حيث علاقته بحياة محمد.
حدد بيل بداية الفترة الثالثة من مهمة محمد بالانتصار في معركة بدر عام 2هـ:
من الخارج؛ من المعروف دائمًا أن معركة بدر كانت نقطة تحوّل في مسيرة محمد، فقد منحه هذا الانتصار الهيبة وثـبَّت دعائم هيمنته. وأعتقد أن هذا الانتصار كان له نفس النتائج داخليًّا. كان انتصار المسلمين -البالغ عددهم 300- على عدوٍّ يفوقهم بثلاثة أضعاف =معجزة. وقد أُنزلت الملائكة لمساعدة الرسول ومَن معه. من ناحية أخرى، كانت غزوة بدر بليّة على كفّار مكة؛ لقد كانت بمنزلة الفُرقان؛ ونجاة المؤمنين من تلك المصيبة ...عَنى أن محمدًا لم يكن نذيرًا لمدينته فقط؛ بل إنه الآن نذير للعالَـم. إنه المشرِّع، وزعيم المجتمع الثيوقراطي؛ إنه الآن أخيرًا النبي الأكمل[52].
يظهر الإسلام أخيرًا في المدينة بعد معركة بدر؛ وبعد أن عاش بين اليهود لمدة عامين، ازدادت معرفة محمد بالأفكار والمواضيع الكتابية، وتعلَّم التفريق بين اليهودية والمسيحية. وفي تلك اللحظة كان قد وصل إلى ذروة رغبته في معرفة الكتاب المقدّس واللاهوت المسيحي والكنيسة[53]؛ وأيضًا هي اللحظة التي تجمعت فيها لديه الموارد الكافية للبدء في عملية تحريره الشخصي للوحي. في الواقع، كان مضطرًّا إلى إعادة ترتيب تلك الكمية الكبيرة من مقاطع الوحي السابقة، والتي بينها اختلافٌ كبيرٌ، من أجلِ جعلِها متّسقة مع النظام الديني الأكثر تطورًا الذي ظهر [في المدينة].
كانت نتيجة تلك الفترة هي أوّل وأهمّ مرحلة تنقيحية للنصّ القرآني شديد التعقيد. وعلى الرغم من أنّ تاريخ عملية التنقيح تلك -وفقًا لبيل- بسيط نسبيًّا، إلا أنه من الصعب للغاية إعادة بنائه. لقد صاغ محمد -باعتباره المحرّر الأساسي- العديد من مقاطع الوحي المختلفة، والموجودة بالفعل في شكلٍ مكتوبٍ على هيئة سُوَر، ولكن كان عليه -وعلى المحرّرين اللاحقين- العمل في موقف صعب للغاية:
كان لا بدّ من النظر في جميع احتمالات التعارض في الصحف المكتوبة؛ سواء كان ذلك في التصحيحات، أو الإضافات بين السطور، أو الإضافات على الهامش، أو الحذف والاستبدال، وكذلك الأجزاء المقتطعة من الفقرات ووُضعت في مكان خاطئ، وكذلك المقاطع المكتوبة على ظهر مقاطع أخرى، ثم قراءة الأوّل منها والآخِر متّصلة معًا. وهذا هو السبب -وليس العيوب النصّية، أو الارتباك في فكر محمد وأسلوبه- وراء الاضطراب المحبِط لنصّ القرآن، الذي كثيرًا ما يأسف له الكُتّاب الغربيون[54].
كان بيل إذَنْ أوّل من انخرط في إعادة تفكير جذرية في تاريخ تنقيح القرآن، والعملية التي أرستها التقاليد الدينية الإسلامية، وأسفرت محاولته تلك عن ترتيب مختلف تمامًا للوحي. ومع ذلك، لم يشكّك في المخطط العام للسيرة التقليدية لحياة محمد، والتي وثّقها الوحي القرآني، بل يمكننا القول إنه مبنيٌّ عليه. لم يدرك بيل أبدًا «الدّوْر الذي تقع فيه تلك العملية؛ أي: استخدام القرآن -خاصّة في الفترة المكية- لاستنتاج التتابع التاريخي، من أجلِ التمكُّن من إعادة صياغة القرآن وفق ترتيبه التاريخي»[55]. لكن لم يشكّك أحد في عصر بيل في السياق التاريخي العام للإسلام المبكّر؛ إِذْ كانوا قد شرعوا للتوّ في مساءلة القصة التي يحكيها الكتاب المقدّس عن نفسه وعن تكوينه وتحوّله إلى نصّ مقدّس[56].
جون وانسبرو:
لطالما افترض دارسو الإسلام الغربيون -تماشيًا مع الآثار الإسلامية- أنّ ظهور القرآن تربطه علاقةٌ بتاريخ حياة محمد؛ ومن ثَم فإنه يمثِّل -بطريقة أقلّ ما يُقال عنها إنها غامضة- تاريخًا حقيقيًّا. ولكن حقيقة الأمر أن النصّ المقدّس في الإسلام -مثل النصوص المقدسة في اليهودية والمسيحية- قد ظهر فيما يمكن وصفه -بشكلٍ شبه كامل- بأنه فراغ تاريخي. صحيحٌ أن الكتابة -وحتى تدوين التاريخ- كانت موجودة بالتأكيد على الأقلّ في وقت ظهور العهد الجديد والقرآن (والكتابة -بحكم تعريفها- كانت موجودة بالتأكيد وقت ظهور الكتاب المقدّس العبري في صورته المكتوبة)، ولكن لا يبدو أنّ أيًّا من الكتابات التي عاصَرَت ظهور تلك النصوص تعكس اهتمامًا بأيٍّ من هذه الوُحِيّ. وأمّا الكتابات اللاحقة فإن علاقتها بتلك النصوص نشأت ضمن سياقات الأديان نفسها، من خلال تطبيق وجهات نظر لاحقة على المواد السابقة. تتكرّر هذه المنهجية كثيرًا لدرجة أنّ المصادر الدينية تكوِّن مؤسّسة منيعة «للتاريخ المقدّس» يصعب الالتفاف عليها من أجلِ الوقوف على سجلٍّ تاريخي محايد غير مثقل بالأبنية اللاهوتية أو الاحتياجات الدينية الأخرى.
إنّ التاريخ المقدّس في السياق الديني[57] هو بناء يُطبّق على مجموعة معيارية من النصوص التي تمثّل وجهة نظر عالمية مبنية من اللاهوت والفقه والأخلاق والعنصر المختصّ بالاختيار. وإنّ التاريخانية المحايدة عن حياة موسى أو عيسى أو محمد هي بالنسبة للوعي الديني مهملة وغير ذات قيمة إلا إذا كانت تدعم أو تؤكّد نظرة المؤمن للعالم (أو ربما من الأفضل استعمال المؤسسة الدينية بدلًا من المؤمن). تُسلِّم الدراسات الدينية التقليدية دائمًا بالتاريخ المقدّس للتقاليد، ولا تتحدّاه أبدًا، حتى يصبح ذلك التاريخ المقدّس جزءًا من البيئة الفكرية العامة بحيث يصعب حتى على الباحثين الناقدين تجاوزه بصورة كاملة. هذا هو الحال بصورة واضحة في الدراسات الكتابية، ولا يزال كذلك حتى يومنا هذا. من جانبه يرى جون وانسبرو أن تلك المشكلة تتفاقم بصورة أكبر في الدراسات القرآنية لأسباب متنوّعة، ليس هنا محلّ تفصيلها. بعبارة موجزة: يرى وانسبرو -وأولئك الذين تأثّروا بشدّة بأفكاره الجريئة- أنّ الدراسات الغربية حول القرآن تنعم بفيلولوجيا استثنائية، ولكنها سطحية، أو على الأقلّ تحتاج لتطعيمها بمنهاج أدبي وتاريخي[58]. لم تنجح تلك الفيلولوجيا في تخليص نفسها من الافتراضات التاريخية للمرويات الإسلامية، وبالتالي لم تستطع أن تذهب بالدراسة التاريخية النقدية للقرآن (والمرويات الإسلامية) إلى ما هو أبعد بكثير من الدراسات الإسلامية التقليدية.
يتجنّب وانسبرو تلك المعضلة التاريخية من خلال قراءة القرآن ليس من جهة وجوده في سياق تاريخي، بل من جهة وجوده في سياق أدبي؛ أيْ قراءة القرآن بالكامل قراءة أدبية، ورفض قراءته قراءة تاريخية. لقد جمع آخرون في قراءتهم للقرآن -من نولدكه فصاعدًا- بين القراءة الأدبية والتاريخية، بيدَ أن موقف وانسبرو من التاريخ القرآني هو أنه «تاريخ خلاصي» بالكامل، بمعنى أنه تاريخ مقدّس مكتوب في شكلٍ أدبي لإثبات علاقة الله الفريدة بنبيّه محمد، وبالتبعية علاقته بشعبه المختار حديثًا ودينهم من وجهة نظر المسلمين والإسلام. ويرى وانسبرو أنه لا يمكن لمثلِ هذه القراءة أن تخبرنا أيَّ شيء عن أوائل القرن السابع؛ الذي من المفترض -وفقًا للمرويات الإسلامية- أنّ القرآن ظهر فيه كنصٍّ أُنزل على نبي الله، ثم صَدَعَ به. كما لا يمكن أن تخبرنا أيَّ شيء عن محمد التاريخي. غاية ما يمكن أن تخبرنا عنه هم أولئك الذين كانوا مسؤولين عن ظهوره في صورة النصّ الذي نعرفه اليوم.
أسفرتْ قراءة وانسبرو الأدبية عن تأريخ القرآن بالقرن التاسع في العراق من خلال إعادة بناء التاريخ الأدبي للنصّ. إِذْ يرى أنه لا وجود للأدب العربي قبل ذلك التاريخ، وأمّا العادة التي اشتهر بها الكُتّاب الدينيون الأوائل في الاستشهاد بأقوال منسوبة لشخصيات مرجعية بارزة من الماضي من خلال سلسلة الإسناد التي تعزو تلك النقول إلى جيل محمد =فيمكن بسهولة أن تكون بناءً اعتباطيًّا للإسقاط اللاحق، باعتباره تصويرًا للواقع التاريخي. يذهب وانسبرو إلى أنه لا توجد مادة أدبية أصيلة قبل أواخر القرن الثامن وحتى أوائل القرن التاسع. ولا شك في أن دراسته واستنتاجاته جذريَّة بالفعل، لكنه يذكر في البداية ويكرّر أن مساعيه تلك مؤقّتة وظنيّة[59]. إنّ أحد الجوانب الاستثنائية في دراساته هي جرأته؛ ولكن ليس المقصود جرأته على عدم احترام القرآن والمرويات الإسلامية، بل جرأته التي -بدافع النزاهة الفكرية والعلمية- تسوقه إلى إخضاع الدراسات القرآنية لمناهج لم يسبقه أحد إلى تطبيقها بالكامل في هذا الحقل.
نُشر كتاب وانسبرو «دراسات قرآنية Quranic Studies» -الذي كُتب بين عامي 1968 و1972- في عام 1977، ونُشرت دراسته الثانية وثيقة الصلة بهذا الكتاب -وهي: الوسط الطائفي The Sectarian Milieu، والتي كُتبت بين عامي 1973 و1977- في عام 1978[60]. هناك تسلسل منطقي بين الدراستين يجعلهما متلائمتين معًا، ولكن من المحتمل أنّ تسلسل نشرهما لم يكن مقصودًا[61]. الكتاب الأول -وهو موضوع المناقشة هنا- يركز على تكوين القرآن بجانب الكتابات التفسيرية المبكّرة التي تشهد على ذلك التكوين، بينما يدرس الثاني التطوّر المستمر للإسلام المبكّر من خلال السيرة النبوية التقليدية وما وراءها. تعرّض منهج وانسبرو لانتقادات شديدة من الباحثين الغربيين والعلماء المسلمين التقليديين على حدّ سواء، ولكن استنتاجاته كان لها النصيب الأكبر من هذا النقد. لسنا معنيين هنا بتقييم إيجابيات وسلبيات تلك الدراسات[62]، إلا أنّنا ننوّه إلى أنّ الحقيقة البديهية القائلة بأن المنهج يتحكم بالنتائج هي التجسيد الأمثل لحالة النزاع بين وانسبرو ومنتقديه. ولكن على الرغم من النقد والإدانة، لا تزال الجماعة العلمية غير قادرة على التوصّل إلى حُكمٍ فصل. ما يهمنا هنا هو منهج وانسبرو أكثر من نتائجه، لا سيما في مقالته الأولى من «دراسات قرآنية»، والتي أظهرت نزوعًا مقارِنًا عميقًا، ومؤطّرة بدقة بالسياق الأدبي للتقليد اليهودي التوراتي وما بعد التوراتي.
يمثّل سياق النصّ المقدّس والتأويل بشكلٍ عام نقطة البداية والنهاية لتحليل وانسبرو؛ إِذْ إنه يبحث في كيفية تلاؤم الكلمات والعبارات والرموز والأفكار القرآنية معًا منتجةً نصًّا مقدسًا نوعيًّا. عامّة نماذج وانسبرو مستمدَّة من الكتاب المقدّس والتقليد الحاخامي (وتجدر الإشارة هنا إلى فكرة تدعم أطروحة وانسبرو -رغم أنه لم يستغلّها- وهي أن التقليد الحاخامي في شكله التلمودي هو بمنزلة النصّ المقدّس في اليهودية الحاخامية). ولكن على عكس جيجر وبيل، لم يكن وانسبرو يهدف إلى إثبات أن محمدًا قد تلقّى الكثير من معلوماته الكتابية بشكلٍ مباشر أو غير مباشر من أشخاص يهود أو مسيحيين، بل إظهار كيف تطور القرآن عضويًّا في ذلك الوسط الطائفي الكتابي/ الحاخامي. إنّ ما يسمى بالمواد «الكتابية» الموجودة في القرآن «لم تتعرّض لعملية ضخمة من إعادة الصياغة بقدرِ ما اقتصر وجودها على الإشارة إليها فقط»[63]. بمعنى أن القرآن نصٌّ غنيٌّ بالإحالات، ويعمل على تأسيس أهميته وسُلطته من خلال وضع نفسه بالكامل في سياق نوع النصّ المقدّس. لقد حاولَت غالبية الدراسات السابقة إثبات الأصل الكتابي لأجزاء كبيرة من القرآن، لكنها وجدت نفسها بعد ذلك أمام معضلة تطرحها طبيعة واتساق الاختلافات -التي أحيانًا ما تكون غريبة- بين تلك الأجزاء والنصوص الكتابية. يلاحظ وانسبرو أنّ ظهور القرآن حدث في «جوّ شديد الطائفية، حيث تعرّضت مجموعة من النصوص المقدّسة المألوفة لضغطٍ تأويلي [من خلال الإشارة والإحالة إليها، وليس من خلال الاقتباس المباشر منها] لتخدم عقيدة كانت غير مألوفة حتى ذلك الوقت [لأنها كانت لا تزال في طور النشأة]»[64]. أمّا المادة السردية التي توجد لها متوازيات كتابية فيسميها وانسبرو بـ«المَثَل exempla»؛ لأنها ليست سردًا بالمعنى الدقيق للكلمة على الإطلاق، إنها بالأحرى إشارات تلميحية إلى مواقف تُستمد منها العِبرة، والتي ربما تكون قد تطوّرت من مادة صيغت أساسًا للأغراض الدعوية/ الوعظية.
يمتلئ القرآن بالمجازات والتراكيب والصور الكتابية، لكن تلك الصور لا تقتصر على المثل. فمثلًا: يُعبَّر عن صورة الانتقام الإلهي من خلال ما يسميه وانسبرو «مفاهيم» الأُمّة والأوّلين والقَرْن والقرية. الدعامة الرئيسة هنا هي الصورة التعبيرية بكامل أبعادها، وليست المتوازيات اللغوية أو النظائر. وللتعبير عن تلك الصور تُستخدم سلسلة كاملة من الاستعمالات المعجمية العربية الرئيسة التي قد توجد أو لا توجد لها نظائر لغوية في العبرية أو الآرامية. هناك صورٌ أخرى مثل: الآية، والحِجْر (في دلالته على النفي والإبعاد)، والميثاق/ العهد؛ ويؤكّد وانسبرو على أنّ وسائل التعبير عن هذه الصور ليست ثابتة، بل قد تُستعمل لها مصطلحات وعبارات أخرى. تضع هذه الصورُ القرآنَ في سياق النصّ المقدس؛ إِذْ لم يُقصد من إيرادها أن تكون إعادة إنتاج للمفردات والصور الكتابية.
مِثل أيّ نصّ مقدس؛ يجب أن يكون القرآن متوافقًا مع أنماط معروفة من الكلام البشري، وفي هذا الصدد، يحتوي القرآن بالفعل على صور من أنواع أدبية عرفناها من الكتاب المقدّس. وهنا يشترك القرآن والكتاب المقدّس في ظاهرة المحاكاة. وهذا يختلف عن العلاقة بين العهد الجديد والكتاب المقدّس العبري، حيث إنّ التفسير الرمزي [التيبولوجي] هو الذي يؤسّس لدعوى أن الأول هو تحقيق لنبوءات وإشارات موجودة في الثاني. أمّا الإيماءات القرآنية لموضوعات من الكتاب المقدّس فهي في الغالب تعكس -بدلًا من أن تطوِّر- الموضوعات الكتابية، وفي نفس الوقت فهي ليست مجرّد استعارات عربية لأشكال سابقة ثابتة[65]. إنّ تلك الإيماءات تمثّل تأريخًا يخلع على نزول وحي القرآن تنظيمًا جديدًا؛ فهذا الوحي ذاته يكشف عن محيطه الجدلي من خلال تسجيله -مثلًا- للمحاججة والجدل المتعلّق بأنماط الوحي؛ مثل مطالبة اليهود والوثنيين محمدًا بأن يأتي بكتاب على غرار نمط الكتاب المقدّس[66]. ومع ذلك، فإن هذا التنظيم الجديد مثقلٌ بعلاقته بالكتاب المقدّس اليهودي، وبالتالي يجب التمييز بينه وبين النصّ نفسه من خلال الجدل الخاصّ به وتفسيره المبكِّر[67].
انتُقد وانسبرو لموضعته ظهور القرآن ضمن بيئة ضيقة مصبوغة باليهودية[68]، وهذا صحيح؛ إِذْ إن مفرداته التحليلية واستشهاداته بالمواضع المتشابهة مأخوذة بالكامل تقريبًا من مصادر توراتية أو حاخامية. ولكن -في حالة وانسبرو- لا تكشف منهجيته عن انحياز أيديولوجي، كما هو الحال مع مستشرقين سابقين؛ فقد اعتُبر ميله نحو استخدام النماذج اليهودية في البداية أنه وسيلة تجريبية لاشتقاق المعنى التناصي/ البَيْن- نصّي للقرآن. وقد أصاب في ملاحظته تداخلًا أكبر للقرآن مع الكتاب المقدّس اليهودي من الإحالات الكتابية المسيحية[69]، وهي ملاحظة سبق وفسّرتها التقاليد الإسلامية من خلال تاريخ تفاعل محمد مع يهود المدينة[70]. وبسبب تفكيكه لتاريخانية القرآن، اضطر وانسبرو إلى قصر تحليله على بحث أدبي بحت لتلك العلاقة.
إنّ رفض وانسبرو قبول مصداقية الأدبيات العربية في تقديم أيّ معلومات دقيقة حول الإسلام المبكّر يعكس صدى أعمال جوزيف شاخت، وقد ردّدت تلك الأعمال صدًى أكبر لدى باحثين آخرين في العِقدَيْن الماضيين[71]. ومع ذلك، فإنّ معظم دارسي الإسلام المبكّر -رغم أنهم لا يزالون متشكّكين في مصداقية هذا الأدب- لا يتّخذون هذا الموقف المتطرف. إنّ رفض مثل هذا الهيكل الأدبي الشامل والمعقّد بسجلّه المفصّل من التقاليد الممتدة عبر أجيال عديدة، والتي تمثّل العديد من الجماعات التي تنقل أجزاءً من المعلومات المتماسكة داخليًّا (إن لم تكن متسقة دائمًا) =قد صَدَم الكثيرين في المجتمع الأكاديمي، واعتبروه اختزالًا لا داعي له. من ناحية أخرى، فإنّ حُجج وانسبرو دائمًا ما تكون مثيرة للإعجاب؛ فحتى لو لم تكن مقنعة دائمًا، فإنها تلمس وعي المرء، وتجبر الباحثين النابهين على الحرص الشديد أثناء قراءتهم للأدب.
لا شك في أنّ قراءة أعمال وانسبرو صعبة ومرهقة، ويرجع ذلك جزئيًّا إلى تراكيبه المعقّدة واستخدامه الحُر للمصطلحات اللاتينية التي يعسُر إيجاد مكافِئات لها من الإنجليزية، وكذلك استخدامه غير المتّسق للغة العربية (والعبرية والآرامية)؛ فأحيانًا يستعمل ألفاظ تلك اللغات بشكلها الأصلي، وأحيانًا يورد لها نَقْحَرة صوتية، وفي كثير من الحالات يكون كلّ ذلك غير مصحوب بترجمة. ومع ذلك، فمن المفيد أن نناقش أعماله، خاصّة مقالته الأُولى: «الوحي والنصّ التشريعي المعياري Revelation and Canon». إنّ ملاحظاته عن المتشابهات الفكرية والموضوعية والتفسيرية والدلالية مفيدة للغاية، وكذلك تعليقاته على الأعمال السابقة حول نفس الموضوعات. وإذا أردنا إيجاز رأيه حول التناص بين القرآن والكتاب المقدّس فسنقول: إنّ الأول قد نشأ من مجموعة مما يسمّيه «الأقوال النبوية prophetic logia»[72] التي كانت موجودة في «المجال العام» إن صح التعبير. ثم انفصل ما أصبح «القرآن» في نهاية المطاف عن هذه المجموعة، ثم صار بنفسه مصدرًا أدبيًّا مستقلًّا. اشتملت صياغة القرآن على صنعة أدبية بارعة، إلا أن النتيجة النهائية لم تخلُ من توزيع غير منتظم إلى حدّ ما للمقاطع التي تربط بينها صِلة واضحة. من المحتمل أنّ هذه الأقوال أو المقاطع تعود جذورها إلى مجتمعات مختلفة، وربما تمثّل مناطق مختلفة أو متمايزة بطرق أخرى. في بعض الأحيان، كان الاضطراب والتناقض يَسِمُ تلك الأقوال، ومن المرجح أنها مأخوذة من بيئة جدلية، يُظَنّ أنها تقع في بلاد ما بين النهرين (بابل اليهودية) في القرنين الثامن والتاسع، حيث خرج ما أصبح يُعرف بـ«الإسلام» في بيئة يهيمن عليها الجدل والنقاشات غير التقليدية بين مجموعات متنوّعة مرتبطة باليهودية الحاخامية أو على دراية بها. امتدّت عملية مَأْسَسة النصّ وترسيخ معياريته على أمدٍ طويل، ويجب أن يُنظر إليها على أنها جزءٌ من عملية تكوين الجماعة نفسها؛ بمعنى أن التحام الأجزاء المكوّنة للقرآن مع بعضها حدث بالتزامن مع التحام جماعة قارئيه/ مستمعيه. في نهاية المطاف، تطلّبت مجموعة الأقوال النبوية تلك نبيًّا لإسنادها إليه ومِن ثم توثيقها؛ وهذا هو النبيّ الذي وُجِد أو وُضِع في أراضي الحجاز العربية من خلال عملية الإسقاط اللاحق[73].
ربما تكون أكبر مساهمة لوانسبرو هي كسر جليد التاريخانية الصارمة للقرآن. وفي حين أنّ نقده لمصداقية التقليد العربي في بناء التاريخ الإسلامي المبكّر أكثر إقناعًا من إعادة التأريخ التي قام بها، فإنّ رفضه أن تكون تلك النتائج نهائية قد فتح المجال أمام الآخرين ودعاهم لتقديم دراسات جريئة مماثلة. يدرك وانسبرو جيّدًا التعقيد الشديد للتناص في الدراسات الكتابية، وهو في نفس الوقت يرشد البحوث المستقبلية إلى الطريق للتعامل مع هذا التعقيد. ربما كان أكثر ما أزعج معاصريه من الباحثين هو الجانب ما بعد الحداثي لمشروعه؛ ففي مجال لا تزال تهيمن عليه الوضعية والحداثة -على الرغم من محاولات وانسبرو- حيث يتعاون جميع المشتغلين في هذا المجال على إنتاج نظام تأويلي مغلق؛ استطاع أن يثبت أنه لا توجد قراءة نهائية للتناص القرآني، وأنّ هذا النصّ مفتوح دائمًا على الدخول إلى منعطف تأويلي جديد[74].
[1] العنوان الأصلي لهذه المقالة هو The Qur’an and the Bible: Some Modern Studies of Their Relationship، وقد نُشرت في Bible and Qur’an: Essays in Scriptural , Intertextuality, edited by John C. Reeves, BRILL, 2004
[2] ترجم هذه المقالة: مصطفى هندي، باحث ومترجم، له عدد من الأعمال المطبوعة.
[3] تمثل دراسة العلاقة بين القرآن والكتاب المقدس مساحة أساسية من الدرس الغربي للقرآن، منذ انطلاقة هذا الدرس في صورته العلمية في القرن التاسع عشر وإلى الآن، هذه المقالة تحاول تتبع جانب مهم من الدراسات الغربية التي تصدت لبحث هذه العلاقة، وتلقي ضوءًا على بعض التغيرات التي مرت بها، وتذكر بعض النظرات التقويمية حولها، وتأتي أهمية هذه المادة في أنها تبرز نقدًا وتقويمًا من الوسط الاستشراقي ذاته ووفق تطوراته النظريَّة والمنهجيَّة الخاصّة لهذه الكتابات فتكشف صورة من صور تنوُّعه وتطوُّره الداخلي، وإلا فقد صدرت كما هو معلوم ردود إسلامية كثيرة على الآراء التي تحملها الكتابات التي عرضتها هذه المادة. (قسم الترجمات).
[4] Reuven Firestone ريفين فايرستون، حاخام وعالم أديان أمريكي، هو أستاذ كرسي ريجنشتاين لدراسات اليهودية والإسلام في العصور الوسطى في كلية الاتحاد العبري في لوس أنجلوس، تتركَّز اهتماماته في دراسة تاريخ الكتب المقدس وتاريخ الأديان الكتابية والعلاقات الإسلامية اليهودية في العصور الوسطى، وله الكثير من الكتب والدراسات في هذا السياق. (قسم الترجمات).
[5] Eileen Barker, New Religious Movements: A Perspective for Understanding Society (London: HMSO, 1989), 148–49.
[6] Geoffrey K. Nelson, Cults, New Religions and Religious Creativity (London: Routledge & Kegan Paul, 1987), 1–2.
[7] قائمة منشوراتهم الفردية والجمعية ضخمة، انظر:
Rodney Stark and William Simms Bainbridge, The Future of Religion: Secularization, Revival, and Cult Formation (Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1985); idem, A Theory of Religion (New Brunswick, N.J.: Rutgers University Press, 1996).
[8] Rodney Stark, “How New Religions Succeed: A Theoretical Model,” in The Future of New Religious Movements (ed. D. G. Bromley and P. E. Hammond; Macon, Ga.: Mercer University Press, 1987), 13.
[9] تك 35: 2؛ خروج 23: 23- 24؛ عدد 34: 55؛ تثنية 7: 1- 4؛ يش 24: 20؛ قضاة 2: 11- 14؛ إلخ.
[10] انظر: متّى 23؛ 27: 25؛ يوحنا 8: 44؛ رومية 2؛ غلاطية.
[11] John Penrice, A Dictionary and Glossary of the Korân (1873; repr., London: Curzon, 1970), 4.
[12] العديد من تلك الإشارات ليست بالضرورة أن تكون مقصودة.
[13] مصطلح «الغرب» أو «الغربي» هو مصطلح مَرِن؛ ورغم أنني سأتمسك بالإشارة إلى دارسي القرآن في هذا الصدد على أنهم «غربيون»، إلا أنّ تلك الردود «الغربية» المبكّرة والمستمرة والعديدة على الإسلام هي بالأساس من صياغة المسيحيين البيزنطيين الذين عاشوا في الشرق الأوسط. ربما يكون المصطلح الأدق -ولكنه الأصعب؛ لأنه يشمل اليهود- هو «غير المسلمين المنحدرين من العالم المسيحي».
[14] Bernard Lewis, Islam and the West (New York: Oxford University Press, 1993), 11– 12.
[15] وهبة مصطفى الزحيلي، آثار الحرب في الفقه الإسلامي، (بيروت، دار الفكر)، ص166- 196.
Majid Khadduri, War and Peace in the Law of Islam (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1955), 141–46.
[16] Lewis, Islam and the West, 7– 8.
[17] Norman Daniel, Islam and the West: The Making of an Image (Edinburgh: Edinburgh University Press, 1960; repr., Oxford: Oneworld, 2000), 55– 59
[18] الاسم الذي أُطلق على مؤلِّف هذا العمل هو عبد المسيح بن إسحاق الكندي، وإن كان بلا شك اسمًا مستعارًا (EI2 5: 120– 21).
[19] See “HÓizayoon ‘al ha- mil–amah ha- ’ah˙aroonah” in Ginzey Schechter: Genizah Studies in Memory of Solomon Schechter (3 vols.; Texts and Studies of the Jewish Theological Seminary of America 7–9; New York: Jewish Theological Seminary of America, 1928–29), 1:310–12; English translation in Bernard Lewis, “On That Day: A Jewish Apocalyptic Poem on the Arab Conquests,” in Mélanges d’islamologie: Volume dédié à la memoire de Armand Abel par ses collègues, ses élèves et ses amis (ed. P. Salmon; Leiden: Brill, 1974), 197–200; and “Nistarot de- Rabbi So imoS n baro Yoho ay,” ˙ BHM 3:78–82.
[20] قليلٌ منها فقط كُتب باعتبارها أعمالًا جدلية. انظر:
Solomon b. Abraham Adret (Rashba, 1235–1310), Ma’amar ‘al Yishma‘el (cf. J. Perles, R. Salomo b. Abraham b. Adereth: Sein Leben und seine Schriften [Breslau: Schletter, 1863]), a work that responds to the attacks of the eleventh- century Muslim scholar Ibn Hazm. Note too Simeon b. Semah ˙ Duran (Rashbas, 1361–1444), Qeset u- Magen, which is mostly directed against Christianity, and also Maimonides (Rambam), ’Iggeret Teyman.
[21] كانت تلك المقاربة في دراسة اليهودية جديدة تمامًا في عصر جيجر، حيث ظهرت قبل حوالي اثني عشر عامًا فقط من كتابة أطروحته، وقد كان لها تأثير عميق ليس فقط على دراسة اليهودية، ولكن أيضًا على توجيه الحياة الدينية اليهودية. انظر:
Ismar Schorsch, From Text to Context: The Turn to History in Modern Judaism (Hanover, N.H.: University Press of New England, 1994), esp. 149–205; and Michael A. Meyer, “Abraham Geiger’s Historical Judaism,” in New Perspectives on Abraham Geiger: An HUC- JIR Symposium (ed. J. J. Petuchowski; Cincinnati: Hebrew Union College Press, 1975), 3–16.
[22] ترجمه لاحقًا إلى اللغة الإنجليزية إف. إم. يونغ F. M. Young على أمل تقريب المسلمين من اليهودية ومن ثَم إلى المسيحية، وقد خرجت الترجمة بعنوان: اليهودية والإسلام (1898, 1970) ؛ repr. ، New York: Ktav للوقوف على ملخصٍ حديث وممتازٍ لتاريخ جيجر الشخصي ومساهمته في مجال الدراسات الإسلامية، انظر:
Jacob Lassner, “Abraham Geiger: A Nineteenth- Century Jewish Reformer on the Origins of Islam,” in The Jewish Discovery of Islam: Studies in Honor of Bernard Lewis (ed. M. Kramer; Tel Aviv: Tel Aviv University, 1999), 103–35.
[وقد ترجمه للعربية من الترجمة الإنجليزية: نبيل فياض، بعنوان: «اليهودية والإسلام»، وصدر عن دار الرافدين، 2018. (قسم الترجمات)].
[23] Moshe Pearlman, prolegomenon to the 1970 Ktav edition of Judaism and Islam (see preceding note), x (all subsequent references are to this edition); translated by Lassner, “Abraham Geiger,” 107.
[24] Geiger, Judaism and Islam, 2.
[25] Ibid., 21.
[26] Ibid., 25.
[27] Ibid., 4–17.
[28] Ibid., 23.
[29] Ibid., 21.
[30] Ibid., 30.
[31] Ibid., 4– 17.
[32] Ibid., 10.
[33] Ibid., 17– 18.
[34] Lassner, “Abraham Geiger,” 108.
[35] (2 vols.; Edinburgh: T&T Clark, 1937–39).
[36] وفقًا لجون ميريل، فقد كانت التكلفة ستة دولارات للمجلد بسبب التعريفة الجمركية الأمريكية الباهظة.
(John E. Merrill, “Dr. Bell’s Critical Analysis of the Qur’an,” MW 37 [1947]: 134; reprinted in Der Koran [ed. R. Paret; Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1975], 11).
[37] (2 vols.; JSS Monograph 14; ed. C. E. Bosworth and M. E. J. Richardson; Manchester: Manchester University Press, 1991). For a review, see Andrew Rippin, “Reading the Qur’an with Richard Bell,” a JAOS 112 (1992): 639–47.
[38] Alfred T. Welch, “Al- Kur’an,” EI2 5:417b.
[39] جلال الدين السيوطي، الإتقان في علوم القرآن، بيروت، 8- 18.
[40] See the discussion in Welch, “Al- Kur’an,” 5:414– 19.
[41] Rippin, “Reading the Qur’an with Richard Bell,” 641; Merrill, “Bell’s Criticala Analysis,” 17– 18.
[42] The Origin of Islam in Its Christian Environment: The Gunning Lectures (London: Macmillan, 1926; repr., London: Cass, 1968).
[43]Ibid., vi.
[44] صرّح بهذا التأريخ في أعماله اللاحقة، ولكنه واضح بالفعل في كتابه:" The Origin of Islam in Its Christian Environment ".
[45] Bell, Origin, 57–58.
[46] يشير بيل إلى كلّ نقلٍ مفرد للمعلومات باعتباره قرآنًا (مفرد)، ومن هنا جاءت صيغة الجمع "قرآنات".qurans. Ibid., 105 (الأقواس من الأصل).
[47] Ibid., 56.
[48] Ibid., 69.
[49] See Reuven Firestone, Journeys in Holy Lands: The Evolution of the AbrahamIshmael Legends in Islamic Exegesis (Albany: State University of New York Press, 1990).
[50] سيطرت هذه الرؤية للعقلية العربية على أذهان كثير من فلاسفة ومؤرّخي القرن التاسع عشر، وهي جزء من النظرات الأثروبولوجية الشائعة في هذا الوقت كاستمرار لنظرية ليفي بريل عن وجود فارق «طبيعي» بين عقلية الأوروبي المسيحي وبقية العقليات خارج أوروبا والتي وُصفت بأنها بدائية، وهذه النظريات ثبت لاحقًا عدم علميتها، فضلًا عن كونها شكّلت ردءًا علميًّا للاستعمار الأوروبي لآسيا وإفريقيا والأمريكتين. (قسم الترجمات).
[51] Bell, Origin, 123– 24; idem, Qur’an, 353, 373
[52] Bell, Origin, 124.
[53] Ibid., 136.
[54] Bell, Qur’an, vi.
[55] Rippin, “Reading the Qur’an with Richard Bell,” 640.
[56] يشير فايرستون هنا إلى المبحث الخاصّ بدراسة عملية تأسيس قداسة النصوص وسلطتها، أي تحوّلها من نصّ نبوي إلى نصّ مقدّس ثم إلى كتاب ذي سلطة، وهذه العملية لم تبدأ دراستها بعمق كبير إلا في العقود الأخيرة مع التطورات الحاصلة في دراسة مخطوطات قمران وعلاقة هذا بدراسة تاريخ الكتاب المقدّس العبري ودراسة تعامل المجتمعات الدينية في الشرق الأدنى القديم المتأخر مع كتبها الدينية. (قسم الترجمات).
[57] على الأقلّ في السياق الديني للتوحيد التقليدي الذي تظهره أنواع مختلفة من اليهودية والمسيحية والإسلام.
[58] يعزو أندرو ريبين هذا الأمر إلى الكسل الفكري، والرغبة في تحقيق نتائج إيجابية، و«المقاربة الإيرينية» التي تتجنّب الأسئلة الصعبة رغبةً منها في فهم التدين الإسلامي وبناء جسور للتواصل معه. انظر بحثه:
“Literary Analysis of Quran, Tafsir, and Sira The Methodologies of John Wansbrough,” in Approaches to Islam in Religious Studies (ed. R. C. Martin; Tucson: University of Arizona Press, 1985), 156–59.
[59] John Wansbrough, Quranic Studies: Sources and Methods of Scriptural Interpretation (Oxford: Oxford University Press, 1977), xi, 119, 138, etc. See also idem, The Sectarian Milieu: Content and Composition of Islamic Salvation History (Oxford: Oxford University Press, 1978).
[60] للتوسّع حول رؤية الاتجاه التنقيحي للمصادر الإسلامية التقليدية، ورؤيتها لتاريخ القرآن وتاريخ الإسلام المبكّر، والرؤية المنهجية المقترحة من قبلها لإعادة بناء هذا التاريخ، والرؤى والنقاشات الناتجة عن بروز هذا الاتجاه؛ راجع ملف الاتجاه التنقيحي على موقع تفسير. (قسم الترجمات).
[61] Rippin, “Methodologies,” 153.
[62] للوقوف على مراجعات لكتاب «دراسات قرآنية» انظر:
Josef van Ess, BO 35 (1978): 349–53; Edward Ullendorf, BSOAS 40 (1977): 609–12; Rudi Paret, Der Islam 55 (1978): 354–56; William A. Graham, JAOS 100 (1980): 137–41; Leon Nemoy, JQR 68 (1978): 182–84; R. B. Serjeant, JRAS (1978): 76–78; Issa J. Boullata, MW47 (1977): 306–7; Ewald Wagner, ZDMG128 (1978): 411; and Kurt Rudolph, TLZ105 (1980): 1–19.
[63] Wansbrough, Quranic Studies,20
[64] Ibid., الأقواس مضافة.
[65] Wansbrough, Quranic Studies, 33.
[66] يقترح وانسبرو أنّ الوثنيين أُعيد إدخالهم إلى الجدل من الماضي؛ فالعديد من السلبيات المنسوبة للوثنيين قد خرجت في بيئة جدلية باعتبار الوثنية معادية لليهودية، ولكن أُسقطت تلك السمات لاحقًا على الوثنيين العرب. وسنتعرض لهذه المسألة فيما يأتي.
[67] Wansbrough, Quranic Studies, 43.
[68] Graham, review of Wansbrough, JAOS 100 (1980): 140.
[69] قد يشمل ذلك، على سبيل المثال، الإشارات إلى تلك الأجزاء من الكتاب المقدّس العبري التي يُستشهد بها بشكل منتظم في اليهودية أكثر مما يُستشهد بها في التأويل المسيحي.
[70] «يمكننا أن نرى أنّ إحدى الآيات التي تشير إلى العهد المسيحي (الآية 14 من سورة المائدة) -مثل الإشارة إلى عيسى في الآية 7 من سورة الأحزاب- إنما تمثل امتدادًا زمنيًّا وليس تطورًا تاريخيًّا»(Wansbrough, Quranic Studies, 11). انظر أيضًا (المرجع نفسه، 39- 42)، حيث أورد قصة من السيرة عن جعفر ومسلمين آخرين يتناقشون مع النجاشي الحبَشي بما يشبه الإعلانات المسيحية حول قوانين الإيمان (أعمال الرسل 15: 20، 28- 29)، على الرغم من أن هذا من المحتمل أنه كان ضرورة فرَضَها واقع القصة لأنّ جعفرًا كان يحاول أن يُـثبت للنجاشي أنه لم يكن يصادق على صحة دين جديد.
[71] Joseph Schacht, An Introduction to Islamic Law (Oxford: Clarendon, 1964). See especially Patricia Crone and Michael Cook, Hagarism: The Making of the Islamic World (Cambridge: Cambridge University Press, 1977).
[72] من اليونانيةlogion (lovgion) ، قول أو وحي، ويعرّفه قاموس ويبستر الدولي الجديد الثالث (1981) بأنه: «قول قصير أو حكمة عابرة محمّلة بالمعنى، وخصوصًا عندما تصدر عن مرشد ديني». قد يكون هذا مشابهًا للـ«ميمرا» memra في المصطلحات اليهودية التقليدية، لكنني أرى أن استخدام وانسبرو للمصطلح يشير إلى بنية أدبية أكبر إلى حدّ ما.
[73] Wansbrough, Quranic Studies, 48– 52.
[74] شكَّل كتاب وانسبرو بدايةً لمنعطفٍ جديد في الدراسات القرآنية الغربية، سواء عبر تشكيكه في السردية الإسلامية التقليدية حول تاريخ القرآن وبالتالي وضع الأُسس النظرية والمنهجية لحقل الدراسات الغربية موضع تشكيك ومراجعة، أو عبر فتح الباب لتطبيق المنهجيات الأدبية على القرآن والتفسير، في مساحة العلاقة بين القرآن والكتب السابقة نتج عن هذا المنعطف اتجاهان متباينان؛ الأول هو الاتجاه الذي افترض كون القرآن ليس إلا تحريرًا لاحقًا لنصّ أصلي كُتب بلغة مختلفة، وأشهر فرضيات هذه الاتجاه هي فرضية لكسنبرج عن قرآن أصلي كُتِب بلغة مزيج بين العربية والسريانية، وهي فرضيات تعتبر إمعانًا في نزع أصالة النصّ القرآني يتجاوز حتى طروحات جيجر وبيل، والاتجاه الثاني يميل لقراءة الصِّلة بين القرآن والكتب السابقة باعتبارها علاقة تفاوض وجدل بين المجتمعات الدينية في الشرق الأدنى القديم، وتمثّل أعمال أنجيليكا نويفرت أبرز مثال لهذا الاتجاه، وبين الاتجاهين طيف من الدراسات التي تجمع بين رؤى تميل لربط القرآن بكتب محدّدة في نفس الوقت الذي تميل فيه لعدم النفي التام لأصالة النصّ، مثل رؤى عمران البدوي وكارلوس سيغوفيا على سبيل المثال. (قسم الترجمات).
كلمات مفتاحية
مواضيع ذات صلة
((المعلومات والآراء المقدَّمة هي للكتّاب، ولا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع أو أسرة مركز تفسير))