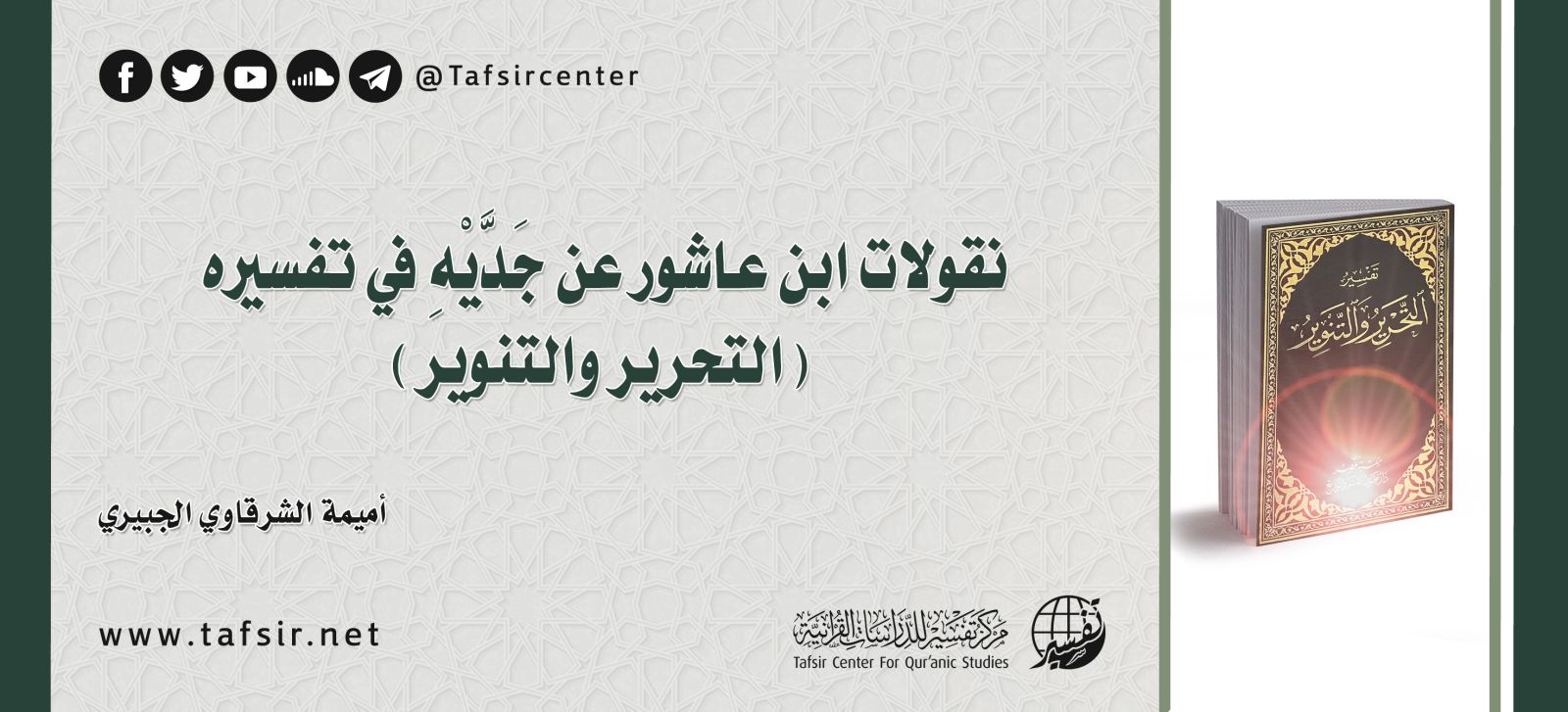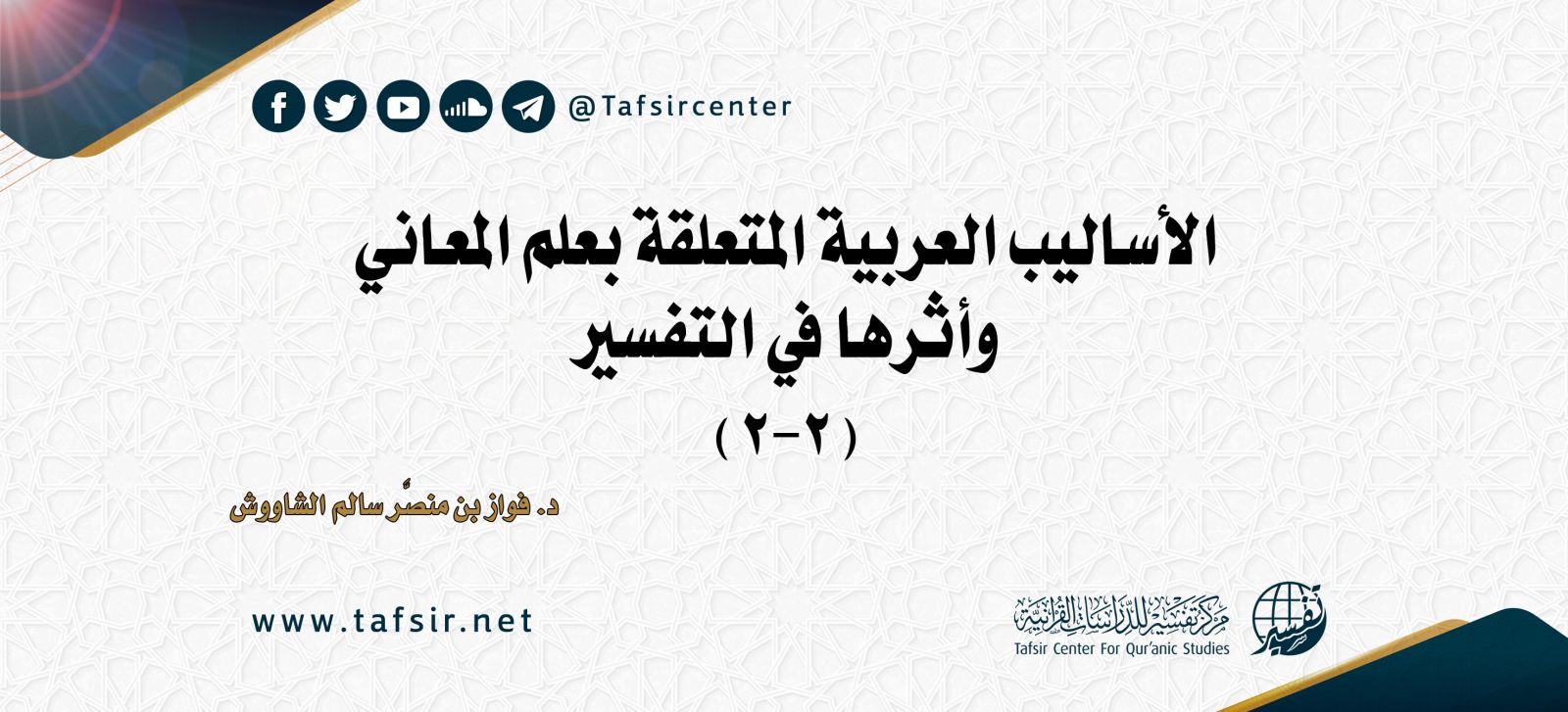الاستطراد في تفسير الرازي؛ وقفات منهجية
الاستطراد في تفسير الرازي؛ وقفات منهجية
الكاتب: محمود حمد السيد

لا شكّ أن النظر في المفاهيم المعبّرة عن المصطلحات العلمية يُعَدّ من أهم المشاغل البحثية؛ وذلك لِما للمفاهيم وضبط تصوّرها وما يتعلق بها من أهمية بالغة في ضبط الحركة العلمية لأيّ علم من العلوم، بل لا يكون العلم علمًا على الحقيقة حتى يكون له مفهومٌ واضحٌ وحدودٌ بيّنة، تميّزه عن غيره، وتُرْسم خريطةُ التأليف فيه تبعًا لها.
والناظر في كتب التفسير يلحظ اختلافًا بيّنًا في مادتها وفي الحدود التي يتبعها كلّ مفسِّر ويوقف مداده عندها فلا يتخطّاها، ومن ثَمّ كان لزامًا النظرُ في هذا الاختلاف وفي الإشكالات العلمية المترتّبة عليه، والتي كان -ولا يزال- من أبرزها رمي بعض التفاسير بالاستطراد والخروج عن حَدّ التفسير، والتوسّع في الكتابة تحته، ومِن أظهرِ تجليات هذا الإشكال في تاريخِ التفسيرِ الحديثُ عن تفسير الرازي وما رُمِيَ به من القول باستطراده وحشوه التفسيرَ بما ليس منه، حتى قيل عن تفسيره: «فيه كلّ شيء إلّا التفسير»؛ تصويرًا لحجم خروج الرازي في تفسيره عن حدود التفسير، واستطراداته فيما لا يمتُّ له بِصِلَة، وهذه المقولة لا يُعْرَف لها على وجه التحديد قائل، نسبها بعضهم إلى ابن تيمية[1]، وآخرون إلى أبي حيان، وعزاها أبو حيان نفسه لعالم لم يسمِّه[2]، ولكن ليس ثمّ دليل قاطع إلى يومنا هذا في نسبة هذه المقولة إلى قائل، ومع هذا فقد استُحْضِرَت كثيرًا عند الحديث عن تفسير الرازي -رحمه الله- والترجمة له، يوردها بعضهم إقرارًا لها وتصديقًا بها، ويوردها آخرون متحفِّظين عليها ومعتبرين أن فيها مبالغة، وأن في تفسير الرازي كلّ شيء مع التفسير، واعتُبِرَ تفسيره تبعًا لهذا النظر موسوعةً علميّةً كبيرةً في عدّة علوم[3].
ونحن لدينا وقفتان مهمّتان مع هذه المقولة وفحواها ومع هذا التناول مِن قِبَل مَن تعرَّضوا لها:
الوقفة الأولى: أن هذا التناول -سواء مَن أقرَّ هذه المقولة ووافق عليه أو من عارضها مبينًا أنها قيلت على سبيل المبالغة- يبدو تناولًا غير منهجي؛ لأن هذه المقولة نابعة عن إشكالِ توسُّع الرازي -رحمه الله- في ذكر مسائل بعض العلوم، وتحديدًا علم الكلام والعلوم الطبيعية والرياضية، وهذا الإشكال أثاره الرازيُّ -رحمه الله- بنفسه وأجاب عنه إجابة وافية، قال -رحمه الله-: «وربما جاء بعضُ الجهال والحمقى وقال: إنك أكثرت في تفسير كتاب الله من علمي الهيئة والنجوم، وذلك على خلاف المعتاد! فيقال لهذا المسكين: إنك لو تأملتَ في كتاب الله حقّ التأمل لعرفت فساد ما ذكرته، وتقريره من وجوه؛ الأول: أن الله تعالى ملأ كتابه من الاستدلال على العلم والقدرة والحكمة بأحوال السماوات والأرض، وتعاقب الليل والنهار، وكيفية أحوال الضياء والظلام، وأحوال الشمس والقمر والنجوم، وذكر هذه الأمور في أكثر السور وكرّرها وأعادها مرّة بعد أخرى، فلو لم يكن البحث عنها، والتأمل في أحوالها جائزًا لما ملأ اللهُ كتابه منها. والثاني: أنه تعالى قال: {أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ}[ق: 6]، فهو تعالى حثّ على التأمّل في أنه كيف بناها، ولا معنى لعلم الهيئة إلا التأمل في أنه كيف بناها وكيف خلق كلّ واحد منها. والثالث: أنه تعالى قال: {لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ}[غافر: 57]، فبيّن أنّ عجائب الخلقة وبدائع الفطرة في أجرام السماوات أكثر وأعظم وأكمل مما في أبدان الناس، ثم إنه تعالى رغب في التأمّل في أبدان الناس بقوله: {وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ}[الذاريات: 21]، فما كان أعلى شأنًا وأعظم برهانًا منها أولى بأن يجب التأمّل في أحوالها ومعرفة ما أَوْدع اللهُ فيها من العجائب والغرائب. والرابع: أنه تعالى مدح المتفكِّرين في خلق السماوات والأرض فقال: {وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا}[آل عمران: 191]، ولو كان ذلك ممنوعًا منه لما فعل. والخامس: أنّ مَن صنّف كتابًا شريفًا مشتملًا على دقائق العلوم العقلية والنقلية بحيث لا يساويه كتاب في تلك الدقائق، فالمعتقدون في شرفه وفضيلته فريقان: منهم من يعتقد كونه كذلك على سبيل الجملة من غير أن يقف على ما فيه من الدقائق واللطائف على سبيل التفصيل والتعيين، ومنهم من وقف على تلك الدقائق على سبيل التفصيل والتعيين، واعتقاد الطائفة الأولى وإن بلغ إلى أقصى الدرجات في القوة والكمال إلا أن اعتقاد الطائفة الثانية يكون أكمل وأقوى وأوفى. وأيضًا فكلّ من كان وقوفه على دقائق ذلك الكتاب ولطائفه أكثر كان اعتقاده في عظمة ذلك المصنَّف وجلالته أكمل»[4].
وهذا النصّ يدلّ على أن الإشكال على تفسير الرازي يرجع إلى عصره، مما يقوي أن هذه المقولة ربما قيلت في حياته[5]، كما قد يفيد أن التفسير عند الرازي -رحمه الله- يشمل: بيان المعاني، وما يترتب عليها من وجوه الاستنباطات، والهدايات، وبيان وجوه إعجاز القرآن، وغير هذا مما يدلّ عليه كلامه، وهو قد استوعب بقدر طاقته بيان هذا كلّه في تفسيره، لكن المقصد الأهم عندنا هنا هو أن نقاش الأمر بعيدًا عمّا قال الرازي يبدو مسلكًا غير علمي، وترتَّبَ عليه -حتى في كلام مَن عارضَ فحوى هذه المقولة- حطٌّ من تفسير الرازي، وَحَيْدَةٌ عن وجهة النقاش التي أراد الرازي أن يُتَّجَه إليها؛ لأنّ كلام مَنْ قال إنها على سبيل المبالغة وإنَّ في تفسيره التفسير وكلّ شيء.. ونحو هذا من العبارات؛ إنما يعني أن ما ذكره الرازي من مسائل بعض العلوم ليست من التفسير، وأنها فيه من الاستطراد، غير أن هذا الفريق لا ينكر وجود التفسير معها، فكأنّ الشقّ المعترض عليه عندهم في هذه المقولة هو نفي حضور التفسير في تفسير الرازي، أما أن فيه أشياء كثيرة أخرى خارجة عن حدّ التفسير فمحلّ اتفاق بينهم. والرازي لم يُرِد هذا، بل اعتَبر أن ما يذكره من علمي الهيئة والنجوم من التفسير، كما يظهر من قوله، ولكن التناول العلمي يقتضي أن تُبْرَزَ مقولته وأن تُصدَّرَ حججُه التي أبداها تدعيمًا لها، ثم يُنسب له ما أراده، ثم يخالفه مَن شاء ويوافقه مَن شاء، وساعتها من أراد أن يخالفه فعليه أن يتصدّى لنقاش الرازي في مذهبه، ومفهومه في التفسير، ويبين غلطه فيه. أما أن يكون لصاحب الإشكال نصّ فنحيد عنه، ونحاول أن نلتمس له منه مخرجًا لو عُرض عليه لأَباه، فهذا ما لا نوافق عليه.
وأيضًا فنحن حين نُبرز الإشكال على ما بينّا مستحضرين كلام الرازي السابق فيه وإجابته عنه فإننا بهذا نجعل النقاش في هذه المسألة نقاشًا منهجيًّا، يتخطى كونها مجرد مقولة لا يُعلم لها قائل، قيلت على سبيل المبالغة؛ إلى إشكال حقيقي وقائم، ومعترف به من قِبَل الرازي نفسه، وهو إشكال ظاهر في تفسيره، ويستطيع كلّ قارئ أن يتلمحه فيه وأن يثيره على هذا التفسير، حتى ولو لم تُقَل هذه المقولة، لكننا حين نكتفي بنقل مقولة لا يُعلم لها قائل ونحملها على أنها مبالغة؛ فإننا نقزّم من حجم إشكال قائم فعليًّا، وله تداعيات عدّة على تفسير الرازي، من أخطرها أنه يحطّ من قيمته في التفسير ومكانته بين مدوناته؛ لأننا إذا وافقنا ابتداءً على خروج هذه المسائل التي يذكرها عن حدّ التفسير فإنها تصير من الحشو الذي لا فائدة منه في باب التفسير، وكلّما كانت مساحة هذا الحشو كبيرة -وهو كذلك- كلّما حطّ هذا من قيمة التفسير، بل يصير في عَدِّهِ من كتب التفسير نظرٌ، ولهذا فإن بعضهم حين يأتي للترجمة لتفسير الرازي يعتبره موسوعة علمية ضخمة في علوم شتى، وهذا وإن قيل على سبيل المدح أحيانًا فإنه يحمل في طياته ذمًّا لمن تأمله؛ لأن كلّ كتاب إنما ينبغي أن يكون مخلَّصًا في بابه وغايته، فإنْ خرَج كثيرًا عن حدّ العلم المؤلَّف فيه ذُمَّ ولم يُمْدَح[6].
وأمّا الذين يوردون هذه المقولة إقرارًا بها فإننا لم نقف على مَن أتى منهم بكلام الرازي وفنَّده، وبيّن غلطه فيما ذهب إليه، فتوضع الأمور حينئذ موضعها المناسب، ويَحْمَى التباحث حول الأمر على نحو علمي يُبْرِز الرأي والرأي المقابل له، لكن الغريب أنّا وجدنا الكلّ -تقريبًا- يذكر خروج الرازي عن التفسير، ولا أحد يورد كلامه ويجيب عمّا قاله ويبطل الأوجه التي ذكرها تدعيمًا لموقفه!
الوقفة الثانية: اختلاف مادة كتب التفسير على نحوٍ ملحوظ لا يجهله ذو عناية بها، وبسبب هذا الاختلاف اضطر المؤلّفون في مناهج المفسِّرين وعلوم القرآن أن يصفوا بعض التفاسير بأنها فقهيّة، وأخرى بأنها لغويّة، وأخرى بأنها علميّة...إلخ، وقالوا: إنّ كلّ مفسِّر استطرد فيما غلب عليه من تخصّصه العلمي، يقول السيوطي -رحمه الله-: «ثم صنَّف بعد ذلك قوم برعوا في علوم فكان كلّ منهم يقتصر في تفسيره على الفنّ الذي يغلب عليه؛ فالنحوي تراه ليس له همٌّ إلّا الإعراب وتكثير الأوجه المحتملة فيه ونقل قواعد النحو ومسائله وفروعه وخلافياته، كالزجّاج والواحدي في البسيط وأبي حيان في البحر والنهر.
والإخباري ليس له شغل إلا القصص واستيفاءها والإخبار عمن سلف سواء كانت صحيحة أو باطلة، كالثعلبي.
والفقيه يكاد يسرد فيه الفقه من باب الطهارة إلى أمهات الأولاد، وربما استطرد إلى إقامة أدلة الفروع الفقهية التي لا تعلّق لها بالآية والجواب عن أدلة المخالفين، كالقرطبي.
وصاحب العلوم العقلية -خصوصًا الإمام فخر الدين- قد ملأ تفسيره بأقوال الحكماء والفلاسفة وشُبَهها، وخرج من شيء إلى شيء حتى يقضي الناظرُ العجبَ من عدم مطابقة المورد للآية، قال أبو حيان في البحر: جمع الإمام الرازي في تفسيره أشياء كثيرة طويلة لا حاجة بها في علم التفسير؛ ولذلك قال بعض العلماء: فيه كلّ شيء إلا التفسير»[7].
إذن فالأمر ليس مختصًّا بالرازي، وإنما بكثير من الكتابات تحت التفسير، ربما يكون الرازي أبعَدَ في نوعية المادة التي أدخلها في كتب التفسير بحسب نظر بعضهم، إلا أنه أدخلها بذات المنطق الذي أدخل به غيرُه كثيرًا من المسائل اللغوية والفقهية والاستنباطات والهدايات والنظر في الحقائق العلمية للقرآن وغير هذا مما يمكن الاعتراض على كونه من التفسير أيضًا، ومساحة هذا الإشكال في نظرنا كبيرة، وتشمل العديد من كتب التفسير، ومن الكتب التي نسبت للتفسير على الرغم من خروجها في نسقها العام عن كتب التفسير العامة أو الشاملة، ككتب معاني القرآن مثلًا، وكتب تفسير آيات الأحكام، وتلك التي تُعَنْوَنُ بالتفسير البلاغي للقرآن...إلخ، ومن هاهنا فإنه يحقّ لنا أن نتساءل عن المعايير والضوابط التي نُظر إليها واعتُمد عليها عند الحكم على تفسير الرازي بهذا الحكم، والتي يمكن عبرها الحكمُ على كلّ الكتابات التي تنتسب للتفسير، وبناء هذه المعايير هو التحدي الحقيقي للمتخصصين في علم التفسير.
إنّ المتكلمين عن تفسير الرازي في هذا الجانب ينطلقون في الحديث وكأنّ للتفسير حدًّا معروفًا ومفهومًا واضحًا تتابعت الكتابات عليه، وأمكن بناءً على وضوح هذا المفهوم أن نقيّم الكتابات في التفسير فنُدْخِل فيه ونُخْرِج منه، لكن الواقع على خلاف هذه الصورة؛ فإن مفهوم التفسير ليس بهذا الوضوح، بل إننا نظنّ أن اختلاف مفهوم التفسير واختلال النظر إليه أحد أهم إشكالات هذا الفنّ، وتفسير الرازي وطريقته فيه ما هو إلا تجلٍّ من تجليات هذا الإشكال، كما أننا نظنّ أن هذا الاختلاف بين كتب التفسير في مادة التفسير وفي صياغته وعرضه هو ما دفع بعضهم لنفي عِلْمية التفسير؛ لأنهم رأوا أن التفسير شرحٌ للنصّ، تختلف أدواته وطرقه ولا تنتظمه قواعد كلية وطريقة واحدة يجري عليها عملُ كلّ مفسِّر، ونحن وإن كنا لا نوافق على هذا إلا أننا نؤكّد على حضور الإشكال وحاجته إلى حلول علمية تمكّن من تجاوزه ليستقيم البحث في مثل هذه الجوانب المهمّة من العلم، وإن لم نفعل فسيظلّ الدفع في كتابات تحت مصطلح التفسير نستشعر خروجها عن حدّه لكننا لا نستطيع ردّها بشكل علمي؛ لأن منطق الاستطراد واحد، فاللغوي يجعل للّغة ومسائلها النصيب الأوفر من كتابته في التفسير، ومثله الفقيه، والمحدِّث، والمعتني بإعجاز القرآن، وهذا من وجهٍ أمرٌ طبيعي، فكلّ العلوم الإسلامية مبنيّة على نصوص القرآن والسُّنة، ولكنه من وجه آخر غير مقبول؛ إذا نظرنا إلى علم التفسير باعتباره علمًا مستقلًّا، له حيثيته المميزة له عن بقية العلوم، ومَن رام الكتابة فيه فعليه أن يميّز حيثيته ويلتزم حدّه، أو يكتب تحت راية علم آخر، ونحن بحاجة إلى كتابات موجّهة نحو هذا الأمر، حتى نستطيع بطريقة علمية وموضوعية تقييد الكتابة تحت مصطلح التفسير بحسب مفهومه الخاصّ وحيثيته المتميزة.
[1] ينظر: الوافي بالوفيات (4/ 179).
[2] قال أبو حيان: «وهكذا جرت عادتنا: أنّ كلّ قاعدة في علم من العلوم يرجع في تقريرها إلى ذلك العلم، ونأخذها في علم التفسير مسلّمة من ذلك العلم، ولا نطول بذكر ذلك في علم التفسير، فنخرج عن طريقة التفسير، كما فعله أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي، المعروف بابن خطيب الري، فإنه جمع في كتابه في التفسير أشياء كثيرة طويلة، لا حاجة بها في علم التفسير؛ ولذلك حُكي عن بعض المتطرّفين من العلماء أنه قال: فيه كلّ شيء إلا التفسير». البحر المحيط (1/ 547). وقد حكاها أبو حيان عن غيره كما هو ظاهر، وليست له كما توهّم بعض من نسبها إليه، ولكنه مقرّ بصحة ما وجّه إلى تفسير الرازي من نقد في هذه الجزئية كما هو ظاهر من كلامه.
[3] يقول د/ غانم قدوري: «وبالجملة فالكتاب أشبه بموسوعة في التفسير وعلم الكلام وعلوم الكون والطبيعة». محاضرات في علوم القرآن (ص: 201).
[4] تفسير الرازي (14/ 274).
[5] معلوم أن هناك اختلافًا في تفسير الرازي، هل أتمه أم لا، وما هو القدر الذي فسره الرازي منه تحديدًا؟ ولكن ليس في هذا قول قاطع، والبحث فيه متجدّد، ولكن جدير بالذّكر أن الرازي -رحمه الله- ذكر هذا النصّ في تفسير سورة الأعراف، وهي من السور المتقدمة التي يُظن أنها من القدر الذي فسّره الرازي بنفسه، وليس مما فسره بعض تلامذته من بعده، وعلى كلٍّ فطريقة الرازي في تفسيره من أوله إلى آخره تعطي معنى ما جاء في هذا النصّ، ومثل الرازي إنما ينبغي أن يكون صنيعه أصلًا في تبين مقاصده.
[6] قال أبو حيان: «...وكان أستاذنا العلّامة أبو جعفر أحمد بن إبراهيم بن الزبير الثقفي -قدّس الله تربته- يقول ما معناه: متى رأيتَ الرجلَ ينتقل من فنّ إلى فنّ في البحث أو التصنيف، فاعلم أن ذلك إمّا لقصور علمه بذلك الفنّ، أو لتخليط ذهنه وعدم إدراكه؛ حيث يظنّ أن المتغايرات متماثلات». البحر المحيط (1/ 548)، وقد أورد أبو حيان هذا الكلام بعد ذكره لتفسير الرازي وانتقاده له، وانتقاده للاستطراد الواقع في التفسير عمومًا.
[7] الإتقان في علوم القرآن (4/ 242).
كلمات مفتاحية
الكاتب:

محمود حمد السيد
باحث في التفسير وعلوم القرآن، شارك في عدد من الأعمال العلمية المنشورة.
مواضيع ذات صلة
((المعلومات والآراء المقدَّمة هي للكتّاب، ولا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع أو أسرة مركز تفسير))