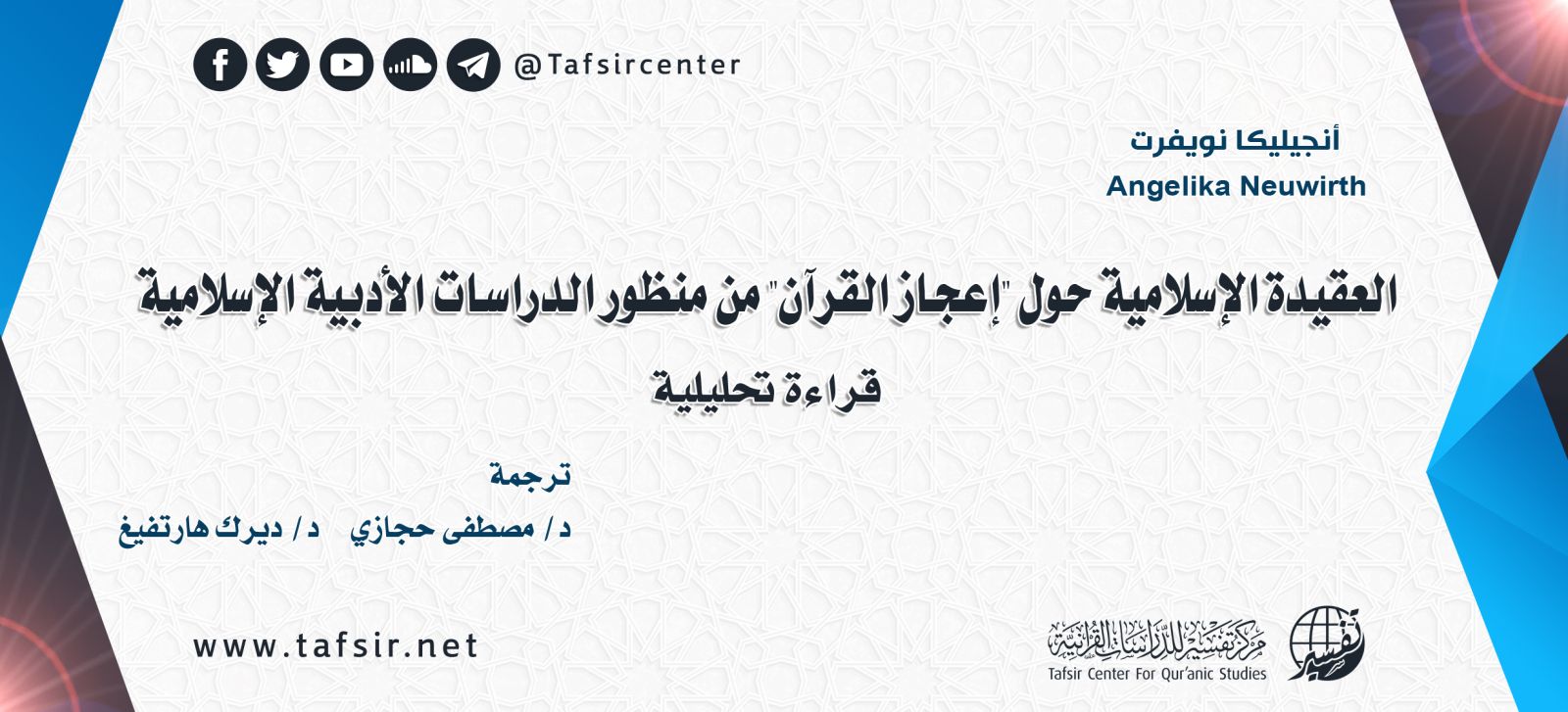فكرة الوثنية ونشأة الإسلام، من الجدل إلى التاريخ
فكرة الوثنية ونشأة الإسلام، من الجدل إلى التاريخ
الكاتب: وليد صالح - WALID SALEH

عرض كتاب
فكرة الوثنية ونشأة الإسلام
من الجدل إلى التاريخ
هذه الدراسة «تناقش المدى الذي وصل إليه الإسلام في الحجاج بشأن المشركين والوثنيين الحقيقيين، كما تقترح أن الإسلام أعار أكبر قدر من اهتمامه للموحدين الآخرين الذين رأى إيمانهم غير كافٍ فهاجمه سجالًا، تمامًا كما فعل مع الوثنية» (ص: XIII).
ولإثبات هذا الطرح نجد الكتاب «يناقش النظرة المعترف بها عمومًا؛ والتي يكون فيها الخصوم الذين يهاجمهم القرآن بوصفهم وثنيين ومشركين (وعادة ما تطلق عليهم تسمية بكلمات وجمل ترتبط بالكلمة العربية شرك)، وثنيين ومشركين بالمعنى الحرفي» (ص: 1). وبناء على ذلك، فإن الموقف النظري الذي يتبناه المؤلف يتناول «صورة الجاهلية، في المقام الأول، مُضَمَّنة في الأدب التراثي بصفتها انعكاسًا لفهم أصول الإسلام التي تطورت بين المسلمين في المراحل الأولى لظهور الشكل الجديد للتوحيد» (ص: 3). أمّا الجاهلية فهي الكلمة العربية التي أطلقها القرآن والتراث على الحقبة السابقة على الإسلام. وبالنسبة للمؤلف، فهو يرى أن المادة التراثية تشمل كل ما نتج عن الحضارة الناشئة، بغضّ النظر عن القرآن نفسه، والوثائق الصادرة من الفترة المبكرة؛ كالنقوش والمخطوطات والعملات (ص: 7، حاشية 13).
وبالنسبة للمؤلف؛ فإن القرآن لا يعبر عن الخلفية العربية، ولا حتى نشأ في قلب جزيرة العرب كما يدّعي التقليد. كما يجادل بأنّ «سجال القرآن ضد المشركين يعكس خلافاتٍ بين الموحدين أكثر مما بين الوثنيين، وأن التقليد الإسلامي لا يبدي معرفة حقيقية بالديانة الوثنية العربية. وليس ثمة سبب مقنع لتعيين أيٍّ من السجال أو التقليد في الجزيرة العربية» (ص: 16).
بالتالي، فإن القضية التي أثارتها هذه الدراسة لا يمكنها أن تظهر كقضية تاريخية، إلا إذا وُجِد اختلاف واضح بين القرآن وبين ما يسميه المؤلف «الأدب الإسلامي التقليدي». هذا -تحديدًا- هو موقف المؤلف، إضافة إلى افتراضه وجود ثغرة تاريخية بين تركيب القرآن وبين شكل هذا الأدب الإسلامي التقليدي (ص: 17- 18). والقرآن بالنسبة للمؤلف سابق على كل الأدبيات الأخرى. علاوة على ذلك، فإن المعرفة التاريخية المقبولة لدينا حتى الآن بشأن ظهور الإسلام المبكر بالنسبة للمؤلف ليست ناتجة عن القرآن، إنما عن هذا الأدب (الذي يعرّفه على أنه شامل كل شيء باستثناء القرآن). وهذه الدراسة مكرسة بالكامل لإثبات أن القرآن لا يجادل بشأن المشركين (الحقيقيين) عندما يتحدث عمّن يدعوهم بالمشركين، أولئك الذين يشركون مع الله آلهة أخرى. بل يدّعي المؤلف أن القرآن يتبنى حيلة بلاغية شائعة جدًّا في التقليد التوحيدي؛ إذا هي: يَعنِي بدعوة الشخص «وثنيًّا» وَسْمَهُ على أنه أقل مسيحية أو أقل يهودية من الفصيل المُتهِم. وهذا أمر يمكن تطبيقه على الحِجَاج القرآني كذلك.
يطرح هوتنج (G.R. Hawting) عمله على الْخُطَى الأكاديمية لعملَي جون وانسبرو (John Wansbrough)ـ[3]: الدراسات القرآنية (1977) والأواسط الطائفية (1979)، بيد أن ادّعاء هذه المصاهرة المنهجية مع منهج وانسبرو تقوِّض مسعى المؤلف في هذه الدراسة (ص: 16- 17). فالمشكلة التي أثارها هوتنج ليست بمشكلة بالنسبة لأنموذج وانسبرو؛ ففحوى مقاربة وانسبرو باختصار تتمحور حول كون الصرح الذي ندعوه (الإسلام) الآن، هو منتجُ تطوُّرٍ تاريخيّ طويل شامل تكوين القرآن. وبالتالي فإن القرآن -بالنسبة لـ وانسبرو- جزء من هذا الأدب الذي يُنَحِّيهِ هوتنج عن القرآن. ولا يزعم وانسبرو فقط بأن عملية اعتماد وتكريس المواد القرآنية حدثت خلال ثلاثة قرون -حيث كانت تتطور المواد القرآنية وتتغير- بل إنه يناقش أيضًا أن المواد القرآنية تكونت بصورة سجالية لمعارضة جماعات طائفية أخرى يُدْعَوْن بيهود العراق الربانيين؛ لذلك فمن غير المعقول أن يكون محور التركيز الرئيس للتقليد الإسلامي -الذي من شأنه في نظر هوتنج ووانسبرو خلق خلفية عربية للدين- قد فشل في ترك أي أثر لتلك الدعوى في القرآن.
يدّعي هوتنج أن القرآن كان الوثيقة الوحيدة التي غابت عن أنموذج وانسبرو، في المقابل يؤكد هوتنج على كون القرآن أنموذجًا مفتاحيًّا لفهم الإسلام، برغم أنه لم يخبرنا سبب ادّعائه؛ لذلك من غير الواضح كيف وإلى أيّ مدى يعنِي هوتنج بأنّ منهجه استكمال أو تحسين لمنهج وانسبرو. فتناول القرآن بمنأى عن التقليد هو إلغاء للأساسات البديهية لمنهج وانسبرو، ولا يمكن الأخذ بقول هوتنج بأن منهجه يتبع منهج وانسبرو وينحرف عنه في نفس الوقت، فلا يمكن للمرء أن يتبع «مقاربة وانسبرو عامةً دون مقترحاته المبدئية حول الكرونولوجيا المطلقة والنسبية» كما يقول هوتنج، إلّا بأن يغير أساسات الأنموذج بأسره (ص: 17). فالدلالات الكرونولوجية في منهج وانسبرو تمثل لب الموضوع، فإذا كانت عملية اعتماد القرآن (وبالتالي إقراره) حدثًا متأخرًا متزامنًا مع أدبيات إسلامية أخرى، فلماذا لا يعتبر التقليد أنّ القرآن أيضًا قد أثر فيما أوشكت أن تكون الدعوى الأساسية للدين الجديد؟ ومن أجلِ فصلِ القرآن عن الأدبيات الإسلامية التقليدية الأخرى علينا أن نلجأ إلى منهج المدرسة الألمانية في الدراسات القرآنية، التي يصرّ هوتنج على تأكيد انفصاله عنها. ولا يمكن للمرء الاستشهاد بوانسبرو والعمل بالمعايير الألمانية في الوقت نفسه؛ لذلك فإننا لسنا بصدد خطأ منهجي بسيط، بل نمثُل أمام خطأ جسيم يفسد العمل بأكمله. بالنسبة إلى من يتبع منهج وانسبرو تكون المشكلة ببساطة: أن القرآن فيه مواد تزعم بأنها تعكس ماضيًا وثنيًّا عربيًّا؛ لأن التقليد يريد أن يخلق تلك الصورة عن ذلك الماضي. وبالتالي فإن المواد القرآنية ليست تاريخية بقدر ما هي لا تعكس أيًّا من الأمور التاريخية عن الجزيرة العربية في القرن السابع، إلا أنها تاريخية بقدر ما تعكس ما أراد المسلمون أن يُلقى الضوء عليه فيما يخص دينهم الجديد وأصوله.
يُتَوَقّع ممّن يتبع منهج وانسبرو أن يعتبر وجود مواد (وثنية) في القرآن -كذكر الآلهة الثلاثة- دليلًا على أن التقليد كان يحاول أن يخلق وهمًا بأنّ محمدًا كان نبيًّا عربيًّا مبعوثًا في جمهور وثني؛ وبالتالي فإن المقاطع التي تتحدث عن الأوثان والمعابد والشعائر -وهي كثيرة في القرآن (راجع إقرار هوتنج بذلك ص 50)- موجودة لخلق هذه الصورة؛ لدرجة أن الأدبيات الإسلامية الأخرى -بوصف هوتنج- تحاول أن تخلق ذلك الوهم، وللدرجة التي يمكن عندها القول بأنها موجودة أساسًا من أجل خلقه، فلماذا علينا التصديق بأن القرآن متفرد في هذا الشأن؟ فنحن لا يمكننا أن نحوز على مختلف نوعي المواد الوثنية في الأدب الإسلامي الذي يطرحه هوتنج: حيث أحدهما خاطئ تمامًا؛ لأنه ليس صحيحًا تاريخيًّا (المواد التي سماها هوتنج «الأدب الإسلامي التقليدي»، والتي تزعم بأنها تعكس الوضع الحقيقي لبزوغ الإسلام في جزيرة العرب)، وثانيهما خاطئ جدليًّا ولكن صحيح تاريخيًّا (المواد الموجودة في القرآن التي تستخدم التصور الوثني مراءً فقط -بحسب هوتنج- والتي لا يمكنها إلا أن تشير إلى بيئة توحيدية، وبالتالي تشير إلى سجال تاريخي حقيقي مع «موحدين» آخرين). يبدو الاستنتاج محتومًا بأن القرآن -مثل التقارير حول حياة محمد التي يطلق عليها السيرة- كان أيضًا يحاول أن يخلق هذه الصورة عن الخلفية العربية.
ولذلك فإن مراجعة باقي الكتاب تتطلب منا إرجاء إطلاق الحكم عليه؛ لأننا حتى إذا تقبّلنا إصرار المؤلف على أن القرآن في مرتبة أعلى من التقليد ومتجاوزة له (متجاهلين المصاهرة المزعومة مع منهج وانسبرو وبالتالي متغاضين عن المعضلة النظرية التي يتضمنها الكتاب)، وحتى إذا اتّبعنا حجاج الكتاب، فسنجد أن معظم استنتاجاته مبنية على أضعف الأدلة، وهو واقع يمكن أن يقرّه المؤلف نفسه. والمحور الذي يدور الكتاب حوله الذي من المفترض أنه يصاهر منهج وانسبرو، يثبت غياب هذه المصاهرة لدى التدقيق فيه، فضلًا عن أن معظم الأدلة التي يستخدمها المؤلف لكي يثبت نظريته تتعارض معها.
سأعرض الآن أمثلة من منهج المؤلف؛ ففي الفصلين الثاني والثالث يحاول هوتنج إظهار أن القرآن لا يشير إلى (الشرك الحقيقي) إطلاقًا. ويعتمد جُلّ حجاجه على تحليل كلمة (شرك) وما شابهها في القرآن؛ فيسعى إلى تبيين أنّ لهذه الكلمات معنًى مختلفًا تمامًا عما نفترضه، كما يعتمد على إثبات ما إذا كانت كلمة (شرك) العربية تشير إلى المشركين أم لا، فإذا كانت النقوش السابقة على إسلام القرن السابع تستخدم هذه الكلمة للإشارة إلى المشركين، فلا بد أن القرآن يقصد بها (المشركين الحقيقيين). ومع توافر هذا النقش الذي يقدّمه نقشٌ سبئيّ في المتحف البريطاني؛ يتوجب على المؤلف أن يتعامل مع هذا النقش، ومع نقشَيْن آخرين استُخدِم فيهما الجذر (ش ر ك)، وفي ضوء ذلك فإن هوتنج حاول تخفيف وطأة تضمينه لهذه النظرية حول النقوش بالتشكيك في هذا التضمين عبر تذييله بحاشية تقول: «لقد نبهني د. آرثر إرڤِن Arthur Irvine إلى أن هناك بعض التساؤلات التي تثيرها قراءة هذا النص» (ص: 70، حاشية 6). ويا لها من طريقة مقلقة لرفض النظر في أعمال منشورة باعتبارها أقاويل! فالمؤلف يعيش ويعمل في لندن، والنقش موجود حيث يعيش، وحيث يمكنه النظر فيه. ولإنكار قراءةٍ ما، على المرء أن يبدي كيف ولماذا يُخَطِّئ القراءة الأصلية التي قام بها رواد من الباحثين في مجالهم. وليس على المرء إلا مراجعة كتاب المفردات الأعجمية في القرآن لآرثر جيفري Arthur Jeffery لكي يَطَّلِع على النقش السبئيّ وترجمته إلى الإنجليزية: «وتجنَّب أن تتخذ شريكًا مع إلهٍ قادر على إحلال الكوارث وكذلك جلب الخيرات» (ص: 186). ولا يشير هوتنج مباشرة إلى هذا الاستشهاد، بل يشير بدلًا من ذلك إلى بحثٍ آخر يستشهد بهذا النقش، والواقع أن أغلب الكتاب هو محاولة للتقليل من شأن الدليل الباليوغرافي الذي يثبت الوجود التاريخي لأسماء الآلهة المذكورة في القرآن. وبالنسبة إلى مدرسة الباحثين الذين يتحسرون على قلة النقوش المؤرخة التي يمكن مقارنتها مع القرآن، فإن التساهل في تجاهل الكتاب لهذا الدليل هو شيء مثير للحيرة[4]؛ لذلك يبدو أن كلمة (شرك) هي كلمة قديمة وشائعة في جزيرة العرب، وأنها تشير إلى المشركين فعلًا. وحتى إذا كان نقشٌ واحدٌ يُعَدّ دليلًا بسيطًا بالنسبة لهوتنج، إلّا أنه غير مساوٍ لعدم وجود دليل على الإطلاق، وطالما لدينا دليل مادي يدعم القراءة التقليدية، فلسنا ملزمين برفض كليهما.
لكن من هم المشركون الذين يشن عليهم القرآن أشد هجومه؟ إن هوتنج لا يقدم تحليلًا مستفيضًا لهذه المواد في القرآن، ويقدم بدلًا من ذلك تلخيصًا مقتضبًا: «فإذا كان بوسع المرء أن يقبل هذه الآيات دون التشكيك في مقاصدها، فلا بد أن المعارضين على علم بسلطان الله، وربما بأمر يوم القيامة، وذلك ليس بأمر يسهل مواءمته مع التصور التقليدي عنهم كمشركين وعابدي أوثان» (ص: 52). وإن كان الأمر كذلك فنحن بصدد مشكلة حقيقية؛ نظرًا لأن أغلب المادة القرآنية تهاجم مجموعة من الناس الذين لا يؤمنون بالنشور ولا بيوم القيامة. وآيات القرآن أكثر مما يمكن أن نستشهد به، لكن يمكنك الاطلاع على الآيات (22- 32) من سورة الأنعام على سبيل المثال. فعليًّا هذه هي طبيعة المواد التي تُحتِّم عليّ الاختلاف مع هوتنج، فأساس الخلاف بين القرآن وأكبر معارضيه كانت مسألة النشور ويوم القيامة، فتقوم مشاهد يوم القيامة حيث لا تستطيع آلهة المشركين أن تشفع لهم أو أن تنقذهم، بدور دراماتيكي، إذ يسخر القرآن من إيمان المشركين بتصوير آلهتهم وكأنها قادرة على الشفاعة عند الله أو كأنهم وسطاء بينهم وبينه (سورة يونس: 18، سورة الزمر: 3)؛ لذلك فإن هوتنج مخطئ بشأن ما انتهى إليه من أن المشركين «ربما» كانوا مؤمنين بيوم القيامة (سورة يونس: 15).
بناء على ما سلف، لم يؤمن المشركون بالنشور (سورة الإسراء: 49، سورة الصافات: 1- 39) وأهم من ذلك، لم يكن لهم كتاب بعكس اليهود والمسيحيين. (ولا يجب أن ننسى أن القرآن هو الذي ابتكر جملة «أهل الكتاب») والواقع أن كلمة أُمّي (الجمع: أميين) المستخدمة في القرآن تصف -تحديدًا- الحالة الآتية: أمّة بدون كتاب سماوي، أمّة جنتايلية (وثنية مشركة)؛ ولذلك فإن عزوف هوتنج عن مناقشة هذه الكلمة في عمله أمر محير، فالعرب قبل الإسلام كأمّة بدون كتاب يمثلون جزءًا رئيسًا في تكوين الصورة التي يقدمها كل من القرآن والسيرة، الأمة التي قرر الله أن ينزل عليها كتابًا عربيًّا وأن يرسل فيهم رسولًا من بينهم يبلغهم بالوحي بلسانهم العربي، وهذا جزء أساس من الصورة القرآنية؛ لذلك حتى إذا تمكن المؤلف من إلقاء ظلال الشك على وثنية معارضي القرآن، ستتبقى لنا على كل حال أجزاء كبيرة من الصورة التقليدية عن العرب قبل الإسلام المقدمة في القرآن بوضوح.
وخلافًا لقول إرنست رِنان Ernest Renan الذي كثيرًا ما اقتُبس وكثيرًا ما كان موضع سخرية؛ بأنّ الإسلام قد وُلِد في تِمِّ ضوء التاريخ، فإنّ المؤرخين الجذريين (التنقيحيين) يقترحون علينا بأن الإسلام قد وُلِد في ضباب التاريخ[5] (ص: 10). وبرغم مرور 30 عامًا على نشر كتاب وانسبرو، فلا يزال علينا أن نتوصل لإطار تاريخي لفهم مسلك تطور الدين الإسلامي، وبغضّ الطرف عن الإجابة العامة القائلة بأن الإسلام (تطور) على مدى تاريخ طويل، فإننا نرفض التواريخ والإجابات القاطعة. وذلك ما يميز الإسلام في تواريخ الأديان التوحيدية في الشرق الأدنى؛ ولذلك نُبِذ المؤرخون الذين يسعون لوضع هذه الخطوط العريضة، لامتناعهم عن الاعتراف باستحالة هذه المهمة، أمّا التشكيك في مدرسة التأريخ الألمانية للإسلام، فهو أهم ما يجب على هذا التنقيحي أن يبرهن عليه. ويدرك هوتنج هذه المشكلة جيدًا، ويعتذر لنا عن كون الكتاب «بشكل أساسي نقدي وتفكيكي، ويشكك فيما استعدّ كثيرٌ من الباحثين لقبوله كثوابت يقينية، ويستبدل بـ (الحقائق) التساؤلات والإشكالات» (ص: 19).
هناك كثير من النظريات البديلة فيما يتعلق بنشوء الإسلام حيث لا يمكن الحديث عن مدرسة تنقيحية، بقدر ما يمكن الحديث عن جهود تنقيحية؛ لذلك كان الإسلام طائفة يهودية (على نسق الهاجرية Hagarism)، أو مسيحية (على نسق لكسنبرج Luxenburgـ[6])، أو أنه قد نشأ في صحراء النقب (على نسق يهودا دي نيفو)، وأنّ القرآن معاصرٌ للسيرة (وانسبرو)، والقرآن سابقٌ على السيرة والحديث (على نسق أوري روبين Rubin)، وفي هذا الكتاب، فالقرآن منتج عراقي سابق على السيرة وعلى خلاف معها. ووفقًا لهوتنج، فالعرب لم يفقدوا كل أثرٍ لماضيهم ما قبل الغزو فحسب، بل نسوا لمن كان القرآن موجّهًا في بادئه، رغم الافتراض بأنه قد تطور في العراق بعد تأسيس الخلافة العباسية. ومع كثرة النظريات المتعارضة، أصبح هوتنج مجبرًا على مخالفة الأشخاص الذي يصنف نفسه معهم فقط لكي يثبت نظريته، وإنه من قبيل التضليل القول بأن هذه الدراسة تهاجم المدرسة الألمانية حصرًا؛ إذ هاجمت جميع الفرضيات الأخرى (وإن كان على نحو ألطف).
إن المدرسة الألمانية تصبح أكثر جذبًا للاهتمام مع ازدهار الفكر التنقيحي؛ ولا عجب أن أحد أبرز أعمال هذه المدرسة: محمد والقرآن لرودي بارت[7] (Rudi Paret - Mohammed und der Koran) يغيب دائمًا عن مساردهما. ويبدو أن القاعدة المنهجية الوحيدة في الفكر التنقيحي هي قدرة المرء على تقديم أيّ نظرية حول أصول الإسلام، مهما كانت مخالفة للدليل، طالما كانت مخالفة للمدرسة الألمانية.
[1] هذه المادة هي ترجمة لعرض كتاب:
G. R. Hawting. Idea of Idolatry and the Emergence of Islam: From Polemic to History. Cambridge: Cambridge University Press, 2002. xvii + 168 pp. $70.00 (cloth), ISBN 978-0-521-65165-3.
المنشورة في: (H-Mideast-Medieval) عام 2005، بعنوان: In the Fog of History.
[2] ترجم هذه المادة: أمنية أبو بكر، مترجمة، لها عدد من الأعمال المنشورة.
[3] جون وانسبرو (1928م- 2002م) مستشرق أمريكي، يُعتبر رائد أفكار التوجّه التنقيحي، وتعتبر كتاباته منعطفًا رئيسًا في تاريخ الاستشراق، حيث بدأت في تشكيك جذري في المدونات العربية الإسلامية وفي قدرتها على رسم صورة أمينة لتاريخ الإسلام وتاريخ القرآن، ودعا لاستخدام مصادر بديلة عن المصادر العربية من أجل إعادة كتابة تاريخ الإسلام بصورة موثوقة، وأهم كتاباته: «الدراسات القرآنية؛ مصادر ومناهج تفسير النصوص المقدّسة» (1977م)، وقد نشرنا عرضًا مترجمًا لهذا الكتاب، كتبه: كارول كيرستن، ترجمة: هند مسعد، يمكن مطالعته ضمن ترجمات ملف (الاتجاه التنقيحي)، على قسم الاستشراق بموقع تفسير. (قسم الترجمات).
[4] لاحظ السهولة التي يشكك بها هوتنج في المواد التي تدحض نتائجه؛ راجع: John F. Healey’s Religion of the Nabataeans: A Conspectus. يقول هايلي: لا مجال للشك في القراءات. (بغض النظر عن هوتنغ 1999، 113 n.1) ص: 128.
[5] نشرنا ملفًا حول هذا الاتجاه بعنوان «الاتجاه التنقيحي»، ضم عددًا من المواد المتنوعة حول نشأته ومنهجياته وأثره في حقل الاستشراق المعاصر، يمكن مطالعته على قسم الاستشراق بموقع تفسير، (قسم الترجمات).
[6] كريستوف لكسنبرج، هو اسم مستعار لكاتب، أصدر عام 2000 كتابًا بعنون: (قراءة آرامية سيريانية للقرآن؛ مساهمة في فكّ شفرة اللغة القرآنية)، وتحدّث فيه عن وجود نسخة مبدئية من القرآن (قرآن أصلي) كتب بلغة مزيج بين العربية والآرامية، وقد نشرنا عرضًا للكتاب، كتبه: فرنسوا دى بلوا، ترجمة: هدى عبد الرحمن النمر، يمكن مطالعته على قسم الاستشراق بموقع تفسير، ضمن ترجمات «الاتجاه التنقيحي». (قسم الترجمات).
[7] رودي بارت، مستشرق ألماني، ولد عام 1901، وتوفي عام 1981، ومن أشهر أعماله ترجمته للقرآن، والتي عمل فيها سنين طويلة وأخرجها تباعًا منذ 1963 وإلى عام 1966، وهي ترجمة وشرح أو تعليق فيلولوجي، كما أنه له كتاب مهم طالما يشير إليه المختصون في الاستشراق الألماني، وهو كتاب «الدراسات العربية والإسلامية في الجامعات الألمانية، المستشرقون الألمان منذ تيودور نولدكه»، وقد ترجم للعربية، حيث ترجمه مصطفى ماهر، وصدر عام 2011 عن المركز القومي للترجمة والهيئة العامة المصرية للكتاب، وهذا الكتاب لا يعرض فحسب صورة لتطور الدراسات العربية والإسلامية في ألمانيا على يد أحد أهم المتخصصين، لكنه كذلك يتناول مسألة التلقي العربي لكتب المستشرقين، ويوضح رأيه فيها. (قسم الترجمات).
الكاتب:

وليد صالح - WALID SALEH
أستاذ الدراسات الإسلامية، ومدير معهد الدراسات الإسلامية بجامعة تورونتو بكندا.
مواضيع ذات صلة
((المعلومات والآراء المقدَّمة هي للكتّاب، ولا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع أو أسرة مركز تفسير))