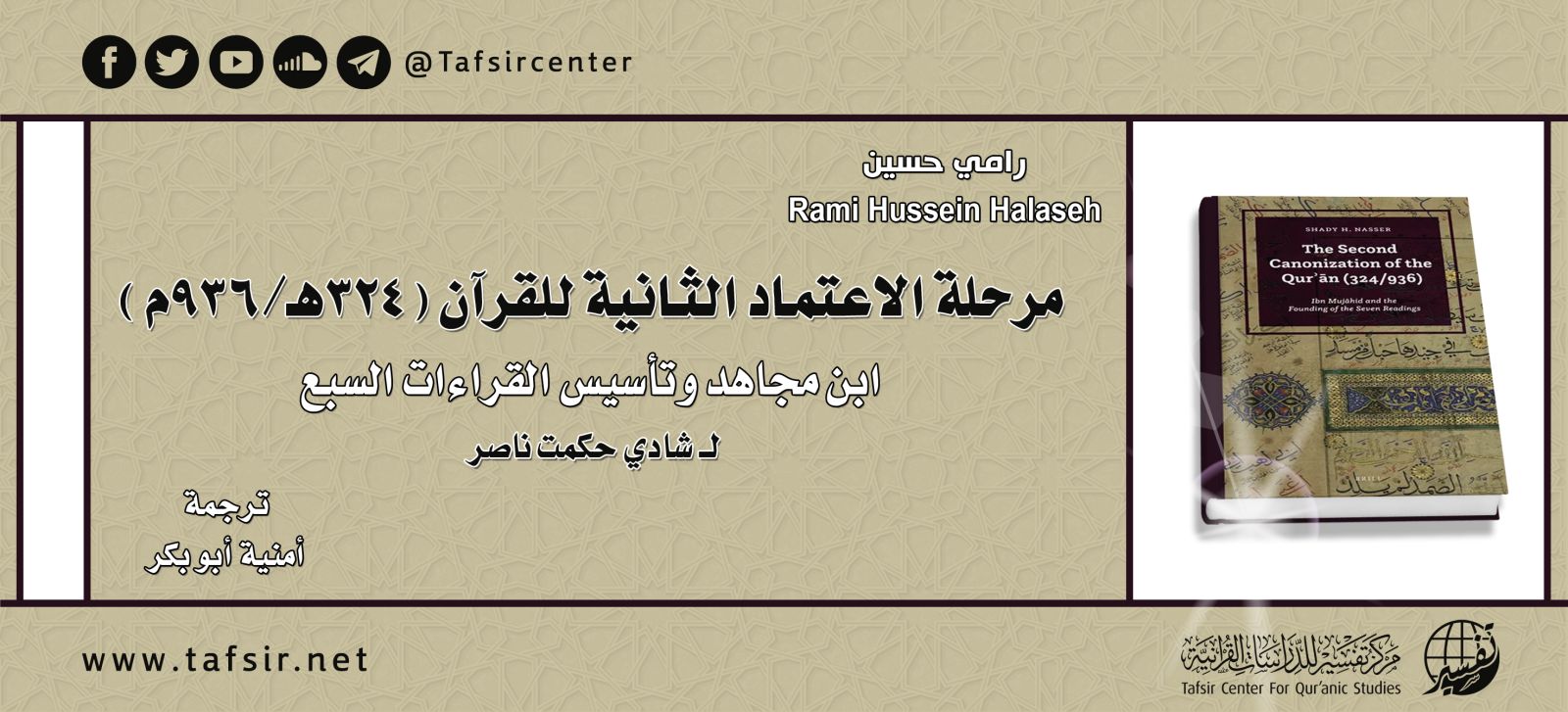عرض كتاب: تشكُّل التقليد التفسيري الكلاسيكي
عرض كتاب: تشكُّل التقليد التفسيري الكلاسيكي

عرض كتاب
تشكُّل التقليد التفسيري الكلاسيكي؛ دراسة لتفسير الثعلبي (ت 427/ 1035)
إننا إِذْ نسأل كيف استطاع المسلمون استخلاص المعاني من القرآن، أو بالأحرى: كيف أفاض عليهم نصُّ القرآن هذا الكمّ من المعاني قرنًا بعد قرن =فإننا سنصل إلى استنتاجٍ مفاده أنّ البحث عن المعنى الحقيقي للنصّ القرآني قد أسفر عن طبقات مضاعفة من المعاني. يستشهد وليد صالح بقول محمد بن أحمد القرطبي (ت671/ 1272) عن الآية: {وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ}[لقمان: 27] التي تبيّن أن كلمات الله لا تنتهي، حيث يرى أنها «تُشير إلى المعاني الفيّاضة والكثيرة لكلمات الله، وأنّ تلك المعاني لا تنفد ولا نهاية لها» (ص1، حاشية2)[3]. يمكن أن تلخّص هذه العبارة جهود الأجيال المتعاقبة من العلماء الذين انخرطوا في تفسير القرآن من أجلِ الوقوف على معاني كلمات الله وشرحها لمعاصريهم. من المحتمل أن يشكِّل «تعدّد المعاني» أساسًا لفهم تعدّدية التقاليد التفسيرية، التي لا تخبرنا كثيرًا عن القرآن بقدر ما تخبرنا عن المفسّرين أنفسهم ومجتمعاتهم وثقافاتهم. يتطرق صالح إلى هذه النقطة تحديدًا عندما يقول إننا نجد في تفسير القرآن «ما يعكس اهتمامات كلّ جيل من العلماء المسلمين» (ص2)، رافضًا بذلك وجهة النظر القائلة بأن هذا التخصّص كان «مشروعًا منفصلًا ومتجاوزًا للتاريخ ومقطوعَ الصلة بالوسط الثقافي الذي أُنتج فيه» (ص11).
ومع ذلك، من المهم أن نلاحظ أنّ ممارسة التعليق على كلمات وفقرات القرآن وتفسيرها وتوسيع الكلام على ما فيها وتطبيقها =لم يكن بالفعل مقصورًا على المفسّرين، كما لم يكن محصورًا داخل النوع الذي نسمّيه (التفسير)؛ فقد أورد العديدُ من المؤلفين من مختلف التخصّصات الكثيرَ من مفاهيم وكلمات وآيات القرآن وأشاروا إليها في أعمالهم؛ وقد يكون كلّ استخدام من هذه الاستخدامات مصحوبًا أو غير مصحوب بشكلٍ واضح من أشكال التفسير، ولكن مجرّد إدراج مقاطع نصيّة من القرآن -ناهيك عن التعليق عليها- يمكن أن يُنظر إليه بالتأكيد على أنه يحمل طابعًا تفسيريًّا مهمًّا. بعد قولي هذا، فإنّ الحجم الهائل ومقدار التفاسير القرآنية الرسمية (مجموعة المكتبة البريطانية، على سبيل المثال، تحتوي على ما يقرب من أربعمائة تفسير) تجعل من الواجب أن يحظى هذا التخصّص بمزيد من الاهتمام؛ وهنا يؤكِّد ظهورُ كتاب وليد صالح على الساحة الأهميةَ المتزايدة للدراسات المتعلّقة بتفسير القرآن كما هو موجود في نوع التفسير الرسمي. بالنسبة لأيّ شخص مطَّلِع على تاريخ التفسير القرآني، فسيكون هذا الكتاب ممتعًا ومفيدًا؛ حيث إنه يفتح اتجاهات جديدة للتساؤل، ويعيد النظر في بعض الأفكار التي اعتُبِرت من مُسَلَّمات هذا المجال، مما يفتح آفاقًا جديدة لفهمٍ أفضل للتراث والأدب التفسيري.
على الرغم من أننا ما زلنا بعيدين عن تحقيق فهمٍ شامل لمجمل التعقيدات التي شكّلت عِلْم التفسير، إلا أنّ الوقت قد حان لأن يتجه عمل الباحثين نحو تاريخ التفسير القرآني، والذي يتطلب بدوره المزيد من الأعمال الفيلولوجية الأساسية (مثل: تحرير المخطوطات وفهرستها)، وإعادة توجيه الجهود التي تركّز على جميع فترات تفسير القرآن، وإعادة تقييم للنظريات التي قُدِّمت في المائة عام الماضية (لم نشهد منذ نشر بحث جولدتسيهر «مذاهب التفسير الإسلامي»[4] في عام 1920 محاولاتٍ لتقديم دراسة شاملة للتفسير تتناول إحداثياته الزمنية والنمطية والمنهجية والعقدية).
يُعَدّ كتاب وليد صالح إسهامًا مفيدًا في تحقيق هذه الغاية؛ إنه مشروع جريء نسبيًّا؛ نظرًا لأن تفسير (الكشف والبيان) لم يُحرَّر بشكلٍ صحيح أو نقدي، ومع ذلك فقد لجأ المؤلّف إلى العديد من المخطوطات على نطاق واسع، وبالتالي استطاع سد ّالفجوة بين العمل الفيلولوجي والمعرفة التحليلية. يغطي كتاب (تشكُّل التقليد التفسيري الكلاسيكي) جانبين مهمّين؛ فمن ناحية: يفحص ويحلّل تفسير أبي إسحاق أحمد الثعلبي (الكشف والبيان عن تفسير القرآن)؛ ومن ناحية أخرى، فإنه لا يقدّم فقط السياق التاريخي والفكري الذي ظهر فيه عمل الثعلبي، بل يبيّن أيضًا كيفية ارتباطه بما يسميه صالح «الاتجاه الجينيالوجي»[5] في التفسير القرآني.
إنّ المفهوم الأساسي الذي ترسَّخ سابقًا -والذي يقدّم صالح رؤية مخالفة له- هو النظرة السائدة لتفسير محمد بن جرير الطبري (ت310/ 923) على أنه -بطريقةٍ ما- ذروة «التقليد التفسيري»؛ حيث يُعتبر كتاب صالح -بمعنًى ما- تأكيدًا لمكانة الثعلبي المؤثرة في تاريخ التفسير، وتجديد النظرة إلى تفسيره على أنه «غيَّر وأعاد تشكيل» التقليد التفسيري، بحيث يصبح عمله «أكثر تأثيرًا» من عمل الطبري (ص5)؛ ويبدو واضحًا أن هدف صالح هو جعل الثعلبي أقرب إلى مركز دراسات التفسير. كما يرى صالح أن الثعلبي لم يواصل مهمّة الطبري فحسب، بل «أعاد بناءها وأنجزها بطريقة جديدة» (ص8). من الثابت في الدراسات الإسلامية (والدراسات التاريخية بشكل عام) أن يُحتفى بمؤلِّفِين معيَّـنِين ويُنظر إليهم كمؤسّسين لبعض الاتجاهات، وآخرين يتعرّضون للتهميش والنبذ باعتبارهم استثناءات وخارجين عن القواعد (أو العكس). في هذه الحالة، يجب أن يُستقبَل إسهام صالح في التخفيف من تأثير الطبري وإبراز تأثير الثعلبي بشيء من الحذر، وإلّا وقعنا في خلط بين التأثير في التقليد التفسيري والتميّز الفكري. يشير صالح مرة أخرى إلى نقطة عامة مهمّة: وهي أنّ القرنَين الفاصلَين بين الطبري ومحمود بن عمر الزمخشري (ت538/ 1144) شَهِدَا «صعود هيمنة» ما يسميه بـ«مدرسة نيسابور في التفسير»؛ والتي تضم تفسير الثعلبي نفسه، وأستاذه الحسن بن محمد بن حبيب (ت406/ 1015)، وتلميذه ووريثه الفكري عليّ بن أحمد الواحدي (ت486/ 1076). وقد كان لمدرسة نيسابور «تأثير بالغ» في القرون التالية (ص4) حتى إنها -كما صرح صالح بشيء من الجرأة- «قد تكون الأفضل في هذا المجال» (ص49). (صرح المؤلف عن نيّـته في الكتابة عن الواحدي (ص28، حاشية 14) والتي ستقدِّم -بلا شك- إسهامًا قـيّمًا لمعرفتنا بـ«مدرسة نيسابور»).
إنّ كتاب (تشكُّل التقليد التفسيري الكلاسيكي) مسبوك جيدًا ومنظّم بعناية؛ حيث يحتوي على ملخص مفيد للفصول (ص5-14)، وقد تعزّزت جودته وقوّته بإضافة ثلاثة ملاحق، هي على التوالي: (مخطوطات تفسير الثعلبي، وشيوخه، والمصادر التي اعتمد عليها في تفسيره ولم تصلنا)، لكن كان من الأفضل أيضًا إضافة قائمة بالمصادر التي وصلت إلينا، حتى مع مناقشتها في صُلب النصّ.
قام التحليل الذي أجراه صالح على شقّين؛ الأول: (مقاربة تناصية خارجية) على المستوى الماكروي/ الكلي (كما يسميه صالح) لمحتويات تفسير الثعلبي في مقارنة مع أعمال المفسرين الآخرين، مثل: الطبري والزمخشري والقرطبي وغيرهم. الشق الثاني: هو (قراءة تناصية داخلية) (على المستوى الميكروي/ الجزئي) لتفسير الثعلبي تركّز على العلاقات الموجودة بين نظرية التأويل التي وضعها في مقدمته وممارسته التفسيرية الفعلية. تشغل الفصول المخصصة لهذا التحليل (الفصلان الخامس والسادس) 40٪ من الكتاب.
يقترح صالح وصفًا للتفسير على أنه «كلّي الوجود»، وأنه «تقليد جينيالوجي» يكون «في كلّ لحظة... متاحًا بأصله وفصله وكامل بنيته أمام المفسِّر»؛ ومن هذا المنظور يضع كلّ مفسّر «لبِنة في صرح مجموعة التفاسير الموروثة» (ص14)؛ ومع ذلك فهو لا يستكشف أو يتبنّى كلّ الآثار المترتبة على تعريف التفسير على أنه (تقليد) من الناحية الأنثروبولوجية. لن نتحدث -كما يفعل صالح- عن التقاليد التي «كان من المستحيل استبعاد أيّ مكون رئيس منها... بعد أن يكون قد دخل فيها وأصبح جزءًا منها» (ص15). بدلًا من ذلك، يجب أن ننظر إلى (التقاليد) على أنها بُنًى، مع الأخذ في الاعتبار عوامل مثل فئة التراث الاجتماعي، ومفهوم -وهو الأهمّ- التقليد المخترع[6]. وهذا يعكس مدى قلّة الباحثين -في حقل في الدراسات الإسلامية- القادرين على استخدام الأدوات المفاهيمية والمصطلحات التي تقدمها الإسهامات الفكرية في العلوم الاجتماعية.
أصاب وليد صالح في رفضه ثنائية التفسير بالمأثور والتفسير بالرأي (التي كانت في الأصل مثيرة للجدل، وكرّرتها الدراسات الحديثة) باعتبارها «قسمة أيديولوجية» لا أساس لها في النوع نفسه؛ وعلى حدّ تعبيره، فإنّ «معظم التفسير بالمأثور هو في الواقع تفسير بالرأي» (ص16)[7]. لكن على الرغم من محاولته -الجديرة بالثناء- فقد خَلَق فئات جديدة لوصف أنواع مختلفة من التفسير (مثل «الموسوعي» و«المدرسي»[8]، والتي أضاف إليها أيضًا «الطابع التعليمي»)[9]، كما أنه استخدم مصطلحًا غامضًا إلى حدّ ما هو: (المذهب السُّنّي). ينظر صالح إلى (المذهب السُّنّي) على أنه «مظلّة كبيرة تتعايش تحتها العديد من الأفكار والمذاهب» (ص18)، لكنه تركها دون أن يحدّد عمق هذه الأفكار. وعلى الرغم من أنّ صالحًا قدَّم تحذيرًا فيما يتعلّق باستخدام مصطلحات (السُّنّة) و(التيار المحافظ/ التقليدي) و(البدعة) (ص28)، إلّا أنه غالبًا ما استخدمها في سياقٍ مجهول وغير محدّد: «كلّ المعاني التي أقرّها أهل السُّنّة كانت مقبولة، وقد أقرّها المذهب السّني؛ لأن شروط قبوله كانت فضفاضة ومرنة» (ص20). ويضيف أنّ «الدولة دَعَمَت ورَعَت الإسلام المحافِظ» (ص27)، وهذا يعني أن هناك ما يمكن أن نسميه (الإسلام المحافظ/ التقليدي) وقد دعمته الدولة، في حين أن ما حدث هو العكس: الدعم الذي قدّمته المؤسّسة على وجه التحديد هو ما شجّع أصحاب عقيدةٍ ما على التلبُّس بثوب (المحافظة). أيضًا، عندما يقول أنّ «العقيدة كانت تُبْنَى، ولا يُنْتَمَى إليها» (ص48) في زمن الثعلبي، فإنه يستخدم مصطلح (المحافظة) كمرادف لـ(السُّنّة)، في حين أنّ الواقع أنه كانت هناك أيديولوجيات متنافسة تدّعي حمل لواء الحقيقة؛ بعبارة أخرى: كانت هناك (تيارت) محافظة متنافسة.
يرى صالح أنه بسبب (الطبيعة الموسوعية) لتفسير الثعلبي، وتضمينه موادّ شيعية =رأى ابن تيمية (ت728/ 1328) أنه غير موثوق به ولا يُعوَّل عليه. إلا أن تصريحات صالح حول «الدور الرئيس الذي لعبه ابن تيمية في ترسيخ نوعٍ جديد من الهرمنيوطيقا التأويلية»، وأنه وجّه «ضربة» لكلّ من الثعلبي والتقاليد التفسيرية الموسوعية، مما يسمح في النهاية بترسيخ التفاسير التي تعتمد التفسير بالمأثور =يبدو أنها تأكيداتٌ مبالَغٌ فيها عن تأثير ابن تيمية على الفكر اللاحق، ويجب إعادة النظر فيها في ضوء أحدث الأبحاث العلمية، مثل عمل خالد الرويهب[10].
يوضح صالح في الفصل الأول أن المجاميع الببليوغرافية هي مصدر مهمّ للكثير من المعلومات، وتزودنا بما يقترب أكثر من تصوير كامل لحياة الثعلبي من خلال إعادة بناء شاملة تستند إلى العديد من الأعمال. وقد ضمّت مصادره الرئيسة الواحدي وعبد الغافر الفارسي المتأخّر (ت529/ 1135)[11].
يتضمن الفصل الثاني تفنيدًا للادّعاء القائل بأن الثعلبي كان مشاركًا صوفيًّا في حلقة أبي القاسم الجنيد، وقد ردّد هذا الادّعاء -مِن بين آخرين- تيلمان ناجل[12]، كما يفنِّد صالح الادّعاء بأنّ عمل الثعلبي بعنوان: «قتلى القرآن»، (وهو مجموعة من القصص عن أولئك الذين عانوا من النشوة حدّ الموت عند الاستماع إلى تلاوة القرآن) هو عمل صوفي، وهو ما أشارت إليه بيات فيسمولر. يشير صالح بتحليل صحيح إلى أنه من المضلل الافتراض أن «التقوى الدينية المفرطة في المجتمعات الإسلامية في العصور الوسطى كانت سمة خاصّة بأتباع الصوفية» (ص59)، ويواصل القول إنه من خلال هذا العمل حاول الثعلبي «رفع أهمية» قراءة القرآن و«وضع القرآن» في قلب «الحياة والممارسة الدينية للمسلمين» (ص63).
يقدم الفصل الثالث هيكل تفسير الثعلبي ومصادره. في الفصول التالية، فعل صالح شيئًا يأمل المرء أن يصبح ممارسة معيارية لدى الباحثين في حقل التفسير القرآني؛ حيث يقدّم نظرية الثعلبي التأويلية من جهة، وتفسيره من جهة أخرى. بعبارة أخرى: يقدّم إطاره النظري جنبًا إلى جنب مع ممارسته التفسيرية الفعلية، ويحلّل العلاقة بينهما. إلى حدّ ما، نحن محظوظون لأنّ مقدمة التفسير التي تطرح وجهات نظر الثعلبي بوضوح تام موجودة بين أيدينا. تعتبر دراسة مقدمات الأعمال التفسيرية -دائمًا- تمرينًا مثمرًا، على الرغم من أن عمل الباحث المعاصر المتمثل في (استخلاص) النظرية التأويلية للمفسّر قد يكون أمرًا معقّدًا مع بعض المفسّرين، ويتطلب ارتباطًا وثيقًا بالنصّ من النوع الذي يراه المرء في أطروحات الدكتوراه أو الرسائل العلمية المُركَّزة التي تشتد الحاجة إليها في مجال دراسات التفسير.
الفصل الرابع، إذن، هو تحليل لفكر الثعلبي والموقع الخاصّ لعمله داخل الأدب التفسيري. يُولي صالح اهتمامًا خاصًّا بـ(الأنحاء الأربعة عشر) التي استخدمها الثعلبي كمبادئ توجيهية لكتابه. هذه الجوانب متقنة ومبتكرة تمامًا، لكنّ صالحًا اكتشف تشابهًا بين مصطلحات الثعلبي وتراث الكرامية الذي يشير إلى تأثير محتمل للأخيرة على نهج الثعلبي. لا يتعمق المؤلف في هذا الرابط وستحتاج دراسة تأثير الكرامية على مؤلِّف نيسابوري إلى مزيد من البحث. أفضل تلخيص لنظرية التأويل عند الثعلبي هو تعريفه للتفسير والتأويل، ودعمه لوجهة النظر القائلة بأن العلماء هم الراسخون في العلم (المقصودون في آية آل عمران) وهم مَن يعرف تفسير «كلّ آيات القرآن، حتى المتشابه منها» (ص94). من النقاط المهمّة في تاريخ التفسير القرآني التي ذكرها الثعلبي -والتي أكّدها وليد صالح- أنّ جميع المفسرين -بمن فيهم السُّنّة- انغمسوا في التفسير، «رغم إعلانهم عكس ذلك»، لكنّ الثعلبي ذهب إلى أبعد من ذلك؛ فمع الأخذ في الاعتبار كلّ ما قيل عن تفسير القرآن من قِبَل الأجيال السابقة، فقد أدخل في التفسير (النحو والشعر والتاريخ والعقيدة والفقه وفقه اللغة) بطريقة متكاملة وشاملة، وكما يقول صالح، فقد ساعد ذلك الثعلبي على إنشاء «تقليد جديد من التفاسير الموسوعية» التي تهدف إلى جعل التفسير «مستودعًا رئيسًا للتربية الأخلاقية الإسلامية» (ص96). وما سمح له بأداء مثل هذه المهمّة هو تعريفه للتأويل على أنه «صرف الآية إلى معنى يتأمله، موافق لما قبلها وما بعدها» (ص92-97). يوضح صالح أنه على الرغم من أن نظرية الثعلبي تتضمن قبول (تعدُّد وتكافؤ) المعاني، إلا أن قبوله للتفسيرات كان مقيدًا في النهاية بالاعتبارات العقائدية وليس اللغوية، أي: (عقيدته السُّنيّة) (ص98). في الواقع كان هذا أحد أكبر قيود الفكر الإسلامي الكلاسيكي، فعلى الرغم من رغبة العديد من المفكرين في أن يكون عملهم شاملًا وموسوعيًّا، إلا أنّ الاختلافات العقائدية أدّت إلى استبعاد مجموعات كبيرة من المواد الفكرية. وهكذا يرفض الثعلبي تفاسير المعتزلة ويتجاهلها. وفقط في الأبحاث العلمية المعاصرة يمكننا النظر إلى مجموعة كاملة من التفسيرات وفحصها وتقييمها جنبًا إلى جنب بمقاربة غير معيارية.
في الفصل الخامس، أصاب صالح في إشارته إلى أن تطبيق جون وانسبرو[13] للمصطلحات المأخوذة من الكتاب المقدس العبري والتقليد المدراشي في دراسة التفسير «لن يعود قادرًا على إثراء فهمنا لهذا التقليد». بدلًا من ذلك، يقترح استخدام مصطلحٍ بديل، والوقت وحده هو الذي سيحدّد ما إذا كان هذا مقبولًا في دراسات التفسير أم لا. بعض هذه المصطلحات مستعار وبعضها الآخر طوّره صالح، مثل: «مدرسة نيسابور» في التفسير (ص4، وغيرها)، و«التفسير الخَلاصي» للقرآن (ص108)[14]، و«الآيات التي تخاطب النبي محمدًا مباشرة» (ص112)، والطبيعة «الإنثولوجية» للتفسير (ص140-152)[15]، «السرديات المتخيَّلة» (ص161، أي: التفسيرات ذات الطابع «السردي، في حين أن ما تسرده ليس له أساس في الآيات المفسّرة»)، و«التفسيرات الوظيفية (أو الأخلاقية)» (ص167)، «الجدل القرآني» (ص175)، وثنائية التفاسير الموسوعية و«المدرسية» (ص199)، وذلك على سبيل المثال لا الحصر.
يلخص الفصل السادس (الميول) الرئيسة التي أدخلها الثعلبي في تفسيره -التصوف، والسرد، والفكر الأخلاقي، والجدل السياسي/ العقائدي، والحديث والطابع المدرسي. ومن خلال تطبيقها على تفسير القرآن، فإن هذه التخصّصات (التي كانت بدورها بطريقةٍ ما «من إنتاج الثقافة التي وُجِد فيها القرآن») أصبحت «مقدّسة». إنّ صالحًا مُحِقّ في تأكيده على الأهمية الثقافية العالية للتفسير من جهة أنه يهدف لـ«جعل العالم نفسه مفهومًا»، وقد كان ذلك مشروعًا «أعظم بكثير» من مجرد «شرح» آيات القرآن (ص151).
يغطي الفصل السابع بإيجاز تاريخ تلقّي كتاب الثعلبي في التقليد التفسيري السُّنّي؛ ويخلص صالح إلى أنه بعد فترة وجيزة من الثعلبي توقّف المفسرون عن استخدام التفاسير الفردية -السابقة على الطبري- مباشرة، معتمدين بدلًا من ذلك على التفاسير «الموسوعية» (ص206). وعلى عكس تفسير الطبري الذي تم تجاهله -تاريخيًّا- إلى حدّ كبير، فإنّ صالحًا تمكّن مِن تتبُّع التأثير الدائم لتفسير الثعلبي، الذي كان أيضًا مصدرًا رئيسًا لتفسير الزمخشري (الكشاف عن حقائق التنزيل)، والقرطبي (الجامع لأحكام القرآن). أخيرًا، يحلّل صالح دور عمل الثعلبي في الجدل السُّنّي الشِّيعي؛ ومن المفارقات أنّ شمولية نهجه، وإدراجه لمجموعة واسعة من المواد (التي قَبِلَها طالما كانت سليمة من الناحية الفيلولوجية) أدّت في نهاية المطاف إلى تقويض مكانة الثعلبي وتفسيره بين المفسّرين السُّنة اللاحقين. يحتوي تفسير الثعلبي على قدرٍ لا بأس به من المواد الشيعية، والتي استخدمها «لتثبيط الموقف الشيعي» و«تطعيم» السُّنة ضد «الدعاية الشيعية». يكشف صالح عن أدلة على أنه بعد 200 عام من وفاة الثعلبي، قام علماء الشيعة -مثل ابن البطريق (ت600/ 1203)، وعليّ بن طاووس (ت664/ 1266)، وشقيقه أحمد (ت673/ 1275)، والعلّامة الحلّي (ت726/ 1235)- باستخدام المرويات الموجودة في «الكشف والبيان»، والتي دعمت المزاعم الشيعية بأنّ عليّ بن أبي طالب مشارٌ إليه في القرآن، واستخدموا تلك المرويات في أطروحات الجدل والردّ على السُّنة أو في عَرْض مذاهب الشيعة. من ناحية أخرى، نظرًا لما أطلق عليه صالح «الهرمنيوطيقا الراديكالية» عند ابن تيمية -أي: إن فقه اللغة/ التحليل الفيلولوجي «ليس له دور» في التفسير؛ والقرآن يجب أن يفسّر بالقرآن، وبالسُّنة، وأقوال الصحابة والتابعين (ص217)- فقد ألْغَى ابن تيمية سُلطة تفسير الثعلبي جزئيًّا بسبب استخدامه موادّ شيعية. يؤكد صالح أيضًا على اضمحلال مكانة الثعلبي منذ ذلك الحين بين السُّنة، كما نرى ذلك، على سبيل المثال، في كتاب «الإتقان في علوم القرآن» لعبد الرحمن السيوطي (ت911/ 1505).
في الختام، يجب الإشادة بمحرري سلسلة Brill التي تصدر بعنوان: (نصوص ودراسات القرآن)، غيرهارد بويرينغ[16]، وجين دي مكوليف[17]، والتي يُعَدّ «تشكُّل التقليد التفسيري الكلاسيكي» المجلد الأول منها، أمّا بالنسبة لكتاب وليد صالح؛ فهو كتاب ممتع يبشِّر بمسيرة واعدة لمؤلِّفِه.
[1] هذه الترجمة هي لمادة: The Formation of the Classical Tafsır Tradition: The Quran Commentary of
al-Thafilabı (d. 427 /1035). By Walid Saleh. Texts and Studies on the Quran, 1.
Leiden: Brill, 2004
والمنشورة في: Journal of Qur’anic Studies في أبريل 2006.
[2] ترجم هذه المادة: مصطفى هندي، كاتب ومترجم، له عدد من الأعمال المنشورة.
[3] كلمات الله تعالى التي وردت الإشارةُ لكثرتها وعدم تناهيها في الآية، منها القرآن الكريم، ولكنها لا تنحصر في ذلك، بل تشمل القرآن وغيره؛ ككلام الله للملائكة، وبالتالي فرَبْط الكاتب بين كثرة كلمات الله وكثرة معاني القرآن فيه إشكال؛ فضلًا عن أنّ القول بتعدّدية معاني القرآن وأنها لا تتناهى مشكِل، فهذا خلاف الظاهر في العمل التفسيري، والذي ينتهي في سرد المعاني عند قدر معيّن، وكذلك ربما يُفضي ذلك للقول بتشتّت المعنى وصعوبة الإمساك به في القرآن، وهو خلاف المراد من الوحي كبلاغ لمراد الله تعالى من البشر. كذلك فالقول بتشتّت المعاني يعارض ما يطرحه بعض الدارسين المعاصرين مثل هيرش من مدى حسم دور مقصد النصّ في إيقاف تعدّد التأويلات، أو على الأقلّ تحديدها فيما يسمّيه إيكو باقتصاد التأويل. (قسم الترجمات).
[4] صدرت الترجمة العربية للدكتور عبد الحليم النجار، ونشرتها مكتبة الخانجي عام 1955. (المترجم).
[5] الجينيالوجيا من الناحية اللغوية تعني البحث عن النشأة والتكوين والأصل؛ وليس المقصود العودة إلى البدايات، بل الكيفية التي تكوّنت بها الأشياء والعوامل التي تضافرت على إنتاجها. (المترجم).
[6] Pace Eric Hobsbawm and Terence Ranger (eds), The Invention of Tradition (London:.Cambridge University Press, 1983); Raymond Williams, Marxism and Literature (Oxford: Oxford University Press, 1977).
[7] تعدّ مسألة تصنيف التفاسير من المشكلات المعرفية في حقل التفسير، وقد اعتنى أحدُ البحوث بمناقشة هذه المسألة بصورة موسّعة، واستعرض التقسيمات الشائعة وبيّن إشكالها، واقترح معيارًا معينًا لتصنيف التفاسير، وهذا البحث بعنوان: (تصنيف التفاسير؛ قراءة في المنجز مع طرح تصنيف معياري للتفاسير)، خليل محمود اليماني، وهو منشور على موقع تفسير تحت الرابط التالي: tafsir.net/research/53 ، (قسم الترجمات).
[8] لنقدٍ منصفٍ لهذا التحليل، انظر:
Andrew J. Lane, A Traditional MuitaziliteQuran Commentary: The Kashshaf of Jar Allah al-Zamakhsharı (d. 538/ 1144), Texts and Studies on the Quran, 2 (Leiden: Brill, 2006), pp. 114–16.
[9] راجع ضمن الملف نفسه على موقع تفسير: تفاسير القرآن، وليد صالح، ترجمة: طارق عثمان. (قسم الترجمات).
[10] Khaled El-Rouayheb, ‘From Ibn Hajar al-Haytamı (d. 1566) to Khayr al-Dın al-Alüsı (d. 1899): Changing Views of Ibn Taymiyya amongst non-hanbalı Sunni Scholars’, paper presented at the conference on ‘Ibn Taymiyyah and His Times’, Princeton, April 8–10, 2005,forthcoming as an article in the conference proceedings.
[11] عبد الغافر الفارسي (451-529هـ/ 1059-1135م) من علماء العربية والتاريخ والحديث، من أهل نيسابور، وهو سبط أبي القاسم القشيري صاحب «الرسالة القشيرية». سافر إلى خوارزم وغزنة والهند، وتوفي بنيسابور. من كتبه: «المفهم لشرح غريب مسلم» و«السياق» في تاريخ نيسابور، بلغ به سنة 518هـ، و«مجمع الغرائب-خ» في غريب الحديث. وأشار المؤلف إليه بالمتأخر تمييزًا له عن عبد الغافر بن محمد بن عبد الغافر بن أحمد بن محمد بن سعيد، أبي الحسين الفارسي ثم النيسابوري المتوفى سنة 448هـ، وقد ترجم له الذهبي في السير. (المترجم).
[12] تيلمان ناجل (1942-)، مستشرق ألماني، حصل على الدكتوراه من جامعة بون، عمل كأستاذ للدراسات اللغوية والأدبية في جامعة توبنغن الألمانية، حتى تقاعده في 2007، مهتم بالسيرة النبوية وتاريخ علم الكلام الإسلامي، من كتاباته في هذا السياق: (تاريخ علم الكلام الإسلامي منذ محمد وحتى العصر الحاضر، 1994)، وصدر له هذا العام بالمشاركة مع عدد من الكُتّاب: (رسالة محمد؛ الدين والسياسة والسلطة في بدايات الإسلام). (قسم الترجمات).
[13] جون وانسبرو (1928م-2002م) مستشرق أمريكي، يُعتبر هو رائد أفكار التوجّه التنقيحي، وتعتبر كتاباته منعطفًا رئيسًا في تاريخ الاستشراق، حيث بدأت في تشكيك جذري في المدونات العربية الإسلامية وفي قدرتها على رسم صورة أمينة لتاريخ الإسلام وتاريخ القرآن، ودعا لاستخدام مصادر بديلة عن المصادر العربية من أجل إعادة كتابة تاريخ الإسلام بصورة موثوقة، وأهم كتاباته: «الدراسات القرآنية، مصادر ومناهج تفسير النصوص المقدّسة» (1977م)، وقد نشرنا عرضًا مترجمًا لهذا الكتاب، كتبه: كارول كيرستن، ترجمة: هند مسعد، يمكن مطالعته ضمن ترجمات ملف (الاتجاه التنقيحي)، على قسم الاستشراق بموقع تفسير. (قسم الترجمات).
[14] يقدم صالح مثالًا على هذا التعبير من تفسير الثعلبي لقوله تعالى: {مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ}[الرحمن: 19]، يقول صالح: إن السائد في تفسير الآية إلى وقت الثعلبي هو تفسير البحرين بالعَذْب والمالِح، لكن الثعلبي يتجاوز هذا التفسير ويقدّم تفسيرًا آخر هو: البحر الأول هو النجاة، فمَن تمسّك بالقرآن نجا؛ والبحر الثاني هو الهلاك وهو هذا العالَم، من تمسّك به وسعى وراءه هلك لا محالة. اهـ من كتاب صالح ص108. (المترجم).
[15] يقول صالح: «تقليد التفسير الإسلامي هو في الأساس أنثولوجي بطبيعته؛ بمعنى أن تفسير القرآن الكلاسيكي يتكون عادة من اقتباسات لأقوال مفسرين سابقين، مع إمكانية أن يضيف المفسّر نظرته الخاصة أو يعلِّق على القديم، أو يوفِّق بينهما. الطبري -الذي بدأ هذا الاتجاه- ابتكره -على ما أعتقد- تحت تأثير سلطة الإجماع التي أصبحت مركزية في النظرة السُّنية للعالم، وقد أثبت المسار الذي وضعه أنه مستمر حتى يومنا هذا». انتهى من كتابه ص141. (المترجم).
[16] غيرهارد بويرينغ (1939-)، مستشرق ألماني، أستاذ الدراسات الدينية بجامعة يال، شارك بعدد من المقالات في موسوعة القرآن، حَوْل الله وصفاته وأسمائه، وحَوْل التسلسل الزمني للقرآن، مهتم بالتراث الصوفي للإسلام، له في هذا كتاب صدر عام 1979 بعنوان: «الرؤية الصوفية للوجود في الإسلام الكلاسيكي، تفسير القرآن لسهل التستري». (قسم الترجمات).
[17] جين مكوليف (1944-) أستاذة الدراسات الإسلامية بجامعة تورنتو، متخصصة في الآداب والفلسفة الكلاسيكية والدراسات الإسلامية، وهي رئيس فخري لكلية برين ماور وعميد سابق لجامعة جورج تاون، وهي مديرة مشروع الموسوعة القرآنية، والتي صدَر منها ستة مجلدات. لها بعض الكتب المتعلقة بالتفسيرات الكتابية، والتفسيرات المسيحية، منها: المسيحيون القرآنيون، تحليل التفسير الكلاسيكي والحديث، 1991، في توقير الكلمة، التفسيرات الكتابية في العصور الوسطى، في اليهودية والمسيحية والإسلام، 2002. (قسم الترجمات).
كلمات مفتاحية
مواضيع ذات صلة
((المعلومات والآراء المقدَّمة هي للكتّاب، ولا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع أو أسرة مركز تفسير))