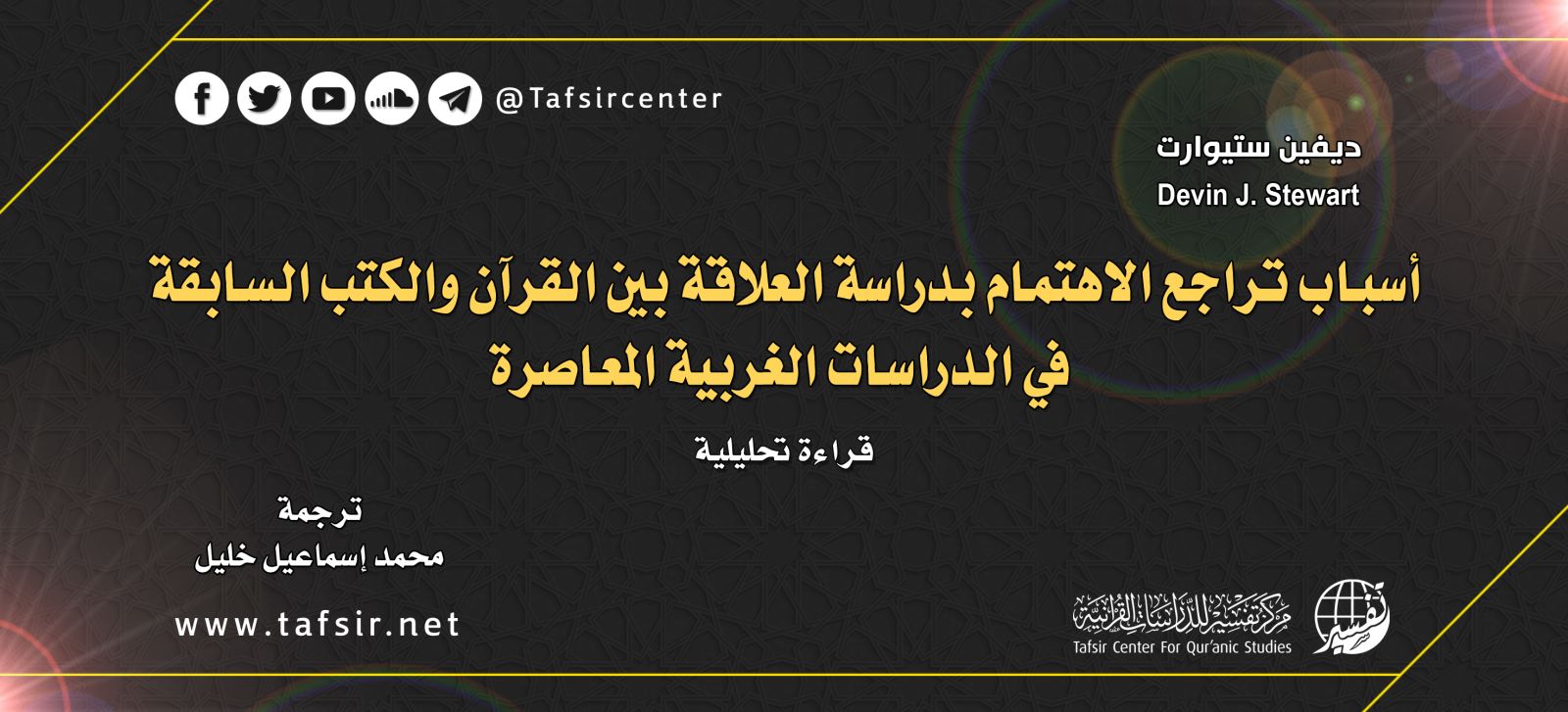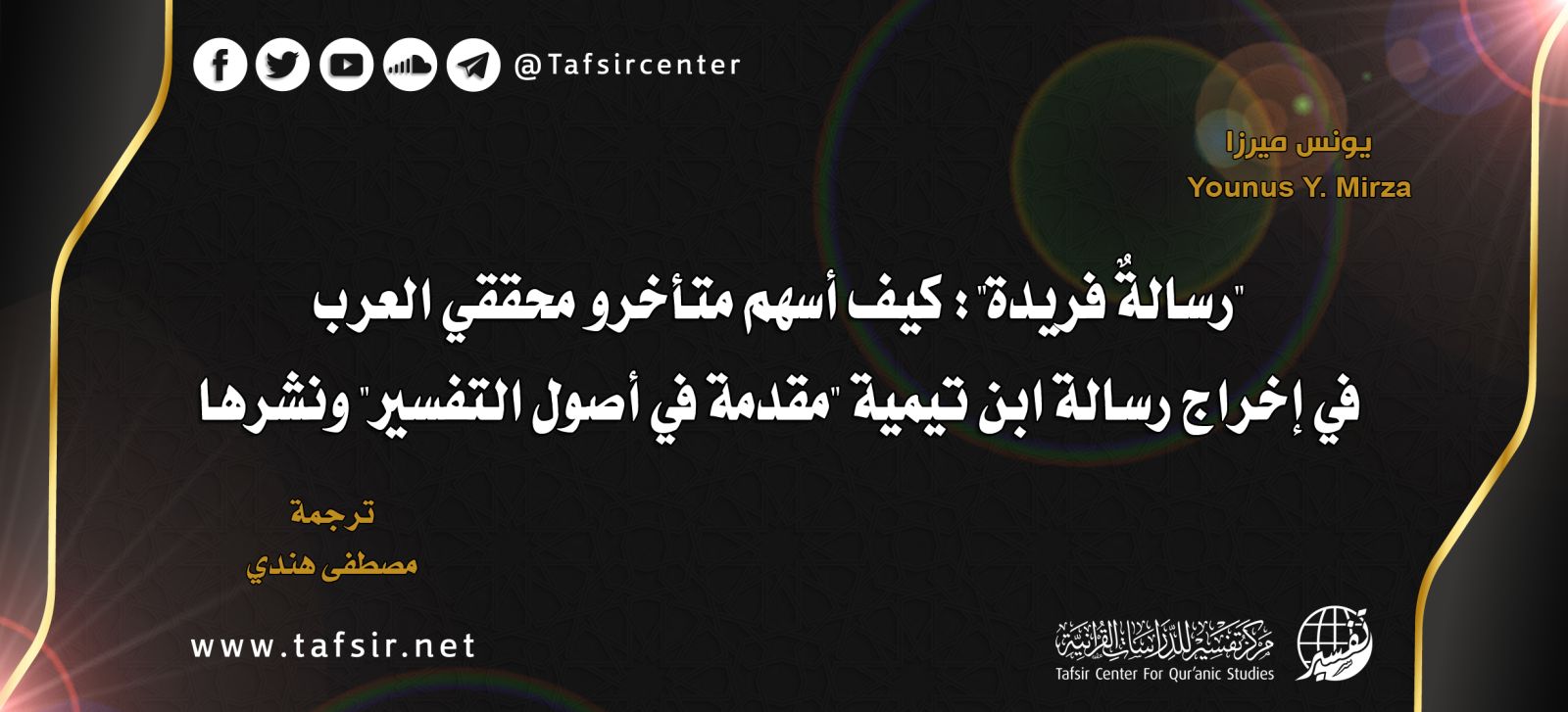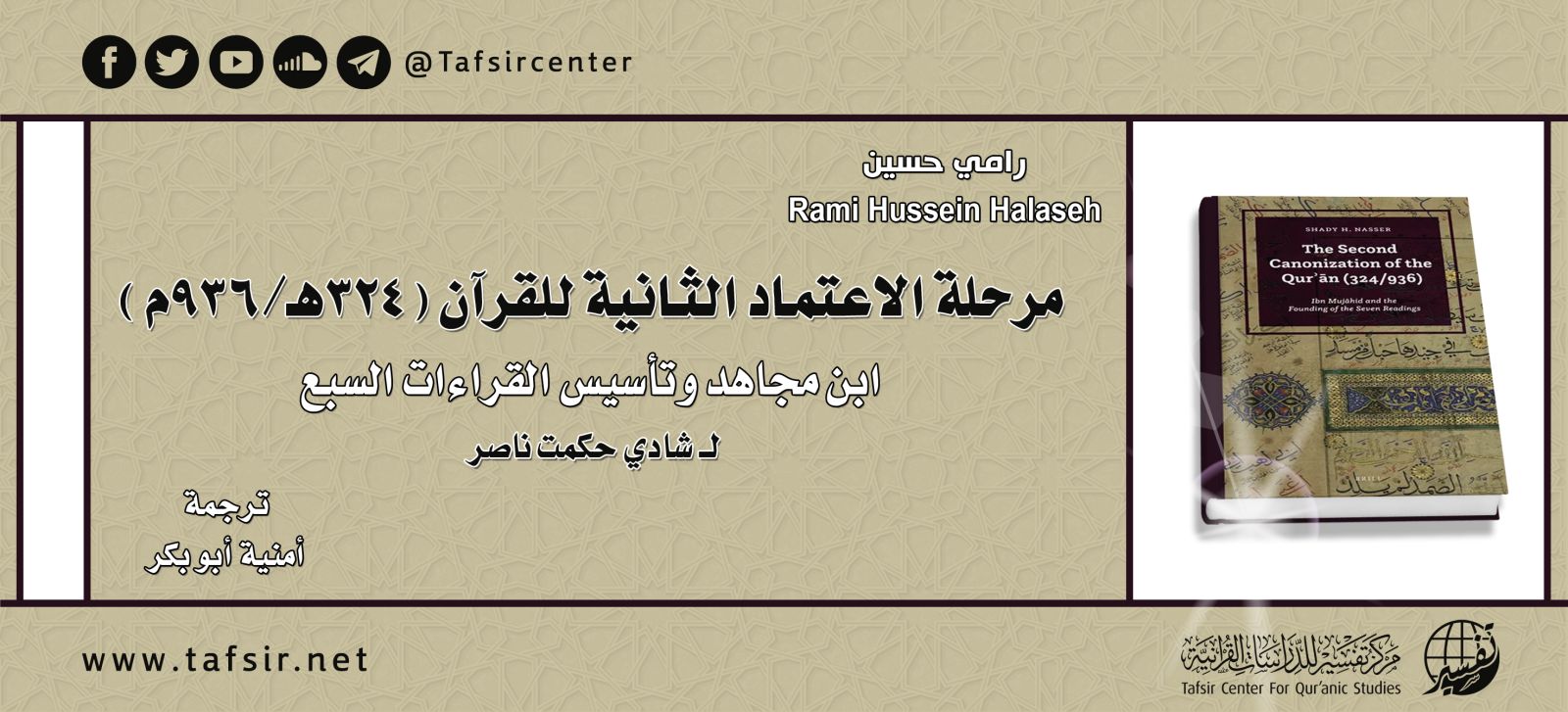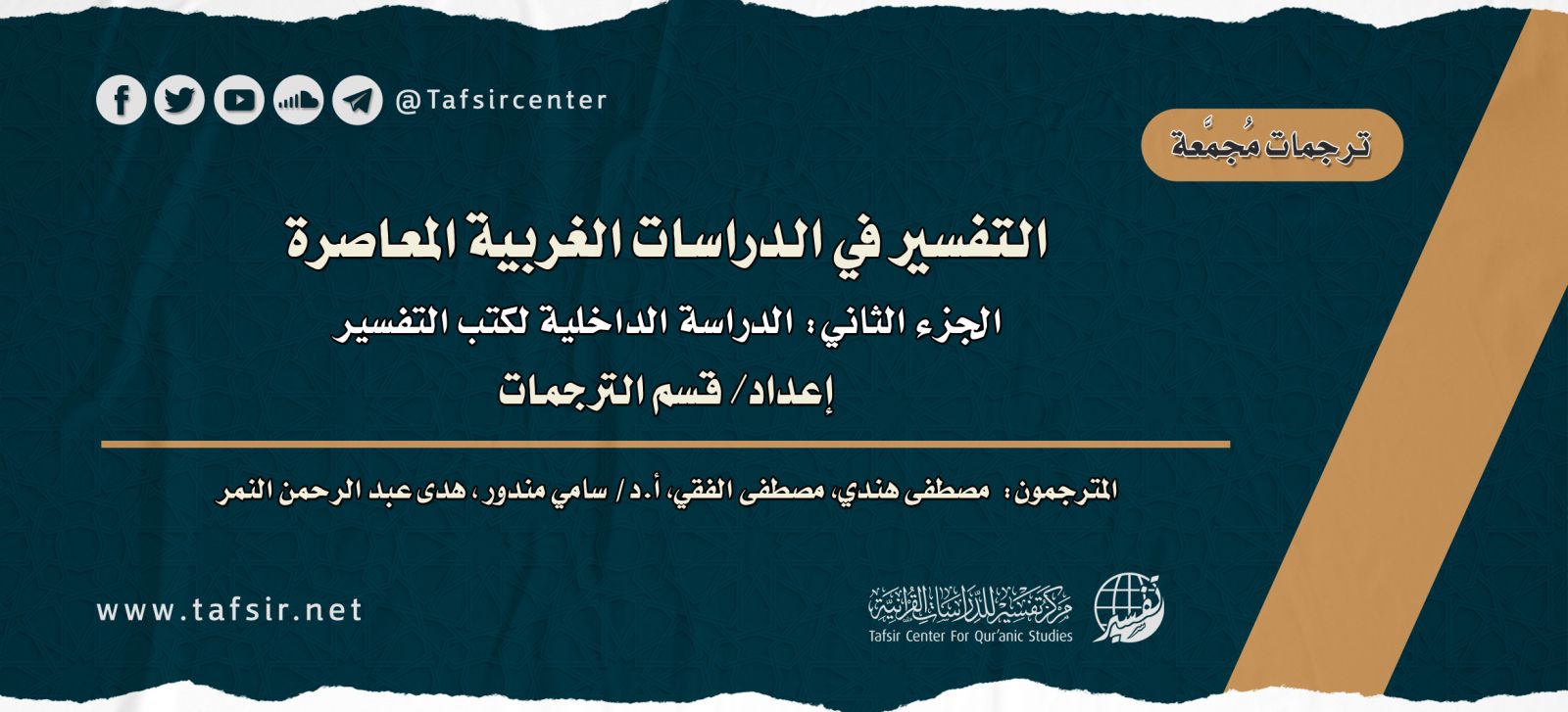أهداف كتب التفسير ومناهجها وسياقاتها؛ القرون: الثاني/الثامن- التاسع/الخامس عشر.
تحرير: كارين باور

هذا المجلد يقدّم مقاربة نحتاج إليها بشدّة في دراسة التفسير، وهي التركيز على أهمية أهداف المفسِّرين ومناهجهم وسياقاتهم الفكرية في تفسيراتهم للقرآن. ويتألّف الكتاب من مقدمة تعريفية للمحرّرة كارين باور عن هذه المقاربة، مع الإشارة للمعالم الكبرى المنجزة في أبحاث التفسير، ثم ثلاثين دراسة حالة (مفردة) مقسّمة على ثلاثة أقسام: (أهداف التفسير)، (مناهج ومصادر التفسير)، (سياقات التفسير). تعرض هذه المراجعة بإيجاز لكلّ قسم من أولئك، ثم تمضي لتقييم إسهام المجلد ككلّ في مجال دراسات التفسير.
تُعرِّف باور التفسير في مقدمتها على أنه «نوع -أدب له ملامحه الخاصّة- من النصوص يُعْنَى بمناهج معيَّنة من التأويل»[1] (ص: 4). وفقًا لهذا التعريف، تناقش باور بمنظور نقدي المحاولات السابقة لإجناس جولدتسيهر وجون وانسبرو لتأريخ مراحل تطوّر التفسير، التي تقوم على افتراض أنّ التفسير يتكون من تصانيف قابلة للتمييز تمثّل مراحل متباينة من التطوّر[2].
وباستقراء ملاحظة العالم اللغوي كيس فرستيج عن كون الأشكال الأولى للتفسير تحوي بالفعل عددًا من تلك التصانيف المفترضة التي عرفها جولدتسهير[3] ووانسبرو[4] لاحقًا[5]، تحاجج باور أن التفسير لطالما كان قائمًا بالفعل على مجموعة من المناهج والمقاربات، تعتمد على الأهداف والسياقات الفردية للمفسِّر[6]:
«بناء على نظريات التأويل، [...] يتراءى لي أن التفسير في جوهره هو محاولة كلّ مفسِّر أن يصل عالمه بعالم القرآن؛ إنها محاولته أن يربط سياق نصّ القرآن بسياقه الفكري والسياسي والاجتماعي. إنها عملية خَلْق معنى؛ لأن ما يتأوَّله العالِمُ من النصّ المقروء ليس مذكورًا فيه صراحة: والتفسير لا يراعي على الدوام نحوَ القرآن وسياقه. والاحتمالات التأويلية تبدو غير محدودة؛ إلا أنها تظلّ مرتبطة بالنصّ بدرجات متفاوتة في دقّتها النحوية والسياقية، ولا يمكن للتفسير أن يستقلّ بذاته مع كلّ ذلك؛ لِمَا يقوم عليه من وصف وتكييف وتوسعة وأحيانًا حتى معارضة لنصّ القرآن. إنه نوع من التأليف الذي يخلق ويفرض معنى على القرآن، وهو كذلك نوع يستنبط معنى من نصّ القرآن، يمكن توسعته بكلّ المناهج المتاحة للمفسِّر، وبالتالي فدرجة التوافق مع القرآن والتوصيف (الأصلي) له، تعتمد كثيرًا على المفسّر نفسه، أي: أهدافه ومناهجه وسياقه».
وتقترح باور[7] كذلك منهجيّة يمكن من خلالها تصنيف مؤلفات التفسير بحسب سياقاتها الفكرية والاجتماعية، عن طريق تمييز عددٍ من (العقد nodes): المنشأ الجغرافي- الفكري، الشبكات البشرية (القرابة، المعلم/الطالب، المدرسة)، المصطلحات، نظم الهرمنيوطيقا وحدود النوع (تَعقُّب نفس التأويلات أو المصادر في مختلف الفنون الأخرى المتصلة بالنص) (ص: 10، 11). ومن بين كلّ تلك العقد، تبرز الهرمنيوطيقا بوصفها المحور الجامع؛ لأن باور تُعرِّف مقاربتها للتفسير في إطار «نظريات التأويل» في المقام الأول (الجملة الافتتاحية في النصّ المقتبس أعلاه). وبعض الإسهامات -مراد وريبين وجعفر-يقال إنها كذلك تعنى باستكشاف نظم الهرمنيوطيقيا التي تشتمل عليها مصنفات التفسير نفسها (ص: 31). (سنعود فيما يلي للنظر في مدى تعامل تلك الدراسات مع الهرمنيوطيقيا بالفعل).
يتألّف القسم الأول (أهداف التفسير) من أربعة فصول، يتصدّرها مقال فراس حمزة[8] بعنوان: «التفسير وفضّ مغاليق القرآن التاريخي: عودة للأساسيات؟». يصف حمزة كيف أن الأكاديميّات الغربية تُعرِّف دراسات التفسير على أنها مجال بحثيّ مباين للدراسات القرآنية. ومنطقها في ذلك أنّ الدراسات القرآنية تُعْنَى بالأصول التاريخية ومعنى القرآن، بينما تركّز دراسات التفسير على ما يمكن للمفسِّرين المسلمين استنباطه من القرآن. وينتقد حمزة هذه التقسيمة محاججًا أنّ دراسات التفسير التي تستبعد التفسيرات التاريخية للقرآن التي يقدّمها المفسرون، تحولها لمشروع باطني تمامًا، بما يعني الاقتصار على المدلول الداخلي للقرآن عند مفسّر معيَّن. ويوضح حمزة قصده من خلال مناقشة مقدمة القيشاني (ت: 736 – 1336) لتفسيره الصوفي الذي يهدف لإثبات أصول اعتقاده في القرآن، لكن غيره من المفسِّرين لهم أهداف أخرى كما يشير حمزة، فعلى دارسي التفسير أن يتعلموا التمييز بينها، ويستعملوا تلك التفاسير التي تهدف لإنتاج تأويلات سليمة تاريخيًّا، أي: تسهم في فهم المعنى التاريخي للقرآن.
وَيَلِي مقالَ حمزة مقالٌ لباور بعنوان: «تبرير النوعية: دراسة لمقدمات التفاسير الكلاسيكية»، والتي تقارن فيها مقدمات من القرن الرابع/التاسع (الطبري، القمِّي، السمرقندي)، والخامس/العاشر (الثعلبي، الطوسي، الواحدي)، والسادس/الحادي عشر (سور آبادي والبغوي)، وتحدّد القواسم المشتركة والاختلافات بينها. وتخلّص باور من ذلك إلى أن كلّ تلك المقدمات تهدف إلى تبرير رغبة المفسّر في إنتاج تأويل جديد: تأويله الخاصّ. وذلك يعني ضمنًا أنّ المفسّر لا يُقبل على تأليف تفسير بهدف تلبية حاجة موضوعية لتأويلاتٍ أصحّ للقرآن، وإنما بالأحرى ليؤيّد مسائل ذاتية في العقيدة والتشريع، فينتج أثناء ذلك ببساطة تفسيرًا جديدًا.
يتناول الفصل الثالث في قسم (الأهداف) مقالَ وليد صالح[9] «المقدمة لبسيط الواحدي: طبعة وترجمة وتعقيب». الواحدي (ت: 486 /1076) كان تلميذًا للثعلبي (ت: 427 /1035 - 1036)، والفصل يتألّف من ترجمة صالح المنقّحة لمقدمة تفسير الواحدي الثالث والأكبر على القرآن (البسيط)، الذي يوجد في نسخة مخطوطة فحسب. وتقوم أطروحة صالح على أن تفسير (البسيط) في غاية الأهمية؛ لأن الواحدي -وإن لم يكن معتزليًّا-إلا أنه «زعيم حركة النقل الثقافي الرائد لشرح المعتزلة الفيلولوجي للقرآن إلى أهل السنة» (ص: 68). وهو كذلك منشئ «تصنيف جديد لعلماء التفسير: أهل المعاني، أي: المفسرين «الذين يبنون تفسيرهم للقرآن على المعرفة اللغوية الصارمة فحسب» (ص: 68)، ويحاجج صالح أنّ الخاصية الفريدة لمقدمة الواحدي هي استعماله لأسلوب المتكلّم في الخطاب، وتشديده على اللغويات وعلم القراءات بوصفهما شرطين لعملية التفسير.
وينحو الفصل الرابع بقلم سليمان مراد[10] نفس الوجهة اللغوية، في مقاله: «نحو إعادة بناء التراث المعتزلي لتفسير القرآن: قراءة مقدمة التهذيب للحاكم الجشمي (ت: 494 /1101)، وتطبيقها»، وهو عبارة عن ترجمة مراد وتحليله للمخطوطة غير المنشورة[11] لمقدمة الجشمي لـ(التهذيب في تفسير القرآن). وكما يبيِّن العنوان، فالجشمي يعدُّ تفسيره (تهذيبًا)؛ ليتوصل إليه قام بتطوير منهجيَّة مبنيَّة على ثمانية محاور تتعلّق بعلوم القرآن، ثم طبقها منهجيًّا في تفسيره: القراءات، علم الألفاظ، النحو، التركيب الإنشائي (للسور والآيات)، المعنى، أسباب النزول، الأدلة والأحكام، الرسائل والروايات. ووفقًا لمراد -الذي يتفق مع صالح- فأوَّل حالة مشابهة هو الجامع الكبير للمعتزلي الرمّاني (ت: 384 /994)، ومن ثم «ففكرة تضمُّن التفسير القرآني للنظام الهرمينوطيقي تبزغ في تفاسير أواخر القرن الرابع/العاشر وأوائل الخامس/الحادي عشر في عددٍ من المجموعات، والدليل الذي لدينا يشير إلى أن تلك المجموعات كانت ناشطة في العراق وخراسان» (ص:107).
ويتمثل إسهام الجشمي في تطوير نظام الرماني؛ ففي حين ظلَّت هرمنيوطيقا الرماني نظرية، بمعنى أنه لم يرتّب تفسيره فعليًّا وفقًا لها، فإنّ الجشمي قام بالفعل بإنشاء تفسيره على أساس تلك المحاور الثمانية، كما وصف مراد، وأهم تلك المحاور هو المعنى، فالجشمي يؤكّد أن هدف الخطاب توصيل معنى، ويطوِّر منهجيةً تحدِّد أيّ المعاني هو الأصوب، عن طريق الجمع بين تحليل السياق (أسباب النزول) والتحليل اللغوي والشرعي- العقدي. وكما يبيّن مراد، فإنّ تفسير الجشمي ذو وجاهة معتبَرة؛ لأنه يبرهن على صحّته بدحض التفسيرات السابقة، وعلى حَدّ قول مراد، فإنّ هذا المنحى سمة معتزليَّة أصيلة.
القسم الثاني من المجلد مخصّص لمناهج ومصادر التفسير، تناقش الفصول الثلاثة الأولى فيه استخدام التقارير التأويلية (المرويات التفسيرية)، ويتصدّر الفصل الأول مقال روبرت جليف[12]: «باكورة الهرمنيوطيقا الشيعية: بعض التقنيات التفسيرية المعزوَّة لأئمة الشيعة». ويعرض الفصل لإشكاليتين محددتين هما: العلاقة بين التفسير واللغويات، وتواريخ التقارير/المرويات. ومن خلال دراسته للتقارير التأويلية/المرويات التفسيرية في مؤلفات الشيعة الإمامية في الشريعة والحديث والتفسير قبل القرن الخامس/الحادي عشر، والمنسوبة بالأساس للأئمة جعفر الصادق (ت: 148 /756)، والحسن العسكري (ت: 260 /873- 874)، يصف جليف كيف أن تأويل الشيعة الإمامية يهدف لتأصيل قاعدة قرآنية لعقيدة الإمامية وشرعها، ولو كان ذلك أحيانًا عن طريق تحايلات تأويلية قاصمة.
ومع أنّ تلك المؤلفات تفتقر لهرمينوطيقا ذات تعريف واضح وتطبيق مطَّرِد، إلا أنّ جليف استبان أربع تقنيات تأويلية، بنَى عليها تحليلاته، وهي: المعنى المكافئ، الحواشي الشارحة، التأويل اللغوي، التصنيفات الهرمينوطيقية القرآنية. ويشير إشارة خاصّة في التقنية الأخيرة للآية السابعة من سورة آل عمران، ومن المدهش أنّ جليف اكتشف أن التقارير/المرويات المنسوبة للعالم المدني جعفر الصادق تحوي مصطلحات لغوية وتراكيب لفظية معزوَّة لمدرسة الكوفة اللاحقة، وهو ما يؤيّد ظاهريًّا أطروحة رفائيل تلمون عن أسبقية المدرسة الحجازية. وينتهي جليف إلى أنه على الرغم من أن التقارير/المقولات قد لا تعكس تأويل جعفر التاريخي نفسه، إلا أنها تبلغنا بالتطورات العامَّة في عقيدة الشيعة وتشريعها من فترة مبكّرة تعود لزمن جعفر الصادق، الذي استُعمل اسمه في المؤلفات المعتمدة التالية؛ لإضفاء سلطة على تعاليم الإماميَّة اللاحقة.
يحتلّ الفصل السادس مقال أندرو ريبين[13]: «بناء السياق التاريخي العربي في تفسير المسلمين للقرآن». وفي ردٍّ على مقاربة أحدٍ مثل أوري روبين[14] الذي يسعى لتحديد مسار تاريخي للتفسير عن طريق دراسة محتويات التقارير التأويلية، يحاجِج ريبين أن تلك التقارير/المرويات لا تعكس السياقات التاريخية الفعلية، بل إنها وُضِعَت لتوفّر سياقات للقرآن الذي يفتقر في غالبه لأيّ إحالات سياقية، وكانت محصّلة ذلك بناء سياق عربي لغوي وتاريخي- ثقافي، وقد نفع ذلك كإطار عام لتفسير القرآن، بما في ذلك الألفاظ غير العربية الأصل. ومع ذلك، يزعم ريبين أننا لم نقف بعدُ على السبب الذي أحوج المفسرين لبناء هذا السياق التاريخي، ويقترح هو عدة أسباب -السوابق الشرعية/القانونية، حيازة القداسة، الأطر النحوية والمرويات- لكن أيًّا منها ليس قطعيًّا. وعلى ذلك، فإنّ هذا السياق يمثّل بتعبيره: «عبقرية تراث التفسير الإسلامي» (ص: 191).
يتابع روبرتو توتولي[15] موضوع التقارير/المرويات في الفصل السابع، بعنوان: «مناهج وسياقات استعمال الأحاديث في أدبيات التفسير الكلاسيكي: تفسير الآيتين [21: 85] و[17: 1]». والمناهج المذكورة متعلقة بنقد الإسناد وعملية إضفاء المرجعية والسلطة على مصنفات الأحاديث، ويضرب مثالًا بالآيتين الأولى من سورة الإسراء، والخامسة والثمانين من سورة الأنبياء، معتمدًا على الدراسة الحديثية الحديثة لجوناثان براون[16][17]. يحاجج توتولي بأنّ استعمال المفسِّر للحديث يظهر أنّ عملية إضفاء القداسة والسلطة على الأحاديث استمرت حتى القرن الخامس/الحادي عشر، وأنّ باب التفسير مَنَحَ للمفسّرين حرية استعمال الأحاديث غير المعتمَدة أكثر من علم الحديث الصحيح. ووفقًا لتوتولي، فسبب ذلك الضرورات المختلفة لذينك العلمين المتباينين، ولعوامل أثَّرت في طبيعة كلّ مؤلِّف تفسير، كتوجُّهات المفسِّر النقدية، ونوع التفسير الدقيق: فالمحققون الموسوعيون استعملوا أحاديث غير معتمَدة أكثر من غيرهم[18].
في الفصل الثامن بعنوان: «حرفًا بحرف: تتبُّع علم الأنساب النصِّي في تفسير صوفي»، يحلل مارتن نجوين[19] تفسير (لطائف الإشارات) للنيسابوري الشافعي والمفسّر الصوفي القشيري (ت: 465 /1072). وبعكس مؤلفات القشيري الأخرى، فإن هذا التفسير يخلو من مراجع مصدرية صريحة، وبالتالي يصنّف الباحث اللطائف على أنه تفسير صوفي، ويتتبّع جذوره في الأدبيات الصوفية المتعلقة، ويهدف نجوين للتعرُّف على مصادر أكثر بالتركيز على تفسير القشيري للحروف المقطعة {الم} في أوائل بعض السور، مقارنًا ذلك بما ورد في تفسير تلك الآيات للصوفيَّيْن: التستري (ت: 283 /896)، والسلمي (ت: 412 /1021)، وكذلك الطبري (ت: 310 /923)، والزجّاج (ت: 310 /923)، والثعلبي (ت: 427 /1035)، والواحدي (ت: 468 /1076). ويكتشف نجوين أنّ القشيري استعمل تفسيرات المفسِّرين غير الصوفيِّين، خاصّة أولئك المنتمين لمذهبه النيسابوري الشافعي، لبناء سلطة علمية تستند لعلم اللغة، على أساس يمكِّنه من بيان الحاجة للتأويل الصوفي الذي ينقل الحروف من حيِّز كونها استشكالات لغوية إلى صيرورتها مادة تأمُّل روحاني. وبهذا يخلص نجوين إلى أنّ لطائف الإشارات لا تعكس كثيرًا انتماء القشيري الصوفي كاتصال محلِّي بين الانتماء الشافعي والتفسير في نيسابور، مع أننا ما زلنا بحاجة لمزيد بحث يميط اللثام عن الطبيعة الدقيقة لتلك العلاقة.
في الفصل التاسع نجد مقال طارق جعفر[20]: «منهج تحري فخر الدين الرازي». يعرض فيه جعفر لأول شرح من نوعه لنظام الرازي عالِم العقيدة [اللاهوت] الأشعري (ت: 606 /1209)، معتمدًا على فرضية أنّ مؤلفاته في الفلسفة وعلم الكلام والتفسير تمثِّل وحدة منهجية يجمع بينها المفاهيم التحليلية: مسألة، وجه، بحث. ويُظْهِر جعفر كيف أنّ الرازي استعمل تلك المفاهيم في تفسيره، بدايةً بهدف الدراسة النقدية لأنواع المعرفة العلمية الجديدة والمنقولة (الفلسفة الإغريقية والعلوم الطبيعية)، وثانيًا ليدمج المعرفة المعتمدة منها في المنظومة العلمية الإسلامية (النموذج المعرفي الإسلامي). وتم تنفيذ ذلك الدمج بإثبات المعرفة المعتمدة في النصّ المقدّس بما يمنحها السلطة الوحيانية المطلوبة، ويضيف جعفر أنه في حين أنّ هذا المنهج مستعمل من قبل في التراث الأشعري، فإنّ الرازي هو أول من يستعمله بهدف تزويد العلوم الدينية بمنهج نقدي متناسق.
في الفصل العاشر بعنوان: «رأس الواضحات: فهم تأويلات الظاهر في التفسير القرآني»، تزودنا لودميلا زاماه[21] برؤية عامّة لمصطلح (الظاهر) الذي استعمله المفسّر والفقيه الأندلسي المالكي القرطبي (ت: 671 /1271)، وتحاجج زاماه أنّ الفهم العام للظاهر على أنه (المعنى الحرفي) سطحي جدًّا. وفي مؤلفات القرطبي، تجد للظاهر أربعة أنواع من المعنى: المعنى العام، المعنى الظاهري السطحي، المعنى المجرد، التأويل السمعي. بالإضافة لذلك، فإنّ تعدد المعاني العربية يوحي ضمنًا بأنّ الظاهر قد يشمل كذلك معاني مخصوصة بالسياق، خلافًا لتلك التصنيفات الأربعة؛ ولأن هذا المصطلح جزءٌ مهمٌّ من منهجية أيّ مفسر -وليس الفِرقة المعروفة بالظاهرية فحسب- ترى زاماه أنه يستحق عنايةً أكبر مما أُوليت له حتى الآن في دراسات التفسير. (في مجال القانون، ينوّه إلى كتاب جليف الحديث «الإسلام والحرفية: المعنى الحرفي والتأويل في النظرية الإسلامية التشريعية» على نفس رأي زاماه عن الأهمية الأوسع للمفهوم)[22].
ويتألف الفصل التاسع من مقال ستيفن بيرج[23]: «جلال الدين السيوطي، المعوذتان وطرق التفسير»، وهو من وحي إلهام فرضية جون وانسبرو أن القرآن لا يوجد إلا من خلال التفسير[24]. فيوضح بيرج كيف أنّ الموسوعي القاهري والمجتهد الشافعي السيوطي (ت: 911 /1505) يخلق المعنى في القرآن من خلال تفسيره للسورتين 113 و 114، المسماتين بالمعوذتين. ومصدر بيرج الرئيس هو تفسير السيوطي (الدر المنثور في التفسير بالمأثور)، إلا أنه يقارن التأويلات الواردة فيه بتلك الواردة في التفسيرَيْن الآخرَيْن للسيوطي: (الإتقان في علوم القرآن) و(لباب النقول في أسباب النزول). وإطاره المرجعي هو مفهوم أندرو ريبين لأسباب النزول على أنها أدوات تفسيرية تُعِين على تزويد الآيات القرآنية بسياق سردي، ومن المادة الهائلة التي يمكن للمفسّر أن يختار منها بحرِّيّة لتزويد الآية بسياق قد حدّده المفسِّر بالفعل. يبيِّن بيرج كيف أن السيوطي يوظِّف أسباب النزول (بالإضافة للنقد النصّي أو القراءات أو الصناعة المعجمية وفضائل القرآن) لتفسير السورتين بطرق تتماشى مع ما نعلمه من انتمائه للطريقة الصوفية الشاذليّة وإقراره للاحتفال بالمولد النبوي. وهكذا توضّح الدراسة بجلاء نموذجي كيف أن استعمال الحديث في التفسير قد يخدم كمطيَّة للتعبير الإبداعي عن الرؤى الفردية والمواقف العقدية.
ويشكّل الفصلان الأخيران القسم الثالث من الكتاب، بعنوان: «سياقية التفسير». والفصل الثاني عشر يتألّف من مقال كلود جيليو[25]: «مدير مدرسة، وقاصّ، ومفسِّر، ومحارب في آن معًا في خراسان: الضحّاك بن مزاحم الهلالي (ت: 106 /724)». والضحّاك سند مهمّ في التفسير بما في ذلك تفسير الطبري، فهو يمثل ما يسمِّيه جيليو الفترة التكوينية للتفسير «منذ بدايات نشاط تدوين التفسير إلى إدخال العلوم اللغوية -وقبل كلّ شيء- النحوية في هذا النشاط» في بواكير المئات الثانية والثامنة، كما يدلّ على ذلك تفسير الفراء وأبي عبيدة (ص: 113). وإذا أخذنا في الاعتبار بحث غريغور شولر عن المصادر المكتوبة مبكرًا، فإن جيليو هنا يراجع تأريخه المتأخّر السابق لأوائل التفاسير، ويقرُّ بأن الأعمال المكتوبة بدأت في الظهور بالفعل في بواكير القرن الثاني/الثامن، مدللًا بالضحَّاك على ذلك.
ترسم دراسة جيليو المسارات وسلاسل الإسناد التي تنقَّل خلالها تفسير الضحاك على أيدي طلبته، ويستكشف كذلك تأثيرها المحتمل على تفسير مقاتل بن سليمان (ت: 150 /767). وكما عوّدنا جيليو في مؤلفاته، فإنّ هذا الفصل ثري بالمعلومات إلى حدّ كبيرٍ. وهو يدلّل بجلاء على سعة وعمق اطلاعه على التراجم وغيرها من المصادر المطلوبة لتتبّع أصول وارتحال التفسير، ولتقييم أهمية تفضيلات المفسّر الشخصية والعلمية في أهدافه ومنهجه.
الفصل الثالث عشر والأخير هو من تأليف مايكل برجيل[26]، بعنوان: «مناهج تأريخ مؤلفات التفسير وتراثه: هل يمكن لتفسير الكلبي الضائع أن يسترجع من تفسير ابن عباس «المعروف كذلك بـ(الواضح)؟» ويشرع برجيل في انتقاد دعوى وانسبرو بأن مجموعة مرويات التفسير التي نسبها الكلبي (ت: 146 /763) لابن عباس هي في الحقيقة تعود للكلبي، وهي بالإضافة لتفسير مقاتل بن سليمان ينتميان للنوع السردي (أو الأجادا)[27] الذي هو باكورة أنواع التفسير، ويختلف برجيل كذلك مع تأريخ ريبين هذه المجموعة لأوائل المئات الثالثة والتاسعة (300 /900)؛ إِذْ يحاجج أنه بينما المجموعة الفعلية متأخرة زمنيًّا، إلا أنها تحوي تراثًا يعود تاريخه لزمن الكلبي؛ مما يكشف بوضوح عن تشابهات لافتة مع بعض تقارير مقاتل. وبناء عليه، يطوّر برجيل منهجية دقيقة للوقوف على تقارير الكلبي المحتملة في أعمال التفسير الأخرى، وبعد كل هذا، يخلص لنفس النتيجة التي وصل لها وانسبرو فيما يتعلّق بالصلة بين تقارير الكلبي وتفسير مقاتل، على الرغم من أنه توصّل لذلك من طريقٍ مغايرٍ للتصنيفات المؤقتة التي اتبعها وانسبرو، وبما أن تصنيفات وانسبرو كانت منطلق باور في المقدمة؛ فإن إعادة ذكرها في ختام الفصل الأخير من الكتاب لهو لفتة أنيقة، بل يمكن للمرء أن يضيف بأنه تنويه على الحاجة المستمرة للانخراط في الكثير من ملاحظات وانسبرو.
كما تبيِّن هذه المراجعة، فإن المجلد يزودنا بخريطة نفيسة تم تأليفها بمهارة عن طليعة دراسات التفسير، مشيرًا أثناء ذلك إلى سلاسل الإسناد والشبكات العلمية والأماكن وميول المفسِّرين وأهدافهم الشخصية، وكلها مواضيع بمثابة أرض خصبة للمزيد من الاكتشافات المثمرة. وقد نجحت المحرّرة ببراعة في ترتيب التلاقي بين هذه المشاركات بحيث يضيف كلّ منها لمنظور الآخر، دون أن تفقد التركيز على القضايا الأوسع التي عرضت لها في المقدمة. ورغم ذلك، ما زالت ثمة سعة للإدلاء ببعض الملاحظات النقدية.
بيَّن الكُتَّابُ المشاركون بمنتهى الوضوح الحاجة لنبذ النماذج القديمة لتأريخ التطوّرات في التفسير، ومن ثَمّ فَهُمْ يقدِّمون بصائر جديدة ومهمّة في تعقيدات التفسير، التي ينبغي أن تثنينا عن الاتِّكاء على تلك النماذج والتصنيفات البسيطة، إلا أنه مفهوم ضمنًا بأنّ النتائج التي تنبثق من دراسات الحالات الفردية في هذا المجلد لم تتم معالجتها على مدى تاريخ التفسير؛ فالمجلد من ثَمّ يفتقر للتقييم المنهجي لمقدار إسهامه الكلِّي في مستحدثات هذا العلم؛ على سبيل المثال: فإسهامات جيليو وإلى حدٍّ ما جليف وبرجيل تؤيد بصورٍ مختلفةٍ التأريخَ المبكّر للتفسير، وهو ما يتعارض خصوصًا مع تأريخ ريبين المتأخّر، وهكذا بينما تعلن باور بأنه من الخير نبذ المحاولات المبكّرة لتأريخ تطورات التفسير، تجد أن المشاركين في هذا المجلد يقدّمون نتائج كان القارئ ليَوَدُّ أن يراها محلّلة بشكلٍ أكثر منهجيّة فيما يتعلّق بالنماذج (بما في ذلك جولدتسيهر ووانسبرو وحتى فرستيج) المذكورة في المقدمة. ويتساءل المرء كذلك عن أثر اختيار المصطلح التعريفي (النوع Genre) -أي: الشكل الأدبي- في مقاربات المشاركين للتفسير في هذا المصنف، فبتعريف التفسير على أنه نوعٌ، أو أدبٌ له ملامحه الخاصّة، يصير من الممكن التعامل معه بوصفه فذًّا أو مستقلًّا بذاته عن المعارف العلمية الأخرى: الفقه والحديث والكلام واللغويات، وما إلى ذلك. وعلى الرغم من إشارات توتولي لعلم الحديث، فلا شيء عام ذكر في مقدمة المجلد عن العلاقة بين التفسير والعلوم الأخرى، وغياب مثل هذا الانعكاس أدَّى لسوء توافق طفيف بين ما يسعى المجلد لتحقيقه وما حققه بالفعل[28].
وفي حين تذكر باور في المقدمة الفَرق بين أهداف وأساليب دراسة القرآن بغرض تعريف معناه التاريخي من جهة، ودراسته بغرض اعتماد نظام عقائدي من جهة أخرى، فإنها لا تناقش أبدًا على الحقيقة الماهية الفعلية للنظريات التوجيهية للتأويل -أعني الهرمنيوطيقا-. ونظرية التأويل هي نظرية تتناول نوع المعرفة التي يمكن استمدادها من نصٍّ ما، فكان يُتَوَقع من باور الإحالة هنا إلى بعض النظريات الأدبية الحديثة، منها على سبيل المثال: المناظرة الكلاسيكية بين إي دي هيرش الابن والهرمنيوطيقيين التجريبيين من جهة، وهانز جورج جادامير وهرمينوطيقيته المثالية؛ بالنسبة لهيرش فمعنى النصّ يساوي نيَّة الكاتب، بينما عند جادامير يساوي فهم المفسر. وهكذا من ناحية يتبنى مجلد باور هرمنيوطيقيا هيرش في دراسته للمفسرين ومصنفاتهم: فأهدافهم ونواياهم هي محلّ التمحيص بافتراض مسبق أن نصوصهم تعبر عنها، ومن ناحية أخرى يعامل المجلد المفسرين أنفسهم كما لو أنهم طبقوا هرمينوطيقيا جادامير، مفترضًا أنّ تفسيراتهم تعبّر عن أهدافهم ومناهجهم الشخصية عوضًا عن معنى القرآن. والاستثناء في كلّ ذلك هو الفصل من تأليف حمزة، إلا أنّ نقاشه يظلّ في الحيِّز النظري؛ لأنه لا يقدّم أيّ دليل ملموس على مفسّر اعتمد نهجًا تاريخيًّا أو هيرشيًّا[29]. يضاف إلى ذلك أنّ الإسهامات التي يقال إنها تهدف لدراسة (نظم الهرمينوطيقيا) عند المفسرين (ص: 13. مراد، ريبين، جعفر) تدرس في الحقيقة نهج استمداد المعرفة من النصّ، لا النظرية الكامنة وراء المنهج، أي: الهرمينوطيقيا.
وهذا يعود بنا إلى مصطلح «النوع»، فلعلّ طريقة تطبيق هذا المصطلح هنا تفسّر جزئيًّا سبب افتقار هذا المجلد لهرمنيوطيقيا لائقة؛ حيث إنه لا يشمل احتمالية أن تكون هرمنيوطيقيا المفسّرين موجودة بالفعل خارج مؤلفاتهم التفسيرية، وقد لاحظ غريغور شوارب في بعض الحالات مفسِّرين يُعرِّفون هرمينوطيقيتهم في أعمالهم على أنها أصول الفقه لا التفسير[30].
ولمزيد تفصيل في هذه الوجهة النقدية، من اللافت أن دراسة جيليو الأصولية «التفسير واللغة واللاهوت في الإسلام: تفسير الطبري للقرآن»[31] لم تذكرها باور في دراستها لمقدمة منهجية الطبري من ضمن آخرين (راجع العملَيْن المنسوبَيْن لمارتنسون المقتبسَيْن في رقم 29 أعلاه)؛ يدرس جيليو مقدمة الطبري وهرمينوطيقيته القائمة على اللغويات بالأساس، مبينًا أنها تتمحور حول المفهوم الهرمينوطيقي الشرعي للفظة «البيان»، وثمة دراسات أخرى حديثة لهذا المصطلح من بينها دراسات جوزيف لويري لرسالة الشافعي، ودراسة ديفيد فيشانوف بعنوان: «تكوين الهرمينوطيقيا الإسلامية»، ودراسة يونس علي: «التداولية الإسلامية في العصور الوسطى»[32]. ولو أن مثل تلك الأعمال حول الهرمنيوطيقيا الشرعية واللغويات أُعطِيَت اعتبارًا في هذا المجلد، لربما أمكن التوصل لتعريف هرمنيوطيقي في سياق التفسير أقوى من الناحية التحليلية.
ولعلّ إهمال دراسة جيليو لهرمنيوطيقا ومنهج الطبري أثّر كذلك على الحجج التي بسطها كلّ من صالح ومراد، من الوارد أنهما بالغَا بعضَ الشيء في تقرير شخصية الواحدي المبدعة و(المعتزلية)، وإسهامات الجشمي للتفسير اللغوي؛ لأنهما يتجاهلان الطبيعة اللغوية لهرمنيوطيقا الطبري وتفسيره المنهاجي، وليس جيليو وحده مَنْ عَرَض لاهتمام الطبري بالمعنى والنحو والقراءات، بل إنّ هذه الملاحظة أشار إليها حسين عبد الرؤوف في كتابه: (البلاغة العربية)[33] ، وإن بصيغة عبارة تقريرية لا على سبيل البحث الكامل، يُعرِّف عبد الرؤوف تفسير الطبري على أنه ينتمي لعلم المعاني، الذي يحلّل المعنى من خلال النحو وتركيب الجملة والنظم، علاوة على ذلك، وكما تظهر دراسة جيليو، فاللغويات والقراءات لم تكونا ركنَيْنِ في تفسير الطبري فحسب، وإنما أداتَيْه الرئيستَيْن لنقد العالِم النحوي المعتزلي الفراء (ت: 207/ 822)، وترجمته المبنيّة على اللغويات في (معاني القرآن)، وكذلك العالم النحوي غير المعتزلي أبو عبيدة (ت: 206/ 821) في (مجاز القرآن). والحقّ أنّ اللغويات كانت ركنًا بارزًا في التفسير على الأقلّ بحلول بدايات المئات الثانية والثامنة، ومن المحتمل قبل ذلك كما يشير كيس فرستيج[34][35]، بل إن مصطفى شاه[36] ذهب لأبعد من ذلك في الزّمن، للقُرّاء وأصول النصّ القرآني نفسه، الذي لم يكن ليتم بغير اللغويات[37]؛ ونظرًا إلى أنه ليس كلّ علماء اللغويات من المعتزلة، فهذا القارئ على الأقلّ تمنَّى لو أنّ (صالح ومراد) أشارَا إلى ذلك أثناء صوغ حججهما عن الأصول المعتزلية بالأساس لبدء الاستخدام النظامي للّغويات في التفسير، بما يوحي أنّ التفسير لا يمكن أن يكون له وجود بغير اللغويات؛ لأن اللغة هي الوسيلة الوحيدة لتوضيح النصّ، وما الذي يَعنِيه صلاح عليّ بالضبط حين زعم أن الواحدي استطاع بتوظيف اللغويات نَقْلَ اهتمام معتزلي إلى السنيّة؟ وبالنظر إلى أنّ الطبري طوَّر نظامَ هرمنيوطيقا في مقدمته ثم طبقه منهجيًّا في تفسيره؛ لينقد ويصحّح التفسيرات السابقة من اللغويين الآخرين، باستعمال القراءات والأدوات اللغوية الأخرى بما في ذلك الحجج القياسية، فما كان ذلك بالضبط الذي -وفقًا لمراد- جعل تفسير الجشمي نموذجًا (معتزليًّا)؟ وليس المجتهد الطبري فحسب، بل التفسير المالكي الأوَّلي ليحيى بن سلام (ت: 200 /815) ومختصره لابن أبي زمنين (ت: 399 /1009) يمثلان تفاسير لغوية كذلك.
ختامًا:
تلك اللفتات النقدية اليسيرة (التي قد تكون متعلقة بافتقار المراجع للرؤية الكلية أكثر من كونها أوجه قصور فعلية في المجلد) لا تنتقص من حقيقة أنه إضافة قيّمة ونفيسة للمجال، تعيد ترسيم حدود دراسات التفسير، وهو يُظهِر الحاجة لاعتبار التداخل بين التفسير والمعارف الأخرى، خاصة لو أن أحدها يهدف إلى إعادة تشكيل بنية هرمنيوطيقا المفسرين، ويظهر كذلك أن التأريخ المبكر للمصادر والمفاهيم يبدو أكثر معقولية، بما يشير ربما إلى أن اللغويات كانت بمثابة شريان الحياة للتفسير.
[1] هذا التعريف للتفسير تعريف مباين تمامًا لواقع تعريفات فنّ التفسير كما هو معلوم، فهو ينطلق من محاولة طرح توصيف للمادة في مصنفات التفسير توصيفًا عامًّا باعتبارها نتاجًا يخضع أصالةً لغاية المفسّر وهدفه الخاصّ وذوقه الشخصي، وصحيح أن كتب التفسير بها معلومات عديدة تتفاوت في جوانب عديدة منها بحسب تفاوت أغراض المفسِّرين الخاصّة من النصّ، إلا أن هذه المعلومات منها ما هو صلب ومنه ما هو تبع، وما يرتبط بصلب الفنّ (بيان المعنى) له قواعد وأطر حاكمة على جميع المفسِّرين، ولا ينظر للنتاج فيها باعتباره ذوقًا لكلّ مفسر، وإنما هو ممارسة علمية بحتة لها قواعدها الصارمة. يراجع مقالة: معيار تقويم كتب التفسير؛ تحرير وتأصيل. للأستاذ/ خليل محمود اليماني، وهي منشورة على موقع تفسير، على هذا الرابط: tafsir.net/article/5110 (قسم الترجمات).
[2] إجناس جولدتسيهر، «مذاهب التفسير الإسلامي» (ليدن: مطبعة بريل، 1920)؛ وجون وانسبرو، «الدراسات القرآنية: مصادر ومناهج التفسير الديني»، (أكسفورد: مطبعة جامعة أكسفورد، 1977).
[3] جولدتسيهر (1850- 1921)، مستشرق مجري يهودي، تلقى تعليمه في جامعة بودابست ثم برلين ثم ليبستك، وفي عام 1870 حصل جولدتسيهر على الدكتوراه الأولى، وكانت عن تنخوم أورشلي أحد شُرّاح التوراة في العصور الوسطى، وعُيِّن أستاذًا مساعدًا في عام 1872، وبعد رحلة دراسية برعاية وزارة المعارف المجرية في فيينا ثم ليدن ثم في القاهرة (حيث حضر بعض الدروس في الأزهر) وسوريا وفلسطين، وفي عام 1894 عيِّن أستاذًا للغات السامية بجامعة بودابست. له عددٌ كبيرٌ من الآثار، أشهرها: (العقيدة والشريعة في الإسلام، تاريخ التطوّر العقدي والتشريع في الدّين الإسلامي)، و(مذاهب التفسير الإسلامي)، والكتابان مترجمان للعربية، فالأول ترجمه وعلق عليه: محمد يوسف موسى، وعلي حسن عبد القادر، وعبد العزيز عبد الحق، وقد طبع أكثر من طبعة، آخرها طبعة صادرة عن الهيئة العامة للكتاب، القاهرة، 2013، بتقديم محمد عوني عبد الرؤوف، والثاني كذلك مترجم، ترجمه: عبد الحليم النجار، وصدر في طبعة جديدة عن الهيئة العامة للكتاب، القاهرة، 2013، بتقديم محمد عوني عبد الرؤوف، وله كتاب مهمّ عن الفقه بعنوان (الظاهرية: مذهبهم وتاريخهم)، وهو أول بحوثه المهمّة حول الإسلام حيث صدر في 1884، كذلك فقد ترجمت يومياته مؤخرًا، ترجمها: محمد عوني عبد الرؤوف، وعبد الحميد مرزوق، وصدرت عن المركز القومي للترجمة، القاهرة، 2016، ونظن أن في هذه اليوميات فائدة كبيرة لفهم الكثير من أبعاد فكر جولدتسيهر ورؤيته للإسلام ودافِع دراسته له، ولمساحات الاشتغال التي اختارها في العمل عليه. (قسم الترجمات).
[4] جون وانسبرو (1928م- 2002م) مستشرق أمريكي، يعتبر هو رائد أفكار التوجه التنقيحي، وتعتبر كتاباته منعطفًا رئيسًا في تاريخ الاستشراق؛ حيث بدأت في تشكيك جذري في المدونات العربية الإسلامية وفي قدرتها على رسم صورة أمينة لتاريخ الإسلام وتاريخ القرآن، ودعا لاستخدام مصادر بديلة عن المصادر العربية من أجل إعادة كتابة تاريخ الإسلام بصورة موثوقة، ومن أهم كتاباته: «الدراسات القرآنية؛ مصادر ومناهج تفسير النصوص المقدسة» (1977م). (قسم الترجمات).
[5] كيس فرستيج، «النحو العربي وتفسير القرآن في صدر الإسلام»، (ليدن: مطبعة بريل، 1993).
[6] باور، «الأهداف والمناهج والسياقات»، ص8.
[7] كارين باور، حاصلة على دكتوراه من جامعة برنستون، هي كبيرة الباحثين في معهد الدراسات الإسماعيلية بلندن، تتركّز اهتماماتها في التفسير والتاريخ الاجتماعي الإسلامي، لها عددٌ من الكتب، منها: (هيراركي النوع في القرآن، تفسيرات العصور الوسطى والردود الحديثة، 2015)، كما حررت كتاب: (أهداف كتب التفسير ومناهجها وسياقاتها، 2013)، بالإضافة للمشاركة في عدد من الكتب، وكتابة بعض المقالات العلمية. (قسم الترجمات).
[8] فراس حمزة، أستاذ مشارك الدراسات الدولية بجامعة ولغنونغ بدبي، حصل على الدكتوراه من جامعة أكسفورد عن أطروحة حول مفاهيم الجحيم والشفاعة (لاهوت الآخرة) في مجتمع الإسلام في القرنين الأول والثاني للهجرة، عمل كأستاذ مساعد دراسات الشرق الأوسط بالجامعة الأمريكية بدبي، كما عمل باحثًا مشاركًا في معهد الدراسات الإسماعيلية بلندن، اهتماماته تتركز في تاريخ بدايات الإسلام خصوصًا التطوّر الديني والسياسي، والتفسير الإسلامي التقليدي والحديث، له ترجمة توضيحية لتفسير الجلالين، 2008. (قسم الترجمات).
[9] وليد صالح، باحث لبناني ولد في كلومبيا، أستاذ بقسم الدّين وقسم دراسات الشرق الأوسط بجامعة تورنتو الكندية، درس اللغة والأدب العربي في الجامعة الأمريكية ببيروت ثم حصل على الدكتوراه من جامعة ييل الألمانية، وجامعة هامبورغ الألمانية، تتركّز اهتماماته في القرآن وتاريخ التفسير واللغة العربية، والأدبيات اللاهوتية في الإسلام، له عددٌ من المقالات والأوراق في هذا السياق، بالإضافة لكتابه الأشهر «تشكيل التقليد التفسيري الكلاسيكي، تفسير القرآن للثعلبي»، والمشاركة في بعض الكتب المهمّة. (قسم الترجمات).
[10] باحث لبناني، درس في الجامعة الأمريكية ببيروت، وحصل على الدكتوراه من جامعة ييل في 2004، مهتم بالتاريخ الإسلامي، وبالفكر الإسلامي الحديث، والأديان المقارنة خصوصًا التوحيديات الثلاثة، من كتاباته في هذا السياق: «الإسلام المبكّر بين الأسطورة والتاريخ، 2000». (قسم الترجمات).
[11] صدر مؤخرًا تفسير الجشمي عن مركز تفسير، بتحقيق عبد الرحمن بن سليمان السالمي، في عشرة مجلدات. (قسم الترجمات).
[12] روبرت جليف، أستاذ الدراسات العربية والإسلامية بجامعة إيستر، ترأَّس عددًا من المعاهد البحثية، منها المعهد البريطاني للدراسات الفارسية، كما عمل كأستاذ زائر في عدد من الجامعات: ميتشغان، واشنطن، طهران، سياتل. تركّزت اهتماماته في التفسير والقانون الإسلامي، يعمل حاليًا كباحث رئيس في عددٍ من المشاريع البحثية التي تدور حول الشريعة والقانون الإسلامي، له عددٌ من الكتابات في هذا السياق، منها: إسلام الكتاب المقدّس، تاريخ وعقائد مدرسة الإخباريين الشيعة، 2007، الإسلام والحرفية، المعنى الحرفي والتفسير في النظرية القانونية الإسلامية، 2012. (قسم الترجمات).
[13] أندرو ريبين، هو باحث كندي من أصل بريطاني، ولد في لندن 1950م، واهتمامه الرئيس يتعلّق بدراسة الإسلام المبكّر، ودراسة تفسير القرآن في العصور الكلاسيكية، له عددٌ من المؤلفات التي قام بتأليفها أو المشاركة في إعدادها، مثل: دليل إلى الإسلام، مع ديفيد إيدي ليونارد ودونالد ليتل ريتشارد، كما حرّر كتابًا بعنوان: «مقاربات في تاريخ تفسير القرآن»، والذي صدر عن جامعة أكسفورد عام 1988م. وقد عمل كباحث زميل في معهد الدراسات الإسماعيلية بلندن، منذ عام 2013م، قبل وفاته في 2016م.(قسم الترجمات).
[14] أوري روبين، «عين الناظر: حياة محمد كما رُئِيَت من قِبَل المسلمين الأوائل»، (برنستون، نيو جيرسي: مطبعة داروين، 1995).
[15] روبرتو توتولي (1964-) مستشرق إيطالي، حصل على شهادته في اللغات الشرقية، ثم حصل على الدكتوراه من الجامعة العبرية وجامعة نابولي، درس الدراسات الإسلامية في جامعة تورينو ثم في جامعة نابولي، وهو أستاذ الدراسات العليا بجامعة نابولي، تتركّز اهتماماته في الأدب الإسلامي وفي التفسير وقصص الأنبياء التوراتيين في القرآن، تولى تحرير عددٍ من المجلات العلمية، وله عددٌ من الكتابات حول هذا أهمها كتابه: أنبياء الكتاب المقدس في القرآن وفي الأدب الإسلامي، 2004، كما شارك في إعداد فهرس للمخطوطات الإسلامية من مجموعة كاهل بقسم الدراسات الشرقية بجامعة تورينو، 2011. (قسم الترجمات).
[16] جوناثان بروان، (1977-)، باحث أميركي، هو أستاذ مشارك الدراسات الإسلامية بجامعة جورج تاون، ورئيس تحرير موسوعة أكسفورد للإسلام، تدور اهتماماته حول الشريعة الإسلامية والحديث والنقد التاريخي والفكر الإسلامي المعاصر، له في هذا عدد من الكتب، منها: محمد، مقدمة قصيرة جدًّا، 2011، بالإضافة لدراسته المشار إليها هنا، تقديس البخاري ومسلم، تشكيل ودور تكريس السُّنّة الحديثية. (قسم الترجمات).
[17] جوناثان براون، «قدسية البخاري ومسلم»، (ليدن: مطبعة بريل، 2007).
[18] في الحقيقة هذا الحِجَاج فيه نظر ظاهر؛ فالأحاديث النبوية معلوم حجيتها الشرعية والاستناد عليها في التشريع منذ بدايات الإسلام، واستعمال المفسِّر لها في سياق التفسير لا صلة له ألبتة بما يذكره توتولي، وإنما هو توظيف تفسيري اجتهادي في إنتاج معنى أو تقرير دلالة لفظة تبعًا لربطها بحديث لا غير؛ ولهذا من الممكن أن يستعمل المفسِّر أحاديثَ فيها ضعف وليست معتمَدة ضمن الصحيح في علم الحديث تبعًا لقرائن تفسيرية لاحت له في تقرير المعنى وتأسيسه من خلالها، وليس لمثل هذه الأغراض المشكلة التي ذكرها. (قسم الترجمات).
[19] مارتن نجوين، أستاذ مشارك في التقاليد الدينية الإسلامية بقسم الدراسات الدينية بجامعة فيرفيلد بكاليفورنيا، تحصّل على بكالوريوس الدراسات الدينية والتاريخ من جامعة فيرجينا، وعلى الماجستير من كلية اللاهوت بجامعة هارفرد حول كتاب (لطيف الإشارات) للقشيري، ويعمل على الدكتوراه في مركز دراسات الشرق الأوسط بجامعة هارفرد، له بعض الكتابات في هذا السياق، آخرها كتابه: «اللاهوت الإسلامي الحديث: فهم الله والعالم بالإيمان والخيال»، 2018.(قسم الترجمات).
[20] أستاذ مساعد في الدراسات الإسلامية بجامعة أمهيرست الأمريكية. (قسم الترجمات).
[21] لودميلا زاماه أستاذ مساعد بجامعة وينيبغ الكندية، أطروحتها للماجستير بعنوان: «السرد مقابل التفسير، دور قصص الأنبياء في تفسير القرطبي»، تتركّز اهتماماتها في التفسير، وقصص الأنبياء، والمرأة، ولها عددٌ من المقالات والأوراق في هذا السياق.(قسم الترجمات).
[22] روبرت جليف، «الإسلام والحرفية: المعنى الحرفي والتأويل في النظرية الإسلامية الشرعية»، (إدنبرة: مطبعة جامعة إدنبرة، 2012).
[23] ستيفن بيرج، حاصل على الدكتوراه من جامعة إدنبرة بإنجلترا، ويعمل كباحث مشارك في معهد الدراسات الإسماعيلية بلندن منذ عام 2009، تركّز اهتماماته في التفسير والحديث، له عدد من الكتابات، منها: الملائكة في الإسلام، (الحبائك في أخبار الملائك) للجلال السيوطي، 2012. كما حرّر كتابًا بعنوان: (معنى الكلمة، المعجم والتفسير القرآني)، 2015.(قسم الترجمات).
[24] وانسبرو، الدراسات القرآنية.
[25] كلود جيليو (1940-)، مستشرق فرنسي وأحد الآباء الدومنيكان، وهو أستاذ الدراسات العربية والإسلامية في جامعة إكس أون بروفانس- مارسيليا بفرنسا منذ عام 1989 وحتى تقاعده في عام 2006، ولد جيليو في السادس من يناير عام 1940، وقد حصل على دكتوراه الدولة في سبتمبر عام (1982) من جامعة السوربون 111Paris -، وكانت أطروحته بعنوان: «جوانب المخيال الإسلامي الجمعي من خلال تفسير الطبري»، والتي أشرف عليه فيها أستاذه محمد أركون، وقد عمل باحثًا في معهد الأبحاث والدراسات حول العالم العربي والإسلامي (IREMAM)، ومشرفًا ومحرّرًا لعددٍ من المجلات البحثية المتخصصة كمجلة أرابيكا (Arabica)، وله إنتاجٌ غزيرٌ وعددٌ كبيرٌ من الكتابات حول تاريخ القرآن والتفسير، وأشرف على العديد من الرسائل الأكاديمية والأعمال العلمية. (قسم الترجمات).
[26] مايكل بريجيل، أستاذ بمعهد دراسات المجتمعات والحضارة الإسلامية بجامعة برنستون، تتركّز اهتماماته في تاريخ بدايات الإسلام، والتفاسير التقليدية للقرآن، وتلقِّي واستقبال الموضوعات والتيمات والموتيفات المسيحية واليهودية في التفسير. (قسم الترجمات).
[27] نسبة للهاجادا، وكلمة: «الهاجادا» تعني السرد أو الرواية، وهي المعتقدات الدينية وقصص الأنبياء المعتبرة كحقائق دينية، لكنها في النهاية نصوص غير قانونية/شرعية مثل المزامير. (قسم الترجمات).
[28] تقرر باور في المقدمة أن النهج المجلد العام في مقاربة التفسير تنطلق من نظريات التأويل، ص8.
[29] ثمة دراستان حديثتان نسبيًّا من تأليفي عن تفسير الطبري، تعرضان لنفس القضية مع الإشارة لهرمنيوطيقيا الطبري ومنهاجه. راجع «البرهان القاطع: سياسات أرسطو وخطابته في القرآن وتفسير الطبري»، مجلة دراسات القدس في اللغة العربية والإسلام 34 (2008)، ص363-420؛ و«ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﻟﻬﺮمنيوطيقا ﺍﻟﺤﺪﻳﺜﺔ: ﻗﺼﺪ ﺍﻟﻤﺆﻟﻒ ﻓﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺍﻟﻄﺒﺮﻱ ﻭﺍﻟﻐﺰﺍﻟﻲ ﻵﻳﺔ ﺍﻟﻨﻮر» مجلة الدراسات القرآنية 11: 2 (2009)، ص20-48.
[30] راجع جريجو شوارب، «سبر معاني كلام الله: علاقة أصول الفقه بفهم أصول التفسير في كلام المسلمين واليهود»، بار أشر، مير م.، سايمون هوبكينز، سارة سترومزا، برونو كييزا (محررون)؛ «كلمة في محلها: دراسات في تفسير القرون الوسطى لكتاب العهد القديم والقرآن» (القدس، معهد بن زفي، 2007)، ص111-56. من الجدير بالذكر أن فرضية أحمد الشمس عن ظهور المذاهب كمناهج وهرمنيوطيقا قانونية منعكس في التفسير مع ظهور النوع الفني الموسوعي، ويعدُّ «جامع البيان» للطبري النموذج الرئيس. راجع الشمسي في «تقديس التشريع الإسلامي: تاريخ اجتماعي وفكري»، (نيويورك: مطبعة جامعة كامبريدج، 2013)، ص212-216.
[31] كلود جيليو، «التفسير واللغة اللاهوت في الإسلام: تفسير الطبري للقرآن»، (باريس: فرين، 1990).
[32] جوزيف لويري، «بعض الملاحظات الأولية على الشافعي وأصول الفقه لاحقًا: قضية مصطلح البيان»، آرابيكا 55 (2008)، ص505-27؛ ديفيد فيشانوف، «تشكيل الهرمنيوطيقا الإسلامية: كيف تخيل المنظِّرون القانونيون السنيّون التشريع الموحى به» (نيو هيفن، كونيكتيكوت: مجلة الجمعية الأمريكية الشرقية، 2011)؛ محمد محمد يونس علي، «البراجماتية الإسلامية في العصور الوسطى: نماذج الاتصال النصي في النظريات السنية الشرعية»، (ريتشموند، سري: مطبعة كيرزون، 2000).
[33] حسين عبد الرؤوف، «البلاغة العربية: تحليل براجماتي»، (لندن، نيويورك: مطبعة روتليدج، 2006).
[34] كيس كرستيج، (1947-) مستشرق هولندي، مختصّ باللغة العربية وتاريخها، له كتابات عديدة حول اللغة العربية ومنها مترجم، أهمها: اللغة العربية؛ تاريخها ومستوياتها وتأثيرها، ترجمه: محمد الشرقاوي، وصدر عن المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، 2003. (قسم الترجمات).
[35] كيس فرستيج، «النحو العربي وتفسير القرآن في صدر الإسلام»، (ليدن، نيويورك، كلون، مطبعة بريل، 1993).
[36] مصطفى شاه، باكستاني الأصل، وهو باحث بكلية الدراسات الشرقية والأفريقية (SOAS)، تتركز بحوثه بالأساس على النصوص الإسلامية المبكّرة، خصوصًا تطوّر التقاليد اللغوية والقراءات القرآنية والتفسير، له عددٌ من المقالات البحثية المهمّة، كما شارك في بعض الكتب، وحرّر البعض الآخر، وكتب عددًا من عروض الكتب المهمّة، كان من بين الكتب والدوريات المهمّة التي شارك في كتابتها: «The Arabic Language..، اللغة العربية، 2008»
ضمن «' In: Rippin, A., (ed.), The Islamic World. New York; London: Routledge, pp. 261-277، العالم الإسلامي التي يشرف عليها المستشرق الكندي أندرو ريبين».
من بين الكتب التي قام بتحريرها: « Tafsir: Interpreting the Qur'an، التفسير: تفسير القرآن، 2013»
ضمن « Critical Concepts in Islamic Studies. London: Routledg، مفاهيم نقدية في الدراسات الإسلامية»، وقد ترجَمْنا له مادةً بعنوان: »إسهامات النحويين المبكرة في توثيق القراءات القرآنية»، منشورة ضمن الملف الثاني على قسم الترجمات، ملف (تاريخ القرآن)، يمكن مطالعتها على هذا الرابط: tafsir.net/translation/25. (قسم الترجمات).
[37] راجع مصطفى شاه، «استكشاف نشأة الفكر اللغوي العربي المبكّر: قرّاء القرآن ونحاة مدرسة الكوفة (ج1)»، مجلة الدراسات القرآنية 1: 5 (2003)، ص47-78؛ «إسهامات النحاة المبكرة في جمع وتوثيق القراءات القرآنية، مدخل لكتاب السبعة لابن مجاهد»، مجلة الدراسات القرآنية 1: 6 (2004)، ص72-102.
- وقد ترجمنا دراسة شاه، وهي منشورة ضمن الملف الثاني على قسم الترجمات ملف (تاريخ القرآن)، يمكن مطالعتها على هذا الرابط: tafsir.net/translation/25 (قسم الترجمات).
كلمات مفتاحية
الكاتب:

أولريكا مارتنسون - ULRIKA MÅRTENSSON
باحثة سويدية، أستاذ الفلسفة ودراسات الأديان بجامعة العلوم والتكنولوجيا النرويجية تتركز اهتماماتها في تاريخ بدايات الإسلام، والقرآن، وتاريخ التفسير.
مواضيع ذات صلة
((المعلومات والآراء المقدَّمة هي للكتّاب، ولا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع أو أسرة مركز تفسير))