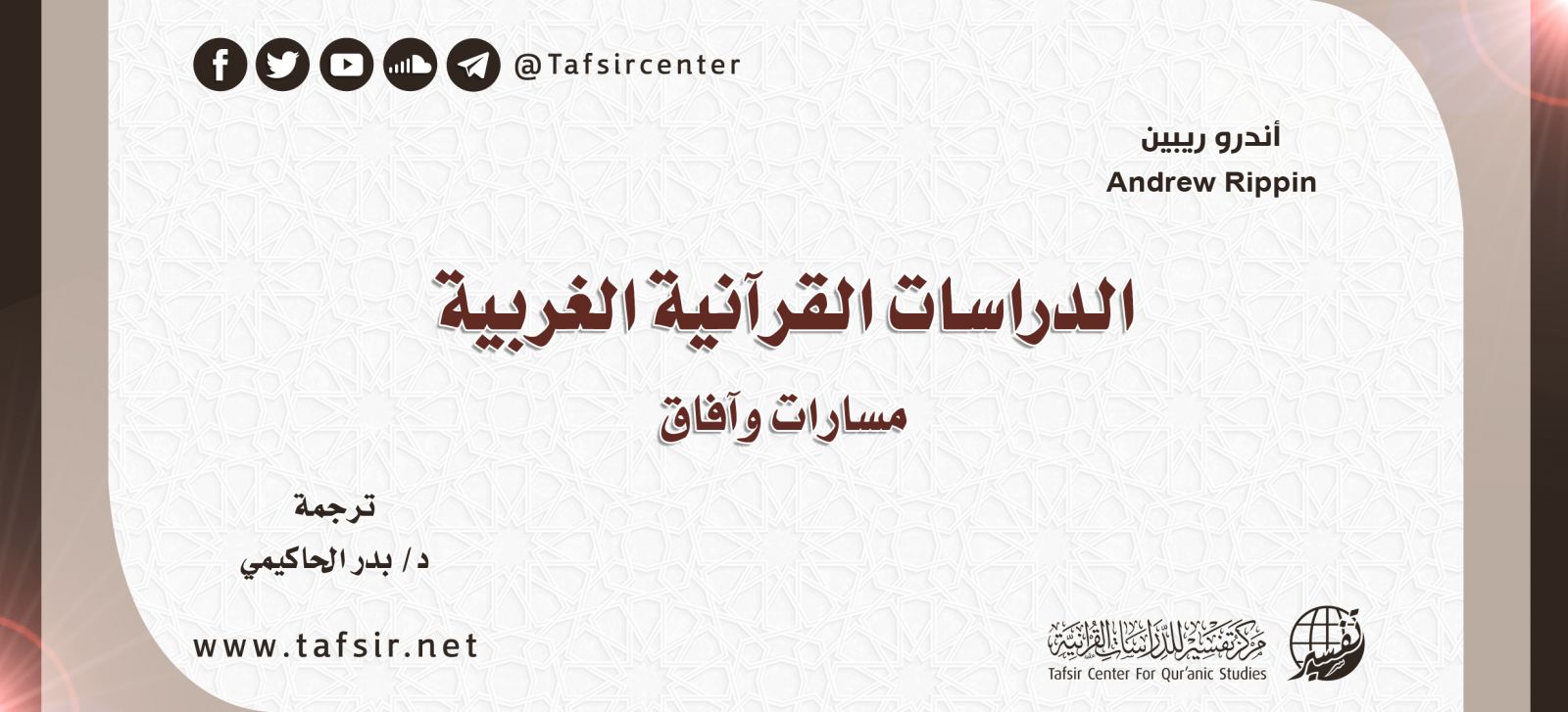
الدراسات القرآنية الغربية
مسارات وآفاق[1][2]
أندرو ريبين [3]
مقدمة[4]:
نظرًا للمكانةِ المحوريةِ التي يتبوَّؤُها القرآنُ في الإسلام وفي نفوسالمسلمين، تُعَدّ الدراسة الأكاديمية للقرآن نقطةً محوريةً ضرورية لأيّ مشاركة في الدراسات الإسلامية. وقد صَيَّرَت هذه المكانةُ المحوريةُ موضوعَ دراسته متشعبًا ومثيرًا للجدل؛ نظرًا للقيمةِ التي يُضفيها كلّ من المجتمع والغرباء على الكتاب [القرآن]. ولا ريب في أنَّ الدراساتِ القرآنيةَ قد تصطدم أحيانًا بخلافاتٍ عقائديةٍ، وشكوكٍ جداليةٍ شأنها في ذلك شأن دراسة الكتب المقدّسة للأديان الأخرى. وقد اختلفت الطريقة التي تعامَلَ بها الأكاديميون مع هذه الخلافات مع مضيّ الوقت؛ فقد أدّى نشوءُ مجتمعٍ مُعَوْلَـم متسارع، إلى جانب وسائل الاتصال السريعة والواسعةِ النطاق، إلى واقع لم يَعُد فيه الباحثون يشتغلون في (برج عاجي) (إن كانوا كذلك يومًا)، بل غدا عملهم يخضع باستمرار للتدقيق والمراجعة والنقد، فضلًا عن إعادة توظيفه لتحقيق أغراض خبيثة ممكنة. ولا يُمكن أن يكونَ الجوابُ الأكاديمي المسؤولُ إزاء هذا الواقع إلا جوابًا نزيهًا، وهو: وجوبُ تعاملِ المرء مع الأدلةِ المعروضةِ في أيّ دراسة بأمانة وإخلاص، مقرونًا أيضًا بتواضُع علمي، واستعداد دائم لتغيير وجهات نَظَره مَتَى اقتضت المعطياتُ ذلك، دون تهيّبٍ أيضًا من الإفصاح عن الآثار المترتبة على دراساتِه. ولذلك يتعيّن على الباحث أن يكونَ متأهّبًا لإسماع صوتِه؛ إمَّا لفضح بحثٍ معين، أو الدفاع عنه حين يقتضي المقام ذلك، وهو على يقين بأنه صادق مع نفسه، وأمين في دراساتِه.
أولًا: مقاربات بحثية:
تُعَدّ الدراسةُ الأكاديميةُ للقرآن، بالطريقة التي يتجلّى بها القرآن في العلوم الإسلامية وفي الثقافة الشعبية عبر القرون، مسارًا علميًّا نابضًا بالحياة ومتعددَ الأبعاد. ورغم أن تاريخَ هذه الدراسة -كما يشار إليه كثيرًا- ليس بِطُول ولا بِغَوْر تاريخ الدراسات الكتابية، إلا أنه أثار -مع ذلك- مجموعة شاملة من الأسئلة، وطَرَح طيفًا متنوعًا من المقاربات التي كانت مجهولة داخل المجتمع الإسلامي في العصور الوسطى، والتي يتصدّى لها المسلمون أنفسهم اليوم في ظلّ اجتياح العالم التكنولوجي المعولم بعد عصر الأنوار. ورغم أنّ الفكرة القائلة بأنّ الدراسات القرآنية تعيش في حالة من «الفوضى»[5]، أو أنها ما تزال تبحث عن موضوعها المناسب[6]، قد راجت وذاع صيتها في بعض المنشورات الحديثة، إلا أن مثل هذا التقييم يمكن فهمُه بشكلٍ أدقّ بأنه مجرّد خطاب بلاغيّ يرمي من خلاله الكاتب إلى الترويج لمزايا مقاربته الخاصّة في مقابل المقاربات المنافسة. وبدلًا من تصورها (فوضى)، يمكن اعتبار هذه النماذج البحثية المختلفة دليلًا على الطبيعة الحيوية لهذا التخصّص، الذي يستقطبُ عددًا كبيرًا من الباحثين الجُدد، ويشهد تنوعًا متزايدًا في وجهاتِ النظر، وعددًا متزايدًا من المنشورات الجديرة بالثناء.
ومع ذلك، توجد بعضُ التوتّرات الكامنة في الدراسات القرآنية حينمايتبنّى بعضُ المسلمين المقارباتِ الأكاديميةَ العلمانية، رغم أنّ الشعور بعدم الثقة في هذه المقاربات، الذي يرتسم باستمرار في الكتابات الإسلامية، هو في حد ذاته في حالة من التقلّب والتغيّر. ويبدو تأثيرُ الدراساتِ القرآنية العلمانية على المسلمين واضحًا بشكلٍ متزايدٍ[7]، ولا سيما في ضوء عدد ترجماتالأعمال العلمية المكتوبة باللغات الأوروبية المنشورة بالعربية والفارسية والتركية، بالإضافة إلى لغاتٍ أخرى. وفي الآن نفسه، أسهم تصاعد الإسلاموفوبيا -ولا سيما عندما وظفَت الإنترنت كمنتدى للنقاشات الدينية- في صدور كتابات جدالية تتستّر تحت عباءة البحث الأكاديمي؛ وقد زاد هذا من شكوك بعض المسلمين في مصداقية الأعمال الأكاديمية. ورغم أنَّ هذه الظاهرةَ منتشرة على نطاق واسع في مجال الدراسات الإسلامية، إلا أن وقعها أشد في سياق دراسة القرآن. وهذا يرجع إلى أنّ الأسئلة التاريخية العلمية المثارة حول النصّ هي تلك التي تمسّ بشكلٍ مباشرٍ قلب القضية الجوهرية التي تثير الجدل (لا الدراسات العلمية)، وهي: حقيقة الطابع الوحياني للقرآن كما يؤمن به المسلمون. أمّا أولئك الذين يغضّون الطرف عن مثل هذه الأسئلة (أو «يستبعدونها» بلغة المذهب الظاهراتي، وهو موقف ما يزال شائعًا في الولايات المتحدة)، فيمكنهم إثارة قضايا أخرى ظلّت غائبة -أو مستحيلة الطرح- داخل الفهم التراثي الإيماني للقرآن[8]. ومن هذه القضايا المحورية التي أثارت أكبر قدر من الخلاف مع مقاربة الدراسة العلمانية: الفرضيات العقائدية المتعلقة بأزلية القرآن (أي وجوده قبل الخَلق)، وإعجازه الأدبي[9]، وهما عنصران لا ينفصلان عن الموقف الإيماني أعلاه الذي يؤكّد على صِدْق الوحي الإلهي.
من المهمّ أن نُدرك في الوقت نفسه أيضًا أنّ الجانب الجدالي في الدراسات القرآنية لم يعد يندرج ضمن إطار الصراع التقليدي بين المسيحية والإسلام فقط، حتى وإن ظلّت النظرة السائدة لدى بعض المسلمين تربط هوية كلّ ما هو غربي بالمسيحية. بل بات مثل هذا النوع من الدراسات الجدلية يرتبط بشكلٍ متزايدٍ بالمقاربات الإنسانوية أو المناهضة للدِّين كما يتجلّى ذلك، على سبيل المثال، في أعمال ابن وراق صاحب الاسم المستعار الذي حاول -من خلال مجلداته التحريرية للكتب العلمية الكلاسيكية عن القرآن- أن يثبت أنّ الإسلام اعتمد على مصادر تاريخية غير أصلية، وغير صحيحة، وعلى أفكار رائجة وزائفة[10]. يقتضي هذا الموقف وجوب مقاربة هذه الكتب، من قبيل كتب ابن ورّاق -رغم ما تقدّمه من فائدة في إعادة إتاحة بعض الأعمال النفيسة للعلماء القدامى- بمستوى عالٍ من التحليل النقدي الأكاديمي الجاد.
يميل الردّ الإسلامي المحافظ تجاه كافة هذه الدراسات الأكاديمية إلى إظهار قَدْر من الريبة، وهي ريبة تبدو مبرّرة إذا نُظَر إليها في ضوء الأعمال الجدالية، إلا أنها تغفل مع ذلك جوهر الأخلاقيات الأساسية، ومقاربة الأعمال الأكاديمية المتوازنة. ويمكننا العثور على مثال مناسب لذلك في بعض المراجعات النقدية المكتوبة مؤخرًا حول موسوعة القرآن الصادرة بتحرير جين دامين ماكوليف (Jane Dammen McAuliffe)[11]. إِذْ يدّعي مظفر إقبال في نقده للموسوعة وجودَ منظورٍ واحدٍ يهيمن على (الغالبية الساحقة) من الإسهامات المبثوثة في هذا العمل الجماعي، ويصفه بأنه: «منظور حداثوي نسبوي تطوُّري يقرأ نصَّ القرآن باعتباره نتاجًا بشريًّا، ويدعُو إلى اعتماد مقاربة تاريخانية- تأويلية»[12]. يرى إقبال أنّ هذه المقاربة «تنكر أو تتجاهل أو لا تعيرُ أهمية لظاهرة الوحي بالطريقة التي تُفْهَمُ في الإسلام»[13]. إِذْ تعدّ مكانة القرآن باعتباره كلام الله قضيةً جوهرية؛ وذلك لأنّ «المدوّنة الكاملة للدراسات الإسلامية المتعلقة بالقرآن تقوم على مقدّمة مفادها أنّ القرآن كلام الله أُنزل على نبي الإسلام عبر الملاك جبريل كما أُنزل الوحي على الأنبياء من قبله»[14]. وهذه دعوى لا يُمكن تجاهُلها، كما يرى إقبال؛ لأنّ مسألة وحي القرآن هي قضية «يجب على المرء إمّا أن يقبلها أو يرفضها»[15]. ولا تعدّ عباراتُ الشك التي تتخلّل نثرَ معظم المؤرخين الأكاديميين إلا دليلًا على الفشل في مواجهة القضية الجوهرية؛ لأنّ القرآنَ هو كتاب الله الذي ﴿لَا رَيْبَ فِيهِ﴾»[16].
ففي نهاية المطاف، يُعَدُّ الطرحُ الجدلي القائل -كما يَنُصُّ عليه محرّرو موسوعة القرآن، ومثلما اقترحتُ أعلاه- بأنّ «وجهات النظر العلمية التي لم يَعُد من الممكن ربطها بشكلٍ واضح بالانتماء الديني» مرفوضة تمامًا كما ذكر ذلك إقبال في الصفحة الثامنة من مقاله الموسوم بـ(الأكاديمية الغربية والقرآن: بعض الأحكام المسبقة المستمرة)، الصادر سنة 2009م؛ فالدراسات القرآنية، كما يقول إقبال، يجب أن تكون استثنائية؛ «لأنّ القرآن كتابٌ لا يشبه أيّ كتاب آخر»[17]. وفي المشروع الذي يرأسه إقبال الموسوم بـ(الموسوعة المتكاملة للقرآن)، كانت صفة (المسلم) -الذي يُعرِّفُه بأنه أحد (علماء المدارس السنيّة الأربعة، والعلماء المنتمين إلى المدرسة الجعفرية)- الشرط الأساس المؤهل لانتقاء باحثين للمشاركة في إعداد هذه الموسوعة الجديدة[18]. وأمام هذه المقاربة الإسلامية، ستجد الدراسة العلمانية للقرآن نفسها في مأزق صعب؛ إِذْ يظلّ تخطّي الحاجز بين البحث الأكاديمي وبعض العناصر الموجودة داخل المجتمع الإسلامي، وبناء جسر عبر وسائل البحث العلمي، أهدافًا جديرة بالاهتمام إلا أنها صعبة التحقّق، ولا يوجد حلٌّ جاهز متاح؛ وهذا هو واقع التخصص.
غالبًا ما يَستشهد الباحثون بالدراسات الكتابية بأنها نموذج منهجي لا يختلف عن دراسة القرآن ومناقشته، ويعتمدون أحيانًا في ذلك على نصّ وانسبرو المثير القائل بأن «[القرآن] بوصفه وثيقة قابلة للتحليل بأدوات وتقنيات النقد الكتابي ما يزال نصًّا مجهولًا تقريبًا»[19]. ويرفض الباحثون في مناسبات أخرى هذا التشابه، ويؤكّدون على تفرّد القرآن بوصفه قطعة من الأدب العربي، وهو ما يستدعي منهجًا مختلفًا خاصًّا به. ومن المعلوم أنّ الدراسات الكتابية نفسها بعيدة كلّ البُعد عن كونها تخصّصًا متماسكًا وموحدًا في حدّ ذاته، ومن ثم عندما يُطرح نقاش المنهج بهذه الطريقة يكون إلى حدّ ما عقيمًا. وما يزال كثير من الباحثين يعتبرون مناقشة المنهج أمرًا زائدًا عن أهدافهم البحثية، ويرون ضمنًا أنّ قراءة النصوص عملية غير معقدة؛ لا تتطلّب من المؤرّخ إلا أن يتعلّم القراءة بين السطور، ويركّز على إثبات صدقية تاريخية المادة المدروسة. وقد كُتبت العديدُ من التحليلات عن هذا الإشكال المنهجي، ويجب أن تكون قراءتُها جزءًا من الخلفيةِ العلميةِ لكلّ باحثٍ في القرآن[20].
وقد ظهرتْ عدّة مقاربات مهيمنة لمن يرغب في تطبيق منهجية محدّدة لدراسة محتويات القرآن. وتتصدّر الدراساتُ الدلالية المرتبطة بأعمال توشيهيكو إيزوتسو[21]، والدراسات البنيوية الأدبية لميشيل كويبرس[22]، وكذلك الأعمال التاريخية السياقية لكلّ من أنجيليكا نويفرت[23]، وجبرائيل سعيد رينولدز[24]، المشهد البحثي. ومع ذلك، فإنّ إلقاء الضوء على هذه العناصر يرسم حدودًا ضيقة لمجال الدراسات القرآنية[25]، لا يمكنها أن تستوعب جميع عناصر هذا المجال التي تتجاوز تحليل النصّ نفسه. ومع ذلك، ساقت نويفرت حججًا قوية تجيز لهذه الدراسات أن تحتل مركز الصدارة في الحقل الأكاديمي[26]. ورغم ذلك، توجد مجالات اهتمام أُخرى تمتدّ عبر التخصصات ذات الصِّلَة -وسوف نسلِّط الضوء على بعضٍ منها في الجزء الخاصّ بمجالات البحث الرئيسة الراهنة أدناه- تشكّل في نهاية المطاف المجال الشامل للدراسات القرآنية، وتوسّع دائرة الاهتمام العلمي لتشمل جوانب أخرى. وقد برهنت في الحقيقة جميع عناصر التفاعل الإسلامي مع القرآن -من تلاوة، وفنّ، وعمارة، وممارسات شعبية، وشعائر، وتفسير، وغير ذلك- على أنها مجالات بحثية مثمرة في حقل الدراساتِ القرآنيةِ المعاصرة.
ثانيًا: المصادر اللازمة لبدء البحث أو تطويره:
تتطلب الدراسة الجادة للقرآن شرطًا أساسيًّا واضحًا، هو: معرفة اللغة العربية. وبما أن القرآن يضمّ بين طيّاته كثيرًا من الخصائص الفريدة في نحوه ومفرداته، فإنّ إتقان اللغة العربية الكلاسيكية يظلّ شرطًا أساسيًّا سواء لفهم النصّ أو دراسته. وهذا لا ينفي قيمة العديد من الترجمات المتاحة[27]. فقد بَذلت أجيال متعاقبة من الباحثين المبرزين جهودًا هائلة لترجمة القرآن إلى كثير من اللغات؛ ومن المنطقي توظيف هذه الترجمات بوصفها أدوات معيّنة على الدراسة المتقدّمة للقرآن. ولا توجد ترجمة معيارية أو مأثورة على غيرها. أمّا فيما يتعلق بالأعمال المكتوبة باللغة الإنجليزية، فقد حظيت ترجمة آرثر آربري (Arthur Arberry) الصادرة سنة 1955م[28] منذ ردح طويل من الزمن بإعجابٍ كبيرٍ؛ نظرًا لِما تتميز به من بلاغة واتساق، وتعزّزت مكانتها باعتبارها مرجعًا جاهزًا، بفضل نشر المعجم المفهرس الذي أعدَّه حنّا كاسيس (Hanna Kassis) سنة 1983م[29]، والذي يقوم على النصّ العربي، إلى جانب فهرس مرتّب وفق ترجمته (كما يقدّم المعجم أيضًا إحالات مرجعية دقيقة جدًّا اعتمادًا على معظم أنظمة عدّ الآي؛ نظرًا لأنّ ترجمة آربري لا تعتمد إلا على تقسيم فلوغل الذي أصبح مُلغى اليوم، ولا تُورد أرقام تلك الآي إلا على هيئة مقاطع تتكوّن من خمس آيات). ومع ذلك، صَيَّر ظهورُ الموارد الرقمية تلك الأعمال المطبوعة إلى حدّ ما زائدة عن الحاجة، كما أمسى عمل كاسيس نفسه متاحًا اليوم عبر الإنترنت. ويمكن اليوم تصفّح ترجمة آربري والبحث فيها بجانب النصّ العربي، بالإضافة إلى مقارنتها بترجمات أخرى في الآن ذاته. ومع ذلك، لا تتوفر بعض الترجمات الجديدة إلا في نسخ مطبوعة، ومن بينها ترجمات كلّ من عبد الحليم الصادرة سنة 2004م[30]، وماجد فخري سنة 2002م[31]، وطريف خالدي سنة 2008م[32]. وقد حظيتْ هذه الترجمات باهتمام ملحوظ وإشادة حارّة. وهذا لا يعني التقليل من أهمية الأعمال القديمة مثل ترجمة يوسف عليّ (خاصة في طبعتها الأصلية الصادرة ما بين سنة 1934 و1937م[33]، والتي اشتملت على جميع الحواشي التي تتميز بمنحى صوفي)، وكذلك ترجمة مارمادوك بيكثول (Marmaduke Pickthall) الصادرة سنة 1953م[34]. أمّا الترجمة الفرنسية لريجيس بلاشير (RégisBlachère) الصادرة سنة 1966م[35]، والترجمة الألمانية لرودي باريت (Rudi Paret) الصادرة سنة 1966م[36]، فتعدّانمن الجهود العلمية القديمة، إلا أنّ السنوات الأخيرة شهدتْ صدور العديد من الترجمات الحديثة بكلتا اللغتين. وعمومًا، ليس المقصود هنا انتقاء ترجمة واحدة ليعتمدها الباحث في عمله، وإنما الهدف هو مقاربة الترجمات بوصفها مصادر يمكن أن تساعد الباحث على إثراء بحثه.
وينطبق الأمر نفسه على المعاجم المخصّصة للقرآن. ورغم أنَّ عدد هذه الأعمال محدودٌ جدًّا مقارنة مع عدد الترجمات، إلا أنها تظلّ مصادرَ نفيسة. ومع ذلك، يجب أن نأخذ دومًا في الحسبان أن القاموس العربي الإنجليزي للقرآن هو في جوهره مجرّد شكل من أشكال الترجمة التي تقدّم في زَيٍّ مختلف. ورغم ذلك، توجد إمكانية أن يتضمّن قاموس مجموعةً كبيرة من المعاني المحتملة، وأن يشير كذلك إلى النقاشات العلمية، إلا أن المصادر الحديثة المتاحة اليوم لا تستوفي كلّ هذه الجوانب. فقد أصدر الباحث المجهول جون بنريس (John Penrice) عملًا أكثر ديمومة، تكرّر صداه عبر طبعات تكاد تندّ عن الحصر سنة 1873م[37]، والذي يعتمد في أساسه على تفسير البيضاوي (المتوفى حوالي سنة 691هـ= 1292م)؛ وهو كتابٌ مقتضبٌ، سهل المنال، غير أنه لا يخلو قطعًا من نفع وفائدة. وقد شهد مطلع القرن الحادي والعشرين موجة محدودة من الإصدارات التي أثْرَتْ بشكلٍ كبيرٍ المصادرَ المعجمية الخاصّة بدراسة القرآن. ويشمل ذلك العمل الموسوعي الذي أنجزه كلّ من عبد الحليم سعيد بدوي، ومحمد عبد الحليم الصادر سنة 2008م[38]، وكذلك عمل كلّ من آرن أمبروس (Arne Ambros)، وستيفان بروشاكا (Stephan Procházka)، الصادر سنة 2004م[39]، إلى جانب مجلد تكميلي أخير قدَّمَا فيه ترتيبًا موضوعيًّا للأسماء الواردة في القرآن سنة 2006م[40].
ويظلّ كتاب رودي باريت الصادر سنة 1971م من المصادر القيّمة التي تحتوي تأملات ورؤى علمية حول الآيات القرآنية[41]، وهو مجموعة من الحواشي المرتبة حسب الآيات. ولا ينبغي أن يكون ضعف الإلمام باللغة الألمانية حائلًا دون الاستفادة من هذا العمل؛ إِذْ يعدّ مصدرًا متفردًا بما يحتويه من مواد بيبليوغرافية، ومراجع إسنادية، وتفاسير (رغم تقادم بعض جوانيه). وتعدّ كذلك موسوعة القرآن التي حررتها ماكوليف (2000- 2006م)، التي أشرنا إليها آنفًا، قطعًا مرجعًا أكثر شمولية وحداثة من تفسير باريت، ومن ثم تعدّ الخيار الأول الذي يمكن الرجوع إليه للظّفر بنظرة عامة عن أيّ موضوع معيّن يحظى باهتمام علمي. ومع ذلك، بما أن الموسوعة مرتبة حسبَ الكلمات الإنجليزية المفتاحية، فإنّ جهود باريت تظلّ ذات أهمية وفائدة. وتوجد كذلك العديدُ من مشاريع الترجمة المفسَّرة قيد الإنجاز حاليًا، والتي يُرتقَب أن تترك آثارًا عميقة على الوضع الراهن.
فقد أمسَى النصّ العربي للقرآن متاحًا اليوم على نطاق واسع، سواء في شكل مطبوع أو رقمي. وتُوسَم النسخة السائدة المعتمدة اليوم باسم طبعة (القاهرة) أو الطبعة (الملكية) التي صدرت لأول مرة سنة 1923م؛ ونُشرت تحت رعاية الملك فؤاد الأول. كما توجد أيضًا نسخة سعودية حديثة منتشرة على نطاق واسع، لا تختلف عن سابقتها إلا في بعض التفاصيل الدقيقة. وقد وُجِّهت سهام النقد إلى نصّ طبعة القاهرة لكونه لم يُبْنَ على أُسس تاريخية صارمة؛ إِذْ لم تعتمد الطبعة إلا على الممارسة المعاصرة، ومصادر العصور الوسطى المتأخرة، بدلًا من المخطوطات والنصوص المبكرة المتيسّرة[42]. تتبع هذه النسخة قراءة القرآن برواية حفص عن عاصم، وهي الرواية السائدة في معظم أنحاء العالم الإسلامي؛ كما توجد أيضًا طبعات أخرى تعتمد على روايات مختلفة، منها رواية ورش، غير أنّ الفروق بين هذه الروايات ليست كبيرة. ونلاحظ أنّمن أبرز الاختلافاتِ السائدة بين النصوص المطبوعة للقرآن ما يتعلّق بعَدِّ الآي؛ إِذْ تتبّع بعض الطبعات الهندية للنصّ (مثل تلك الموجودة مع ترجمة يوسف عليّ الصادرة في الفترة ما بين 1934- 1937م) نظامًا مختلفًا في ترقيم الآي. وما تزال الطبعة الأوروبية للقرآن التي أنجزها فلوغل -رغم قِدَمِها- مفيدة إلى اليوم؛ فقد نُشِرَت لأول مرة سنة 1834م، ثم راجعها غوستاف ريدسلوب (Gustav Redslob) سنة 1837م، وصدرتْ مراجعتها الأخيرة سنة 1858م. وما تزال تحتفظ هذه الطبعة ببعض قيمتها، ويرجع ذلك جزئيًّا إلى سهولتها مقارنةً بنصّ القاهرة؛ لأنها تتجاهل بعض دقائق أحكام التلاوة، وتعتمد بشكلٍ عام على رسمٍ إملائي أقرب إلى العربية الفصحى المعيارية؛ غير أنّ نظام عدِّ الآي الخاصّ بها -الذي يتعارض مع أيّ تقليد إسلامي معتمد- خلق التباسًا مؤسفًا في الإحالة العلمية. ورغم أن هيمنة النصّ القاهري قد أزاحت في الزمن الحاضر معظم الإشكالات المتعلّقة بعدِّ الآي، إلا أن بعض الأعمال العلمية المنجزة في القرن العشرين كثيرًا ما تُورد إشارات نصّية لعدِّ الآي في كلّ من طبعتي القاهرة وفلوغل (أو تقتصر على طبعة فلوغل).
يعدّ كذلك المعجم المفهرس لعبد الباقي الصادر سنة 1945م مصدرًا أساسيًّا يساعد القارئ على استكشاف النص العربي، ومعرفة مواضع الألفاظ في القرآن. غير أن ظهور الموارد الإلكترونية قد حدَّ بدوره من الاعتماد العلمي على هذه النسخ المطبوعة. ومِن أفيد المواقع الإلكترونية في هذا السياق موقع ذِكْر (zekr.org/quran)، وهو مصدر ممتاز لنصّ القرآن نفسه، بالإضافة إلى القراءات والترجمات. وهناك مواقع أخرى مثل (qibla.appspot.com)، و(corpus.quran.com)، و(tanzil.net)،تتيح إمكانية البحث في النصّ العربي للقرآن بطرق متعددة ومتقدمة.
أمست المصادر الهائلة للتراث الإسلامي متاحة أيضًا للإفادة منها في دراسة نصّ القرآن نفسه، ودراستها في حدّ ذاتها بوصفها موضوعًا قائمًا بذاته، (وهو موضوع تناولته أدناه في الجزء الخاصّ بالتفسير الإسلامي للنصّ). ورغم أنّ كثيرًا من الباحثين يرغبون في فصل أعمالهم عن تأثير التراث التفسيري الإسلامي؛ سعيًا وراء فهم القرآن في سياقه الأصلي الذي نشأ فيه، إلا أن إمكان تحقيق هذا الفصل التام ما يزال محلّ نقاشٍ مثير في الأوساط العلمية. فقد امتزج التراث التفسيري الإسلامي امتزاجًا تامًّا بالتقاليد النحوية والمعجمية للغة العربية، حتى أثّرَ فيها تأثيرًا عميقًا؛ ومن ثم فإنّ كلّ من أراد الخوض في دراسة القرآن لا يسعه أن يتجنب الاعتماد -ولو جزئيًّا- على مواد مشبعة برؤى العقيدة والأسطورة الإسلامية المتأخرة[43]. ورغم إمكان فرز الإضافات اللاحقة الواضحة التي ظهرت تحت تأثير العقيدة الإسلامية، إلا أنّ القرآن ودراسته التراثية يشكّلان الأساس الذي انبثقت منه جميع أشكال الأدب العربي، إلى الحدّ الذي يجعل التحرّر التام من تأثير التراث التفسيري اللاحق أمرًا صعب المنال.
يعدّ كذلك الأدب التفسيري المعروف بالتفسير وعلوم القرآن مجالًا ممتدًّا؛ إِذْ يشمل مختلف جوانب التفاعل الإسلامي مع نصّ القرآن، سواء ما يتعلق باستنباط الأحكام الشرعية، أو تقديم المواد الوعظية والتربوية، أو تفصيل السِّمَات النصّية، ولا سيما تلك المتعلقة بأحكام التلاوة. فقد شكّل المشروع التفسيري محور الجهود التعليمية في العصور الوسطى، وتكوثرت مادّته مع مرور الزمن مع ظهور أولويات اجتماعية ودينية جديدة في العالم الإسلامي. ولا تخدش المصادر العلمية الحالية إلا سطحَ الكمّ الهائل من هذه المواد المتاحة. وما يزال العمل على إتاحة النصوص الأصلية يستنزف قدرًا كبيرًا من الجهود، ولا سيما من قِبَل باحثي العالم الإسلامي؛ وبفضل ذلك، أصبح الوصول الإلكتروني إلى أبرز وأشهر هذه النصوص متيسّرًا.
ثالثًا: مجالات البحث الرئيسة الحالية:
النص القرآني:
أضحى تاريخ تشَكُّل نصّ القرآن -بفعل الاهتمام الكبير الذي حظي به في الصحافة الشعبية على مدى العقد الماضي أو نحوه (بدءًا على الأقلّ في أمريكا الشمالية مع مقال ليستر سنة 1999م)[44]، ولا سيما ما يتّصل بنُسخ المخطوطات- جزءًا حيويًّا من التخصّص؛ ومع ذلك، يعدّ مجالًا دراسيًّا متخصصًا جدًّا يتطلب مهارات خاصّة في علم دراسة الخطوط القديمة، وعلم المخطوطات. وقد رافقت هذا المشروعَ الضخم-الموسوعة القرآنية- الذي يُجرَى تنفيذه حاليًا في جامعة برلين بقصد إعداد طبعة نقدية لنصّ القرآن، جهودٌ كبيرة لإصدار نسخ متاحة من مخطوطات القرآن المبكرة، يصبو هذا الجهد الكلي المبذول إلى تحقيق هدفين متكاملين:
يتمثّل أحد أهداف هذا المسعى النقدي للنصّ في توثيق الطريقة التي تفاعل بها المسلمون مع نصّ القرآن عبر التاريخ. وتكشف المخطوطات المبكّرة، مثل تلك التي درسها فرانسوا ديروش بشكل مستفيض سنة 2009م[45]، عن العناية الفائقة التي أَوْلَاها المسلمون على مدار عدد من القرون لحِفْظ النصوص القديمة والنفيسة للقرآن، مع الحرص على مواكبتها للمعايير السائدة في الكتابة والإنتاج في كلّ عصر. ويتجلّى إسهام ديروش الخاصّ بدراسة مخطوطات القرآن المبكّرة في دراسته المستفيضة عن رسم هذه النصوص؛ وهو مجال دراسي ينقّب عن الأدلة المتعلّقة بالتطوّر المبكّر للنصّ، وتاريخ رواية النصّ المكتوب. ويبدو من الناحية التاريخية أنّ بعض المخطوطات تعود إلى فترة تسبق استقرار عدّ آي السور، وتسبق أيضًا اعتماد مجموعات القراءات النصّية المختلفة ضمن حدودها الرسمية؛ ويقترح ديروش أنّ تاريخ نَسْخ إحدى أقدم هذه المخطوطات يعود إلى الربع الثالث من القرن السابع الميلادي. كما يزعم أنّ التناقضات الحاصلة بين النُّسَّاخ المختلفين (الذين يقدر عددهم بخمسة تقريبًا) الذين شاركوا في إنتاج تلك المخطوطة ترجع أساسًا إلى أنّ النسخة النموذجية التي نُسخت عنها كانت في حدّ ذاتها عسيرة الفهم والتفسير. وعمومًا، كانت هذه المخطوطاتُ المبكرةُ قيد الاستخدام بوضوح حتى القرن الثالث الهجري، وتكشف عن تصحيحاتٍ أدخلت عليها بغرض توفيق النصّ مع المعايير الكتابية التي استقرّت في تلك الفترة المتأخرة.
وإلى جانب المسائل المرتبطة بتفاصيل النصّ ودقائقه، يطرح ديروش في عمله الصادر سنة 2009م أسئلةً تاريخية تتعلّق بالتدوين المبكّر للقرآن بناء على أدلة المخطوطات[46]؛ وهذا كذلك مجالٌ يمكن أن تقدّم فيه الدراساتُ المعمّقة إسهامات جوهرية. يرى أن رواية جمع القرآن على يد الخليفة عثمان، ورواية نسخ مجموعة معتمدة من المصاحف وتوزيعها عبر الإمبراطورية الجديدة بأمرٍ منه لا يمكن أن تكون روايات دقيقة من الناحية التاريخية. ويدعي -بناء على أدوات الكتابة المتاحة في تلك الفترة- استحالة تحقيق هدف عثمان المنشود. ومع ذلك، من الواضح أنّ المخطوطات المبكّرة تتبع بنية موحدة، وأنّ المحتويات الكلية للنصّكانت مستقرة؛ أمّا الاختلافات الموجودة، فيمكن تفسيرها في ضوء تطوّر نظام الرسم العربي. والملاحظة الجوهرية هنا هي أنَّ توحيد جميع النُّسَخ مع النصّ النموذجي الذي حدّده المجتمع، كان عملية مستمرة استغرقت عدّة قرون. وما يزال هذا التاريخ الشاملللرواية المكتوبة للنصّ القرآني يكتب عنه الباحثون، ومن بين الإسهامات المهمّة في هذا المسار، عمل كايت سمول (Keith Small) الصادر سنة 2011م[47]، الذي يقدّم نموذجًا يُحتذى به في الدراسات المستقبلية، وذلك من خلال فَحْص الرسم والقضايا النصِّية ذات الصِّلَة لجزء معيّن من القرآن بالرجوع إلى مجموعة واسعة من المخطوطات المبكّرة؛ وتندرج ضمن هذا الاتجاه أيضًا أعمال ياسين داتون (Yasin Dutton) التي تكشف عن قيمة نتائج الفحص الدقيق للمخطوطات الفردية[48][49].
يُعَدّ الهدف الثاني للدراسات النقدية النصِّية للقرآن مكمّلًا، وإن كان منفصلًا عنه، لهذا النوع من القراءة التاريخية: ويتمثّل في تحديد الكيفية التي تلقَّى بها الجمهور الأول نصَّ القرآن، وهو الدافع الكامن وراء بعض المقاربات الرامية إلى إعداد نصّ نقدي قائم على مصادر المخطوطات. لكن لا يشترط في هذا النصّ النقدي أن ينطلق من فرضية وجود نصّ واحد أصلي، بل يمكن -كما في مشروع كوربوس كورانيكوم- أن يوثّق حجم التباين الذي تكشفه المصادر النصّية. وهذا يجعل مجال الدراسة بأكمله مثيرًا للجدل الشديد وبعيدًا عن الوضوح. وتجدر الإشارة إلى أنّ الباحثين محظوظون؛ لأنهم يواجهون سياقًا لنصّ القرآن مختلفًا تمامًا، وأقلّ تعقيدًا من نصّ الكتاب المقدّس، وإن لم يكن أقلّ إشكالية من الناحية الدينية إلا بدرجة يسيرة. ويكفي الباحث أن يتأمّل في النصّ العبري وعلاقته بترجماته -على رأسها اليونانية، وكذلك التراجم الآرامية، فضلًا عن الترجمات اللاتينية والقبطية والسريانية- ليدرك أن التجسيد الراسخ للقرآن في اللغة العربية وحدها يمثّل ميزة متفردة.
يعدّ تاريخ النقد النصِّي الكتابي أكثر تعقيدًا وإثارة للإشكال من نظيره القرآني. فقد نشأ هذا النقد النصِّي بوصفه نشاطًا تأمليًّا في القرن السادس عشر، وكان معتمدًا على المهارات اللغوية السائدة في تلك الحقبة في العبرية واليونانية، وتطوّر الكنيسة، وبروز الفكر الإنساني، وظهور الطباعة. فقد كانت حركة الإصلاح الديني عاملًا حاسمًا في نشوء فكرة إصدار (الطبعة النقدية) للنصّ، وإن لم يكن من الضروري اعتبارها المحرك الأول لهذا المسار: فإذا كان الكتاب المقدس يعدّ(المصدر الوحيد) لدى البروتستانتية، فإنّ التيقن من مصداقيته كان أمرًا بالغ الأهمية؛ غير أنّ الدافع الأساسي لإعداد نصّ نقدي كان نابعًا من التأويل، والذي تضمّن دعوى لاهوتية تقول بوجود (نصّ أصلي)، وهي دعوى قادت في نهاية المطاف إلى تركيز متزايد على النصّ في حدّ ذاته.
اغترفت الجهودُ الحديثة الرامية إلى إصدار طبعة نقدية لنصّ القرآن من مَعِين تجربة إعداد طبعة نقدية لنصّ الكتاب المقدّس؛ إِذْ بات من الممكن أن تسترشد مثل هذه الجهود العلمية بأسسٍ منهجيةٍ مناسبة تَحُول دون الوقوع في المزالق التي عرفتها الدراساتُ الكتابية في العصور السابقة. والأهمّ من ذلك، من الواضح أنّ نظرياتِ النصوص والعلاقاتِ القائمة بينها يجب أن تنبثقَ من معطياتِ المخطوطات نفسِها، لا أن تفرض نظريات نسبية على النصوص. كما أنّ التوثيقَ يجب أَنْ يتقدّم على التفسير. فلا تهدفُ الطبعة النقدية للنصّ إلى انتقاءِ الأدلة أو توجيهِ النتائج، بل تقوم على الحياد. ولا ينبغي أن تحركها أيّة دوافع تفسيرية، أو أدلة جزئية تهدف إلى تعديل النصّ أو تصويبه.
يتعيّن أن تكون شمولية المعطيات هدفًا جوهريًّا في أيّ مشروع نقدي نصِّي. وهذا يتطلّب تعريفًا دقيقًا لمفهوم الدليل النصّي، وتحديد النصّ المرجعي المعتمد للطبعة، واعتماد نظام اختصارات دقيق يتيح تقديم أكبر قدر ممكن من المعلومات لكلّ قارئ. ويجب أن يحول هدفُ هذا العمل التأسيسي الدقيق دون قفز الباحثين إلى نتائج متسرّعة قبل الإحاطة التامة بجميع الأدلة النصّية. وقد نلاحظ، فيما يتعلق بهذه المسألة، أنّ كثيرًا من التصحيحات النصّية العلمية المقترحة للقرآن ما تزال تميل إلى اعتماد معيار عشوائي في (تفسير) الأخطاء[50]؛ وهذا منهج قديم في النقد النصِّي، تحركه قراءة تفسيرية تنطلق من الفرضية الآتية: (نلاحظ إشكالًا، ونعتقد أننا نملك الحلّ)، ثم تقترح الكيفية التي نشأ بها هذا الإشكال. وتعدّ هذه الفرضية قلبًا لمنهج النقد النصِّي على رأسه؛ إِذْ تفترض الحلّ قبل التحقّق من وجود الإشكال.
ومع ذلك، توجد حتمًا قضايَا أخرى مثيرة للجدل في مشروع النقد النصِّي المتعلّق بالقرآن. ويعدّ كتابمحمد مصطفى الأعظمي الصادر سنة 2003م عملًا طموحًا ومثمرًا[51]، إلا أنه يتسم في نهاية المطافِ بطابعٍ جداليٍّ حادٍّ يعكس المخاطر الناتجة عن مجرّد التفكير في إعداد نصّ نقدي للقرآن. يدّعي الأعظمي أنّ (المستشرقين) يسعون إلى إسقاط النماذج التشكيكية المطبقة على العهدَيْن الجديد والقديم على القرآن؛ إِذْ يرى -بعد تفكيك الكتب المقدّسة اليهودية والمسيحية- أنَّ ثمة دافعًا مماثلًا يستهدف القرآن، ويمكن اعتبار ذلك جزءًا من تصاعد الهجمات العلمانية على جميع الأديان. ويراهن الأعظمي على أنّ المبتغى من وراء ذلك كله هو الهدم الشامل لله والتاريخ والدِّين. ولذلك يزداد حِرْصه على الدفاع عن سلامة القرآن ونزاهته عندما ينظر إلى الدمار الذي خلّفه الهجوم على الكتاب المقدس.
وهذا تذكيرٌ مفيدٌ بالسياق الذي يجب أن يُجْرَى فيه الاشتغالُ على التوثيق النقدي للنصّ. ويجب أن تلتزمَ هذه العملية بأدقّ التفاصيل، وأن توجّه بشكلٍ واضحٍ وصريحٍ نحو السياق التاريخي، وأن تعرض معطياتها استنادًا إلى الأدلة؛ فالانتباه الدقيق إلى الأعمال السابقة الخالية من النظريات المسبقة يعدّ أمرًا جوهريًّا. إنَّ إعداد طبعة نقدية للقرآن، بغضّ النظر عن الخطة المعدَّة لإنجازها، يجب أن يمنحَ الباحثين فرصة الاطلاع الشامل على جميع أدلة المخطوطات المتاحة في مختلف أنحاء العالم. ويُقدِّمُ عملُ كايت سمول الصادر سنة 2011م مرّة أخرى مرجعًا ونموذجًا لهذا النوع من الدراسة؛ كما تُظهر دراسة كلّ من بهنام صادقي (Behnam Sadeghi)، وأوي بيرجمان (UweBergmann) الصادرة سنة 2010م، إمكانات الدراسات المعمقة[52]، التي تستعين بالتراث الإسلامي اللاحق المتعلق برواية النُّسَخ المختلفة للقرآن.
محتوى القرآن وخلفيته:
أثار سؤال الخلفية المتعلقة بالمحتوى النصِّي للقرآن موجةً من الاهتمام البحثي الكبير في هذا المجال، ويرجع السبب في ذلك إلى الاهتمام الإعلامي الذي حظي به القرآن في السنوات الأخيرة؛فقد اتجهَت الدراسات المعاصرة بشكلٍ متزايد نحو إخراج أصول القرآن من الصورة النمطية التي تقدِّمه معزولًا في واحات شبه الجزيرة العربية، ووضعه ضمن السياق الحيوي للثقافة الدينية في العصور القديمة المتأخرة، ولا سيما المسيحية السريانية. ورغم أن طرق انتقال هذه التأثيراتضمن هذا السياق تظلّ غير محدّدة بدقة (وربما غير قابلة للتحديد إطلاقًا) -هل كانت عبر التجارة، أو الترحال، أو عبر المجتمعات المسيحية العربية، أو أنّ الإسلام نشأ في مناطق خارج تلك التي جرت العادة على اعتبارها موطن نشأته؟[53]- إلا أنّ الجهود المبذولة الرامية إلى تتبُّع الأواصر اللغوية والموضوعية والتعبُّدية بين القرآن والدِّين الممارَس في القرن السادس الميلادي بدأت تؤتي ثمارًا مهمّة.
يجب أن نفهم المقاربة المعاصرة لهذه الأسئلة بأنها مختلفة جذريًّا عن بعض مقاربات القرن التاسع عشر التي كانت تقتصر على المقارنة السردية بين الكتاب المقدّس والقرآن. فقد أخضعت بعضُالدراسات الدقيقة -مثل دراسة شباير الصادرة سنة 1961م (التي نُشرت في الأصل حوالي سنة 1931م)- مجموعةًواسعة من نصوص الأدب اليهودي للمقارنة، وأقرّت بأنَّ التقليد الشفوي الحي لا يقل أهمية عن التقليد النصِّي المكتوب -بل قد يفوقه- في تشكيل خلفية القرآن. ورغم إجراء بعض المحاولات الأوّلية للنظر في المصادر السريانية، إلا أنّكثيرًا منها كان مشوبًا بدافع جدالي (وهي ظاهرة لم تختفِ تمامًا من بعض الأعمال الهامشية المعاصرة)، والتي ارتأت أنّ الإسلام يفتقر إلى تصوّر ديني أصلي[54]. ومع ذلك، كان هذا هو المجال الذي أحرزت فيه الدراسات الحديثة بعض التقدُّم ليس في تتبُّع أوجه التشابه السردية فقط، بل في رصد أوجه التشابه كذلك التعبدية والشّعرية والمجازية واللغوية مع المسيحية السريانية[55]. كما ذكرنا آنفًا، فإنّ الوسائل التي أُجرِي بها هذا النقل، وكذلك الموقع الجغرافي الذي وقع فيه، تظلّ غامضة تمامًا، ويبدو أحيانًا أن القرآن يستخدم مزيجًا غريبًا من المصادر يصعب إرجاعه إلى أصل واحد. علاوة على ذلك، لم تتضح بعدُقابلية تفسير النصّ القرآني كلّه من خلال تتبُّع النصوص المتشابهة في سياق العصر القديم المتأخر؛ ومن المحتمل أن يكون هناك حيِّز كبير للأساطير العربية والمواد الأصلية التي يجب أخذها بعين الاعتبار في هذا المزيج.
لقد حظيت الرسالةُ الدينية للقرآن واللغة التي صِيغت بها باهتمام كبير -بصرف النظر عن الأسئلة المتعلقة بخلفيته- وما يزال هذا المجال نابضًا بالحياة في الأوساط الأكاديمية. وما تزال كذلك البنية الشِّعْرية واللغوية للنصّ، وكيفية توظيفها في إيصال رسالته بأسلوب قويّ وفعّال تأسر اهتمام الباحثين. فقد ظلَّ الاهتمامُ بالعناصر اللغوية والبنيوية المميزة للنصّ، بدءًا من العمل الكلاسيكي لنولدكه[56]، مجالًا خصبًا لتجريب مناهج بحثية متعدّدة. فقد قدّمَت كلٌّ من أنجيليكا نويفرت[57]، وميشيل كويبرس[58]، وسلوى العوا[59]، نماذج لمقاربات مختلفة لتحليل بنية النصّ. كما تقدِّم كثير من المقالات الواردة في العمل الذي حرّرهعيسى بولاتا رُؤًى ثاقبة عن هذه القضايا أيضًا[60]،في حين يعدّعمل كلّ منتوماس هوفمان[61]، وميكائيل زفيتلر[62]، مفيدًا كذلك في فهم علاقة النصّ بالشِّعْر.
يمكن تحديد موضوعات القرآن بطرق مختلفة، غير أنّ الموضوعات الرئيسة تدور حول وعي النصّ بأنه كتاب مقدّس، وعلاقة الله بخلقه، ورسله (لا سيما في ضوء ما ورد في الكتاب المقدّس)، إلى جانب الشريعة، ويوم الحساب. ويساعد النظر إلى القرآن في ضوء موضوعاته الكلية على إضفاء قدر من الوحدة على النصّ، ويشكّل وسيلة مناسبة لتكوين نظرة عامة أولية، وإطار تمهيدي قبل الشروع في قراءته[63]. يعرض القرآن نفسه بوصفه (كتابًا)، غير أنَّ تحديد معنى هذا الوصف بدقة، وكيفية فهمه، كانَا مدار تفكير عميق ونقاش مستفيض[64]. ويرجع أصل بعض هذه الأفكار ذات الصِّلَة إلى السياق العام لثقافات الشرق الأدنى القديم[65]، ويرتبط هذا المفهوم برمّته ارتباطًا وثيقًا بفهم الوحي والتجربة النبوية[66].ويمكن القول: إنّ الموضوع المحوري في القرآن هو الله؛فقد استأثر تحديد طبيعة تفاعل الله مع العالم المخلوق وفهمه باهتمام المسلمين عبر القرون، وما يزال هذا الاهتمام مستمرًّا في الأوساط الأكاديمية الحديثة[67]؛فقد حمل الأنبياء رسالة الله إلى البشر. وبما أنّمعظم الأنبياء الوارد ذِكْرهم في القرآن مألوفين من التراث الكتابي، فإنّهذا المجال يثير تلقائيًّا أسئلة تتعلّق بخلفية النصّ؛فقد ركّزت الدراسات السابقة على هذه الجوانب من منظور يهودي[68] أو مسيحي[69]، غير أنّ المقاربات الحديثة -التي تتسم بقدر أقلّ من الاختزالية- أضحت سائدة اليوم، رغم أن جميعها ما تزال تشتغل في ضوء الدراسات القديمة[70]. فالأنبياء يحملون رسالة الله إلى الناس، وهي رسالة تهدف إلى تعليمهم طريقة العيش وفق إرادته، وتميل الدراسات الحديثة إلى تناول مواضيع تحظى باهتمام معاصر؛ مثل الموضوعات المتعلقة بمكانة المرأة[71]، والمسائل الأخلاقية[72]،وتحديد مصير الإنسان الأخروي -ما بين الجنة والنار-بحسب أعماله التي أنجزها وفق ما تقتضيه أحكام الشريعة[73]. تسهم، كما أشرنا من قبل، هذه الدراسات التي تتناول موضوعات القرآن في تعزيز الفهم الكلي للنصّ من حيث وحدته و(ربما) تطوّره التاريخي الداخلي؛ كما ترتبط أيضًا بفهم التطورات اللاهوتية، والصوفية، والفقهية اللاحقة في الإسلام بالطريقة التي فَهمت بها هذه التخصصاتُ القرآن. ومع ذلك، ما تزال كثير من المواضيع بحاجة إلى تفسير علمي دقيق.
التفسير الإسلامي للنصّ:
رغم أنّ دراساتِ التفسير لم تنشأ بوصفها عنصرًا مميزًا من الاهتمام البحثي إلا في السنوات الأربعين الماضية أو نحو ذلك، إلا أنها حازت قدرًا كبيرًا من الاهتمام داخل المجتمع العلمي. فلم تكن دراسة هذه المادة التفسيرية في الأجيال السابقة تخلو عادةً من دوافع خفية بشكل أو بآخر. وكانت إحدى أهداف دراسة التفسير هي مساعدة الباحثين على إتقان النحو العربي، وهو هدفٌ كان يرتكز في الأصل على تعزيز الدراسة التاريخية للكتاب المقدّس؛ نظرًا للتقارب اللغوي بين العربية والعبرية، ونظرًا لاعتقاد يرى أنّ بعضَ العرب حافظوا على نمط حياة بدوي، الذي تمتد جذوره إلى أصول ساميّة عميقة، قد يضيء جوانب من حياة الآباء المؤسّسين المذكورين في الكتاب المقدّس.
ومن الأهداف المبكّرة الأخرى لدراسة التفسير: بيانُ معاني نصوص القرآن، وتوثيقُ القراءات المختلفة (والتي غالبًا ما تُضمَّن في المؤلَّفات التفسيرية)، إضافة إلى توجيه النقد إلى الطريقة التي يُفترض أنّ المسلمين قد لووا بها أعناق نصّ القرآن لتحقيق أغراضهم الخاصة في مرحلة ما بعد الوحي. فلم تكن مثل هذه المقاربات تُعنَى بنوع الأدب بوصفه جنسًا أدبيًّا قائمًا بذاته، بل كانت تركّز على محتوياته. ومع ذلك، برز في العقود الأخيرة اهتمام بفهم الاتجاهات الفكرية والتربوية في العصور الوسطى (والحديثة) خارج حدود تخصّص علم الكلام (الذي يتميز بنزعته الفلسفية والكتابية)، وخارج نطاق الأبعاد العملية للفقه. وقد وجد هذا الاهتمامُ ضالّتَهُ المُثلى في دراسة التفسير.
يُمثل عملُ غولدتسيهر المنجز في مطلع القرن العشرين -الذي تُرجِم إلى الإنجليزية سنة 2006م- نقطة انطلاق الدراسة الأكاديمية للتفسير بوصفها مشروعًا علميًّا مستقلًّا. ورغم أنّ عمله يعدّ قطعًا عملًا تأسيسيًّا، إلا أنّ محدوديته تبدو واضحة، وترجع في الأساس إلى قلة المصادر التي كانت متاحة في زمنه. ورغم أنّ عددًا من الباحثين الآخرين قد درسوا بالتأكيد المادة التفسيرية في السنوات الفاصلة بين غولدتسيهر ووانسبرو، ونشروا طبعات لبعض التفاسير الأساسية، إلا أنّ التحليل الجادّ للتفسير لم يبدأ فعليًّا إلا بعد صدور عمل وانسبرو[74]. ومع ذلك، اقتصر نطاقُ الدراسة حينَها على التفاسير التي تعود إلى القرون الأربعة الأُولى. والجدير بالذِّكْر أنّ غالبية الأعمال التي اعتمدها وانسبرو لم تكن متاحة في ذلك الوقت إلا في صورة مخطوطات، أمّا اليوم فقد حُقّقت ونُشرت معظم تلك المصادر التي اعتمد عليها، وهو ما يعكس الاهتمام المتزايد، لا سيما في العالم العربي، بتجديد التراث الثقافي الإسلامي وإحيائه وتقديره، ناهيك عن ظهور اهتمام علمي متزايد بنصوص هذه الأعمال التفسيرية.
يجب أن لا تُغنِيَنَا بطبيعة الحال المعرفةُ المتعلّقة بالدراسات العلمية الحديثة عن الدراسة المباشرة للنصوص التفسيرية الأصلية ذاتِها؛ إِذْ يعدّ تعلُّم قراءة نصّ تفسيري فنًّا في حدّ ذاته. أمّا الإلمام الجيّد باللغة العربية فلا يعدو أن يكون نقطة البداية؛ لأنّ القواعد النحوية تعدّ الأداة الفنية الأساسية التي يعتمد عليها المفسّرون عادة في مناقشة المعاني المتعدّدة والمختلفة للنصّ. كما يستحضر التفسير في نقاشاته سياقات أسطورية، ولاهوتية، وفقهية، وفلسفية، وأحيانًا سياقات ثقافية وعلمية. علاوة على ذلك، يتطلبُالأسلوبُ الذي كُتبت به التفاسير في التراث الإسلامي اهتمامًا دقيقًا؛ لأنه رغم عدم اختلاف العناصر الأساسية بشكلٍ كبيرٍ من نصّ إلى آخر، إلا أنَّ ثمة اختلافًا ملحوظًا بين المفسِّرين في طريقة عرض المادة. وقد يجد المبتدئ عونًا في عمَلَيْ دفيس مارجليوث (Davis Margoliouth) (1894م)[75]، وألفرد بيستون (Alfred Beeston) (1963م)، اللذَيْن ترجمَا لطلبتهما تواليًا تفسير سورتي آل عمران ويوسف من تفسير البيضاوي،وهي أعمال تهدف إلى تقوية مهاراتهم في اللغة العربية، والاستئناس بأسلوب التفسير. يشير بيستون في عمله إلى أنّ:
«الطالب الأوروبي يواجه صعوبات بالغة في مقاربته الأولى لهذا النوع من الأدب التفسيري؛ إِذْ يتميز التفسير بأسلوب خاصّ تطوّر عبر الزمن، يتّسم بإيجاز مكثف، وحابل بالمصطلحات التقنية، والتعبيرات المختصرة التلميحية. ومتى ما أتقن القارئ الخصائص الأسلوبية لهذا النوع من الأدب التفسيري، فلن يجد صعوبة في الاستفادة من أيّ عمل من أعمال التفسير الكلاسيكية (ولعلّ هذا ما يفسِّر غياب أيّ ترجمة كاملة لعمل تفسيري إلى لغة أوروبية حتى الآن)؛ غير أنّ الصعوبة الحقيقية تكمن في الخطوة الأولى، وهي إتقان الأسلوب والمنهجية»[76].
فقد عبّر بيستون عن التحدِّي الجوهري الذي يصادفه القارئ الغربي في هذا النصّ الصريح بقوله: «هذا العمل موجَّه لأولئك الذين يمتلكون ناصية اللغة العربية بدرجة كافية تمكّنهم من قراءة نصّ عربي عادي، ولديهم إلمام بالمبادئ الأساسية للنحو العربي، ومصطلحاته التقنية»[77].
كما أشرنا أعلاه، تدلّ خصائص جنس التفسير -الذي يركّز على النحو، وعلى أسلوب بالغ الإيجاز والإيحاء- على وجوب إتقان اللغة العربية لفهم نصوصه. غير أن هذه الخصائص تقترح في الآن ذاته تعريفًا لجنس التفسير من حيث أسلوبه وأدواته التأويلية، وتكشف كذلك عن الطابع النخبوي للجمهور المتعلّم الذي خاطبته أمهات التفاسير في العصور الوسطى.
فالتفسير هو حصيلة نظام مدرسي، وثمرة مشروع تعليمي واسع يجمع بين مجموعة واسعة من العلوم الإسلامية؛ ومن ثم يعدّ التفسير بهذه الطريقة عصارة علمية، ومنصة لاستعراض كفاءة المفسِّر، ووسيلة لاستقطاب الطلاب، واكتساب المكانة والسلطة العلمية داخل المجتمع، وبثّ وجهة نظره حول الإسلام والعالم. وتمثّل هذه الأهداف المتعدّدة -بطبيعة الحال- تحديًا آخر لدراسة هذه المادة التفسيرية.
ويمكن أن تقدّم بعضُ التفاسير المترجمة مداخلَ وتوجيهات مفيدة لهذا الحقل. فعلى سبيل المثال، ترجم كوبر (Cooper) سنة 1987 أجزاء من التفسير الكلاسيكي المبكّر للطبري (ت: 310هـ= 923م)، رغم أن الطابع التقني المتخصّص للعمل الأصلي استلزم أحيانًا حذف بعض المقاطع من الترجمة؛ نظرًا لكونها إمّا مقاطع هامشية لا تمسّ الموضوع الجوهري، أو خاوية من المعنى عند نقلها إلى الإنجليزية. ولذلك يجب أن تكون -بطبيعة الحال- قراءة أيّ عمل مترجم مصحوبة بالنصّ العربي.
ويمكن العثورُ على الأعمال التفسيرية الأصلية في كثير من المكتبات، وهي متاحة للشراء بسهولة من المكتبات الإسلامية في أوروبا وأمريكا الشمالية والشرق الأوسط، سواء بصيغ مطبوعة أو رقمية؛ كما أن الكثير منها متاح مجانًا على الإنترنت. وتتفاوت جودة طبعات هذه النصوص بشكلٍ ملحوظ، ولسوء الحظ، لم يتبلور حتى الآن أيّ إجماع بشأن الإصدارات المعتمدة في النقاشات العلمية.
يفتح التمكن من هذه المادة التفسيرية آفاقًا واسعة للدراسة والبحث. ومن التصوّرات المغلوطة الشائعة بين عامة الناس عن الإسلام -والتي ينفق الباحثون قدرًا كبيرًا من وقتهم لدحضها من خلال تقديم معطيات دقيقة عنها- تلك المتعلقة بالطبيعة الموحدة المتراصة المفترضة للدِّين نفسه؛ إِذْ تعدّ الفكرة القائلة بوجود إسلام واحد يعتز به كلّ المسلمين فكرة شائعة ومنتشرة على نطاق واسع. ويكمن وراء هذه الفكرة أيضًا موقف تجاه القرآن يعكس رؤية بروتستانتية: وهي أن القرآن، بفعل مكانته العميقة في نفوس المسلمين، يمثل دستورًا شاملًا لجميع تصرفات المسلمين، ولا يمكن للمؤمنِ الحقِّ الإفلاتُ من التزاماته. ويستند مثل هذا الموقف إلى فكرة العلاقة الفردانية بالقرآن، التي ترى أن الإيمان الديني نابع من قراءة المرء الخاصّة للنصّ، وهي فكرة تبدو لا محالة -من منظور خارجي- أنها مقيّدة بمعنى حرفي للنصّ. ويتعارض هذا الفهم التبسيطي للعلاقة التي تجمع بين المسلم والقرآن بوضوح مع الأدلة التي يقدّمها لنا تاريخ تفسير القرآن كما هو مبثوث في مصادر التفسير الضخمة والعلوم المرتبطة به. ومع ذلك، رغم الأهمية البالغة لهذا التراث، إلا أن معرفتنا بالأبعاد الكاملة لمادته تظلّ محدودة، وما يزال معظمه غير مطروق حتى داخل الدوائر العلمية.
كما أشرنا أعلاه، تُعَدّ دراساتُ التفسير بوصفها تخصصًا فرعيًّا ضمن دراسة الإسلام دراسة جديدة نسبيًّا، إِذْ لم تظهر إلا في العقود الأربعة الماضية. ومع ذلك، فقد أُثيرت مؤخرًا بعض الأسئلة بشأن الإهمال الواضح لقراءة نصّ القرآن ذاته في سياقه التاريخي الأوسع خلال هذه المرحلة النشطة من تطوّر دراسات التفسير[78]؛ وقد فُسّر هذا الإهمال بأنه نتيجة لتردّد تأويلي معيّن حول كيفية التعامل مع الإشكالات التاريخية واللاهوتية التي يثيرها القرآن نفسه. ومع ذلك، استطاعتْ دراساتُ التفسير أن ترسّخ قدمها بقوّة كافية، حتى صارت منارة تضيء دروب المؤتمرات المتواصلة، وسلاسل الكتب العلمية. تنتهج دراسات التفسير عدّة مقاربات لدراسة الموضوع، إلا أن أنجح المبادرات وأكثرها تأثيرًا في السنوات الأخيرة كانت الكتب والمقالات المخصّصة للمفسِّرين الأفراد وأعمالهم، ووضع النصوص التفسيرية في سياق المناخ الفكري والاجتماعي لعصر المؤلِّف. ويمتد هذا الاهتمام من العصور المبكّرة[79] إلى العصر الحديث[80]. وقد أثارت كثيرٌ من الدراسات التركيبية التي تُعنى بتحديد ووصف المقاربات التأويلية عبر القرون -انطلاقًا من تقييم المقاربة الأدبية لسيد قطب (ت: 1956م)[81] إلى الدراسات التي تتناول مسألة العلاقة بين القواعد التفسيرية اليهودية ونظيراتها الإسلامية[82]- مزيدًا من الاهتمام. ومع ذلك، يظلّ تحليل التعريفات، والمنظورات، والاتجاهات، والسياقات الخاصة بجنس التفسير؛ مَهمة عِلمية لم تُطرق من قبل على نطاق واسع.
يفتقر المجالُ حاليًا إلى عدد من العناصر التأسيسية المهمّة، ومنها غياب فهم واضح للأبعاد المنهجية والنحوية والجغرافية والفقهية والكلامية (بما في ذلك الأبعاد التي ترتبط بالعلاقة بين الأديان)، وكذلك المسارات التاريخية لهذا الجنس من التأليف: وهو ما يمكن تسميته بـ(الصورة الكلية) للتفسير. وهذا يفتح الباب أمام كثير من مجالات البحث الجديدة. فعلى سبيل المثال، كيف نفسِّر هذا التزايد الملحوظ في مؤلّفات التفسير في القرون المتأخّرة، والتي لطالما نُعتت بأنها عصر جمود فكري؟ علاوة على ذلك، ما الاتجاهات الإقليمية التي يمكن رصدها في نسيج تطور التفسير عبر الأمصار؟ لقد لفت كلٌّ من كلود جيليو سنة 1999م، ووليد صالح سنة 2006م، الانتباهَ إلى مدرسة نيسابور خلال العصور الكلاسيكية[83]، غير أنَّ ثمة مناطق جغرافية أخرى ذات خصائص متفرّدة، وازدهارات تاريخية تستحقّ كذلك المزيد من الاهتمام. ثم ما الاتجاهات التي يمكن رصدها في انتماءات المدارس الكلامية والفقهية للمفسِّرين الأفراد؟ وإلى أيّ مدى أثَّرت التفاعلات الإسلامية مع اليهود والمسيحيين على بنية هذا الفنّ ومضمونه[84]؟ وما وجهات النظر التأويلية التي تجسّدت في أعمالهم؟ يكتسب هذا الجانب أهمية خاصّة عند محاولة تقييم أثر ابن تيمية (ت: 728هـ= 1327م)، وتلميذه ابن كثير (ت: 774هـ= 1373م): هل أحدث هذان العالمان حقًّا تحولًا نوعيًّا في مسيرة هذا التخصص[85]؟ وإلى أيّ حدّ احتفظت نصوص التفسير التي جاءت بعد ابن تيمية بالمناهج السابقة التي تعتمد على النحو (والعقل) في عملية التفسير أم تنكّبَت عن السبيل؟ وما مدى دقّة تقسيمنا الزمني الحالي لتاريخ هذا النوع؟ وما دور الحاشية والمختصر؟ وما سبب كتابة مثل هذه الأعمال؟ وكيف أضحت تفاسير الزمخشري (ت: 538هـ= 1144م)، والبيضاوي، والسيوطي (ت: 911هـ= 1505م)، أبرز أهداف الشروح والحواشي؟ علاوة على ذلك، رغم أننا نلاحظ أن العصر الحديث قد ابتعد في الغالب عن الإخلاص التام للشكل الكلاسيكي للتفسير، إلا أنّ الحاجة إلى تقييم دقيق لتبين مدى صحة هذا التعميم، ومدى تأثير هذا التحول ما تزال ملحّة؛ فقد أحرزت بينك سنة 2011م خطوات مهمّة في تحليل السياق الحديث للتفسير، إلا أنّ ثمة بالتأكيد حاجة ماسّة كذلك إلى إنجاز أعمال أخرى من أجلِ فهمِ الفترة الحديثة فهمًا أوسع في ضوء الإنجازات الكلاسيكية.
ومن الأمثلة الأخرى على الإشكالات المطروحة في دراسة التفسير ما يتعلق بالمنعطفات التاريخية التي مَرَّ بها هذا الفنّ. تنطلق هذه التأمّلات من مقالة كالدر الصادرة سنة 1993م، وهي مقالة تأسيسية تقترح إطارًا لتحليل التفسير الكلاسيكي، يركز فيها، بناءً على عمل وانسبرو الصادر سنة 2004م، على شكلِ النصوص وتقنياتها بدلًا من محتوياتها. يرى كالدر أنّ التفسيرَ عملية وتمظهر في جنس أدبي يهدف إلى تقييم نصّ القرآن في ضوء الممارسات اللغوية العربية، مثل الرسم والمفردات والنحو والبلاغة والرمز أو المجاز؛ ويهدف كذلك إلى وضع النصّ ضمن إطار البنى الأيديولوجية للمجتمع الإسلامي، من قبيل التاريخ النبوي، وعلم الكلام، وعلم الآخرة، والفقه، والتصوّف. ولا تعكس الموازنة بين كلّ هذه العناصر إلا مهارة المؤلِّف وبراعته الفنية. وتنبثق من عمل كالدر كذلك فكرة أساسية مفادها أنّ اعتماد مقاربة تحدّد نوع التفسير من خلال مناهجه -أي تلك التي تدرك التفاوت في الأهمية التي يوليها مختلف المفسِّرين للبنى الأدواتية والأيديولوجية- من شأنه أن يمكننا من تمييز أوجه الاختلاف والتشابه داخل هذا النوع التفسيري بأكمله. فعلى سبيل المثال، بدلًا من فصل التفسير المعتزلي بناء على معايير (حدسية) أو مضمونية أو تراثية/ سيرية (كما ناقش ذلك لين (Lane)في عمله الصادر سنة 2006م)، فإنّ تحليل التفسير بوصفه جنسًا أدبيًّا/ معرفيًّا يمكن أن يقدِّم تمثيلًا أدقّ لطبيعة هذا التخصّص المدرسي من خلال الاهتمام ببناه ومناهجه المتأصلة فيه.
خاتمة: مستقبل الدراسات القرآنية:
تُعَدّ الدراسات القرآنية مجالًا دراسيًّا واسعًا ونشطًا جدًّا ضمن دراسة الإسلام. ورغم أن هذا المجال لم يخلُ من الجدل، إلا أنّ الأبحاث أحرَزَتْ تقدّمًا كبيرًا في العقود الأخيرة من خلال توفير الأدوات اللازمة للعمل المتقدّم، وإتاحة المخطوطات والنصوص الكلاسيكية للاستخدام العلمي، بالإضافة إلى رسوخ مكانته الأكاديمية عبر تنظيم مؤتمرات دورية، وسلاسل كتب، ومجلات. ورغم جسامة التحديات التي يواجهها هذا المجال، إلا أن المكاسب العظيمة التي يجنيها الباحثون من المشاركة في مجتمع علمي نابض بالحياة وحابل بالجدل البناء تفوق كلّ عقبة.
[1] عنوان المقالة باللغة الإنجليزية: Qurʾānic Studies، وقد نُشِرت في The Bloomsbury Companion to Islamic Studies، الصادر سنة 2013، وجدير بالذكر أننا أضفنا إلى العنوان كلمة "الغربية" لتكون قيدًا معبِّرًا عن مساحة اشتغال المقالة، كذلك أضفنا "مسارات وآفاق" ليصبح العنوان أكثر تعبيرًا عن اشتغال المقالة. (قسم الترجمات).
[2] ترجم هذه المقالة، د/ بدر الحاكيمي، باحث ومترجم، صدر له مؤخرًا ترجمة لكتاب "الدراسات القرآنية الغربية، المفهوم والتاريخ والاتجاهات، بحوث ودراسات عامة"، هارتموت بوبزين، ماركو شولر، ديفين ستيوارت، فريد دونر، نماء للبحوث والدراسات، بيروت، 2025.
[3] أندرو ريبين Andrew Rippin، (1950- 2016)، هو باحث كندي من أصل بريطاني، ولد في لندن، وقد عمل كباحث زميل في معهد الدراسات الإسماعيلية بلندن، منذ عام 2013م، قبل وفاته في 2016م، واهتمامه الرئيس يتعلق بدراسة الإسلام المبكر، ودراسة تفسير القرآن في العصور الكلاسيكية، له عدد من المؤلفات التي قام بتأليفها أو المشاركة في إعدادها، مثل: Guide to Islam, co-authored with David Ede, Leonard Librande, Donald P. Little, Richard Timmis, and Jan Weryho, Boston 1983.
دليل إلى الإسلام، مع ديفيد إيدي ليونارد ودونالد ليتل ريتشارد.
كما حرر كتابًا هامًا بعنوان Approaches to the history of the interpretation of the Qurʾān (ed.), Oxford 1988
«مقاربات في تاريخ تفسير القرآن»، وهو كذلك محرر الدليل الهام
lackwell companion to the Qurʾan (ed.), Oxford 2006. (قسم الترجمات).
[4] أعبّر عن امتناني العميق للدكتور وليد صالح من جامعة تورنتو على الملاحظات الثمينة التي أسداها لي أثناء صياغة أجزاء من هذا العمل.
[5] Fred M. Donner, “The Q urʾān in Recent Scholarship: Challenges and Desiderata,” in The Qurʾān in its Historical Context, Gabriel Said Reynolds (ed.). London: Routledge, 2008, 29–50; Angelika Neuwirth and Nicolai Sinai, “Introduction,” in The Qurʾān in Context: Historical and Literary Investigations into the Qurʾānic Milieu , Angelika Neuwirth, Nicolai Sinai, and Michael Marx (eds). Leiden: Brill, 2010, 1–24.
[6] Nicolai Sinai, “The Qurʾān as Process,” in The Qurʾān in Context: Historical and Literary Investigations into the Qurʾānic Milieu, Angelika Neuwirth, Nicolai Sinai, Michael Marx (eds). Leiden: Brill, 2010, 407–39.
[7] انظر المقالات المبثوثة في مجلة الدراسات القرآنية، العدد 15، 2012.
[8] Mohammed Arkoun, “Introduction: An Assessment of and Perspectives on the Study of the Qurʾan,” in The Qurʾan: Style and Contents , Andrew Rippin (ed.). Aldershot: Ashgate, 2001, 297–332 (French original 1982).
[9]Farid Esack, “Qurʾānic Hermeneutics: Problems and Prospects,” The Muslim World 83, 1993, 119.
[10] Ibn Warraq (ed.), The Origins of the Koran: Classic Essays on Islam’s Holy Book. Amherst, NY: Prometheus Press, 1998; (ed.), What the Koran Really Says. Language, Text, and Commentary. Amherst, NY: Prometheus Press, 2002.
[11] Jane Dammen McAuliffe (ed.), Encyclopedia of the Qurʾān. Leiden: Brill, 2001–6.
[12] Muzaffar Iqbal, “The Qurʾān, Orientalism, and the Encyclopaedia of the Qurʾān,” Journal of Qurʾanic Research and Studies 3:5, 2008, 11; “Western Academia and the Qurʾān: Some Enduring Prejudices,” Muslim World Book Review 30:1, 2009, 6–18.
[13] Ibid., p. 12.
[14] Ibid., p. 13.
[15] Ibid., p. 23.
[16] Ibid., p. 24
[17] Muzaffar Iqbal, “Western Academia and the Qurʾān: Some Enduring Prejudices,” Muslim World Book Review 30:1, 2009, 8
[18] Muzaffar Iqbal, Integrated Encyclopedia of the Qurʾān: Raison d’être and Project Summary. Sherwood Park AB: Center for Islam and Science, 2010, p. 16
[19] John E. Wansbrough, and Andrew Rippin, Quranic Studies Sources and Methods of Scriptural Interpretation. New York: Prometheus Books. 2004, ix
[20] Berg, 2000 , 2003; Madigan, 1995; Rippin, 2001 , chapters 1, 2, 4
[21] Toshihiko Izutsu, God and Man in the Koran: Semantics of the Koranic Weltanschauung. Tokyo: The Keio Institute of Cultural and Linguistic Studies, 1964;. Ethico-Religious Concepts in the Qurʾan. Montreal: McGill University Press, 1966.
[22] Michel Cuypers, The Banquet. A Reading of the Fifth Sura of the Qurʾan, Miami: Convivium Press, 2009 (French original 2007).
[23] Angelika Neuwirth, “Qurʾān, Crisis, and Memory. The Qurʾanic Path Towards Canonization as Refl ected in the Anthropogonic Accounts,” in Crisis and Memory in Islamic Societies: Proceedings of the Third Summer Academy of the Working Group Modernity and Islam held at the Orient Institute of the German Oriental Society in Beirut , Angelika Neuwirth and Andreas Pflitsch (eds). Würzburg: Ergon Verlag, 2001, pp. 113–52.
[24] Gabriel Said Reynolds, The Qurʾān and Its Biblical Subtext. London: Routledge, 2010.
[25] للتوسّع في رؤية ريبين لتطوّر الدراسات الأدبية للقرآن وأسبابه، يمكن مطالعة: الأشكال الأكاديمية في الدراسة الأدبية للقرآن، أندرو ريبين، ترجمة: إسلام أحمد، موقع تفسير، قسم الترجمات.
[26] Angelika Neuwirth, Der Koran als Text der Spätantike. Ein europäischer Zugang. Berlin: Verlag der Weltreligionen, 2010.
[27] Binard & Eren, 1986.
[28] Arthur Arberry, The Koran Interpreted. 2 vols. London: Allen & Unwin, 1955.
[29] Hanna E. Kassis, A Concordance of the Qurʾan . Berkeley, CA: University of California Press, 1983.
[30] Muhammad A. S. Abdel Haleem, The Qurʾan: A New Translation. Oxford: Oxford University Press, 2004.
[31] Majid Fakhry, An Interpretation of the Qurʾan. New York: New York University Press, 2002.
[32] Tarif Khalidi, The Qurʾan: A New Translation. London, New York: Penguin, 1994/2008.
[33] Abdullah Yusuf Ali, The Holy Qurʾan: Text, Translation, and Commentary. Lahore: Shaikh Muhammad Ashraf, 1934–7.
[34] Mohammed Marmaduke Pickthall, The Meaning of the Glorious Koran. An Explanatory Translation. New York: New American Library, 1953.
[35] Régis Blachère, Le Coran (al-Qorʾân). Paris: G.-P. Maisonneuve et Larose, 1966.
[36] Rudi Paret, Der Koran. Übersetzung. Stutt gart: Kohlhammer, 1966.
[37] John Penrice, A Dictionary and Glossary of the Korʾān, with Copious Grammatical References and Explanations of the Text. London: H. S. King, 1873.
[38] Badawi, Abdel Haleem, El-Said M., and Muhammad Abdel Haleem, Arabic-English Dictionary of Qurʾanic Usage (Leiden: Brill, 2008)
[39] Ambros, Arne and Stephan Procházka, A Concise Dictionary of Koranic Arabic (Wiesbaden: Reichert Verlag, 2004)
[40] The Nouns of Koranic Arabic Arranged by Topics. A Companion Volume to the “Concise Dictionary of Koranic Arabic” ( Wiesbaden: Reichert Verlag, 2006)
[41] Rudi Paret, Der Koran: Kommentar und Konkordanz . Stutt gart: Kohlhammer, 1971.
[42] Gotthelf Bergsträsser, “Koranlesung in Kairo (mit einem Beitrag von K. Huber),” Der Islam 20 (1932), 1–42; 21,110 -40.
[43] Kopf, 1956; Rippin, 2001 , chapters 7, 8, 9.
[44] Toby Lester,“What is the Koran?” The Atlantic Monthly 283:1 (January), 1999, 43–56.
[45] François Déroche, La transmission écrite du Coran dans les débuts de l’islam: le codex Parisino-petropolitanus. Leiden: Brill, 2009.
[46] Ibid.
[47] Keith E. Small,Textual Criticism and Qurʾān Manuscripts. Lanham, MD: Lexington Books, 2011.
[48] Yasin Dutton,“Red Dots, Green Dots, Yellow Dots & Blue: Some Refl ections on the Vocalization of Early Qurʾanic Manuscripts,” Journal of Qurʾanic Studies 1:1 (1999), 115–40; 2:1, 1–24; “An Early Muṣḥaf According To The Reading Of Ibn Āmir,” Journal of Qur’anic Studies 3:1, 2001, 71–89; “An Umayyad Fragment of the Qurʾan and Its Dating,” Journal of Qur’anic Studies 9:2, 2007; 57–87.
[49] للتوسع في النتاج المعاصر حول الدراسات الغربية للمخطوطات، راجع: ملف مخطوطات القرآن في الدراسات الغربية، ضمن قسم الترجمات على موقع تفسير. (قسم الترجمات).
[50] انظر على سبيل المثال:
James Bellamy, “Textual Criticism,” in Encyclopedia of the Qurʾān, Jane Dammen McAuliffe (ed.). Leiden: Brill, vol. 5, 2001–6, 237–52.
[51] Muḥammad Muṣṭafá Aʻẓamī, The History of the Qurʾanic Text from Revelation to Compilation: A Comparative Study with the Old and New Testaments. Leicester: UK Islamic Academy, 2003.
[52] Behnam Sadeghi and Uwe Bergmann, “The Codex of a Companion of the Prophet and the Qur ʾān of the Prophet,” Arabica 57, 2010, 343–436.
[هذه الدراسة مترجمة على موقع تفسير بعنوان: (موازنة بين مصحف عثمان وإحدى مخطوطات صنعاء)، ترجمة: د/ حسام صبري، قسم الترجمات].
[53] يشير الكاتب هنا للاتجاه التنقيحي، والذي اعتَبر أنّ القرآن نشأ في بيئة خارج الجزيرة، في بلاد الرافدين وسوريا، للتوسّع حول هذا الاتجاه، راجع ملف الاتجاه التنقيحي على قسم الترجمات بموقع تفسير. (قسم الترجمات).
[54] انظر على سبيل المثال العديد من المقالات في كتاب ابن وراق الصادر سنة 1998- 2002.
[55] انظر كثيرًا من المقالات في أعمال رينولد ونويفرت:
Reynolds 2008 and Neuwirth et al. 2010.
[56] Theodor Nöldeke, “Zur Sprache des Korans,” in Neue Beiträge zur semitischen Sprachwissenschaft, T. Nöldeke (ed.). Strassburg: K. Trubner, 1910, 1–30.
[57] Angelika Neuwirth, Studien zur Komposition der mekkanischen Suren. Berlin: Walter de Gruyter, 1981
[58] Michel Cuypers, The Banquet. A Reading of the Fifth Sura of the Qurʾan . Miami: Convivium Press, 2009 (French original 2007).
[59] Salwa M. S. El-Awa, Textual Relations in the Qurʾān: Relevance, Coherence, and Structure. London: Routledge, 2006.
[60] Issa J. Boullata, (ed.). Literary Structures of Religious Meaning in the Qurʾān. Richmond: Curzon, 2000.
[61] Thomas Hoffmann, The Poetic Qurʾan: Studies on Qurʾanic Poeticity. Wiesbaden: Harrassowitz, 2007.
[62] Michael Zwettler, “A Mantic Manifesto: The Sūra of ‘The Poets’ and the Qurʾanic Foundations of Prophetic Authority,” in Poetry and Prophecy: The Beginnings of a Literary Tradition , James L. Kugel (ed.). Ithaca, NY: Cornell University Press, 1990, 75–119.
[63] Fazlur Rahman, Major Themes of the Qurʾān. Minneapolis, MN: Bibliotheca Islamica, 1980.
[64] William A. Graham, Beyond the Written World: Oral Aspects of Scripture in the History of Religion. Cambridge: Cambridge University Press, 1987
[65] Geo Widengren, The Ascension of the Apostle and the Heavenly Book. Uppsala: A. B. Lundequistska Bokhandeln, 1950; Muḥammad, the Apostle of God, and His Ascension. Uppsala: A. B. Lundequistska Bokhandeln, 1955.
[66] ArthurJeffery, The Qurʾān as Scripture . New York: Russell F. Moore, 1952; Daniel A. Madigan, The Qurʾān’s Self-Image: Writing and Authority in Islam’s Scripture. Princeton, NJ: Princeton University Press, 2001.
[67] Thomas J. O’Shaughnessy, Creation and the Teaching of the Qurʾān. Rome: Biblical Institute Press, 1985; Izutsu, God and Man in the Koran: Semantics of the Koranic Weltanschauung. Tokyo: The Keio Institute of Cultural and Linguistic Studies, 1964.
[68] Abraham Geiger, Judaism and Islam , F. M. Young (trans.). First published 1898 (German original 1835), available electronically at htt p://answering-islam.org/Books/ Geiger/Judaism/index.htm. Accessed March 17, 2012; Charles C. Torrey, The Jewish Foundation of Islam. New York: Jewish Institute of Religion, 1933.
[69]Richard Bell, The Origin of Islam in Its Christian Environment. London: Macmillan, 1926.
[70] John C Reeves, (ed.) Bible and Qurʾān: Essays in Scriptural Intertextuality. Atlanta: Society of Biblical Literature, 2003.
[71] Asma Barlas, Believing Women in Islam: Unreading Patriarchal Interpretations of the Qurʾān. Austin: University of Texas Press, 2002; Barbara Stowasser, Women in the Qurʾān, Traditions, and Interpretation. New York: Oxford University Press, 1994; Amina Wadud, Qurʼan and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman’s Perspective. New York: Oxford University Press, 1999.
[72] Toshihiko Izutsu, Ethico-Religious Concepts in the Qurʾan. Montreal: McGill University Press, 1966.
[73] O’Shaughnessy, Muhammad’s Thoughts on Death: A Thematic Study of the Qurʾānic Data. Leiden: E. J. Brill, 1969; Eschatological Themes in the Qurʾān. Manila: Cardinal Bea Institute, Loyola School of Theology, 1986; Jane Idleman Smith and Yvonne Yazbeck Haddad, The Islamic Understanding of Death and Resurrection. Albany, NY: State University of New York Press, 1981.
[74] صدرت الطبعة الأصلية سنة 1977، وصدرت مرة أخرى سنة 2004.
[75] Davis S. Margoliouth, Chrestomathia Baidawiana: The Commentary of el-Baiḍāwī on Sura III Translated and Explained For the Use of Students of Arabic. London: Luzac & Co, 1894.
[76] Alfred Felix Landon Beeston, Baiḍāwī’s Commentary on Sūrah 12 of the Qurʾān; Text, Accompanied by an Interpretative Rendering and Notes. Oxford: Clarendon Press, 1963 , v–vi.
[77]Beeston, 1963 , vii.
[78] Nicolai Sinai, “The Qurʾān as Process,” in The Qurʾān in Context: Historical and Literary Investigations into the Qurʾānic Milieu , Angelika Neuwirth, Nicolai Sinai, Michael Marx (eds). Leiden: Brill, 2010, 407–39; Neuwirth & Sinai, “Introduction,” in The Qurʾān in Context: Historical and Literary Investigations into the Qurʾānic Milieu, Angelika Neuwirth, Nicolai Sinai, and Michael Marx (eds). Leiden: Brill, 2010, 1–24.
[79] Walid Saleh, The Formation of the Classical Tafsīr Tradition. The Qurʾān Commentary of al-Thaʿlabī (d. 427/1035). Leiden: Brill, 2004; Andrew Lane, A Traditional Muʿtazilite Qurʾān Commentary: The Kashshāf of Jār Allāh al-Zamakhsharī (d. 538/1144). Leiden: Brill, 2006; Nicolai Sinai, Fortschreibung und Auslegung. Studien zur frühen Koraninterpretation. Wiesbaden: Harrassowitz, 2009 ; Bruce Fudge, Qurʾānic Hermeneutics. Al-Ṭabrisī and the Craft of Commentary. London: Routledge, 2011
[80] Johanna Pink, Sunnitischer Tafsīr in der modernen islamischen Welt. Leiden: Brill, 2011.
[81] -Issa J. Boullata, “Sayyid Quṭb’s Literay Appreciation of the Qurʾān,” in Literary Structures of Religious Meaning in the Qurʾān, Issa J. Boullata (ed.). Richmond: Curzon, 2000, 354–71.
[82] Y. Goldfeld, “The Development of Theory on Qurʾānic Exegesis in Islamic Scholarship,” Studia Islamica 67, 1988, 5–28; Gregor Schwarb, “Capturing the Meanings of God’s Speech: The Relevance of uṣūl al-fi qh to an Understanding of uṣūl al-tafsīr in Jewish and Muslim kalām ,” in A Word Fitly Spoken. Studies in Medieval Exegesis of the Hebrew Bible and the Qurʾan Presented to Haggai Ben-Shammai, Meir M. Bar-Asher, Simon Hopkins, Sarah Strousma, and Bruno Chiesa (eds). Jerusalem: Ben-Zvi Institute and the Hebrew University, 2007, 111–55.
[83] للتوسع راجع الكتاب المجمع: (التفسير في الدراسات الغربية)، الجزء الثاني، على قسم الترجمات بموقع تفسير. (موقع تفسير).
[84] Richard C.Steiner, A Biblical Translation in the Making. The Evolution and Impact of Saadia Gaon’s Tafsīr. Cambridge MA: Harvard University Center for Jewish Studies/ Harvard University Press, 2010.
[85] Saleh, “Ibn Taymiyya and the Rise of Radical Hermeneutics: An Analysis of An Introduction to the Foundations of Qurʾānic Exegesis,” in Ibn Taymiyya and His Times, Yossef Rapoport and Shahab Ahmed (eds). Oxford: Oxford University Press, 2010, 123–62.
مواد تهمك
-
 دراسات التفسير الغربية ومعضلة المعيارية
دراسات التفسير الغربية ومعضلة المعيارية -
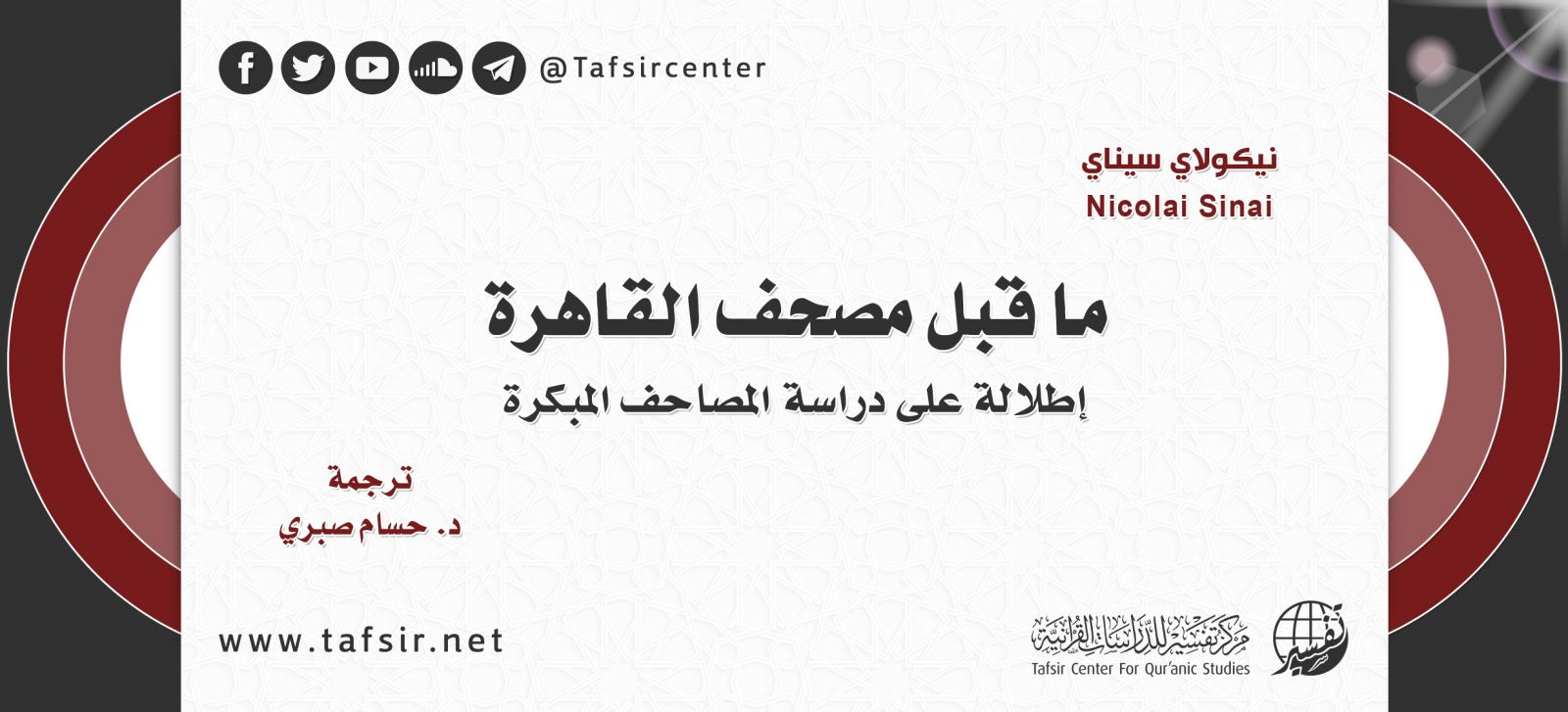 ما قبل مصحف القاهرة؛ إطلالة على دراسة المصاحف المبكّرة
ما قبل مصحف القاهرة؛ إطلالة على دراسة المصاحف المبكّرة -
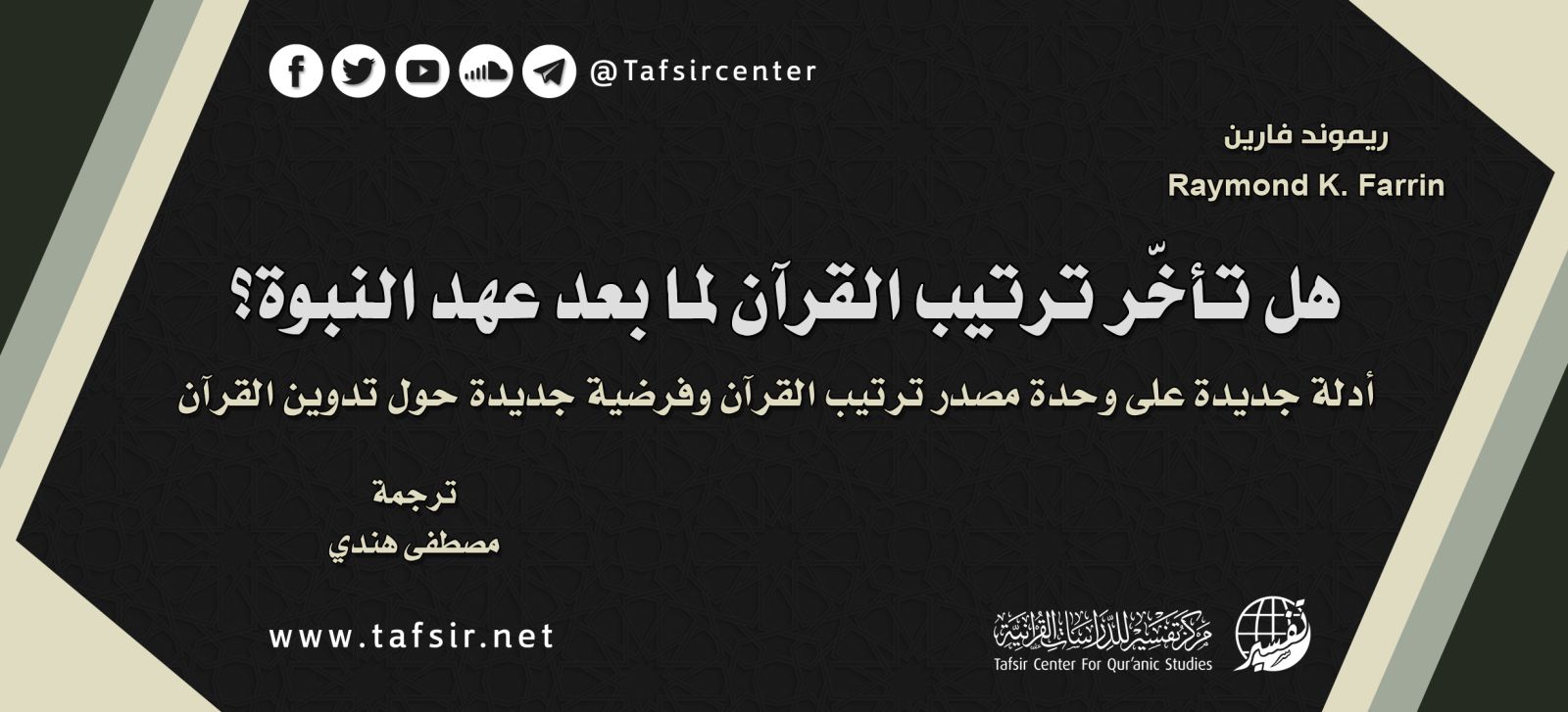 هل تأخّر ترتيب القرآن لما بعد عهد النبوّة؟ أدلة جديدة على وحدة مصدر ترتيب القرآن وفرضية جديدة حول تدوين القرآن
هل تأخّر ترتيب القرآن لما بعد عهد النبوّة؟ أدلة جديدة على وحدة مصدر ترتيب القرآن وفرضية جديدة حول تدوين القرآن -
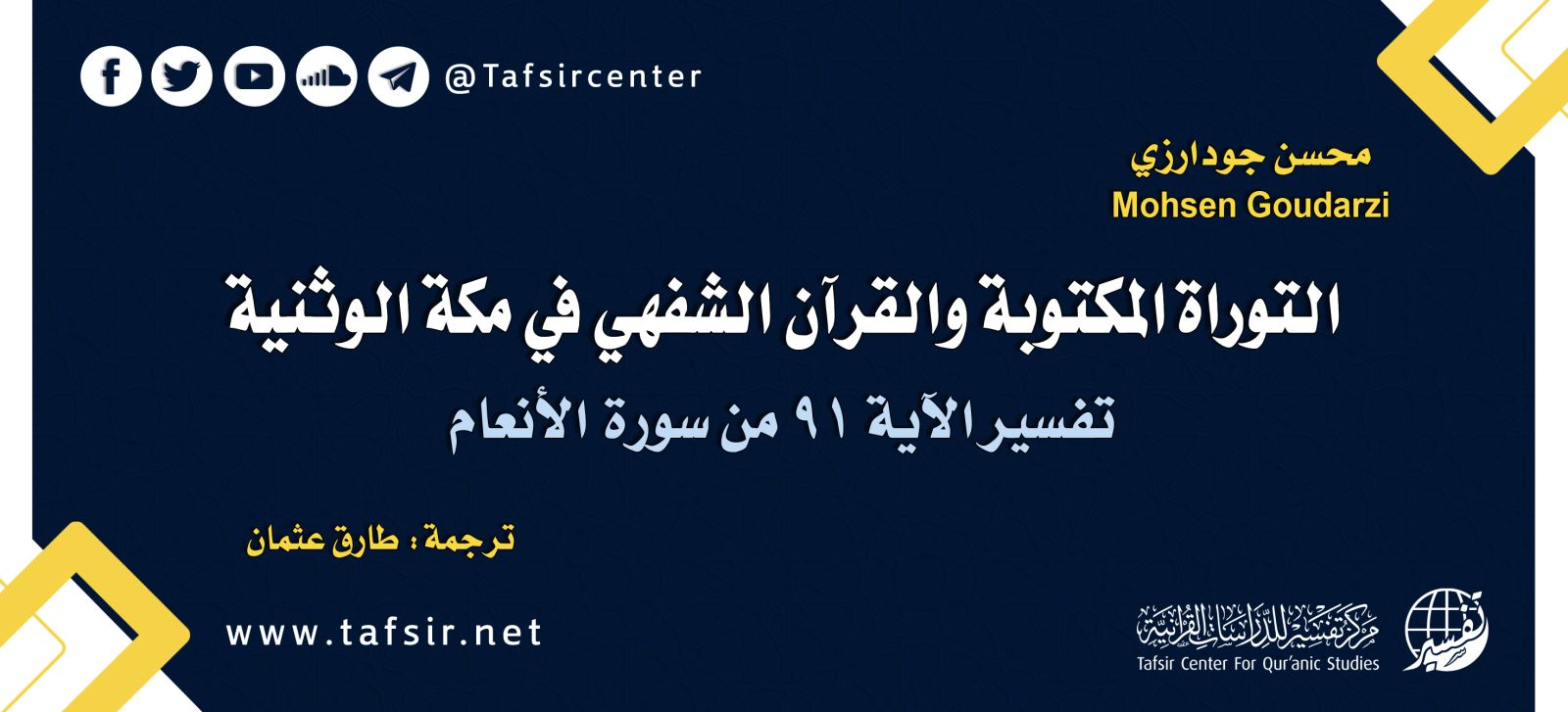 التوراة المكتوبة والقرآن الشفهي في مكة الوثنية؛ تفسير الآية 91 من سورة الأنعام
التوراة المكتوبة والقرآن الشفهي في مكة الوثنية؛ تفسير الآية 91 من سورة الأنعام -
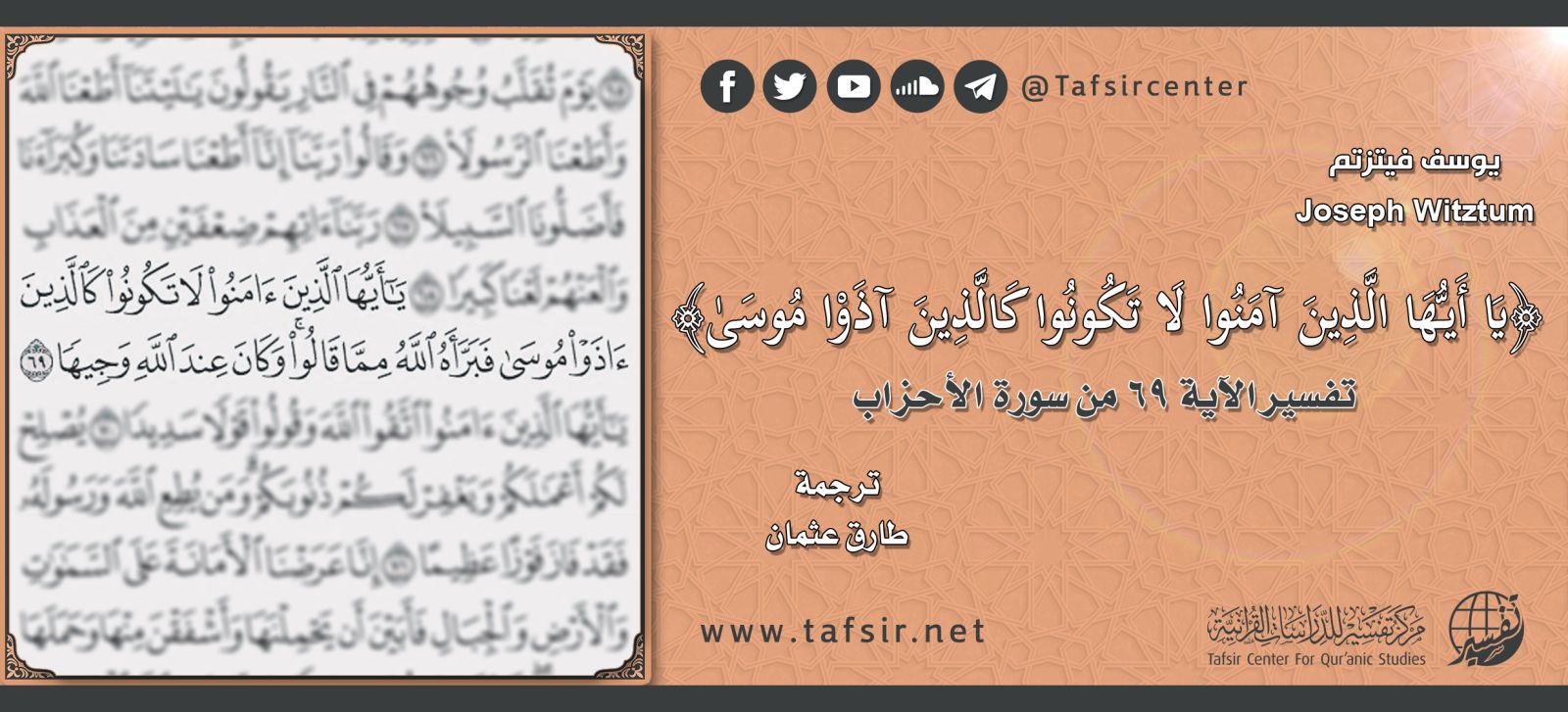 ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَى﴾ تفسير الآية 69 من سورة الأحزاب
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَى﴾ تفسير الآية 69 من سورة الأحزاب -
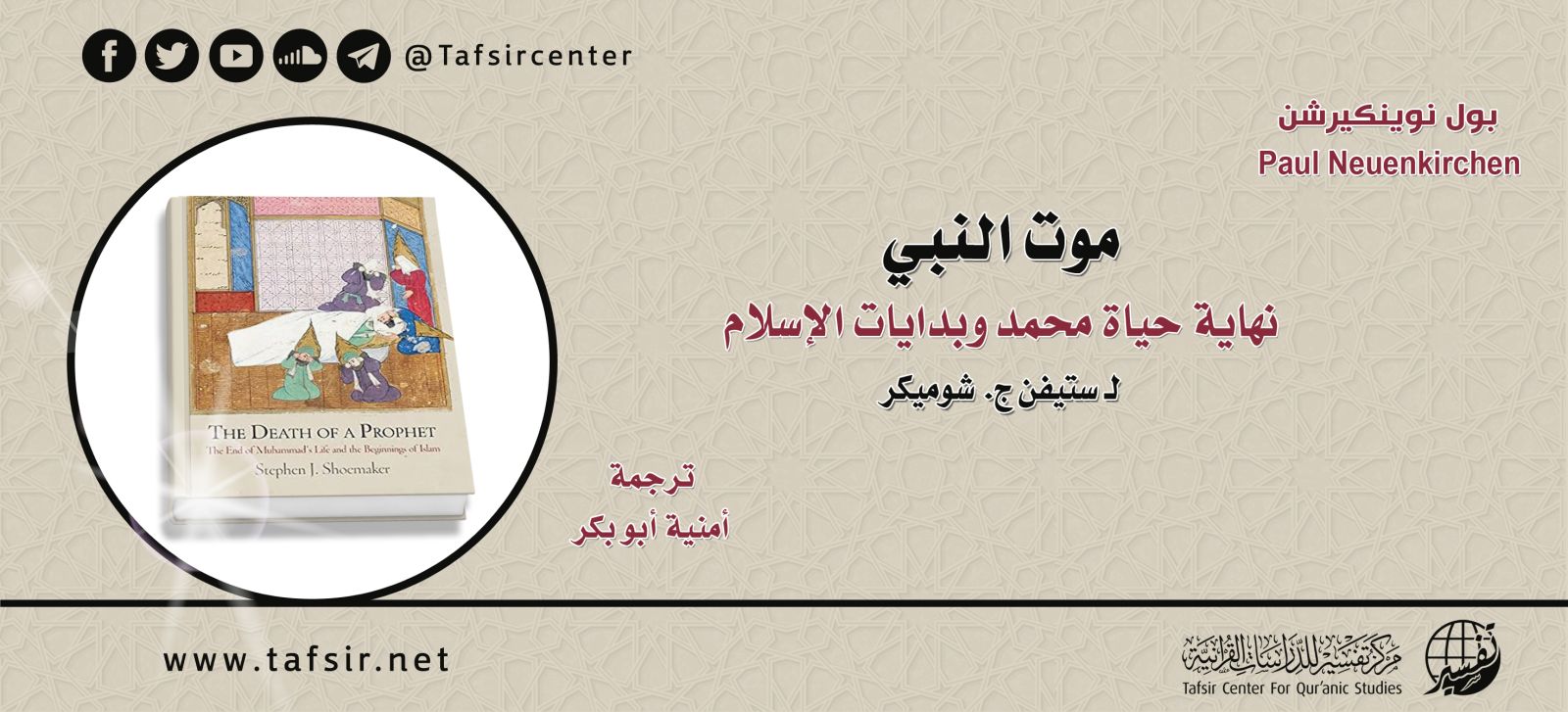 موت النبي، نهاية حياة محمّد وبدايات الإسلام لـ ستيفن ج. شوميكر
موت النبي، نهاية حياة محمّد وبدايات الإسلام لـ ستيفن ج. شوميكر


