العقيدة الإسلامية حول "إعجاز القرآن" من منظور الدراسات الأدبية الإسلامية
قراءة تحليلية
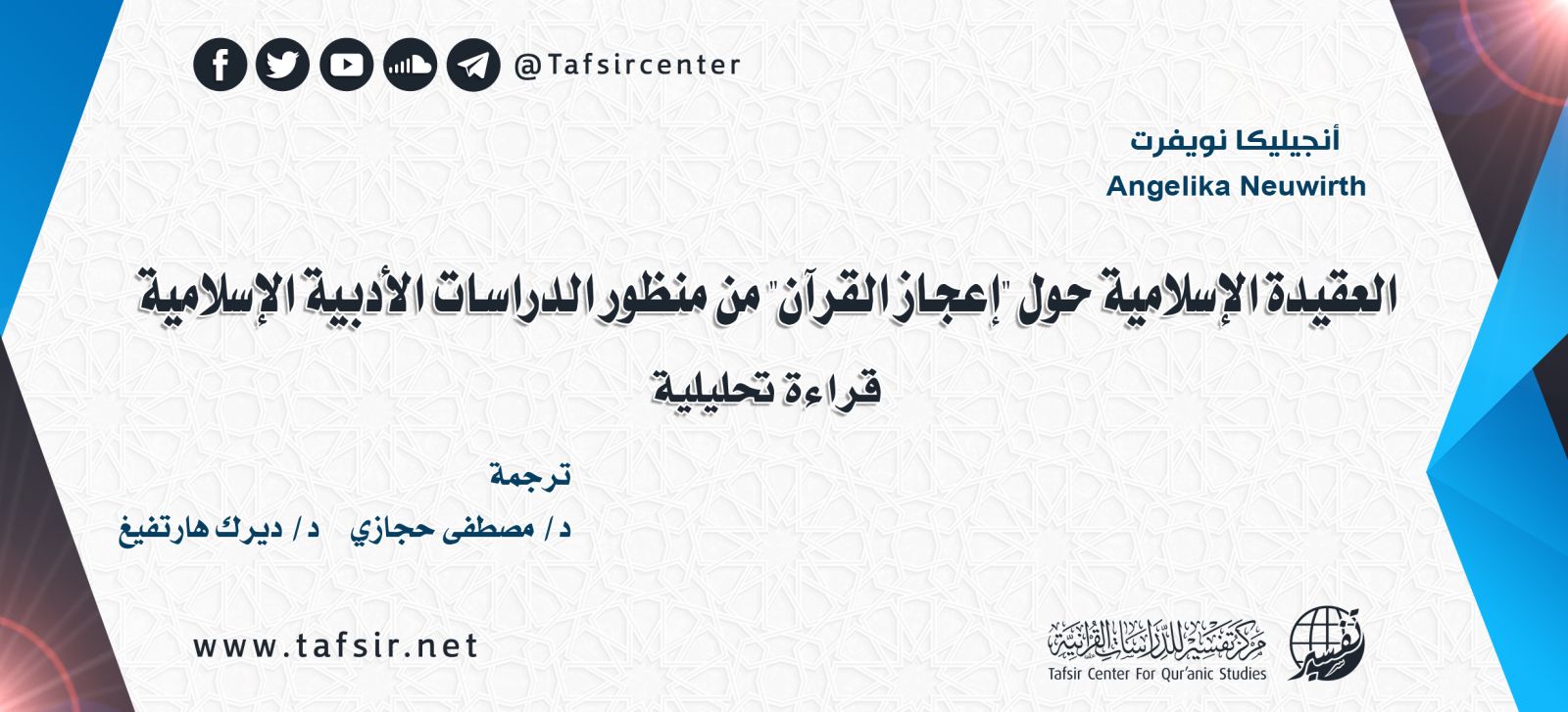
العقيدة الإسلامية حول "إعجاز القرآن" من منظور الدراسات الأدبية الإسلامية
قراءة تحليلية[1][2]
أنجيليكا نويفرت[3]
يُـمثِّل الإسلامُ أحدثَ الديانات التوحيدية الثلاث في حوض البحر الأبيض المتوسط، وقد ورث عن سابقتَيْه؛ اليهودية والمسيحية، سماتٍ جوهريةً تجمع بينها. وعلى غرارهما، يرفع منذ بداياته دعوى التفويض الإلهي بكلمة الله التي وجّهها إلى البشر في مجرى التاريخ. أمّا دستوره الأساس الملزِم للمؤمنين، أي القرآن، فقد اعتُبر كتابًا مقدَّسًا، ووحيًا جاء من السماء. وإلى هذا الحدّ لا يبدو أنّ في الأمر ما يثير الدهشة أو يُضفي على الإسلام خصوصيةً استثنائية.
وكما يحدث غالبًا عند إمعان النظر في ظواهر تبدو بديهية في بيئة ثقافية متقاربة، تكشف المفاهيم والتصوّرات الفردانية التي تطوّرت انطلاقًا من فكرة أساسية مألوفة أنها من المسلّمات لدينا، بل وحتى غريبة علينا في آنٍ واحدٍ. فأيّ مسيحيّ، على سبيل المثال، لا يدّعي أنّ الكتاب المقدّس ليس أدبًا عظيمًا فحسب، بل يمثِّل المطلقية والتعالي بذاته من الناحية اللغوية والبلاغية والأدبية؟ وبالمعنى الحقيقي للكلمة، أيّ مسيحي لا يرى أنّ الكتاب المقدّس لا نظير له، وأنه المطلق بين عموم الآحاد والأُمم؟ وأيّ مسيحي لا يعتبر في هذه المطلقية والتعالي الدليل -بل البرهان القاطع- على صحة الوحي؟
ومع ذلك، فإنّ مثل هذا الادّعاء المسيحي تحديدًا هو نفسه ما ينصبه الإسلام لقرآنه، فهو بمثابة العقيدة الملزمة لكلّ من أراد أن يحقّق الإيمان الصادق، بل ويقول المسلمون أيضًا إنّ (معجزة) القرآن من ناحية البلاغة والنَّظْم تمثّل الحُجّة البالغة التي لم تؤتَ لنبيّ قط. فكيف نشأ هذا الزعم المثير، وكيف يمكن فهمه؟
ربما كان التصوّر المسيحي الخاصّ بالوحي كامنًا بين الحين والآخر خلف هذا الموقف الغربي (المستنير) وبلا وعي يكاد يكون حاضرًا. ووفق هذا التصور، سيكون من المحال أن يُلبس الكتاب المقدّس ثوب العظمة اللغوية. فكما أنّ المسيح -أَقْتَبِس فقرة معروفة من رسالة فيلبي[4]- «الذي إِذْ كان في صورة الله لم يحسب خلسة أن يكون معادلًا لله، لكنه أخلى نفسه [وتواضع] آخذًا صورة عبد صائرًا في شبه الناس»؛ لذا وجب على كلمة الربّ، أي الكتاب المقدّس، أن تسلك مسارها متواضعة عبر العصور في صورة عبد. وهكذا يتخذ الكتاب المقدس عن قصد أسلوبًا متواضعًا (genus humile)، ليُبلغ القارئ مراده بلا تكلّف عبر خطابه. وقد خلص غوستاف جرونبوم / Gustav von Grunebaumـ [5]، الذي قارن بين الموقفين الإسلامي والمسيحي، إلى أنّ الكنيسة في وقت مبكّر لجأت إلى نظرية الأسلوب الخطابي المتواضع؛ لأنّ مقارنة الأناجيل بالأدب اليوناني الكلاسيكي أجبرتها على ذلك. أمّا القرآن، الذي لم يسبقه أيّ أدب بارز، فلم يكن خاضعًا لمثل هذه المقارنة وفقًا لجرونبوم. ومع ذلك، يبدو أنّ هذا الادّعاء يظلّ سطحيًّا. فالباب مفتوح على مصراعيه لكلّ من أراد استخراج (اللآلئ) الشِّعْرية والبلاغية من الكتاب المقدس المسيحي لمقارنتها بالمؤلِّفين الكلاسيكيين. وفي أبسط مثال، استشهد لونجينوس /Longinus، الفيلسوف الجمالي الوثني من العصور القديمة، في كتابه (عن السموّ) ببداية سفر التكوين كمثال على العظمة الاستثنائية.
لكن مهما كانت الأفكار والتطلعات المسيحية، فإن السؤال المطروح هاهنا هو: كيف حدث هذا التطور تحديدًا في الإسلام؟ يكمن الجانب الأساسي في السِّمة الخاصة للقرآن وأثره الحقيقي على المؤمنين.
يتمايز كتاب الوحي الإسلامي في نشأته تمايزًا جوهريًّا عن الكتب التي سبقته: فبينما انتخبت اليهودية والنصرانية أسفارها المعتمدة من مجموعة أكبر من الكتابات التي ترجع إلى مؤلِّفين مختلفين، ثم استخرجت منها المقاطع اللازمة للإنشاد الشعائري، شعر نبي الإسلام مع اشتهار مراسم الصلوات المتلوّة تلك في نطاقه من (أهل الكتاب) بأنه مطالب بشكل فردي وبتوجه شبه مستقلّ إلى تقديم (كتاب) مماثل للعرب، يقدّم نصوصًا مشابهة للتلاوة الليتروجية (بلسانٍ عربي مبين)، ليس هذا فحسب، بل إنّ هذا الكتاب جاء من السماء، حتى يتمكّن العرب مِن تملُّك شيء ما في لغتهم الخاصّة، ليقف على قدم المساواة مع التلاوة الشعائرية للنصوص إبان مراسم الصلوات لدى اليهود والمسيحيين. وقد قدّم آرثر جيفري /Arthur Jeffery، هذا التعريف للقرآن الكريم وبرهن عليه باستفاضة في كتابه: (القرآن ككتاب مقدّس) (The Quran as Scripture) الذي صدر عام 1952، ومع ذلك لم يأتِ حتى اليوم مَن استخلص من هذا الكتاب أيّ استنتاجات لفهم الشكل القرآني وتقييمه. وغالبًا ما تُساق الحُجَج أنّ القرآن أُريد به أن يكون مجموعة من المواعظ، أو كما لو كان مُخصَّصًا ليقرأه الفرد في عزلة مضيئة، متأمّلًا فيه على نحو متواصل.
ومن خلال عدّة شهادات حول القرآن[6]، لزم القول إنّ أهمية كبرى قد أُوليت منذ البداية لتحديد مساره ضمن التلاوة التعبدية وطرائقها، إذًا يجب تصوّر هذه التلاوة وكأنها أنشودة منغّمة تسمو بوضوح فوق نبرة الكلام العادي. وقد كان فريدريش شفالي/ Friedrich Schwally محقًّا تمامًا في اعتراضه على ترجمة كلمة: (قرأ) ومنها اشتقت لفظة (القرآن)، حيث اعترض على ترجمة (قرأ) بمعنى (دعا) أو (أعلن)، واستدل شفالي: «إنما تُستخدم كلمة: (قرأ) في أيّ من مواضع القرآن للدلالة على التلاوة المرنمة أو المنغمة للنصوص المقدّسة، كما لو كانت أنشودة متناغمة»[7]. وقد أصاب فريدريش روكرت/ Friedrich Rückert كبد الحقيقة عندما ترجم الأمر الوارد في إحدى أقدم السور القرآنية: ﴿وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا﴾[8]، بمعنى: «وتغنَّ بالقرآن تغنِّيًا»[9]. ولم تكن هذه الممارسة حكرًا على النبيّ وحده، بل كان على المؤمنين أن يحفظوا آيات القرآن ويجعلوها قلب طقوس عبادتهم وجوهرها. ومن الأمثلة الواجب تذكّرها أنّ الخليفة اللاحق عمر بن الخطاب، أحد أبرز الشخصيات حزمًا وحصافة في صدر الإسلام، أَسْلَم لـمّا وقع سَمْعُه على القرآن من قبيل المصادفة من أخته، وليس من النبيّ نفسه.
وكما هو مأثور في عِلْم التجويد المستقلّ بتلاوة القرآن، تعود طرائق التلاوة المتقنة والمتنوعة إلى ممارسة ثابتة من النبي، وإن كانت هذه الممارسة في جوهرها أبسط بكثير، رغم أن تفاصيلها الدقيقة لم تَعُد مفهومة لنا اليوم. والدليل على ذلك لا يكمن فقط في نداء النبي المذكور آنفًا والمصدَّق بالشواهد القرآنية إلى التحضير لكتاب قراءات عربي كما يتضح من الاسم نفسه، وإنما أيضًا في بنية الآيات القرآنية نفسها. فعناصر مثل العبارات الختامية للآيات الطوال القائمة على الإيقاع والنغم المتولد من القافية تبقى في الواقع عديمة الفائدة ومنفرة شريطة أن تكون التلاوة بنبرة الصوت العادية التي لا تجويد فيها ولا نغم. وأمّا التلاوة التعبدية المقترنة بالترنيم والتغني والإنشاد فإنها تعزّز بشكل حاسم من الجودة الإيقاعية في التلاوة ذات الطابع الإنشادي؛ والأهمّ من ذلك أنّ الصِّيَغ القرآنية، التي غالبًا ما تتجاوز السياق المعنيّ دلاليًّا، توفّر نقاط استراحة فعّالة في تقدّم وتسلسل المواضيع. إنّ التباعد بين هذه المقاطع الثابتة من الآيات ومكونات الآيات الأخرى ذات الصياغة الأكثر حريةً هو سمة أساسية من سمات الشكل القرآني[10].
ومن طبيعة القرآن أنه كتابٌ للتلاوات في المجتمع الناشئ، وتتجلّى أيضًا الحقيقة اللافتة بأنّ العديد من السور تغيّر من تسلسلاتها المواضيعية المتشابهة، وأنّ كلّ سورة تحوي عناصر متنوعة، مثل: قصص الأنبياء، والوعيد، والتصويرات الأخروية، والمواعظ، وغيرها من العناصر الأخرى. فالسورة الواحدة، باعتبارها الوحدة الأساسية للتلاوة، تهدف إلى توحيد وتضمين العناصر المتعدّدة في الصلوات المتلوّة عند أهل الكتاب[11]، بحيث تتوافق معها، ليس في تفاصيلها، بل في أثرها العام. وبهذا الشكل، قدّم القرآن نفسه لمعاصري النبي كشيء غير مألوف على الإطلاق، مختلف بالكلية عن الأنماط الأدبية السائدة، بل وغير مسبوق لم يعهدوه من قبل، وهؤلاء المعاصرون، كما نعلم من مصادر أخرى موثوقة، كانوا منفتحين للغاية على الانطباعات اللغوية.
وقد ظلّت تلاوة القرآن محتفظة بتأثيرها القوي على مستمعيها حتى بعد أن أصبح الإسلام دين الدولة في إمبراطورية عظيمة مترامية الأطراف، ولم يَعُد تأثير التلاوة قائمًا على وطأة الغريب الذي لم يعهدوه من قبل، بل على مكانة النقطة المحورية التي لا شك فيها للحضارة الناشئة حديثًا. ولا مجال هنا للاستطراد في هذا بالتفصيل، لكن يجدر التأكيد على أن القرآن لم يحدد الإيقاع والجو الروحي في الشعائر العامة في المساجد فحسب، بل إن تلاوة بعض الآيات التي يختارها المؤمن بنفسه شكّلت أيضًا جوهر الصلاة المفروضة على كلّ مؤمن خمس مرات في اليوم والليلة. فلا يوجد في الإسلام على غرار المسيحية ما يُعرف بالأسرار المقدسة ولا القربان المقدس، بل يختبر الإنسان قُرب الله ولقاءه معه من خلال سماع كلماته[12].
وليس ثمة من يختصر هذه الحقيقة الجوهرية ويعبّر عنها بدقة أعظم من قول أحد المتصوّفة المسلمين: كنت أقرأ القرآن فلا أجد له حلاوة، فقلت لنفسي: اقرئيه كأنك تسمعينه من رسول الله فجاءت حلاوته، ثم أردتُ زيادة، فقلت: اقرئيه كأنك تسمعينه من جبريل ينزل به على النبي فزادت حلاوته، ثم قلت: اقرئيه كأنك تسمعينه من ربّ العالمين فجاءت الحلاوة كلّها[13].
ولذا فإنها تجربة محورية للمسلمين على صعيد الحياة الداخلية والتألّق الداخلي، تجربة حقيقية ومذهلة من الجمال الميتافيزيقي لنصوص الوحي، والتي أفضَت في نهاية المطاف، في القرن التاسع الميلادي، إلى صياغة عقيدة إعجاز القرآن وتفرّده -وليس مجرد تكهّنات لاهوتية أو حتى سفسطة علمية. لقد كان الأمر يتعلق بعقلنة تجربة جذرية شملت جميع أفراد المجتمع الديني- ومهما كانت هذه التجربة محدودة في آفاقها، فإن عملية العقلنة التي جرت لها لم تأخذ بعين الاعتبار بالقدر الكافي أو الجاد تجارب الجماعات البشرية الأخرى.
فالتعريف الاصطلاحي الذي صاغه الإسلام لهذه العقيدة، والذي ترسّخ بثبات منذ النصف الثاني من القرن التاسع، هو (إعجاز القرآن)، وليس من السهل نقله إلى أيّ اللغات الأوربية. والترجمة الألمانية الأكثر شيوعًا، المتمثلة في "Unnachahmlichkeit" بمعنى (لا يُضاهى) و"Einzigartigkeit" بمعنى (التفرّد)، لا تنقل المعنى الدقيق إلا بشكل تقريبي. ويأتي الإعجاز مصدرًا من أعجز، ومادة الكلمة هي العجز، ومعناها يدور حول (العجز) و(عدم القدرة على النهوض بالأمر). وعليه فإنّ المصطلح يعني حرفيًّا (إعجاز القرآن)، وهو تعبير جلي يمكن تفسيره، وفقًا لتور أندريه/ Tor Andrae (1918) [14]، بأنه (طبيعة القرآن التي تجعل الناس عاجزين عن الإتيان بمثله).
رفض العالم الهولندي جان بومان/ Jan Boumanـ[15] هذه الصياغة، مطالبًا بترجمتها: (الطبيعة المعجزة للقرآن، التي تجعل الناس يدركون أنهم عاجزون عن الإتيان بمثله). ويمكن تفهُّم جهود بومان في استخدام المناورة الدلالية للتخفيف من وطأة المصطلح المعقد على الفكر الغربي وتوضيحه بشكلٍ منطقي. لكنه يتساءل؛ لأسباب نحوية وسيميولوجية، عمّا إذا كان بالإمكان استخلاص الصيغة السببية (جعله عاجزًا)، والفارق الأكثر تعقيدًا (جعله يدرك أنه عاجز) من الفعل أعجز. ويبدو لي أن محاولة بومان تتجاوز أو تتجاهل في المقام الأول الحسّ الإسلامي.
فالقرآن، بالنسبة للمسلم، له تأثير قوي للغاية، ويمكن الحديث بصورة مجازية عن تأثير الصدمة الذي يجعل أيّ محاولة لمعارضة القرآن عديمة الجدوى. على أيّ حال، تجدر الإشارة إلى أن المصطلح العربي، خلافًا للترجمة الألمانية الشائعة، لا يتضمن في صياغته النحوية صفةً ثابتة وسلبية تمثل (الإعجاز)، بل عنصرًا فاعلًا لا لَبْس فيه، يقوم بـ(إفناء) أيّ محاولة للمساواة معه أو حتى تجاوزه. إنّ دلالات مثل التحدي والمنافسة والهزيمة متأصّلة في الكلمة، سواء في استخدامها الدنيوي/ الأدبي أو الديني، وبهذا المعنى تُعَدّ هذه العقيدة استمرارًا مباشرًا للتحديات الواردة في النصّ القرآني، والتي سأناقشها لاحقًا. هذا كلّ ما يتعلق بتعريف الكلمة، والآن لنشرع إلى معالجة تاريخ الإعجاز.
وقد تضافرت الحجج التي صاغها العالِم الباقلاني الأشعري في القرن العاشر، وشكّلت الصورة الكلاسيكية للمعتقد الصحيح، حيث قدّمها عبر مسارات شتى وطرق متباينة، ولم تقتصر بأيّ حال على الجوانب اللاهوتية فقط. ونظرًا لندرة المصادر المعروفة لدينا حاليًا عن الفترة المبكّرة، فإنّ أيّ محاولة لإعادة بنيوية أصول الجدالات المختلفة، التي أسهمتْ في نهاية المطاف في صياغة عقيدة الإعجاز، لا تبدو واعدة. ومع ذلك، يمكن تمييز عدّة دوافع بوضوح.
وقد ذكر غوستاف جرونبوم عاملَيْن فقط في أحدث ملخص لبحثه، في مقاله المعنون بـ(الإعجاز)، ضمن دائرة المعارف الإسلامية[16]: 1) ضرورة إثبات بعثة النبي. 2) ضرورة ضمان مرجعية قطعية للعقيدة والشريعة والتقاليد الإسلامية. غير أن صياغته للعامل الثاني تبدو عامة إلى حدّ كبير. أمّا عبد العليم[17] فقد لخّص لأول مرة التطوّر التاريخي للإعجاز برمّته في مقال قصير صدر عام 1933، وجمع كلّ المصادر الأولية، ووضع إطارًا للبحث المنهجي المستقبلي. وقد عدّ ثلاثة عوامل: 1) التفسير المنهجي للقرآن الكريم. 2) الجدل العقائدي أو الكلامي حول خَلْقِ القرآن أو قِدَمه. 3) النبوّة وربطها بنظرية دلالة المعجزات على النبوّات. ومع ذلك، يجب التمييز بين سبعة عوامل على الأقل، حتى لو دمجها المؤلِّفون أو خلطوا فيما بينها بطرق مختلفة.
1. الدور الخاصّ للقرآن الذي ذُكر سابقًا في حياة جماعة المؤمنين، والتجارب الروحية والجمالية المرتبطة به. ولولا هذا الأساس لما استطاعت الدوافع التالية أن تحقّق مثل هذا الصدى القوي.
2. تفسير القرآن: بالإضافة إلى العديد من الآيات الأخرى التي وُضعت على لسان النبيّ لتكون دفاعًا عنه ضدّ اتهامات الكافرين، كان على المفسِّرين أيضًا توضيح مجموعة خاصة من الآيات التي يُطلب فيها منه، بطريقةٍ ما، أن يتولى الهجوم بنفسه: في مواجهة الاتهام الذي نال منه وأهمّه بشدة، وهو أنّ القرآن مُفتَرى من عنده. وعليه، توجَّب عليه أخيرًا مواجهة التحدي: ﴿أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ [هود: 13]. فلمّا ظلّ هذا التحدي دون جواب، تبعه تحدٍّ أعظم جرأة: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ [البقرة: 23]. ولا شكّ أنّ الموضع الكلاسيكي، الذي استُشهد به لاحقًا على نطاق واسع، إِذْ يعلن التحدي بطريقة شاملة، وفيه جاء: ﴿قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا﴾ [الإسراء: 88]. ولم يكن من الممكن صياغة الادّعاء بالتفرد بشكلٍ أوضح من هذا. ويبدو أن التفسير، الذي تطور في البداية بشكلٍ متباين للغاية -ربما تحديدًا بسبب وضوح لغة القرآن- لم يكن لينتج أيّ فرضيات خاصّة حول هذه الآيات، لولا طرحه للنقاش والمشاكلة من جهات أخرى. ومع ذلك، ما زال التقييم المنهجي للشواهد المتعلقة بالتفسيرات المبكرة قيد الدراسة.
3. إجمالًا، كان العامل الأكثر تأثيرًا على الإطلاق هو علم النبوّات، الذي طُوّر بطريقة فريدة ضمن عِلْم الكلام الإسلامي لجميع الأنبياء المعترف بهم، بدءًا من آدم، مرورًا بموسى، ووصولًا إلى محمد. ودون اهتمامٍ كبيرٍ بالأخبار والنصوص غير الإسلامية، مع التركيز على قصص الأنبياء الواردة في القرآن، والتي صِيغت جميعها بطريقة متقاربة إلى حدّ كبير، وضع المتكلمون نظرية (دلائل النبوّة) التي تُظهِر تصديق الله للأنبياء، وجادلَتْ بشأن المعجزات الخاصة بمحمد. رغم الوعي الواقعي الرصين لمحمد في هذه النقطة، حيث كان قد نبذ في كثير من الأحيان أية قدرة له على الإتيان بالمعجزات، لكن سرعان ما نشأت بين الناس صورة أسطورية للنبي كونه خارقًا للعادات. وقد وصف تور أندريه[18] الدوافع الكامنة وراء تلك العملية بالتفصيل. فمِن جهةٍ لكبح الولع الشعبي بالمعجزات، ومن جهةٍ أخرى لئلا يترك النبي بلا تصديق سماوي، تركزت جهود المتكلمين على معجزة واحدة: معجزة القرآن. في إطار هذه الثنائية ندرك ما جاء عن محمد في صحيح البخارى: (ما من الأنبياء من نبيٍّ، إلا وقد أُعطي من الآيات ما مِثلُه آمَنَ عليه البشرُ، وإنما كان الذي أُوتيتُه وحيًا أوحاه اللهُ إليَّ، فأرجو أن أكون أكثرَهم تابعًا يومَ القيامةِ).
4. التكهّنات حول طبيعة القرآن: لقد أفضت المناقشات الفلسفية ذات الإلهام الهلنستي حول صفات الله والمعنى الدقيق لمفهوم (كلام الله) إلى جدلٍ حول مسألة خَلْقِ القرآن أو قِدَمه. وقد حمل هذا الجدلُ أنصارَ القول بقِدمه إلى الجزم بالتباعد والبون بين القرآن وسائر ضروب الكلام الأخرى.
5. مجادلة أهل الكتاب الآخرين، أي: اليهود والنصارى الذين شهد القرآن لأنبيائهم وأقرّ بهم. فلم يكن كافيًا التدليل على نبوة محمد من الله، بل وجبَت إقامة الحجة على أنّ نبي الإسلام هو خاتم الأنبياء وعلى تعالِي كتابه. غير أنّ مقارنة دقيقة بين القرآن والتوراة والإنجيل ظلّت غائبة عن المشهد، وهي مقارنة لو وُجِدَتْ، لكانت جديرة أن يتم النظر إليها بعناية خاصّة. وبدلًا من ذلك تطالعنا نظرية مدهشة في عِلْم نفس الشعوب، يُعزى ظهورها أولَ مرة-على حدّ علمي- إلى الجاحظ[19]، الأديب اللامع في القرن التاسع الميلادي، ومفادها: أن الله بعث كلَّ نبي من الأنبياء بمعجزة تُناسِب أهل زمانه، وأنّ معجزات الأنبياء جانسَت ما برع فيه قومهم، وقد تنوّعت الآيات والبراهين بتنوع الأزمنة والأقوام؛ ولذلك جـاءت بمـا يتلاءم مع الغالب على الناس في كلّ عصر من هذه العصور. وقد بعث اللهُ موسى إلى المصريين، حيث كان السحر وتعظيم السحرة؛ ولأنّ معجزة موسى-تحويل عصاه إلى ثعبان مبين- بهرت الأبصار وحيَّرتْ كلّ ساحر في ملك فرعون؛ ثبتت له النبوّة. وكان الناس في عهد المسيح يهتمون بالطب ويقدِّرون الأطباء، ويثقون بهم فتحدّاهم المسيح في ذلك؛ إذ أبرأ المرضى وأحيَا الموتى، فثبتت نبوّته. ثم ختم الله بمحمد، فأرسله إلى قوم يجلّون البيان ويتباهون بالبلاغة والفصاحة والشعراء الفطاحل؛ لذا استلزم أن تكون المعجزة تحفة لغوية في البلاغة والبيان، لا يضاهيها شيء مما في أيديهم، وليبين ضعفهم إزاءها. تُعفي هذه النظرية أصحابها ابتداءً من عبء المقارنة المباشرة بين الخصائص اللغوية للقرآن والكتب السماوية الأخرى؛ إِذْ كان تصديق النبيَّين الآخرين قائمًا منذ البداية على مستوى مختلف؛ فكتبهم إنما عُدَّت معجزة من حيث المضمون وحده، ولم تكن لغتها آنذاك محلّ نظر أو موضع اعتبار.
6. تجلّت قيمة هذه النظرية في صراع الكبرياء القومي العربي مع الشعوب المندحرة، أي في مواجهة ما يُعرف بالشعوبية، النزعة التي أنكرتْ تفوّق العرب على غيرهم. وقد جاهر دعاة هذه النزعة -ولا سيّما الفُرس- بأنّ حضارتهم ونُظمهم وفنونهم وغيرها أكثر تطورًا بكثير من حضارة وإدارة وفنون الفاتحين الوافدين من الصحراء؛ إِذْ لم يكن الامتياز الحاسم -يمكن المجادلة بشأن ذلك- في الحضارة المادية، بل في النضج الفكري، فلم يكن العرب بحاجة إلى معجزات حسية كما كان الحال مع أسلافهم من الأمم؛ إِذْ كانت قدرتهم العالية على الفهم تُمكّنهم من إدراك المعجزة اللغوية المحضة، وإن كانت فائقة الدِّقة. وهكذا فإنّ المعجزة الروحية الأسمى ما هي إلا دليل على السموّ الفكري للأمّة العربية، ويحقّ للعربي أن يتطلع بفخر إلى الفُرس والبيزنطيين المندحِرين.
وفي خدمة هذا الفخر القومي، ابتكر اللغوي ابن فارس (ت: 1004) نظرية أكثر تطرّفًا، تهدف إلى إثبات قداسة اللغة العربية في سياق مسألة أصل اللغات، مستندًا إلى الآية: ﴿وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا﴾. يقول ابن فارس: «وقّف الله -جلَّ وعزَّ- آدمَ -عليه السلام- عَلَى مَا شاء أن يعلّمه إياه مما احتاج إلى عِلْمه فِي زمانه، وانتشر من ذَلِكَ مَا شاء الله، ثُمَّ علَّم بعد آدم -عليه السلام- من عرَب الأنبياء -صلوات الله عليهم- نبيًّا نبيًّا مَا شاء أن يعلمه، حَتَّى انتهى الأمر إِلى نبيّنا محمد صلى الله عليه وسلم، فآتاه الله -جلَّ وعزَّ- من ذَلِكَ مَا لَمْ يؤته أحدًا قَبله، تمامًا عَلَى مَا أحسنَه من اللغة المتقدمة. ثُمَّ قرّ الأمر قراره فلا نعلم لغة من بعده حدثت. فإنْ تعمَّلَ اليوم لذلك متعمِّل وجد من نُقَّاد العلم من ينفيه ويُردّه»[20]. تظهر اللغة العربية هنا كثمرة الوحي المتعاقب، الذي تلقّاه مختلف الأنبياء منذ آدم، وأين لسائر اللغات من السَّعة مَا للغة العرب كما يحاول ابن فارس أن يقول، وهي عنده بمثابة الوسيلة التي اختصّ اللهُ بها الرسالة الخاتمة.
7. الاهتمام بالنظرية الأدبية: آخر دافع يمكن ذِكْره، والذي أفضى إلى دراسة السِّمَات الأدبية في القرآن، نشأ من اهتمامات العصر. وظهور الشعر (الجديد) في مطلع العصر العباسي، الذي تميز باستخدام متعمّد ومتكرّر للصور البلاغية والمجازات (البديع) خلافًا للمدرسة الشِّعْرية التقليدية، وقد أثار هذا جدلًا حادًّا بين أنصار المدرستَيْن القديمة والجديدة. وظهرت أُولى الأعمال النظرية والنقدية الأدبية، وبذل المجدِّدون جهدهم واستفرغوا وُسعهم دفاعًا عن موقفهم لإثبات أن عناصر البدائع الفردية كانت موجودة مسبقًا في الشعر الجاهلي والقرآن. وفي خضمّ هذه الأجواء الجدلية، استحوذ القرآن على نصيب معتبر من الاهتمام التحليلي.
ومع ذلك، لم تكن هذه المرّة الأولى التي يُولَى فيها الاهتمام بالمجازات القرآنية؛ فقد سبق المعتزلةُ إلى ذلك؛ إِذْ أعطت تفسيراتهم الحافز الأساسي لتبيان وجود الصور البلاغية في القرآن، ولا ريب أن منهجهم كان مؤسّسًا على فرضية أصيلة مفادها وجود الخطاب المجازي في القرآن. وقد نتجت الإشكالات التي واجهت هؤلاء المدافعين عن تنزيه الله في كثير من المواضع التي تفيد التجسيم في القرآن، فأفضتبهم إلى صياغة نظرية مفرّقة بين الحقيقة والمجاز. وحتى قبل ظهور أول مصنّف في الشعر العربي، وهو كتاب (البديع) لابن المعتز عام 888، كانت المعرفة التفصيلية بالأساليب المجازية قد شاعت بين المفسّرين وانتشرت انتشارًا واسعّا، حتى إنها وجدت طريقها أيضًا في المعالجات التي وردَت في تفسيرات أهل السُّنة/ أهل الحديث، مثل (تأويل مشكل القرآن) لابن قتيبة (ت: 889).
لا يوجد حتى الآن سردية تاريخية مُرضية للنظرية الأدبية العربية، والتي يجب أن تشمل وتصنّف وترتّب المنظِّرين في مسألة الإعجاز. ويقدِّم وولفارت هاينريشس/WolfhartHeinrichs في مقاله: (النظرية الأدبية: إشكاليات فاعليتها) (1973)[21]؛ لمحة عن الأعمال التحضيرية التي صدرت حتى الآن، وما يُمكن توقّعه وما لا يُمكن توقّعه من المنظّرين والنقّاد العرب. كما يشدّد على أنّ الإسهامات التي قدّمها أولئك الذين ألّفوا ودوّنوا في الإعجاز لم تؤخذ بعين الاعتبار في المحاولتَيْن السابقتَيْن للتلخيص (لأمجد طرابلسي عام 1955، ومحمد زغلول سلام عام 1964).
ولا يحتاج الأمر إطالة النظر لتفسير غياب الدراسات الأدبية المعمّقة في ميدان النقد القرآني الإسلامي، ويُعزى ذلك إلى غياب الدراسات الأدبية الشاملة حول القرآن نفسه. وطالما أنّ العديد من السمات الأدبية للقرآن لم تدرك بعدُ، فإنّ المعالجة الملائمة لإنجازات وإخفاقات النقد القرآني من قِبَل المسلمين أمرٌ صعب المنال، وبالتالي فإنّ الملخص الآتي لا يستطيع إلا أن يشير إلى نوع الملاحظات التي يُقدّمها النقاد العرب.
في المرحلة التأسيسة من تطوّر عقيدة الإعجاز أَوْلى ثلاثةُ مؤلِّفين هذا المضمارَ معالجةً منهجية على نحو خاصّ. جميعهم يرون في السِّمة اللغوية للقرآن الحُجّة البينة على فوقيته؛ إذ لا مثيل له يضاهيه، ومن ثمّ يغلب على تفصيلاتهم الحجج النظرية الأدبية، وهم: عليّ بن عيسى الرماني، اللغوي المعتزلي (بغداد، 889- 994)، وأبو سليمان حمد الخطابي، المحدِّث (مدينة بُسْت/ سجستان، 931- 998)، وأبو بكر محمد الباقلاني، المتكلم الأشعري الشهير (من البصرة، ت: 1013 في بغداد).
عند الاطلاع على مدافعتهم عن الخطاب القرآني، فمِن المتوقع أن تكون ثمة مواجهة بصورة مباشرة مع الملاحظات التجربية، غير أن هذا التوقّع لم يتحقّق إلا جزئيًّا. كان من عادات العلماء الثلاثة أن يمتنعوا عن تقديم أيّ براهين أو تعليلات نظرية للعديد من أطروحاتهم. ومع ذلك، إلى جانبِ وفرةٍ من الافتراضات المجرّدة عندهم، هناك أيضًا عدد من الملاحظات الفردية والتحليلات التي تتعلّق بالظواهر الواقعية. وسيتمّ عرضها بإيجاز أدناه.
في رسالته المقتضبة عن الإعجاز دأب عليّ بن عيسى الرماني بشكلٍ رئيس على التأسيس لتأطيرٍ منهجي وافٍ لكلّ جانب من جوانب الإعجاز[22]، ولم يسعفه ميله نحو الفواصل ودلالتها على المقاطع، وكذا ميله نحو القياسات المنطقية، لم يسعفاه لتطبيق بعض المناهج التجريبية الجديرة بالنظر. وبعض أفكاره التي سنعرضها الآن جرى استنتاجها من تفسيراته الموجزة.
وفقًا للرأي السائد في القرن العاشر الميلادي يرى الرماني أنّ القرآن أعلى طبقات البلاغة خاصّة، وأنّ إعجازه قائم على هذا، وأنه معجز للعرب والعجم كإعجاز الشِّعْر المفحم، فالشِّعْر معجز للمفحم خاصّة كما أن القرآن معجز للكافة. ويرى الرماني أن البلاغة على عشرة أقسام، ترِد جميعها في القرآن وتكرّر مجيئها كثيرًا: أربعة منها من البديع الذي احتدم النقاش بشأنه في عصر الرماني، وهي: التشبيه، والاستعارة، والتجانس، والمبالغة. وثلاثة أخرى تتوافق مع المتطلبات التقليدية للبلاغة العربية، وهي: الإيجاز، والبيان، والتلاؤم. أمّا الثلاثة الأخيرة فقد طوّرها الرماني بالأصالة، وهي: تصريف المعاني[23]، والتضمين[24]، والفواصل.
لم تتجلَّ أصالة الرُّمّاني في تطويره لمعايير مبتكرة للإعجاز فحسب، بل ظهرت كذلك في أنّه أعاد إلى بعض المواضع البلاغية الموروثة فهمًا جديدًا مخصوصًا بالقرآن. فالاستعارة والتشبيه في نظره ليسَا أدوات لتجميل الخطاب أو تحسين رونقه، وإنما وسيلتان لإبانة المعنى وتوضيحه. وما خرج عن حدود العادة، وهذا ما يحفّز الناقد الأدبي للنصوص غير الدينية، لا يثير اهتمام الرماني في العبارات المجازية، بل يركّز على وضوح المعنى المضاف. ومع هذا التحوّل في التركيز، من التأكيد المعتاد على القيمة البديعية في أشكال البديع إلى إبراز وظيفتها كوسيلة للبيان، يقف الرماني في تعارض واضح مع نظريات النصوص غير الدينية/ الأدبية، لكنه في الوقت ذاته يقترب أكثر من الهدف الأصيل للخطاب القرآني الذي يصف نفسه بأنه بيان (أي التفسير والتبيان).
ومن الواضح أنّ الأقسام الثلاثة الجديدة للبلاغة التي أدخلها الرماني بنفسه تُعَدّ عنده من الخصائص القرآنية، وهو رأي قد يربك القارئ في البداية، وبينما يقصد بالتصريف هنا تصريف المعاني، وهو أمر كثير الورود في القرآن، إلا أنه في الواقع لا يمكن اعتباره من صفات القرآن الخاصّة المقصورة عليه. وحتى القصيدة -على سبيل المثال لا الحصر، بوصفها أحد أنماط الشِّعْر الجماعي العربي- يتكرّر في مكوناتها المعهودة كلّ مرة موضوع واحد من الأغراض التقليدية الثابتة، فكيف يصل الرماني إلى اعتبار تغيير الأغراض سمة مميزة للقرآن؟ يمكننا استنتاج السبب: هناك فرق حاسم بالفعل بين معالجة الأغراض في القرآن وفي الشِّعْر، فإعادة صياغة غرض شِعْري تقليدي تحتاج فقط إلى الانسجام شكليًّا، أي: من حيث الوزن والقافية، مع القصيدة ككلّ، لكنها لا تتطلّب أيّ ارتباط منطقي بين الأغراض. أمّا في القرآن، فالأمر مختلف: هنا لكلّ غرض في القرآن -حسب استخدامه- وظائف مختلفة، وذلك بحسب السياق الفكري الذي يهدف إلى دعمه. يبدو كما لو أنّ الرماني كان لديه إحساس واضح بهذه الاستخدامات الخاصّة للأغراض القرآنية، وقد قادته إلى الاعتقاد بأن تغيير الأغراض بحدّ ذاته يُعَدّ سِمَة مميزة للقرآن. ولكن بما أنه امتنع عن تحليل السور كاملةً، فإنه لم يتمكّن من صياغة تصوّر دقيق عن جوهر تغيير الأغراض القرآنية. وحتى مع إدخاله لوجهة النظر المتعلّقة بالتضمين للتعابير الثابتة، يسلك الرماني طريقًا واعدًا للغاية. فالقرآن يقدِّم وفرة من الصِّيَغ الافتتاحية والختامية المميزة لأجزاء مختلفة من السورة. ويبدأ الرماني بالأمر الأقرب للبساطة، وهو صيغة الافتتاح لكلّ سورة، البسملة. كان بإمكانه بسهولة إدراج صِيَغ أخرى ذات دلالات إشارية، لكنه تخلّى فجأة عن الموضوع.
وأكثر ما يثير النظر ويستثير الظنّ هو شروحُه عن الفواصل في القرآن، والأمر يتعلّق -إذا كنت أفهم طريقة تعبير الرماني الموجزة على وجهها الصحيح- بالملاحظة الآتية: يُظهِر القرآن في المقاطع سجعًا ختاميًّا، ولمّا كان بلوغ هذا السجع أمرًا يسيرًا من الناحية الفنية، فإنّه ينشأ تلقائيًّا، دون التأثير في نَظْم الكلام من الناحية النحوية أو الدلالية. وفي هذا تكمن ميزة رئيسة للخطاب القرآني على السّجع، أي: السّجع المألوف، حيث غالبًا ما تكون القافية -لا نظير لها وجوهرية في عملية السجع- حاسمة في نَظْم الكلام من الناحية النحوية، وأحيانًا حتى من الناحية الدلالية. فإنّ تأثير السجع يقوم على هذه القافية، وهي الأولوية الشكلية التي يعيب عليها الرماني؛ لأنها تجعل من التطوّر الحر في الخطاب أمرًا مستحيلًا. وينطبق ما يشبه ذلك على الشِّعْر أيضًا عنده، حيث تعمل القافية الموحدة والالتزام بالوزن على تقييد الخطاب بشدّة.
ويبالغ الرماني في تبسيط تقديره لإمكانات التطوّر اللغوي في الشِّعْر والسجع. ومع ذلك، فإنّ استنطاقه لكلٍّ من السِّمَة الزخرفية والوظيفية معًا للخواتم القرآنية (أو الأقفال)، إلى جانب سمة المرونة الواسعة نسبيًّا في التراكيب النحوية لهذه الأقفال، يُشكِّل إسهامًا بارزًا لا يستهان به في إدراك شكل الخطاب القرآني. وهذه العناصر تحديدًا تسهم بشكلٍ خاصّ في ملاءمة القرآن كنصّ للتلاوة.
أمّا المنظِّر الثاني، فكان ممن عاصر الرماني، وإن كان أصغر منه عمرًا. قضى عالم الحديث أبو سليمان حمد الخطّابي[25] حياته في مدينة بُسْت ببلاد فارس. ولعلّ عزلة موطنه، وربما أيضًا تكوينه العلمي التقليدي، أسهم في تأخره كثيرًا عن الرماني في تأملاته المنهجية.
ولسنا بحاجة هنا إلى إعادة سرد حُجَجه حول كمال الألفاظ والمعاني في القرآن على نحو خاصّ، فهي لا تتضمن أيّ جديد مقارنة بالرماني. غير أنّ الخطّابي على مستوى النَّظْم يطرح نقطة جديرة بالملاحظة، وهي نقطة -بقدر ما أرى- لم يسبقه إليها أيّ عالم مسلم من قبل: أنّ الكلام يقوم بهذه الأشياء الثلاثة: لفظ حامل، ومعنى به قائم، ورباط لهما ناظم. وأن هذه الأمور بعد التأمل من القرآن في غاية الشرف والفضيلة، فلا شيء أفصح من ألفاظه، ولا نَظْم أحسن تأليفًا منه. وأمّا المعاني فقد بلغت بالتقدم في أبوابها. ويذهب الخطابي إلى أن القرآن نزل على هذه الصفة من جمع أشياء مختلفة المعاني في السورة الواحدة وفي الآية المجموعة القليلة العدد لتكون أكثر لفائدته وأعمّ لنفعه. بهذه الحُجّة يواجه الخطابي نقادًا لم يسمّهم يدّعون أنه لو كان نزول القرآن على سبيل التفصيل والتقسيم، لكان أحسن نظمًا وأكثر فائدة ونفعًا. ويردّ الخطابي عليهم، أنه لو كان لكلّ باب من القرآن قبيل، ولكلّ معنى سورة مفردة لم تكثر عائدته، ولكن الواحد من الكفار والمعاندين المنكرين له إذا سمع السورة منه لا تقوم عليه الحجة به إلا في النوع الواحد الذي تضمّنته السورة الواحدة فقط، فكان اجتماع المعاني الكثيرة في السورة الواحدة أوفر حظًّا من التمييز والتفريد. ومع ذلك يُرجّح أن إدراك الخطّابي لم يكن رؤية تأملية للتركيب في السور والآيات من منظور فني، بل كان انطباعًا مباشرًا من جمع أشياء مختلفة المعاني في السورة الواحدة وفي الآية المجموعة القليلة العدد. وإن كان إدراكه للسور/ الوحدات الأكبر لم يكن دقيقًا بما يكفي ليعبّر عن نفسه تحليليًّا. ومع ذلك فقد نظر الخطابي -وإن كان ذلك بدافع الجدل- إلى السورة كونها وحدة أدبية. ولم يتمكّن المنظِّرون اللاحقون من تجاوز إدراكه المبهم.
أمّا المعالجة الثالثة المنهجية لموضوع الإعجاز، فقد وصلتْ إلينا في شكلِ مصنَّف ضخم من تأليف العالم والمتكلّم أبي بكر محمد الباقلاني (ت: 1013 في بغداد)[26]، وقد جذبت ثلاثة أبواب مستفيضة من هذا العمل اهتمام مؤرخ الأدب غوستاف فون غرونباوم، الذي ترجمها إلى الإنجليزية عام 1950 تحت عنوان: (وثيقة من القرن العاشر حول النظرية والنقد الأدبي العربي/ A Tenth Century Document of Arabic Literary Theory and Chriticism)[27]. فالقسم الأول من هذه الأبواب يتناول الأساليب البلاغية المشتركة في الأنماط الأدبية، بينما يتناول القسمان المتبقيان نقدًا مفصلًا لكلّ بيت لقصيدتين من الشِّعْر البديع لاثنين من فحول الشعراء: معلقة امرئ القيس من شعر الجاهلية، وأخرى للبحتري من شعر المدرسة الجديدة في العصر العباسي.
وفوق كلّ ذلك، فإنّ ما يقدّمه الباقلاني هنا لا يعبّر عن نقد متوازن للقصائد، بل محاولة متحيّزة لإيجاد نقطة يمكن انتقادها على الأقل في كلّ بيت. فهو لا يُعنى بالتقييم الملائم لكلّ قصيدة منهما، بل هدفه الحطّ من شأن الشِّعْر بشكلٍ عام. فيتّهم الباقلاني القصائد بأنها تفتقر تحديدًا إلى تلك السِّمات التي لا بدّ أن تكون متأصلة فيها وفق العوائد الشِّعْرية العربية، كذِكْر ما لا يفيد من بعض المواضع، مثل تسمية بعض الأماكن في الصحراء: من (الدَّخُول) و(حَوْمَل) و(تُوضِح) و(المقراة) و(سقط اللوى). فهذَا التطويل، إن لم يفد، كان ضربًا من العي عنده. ويتجلى من السياق أنّ هذه الأبواب عند الباقلاني تهدف فقط إلى تقديم خلفية قاتمة/ مظلمة لباب آخر خاصّ بالقرآن[28]، يسعى فيه الباقلاني إلى مقارنة بنية أبيات القصائد التي تم الحطّ من قدرها سابقًا بالبنية الكاملة للآية القرآنية. وقد تجاهل غروينباوم هذا الجزء، والذي قصد به الباقلاني بلا شك أن يكون ذروة لكتابه واستفراغًا لوسعه، ومن ثم فهو ينظر إلى شروحات الباقلاني للشِّعْر من منظور مشوّه بعض الشيء.
ومع ذلك إذا أخذنا بعين الاعتبار كتاب الباقلاني كاملًا، فإنّ صورة مغايرة تمامًا لموقفه من إشكالية الإعجاز تلوح في الأفق، مقارنة بما عرضه لنا غرونباوم. ويتفق الباقلاني بلا شك مع الرأي السائد في القرن العاشر الذي يرى أن الإعجاز يكمن في البلاغة. لكنه على خلاف الرماني، فليست الصور البديعية عنده ما يجعل من القرآن كتابًا معجزًا؛ إِذْ لا مفرّ من وجودها في الشِّعْر، ومن ثم فهي جزء من الصنعة الشِّعْرية التي يمكن للشاعر اكتسابها. غير أنه لا ينبغي أن نفترض على الفور -كما يفعل غرونباوم- أنّ الإعجاز عند الباقلاني غير قابل للإثبات من الناحية الجمالية؛ فالفلسفة والحكمة البالغة لا تمنعانه بأيّ حال من الأحوال من الإقرار بأنّ الإعجاز يمكن التعليل له من الناحية التجريبية. فهو نفسه يثبت الإعجاز بشكل تجريبي، لكنه لا يستمدّه من التعبير اللغوي بالمعنى الضيق (اللفظ)، بل -كما يوضح في الباب الخاصّ ببنية الآيات القرآنية- من تركيب الآيات، أي: من النَّظْم.
ولتحقيق هذه الغاية يوضح كيف أنّ الآيات الطوال تنقسم إلى سلسلة من الوحدات الأصغر المستقلّة في الغالب من الوجوه النحوية، تسمى بالكلمات. فوحدة الخطاب المشار إليها هنا ليست نحوية مجرّدة، بل هي وحدة ذات بُعد بلاغي أكثر. لم يبرّر الباقلانِي إدخال هذا الاصطلاح في أيّ موضع، ولم يقدِّم تعريفًا أكثر دقّة له في أيّ مكان، ولم يورِد حتى أيّ دلائل على الكلمات. ومع ذلك، يمكن للقارئ تحديدها بسهولة؛ إِذْ يحدّد الباقلانِي عدد الكلمات في حوالي 20 آية قرآنية.
ويبدو أنّ الباقلانِي لم يكن مستقلًّا فحسب في تقديمه لمصطلح (الكلمة)، بل لا توجد أيضًا -على حدّ علمي- أية سابقة موضوعية أو عملية لوحدة الكلام التي يعرفها، ولا يُظهِر تقسيم الكلمات أيّ تجانس مع التقسيم الداخلي للآيات، كما يُمارس في التلاوة من خلال أنواع الوقف المتعدّد، إِذْ إن وحدات التلاوة أطول، وعادةً ما تشمل العديد من الكلمات طبقًا للنهج الباقلاني؛ لذا يُرجَّح أنه توصّل إلى تقسيمه هذا اعتمادًا على معايير نحوية ودلالية فقط.
وما يتعجب منه الباقلاني يتمثّل في انفراد كلّ كلمة بنفسها، إِذْ يثني على نحو يبعث على الدهشة تحديدًا على تلك الكلمة التامة المنفصلة المتباينة من جهة النحو عن الكلمة التي تسبقها. وبذلك يُحيل الباقلاني القرآن إلى الذَّوْق الشِّعري المعهود: الإيجاز اللطيف بما لا يفسده الاختصار ولا يُعميه التخفيف، بل مما يزيده الاختصار بسطًا لتمكّنه ووقوعه، ويتضمّن الإيجاز منه تصرّفًا يتجاوز محله وموضعه. ففي التصنيف الأدبي التقليدي لأنواع الشِّعْر، كان الثناء للأبيات التي تكون أشطارها مستقلّة في دلالتها، تامة في معناها. فهل كان الباقلاني في انتصاره للكلمة المنفصلة تابعًا فحسب للذوق العربي المتعارف عليه في الحكم على الشطر الشعري، أم كان يُمثَّل أمام ناظِرَيْه أيضًا تجسيد واقعي لهذه الكلمة؟ ويمكن الإجابة عن هذا السؤال على الأرجح. فهذه العبارات الختامية للآيات، التي عادةً ما تأتي دون أدوات تربطها بما قبلها، وغالبًا ما تشكّل وحدات مستقلّة من حيث محتواها عن ما سبقها. وهذا في الغالب يتوافق مع نوع الكلمة الذي كان الباقلاني يعلي من شأنه كثيرًا، بينما نادرًا ما تتحقّق هذه الشروط داخل أجزاء من الآية. ويكاد لا يوجد شك في أن الباقلاني كان يقصد بنـوع الكلمة الذي يحبذه في المقام الأول، هذا العنصر الذي يميز الخطاب القرآني.
واستنادًا إلى بنية الكلِمات يرى الباقلاني أنّ الآيات القرآنية تنقسم إلى نوعين؛ الأول: آيات قصار، مكوَّنة من وحدة واحدة أو وحدتين تركيبيّتين داخل الآية، أي: كلمة واحدة أو كلمة مع فصلة. والثاني: آيات طوال متعدّدة الوحدات، تتكون من ثلاث كلمات أو أكثر. ويقوم الباقلاني بهذا التقسيم دون تقديم أيّ شرح إضافي. ومع ذلك يمكننا أيضًا استنتاج مثل هذا التفسير؛ فهذا التقسيم لم يأتِ اعتباطًا: فالآية القرآنية المكوَّنة من وحدتين تتوافق من حيث طولها المتوسط والوقف الواضح بين الشطرين مع أبيات القصائد في الشعر العربي القديم. وبناءً عليه، يمكن مقارنة الآية المكوَّنة من وحدة واحدة مع الشطر الواحد من البيت في القصائد العربية القديمة. أمّا الآيات القرآنية الطوال، فلا تمتلك مكافئًا كميًّا أو تركيبيًّا في أيٍّ من الأنواع الأدبية الأخرى. ويمكننا أن نفترض أنّ هذا التوافق مع الطول الشِّعْري في العروض، الذي كان حاسمًا في الذوق الفني عند العرب، هو ما دفع الباقلاني إلى أن يميّز الآية المكوَّنة من وحدة أو وحدتين ويخصصها كفئة مستقلة، وربما لم يكن الباقلاني على دراية بهذا المعيار. ويمكن تفسير انتشار/ تقسيم هذين النوعين من الآيات في القرآن نفسه بطريقة مماثلة. وتقع السور التي تحتوي على آيات مكوَّنة من وحدة أو وحدتين في بداية مرحلة التطور، وتُستعمل هذه الآيات القصيرة في المرحلة المكية المبكرة، أي في فترة كان شكل اللغة القرآنية لا يزال خاضعًا إلى حدّ كبير للمفاهيم الشكلية للعربية القديمة. ومع مرور الوقت، تطورت اللغة القرآنية نحو حرية أكبر واستقلالية أوسع. حتى في المرحلة المكية الوسطى، أصبحت الآيات المكوَّنة من وحدتين أقلّ شيوعًا، أمّا منذ الفترة المكية المتأخرة فلم نصادف سوى الآيات الطوال[29]. وبالتالي فإنّ ثنائية الباقلاني تنطبق أيضًا على مرحلتين حقيقتين من التطور الشكلي للخطاب القرآني.
مع أن تحليل الباقلاني للآيات القرآنية لا يدّعي الشمولية مطلقًا، وخصوصًا أنه لم يشر إلا إلى ملاحظات مهمة، إلا أنه يجب النظر إلى إدخاله لمفهوم (الكلمة)، ولتمييز أنواع الآيات باعتباره تقدّمًا مهمًّا في إدراك بنية اللغة القرآنية.
وكلّ الجوانب التي نُوقشت هنا -وهذا ما أخلص إليه- لا تمثِّل إشكاليات للمتخصّصين عند الباقلاني، وهو لا يملّ من التأكيد أنّ كلّ مؤمن مطالب أن يعي بنفسه تفرّد القرآن، وبهذه الطريقة فقط يكون راسخ الإيمان. وكما يلاحظ الباقلانى نفسه، لا يقدر على إدراك هذا التفرد، ولا على الإتيان بمثله إلا مَن أحاط بمذاهب العربية وغرائب الصنعة. أمّا دونهم -سواء المتأخر في الصنعة أو المتوسط من أهل اللسان- فهم معتمدون على إقرار أهل الصنعة ونقلهم، أنهم عاجزون عن الإتيان بمثله. يبقى السؤال: إلى أيّ مدى كان الباقلاني مدركًا بتداعيات منهجه/ كتابه؟ فهو في الواقع يحدث شرخًا بين فئة قليلة مخصوصة من أصحاب الصنعة في الأدب وسائر الناس، وهو انقسام بين المؤمنين من أهل العلم من أصحاب الصنعة وبين العوام الأجانب عنها، وهذا ما يتعارض تمامًا مع مقصد النبي الأصلي.
[1] العنوان الأصلي للمقالة هو „Das islamische Dogma der 'Unnachahmlichkeit des Korans وقد نشرت فيliteraturwissenschaftlicher Sicht“ in: Der Islam 60 (1983), 166–183.، جدير بالذكر أننا أضفنا لعنوان المقالة كلمة "الإسلامية" باعتباره تقييدًا توضيحيًّا في ضوء اشتغال المقالة، الذي انصب على عرض منظور الكتابات الأدبية في التراث الإسلامي، (قسم الترجمات).
[2] ترجم هذه المقالة، د/ مصطفى حجازي، المدرس بكلية اللغات والترجمة جامعة الأزهر، قسم الدراسات الإسلامية باللغات الأجنبية (اللغة الألمانية)، له عدد من الترجمات المنشورة.
ود/ ديرك هارتفيغ، مدرس الدراسات العبرية والعربية في جامعة برلين الحرّة، والمدير الحالي لمشروع "كوربس كورانيكوم" مشاركة مع أ.د/ مهند خورشيد مدير معهد الدراسات الإسلامية في جامعة مونستر.
[3] أنجيليكا نويفرت Angelika Neuwirth (1943-) من أشهر الباحثين الألمان والأوروبيين المعاصرين في الدراسات القرآنية والإسلامية.
أستاذ الدراسات السامية والعربية في جامعة برلين الحرة، درست الدراسات السامية والعربية والفيلولوجي في جامعات برلين وميونيخ وطهران، عملت كأستاذ ومحاضر في عدد من الجامعات، مثل برلين وميونيخ وبامبرغ، كما عملت كأستاذة زائرة في بعض الجامعات مثل جامعة عمان بالأردن وجامعة عين شمس بالقاهرة.
أشرفت على عدد من المشاريع العلمبة منها: مشروع "كوربس كورانيكوم".
ولها عدد من الكتابات والدراسات المهمة في مجال القرآن ودراساته.
من أهمها:
- Der Koran als Text der Spätantike: Ein europäischer Zugang, 2010
القرآن نصًّا من العصور القديمة المتأخرة، مقاربة أوروبية.
وقد ترجم للإنجليزية هذا العام فصدر بعنوان:
The Qur'an and Late Antiquity: A Shared Heritage, 2019
Studien zur Komposition der mekkanischen Suren, 1981-
دراسات حول تركيب السور المكية، وقد ترجمنا لها بعض الدراسات على قسم الاستشراق، يمكن مطالعتها على موقع تفسير، قسم الترجمات.
[4] فيلبي 2: 5- 8.
[5] G.E. von Grunebaum,A Tenth-Century Document of Arabic Literary Theory and Criticism. The Section on Poetry of al-Bāqillānī’s Kitāb Iʿǧāz al-Qurʾān. Chicago 1950, p. XV.
[6] سور العلق والمزمل والأعلى.
[7] Geschichte des Qorans I 21919, p. 82.
[8] سورة المزمل: الآية 4.
[9] Der Koran. Im Auszuge übersetzt von Friedrich Rückert. Hrsg. von August Müller, Frankfurt 1888.
[10] تناولت المؤلفة هذه السِّمَة من سمات الخطاب القرآني بشكل مفصل في مقالة ضمن الكتاب الذي صدر تكريمًا لأنطون شبيتلر/ Anton Spitaler:
Zur Komposition der Yūsuf-Sure. In: Studien aus Arabistik und Semitistik. Wiesbaden 1980, p. 123-152.
قارن أيضًا:
Studien zur Kompositioon der mekkanischen Suren, Berlin 1981, p. 157-166.
[11] تعتبر نويفرت أنّ ثمة فارقًا أساسيًّا بين القرآن والكتاب المقدس، من حيث تأطير الأنواع الأدبية، فبينما نجد أن الكتاب المقدس العبري وكذا الأناجيل بصورة ما، تفصّل الأنواع عن بعضها، فالنبوءة والتاريخ والمثل والأقوال منفصلة في أسفار أو فصول مختلفة، فإنّ القرآن يجمع هذه الأنواع داخل السورة نوعًا أدبيًّا فريدًا. (قسم الترجمات)
[12] تقارن نويفرت في كثير من كتاباتها اللاحقة على هذه المقالة بين طقس القربان في المسيحية وتلاوة القرآن في الإسلام، والغرض من هذه المقارنة الوقوف على الفارق بين نظرة الإسلام والقرآن للوحي وللكلمة، فبينما الكلمة في المسيحية متجسدة وبالتالي يشارك المسيحي فيها عبر طقس تناول دم وجسد المسيح (الافخارستيا)، فإن الكلمة في الإسلام غير متجسدة، بل متعالية، والمشاركة فيها تكون عبر تلاوة الكتاب. (قسم الترجمات)
[13] الاقتباس يرجع إلى عبد الوهاب الشعراني، من كتابه: لواحق الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية (المجلد الأول: ص61)، وهو مأخوذ من:
Louis Massignon, Essai sur les origines du lexique technique de la mystique musulmane, Paris 1954, p.46(1).
[14] Tor Andrae, Die Person Muhammeds in Lehre und Glauben seiner Gemeinde, Stockholm 1918.
[15] Jan Bouman, Le Conflict autour du Coran et la solution d’al-Bāqillānī, Amsterdam 1959.
[16] EI2 III, 1018-1020 (1970).
[17] Abdul Aleem, ʿIjazu ´l-Qur‘an (sic). In: Islamic Culture VII/1933/p. 64-82, 215-233.
[18] Tor Andrae, Die Person Muhammads in Lehre und Glauben seiner Gemeinde, Stockholm, 1918.
[19] كتاب خلق القرآن، في: رسائل الجاحظ، للجاحظ، تحقيق: حسن السندوبي، القاهرة، 1352= 1933.
[20] الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كلامها، ابن فارس، القاهرة، 1328 =1910، ص31، 32.
[21] Wolfhart Heinrichs, Literary Theory – the Problem if Its Efficiency. In: Arabic Poetry. Theory and Development. Hrsg. G.E. von Grunebaum. Wiesbaden 1973, p. 19-69.
[22] النكت في إعجاز القرآن، في: ثلاث رسائل في إعجاز القرآن، علي بن عيسى الرماني، تحقيق: محمد خلف الله - محمد زغلول سلام، القاهرة، 1968، ص75- 113. الكهف: آية 54، طه: آية 113، الأنعام: آية 105، الزمر: آية 27، الأحقاف: آية 27. (تفسير الآيات).
[23] يتطرق الرماني هنا إلى تحديد السمات الداخلية للقرآن في الخطاب القرآني، انظر: سور الإسراء: آية 41، الكهف: آية 54، طه: آية 113، الأنعام: آية 105، الزمر: آية 27، الأحقاف: آية 27. (تفسير الآيات).
[24] استخدام مصطلح التضمين عند الرماني لا يتوافق والمعنى المعتاد له (كاستشهاد شعري)، قارن:
G.E. Von Grunebaum, Kritik und Dichtkunst, Wiesbaden 1955, p. 117.
التضمين الذي يقصده الرماني ينشأ من جانب المعنى الديني للوحدات اللفظية الفردية في الآية القرآنية، ومن جانب آخر من دور الآية القرآنية المعنية بوصفها وحدة كاملة/ ككلّ في الشعائر الإسلامية.
[25] بيان إعجاز القرآن، في: ثلاث رسائل في الإعجاز، أبو سليمان حمد الخطابي، تحقيق: محمد خلف الله - محمد زغلول سلام، القاهرة، 1968، ص21- 71.
[26] الإعجاز في القرآن، أبو بكر الباقلاني، تحقيق: السيد أحمد صقر، القاهرة 31972.
[27] انظر أعلاه، هامش رقم 5.
[28] منذ ذلك الحين حاول المؤلِّف إظهار معنى هذه الفقرة في: طريقة الباقلاني في إظهار إعجاز القرآن الكريم، انظر:
Studia Arabica et Islamica. Festschrift for Iḥsān ʿAbbās. Ed. Wadād al-Qāḍī. Beirut 1981, p. 281-296.
[29] حول بنية الآية في القرآن، انظر:
Studien zur Komposition der mekkanischen Suren. Berlin 1981, p. 117-173.
مواد تهمك
-
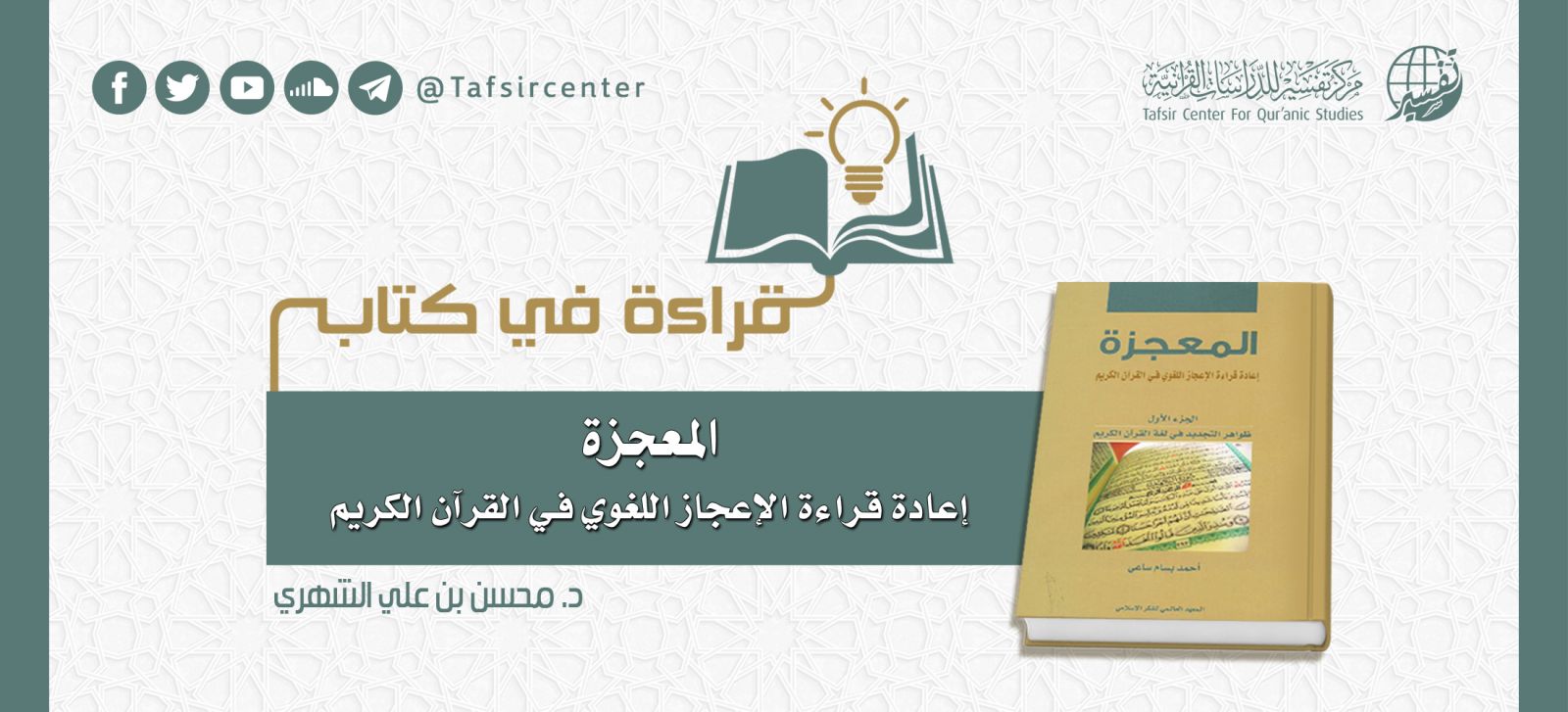 قراءة في كتاب «المعجزة؛ إعادة قراءة الإعجاز اللغوي في القرآن الكريم»
قراءة في كتاب «المعجزة؛ إعادة قراءة الإعجاز اللغوي في القرآن الكريم» -
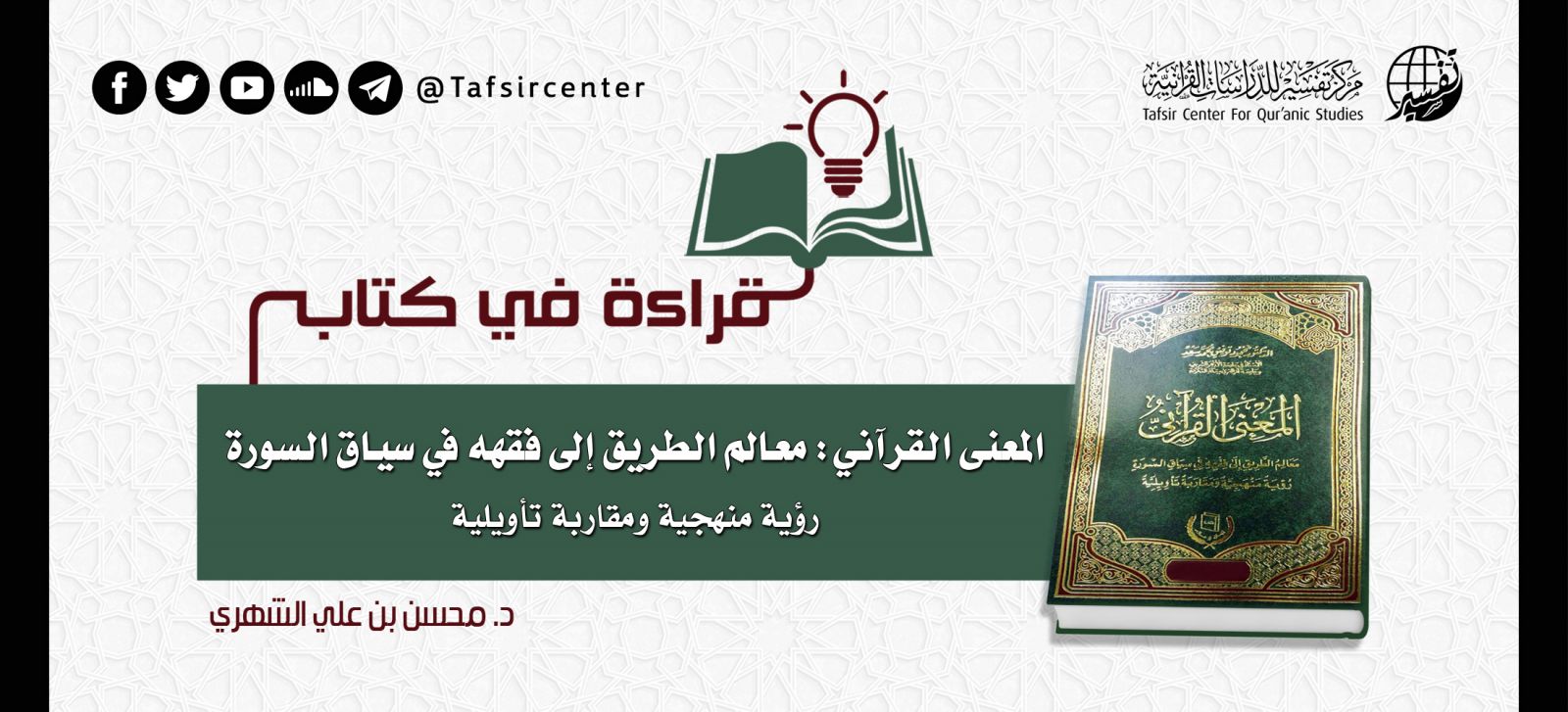 قراءة في كتاب "المعنى القرآني: معالم الطريق إلى فقهه في سياق السورة؛ رؤية منهجية ومقاربة تأويلية"
قراءة في كتاب "المعنى القرآني: معالم الطريق إلى فقهه في سياق السورة؛ رؤية منهجية ومقاربة تأويلية" -
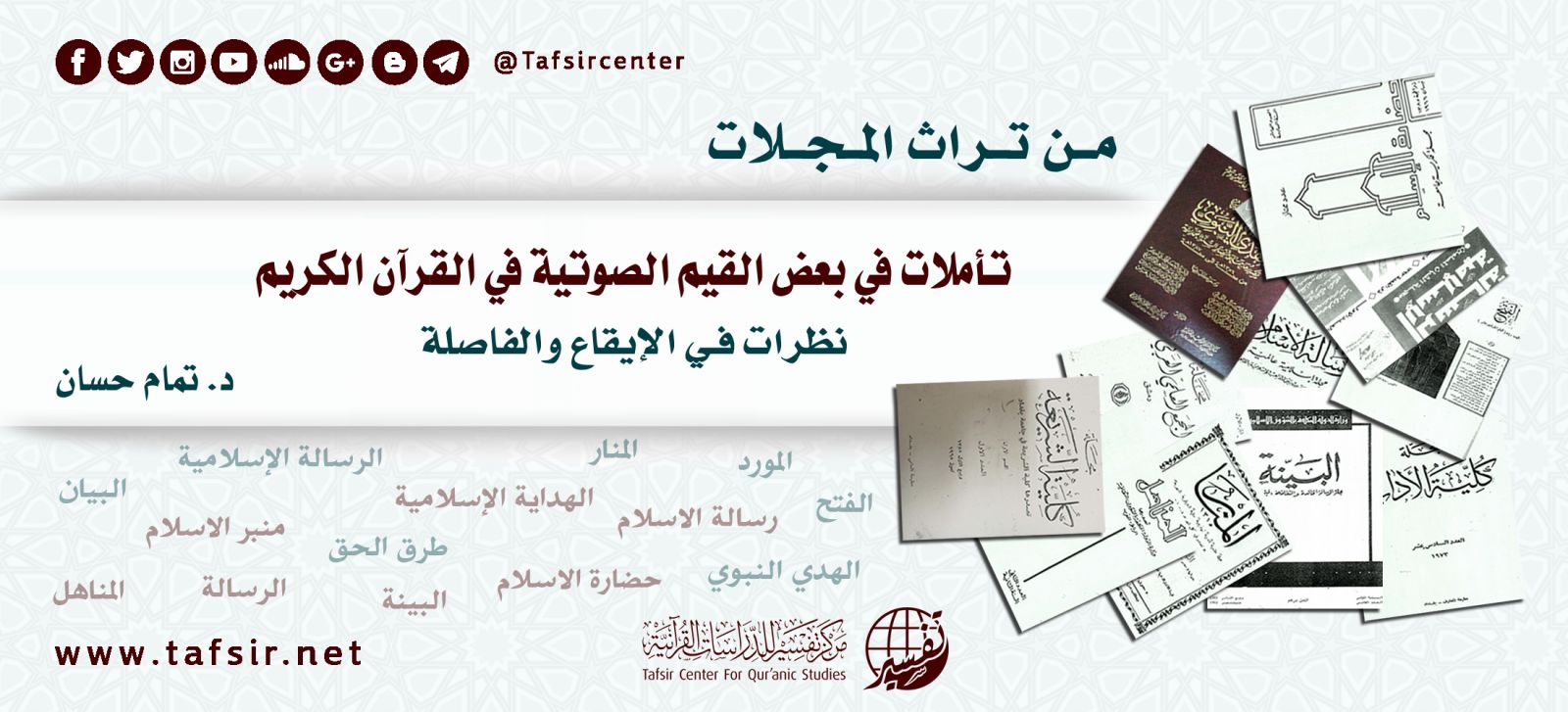 تأملات في بعض القيم الصوتية في القرآن الكريم؛ نظرات في الإيقاع والفاصلة
تأملات في بعض القيم الصوتية في القرآن الكريم؛ نظرات في الإيقاع والفاصلة -
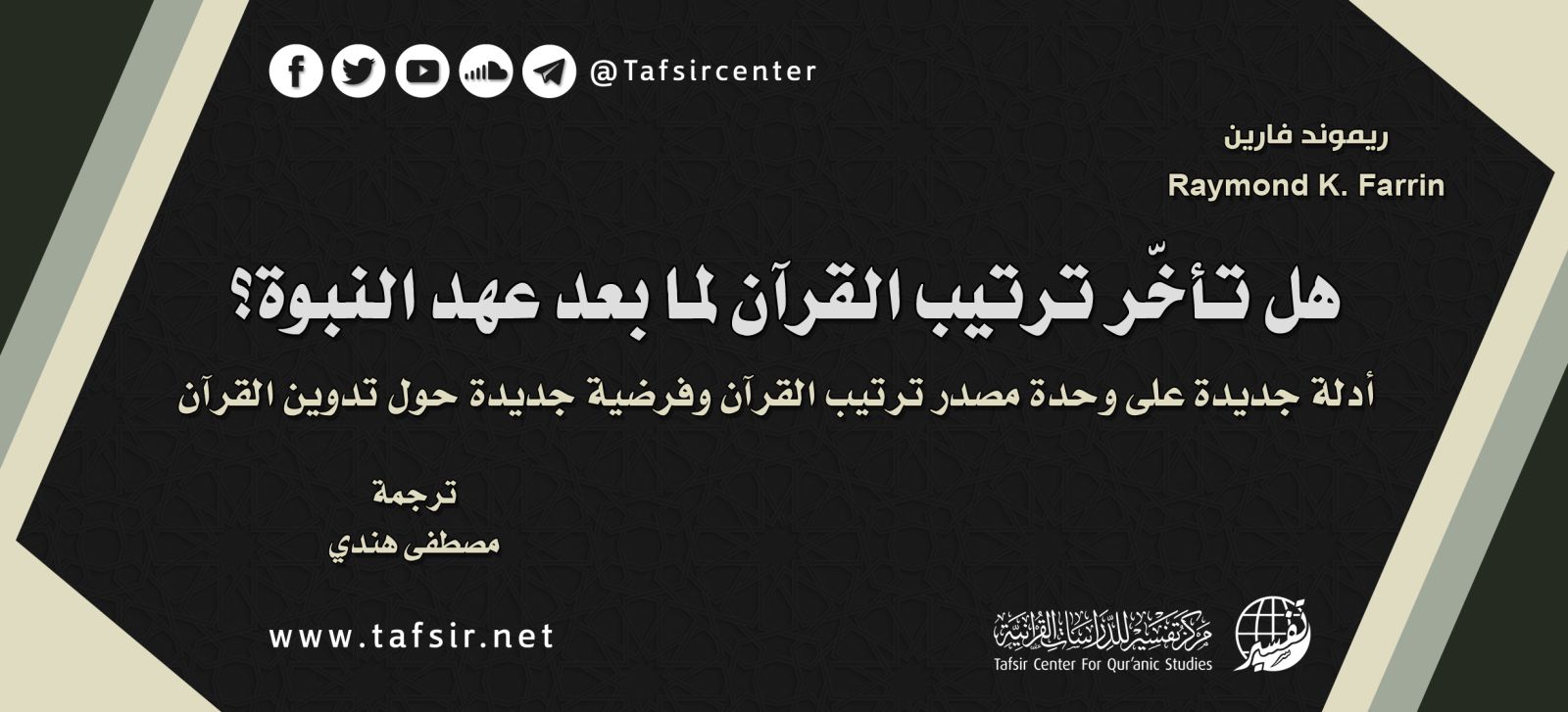 هل تأخّر ترتيب القرآن لما بعد عهد النبوّة؟ أدلة جديدة على وحدة مصدر ترتيب القرآن وفرضية جديدة حول تدوين القرآن
هل تأخّر ترتيب القرآن لما بعد عهد النبوّة؟ أدلة جديدة على وحدة مصدر ترتيب القرآن وفرضية جديدة حول تدوين القرآن -
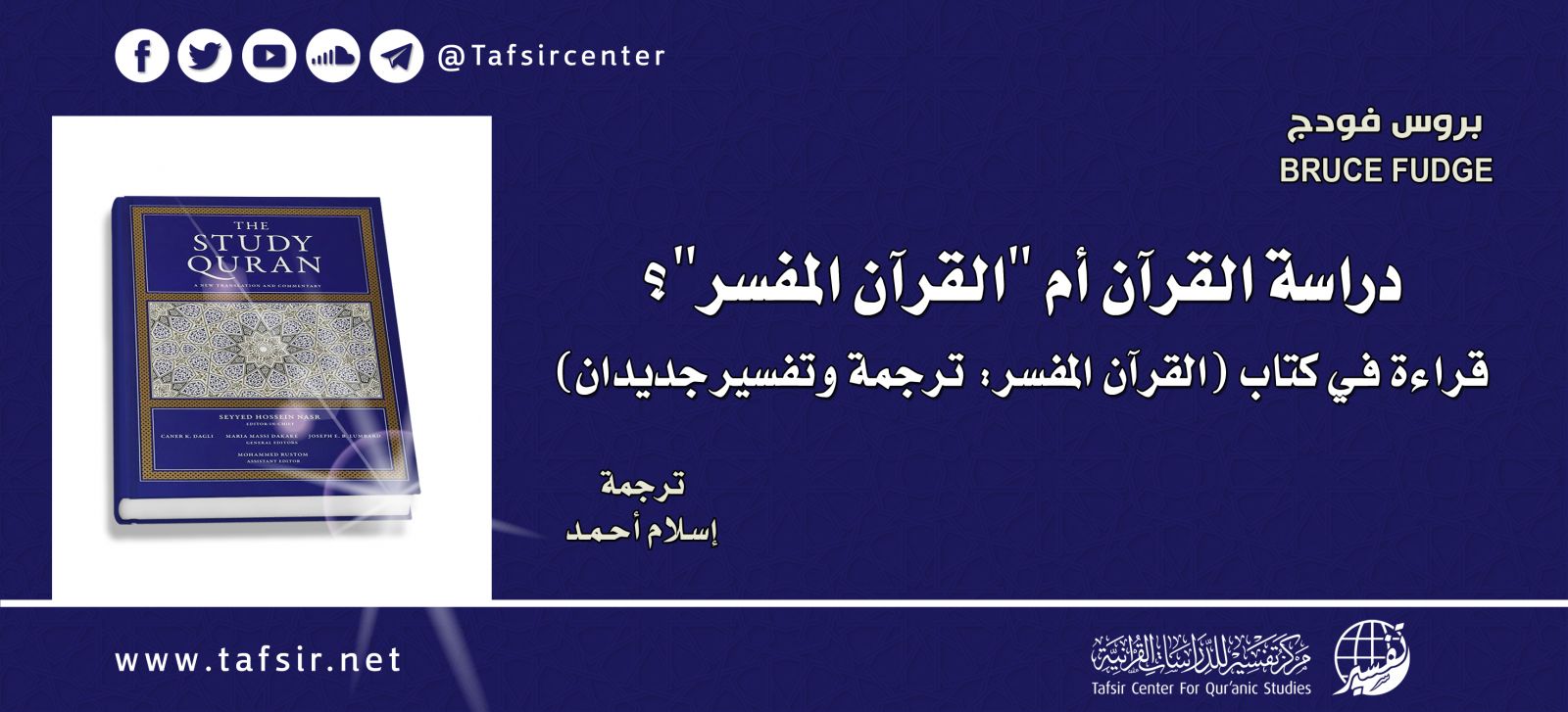 دراسة القرآن أم "القرآن المفسّر"؛ قراءة في كتاب (القرآن المفسّر: ترجمة وتفسير جديدان)
دراسة القرآن أم "القرآن المفسّر"؛ قراءة في كتاب (القرآن المفسّر: ترجمة وتفسير جديدان)


