المنشورات الحديثة في المجلات العلمية الغربية المتخصّصة في الدراسات القرآنية
ملخصات مترجمة
الجزء الثاني والأربعون
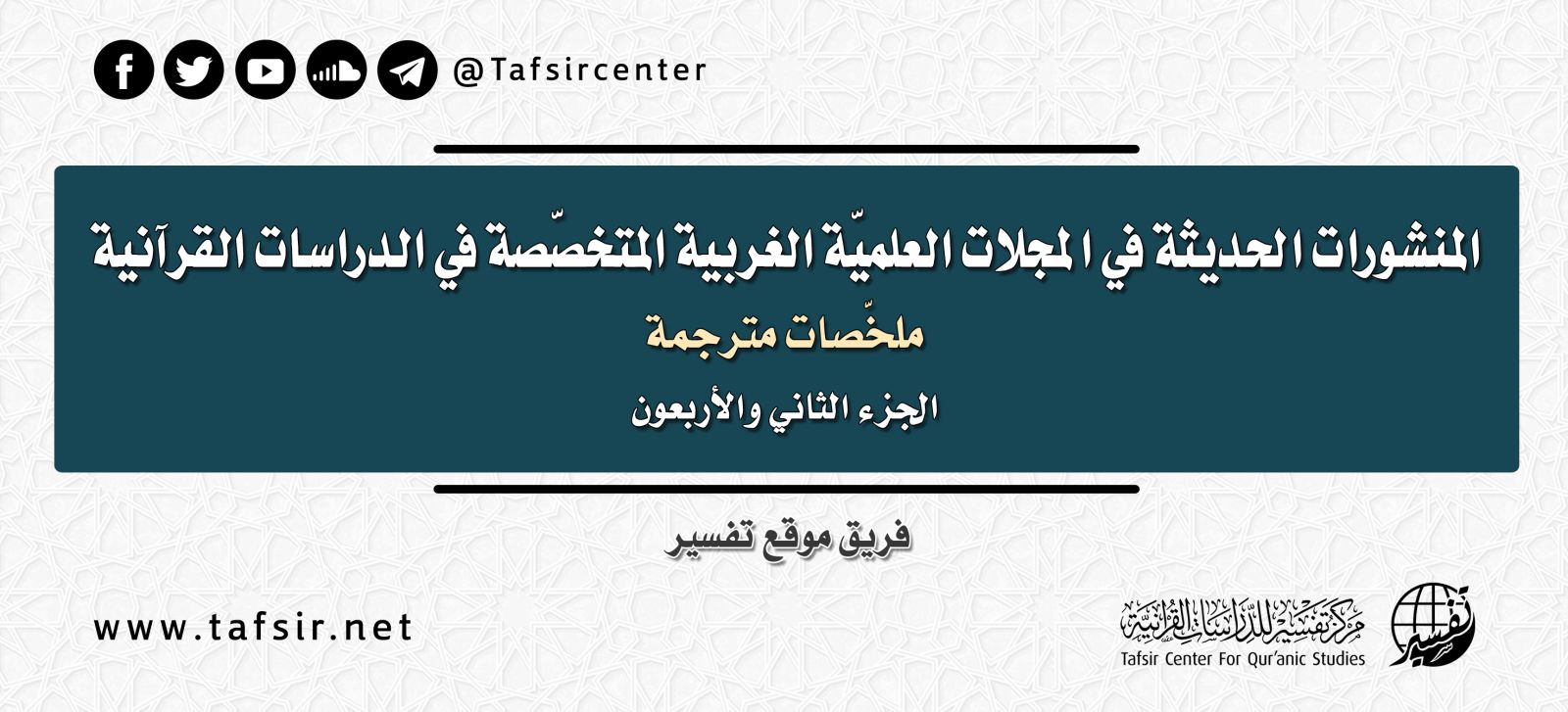
هذه المقالة هي الجزء (42) من ترجمة ملخَّصات أبرز الدراسات الغربية المنشورة حديثًا[1]، والمنشورة في بعض المجلات الغربية، والتي نحاول من خلالها الإسهام في ملاحقة النتاج الغربي حول القرآن الكريم ومتابعة جديدِه بقدرٍ ما، وتقديم صورة تعريفية أشمل عن هذا النتاج تتيح قدرًا من التبصير العامّ بكلِّ ما يحمله هذا النتاج مِن تنوُّع في مساحات الدرس.
1- What Were the Most Popular tafsīrs in Islamic History? Part 1: An Assessment of the Manuscript Record and the State of tafsīr Studies
Samuel J. Ross
Journal of Qur'anic Studies, Volume 27, Issue 1, 2025
ما أشهر التفاسير في التاريخ الإسلامي؟ الجزء الأول: تقييم سجلّ المخطوطات وواقع دراسات التفسير[2]
صامويل روس
حتى الآن، واجَه مجالُ دراسات التفسير تحدياتٍ عديدةً أعاقت قدرته على إنتاج مخطط تاريخي موثوق لهذا العلم. تشمل هذه التحديات: 1- ضخامة المصادر؛ سواء من حيث العدد الهائل من الأعمال أو طول كلّ منها. 2- حقيقة أنّ الغالبية العظمى من الأعمال ما تزال متاحة فقط في شكل مخطوطات. 3- ميل الدراسات السابقة إلى التركيز على الفترة (الكلاسيكية)، تاركةً تقاليد التفسير ما بعد الكلاسيكي دون استكشاف كبير، وخاصةً الحواشي. 4- معرفتنا المحدودة بالأعمال التي كانت شائعة تاريخيًّا، ومتى وأين ولِـمَن.
تُشارك هذه المقالة نتائج مشروعٍ استمر لسنواتٍ لتحويل أهمّ فهرس موحد لمخطوطات التفسير العربية (الفهرس الشامل) إلى قاعدة بيانات قابلة للبحث، واستخدام هذه القاعدة للطرحِ والإجابة عن أسئلةٍ كان من الصعب استكشافها حتى ذلك الحين. تشمل هذه الأسئلة: 1- ما أكثر التفاسير شيوعًا على مرّ العصور للقرآن، كما يُشير إليه عدد المخطوطات الموجودة وتوزيعها الجغرافي اليوم؟ 2- إلى أيّ مدى درس الباحثون الأكاديميون هذه الأعمال؟ يُؤمل أن تُساعد هذه النتائج هذا المجال في التخطيط للمشاريع العلمية المستقبلية، وفي نهاية المطاف، في وضع مخطط أكثر موثوقية لتراث التفسير.
2-What Were the Most Popular tafsīrs in Islamic History? Part 2: A Preliminary Profile of the Top 50 works and their Authors
Samuel J. Ross
Journal of Qur'anic Studies, Volume 27, Issue 1, 2025
ما أشهر التفاسير في التاريخ الإسلامي؟ الجزء الثاني: لمحة أولية عن أشهر خمسين تفسيرًا ومؤلّفيها
صامويل روس
يسعى هذا المقال (الجزء الثاني) إلى تقديم لمحة أوّلية عن أفضل خمسين كتاب تفسير ومؤلّفيها. يدرس الأنماط الجغرافية -والتسلسل الزمني- التي تميز هذه الكتب واسعة الانتشار، ويستكشف كيف حقّقت هذه الأعمال شهرتها. ويختتم الجزء الثاني بأسئلة جديدة في هذا المجال، وينظر في الأهمية المحتملة لأفضل خمسين كتاب تفسير لمجال الدراسات القرآنية الأكاديمية نفسه.
3- An Early Ḥijāzī Qur’an Fragment at the Dār al-Kutub and its Berlin Counterpart
Abdallah El-Khatib
Qatar University
Ahmed W. Shaker
Journal of Qur'anic Studies, Volume 27, Issue 1, 2025
قطعة قرآنية حجازية مبكّرة في دار الكتب ونظيرتها في برلين
عبد الله الخطيب وأحمد شاكر
تتناول هذه الورقة البحثية مخطوطتين قرآنيتين حجازيتين قديمتين محفوظتين في دار الكتب بالقاهرة (رقم المخطوطة ٢٤٧ مصاحف)، ومكتبة برلين الحكومية (رقم المخطوطة ٤٣١٣). تبدأ الورقة باستعراض عام للخصائص العامة للمخطوطة، يليه تحليل لأصولها ومصدرها. وتغطّي أوصاف المخطوطات أبعادها، ولونها، وخصائصها الكتابية، ورسمها (الإملاء)، ونظام التعابير، وعلامات التشكيل، وعدد السطور، وأنماط الكتابة. يوفر التحليل الكتابي والإملائي، المدعوم بالتأريخ بالكربون المشعّ (C14) =رؤى ثاقبة حول تأريخها. نُسِبَت المخطوطات في البداية إلى القرن التاسع من قِبل برنهارد موريتز ورودولف سيلهايم، ثم أُعِيدَ النظر فيها لاحقًا من قِبل أدولف غروهمان وسيرجيو نوسيدا، اللذين اقترحَا تأريخها إلى القرن الأول/ السابع. وقد ضيّق التأريخ بالكربون المشعّ للمخطوطة أور. فول 4313 -الذي أجراه مشروع كوربوس كورانيكوم- هذا التاريخ إلى الفترة 15- 30هـ/ 606- 652م.
4- The Qur’an in South Asia: Hermeneutics, Qur’an Projects, and Imaginings of Islamic Tradition in British India By Kamran Bashir
Bruce B Lawrence
Journal of Islamic Studies, Volume 36, Issue 3, September 2025
القرآن الكريم في جنوب آسيا: التأويلات، ومشاريع قراءة القرآن، وتصوّرات التقاليد الإسلامية في الهند البريطانية. بقلم كامران بشير
بروس لورانس
تُعدّ دراسة تفسير القرآن، موضوعًا راسخًا، داخل الأوساط الأكاديمية الأوروبية الأمريكية وخارجها. وقد كتب عنه الكثيرون، سواء كانوا علماء مسلمين أو غير مسلمين، مدافعين عنه أو نقادًا له، كتابة متخصِّصة أو عامّة. ومع ذلك، لم يُحدّد أحدٌ طوال القرن -من منتصف القرن التاسع عشر إلى منتصف القرن العشرين- نطاق بحثه لنقاش وضع النصّ الإسلاميّ الأساسيّ وتفسيره في شبه القارة الآسيوية. تتطلّب هذه الدراسة إتقانًا للغة العربية الفصحى والفارسية والأردية، ومجموعةً من الشروح باللغات الثلاث -العربية والفارسية والأردية- فضلًا عن الانخراط في المناهج التاريخية، بالإضافة إلى النظريات النقدية حول الترجمة والتفسير. كما تتطلّب، بالطبع، إجادةً ممتازةً للّغة الإنجليزية الأكاديمية، وهو أمرٌ ليس مُسلّمًا به لكثيرٍ من الباحثين الذين يكتبون باللغة الإنجليزية ممن ليسوا ناطقين بها كلغةٍ أصلية. في ضوء هذه المتطلبات الأساسية الهائلة، قام كامران بشير بتحليل هذا المجال ببراعة، محددًا الفاعلين الأساسيّين وأفضل السّبل لتقديم إسهاماتهم. وبينما كتب آخرون دراسات تحليلية لإحدى القضايا التي يواجهها، لم يقم أحد بدراسة قرنٍ كامل من الاستعمار البريطاني في جنوب آسيا، ثم وَضْع المفسرين المسلمين الهنود (وكذلك، بعد عام ١٩٤٧، المفسرين المسلمين الباكستانيين) في حوار بعضهم مع بعض، وكذلك مع الباحثين المعاصرين في أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية، هذا المقال يقدِّم عرضًا لكتاب بشير وبيانًا لأهميته.
[1] يمكن مطالعة الجزء السابق على هذا الرابط: tafsir.net/paper/88.
[2] تعريب عناوين المقالات والبحوث هو تعريب تقريبي من عمل القِسْم. (قِسم الترجمات)


