الاستشراق والدراسات القرآنية (1- 2)
الاستشراق؛ مفهومه ونشأته وتاريخه
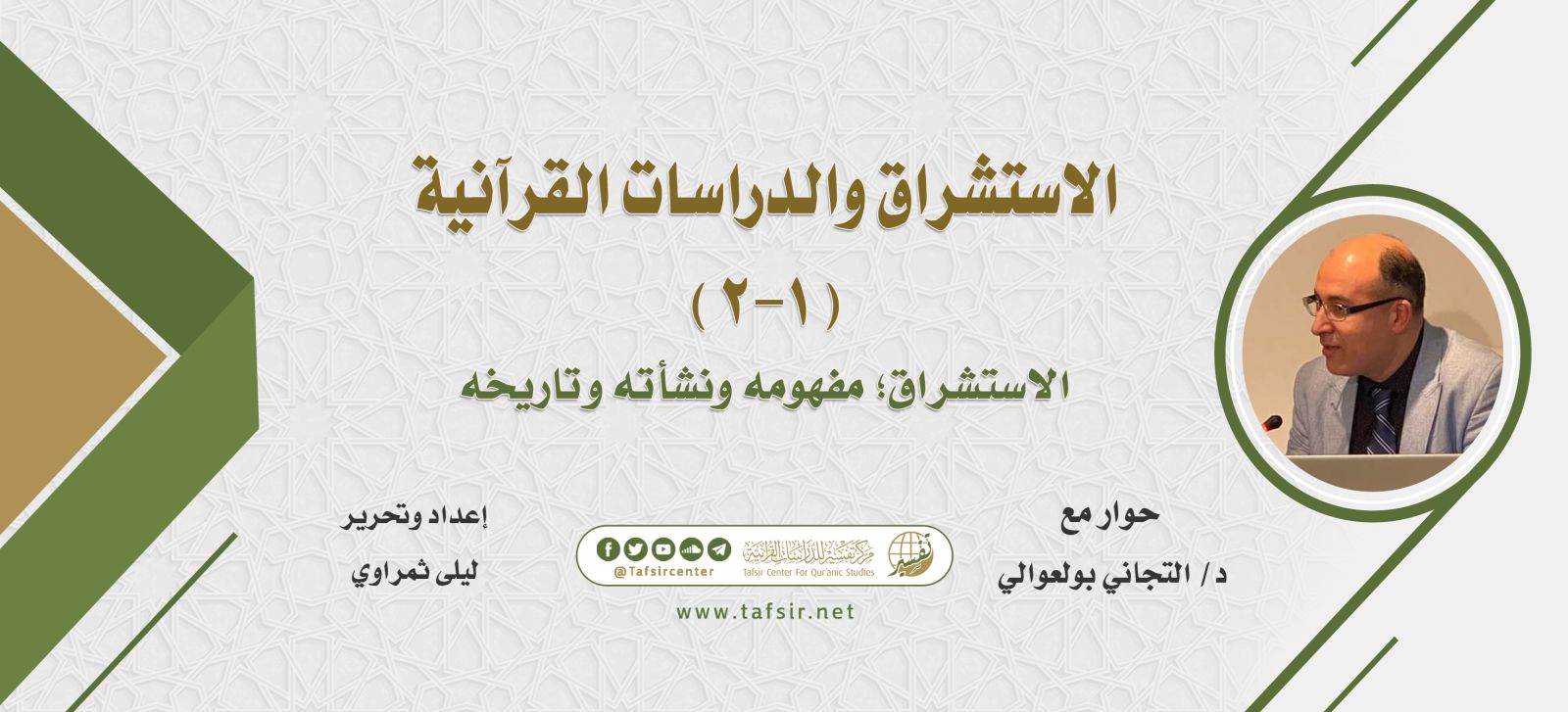
مقدمة:
يمثّل الاستشراق ظاهرة معرفية وسياسية مهمّة في تاريخ العلاقة بين الشرق والغرب، وقد أصبح نتاجُ الاستشراق حول الشرق والإسلام والقرآن جزءًا من الخريطة المعرفية المعاصرة لدراستهم، مما يحتِّم علينا محاولة فهم الظاهرة وطبيعتها وحدودها وطُرُق التعاطي المعرفي معها. وقد خضع الاستشراق لعديد من الدراسات، وحظي بالتناول المعمَّق شرقًا وغربًا، وعرف الكثير من المقاربات لتحديده مفهوميًّا وتاريخيًّا، وتتبّع مراحله، وتعيين طُرق قراءته والتفاعل معه.
يتناول هذا الحوار الذي أجرته الأستاذة ليلى ثمراوي مع الدكتور التجاني بولعوالي، ظاهرةَ الاستشراق والدراسات القرآنية الغربية، وينقسم إلى محورين؛ الأول: الاستشراق، والمحور الثاني: دراسات القرآن الغربية؛ هذا الجزء من الحوار هو المحور الأول، ويتناول مفهوم الاستشراق، ومحاولات تحديدها، ومقاربات دراسته شرقًا وغربًا، كما يُلْقِي الضوء على التطوّر الذي شهده الاستشراق مع ما يُعرف بالاستشراق الجديد؛ فيتناول الطبيعة المنهجية والمعرفية لهذا الاستشراق الجديد، وهل يمثِّل استمرارًا للاستشراق التقليدي، أم يمثِّل قطيعةً معه، وما ملامح الاتفاق والاختلاف بينهما.
المحور الأول: الاستشراق.. بين التأسيس التاريخي والتحوّل المعرفي:
س1: هل يمكن اعتبار بداية تَعَرُّف الأوروبيين على الثقافة الإسلامية في الأندلس لحظة التأسيس الفعلية للاستشراق، أم أنّ قرار مجمع فيينّا في القرن الرابع عشر يمثِّل التحوّل الفعلي الأول؟
د/ التجاني بولعوالي:
من خلال اشتغالنا بحقل الاستشراق، وجدنا أنّ الباحثين يختلفون إلى حدّ كبيرٍ حول الانطلاقة الفعلية لهذا الحقل المعرفي، ومن ثَمَّ بداية اهتمام الأوروبيين وتعرّفهم على الثقافة الإسلامية. وإذا كان المستشرق الفرنسي مكسيم رودنسون يُرجِع -في كتابه: (جاذبية الإسلام)- ظهور مصطلح (الاستشراق) إلى سنة 1779م، حين استُخدم لأول مرة في اللغة الإنجليزية، فإنّ الظاهرة الاستشراقية كمفهوم وسلوك أقدم من ذلك بكثير؛ إِذْ ثمة من يربط بدايتها بالحروب الصليبية التي انطلقت سنة 1049م، ومن يقرنها بقرار مجمع فيينّا في القرن الرابع عشر، الذي قضى بإنشاء كراسي لتعليم اللغة العربية في الجامعات الأوروبية، ومنهم من يُعيد بدايتها إلى حملة نابليون على مصر عام 1798م. وقد أشار إدوارد سعيد إلى أن جذور الاستشراق تعود إلى التراث والآداب اليونانية.
كما يمكن أن نضيف هنا الاهتمام المبكِّر بالإسلام في المصادر المسيحية واليهودية، والذي بدأ منذ ظهوره، ونجد ذلك في ما يُعرف بـ(الوثائق الخارجية) التي أُلِّفَت منذ عام 634م على يد رهبان ولاهوتيين من خلفيات مسيحية ويهودية، وبمختلف اللغات؛ كالعِبرية، والآرامية، والقبطية، والفارسية، واليونانية. وقد امتدّ هذا الاهتمام الكتابي عبر تاريخ الإسلام، في دمشق وبغداد ومصر والأندلس وغيرها.
وقد أضفتم في سؤالكم لحظة تاريخية مهمّة، وهي الاحتكاك السياسي والمعرفي الذي تم بين المسلمين والأوروبيين، وهي مرحلة الأندلس. وأعتقدُ شخصيًّا أن البداية الفعلية لاكتشاف أوروبا المسيحية للإسلام لا تتعلّق بلحظة تاريخية محدّدة، بقدر ما أن هذه اللحظات تضافرت كلّها مجتمعة لتزويد الأوروبيين بجوانب من الحضارة الإسلامية. ومع مرور الوقت، توفّرت لدى الدوائر السياسية والأكاديمية معرفة واسعة بتاريخ الإسلام وعلومه وفنونه وشعوبه وبلدانه. وهكذا تحقّق نوع من التراكم المعرفي، حيث شكَّل ما تركه المسيحيون الأوائل من وثائق ومؤلّفات حول الإسلام -عشية ظهوره أو أثناء احتكاك المسلمين بالمسيحيين في البلدان التي فتحوها أو لاحقًا خلال الحروب الصليبية أو المرحلة الأندلسية- أرضيةً لمن جاء بعدهم من المستشرقين واللاهوتيين والمترجمين. هؤلاء لم يبدؤوا من الصفر، بل أسّسوا اشتغالهم بالإسلام على ما خلّفه أسلافهم. وقد اتّضح ذلك في قرار مجمع فيينّا في القرن الرابع عشر بتأسيس كراسي اللغة العربية والدعوة إلى ترجمة القرآن لأهداف جدلية وتبشيرية. وبحلول القرن الثامن عشر، حيث اشتدّ عُود عِلْم الاستشراق، نقل المستشرقون مباحث اللغة العربية والعلوم الإسلامية إلى رواق الجامعات، فأسّسوا تخصّصات الدراسات العربية والإسلامية وترجمة القرآن، وعمّموها على مُعْظَم الجامعات الأوروبية التي كانت مشهورة في تلك المرحلة.
س2: كيف يمكن التمييز بين الظهور العفوي للاستشراق والظهور المؤسّسي له؟ وما أهمية قرار مجمع فيينّا في هذا السياق؟
د/ التجاني بولعوالي:
إذا كانت جذور الاهتمام الكتابي بالإسلام تشكِّل الظهور المبكّر للاستشراق (بالقوّة) أو (بعفوية) إن صح التعبير، فإنّ ظهوره الحقيقي (بالفعل) أو (كمؤسّسة قائمة) قد تحقّق لاحقًا. فهناك طيفٌ واسع من الباحثين، كما تمّت الإشارة آنفًا، يَعْتَبِر أنّ الاستشراق الفعلي كحقل معرفي مؤسّس ومنظّم بدأ في القرن الثامن عشر، مع نشوء دراسات أكاديمية متخصّصة في مختلف المجالات المرتبطة بالشرق، وخاصّة الإسلام.
ومع ذلك، لا يمكن تجاهل أهمية قرار مجمع فيينّا سنة 1312م بإنشاء كراسي للّغة العربية والفارسية والعِبْرية، وهو القرار الذي أسهم في الانتقال التدريجي من الاهتمام اللاهوتي الجدلي بالإسلام إلى تأسيس أكاديمي نِسبي للدراسات العربية والإسلامية. فرغم الهيمنة المطلقة للطابع الجدلي الاعتذاري في الدراسات الاستشراقية التقليدية حتى القرن الثامن عشر على العموم، فإنّ المدرستَيْن الاستشراقيتَيْن الألمانية والهولندية قدّمتَا أعمالًا أكاديمية مهمّة في تناولها لقضايا الإسلام؛ كدراسة القرآن الكريم، والنبي محمد صلى الله عليه وسلم، والفقه، والحديث، والعقيدة، فضلًا عن اللغة العربية، لكنها لم تكن خالية تمامًا من النزعة الجدلية والدفاعية عن المسيحية.
وعلى الرغم من أنّ مصطلح (الاستشراق) له تاريخ يتجاوز القرنَيْن، ومفهومه ضارب في عمق التاريخ، فإنه لا يزال يعاني من الغموض والتداخل المفاهيمي؛ إِذْ لا يمكن إدراج كلّ ما يتعلّق بالشرق ضمن إطار موحّد، خاصّة أنّ الحضور الجغرافي والثقافي للإسلام لا يقتصر على المنطقة العربية أو ما يُعرف بالشرق الأوسط، بل يمتد إلى جنوب أوروبا (الأندلس وصقلية)، وآسيا (إندونيسيا، ماليزيا، الصين، الهند).
كما أنّ المجالات التي اشتغل بها المستشرقون متعدّدة ومعقّدة، ما أدى إلى ظهور تخصّصات جديدة تُعْنَى بكلّ مجال على حِدَة، فظهر (علم الاستغراب) الذي يهتمّ -من منظور عربي وإسلامي- بدراسة الغرب، و(علم الاستعراب) الذي يختصّ بالدراسات العربية، و(علم الاستمزاغ) المعنيّ بالثقافة الأمازيغية في شمال إفريقيا، و(علم الاستتراك) المتخصّص في الدراسات التركية، و(علم الاستفراق) الذي يتناول الدراسات الإفريقية. ويمكن لهذا التنويع -كما أعتقدُ شخصيًّا- أن يسهم في الحد من غموض مصطلح (الاستشراق) وهلاميّته.
س3: كيف تقارن النظرة الغربية التأريخية لبداية الاستشراق بالنظرة العربية، وهل توجد بداية أخرى أكثر دقّة يمكن ترجيحها علميًّا؟
د/ التجاني بولعوالي:
أبدأُ بالمنظور العربي في التأريخ لبداية الاستشراق، لا سيّما بعد كتاب: (الاستشراق)، لإدوارد سعيد، فهو غالبًا ما يربط الاستشراق بالمشروع الاستعماري والهيمنة الإمبريالية الغربية. وفي المقابل، تميل الرؤية الأوروبية والغربية إلى اعتبار القرن الثامن عشر بداية فعلية لهذا الحقل؛ وذلك لتقاطع عدّة عوامل سياسية، وأكاديمية، ومفاهيمية: سياسيًّا، مع حملة نابليون على مصر؛ وأكاديميًّا، مع ظهور دراسات استشراقية رصينة؛ ومفهوميًّا، مع صياغة مصطلح (الاستشراق) في اللغة الإنجليزية.
أمّا بخصوص نظرتِي الشخصية، فأعتقدُ أن الموضوع مركّب، تتداخل فيه العوامل التاريخية والمفاهيمية والمنهجية. لذلك، يمكن التمييز بين جذور الاستشراق المبكّرة، التي بدأت مع الاهتمام الكتابي بالإسلام منذ ظهوره، وامتدّت في محطات لاحقة إلى فتح الأندلس والحروب الصليبية، وهو (حضور بالقوة) أو (عفوي). في المقابل، يمكن الحديث عن (الحضور المنظّم والمؤسّسي) للاستشراق في محطات متفرّقة، منها: ترجمة القرآن الكريم إلى اللاتينية عام 1143، ترجمة أعمال ابن رشد، قرار مجمع فيينّا بإنشاء كراسي للّغات الشرقية عام 1312، وأخيرًا حملة نابليون على مصر سنة 1798، التي شارك فيها عشرات العلماء والمستشرقين.
س4: كيف تطوّر تعريف الاستشراق من كونه دراسة للشرق إلى كونه أداة للهيمنة؟ وما الأثر الذي أحدثه كلٌّ من إدوارد سعيد وأنور عبد المالك في تغيير هذا المفهوم؟ ثم كيف أسهم وائل حلاق في تعميق هذا التحوّل؟ وهل يمكن اعتبار كلٍّ من إدوارد سعيد ووائل حلاق ممثلين للاتجاه الاستشراقي الجديد؟
د/ التجاني بولعوالي:
ظلّ الاستشراق لزمن طويل يشكِّل مادةً خامًا في شكل دراسات ومؤلَّفات محفوظة في أروقة المكتبات الأكاديمية الغربية، وإلى حدّ ما في السياقات الجامعية العربية. وقد مَثّلَت هذه الدراسات مصادر أساسية لعددٍ كبيرٍ من الطلبة والباحثين والكُتّاب العرب والمسلمين طوال القرن العشرين. وعادةً ما كانت هذه المصادر تُتلقّى إمّا بالقبول التام أو بالرفض المطلق، ما أسفر عن تشكُّل ثلاثة تيّارات رئيسة:
❖ التيار الأول: تأثَّر بأساتذته من المستشرقين؛ كما هو الحال لدى طه حسين، وأحمد أمين، وحسين مؤنس، وزكي نجيب محمود، وغيرهم.
❖ التيار الثاني: وهو التيار المهيمن؛ تبنّى موقفًا رافضًا لكلّ ما يأتي من أوروبا المسيحية والاستعمارية.
❖ التيار الثالث: اتخذ موقفًا وسطًا؛ فاستفاد من منجزات الحضارة الغربية في مجالات التكنولوجيا والصناعة، دون أن يتبنّى القيم الغربية المتأرجحة بين المسيحية، والعلمانية، والحداثة.
وتجدر الإشارة إلى أنّ التيار الرافض للتراث الاستشراقي الغربي حول الإسلام لم يتبلور بشكلٍ متكامل وواضح إلا مع صدور كتاب المفكّر إدوارد سعيد: (الاستشراق)، سنة 1978، الذي مَثّل نقطة تحوّل حاسمة. فقد اعتبر سعيد -إلى حدٍّ من التعميم- أنّ الاستشراق مشروع أيديولوجي استعماري، وأداة من أدوات الهيمنة الغربية على الشرق عمومًا، والعالم الإسلامي خصوصًا. وهذا الطرح أعاد تعريف الاستشراق؛ فبَعد أن كان يُنظر إليه على أنه مجرّد دراسة للغات وآداب وثقافات الشرق، أصبح يُفهم باعتباره خطابًا معرفيًّا- سلطويًّا يخدم مشاريع الاستعمار ويدّعي امتلاك المعرفة التفسيرية للشرق.
وقد سبق إدوارد سعيد جزئيًّا المفكّر أنور عبد المالك، الذي قدّم في 1973 نقدًا داخليًّا للاستشراق من منظور ماركسي، واعتبره خطابًا متحيزًا طبقيًّا وغربويًّا.
أمّا وائل حلاق، فقد ذهب إلى أبعد من ذلك بكثير؛ إِذْ قام بتفكيك البنية المعرفية (الإبستمولوجية) للحداثة الغربية ذاتها، مؤكّدًا أنّ الاستشراق -حتى في صوره الأكاديمية المعتدلة- يبقى أسيرًا لنموذج معرفي استعلائي. غير أنه لم يتبنَّ مقاربة سعيد التي ألهمتْ أجيالًا من الباحثين العرب والغربيين، بل خصّص كتابًا بعنوان: (قصور الاستشراق)؛ لنقد مشروع سعيد، واعتبره امتدادًا للحداثة الليبرالية الغربية، بل ومؤسّسًا لنموذج معرفي تبنّى الأدوات ذاتها التي استعملها الاستعمار، رغم ادّعائه الوقوف ضدّه. فإدوارد سعيد -وفق حلاق- لم يكن مفكرًا هامشيًّا، بل كان جزءًا لا يتجزأ من المركزية الغربية، وابنًا للحداثة، درس في جامعاتها وتشكَّل فِكْره بأدواتها. ولهذا، فإنّ حلاق يقدّم نقدًا عميقًا لتعميمات سعيد ولميله إلى تسييس مفهوم الاستشراق.
وعلى هذا الأساس، لا يمكن اعتبار إدوارد سعيد أو وائل حلاق ممثلَيْن لاتجاه استشراقي جديد؛ لأنهما لا ينتميان فكريًّا وأيديولوجيًّا إلى السياق الغربي المنتج للاستشراق، بل هما ناقدان له من خارجه. إلا أنّ تأثيرهما يقع ضمن ما يُعرف بـ(ما بعد الاستشراق)، وهو تيار نقدي مستقلّ يُعنى بتفكيك البنى المعرفية والخطابية التي أنتجها الاستشراق الكلاسيكي.
ويجدر التنويه بأنّ هذا التيار يمكن ربطه أيضًا باتجاه الاستغراب، الذي نشأ كردّ فعلٍ على الاستشراق، وسعى إلى تفكيك منطلقاته ومقارباته للشرق والإسلام. ويُعَدّ إدوارد سعيد، في الحقيقة، من أوائل من أشاروا إلى مفهوم (الاستغراب) قبل قيام حسن حنفي بتأصيله وتوسيع مفاهيمه في كتابه: (مقدمة في علم الاستغراب، 1991).
س5: إلى أيّ مدى أسهم التخلّي عن مصطلح (الاستشراق) لصالح تعبيرات، مثل: (الدراسات الشرقية) أو (دراسات الشرق الأدنى)، في إرباك التأريخ العلمي للاستشراق؟ وهل كان هذا التبديل مجرّد تجميل أم يحمل تحوّلات جوهرية في الرؤية والمنهج؟
د/ التجاني بولعوالي:
في تقديري، لم تأتِ هذه الخلخلة لمصطلح الاستشراق من فراغ، ولم يكن هذا التغيير الاصطلاحي شكليًّا فحسب. فقد جاء التخلِّي -أو محاولة التخلّي- عن المصطلح نتيجة الضغوط النقدية، خاصّة بعد كتاب إدوارد سعيد، في محاولة لإعادة تلميع المشروع من الداخل. غير أنّ التحوّل لم يكن دائمًا جوهريًّا؛ إِذْ لا تزال كثير من المضامين والرؤى الكلاسيكية حاضرة، حتى وإِنْ تغيّر العنوان. ومع ذلك، ظهرتْ تحت هذه العناوين البديلة دراسات جادّة تتّسم بقدر أكبر من الإنصاف والمنهجية النقدية الذاتية.
وهذا يعني أنّ هذا التغيير المصطلحي، الذي بدأ في النصف الثاني من القرن العشرين، كان -في جزء منه- ردَّ فِعْلٍ على النقد الموجَّه إلى مصطلح (الاستشراق)، سواء من طرف إدوارد سعيد أو غيره. وهكذا بدَا استبدال المصطلح في البداية شكليًّا، لكنه أتاح إعادة هيكلة الحقول الأكاديمية، فظهرت تخصّصات جديدة، مثل: (الدراسات الإسلامية)، و(دراسات الشرق الأوسط)، و(الدراسات العابرة للأقاليم)، و(الإسلامولوجيا).
ومع ذلك، لم يُنْهِ هذا التحوّل الإشكالات التي أثارها النقد ما بعد الاستشراقي؛ لأنّ كثيرًا من التحامل المعرفي لا يزال قائمًا داخل هذه الأقسام الأكاديمية الجديدة، خصوصًا في المناهج والمقاربات النقدية، ولا سيّما في الدراسات القرآنية والحديثية والفقهية، وفي البحث في جذور الإسلام وظهوره المبكّر. لكن، من الإنصاف القول أنّ بعض المراكز والجامعات الغربية تسعى اليوم لتجاوز الإرث الأيديولوجي للاستشراق التقليدي.
على هذا الأساس، أرى أنّه ينبغي التمييز اليوم بين تيارات متنوّعة داخل الدراسات الغربية المهتمة بالإسلام، أوّلها تيار يُعَدّ امتدادًا للاستشراق التقليدي، ويمكن تسميته: (الاستشراق الجديد) أو (المعاصر)، ويشمل توجّهات متباينة، منها: التنقيحية (Revisionist)، كما عند باتريشيا كرون، ومايكل كوك، وفريد دونر، وهارالد موتسكي، وروبرت هويلاند. والفيلولوجية (Philological)، كما عند جون وانسبرو، وكريستوف لوكسنبرغ، وغيرد بوين، وغابرييل سعيد رينولدز، وفرانسوا ديروش، وأنجليكا نويفرت. والاعتذارية (Apologetic)، كما عند مارشال هودجسون، وفريد هاليداي، وهارون طسيف، وديفيد توماس، ومارك دوري، وإيميليو بلاتي. ويلاحظ أنّ هذه التوجّهات تتداخل بشكلٍ لافتٍ عند بعض المستشرقين الجُدد، ويصعب أحيانًا تحديد الانتماء الدقيق لهم، كما في حالة باتريشيا كرون ومايكل كوك، حيث تحضر مختلف المستويات النقدية للإسلام.
أمّا التيار الثاني، فهو تيار أكاديمي موضوعي تناول الإسلام بقدرٍ كبيرٍ من الحياد، بعيدًا عن أيّ تحيّز بحثي أو أيديولوجي؛ سواء كان لصالح المسيحية أو الفيلولوجية أو التنقيحية. هؤلاء يُستحسن ألّا نطلق عليهم مصطلح (مستشرقين)، بل نعرّفهم وفق حقولهم المعرفية، مثل: فلاسفةِ الدِّين: جون هيك، وهينك فروم. والإسلامولوجيين: فان كونينسفيلد، وجون إسبوزيتو، ووائل حلاق. والمؤرّخين: كارين أرمسترونغ. واللاهوتيين: هانز كونغ وكونسيدين كرايخ. والفلاسفة: تزفيتان تودوروف ومارتا نوسباوم. وما دام أنّ هؤلاء الباحثين والمثقّفين الغربيين المعاصرين تناولوا الإسلام بمنهجية موضوعية بعيدة عن أيّ تحيّز أيديولوجي؛ لذا أمِيل إلى عدّهم باحثين موضوعيين أو تعدّديّين.
أمّا التيار الثالث فيضمّ الباحثين الذين أنصفوا الإسلام إلى حدّ بعيد، وكانت النتيجة أن اعتنقوا الإسلام، فصاروا من المدافعين عنه من داخل الوسط الأكاديمي الغربي. ومن الجيل الأول من هؤلاء: محمد أسد، ومحمد مارمادوك بكتال، وتوري أندريه، وغيرهم. أمّا الجيل الثاني فيشمل: عبد الكريم جريلي، وعبد الحق بوير، وعبد الوهاب هوار، وحمزة يوسف، وجوناثان براون، وغيرهم.
س6: متى بدأ استخدام مصطلح (الاستشراق الجديد) في الكتابات الغربية والعربية؟ ومَن أبرز مَن تولَّى تعريفه، ورَصْد أنواعه، وتقديم تأريخ شامل له؟
د/ التجاني بولعوالي:
في الحقيقة، يصعب تحديد تاريخ ظهور مصطلح الاستشراق الجديد Neo-Orientalism بشكلٍ دقيقٍ؛ أوّلًا: لأنّ هذا الحقل المعرفي واسع ومترامي الأطراف، ولا يمكن الإحاطة علمًا به من خلال قراءة كتاب أو مقالة، وإنما من خلال الاشتغال البحثي الأكاديمي بمشاريع استشراقية كاملة تحتاج إلى سنوات من الدراسة والتعمّق والحفر. وثانيًا: لاختلاف رُؤى الباحثين حول التحوّلات المنهجية والأيديولوجية التي طرأت على مآل الاستشراق منذ منتصف القرن العشرين إلى اليوم. وقد أشرتُ أعلاه إلى مختلف المسائل المتعلقة، لا سيّما بالتحوّل المصطلحي والمفهومي. لذلك، أحاول في الفقرات الآتية التوقّف عند بعض القضايا المتعلّقة بالاستشراق الجديد؛ كالمفهوم والخصائص والتوجّهات.
أوّلًا وقبل كلّ شيء، لا أُدْرِج كلّ ما كُتب من الدراسات الأوروبية والغربية المعاصرة في خانة الاستشراق عامة والاستشراق الجديد خاصّة، كما سبقَت الإشارة. أميلُ إلى وضع كلّ باحث غربي معاصر تناول الإسلام في إطار تخصّصه، وهذا ما هو معمول به اليوم أكاديميًّا، وإلّا فلماذا نتشبّث بأن نطلق على المتخصّص الغربي في علم الاجتماع (السوسيولوجي)، وإِنْ تناوَلَ بعض القضايا الأسرية والقيمية الإسلامية، وما أكثرهم اليوم. وهذا ما ينطبق على الأنثروبولوجي والإثنوغرافي والصحافي وغيرهم. لكن عندما يتعلّق الأمر بدارس الإسلام الغربي، فإننا نضعه مباشرة في خانة الاستشراق، مجرِّدِين إياه من تخصّصه الأكاديمي الذي أفنى فيه عُمره وألّف فيه مختلف بحوثه. لذلك، لا أقبل -على سبيل المثال لا الحصر- أن نُطلق على الباحث الهولندي فان كونينسفيلد مستشرقًا، بينما هو يُعْرف في الوسط الأكاديمي بأنه إسلامولوجي، أي: عالم أو دارس متخصّص في قضايا الإسلام.
أمّا فيما يتعلّق بمفهوم الاستشراق الجديد، أي: تلك الدراسات والمقاربات التي تُعتبر امتدادًا إبستمولوجيًّا ومنهجيًّا للاستشراق التقليدي، وتمثّله التوجّهات التنقيحية والاعتذارية والفيلولوجية، ويمكن تعريفه بأنه مجموعة من الخطابات الأكاديمية والإعلامية والسياسية المعاصرة حول الإسلام والمجتمعات المسلمة، والتي تستمد الكثير من افتراضات الاستشراق الكلاسيكي، لكنها تعمل في إطار حديث محكوم بالشروط الحضارية المعاصرة وتستعمل أدوات العولمة ووسائل الإعلام الجديدة. ويستخدم هذا المصطلح خصوصًا لوصف التمثلات الغربية للإسلام بعد نهاية الحرب الباردة وأحداث 11 سبتمبر، حيث امتزجت التحيّزات المعرفية التقليدية مع هواجس الأمن القومي والروايات الثقافية والأجندات الجيوسياسية.
س7: هل تختلف أدوات الاستشراق الجديد ومقاصده عن الاستشراق التقليدي؟ وما أهمّ سماته؟
د/ التجاني بولعوالي:
تتحدّد أهمّ سِمَات الاستشراق الجديد في أنه استمرار للاستشراق التقليدي، حيث حافظ على الكثير من هذه الرؤية الجوهرانية، لكنه أعاد صياغتها بلغة معاصرة تتلاءم مع اهتمامات الأمن والسياسة في القرن الحادي والعشرين. وهذا يعني أنّ الاستشراق الجديد يتّسم في تناوله للإسلام بتركيز مكثّف على الجانب الأمني، حيث يُنظر إلى الإسلام غالبًا ليس كدِين أو حضارة متكاملة، بل كتهديد محتمل يرتبط بالتطرف والإرهاب، مع تضخيم هذه القضايا. كما يميل إلى التقدير الانتقائي للثقافة الإسلامية؛ إِذْ يبرز ما يُصوَّر على أنه تخلّف أو عدم استقرار سياسي واجتماعي، بخلاف جانب من الاستشراق الكلاسيكي الذي كان يمجّد الجوانب الفنية والروحية مثل التصوّف والعمارة الإسلامية. ويتّصف الاستشراق الجديد كذلك بالتأطير الاختزالي، حيث تُعامَل الدول والمجتمعات الإسلامية ككتلة متجانسة متجاهلة بذلك التنوّع الفكري والسياسي والتاريخي بداخلها. بالإضافة إلى ذلك، يؤدّي التضخيم الإعلامي دورًا بارزًا في تشكيل صورة نمطية عن الإسلام، حتى في سياقات تُروِّج للفهم والحوار، ما يرسخ هذه الصور النمطية ويعمق الانطباعات السلبية.
ويتمثّل الاستشراق الجديد في التوجهات التنقيحية والاعتذارية (وهي تعني ذلك التيار الجدلي الذي يدافع عن المسيحية عبر التشكيك اللاهوتي والمنهجي في حقيقة الإسلام) والفيلولوجية الجديدة، كما يمكن أن يضاف إليها الدراسات الموجهة بالسياسات التي تركّز على الإسلام السياسي والهجرة والاندماج، غالبًا من منظور صراع الحضارات، كما أرساه صموئيل هانتينغتون وبرنارد لويس وغيرهما. كما يتمثّل أيضًا في برامج الدراسات الإسلامية بعد 11 سبتمبر، والتي ترتبط أحيانًا بمصالح حكومية أو عسكرية، ما يطرح إشكالات حول استقلالية البحث العلمي.
س8: ما تأريخ الاستشراق الجديد؟ ومَنْ أبرز نقّاده؟ وهل هناك مبادرات بحثية إسلامية تعالج هذا الموضوع؟
د/ التجاني بولعوالي:
ينبغي التمييز في تاريخ الاستشراق الجديد بين المصطلح الذي ظهر منذ تسعينيات القرن الماضي، وبين كونه مفهومًا أو ظاهرة، وهي تمتد إلى أكثر من ذلك، ربما إلى خمسينيات القرن العشرين. إذا ما توقّفنا عند السياق الهولندي، فإنّنا نجد أنه ظهرت منذ منتصف القرن العشرين دراسات مختلفة حول الإسلام لمجموعة من المستشرقين والمستعربين الهولنديين الجُدد، مثل فاردنبورخ، ويان بيترس، وديرك أتيما، ويان سلومب، وهانس يانسن، وغيرهم. وقد ظلّ هؤلاء أوفياء للمقاربة الاستشراقية التقليدية، لكن في الوقت نفسه بدأت تظهر بوادر تيار جديد يقطع مع الاستشراق الكلاسيكي، ويعتبر فان كونينسفيلد رائدًا له. وهذا التيار الموضوعي يطلق عليه أيضًا (ما بعد الاستشراق)، رغم أني أرى أن هذا المصطلح يبقى نسبيًّا؛ لأنه لا يشكل بديلًا أو نفيًا للدراسات الاستشراقية التنقيحية والاعتذارية التي تمتدّ اليوم بشكلٍ واسعٍ في الاستشراق الجديد، حيث أتباعه يعيدون إنتاج التحيزات القديمة رغم اختلاف السياقات والأساليب والمنهجيات.
وهذا يعني أن الاستشراق الجديد يوظّف آليات حديثة (علم الاجتماع، الأنثروبولوجيا، الدراسات الثقافية)، لكنه يحافظ على فرضيات غير معلنة حول (الاستثناء الإسلامي) أو (أزمة الإسلام)، ويضخم قضايا مثل التطرّف والمرأة. لذا، تختلف أدواته لكنه يشترك مع القديم في جُمْلة من المنطلقات والمقاصد.
وكما أنّ للاستشراق الجديد مؤلِّفيه وصُنَّاعه، فإن له نقّاده أيضًا، وأهمّهم إدوارد سعيد، ووائل حلاق، وحميد دباشي، وطارق رمضان، وزياد الدين سردار، بالإضافة إلى مجموعة من الباحثين المسلمين الذين يقيمون في أوروبا والغرب ويعملون في الجامعات والمراكز البحثية الغربية. وهؤلاء يمكن أن يُدرجوا في إطار عِلْم الاستغراب الذي جاء كردّ فعل على عِلْم الاستشراق، وذلك ليدرس الثقافة الغربية ويفكّك أنساقها الثقافية والاجتماعية والقيمية والسياسية، تمامًا كما صنع الاستشراق بالشرق والإسلام.
وتجدر الإشارة إلى أنه أُطلقت في السنوات الأخيرة مبادرة جديدة في أوروبا تقدّم مقاربة أكاديمية داخلية للإسلام عامة، والإسلام في أوروبا والغرب خاصّة، وذلك لسدّ الفجوة البحثية التي نشأت جرّاء غياب مراكز بحثية إسلامية تشتغل بالدراسات الإسلامية انطلاقًا من المصادر الإسلامية الأصيلة الموثوقة، وفي الوقت نفسه تفكّك الدراسات الاستشراقية للإسلام التي لا تخلو من مغالطات وانحرافات لا تمتّ بصِلَةٍ إلى البحث العلمي الجادّ والرزين.
ويتعلّق الأمر بمركز اجتهاد للدراسات والتكوين في بلجيكا، والذي رغم حداثة عهده بالنشأة وانعدام موارده المادية، فإنه تمكَّن في وقت قياسي وبموارد ذاتية من تقديم إسهامات متنوّعة تقارب الإسلام من الداخل الأوروبي لتصحيح المقاربة الاستشراقية والخارجية التي تحضر بشكل مكثف على مختلف المستويات. وسعيًا لتحقيق أهدافه، أطلق مركز اجتهاد جُمْلة من المبادرات؛ كالندوات العلمية الدولية، والندوات الشهرية التفاعلية، والكراسات البحثية، ومجلة اجتهاد للدراسات الإسلامية والعربية في أوروبا، والتي حقّقت نجاحًا كبيرًا رغم صدور ثلاثة أعداد منها فقط، وتأسيسها في بلجيكا منذ أقلّ من عامين.
س9: هل لا تزال التقسيمات الجغرافية التقليدية (فرنسي، إنجليزي، ألماني...) صالحة لفهم تنوّع المدارس الاستشراقية، أم أنَّ تشابه المناهج وتكامُل الاهتمامات يفرض تصنيفًا جديدًا أكثر دقة؟ ولماذا يتمّ تجاهل أمريكا وكندا عند الحديث عن الاستشراق الإنجليزي، وبلجيكا وسويسرا عند الحديث عن الاستشراق الفرنسي؟
د/ التجاني بولعوالي:
هناك بالفعل تقسيمات متعدّدة للاستشراق، يمكن تصنيفها تاريخيًّا أو جغرافيًّا أو أيديولوجيًّا أو منهجيًّا. وقد شهدنا في العقود الأخيرة تصاعدًا في النقاش حول الاستشراق وتنوّع أشكاله، ليس فقط بكونه تيارًا أكاديميًّا، بل كظاهرة ثقافية لها تجليات سياسية وإعلامية وفنية.
فيما يخصّ التقسيم الجغرافي التقليدي (فرنسي، بريطاني، ألماني...)، فقد أدى دورًا مهمًّا في رسم خارطة الاستشراق، ليس من حيث النطاق الجغرافي فقط، بل من حيث الخلفيات الأيديولوجية والثقافية وحتى الاستعمارية. على سبيل المثال، ارتبط الاستشراق الفرنسي تاريخيًّا بالسياق الاستعماري لشمال إفريقيا، حيث ركّز باحثون -مثل: لويس ماسينيون، وجاك بيرك- على المنطقة المغاربية، وشاركوا في صياغة السياسات الثقافية الفرنسية تجاه الجزائر وتونس والمغرب. بينما تمحور الاستشراق البريطاني حول مصر والهند، كما في أعمال إدوارد وليم لين عن المجتمع المصري، وهاملتون غِب الذي جمع بين الاهتمام بالشرق الأوسط وقضايا الإسلام السياسي. في حين اشتهرت المدرسة الألمانية بالتركيز الفيلولوجي واللغوي، وأنتجت روّادًا مثل تيودور نولدكه في دراسات القرآن، وكارل بروكلمان في تاريخ الأدب العربي.
أمّا من حيث مناطق الاستهداف، فقد ركّزت بعض الدراسات الاستشراقية على الهند (كما فعل البريطانيون في مرحلة الاستعمار)، وأخرى على إندونيسيا (كما فعل الهولنديون مثل سنوك هرخرونيه)، أو على الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وأعتقدُ أنّ هذه التصنيفات لا يمكن فَصْلها عن الدوافع الأيديولوجية؛ فهناك استشراق سياسي، وآخر تبشيري، أو اقتصادي، أو إثنوغرافي، وأحيانًا كان التقاطع بينها كبيرًا. فالاستشراق التبشيري الفرنسي في القرن التاسع عشر مثلًا خدم بشكلٍ مباشرٍ الأهداف الكاثوليكية في المشرق العربي، بينما ارتبط الاستشراق الهولندي بمصالح استعمارية في جنوب شرق آسيا.
واليوم، ومع العولمة الأكاديمية، أصبح التشابه بين المناهج كبيرًا، ونجد أحيانًا اندماجًا واضحًا بينها. فالباحث الأمريكي جون إسبوزيتو مثلًا يستعمل أدوات بَحْث قريبة من المدرسة البريطانية في دراساته عن الإسلام السياسي، بينما تستعين أبحاث كندية مثل أعمال إيزابيل سانت أونج بمناهج فرنسية- ألمانية مختلطة.
ويلاحظ أنه غالبًا ما تُستثنى أمريكا وكندا عند الحديث عن الاستشراق (الإنجليزي)؛ لأنّ جذور المصطلح والممارسة كانت أوروبية في الأصل، ولم يكن للولايات المتحدة دور مركزي إلا بعد الحرب العالمية الثانية، خاصّة مع صعود مراكز الدراسات الشرق أوسطية في جامعات، مثل: هارفارد وبرنستون. أمّا كندا، فقد أسهمت من خلال جامعات، مثل: ماكغيل في الدراسات الإسلامية، لكنها بقيت في الظلّ مقارنة بالنموذجَيْن البريطاني والفرنسي.
أمّا بلجيكا وسويسرا، فإنتاجهما الاستشراقي مهمّ لكنه ظلّ خارج التصنيفات الكبرى لأسباب جيوسياسية وحجم التأثير الدولي المحدود. فبلجيكا قدّمت أسماء بارزة، مثل: جاك بيرين، وأرماند آبل، ودانيال دي سميت. ومراكز بحثية، مثل: معهد اللغات الشرقية في لوفان، بينما أنتجت سويسرا مستشرقين بارزين، مثل: آدم متز، لكنها لم تُدْرَج تقليديًّا كـ(مدرسة) قائمة بذاتها.
ومما سبق، يمكن أن نخلص إلى أنّ التقسيمات الجغرافية الكلاسيكية مفيدة تاريخيًّا لكنها لم تَعُد كافية. أمّا في السياق المعاصر، فالأفضل تصنيف المدارس الاستشراقية وفق المناهج والأهداف والأيديولوجيا، مثل: المدرسة الفيلولوجية، أو الأنثروبولوجية، أو السياسية الأمنية، أو الإعلامية الثقافية؛ لأنّ هذا يعكس بدقّة أكبر واقع البحث اليوم.
س10: هل يمكن التسليم بمقولة: «موت الاستشراق»، في ظلّ استمرار الدراسات الغربية عن الإسلام؟ وإذا كان الاستشراق قد عَرف اتساعًا وهيمنة، فلماذا لم يَعرف (الاستعراب) المعادل الموضوعي العربي له هذا المسار؟ وما العوامل التي تُعِيق ازدهاره وتفعيله كمجال معرفي مستقلّ؟
د/ التجاني بولعوالي:
أرى أنّ مقولة: «موت الاستشراق»، مبالَغ فيها؛ لأنها لا تعكس واقع البحث الأكاديمي الأوروبي والغربي حول الإسلام. فالاهتمام بالدراسات الإسلامية في الجامعات الغربية ومراكز الأبحاث تَضَاعَف واتّسع مجاله بشكلٍ كبيرٍ. صحيح أن هناك تراجعًا نسبيًّا في استخدام مصطلح الاستشراق في بعض الدوائر الأكاديمية والإعلامية الغربية؛ وذلك لمنح هذه الدراسات طابع الجدّية والقبول، بعد أن بات كلّ عَمَل يندرج تحت شعار الاستشراق يُقابَل بالرّيبة والنقد. غير أن هذا لا يعني توقّف الممارسة نفسها، بل شهدنا إعادة إنتاجها وتدويرها تحت مسميات وتوجّهات جديدة، مثل: الاستشراق التنقيحي، والاستشراق النقدي السياسي، والاستشراق الاعتذاري.
ومن هنا، فإنّ مقولة: «موت الاستشراق»، التي راجتْ بقوّة بعد صدور كتاب إدوارد سعيد سنة 1978 لا تشير إلى نهاية الدراسات الغربية عن الشرق أو الإسلام، وإنما إلى تراجع النمط التقليدي للاستشراق المرتبط بالهيمنة الاستعمارية وبالبنية المعرفية التي صاغها المستشرق الأوروبي في القرنين التاسع عشر والعشرين. وبعد النقد الحادّ الذي تعرَّض له هذا التراث، أُعيدت صياغة العلاقة بين الباحث الغربي وموضوعه الشرقي، فانتقلنا من الاستشراق التقليدي إلى ما يُعرف اليوم بـ(الاستشراق الجديد)، الذي لا يزال نشطًا ومؤثرًا، خاصّة في الجامعات ومراكز الأبحاث وصُنْع السياسات الدولية. وهذا يعني أنّ الاستشراق لم يَمُتْ، وإنما طوّر أدواته ومصطلحاته وأُطره المؤسّسية.
أمّا الاستعراب، فهو فرع من فروع الاستشراق يختصّ بالدراسات التي ينجزها غير العرب حول اللغة العربية وثقافتها وتاريخها ومجتمعاتها. وقد جرى العُرْف على إطلاق المصطلح العام (الاستشراق) على ما هو خاصّ؛ فيُقَال: (استعراب) في حال الدراسات العربية، و(استفراق) في حال الدراسات الإفريقية، و(استمزاغ) في حال الدراسات الأمازيغية. وهناك باحثون غربيّون، خصوصًا في المدرستَيْن الهولندية والإسبانية، درسوا الإسلام واللغة العربية لكنهم يرفضون أن يُصنَّفوا كمستشرقين، بل يميلون إلى تسمية (المستعرب).
وعلى الأساس، فإنّ عدم شيوع استخدام مصطلحَي الاستشراق أو الاستعراب لا يعني أن هذين الحقلَيْن في تراجع. على العكس، فإنّ حجم الإنتاج العلمي في العقود الأخيرة داخل أقسام الدراسات العربية والإسلامية في الجامعات الأوروبية والغربية ربما يضاهي -بل يفوق- ما أُنجز في تاريخ الاستشراق كلّه حول الإسلام واللغة العربية.
س11: ما مدى تأثير التحوّلات السياسية العالمية (كالحرب على الإرهاب أو صعود اليمين في الغرب) على مضامين الدراسات الاستشراقية المعاصرة؟ وهل أدّت إلى إعادة إنتاج أنماط استشراقية تقليدية بصياغات جديدة؟
د/ التجاني بولعوالي:
إنّ التحوّلات السياسية العالمية خلال العقود الأخيرة، وعلى رأسها أحداث 11 سبتمبر 2001، والحرب على الإرهاب، وصعود التيارات اليمينية والشعبوية في الغرب، كان لها أثر بالغ على مضامين الدراسات الاستشراقية المعاصرة، سواء على مستوى الموضوعات أو المناهج أو الخطاب. فقد أدّى التركيز الأمني والوقائي إلى جَعْلِ الإسلام، في كثير من هذه الدراسات، يُقارب من منظور المخاطر والتحديات، ما أعاد إلى الواجهة أنماطًا قديمة من المقاربات الاستشراقية، ولكن بقشيب جديد يتناسب مع السياق السياسي الراهن.
إنّ المستشرقين في زمن الاستعمار التقليدي كانوا يدرسون المجتمعات الإسلامية بهدف فهمها للسيطرة عليها وإدارتها. أمّا اليوم، فالكثير من الدراسات التي تندرج تحت ما يُسمّى بـ(الدراسات الأمنية) أو (التحليل الإستراتيجي)، توظّف نفس الآليات الاختزالية، ولكن لتبرير سياسات الهجرة الصارمة، أو التدخّلات العسكرية، أو منع الرموز الدينية، أو مراقبة المجتمعات المسلمة في الداخل الغربي. كذلك، أسهم صعود اليمين في الغرب في تغذية خطاب ثقافوي استقطابي وعنصري يرى في الإسلام جوهرًا ثابتًا غير قابل للتوافق مع (القيم الغربية)، وهو طرح يذكّر بمقولات الاستشراق التقليدي حول (التخلف)، و(الجمود) الحضاري، وإن كان يُقدَّم الآن تحت عناوين أكاديمية، مثل: (دراسات التطرف) أو (أمن الحدود) أو (التكامل الثقافي).
ومن هذا المنطلق، يمكن القول أنّ التحوّلات السياسية لم تُنْهِ الاستشراق التقليدي، أو تُعْلِن موته، بل أطلقت عملية إعادة تدويره وإعادة إنتاجه؛ فالمقولات الجوهرانية، والتعميمات الثقافية، والصور النمطية ما زالتْ حاضرة، لكنها تُقَدَّم الآن بلغة (بحثية) أو (سياسية) تواكب الخطاب المعاصر، وتجد شرعيتها في مناخ عالمي يتّسم بالتوترات الأمنية والصراعات الثقافية.
مواد تهمك
-
.jpg) الاستشراق والدراسات القرآنية (2-2) الدراسات القرآنية الغربية
الاستشراق والدراسات القرآنية (2-2) الدراسات القرآنية الغربية -
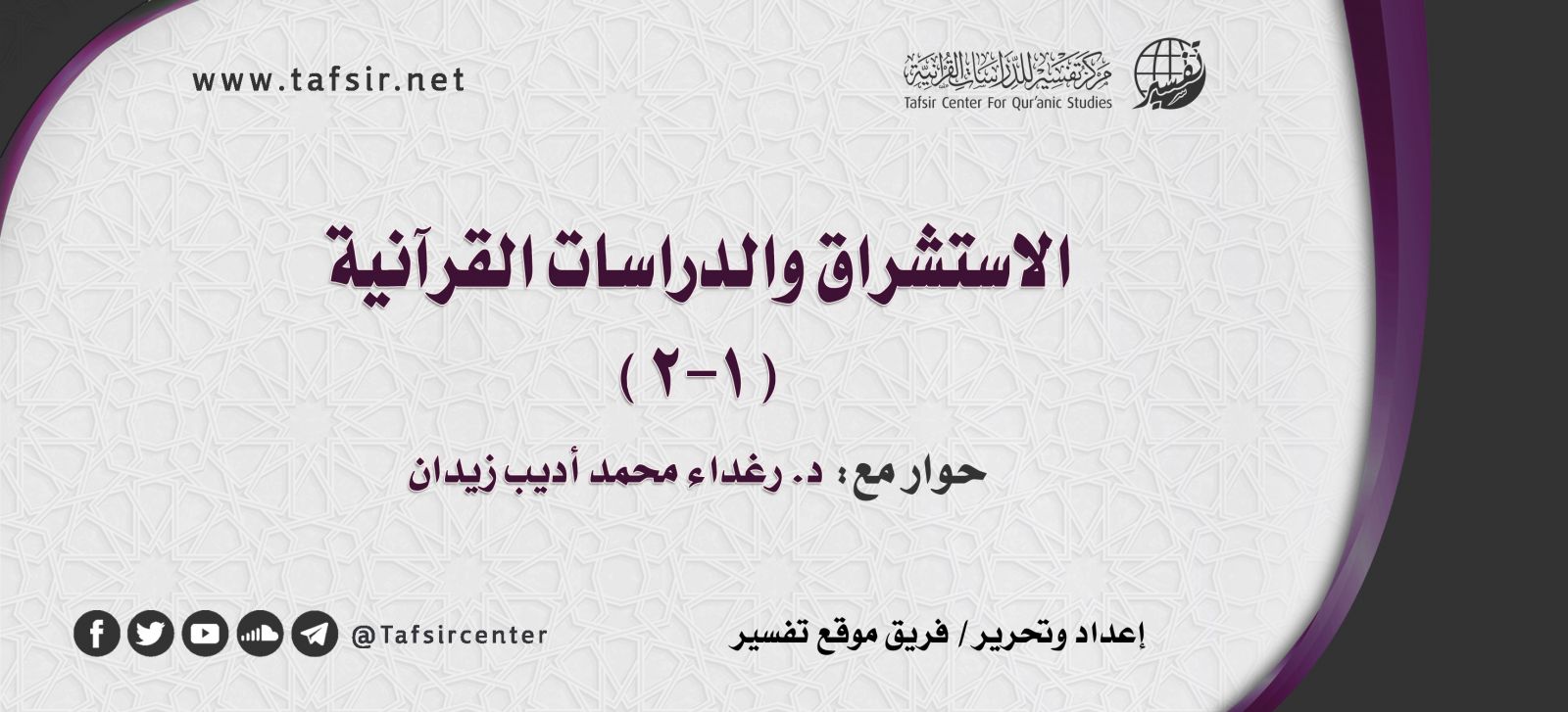 الاستشراق والدراسات القرآنية (1-2)
الاستشراق والدراسات القرآنية (1-2) -
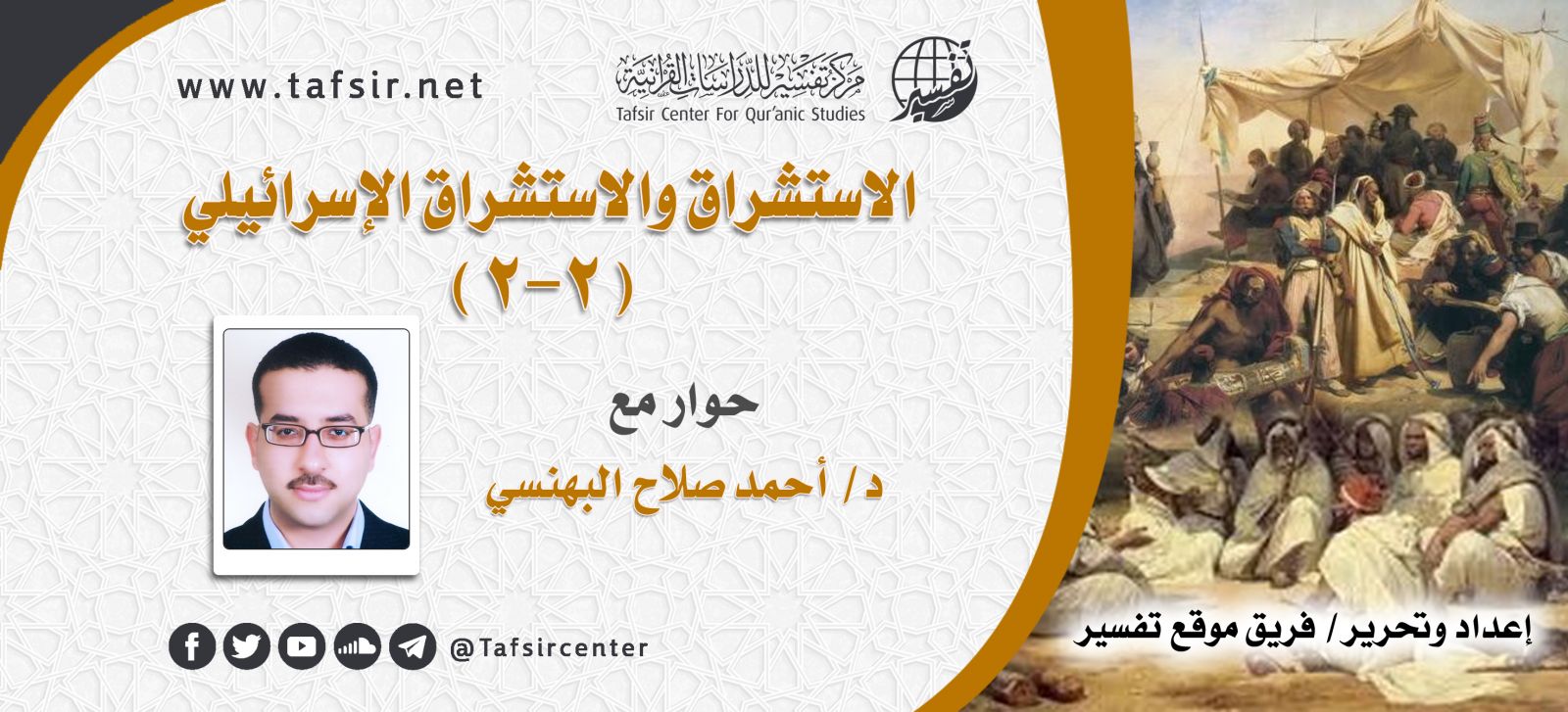 الاستشراق والاستشراق الإسرائيلي (2-2)
الاستشراق والاستشراق الإسرائيلي (2-2) -
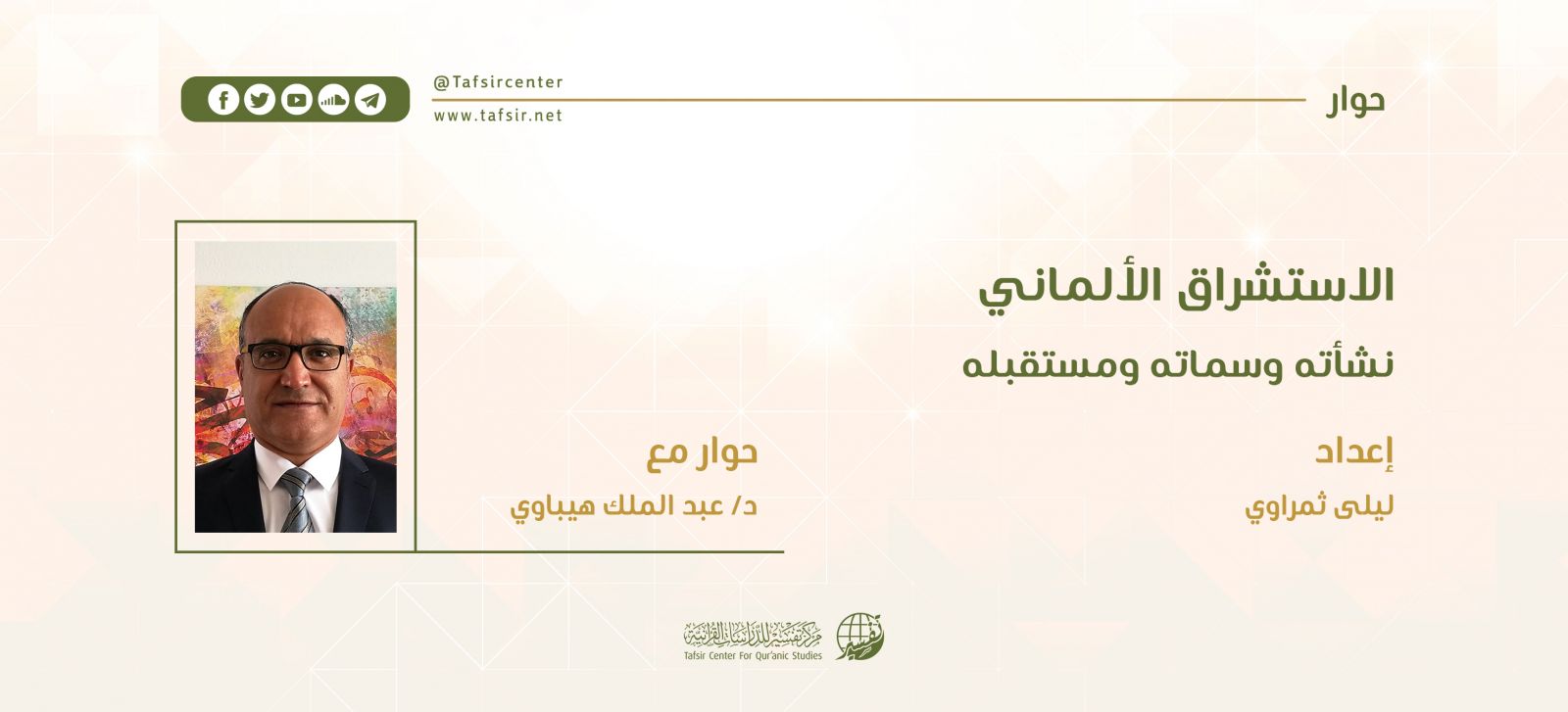 الاستشراق الألماني؛ نشأته وسماته ومستقبله
الاستشراق الألماني؛ نشأته وسماته ومستقبله -
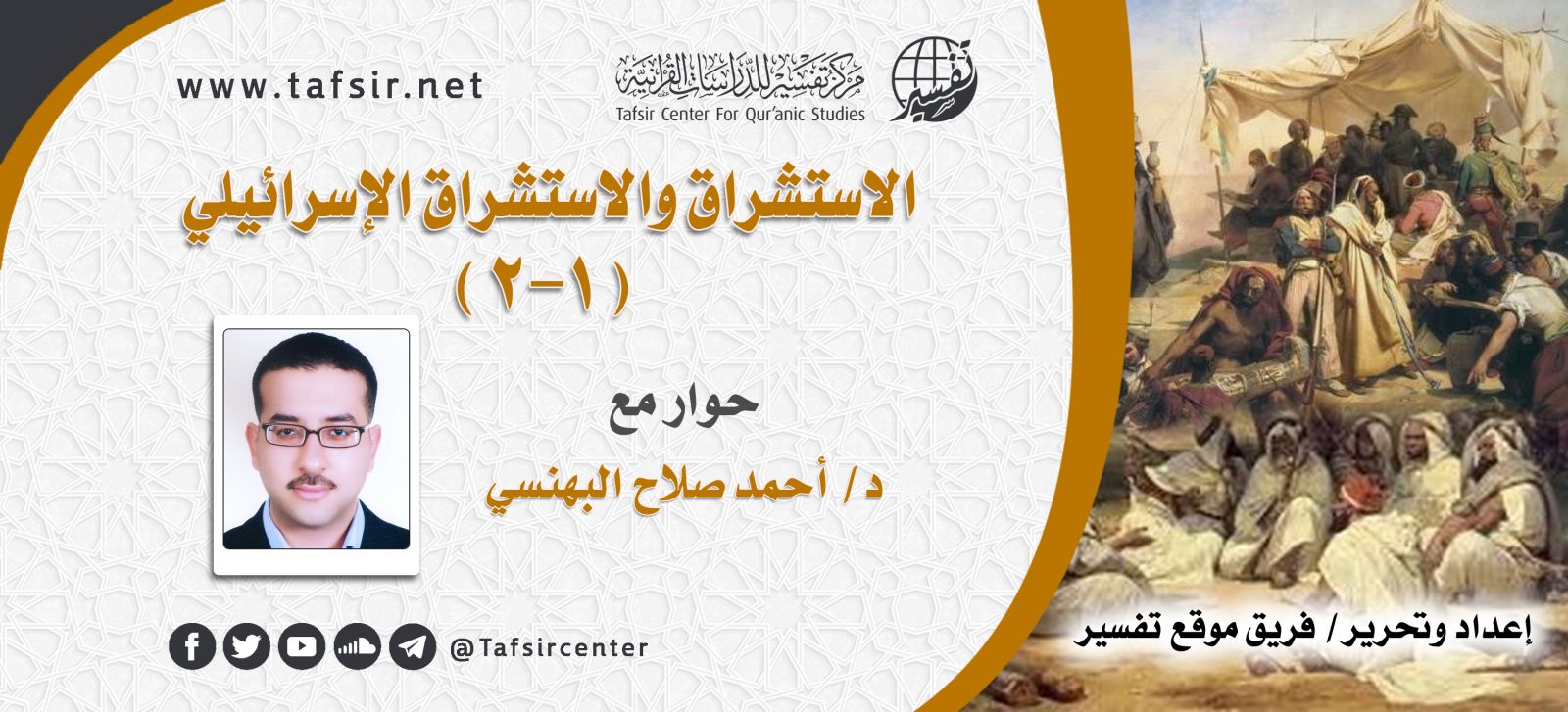 الاستشراق والاستشراق الإسرائيلي (1-2)
الاستشراق والاستشراق الإسرائيلي (1-2) -
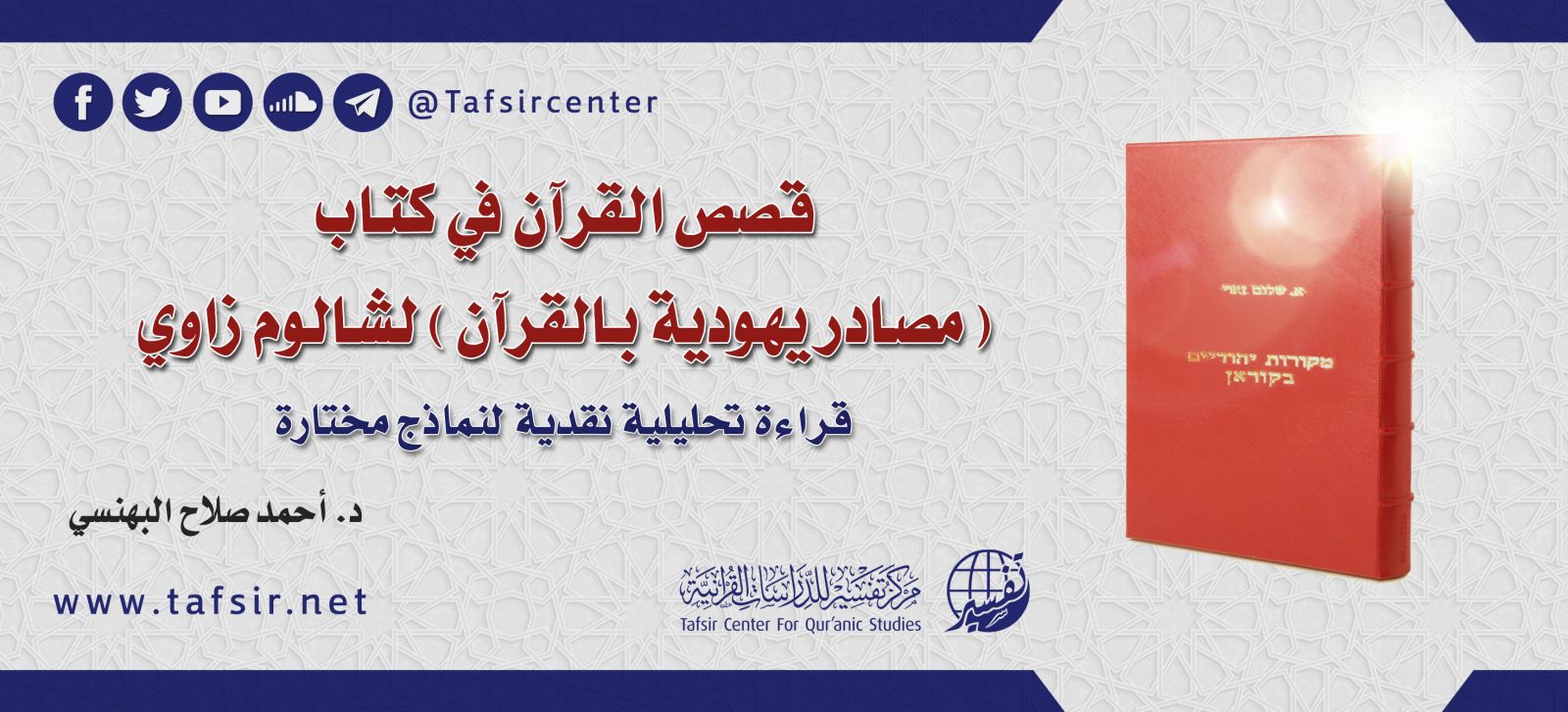 قصص القرآن في كتاب (مصادر يهودية بالقرآن) لشالوم زاوي، قراءة تحليلية نقدية لنماذج مختارة
قصص القرآن في كتاب (مصادر يهودية بالقرآن) لشالوم زاوي، قراءة تحليلية نقدية لنماذج مختارة


