المنشورات الحديثة في المجلات العلمية الغربية المتخصّصة في الدراسات القرآنية
ملخصات مترجمة
الجزء الحادي والأربعون
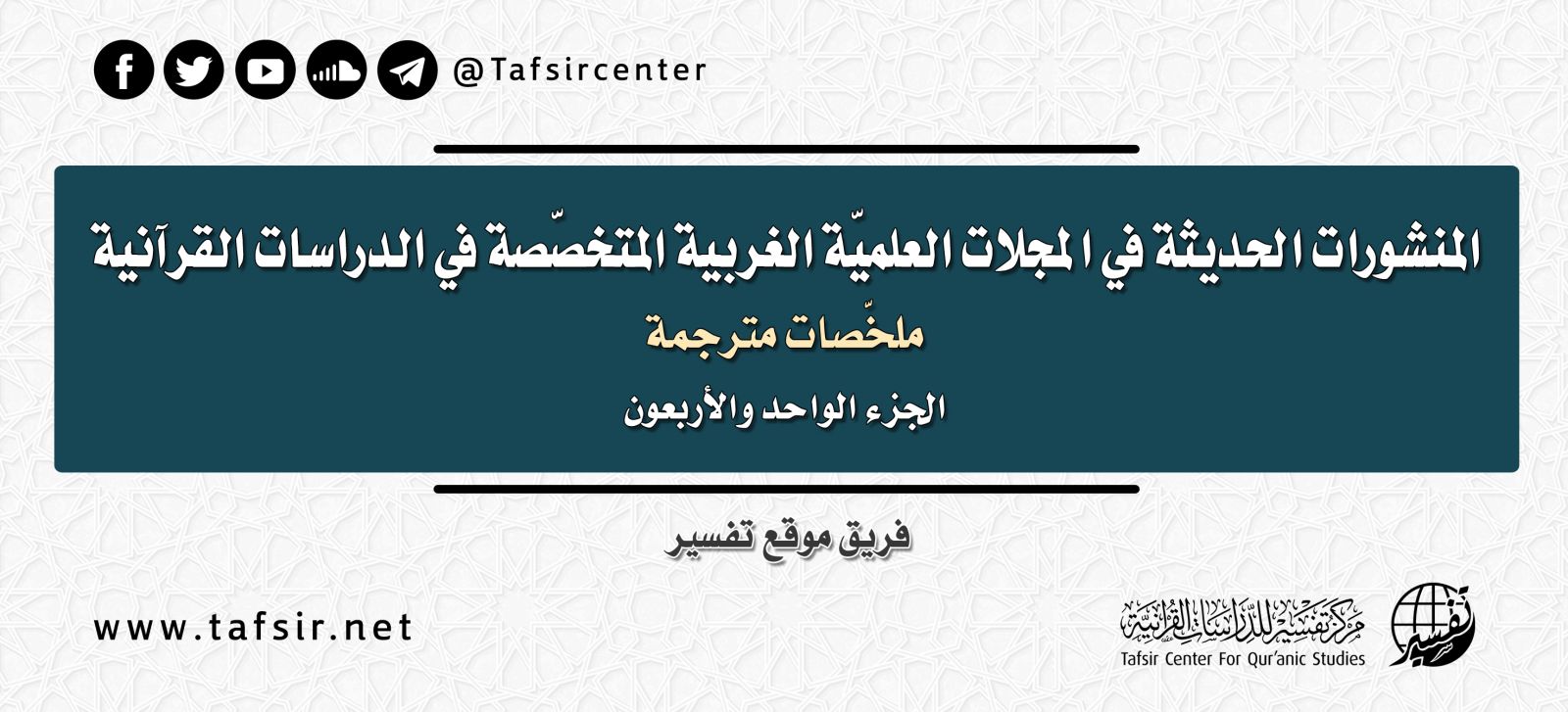
هذه المقالة هي الجزء (41) من ترجمة ملخَّصات أبرز الدراسات الغربية المنشورة حديثًا[1]، والمنشورة في بعض المجلات الغربية، والتي نحاول من خلالها الإسهام في ملاحقة النتاج الغربي حول القرآن الكريم ومتابعة جديدِه بقدرٍ ما، وتقديم صورة تعريفية أشمل عن هذا النتاج تتيح قدرًا من التبصير العامّ بكلِّ ما يحمله هذا النتاج مِن تنوُّع في مساحات الدرس.
1- Ibn Masʿūd’s Preference for the Grammatical Masculine Form and its Impact on the Ten Readings
Elaheh Shahpasand
Journal of Qur'anic Studies, Volume 27, Issue 1, 2025
تغليب ابن مسعود المذكّر النحوي وأثره في القراءات العشر[2]
إلهة شاه بسند
اعتبَر عبد الله بن مسعود (591- 32/ 652) القرآن مذكّرًا، وطالَب قرّاءه بمعاملته على هذا الأساس. ويوصِي القرّاء، كلما اختلط عليهم أمْرُ استخدام الياء (علامة الذّكورة) أو التاء (علامة الأنوثة)، بالرجوع إلى المذكَّر. ويؤدّي تفكيك الأساس المنطقي وراء ذلك إلى استكشاف التقليد في الفكر العربي الذي يُعلي من شأن المذكَّر؛ والذي يظهر في تصنيف علماء الحديث والأدب عِلْمهم على أنه مذكَّر. وبعد بضعة عقود، أصبح كلام ابن مسعود أشبه بمبدأ القراءة.
يستكشف هذا البحث ما إذا كان فهم ابن مسعود قد أثّر على القرّاء، وكيف كان ذلك. فيسعى أوّلًا إلى وضعِ أعماله في سياقها، من خلال سلاسل الإسناد وتحليل المتن.
ثم يتناول ثانيًا: تحليل تأثير لفظ ابن مسعود على القراءات العشر، أي: القراءات المشكوك فيها في الأفعال المذكّرة أو المؤنثة (أو التي تحمل اسم رفع مؤنث). ويُظهر التحليل أنّ قراءات حمزة بن حبيب (80- 156/ 699- 723)، وعليّ بن حمزة الكسائي (ت: 189/ 805)، وخلف بن هشام (ت: 229/ 844)، تميل إلى المذكَّر بشكلٍ كبيرٍ، وهذا يشهد على التأثير الكبير لابن مسعود، تحديدًا، على القراءات الكوفية. في حين أنّ المخطوطات القديمة -وخاصة تلك الموجودة في مكتبة آستان قدس رضوي- تظهر أنَّ فكّ الرموز النحوية للمذكّر/ المؤنث لا يؤدي إلى أيّ فرق كبير، فإنّ المخطوطات التي تأثرت بابن مسعود أو زملائه الكوفيِّين تظهر علامات تحيز للذكورة.
2-A Byzantine Reading of the Qur’an: Was Sūrat al- Fātiḥa Included in the Earliest Greek Translation of the Qur’an (Third/ Ninth Centuries terminus ante quem)? — A Philological Analysis
Manolis Ulbricht
Journal of Qur'anic Studies, Volume 27, Issue 1, 2025
قراءة بيزنطية للقرآن الكريم: هل أُدرجت سورة الفاتحة في أقدم ترجمة يونانية للقرآن الكريم (نهاية القرنين الثالث/ التاسع قبل الميلاد)؟ تحليل لغوي
مانوليس أولبريخت
تناقش هذه الورقة البحثية ما إذا كانت سورةُ الفاتحة جزءًا من الترجمة اليونانية المبكرة للقرآن التي استخدمها نيكيتاس البيزنطي في القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي. لم يُستشهد بالسورة الأُولى صراحةً في كتاب نيكيتاس الجدلي (دحض القرآن)، الذي احتفظ بأجزاء واسعة من الترجمة. مع ذلك، تُلمّح بعض مقاطع هذا العمل المُعادِي للإسلام إلى وجود سورة الفاتحة، حتى لو لم تُفهم على أنها سورة كاملة (κεφάλαιον/ kephalaion، "سورة") من القرآن الكريم. من خلال تحليل لغوي لمقاطع مُحدَّدة في كتاب (دحض القرآن)، يعيد هذا البحث تقييم فهم إشارات نيكيتاس إلى سورة الفاتحة. وسوف يسهم هذا البحث في إعادة بناء الشكل النصِّي الأصلي للترجمة اليونانية للقرآن والفهم المبكّر لمجموعة النصوص القرآنية على هذا النحو.
3- Udūl (Semantic Deviation) in the Noun Forms in the Story of Moses
Mohammad Al- Hejoj Al- Btoush and Adibeh Mustafa Ahmad
Mustafa
Journal of Qur'anic Studies, Volume 27, Issue 1, 2025
الانحراف الدلالي في صيغ الاسم في قصة موسى
مصطفى أحمد مصطفى
يهدف هذا البحث إلى دراسة الأثر الصرفي والدلالي لظاهرة العُدول (الانحراف الدلالي، أي: عدم الامتثال للمعايير البنائية) في صيغ الأسماء في قصة موسى القرآنية. يتناول هذا التحليل للعُدول: الانحراف عن المفعول به إلى صِيَغ اسمية أخرى، والانحراف بين صِيَغ الأسماء الفعلية المختلفة، وكذلك الانحراف بين تراكيب الأسماء في البناء الواحد. من خلال هذا البحث التحليلي، يتّضح أنّ الغرض من العُدول في سياق قصة موسى هو غرض بلاغي، وأنّ الخروج عن الاستخدام اللغوي السائد يهدف إلى الكشف عن بُعد فنّي وجمالي. بالإضافة إلى ذلك، يعمل كأداة أسلوبية تُثري السياق بقيم دلالية وإيحائية.
4- al- Tafrīʿ and its Types in al- Ṭāhir b. ʿĀshūr’s al- Taḥrīr waʼl- tanwīr
Fehmieh R. Nawaya, Ahmad S. Burhan and Abdulaziz E. Hajji
Journal of Qur'anic Studies, Volume 27, Issue 1, 2025
التفريع وأنواعه في كتاب التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور
فهمية نوايا، أحمد برهان، عبد العزيز الحاج
يُعَدّ التفريع أحد مظاهر الإعجاز القرآني. ورغم اهتمام المفسِّرين بالجوانب اللغوية والبلاغية للقرآن، إلا أنّ التفريع لم يحظَ بالاهتمام الكافي في دراساتهم. يهدف هذا البحث إلى إبراز روعة التفريع البلاغية، من خلال تعريفه وتحديد أنواعه من خلال كتاب تفسير (التحرير والتنوير). وتعتمد الدراسة على منهج تحليلي نقدي، متتبعةً ورود التفريع في القرآن الكريم من خلال هذا التفسير. وقد توصّل البحث إلى أن للتفريع في (التحرير والتنوير) أساسًا نحويًّا، مستخدمًا أدوات نحوية للدلالة على الترابط والتماسك داخل النص، بحيث يُفسِّر بعضُ أجزاء الكلام أجزاءً أخرى. في كلِّ حالةٍ من حالات التفريع، يوجد -على الأقلّ- أصلٌ واحدٌ وفرعٌ واحدٌ، حيث يُضيف الفرعُ معنًى إضافيًّا ضروريًّا لتوضيح الأصل، وإزالة الغموض، وتقديم التفسير. والتفريع ثلاثةُ أنواع: دلاليّ، وإشاريّ، ودلاليٌّ وإشاريٌّ مُجتمعان. ومع أنَّ ابنَ عاشور أتقنَ مناهجَ العلماءِ السابقين في التفريع، وتوسَّعَ فيها، فإنَّ الدراسةَ ستتناولُ أيضًا الجوانبَ التي انتقده فيها البعضُ بسبب آرائه في هذا الموضوع.
[1] يمكن مطالعة الجزء السابق على هذا الرابط: tafsir.net/paper/86.
[2] تعريب عناوين المقالات والبحوث هو تعريب تقريبي من عمل القِسْم. (قِسم الترجمات)


