الدراسة الغربية المعاصرة للمخطوطات القرآنية المبكرة
دراسات لطرس صنعاء
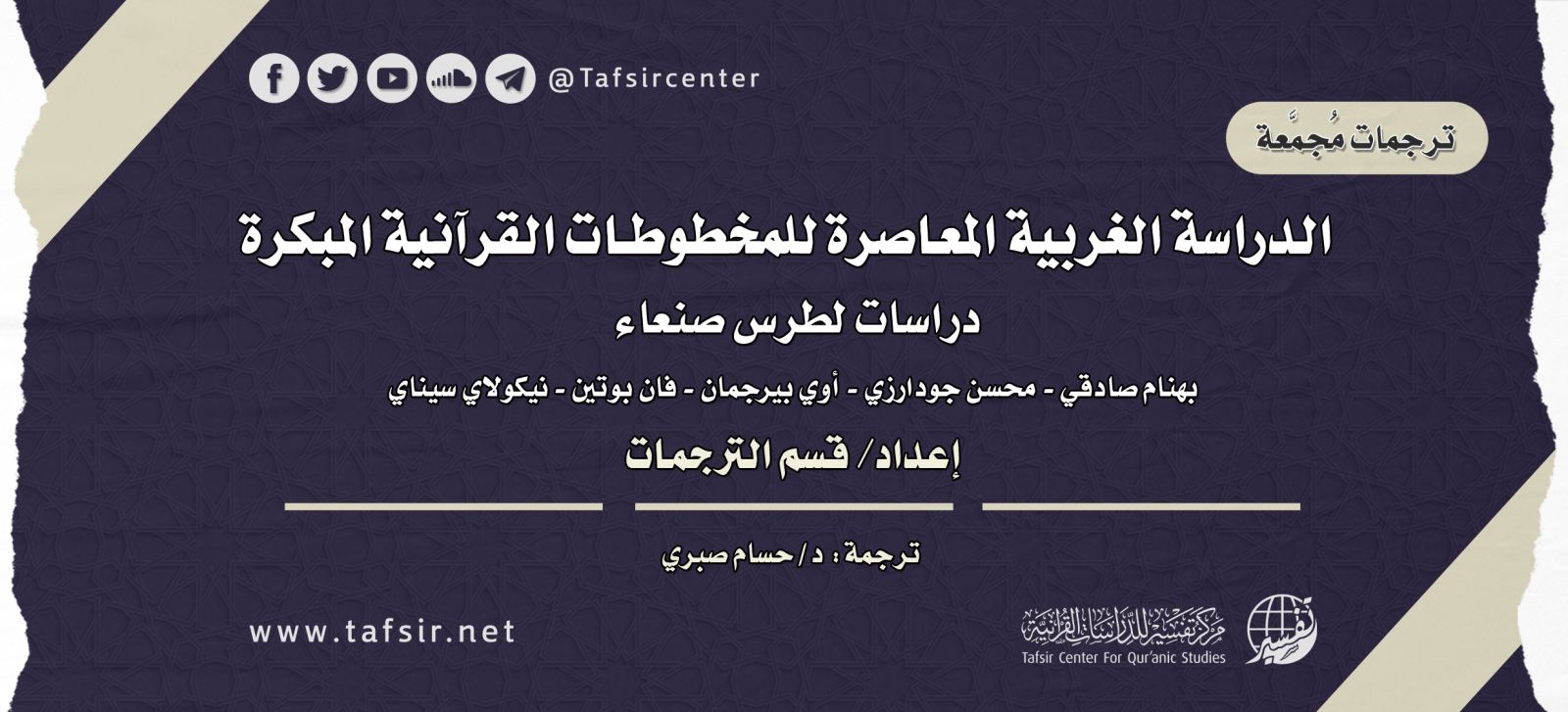
يهتم الدرس الغربي للقرآن اهتمامًا كبيرًا بمسألة تاريخ القرآن الكريم، حيث يبحث فيها بصورة رئيسة السياقَ التاريخي الديني والنصِّي للقرآن، وكذا تشكّل نصّ القرآن منذ كان مجموعة من الآيات إلى أن تم تدوينه وجَمعه في نُسخة معتمدة ملزمة (مصحف عثمان/ المصحف الإمام)، ويعتبر هذا الاهتمام أحد أبرز مساحات الدرس الغربي للقرآن قاطبة، بل إنّ دراسة تاريخ القرآن هي النقطة ربما التي شكّلت منطلق هذا الدرس، وقد اقتصر عليها العمل الغربي على القرآن إلى حدود الثمانينيات من القرن الماضي تقريبًا، مما دفع فضل الرحمن مالك لانتقاد الدراسات الغربية للقرآن لانحصارها في دراسة تاريخ القرآن وإهمالها دراسة نصّ القرآن ذاته، والاهتمام بمسألة تاريخ القرآن بشكلٍ مكثّف ومركزي في ساحة الدرس الغربي للقرآن يتموضع فيما يعتبره المسكيني نقلًا للقرآن من كونه أفقًا للمعنى أو سؤالًا للذات إلى كونه موضوعًا للتاريخ، أي تحوّله من كتاب يمنح المعنى لمجموعة من المؤمنين إلى مجرّد وثيقة تاريخية صرفة يُبحث تاريخها وسياقها وملابسات تطوّرها على مستوى التدوين، وهو المنظور الذي يشكّل طبيعة النظر الاستشراقي للقرآن بشكلٍ عام، ويعود لمركب من الأسباب التي تتعلّق بطبيعة الاستشراق وطبيعة العلاقة بالشرق -القائمة على الموضعة والتمثيل بالأساس- وكذلك بطبيعة المناهج المتاحة للمستشرقين في القرن التاسع عشر، والتي تركّزت في المناهج النصِّية الفيلولوجية الكلاسيكية.
في هذا السياق تأتي الأهمية الكبيرة المعطاة في الدرس الغربي قديمًا وحديثًا لدراسة المخطوطات القرآنية، فقد كان القرآن ذاته يُنظر إليه كإحدى مساحات التحقيق الفيلولوجي، ولطالما مثّل البحث عن إيجاد نسخة فيلولوجية نقدية من القرآن هدفًا استشراقيًّا أساسيًّا، سواء فيما قبل ظهور ما يعرف بـ(مصحف القاهرة) -حيث نجد في هذه الفترة مصاحف استشراقية قائمة على الجهد الفيلولوجي مثل مصحف فلوجل- أو بعد ظهور مصحف القاهرة حيث الأمل الاستشراقي ببناء التاريخ النقدي للقرآن الذي نلمسه عند مستشرقين قدامى مثل منجانا وبرجستراسر وشبتلر.
ورغم أن الفترة الاستشراقية الكلاسيكية على تنوّع مقارباتها وطريقة تعاملها مع المصادر التاريخية كانت تشهد في العموم بعض الثقة في المرويات والمصادر الإسلامية، وتنطلق من إمكان الاعتماد عليها في بناء تاريخ القرآن وتاريخ الإسلام المبكّر، إِذْ لم يكن قد نشأ بعدُ التشكيك الكامل في هذه المرويات الذي ظهر في السبعينيات من القرن الماضي مع نشأة الاتجاه التنقيحي، إلا أن بناء نسخة من القرآن تقوم على معطيات المصادر التراثية وحدها (كتب القراءات والرسم والعدّ... إلخ) دون العودة للفيلولوجيا والكوديكولوجيا -كما حدث من قِبل المسلمين في طبعة القاهرة 1924- فإنه أمر ظلّ موضع تشكيك وانتقاد استشراقي، وظلّ الحلم قائمًا بإنتاج نسخة نقدية فيلولوجية للنصّ؛ على مستوى القراءة، بحيث تجمع الاختلافات في النُّسخ القرآنية المبكّرة، وكذلك على مستوى البعد التاريخي والثقافي؛ حيث تشمل ما يعتبر الفضاء النصِّي والتاريخي والذي يصدر عنه/ أو يتفاعل معه -وفق الدارسين الغربيين- القرآن.
في هذا السياق يمكن فهم هذا الاهتمام الكبير والخاصّ الذي صاحب اكتشاف مخطوطات صنعاء في سبعينيات القرن الماضي، حيث مثّل هذا الاكتشاف والتنبؤات الأوّلية حول قِدَم هذه المخطوطات بداية حقيقية -من وجهة نظر الدرس الغربي- لتحقيق هذا المشروع المؤجّل بإنتاج نسخة نقديّة من النصّ قائمة على المخطوطات المبكّرة بالأساس، لكن زيادة وتضاعف هذا الاهتمام بمخطوطات صنعاء لا يمكن أن يُفهم إلا باستحضار السياق الأوسع لظهور هذه المخطوطات، حيث صاحب ظهورها تغيّر منهجي مركزي ضمن الدرس الغربي للقرآن، وهو ظهور كتابي وانسبرو: (الدراسات القرآنية، مناهج ومصادر تفسير النصوص المقدسة)، ولولينغ: (القرآن الأصلي: إعادة بناء التراتيل المسيحية)، واللذَيْن شكّلَا بداية مركزية للتشكيك الجذري في موثوقية السردية الإسلامية التقليدية وإمكان الاعتماد عليها كمصادر تاريخية في بناء تاريخ الإسلام المبكّر وتاريخ القرآن، من هنا كان الاهتمام بالمخطوطات مضاعفًا، حيث إنها مثّلت ضمن هذا السياق دليلًا إيبيغرافيًّا يمكن الاعتماد عليه بعد التشكيك الكلّي في المصادر الإسلامية، وقد حفز هذا الاكتشاف في هذا السياق الكشف عن مخطوطات أخرى، مثل مخطوطات برجستراسر كما يذكر دونر. كما كان له التأثير الكبير ضمن عوامل أخرى أوسع -منها التطوّر الحادث في المناهج الأدبية والكتابية والاعتماد الاستشراقي عليها، وتكثف الاهتمام بنتائج دراسة مخطوطات قمران وآثارها على فهم تاريخ الكتاب المقدّس- في خَلْق مسارات علمية بحثية جديدة لدراسة جوانب من تاريخ القرآن وعلاقته بالكتب السابقة عليه، وذلك مع كثير من الدارسين الذين أفادوا في اشتغالهم مما أتاحه التطوّر الحادث في المناهج الأدبية والكتابية في الواقع الغربي، وتكثف الاهتمام بنتائج دراسة مخطوطات قمران وآثارها على فهم تاريخ الكتاب المقدّس.
التلقي الإعلامي لمخطوطات صنعاء:
وبالرغم من طبيعة هذا السياق الذي تم فيه اكتشاف المخطوطات، ووضوح الأهمية الكبيرة لمثل هذا الاكتشاف في سياق الدرس الغربي للقرآن، إلا أن بداية تلقّي خبر اكتشاف المخطوطات لم تكن بداية علمية بالضرورة، بل شكّل التعامل الإعلامي أول تعامل مع المخطوطات، مما أدرج هذا الاكتشاف العلمي المهم ضمن ترسانة من الصور والتنميطات الإعلامية الجاهزة، فتحوّلت المخطوطات المكتشفة وقبل دراستها لأداة ضمن الجدل الإعلامي العام حول المسلمين والمشكّك في كتابهم المقدّس، وتم النظر إليها من خلال التصوّرات الشعبية العامة عن الإسلام، والتي لا تختلف كثيرًا عن التصوّرات الأوروبية الوسيطة والتي تنظر له كدِين مزيّف ولكتابه ككتاب منتحَل، وافتراض أن هذه المخطوطات قادرة على بيان واقع مختلف لنَصّ القرآن عن الحاضر بأيدينا منه، ما أدى بطبيعة الحال لتبلور بعض الفرضيات المخالفة للنظر الإسلامي بشأن القرآن وتاريخه في ضوء محض تخمينات وتوقّعات لما لم تتم دراسته أصلًا!
ومن المؤسِف أنّ هذا التلقي الإعلامي للمخطوطات في البيئة الغربية، قد شارك في تغذيته والترويج له عددٌ من الباحثين مثل جيرد بوين -وهو المسؤول الألماني عن إدارة مشروع دراسة المخطوطات- وحديثه عن مؤامرات إسلامية للتعمية على المخطوطات وإخفاءها خوفًا من نتائجها الصادمة لحساسية المجتمع المسلم، وهو ما اتضح لاحقًا غلطه وعدم صحّته، وأنه محض ادعاء لا أساس له من الصّحة، وأن بعض الدارسين الغربيّين هم من أسهموا في عملية حَجْب المخطوطات لفترة طويلة، والوقوف عائقًا أمام إتاحتها للدارسين، حتى إن أُولى الدراسات الكبيرة والمتوسّعة حول مضمون المخطوطات جاءت بعد مرور عشر سنوات كاملة من الألفية الجديدة.
- التعامل العلمي مع مخطوطات صنعاء:
كما أسلفنا فقد شهدتْ سبعينيات القرن الماضي حالة من التشكيك الجذري في موثوقية المرويات والمصادر الإسلامية التقليدية ومدى إمكان الاعتماد عليها في بناء سردية حول تاريخ القرآن وتاريخ الإسلام المبكّر، وقد نتج عن هذا التشكيك تغيّرات منهجية في طريقة نقاش تاريخ القرآن، وهو ما تمثّل في بروز عدد من المسارات لهذا النقاش، يمكن حصرها في أربعة مسارات رئيسة:
1- إعادة بناء المصادر: حيث تتم إعادة النظر في الروايات الإسلامية التقليدية والمناهج الإسلامية، من أجل الوصول لموقف دقيق من السردية الإسلامية التقليدية نفسها ومدى موثوقيتها ومدى إمكان الاعتماد عليها في بناء تاريخ المصحف، يتمثّل هذا في أعمال: غريغور شولر، وهارالد موتسكي.
2- دراسة البُعْد المفهومي في تاريخ النصّ: حيث تتم دراسة مفاهيم سُلطة النصّ وحُجّيته من داخل النصّ؛ لتكوين فهم عميق حول عملية اعتماد النصّ كنصّ ذي سلطة في الإسلام واقترابه أو ابتعاده من تاريخ تشكيل الكتاب المقدّس، يتمثّل هذا في أعمال: أنجيليكا نويفرت، ونيكولاي سيناي، ودانييل ماديغان، وآن سيلفي بواليفو.
3- محاولة الاعتماد على الأدلة الإيبغرافية وحدها في النظر لتاريخ النصّ: حيث يتم رفض الأدبيات الإسلامية حول تاريخ النصّ واللجوء لأدلة مثل النقوش والعملات في بناء تاريخ القرآن وتاريخ الإسلام المبكّر.
4- دراسة المخطوطات: حيث تتم دراسة المخطوطات المكتشَفة للقرآن، سواء مخطوطات صنعاء أو غيرها -مثل مخطوطات برجستراسر، ومثل مصحف باريس- في محاولة لفهم تاريخ تدوين القرآن، عبر استخدام المناهج الإيبغرافية والكوديكولوجية الحديثة بطريقة بعيدة عن التحيّزات التنقيحية المسبقة تجاه المصادر الإسلامية.
في هذا السياق نشأ اهتمام موسّع ومكثّف بالمخطوطات المتاحة للقرآن، سواء مخطوطات صنعاء، أو غيرها من المخطوطات، وتبلور هذا الاهتمام في عددٍ من المشاريع الكبرى مثل مشروع كوربس كوارنيكوم ومشروع أماري وغيرهما، وفي ظهور عدد من الدراسات المهمّة التي أصبحتْ مرجعية في دراسة المخطوطات القرآنية.
إنّ مخطوطات صنعاء وفي ضوء أهميتها وقِدمها الكبير حظيتْ باهتمام خاصّ في وسط العناية الغربية بدراسة مخطوطات القرآن الكريم، وانصبّت عليها دراسات تناولتها بالفحص والدّرْس كدراسات: صادقي، وجودارزي، وبيرجمان، وفان بوتين، وأسماء هلالي، وإلينور سيلار، وغيرهم، وقد أثارت هذه الدراسات في سياق اشتغالها على هذه المخطوطات عددًا من التساؤلات المتعلّقة بالقرآن وتاريخه والمصحف العثماني والموقف من السردية الإسلامية ومدى موثوقية الاعتماد عليها في النظر لتاريخ القرآن، وغير ذلك من القضايا المهمّة والملحّة في سياق الدرس الغربي للقرآن.
وفي ضوء الرغبة في متابعة النقاش الغربي حول مخطوطات صنعاء وتقديم صورة منه للقارئ العربي؛ فقد حاولنا انتقاء جملة من المواد الغربية المتعلّقة بمخطوطات صنعاء، وقُمنا بترجمتها، وفيما يلي نُلقي ظلالًا توضيحية حول هذه المواد.
المواد المترجمة حول مخطوطات صنعاء:
منذ الدراسة العلمية الدقيقة لطرس صنعاء 1 كان ثمة سؤالٌ مركزيٌّ وهو العلاقة بين هذا الطرس وبين المصحف العثماني الإمام، وهل تمثّل الكتابة السُّفلية والعُلوية على الطرس نسخة من هذا المصحف أم نسخة سابقة عليه أم نسخة تالية عليه؟ كذلك هل يمثّل هذا الطرس مصحفًا كاملًا من الأساس أم مجرّد تدوين غرضه الاستخدام الشخصي التعليمي؟ وأيضًا مدى مساحة الاتفاق والاختلاف بين هذا الطرس والمصحف العثماني؟ وهي أسئلة مهمّة تفيد في تجلية وتوضيح الكثير من الأمور المرتبطة بتاريخ القرآن وجمعه ودقّة نقله وموثوقية السردية الإسلامية ومصادرها، وغير ذلك، حاولتْ هذه الدراسات الأربعة التي يضمّها هذا الكتاب المجمع الاشتباك مع هذه الأسئلة والإجابة عنها.
حيث مثّلت الدراسة الأولى: (طرس صنعاء 1 وأصول القرآن) لبهنام صادقي ومحسن جودارزي، دراسة تفصيلية لتاريخ الطرس ومضمون الكتابة العلوية والسفلية عليه.
كما نتج عن هذه الدراسات كذلك بعض النتائج المهمّة الأعم، والتي تتعلّق بسؤال معيارية مصحف عثمان، وما معناها؟ وما علاقته ببقية المصاحف؟
في الدراسة الثانية: (موازنة بين مصحف عثمان وإحدى مخطوطات صنعاء) لبهنام صادقي وأوي بيرجمان، يتناول المؤلِّفان مسألة علاقة مصحف عثمان بمصاحف الصحابة وعلاقة ذلك كلّه بالمصدر الأصلي، والنماذج المفترضة للعلاقة بين هذه المصاحف.
كما سنجد في الكتاب تناولًا لقضية طريقة نقل القرآن، وهل كانت شفاهية بشكلٍ كاملٍ أم تدخّلت الكتابة؟ ففي الدراسة الثالثة: (خواص الرسم المشتركة) لماراين فان بوتين، حيث تناول خواصّ الرسم المشتركة بين النُّسَخ القرآنية المبكّرة، ويصل فان بوتين من خلال تحليلاته للميل إلى وجود نصّ عثماني مكتوب كان يمثّل مصدرًا للنُّسَخ.
كذلك نجد في الدراسة الرابعة: (ما وراء مصحف القاهرة) لنيكولاي سيناي، نقاشًا حول مدى تعبير الطرس عن مصحف كامل، حيث يقدّم سيناي نقاشًا موسّعًا بين افتراضات صادقي-بيرجمان من جهة وافتراضات أسماء هلالي في كتابها حول مخطوطات صنعاء من جهة أخرى.
فهذه الورقات الأربع التي يضمّها هذا الكتاب تُعطي صورة دقيقة عن إحدى أهم مخطوطات صنعاء، وهي طرس صنعاء 1، وتقدّم تصوّرًا عن تاريخها ومحتواها، كما تقدّم رؤية من خلال هذا الطرس عن تاريخ تدوين القرآن ونشأة المصحف الإمام وعلاقته ببقية المصاحف، فضلًا عن كونها تلقي ضوءًا على الاهتمام الاستشراقي المعاصر بالدراسة الفيلولوجية والكوديكولوجية للقرآن.
وقد حرصنا على تذييل الكتاب بملحقٍ فيه بعض الصور المتعلّقة بمخطوطات صنعاء، وصور مسجد صنعاء الذي تم اكتشاف المخطوطات فيه؛ لما رأينا فيه من فائدة تتميمية للقارئ حال لم يكن قد اطلع على مثل ذلك.
ويجدر الإنباه هاهنا لعدد من الأمور:
أولًا: هذه الترجمات سبق ونشرناها بشكلٍ مستقلّ على موقع تفسير ضمن قسم الاستشراق، وفي نشرها هاهنا قُمنا فقط بحذف الحواشي المكرّرة وتعديل وإضافة بعض الحواشي، كما أنه وفي سياق هذا النشر الإلكتروني السابق تم وضع مقدّمات لكلّ مادة على حِدَة تعمل على إبراز موضوع اشتغالها وتوضيحه، وقد آثرنا الإبقاء على هذه المقدّمات هاهنا ليبرز للقارئ قبل الولوج لكلّ مادة موضوعها وطبيعة المقاربة التي تعمل عليها.
ثانيًا: كما أسلفنا فقد راجتْ على إثر ظهور مخطوطات صنعاء ادعاءات عديدة ترى أنّ هذه المخطوطات ستبرز واقعًا مختلفًا للنصّ القرآني عن الحاضر منه بأيدينا، ومن ثم فإنها تطعن بوضوح في سلامة النصّ القرآني وفي صحة عقيدة المسلمين تجاه كتابهم المقدّس، والمتصفّح لهذه الترجمات سيلحظ أنها استطاعتْ بشكلٍ كبيرٍ تفنيد الاتهامات التي لطالما رُوِّج لها، وبيان غلط هذه الادعاءات وزيفها، وأنّ المخطوطات تؤيّد النصّ في صورته القائمة وتؤكّدها وليس العكس، وبرغم أهمية هذه النتائج بالنسبة لنا كمسلمين، لا سيما وأنها صادرة بالأصالة عن درس غير إسلامي للمخطوطات؛ إلا أنّ نَشْرَنا لهذه المواد ليس الغرض منه الوقوف عند هذا الحد وبيان غلط الادعاءات الطاعنة في القرآن، ولكن إضافة لذلك إثراء الواقع البحثي العربي وتبصيره بالدرس الغربي للمخطوطات ومعطياته، وأن يكون ذلك سبيلًا للتعرّف على هذا الواقع ومساجلته وفتح الباب نحو مزيد من النقاش له ولطرائقه في الدرس والتحليل والنتائج التفصيلية التي يخرج بها، وكذا الإسهام في إثراء البحث في تاريخ المصحف، وبناء تصوّرات عِلمية موسّعة حول العلاقات بين نُسخه المبكّرة، وكذلك لمسألة الشفاهة والتدوين في عصر صدر الإسلام، وغير ذلك من القضايا المهمّة التي تحتاج لمزيد بحث وتحرير.
ثالثًا: كما بينّا فإننا لا نستطيع فهم هذا الاهتمام الموسّع المعاصر بالمخطوطات القرآنية المبكّرة بعيدًا عن سياق التشكيك التنقيحي في تاريخ النصّ وفي المرويات الإسلامية، ورؤيته ضرورة الاقتصار فحسب في ذلك على الأدلة الإيبغرافية، وهو الموقف الذي لا يخلو من تعسّف منهجي واضح وغير مقبول علميًّا، ومن ثم كان محلّ نقد من قِبَل كثير من الدارسين الغربيين، كما تعرّض هذا الموقف ونتائجه لانتقاد حتى من بعض الدارسين المنتمين لهذا الاتجاه مثل بريمار وهوتنج، كما أنّ السياق الغربي نفسه شهد نشأة بعض اتجاهات البحث التي ترى عدم صحة هذا الرفض المجاني والمسبق والشامل للمرويات الإسلامية الذي يصدر عنه الاتجاه التنقيحي، حيث حاول بعض الدارسين مثل شولر وموتسكي وجونيبول إعادة النظر في المناهج الإسلامية التراثية ومدى عِلميتها وكفائتها، وتوصّلوا لكونه من غير الدقيق التخلّص من كلّ هذه الثروة المعرفية بالتشكيك الشامل فيها، بل ينبغي على المؤرّخ الاشتباك معها، وصحيح أن ظهور المخطوطات المبكّرة كشف عن أخطاء الاتجاه التنقيحي ومزاعمه حول القرآن وقوله بعدم موثوقية السردية الإسلامية في قضايا كتاريخ القرآن، كما أبرز وجود أهمية بالفعل لدراسة هذه المخطوطات في النظر لجوانب من تاريخ القرآن وبعض القضايا القرآنية الأخرى، بيد أنه من المهم جدًّا التحرّر مما فرضه حضور الاتجاه التنقيحي وتشكيكه من النظر للمخطوطات بصورة مستقلّة وباعتبارها دليلًا قائمًا بذاته يوظّف في بيان خطأ فرضيات هذا الاتجاه حول القرآن وتاريخه، والانتقال لدراسة المخطوطات باعتبارها ضمن الواقع التراثي القرآني نفسه واستثمارها وجديد المناهج الخاصّة بها في دعم وتثوير معطيات هذا الواقع ومقولاته وعلومه القائمة حول القرآن، وإلا ففساد الاتجاه التنقيحي يتأتّى من جهات عديدة منها حضور المخطوطات، ولا غرو فالحديث عن تاريخ القرآن لا يمكن أن يتم من خلال المخطوطات وحدها، كما أنّ تثوير البحث في واقع الدرس القرآني من خلال المخطوطات يكفل على نحو أنجع حُسن الاشتغال بهذه المخطوطات وتتابعه.
ونأمل أن يكون هذا الكتاب المجمّع مفيدًا في إطلاع الدارِسين العرب على الدراسات الغربية حول مخطوطات صنعاء، هذه القضية التي كانت ولا تزال مثارًا للجدل، وأن يكون فاتحة وبداية لخَلْق نقاش عربي حول مخطوطات صنعاء والدرس الغربي لها، ومسالك استثمار حضور هذه المخطوطات في تثوير النقاش في القضايا والعلوم القرآنية ذات الصِّلة.
مواد تهمك
-
 موازنة بين مصحف عثمان وإحدى مخطوطات صنعاء (طرس صنعاء 1)؛ نظرات حول تاريخ تدوين القرآن
موازنة بين مصحف عثمان وإحدى مخطوطات صنعاء (طرس صنعاء 1)؛ نظرات حول تاريخ تدوين القرآن -
%20%D9%88%D9%86%D8%B4%D8%A3%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86.jpg) طرس صنعاء (1) وأصول القرآن
طرس صنعاء (1) وأصول القرآن -
.jpg) تاريخ القرآن في الدراسات الغربية المعاصرة؛ الجزء الأول: النظريات المعاصرة حول تاريخ القرآن
تاريخ القرآن في الدراسات الغربية المعاصرة؛ الجزء الأول: النظريات المعاصرة حول تاريخ القرآن -
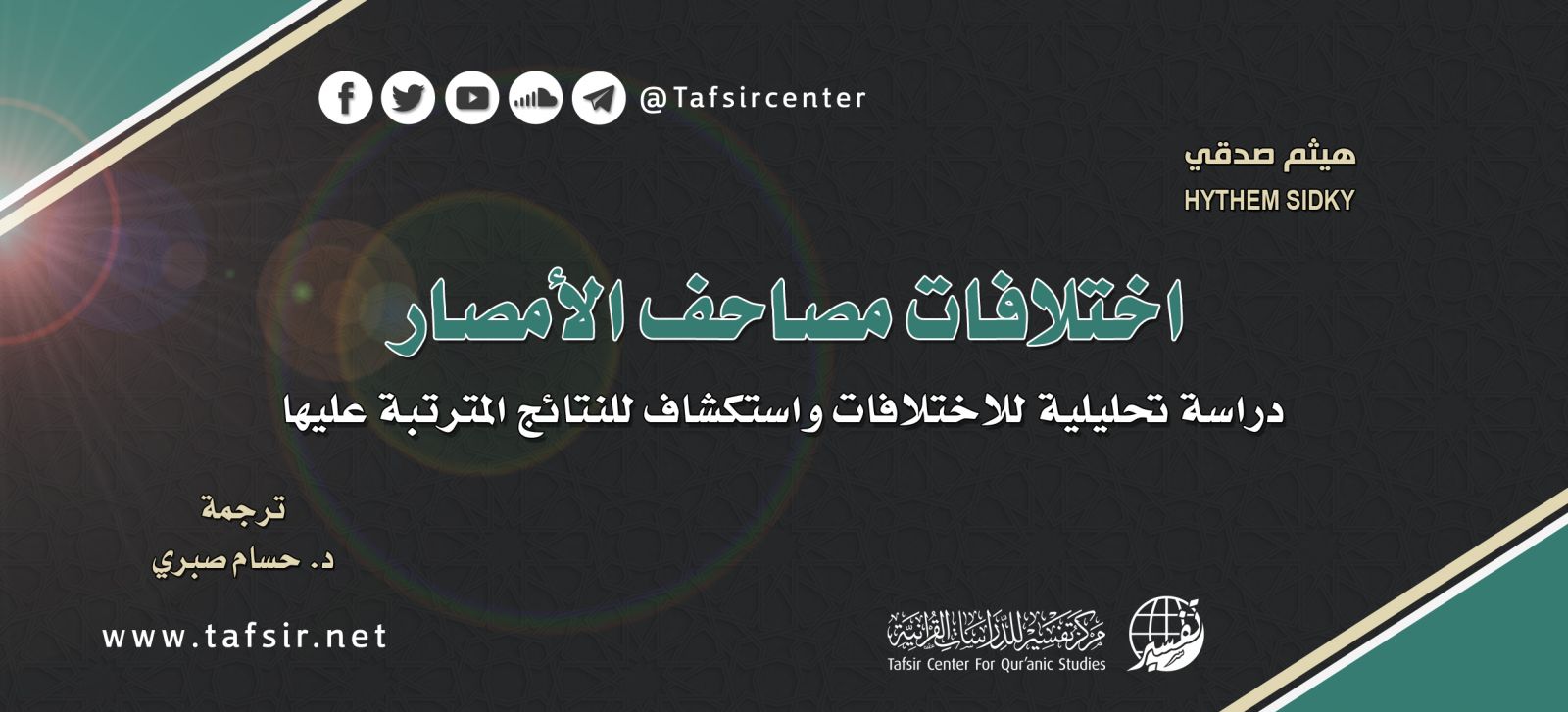 اختلافات مصاحف الأمصار؛ دراسة تحليلية للاختلافات واستكشاف للنتائج المترتبة عليها
اختلافات مصاحف الأمصار؛ دراسة تحليلية للاختلافات واستكشاف للنتائج المترتبة عليها -
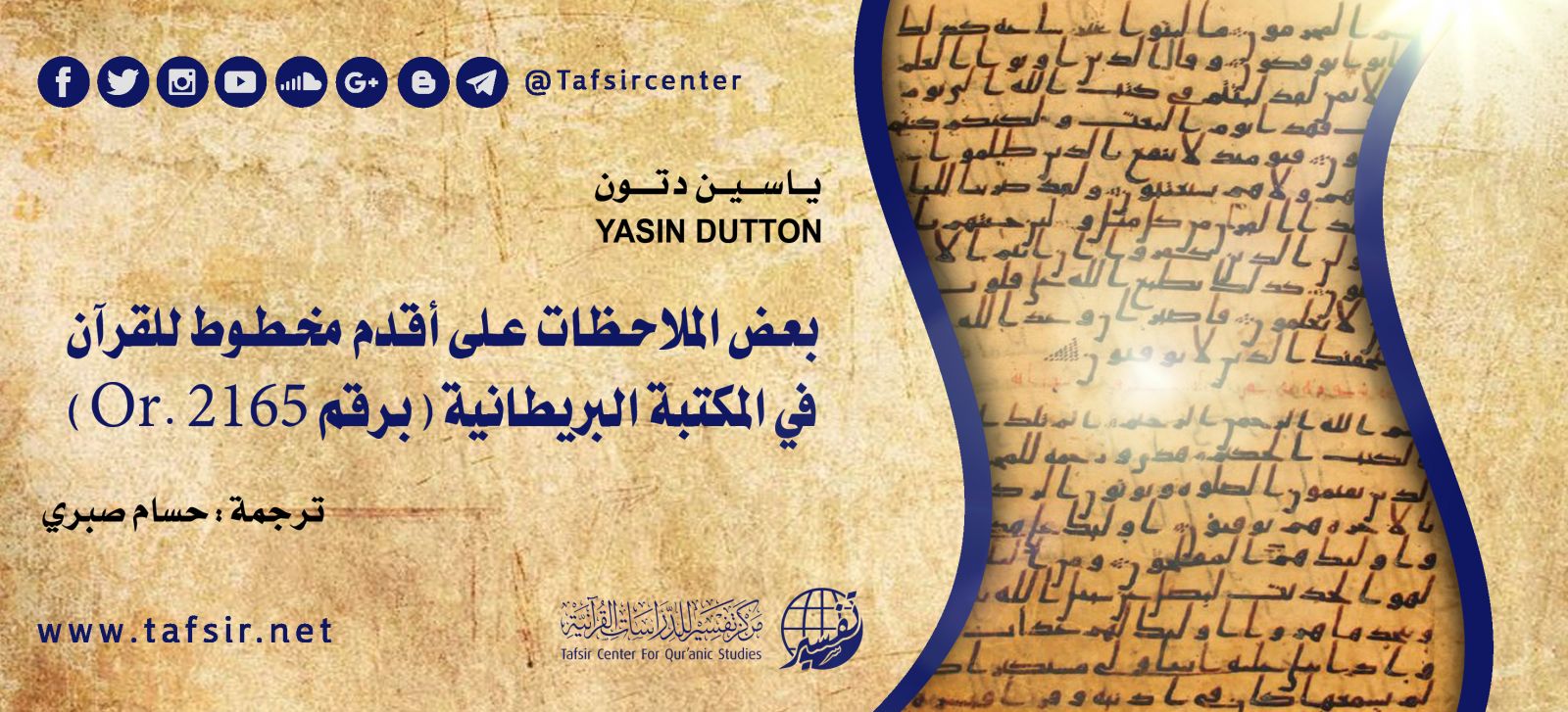 بعض الملاحظات على أقدم مخطوط للقرآن في المكتبة البريطانية (برقم Or. 2165)
بعض الملاحظات على أقدم مخطوط للقرآن في المكتبة البريطانية (برقم Or. 2165) -
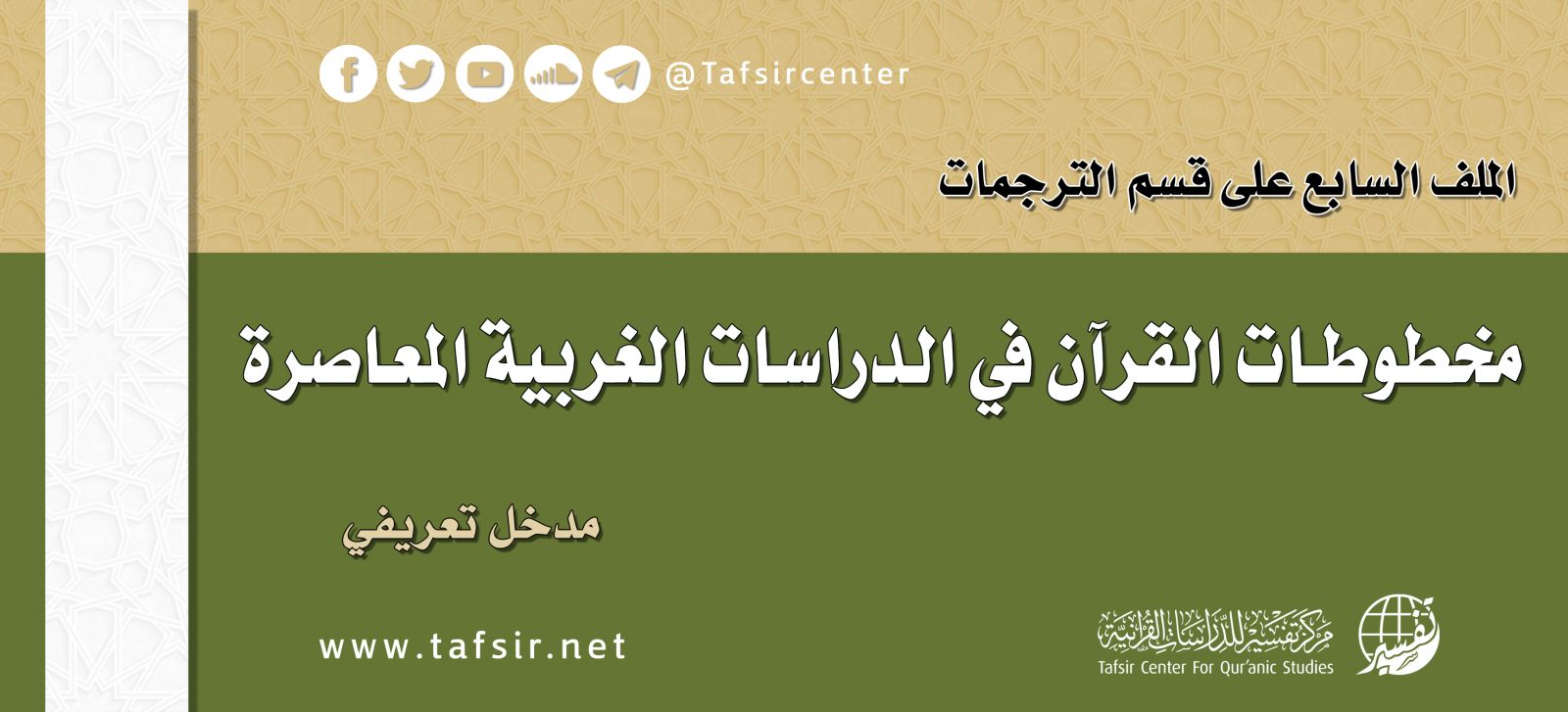 مخطوطات القرآن في الدراسات الغربية المعاصرة؛ مدخل تعريفي
مخطوطات القرآن في الدراسات الغربية المعاصرة؛ مدخل تعريفي


