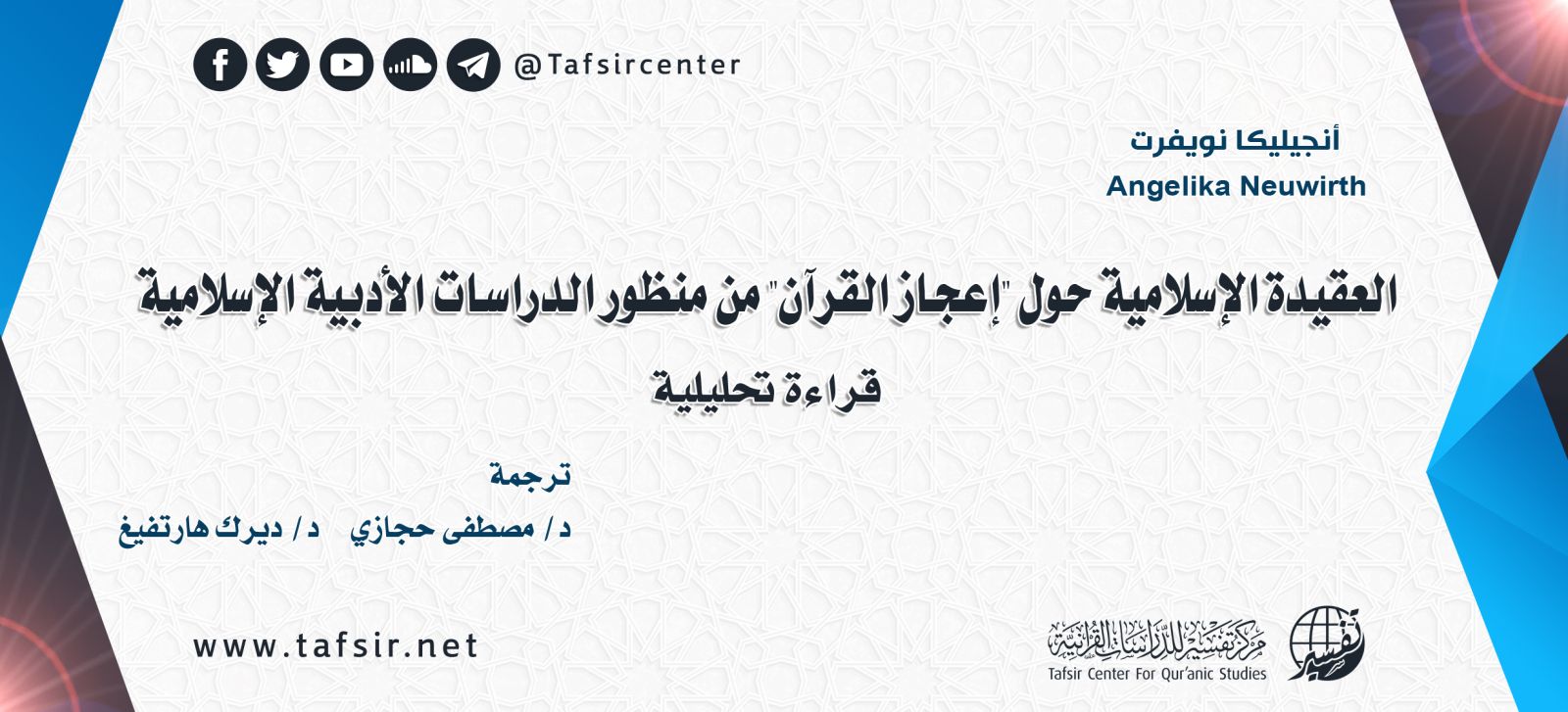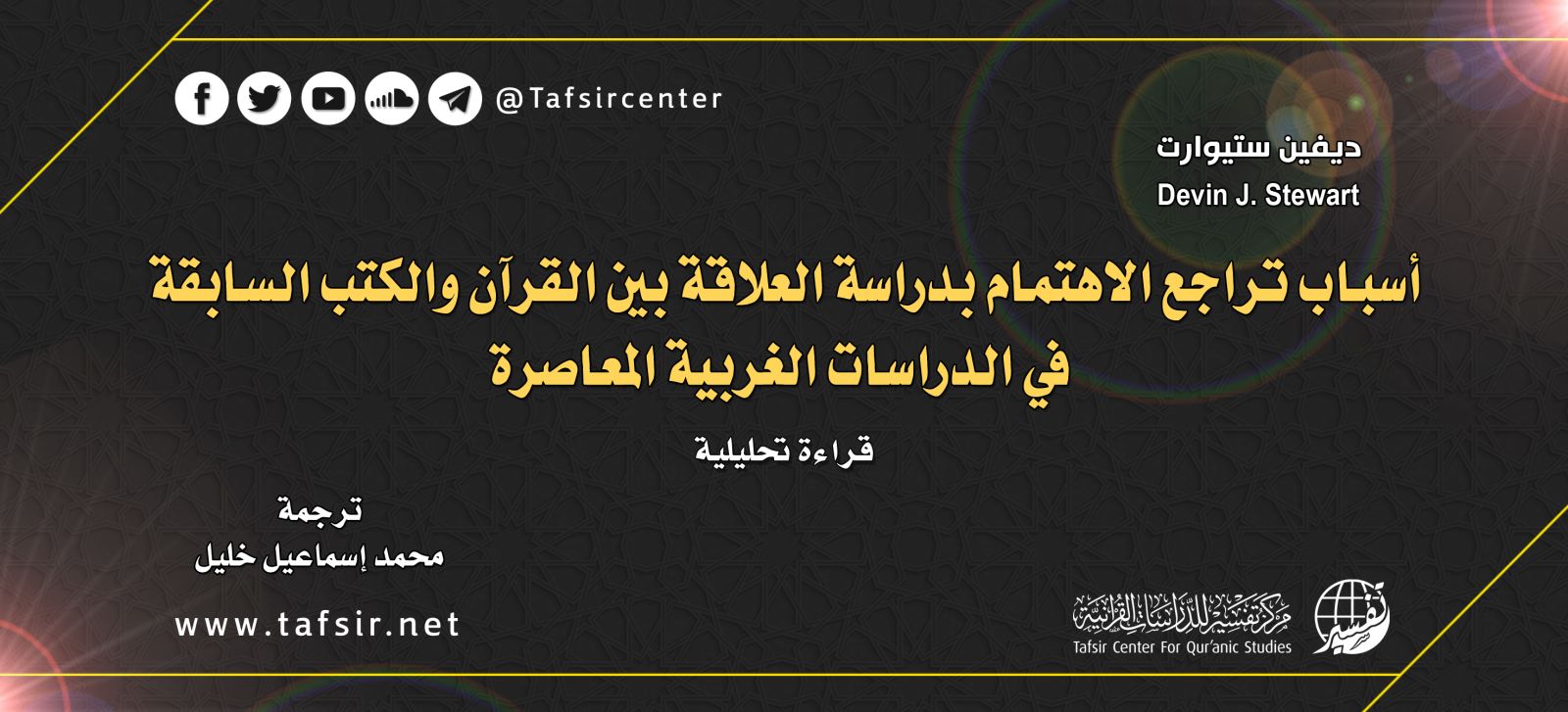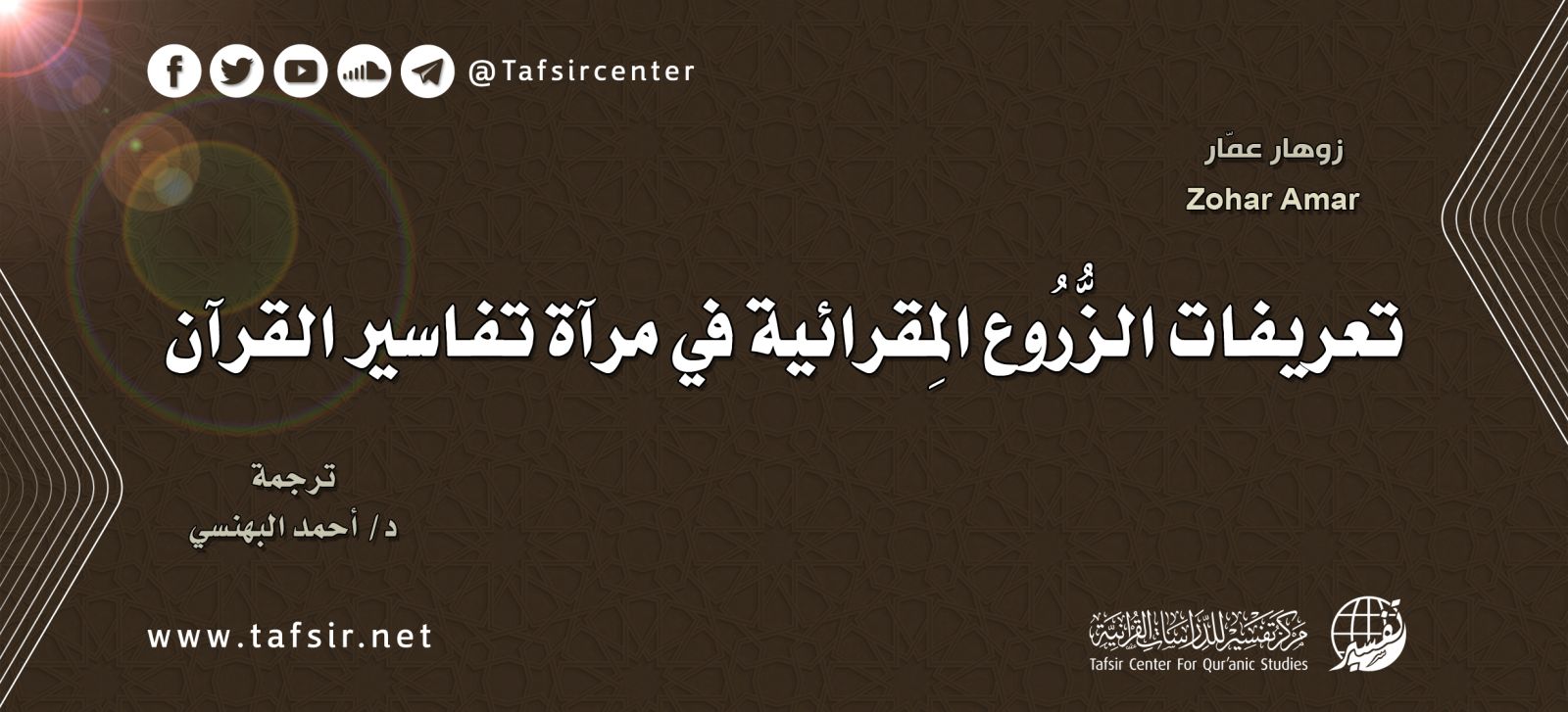جمع القرآن كعمل مُدوَّن؛ هل يُمثِّل "براديغم" لتدوين الحديث والعلوم الإسلامية
جمع القرآن كعمل مُدوَّن؛ هل يُمثِّل "براديغم" لتدوين الحديث والعلوم الإسلامية
الكاتب: غريغور شولر - Gregor Schoeler

جمع القرآن كعمل مُدوَّن؛ هل يُمثِّل "براديغم" لتدوين الحديث والعلوم الإسلامية[1]؟
مقدمة[2]:
تعرضت المدوَّنات الإسلامية للتشكيك الجذري من قِـبَل بعض الباحثين الغربيين في العقود الأخيرة، فيما يعرف بالاتجاه التنقيحي مع جون وانسبرو وجيرالد هوتنج وغيرهم، الذي اعتبر أنه من غير الممكن الثقة في مصداقية المدونات الإسلامية التقليدية، أو الاعتماد عليها في بناء سردية حول تاريخ القرآن وتاريخ بدايات الإسلام، كما كان صنيع معظم المستشرقين الكلاسيكيين. في مواجهة هذا الطرح قدّم بعض الباحثين رؤى جديدة للمدوَّنات التقليدية، تقوم على أساس إمكان الاستفادة من هذه المدوَّنات عبر تفعيل منظورٍ نقديٍّ يستطيع استخلاصَ الحقيقةِ التاريخيةِ منها، ومن أهم الباحثين أصحابِ هذه الرؤى: غريغور شولر، والذي اعتبر أن المرويات التي تذخر بها المدوَّنات التقليدية حول تاريخ القرآن وتاريخ بدايات الإسلام - وإنْ صَعُبَ اعتبارها صادقة في كل تفاصيلها وَفْقًا له، إلا أنها كذلك - ليست «تَزْيِيفًا ورعًا للتاريخ» كما يدّعي التنقيحيون، بل يستطيع المؤرخ أن يقف فيها عبر التحليل النقدي على «نواة أصيلة» من الأحداث تُعِينُه على بناء سردية موثوقة بقدر كبير لتاريخ القرآن وتاريخ بدايات الإسلام.
وعَمَلُ غريغور شولر على المدوَّنات التقليدية مَتّسِعٌ؛ حيث يشمل تاريخ القرآن والسيرة وتاريخ نشأة العلوم الإسلامية؛ خصوصًا الحديث، ضمن اهتمامٍ أوسع، هو انتقال الثقافة العربية من الشفاهة إلى التدوين.
في هذه المقالة يقارن شولر بين مراحل تدوين القرآن، ودوافعه، والعوائق أمامه، ومراحل تدوين الحديث، ودوافعه، والعوائق أمامه، ويحاول عبر هذه المقارنة أن يحاجج عن كون عملية تدوين القرآن كانت بمثابة البراديغم (النموذج) لتدوين الحديث، ومن ثَمَّ لنشأة العلوم الإسلامية، فتُبرِزُ المقالةُ بهذا كيف أنّ عملية تدوين القرآن كانت بمثابة المركز لانتقال العرب من الشفاهة إلى التدوين.
تُقدِّم هذه المقالة إذن منظورًا خاصًّا لتناول عملية تدوين القرآن من زاوية مختلفة، هي زاويةُ دَوْرِ هذه العملية في نشأة العلوم الإسلامية، وفي بناء حضارة جديدة يقع في قلبها النصُّ القرآنيُّ.
المقالة[3]
كان القرآن[4] كتابًا بالفعل أثناء حياة النبي، وإن لم يَعْدُ كونَه مجرّدَ هدفٍ أو فكرة مستهدَفة وقتئذٍ، وليس كتابًا مدوَّنًا في الحقيقة[5]. ولم يكد يمضي 20-25 عامًا على وفاة النبي حتى أصبح القرآن كتابًا مدوَّنًا بالفعل. وقد أحرزت عملية التدوين تقدُّمًا ملحوظًا من مجرد تدوين مُسوَّدات يتم بطريقة عرَضية، إلى عملية جمع مُتعمَّدة، إلى كتابٍ مُحرر ومنشور.
الحديث (التقليد، مفرد)، وهو التقارير الموروثة (التقاليد أو الأحاديث، جمع)[6] من أقوال وأفعال النبي محمد، تُدُورِسَ في الأصل وتُنوقِلَ بطريقة شفوية خالصة، وليست كتابية. ومع ذلك، دَوّن بعضُ علماء الحديث (يطلق عليهم أيضًا المُحدِّثين) منذ البداية بعضَ الملاحظات الحديثية بين الفَيْنة والأخرى، وفي وقت لاحق (منذ حوالي عام 680م)، قاموا بتصنيف بعض الأعمال، واعتبارًا من منتصف القرن الثامن، بُوِّبت تلك المصنفات بطريقة منهجية وقُسِّمت إلى أبواب وَفْقًا للمعايير ذات الصلة بالمحتوَى الموضوعيّ[7]. وبعد مُضيّ حوالي 100 عامٍ أخرى، أصبح الحديث قائمًا بذاته في كتبٍ مدوّنة (بطريقة أو بأخرى)، وأهمها المدوَّنات المعتمدة للبخاري (ت: 870م) ومسلم بن الحجّاج (ت: 875م)، والتي توازي القرآن تقريبًا من حيث أهميتُها في الديانة الإسلامية.
واعتمادًا على الملاحظات التي تشير إلى أن عملية تدوين كلٍّ من القرآن والحديث تُظهِر تشابهاتٍ مهمةً جديرةً بالاعتبار، وأن تدوين العديد من العلوم العربية الإسلامية ماشَتْ بشكل مشابه عمليةَ تدوين الحديث، فإنني سوف أبحث فيما يأتي عمّا إذا كان تدوين النص المقدس الإسلامي عَمِل بمثابة براديغم تدويني، احتُذِيَ لحظة تدوين الحديث وغيره من العلوم الإسلامية العربية الأخرى أم لا؟ ولا ينبغي أن يُفهم مصطلح (براديغم) هنا على أنه تجربة (روحية) مبكرة، ولكن بوصفه نمطًا من التطور الذي يكرر نفسه مرتين أو أكثر؛ لأن الشروط ذاتها تستدعي نفس التأثير. والسؤال الآن عمّا إذا كان مثل هذا النمط يمكن أن يقتضي فائدة معيّنة أم لا؟ فإذا كان بالإمكان الوصول إلى إجابة إيجابية لهذا السؤال، فمن الممكن أن نبرهن على وجود انتظامٍ ما وقع بموجبه التطور من الشفاهة إلى الكتابة في الإسلام.
القرآن:
في البدء، عندما كانت آيات الوحي لا تزال تتسم بالقِصَر، ربما لم تنشأ حاجة إلى تدوينها. ومع ذلك، تغيَّر هذا الموقف لاحقًا عندما أصبحت الآيات أطول وأكثر تتابعًا. ومن المرجح أن يكون محمد قد بدأ في كتابة آيات الوحي في وقت مبكر، خلال ما يسمى بالحقبة المكية الثانية (615-20) (Nöldeke 1909-38:i, 45f. and ii.1ff.; Watt 1977:37 and 136; Bellamy 1973:271; Neuwirth 1987:102). يمدنا التقليد الإسلامي بتفاصيلَ عديدةٍ عن عملية التدوين تلك، بما في ذلك أسماء مختلف الأفراد الذين أملَى عليهم محمد آياتٍ قرآنيّةً. ويكفي في هذا المقام أن نذكر أهم (كُتّاب الوحي)، وهو زيد بن ثابت (توفي عام 666م). ومع ذلك، لم تكن هذه الكتابات تشكل أكثر من مجرد وسيلة تُعِينُ المؤمنين على التلاوة.
لا نعرف على وجه الجزم متى أصبح مشروعُ إنتاجِ (كتابٍ)، (كتابٍ مقدسٍ) حقيقي؛ أولويةً للمسلمين. ومع ذلك، توضح حقيقة أن القرآن ذاته قد بدأ في استخدام مصطلح كتاب [(الكتاب المقدس)، أو (الكتاب)] بوتيرة متزايدة لوصف الوحي ككل، وهو المصطلح الذي وبشكل فعال حلّ محل مصطلح القرآن [بمعنى (التلاوة)] - توضح هذه الحقيقة أن فكرة جمع النص المقدس، في هيئة كتاب، مثل تلك الكتب التي يمتلكها «أهل الكتاب» (المسيحيون واليهود)، وتحديدًا كتاب للقراءات الطقوسية lectionary(Neuwirth 1987: 102f.)؛ اكتسبت المزيد والمزيد من الأهمية.
ومع ذلك، لم يكن ثمة (كتاب مقدس) أو (كتاب) جُمع بين دفتين لحظة وفاة محمد، وتتفق التقاليد الإسلامية وأغلبية الباحثين المعاصرين على تلك النقطة[8]. وبحسب التقاليد الإسلامية، كل ما كان موجودًا في ذلك الوقت، بجانب التقليد الشفهي، كتابات متناثرة كُتبت على مواد مختلفة، مثل الرقوق وأوراق البردي، والصخور الملساء، وجلود الحيوانات، وعظام الأكتاف، وسيقان النخيل، والألواح، والصحُف، تحتوي «فيها الكتاب» (Ibn Abī Dāwûd 1936-37:24 [Arabic]).
وبحسب الرؤية السائدة في التقليد الإسلامي، جُمع القرآن لأول مرة بأمرٍ من أبي بكر بِناءً على نصيحة عمر، وهي المهمة التي نهض بها بعد ذلك كاتب الوحي الأهمّ: زيد بن ثابت؛ ونتج عن هذه المهمة تجميع نسخة مدونة على صُحُف حظيت بذات الشكل والحجم. وهكذا ظهر كتاب (بين لوحين)، وهو مخطوطة فعلية قائمة، وكانت هذه المخطوطات المجموعة، المسمّاة في المصادر (صُحُفًا)، نسخة شخصية أراد الخليفة أن يمتلكها لاستخدامه الخاص. وعندما مات عمر، انتقلت ملكية هذه الصحف إلى ابنته حفصة.
ومع ذلك، لم يكن الخليفة وعائلته وحدهم من يمتلكون نسخة من القرآن من أجل استخدامهم الخاص؛ فبحسب التقليد الإسلامي، كانت هناك أيضًا نسخ أخر، دوّنها أفراد مختلفون كانوا معاصرين لجمع نسخة أبي بكر وعمر. وينصّ التقليد على العديد من الأفراد البارزين (الذين ماتوا بحلول عام 640 أو بعد ذلك) ممن امتلكوا نسخًا خاصة بهم من القرآن، وأشهرهم: أُبَيُّ بن كعب (توفي عام 640 أو في وقت لاحق تقريبًا)، وعبدُ الله بن مسعود (توفي عام 653 أو في وقت لاحق)، اللذان قيل إنهما كانا يحوزان نُسَخًا كاملة من القرآن بِناءً على جمعهما الخاص.
وبالرغم من ذلك، وفي ظل غياب (نسخة) رسمية، أصبحت التهجيات المختلفة الملحوظة في القرآن موضوعًا للنزاعات حول الشكل (الصحيح/ المُحرَّر) للنص المقدس. وعندما نشأت مثل هذه الخلافات حتى بين عناصر الجيش، مما هدد الشعور بالوحدة الإسلامية، قرر الخليفة عثمان (حَكم 644-656) إصدار طبعة رسمية من النص القرآني، وهو ما أصبح معروفًا باسم (المصحف العثماني).
ومرةً أخرى، وقعت مهمة جمع وتحرير الوحي على عاتق زيد بن ثابت، ولكن هذه المرة بمساعدة لجنة استشارية (مكونة من ثلاثة أعضاء من ذوي الأنساب المكية الشريفة). وتُجمِع المصادر الإسلامية على هذه النقطة، وتتفق غالبية الروايات على أن زيدًا وأولئك الذين عاوَنُوه استندوا إلى مجموعة الصحف التي كانت بِحَوْزَةِ حفصة بنت عمر. وقام عثمان بإضفاء الطابع الرسمي على النسخة التي فوضهم بجمعها من خلال الأمر بإرسال نُسَخ إلى جميع أمصار الإمبراطورية، حيث كانت بمثابة النسخ المعتمدة ذات السُّلطة. بالإضافة إلى ذلك، أمَر بتدمير جميع المصاحف التي لا تتفق مع النسخة الرسمية الجديدة.
لقد أضحى القرآن الذي كان قائمًا نظريًّا فحسب في زمن النبي حقيقةً واقعية الآن؛ كتابٌ ذو هيئة وصياغة نهائية (تقريبًا)، ومدوَّن في (مصحف). والأكثر من ذلك أنه أصبح في أذهان السلطة المركزية (كتابًا منشورًا) كان نصُّه مُلزِمًا لكل مسلم. وقد (نُشِر)، بمعنى: إرسال نسخ معتمَدة منه إلى عواصم المقاطعات الإسلامية. «ومع الجمع العثماني، تحول التركيز الرئيس في تداول القرآن نحو الكتاب المكتوب». (Nöldeke 1909-38:iii, 119).
كان التناقل الشفهي للقرآن من البداية حاضرًا إلى جانب النَّسْخِ الكتابي، واضطلع به في الأساس «طائفة» «قرّاء» القرآن (أو بالأحرى القرّاء). قبل «الجمع العثماني»، كانت التلاوة هي الطريقة الوحيدة لِبَثِّ و(نشر) النص. بعد ذلك، فقدَت هذه «الطائفة» جزءًا من أهميتها؛ لأنها لم تَعُد هي القيّم الوحيد على نص الكتاب المقدس، لهذا يبدو أنّ قرّاء القرآن كانوا يعارضون بشدة هذه الخطوة، وقد تجلت هذه المعارضة بوضوح في التهمة التي وُجِّهت فيما بعد لعثمان على لسان العديد من المتمردين: «كان القرآن مصاحف عدّة، فأحرقْتَها إلا واحدًا» (at-Tabarī 1879-90:i, 2952.) ومع ذلك، كان قرّاء القرآن قادرين -مع بعض التحفظ- على الحفاظ على أهميتهم حتى بعد تحرير النص القرآني، في ضوء الحقيقة القائلة بأن «النص العثماني كان نصًّا غير منقوط، ورسمًا[9] غير مشكول» ولا يمكن تلاوته بشكل صحيح دون توجيه من العالِمِين به، ولا يزال لدى قرّاء القرآن ما يمكنهم القيام به. ولكن رغم ذلك، ومن الآن فصاعدًا، كان عليهم أن يأخذوا النص العثماني الساكن كأساس لتلاوتهم.
الحديث:
خلافًا للقرآن، كان مقصود الحديث في الأصل أن يُدرَس ويُتناقل نقلًا شفويًّا خالصًا. ومن المؤكد أن هذا الأمر لم يتنافَ مع كون العديد من صحابة النبي قد قاموا بالفعل بتدوين بعض المسوَّدات كإسعاف للذاكرة، وثمة أدلةٌ وافرة على هذه الممارسة. وبحسب ما ورد في الروايات، امتلك العديد من الصحابة صحفًا للتدوين. وقيل إن ابن عباس [ابن عم النبي وأحد أعمدة تفسير القرآن المؤسسين] شُوهِد يحمل «ألواحًا» «كَتب عليها شيئًا من أعمال رسول الله» (Ibn Sa‘d 1904-28:ii, 2, 123). ومع ذلك، كان هذا التدوين نتيجة جهود فردية متفرقة وغير منهجية.
لم يتغير هذا النهج حتى مجيء الجيل الأول من (التابعين)، الذين كانوا نشطين في الربع الأخير من القرن السابع وفي الربع الأول من القرن الثامن، كما هو مقدَّر تقريبًا، ولم يكن لديهم خبرة مباشرة بمحمد. وهنا بدأ بعضهم بشكل واضح في الاستفسار من أشخاص مختلفين عن حياة وكلمات الرسول، وبالتحديد من الصحابة الذين كانوا لا يزالون على قيد الحياة، وقاموا بتجميع هذه التقارير (الأحاديث)، بطريقة أو بأخرى. ويجدر بنا أن نلاحظ مباشرة أن هؤلاء الرواة قاموا بشكل عام قبل أن يذكروا الأحاديث بتسمية مَن رَوى لهم تلك الأخبار، وتطورت تلك الممارسة لاحقًا بنفس الطريقة بحيث شكّلت سلاسل من الراوين تسبق منطوق النصوص ذات الصلة (وهو ما يسمى بالأسانيد، على سبيل المثال: حدثنا ‘أ‘ أخبرنا ‘ب‘ عن ‘ج‘ "قال...).وقد أصبح هذا النهج مُلزِمًا في وقت لاحق، وبهذه الطريقة، يتكون كل حديث من جزأين: سلسلة من الرجال (الإسناد)، والنص محلّ الموضوع (المتن).
كان عروة بن الزبير (حوالي 643-712)، نجل ابن عمة النبي وابن أخت زوجته المفضلة عائشة[10]، هو أهم علماء الجيل الأول من التابعين. فمن ناحية، جمع العديد من التقاليد الفقهية والروايات التاريخية الأخرى عن حياة محمد، وهي التي شكلت نواة كتب السيرة اللاحقة (أي: سيرة محمد). وكثيرًا ما كان يروي الحديث عن خالته عائشة، وتذكر المصادر صراحة أنه دوّن كتبًا لأحاديثه الفقهية، وقد رواها عادة مبوَّبة في فصول حسب موضوعها، وهذه في الواقع هي بداية «التصنيف» الذي أصبح ممارسة شائعة في وقت لاحق فقط (انظر أدناه). وهكذا، اعتاد أن يبدأ تصنيفه بباب الطلاق، ثم يعالج مسألة الطلاق بِناءً على طلب الزوجة (الخلع)، ثم الحج، وهكذا... (al-Fasawī 1981:i, 551)، وقد نشر عروة ومعاصروه تقاليدهم التي جمعوها شفويًّا من خلال حلقات التعليم العامة. لقد أصبح نقل المعرفة بهذه الطريقة، حيث كان النقل والتعليم ممارسة واحدة، يحيل فيها المُعلِّم إلى من علّمه، أو إلى سلسلة من الناقلين (الإسناد)، أقول: أصبح نقل المعرفة بهذه الطريقة أحد المحددات المهمة في العديد من العلوم العربية-الإسلامية. نحن الآن نتحدث عن (المنهجية العلمية) methodology للمُحدِّثين.
من الممكن أن يكون الدافع الذي حفّز عروة بن الزبير في البداية لاشتغاله بسيرة النبي قد جاء من بلاط الخليفة؛ فقد أرسل إليه الخليفة عبد الملك بن مروان (685-705) رسائل يسأله فيها عن أحداث وقعت في حياة محمد، وأجاب عليها عروة عن طريق كتابة الرسائل. ومن ناحية أخرى، عَمَّم محتوى هذه الرسائل عروةُ في دروسه، وبقيت هذه الرسائل في هذا الشكل المنقول لتمثّل أقدم شهادة مكتوبة على حياة محمد، كما أنه من المفترض أيضًا أن تكون أول تصانيف واسعة النطاق من الأحاديث الفقهية قد أُطلقت بمبادرة من بلاط الحُكم، وتحديدًا في عهد الخليفتين الأمويين عمر بن عبد العزيز (717-20) وهشام بن عبد الملك (724-43). ومع ذلك، لم تعد هذه المصنفات موجودة (Goldziher 1890:208ff.; Sezgin 1967-84:i, 55ff.; Schoeler 2006:123ff.).
بعد جيلين -أي حوالي منتصف القرن الثامن- ظهرت طريقة أكثر منهجية في التعاطي مع الأخبار المروية: التصنيف، وهو ترتيب الأبواب بحسب المحتوى الموضوعي (Goldziher 1890:226ff. [213ff. in Mālik’s al-Muwatta’]; Sezgin 1967-84:i, 55ff.; Schoeler 2002:71ff.)ـ[11]. وتسمى هذه الأعمال ذات الصلة بالمُصنَّفات (ومفردها: مُصنَّف). وأشهر مثال على تلك المصنفات من الأحاديث والمذاهب الفقهية هو موطأ مالك بن أنس (ت: 795)، وأشهر مصنف جمع سيرة النبي على هذا النحو في تلك الحقبة هو كتاب ابن إسحاق (المتوفى 767) «كتاب المغازي». واستمرت تلك النزعة لما يزيد عن قرن من الزمان، وتُعَدّ كتب الحديث المعتمدة لكلٍّ من البخاري ومسلم مصنفات أيضًا. وترجع المجموعة الأقدم لهذا النوع من المصنفات إلى القرن الثامن، حيث لم تكن تعدو أكثر من كونها صُحفًا مرتبة (أو غيرها من وسائل التدوين المساعدة) اتُّخذت كأساس لدروس العلم الشفوية، ومع ذلك، ومنذ القرن التاسع فصاعدًا، أصبحت المصنفات المعتمدة المدونة نصوصًا مثبَّتة بطريقة أو بأخرى. وأعني هنا بقولي: «نصوصًا مُثبَّتة بطريقة أو بأخرى» أن كل تصنيفات الحديث هذه، حتى المعتمدة منها، كانت مدونة في العديد من النُّسَخ والمخطوطات، مع وجود اختلافات في ترتيب الأبواب وبنية النص. وقد ظهر شيء أشبه بـ(طبعة نقدية) من صحيح البخاري فقط في القرن الثالث عشر (Fück 1938: 79ff.). ومع ذلك، فمن المؤكد أن بعض مصنفي القرن التاسع صنفوا أعمالهم آخذين جمهور القراء في عين الاعتبار، ويوضح صحيح مسلم بن الحجّاج هذا الأمر جليًّا؛ إذ إن مصنفه المعتمد هو المصنف الوحيد الذي يشتمل على مقدمة موجهة للقراء، وهي علامة لا تخطئها عين على كتاب «حقيقي» (مسلم 1972).
كانت عملية تدوين الحديث برمتها -حتى ظهور مصنفات الحديث المعتمدة في القرن التاسع- مصحوبة بنقاش محموم بين المُحدِّثين حول ما إذا كان مسموحًا بتدوين الأحاديث ابتداءً أم لا (Schoeler 2006:111ff; Cook 1997). اتخذت طائفة من علماء الحديث موقفًا يقضي بضرورة تناقل التقاليد شفهيًّا فحسب، وأن القرآن هو النص الحصري صاحب الحق الوحيد في التدوين. من وجهة نظر هؤلاء العلماء، كان القرآن هو كتاب الإسلام الوحيد ويجب أن يظل كذلك. وهكذا، حدّث العديد من العلماء بتقاليدهم التي قد جمعوها من الذاكرة، تاركين صحفهم المدونة (التي ظلت، على الرغم من كل شيء، بحوزتهم دائمًا) في منازلهم أو مخبوءة في مكانٍ ما، ونهوا تلاميذهم عن تقييد الحديث الذي يسمعونه منهم في حلقات الدرس. وفي حين حُوفِظَ على تلك الفرضية الشفوية الصارمة في العراق، في مِصْرَي البصرة والكوفة، حتى وقت طويل من القرن التاسع، إلا أنه تُخُلِّيَ عنها بالفعل منذ منتصف القرن الثامن في المدينة في إقليم الحجاز. وأحد المصنفات الفقهية الأولى التي وصلت إلينا (ليس في هيئته الأصلية، ولكن في روايات رواها الأتباع) هو موطأ مالك بن أنس (ت: 795) المذكور آنفًا. ومع ذلك، لا تزال نصوص مختلف روايات الموطأ متباينة بشكل كبير.
وبمرور الوقت تدريجيًّا، أصبحت مسألة شفاهة الحديث مجرد افتراض نظري، في حين أنه من الناحية العملية كانت هناك نُسَخ أكثر وأكثر من نصوص الحديث المكتوبة، وعندما نعقد مقارنة بين عمليتي تدوين القرآن والحديث، نرى أنه في كلتا الحالتين يمكننا التمييز بين ثلاث مراحل، وقد اعترفت بهذه المراحل بالفعل تلك المعارفُ المعنية، وفي حالة الحديث، تم تزويدها بمصطلحات فنية[12].
فقد دُوِّن القرآن على النحو التالي:
1. كتابات غير ممنهجة لنصوص الوحي على موادَّ متباينةٍ (قصاصات من الرقوق وأوراق البردي، قطع من الجلد، صُحُف، جريد النخيل، عظام، وما إلى ذلك...) إبّان حياة النبي محمد (وحتى وفاته في عام 632).
2. كتابات متعمَّدة على أوراق متساوية الحجم (صُحُف) بعد فترة قصيرة من وفاة محمد. ومن الأمثلة على ذلك نُسَخ القرآن التي كانت بحوزة عمر وابن مسعود وأُبيّ.
3. الجمع الرسمي النهائي في ظل حكم عثمان (حوالي عام 650)، وهو ما أسفر عن إنتاج (رسم) المصحف (أي: نص ساكن غير منقوط ولا مشكول)، ثم نشره عن طريق إرسال نُسخ إلى الأمصار الكبرى، من خلال نسخ المخطوطات لاحقًا.
تدوين الحديث:
1. كتابة غير ممنهجة في زمن أصحاب النبي محمد والتابعين الأوائل (632-80) على ألواح وصُحف وأوراق.
2. تدوين متعمَّد للمواد المتناثرة في الربع الأخير من القرن الأول والربع الأول من القرن الثاني الهجري (حوالي 680-740م).
3. إنتاج مصنفات مرتبة بشكل ممنهج وَفْقًا لمحتويات موضوع الباب (التصنيف)، بداية من حوالي 125هـ/ 740م إلى القرن التاسع وما تلاه، وفي نهاية القرن التاسع تقريبًا وضعت المصنفات المنقّحة.
بجانب هذه التشابهات[13]، ثمة أيضًا اختلافاتٌ يجب ملاحظتها بين عمليتي تدوين القرآن والحديث؛ فمن المهم أن نأخذ في عين الاعتبار أنه في حين وصل القرآن إلى صيغته النهائية (على الأقل فيما يتعلق بــ (الرسم)، أي: النص الساكن غير المنقوط ولا المشكول) بعد 25 عامًا تقريبًا من وفاة محمد، أي: حوالي عام 650، فإن مدوَّنات الحديث الأولى ذات النصوص الثابتة تقريبًا لم تظهر إلا بعد حوالي 250 سنة من ذلك الوقت، في القرن التاسع. ومع ذلك، فإن التشابه في عمليات التدوين لكل من الظواهر النصية الأكثر أهمية في الإسلام لا تزال جلية وبحاجة إلى تفسير.
لماذا ظهرت تدوينات حرة غير ممنهجة في المرحلة الأولى من تدوين القرآن والحديث فحسب؟
أ) أولًا القرآن: سادت لدى العرب قبل الإسلام -وفي وقت مبكر من ظهور الإسلام- أفكارٌ ضبابية غامضة عن ماهية الكتاب «الحقيقي»، أي: الكتاب الكامل المُحرَّر. وبصَرْفِ النظر عن صُحُف التوراة اليهودية، والتي لم يكن من الممكن رؤيتها على الإطلاق خارج نطاق أماكن التعليم اليهودية، فإن الكتب المحرّرة الوحيدة المعروفة كانت كتب الطقوس وكتب الخدمة الدينية التي يستخدمها رجال الأكليروس السريان أو الناطقين باللغة العربية. وبالتالي، عندما يصف القرآن نفسه بــ«الكتاب»، فمن المؤكد أن المعنى المقصود هو الكتاب الطقسي. ومع ذلك، لم يكن بالإمكان تحرير القرآن خلال حياة النبي؛ لأن الوحي كان لا يزال متواصلًا، ولأن الشروط التشريعية كان يجري تعديلها (أو إبطالها)[14] من حين لآخرَ. كما لم تكن هناك أيّ حاجة على الإطلاق لتحرير نص القرآن؛ لأنه ككتاب إرشادي أو طقسي، كان يتم نسخ الآيات المنجّمة منه فقط في كل مرة. وهكذا لم يكن لدى «أمناء الوحي» وقرّاء القرآن فرصةٌ خلال حياة النبي لإنتاج كتاب محرّر. بل كان يكفي فقط تدوين مقاطعَ قصيرةٍ تكون عونًا للذاكرة على الاستظهار[15].
ب) ثانيًا الحديث: كما رأينا من قبل[16]، كان القرآن بالدرجة الأولى، حتى قبل أن يتبلور في صورته النهائية، هو «الكتاب» بامتياز في الإسلام، حتى ولو بدأ كفكرة وغاية مستهدفة فحسب. والأكثر من ذلك، يجب أن تكون الفكرة التالية قد فرضت نفسها بعد فترة محددة من الجمع النهائي للقرآن؛ أيْ: كتاب آخر يتم تحريره يستوي مع كتاب الله. وعلى الرغم من أن جميع المُحدِّثين لم يتبنوا هذا الرأي -منذ منتصف القرن الثامن كان هناك أيضًا مؤيدون لتدوين الحديث- لفترة طويلة، إلا أن هذه الفكرة عاقت، بل منعت، ظهور أيّ كتب أخرى بجانب القرآن، يشرح لنا هذا الموقف لماذا حدثت مقاومة لتدوين الحديث، بل ينعكس هذا النفور على الحديث ذاته؛ على سبيل المثال، يُروى عن محمد، عندما أراد شخصٌ ما أن يكتب عنه كلماته، أنه قال: «أكتابًا غير كتاب الله تريدون؟» (al-Khatīb 1975:33ff.). وعن أحد (التابعين) [وهو من الجيل الذي جاء بعد أصحاب محمد]: «تريدون أن تجعلوها مصاحف؟» (36ff.). كما وُجِدت فكرة أخرى الْتَأمَت مع هذه الفكرة، وهي أنّ (أهل الكتاب)، اليهود والمسيحيين، قد حرّفوا ملّتهم عندما قبلوا بكتب أخرى غير كتب الوحي. وقد جاء عن محمد قوله: «ما أضلَّ الأممَ مِن قبلكم إلا ما اكتتبوا من الكتب مع كتاب الله» (33ff.). (مصدر القلق هنا ينبع إلى حد كبير من التقاليد الشفوية لليهود [المشناه والتلمود] التي لم يكن من المفترض أن تُدَوّن في الأصل)؛ لهذا السبب، تُدُورِسَ الحديث (وغيره من العلوم العربية الإسلامية الأخرى أيضًا) وتُنوقِلَ شفويًّا فقط عن طريق الدروس في حلقات الدرس العلمية، ومع ذلك، أثبتت المسوَّداتُ وغيرُها من وسائل دعم الذاكرة (حتى التصانيف الشاملة التي ظهرت لاحقًا، والمبوّبة حسب موضوع الباب) أنها ضرورية أكثرَ من أيّ وقت مضى، وأنها كانت قادرة -على الرغم من الاعتراضات- على فرض ذاتها بدرجة متزايدة.
كيف نشأ التدوين المتعمَّد؟
أولًا القرآن: عند وفاة النبي انقطع الوحي، ويمكن الآن النظر إلى المادة القرآنية على أنها مجموعة من المواد القائمة بذاتها، وأراد العديد من الصحابة -لا سيما بالطبع خلفاء محمد في الحُكم- الحصولَ على نُسخٍ خاصّة تكون تحت تصرفهم؛ لذلك شرعوا في إنتاج نسخ متعمَّدة، ولم نقف على أيّ معارضة لهذه المبادرات.
ثانيًا الحديث: ظهرت مدوَّناتٌ متعمَّدة من أقوال وأفعال وتقارير محمد في وقت رحيل جيل الصحابة الذي عاصر حياة محمد. وفي هذه الأثناء، بدأت تتشكل فكرة الشخصية القدوة، أو الاقتداء بهدي محمد في حياته، بين علماء الفقه، أو بين أُناس منهم على أيّـةِ حال (Juynboll 1983:30f.)؛ كما أن تقارير أقواله وأفعاله التي عبر عنها في هيئة الأحاديث، والتي تُنوقِلَت بلا تدقيق حتى ذلك الحين، يجب الحفاظ عليها وجمعها وإتاحتها، ونحن نسمع بشكل متكرر عن تلك المشاريع التي بدأها بلاط الخلفاء. وهنا يظهر دَور نزعة المحاباة؛ إذ نقرأ أن الخلفاء أرادوا، من خلال استفساراتهم (كما حدث مع عروة بن الزبير على سبيل المثال) ومن خلال غيرها من وسائل الجمع التي أمَروا بها، الوصول إلى المواد المناسبة لهم (Schoeler 1996:150 and 2006:123ff.; Petersen 1963:102ff.). وخلافًا لحالة القرآن، نشأت جدالات كبيرة ومستمرة خلال هذه المرحلة الثانية من تدوين الحديث؛ فقد ناقش المُحدِّثين طوال القرن الثامن وما يليه ما إذا كان جائزًا تقييد التقاليد أم لا، وتعرضت المدوَّنات المتعمدة التي أمَر البلاط بجمعها على وجه الخصوص لانتقادات حادة.
كيف حُرِّر القرآن ومدونات التقاليد اللاحقة عليه؟
أولًا القرآن: لقد اعتاد قرّاء القرآن على نقل ونشر القرآن من خلال التلاوة الشفوية، والتي كانت تستند في معظمها على ملاحظاتهم المكتوبة. وعلى هذا النحو، لم تكن هناك حاجة بالنسبة إليهم للتحقق فيما إذا كانت النصوص المكتوبة التي بحوزتهم متطابقة أم لا، واتخذ كلٌّ منهم موقفًا مُفادُه أن النص الذي كان بحوزته هو النص الأفضل. من ناحية أخرى، كانت الصيغ المختلفة التي وُجد فيها «الكتاب» نصًّا وتلاوة، تمثل مشكلة لِمَن هم في سُدَّة الحُكم، خاصةً بعدما نشبت الخلافات في هذا الصدد، حتى بين صفوف الجيش. وهكذا أصبح من الضرورة بمكان أن يُنتَجَ نص نهائي وموحد وملزِم للإمبراطورية الضخمة التي تشكّلَت في تلك الفترة؛ كان هذا النص هو المصحف العثماني. ويرجع أول دليل إثبات مكتوب لهذا المصحف (مخطوطات القرآن في صنعاء) إلى عهد الخليفة الوليد بن عبد الملك (705-15) (von Bothmer 1991:46)، وبالتالي، يجب أن يكون «مصحف عثمان» قد انتشر على نطاق واسع في هذا الوقت[17]. ويبدو أن معارضة جمعِ القرآن نشأت بين قرّاء القرآن الذين خَشُوا ضياعَ احتكارهم المطلق له.
ثانيًا الحديث: تربط صيرورة تناقل التقاليد الصحيحة بين ظهور حركة التصنيف في منتصف القرن الثامن، وانتشار العلماء في المدن الإقليمية للإمبراطورية، وصعود الحركات الهرطوقية: «كان ذلك في الوقت الذي رحل فيه العلماء إلى المدن الكبرى، وعندما أصبح الابتداع في الدين أكثر شيوعًا» (ابن حجر 1978: 5). ويمكننا فهم ذلك على أنه يعني أن المصنفات الشاملة اعتُبرت ضرورية في تلك المرحلة من الوقت، عندما كان على العلماء الذين لم يعودوا مقيمين في المدينة (موطن السُّنة) بل في مدنٍ أخرى - أن يتعاملوا مع عدد أكبر من التقاليد الصحيحة وغير الصحيحة على حد سواء، والتي كان عليهم أن يخضعوها عندئذٍ للفحص والتدقيق. وهذا هو بالفعل الوقت الذي ظهر فيه نقد الحديث (Juynboll 1983:xx, 134ff.). ومع ذلك، ومن أجل أن تكون المصنفات الكبيرة قابلة للاستخدام، نشأت حاجة إلى نظام تنسيقي، فكان الترتيب بحسب المحتوى الموضوعي مناسبًا بشكل خاص (التصنيف)، ولكن بعد ذلك بقليل تم استخدام ترتيب آخر، أي: الترتيب بحسب الرواة الأوائل (المُسْنَد) (Sezgin 1967-84:i, 55; Juynboll 1983:22)، وقد استغرقت هذه الأعمال -حوالي- قرنًا آخر على الأقل لتصل إلى نماذج ثابتة تقريبًا[18].
والآن، دعونا نعود إلى السؤال المطروح في البداية: هل يمثل تدوين القرآن براديغم لتدوين الحديث وغيره من العلوم العربية الإسلامية الأخرى؟
أظهر الفحص التفصيلي لكل مرحلة من المراحل الفردية لتدوين القرآن والحديث، والأسباب والخلفيات الأساسية ذات الصلة، أن الدوافع المتشابهة جزئيًّا قد أدت إلى ذات النتائج أو إلى نتائج مشابهة. فإذا ما قسمنا الدوافع التي شجعت أو عاقت التقدم في عمليات التدوين (لفترة معينة من الزمن) إلى دوافع «عملية» وأخرى «أيديولوجية»، يمكننا عندئذٍ التحقق من عدة نقاط.
أولًا: كان التدوين الأولي لكل من القرآن والحديث يتم على أساس عملي؛ فقد كانت وظيفة النص في كلتا الحالتين هي تعزيز الذاكرة، وفي هذه المرحلة الأولى من التدوين لم تكن هناك أسباب أيديولوجية تعارض عملية التدوين.
ثانيًا: كانت هناك أسباب عملية تدعو إلى عمليات الجمع المتعمَّدة لكل من القرآن والحديث (المرحلة الثانية من التدوين)؛ فقد أراد الأفراد -وعلى رأسهم الحاكم والدوائر المقربة منه- حيازةَ نُسَخٍ من القرآن ونصوص الحديث تحت تصرفهم من أجل استخدامهم الخاص. وفي حين لم يكن هناك سبب يدعو لمعارضة التدوين غير الرسمي للقرآن بغرض الاستخدام الخاص، نشأت تحفظات أيديولوجية قوية ضد تدوين الحديث. لقد كان وجود القرآن مدوَّنًا في هذه اللحظة تحديدًا هو الذي عاق -لفترة طويلة- تطوير مجموعة ثانية من النصوص الدينية المدونة للمستقبل. كما كانت هناك أسباب أخرى إضافية وعلى رأسها التخوف من أن يقوم المصنفون أو من ينوب عنهم بإدراج تقاليد غير صحيحة وغير مؤكدة ومغرضة في مصنفاتهم، وبالتالي تصبح هذه النصوص المشكوك في صحتها مُلزِمةً طَوال الوقت.
كما ارتكز أيضًا الجمع النهائي والرسمي للنص القرآني، وعمليات التدوين الممنهج والواضح للحديث (المرحلة الثالثة من عملية التدوين) على أسباب عملية؛ ففي كلتا الحالتين أراد أحدهم أن يُنتج نصوصًا موحدة وموثوقًا بها (لاحظ لفظة «صحيح» التي تطلق على المدونات المعتمدة لكلٍّ من البخاري ومسلم). كما واجه كلا المشروعين معارضة ذات طابع أيديولوجي؛ ففي حالة القرآن، جاءت المعارضة من جانب المصالح الحِرَفية لقرّاء القرآن من الذين يبدو أنهم فقدوا احتكارهم للكتاب المقدس بصفتهم الأمناء الوحيدين عليه[19]، وفي حالة الحديث، استمرت الشكوك المتزايدة حيال تنصيب نصوص دينية مشابهة إلى جانب القرآن، ونشر تقاليد غير مؤكدة ومغرضة، وما إلى ذلك من اعتراضات.
لذلك، نخلُص إلى ما يأتي: في حين أنّ دوافع تدوين القرآن والحديث كانت متماثلة أو متشابهة، فإن أسباب عرقلة عمليات التدوين كانت مختلفة تمامًا. الجدير بالذكر أن القرآن ظلّ كتاب الإسلام المُحرَّر لمدة قرون، في حين مُنع تدوين الحديث رسميًّا بشكل واضح، ويمكننا رؤية حالة الاضطراد في التدوين فقط في حالة ميل مجموعة من العلماء الذين ينقلون مجموعات كبيرة من النصوص -مع تيسُّر الكتابة ولأسباب عملية- إلى تحرير هذه الروايات كتابةً. ويمكن للاعتراضات «الأيديولوجية» أن تحبط هذه العملية لفترة طويلة من الزمن، ومن الأمثلة على ذلك في الثقافات الأخرى، عمليات التدوين المتأخرة للغاية للفيدا (von Hinüber 1990) والأفيستا (Hoffmann and Narten 1989) والتي استغرقت حوالي 1000 عام (أو أكثر) لتصبح أعمالًا مدوَّنة[20].
المراجع:
- Bellamy 1973: James A. Bellamy. “The Mysterious Letters of the Koran: Old Abbreviations of the Basmalah.” Journal of the American Oriental Society, 93:267-85.
- al-Bukhārī 1410/1990: Muhammad ibn Ismā‘īl al-Bukhārī. Sahīh al-Bukhārī. Ed. by M. D. al-Bughā. 7 vols. Beirut, Damascus: Dār Ibn Kathīr.
- Burton 1977: John Burton. The Collection of the Qur’ān. Cambridge: Cambridge University Press.
- Cook 1997: Michael Cook. “The Opponents of the Writing of Tradition in Early Islam.” Arabica, 44:437-530.
- Bearman, Bianquis, et al.: P. J. Bearman, Th. Bianquis, et al., eds. The Encyclopedia o f Islam. 2nd ed. 12 1960-2005 vols. Leiden: Brill.
- al-Fasawī 1981: Ya‘qûb ibn Sufyān al-Fasawī. Kitāb al-Ma‘rifa wat-ta’rīkh. Ed. by A. D. al-‘Umarī. 3 vols. 2nd ed. Beirut: Muʾassasat ar-Risāla.
- Fück 1938: Johann Fück. “Beiträge zur Überlieferungsgeschichte von Buh ā r ī s Traditionssammlung.” Zeitschrift der deutschen Morgenländischen Gesellschaft, 92:60-87.
- Goldziher 1890: Ignaz Goldziher. “Ueber die Entwickelung des Hadīth.” Muhammedanische Studien, 2. Halle. pp. 1-274.
- Hoffmann and Narten 1989: Karl Hoffman and Johanna Narten. Der sasanidische Archetypus. Wiesbaden: L. Reichart.
- Ibn Abī Dāwûd 1936-37 Arthur Jeffery. Materials for the History of the Text of the Qur’ān. The Old Codices. The Kitāb al-Masāhif of Ibn Abī Dāwûd. Cairo and Leiden: Brill.
- Ibn Hajar 1978: Ahmad b. ‘Alī ibn Hajar al-‘Asqalānī. Fath al-bārī: Sharh Sahīh al-Bukhārī. Ed. by T. ‘A. Sa‘d, M. M. al-Hawārī. Muqaddima (Introduction) and 28 vols. Cairo: Maktabat al-Kulliyyāt al-Azhariyya.
- Ibn Sa‘d 1904-28: Muhammad ibn Sa‘d. Kitāb at-Tabaqāt al-kabīr. Ed. by E. Sachau et al. 9 vols. Leiden: Brill.
- Juynboll 1983: Gautier H. A. Juynboll. Muslim Tradition: Studies in Chronology, Provenance, and Authorship of Early Hadīth. Cambridge: Cambridge University Press.
- al-Khatīb 1975: Ahmad ibn ‘Ali al-Khatīb al-Baghdādī. Taqyīd al-‘ilm. Ed. by Y. al‘Ush. 2nd ed. No publisher.
- Motzki 2001: Harald Motzki. “The Collection of the Qur’ān: A Reconsideration of Western Views in Light of Recent Methodological Developments.” Der Islam, 78:1-34.
- Motzki 2004 _______, ed. Hadīth: Origins and Developments. The Formation of the Classical Islamic World, 28. Aldershot: Ashgate.
- Muslim 1972: Muslim b. al-Hajjāj. Sahīh Muslim bi-sharh an-Nawawī. 18 parts in 9 vols. 2nd ed. Beirut: Dār Ihyāʾ at-Turath al-ʿArabī.
- Neuwirth 1987: Angelika Neuwirth. “Koran.” In Grundriss der arabischen Philologie. vol. 2. Literaturwissenschaft. Ed. by Helmut Gätje. Wiesbaden: L. Reichart. pp.96-135.
- Nöldeke 1909-38: Theodor Nöldeke. Geschichte des Qorāns. Parts I and II. Ed. by Friedrich Schwally. Part III. Ed. by Gotthelf Bergsträsser and Otto Pretzl. Leipzig: Reimpression, Hildesheim: Olms, 1981.
- Petersen 1963: Erling Ladewig Petersen. “Studies on the Historiography of the ‘Alī-Mu’āwiya- Conflict.” Acta Orientalia, 27:83-118.
- Schoeler 1996: Gregor Schoeler. Charakter und Authentie der muslimischen Überlieferung über das Leben Mohammeds. Berlin: Walter de Gruyter.
- Schoeler 2002 _______. Ecrire et transmettre dans les débuts de l’islam. Paris: Presses Universitaires de France.
- Schoeler 2006 _______. The Oral and the Written in Early Islam. Trans. by Uwe Vagelpohl. Ed. by James Montgomery. New York: Routledge.
- Sezgin 1967-84 Fuat Sezgin. Geschichte des arabischen Schrifttums. 9 vols. Leiden: Brill.
- Sezgin 1971 Ursula Sezgin. Abû Mihnaf. Ein Beitrag zur Historiographie der umaiyadischen Zeit. Leiden: Brill.
- at-Tabarī 1879-1901: Muhammad ibn Jarīr at-Tabarī. Ta’rīkh ar-rusul walmulûk (Annales). Ed. by M. J. de Goeje et al. 15 vols. Leiden: Brill.
- Versteegh 1993 Cornelis H. M. (Kees) Versteegh. Arabic Grammar and Qur’ānic Exegesis in Early Islam. Leiden: Brill.
- von Bothmer 1991 Hans-Caspar Graf von Bothmer et al. “Neue Wege der Koranforschung.” Magazin Forschung, Universität des Saarlandes, 1:45-46.
- von Hinüber 1990 Oskar von Hinüber. Der Beginn der Schrift und frühe Schriftlichkeitin Indien. (Akademie der Wissenschaft und der Literatur. Mainz. Abhandlungen der Geistes- und Sozialwissenschaftlichen Klasse. Jahrgang 1989, no. 11). Stuttgart: Franz Steiner Verlag.
- Wansbrough 1977 John Wansbrough. Quranic Studies: Sources and Methods of Scriptural Interpretation. Oxford: Oxford University Press.
- Watt 1977 William Montgomery Watt, ed. Bell’s Introduction to the Qur’ān. Edinburgh: Edinburgh University Press.
[1] هذه هي ترجمة مقالة: "The Constitution of the Koran as a Codified Work:
?Paradigm for Codifying Hadīth and the Islamic Sciences"، والمنشور في: Oral Tradition في 2010.
[2] قام بكتابة المقدمة وكذا التعليقات الواردة في نص الترجمة مسؤولو قسم الترجمات بموقع تفسير، وقد ميّزنا حواشينا عن حواشي المؤلف بأن نصصنا بعدها بــ(قسم الترجمات).
[3] ترجم هذه المادة: مصطفى الفقي، مترجم وباحث، له عدد من الترجمات المنشورة.
[4] حول عملية تدوين القرآن، انظر:
Nöldeke 1909-38:iii; Neuwirth 1987:101ff.; Motzki 2001; and Schoeler 2002:31ff.
[5] توضح حقيقةُ إحلالِ مصطلح الكتاب محل مصطلح القرآن (بمعنى التلاوة) في نص القرآن مع مرور الوقت -كما هو الحال مع مصطلح الوحي ككل بشكل واضح- أن مفهوم الكتاب الفعلي كان يدخل أكثر فأكثر في دائرة التركيز.
[6] For the hadīth, see Sezgin 1967-84:i, 53ff.; Motzki 2004, espec. xiiiff. and Introduction; Goldziher 1890; and Juynboll 1983. For the codification of the hadīth, see Goldziher 1890:194ff.; Sezgin 1967-84:i, 55ff.; Schoeler 2002:43ff. and 2006.
[7] هذه هي الكتب الستة الأولى من صحيح البخاري (انظر أدناه): 1. كتاب بدء الوحي، 2. كتاب الإيمان، 3. كتاب العلم، 4. كتاب الوضوء قبل الصلاة، 5. كتاب الغسل، 6. كتاب الحيض.
[8] يشكِّل كلٌّ من جون وانسبرو (1977) وجون بورتون (1977) اللذَين تُناقِض نظريةُ أحدهما نظريةَ الآخر =استثناءً في هذا الصدد.
[9] في البداية، تمّت كتابة الحروف المجرّدة فقط، وحتى هذه الحروف لم يكن يتسنى تمييز بعضها عن بعض بشكل كافٍ؛ لأن نفس الرسم المكتوب قد يشير في بعض الأحيان إلى حرفين مختلفين أو أكثر.
[10] For ‘Urwa see Schoeler 2002:45ff.; Bearman, Bianquis, et al. 1960-2005:x, 910-13, s.v. ‘Urwa ibn al-Zubayr (G. Schoeler).
[11] كانت طريقة عروة بن الزبير في عرض ما جمعه من الأحاديث الفقهية هي السابقة الأولى للتصنيف. انظر هامش رقم 13 أدناه.
[12] For the Koran, see Nöldeke 1909-38:ii, 11ff. and 47ff.; for the hadīth, see Sezgin 1967-84:i, 55ff.
[13] في الواقع، لم تكن المراحل الثلاث مخططة تمامًا كما يوحي هذا العرض التوضيحي أعلاه. وفي الحقيقة، بالنسبة للنسخة الرسمية للقرآن، تم تطبيق مبدأ تنظيمي تم تطويره بالفعل وتطبيقه على أول جمع متعمد للقرآن، وهو ترتيب السور الطويلة تنازليًّا. وبالنسبة لتدوين الحديث بشكل متعمد، كما رأينا، كان هناك مصنف واحد على الأقل يلتزم منهجية الترتيب بحسب الموضوع: وهو تصنيف التقاليد الفقهية لعروة بن الزبير.
[14] هذا هو السبب الذي يجعل نظرية بورتون (1977)، التي تقول إن النبي نفسه قام بالفعل بتحرير القرآن، غير محتملة إلى حد كبير!
[15] يفترض غريغور شولر أن مفهوم الكتاب في القرآن يحيل للكتاب الطقوسي فحسب، وليس الكتاب المقدس، وهذا انطلاقًا من كون العرب لا يعرفون إلا هذا الكتاب حيث الكتاب المقدس لم يكن متاحًا للعامة ولغير اليهود والمسيحيين بالأحرى، وهذا في ظننا غير دقيق، حيث يفترض كون القرآن يخاطب العرب وحدهم، وهذا يتجاهل التعدد في طبقات المخاطَبين بالقرآن في الجزيرة، ففيهم اليهود والمسيحيون ذوو المعرفة قطعًا بالكتب المقدسة التي يحيل لها القرآن في صورتها الكاملة التي تتجاوز الطقسية، كذلك فإن العهد القديم لا يمثل مجرد كتاب طقسي عند اليهود، ربما هذه هي دلالاته الأعمق في المسيحية بسبب تصورها عن تجسد الكلمة وبالتالي كون تلاوة الكتاب المقدس تنتهي في المسيحية للمشاركة الطقسية في المسيح، حيث المسيحية (ليتورجي الكلمة)، لكن الأمر مغاير في اليهودية، بل حتى في المسيحية نفسها يظل للكتاب وظائف أخلاقية واجتماعية ورؤيوية وليس فقط طقسية، من هنا يظل ثمة مستويات تأويلية عديدة للكتاب المقدس مسيحيًّا (أخلاقيًّا وروحيًّا)، كل هذا يجعل حصر دلالة مفهوم الكتاب في الكتاب الطقسي انطلاقًا من وضعية المتلقين له كما يفترض شولر وغيره =غير دقيق. (قسم الترجمات).
[16] انظر هامش رقم 2 أعلاه.
[17] وهكذا، يتم تفنيد نظرية وانسبرو (1977)، والتي تنص على أن القرآن لم يظهر في شكله النهائي حتى بداية القرن التاسع.
[18] ينطبق أيضًا تسلسل العملية التدوينية بدءًا من الملاحظات (غير الممنهجة)، والجمع المتعمد للمواد المتناثرة، وترتيب المحتوى بوعيٍ ما (وهو نوع من تحرير المحتوى) أيضًا على كلٍّ من السيرة النبوية: (Sezgin 1967-84:i, 237ff., 251ff., and 275ff.; Schoeler 2002:45ff. and 71f.; 1996:40ff. and 75ff.)، وتلاوة القرآن (كنوع من الكتابة الممنهجة): (Nöldeke 1909-38:ii; Sezgin 1967-84:i, 3ff.; Schoeler 2006:78ff.)، وتفسير القرآن: (Sezgin 1967-84:i, 19ff.: Schoeler 2002:49ff., 79), وعلم التاريخ: (Sezgin 1967-84:i, 237ff. and 257ff.; Sezgin 1971:79ff.; Schoeler 2002:79f.)، وفقه اللغة، وخاصة جمع الشعر: (Sezgin 1967-84:ii, 24ff.; Schoeler 2002:18ff. and 115ff.; 2006:65ff.)، والصناعة المعجمية: (Sezgin 1967-84:viii, 7ff.; Versteegh 1993; Schoeler 2002:91ff. and 100ff.). ويُعلل هذا التشابه بأن العلماء في مختلف هذه العلوم قد اتبعوا منهجية المحدِّثين (نقل المعارف من خلال حلقات العلم بطريقة كان التدريس والنقل فيها شيئًا واحدًا؛ عن طريق سَوق سلاسل الإسناد، وما إلى ذلك). بالإضافة إلى ذلك، وبالنسبة للسيرة النبوية، لم تكن الحدود بين الحديث وبينها واضحة. كما أن التفسير القرآني أيضًا، وعلى الرغم من أن التقاليد التفسيرية لا تُعزى إلى النبي أبدًا، إلا أنها تشترك كثيرًا مع الحديث، فنجد في مجموع أحاديث البخاري فصولًا لتقاليد تعالج سيرة النبي (كتاب بعثة محمد، وكتاب المغازي)، وكذلك نجد فصلًا يحتوي على التقاليد التفسيرية (كتاب التفسير). إن التقاليد التاريخية التي امتدت من زمن الخلفاء الأوائل والفتوحات العظيمة ليست سوى استمرار زماني لتقاليد السيرة النبوية. كما ظهر فقه اللغة بالاتصال الوثيق بتفسير القرآن (Versteegh 1993:1ff. and passim).
[19] لا شك أنّ هذا النظر في تفسير الأحداث في التاريخ الإسلامي يمثّل إشكالًا عادة في الطرح الاستشراقي، حيث يتم التعامل مع تحليل الأحداث بأبعاد صراعية (مادية أو رمزية)، وتصويرها وكأنها صراعٌ قويّ بين الأطراف، وهو شيء يحتاج إلى بحوث أدقّ لإثباته، ويصعب إطلاقه بهذا الشكلِ كما في المقالة، خصوصًا وأن المقال يعالج فترةً مبكّرةً من تاريخ أمّة ما، يصعب نظريًّا أن تشهد تشكّلًا متمايزًا للقوى وصراعًا واسعًا بينها. (قسم الترجمات).
[20] أود أن أشكر د/ ج. بيرترام تومسون على ترجمته الإنجليزية الممتازة.
كلمات مفتاحية
الكاتب:

غريغور شولر - Gregor Schoeler
أستاذ الدراسات الإسلامية في المدرسة التطبيقية للدراسات العليا في جامعة السوربون.
مواضيع ذات صلة
((المعلومات والآراء المقدَّمة هي للكتّاب، ولا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع أو أسرة مركز تفسير))