علم المناسبات بين السور والآيات
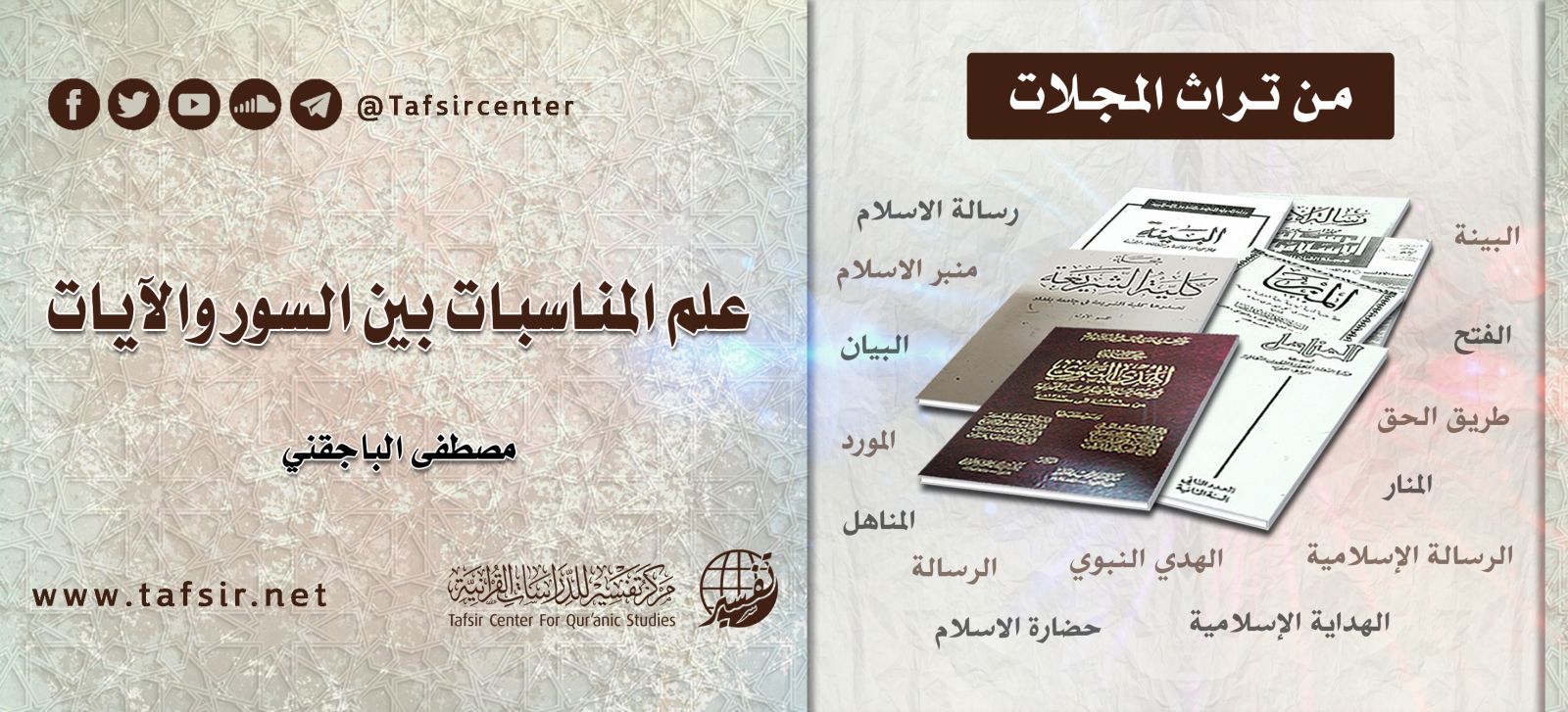
علم المناسبات بين السور والآيات[1]
تمهيد:
نهَجَ القرآن الكريم منهجًا فريدًا في عرضه للقضايا والأغراض التي تضمّنها، خالف به سائر المناهج الوضعية السابقة له أو اللاحقة، التي اصطلحت في مناهجها أن تُبْنَى على مقدّمات ومباحث متسلسلة أو أبواب وفصول، إلى غير ذلك من التقسيمات، في إطار مقاصد محدودة ونتائج مرسومة.
فالقرآن الكريم ليس كذلك، فهو آيات مجتمعة، ذات مرامٍ متنوّعة، ومقاصد شتّى؛ فتراه يراوح بالموعظة حينًا، والقصة حينًا، ثم بحكم شرعي حينًا آخر، ويذكر طرفًا من الشيء، ثم يتركه، ثم يعود إلى إتمامه. وهكذا حتى لا تسأم النفوسُ هَدْيَه، ولا تستثقل حديثه؛ وهذا أمر طبيعي لأنه ليس كتابًا فنيًّا متخصّصًا، يفرد لكلّ غرض من أغراضه بابًا مستقلًّا، وإنما هو كتاب هداية وإرشاد وتوجيه وتشريع.
قال الأستاذ محمد عبده: «إنّ القرآن ليس كتابًا فنيًّا، فيكون لكلّ مقصد من مقاصده باب خاصّ به، وإنما هو كتاب هداية ووعظ، ينتقل بالإنسان من شأن من شؤونه إلى آخر، ويعود إلى مباحث المقصد الواحد المرّة بعد المرّة، مع التفنّن في العبارة والتنويع في البيان»[2].
هذا المنهج الفريد استرعى انتباه قِلّة من العلماء والمفسِّرين قديمًا وحديثًا، فانكبّوا على دراسته، وأفردوا له عِلْمًا مستقلًّا يدرس خصائصه، ويحدّد معالمه، ويجلي غوامضه، أطلقوا عليه (علم المناسبة)، فما معنى المناسبة؟ وما صِلَتها بالنصّ القرآني؟ وما موقف العلماء منها؟
المناسبة لغة: جاء في معجم مقاييس اللغة: «النون والسين والباء كلمة واحدة قياسها اتصال شيء بشيء. منه النسب، سُمِّي لاتصاله وللاتصال به. تقول: نسبت أنسب وهو نسيب فلان، ومنه النسيب في الشِّعْر إلى المرأة، كأنه ذِكْر يتصل بها، والنسيب: الطريق المستقيم لاتصال بعضه من بعض»[3].
وفي الصحاح للجوهري: «فلان يناسب فلانًا فهو نسيبه، أي: قريبه، وتقول: ليس بينها مناسبة، أي: مشاكلة»[4].
وفي القاموس: «المناسبة: المشاكلة»[5].
والمشاكلة بمعنى: المماثلة. تقول: هذا شكل هذا، أي: مثله[6]. فالمناسبة لغة تعني: الاتصال والقرابة، والمماثلة. ويبدو أنّ توافق المعنى اللغوي مع المعنى الاصطلاحي لهذه اللفظة هو السبب في عدم وضع [معنى] اصطلاحيّ لها[7]، إلا أنه بالإمكان استخلاص هذا المعنى من خلال أقوال العلماء والمفسِّرين المشيدة بهذا العلم، ويعني: (البحث عن أوجه الارتباط بين الآية وجارتها، أو بين الآيات في مجموع السورة الواحدة، أو بين السورة والسورة).
ولعلّ أوّل من أظهر هذا العلم ببغداد الإمام أبو بكر النيسابوري، وكان يقول إذا قُرئت عليه الآية: لِـمَ جُعلت هذه الآية إلى جنب هذه؟ وما الحكمة في جَعْلِ هذه السورة إلى جنب هذه السورة؟[8].
قال الإمام ابن العربي مشيدًا بهذا العلم: «ارتباط آي القرآن بعضها ببعض حتى يكون كالكلمة الواحدة متّسقة المعاني منتظمة المباني= عِلْم عظيم»[9].
ويبيِّن الإمام برهان الدين البقاعي خصائصه وموضوعه وثمرته بقوله: «عِلْم مناسبات القرآن عِلْم تُعرف منه عِلَل ترتيب أجزائه. وموضوعه: أجزاء الشيء المطلوب علم مناسبته من حيث الترتيب. وثمرته: الاطلاع على الرُّتبة التي يستحقّها الجزء بسبب ما له بما وراءه وما أمامه من الارتباط والتعلّق الذي هو كلمته النسب»[10]، ولقد قيل: «المناسبة أمر معقول، إذا عُرض على العقول تلقّته بالقبول»[11].
ومما تجدر الإشارة إليه من خلال الوقوف على المعنى اللغوي والاصطلاحي لكلمة (المناسبة) أنها تعني أنّ الآية وجارتها شقيقتان يربط بينهما رباط من نوعٍ ما كما يربط النسب بين القريبين، غير أن ذلك لا يعني أن تكون الآيتان أو الآيات متماثلة تمام التماثل، بل ربما يكون بينهما تضاد أو تباعد في المعنى، كما لا يتوقّع أن تكون الأختان الشقيقتان متماثلتين تمام التماثل.
إلا أنّ الرابط قاسم، والصِّلَة موجودة، سواء أكَشَفَها العلماء أم لا، فقد تظهر أحيانًا، وتختفي أحيانًا أخري، وفي هذا مجال لتسابق الأفهام.
ولا يفوتني في هذا المقام أن أُشير أيضًا إلى أنّ البحث عن أوجه الارتباط بين آيات القرآن وسوره مبنيّ على أنّ ترتيب السور توقيفي، كما هو الحال في ترتيب آياته، وهو الرأي الراجح والمعتمَد[12].
ولقد كانت هذه الظاهرة القرآنية التي تُعتبر مظهرًا من مظاهر تفرّد منهجه واستقلاله عن كلّ طرق البحث والتأليف ودليلًا من دلائل إعجازه =سببًا بأن يدّعي بعض العلماء المسلمين -عن حُسْن قصد- بأنّ القرآن اشتمل على عدد من السور، وأن السورة الواحدة يتنوّع فيها الكلام بين كلّ آية وجارتها، فهذه للوعظ وتلك للقصة، وثالثة لحكم شرعي إلى غير ذلك من القضايا بما لا يتأتّى حصول رابط يربط بينها، وقد نزلت في أوقات متباعدة وعلى أسباب مختلفة.
فمِن بين العلماء القُدامَى الذين أيّدوا هذا الرأي الشيخ عزّ الدين بن عبد السلام، حين قال: «المناسبة علمٌ حسنٌ، ولكن يُشترط في حسن ارتباط الكلام أن يقع في أمر متّحد مرتبط أوّله بآخره، فإن وقع على أسباب مختلفة، لم يُشترط فيه ارتباط أحدهما بالآخر. ثم قال: ومن ربط ذلك فهو متكلّف بما لا يقدر عليه إلا برباط ركيك، يُصان عنه حسن الحديث، فضلًا عن أحسنه، فإنّ القرآن نزل في نيف وعشرين سنة في أحكام مختلفة، ولأسباب مختلفة، وما كان كذلك لا يتأتّى ربط بعضه ببعض»[13].
ومن المحدَثِين الدكتور/ صبحي الصالح، حين قال: «ومعيار الطبع أو التكلّف فيما لُمِح من ضروب التناسب بين الآيات والسور يرتدّ في نظرنا إلى درجة التماثل أو التشابه بين الموضوعات، فإِنْ وقع في أمور متّحدة مرتبطة أوائلها بآخرها فهذا تناسب معقول مقبول، وإِنْ وقع على أسباب مختلفة وأمور متنافرة فما هذا من التناسب في شيء»[14].
ولقد شجّع هذا القولُ بعضَ المستشرقين، حتى حسبوا أنّ هذه الظاهرة ثلمة يمكن نقد القرآن عن طريقها، وعدُّوا ذلك عيبًا فيه واضطرابًا في التأليف. ومن هؤلاء المستشرقين: (دوزى) الهولاندي، و(كارليل) الإنكليزي، و(بلاشير) الفرنسي[15].
قال بلاشير: «إنّ أشدّ الشواهد وضوحًا على ذلك نجده في سورة النور حيث تعالج بالتتابع أربعة موضوعات تتعلّق إمّا بالزنا، وإمّا بروابط اللياقة بين الجنسين، ثم يأتي بيانان: عن النور المنبثق عن الله، وعن قدرة الله الخالقة، لا صلة لهما بما سبق...»[16].
ولقد فنّد العلماء هذه الآراء وأبطلوا مزاعم المستشرقين مسترشدين بهدي هذا العلم (علم المناسبة)، وردُّوا على هؤلاء وأمثالهم ردودًا منطقية قاطعة.
وتتركز هذه الردود على عدد من المحاور:
المحور الأول: ردود مباشرة:
قال الشيخ وليّ الدين الملوي: «قد وَهِمَ من قال: لا يطلب للآي الكريمة مناسبة؛ لأنها على حسب الوقائع متفرّقة، وفصل الخطاب أنها على حسب الوقائع تنزيلًا، وعلى حسب الحكمة ترتيبًا»[17].
وأشار الإمام الشاطبي إلى تعدّد القضايا في السورة الواحدة، وأكّد أنّ هذا التعدّد لا يمنع من وجود الترابط والتناسب بين الآيات، وضرب مثلًا بسورة (المؤمنون)[18].
وقال الأستاذ/ محمد فريد وجدي: «إنّ القرآن الكريم كتاب لا كالكتب، فيه كلام لا كالكلام، لا يستطيع تاليه أن يزعم أن لا ترتيب فيه، بل يرى أنّ الترتيب مهما كان فسلطانه قاصر على الكلام البشري، يجلّ عن هذا الكلام الإلهي، كما يجلّ البحر أن يحدّ بما تحدّ به الجداول»[19].
المحور الثاني: موقف بلغاء العرب وشعرائهم من القرآن، وعجزهم عن معارضته:
نزل القرآن بلسان العرب ولغتهم، قال الله تعالى: ﴿بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ﴾ [الشعراء: 195]، وقال: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾ [يوسف: 2]، وهم أعلم بها من غيرهم، وتدرّج معهم في التحدّي على أن يأتوا بعشر سور مثله: ﴿أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ﴾ [هود: 13].
ثم اقتصر التحدّي على سورة: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ﴾ [البقرة: 23].
ولو كان في وُسْعِهم أن يجدوا ثغرة للنفاذ منها لنقده لما تردّدوا، بل وقفوا مبهوتين حائرين ولم ينقذهم من حيرتهم إلا أن قالوا كما أخبر القرآن: ﴿إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ﴾ [المدثر: 24].
لم يقولوا إنه مفكّك التركيب، مهلهل البناء، مختلف القضايا والأغراض، لا رابطة تربطها، ولا سياق يجمعها.
بل إنّ الذي وصمه بالسحر لم يملك -حين سمع آياته- إلا أنْ وَصَفَه بأبلغ وصفٍ وأدقّ تعبير حتى خشي القوم إسلامه، قال الوليد بن المغيرة حين سمع قوله تعالى: ﴿حم * تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ * غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ ذِي الطَّوْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ إِلَيْهِ الْمَصِيرُ﴾ [غافر: 1- 3]: «والله إنَّ له لحلاوة، وإنّ عليه لطلاوة، وإنّ أعلاه لمثمِر، وإنّ أسفله لمغدِق، وإنه ليَعلو ولا يُعلَى عليه، وما يقول هذا بَشَر»[20].
وأمّا البلغاء فما برحوا يضربون به الأمثال في جَودة السَّبْك وإحكام السرد، حين ينتقل من فنٍّ إلى فنّ، ومن موضوع إلى آخر.
المحور الثالث: نزول القرآن منجّمًا في فترات متباعدة:
إنّ القرآن نزل في أوقات متباعدة على مدى ثلاث وعشرين سنة وفي أغراض من الكلام متعدّدة ومتنوّعة، بعضه مكي، وبعضه مدني، لكنه بهذا الترتيب والوضع الذي هو عليه الآن بوحي الله وتوفيقه، يُرى كأنه نزل اليوم لتوّه جملة واحدة، كما هو في اللوح المحفوظ.
والمتأمّل في أماكن نزول القرآن يعلم أن هناك آيات مدنية في سور مكية، وآيات مكية في سور مدنية؛ فقوله تعالى: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾ [المائدة: 3]، تعتبر من آخر القرآن نزولًا، وقد نزَلَت بعرفات في حجة الوداع وأُلحقت بسورة المائدة المدنية[21].
وقوله تعالى: ﴿وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ...﴾ [الكهف: 28- 29]، فالآية الكريمة وما تلتها من آيات إلى قوله تعالى: ﴿إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا﴾، نزلت بالمدينة في شأن سلمان الفارسي وأبي ذر وفقراء المسلمين، وأُلحقت بسورة الكهف وهي مكية[22].
فهل مكان نزول الآية أو الآيات وزمنها هو الذي يحدّد موضعها من السورة؟ كلا. وإنما هناك شيء آخر هو الذي يحدّد موضعها وهو الموضوعية للسورة. وإلا فلو كان القرآن مختلط الأغراض والقضايا بلا رابطة كما يزعم المستشرقون ما كان هناك سبب ولا معنى لإلحاق آية مدنية بسورة مكية، ولا آية مكية بسورة مدنية، وكان الأَوْلى أن تُوضع حيث نزَلَت في أيّ سورة متجانسة معها في الزمان والمكان.
بل إنّ وضعها في سورة غير متّحدة معها في الزمان والمكان، وفي موضع معيّن منها بالذات لهو أشدّ دلالة على وجود مناسبة بينها وبين جارتها.
ولقد كان جبريل -عليه السلام- ينزل بالوحي ثم يخبر الرسول -صلى الله عليه وسلم- بأنّ مكان الآية أو الآيات هو في سورة كذا عقب آية كذا.
فهي إذن توضع في موضعها المقرّر، كما هي في اللوح المحفوظ[23].
إنّ الزمان -كما يقول الزركشي- لا يشترط في المناسبة؛ لأن المقصود منها وضع آية في موضع يناسبها، والآيات كانت تنزل على أسبابها، ويأمر النبي -صلى الله عليه وسلم- بوضعها في المواضع التي علم من الله تعالى أنها مواضعها[24].
المحور الرابع: تعدّد القضايا هو الدافع إلى تلمّس المناسبة:
إنّ هذا التعدّد والتنوّع في القضايا والأغراض هو نفسه الدافع إلى تلمّس وجه المناسبة بين الآية وجارتها أو لو كان المعنى واحدًا في آيات السورة، فلماذا تلتمس المناسبة؟ وكيف؟ هل تعقد مناسبة بين الشيء ونفسه؟[25].
غير أنّ طلب المناسبة أمر دقيق حتى قال الزركشي: «وعلمُ المناسبة علمٌ شريف، قلّ اعتناء المفسِّرين به لدقّته»[26].
قال الله تعالى: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ [البقرة: 238]، موضع الآية الكريمة مثال جليّ لهذا التنوّع في القضايا والأغراض، فقد وردت عقب آيات تشريع العدّة والطلاق للتنبيه الإلهي بوجوب المحافظة على الصلاة في كلّ الأوقات ولمّا تنته بعد هذه القضايا.
فما الحكمة في مجيء هذا الحكم، وهل هو غريب عن السياق؟ يجيب عن هذا المفسِّر البيضاوي بقوله: «لعلّ الأمر بها في تضاعيف أحكام الأولاد والأزواج لئلّا يلهيهم الاشتغال بشأنهم عنها»[27]، ثم إنّ القضايا السابقة واللاحقة لهذا الحكم عادةً ما تكون مثار نزاع وخصام، والدعوة إلى المحافظة على الصلاة في خضمّ هذه الأحداث يغرس في النفوس روح المراقبة والخشية منه -سبحانه وتعالى-، وما كان كذلك فلن يبخس حقوق الآخرين[28].
وفيه إيحاء بأنّ هذه الأمور كلها عبادات، وطاعة الله فيها من جنس طاعته في الصلاة[29].
المحور الخامس: حِكَم عُليا وغايات سامية:
إنّ هذه الظاهرة في هذا المنهج الإلهي يمكن أن يُستنبَط منها حِكَمٌ عالية وغاياتٌ سامية تقصر دونها المناهج البشرية، منها:
1- إنّ جميع مقاصد القرآن التي جعلها الله سبحانه هداية للبشر إنما تدور جميعها على الدعوة إلى الله، والقرآن يبثّ هذا المعنى من خلال المقاصد والأغراض الموزّعة على كافة الآيات والسور، فلو جمع كلّ نوع منها على حدة لفقد القرآن بذلك أعظم مزايا هدايته المقصودة وهي التعبدية[30].
2- هذه الظاهرة تنفي الملل والسآمة عن القارئ أو السامع من طول النوع الواحد، فيقبل كلّ منهما على الاستكثار من أزمان تلاوته وسماعه الذي هو أحد أغراض القرآن، قال الأستاذ محمد رشيد رضا: «وقد خطر لي وجه وهو الذي يطّرد في أسلوب القرآن الخاص في مزج مقاصد القرآن بعضها ببعض؛ من عقائد، وحِكَم ومواعظ، وأحكام تعبدية ومدنية وغيرها. وهو نفي السآمة عن القارئ والسامع من طول النوع الواحد منها، وتجديد نشاطها ومنهجها»[31].
3- إنّ أسلوبَ القرآن في التوفيق بين القضايا والأغراض المتنوّعة، فإذا هي بنية متماسكة، مع حسن ربط، وبراعة مسلك، وانتقال من غرض إلى غرض، من غير جفوة أو نَبْوة، أو غربة بين أجزاء الكلام =دليلٌ من دلائل إعجازه.
يقول الزمخشري في تفسيره: «فانظر إلى بلاغة هذا الكلام وحُسْنِ نَظمه وترتيبه، ومكانةِ أضماده ورصافةِ تفسيره وأخْذِ بعضه بِحُجَزِ بعض، كأنما أُفرغ إفراغًا واحدًا، ولأمرٍ ما أَعجز القوي، وأخرس الشقائق»[32].
ويقول الفخر الرازي في خاتمة تفسيره لسورة البقرة: «ومَن تأمّل في لطائف نَظْم هذه السورة وفي بدائع ترتيبها علم أنّ القرآن كما أنه معجز بحسب فصاحة ألفاظه وشرف معانيه؛ فهو أيضًا معجز بحسب ترتيبه ونَظْم آياته، ولعلّ الذين قالوا إنه معجز بحسب أسلوبه أرادوا ذلك»[33].
ولعلّ بعض المفسِّرين لم يبالغوا حين قدّموا -أحيانًا- ذِكْر المناسبة بين الآيات على معرفة سبب نزولها كلّما رأوا هذه المناسبة هي المصحّحة لنَظْم الكلام[34].
أوجه الارتباط بين الآي والسور:
أولًا: بين الآيات:
لقد تفنّن القرآن وأبدع في تنقلاته بين فنٍّ وفنّ عن طريق أساليب الربط التي يستعملها بُلغاء العرب وشعراؤهم، بحيث جاءت أساليبه بديعة عزيزًا أمثالها في شِعْر العرب ونثرهم.
فهو يستعمل أساليب العطف، والاعتراض، والاستطراد، والتنظير، والتذييل، وحسن التخلُّص، والالتفات، والإتيان بالمترادفات تجنبًا للثقل في مواطن التكرير، والتقديم والتأخير، إلى غير ذلك.
وفي روعة التنقل بين الغرض والآخر، مع وجود المناسبات بين المتنقل منه والمتنقل إليه، ما لا يشعر السامع أو القارئ بهذه النقلة إلا بعد حصولها[35].
وسأضرب بعض الأمثلة لتميط اللثام عن أهمية (علم المناسبة) من الجانب التطبيقي، من أجل الوقوف على الوشائج القوية التي تربط آيات القرآن وسوَره، حتى يبدو لك كالكلمة الواحدة.
قال الله تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [البقرة: 189].
فقد يتساءَل المرءُ عن وجه المناسبة بين أحكام الأهلّة، وحكم إتيان البيوت؟ ثم لا يلبث أن يكتشف سِرّ الارتباط في تعريض القرآن بأنّ سؤالهم عن الأهلّة، وعن الحكمة في نقصانها وتمامها في غير محلّه، وكان الأجدر أن يسألوا عن حكم أمر يفعلونه ليس من البرّ في شيء، مع العلم بأن ما يفعله -سبحانه وتعالى- لا يكون إلا لحكمة بَالِغَة ولمصلحة العباد.
فالقرآن أجاب عن سؤالهم بأنها مواقيت للحج بأسلوب الحكيم، ثم ربط الإجابة بعادة جاهلية خاصّة بالحج، عن طريق التعريض والاستطراد. قال الواحدي: «كانت الأنصار إذا حجّوا فجاؤوا لا يدخلون من أبواب بيوتهم ولكن من ظهورها، فجاء رجل فدخل من قِبَل بابه، فكأنه عُيِّر بذلك»[36].
فكأنه قال لهم: كان الأَوْلَى بكم أن تسألوا عن حكم صنيعكم هذا، وتتركوا السؤال عن الأهلة[37].
وقد تكون العلاقة بين آية وأخرى التضاد، وهذا كمناسبة ذِكْر الرحمة بعد ذِكْر العذاب، وذِكْر الكفر بعد الإيمان أو ذِكْر الرغبة بعد الرهبة، قال تعالى: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ﴾ [الإسراء: 57]، وقال: ﴿أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ﴾ [الحديد: 16].
قال الإمام الشاطبي: «إذا وردَ في القرآن الترغيب قارنه بالترهيب في لواحقه وسوابقه أو قرائنه، وبالعكس. وكذلك الترجية مع التخويف، وما يرجع إلى هذا المعنى مثله، ومنه ذِكْر أهل الجنة يقارنه ذِكْر أهل النار، وبالعكس»[38].
ولمّا كانت بعض النفوس تأبَى إلا أن تنتصر لنفسها ممن اعتدى عليها بَيَّن سبحانه حدّ الانتصار بقوله: ﴿وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ * وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا﴾ [الشورى: 39- 40]، ثم رغّب في العفو فقال: ﴿فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ﴾ [الشورى: 40]، بعدها أشار إلى أنّ الذي يردُّ الإساءة بمثلها لا لوم عليه، وإنما اللوم والمؤاخذة على الذي يعتدي على الناس، والتكبر في الأرض، فقال: ﴿وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ * إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [الشورى: 41- 42]، وفي التذييل بقوله تعالى: ﴿أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ ترهيب شديد. ثم ختم سبحانه الآية بالترغيب في الأفضل، فقال: ﴿وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ﴾ [الشورى: 43]، فالذي يصبر على الظُّلْم، ويكفّ نفسه عن الانتقام، ولا ينتصر لنفسه عندما لا يكون العفو تمكينًا للفساد في الأرض؛ إنّ ذلك منه لمن عزم الأمور التي ندب إليها عبادَه، وعزم عليهم العمل بها[39].
ومن أمثلة حُسْن التخلُّص: قوله تعالى: ﴿وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِيَّايَ...﴾ إلى قوله: ﴿أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ [الأعراف: 155- 157]، فإنّ الله -سبحانه وتعالى- ذَكَر الأنبياء والقرون الماضية إلى عهد موسى -عليه السلام- فلما أراد ذِكْر نبيّنا محمد -صلى الله عليه وسلم- ذَكَرَه بتخلُّصٍ انتظم به بعضُ الكلام ببعض.
ألا ترى إلى قول موسى: ﴿وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ﴾ [الأعراف: 156]، فأُجيب بقوله: ﴿قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ * الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ﴾ [الأعراف: 156- 157].
فأخبر سبحانه بأنّ رحمته وسعتْ كلّ شيء وسيكتبها للذين من حالهم كذا وكذا ومن صفتهم كذا وكذا، وهم الذين يتّبعون النبيّ الأمّي، ثم وصفه بصفاته صلى الله عليه وسلم[40].
ومن أمثلة التكرير قوله تعالى: ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ * لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ * وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ * وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ * وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ * لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ﴾ [سورة الكافرون].
وهذا التكرير أعطى فوائد جمة؛ فقوله: ﴿لَا أَعْبُدُ﴾ في المستقبل من عبادة آلهتكم، ولا أنتم فاعلون ما أطلبه منكم من عبادة إلهي، وقوله: ﴿وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ﴾ في الماضي لم يكن من شأني عبادة ما عبدتم من أصنام في الجاهلية، فأنَّى يُرْجَى ذلك مِنِّي في الإسلام؟ ﴿وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ﴾ في أيّ وقت ما أنا على عبادته الآن[41].
قال ابن الأثير كأنه يردُّ على القائلين بعدم الفائدة من التكرير في القرآن: «فاعلم أنه ليس في القرآن مكرّر لا فائدة في تكريره، فإن رأيتَ شيئًا منه تكرّر من حيث الظاهر، فأنعِم نظرك فيه، فانظر إلى سوابقه ولواحقه، لتنكشف لك الفائدة منه»[42].
ومن أمثلة الاعتراض: قوله تعالى: ﴿فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ * وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ * إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ﴾ [الواقعة: 75- 77]، وهو اعتراض بين القسم: ﴿فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ﴾، وجوابه: ﴿إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ﴾، وهناك اعتراض آخر بين الموصوف ﴿لَقَسَمٌ﴾ وبين صفته ﴿عَظِيمٌ﴾ وهو قوله: ﴿لَوْ تَعْلَمُونَ﴾، وفائدة هذا الاعتراض بين القسم وجوابه لتعظيم شأن المقسَم به في نفس القارئ أو السامع[43].
ومن أمثلة الالتفات: قوله تعالى: ﴿وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا * لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا﴾ [مريم: 88- 89]: «فقوله تعالى: ﴿لَقَدْ جِئْتُمْ﴾ وهو خطاب للحاضر بعد قوله: ﴿وَقَالُوا﴾ وهو خطاب للغائب؛ لِفائدة حسنة، وهي زيادة التسجيل عليهم بالجراءة على الله تعالى، والتعرّض لسخطه لعِظَم ما قالوه، كأنه يخاطبهم منكرًا عليهم وموبخًا لهم»[44].
ثانيًا: بين السور:
أمّا ارتباط سور القرآن فعلى ثلاثة أقسام:
القسم الأول: مناسبة فواتح السور لخواتمها:
فسورة (المؤمنون) افتُتحت بقوله تعالى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ﴾ [المؤمنون: 1]، وورد في خاتمتها قوله تعالى: ﴿إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ﴾ [المؤمنون: 117]، قال الزمخشري: «فشتّان ما بين الفاتحة والخاتمة»[45].
وسورة (ص) بدأها بالذِّكْر، في قوله تعالى: ﴿ص وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ﴾ [ص: 1]، ووردَ في خاتمتها قوله تعالى: ﴿إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ﴾ [ص: 87].
وسورة (القلم) بدأها بقوله عز وجل: ﴿ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ * مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ﴾ [القلم: 1- 2]، وختمها بقوله: ﴿وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ * وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ﴾ [القلم: 51- 52].
وسورة الإسراء ابتُدِئَت بالتسبيح، بقوله تعالى: ﴿سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ...﴾ [الإسراء: 1] الآية، وخُتمت بالجملة في قوله تعالى: ﴿وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا...﴾ [الإسراء: 111] الآية، والتسبيح حيثما ذُكر فهو مُقَدَّم على الحمد، تقول: سبحان الله والحمد لله.
القسم الثاني: مناسبة افتتاح السورة لخاتمة ما قبلها:
قال الزركشي: «إذا اعتبَرْتَ افتتاح كلّ سورة وجدته في غاية المناسبة لِمَا خُتم به السورة قبلها، ثم هو يخفى تارة ويظهر تارة»[46].
فسورة (الأنعام) افتُتحت بالحمد، بقوله تعالى: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ﴾ [الأنعام: 1]، فإنه مناسِب لختام سورة المائدة من فصل القضاء[47]، كما في قوله تعالى: ﴿وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [الزمر: 75].
وكافتتاح سورة (فاطر)، بقوله تعالى: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ [فاطر: 1]، فإنه مناسب لخاتمة سورة سبأ التي قبلها، بقوله تعالى: ﴿وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ...﴾ [سبأ: 54] الآية.
وافتتاح سورة الحديد بالتسبيح، بقوله تعالى: ﴿سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ [الحديد: 1]، فإنه في غاية المناسبة لختام سورة الواقعة التي قبلها التي أمرت به، بقوله: ﴿فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ﴾ [الواقعة: 96][48].
وافتتاح سورة (المائدة) بالأمر بالوفاء بالعقود، في قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة: 1]، فإنه مناسب لختام سورة النساء، في قوله تعالى: ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ...﴾ [النساء: 176] الآية، ففيها بيان للفرائض ومستحقيها، فالواجب أن تؤدّى على الوجه الصحيح.
القسم الثالث: مناسبة افتتاح السورة لمقاصدها:
فسورة الإسراء افتُتحت بالتسبيح، بقوله تعالى: ﴿سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ﴾ [الإسراء: 1]، وسورة الكهف وهي تالية لها في الترتيب افتُتحت بالحمد، بقوله تعالى: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا﴾ [الكهف: 1]؛ وذلك لأن التسبيح يسبق الحمد، قال الله تعالى: ﴿فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ﴾ [الحجر: 98].
ووجه المناسبة بين التسبيح في سورة الإسراء والتحميد في سورة الكهف: أن سورة الإسراء ابتُدِئَت بقصة الإسراء، وكذَّب المشركون محمدًا -صلى الله عليه وسلم-، فناسَب أن تفتتح بالتسبيح تصديقًا لنبيّه، وتنزيهًا له سبحانه؛ لأن تكذيبهم لنبيّه هو تكذيب لله تعالى.
أمّا سورة الكهف، فإنه لمّا احتُبس الوحي، وأرجف المشركون بسبب ذلك، أنزلها الله ردًّا عليهم، وأنه لم يقطع نِعمه عن نبيّه، بل أتم عليه بإنزال الكتاب، فناسب افتتاحها بالحمد على هذه النعمة[49].
وسورة النساء افتُتحت بقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ...﴾ [النساء: 1]، حيث تضمّنت الآية المفتتح بها ما في أكثر السورة من أحكامه من نكاح النساء، والمحرمات، والمواريث المتعلّقة بالأرحام[50].
أمّا سورة المائدة، فقد افتُتحت بالوفاء بالعقود، بقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة: 1]، وهو مناسب لما تضمّنته من بيان تمام الشرائع وإكمال الدِّين والوفاء بعهود الرسل، وفيها تحريم الخمر والصيد، وعقوبة السارق والمحارب، وإحلال الطيبات[51].
وبعد، فإنك تجد القرآن الكريم في عرضه للقضايا والأغراض أشبه ببُستان فرّقت ثماره وأزهاره في جميع جنباته كي يأخذ المرء أنّى وجد منه ما ينفعه وما يشتهيه من ألوان مختلفة وأزهار متنوّعة وثمار يعاون بعضها بعضًا في الروح العام الذي يقصده، وهو روح التغذية بالنافع والهداية إلى الخير.
فجميع أغراضه مترابطة في آياته وسورِه مع التجانس والأُلفة، قال الشيخ كمال الدين الزملكاني: «وإذا ثبت هذا بالنسبة إلى السور فما ظنّك بالآيات وتعلّق بعضها ببعض، بل عند التأمل يظهر أن القرآن كلّه كالكلمة الواحدة»[52].
[1] نُشرت هذه المقالة في مجلة «كلية الدعوة الإسلامية» بالجماهيرية الليبية، العدد السابع، سنة 1399هـ/ 1990م، ص64. (موقع تفسير).
[2] تفسير القرآن الكريم الشهير بتفسير المنار (2/ 452).
[3] انظر: معجم مقاييس اللغة، لابن فارس (5/ 423).
[4] انظر: الصحاح، للجوهري (1/ 224).
[5] انظر: القاموس المحيط، للفيروزآبادي (1/ 136).
[6] انظر: معجم مقاييس اللغة (3/ 204).
[7] كلّ المصادر والمراجع التي رجع إليها الباحث لم تتعرض له ما عدا كتاب مباحث في علوم القرآن، لمناع القطان، فقد أعطى تعريفًا لها.
[8] انظر: البرهان في علوم القرآن، للزركشي (1/ 36).
[9] البرهان في علوم القرآن (1/ 36).
[10] نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، للبقاعي (1/ 6).
[11] البرهان في علوم القرآن (1/ 35).
[12] انظر: البرهان (1/ 257) وما بعدها، والإتقان في علوم القرآن، للسيوطي (1/ 62) وما بعدها، روح المعاني، للألوسي (1/ 27)، تفسير القرطبي (1/ 53)، مباحث في علوم القرآن، صبحي الصالح، ص71، منهج القرآن في تقرير الأحكام، للباحث، ص61 وما بعدها.
[13] البرهان في علوم القرآن (1/ 152).
[14] مباحث في علوم القرآن، د. صبحي الصالح، ص152.
[15] انظر: المصحف المفسر (المقدمة)، محمد فريد وجدي، ص94.
[16] القرآن، بلاشير، ص69.
[17] البرهان، للزركشي (1/ 36).
[18] انظر: الموافقات في أصول الشريعة، للشاطبي (3/ 415).
[19] المصحف المفسّر (المقدمة)، ص94.
[20] تفسير القرطبي (19/ 74).
[21] انظر: أسباب النزول، للواحدي، ص126، والبرهان (1/ 195).
[22] انظر: أسباب النزول، للواحدي، ص201، والبرهان (1/ 201).
[23] انظر: الإتقان، للسيوطي (1/ 61)، وانظر: دراسات قرآنية، محمد قطب، ص406 وما بعدها.
[24] انظر: البرهان (1/ 26).
[25] انظر: مجلة منبر الإسلام (الوحدة الفكرية في السورة القرآنية)، العدد 7 السنة 32 يوليو 1974م، ص50 وما بعدها.
[26] البرهان (2/ 36).
[27] تفسير البيضاوي (2/ 81).
[28] انظر: التفسير الوسيط، ص680.
[29] انظر: النبأ العظيم، ص206، وتفسير المنار (2/ 445).
[30] انظر: تفسير المنار (11/ 197)، من روائع القرآن، للبوطي، ص143.
[31] تفسير المنار (2/ 445).
[32] الكشاف (2/ 153).
[33] التفسير الكبير (7/ 138).
[34] انظر: البرهان (1/ 64)، مباحث في علوم القرآن، صبحي الصالح، ص150.
[35] انظر: البرهان في علوم القرآن (1/ 40) وما بعدها، والتحرير والتنوير، لابن عاشور، المقدمة العاشرة (1/ 116) وما بعدها.
[36] انظر: الكشاف (1/ 141)، والبرهان (1/ 41).
[37] أسباب النزول، للواحدي، ص:32.
[38] الموافقات، للشاطبي (3/ 358).
[39] انظر: التفسير الواضح، محمود حجازي (25/ 25)، ومجلة منبر الإسلام، العدد 6، ص28.
[40] انظر: المثل السائر، لابن الأثير (3/ 131).
[41] انظر: المثل السائر (3/ 7).
[42] المثل السائر (3/ 8).
[43] انظر: المثل السائر (3/ 24).
[44] انظر: المثل السائر (2/ 175).
[45] الكشاف (3/ 45).
[46] البرهان (1/ 38).
[47] انظر: البرهان (1/ 38)، والإتقان (2/ 111).
[48] انظر: البرهان (1/ 39)، والإتقان (2/ 114).
[49] انظر: البرهان (1/ 39)، والإتقان (2/ 114).
[50] انظر: الإتقان (2/ 112).
[51] انظر: الإتقان (2/ 112).
[52] البرهان (1/ 39).


