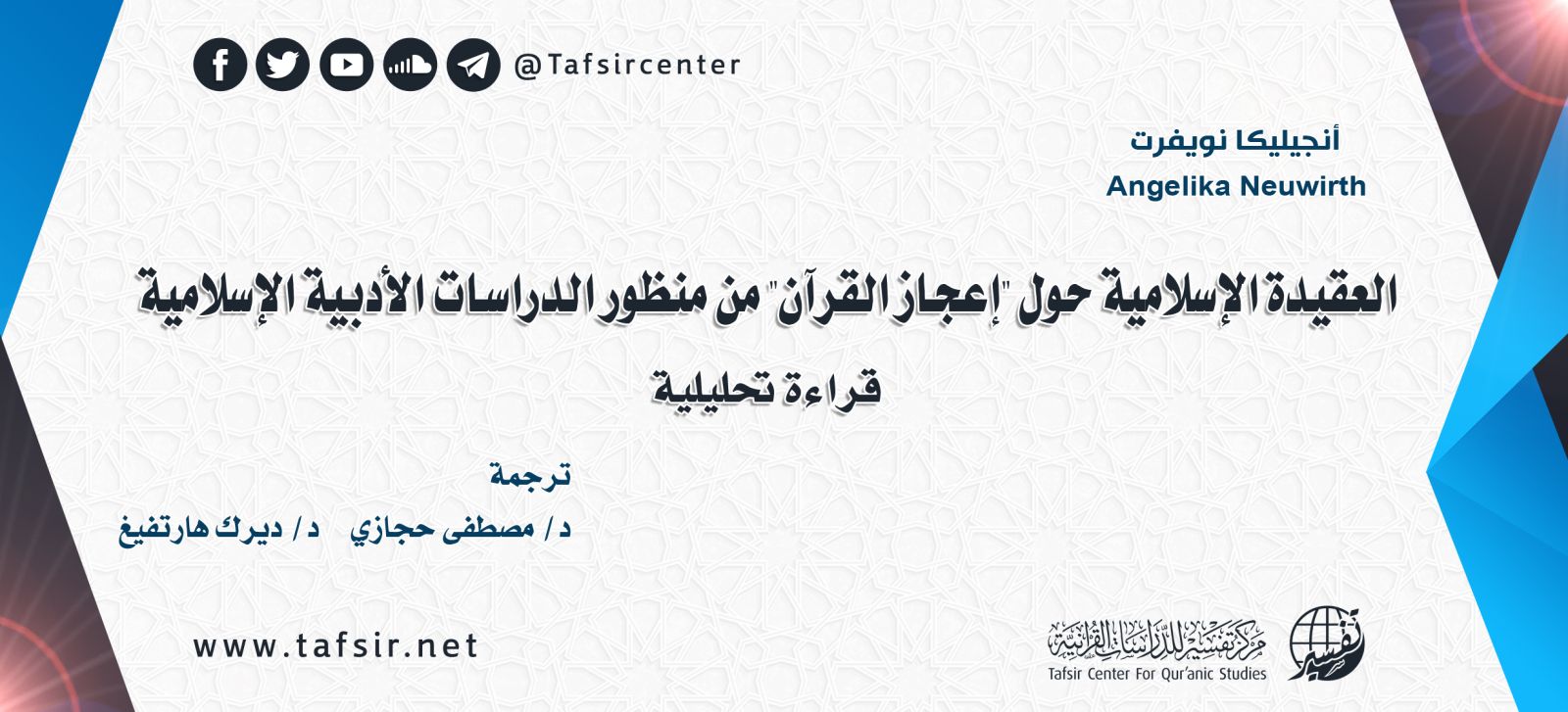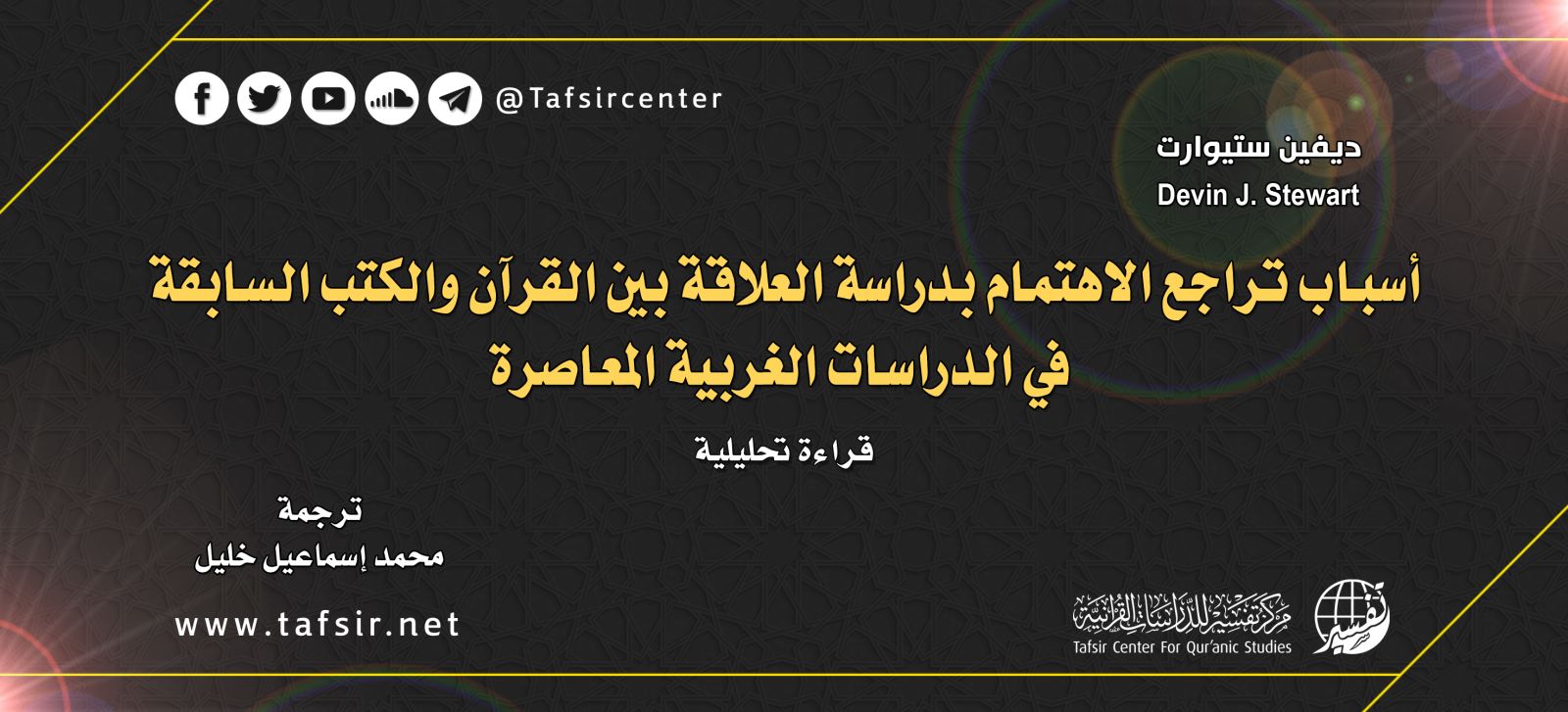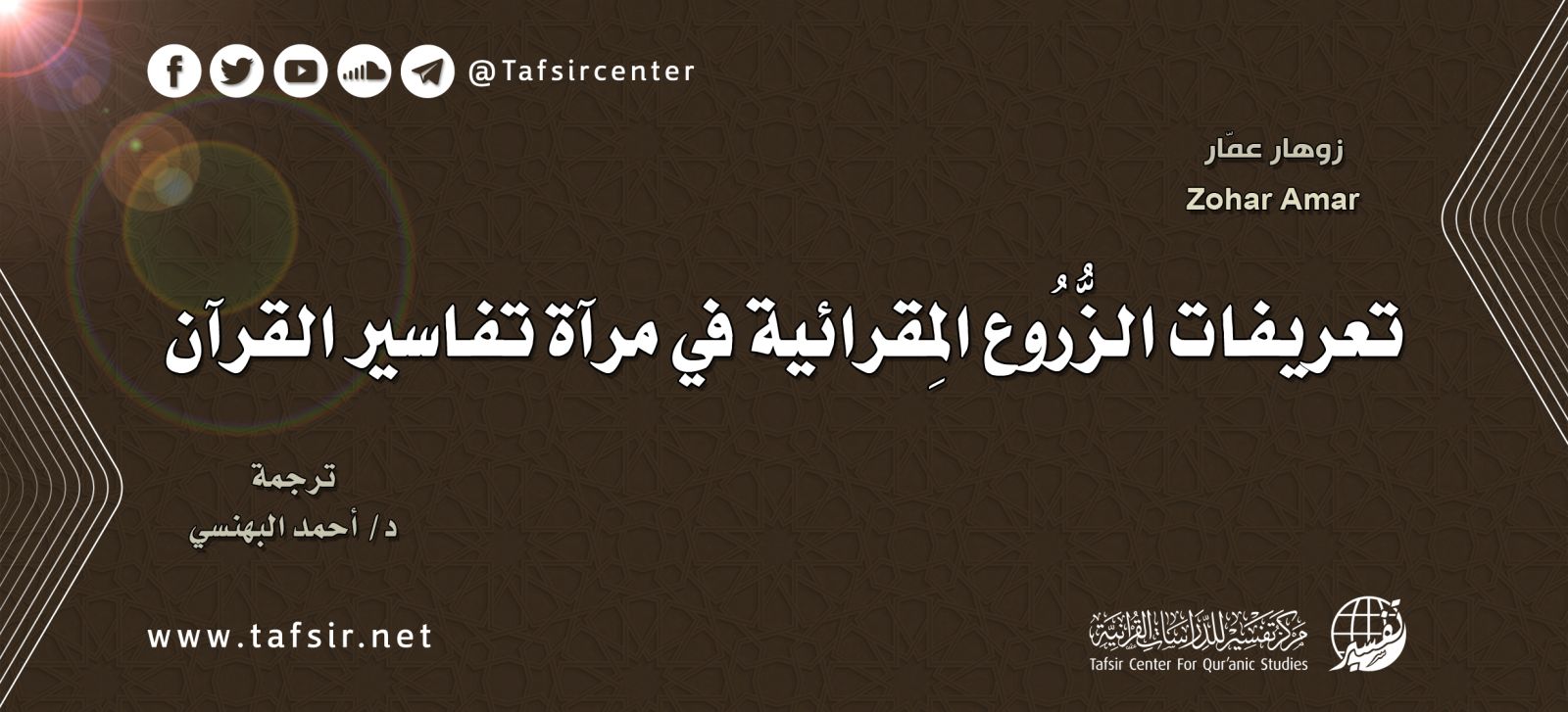بين كتابي؛ نظم القرآن لميشيل كويبرس، والأحاديث حول تثبيت مصحف عثمان لفيفيان كوميرو
بين كتابي؛ نظم القرآن لميشيل كويبرس، والأحاديث حول تثبيت مصحف عثمان لفيفيان كوميرو

يرتبط الكتابان المنشوران حديثًا باللغة الفرنسية -والمشار إليهما في هذه المراجعة- بالطريقة التي نُظم أو ينظم بها القرآن، هذا برغم تبَنِّي كلّ منهما مقاربة مختلفة عن الآخر، حيث يتعامل أولهما مع البنية الداخلية للنصّ القرآني، بينما يتعامل الثاني مع عملية تشكُّل وتطوُّر الرؤى التقليدية لتاريخ جمع القرآن وتثبيته.
إنّ كتاب (نظم القرآن) مكرّسٌ لعرض منهجية محدّدة لتفكيك النصّ القرآني (وإعادة بنائه) أو «منهجية التحليل البلاغي السامي» كما يطلق عليها كويبرس -وتعني تحليل النص وفق قواعد البلاغة الساميّة-. لبعض الوقت، كانت هذه المنهجية -ولا تزال- تستخدم في دراسات الكتاب المقدس، كذلك في تحقيق اللغات السامية القديمة مثل اللغة الأكادية، وذلك يعتمد على إيجاد علامات من (التشابه والتضاد) في النصّ، التي تتيح بدورها إعادة بناء الهيكل غير الخطِّيّ المستخدم في نظم النصّ كما تفترض هذه المنهجية، فيتوفّر -نتيجةَ معرفةِ هذه البنيةِ الدقيقة- مفتاحٌ أسهل وأكثر موثوقية لفهم النصّ أكثر من الاعتماد على القراءة الخطية.
ظلّ ميشيل كويبرس- الباحث البلجيكي بمعهد الدراسات الشرقية للآباء الدومنيكان IDEO بالقاهرة- يطبق هذا «التحليل البلاغي السامي» على النصّ القرآني لسنوات، ونشَر عدّة مقالات حلَّل فيها عددًا من قصار السور[i]. يعتمد كويبرس منهجيًّا بشكل أساسي على أعمال الباحث في الكتاب المقدس رولان مينيه[ii]، كما هو موضح في كتابه: (التحليل البلاغي؛ مقدمة إلى البلاغة الكتابية)[iii].
احتلَّت أعمال كويبرس الصدارة في مجال الدراسات القرآنية في عام 2007 إِثْر نشرِه كتابه Le Festin : Une lecture de la sourate al-Mā’ida : (باريس: مطبوعات لوتيلو. 2007)، والمترجَم إلى الإنجليزية بعنوان: The Banquet: A Reading of the Fifth Sura of the Qur’an (باريس: مطبوعات كونفيفيوم)[iv]، الذي اشتمل على تطبيق هذه المنهجية على سورة المائدة. كذلك تضمَّن تحليلًا للعلاقات البين/ نصيّة (التناصية) بين هذه السورة وبين عناصر كتابية، ولكن هذه الميزة كانت أقلّ ابتكارًا من تقديم برهنة صارمة على وجود بنية قوية لواحدة من أطول سور القرآن، التي يمكن أن تكون -وفقًا لرؤى تقليدية- آخر طوال السور المنزلة، أو آخرها تأليفًا؛ وفقًا لفرضيات بعض الباحثين المعاصرين. في الواقع، لقد وضعَت هذه المنهجية احتمالًا يفترض بناء القرآن كلّه على مثال ذلك «البناء السامي».
اختلف تلقِّي الباحثين لكتاب (المائدة)؛ إِذْ نظر إليه بعض الباحثين بشيء من الحذر بسبب إحجام بعضهم عن تطبيق المنهجيات المستخدمة في دراسات الكتاب المقدس، لأسباب إمّا أيديولوجية، أو بسبب التقدير بأن النصّ القرآني له سماته الخاصّة التي ستتطلب التكيُّف مع أسلوب الدراسات الكتابية، والبعض الآخر ينظر لتطبيق هذه المنهجية من مسافة بعيدة، باعتباره تطبيقًا لإطار شديد الصرامة من شأنه أن يفرض على النصّ أقسامًا صارمة وتفسيرًا معقّدًا ومتشددًا بشكلٍ لا يُصَدَّق. كذلك يتساءل البعض عمّا إذا كان التكوين (النظم) الظاهر في نصّ كويبرس في النهاية ليس عالميًّا أو شاملًا لكافّة أشكال التعبير في اللغة البشرية، في مقابل هؤلاء يُظهر البعض الآخر حماسةً تجاه هذا الأسلوب التحليلي الجديد الذي يوفِّر تفسيراتٍ جديدة لنصّ أصيل ذي آثار حاسمة؛ لهذه الأسباب كلها لم يمرّ كتاب (المائدة) مَرّ الكرام. استشعر كويبرس حاجته إلى كتابةِ كتابٍ جديد من شأنه توفير إطارٍ نظري وإرشاد منهجي لتطبيق التحليل البلاغي السامي على القرآن، بعدما حثّه استخدام جيل أصغر من الباحثين لهذه المنهجية، ولتدارك الفهم الخاطئ للكتاب أيضًا. فكتب (نظم القرآن)؛ هادفًا إلى «وَصْف منهجي لمجموعة من طرق التنقيح (عمليات الكتابة) التي تضمَن التماسك» في النص القرآني (ص9، ترجمتي).
يرى كويبرس أنّ هذه الطريقة بمثابة خطوة إلى الأمام في ميدان الدراسات القرآنية، إِذْ تصف واحدة من سمات القرآن التي لم يتمّ الكشف عنها بشكلٍ كاملٍ، بالرغم من أنّ بعض عناصر البناء السامي للقرآن تمَّت الإشارة إليها بالفعل مِن قبلُ في الأدبيات الكلاسيكية، ويشير كويبرس إليها في الفصل الأول، مثل تلك الخاصّة بـ(علم المناسبات)، بهذه الطريقة يموضع منهجيته ضمن السعي العام إلى الكشف عن التماسك في النصّ القرآني.
الفصول من الثاني إلى السادس مخصّصة للمنهجية نفسها؛ فيأتي الفصل الثاني حول (الثنائية والتجاور)، وهما من سمات النصّ القرآني التي تساعد في تفكيكه وإعادة هيكلته، ويشير كويبرس بكلمة: (ثنائية binarité’) إلى عنصر ذي أهمية في البلاغة القرآنية، وقد كان من الأصح أن يطلق عليها: (pairs and pairing) كما في عنوان مقالة سابينه شميتكه (Sabine Schmidtke) في موسوعة القرآن، فهذا المعنى يختلف عن استخدامنا لمصطلح (binarité) الذي يُفهم أنه اقتصار المفردات على زوج وحيد من الاحتمالات، كما هو الحال في اللغة الثنائية للحواسيب. علاوة على ذلك، أشار المؤلف إلى أن القرآن يعجُّ بالجمل المتجاورة الـمُرْدَفَة بعضها تلو بعض دون تحديد علاقة كلّ جملتين ببعضهما البعض، واختار مثالًا على ذلك أداة الربط (و)، ولكنه نسي على ما يبدو، أن (و) في النحو العربي لا تعني (التزاوج and) بالضرورة (ص31، 32). ومع ذلك، فإن ملاحظته مثيرة للاهتمام؛ إِذْ يلاحظ أنّ قلّة أدوات الربط التي تعبر بوضوح عن علاقة جملتين ببعضهما البعض هي واحدة من سمات القرآن، واللغة العربية عمومًا، بعكس طرُق الكتابة اليونانية والأوروبية والغربية فيما بعد، حيث «اليونانية تفرض، والسامية تقترح» (ص34).
يعرض الفصل الثالث مستويات نظم النصّ ‘niveaux de composition’ المقابلة للوحدات النصيّة المتعيّن على الباحث تحليلها واحدة تلو الأخرى. بينما يقدم كويبرس في الفصل السادس مزيدًا من اللمحات حول آلية تحديد هذه المستويات، ففي الفصل الثالث يصف كلًّا منها بالتفصيل من أصغرها إلى أكبرها على النحو التالي: العنصر (وهو الكلمة المفردة أو المرتبطة بحرف)، والمفصل، والفرع، والقِسم، والجزء، وصولًا إلى الكتاب في النهاية، (كما يمكن إضافة أجزاء فرعية وسلاسل فرعية وشعبات فرعية عند الحاجة). إنّ اختيار تلك المصطلحات تعسُّفي بعض الشيء بالطبع، لكنها ذات أهمية قصوى، ليس بالنسبة إلى المؤلف وحده لكي يوضح مراده من كلّ منها، ولكن أيضًا لأنه يُرْسِي استخدام هذه المصطلحات قاعدةً، كما يُعْرِب عن تطلُّعه لأنْ يستخدم الباحثون الآخرون هذه المصطلحات بالطريقة ذاتها، وهذا من شأنه تيسير أيّ نقاش مقبِل في هذا الميدان على الجميع، وتجنُّب الصعوبات التي يواجهها حقل دراسات الكتاب المقدس، حيث طوّر كلّ باحث فيه نظامه الخاصّ باستخدام مصطلحاته الخاصة للأسف (ص141).
ويشير كويبرس في الفصل نفسه إلى قاعدة من أهم القواعد التي تقوم عليها منهجيته، وفي رأيي يُعَدّ تجاهلها سببًا لكثير من سوء الفهم الذي يقع فيه منتقدو منهجيته؛ فيوضح كويبرس أنّ التقسيم الذي يطبقه على النصّ ليس بتقسيم عشوائي وفقًا للموضوعات وللتحليل المنطلق من الوحدات الأكبر إلى الأصغر، بل هو على العكس من ذلك، تقسيمٌ موضوعيٌّ مبنيٌّ على الفحص الدقيق لكلّ آية، مع مراعاة التسلسل التصاعدي لمستويات الوحدات النصيّة؛ أيْ: إنه تحليل من الأسفل إلى الأعلى (ص35). ويتوجب علينا أولًا أن نعثر على «دلائل النظم» التي يمكن أن تكون متّصلة بالشكل: (السجع والقافية والأنماط النحوية)، أو بالمحتوى: (المفردات والمترادفات والمتضادات). ومجموع دلائل النظم هذه يعدُّ العلامات النصيّة التي تشكّل «صورة النظم».
يفصِّل كويبرس صور النظم المختلفة في الفصل الرابع إلى: النظم المتوازي في حالة التماثل التامّ، والنظم المتوازي المعكوس، والنظم المحوري. ويكون التركيز في حالة التماثل الجزئي منصبًّا على عناصر بعينها: عناصر أوليّة، وعناصر نهائية، وعناصر قاطعة، وعناصر متوسطة، وعناصر مركزية. وقد تم التعريف بكلّ منها بشكلٍ دقيقٍ، وعليه، يمكن للباحث -بناءً على اكتشاف صور النظم هذه- أن يستنبط الوحدات التي ينقسم إليها النصّ في كلّ واحد من مستويات النظم، بدءًا من المستوى الأدنى.
ويصف الفصل الخامس مراكز النظم المحورية بتفصيل أكبر؛ فيعرض أولًا قواعد لوند (المستقاة من ملاحظة الباحث الكتابي ن.و. لوند) حول مراكز النصوص الكتابية، وهذه القواعد تساعدنا على فهم دَور مراكز النظم المحورية (ص119-131)، بعد ذلك يعرض المؤلف ملاحظة مثيرة مفادها أن كثيرًا من النظم المحورية في القرآن هي اقتباسات، أي: كلام منقول (ص132)، أو أقوال مأثورة (ص136).
ومؤكَّدٌ أنّ الفصل السادس سيُـثْبت أهميته العظيمة لمن ابتغى تطبيق منهجية التحليل البلاغي السامي؛ إِذْ يَعرِض أُسُسَ وضعِ النصّ في المخططات البيانية، تجري (إعادة الكتابة) تلك إبّان تحليل كلّ مستوى من مستويات النظم المتعاقبة، والمضيّ قُدُمًا عبر تقسيمات مبدئية، فيتردّد الباحث بين هذا المستوى والمستويات التي تليه حتى يخلص إلى حلول تناسب المستويات جميعها كما وضّح في كتابه (ص143): «سوف يتعيّن على التحليل أن يتأرجح باستمرار بين مستوى من التحليل ومستويات تحليلية عُليا غيره... حتى يؤدي إلى التماسك الأكثر إرضاءً في جميع المستويات النصية المتحكمة في بعضها بعضًا» (ص143)، بعد ذلك يقوم بإعادة كتابة التقسيم الصحيح لكلّ مستوى، مما يُتيح تصور نتائج الطريقة التي يمكن استخدامها لاحقًا في محاولات التفسير. يمكن وضع مبادئ التحليل العامّة الموضحة هنا باعتبارها مبادئ عامّة يجب مراعاتها أثناء أيّ تحليل بحثي للنصّ القرآني، كما يقدّم ذلك الفصل كثيرًا من الأمثلة على أنماط المخططات البيانية التي يقدمها كويبرس لإبداء النتائج في إطار واضح.
أما الفصل السابع فهو مخصص لعرض تقنيات التفسير، ويشدّد كويبرس على أنّ أول عنصر يجب مراعاته عند التعليق على آيةٍ أو مقطع -من بعد البيانات المعجمية والنحوية- هو سياقها، وبالسياق فإنه يقصد أصغر وحدة نصيّة توجد الآية أو المقطع فيها، ثم ما يليها أو يعلوها وصولًا إلى أعلى مستوى (أي: القرآن بأكمله)، وهنا تتضح فائدة طريقة التحليل البلاغي السامي للقـرآن؛ إِذْ تتيح للمفسِّر الوصول إلى فهم الآية في ظلّ سياقات محدّدة في كلٍّ من مستويات النظم، أي: في نفس السياقات التي وضعَ مؤلِّف أو منقِّح النصّ القرآني فيها هذه الآية بالتحديد (على مستوى المفصّل ومستوى الفرع ومستوى المقطع...إلخ). ويصرُّ كويبرس على أنه على العكس من منهجية تفسير القرآن بالقرآن، التي يختار فيها المفسِّر أيَّ آية أخرى ويربطها بالآية المفسَّرة بشكلٍ تعسُّفي، فإنّ طريقة التحليل البلاغي السامي -بتركيزها أولًا على الوحدة الأصغر والاعتماد على أسسٍ موضوعية لتحديد أيِّ آية ترتبط بالأخرى- تشكِّل ضامنًا لفهمٍ موضوعيٍّ (ص161).
بعد ذلك يأتي العنصر المتوجّب مراعاته عند تفسير آية، وهو (التناص)، أي: احتمال وجود موضوعات مماثلة في النصوص الكتابية أو في الـ para- Biblical texts (مجموع النصوص المكتشفة في قمران، والتي ليست من التوراة، لكن لها صلة قريبة أو بعيدة بنصوص أو موضوعات أو قصص التوراة). يقدّم كويبرس أمثلة قليلة -لكن معبرة- والتي تُتيح فيها طريقةُ التحليل البلاغي السامي -بالإضافة إلى التناص- تفسيرًا مبنيًّا على عناصر أكثر موضوعية من التفسير العادي؛ مثال ذلك الوضع بالنسبة إلى آية النسخ: (سورة البقرة 2، الآية 106) و(سورة العلق 96). وعادةً ما يُفَسَّر الجزء الأول من سورة العلق بالطريقة التقليدية، باعتباره نداءَ تكليفِ النبوّة لمحمد في غار حراء، وأنّ النصف الآخر من السورة قد أُضيف لها بوحيٍ آخر، لكن تطبيق التحليل البلاغي السامي يخلص إلى أن السورة تمّ بناؤها كوحدة، مما يوضح أنّ السورة في الأصل هي في الواقع دعوة إلى الصلاة. كذلك يدعم (التناص) هذا الاستنتاج؛ إِذْ يقود كويبرس لأنْ يعرض أن الفعل: {اقرأ} يعني في الأصل: (صلِّ باسم ربك)، أي: إنها دعوة لأداء الصلاة، وهو الأمر الذي طالما أُسيء فهمه (ص168-172). ويقول كويبرس أنّ استنتاجه بدعوة السورة إلى الصلاة يرتكز على عدّة عناصر، بينما التفسير التقليدي لها يرتكز على عنصر واحد هو صيغة الفعل {اقرأ} على وزن الأمر، يخلص كويبرس إلى أن «التحليل السامي بإمكانه أن يُعيد للنصّ طابعه العالمي الذي فُقِد جرّاء التفسيرات الأيديولوجية التي لا تعتمد بشكلٍ حقيقي على النصّ» (ترجمتي ص179). كذلك يعرض كويبرس في كثير من المناسبات أنّ نتائجه تؤدي إلى قراءات للنصّ مماثلة لقراءات مفسِّرين مسلمين كلاسيكيين أقلّ شُهرة، وكثير من المفسرين المسلمين المعاصرين.
مؤلفة الكتاب الثاني المشار إليه في هذا العرض الفرنسي، هي فيفيان كوميرو دي بريمار، أستاذة الدراسات الإسلامية في قسم اللغة العربية بمعهد إينالكو INALCO (المعهد الوطني للغات والحضارات الشرقية في باريس، حيث يمكن للطلبة دراسة جميع اللغات والثقافات غير الشرق أوروبية)، الأحاديث حول تدوين مصحف عثمان، وهي أطروحة في المدونة (الحديثية) حول الطريقة التي تشكَّل بها القرآن في نسخةٍ مكتوبة واحدة تحت مسمّى (مصحف عثمان). فوجهة النظر الإسلامية السائدة والتقليدية تقول بأنّ القرآن قد جُمِع ودُوِّنَ بشكلٍ منفصلٍ قبل وفاة النبي، ومِن بعدِها بشكلٍ أساسي، وفي ظلّ خلافة عثمان بن عفان (المتوفى سنة 35 هجريًّا – 656 ميلاديًّا) نُقِّحَ وجُمِع في نسخة واحدة أُعيد نسخها قرنًا تلو الآخر، الفولغاتا[v] المعاصرة المعتقد أنها استنساخ للنصّ نفسه، وبالتالي استنساخ للوحي الإلهي نفسه. لكن ما الذي تقوله التقاليد المبكِّرة فعلًا حول مسألة جمع هذا النص؟ هذا هو السؤال الذي عملَت كوميرو عليه لعدّة سنوات في برنامج: CAPES et Agrégation d’arabe -وهي أكبر المسابقات الوطنية في مجال اللغة العربية في النظام الأكاديمي الفرنسي- وقد حوَّلَت أطروحتها هذه إلى الكتاب المشار إليه في هذه المراجعة، والمنشور بمساعدة من المعهد الألماني للأبحاث الشرقية في بيروت. والأحاديث المفحوصة بهذا الصدد من جميع الأنواع، بداية من أيّ نوع من المعلومات المنقولة مِن قبلِ تدوين الحديث في مدوَّنة معتمَدة (في القرون من الثالث إلى التاسع من الهجرة)، وصولًا إلى الأحاديث المجموعة، مثل: صحيح البخاري (المتوفى سنة 256هـ-870م) (الفصلان الأول والرابع)، وصحيح مسلم (المتوفى سنة 261هـ-875م) (الفصل الخامس)، إلى تفسير الطبري (المتوفي سنة 310هـ-923م) (الفصل الثاني)، إلى بعض كتب الحديث الشيعية (الفصل التاسع) والمصادر السُّنية المتأخرة إلى نهاية القرن التاسع الهجري (الخامس عشر الميلادي) (الفصل السابع). تحلِّل كوميرو الأحاديث التي رواها ابن شهاب الزهري (المتوفى سنة 124هـ-742م) الذي كثيرًا ما ترجع إليه الأحاديث المروية في البخاري والطبري. ولكن على العكس من دراسة هارالد موتسكي[vi] -التي تقول كوميرو إنّ عملَها مدينٌ لها، (جمع القرآن؛ إعادة نظر في الرؤى الغربية في ضوء التطوّرات المنهجية الحديثة)[vii]- فإنها لا تسعى إلى تأريخ الأحاديث المبكرة المتعلقة بتاريخ تدوين القرآن بشكلٍ رسمي، وقد أَعربَت أنّ هدفها هو تبيان وتحليل تاريخ رواية هذه الأحاديث؛ لذلك فهي لا تسعى لِـحَسْمِ (كيف؟ ومتى؟ وأين؟ وبوساطة مَن؟) تشكّلَت هذه الفولغاتا، وتسعى بدلًا من ذلك لتوضيح كيف نُقِلَت المعلومات حول هذه الأحداث لاحقًا، أو استُبْعِدَت أو اختيرت أو صِيغت أو رُتِّبت أو أُدرجت ضمن سياقات بعينها...إلخ.
يختصّ الفصل الثالث بدراسة حول (الأنماط السردية) المتنوعة الظاهرة في المدونات المغلقة التي كانت موجودة بالفعل ولكن بشكلٍ منفصلٍ في الأحاديث المتقدّمة. وقد اختار كلّ جامع للحديث تلك الأنماط السردية وآلَفَها وفقًا لأهدافه الخاصّة، مثلًا: اتخذ البخاري قراره فيما يخصّ الدَّور الذي أدّاه (زيد بن ثابت) في مسألة جمع القرآن، فكان السؤال، هل حفظ زيدٌ القرآن عن ظهر قلب قبل وفاة النبي كما ذكرَت بعض الأحاديث؟ أم أنه كان على نقيض ذلك، واحتاج إلى سماع القرآن يتلوه آخرون كي يكتبه، كما ذكرَت أحاديث أخرى؟ فالبخاري مؤيّد للقول بخلقِ القرآن (ص100)[viii]؛ وبناءً على ذلك استخدم الأحاديث ليؤكد على العمل الفني الذي قام به فريق يَرْأَسُه زيد، مشددًا على عنصري؛ المبادرة والاجتهاد الإنسانيَّين. كما تجنّب البخاري الأحاديث التي تَذْكُر تبايُن التلاوات بين العراقيين والسوريين (ص63) ربما بمقتضى قلَقهِ بشأن الوحدة. ويحلِّل الفصل الرابع هذه الأسئلة وغيرها من الأسئلة المرتبطة بـ(فنّ التركيب) الذي برع فيه البخاري، والموضحة أنه لم يكن أبدًا مجرد راوٍ غير فاعل.
يقارن الفصل الخامس بين أحاديث البخاري وبين الأحاديث التي رواها مسلم؛ فمِن ناحية أخرى، لم يهتم مسلم بالحدَث نفسه الخاصّ بتكوين مصحف عثمان، وتحلِّل كوميرو موضوعات أخرى شرحها مسلم في صحيحه، مثل: دَور ابن مسعود، ونزول القرآن على سبعة أحرف.
الفصلان السادس والسابع مخصصان لعرض مراحل لاحقة؛ فالفصل السادس يتعاطى مع تاريخ المصحف من بعد تثبيته، مثل مسألة القراءات السَّبع. ويوضح الفصل السابع كيف كانت الأفكار اللاهوتية مفيدة لتكريس رؤى محددة من تاريخ تكوين المصحف، كذلك تشير كوميرو إلى استبعاد الأحاديث الشائعة لدَورٍ ربما أدّاه كلٌّ من: عائشة (الفصل الثامن)، وعليّ (الفصل التاسع) في كتابة المصحف. هذا بالرغم من وجود أدلة على دور عائشة في صحيح البخاري مثلًا.
يُعَدُّ الفصل الأخير بمثابة توليفة من استنتاجات كلٍّ من الأسئلة المطروحة في الكتاب، مُظهِرًا بجلاء إتمام بحث لاهوتي متقدِّم حول تاريخ المدوَّنة المغلقة للقرآن (ص204). بعبارة أخرى، فإنّ المعلومات المنقولة عبر الإسلام السُّني الكلاسيكي حول مسألة الطريقة التي جُمع القرآن بها وتم تثبيته، قد توافقَت مع الدوغما التي تُعرِّف القرآن. وبينما قام بعض العلماء القدامى بتدوين كلّ ما يمكن من المعلومات التي جمعوها، مثل عمر بن شبة؛ قام آخرون باختيار وجَمْع الأحاديث بشكلٍ منهجي ليتواءم مع الأفكار اللاهوتية السائدة، مثل عقيدة عدم خلق القرآن.
كان من الممكن جَعْل الحجة النقدية لكوميرو أكثر وضوحًا عن طريق استخدام مخططات بيانية توضح مسارات الرواية الخاصّة بالرواة المذكورين (بالإضافة إلى المخطط البياني لغوتييه هندريك ألبرت يوينبول G.HA. Juynboll على سبيل المثال)، كما أن جدولًا يدرج فيه الرواة وتاريخ وفاتهم ومحلّ إقامتهم كان سيقدِّم عونًا. كذلك الاقتباسات المدروسة في تضاعيف نصّ الأحاديث العربية على الرغم من أهميتها؛ فإنها تَرِد في الحواشي بترجمة فرنسية.
إنّ الإسهام المُقدَّم في ميدان الدراسات القرآنية من كلا الكتابَيْن في غاية الأهمية من وجهة نظري، رغم اختلاف المنهج الذي يعتمد كلّ منهما عليه (الفيلولوجي/ والتاريخي)، ورغم اختلاف المصادر (القرآن/ والحديث، والتفسير)؛ فيقدِّم الكتاب الأول الإطار المنهجي اللازم لتطبيق الباحثين الآخرين منهج التحليل البلاغي السامي. ورغم احتمال اعتبار المؤلف مبالغًا بالنسبة للبعض؛ إِذْ يتوقع على نحوٍ كبيرٍ من الباحثين الآخرين أن يقوموا باتّباع نهجه، فبالإمكان النظر لهذا الكتاب باعتباره تكثيفًا متواضعًا للطريق الذي يسلكه المؤلّف نفسه في هذا المنهج، ومشاركة شفافة له؛ متيحًا لغيره من الباحثين أن يتلمّسوا -كما حدث معه- الفائدة من هذا المنهج، وأظنّ أنّ لديه وجهة نظر في محاولته تثبيت مصطلحات يمكن استخدامها في الدراسات المقبلة، وإن تحقّقت آماله فهذا سيسهّل العمل على هذه المسائل. كما يفرغ كويبرس -بفضل التحليل البلاغي السامي- إلى عدم إمكان وصف القرآن باعتباره نصًّا خِلْوًا من النظام والتركيب (وهذا مجرد تكرار لما خلص إليه في كتابه المنشور في 2007). الشيء نفسه بالنسبة لكتاب كوميرو؛ إِذْ يعدُّ إسهامًا جادًّا في دراسة تاريخ تثبيت المصحف المنسوب إلى عثمان، كما أنه إنجاز كبير في دراسة الطريقة التي نُقل بها هذا التاريخ؛ إِذْ يوضح تحليل فيفيان كوميرو الارتباط الوثيق بين تاريخ «ما حدث»، وبين تاريخ انتقال الأفكار المتعلقة بـ«ما حدث».
كلا الكتابَين يطرحان أسئلة جديدة مهمّة في ميدان الدراسات القرآنية؛ فالعمل الذي يقدمه كويبرس لا يطرح أسئلة غير التي طرحها في كتابه الأسبق (المائدة)، ولكن الأسئلة الذي طرحها كتاب (المائدة) لا تزال حاضرة، ولا تزال تتردّد على قارئ نظم القرآن، وهي أسئلة متوقع وجودها في فصل ختامي قصير (الفصل الثامن)، حيث يشير كويبرس إلى بعض الإشكالات المثارة جرّاء اكتشاف بناءٍ أو تركيبٍ بلاغيٍّ سامٍ في القرآن، ويلاحظ أن هذا البناء (السامي) يمكن له أن ينتمي لمنطقة ثقافية أوسع؛ فيضرب مثالًا نصًّا فرعونيًّا مبنيًّا على هذا البناء (ص182). كما يقترح أيضًا أنّ حقيقة وجود التناظر في كلّ مكان في الطبيعة قد تكون سببًا لوجود التناظر في الخطاب البشري. لكن، كيف يتم التعامل مع حقيقة أن هذا البناء هو أساس التعبير السامي أكثر من كونه تعبيرًا عن اللغات اليونانية أو الأوروبية مثلًا؟ يلاحظ كويبرس أيضًا أنّ التحليل السامي قد أثار سؤالًا حول نظم القرآن.. ما إن كان قد دُوِّن شفاهيًّا أم كتابةً بشكل أساسي؟ وهل كان المنقِّح واعيًا لاستخدام هذا البناء البلاغي أم لا؟ ويترك كويبرس هذه الأسئلة بلا إجابة، وهو أمر مفهوم؛ فالأسئلة المطروحة ليست بسيطة. يرى بعض الباحثين أنّ ذلك التحليل السامي يقدّم دليلًا على أنّ نظم القرآن كان شفاهيًّا بشكلٍ مبدئي، وبالنسبة لي فإنني أستصعِب تصوُّرَ أشخاصٍ ينظمون مثل هذا النصّ المعقَّد شفاهيًّا، وأرى أنّ دعمًا كتابيًّا له كان أساسيًّا وضروريًّا لتأليف أو جمع نصٍّ كهذا. ورأيي الشخصي -وهو مجرد رأي لا أقصد فرضه على الآخرين- أنّ استنتاجات كويبرس ترافع عن جزئية مهمّة من فكرة النظم المكتوب للنصّ بواسطة كتَبةٍ مدرَّبِين جيدًا على هذه القواعد السامية وربما الكتابية. فإنّ كان الأمر كذلك، فمَن هم هؤلاء الكتَبة؟ ومتى وأين قاموا بذلك؟ وكيف اعتُبر نصٌّ كهذا بمثابةِ مجموعةٍ من النصوص المبلَّغة شفهيًّا من النبي محمد باعتبارها وحيًا؟ وهل هناك ارتباط بين ذلك وبين حقيقة ادّعاء القرآن في تعريفه لنفسه على أنه سرد شفهي للوحي الإلهي المنزل على محمد؟[ix]
يُنظر إلى هذا النصّ على الصعيد الديني على أساس أنه وحي من الله، بالتالي وبطبيعة الحال فلن تُطرح أسئلتي، أو ستطرح على نحوٍ مختلِف. في الحقيقة ومن ناحية أولى، بالنسبة إلى جزء من التقليد الذي ينفي الدَّور الإنساني في تثبيت تنظيم المدونة القرآنية، فقد ناقش البعض كون إظهار كويبرس البناء المنظم الرائع للقرآن هو دليل آخر على أصله الإلهي؛ وكون التحليل السامي إسهامًا في عقيدة الإعجاز. ومن ناحية أخرى، في الجزء من التقليد الإسلامي الذي يُقِرُّ ببعض المشاركة من الرسول وتابعِيه في تقرير كيفية جمعِ الوحـي، فإن فرضيات كويبرس ستطرح ما يلي: هل قاموا بذلك وفقًا لقواعد البناء السامي؟ وعليه يتعين التحقق إذا ما كانت فرضية كهذه قد انسجمَت على نحوٍ ملموس مع الأسلوب الذي وصفه كويبرس.
هناك إشكال آخر، هو التحدي الذي قد تمثله النتائج التفسيرية لمنهج كويبرس للتفسيرات الدينية التقليدية الشائعة، ورغم أنه يعزم على تقديمها بروح ودّية، إلا أنّ بعضًا من هذه النتائج قد لا تَلْقَى قبولًا. وعندما عرَض أعماله على بعض علماء الدّين في معهد لدراسة اللاهوت في دمشق، قد شهدتُ بنفسي فيضًا غير متوقع من المعارضة، ولم تكن تلك المعارضة موجهة ضدّ منهجه الذي اتّبعه أغلب الجمهور بحماسة حتى الآن، بل ضد انتهائه إلى عدم إمكان إسناد النظرية التشريعية للنسخ إلى (آية النسخ) المزعومة. وزيادة التركيز الأكاديمي على التعددية التاريخية لاتجاهات الفكر الإسلامي الكلاسيكي، قد يساعد في وضع نتائج هذا المنهج ضمن تنوع التراث التفسيري المسلم.
من الممكن النظر إلى المسألة المطروحة بخصوص حدوث تطور كرونولوجي محتمَل في النصّ، ضمن بحث أكاديمي، باعتبارها تحديًا لاكتشاف بناءٍ سامٍ. رغم ذلك، فهناك تصوران من شأنهما التخفيف من حدّة المعارضة بين فرضيتي: نظم النصّ، التزامنية واللا تزامنية.
يفترض التصوّر الأول ظهورًا كرونولوجيًّا لبعض أجزاء النصّ، ثم جمعها في وحدات السورة على أيدي الكتَبة الذين استخدموا (قواعد البناء السامي)، عندئذ فإنّ النصّ قد عُدِّل، شكلًا على الأقل. التصور الثاني يفترض أنّ التحليل البلاغي السامي ليس (صارمًا) كما قد يظهر، بل إنه مرنٌ إلى حدٍّ ما. وتتضمن (قواعد الكتابة) السامية الإمكانية الفنية لتضمين مقطوعات/ أجزاء داخل بِنْيَةٍ مصمّمة فعلًا. وعلى ذلك فالتصوّر الثاني يمكن أن يتكوّن من عمليات إدخال متأخرة للمفاصل أو الأفرع في نصّ متقدِّم، مثل ما يطلق عليه تضمين السور المدنية في السور المكية. وبطريقة أعمّ، هناك سؤال جدير بالطرح، وهو: لماذا فقدَ المتحدثون بالعربية عند مرحلةٍ ما قدرتهم على نظم و(قراءة بِنْيَة) النصوص في وضعها البلاغي السامي؟ أم أنهم تمكنوا من ذلك؟ وقد وجد كويبرس وغيره من الباحثين بناءً بلاغيًّا ساميًا إلى حدٍّ ما في بعض الأحاديث[x]. ولكن يبدو أنّ قواعد النظم تلك قد اختفَت من فوق وجه الأدب العربي الكلاسيكي، بينما عاشت قواعد نظم الشعر بالتفاعيل والقوافي، وهل يمكننا افتراض أنّ الفترة التي نُقِلَت وتُرجِمَت فيها العلوم اليونانية إلى العربية في بدايات العصر العباسي مسؤولة عن ذلك؟
على صعيد آخر، فالأسئلة غير المتوقعة التي يطرحها كتاب كوميرو أقلّ، حيث إنّ هذه الأسئلة شائعة في أيّ تحقيق بخصوص تاريخِ اتجاهٍ فكريٍّ كالدّين، ولا شك في ارتباطٍ بين عقيدة هذا الدّين وبين انتقال رواياتِ لحظات تأسيسه التاريخية، لا سيما مصادر تأسيسه وكتُبه المقدسة؛ لذلك لم يكن اكتشاف أن التدوين النهائي للحديث المرتبط بتثبيت المصحف، هو نتيجة لعملية متراكبة منطوية على اختيارات مقرّرة من رواةٍ مختلِفين، وفقًا لآرائهم اللاهوتية في كثير من الأحيان =مفاجئًا إلا فيما يتعلق بالاتجاهات الراديكالية غير الأكاديمية. رغم ذلك فإنّ دراسة كوميرو تطرح أسئلة تفصيلية تحتاج إلى التحقيق، مثل: ماذا كان الدَّور المحدَّد لكلّ شخص مشارك في عملية تدوين القرآن؟ هل كُتب القرآن وثَبت بشكلٍ كاملٍ قبل وفاة الرسول، الذي قام بتلاوة القرآن بأكمله معتمدًا على مصحف زيد (ص52)؟ ما هي النقاشات اللاهوتية المختلفة المتعلقة بالقرآن بين علماء المسلمين الكلاسيكيين؟ ومتى وقعت؟ وما النتائج التي خلّفتها؟ ولا تزال بعض المصادر -بخلاف الأحاديث السُّنيّة المدوَّنة أو السابقة عليها- بحاجة إلى تدقيق؛ لكي تساعدنا على إعادة كتابة تاريخ أفكار فترة مبكرة[xi].
[i] «تحليل بلاغي لبداية ونهاية القرآن» [تحرير] د. دي سيمه، ج. دي كالاتاي، ج. م. فان ريث. «الكتاب؛ قدسية النصّ في العالم الإسلامي» (بروكسل لوفان لانوف لوفين، 2004)، ص233-272. «القراءة البلاغية والنصية لسورة الإخلاص»، مجلة معهد الدراسات الشرقية للآباء الدومينيكان MIDEO المجلد 25-6 (2004)، ص141-175. «التركيب البلاغي للسور من 81 إلى 84»، الحوليات الإسلامية الصادرة عن المعهد الفرنسي للآثار الشرقية IFAO المُصنف رقم 37 (2003)، ص91-136. «البنى البلاغية للسور من 58 إلى 90»، الحوليات الإسلامية الصادرة عن المعهد الفرنسي للآثار الشرقية IFAO المُصنف رقم 35 (2001)، ص27-100. «البنى البلاغية للسور من 92 إلى 98»، الحوليات الإسلامية الصادرة عن المعهد الفرنسي للآثار الشرقية IFAO المُصنف رقم 34 (2000)، ص95-138. «البنى البلاغية للسور من 99 إلى 104»، الحوليات الإسلامية الصادرة عن المعهد الفرنسي للآثار الشرقية IFAO المُصنف رقم 33 (1999)، ص31-62. «البنى البلاغية للسور من 105 إلى 114»، مجلة معهد الدراسات الشرقية للآباء الدومينيكان MIDEO المجلد 23 (1997). «البنى البلاغية في القرآن؛ تحليل بنيوي لسورة (يوسف) وبعض السور القصيرة»، مجلة معهد الدراسات الشرقية للآباء الدومينيكان MIDEO المجلد 22 (1995)، ص107-195.
[ii] رولان مينيه (1939-)، راهب يسوعي فرنسي، أستاذ علم اللاهوت الكتابي في الجامعة الغريغوية الحبرية بروما، متخصص في الساميات وفي إنجيل لوقا، وقد طبق منهجية البلاغة السامية على إنجيل لوقا؛ من أشهر كتبه: «رسالة في البلاغة الكتابية»، 1982، «طريقة التحليل البلاغي والتفسير؛ تحليلات نصوص من الكتاب المقدس والحديث الشريف»، 1989، بالإضافة لكتابه المشار إليه في هذا العرض: «التحليل البلاغي؛ مقدمة إلى البلاغة الكتابية، 1998». (قسم الترجمات).
[iii] رولان مينيه: «التحليل البلاغي؛ مقدمة إلى البلاغة الكتابية» (Sheffield: Sheffield AcademicPress, 1998).
[iv] ترجم الكتاب عن دار المشرق عام (2016) تحت عنوان: «نظم سورة المائدة؛ نظم آي القرآن في ضوء منهج التحليل البلاغي» وقد ترجمه: عمرو عبد العاطي صالح. (قسم الترجمات).
[v] كلمة الفولغاتا تشير إلى ترجمة الكتاب المقدس اللاتينية، والتي ترجمت في القرن الخامس عن الترجمة السبعينية، وهي التي أقرّتها الكنيسة الكاثوليكية ككتاب مقدّس. (قسم الترجمات).
[vi] هارالد موتسكي، مستشرق ألماني ولد عام 1948، حصل على الدكتوراه من جامعة بون الألمانية عام 1978، واهتمامه الأساس هو نقل الحديث في التراث الإسلامي، له عدد من الكتب، منها: «أصول الفقه الإسلامي، 2002»، «إعادة بناء ابن إسحق حياة النبي»، و«تفسير القرآن المبكر؛ دراسة للتقاليد المبكرة لابن عباس، 2017».(قسم الترجمات).
[vii] هارالد موتسكي: «جمع القرآن؛ مباحثات حول الرؤى الغربية في ضوء التطورات المنهجية الأخيرة». (DerIslam78 (2001), pp. 1–34).
[viii] لا تصح نسبة القول بخلق القرآن إلى الإمام البخاري، وقد نُسب إليه هذا القول، ووقعت بسببه فتنة، وذلك حين سُئل بنيسابور عن اللفظ بالقرآن، فقال: «أفعالنا مخلوقة وألفاظنا مِن أفعالنا»، فوقع بين الناس اختلافٌ، فقال بعضهم: «قال لفظي بالقرآن مخلوق»، وقال بعضهم: «لم يقل»، ووقعت فتنة أبرزها ما كان بينه وبين محمد بن يحيى الذهلي (ت258هـ).
وللبخاري في كتابه (خلق أفعال العباد) عبارات صريحة في كون القرآن غير مخلوق، ورواياته عن الأئمة في وصف القائل بذلك بأنه من «المعطلة» و«من شرار الخلق» ونحو ذلك، يُنظر: «باب ما ذكر أهل العلم للمعطلة الذين يريدون أن يبدلوا كلام الله -عز وجل-»، من كتاب: (خلق أفعال العباد) (ص: 29 وما بعدها)، والكتاب ثابت النسبة للبخاري، نسبه إليه ابن النديم (ت438هـ) في "الفهرست" (ص: 282) وغيره، كما نقل عن الكتاب جماعة من أهل العلم.
وقد رُويت عن البخاري عدة روايات في بيان عدم قوله بخلق القرآن، نقل بعضها ابن حجر (ت852هـ) في مقدمة فتح الباري (1/ 490)، ويُنظر: (13/ 491)، كما يُنظر: تاريخ بغداد، للخطيب البغدادي (ت463هـ) (2/ 340)، وسير أعلام النبلاء، للذهبي (ت748هـ) (12/ 457).
وفي ضوء ذلك؛ فإن بناء فيفيان كوميرو فرضيتَها بشأن البخاري على مقدِّمة قوله بخلق القرآن -فيما تنقله بواليفو- فيه نظر؛ لعدم ثبوت القول عنه، وتظلُّ فرضيتها حول صلة بناء مدونات الحديث بالآراء العقدية هي في النهاية مجرَّد فرضية تخضع للاختبار. (قسم الترجمات).
[ix] آن-سيلفي بواليفو: «القرآن من خلال القرآن؛ مصطلحات وحجج الخطاب القرآني حول القرآن» (Leiden: Brill, forthcoming 2013).
[x] راجع رولان مينيه: «طريقة التحليل البلاغي والتفسير؛ تحليلات نصوص من الكتاب المقدّس والحديث النبوي الشريف»، (بيروت، جامعة سان جوزيف - دار المشرق 1993).
[xi] هناك عمل آخر منشور بالفرنسية بهذا الصدد يحلل النصوص الشيعية في التاريخ الإسلامي المتقدم: «القرآن الصامت والقرآن الناطق»، (باريس، إصدارات CNRS 2011).
الكاتب:

آن سيلفي بواليفو - Anne-Sylvie Boisliveau
أستاذة محاضرة في تاريخ الأمم الإسلامية بجامعة ستراسبورغ، متخصصة في الإسلاميات.
مواضيع ذات صلة
((المعلومات والآراء المقدَّمة هي للكتّاب، ولا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع أو أسرة مركز تفسير))