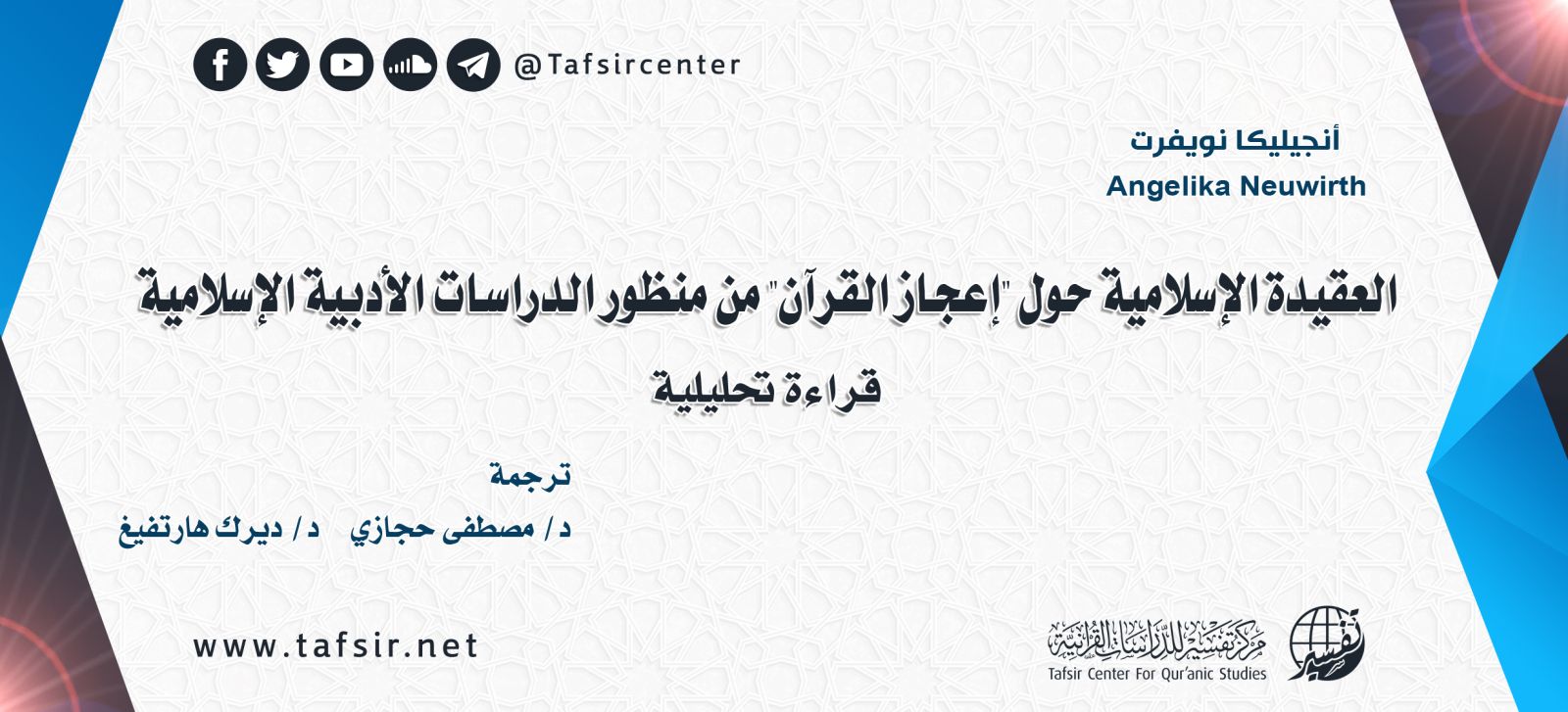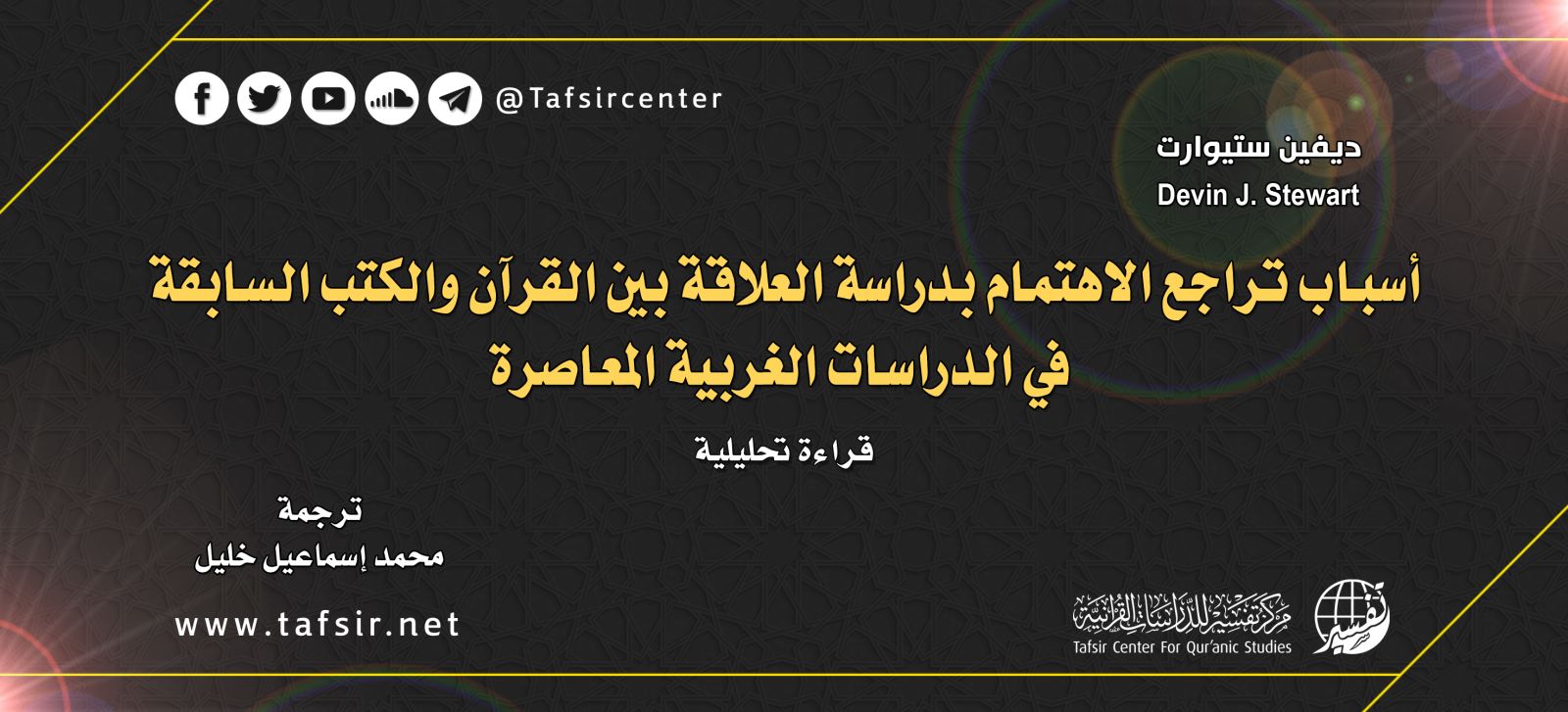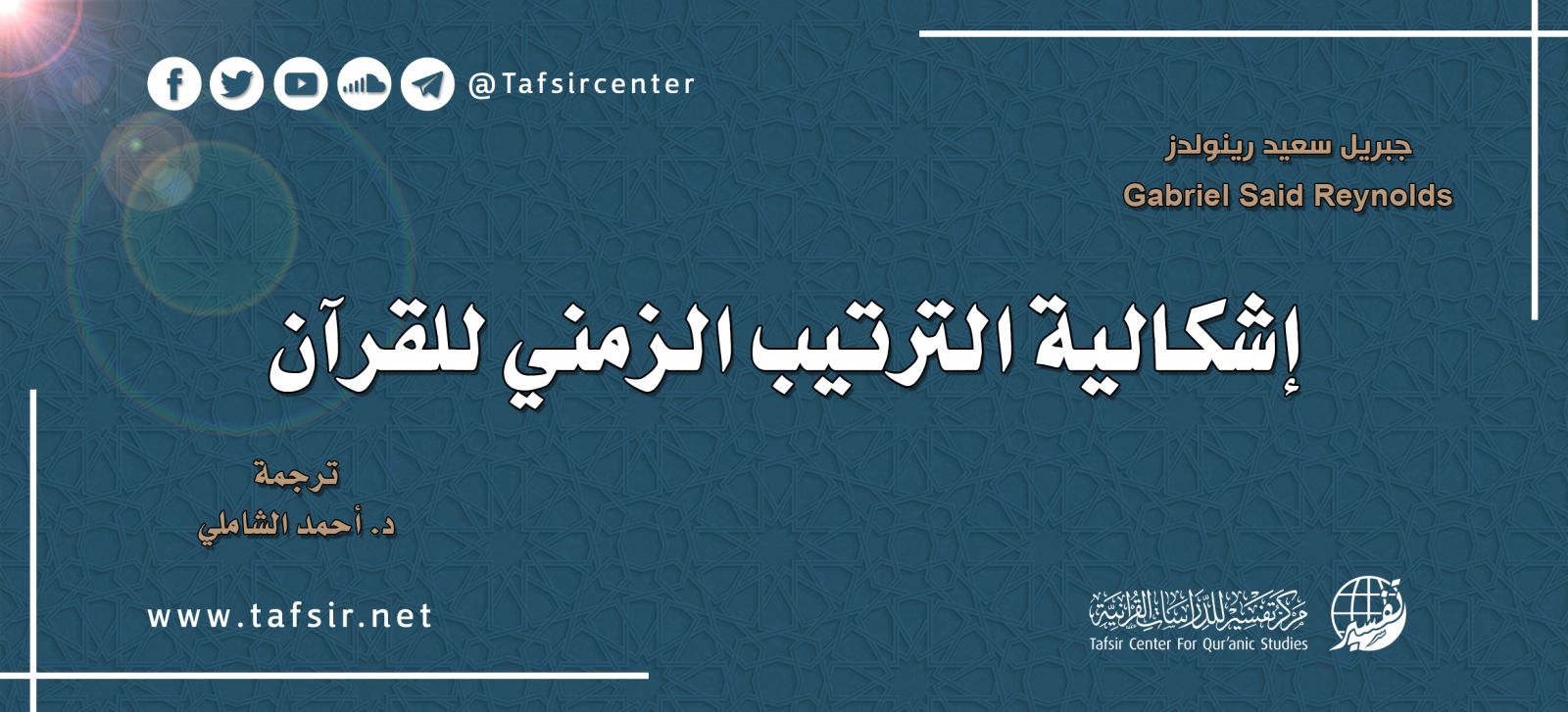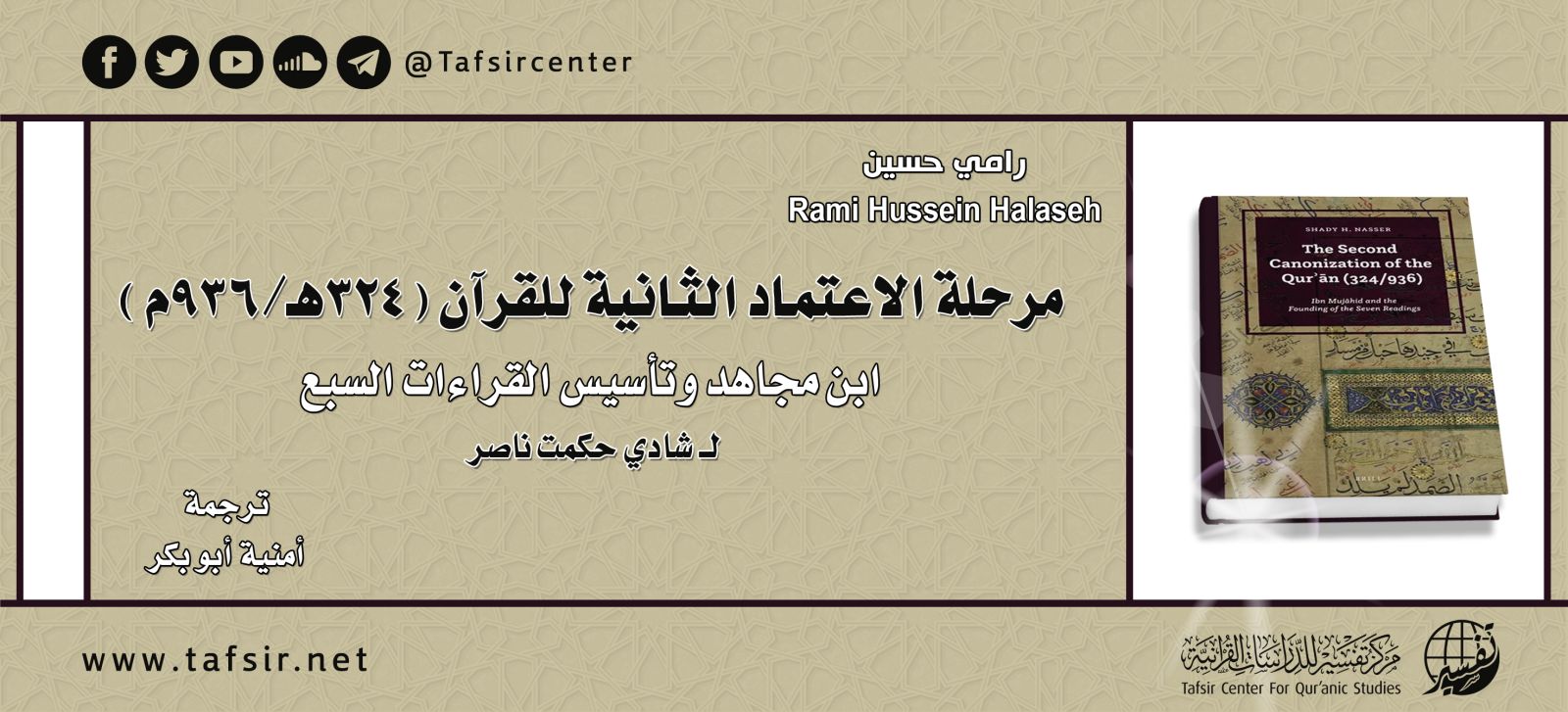الدراسات القرآنية والمنعطف الأدبي؛ قراءة في أهم الدراسات الأدبية الغربية للقرآن
الدراسات القرآنية والمنعطف الأدبي؛ قراءة في أهم الدراسات الأدبية الغربية للقرآن
الكاتب: ترافيس زاده - Travis Zadeh

الدراسات القرآنية والمنعطف الأدبي[1][2]
قراءة في أهم الدراسات الأدبية الغربية للقرآن[3]
حظيتْ دراسة القرآن في الآونة الأخيرة باهتمامٍ كبيرٍ في آفاق الأكاديميا الغربية وخارجها معًا. ويمكن قياس أحد مؤشرات هذا الاهتمام من مجرّد العدد الهائل من المطبوعات باللغات الأوروبية التي تُعْنَى بالقرآن بشكلٍ ما، والموجّهة للمختصّين وعامة القرّاء على حدّ سواء. هذا بالإضافة إلى الأثر العميق الذي تتركه بصمة موارد الإنترنت في الميدان، من حيث النقل الحي للمعلومات وتشكيل طرائق الفهم. وفي حين تركّز كثير من مواضيع الدراسات الغربية للقرآن على التفسير والاستقبال التاريخي للقرآن، إلا أنّ هناك مجموعة متزايدة من الأبحاث التي تتعقّب سمات التكوين التاريخي للقرآن من خلال مناهج أدبية مثل: علم صناعة المعاجم، وعلم المخطوطات، والنقد النصّي.
بالنظر إلى الطابع الفيلولوجي الصريح الغالب على هذا النمط البحثي، ربما لا يكون من المستغرب للكلاسيكيات الرائدة في الدراسات القرآنية الألمانية من القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين أن تظلّ ذات صلة. وقد انعكس هذا مؤخّرًا في ترجمات فولفجانج بيهن من الألمانية للإنجليزية لـ(تاريخ القرآن) من تأليف تيودور نولدكه[4] وخلفائه مِن بعد (1909- 38؛ تمّت الترجمة للإنجليزية 2013). وترجمة (اتجاهات تفسير القرآن الكريم) من تأليف إجناتس جولدتسيهر[5] (1920؛ ترجمة 2006). وكان هذان العملان اللذان يتناولان التشكيل التاريخي للنصّ القرآني والممارسات الأصلية للتفاسير القرآنية على الترتيب =قد تُرْجِما للغات غير الأوروبية قبل ترجمتهما للإنجليزية: (تاريخ القرآن) تُرجِم جزئيًّا للتركية (1970)، وتُرْجِم كاملًا للعربية (2004). بينما دراسة جولدتسيهر ظهرت بالعربية (1944، 1955)، وبالفارسية (2004). هذا النشاط الترجميّ العريض يعكس تعدد الدوائر العِلْمِيّة وجماهير القرّاء الذين انخرطوا في الدراسات القرآنية الغربية.
ثمة أُطُر وافتراضات ومنهجيات متباينة شكّلت المجال الحديث للدراسات القرآنية، داخل الغرب وخارجه، وهي التي جعلت تبادل الأفكار بين المجتمعات الدينية والفكرية هشًّا إلى حَدّ ما في بعض الأحيان. وغني عن الذِّكْر أنّ العديد من علماء المسلمين الحديثين تابعوا عن كثبٍ الأبحاث القرآنية التي أجراها غير المسلمين، لا من باب الخصومة أو المواجهة. وكما الحال مع كثير من بواكير الكتابات الأكاديمية الغربية في المجال، فكتاب ريجيس بلاشير (المدخل إلى القرآن) (1947) يمكن أن يتوقَّع قرّاء غير مسلمين يتألّفون إلى حدّ كبير من مجموعة من المستشرقين الطموحين. ومع ذلك، وجدت مقدّمة بلاشير النقدية جمهورًا مختلفًا تمامًا في ترجمتها الفارسية التي قدّمها محمود راميار (1980)، المختصّ بالدراسات الإسلامية في جامعة مشهد، والذي تقدّم لدكتوراه ثانية بإشراف مونتجمري وات[6] في جامعة إدنبرة، وأشهر مؤلّفاته: (تاريخ القرآن) (1976). كما يوحي العنوان، تستلهم هذه الدراسة مادتها من المرجع التأصيليّ لنولدكه في هذا المجال. ويتعامل راميار مع مجموعة من العلماء الأوروبيين المعاصرين بالإضافة إلى المراجع الإسلامية الكلاسيكية في التفسير القرآني. من جهته لاحظ وات في تنقيحه عام 1970 لمقدّمة القرآن لريتشارد بيل (1953) أنّ من الواجب إحداث تغيير جذري في ما رآه «العالم الجديد الغريب» في أواخر القرن العشرين. وبالنظر للتقارب المتزايد بين المسلمين وغير المسلمين، دعا وات لبحث جديد حول القرآن يضطلع به كِلا الفريقين بروح تعاونية. وتمامًا كما أنه لم يَعُد من المقبول تأييد مبدأ الكتابة لمجموعة متخيلة من العلماء من فئة غير المسلمين فقط، فإنّ الفصول الدراسية الجامعية في أمريكا الشمالية وأوروبا تتنوّع بشكلٍ متزايد في المساحات الدينية والعرقية.
ويمكن لحظ هذا التحوّل في المقدمات من المجموعة الواسعة من الإسهامات التمهيدية باللغة الإنجليزية عن القرآن، من تأليف مسلمين وغير مسلمين، والموجهة إلى الجمهور العام، داخل وخارج الفصول الدراسية الجامعية. ثم تغيّر هذا الوضع كثيرًا منذ الأيام التي اقتصرت فيها المواد التمهيدية الإنجليزية المتاحة على -مثلًا- استطلاع وات، ومقدّمة القرآن لكينيث كراج (1971)، ودراسة فضل الرحمن الموضوعية (1980). وقد شهد العقدان الماضيان إنتاجًا دوريًّا من المطبوعات التي تتناول القرآن بطريقة ما؛ منها مقدّمات: نيل روبنسون (1996)[7]، م. عبد الحليم (1999)، مايكل سيلز (1999)، محمد أبو حمدية (2000)، مايكل كوك (2000)، فريد إسحاق (2002)، بروس لورانس (2006)، منى صدّيقي (2007)، عبد الله سعيد (2008)، إنغريد ماتسون (2008)، والتر واجنر (2008)، كلينتون بينيت (2009)، آنا جايد (2010)، جون كالتنر (2011)، وضياء الدين سردار (2011). ولا يفوتنا في هذا المقام المجلدات الجامعة لعدّة مؤلِّفين؛ مثل تلك التي حرّرها جين دامين مكوليف (2006)، وآندرو ريبين (2006)، وهي كذلك موجهة للمستوى التمهيدي. من المؤكّد أن هذه المواد تعرض لمجالات تركيز مختلفة وتطرح عددًا من الرؤى لأصحابها من الملتزمين دينيًّا إلى اللاأدريين المتعاطفين إلى حدّ كبير. حتى إنّ المواد الأكثر تشكّكًا في تناولها للقرآن تميل إلى التعبير عن قدرٍ كبيرٍ من الاحترام للنصّ المقدّس. ومن المُسلّم به أنّ الكثير من هذا الاهتمام المبدئي بالنصّ المقدّس للإسلام قد ظهر ضمن السياقات السياسية الأوسع للحرب والإرهاب، إِذْ دفعت بالقرآن للصدارة بوصفه المفتاح لفهم الأحداث الجارية. العديد من هذه الأعمال التمهيدية يتناول بطريقةٍ ما أوجه القصور في الخلط بين الكتاب المقدّس والدِّين، مع التأكيد على الثغرات المعرفية والأخلاقية العميقة الكامنة في منهج الاقتصار على تفسير النص المقدّس من خلال عدسة الصراعات الحديثة. ومع ذلك، فإنّ مثل تلك المخاوف الحاضرة قد غذّت إلى حدٍّ كبير الاهتمام بالإسلام بشكلٍ عامّ والقرآن بشكلٍ خاصّ، وساعدت في إنشاء سوق متنامٍ من المطبوعات لجمهور العلماء والمهتمّين من العامّة.
ممن يَعُون تمامًا هذا التلاقي بين النَّشْر والحقل العلمي والمجال العام؛ كارل إرنست الذي تعكس عقوده العِلْمِيّة خبرة عميقة في الدراسات الإسلامية والدراسة الأكاديمية للدِّين. أسهم إرنست مؤخّرًا في هذا البحر الزاخر من المُؤَلَّفات بمقدمته عام 2011، بعنوان: (كيف تقرأ القرآن)، وهو دليل موجَز ومدروس كتبه بعد عدّة سنوات من الخبرة في تدريس القرآن غالبًا لطلاب الجامعات الأمريكية. يقدّم هذا الكتاب عرضًا شفّافًا للقرآن، مصمّمًا خصيصًا للفصول الدراسية الجامعية. وإرنست قارئ متعاطف ذو قرب من النصّ، ملتزم بمبادرة أوسع لإزالة الغموض عن الإسلام وبناء جسور التواصل بين مختلف الرؤى الثقافية والفكرية والدينية. وقد نجح في الحفاظ على هذا الاهتمام الأخلاقي الأكبر، بالتوازي مع تحليل القرآن عن كثبٍ كوثيقة نصيّة وتاريخية، تستحقّ الاهتمام الأدبي وفقًا لحدودها الخاصّة.
يقدّم إرنست لقرائه الكثير من الأبحاث الحديثة حول القرآن، ويقدّم أثناء ذلك حُجَجًا مقنعة لمقاربة أدبية للنصّ المقدّس. وتشهد الحواشي الثرية باتصاله الواسع مع الدراسات الغربية الحالية (خاصة الألمانية) في هذا المجال. وأشار أيضًا إلى عدد من علماء المسلمين المعاصرين والمفكرين والمصلِحين (على سبيل المثال، الصفحات 64- 65). استنادًا لكلّ من النصّ الأساسي والملاحظات الإضافية، قد يتكوّن بسهولة لدى القارئ انطباع بأنّ أهم معرفة تُكتسب عن القرآن اليوم تأتي من خارج مجال التعليم الإسلامي، مهما كانت سعة نطاق تفسيرها. ولعلّ التزام إرنست بالقراءة غير اللاهوتية للنصّ أسهم في الغياب العام للدراسات الإسلامية الحديثة في عمله، وقد يعكس أيضًا الازدواجية والشكّ اللذَيْن أعربتْ عنهما بعضُ المرجعيات الدينية الإسلامية تجاه النقد الغربي للقرآن، والذي يشكّل موضع اهتمام أساسي لمبادرة إرنست. في الواقع، يهدف إرنست صراحة إلى إقصاء التفسيرات المتجذّرة في الالتزام الديني، كوسيلة للنهوض بما يسميه القراءة غير اللاهوتية التي يسهل استيعابها لدى نطاق واسع من الجماهير.
يجد عنوان كتاب إرنست نظيرًا في العديد من المطبوعات التي ينطوي عنوانها بشكلٍ ما على «كيفية قراءة الكتاب المقدّس». وفي حين يظهر العنوان بشكلٍ بارز في مدرسة الأحد البروتستانتية في القرن التاسع عشر، فقد ارتبط لبعض الوقت بالدورات التمهيدية الجامعية حول الكتاب المقدّس. وقد تقاطع هذا الاتجاه مؤخّرًا مع تعليم القرآن، كما انعكس أولًا مع الباحثة الباكستانية البريطانية منى صدّيقي، التي نشرت دليلًا بعنوان: «كيف تقرأ القرآن» (2007) بهدف تقديم قراءة تخاطب جمهورًا عامًّا. وبالبناء على نموذج موجود بالفعل للدراسات المتعلّقة بالكتاب المقدّس، يسلِّط هذا العنوان المشترك الضوء على الرغبة المتزايدة للناشرين والقرّاء والمعلِّمين في المواد التربوية التمهيدية المصمّمة لشرح نصّ مهمّش لفترة طويلة في التعليم الغربي.
وكما الحال مع إرنست، والعديد من العلماء الجُدد الآخرين في هذا المجال، تتعرّض صدّيقي لتحديات قراءة القرآن في فترة ما بعد 11 سبتمبر. وعلى النقيض من ذلك، تكتب صدّيقي أيضًا بصفتها أكاديمية مسلمة ملتزمة عباديًّا تجاه القرآن باعتباره «كتابًا للهداية والإلهام الإلهي». ومن ثم تتعامل مع الحجج المعيارية العامة فيما يتعلّق بكيف ينبغي للمسلم أن يقرأ القرآن بروح «ناضجة» تقدّر التعدّدية الدينية والتسامح الديني، وهذا يمثّل تحديًا مباشرًا للهرمنيوطيقا الحرفية التي قدّمها الأصوليون بشكلٍ واضح ومسموع (ص:86). يتبع دليل صدّيقي المختصر محاور متسلسلة إلى حدٍّ كبير، حيث يقدم موضوعات رئيسة متعلّقة بالقرآن وتطوّر التاريخ الإسلامي، وتسعى من خلالها إلى استخلاص رسالة تأسيسية للعدالة والرحمة. وتختم صدّيقي بالتفكّر في تحديات وفوائد الدراسات النقدية الغربية الحديثة حول القرآن، وتحثّ المؤمنين المسلمين على تقبُّل المعالجات التعبدية والنقدية للنصّ، كجزء من واجبٍ أخلاقي أوسع لتعزيز التفاهم والاحترام المتبادلَيْن (ص:105). لا تتطرّق صدّيقي بشكلٍ نقدي إلى حدود الإطار الأدبي الأخلاقي للتعدّدية والتعدُّد الثقافي من حيث الممارسة أو الغرس داخل الميادين المتميّزة للتعليم العلماني الغربي والحياة العامة. وبالمثل، فإنّ معالجة القرآن في بعض الأحيان تكون خاطفة وانطباعية إلى حدّ ما، وغالبًا ما تبسط مواقف قائمة على الإيمان فيما يتعلّق بتشكيل ونقل النصّ الذي روّجت له المرجعيات الإسلامية المبكّرة، مع القليل من المؤهّلات فيما يتعلّق بالمشاكل التاريخية المصاحبة التي شغلتْ كثيرًا من السجالات العلمية الحديثة في الغرب.
في المقابل، تسعى مقدّمة إرنست لنقل التركيز بعيدًا عن العرض المعياري القائم على التقاليد والمتجذّر في الاستقبال التفسيري اللاحق، وتحويل الانتباه عوضًا عن ذلك جهة الأسئلة ذات السياقات التاريخية والأدبية عن تكوين القرآن. ويوافق إرنست صدّيقي إِذْ يتجه لخطاب القرّاء ذوي حسّ الواجب الأخلاقي الأوسع الذي شكّلته الأحداث الجارية. ومع ذلك، يسعى للحفاظ على قُرب اهتمامه بالنصّ نفسه، أثناء محاولة الجمع بين الدراسات الحديثة حول القرآن مع تحليله النقدي الخاصّ.
ولهذه الغاية، يفتتح إرنست كتابه بفصلَيْن تمهيديَّيْن ثاقبَيْن: الأول عن تحديات قراءة القرآن في السياق السياسي والثقافي الحالي؛ والثاني عن تاريخ استقبال القرآن وتفسيره. ويليهما ثلاثة فصول تركّز بالكامل على التطوّر الكرونولجي/ الزمني للنصّ القرآني. يُختتم العمل بفصلٍ أخير يعرض لتطوير قضية القراءة الأدبية، والتي يُقصد بها إلى حدّ كبير التحليل البنيويّ والمعنيّ بنقد الصيغ/ الأشكال. في هذا السياق، يقدّم إرنست ثلاثة ملاحق مفيدة: الأول مخطط زمني وتركيبي للسور المكية، كما طوّرته أنجيليكا نويفرت[8] في تحليلها الأدبي الشكلي «دراسات في تكوين السور المكية» (1981؛ طبعة منقحة 2007). والملحق الثاني مخطّط للبنية الحلقية لسورة البقرة (س 2)، على النحو الذي اقترحه ريمون فارين (2010). ثم التفاسير المقدّمة في الملحق الأخير تركّز بشكلٍ شبه حصري على التحليل النصّي للقرآن. وهكذا يتّضح هدف إرنست في إرشاد قرّائه لكيفية قراءة القرآن بتوظيف الإطار الخاصّ لنقد الأشكال.
يخاطب إرنست جمهورًا عريضًا من الطلاب وعامّة القرّاء، سواء من المتدينين وغير المتدينين؛ كما أنه يتحدّث مباشرة إلى المسلمين الذين قد ينتابهم «فضول حول ما يعتقده العلماء غير المسلمين في القرآن»، ويحاجج بأنّ «نهجه التاريخي والأدبي محايد ومحترِم»؛ إِذْ يسعى إلى تعزيز التفاهم وهو «الأساس للتواصل الحقيقي» (ص:8). يطبّق إرنست على القرآن المناهج التي تم تطويرها في القراءات الأدبية للكتاب المقدّس القائمة على تحليل النصّ من حيث محتواه و(أشكاله) المختلفة، ويعزل هذه القراءة عن التقاليد التفسيرية اللاحقة للمرجعيات الدينية الإسلامية التي طوّرت تفسيرات معيارية. يلاحظ إرنست أنّ هذا النهج يتناقض مع غالبية الأعمال التمهيدية عن القرآن، والتي يحاجج بأنها تقدِّم إلى حدٍّ كبيرٍ مواضيع ورسائل واسعة النطاق، وتعتمد عمومًا على التقليد التفسيري السنّي باعتباره المرجع الأساسي لفهم النصّ. بالإضافة إلى ذلك، يرثي إرنست افتقار تلك المقدمات لأيّ تفاعل حقيقي مع الدراسات الحالية حول التكوين التاريخي للقرآن. وبالنظر إلى النطاق الواسع للمواد التعليمية في هذا المجال، قد لا يكون هذا هو التقييم الأكثر عدلًا. ومع ذلك، فهو بمثابة المنطلق لعرض إرنست لقراءة نقدية للنصّ، بالبناء على حجّة طوّرها سابقًا في مقالته: (إستراتيجيات قراءة لتقديم القرآن كمادة أدبية في جامعة أمريكية عامة) (2006).
يسعى إرنست للوصول إلى القرآن في فترة ما قبل تفسيره وما قبل تحوله لنصّ ذي مرجعية وسُلْطة، ويشرع في تحقيق ذلك من خلال التحقيق في الأدلة الداخلية للقرآن كوثيقة نصية. تتخطّى هذه الممارسة سُلطة التقليد التفسيري على أمل إعادة خَلْق أول استقبال تاريخي للنصّ القرآني[9]، فيهدف إرنست من خلال منهج نقد الصيغ/ الأشكال إلى وضع دراسة القرآن على قدم المساواة مع دراسة الكتاب المقدّس العبري والعهد الجديد في سياق التعليم العالي الأمريكي، كـ«نصوص أدبية ظهرت في سياقات تاريخية معيّنة» (ص:17). علاوة على ذلك، يؤكِّد أنه نظرًا لأنّ نهجه الأدبي غير اللاهوتي لا يقيِّم الأصالة الدينية الفعلية للقرآن، فإنه يقدّم بديلًا عن «العداء الشديد والتحيُّز ضد الإسلام» الذي يشكّل المواقف تجاه المسلمين في أمريكا وأوروبا. في النهاية، بالنسبة لإرنست، توفّر هذه القراءة الأدبية أساسًا للتعدّدية الدينية؛ لأنها ليست معنية بشرعية أيّة دعوى دينية معيّنة.
أمّا بالنسبة لتحليل إرنست، فهو مدِين بشكلٍ كبيرٍ لعمل تيودور نولدكه وأنجيليكا نويفرت، بالإضافة إلى الكمّ الهائل من الدراسات التي تضمّنتها (موسوعة القرآن) (2001- 2006). يُعَدّ الترتيب الزمني للسور التي اقترحها نولدكه وتم تعديله بواسطة نويفرت بمثابة الأساس لعملية إرنست التأويلية، حيث يأخذ قراءة عبر مسار نولدكه في ترتيب السور المكيّة المبكّرة والمتوسطة واللاحقة، تليها قراءة للسور المدنية. ولم يلمح إرنست إلى النقد الأكاديمي الموجّه لهذا النهج المعيّن في ترتيب النصّ. وعلى ذلك، فقد تجاوز هذه القضايا إلى حدٍّ كبيرٍ لصالح فرضية براجماتية وفاعلة تساعده على تخطيط التنوّع البنيوي والخطابي والموضوعي داخل النصّ القرآني على أساس تطوّر زمني معيّن.
يتمثّل أحد الأهداف الأساسية لدراسة إرنست في جعلِ البحث الحديث عن القرآن أكثر سهولة لغير المتخصّصين. ينتج عن هذا توازن جيد إلى حدّ ما بين الاهتمام عن كثبٍ بالقرآن والحجج الأوسع المتعلّقة بالتطوّر التاريخي للنصّ ومراحل (تحوّله لمرجعية ولنص ذي سلطة). في ضوء ذلك، يقدّم إرنست تحليلًا مقنعًا للسورة الخامسة (ص:162- 63، 190- 203) متشابهًا بنيويًّا مع فكرة البناء الدائري-المتوازي ring-cycle المستمدة من دراسة ميشيل كويبرس[10] في سورة المائدة (2009). ويتبع هذا استكشافات بنيوية وموضوعية مماثلة للسور 2 و3 و60. ومن الأهمية بمكان أيضًا اهتمام إرنست بالمعرفة التاريخية الأوسع عن العصور القديمة المتأخّرة، التي يضعها في حوار مع القرآن. وتُعَدُّ مناقشاته حول ممارسات الدفن والمقابر ومفاهيم الحياة الآخرة في سياق شبه الجزيرة العربية في فترة ما قبل الإسلام (ص:84- 89) ثاقبة النظر بشكلٍ خاصّ في هذا الصّدد.
في حين يمكن أن يكون لمثل ذلك الاعتماد على مجموعة مصادر علمية ثانوية أوجه قصور، إلا أنها تنعكس هنا فقط في بعض المواضع الثانوية التي تتطلّب مزيدًا من الشرح أو التوضيح أو التصحيح. وفي مناقشته الموجزة والحصيفة معًا للغة العامية والترجمة، يشرح إرنست أنه في القرن العاشر تمت بالفعل «تَرجمة تفسير الطبري الضخم للقرآن العربي إلى الفارسية» (ص:68). وغني عن القول أنّ هذا يبالغ في تبسيط العلاقة بين التفسير الفارسي المعروف عمومًا في تقليد دراسة المخطوطات باسم تفسير الطبري، والمتون التفسيرية والتاريخية المرتبطة بالطبري. وبالمثل، يدّعي إرنست أن تفسير الثعالبي لم يُنشر (ص:64)؛ ومع ذلك، بينما لا نزال نفتقر إلى نسخة نقدية من التفسير، فإن العمل نفسه متاح على نطاق واسع على الإنترنت كملف PDF من طبعة بيروت (2002) وكملف نصّي قابل للبحث فيه. ومع ذلك، بما أنّ التفسير ليس مجال اهتمام إرنست، فإنّ مثل هذه الزلّات لا تنتقص من قدر المسائل الأخرى التي تمثّل التركيز الأكبر للعمل.
في نقاش حول السياق التاريخي للقرآن، يلخّص إرنست حجّة قدّمها نولدكه (1890) ثم أعاد النظر فيها كيفن فان بلاديل (2008) حول العلاقة بين الرواية القرآنية لذي القرنين (س 18: 83- 102) والنبوءة السريانية المجهولة من القرن السابع للإسكندر الأكبر (Neṣḥānā d'Aleksandrōs انتصار الإسكندر). بعد تأريخ الانتصار الذي قدّمه جيريت رينينك (1985، 2003)، يقترح إرنست أنّ الأسطورة السريانية قد تم دمجها في ثنايا مجموعة سابقة من السور المكية في أواخر الفترة المدنية (ص:138). لكن على المستوى اللغوي[11]، تثير مواضع الافتراق المهمّة بين النصّ القرآني والنصّ السرياني تساؤلات جدية حول العلاقة الدقيقة بين الروايتين. ثمة الكثير مما يوحي بأنّ الخطابات الأخروية حول حياة الإسكندر ويأجوج ومأجوج قد انتشرت على نطاق واسع طوال القرن السابع، شفهيًّا ونصيًّا. وبالتالي من الصعب محاولة تأريخ الرواية القرآنية باستخدام مواد قد لا يكون فيها تناصّ مباشر مع القرآن. ونظرًا لأن هذه القضية بالذات ظلّت موضوعًا لبعض الجدل الأكاديمي، فكان يمكن أن تكون بمثابة فرصة لاستكشاف المفاهيم المبسطة في كثير من الأحيان للتأثير والاستعارة وتداول النصوص في أواخر العصور القديمة، والتي تطوّرت في الدراسات الاستشراقية في القرن التاسع عشر حول مصادر القرآن.
يسارع إرنست للتوضيح بأنّ قراءته الأدبية تقدّم وجهًا واحدًا فحسب من بين وجوه عديدة للتعامل مع النصّ المقدّس، وأنه بوسع الآخرين أن يتحدّوا تفاصيل تحليله. هذه الصراحة منعشة وتضفي ديناميكية على معالجته للمواد، إلا أن المرء لَيتمنى مع ذلك إيلاء المزيد من الاهتمام للتضمينات والحدود الخاصّة بأنماط معيّنة من القراءة المقدّمة في الكتاب. على سبيل المثال، معالجة البنية الشكلية للقرآن على مستوى الآيات الفردية ومجموعات الآيات الأكبر تتبع عن كثب الطريقة التي طورتها نويفرت في دراستها الأساسية حول تكوين السور المكية. هذا يسمح لإرنست باستخلاص الأنماط البلاغية الأوسع ورصف الموضوعات والمواد في تنظيم بنيوي للسورة كوحدة أدبية، وهو يتبع في ذلك ملاحظة نويفرت أنّ المواد التي تُسبِّب انقطاعًا في هذه الأقسام البنيوية أو المجموعات المستقلة من الآيات (مثل Gesätz؛ راجع Studien، ص:175- 78) بشكلٍ موضوعي أو تتعارض مع القافية الداخلية وبنية الفقرة، كلّها قد تمثّل إضافات لاحقة أو إقحامات على النصّ الأصلي، كما في ورود مقطع طويل من النثر ضمن سلسلة من الآيات المتناغمة. في بعض الأحيان يمكن أن تكون هذه التفسيرات مقنعة إلى حدّ ما. ومع ذلك، فإن النقد الداخلي الأدنى -مستقلًّا عن أيّ شكلٍ من الشهود الخارجيين كالمخطوطات أو المفسِّرين- يخاطر بالإطناب في حلقة حُجج مفرغة. وكما وضح أندرو ريبين (1982) في مراجعته لدراسة نويفرت عن التكوين، هناك قيود منهجية عميقة لعملية تحديد البنية الأساسية أو تجميع الآيات، وهو إجراء يرى أنه شخصي بالضرورة وفي بعض الأحيان عشوائي. هذا، ومن شأن التفاعل الكامل مع الفوائد والحدود لهذه المنهجية الهرمنيوطيقية المعينة أن تمنح مزيدًا من الشفافية لقراءة إرنست الخاصّة.
تُعتبر قراءة القرآن كمادة أدبية بالنسبة لإرنست ممارسة للتحليل البنيوي إلى حَدّ كبير، ودراسة الصفات الشكلية للنصّ هي وسيلة لسبر أغوار تكوينه التاريخي. هناك مآخذ معرفية ملحوظة لمثل هذه الطريقة، سيّما في المدى الذي يمكن أن تكشف فيه مثل هذه المقاربات الوضعية حقيقة «المكانة في الحياة Sitz im Leben» لتكوين كتاب مقدّس، مستقلّة عن الاستقبال التفسيري اللاحق. فمع تقدّم النقد ما بعد البنيوي، بدأ مجال الدراسات اللاهوتية الحديثة يتصارع مع هذه المشاكل بالذّات، وهذا أمر مناسب تمامًا أن يحدث في عمل تقديمي للقرآن من أجل معالجة أوجه القصور في النظرية الأدبية البنيوية والنقد النصّي كوسيلة لاستعادة المعرفة التاريخية. ومع ذلك، يمكن لقراءة أدبية للقرآن أن تتجاوز هذه الاعتبارات الشكلية لعملية اعتماد النصّ وللتكوين النصّي والأنماط البنيوية.
ثم تأتي المشكلات التي يطرحها تصنيف الأدب نفسه، وهي وإن كانت مسائل دقيقة إلا أنها تظلّ مهمّة. يستخدم إرنست الأدب بشكل أساسي كمصطلح محايد وشفاف، ومن الواضح أنه عالمي في نطاقه، ويحتاج إلى القليل من التفسير أو التهيئة للسياق. يسلّط إرنست الضوء بحقّ على مسألة أنّ المقاربة الأكاديمية للقرآن كأدب مصمّمة بحيث تستبعد السؤال اللاهوتي عن الإيمان تمامًا كما حصل مع الكتاب المقدّس، وهي مهمّة تتوافق بالكليّة مع الأهداف الخطابية للتعليم العلماني. هنا يعلو التأييد للقراءة الأدبية التي تعني عمومًا النقد التاريخي، باعتبارها طريقة لسبر أغوار التكوين النصّي للكتاب المقدّس كظاهرة تاريخية. وغنيّ عن القول أنّه لا تصنيف الأدب ولا أساليب النقد التاريخي متحرّران من الالتزامات أو الافتراضات الأيديولوجية. وقد حاجج الناقد الأدبي البريطاني تيري إيجلتون (2008) في نقاش حول الجماليات العلمانية أنّ «معظم المفاهيم الجمالية هي مفاهيم لاهوتية مقنعة»، وهي ملاحظة قدّمها أيضًا طلال أسد (2011) في مناقشة حول العلمانية والدّين وحرية التعبير. وبالفعل تنطوي أنماط القراءة عمومًا على التزامات أيديولوجية، إن لم تكن لاهوتية صريحة. وإنّ تاريخ المسلمين ثريّ جدًّا في التعامل مع القرآن باعتباره كلامًا إلهيًّا فائقًا ذا نبوغ أدبي. ومع ذلك، يوضح إرنست بجدارة أن القراءة الأدبية يمكن أن تتجنّب حقيقة المقاربة اللاهوتية الصريحة للقرآن، إلا أنّ مثل هذه المقاربات التفسيرية وإن لم تكن مبنية على التزامات لاهوتية، فهي لا تزال تنقل قِيَمه وافتراضاته.
إنّ التأصيل للأدب كمجال علماني لا يحمل السلطة ولا الأصالة الإلهية لا في أصله ولا في نطاقه، يشكل جزءًا من عملية معينة في تاريخ العلمانية الغربية تستدعي تأملًا أوسع عندما نضع في الاعتبار الدلالات السياسية لقراءة الكتب غير المقدّسة. في حين أشار أندرو ريبين (1983) إلى بعض المشاكل المتعلّقة بقراءة القرآن بوصفه أدبًا[12]، فإنّ السؤال يستحقّ مزيدًا من الدراسة، ويمكن لمقدّمة عن القرآن كنصّ أدبي مثبت في التاريخ أن تخاطب هذه المشكلات بشكلٍ مباشرٍ. وإحدى تلك المضامين هي أنّ المنهج التاريخي للنقد الأدبي يميل إلى تفضيل العالم الكامن وراء النصّ في تشكيلاته المعتمدة وما سبقها، وبالتالي يمكن أن يخاطر بتجميد الكتاب المقدّس ومعناه في فراغ تاريخي. وبدلًا من وثيقة حية تُنشر من خلال سياقات متنوّعة للاستقبال، فإنّ التركيز على أولوية المعنى الأصلي يمكن أن يشوش على الضرورات الاجتماعية والأخلاقية التي تواجه مجتمعات تفسيرية متعدّدة، والأهمية الأصلية في ساحة المعركة هي بالضبط حيث يتم تقديم أشكال متنوّعة من السلطة الدينية والعلمانية، وقد تم تحليل مثل هذه المشاكل الأخلاقية بشكلٍ جيد في سياق ردود الفعل ما بعد الحداثية على النقد التاريخي للكتاب المقدّس، وقد صار النقد التاريخي باعتباره أحد أنماط القراءة بشكل متزايد (وربما هذا من المفارقات) قوّة محافظة في خضم تيارات معينة من الهرمنيوطيقية اللاهوتية الحديثة.
إذا وضَعْنا جانبًا هذه الأمورَ الصغيرة، فإنّ عرض إرنست الضليع لما يسميه أفضل الأبحاث الحالية في هذا المجال يقدّم مقدّمة نابهة ويسهل فهمها للمعلمين والطلاب المهتمين بدراسة جادة للقرآن. يتناسب التركيز على المراحل التكوينية للنصّ القرآني مع الجهد المتزايد داخل الأكاديميا وخارجها لوضع القرآن في سياق الوسط الديني لأواخر العصور القديمة، وخاصّة في ضوء النصوص الكتابية وغير الكتابية. وثمة العديد من العوامل التي تحفز هذا الاهتمام؛ فعلى المستوى العلمي، كان هناك ردّ فعل متزايد لاستخدام التفسير الإسلامي كوسيلة لدراسة القرآن، وقد قيل إنّ المواد التفسيرية باعتبارها متونًا أدبية تميل إلى التهوين = بل والتجاهل أحيانًا للروابط الحوارية العميقة بين القرآن والبيئة الدينية الأكبر لسياقات استقباله الأولية.
ومعلوم أنّ المقاربة بين القرآن والكتاب المقدّس قد وَضعت حجر الأساس للحوار بين الأديان وللهجمات العدائية ضدّ محمد والإسلام، غير أنّ العديد من هذه المنشورات ذات الطابع العمومي يعاني من ثغرات معرفية خطيرة، ومن الأمثلة الواضحة على المزالق التي ابتُليت بها الكتابة الشعبية عن القرآن مجموعة مثل تلك الموضوعة بحسن نية بعنوان: (تشارك مريم: الكتاب المقدس والقرآن جنبًا إلى جنب)، والتي جمعتها الكاتبة الهولندية مارليس تير بورخ. يسعى المجلد إلى تقديم قراءة غير منحازة، في هذه الحالة من خلال «وضع قصص الكتاب المقدّس والقرآن جنبًا إلى جنب على قدم المساواة» (ص:31). تؤكّد تير بورخ أن المجاورة بين الكتابَيْن المقدسَيْن يرتكز في النهاية على محاولة للتنصل من التفسير أو التقييم. وكما تحاجج: «هذا أفضل من التجربة التاريخية [كذا ورد] لسوء التفسير». وتؤكّد الكاتبة أنها لا تتبع انتماءً دينيًّا معيّنًا وإنما تكرّس جهدها لزيادة التفاهم بين الإسلام والغرب. كما تصرّح بوضوح أن مجموعتها مصمّمة لتعزيز الحوار الديني والتفاهم المتبادل.
تسارع تير بورخ إلى التأكيد على أنها هي نفسها ليست عالمة مختصّة بدراسة الإسلام أو القرآن أو الكتاب المقدّس، والمجموعة ليست إلا طبعة مزيدة وترجمة جزئية لمجموعتها الهولندية السابقة: (القرآن والكتاب المقدس في القصص) (2007)، وقد نجحت تير بورخ في النسخة الإنجليزية في حشد مجموعة واسعة من المراجع العلمية، مع تأملات تمهيدية وختامية في المجلد لثلاثة علماء مشهورين معتنين بالإسلام والقرآن في أكاديمية أمريكا الشمالية: أندرو ريبين[13]، والراحلة باربرا ستوواسر، وخالد أبو الفضل. كما تمّ تضمين مجموعة من العلماء والمرجعيات الدينية من هولندا، كثير منهم منخرِط في تعزيز التعدّدية الدينية والحوار بين الأديان بطريقةٍ ما: مارثا فريدريكس، وهيرمان بيك، وموك نور إيشوان وهو باحث إسلامي إندونيسي ومتدرب في هولندا، بالإضافة للحاخام الهولندي الليبرالي أوراهام سوتندورب. ومن الذين أسهموا أيضًا محمد باتشاجي، وهو عالم تركي معروف في التفسير القرآني. تُعَد المنتخبات الواسعة من الأصوات التي تم ضمّها معًا في صفحات مجموعتها، والتي تمتد عبر القارات والتخصّصات والأديان، شهادة على نجاح مشروع تير بورخ الذي وضع خصّيصًا لتعزيز الحوار والتواصل والتفاهم المتبادل بين الأديان. وكافة العناوين وعناوين الفصول، والمواد المصورة، والمحتوى الفعلي للمجموعة الذي يجمع بين هذه الأصوات العلمية والدينية بالتوازي مع مقاطع من الكتب المقدّسة، كلها تشير إلى تفاعل إبداعي وحيوي للغاية مع مادة المصدر.
ومع ذلك، فإنّ التطلعات الرائعة لذلك المشروع تشوبها عدّة مشاكل؛ إِذْ تبدو معظم تلك الإسهامات أصلية بالنسبة للمجلد. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أنّ المقطع الذي كتبته باربرا ستو واسر هو -إلى حدّ كبير- إعادة كتابة لمواد من كتابها (نساء في القرآن) (1994)، وهي مسألة لم يتم ذكرها صراحة وقد تؤدّي إلى بعض الالتباس. وبالمثل، تُظْهِر صفحة الغلاف اسم (أبو الفضل) بشكلٍ بارز ككاتب مُسْهِم، إلا أنّ المجموعة تقتبس فقط مقاطع من عمله المنشور سابقًا: (البحث عن الجمال في الإسلام) (2001).
بتجاوز هذه العيوب غير ذات البال إلى حدّ ما، نجد بنية وإخراج المبادرة يستحقان أيضًا مزيدًا من التفكّر؛ فقد تمّ إدراج الفقرات المتوازية بترتيب يقدّم عرضًا متسلسلًا منذ قصة بدء الخليقة مع آدم وحواء، متبوعة بروايات عن الأنبياء والملوك الكتابيّين (الفصول: 5- 17)، ثم ينتقل لحياة مريم ويسوع/ المسيح (الفصول: 18- 21) واستطراد قصير (الفصل: 22) يربط بين عيسى ومحمد. يتناول ذلك الفصل بإيجاز وبشكلٍ غير كافٍ الأحاديث التفسيرية المسيحية والإسلامية فيما يتعلق بـ(الباراكليت/ المخلص) في إنجيل يوحنا وفي المقطع القرآني عن نبوءة عيسى برسول يخلفه اسمه أحمد (أي المحمود لأقصى درجة)، وفي القرآن: {وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ}[الصف: 6]. ومن هناك ينتقل المجلد إلى أقسام تدور حول علم أمور الآخرة وعلم الخلاص (الفصول: 23- 25) والمخاوف القانونية والأخلاقية (الفصل: 36- 39). ويلي ذلك فصل أخير عن صفات الله، يؤكِّد على جوهر التوحيد المشترك بين اليهود والمسيحيّين والمسلمين.
تُصِرّ تير بورخ على أن مجموعتها تتجنّب الشروحات التفسيرية اللاحقة من أجل ترك «التفسير والتحليل السياقي والتاريخي للقارئ» (ص:40). وغنيّ عن الذِّكْر أن مقدماتها المختصرة لكلّ فصل هي في حدّ ذاتها انعكاسات لإطار استكشافي خاصّ للغاية، مستمدّ إلى حدّ كبير من المصادر التفسيرية التقليدية؛ هذا هو الحال بلا شكّ في معالجة مثل هذه القضايا اللاهوتية والسياسية مثل ألوهية المسيح، والحرب المقدّسة والإرهاب، وحقوق الإنسان، والمثلية الجنسية، ومكانة المرأة. علاوة على ذلك، فإنّ طريقة اختيار مقاطع معينة ومحاذاتها جنبًا إلى جنب، غالبًا بطريقة ذرّية عميقة، هي في حدّ ذاتها شكل من أشكال التدخّل الهرمنيوطيقي المصمّم لا محالة لتعزيز تحليل وتفسير معيّنَين. وإذا كانت تير بورخ صريحة في أسلوبها التحريري القائم على اقتطاع أجزاء كبيرة من النصّ من المصادر اللاهوتية المعنية، إلا أنّ النتيجة غالبًا ما تكون عبارة عن محاكاة مضطربة عارية إلى حدّ كبير عن ارتباط بأيّ سياق معطى، اللهم إلا الإخراج التحريري للمجموعة.
وهكذا، على سبيل المثال، فيما يتعلّق بمسألة الحجاب (ص:267- 68)، تصفُّ تير بورخ مقاطع من سفر التثنية، وكورنثوس الأول، وبطرس الأول، وتيموثاوس الأول، باعتبارها تمثّل بوضوح موقف الكتاب المقدّس بشأن هذه المسألة، ثم تجاور أولئك مع آيات قرآنية مأخوذة من ثلاث سور مختلفة (7: 26، 24: 30- 31، 33: 95). مثل هذا النهج يتوافق تمامًا مع مجموعة معيّنة من الممارسات الهرمنيوطيقية البروتستانتية. يتجلّى هذا، على سبيل المثال، في العقيدة البروتستانتية التأسيسية «الكتاب المقدّس منفردًا»، والتي تضع السلطة التفسيرية في يدِ الفرد المؤمن الذي يواجه الكتاب المقدّس نفسه، متجرّدًا من أيّ تدخُّل تفسيري وسيط. وتجد عملية القراءة هذه تعبيرًا كاملًا من خلال مجموعة إثبات البيانات- نصوص إثبات يمكن اختزالها وإعادة ترتيبها وإزاحتها من سياقاتها الأصلية من أجل تشكيل أساس (لاهوتي) لعقائد معيّنة. وفي حين يمكن لبعض المناهج الكلاسيكية للتفسير الإسلامي أن تكون ذرّية للغاية أحيانًا، فإنّ السياق التاريخي وترتيب الوحي اللذَيْن تعرضهما متون أسباب النزول والنَّسْخ يحدّان بشكلٍ عام من أنماط إعادة الترتيب والتنظيم التي يمكن قبولها في أيّ إجراء تفسيري معيّن. وهكذا، فإنّ العديد من المقاربات التي تعقدها تير بورخ بين الكتاب المقدّس والقرآن تبدو أحيانًا إمّا عشوائية أو محكومة بمجموعة استنتاجات تفسيرية مبطنة تأمل أن القارئ سيتوصل إليها.
وبالنظر إلى الأساليب المتنوّعة التي يتم بسط المحتوى بها على مدى صفحات القرآن، لا سيما سلالة الأنبياء الذين سبقوا محمدًا، هناك الكثير الذي يمكن الظفر به بوضع التناصّ ذي الصلة من الكتاب المقدّس وخارجه جنبًا إلى جنب مع المواد القرآنية. وكما لاحظت الدراسات الغربية منذ فترة طويلة، هناك العديد من المقاطع التي تثبت فيها المقارنة جنبًا إلى جنب أنها مثمرة إلى حدّ ما. في الواقع، يتصوّر القرآن نفسه على أنه تتويج لتقليد سماوي من الوحي الديني الذي يمتد من خلال الكتابات الموحاة لإبراهيم والتوراة ومزامير داود وإنجيل المسيح؛ لذلك من المؤكّد أنّ تسليط الضوء على هذه الترابطات العميقة سيساعد في وضع القرآن ضمن مجموعة أوسع من التقاليد اللاهوتية. في جوهر شكله ذاته، مثل هذه المجاورة يمكن أن تعِين على جلاء الغموض حول التغيير الجذري الذي يربطه العديد من غير المسلمين بالإسلام وكتابه المقدّس.
ومع ذلك، فإنّ طريقة التجاور هنا مشكلة للغاية. والأهمّ من ذلك، أنّ المجموعة تقدِّم الكتاب المقدّس باعتباره الوسيلة الأصيلة والموثوقة التي تصوغ الدّين وترسي قواعده. ويسلّط أندرو ريبين الضوء على هذا الاختزال في مساهمته في المجلد، حيث يلفت الانتباه إلى الأُسس البروتستانتية الخاصّة لمساواة «الدّين بكتابه المقدس» (ص:49). كما يحاجج بأنّ مثل هذا التجاور جنبًا إلى جنب بين الكتاب المقدّس والقرآن سيعطي الحظوة للنصوص المعتمدة التي قد لا تكون محلّ تناصّ تاريخيّ مع القرآن، وبالتالي فإنّ أيّ استنتاجات مستخلصة من مثل هذه المجاورة يمكن أن تؤدّي بسهولة إلى «تفسيرات خاطئة خطيرة» (ص:50) حول تأليف القرآن. وعلى ذلك، جاء إدراج نقد ريبين اللاذع لذات الممارسة التي تتبنّاها المجموعة مخفّفًا لحدّ ما من أوجه القصور العميقة في طريقة الإخراج، إلا أنّ المرء ليتساءل مع ذلك: لماذا لم تُولِ تير بورخ المزيد من الاهتمام لنقد ريبين؟ هذا، وتعكس مشاركة الأكاديميين في المطبوعات الشعبية عن القرآن ضرورة أكبر للانخراط في نقاشات عمومية أوسع حول الإسلام. ويوضح ريبين أنّ مسألة الاستقطاب بين الصرامة الأكاديمية أو تخفيفها في مثل تلك الأعمال هي عواقب لا يمكن التغلّب عليها.
تتلاءم الجوهرية النصّية لـ(تشارك مريم) مع نهج معيّن للكتاب المقدّس بوصفه أدبًا غير مرتبط بالسياقات التاريخية لتشكيله أو استقباله. مثل هذا النهج يعزّز توهُّم وجود عملية قراءة مباشرة وغير وسيطة. بالنسبة لتير بورخ، وُضعت ممارسة المقارنة للتأكيد على أنّ الكتاب المقدّس والقرآن «جزء من الأدب العالمي»، وعلى هذا النحو، يستحقّان أن يكونَا في متناول «كلّ قارئ راغب» (ص:31). هذه البنية الخاصّة للأدب تهدف لتمكين القارئ الفردي من الوصول إلى النصّ والحكم على معناه بشكلٍ مستقلّ عن التقاليد التفسيرية، والتي يُنظر إليها على أنها اتفاقات تاريخية أو أيديولوجية أو لاهوتية. والحقّ أنّ دافع تير بورخ صحيح تمامًا من حيث إنّ تضمين مقتطفات من القرآن والكتاب المقدّس ومجموعة من الكتب اللاهوتية الأخرى في مناهج الأدب العالمي أصبحتْ ممارسة شائعة بشكلٍ متزايد. ينعكس هذا -على سبيل المثال- في الطبعات الأخيرة لمختارات من الأدب العالمي صادرة عن نورتون (2012) ولونجمان (2004)، وكلاهما يستهلّ المجموعة بمقتطفات من القرآن مع مقدّمات عامة وحتمًا روتينية عن تاريخ النصّ وأهميته في تنمية الفكر الإسلامي. وإذا كان استبعاد القرآن من مثل هذه المختارات سيجعلها تبدو ضيقة الأفق، إلا أنه بدون السياقات التاريخية والتفسيرية الأكبر التي تحيط بالتركيب النصّي للقرآن، فإن القراءة (الأدبية)، لا سيما المقارنة، تخاطر بتسطيح التعقيدات العميقة التي تشكّل علاقة القرآن بالبيئة الدينية والطائفية في العصور القديمة المتأخرة، بالإضافة للاستقبال التاريخي بين المسلمين وغير المسلمين على حَدّ سواء.
التحدّي الآخر الذي يواجه عملية المقارنة هو أنها يمكن أن تتحوّل بسرعة إلى ممارسة تقييمية. هذه مشكلة تدركها تير بورخ جيدًا وتحتاج إلى الكثير من الجهد لتجنّبها. ومع ذلك، فقد صاغت بنية المجموعة نفسها بناءً على تدخُّل تفسيري روّج له المستشرقون منذ فترة طويلة في القرآن. وأحد المصادر المهمّة خاصّة لتير بورخ في عمليتها لتخيّر المقاطع ومقابلتها هو كتاب يوهان ديتريتش ثين (الكتاب المقدس والقرآن: ملخص للتقاليد الشائعة) 1989، والذي يقابل إجمالًا القرآن مع مواد الكتاب المقدّس بشمولية أكبر. كما توضح مقدّمة ثين، فإنّ مثل هذه الممارسة تهدف لإثبات أنّ القرآن اشتقاق منقوص من الكتاب المقدّس، وهو درس يشعر أنه سيكون مفيدًا بشكلٍ خاصّ للمعلمين والقساوسة والكهنة، من بين آخرين (ص: xvi–xvii). وثين يكتب بوضوح في إطار لاهوتي بروتستانتي، متصوّرًا عملية لجأ فيها محمد -الذي يُعرّفه على أنه مؤلِّف القرآن- إلى الاقتراض من النصوص الكتابية (zuAnleihen bei biblischen Texten gegriffen) لأجل أن يعزّز مصداقية رسالته بين اليهود والمسيحيين (ص: xx). هذه الاستنتاجات مستمدة من أسلوب النقد التاريخي (historisch Kritik) الذي يقاومه المسلمون بجدارة كما يرى ثين. وقد تم وضع مجموعة ثين للكشف -من خلال قوة المجاورة الإجمالية- عن الطبيعة المشتقة والشَّظوية للقرآن.[14]
هناك جينالوجي مطوّل لهذا الشكل المعيّن من التدخل، والذي غالبًا ما يسعى في فورة المعرفة اللغوية إلى تسليط الضوء ليس فقط على اعتماد القرآن على المصادر اليهودية والمسيحية، ولكن أيضًا لفضح فهم القرآن غير الكامل لتلك المواد الأصلية، وهو قصور يُنسب عادة إلى محمد مباشرة. يمكن تتبّع مثل هذا التيار في النقد التاريخي الألماني على مدار قرن، مع الدراسة الرائدة لأبراهام جايجر (1833) من ناحية، ودراسة هاينريش شباير (1937 [1931]) من ناحية أخرى. إنّ فكرة استعارة النصوص وسرقتها لا تزال حاضرة إلى حدّ كبير حتى يومنا هذا في تكاثر المطبوعات الرائجة التي تسعى إلى الكشف عن اعتماد القرآن القاصر على المواد اليهودية والمسيحية[15].
ومع ذلك، وعلى الجانب الآخر، فإنّ المشكلة في عدم الانخراط بشكلٍ مباشر في العلاقة الجدلية العميقة التي أظهرها القرآن بوضوح مع مجموع النصوص الموجودة مسبقًا في العصور القديمة المتأخرة، هي أنه، كما أكّدت أنجيليكا نويفرت (2007) يخاطر بفصل النصّ، بل وإضفاء الصبغة الحصرية الشرقية عليه باعتباره انعزاليًّا أجنبيًّا غير قابل للدمج. على المستوى الأكاديمي، لا يزال مجال الدراسات القرآنية يتصارع إلى حدّ كبير مع قضايا تكوين القرآن وعلاقته بالوسط الكتابي الأكبر في الشرق الأدنى. وقد عالجتْ مجموعة متنوّعة من المطبوعات في السنوات الأخيرة هذه الأسئلة بشكلٍ مباشر وغالبًا بطرق مثيرة ومبتكَرة إلى حدّ كبير. وينعكس هذا بشكل ملحوظ في الدراسات والأطروحات الكاملة، مثل دراسات جابرييل رينولدز (2010)، وعمران البدوي (2011)، وجوزيف ويتزتم (2011)، وفي المجلدات المحرّرة لأمثال جون ريفز (2003)[16]، وجابرييل رينولدز (2008، 2011)، وتيلمان ناجل (2010)، وأنجيليكا نويفرت وآخرين (2010). هذا الحقل العلمي المتنامي يسعى بمزيد من الدقّة النظرية لاستقصاء الأساليب المتنوعة التي انخرط بها القرآن في حوار مع مجموعة واسعة من مواد المصدر. وقد خلت هذه المناقشات إلى حدّ كبير من لغة الاقتراض والسرقة؛ تم استبدالها بشكلٍ منعش بالتركيز على المجتمعات التاريخية المضمنة في النصّ القرآني ونقاط الاتصال النصية التي تجمعها معًا وتفصل بينها. وغالبًا ما يتماشى مع هذا المنهج التركيز على التناص القرآني والإحالة الذاتية المنتشرة في بيئة طائفية أوسع. إنّ الاهتمام بالشكلِ العام للقرآن هو أيضًا سمة بارزة لهذه المجموعة العلمية الناشئة، لا سيّما فيما يتعلق بالنصوص الدينية اليهودية والمسيحية في تلك الفترة والأنماط المتنوّعة لنقل النصوص بين المجتمعات الدينية.
كذلك سعى هذا العمل في كثير منه لتجنُّب المصادر التفسيرية الكلاسيكية للمرجعيات الدينية الإسلامية في محاولة لفهم السياق التاريخي للقرآن بشكلٍ أفضل وترابطاته العميقة مع المجتمعات الطائفية المتنوّعة في تلك الفترة. وقد طفَت على السطح جوقة متنامية في مجال النصّ القرآني تشكّك في صحة قراءة القرآن من خلال المرجعيات الإسلامية الأصلية -المواد التي تشكّلت بالضرورة من خلال تاريخ خلاص إسلامي معيّن- منذ النقد الثاقب الذي وجّهه جون وانسبرو (1977)[17]. تجد هذه الشكوك صدًى في العديد من الدراسات الحديثة حول السياق التاريخي للقرآن. وغالبًا ما تكون هذه الملاحظات مصحوبة بالرثاء على حال مجال الدراسات القرآنية الذي يتراجع منهجيًّا ونظريًّا عند مقارنته بالتقدّم المُحرَز في الدراسات اللاهوتية الأخرى؛ ولذلك تشترط غالبًا الكفاءة في لغات ومصادر العصور القديمة المتأخّرة، عادةً العبرية والسريانية، كمتطلبات لدراسة القرآن بشكلٍ صحيح. وبالمثل، فإنّ الكثير من هذا العمل الأخير، والذي من المؤكّد أنه ليس متجانسًا بأيّ حال من الأحوال، قد قدّم مقاربة أدبية لدراسة القرآن، بطريقة النقد الأعلى، كشكل من أشكال التحديد الصحيح للتكوين التاريخي للنصّ.
ومثل معظم الأُطر المنهجية، فهناك فوائد وكذلك قيود على النقد النصّي. من حيث اتخاذه أساسًا للمعرفة الاستدلالية يمكن أن يعاني هذا التيار من التحليل الأدبي في عزلته الخاصّة من درجة معيّنة من الدوران في حلقة فكرية مفرغة. على مستوى النقد العالي، من الجدير بالملاحظة تلك الفرضيات المتباينة غالبًا على نطاق واسع والتي يتم التوصّل إليها باستخدام مثل تلك الأساليب، سيّما مع اختلاف وجهات النظر فيما يتعلّق بتكوين القرآن في سياقه (سياقاته) الطائفي الأصلي للاستقبال. على مستوى النقد الأدنى، يمتد هذا أيضًا إلى النتائج المتضاربة في كثير من الأحيان المتولّدة عن الحجج الخاصّة بتحرير النصّ.
في كثير من الأحيان تقوم مثل هذه التدخلات التفسيرية على تنصُّل كامل من تقاليد التفسير الكلاسيكي. ومن هنا كان استبعاد المتون التفسيرية أساسًا لكثير من الأشكال الراديكالية للاتجاه التاريخي التنقيحي؛ لذلك فالشّكوك العميقة وأحيانًا الزائدة التي تؤثّر على المصادر التفسيرية الإسلامية تستحقّ مزيدًا من الدراسة. وثمة تيار قوي في مجال نقد الحديث، يمثّله علماء مثل هارالد موتسكي، وجي إتش آي يونبول، وغريغور شولر الذي سعى إلى تأريخ تداول وجمع الكلام النبوي بشكلٍ مباشر في بداية القرن الثاني من حقبة الإسلام. وبالمثل، فإنّ الدراسات المخطوطة التي أجراها فرانسوا ديروش (2009) وبهنام صادقي وآخرون (2010، 2012)؛ تؤرّخ لأقدم مخطوطات القرآن الباقية حتى قبل ذلك. وتجدر الإشارة إلى أنه -من بين أمور أخرى- غالبًا ما تنقلب البيانات المنسوبة إلى النبي ومجتمع السَّلَف بشكل مباشر إلى قضايا تفسير الكتاب المقدّس.
النقطة المهمّة هي أنه في حين أنّ نصوص الحديث في أقدم أشكاله المتغيرة والمتباينة وغير المتجانسة قد تأخّرت بلا شك عن تأريخ القرآن، فإنّ الهوّة التاريخية التي تفصل بين الاثنين ربما لا تكون واسعة بحيث تبرّر التبرؤ الكامل من أحدهما لمصلحة الآخر، على الأقلّ ليس بدون سبب منهجي متّسق داخليًّا للقيام بذلك. ولا يعني هذا أنّ القرآن يجب أن يُقرأ فقط من خلال مفسّريه المتأخّرين، الخاضعين بالكامل للتاريخ الملحمي لأدب السيرة والمغازي عن حياة محمد ومجتمع السَّلَف. نعم، يرتبط التقليد التفسيري التكويني للقرن الثاني/ الثامن ارتباطًا وثيقًا بمواد الحديث المبكّرة في تاريخ النبيّ ومجتمع المؤمنين الأوائل. لكنها أيضًا تستثمر بعمق في استعادة المعنى على المستوى الأساسي للدلالة النحوية والمعجمية للقرآن. ولا يتشارك مجال الدراسات الكتابية أيّ توازٍ مباشر مع طبيعة المصادر التفسيرية المبكّرة للقرآن، من حيث القرب التاريخي لهذه المواد من النصّ. وفي حين يؤثر تاريخ الخلاص قطعًا على قدرٍ كبيرٍ من هذه المادة، إلا أنه ليس كلّ ما تحشده هذه المصادر يهدف لخدمة حجّة لاهوتية أو تاريخية؛ إِذْ قبل كلّ شيء، المصادر ليست متجانسة الوحدة، وتركّز الكثير من المتون التفسيرية التكوينية على قضايا أساسية متعلّقة بالفهم الحرفي. كما أنّ هناك وعيًا عميقًا بالمصادر اليهودية والمسيحية ملموسًا في كافة التقاليد التفسيرية المبكّرة، سواء في أشكالها النصّية أو الشفوية، وهو الإرث الذي أظهره باستمرار علماء مثل وليد صالح (2008)، وسيدني جريفيث (2013)، في تشكيل تطوّر التاريخ الفكري الإسلامي. ولا مراء في أنّ النقاط التفسيرية المبكّرة للتواصل مع مواد الكتاب المقدّس وغيرها توفّر أرضًا خصبة لفحص مجموعة من المواد الدينية المتداولة في أواخر العصور القديمة.
على الرغم من القوّة الواضحة للتقاليد التفسيرية، هناك بالفعل مواد قرآنية لم تعيها المرجعيات الدينية المبكّرة على وجهها أو أخفقتْ بجلاء في تحصيل إجماعٍ تفسيري عليها. على سبيل المثال، الحروف المقطّعة الغامضة التي تتصدّر عدّة سور، ودلالة كلمات وعبارات معيّنة، وإشارات مختلفة إلى نصوص وموضوعات الكتاب المقدّس وخارج الكتاب المقدّس. ومن ثم كثيرًا ما أُثير الاعتراض على أنّ هذا المأزق التفسيري يعكس انقطاعًا تاريخيًّا بين النصّ القرآني والتقليد التفسيري اللاحق، وهذا الانقطاع يبدو مقنعًا إلى حدّ ما، سيّما إذا تخيّلنا أنّ نَشْر القرآن شفهيًّا ونصيًّا في شكله قبل المعتمد كان من الممكن أن يتفوّق بسهولة على المتون التفسيرية الأولى التي سعَتْ للتحكّم في توجيه معناه. ويمكن كذلك أن تعكس تلك المناطق العمياء لدرجةٍ ما أنّ ما هو واضح أو مهم في جيل واحد قد لا يعود كذلك في الجيل التالي. ومع ذلك، فإنّ حقيقة أنّ الانقطاعات التفسيرية لا تعدو إلا جزءًا صغيرًا من المتون التفسيرية هي بلا شكّ تستحقّ التأمّل[18].
ولعلّنا نتساءل كذلك عن المدى الذي يجب أن تحاكي فيه الدراسات القرآنية مناهج ونظريات الكتاب المقدّس؛ لأنه بينما تتداخل المدونات بطرق مهمّة وواضحة، هناك اختلافات ذات مغزى في التواريخ الفعلية المحيطة بالنصوص والمجتمعات التفسيرية الخاصّة بكلّ منها، ولا تقف هذه الاختلافات عند حدود أواخر العصور القديمة، بل تمتد إلى حركات الإصلاح اليهودية والمسيحية اللاحقة، كما أنها تنعكس في السلطة المعرفية للاستشراق التي استخدمت النقد التاريخي لأهداف جدلية إلى حدّ ما. وكما وضح (ويليام جراهام) باقتدار (1987)، يمكن أن تنتج أوجه قصور عميقة جراء تصدير الكتاب المقدّس باعتباره القاعدة الأساسية والافتراضية للدراسة اللاهوتية المقارنة.
لا يعني ما سبق أننا ينبغي أنْ نُوَلِّي ظهورنا للقراءة الفاحصة للنصّ القرآني، أو سياقه التاريخي، أو سياق محيطه الديني الأوسع. بل في الواقع، ومن نواحٍ عديدة، أدى هذا التحليل الأدبي إلى إثراء مجال الدراسات القرآنية وساعد في تعضيد صدارة القرآن ضمن الأُطر والافتراضات الحالية التي تحكم المرجعيات العلمية. ومع ذلك، فإن هذا النهج يخاطر أيضًا بتعزيز وَهْم إمكان وجود عملية هرمنيوطيقية مباشرة وفورية مستقلّة عن مساعدة أصوات تفسيرية. يجب أن تتوقّف الأسس البروتستانتية لمثل هذه المبادرات، خاصّة في الخطابات التي تهدف إلى تنمية الشرعية من خلال خلق انطباع الغموض اللغوي. عادةً ما يتم تقديم قوّة النقد التاريخي في معارضة مباشرة لما يتم تكوينه بالضرورة كتقليد تفسيري واهنٍ فكريًّا وغير جدير بالثقة من الناحية اللاهوتية. مما لا شك فيه أنّ هناك الكثير الذي يمكن اكتسابه من خلال المطالعة المتأنية لتكوين القرآن في ضوء فهمنا المتنامي للتاريخ الإسلامي المبكّر والتقاليد الدينية في أواخر العصور القديمة المتأخّرة. ومع ذلك، فبالانتقال إلى ما وراء الانكباب على مسألة مضمحلة في أصول التاريخ الإسلامي، يمكن أن يُعْنَى منعطف أدبي ما بشكلٍ مباشر ومنعكس ذاتيًّا بالأُطُر التفسيرية الحالية التي تشكّل الدراسة النقدية التاريخية للقرآن. ورغم أنها ربما تكون حقيقة واضحة إلى حدّ ما، لكن لعلّه من الجدير بالذِّكْر أنه حتى التدخلات العلمية هي تدخلات تفسيرية لا تقلّ عن غيرها تجذّرًا في تواريخ ودوافع أخلاقية معيّنة. فكما أنه لا نصّ بدون مترجِمين، لا مترجم بدون سياق. وبما أنّ السلطة التفسيرية يمكن بالتأكيد أن تبني على الأجيال السابقة، فإنها غالبًا تستثمر في إزاحة سلطة الآخرين. وإذا كان هذا النشاز في الأصوات والأساليب غالبًا ما يكون مدعاة -للأسف- في تقييمات الحالة الراهنة للمجال من جهة، فإنه يعكس بشكلٍ عجيب من جهة أخرى عدم تجانس المادة التفسيرية الكلاسيكية، والتي جاهدت أيضًا بطرق متنوّعة -وغالبًا إبداعية- لإتقان فهم معنى القرآن.
[1] العنوان الأصلي للمادة:
Quranic Studies and the Literary Turn، والمقالة منشورة في Journal of the American Oriental Society في عام 2015.
[2] ترجم المقالة: هدى عبد الرحمن النمر، كاتبة ومترجِمة، لها عدد من الأعمال المطبوعة.
[3] أضفنا عنوانًا فرعيًّا لعنوان المقالة، وهو: (قراءة في أهم الدراسات الأدبية الغربية للقرآن)، وهذا من أجل جعل العنوان أكثر تعبيرًا عن اشتغال الكاتب في مقالته. (قسم الترجمات).
[4] تيودور نولدكه، Theodor Nöldeke ـ(1836- 1930): شيخ المستشرقين الألمان كما يصفه عبد الرحمن بدوي، درس عددًا من اللغات الساميّة: العربية، والعبرية، والسيريانية، وآرامية الكتاب المقدّس، ثم درس -وهو طالب في الجامعة- الفارسية والتركية، وفي العشرين من عمره حصل على الدكتوراه عن دراسته حول «تاريخ القرآن»، وهي الدراسة التي قضى عمره في تطويرها، وقد صدر الجزء الأول من «تاريخ القرآن» في 1909، وعمل عليه مع نولدكه تلميذه شفالي، ثم صدر الجزء الثاني عن تحرير تلميذه فيشر عام 1920، وصدر الجزء الثالث عام 1937 عبر تحرير تلميذه برجستراسر ثم برتزل. كذلك درس نولدكه «المشنا» وتفاسير الكتاب المقدّس أثناء عمله معيدًا في جامعة جيتنجن، له إلى جانب كتابه الشهير «تاريخ القرآن» كتبٌ حول اللغات الساميّة، منها: «في نحو العربية الفصحى»، و«أبحاث عن علم اللغات الساميّة»، عمل أستاذًا في جامعة كيل ثم جامعة اشتراسبورج، كتابه «تاريخ القرآن» مترجم للعربية، حيث ترجمه: جورج تامر، وصدر عن منشورات الجمل، بيروت، 2004. (قسم الترجمات).
[5] جولدتسيهر، Ignác Goldziher ـ(1850- 1921): مستشرق مجَريّ يهودي، تلقَّى تعليمه في جامعة بودابست ثم برلين ثم ليبستك، وفي عام 1870 حصل جولدتسيهر على الدكتوراه الأولى، وكانت عن تنخوم أورشلي أحد شرّاح التوراة في العصور الوسطى، وعيّن أستاذًا مساعدًا في عام 1872، وبعد رحلة دراسية برعاية وزارة المعارف المجَرية في فيينّا ثم ليدن ثم في القاهرة (حيث حضر بعض الدروس في الأزهر) وسوريا وفلسطين، وفي عام 1894 عيّن أستاذًا للغات السامية بجامعة بودابست.
له عددٌ كبيرٌ من الآثار، أشهرها "Vorlesungen über den Islam"، (العقيدة والشريعة في الإسلام، تاريخ التطور العقدي والتشريع في الدين الإسلامي)، وSchools of Koranic Commentators، (مذاهب التفسير الإسلامي)، والكتابان مترجمان للعربية؛ فالأول ترجمه وعلّق عليه: محمد يوسف موسى، وعليّ حسن عبد القادر، وعبد العزيز عبد الحق، وقد طُبع أكثر من طبعة، آخرها طبعة صادرة عن الهيئة العامة للكتاب، القاهرة، 2013، بتقديم محمد عوني عبد الرؤوف. والثاني كذلك مترجم، ترجمه: عبد الحليم النجار، وصدر في طبعة جديدة عن الهيئة العامة للكتاب، القاهرة، 2013، بتقديم محمد عوني عبد الرؤوف، وله كتاب مهم عن الفقه بعنوان: (The Ẓāhirīs: Their Doctrine and Their History : a Contribution to the History of Islamic Theology) (الظاهرية: مذهبهم وتاريخهم) وهو أول بحوثه المهمّة حول الإسلام حيث صدر في 1884، كذلك فقد ترجمت يومياته مؤخرًا، ترجمها: محمد عوني عبد الرؤوف، وعبد الحميد مرزوق، وصدرت عن المركز القومي للترجمة، القاهرة، 2016، ونظنّ أن في هذه اليوميات فائدة كبيرة لفهم الكثير من أبعاد فكر جولدتسيهر ورؤيته للإسلام ودافع دراسته له ولمساحات الاشتغال التي اختارها في العمل عليه. (قسم الترجمات).
[6] مونتجمري وات، W. Montgomery Watt ـ(1909- 2006): كاهن إنجليكاني ومستشرق بريطاني، أستاذ الدراسات العربية والإسلامية بجامعة إدنبرة بإسكتلندا إلى تقاعده عام 1979، من أهم المستشرقين المعاصرين في مجال تاريخ الدعوة والسيرة النبوية، ومن أشهر كتبه في السيرة: محمد في مكة (1953)، محمد في المدينة (1956)، والإسلام واندماج المجتمع (1998). والثلاثة مترجَمة للعربية؛ فقد ترجم الأول عبد الرحمن الشيخ، وصدر عن الهيئة العامة للكتاب عام 1994. وترجم الثاني شعبان بركات، منشورات المكتبة العصرية، ببيروت، 1985. وترجم الثالث عليّ عباس مراد، وصدر عن المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، ط1، 2009، وكذلك ترجم كتابه: « Muslim- Christian Encounters: Perceptions and Misperceptions,1991»، بعنوان: «الإسلام والمسيحية في العالم المعاصر»، ترجمه: عبد الرحمن الشيخ، وصدر عن الهيئة العامة للكتاب عام 1998، كما ترجم مؤخرًا كتابه: «The influence of Islam on Medieval Europe، 1972»، بعنوان: «تأثير الإسلام في أوروبا في القرون الوسطى»، ترجمه: سارة إبراهيم الذيب، جسور للترجمة والنشر، بيروت، ط1، 2016.
[7] نيل روبنسون Neal Robinson ـ(1948-): أستاذ الدراسات الإسلامية بجامعة ليدز، من أشهر أعلام الاتجاه السانكروني (التزامني) في قراءة القرآن.
ومن أشهر كتبه في هذا السياق كتاب: Discovering the Qur'an: A Contemporary Approach to a Veiled Text، اكتشاف القرآن، قراءة معاصرة لنصّ مقنع، 1996.
والذي درس فيه تركيب عدد من السور القرآنية المكية والمدنية، كما حاول فيه التأسيس نظريًّا لفكرة القراءة التزامنية للنصّ، والحِجَاج حولها.
له أيضًا عدد من الكتب حول الإسلام منها: Christ in Islam and Christianity-المسيح بين الإسلام والمسيحية، 1990.
Islam, a Concise Introduction- الإسلام مقدمة موجزة، 1999.
وقد ترجمنا له دراسته: بنية وتفسير سورة المؤمنون، ترجمة: أمنية أبو بكر، يمكن مطالعتها ضمن ملف الاتجاه التزامني في قراءة القرآن ضمن قسم الاستشراق على موقع تفسير. (قسم الترجمات).
[8] أنجيليكا نويفرت Angelika Neuwirth ـ(1943-...): من أشهر الباحثين الألمان والأوروبيين المعاصرين في الدراسات القرآنية والإسلامية.
أستاذ الدراسات الساميّة والعربية في جامعة برلين الحرّة، درسَت الدراسات الساميّة والعربية والفيلولوجي في جامعات برلين وميونيخ وطهران، عملَت كأستاذ ومحاضر في عدد من الجامعات؛ مثل برلين وميونيخ وبامبرغ، كما عملت كأستاذة زائرة في بعض الجامعات؛ مثل جامعة عمّان بالأردن وجامعة عين شمس بالقاهرة.
ترأست مشروع «كوربس كورانيكوم» منذ 2007 إلى 2010.
ولها عدد من الكتابات والدراسات المهمّة في مجال القرآن ودراساته؛ من أهمها:
Der Koran als Text der Spätantike: Ein europäischer Zugang, 2010.
القرآن كنصّ من العصور القديمة المتأخرة، مقاربة أوروبية.
وقد ترجم للإنجليزية فصدر بعنوان:
The Qur'an and Late Antiquity: A Shared Heritage, 2019.
Studien zur Komposition der mekkanischen Suren, 1981.
دراسات حول تركيب السور المكية. (قسم الترجمات).
[9] هذا النمط من التحليل الغربي للقرآن والذي يفترض وجود حالة للقرآن لم يكن فيها ذا سُلطة ومرجعية هو نمط لا يتوافق مع الرؤية الإسلامية؛ فالقرآن وفق الرؤية الإسلامية لم يكن نصًّا بغير مرجعية وسلطة ثم صار بعد ذلك، وهو كذلك نمط تحليل مشكل داخل الدراسات الغربية ذاتها، فقضية تَشَكُّل النصّ القرآني كنصّ ذي مرجعية وسُلطة، وما يتعلق بها من قضايا جمع النصّ وتدوينه وتحريره، تشهد اختلافًا كبيرًا في الدرس الاستشراقي المعاصر، وفي هذا السياق قَدّم بعض المستشرقين المعاصرين أمثال نويفرت وآن سيلفي بواليفو ونيكولاي سيناي وغيرهم محاولات لضبط المصطلحات المتداولة غربيًّا في دراسة تاريخ النصّ القرآني، وارتأى البعض وبعد التحليل الداخلي للنصّ القرآني بشكلٍ تزامني (سانكروني) وتعاقبي (دياكروني) كون عملية تحويل القرآن لنصّ ذي سلطة ومرجعية هي مسألة مختلفة عن عملية الجمع والتدوين اللاحق على النصّ، حيث إنّ لها حضورًا داخل النصّ القرآني نفسه متجذّرًا في مفاهيمه عن ذاته في أبكر مراحله، في هذا السياق يمكن مراجعة بعض الدراسات مثل: حديث القرآن عن القرآن في السور المكية الأولى، آن سيلفي بواليفو، ترجمة: مصطفى أعسو؛ القرآن والتاريخ، علاقة جدلية، أنجيليكا نويفرت، ترجمة: إسلام أحمد. (قسم الترجمات).
[10] ميشيل كويبرس (Michel Cuypers): ميشيل كويبرس هو رجل دين كاثوليكي، من أتباع شارل دو فوكو، عاش في مصر منذ العام 1989 كعضو في المعهد الدومينيكي للدراسات الشرقية (IDEO)، وتخصّص في الدراسة الأدبية للنصّ القرآني، لا سيما فيما يتعلّق بتركيبه وبعلاقاته النصية مع الأدب المقدّس المتقدِّم تاريخيًّا.
من أهم أعماله:
• La Composition du Caran. Nazm al- Qur’ân, Paris, Gabalda, 2012.
«في نظم القرآن»، وهو مترجم للعربية، ترجمه: عدنان المقراني وطارق منزو، وصدر عن دار المشرق، لبنان، 2018.
• Le Festin, une lecture de la sourate al- Mâ’ida, Lethielleux, 2007.
«في نظم سورة المائدة: نظم آي القرآن في ضوء منهج التحليل البلاغي»، وهو مترجم للعربية، ترجمه: عمرو عبد العاطي صالح، وصدر عن دار المشرق عام 2016.
وقد ترجمنا له على موقع تفسير عددًا من الترجمات:
- مقارنة بين التحليل البلاغي والنقد التاريخي لجون وانسبرو وغونتر لولينغ، ترجمة: خليل محمود، ضمن ملف علاقة القرآن بالكتب السابقة.
- البلاغة السامية، ترجمة: خليل محمود.
- الكتاب المقدّس والإسلام، نسق أدبي واحد، ترجمة: عبير عادل. والترجمتان الأخيرتان ضمن ملف الاتجاه التزامني في قراءة القرآن. (قسم الترجمات).
[11] تأتي أمثال هذه الفرضيات في ضوء الطّرْح الغربي الاستشراقي الذي لا يرى القرآن الكريم كتابًا سماويًّا نزل من عند الله تعالى، وكذلك لا يرى أنه لم يتدخل أحد في نصّ القرآن بالحذف والإضافة بأيّ شكل من الأشكال، وهي فرضيات تخالف الرؤية الإسلامية للقرآن. (قسم الترجمات).
[12] راجع: أشكال الفَهْم الأكاديميّ المعاصِر لتماسُك النصّ القرآنيّ، أندرو ريبين، ترجمة: إسلام أحمد، منشورة ضمن الترجمات المنوّعة على قسم الاستشراق بموقع تفسير. (قسم الترجمات).
[13] أندرو ريبين Andrew Rippin (1950- 2016): هو باحث كندي من أصل بريطاني، وُلد في لندن، وقد عمل كباحث زميل في معهد الدراسات الإسماعيلية بلندن، منذ عام 2013م، قبل وفاته في 2016م، واهتمامه الرئيس يتعلّق بدراسة الإسلام المبكّر، ودراسة تفسير القرآن في العصور الكلاسيكية، له عدد من المؤلفات التي قام بتأليفها أو المشاركة في إعدادها، مثل:
Guide to Islam, co- authored with David Ede, Leonard Librande, Donald P. Little, Richard Timmis, and Jan Weryho, Boston 1983.
دليل إلى الإسلام، مع ديفيد إيدي ليونارد ودونالد ليتل ريتشارد.
كما حرر كتابًا مهمًّا بعنوان:
Approaches to the history of the interpretation of the Qurʾān (ed.), Oxford 1988.
«مقاربات في تاريخ تفسير القرآن».
وهو كذلك محرر الدليل المهم:
Blackwell companion to the Qurʾan (ed.), Oxford 2006.
(قسم الترجمات).
[14] جدير بالذِّكْر أنّ هذه الرؤى إزاء القرآن الكريم ونَظْمِه والتي تشيع بصورة كبيرة في الكتابات الاستشراقية الكلاسيكية منذ نولدكه، يرفضها بعض المستشرقين المعاصرين الذين يستلهمون المناهج الأدبية والكتابية في دراسة القرآن، والمعتنين بمسألة نَظْم النصّ القرآني والبحث عن بنيته وتركيبه الخاصّ، من أمثال ميشيل كويبرس وغيره، فقد عَرَض هؤلاء بعض وجهات نظر مغايرة مفادها أنّ القرآنَ مُتَّسِقُ النَّظْم وليس متشظيًا كما يذكر المستشرقون من أرباب المنهج التاريخي النقدي، وأن له بنية تركيبية متماسكة تتضح في الترابط القواعدي والأسلوبي، راجع في هذا: ملف الاتجاه التزامني، ضمن ملفات قسم الترجمات بموقع تفسير. (قسم الترجمات).
[15] هذا التَوجُّه الذي دَأَب عليه مستشرقون كُثُر في التعامل مع القرآن وعلاقته بالنصوص السابقة عليه هو تَوجُّه يقوم على تجاهل الطريقة التي يتعامل بها القرآن مع النصوص السابقة عليه وكيفيات استعماله وتوظيفه لها، وهي العلاقة المهِمَّة في استكشاف البناء الخاصّ للقرآن، لذا فقد اهتم الكثير من المستشرقين المعاصرين بمحاولة طرح رؤى أكثر تركيبًا بين القرآن وبين الكتب والمدونات الدينية السابقة، هدفها استكشاف هذا البناء الخاصّ للخروج من اختزالية رؤية الاستعارة والنقل. يراجع مثلًا ضمن ملف (القرآن وعلاقته بالكتب السابقة): المسيحية في القرآن؛ تعدّد مظاهر البيان القرآني إزاء عرض المسيحية، جبريل رينولدز، ترجمة: مصطفى الفقي؛ بعض المظاهر شبه الكتابية في قصة هاروت وماروت، جون سي ريفز، ترجمة: مصطفى الفقي؛ عيسى ومريم في القرآن، موازنة الآباء التوراتيين، أنجيليكا نويفرت، ترجمة: حسام صبري. (قسم الترجمات).
[16] جون سي. ريفز: أستاذ الدراسات الدينية بجامعة نورث كالورينا، تتركّز اهتماماته في النصوص الدينية في الشرق الأدنى، وتاريخ الديانات الثنوية القديمة، والتقاليد الدينية الوسيطة.
من أشهر كتبه في هذا السياق:
Enoch from Antiquity to the Middle Ages: Sources from Judaism, Christianity, and Islam,2018
أخنوخ من العصور القديمة إلى العصور الوسطى؛ مصادر من اليهودية والمسيحية والإسلام.
Prolegomena to a History of Islamicate Manichaeism,2012
مدخل إلى تاريخ أسلمة المانوية.
ومنشور له على موقع تفسير، دراسته: بعض المظاهر (شبه الكتابية) في قصة هاروت وماروت، ترجمة: مصطفى الفقي، يمكن مطالعتها ضمن ملف العلاقة بين القرآن والكتب السابقة. (قسم الترجمات).
[17] عقدنا ملفًّا في قسم الترجمات حول الاتجاه التنقيحي يناقش فرضيات التنقيحيين منذ كتاب وانسبرو من وجهات نظر مختلفة، يمكن مطالعته على موقع تفسير. (قسم الترجمات).
[18] فهم النصّ وتفسيره هو مسألة عُرْضة بطبيعتها لوقوع الاختلاف وتعدّد الآراء وتباينها؛ ومن ثم فإن وجود خلافات تفسيرية بين المفسِّرين إزاء بعض معاني القرآن هو أمر متوقّع جدًّا، لذلك فهذا لا يتعلق بالانقطاع بين النصّ القرآني والتفسير اللاحق كما يذكر المؤلِّف، خصوصًا مع تعرّف الدراسات الغربية الحديثة نفسها على بعض التفاسير المبكّرة مثل تفسير مقاتل الذي حظي باهتمام عدد من الباحثين مثل أوري روبين وجوردون نيكل وغيرهما، وهو ما يشِفّ عن تقليد تفسيري متمايز عن النصّ المدركة قداسته ومرجعيته بالطبع، لكنه مبكّر كذلك. (قسم الترجمات).
كلمات مفتاحية
الكاتب:
مواضيع ذات صلة
((المعلومات والآراء المقدَّمة هي للكتّاب، ولا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع أو أسرة مركز تفسير))