قراءة في كتاب "المعنى القرآني: معالم الطريق إلى فقهه في سياق السورة؛ رؤية منهجية ومقاربة تأويلية"
قراءة في كتاب "المعنى القرآني: معالم الطريق إلى فقهه في سياق السورة؛ رؤية منهجية ومقاربة تأويلية"
الكاتب: محسن بن علي الشهري
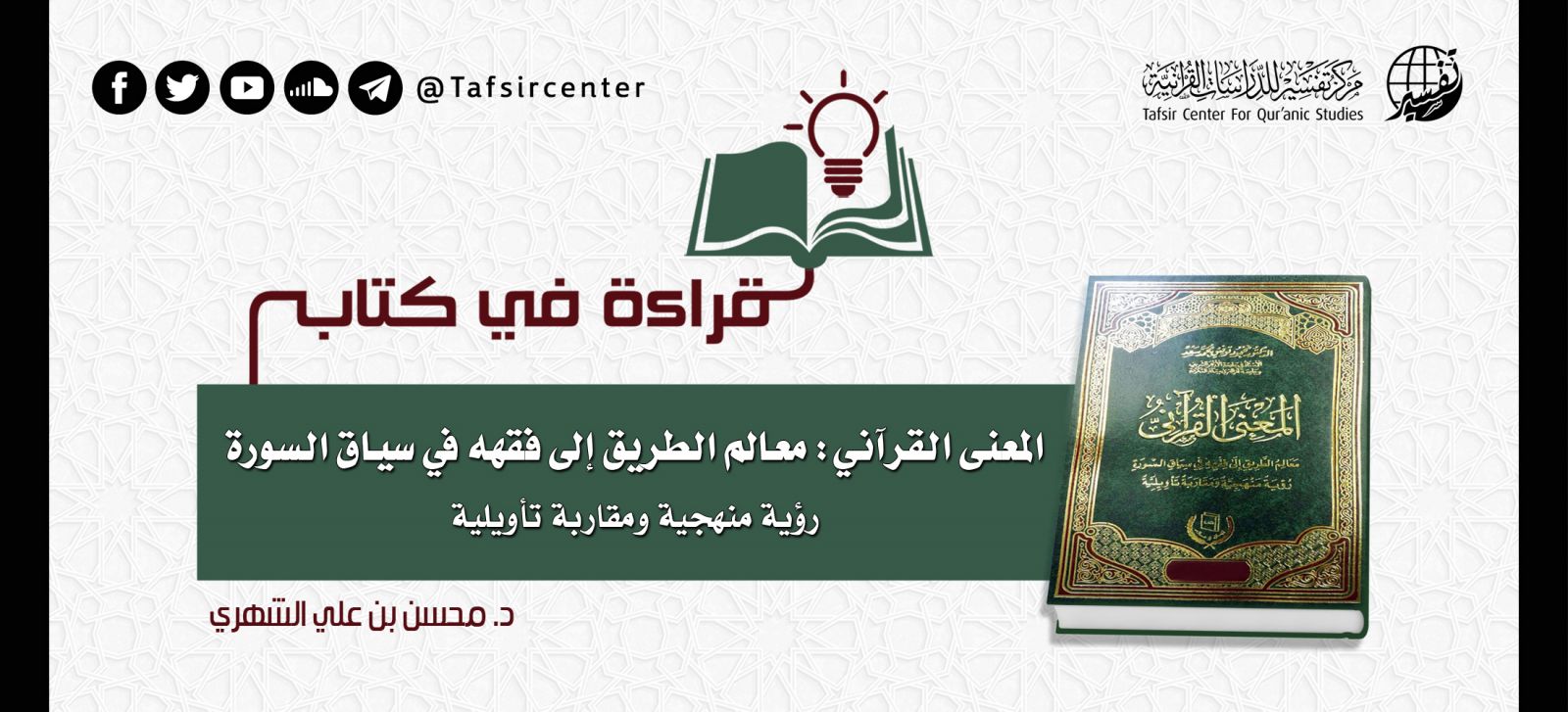
بيانات الكتاب:
عنوان الكتاب: المعنى القرآني: معالم الطريق إلى فقهه في سياق السورة؛ رؤية منهجية ومقاربة تأويلية.
اسم الكاتب: الدكتور/ محمود توفيق محمد سعد.
أجزاء الكتاب: 1.
عدد الصفحات: 536.
الناشر: مكتبة وهبة، القاهرة.
سنة النشر: 1442هـ/ 2021م.
رقم الطبعة: الأولى.
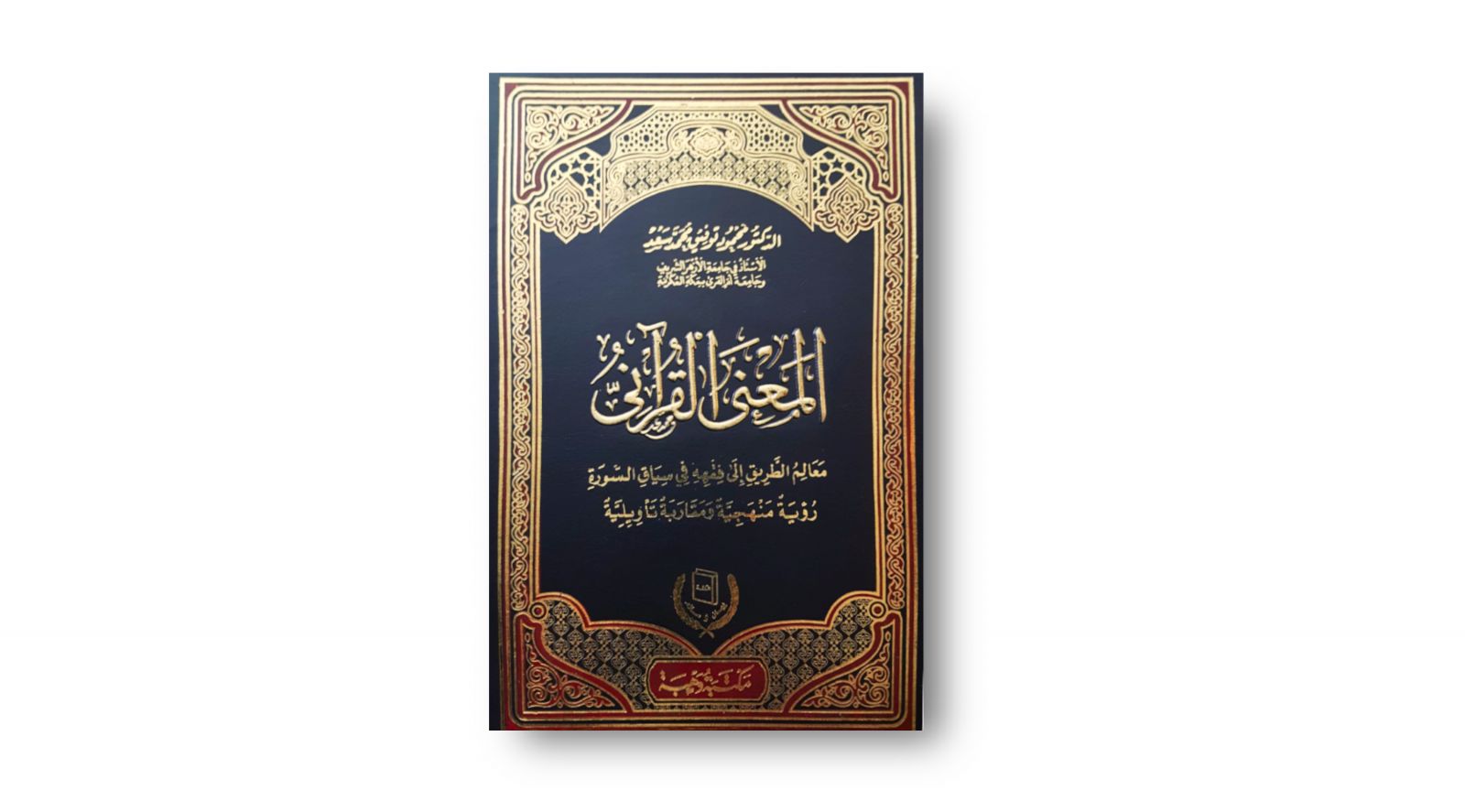
نبذة عن المؤلّف:
هو الدكتور/ محمود توفيق محمد سعد، أستاذ البلاغة والنقد في جامعة الأزهر الشريف، عضو هيئة كبار العلماء في مصر، وهو من طلاب الشيخ محمد محمد أبو موسى، دَرَّس في عددٍ من الجامعات العربية، أبرزها جامعة أم القرى في مكة المكرمة، له عديد من الكتب والمؤلفات والأبحاث العلمية، من أبرزها:
• الإمام البقاعي؛ جهاده ومنهاج تأويله بلاغة القرآن الكريم.
• دلالة الألفاظ عند الأصوليين؛ دراسة بيانية ناقدة.
• سبل الاستنباط من الكتاب والسُّنَّة؛ دراسة بيانية ناقدة.
• صورة الأمر والنهي في الذِّكْر الحكيم.
• قراءة في المثل السائر لابن الأثير.
• مسالك العطف بين الإنشاء والخبر.
• فقه بيان النبوّة؛ منهجًا وحركة.
• إشكالية الجمع بين الحقيقة والمجاز في ضوء البيان القرآني.
• الإغريض في الفرق بين الكناية والتعريض للتقيّ السبكي؛ تحقيق ودراسة.
• القول البلاغي في بديع القرآن؛ مراجعات منهجية.
• معالم التكليف والتثقيف في آيات الربا من سورة البقرة.
• إعجاز القرآن بالصّرفة؛ دراسة نقديّة.
• شذرات الذهب؛ دراسة عربية في البيان القرآني.
• نظرية النَّظْم وقراءة الشِّعْر عند عبد القاهر.
• أسرار البلاغة القرآنية في سورة تبت يدا أبي لهب.
• الرجال قوامون على النساء؛ مدارسات إيمانية أخلاقية في ضوء علم البلاغة العربي.
• الكلمة نور؛ محاورات منهجية في كتاب شرح أحاديث من صحيح مسلم لشيخنا محمد أبو موسى.
تمهيد:
تدبّر القرآن العظيم من أعظم المقاصد التي نزل بها؛ لما يترتّب عليه من الفهم والتعقّل والتذكّر، يقول تعالى: {كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ}[ص: 29]، ومن أجلّ طرقِ التدبّر إدراكُ وحدة النصّ القرآني المتمثّل في ترابط سوره وآياته، وهو أحد أبرز وجوه الإعجاز القرآني، وهو مطلبٌ بعيدُ الغور عميق الفهم عزيز الغاية، يحصل -بتوفيق من الله- لمن أطال التأمّل والتبصّر، وأعاد النّظر، وتثبّت وتروّى، وراقَب حركة المعنى؛ نموّه وامتداده، تفرّعه واشتباكه، وهذا من أخفى أبواب البلاغة وأغمضها، كما ذكر العلماء، وكذلك هي المعاني العزيزة لا تحصّل إلا بعد كَدٍّ ومعاناة؛ فالمحصّل بعد تعبٍ أعزّ من المنساق بلا طلب.
وقد عني أئمة التفسير بجلاء هذا الموضوع الذي يبين وجه الارتباط بين آيات السورة الواحدة، وبيان تناسب كلّ آية بسياقها في السورة، وهو ما يُعْرَف بعلم المناسبات، وصفه البقاعي (885هـ) بأنه: علمٌ تُعرف منه عِلل أجزاء القرآن[1]. أي إنه العلم الذي يبرز وجهَ ارتباط الآية بما قبلها وبما بعدها، وكيف جاءت هذه من تلك، وكيف تفرّعت الآيات من المعنى الأُمّ الذي انحدرت منه.
وإذا ما طالعنا المؤلّفات في هذا العلم الشريف فإنّنا نلامس بداياته في القرن السابع الهجري، مع الرازي (606هـ) في تفسيره (مفاتيح الغيب)، الذي تجلَّت فيه المناسبات تجليًا واضحًا، حيث ذكر المناسبة بين السورة وما قبلها وبين الآية وما قبلها، وكان صاحبَ نَفَس عميق في ذكره لأوجه المناسبة، يقول الرازي: «فما أحسن هذا الترتيب؛ لأن أكثر لطائف القرآن مُودَعة في الترتيبات والروابط»[2]. ولا ننفي المناسبات التي حضرت في التفاسير الأخرى، إلّا أنها لم تمثّل ظاهرة يُلتفت إليها، أمّا التصانيف التي خصّصت لدراسة المناسبات، فنجدها بدأت من كتاب: (البرهان في ترتيب سور القرآن) لأبي جعفر بن الزبير الغرناطي (708هـ)، الذي خصّصه لترتيب السور دون الآيات كما يظهر من العنوان، ثم جاء بعده برهان الدين البقاعي فكتب تفسيره الذي أَوْلَى المناسبات اهتمامًا كبيرًا أظهر فيه براعته في هذا العلم، تطرّق فيه للمناسبات بين السور والآيات، حتى أسماه: (نظم الدّرر في تناسب الآيات والسور)، وقد بَيّنَ أهمية هذا العلم وفوائده ومنزلته في مقدّمة كتابه، وللسيوطي جهود طيّبة في المناسبات؛ فقد خصّ هذا العلم في أكثر من كتاب، حيث ألّف كتابًا في التناسب سماه: (قطف الأزهار في كشف الأسرار)، واعتنى فيه بالمناسبات بين السور والآيات، واستقى من هذا الكتاب المناسبات بين السور فقط في كتابه: (تناسق الدّرر في تناسب السور)، وآخر مختصرًا في تناسب فواتح السور مع خواتمها سماه: (مراصد المطالع في تناسب المقاطع والمطالع).
ومن الجهود الحديثة البارزة في هذا الشأن كتاب: (دلائل النظام) لعبد الحميد الفراهي (1349هـ)، وكتاب: (النبأ العظيم) للدكتور محمد عبد الله دراز (1377هـ)، وما كتبه الدكتور محمد محمد أبو موسى في تفسيره لسور آل حم، وكذلك الدكتور إبراهيم الهدهد في كتابه: (علاقة المطالع بالمقاصد في القرآن الكريم)، والكتاب الآخر هو: (حركة المعنى في سورة الفجر)، كما أن هناك رسائل أكاديمية اهتمّت بهذا العلم من حيث مناهج العلماء، أو الدراسات التطبيقية التي تناولت المناسبات وفصّلت القول فيها تنظيرًا وتطبيقًا.
وعلى ما تقدّم فإنّ هذه الجهود الطيّبة لا تزال بحاجة لتتميم واعتناء بالجانب المنهجي والتطبيقي بصورة أكثر توسّعًا، ومن هنا تأتي أهمية هذا الكتاب الذي يحاول تقديم مقاربة منهجيّة تطبيقيّة لتفعيل الروابط الداخلية للنصّ في عملية الفهم والتدبّر واجتناء المعاني، والاقتراب من المعاني الإحسانية التي هي من فيوض التدبّر للكتابِ العزيز، وتأتي هذه القراءة لمقاربة أفكار المؤلّف التي رسم معالمها في هذا الكتاب.
محتويات الكتاب:
قسّم المؤلف كتابه إلى مقدّمة، وشريجين[3]، ثم معاقد، جاءت على النحو الآتي:
المقدمة وَبَيّنَ فيها تَكَفُّلَ الله بحفظ كتابه، كما تطرّق لأوجه من الإعجاز فيه. والغرض من تأليفه، وتوضيح منهجه، وتقسيمه للكتاب. فبدأ بالشريج وكتب له توطئة مبينًا فيها المقصد الرباني في إعجاز البيان القرآني، وهو على ضربين؛ الأول: إعجاز بلاغة الإقناع والمحاجّة التي جاء بها النظم الكريم. والثاني: وهو ما يمثّل فكرة الكتاب، وهو إعجاز بلاغة تناسب المعاني وتآخيها وتناديها وتناغيها، كما نبّه الدكتور على أن هذا الوجه من الإعجاز يظلّ ظاهرًا حتى مع ترجمة القرآن لغير العربية؛ فليس مَرَدّ الإعجاز فيه إلى تصوير المعاني، بل إلى منهج الإقناع والمحاجّة الحقّة، وبذلك نَعِي أنّ النقطتين اللتين ذكرهما الدكتور تراتبيتان؛ حيث إنّ الثانية مرتّبة ومبنيّة على الأُولى[4].
ثم ابتدأ بالمعقد الأول معنونًا له: (التدبر مفهومًا ومغزى)، لم يُطِل فيه المؤلف، حيث ذكر معنى التدبّر، وأنّ طريقه يبدأ من التعقّل، وهو استيعاب البيان وأصول معانيه، ثم التفكّر، وهو تفكيك البيان وتحليله، ثم التبصّر، وهو إدراك دقائق القرآن ورقائقه، ثم الاستنباط، وهو استخراج الدقائق واللطائف، ثم الاستنتاج وهو استخراج ما ليس موجودًا مما هو موجود، ثم الوصول إلى المبتغى الأخير أَلَا وهو الاستطعام؛ ليظهر كلّ ما سبق على سلوك الإنسان وخلقه[5].
أمّا المعقد الثاني فعنون له: (المعنى القرآني؛ مفهومه، وأنواعه، وخصائصه)، وقد أطال فيه المؤلّف، فقد حضر فيه أربعة عناصر؛ أولها: المعنى القرآني الذي عرّفه بقوله: «هو كلّ ما أبان الله تعالى في كتابه العليّ الحكيم المنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، بلسان عربي مبين، ويدركه ويستنبطه الأعيان من أهل العلم من النصّ القرآني في سياقه القريب والمديد، وفقًا لأصول الفهم والاستنباط وضوابطهما، متجليًا فيه جلال الألوهية، وجمال الربوبية، هاديًا مَنْ آمن به إلى الارتقاء إلى مقام العبودية والصفاء لله ربّ العالمين»[6]. ثم بيّنَ أنماط المعنى، وهي ثلاثة أنماط: المعنى المقصود؛ ومرجعه إلى الله -عز وجل-. والمعنى المدلول؛ وهو الذي تدلّ عليه صورة التراكيب ضمن سياقها. والمعنى الإدراكي؛ وهو الذي يقع في قلب المتلقي من تبصره. ثم ذكر بعد ذلك خصائص المعنى القرآني، وهي: إلهية المصدر آدمي الغاية، وجلال ألوهيته وجمال ربوبيته، وتكاثره في أفئدة المتقين، ومواءمته لأحوال المؤمنين به، وامتزاج معاني التثقيف بمعاني التكليف، ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وحسن تلقيه من حسن العلاقة بمنزله الله -سبحانه وتعالى-. ثم ساق بعد ذلك مستويات المعنى، وذكر مستويين؛ الأول: المستوى الكلي، وهو المعنى الجمهوري المدرك من كافة الناس. والمستوى الكلي الآخر، وهو المعنى الإحساني، ولا يتوصل إليه إلا بطول التدبّر والتأمّل[7].
وبيّنَ في المعقد الثالث: (العواصم من القواصم، المنقذ من الضلال)، حيث قصد فيه المؤلّف الأمورَ التي تعيق المؤمن عن تلقّي كلام الله -عز وجل-، فأجملها في أربع كليات: عواصم تتعلّق بالقول في شأن منزل الكتاب، وعواصم تتعلّق في شأن الكتاب نفسه، وعواصم تتعلق في مقاصد الكتاب، وعواصم تتعلّق باللسان الذي أبان به الكتاب[8].
أمّا المعقد الرابع: (مستويات صورة المعنى في الذِّكر الحكيم)، لم يطل المؤلف في هذا المعقد حيث ذكر قسمين لمستويات المعنى: مستوى البناء، وفيه بناء المعنى من النظم والترتيب والتأليف والتركيب. وسمات التشكيل، وهي والصياغة والتصوير والنسج والتحبير[9].
وختم الشريج الأول بالمعقد الخامس الذي عنون له بـ: (النصّ والخطاب وما إليهما)، ذكر فيه الفرق بين النصّ والخطاب؛ فالنصّ قول مستقلّ بنفسه مكتمل الدلالة غير مرتبط بسياق استعمالي، والخطاب هو النصّ الملحوظ فيه حال المخاطب لتحقق التواصل والتأثير. والنظر البلاغي ركز على الخطاب؛ لما فيه من مطابقة الكلام لمقتضى الحال[10].
أمّا الشريج الثاني فهو لبيان معالم الطريق إلى مدارسة المعنى المركزي وأثره في تناسب بناء السورة القرآنية، وضمّنه خمسة معاقد، جاءت على النحو الآتي:
جاء المعقد الأول بعنوان: (موقع السورة من نسق التلاوة المديد والحزب الذي تكون فيه)، أوضح الدكتور في هذا المعقد ما توارثه أهل العلم أن للقرآن ثلاثة تنزّلات: من الله إلى اللوح المحفوظ، ومن اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا جملة واحدة ليلة القدر، ثم من السماء الدنيا إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في ثلاث وعشرين سنة، بدءًا من ليلة القدر على حسب الأحداث والوقائع، وكانت العرضتان الأخيرتان في شهر رمضان الأخير من حياة النبي -صلى الله عليه وسلم- مطابقتين في ترتيب الآيات والسور لما هو عليه في اللوح المحفوظ وفي بيت العِزّة في السماء الدنيا، وهو الذي بين أيدينا الآن[11]. كما تطرّق الدكتور إلى ملمح دقيق ألَا وهو الصبغة التي تتشكّل فيها السورة، فسور كلّ حزب تمتاز بخصوصية سور الأحزاب الأخرى[12].
ووضح في المعقد الثاني: (الطريق إلى استنباط المقصود الأعظم للسورة، وفقه أثره في البناء النصّي للسورة)، حيث بيّن فيه أنّ مصطلح السورة مأخوذ من السؤر الذي هو بقية مما يشرب ثم خففت الهمزة؛ وفي ذلك دلالة على تجانس آيات السورة من جهة، وتجانسها مع سائر السور الأخرى من جهة ثانية، كون سؤر الشراب يجانس سائره[13]، وعلى ذلك فإنّ لكلّ سورة من السور مقصدًا رئيسًا ومحوريًّا تدور حوله آيات السورة، ومن روافد الوصول إلى المعنى المقصد في السورة سبعة أمور؛ هي: اسم السورة، ومطلع السورة، والفروق البيانية بين المعاني الكلية المصرّفة في السور والمعاني الكلية الخاصة، والفروق البيانية بين المعاني الجزئية المصرّفة في السور، وتكرار النمط التركيبي في سياق السورة، والمعجم الكِلمي.
وعلى غرار ما سبق فقد شرح في المعقد الثالث: (تقسيم السورة إلى معاقد، وعلاقتها بالمقصود الأعظم وحركة المعنى)، وقد بيّن هنا أنّ سور القرآن -لا سيما الطوال منها- لا تكاد تخلو من مطلع ومقطع وقلب، وقد طبق هذا المعقد على ثلاث سور: البقرة، ويوسف، والنحل.
وكذلك فعل في المعقد الرابع الذي عنون له بـ: (تقسيم المعاقد إلى نجوم، وعلاقتها بالغرض المرحلي للمعقد)، حيث ذكر بإيجاز أنّ كلّ معقد في السورة إنما يتكون من نجوم من آيات من جمل وكلم، وكلّ تلك المكونات إنما تقوم بينها علاقة نسب وثيقة، تظهر أحيانًا وتخفى أحيانًا، إلا أنها حاضرة لا تغيب[14].
وختم المعقد الخامس بـ: (التحليل البياني في ضوء السياق والمغزى)، جعل المؤلّف هنا للتحليل البياني في المعنى القرآني ولصورته ثلاثة مجالات كلية: علاقات المعاني ومواقعها، وبناء صورة المعنى، ودلالة صورة المعنى ومستويات دلالتها عليه[15].
ثم عقد خاتمة يجمل ما ذكره في كتابه عنون لها: (زبدة البيان وسلافته)[16].
هدف الكتاب، ومنهجه:
أولًا: هدف الكتاب:
بَيّنَ المؤلّف في مقدمة كتابه أنّ الهدف من الكتاب هو: سعيه إلى تقديم رؤية منهجية مُعِينَة على اجتناء المعاني القرآنية في سياق السورة، تأسيسًا على أنها وحدة التحدّي الصغرى؛ لتكون زادًا إلى حسن الفهم عن الله[17]، وبعبارة أخرى يريد المؤلف أن يدرب القارئ المتدبّر على أنّ السورة الواحدة لها مقصد واحد تدور حوله جميع المعاني المتولّدة والمتفرّعة في السورة الكريمة، وهو بذلك يُعِينه على الوصول إلى المعاني الإحسانية التي لا تُدْرَك إلا بالتدبّر والتأمل.
ثانيًا: منهج الكتاب:
بيّن المؤلّف المنهج الذي سار عليه، وهو المنهج التجريبي التأويلي، حيث قصد منه إيصال الطالب إلى الرؤية أو البوصلة التي يتمكّن من خلالها من الوصول إلى جمع المعاني القرآنية المنثورة في السورة وسلكها في نظام المقصد الكلي من السورة[18]، وهذا الذي صرّح به المؤلّف، والمنهج التجريبي هو سلوك طريق لبيان فكرةٍ ما أو نظريةٍ ما بطريق غير معهود من قبل، أو عن طريق المعرفة التراكمية أو القراءة المستدامة من قبل، تُمَكّن صاحبها من ابتكار الطّرق الإبداعية والرؤية التأويلية العاقلة، هذا من حيث تصريف فصول الكتاب وطريقة طرح الأفكار، أمّا إذا دخلنا إلى صلب الكتاب وجدنا المنهج الوصفي التحليلي حاضرًا؛ فقد تمثّل المنهج الوصفي في التصنيفات والتبويبات التي تمثّلت في تشريجات الكتاب ومعاقده، ومناقشة المصطلحات والتعريفات والآراء التي نقلها عن العلماء، والتحليلي الذي تمثّل في البوصلة التي رسمها المؤلّف في تقسيم السورة إلى مقدمة ومعاقد يجمعها المقصد الرئيس من السورة، واستنباط اللطائف والنكت التي تخلّلت ذلك.
والشيخ محمود توفيق كَلِفٌ بهذا الأمر جدًّا، وهو بيان المنهج؛ بصفته المحرك الفكري الأول لطالب العلم، يقول الشيخ: «ولذا أرى أن من مسؤولية الدراسات العلمية التي يقوم لها طلاب العلم -لا سيما في جامعة الأزهر- أن يبين لنا في دراسته منهج العالم في التفكير والتعبير، ولا يرغب عن أن يقول كيف دخل العالم إلى هذه المسألة تفكيرًا، وكيف عبّر عمّا قام في قلبه من العلم فيها من اجتهاده في التفكير فيها»[19]، ويقول: «فحِرْصُ طالب العلم على أن يبصر مدخل العالم إلى القضية والمسألة تفكيرًا ومدخله في الإبانة عمّا أنتجه قلبه من المعرفة؛ إنما هو أمرٌ جليلٌ جدًّا»[20]. وأحسب أن الشيخ -وفّقه الله- قد فعل ما أمر بتطبيقه، فهو في هذا الكتاب يشير إلى منهجه التجريبي الذي يريد أن يقدّم به نموذجًا يحمل به طلاب العلم إلى الابتكار والإبداع، يقول الشيخ: «التجريب صنعة الأحرار، والتطبيق عبادة الصغار. في التطبيق تقديس وفي التجريب تقويم وتزكية»[21]. وفي هذا رسائل لنا طلاب العلم أن نعِي منهج علمائنا أولًا؛ لنقدّم بعد ذلك لمن يخلفنا معرفةً جديدة يُصنع من خلالها معرفة، وهكذا دواليك في حركة مستمرة من العطاء والتثقيف.
الإشكاليات الرئيسة للكتاب وتخلّقها:
تتمحور إشكالية كتاب: (المعنى القرآني، معالم الطريق إلى فقهه في سياق السورة)، حول ثلاث نقاط مرتبطة بعضها ببعض، كلّ نقطة آخذه بزمام أختها، يمكن إجمالها على النحو الآتي:
أولًا: تنطلق هذه الإشكالية من المعاني المتفرّقة في السورة الواحدة، والتي تحتاج إلى رباط ناظم يربطها ببعضها، وأن يعد بناء النصّ القرآني بناءً متراصًّا، وهذا رأس التدبّر، وهذا الأمر يحتاج إلى إعانة لطالب العلم بكتاب الله -سبحانه وبحمده- على أن يقوم بما أمره به الله من الاتباع الذي يقتضي التدبّر، كما في قوله: {وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ}[الزمر: 55]، فقوله:{أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ}، خصوص بعد عموم ما أنزله، إِذْ إنّ القرآن أحسن ما أنزله -سبحانه وتعالى-. وأن سلوك طريق التدبّر يتطلّب مهارات وأدوات زائدة على ما تحتاجه مدارسة الكلمة الإنسان شعرًا ونثرًا أدبيًّا، فقد يكون المرء مستنطقًا للكلمة الشاعرة، ولا يقدر على أن يحوم حول حمى البيان القرآني على النحو الذي كان له في الكلمة الإنسان[22].
ثانيًا: ينبّه المؤلّف إلى أنّ إشكالية أخرى لا تقلّ عن الأولى، وهي أنّ مما هو قائم في وعي غير قليل من طلاب العلم بكتاب الله أن مقصديّة إعجاز بلاغته إنما تتمثّل في تحقيق أنه كتاب الله، ومنزله على نبيّه -صلى الله عليه وسلم-، إلّا أن الذي ليس بحقّ أن تكون مقاصد إعجاز بلاغة القرآن منحصرة في هذا المقصد، فهذا المقصد أن كان أوليًّا لا يلغي مقاصد أخرى جمّة، في مقدمتها المقاصدُ التربوية التي يجب استحضارها في مدارسة البيان القرآني بأيّ منهج من مناهج الدّرس[23]، ومقصديّة أخرى ينبّه عليها المؤلّف، وهي التي أقام كتابه عليها، ألَا وهي أنّ مردّ الإعجاز ليس إلى تصوير المعاني فقط، إنما إلى منهجه في بلاغة الإقناع والمحاجّة، وإلى تناسب المعاني وتصاعدها[24].
ثالثًا: الإشكالية الأخرى أنّ أدوات منهجية نظر العقل البلاغي العربي في الكلمة الإنسان شعرًا ونثرًا أدبيًّا، تختلف عن منهجية النظر في الكلمة الوحي قرآنًا وسُنّة نبويّة؛ لما في خصوصية النّظم القرآني أولًا، ثم البلاغة النبويّة، مع العلم بأن الأدوات الفعلية في تلقي القرآن منها ما هو معرفي يتوصّل إليه بطريق التعليم والتعلّم والممارسة، وبعضها إيماني سلوكي مرتبط بعلاقة الدّارس والباحث في هذا البيان الوحي[25]. فكان لزامًا لذلك أن يسلك المؤلّف المنهج التجريبي الذي يفارق قراءة الشِّعْر وكلّ الأجناس الأدبية؛ لما حواه النظم من بلاغة عالية تستلزم تطوّر الأدوات والوسائل.
وإذا كانت هذه الإشكالية، فكيف قاربها المؤلّف؟
في ضوء حرص المؤلّف على تقديم رؤية منهجية مُعِينة على اجتناء المعاني القرآنية في سياق السورة، تأسيسًا على أنها وحدة التحدي الصغرى لتكون زادًا إلى حُسْنِ الفهم عن الله[26] ومعالجة الإشكاليات المثارة في كتابه؛ قوّم المؤلّفُ كتابَه على أسس ومعاقد اقترح فيها معايير وأسسًا من شأنها أن توضح كيف لطالب التدبّر أن يضبط ويجمع ما تفرّق من المعاني في السورة القرآنية، فيستطيع من خلالها أن يستخرج مقصد السورة والمعاني الرئيسة والمتفرّعة منها.
أقول: عالج المؤلِّفُ إشكالية صعوبة الوصول إلى وحدة النصّ القرآني ومقصد السورة التي بدورها أعظم سبل التدبر من حيث ما يأتي:
أولًا: قوّم كتابه من شريجين فيهما معاقد، كلّ شريج يفضي إلى الآخر، على مستوى التراتب والتداخل، فكلّ شريج مبنيّ على الذي قبله، ومن هنا فَقَدْ أحسن المؤلّف ودقّ نظرُه حين أطلق الشريج بدلًا من فصل أو مبحث، وهذا من حيث البناء الذي سَوّر به المؤلف كتابه.
ثانيًا: عالج المؤلف نظرية وحدة النصّ القرآني على مستوى التنظير والتطبيق، وحاول أن يؤسّس منهجًا في القراءة المقاصدية للقرآن الكريم، تكمن جِدَتها في تعميق بعض المفاهيم التي لا تتأتى إلّا من خلال الجمع بين أمرين: نظرية النَّظْم، والوحدة السياقية لسور القرآن الكريم[27].
هذا من حيث الإجمال، أمّا من حيث التفصيل فأقول:
عالج المؤلف في الشريج الأول الجوانبَ النظرية التي أطّرها في تعريفات وتقسيمات؛ حيث ركّز فيها على البناء النظري الذي يعمّق المفاهيم التي تسهم في حُسْن الفهم لكتاب الله من جهة ترابط الكلام بعضه ببعض وتآخيه وتناغمه، من أجل ذلك ذَكَر المؤلفُ في الجانب التنظيري خمسة معاقد، وذلك بعد أن وَطّد القول بأنّ ترتيب المعاني والحجية في الإقناع وجه بارز من وجوه الإعجاز.
يمكن القول: إنّ المؤلّف استعان في معالجة الإشكالية بالمنهج الوصفي أولًا، حيث ركّز على تعريف التدبّر ومغزاه، وأن طريقه يكون مبنيًّا على ستة أفعال؛ تبدأ من التعقّل، ثم التفكّر، ثم التبصر، ثم الاستنباط، ثم الاستنتاج، ثم الاستطعام، وهذه المراحل التي ذكرها المؤلف تلتقي وشائجها وتتماسك مع مستويات المعنى التي ذكرها في الشريج الثاني، وهو ما يدلّل على كفاءة نظر المؤلّف حين أطلق لفظ الشريج على تقسيم كتابه، وهو بذلك يمسك جيدًا بزمام يد القارئ ليتدرّج به إلى أهداف الكتاب التي ينشدها.
وبيان التماسك نلحظه في مستويات المعنى التي ذكرها المؤلّف؛ بغية توصيف الطرق المؤدية للتدبّر، وهي على مستويين، الأول: وهو الجمهوري، وهي المعاني التي يدركها العامة. والثاني: المعاني الإحسانية، وهي التي تدرَك بالتدبر. ومن هنا وبالموازنة بين طرق التدبر ومستويات المعنى، نلحظ أنّ أول طريق للتدبّر هو المعنى، وهو ما يلتقي بالمعنى الجمهوري الذي يدركه كلّ الناس، والخمسة الطرق الأخرى هي تدخل ضمن المعنى الإحساني، وهذا يعطينا إشارة إلى أنّ طريق التدبر لا ينال بالهوينى، إنما بالصبر والإنارة والمثاقفة والمدارسة وثني الرُّكب. وأودّ الإشارة هنا إلى أمر مهمّ يدفع إشكالية قد تُثَار أو تُسْتَحدث، وهي أن المعنى الجمهوري يحتاج إلى تعقّل حتى يفهم المعنى، ولا يفهم من ذلك أنّ المعنى الجمهوري متناول دون أدنى تعقل أو تأمل.
كما نبّه المؤلف إلى أصل من أصول النَّظْم ندرك من خلاله المقاصد القرآنية ونصلُ به إلى المعاني الإحسانية، ألَا وهو المقابلة الموضوعية، كما يجيء في البيان القرآني من تصوير حال المؤمنين إلّا ويصحبه تصوير حال الكافرين، ولا يذكر الدنيا إلا ويذكر الآخرة، وهكذا، ودراسة هذه المتقابلات في سياقات سورها وموازنتها مع السور الأخرى يهدينا إلى بلاغة النظم القرآني ويعضد من مقصدية السورة[28]، وبمقابل المقابلة الموضوعية، هناك الفرائد القرآنية التي لم تأتِ إلا مرّة واحدة في القرآن، وتبقى هذه الفريدة مناط تساؤل واهتمام وتدعم كذلك المقصدية[29].
وإِذْ عالج في المعقدين الأوّلين طرق التدبّر في ضوء المعنى والتأثر به واستطعامه وأثره على الجانب السلوكي، فإننا نراه مشغولًا بما قدّمه؛ ليؤكّد في المعقد الثالث على أمور قد تعيق السعي نحو التدبّر، فذكر أمورًا في غاية الأهمية، وهي العلم بالمتكلّم، وهذا أصل من أصول البيان ومنهج أساسي فيه، والغفلة عن ذلك تؤدي إلى التأويل والانحراف كما هو شأن كثير من الْفِرَق التي ضلّت، فمن هنا أوتِيَتْ، ونبّه المؤلف هنا إلى ضرورة الاعتناء بفقه الأسماء الحسنى في سياقات النظم القرآني، فاستحضارها يُعِين المتبصّر إلى فقه كلام الخالق، واستبصار المعاني القرآنية، وهذا الأصل متبع في كلّ منهج قويم يُرَام منه الوصول إلى مقاصد الكلام البليغ، فكيف إذا كان ذلك في كلام الخالق الذي هو معجزة النبي الخاتم -صلى الله عليه وسلم-، معجزة قائمة إلى قيام الساعة. والأمر الثاني هو عدم الغفلة عن التوحيد، الأمر الذي يُعَدّ ركيزة أساسية من ركائز الدِّين، فلا تكاد تمر آية في الذِّكْر الحكيم إلا تجد أمر التوحيد حاضرًا؛ إمّا تصريحًا أو تلويحًا، وهذا الحضور الدائم يصطبغ دائمًا بالسياق الذي يأتي فيه، لا يظهر إلا بالتدبّر، وعطفًا على ذلك فإنّ قوله تعالى: {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ}[الفاتحة: 5]، محور رئيس ترتبط به كلّ آية من آيات القرآن الكريم، فما من آية إلا معناها من معدن هذه الآية[30]. ثم أشار المؤلّف إلى أمرٍ آخر مهم، وهو المقصد، وفي أثناء كلامه عن المقصد ومكانة إدراكه من أصول البيان، نبّه المؤلّف إلى إشكالية اعتناء البلاغة بشأن المتكلِّم والمخاطب أكثر من اعتنائها بالمعنى وطريق إبانته.
قد حاول المؤلِّف في الشريج الأول أنْ يكرّس جهده حول الموضوعات التي يجب أن يتعامل معها طالب وحدة النصّ القرآني، فليست الصلة الوحيدة هي السورة القرآنية، بقدر ما هناك ملابسات تُستلزم أن تُستدعى وتُعلم، وقد تطرّق المؤلِّفُ إلى عددٍ منها، إلا أنّ هناك أمورًا أخرى يجب أن تُؤخذ في عين الاعتبار نسوقها في الملحوظات بإذن الله.
انتقلت المعالجة في الشريج الثاني إلى الجانب التطبيقي، فقد رسم المؤلف في شريجه الثاني خطواتٍ وطرقًا للوصول إلى مقاصد السور، وهذه الخطوات إن رأيناها في كتاب (علاقة المطالع بالمقاصد) للدكتور إبراهيم الهدهد، فقد جاءت على سبيل الإجمال والاختزال دون الشرح والتفصيل[31]، والدكتور هنا يفصّل ويبيّن.
قد رأيتُ هنا أن أضع إطارًا نستطيع من خلاله أن نرقب منه المعالجة التطبيقية للمؤلِّف؛ ولذا فقد ارتأيتُ أن أقسم معالجة المؤلّف إلى ثلاث مراحل:
المرحلة الأولى: قبل الدخول إلى السورة:
يقرّر المؤلف أصلَيْنِ في هذه المرحلة للوصول إلى مقصدية السورة، وهما:
الأمر الأول: موقع السورة من أُمّ الكتاب (الفاتحة).
الأمر الثاني: موقعها من سور حزبها.
ومن الأمثلة الدالة على ذلك، ما ذكره الدكتور أن تسمية الفاتحة بأُمّ الكتاب تسمية توقيفية، فإنّ ما جاء بعدُ في النّظم الكريم راجع إلى أصولها وشارح لها، وهذا الأمر كان حاضرًا عند علمائنا، وقَصْدُ المؤلّف من هذه النقطة هو أن يكون في وعي المتدبّر أصول وأسس يرجع إليها، والتدريب على سلوك هذا الطريق ينير الفكر بمكاشفة الأفكار والقضايا، ويجمعها في إطار واحد، وأن يترقّب حركة المعنى، وهذه المرحلة قبل الولوج إلى السورة.
المرحلة الثانية: وهي مرحلة البناء الكلي، التي تلج بنا إلى مكنونات السورة، وهذه يكون تحصيلها بالروافد التي ذكرها المؤلف، وهي أنّ من روافد الوصول إلى المعنى المقصد في السورة سبعة أمور، هي: اسم السورة، ومطلع السورة، والفروق البيانية بين المعاني الكلية المصرّفة في السور، والمعاني الكلية الخاصة، والفروق البيانية بين المعاني الجزئية المصرّفة في السور، وتكرار النمط التركيبي في سياق السورة، والمعجم الكِلمي. ومن ثم تقسيم السورة إلى معاقد كلية.
المرحلة الثالثة: وهي البناء الداخلي الذي يلج داخل آيات السورة، وهي التحليل البياني الذي يوضح وشائج القربى بين المعاني، وبناء صورتها.
ومن خلال هذه المراحل الثلاث يمهّد المؤلّف طريق التدبّر والوصول إلى المعاني الإحسانية التي يروم إليها وينشدها كلّ من يسعى إلى تدبر الكتاب العزيز.
أبرز مزايا الكتاب:
1. حسن ترتيب أفكار الكتاب، وتهيئة كلّ فكرة لما يأتي بعدها؛ فالشريج الأول أُشبع بالتنظير، والشريج الثاني أُغني بالتطبيق، في تلاؤم وحسن تناسق بين كلٍّ.
2. الجِدَة في الطرح؛ والتي تمثّلت في الجانب النظري، والخطوات العلمية التي انتهجها المؤلّف.
3. حوى الكتابُ بعضَ المشاريع العلميّة الرائدة التي تنهض بالدراسات البلاغية والقرآنية على وجه الخصوص، ومما ذكره من ذلك:
• أن نستقرِئ كلّ سورة من سورة القرآن على أنها أصل من سورة الفاتحة (أُمّ القرآن)، ومن ثم ننظر في المعاني التي حضرت في سورة دون أخرى، ومدى تفاوت وجودها في كلّ سورة[32].
• أنّ لدينا بعدد سور القرآن عدد مناهج مدارسة لبناء السورة القرآنية، ومنهاج إبانتها وإعرابها وإفهامها. وبحسب تعبير المؤلف: هذا الأمر من المسكوت عنه والفريضة الغائبة، وهو حمل ثقيل، ينبغي له عمل مؤسّسي يقوم به أعيان أهل العلم[33].
• استجلاء مقاصد السورة ومعانيها من موقعها في حزبها، وإدراك علاقتها بسابقتها ولاحقتها في ضوء الخصائص العامة لسور الحزب[34].
• لفت المؤلّف إلى موضوع جدير بالمُدَارَسة، ولا يقوم به إلا ماجد بحسب وصفه، حيث ذكر أنّ خمس سور في القرآن الكريم استفتحت بالحمد؛ الفاتحة والأنعام والكهف وسبأ وفاطر، وكلّ سورة جاءت حمدًا على نعمة من النعم الكلية الأربع: الإيجاد الأول كما في الأنعام، والإبقاء كما في الكهف، والإيجاد الآخر أو البعث كما في سبأ، والإبقاء الأخير كما في فاطر، والفاتحة حمدٌ على النعم كلّها، وهذا الكلام يحتاج إلى دراسة وتفصيل[35].
• استقراء مقدّمات سور القرآن ومستهلّها، ودراستها في ضوء مقاصد السور هي أوثق الطرق إلى توثيق المقاصد ومقاربتها[36].
4. التنوّع في الجانب التطبيقي، حيث طبّق في سورة البقرة، وهي أطول سور القرآن، ثم سورة يوسف وقد تخصّصت في القصص القرآني، وسورة النحل التي يبلغ عدد آياتها 128 آية. وهذا التنوّع يهدينا إلى كفاءة الطريقة التي سار عليها المؤلّف رغم اختلاف موضوعات كلّ سورة بما فيها من محتوى.
5. استثمر المؤلِّف الدراسات السابقة في موضوعه، خصوصًا ما قدّمه الشيخ محمد محمد أبو موسى في دراسته البلاغية لآل حم، وكذلك ما قدّمه الدكتور إبراهيم الهدهد في كتابيه: (علاقة المطالع بالمقاصد في القرآن الكريم)، و(حركة المعنى في سورة الفجر). وهذه الدراسات ركّزت على الجانب التطبيقي، وكتاب الدكتور محمود توفيق ركّز على الجانب النظري والتطبيقي.
6. أشار المؤلِّفُ إلى نقطة جديرة بالعناية والاهتمام، ألَا وهي مفارقة البلاغة القرآنية ثم النبويّة عن غيرها من منثور الكلام وشعره، وهذا الأمر إن كان مسلَّمًا به، إلا أنّنا بحاجة إلى مراجعة بعض القضايا اللغوية والبلاغية في ضوء هذه المفارقة، وعمل موازنة؛ ليتجلّى على مستوى النظرية تقدّم البلاغة القرآنية وعلوّ كعبها، ثم النبويّة؛ فيتجلى الأمر بصيغة علمية ومعايير مباينة.
7. الحسّ العروبي والانتماء إلى الهوية والاعتزاز بها، وهو ما نلحظه عمومًا في كتب الشيخ، فهو يستثمر ذلك الاعتزاز في موضوع كتابه والفنّ الذي يدرسه ويعالجه، ومن الأمثلة على ذلك ما ساقه في كتابه حيث يقول: «يراد بالمقاصد ما يراعيه بيان الوحي قرآنًا وسُنةً من المعاني والحكم؛ تحقيقًا لمصالح العباد في معاشهم، تيسيرًا لطاعتهم ومعادهم، تحقيقًا لفلاحهم. ولعلمائنا نظرٌ وسيعٌ متغور في هذا الباب، لا تكاد تجد له نظيرًا عند غيرهم، ولو أنّا أحسنّا فقهه، ونشره في ديارنا، ثم في ديار غيرنا؛ لعلم الآخر قَدْرَنَا، ولسعوا إلى الأخذ عنّا، لا أن تسعى إلى قَمِّ فُتات موائدهم وإلى الْعَبِّ من رجيع عقولهم»[37].
الملحوظات:
1. لم يتطرّق المؤلّف في أثناء معالجته إلى الحديث عن المكي والمدني، ويظهر لي أن معرفة خصائص كلٍّ من المكي والمدني يترتب عليه ما بعده، وهو من الأهمية بمكان، فقد راعى النظمُ الكريمُ حالَ المخاطبين وما هم عليه من الكفر في المرحلة المكية، وتثبيت الرسول -صلى الله عليه وسلم- والمؤمنين، إلى آخر تلك الخصائص. وحال المؤمنين وما يستلزم نحو توضيح التشريعات والأحكام في الفترة المدنية، وخصائص أخرى، والمؤلف إن ضمنها في كلامه، إلا أنها لم تجد حضورًا بارزًا يجليها ويوضحها.
2.في تصوّري أنّ مقدمة الكتاب كانت تحتاج إلى بيانِ معهودِ كلام العرب وسننهم في بناء النصّ؛ حيث كان النصّ العربي شعرًا أو نثرًا يُبنى على عدة مواضيع وأغراض يربطها نظام كلي، والقرآن الكريم نزل على معهود كلام العرب، يقول تعالى:{وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ}[إبراهيم: 4]، وبذلك يكون القارئ على بيّنة وبرهان من هذا الأمر، مع العلم أنّ المؤلف عرّج على هذا الموضوع في منتصف كتابه وساق كلامًا طيّبًا عن العلماء[38]، إلا أنّ أوليته ضرورية، خصوصًا إذا أُردف هذا الموضوع مع حديثه عن الإعجاز كما مقدمته. ولعلّ الصواب يكون فيما ذهب إليه المؤلّف -وفّقه الله-.
خاتمة:
هذه قراءة موجزة لكتاب: (المعنى القرآني: معالم الطريق إلى فقهه في سياق السورة؛ رؤية منهجية ومقاربة تأويلية)، رسم المؤلّف من خلال هذا الكتاب الطرقَ والوسائل المُعِينة إلى الوصول إلى التدبّر الأمثل للكتاب العزيز، وتمثّلت تلك الطرق بضرورة التبصّر بفقه الأسماء الحسنى في السياقات القرآنية، وإدراك القضية الأهم التي بعث الله من أجلها الرسل وأنزل الكتب، وهي توحيد الله، فالتوحيد مُلابِس لكلّ آية من آيات الذِّكْر الحكيم، بالتصريح أو التلويح، وأن لكلّ سورة مقصدًا تدور حول رحاه جميع الآيات فيها، كما ساق بعض المعايير المُعِينة على فقه المعاني القرآنية ضمن وحدة النصّ وتماسكه. والحقيقة أنّ هذا الجهد المبذول من المؤلف -وفّقه الله- يدعونا إلى مزيد من النظر في كتب علماء البلاغة والإعجاز والمفسّرين، واستنطاقها، وتطوير وتوسيع آفاق البحث في وحدة النصّ القرآني وتآلف معانيه وتماسك مبانيه، ونستثمر في هذا العلم الشريف، ونزيد به وعيًا وتبصّرًا للذِّكْر الحكيم.
نسألُ اللهَ أن ينفع بجهود علمائنا ويبارك فيها. هذا واللهُ أجَلّ وأعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
[1] ينظر: نظم الدرر (1/ 6).
[2] مفاتيح الغيب (1/ 113).
[3] الشريج في اللغة من أصل مادة شرج، وهو أصل يدلّ على اختلاط ومداخلة. مقاييس اللغة، كتاب الشين، باب الشين والراء وما يثلثهما، (3/ 862).
[4] ينظر: المعنى القرآني، ص29.
[5] المعنى القرآني، ص38.
[6] المعنى القرآني، ص46.
[7] المعنى القرآني، ص74.
[8] المعنى القرآني، ص104.
[9] المعنى القرآني، ص141.
[10] ينظر: المعنى القرآني، ص152.
[11] المعنى القرآني، ص173.
[12] المعنى القرآني، ص178.
[13] المعنى القرآني، ص191.
[14] المعنى القرآني، ص372.
[15] المعنى القرآني، ص399.
[16] المعنى القرآني، ص516.
[17] المعنى القرآني، ص10.
[18] المعنى القرآني، ص10.
[19] الرجال قوّامون على النساء؛ مدارسات إيمانية أخلاقية في ضوء علم البلاغة العربي، ص18.
[20] الرجال قوّامون على النساء؛ مدارسات إيمانية أخلاقية في ضوء علم البلاغة العربي، ص18.
[21] المعنى القرآني، ص11.
[22] ينظر: المعنى القرآني، ص17.
[23] المعنى القرآني، ص26.
[24] ينظر: المعنى القرآني، ص30.
[25] المعنى القرآني، ص31.
[26] المعنى القرآني، ص10.
[27] المعنى القرآني، ص9.
[28] ينظر: المعنى القرآني، ص93.
[29] المعنى القرآني، ص97.
[30] المعنى القرآني، ص115.
[31] ينظر: علاقة المطالع بالمقاصد في القرآن الكريم، ص587.
[32] ينظر: المعنى القرآني، ص183.
[33] المعنى القرآني، ص186.
[34] المعنى القرآني، ص187.
[35] المعنى القرآني، ص242.
[36] ينظر: المعنى القرآني، ص239.
[37] المعنى القرآني، ص117.
[38] ينظر: المعنى القرآني، ص282، وما بعدها.
كلمات مفتاحية
الكاتب:

محسن بن علي الشهري
حاصل على الدكتوراه من كلية اللغة العربية بالجامعة الإسلامية، وله عدد من الأعمال العلمية المنشورة.
مواضيع ذات صلة
((المعلومات والآراء المقدَّمة هي للكتّاب، ولا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع أو أسرة مركز تفسير))









