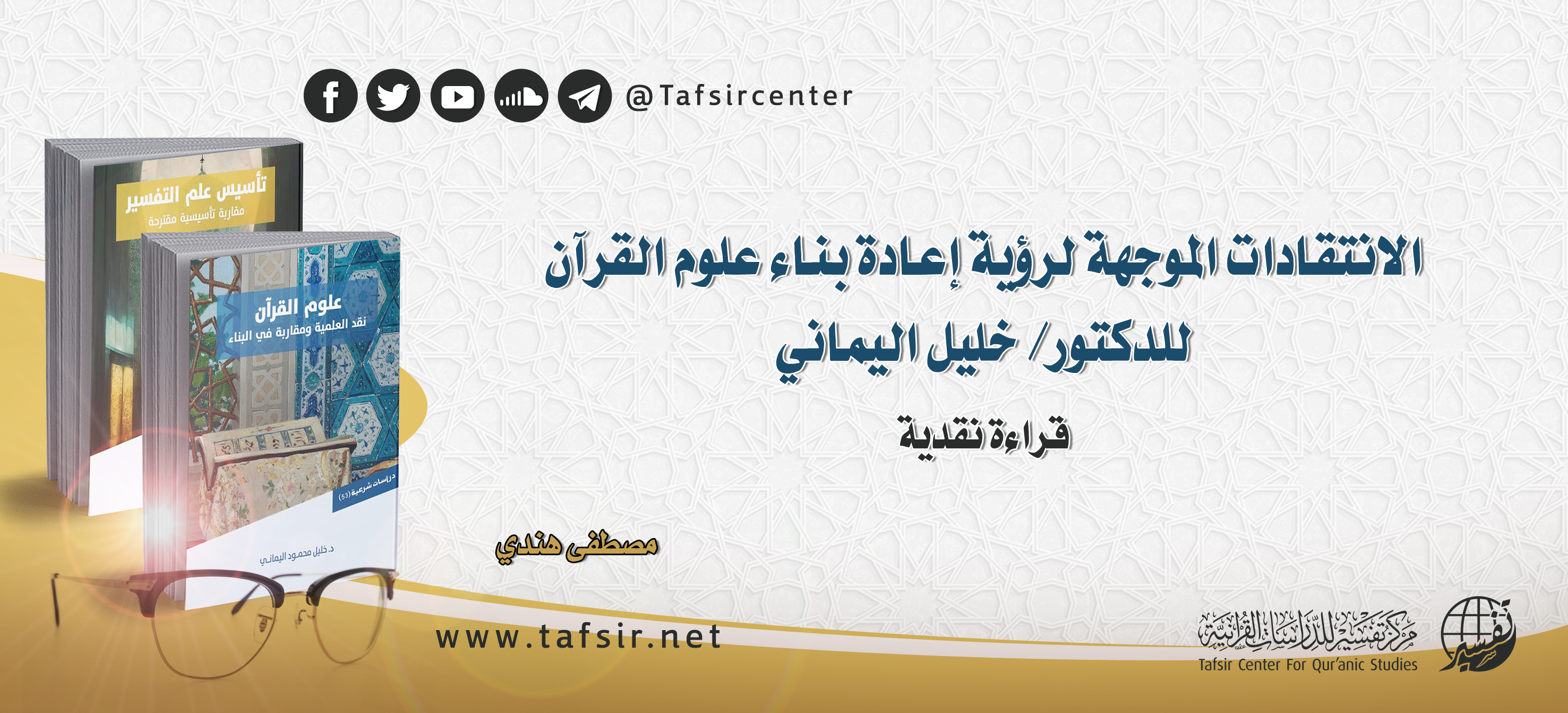قراءة في كتاب «المعجزة؛ إعادة قراءة الإعجاز اللغوي في القرآن الكريم»
قراءة في كتاب «المعجزة؛ إعادة قراءة الإعجاز اللغوي في القرآن الكريم»
الكاتب: محسن بن علي الشهري
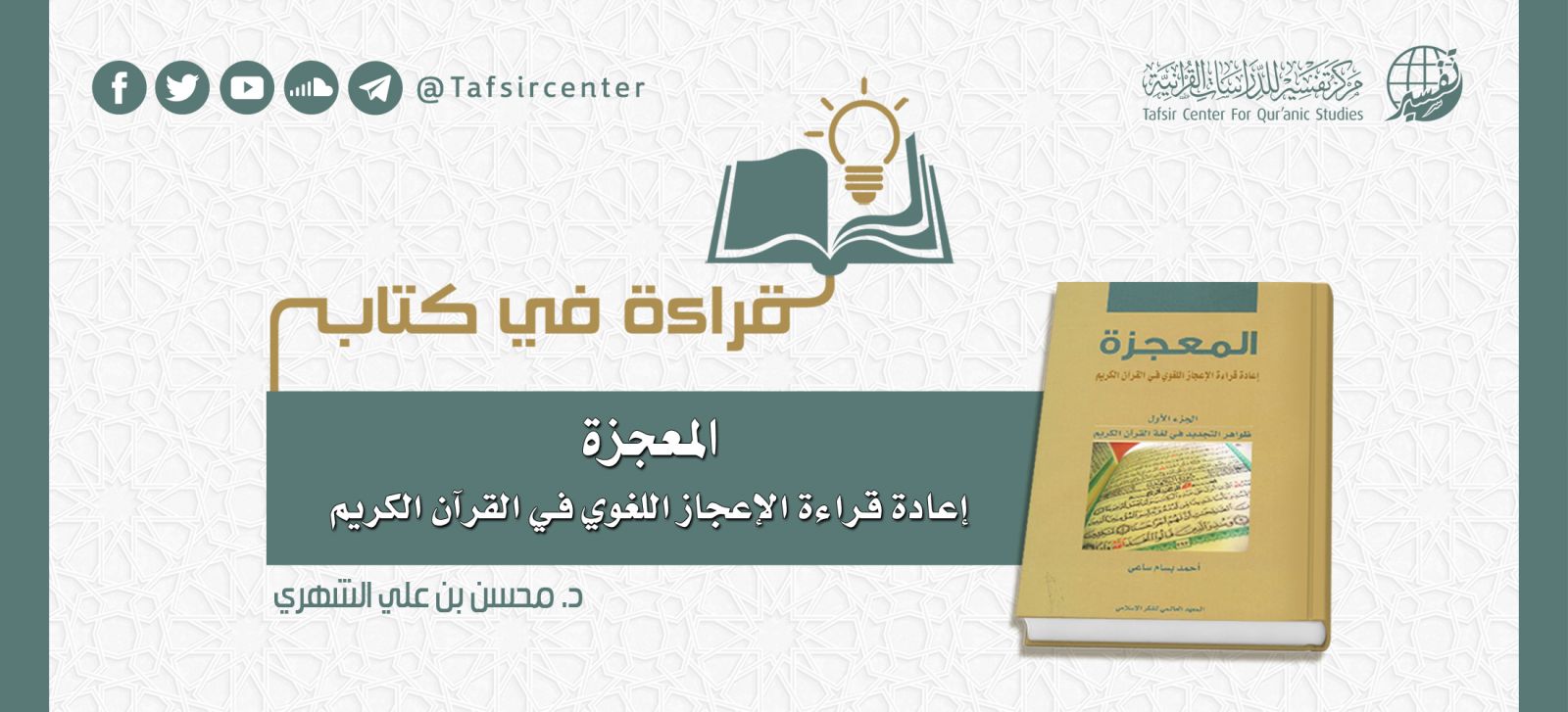
بيانات الكتاب:
عنوان الكتاب: المعجزة؛ إعادة قراءة الإعجاز اللغوي في القرآن الكريم- الجزء الأول؛ ظواهر التجديد في لغة القرآن الكريم[1].
المؤلف: الدكتور/ أحمد بسام ساعي.
دار النشر: المعهد العالمي للفكر الإسلامي، ومقره الولايات المتحدة الأمريكية.
أجزاء الكتاب: 2.
عدد صفحات الجزء الأول: 358.
سنة النشر: 1433هـ/ 2012م.
رقم الطبعة: الأولى.
نبذة عن المؤلف[2]:
ولد الدكتور/ أحمد بسام ساعي، في اللاذقية عام 1360هـ/ 1941م. حصل على درجته العلمية الأولى من جامعة دمشق، وعلى الماجستير والدكتوراه في الأدب العربي من جامعة القاهرة. درّس في الجامعات السورية والعربية، ودرّس في جامعة أوكسفورد، وأسس أكاديمية أوكسفورد للدراسات العليا لتكون أول معهد جامعي في الغرب يؤسسه عربي مسلم، وينال اعترافًا حكوميًّا.
كتب عددًا من المؤلفات، منها:
- الصورة بين البلاغة والنقد. حوى الكتاب 128 صحيفة، الناشر: دار المنارة للطباعة والنشر، الطبعة الأولى، 1984م.
- الواقعية الإسلامية في الأدب والنقد. حوى الكتاب 198 صحيفة، الناشر: دار المنارة للطباعة والنشر، الطبعة الأولى، 1985م.
- حركة الشعر الحديث من خلال أعلامه في سورية. حوى الكتاب 599 صحيفة، الناشر: دار الفكر المعاصر، الطبعة الأولى، 2006م.
- مسلمون في مواجهة الإسلام، مسيحيون في مواجهة المسيحية. حوى الكتاب 318 صحيفة، الناشر: الفرات للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، 2008م.
- إدارة الصلاة، إعادة اكتشاف الركن الثاني في الإسلام. حوى الكتاب 160 صحيفة، الناشر: المعهد العالمي للفكر الإسلامي، الطبعة الأولى، 2015م.
تمهيد:
إن موضوع الإعجاز جدير بالعناية والاهتمام، لا سيّما أنّ القرآن الكريم هو المعجزة الخالدة والبرهان الساطع الذي أظهر الله به دعوة النبي محمد -صلى الله عليه وسلم-، وأنّ العرب الأوائل الذين نزل القرآن الكريم في زمنهم امتلكوا ناصية البيان، والذوق السليم الذي أدركوا به الإعجاز، استمر ذلك الإدراك إلى أن بدأت السليقة العربية تفقد صفاءها، وبدأ الناس يفكرون بطريقة عقلية مجردة عن الذوق الجمالي وإدراك المعاني والأساليب القرآنية، ومن هنا برز الحديث عن المعجزة القرآنية[3]، وبدأ العلماء يكتبون في هذا الشأن حتى ظهر عدد من المؤلفات، ويُعَدّ القرن الرابع والخامس مرحلة خصبة في تاريخ الدراسات القرآنية، والإعجاز على وجه الخصوص، حيث نضج فيها التأليف في الإعجاز. وأوّل هذه المؤلفات التي خصصت حديثًا عن الإعجاز، رسالة[4] بعنوان: (النكت في إعجاز القرآن) كتبها أبو الحسن علي عيسى الرماني (386هـ)، وتبعه معاصره أبو سليمان الخطابي في رسالته: (بيان إعجاز القرآن) (319هـ)، وقد ضمّنت هذه الرسالة آراء مهمة في البلاغة، ويقابلنا في القرن الخامس كتاب: (إعجاز القرآن) للإمام أبي بكر محمد بن الطيب الباقلاني (403هـ) الذي يُعَدّ أوسع ما كتب في الإعجاز، ثم توجت هذه الجهود عند عبد القاهر الجرجاني (471هـ) فكتب في هذا الشأن ثلاثة كُتُب؛ الرسالة الشافية، ودلائل الإعجاز، وأسرار البلاغة. ويُعَدّ الأخيران هما الكتابان اللذان قامت عليهما البلاغة العربية؛ إذ أحال فيهما سر الإعجاز البلاغي على نظرية النَّظْم وأنها مكمن الإعجاز، وعرّف النظم بقوله: «اعلَمْ أن ليس النظم إلّا أنْ تضعَ كلامك الوضع الذي يقتضيه علم النحو، وتعملَ على قوانينه وأصوله، وتعرفَ مناهجه التي نهجت لك فلا تزيغَ عنها، وتحفظ الرسوم التي رسمت لك، فلا تُخِلّ بشيء منها»[5]. فالنظم كما وصف معاني النحو، أو النحو المعلل كما هو في إجراء النظرية وتطبيقها.
ومن الجهود الحديثة في إعجاز القرآن، ما قدّمه مصطفى صادق الرافعي (1356هـ) في كتابه: (إعجاز القرآن والبلاغة النبوية) حيث بيّن أنّ إعجاز القرآن في نظمه وطريقة تركيبه، وقد أَولى الجانب الصوتي اهتمامًا كبيرًا. ومن الذين تحدثوا عن الإعجاز الدكتور محمد عبد الله دراز (1377هـ) في كتابه: (النبأ العظيم) ويُعَدّ كتابه من أبرز وأنفَس ما أُلِّف في إعجاز القرآن؛ لِما احتوى من عمقٍ في الطرح وجدةٍ في عرض المسائل.
وبعدُ؛ فإن كتاب (المعجزة) لأحمد بسام ساعي بجزأيه: الأول (النظري)، والثاني (التطبيقي)؛ يضاف لِما سبق من الجهود لِما ضمّن فيه من آراء واستنتاجات جديرة بالدراسة والتأمل، وحافلة بالعديد من النظرات التجديدية لموضوع الإعجاز، والإشارات الثرية في عدد من المسائل المهمة، وأحسب أنه فصّل بعض المجمل الذي ورَد عند العلماء كما سيأتي في قراءتنا، وهذا مما يسوِّغ لنا تقديم قراءة حول الكتاب، فضلًا عن أهمية موضوع الإعجاز الذي يشكل مرتكزًا رئيسًا في الدراسات القرآنية. وستقوم هذه القراءة على الجزء الأول من الكتاب. ومن الله أستَمِدُّ التوفيق.
محتويات الكتاب:
قسّم المؤلف كتابه إلى تمهيد، وبابين، وجاء على النحو الآتي:
التمهيد أطال المؤلف فيه، وذكر عددًا من الأمور: ابتدأ بذكر دوافع تأليفه للكتاب، ثم ذكر الإعجاز عند القدماء[6]، وتحدّث عن إحجام الدارسين عن الخوض في الإعجاز، كما تطرق لموضوع وقع الصدمة التجديدية على العربي الأول عند سماع القرآن، وتكلم عن طبيعة التحدِّي مبينًا رفضه لمذهب الصَّرْفة، ثم بيّن بعد ذلك الحجم الحقيقي للإعجاز التجديدي، موضحًا عدم استسلامه لمقولة: «لم يترك الأوّلون للآخرين شيئًا»، ثم قسم بعد ذلك موقف المسلمين من القرآن إلى طائفتين؛ الأولى: وهي الأعمّ أنها تتخذ من القرآن سلوى وبركة. والثانية: هم أهل الإنصات كأنهم يسمعونه أول مرة يتدبرون المعنى ويتفكرون في الآيات، كما شرح الكثافة الإعجازية للمواقع التجديدية، ثم كشف عن رحلته في آلة الزمان شارحًا محاولاته لتملك أُذن العربي الأول، ثم وازن بين المعجم القرآني والمعجم الجاهلي والمعجم النبوي خالصًا إلى الثورة اللغوية الجديدة، ثم ذكر الحدود بين الأعراف والقواعد مبينًا أن القرآن يمهد لتحويل الأعراف اللغوية إلى قواعد، وختم التمهيد ببيان منهج الدراسة.
وأمّا الباب الأول فعنون له بـ: لغة الوحي الجديدة، وذكر فيه سبعة فصول، أوردها المؤلف على شكل ترتِيبي، فذكر في الفصل الأول: الشخصية اللغوية للقرآن الكريم، فبيّن انفراده في تسميته بالقرآن ثم تقسيمه إلى سور، وبيان التجديد في أسماء السور، وأن السور مقسمة إلى وحدات لغوية صغيرة تسمى آيات، وأن لكل سورة مقوماتها الفنية الخاصة بها، والتميز الفني لفواتح السور، والفاصلة القرآنية وأنّ مدار البلاغة فيها ليس الحرف الأخير كما في السجع، إنما النغمة والوزن. وفي أثناء ذلك تعرّض لنظرية النظم عند الجرجاني، وختم الفصل بذكر عشرين خصيصة من خصائص القرآن الكريم.
ثم انفرد الفصل الثاني بعنوان: السبيكة القرآنية، وهو بهذا العنوان يصف تراكيب النظم الكريم بالسبيكة القرآنية، وكشف عن سمة التجديد في السبيكة القرآنية وكثافتها، بينما ظلّت السبائك الشعرية مكرورة على تباعد الحقب الزمانية.
وجاء الفصل الثالث بعنوان: بين السبيكة القرآنية والنبوية والبشرية، وهو من أمتع فصول الكتاب، وازن المؤلف بين آيات القرآن والنصوص التي تتشابه في التراكيب، إلا إنه عند أدنى تأمل تتفرد السبيكة القرآنية على غيرها.
واستعرض في الفصل الرابع التراكيب والتعبيرات القرآنية، وسرد بعض التراكيب اللغوية التي أحدثها القرآن الكريم، وكأنّ هذا الفصل جاء نتيجة لما وازَنه من قبل.
أمّا الفصل الخامس فجاء بعنوان: الألفاظ والأدوات الجديدة، وبيّن فيه المؤلف طبيعة الألفاظ الجديدة التي جاء بها النظم الكريم، والتجديد لبعض الأدوات القديمة.
أمّا الفصل السادس فحمل عنوان: الألفاظ الجديدة في بواكير الوحي؛ سورة المدثر. وبيّن في هذا الفصل الألفاظ الجديدة التي جاءت في سورة المدثر، وهي سورة مكية عدد كلماتها 256 كلمة، لا تقل ألفاظها الجديدة عن 84 كلمة، إضافة إلى عشرات التراكيب والسبائك اللغوية والصور البلاغية الجديدة، والعبارات المنفتحة وجوامع الكلم.
وعرض في الفصل السابع العلاقات اللغوية الجديدة، وبيّن في هذا الفصل التجديد في العلاقات اللغوية بين الألفاظ والعبارات.
بينما جاء الباب الثاني بعنوان: البلاغة القرآنية الجديدة، اهتم المؤلف ببيان بعض صور البلاغة من علمي البيان والمعاني، وساق في هذه الباب أربعة فصول، جاءت على النحو الآتي:
الفصل الأول: البناء الجديد للصورة القرآنية، وذكر في هذا الفصل الصور القرآنية التي لم تجئ في كلام العرب مع أنها مستمدة من بيئاتهم، مما أحدث علاقات متطورة وبعيدة الأطراف من شأنها أنْ وسّعت الخيال وكاثرَت العلاقات ونوّعتها.
وجاء الفصل الثاني بعنوان: الفن القرآني الجديد؛ الالتفات، ذكر فيه أنّ الالتفات في القرآن تمثَّل بصورة لم تُعرف في الأدب العربي، كونه ظاهرة فريدة؛ فذكر التفات المشهد، والتفات الشخصيات، والتفات الحدث، والتفات الزمن، والتفات الجنس، والتفات العدد، والتفات العاقل وغير العاقل، والتفات النصب، والتفات الحذف والإثبات. وهو بذلك يشير إلى أن الأقلام ما زالت بعيدة عن تناول هذه الظاهرة.
أمّا الفصل الثالث فجاء بعنوان: اللغة المنفتحة في القرآن الكريم، فذكر فيه المرونة التي تتمتع بها اللفظة القرآنية في تراكيبه مما يعدد لها الاحتمالات.
وختم الكتاب بالفصل الرابع بعنوان: جوامع الكلم، وهو الفصل الأخير الذي ذكر فيه بعض الآيات التي تجدها دائرة على الألسن حتى أضحى غيرُ المسلِم ناطقًا بها؛ كما جاء في قوله تعالى: {إِنْ شَاءَ اللَّهُ}[البقرة: 70]، وقوله تعالى: {إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ}[البقرة: 156]، وقوله تعالى: {بِإِذْنِ اللَّهِ}[آل عمران: 49]، وقوله تعالى: {الْحَمْدُ لِلَّهِ}[الفاتحة: 2]، وقوله تعالى: {تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ}[ هود: 56]، وقال تعالى: {مَا شَاءَ اللَّهُ}[الكهف: 39][7].
هدف الكتاب، ومنهجه:
أولًا: هدف الكتاب:
بيّن المؤلف في مقدمة كتابه أن الهدف من الكتاب هو: أن يأخذ بيدي القارئ ويزيل عنه الأُلفة التي تقتل قدرته على رؤية الإعجاز اللغوي، ويحاول أن يقربه إلى الأُذن العربية الأولى التي تلقّت الوحي، فيلبس القارئ نظّارات جديدة يمدّه بها ليعيد نظره في الإعجاز من خلال الأسرار اللغوية والبيانية، ويفتح له الآفاق من خلال ما سيذكره المؤلف عن إعجاز القرآن الكريم في ثنايا بابَي الكتاب وفصوله[8].
ثانيًا: منهج الكتاب:
لم يصرح المؤلف ببيان المنهج الذي استعان به، إلّا أنه من خلال قراءة كتابه يتضح للقارئ أنه استعان بالمنهج التحليلي المقارِن، الذي يقارن ويوازن بين الآيات القرآنية وغيرها من النصوص، ساعده في ذلك الموسوعة الضوئية الإلكترونية التي حَوت الأحاديث النبوية الشريفة، والدواوين الشعرية للعرب، كما استعان ببعض الأمثلة المأخوذة من لغتنا اليومية؛ وصولًا إلى تذليل ما يصعب شرحه من غوامض المواقع القرآنية الجديدة، وإبراز جِدَتِها ومخالفتها لما سبقها من تقاليد وأعراف كانت تحكم اللسان العربي قبل القرآن[9].
الإشكاليات الرئيسة للكتاب وتخلقها:
تتمحور إشكالية الكتاب حول الرؤية النقدية التي قدمها المؤلف وكشف فيها عن رأيه في طرائق كتابات علماء التراث عن موضوع الإعجاز، حيث يرى أن اللغويين الغربيين لو اتبعوا مناهج المسلمين في إثبات الإعجاز اللغوي للقرآن الكريم لقادهم ذلك إلى إثبات أنّ عباقرة مثل شكسبير أو دانتي أو روسو هم أيضًا آلهة[10]، وجاء تقسيمه للإعجاز عند القدماء على ثلاثة جوانب:
أولًا: الجانب الجمالي أو البلاغي: وهو ما عناه في الكلام السابق، أن ليس هناك حدود للظواهر البلاغية التي نستطيع أن نضع يدنا فيها على الإعجاز، حيث يرى المؤلف هلامية الحدود بين ما جاء في كلام البلاغيين عن نظم القرآن وغيره من النصوص الأدبية، ولم يضعوا حدًّا فاصلًا بين بلاغة النظم الكريم وبلاغة الشعر.
ثانيًا: الجانب التعبيري: حيث ضرب المؤلف مثالًا على ظاهرة متشابه القرآن، ويقصد المتشابه اللفظي، وأنّ تناوُل المفسرين وعلماء المتشابه لم يرتقِ إلى درجة الإعجاز في عين البحث العلمي المجرد[11].
ثالثًا: الجانب العلمي: وهنا يرى المؤلف أن هذا الجانب طُرِق قديمًا، بخلاف ما يدور في الأوساط الثقافية أن الإعجاز العلمي وليد العصر الحديث، واستدل بما ذكر ببعض الجهود القديمة، كما جاء عند الجاحظ، وابن سراقة، والماوردي، والغزالي[12].
وبناءً على ما تقدم من رؤى نقدية، فقد أوجب ذلك على المؤلف أن يقدم قراءة جديدة للإعجاز، وعدم التوقف عند الجهود السابقة، لا سيّما بالطريقة التي قُدّمت بها.
وتلك الإشكالية دفعت المؤلف إلى أن يتناول قضية التجديد من سؤالين نصّ عليهما المؤلف: «أين الجديد في لغة الوحي؟ وماذا أضافت هذه اللغة إلى قاموسنا؟»[13].
واقتضى ذلك عنده أن يتناول التجديد من جانبين، هما: البناء اللغوي الجديد، والبلاغة القرآنية الجديدة، وإصرار المؤلف على أن لفظ الجديد ينطلق من قناعاته بأن القرآن نزل بالعربية وانطلق من قواعدها، وتجاوز اللغة، والقفز فوق محدودية ألفاظها وتراكيبها وسبائكها وصورها وعلاقاتها اللغوية، كما يأتي من تطوير أعرافها، ثم قواعدها، من غير إلغاء هذه القواعد، وفتح الباب لتطور اللغة ونموها ومنحها أبعادًا وآفاقًا أوسع[14].
إنّ المؤلف يقدر للسابقين جهودهم إلا أنّ تناوُلهم للإعجاز -بحسب رأيه- كان يخص إلى حد كبير الجانب البلاغي والجمالي، وهذه صفات قد نجدها على تفاوت في آداب البشر، مهما اختلفت لغاتهم، إضافة إلى ذلك أن الإعجاز كامنٌ في نفوسنا دون عقولنا؛ فكان لا بد من البرهنة على ذلك وبيان أنّ مكمن الإعجاز في لغة القرآن التجديدية[15].
وهذا الرأي إن لم نكن نلامس صراحته عند العلماء إلا أنهم على وعي بذلك، ولا أدَلّ على ذلك مما ورَد عند الرماني، الذي وجّه أحد أوجه الإعجاز إلى نقض العادة فينص عليها: «أنّ العادة كانت جارية بضروب من أنواع الكلام معروفة: منها الشعر ومنها السجع ومنها الخطب ومنها الرسائل، منها المنثور الذي يدور بين الناس في الحديث، فأتي القرآن بطريقة مفردة خارجة عن العادة لها منزلة في الحسن تفوق به كل طريقة»[16]. فتميز المؤلف بأنْ جدّد هذه الفكرة وزاد حسنها بما أورده من تنظير وتطبيق.
وكذلك قول أبي حيان: «ولسنا متعبدين بقول نحاة البصرة ولا غيرهم ممن خالفهم، فكم حُكم ثبت بنقل الكوفيين من كلام العرب لم ينقله البصريون، وكم حُكم ثبت بنقل البصريين لم ينقله الكوفيون»[17]. ومعلوم أن البصريين والكوفيين لا ينقلون إلا أحكامًا لغوية. وإضافة لكلام أبي حيان ذكر الرماني أن أحد أوجه الإعجاز نقض العادة. وسيأتي بيان ذلك.
ومن الممكن أن نقارب وجهة المؤلف هنا مع ما لحظه الدكتور محمد محمد أبو موسى حيث يقول: «وليس بين يديّ كتابٌ واحدٌ من كتب البلاغة والإعجاز أصاب الهدف الذي رمى إليه صاحبه، وقدّم ما ينفع ويقطع الطريق بتحقيق الغاية التي توخّاها، ولهذا تواترت الكتب والجهود في هذين العِلمين الشريفين، وترك كل كتاب من ورائه الباب مفتوحًا يدعو غيره»[18].
وعلى ذلك يمكن أن تُحمل بعض آراء المؤلف على الهمّ المعرفي الذي يشترك فيه علماء الأمة، استرشادًا منهم وتوجيهًا.
وأخيرًا نستنتج من ذلك أن المؤلف حصر وجه الإعجاز في الجانب اللغوي عن طريق التجديد في اللغة، وهو ما حاول أن يثبته بطريق التحليل والموازنة، كما أنه لم ينكر الإعجاز العلمي الذي طرقه قليلًا إلا أن سياق كتابه تركّز على الجانب اللغوي.
وإذا كانت هذه الإشكالية فكيف قاربها المؤلف؟
في ضوء حرص المؤلف على بيان الجديد في لغة الوحي فقد استهل الفصل الأول بعنوان: الشخصية اللغوية للقرآن وما تميزت به من البناء اللفظي والمعنوي الذي لم يكن معهودًا من قبل؛ ليمهد بذلك جوهرة فكرة كتابه، وهو ما عنون له بـ: السبيكة القرآنية، وذلك في الفصل الثاني، والذي أتبعه بالفصل الثالث: بين السبيكة[19] القرآنية والنبوية والبشرية. والحقيقة أن هذه التسمية من ابتكار المؤلف وابتداعه، وعند الرجوع إلى المعجم لاستكناه معنى السبيكة نجد أن ابن فارس ينص على أن «السين والباء والكاف أصل يدل على التناهي في إمهاء الشيء، من ذلك: سبكتُ الفضة وغيرها أسبِكُها سبكًا»[20]. ويزيد ابن منظور بيانًا؛ سبكه أي: «ذوّبه وأفرغه في قالب»[21]، وعلى ذلك فالمؤلف بهذه التسمية يكشف للقارئ أن السبيكة القرآنية هي القالب الخاص والبناء الإبداعي الذي تتشكل فيه آيات القرآن الكريم.
يسير المؤلف كما هو منهجه في الطرح، يوازن ويقارن بغية الوصول إلى بيان الجديد في لغة الوحي، ووضع حدود فاصلة بين نص القرآن وغيره من النصوص وذلك حتى يتمكن من مقاربة إشكاليته من ذكر الجديد في لغة القرآن. وأعرِض هنا فكرته حول مصطلح السبيكة الذي صاغه:
يعرض الكاتب مجموعة من السبائك اللغوية التي جاءت عند مجموعة من الشعراء من مختلف الأزمنة؛ ليبرهن على أنها أشبه بالمقصوصات الكرتونية والقوالب الجاهزة التي يسبك عليها الشعراءُ قصائدهم، وأنها غالبًا ما تتكرر، خصوصًا إذا كان البحر العروضي واحدًا، ومثّل هنا بالسبائك التي جاءت على بحو الطويل.
يقول امرؤ القيس (ت80 ق.هـ)
وليلٍ كموج البحر أرخى سدوله ** عليّ بأنواع الهموم ليبتلي
وعنسٍ كألواح الإران نسأتها ** على لاحب كالبرك ذي الخبرات
ويقول الشنفرى (ت70 ق.هـ)
وخرقٍ كظهر الترس قفر قطعته ** بعاملتين، ظهره ليس يعمل
ويقول حاتم الطائي (ت46 ق.هـ)
وخرقٍ كنصل السيف قد رام مصدفي ** تعسفته بالرمح والقوم شهّدي
ويقول دريد بن الصمة (ت8 هـ)
وخيلٍ كأسراب القطا قد وزعتها ** على هيكل نهد الجزارة مرمد
فهذه الأبيات تبدأ بسبيكة واحدة مؤلفة من خمسة أجزاء في أربع كلمات:
1. مبتدأ، هو المشبه، مجرور لفظًا بواو (رُبّ) التي تسبقه، ثم.
2. خبر هو الكاف التي بمعنى (مثل)، وهذه مضافة إلى:
3. اسم هو المشبه به، وهذا مضافٌ أيضًا إلى:
4. مضاف إليه متمم للمشبه به.
5. ويليها جميعًا فعلٌ ماضٍ مرتبط بضمير يعود على المبتدأ.
واستطاع المؤلف من خلال هذه الفكرة الفذّة أنْ يصل إلى أنّ لكل بحر شعري سبائكه العروضية والنحوية الخاصة به، فالأبيات السابقة جاءت من بحر الطويل وتوافقت في الأبيات كلها السبيكة النحوية[22].
ومن موازناته التي أبداها في كتابه، أنه يضعك أمام عَشْر جملٍ، واحدة منها فقط قرآنية، وأن أيّ قارئ لهذه الجمل لا يحتاج إلى مهارات لغوية حتى يتعرف على الجملة القرآنية، فالجملة القرآنية فيها القدرة الإلهية التي تعرب عن بنائها وتعجز قدرتنا النقدية عن إدراك كنهها، مع سبكها الذي له خصوصيته[23].
وخلص المؤلف في هذا الفصل الماتع إلى أن معظم سبائك القرآن ترِد مرة واحدة لا أكثر، وتظل سبائك القرآن لها سمتها المميز، بخلاف السبائك البشرية؛ شعرًا كانت أو نثرًا، وهذه فكرة فريدة لم يُسبق إليها المؤلف كما سنبين لاحقًا.
بين السبيكة والنَّظْم:
ما كان للمؤلف بهذه الفكرة -وهو يتحدث عن السبيكة القرآنية- أن يتجاوز فكرة النّظْم؛ كون أن فكرة النظم كما مرّ معنا سابقًا هي مدار الإعجاز عند جُلّ العلماء الذين كتبوا في الإعجاز، سواء كان ذلك بلفظ النظم، أو بغيره من الألفاظ، إلا أن الكاتب هنا ينوِّه على أن فكرة النظم عند واضعها الجرجاني، كان معظم إنجازها إثبات قيمة التقديم والتأخير، والفصل والوصل، والإضمار والإظهار، والقطع والاستئناف، وغير من ذلك من فنون البلاغة والفصاحة، وعدم الوقوف عند الجديد في النظم القرآني[24][25].
وفي سياق بحث المؤلف عن الجديد في لغة الوحي، وبعد أنْ بيَّن تميُّـز النسق التركيبي في القرآن الكريم، حاول المؤلف أن يرصد التراكيب البيانية والعلاقات اللغوية أو النحوية التي لم تعرفها اللغة العربية[26]، وحرص ألا تتجاوز الأمثلة التي أوردها ثلاث كلمات، وهي ما أسماها الوحدة اللغوية الصغرى[27]، ومن الأمثلة التي أوردها ووضع بإزائها تعبيراتنا البشرية ليبين لنا المفارقة:
ما جاء تحت عنوان: التراكيب والتعبيرات القرآنية:
قوله تعالى: {مَنْ ذَا الَّذِي}[البقرة: 245]، من الذي.
قوله تعالى: {هَلْ عَسَيْتُمْ}[البقرة: 246]،هل ينتظر منكم.
قوله تعالى: {بَعْدَ إِذْ}[آل عمران: 8]، بعد أن.
قوله تعالى: {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا}[الأنعام: 112]، وهكذا جعلنا.
قوله تعالى: {إِنَّكَ لَأَنْتَ}[هود: 87]، لا شك أنك.
قوله تعالى: {وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا}[هود: 111]، وكل واحد منهم.
قوله تعالى: {وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ}[يوسف: 80]، وقد فرطتم قبل ذلك.
قوله تعالى: {إِنْ كَادَ لَيُضِلُّنَا}[الفرقان: 42]،كاد أن يضلّنا.
وهو بهذه الأمثلة يشير إلى أن هذه التراكيب لم تعرفها العربية، وأنها بعيدة عن استعمالاتنا البشرية، ومع ذلك فقد نجد أنّ مثل هذه التراكيب انسابت في لغتنا، وما يزال الكثير من التراكيب القرآنية مرشحًا للدخول إلى لغتنا[28]. وهي من المواطن التي ينبغي جمعها ودراستها.
وختم الفصل في دراسة فريدة لتراكيب سورة المدثر؛ كون تراكيبها في الغالب لا تزيد عن ثلاث كلمات، وقد حصر المؤلف من خلال عدد آياتها الستّ والخمسين، ما لا يقلّ عن خمسةٍ وستين تركيبًا جديدًا[29].
إذا كانت الفصول السابقة قد عنيت بالتراكيب أو السبائك، فإن الألفاظ لم تَغِب عن رؤية المؤلف في استشراف الإبداعات التجديدية لألفاظ القرآن الكريم، منبهًا إلى أن الألفاظ لم تكن معظمها جديدة كما السبائك، وعقَد فصلًا للألفاظ بعنوان: الألفاظ والأدوات الجديدة، ووضّح المؤلف طبيعة وميزات الألفاظ القرآنية من حيث الجدة بثلاثة أمور:
1. أن يكون اللفظ موجودًا إلّا أنّ وَضْعَه في القرآن الكريم أعطاه معنًى اصطلاحيًّا جديدًا يُفهم من خلال سياقه.
2. أن يكون اللفظ غيرَ موجود لكنّ القرآن الكريم يشتقُّه من جذر موجود ومتداول، فيعطيه من خلال صياغته الجديدة معنًى مختلفًا.
3. ألّا يكون اللفظ ولا جذره موجودَين أو متداولَين أصلًا[30].
ثم ختم الفصل بالاستعمال الجديد لبعض الأدوات واستدل بــ: (كان) و(ما زال)، و(لا) و(هل) و(قد) و(ربما) و(لمـّا) و(أن) و(ما) و(لو) و(لولا) و(كما) و(ثم) و(حاشا) و(لئلا) و(إذن) و(إذا) و(إذ) و(وذلك) و(إلا) و(حتى) و(ما برح) و(ما فتئ) و(صار) و(أمسى) و(بات) و(على) و(إن) و(عن) و(إنّ)[31].
وبعد هذا العرض، وقبل إبداء المزايا والملحوظات على الكتاب، فإني أنصح أخي القارئ بالاطلاع على كتاب المعجزة؛ لِما حفل به من الأفكار والرؤى التي تحتاج لمزيد من المطالعة والتأمل والمدارسة، ولِما اكتنزه الكتاب من تحليلات ومناقشة عميقة لموضوعه.
أبرز مزايا الكتاب:
أولًا: المزايا المنهجية:
1. يُعَدُّ الفصلان الثاني والثالث أبرز ما في الكتاب؛ لأن لُبّ الأفكار الجديدة للمعجزة (السبيكة القرآنية) تمركزت في هذين الفصلين.
2. عُمْق التناوُل للمواضيع وتحريرها بشكل علمي، وظهور الشخصية العلمية المحاوِرة والمستدرِكة.
3. الجدة في الطرح، فالكتاب حوى بعض الإضافات العلمية القيّمة، فقد حضرت مسائل لم يُسبق إليها؛ كمقارنته بين السبائك القرآنية وغيرها من النصوص.
4. حضور الجانب التطبيقي الذي يقوّم التنظير، وإلّا فإن التطبيق المفصّل جاء في الجزء الثاني من الكتاب.
5. استعان المؤلف في أثناء تحليله بالمنهج الإحصائي، فأظهر عددًا من المواضيع التي تفتح الباب للدارسين، أحصيتُها له في هذه النقاط:
- أنّ القرآن الكريم استخدم الفعل الناقص (كان) بمعنى (إنّ)، وجاء هذا الاستعمال بما لا يقل عن 190 مرة. ولا وجود لهذا الاستعمال خارج النظم الكريم.
- جاء النظم الكريم بقوله: (آيات بيِّـنات) في ثمانية مواطن، لكن التعبير بقوله: (آيات مُبيّـنات) لم يجئ إلا مرتين في سورة النور فقط.
- مجيء الفعل (مزّق) بمختلف اشتقاقاته في أربعة مواطن كلها في سورة سبأ.
- أن اللفظ (مستمرّ) على تمييزه ورَد مرتين في سورة القمر.
- مجيء الأداة (حاشا) مرتين، في سورة يوسف فقط.
- مجيء الفعل (استنكف) على ندرة استعماله ثلاث مرات كلها في سورة النساء.
- مجيء الفعل (راغ) ثلاث مرات؛ منها مرتان في سورة الصافات، وكل مرة يتعدّى بحرفٍ مختلف.
- أن التعبير بقوله: (وما الله بغافل عما تعملون) جاء ستّ مرات في القرآن، خمس في البقرة، ومرة في آل عمران، ثم لا يتكرر بعد ذلك[32].
ثانيًا: المزايا الفنية:
1. السبائك من الأفكار التجديدية التي طرحها المؤلف ومن الظواهر التجديدية التي نلحظها عند المؤلف، فإذا كانت السبائك تتميز بسبكها ورصفها على المستوى الإدراكي الحسي، فلا يفوتنا ما تحدثه هذه السبائك من الأثر النفسي الذي تتركه في النفوس، وهذا الوجه أحد وجوه الإعجاز الذي أشار إليه الخطّابي[33]، وهو ما نفهمه ضمنًا في كلام المؤلف.
كما أن هذه الفكرة توقفنا عند كلام الدكتور محمد دراز عندما أراد بيان المعجزة فيقول: «... ستجد اتساقًا وائتلافًا يسترعي من سمعك ما تسترعيه الموسيقى والشعر، على أنه ليس بأنغام الموسيقى ولا بأوزان الشعر، وستجد شيئًا آخر لا تجده في الموسيقى ولا في الشعر»[34].
وفكرة المؤلف فريدة لم يُسبق إليها -بحسب اطلاعي- وقد أكثر المؤلف من الأمثلة الدالة على فكرته، وعرض أمثلة أخرى للسبائك الشعرية الذائعة بين الشعراء على مختلف العصور تحت عنوان: السبيكة الشعرية.
2. خروج المؤلف من دائرة النظم ليقدِّم رؤية جديدة حول لغة الوحي، وهو ما بيّـنه في السبيكة القرآنية، ولتوضيح فكرة المؤلف بشكل جليّ هنا أعرض بيان بعض الفروق بين النَّظْم والسبيكة، وهي نسبية أكثر من كونها حدودًا صارمة:
نظرية النَّظْم | السبيكة القرآنية |
صيغت على شكل منظومة من المفاهيم والعلاقات التي تقدِّم تفسيرًا منطقيًّا منهجيًّا، فارتقت إلى النظرية. | صيغت على شكل مفهوم محدد وفق السياق الذي جاءت فيه (التجديد في لغة الوحي). |
تنظر إلى طريقة تركيب الكلام. | تنظر إلى طريقة سمت الكلام. |
صفات النظم، تشرك الآيات القرآنية بغيرها من النصوص. | لها تميزها وتفردها بما استجد من خصائص لغوية جديدة. |
النظم يُدرك من المتخصص والعارف باللغة. | السبيكة تُدرك ممن ليس له أدنى مهارة باللغة. |
النظم يصلك إلى التفسير والتحليل. | السبيكة تصلك إلى الأثر. |
3. حسن ترتيب الفصول؛ حيث جاء كل فصل في غالب الكتاب في مكانه المناسب له، مهيِّئًا لِما بعده، ونتيجةً لما قبله.
4. لغة الكتاب لغة سهلة قريبة من القارئ، وعلى ذلك نص المؤلف حيث يقول: «... مع محاولتي المخلصة والمستمرة لتقريب لغتي فيها أيضًا من لغة القارئ العادي»[35].
أهم الملحوظات:
أولًا: نقد المؤلف كتابات علماء التراث في موضوع الإعجاز:
إن معرفة السياق المعرفي للمؤلفات من الأهمية بمكان، ومما ينبغي أنْ يُدرك أنّه كلما تأخر السياق الزمني عن المعجزة اشتدت الحاجة إلى البرهنة العقلية التي توافق كل عصر، وعلى هذا فإني لا أميل إلى ما ذكره المؤلف من هلامية حدود الظواهر البلاغية، فإن المؤلفات في إعجاز القرآن الكريم كُتبت في عصور متفاوتة ولم تكن البرهنة لتصل إلى الطريقة التي ينبغي أن تطرح وتصاغ في هذا العصر. هذا، ومما يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار أنّ الانشغال بالاحتجاج لكون القرآن معجزةً غلب على جانب الكشف عن وجوه الإعجاز، فالجهود المذكورة سابقًا يغلب عليها إثبات كون القرآن معجزةً مثل معجزات الأنبياء السابقين، إلّا أنّ الأمر لم يظل على حاله، فقد تحرر منه كثير من المعاصرين إلى البحث والتنقيب عن أسرار وجه الإعجاز[36].
أمّا على الجانب الآخر، فإنه لم يرتضِ الجهود التي كُتِبَت في كُتُبِ متشابه القرآن، ولا ما جاء كذلك من المفسرين، ولعلِّي التمس العذر هنا للمؤلف إن أراد أن يقيس الجهود السابقة بما كتبه في مُؤلَّفِه، نعم نسلِّم بعمق الدكتور أحمد بسام ساعي في كتابه المعجزة، إلا أني أقول إنّ كتب المفسرين مليئة بالبلاغة المسكوت عنها، وأنها تمثل الجانب الأسمى للبلاغة العربية؛ كونها راعت الجانب التطبيقي أكثر من الجانب التنظيري، أمّا ما كُتِبَ في كُتُبِ المتشابه اللفظي فإني لا أتفق مع رأي الدكتور؛ فجهود علماء المتشابه اللفظي من الجهود التي أثرت الدرس البلاغي؛ فعلماء المتشابه اللفظي كانت لهم جهود بارزة في استنطاق النكات البلاغية بين المتشابهات، بما استعانوا به من السياق والملابسات والمقام والمقاصد.
ثانيًا: نقَد المؤلف نظرية النّظْم عند الجرجاني؛ كون أنّ معظم إنجازها إثبات بعض الظواهر البلاغية، ومن هنا يمكن مناقشة الكاتب في رأيه هذا من ناحيتين:
1. يُستحسن معرفة السياق المعرفي الذي جاءت فيه نظرية النظم، فالجرجاني أسّس كتابَيه: الدلائل، والأسرار -في المقام الأول- ردًّا على مَن أحال الإعجاز إلى الألفاظ، وصفحات الكتاب تمتلئ مِن تعريضه بمَن يُحِيل الإعجاز إلى الألفاظ كما هو بين لمن يطالع الكتاب.
2. عنوان الكتاب يدُلّنا على أنّ عبد القاهر لم يضعه لتفسير الإعجاز، إنما يقدّم لقارئه الأدوات والوسائل والمنهج الذي يتم فيه تناول النص القرآني، وأسوق هنا نصًّا لعبد القاهر أبيّن فيه ذلك، يقول الجرجاني: «فينبغي لكل ذي دِين وعقل أن ينظر في الكتاب الذي وضعناه، ويستقصي التأمل لِما أودعناه، فإنْ عَلِمَ أنه الطريق إلى البيان والكشف عن الحجة والبرهان تَبِعَ الحقَّ وأخذ به، وإنْ رأى له طريقًا غيره، أومأ إليه، ودَلّنا عليه، وهيهات ذلك»[37].
ثالثًا: أصدر المؤلف بعض الأحكام التي كانت تحتاج إلى مراجعة ونظر أكبر؛ من ذلك رأيه في العلاقات اللغوية الجديدة، وأقصد هنا التجديد في الفصل والوصل، حيث خرجت اللغة القرآنية الجديدة عن الأدوات اللغوية المعتادة في هذا الباب من مثل: (الواو والفاء وإذ وإن وإنما وقد والضمائر المتصلة) إلى أدوات ربط لم نعهدها من قبل.
ذكر المؤلف مجموعة من الأمثلة ووضع تحت الشاهد خطًّا، وحثَّ القارئ على شحذ ذهنه بأن يستحضر أدوات الربط المختفية، ثم بعد أن ذكر الآيات نص على تقدير وجود الأداة، فيقول: «هذا النوع من الحذف ليس مجرد أسلوب لغوي جديد أضافه القرآن الكريم إلى اللغة العربية فحسب...»[38].
وأسوق هنا آيتين مما أشار إليهما المؤلف:
قال تعالى: {وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آيَةٌ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ}[البقرة: 118].
وقال تعالى: {قُلْ إِنِّي عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَكَذَّبْتُمْ بِهِ مَا عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ}[الأنعام: 57].
فهل لنا أن نقدِّر أدوات للعطف كما طلب المؤلف؟ أم نتساءل لِم فصلت هذه الآيات ولم تجئ أدوات العطف؟
عند النظر فيما وضع المؤلف تحته خطًّا من الآيات لا نستطيع أن نقدِّر أيًّا من أدوات العطف؛ إذ لو قدَّرْنا أيًّا من الأدوات لاختلف المعنى ونَـبَا الثاني عن الأول، بيان ذلك أن الآية الأولى التي أوردها المؤلفُ جاءت في مقام التسلية للنبي -صلى الله عليه وسلم- إزاء ما لقيه من قومه، ففصل قوله: {كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ}؛ لأنها جواب عن مقالة الذين لا يعلمون، وجيء الجواب بالعدول عن توجيه الكلام إليهم؛ كونهم ليسوا أهلًا لأنْ يكلمهم الله، وأنّ أفهامهم لا ترقى لإدراك ما في نزول القرآن من أعظم آيات الله المنزلة عليهم[39]، وعلى ذلك تكون علاقة الثانية بالأولى من شبه كمال الاتصال كما سمّاه البلاغيون[40]، ولو قدّرنا أيّ أداة لفاتت علينا هذه النُّكَت.
أمّا الآية الثانية في سورة الأنعام حيث فصل قوله: {إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ} عما قبلها؛ لأنها في مقام التوكيد، حيث إنّ المشركين طالبوا باستعجال العذاب إنْ كان الرسول على بيِّـنة، فردَّ عليهم الرسول بقوله: {مَا عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ} وأكّد هذا الحكم بقوله: {إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ}[41]. ومعلوم أن العطف يفيد المغايرة، ولا مغايرة هنا لكمال الاتصال بين الجملتين، وهذا ما يسمى عند البلاغيين بكمال الاتصال[42].
والحقُّ أنّه بالرجوع إلى باب الفصل والوصل الذي وضعه البلاغيون تظهر لنا أسرارٌ بديعة ونكاتٌ عظيمة للنظم الكريم. إلّا أنّ المـُكنة من هذا الباب المهم تحتاج ذوقًا مدرَّبًا، وتمرُّسًا على الأساليب العالية في البيان[43].
رابعًا: خلوّ الكتاب من خاتمة يُجمِلُ فيها المؤلف أبرز نتائجه ويضمُّها في موطن واحد، فالجهد المبذول في الكتاب يحتاج التتويج والتثبيت.
لا شك أن هذه الملحوظات لا تغضُّ من قيمة الكتاب، كما أننا يمكن أن نقول من باب الإثراء أن المتأمل في طريقة تكوين الألفاظ الجديدة، يهديه ذلك التأمل إلى كلام ابن تيمية عن الألفاظ، حيث أشار إلى أن الكلمة تأخذ معناها من سياقها، فالمعنى تحكمه قوانين الإضافة والتقييد ونسبية الخطاب وتداوليته[44]، فإذا كانت الكلمة تحتمل أكثر من معنى فإن السياق هو الذي يضبط المعنى ويسيره وفق المقام الذي ورَد فيه، ونلحظ أن معاني الأدوات التي ساقها المؤلف كان للسياق الدور البارز في إضفاء المعاني الجديدة لها، وبهذا يمكننا أن نقارب فكرة المؤلف ونصوغها بطريقة أخرى، هي أنّ تكَوُّن معانٍ جديدة للألفاظ القرآنية ينبع من تفرُّد السبائك القرآنية وتشكُّلها الإبداعي[45].
خاتمة:
انتهت بنا هذه القراءة إلى بيان شيء من الجهد الذي بذله المؤلف، والآراء التي طرحها، والتي تُضم إلى الجهود المقدّمة من تراثنا، وأحسب أنه كشف عن جوانب جديدة في موضوع الإعجاز، تفرَّد فيها، ففتح بذلك أبوابًا للمشاريع العلمية والأفكار البحثية التي نطمح من خلالها إلى النظر في موضوع الإعجاز من زوايا أخرى، كما أن المؤلف أدرك روح عصره واحتياجه المعرفي، فإخاله فتَح الآفاق، وكسَر الأقفال، فمنذ كتاب دراز (النبأ العظيم) لم تظهر دراسات تقدِّم جديدًا في موضوع الإعجاز، وهذا الدكتور أحمد بسام ساعي -وفقه الله- يطالعنا بكتابه المعجزة، فيقدِّمه للقارئ غير المختص، بأسلوب سلس، وعبارة واضحة مبينة عن مقصوده، وكذلك للقارئ المختص بمكاشفة أفكاره ومباحثة مشاريعه التي ضمنها في كتابه. أرجو أن تكون هذه القراءة محرِّضة ومحفِّزة على النظر في كتاب المعجزة بجزأيه.
هذا، واللهُ أجَلُّ وأعلمُ، وصلى اللهُ على نبينا محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين.
[1] الجزء الثاني هو الجانب التطبيقي من الكتاب، وعنوانه: (المعجزة إعادة قراءة الإعجاز اللغوي في القرآن الكريم، لغة الإعجاز في الفاتحة وقصار السور) والكتاب مكوّن من: 576 صفحة.
[2] أخذت النبذة التعريفية للمؤلف من كتاب المعجزة نفسه.
[3] ينظر: مباحث في إعجاز القرآن لمصطفى مسلم: ص40. دار التدمرية، الطبعة الأولى، 1432هـ.
[4] سميت رسالة لصغر حجمها.
[5] ينظر: دلائل الإعجاز للجرجاني: ص81. تحقيق: محمود شاكر، دار المدني بجدة، الطبعة الثالثة، 1413هـ.
[6] سيأتي بيان هذه النقطة وأثرها في تأليف الكتاب فيما يلي.
[7] المعجزة: ص333.
[8] المعجزة: ص39، 63.
[9] المعجزة: ص57.
[10] المعجزة: ص27.
[11] المعجزة: ص28.
[12] المعجزة: ص29.
[13] المعجزة: ص62.
[14] المعجزة: ص89.
[15] المعجزة: ص24.
[16] ثلاث رسائل في إعجاز القرآن، النكت في إعجاز القرآن: ص111.
[17] البحر المحيط في التفسير: (3/ 500).
[18] الإعجاز البلاغي، للدكتور محمد محمد أبو موسى: ص156. مكتبة وهبة، الطبعة الثانية، 1418هـ.
[19] وردت لفظة (السبك) قديمًا في أوصاف متعددة، منها: حسن السبك، وجودة السبك، وسلامة السبك،... وقُصد من ذلك ترابط النص وتلاحم أجزائه وتماسكه، كما أنها انحصرت غالبًا في التركيب الإضافي، بخلاف ما قدّمها لنا المؤلف، حيث توسع معناها وانفتحت دلالتها أكثر، وأسبغ عليها المؤلف طابع فكرته، وعلى مستوى الصيغة جاءت صفة مشبهة.
[20] مقاييس اللغة: باب السين، مادة سبك: (3/ 129).
[21] لسان العرب: باب الكاف، فصل السين المهملة: (10/ 438).
[22] ينظر: المعجزة: ص118 وما بعدها.
[23] المعجزة: ص149.
[24] المعجزة: ص87.
[25] سأرجئ مناقشة الكاتب في هذه النقطة في (الملحوظات).
[26] اقترح المؤلف في بداية الفصل إلى الحاجة إلى دراسة ما دخل في العربية وما لم يدخل من تعبيرات وتراكيب لغوية قرآنية، ونقوم برصدها وجمعها وتصنيفها لنحصل على معجم فريد يسدّ ثغرة كبيرة، وهو بهذا يوضح وجود ثغرة في معرفة التطور التاريخي للغة العربية بإمكاننا حلّها. ينظر: المعجزة: ص170.
[27] المعجزة: ص171.
[28] المعجزة: ص179.
[29] المعجزة: من ص181- 184.
[30] المعجزة: ص189.
[31] المعجزة: من ص199- 207.
[32] المعجزة: ص78 و79.
[33] بيان إعجاز القرآن: ص82. تحقيق الدكتور: يوسف بن عبد الله العليوي، دار التوحيد للنشر، الطبعة الأولى، 1439هـ.
[34] النبأ العظيم؛ نظرات جديدة في إعجاز القرآن، للدكتور محمد عبد الله دراز: ص87. المكتبة الوقفية، الطبعة الثانية، 2013م.
[35] المعجزة: ص62.
[36] وصف القرآن بالمعجزة، للدكتور إبراهيم التركي: ص131. دار كنوز إشبيليا، الطبعة الأولى، 1439هـ.
[37] دلائل الإعجاز: ص40.
[38] المعجزة: ص225.
[39] ينظر: التحرير والتنوير: (1/ 689).
[40] شبه كمال الاتصال: هو أن تكون الجملة الثانية جوابًا عن سؤال يُفهم من الأولى، فيتم الفصل كما يتم الفصل بين السؤال والجواب. ينظر: الإيضاح في علوم البلاغة: (1/ 3/ 97).
[41] ينظر: التحرير والتنوير: (7/ 268).
[42] كمال الاتصال: هو اتحاد الجملتين اتحادًا تامًّا، بحيث تكون الثانية مؤكدةً للأولى، أو موضحةً لها، أو بدلًا منها.
[43] يُعَد باب الفصل والوصل من أدق أبواب البلاغة وأخفاها، ومن المراجع القيّمة في هذا الباب، كتاب: الواو ومواقعها في النظم القرآني، للدكتور محمد الأمين الخضري. مكتبة وهبة، الطبعة الأولى، 1436هـ.
[44] ينظر: الأبعاد التداولية لنظرية المجاز عند ابن تيمية، للدكتورة فريدة زمرد: ص528. مركز تفسير للدراسات القرآنية، الطبعة الأولى، 1436هـ.
[45] لا أقصد هنا تحديدًا إنكار الوضع الأول للكلمات، لكن حاولت أن أقارب الفكرة وأزيدها بيانًا وإيضاحًا. ومن المراجع التي أرشّحها للنظر في رأي ابن تيمية إضافةً إلى المرجع السابق، كتاب: إنكار المجاز عند ابن تيمية رحمه الله؛ عرض ودراسة، للدكتور: إبراهيم بن منصور التركي. دار كنوز إشبيليا، الطبعة الثانية، 1439هـ.
كلمات مفتاحية
الكاتب:

محسن بن علي الشهري
حاصل على الدكتوراه من كلية اللغة العربية بالجامعة الإسلامية، وله عدد من الأعمال العلمية المنشورة.
مواضيع ذات صلة
((المعلومات والآراء المقدَّمة هي للكتّاب، ولا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع أو أسرة مركز تفسير))
.jpg)