منهج تفسير القرآن في فضاء القراءة الحداثية
بين قطعيات حقائق الوحي المأصولة وسياقية مناهج النظر الحداثية المنقولة

مقدمة:
كثرت منذ عقود الدراساتُ المتعلقةُ بالنصّ القرآني في فضاء الفكر الإسلامي المعاصر، خصوصًا بعد توالي نقل المناهج الحداثية المتعلقة بالنصّ الديني؛ سواء كانت تاريخية أو ألْسنية أو سميائية أو اجتماعية أو نفسية أو غيرها. وقد اعتبر كثيرٌ من أهل إعادة النظر في النصّ القرآني، أن تلك العدّة المنهجية المنقولة عن الدراسات الحداثية الغربية، صالحة للاستناد إليها لتقديم قراءة تأسيسية جديدة لآيات النصّ القرآني، مع أنهم لم يراعوا ما احتفّ بها من نواظم الإنشاء ومسارات التحوّل. الأمر الذي أفضى إلى مصادمة جملة من قطعيات حقائق نصّ وحي القرآن، خصوصًا تلك الخصائص النصيّة، التي تشكّل إنّية/ ماهيّة النصّ القرآني؛ كمحدّد الوحي، محدّد الحفظ، محدّد التصديق والهيمنة، محدّد الخاتمية، محدّد العالمية، محدّد الإحكام، محدّد الكمال والتمام، محدّد البيان المبين، ونحوها، التي اعتبرت في تاريخ التفسير الإسلامي من أهم ما يتأسّس عليه منهج تفسير آيات القرآن. في هذا الحوار الذي نجريه مع الأستاذ/ سالم زنو، المنشغل بالدراسة المقارنة بين منهج التفسير الإسلامي والنظر الحداثي في نصّ وحي القرآن نقارب جملة من معالم هذين الاتجاهين في تفسير نصّ وحي القرآن في تاريخ التفسير والقراءة، وقد جاء حوارنا معه على ثلاثة محاور؛ المحور الأول: تفسير آيات القرآن في سياق التاريخ الإسلامي، ومدى مراعاته لقطعيات حقائق الوحي ومقتضياتها في النظر التفسيري، ونتناول فيه تفسير القرآن في التاريخ الإسلامي في مرحلته الأولى النبويّة أو لاحقًا في مراحل التأسيس بعد عصر الصحابة، ونتساءل عن مدى مراعاته قطعيات الوحي كمحدّدات في التفسير. المحور الثاني: القراءات الحداثية لآيات القرآن ومأزق الاختيار المنهجي بين الاحتكام إلى قطعيات حقائق الوحي المنزّل والمناهج التأويلية الحداثية الغربية، نتناول فيه الاشتغال الحداثي المعاصر على القرآن والمناهج التي يستند عليها والحقول المعرفية التي يمتح من مَعِينها، ومدى مراعاة هذا لقطعيات الوحي ومحدّدات تفسيره. ونختم بالمحور الثالث: القراءات الحداثية لآيات القرآن، وحدود الاستفادة منها في بناء منهج النسق التفسيري المعاصر وفق معيار تحكيم قطعيات حقائق الوحي، والذي نتناول فيه أُفُق الاستفادة من المنهجيات المعاصرة في بلورة رؤية منهجية تجاه النصّ تظلّ محتكمة لمحدّداته الخاصّة.
وفيما يلي نصّ الحوار:
نَصُّ الحوار
المحور الأول: تفسير آيات القرآن في سياق التاريخ الإسلامي ومدى مراعاته لقطعيات حقائق الوحي ومقتضياتها في النظر التفسيري.
س1. في سياق التأصيل لبدايات تأسيس منهج تفسير القرآن، يرجع النظّار ذلك إلى أن القرآن يعدُّ تفسيرًا للقرآن، بالنظر إلى أنه موصوف بــ{المُبِين}[1]. فيكون بالتّبع المحدّد الأساس هو الوحدة البنائية بين آيات القرآن كلّها. لو تحدّدون لنا هذا المنحى في تفسير القرآن، مع بيان كيف يمكن استثماره في تأسيس منهج التفسير الذي يعصم من الزيغ والانحراف في النظر والعمل، ويكشف في المقابل عن الدلالات السياقية الموضوعية لآيات القرآن.
أ/ سالم زنو:
تكرر ورود وصف: {المبين} في العديد من آيات القرآن؛ سواء تعلق بـ{لسان} القرآن كما في قوله تعالى: {بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ}[الشعراء: 195]. أو تعلّق بمختلف محمولات آيات القرآن، بالنظر إلى أنها تضم بمسلك الإجمال أو التفصيل «بيان» و«تبيان» كلّ شيء، كما في قوله تعالى: {وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ}[النحل: 89]. ويمكن فهم هذا التلازم بين وصف الأداة ووصف المضمون بــ(البيان)، بالنظر إلى أن فقه المضمون يتوقّف على فقه اللسان. وبهذا الاعتبار، يظهر تهافت مقولة تفسير آيات القرآن بغير معهود اللسان الذي نزل به زمن النبوّة والنزول. وفي هذا السياق، أسَّس الشافعي في الرسالة والشاطبي في الموافقات وغيرهما بناءً على مجموعة من المرتكزات المنهجية والمعرفية[2] =أنه لا مدخل للتفسير المعتبر لآيات القرآن بدون معهود (اللسان العربي). ولكن هذا لا يقتضي ألبتة كون آيات القرآن تابعة لمعهود اللسان العربي زمن النزول، إذ بحكم معيارية وتعالي آيات القرآن، فهو يخضع لها ولا تخضع له، وإلا فقدت تعاليها وتجرّدها عن التاريخي المتعين، بوصفه محددًا منهجيًّا قاطعًا.
إنّ مراعاة هذا المنهج في تفسير آيات القرآن، القائم على أنّ القرآن محدّد نصًّا بـ(البيان) و(التبيان) =من شأنه أن يضع المعالم الأساسية لمنهج التفسير المرضي في الباب، ومن أهمها على سبيل التمثيل: كون آيات القرآن مكتفية بذاتها على مستوى بيان الدلالات وإنشاء الأحكام، ولا يمكن تحديد ما ورد فيها من خارجها إلا إذا تعذّر ذلك، ويستثنى من ذلك (البيان النبوي)، إذ هو ملازم للبيان القرآني من حيث الوصف بـ(البيان) و(التبيان)، كما في قوله تعالى: {وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ}[النحل: 44]. وفق هذا المنحى، تأسّست في فضاء التفسير التراثي مقولة: «القرآن يفسِّر أو يَشرح بعضُه بعضًا»؛ إِذْ ما أُجْمِل في آية فُصِّل في أخرى، وما ورَد عامًّا في سياق خُصِّص في آخر، وما ورد مطلقًا في موطن قُـيّد في آخر وهكذا. ومن شأن مراعاة هذا المنهج أيضًا، أن يقلّل من اللجوء إلى مختلف المُعِينات الخارجية؛ إِذْ هي بطبيعتها محمّلة، إلا إذا تعذّر تحقيق البيان بالقرآن أو بالسُّنة، مع تحقّق صحتها واعتبارها في الباب، فضلًا عن تعطيل المسبقات، مذهبية كانت أو تاريخية أو نحوها، إذ ذلك يفضي إلى جعل النصّ القرآني تابعًا لا متبوعًا، فتتعدّد أوجه التلاعب بدلالاته وأحكامه.
في سياق التحديد المنهجي والمعرفي، يقول أبو الطيب مولود السريري: «يلزم أن يؤخذ في الاعتبار أن هذه النصوص (نصوص الكتاب والسُّنة) قصد الشارع بها بناء الدّين الإسلامي، ولهذا كان بين هذه النصوص بعضها وبعض علاقة تأثير وتأثر، وهذا التأثّر والتأثير قد خصّه علماء الأمة بطرفٍ من اهتمامهم وجهدهم الفكري والبحثي والنظري... قلنا إن هذه النصوص بينها علاقة تأثير وتأثر، فبعض منها مقيد لبعض منها، وبعض منها مخصص لبعض (...) فلزم في بناء الأحكام الفقهية (=الاجتهاد) وفي تفسير هذه النصوص وقراءتها، مراعاة ذلك العمل بمقتضاه، فإنْ ترك ولم يعمل به، كان ذلك مسلكًا مفضيًا إلى الإتيان بنتاج معرفي في هذا الشأن ساقط...»[3].
س2. كما ألمحتم في جوابكم، فإنّ الناظر في تأسيس منهج تفسير القرآن لا غنى له عن (البيان النبوي) للقرآن؛ إِذْ إن الرسول -عليه الصلاة والسلام- لم تقتصر مهمته على (التلقِّي) و(التبليغ)، بل شملت أيضًا (البيان) و(التبيان)[4]. بالنظر إلى أن وحي (البيان النبوي) لا يقلّ عن وحي آيات القرآن، كيف تجلّت في نظركم هذه الحقيقة في (البيان النبوي)، فضلًا عن ظهور الوحدة القرآنية في (البيان النبوي)؟
أ/ سالم زنو:
لا أحد ينكر دور وفضل السُّنة النبوية في علاقتها بآيات القرآن، باعتبارها الموضحة والمفسّرة، وكونها مدخلًا رئيسًا لبيانه البيان الأمثل، إلا ما كان من بعض الاتجاهات التي اختصت بالدعوة إلى الاكتفاء بالقرآن عن (البيان النبوي) بتبريرات متهافتة، ذلك أن النبي -عليه الصلاة والسلام- بيّن الكثير من الآيات التي أُشكلت على الصحابة -رضي الله عنهم-؛ وفي المقابل، حثّ ذوي النباهة منهم على الاجتهاد والاستنباط كما فعل -عليه الصلاة والسلام- مع سيدنا معاذ بن جبل لمّا أرسله قاضيًا إلى اليمن.
إنّ دعوى الاكتفاء بالقرآن دون السُّنّة في علاقتها به، دعوى ليس لها أيّ أساس علمي موضوعي معتبر في الباب؛ سواء بالنظر إلى المنطلقات والمآلات، أو بالنظر إلى تحكيم محدّدات القرآن، وتفصيل القول في بيان تهافت هذه الدعوى لا يسمح به المقام. والناظر في تاريخ الفكر الإسلامي يجد أن أهل الشأن قد أحصوا وجوهًا عديدة في علاقة السُّنة بالقرآن، أغلبها متعلقة بناظم (البيان). ولكن الذي يهمنا في هذا الصدد رأسًا هو التأكيد على أن الرسول -عليه الصلاة والسلام- في جملة من البيانات الصادرة عنه، تأسّس هديُه على كون آيات القرآن بيانًا لبعضها بعضًا، باعتبار ذلك أهم محدّد منهجي في تفسير أو قراءة آيات القرآن. ذلك أن من أهم ما يسهم في تحرير آيات القرآن من (أزمة الفهم) بوجهه غير المعتبر، اتباع (البيان النبوي لآيات القرآن) لـ(كماله) و(عصمته) بعد صحته، ليس في نماذجه الواردة في الباب فحسب، وإنما في تحديد روحه المنهجية ومحدّداته المعرفية الكامنة، والسعي في سبيل الاسترشاد بها على الوجه المعتبر، لفقه (البيان القرآني)؛ ولتقريب المعنى، نمثل لذلك بالحديث الآتي: عن عبد الله قال: لمّا نزلت هذه الآية: {الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ}[الأنعام: 82]. شقّ ذلك على أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وقالوا: «أيُّنا لم يَلبِس إيمانَه بظُلم»، فقال رسول الله -عليه السلام-: «إنه ليس بذاك، ألا تسمع إلى قول لقمان لابنه: {إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ}»[لقمان: 13][5].
يبيّن النصّ أنّ الصحابة زمن النزول قد أشكل عليهم فهم آية سورة الأنعام؛ بوصفها تحدّد الشرط، وما يترتب عنه من جزاء، فإذا لم يتحقّق الشرط -الذين آمنوا ولم يَلبِسوا إيمانهم بظلم- لم يتحقق بالتبع الجزاء -أولئك لهم الأَمْن وهم مُهْتدون-. فأزال (البيان النبوي) الإشكال وسوء الفهم منهجيًّا بربط آية الأنعام بآية سورة لقمان، فعلم الصحابة أن المقصود بـ(الظلم) في الآية ينصرف إلى ناظم (الشرك) العقدي أو الأخلاقي بالمعنى الذي عهدوه زمن جاهليتهم قبل الإيمان بما جاء به الرسول -عليه الصلاة السلام-. وهذا التعامل النبوي، يحمل منهجًا واضحًا لبيان معاني آيات القرآن، ولبّه أنّ القرآن إذا كان يتحدّد بكونه: {مُبِين} كما ثبت نصًّا، فإنّ أولى مناطات تحقّق ذلك، أنه بيان لذاته بذاته. ويدلّ المنهج النبوي في (البيان) أيضًا، على أنّ آيات القرآن وإن اختلفت سياقات ورودها وأزمنة نزولها، إلا أنها تفسّر من خلال ما يسمى بمنهج (التفسير الموضوعي)، بالنظر إلى الوحدة أو النسق البنائي لآيات القرآن، كما تأسّست معالم ذلك في رحاب التفسير التراثي بمختلف مصادره المتنوعة.
س3. من المعلوم أن التأسيس التراثي لمنهج التفسير اعتمد على مجموعة من المداخل المنهجية، والتي اعتُبرت محدّدات منهجية قرآنية صريحة، نُورد منها: تفسير القرآن بالمعهود العربي، تفسير القرآن بأسباب النزول، تفسير القرآن بالناسخ والمنسوخ، تفسير القرآن بالمأثور الثابت. في نظركم، إلى أيّ حدّ يمكن اعتبار هذه المداخل المنهجية من باب القطعيات المطلقة للوحي المنزل لتحقيق التفسير المرْضي؟ وما المعيار الحاكم لمتجلياتها في المتون التفسيرية؟
أ/ سالم زنو:
ما حددتم في السؤال، هي جملة المداخل المنهجية التي تأسّست أكثر وتوطّنت في مختلف الاجتهادات التفسيرية في تاريخ الفكر الإسلامي، المنبثقة في الأصل عن الروح التأسيسية منهجيًّا ومعرفيًّا، ابتداء على الأقلّ مع فرادة اجتهاد عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما-، خصوصًا في أجوبته على مسائل ابن الأزرق كما هو معلوم، المتعلقة ببيان آيات القرآن من خلال إيراد معهود الكلام العربي زمن النبوّة والنزول، وتوالي ذلك النظر في مختلف مراحل التأسيس المنهجي في التفسير، منذ اللمسات الجنينية الأولى للصحابة -رضي الله عنهم- في التعامل والتفاعل مع آيات القرآن بعد اكتمال التنجيم.
تعدُّ تلك المداخل المنهجية للتفسير من حيث التحديد، منبثقة في الأصل الأول من آيات القرآن؛ سواء تعلقت بمراعاة المعهود العربي في التفسير، أو أسباب النزول، أو الناسخ والمنسوخ، أو التفسير بالمأثور عن الرسول -عليه الصلاة السلام-؛ إذ كانت في عمومها متأسّسة على ما حدّده القرآن من منطلقات ومحدّدات ومعايير. ولبيان ذلك، نسوق الكلام عن (مدخل مرويات أسباب النزول)، بالنظر إلى دورها في فهم وتفسير آيات القرآن؛ إِذْ من المعلوم أنه قد ثبت نصًّا في القرآن على مستوى الحدّ، أنه يعدّ مجموعة (آيات) استغرق نزولها مدّة ثلاث وعشرين سَنة على القول المختار في الباب، موزّعة بين (العهد المكي) و(العهد المدني)، إِذْ هي قد تمّ إنزالها وفق سُنّة التدرج، عكس ما سبق من آيات ومقاطع النصوص الدينية السابقة، كما هو منصوص عليه في العديد من الآيات القرآنية، منها قوله تعالى: {وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا}[الفرقان: 32]، وقوله سبحانه: {وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا}[الإسراء: 106].
بناء على هذه الخصيصة القرآنية، كانت للعديد من آيات القرآن أسبابُ نزول مصاحبة في العهدين معًا، ومن مقتضيات المنهج في هذا الباب، أنّ التعرف على مرويات أسباب النزول بعد ثبات صحتها، يساعد على تفسير آيات القرآن على وجهها الأمثل المعتبر، دون تقوّل ولا نسف لها عن السياق، فإنّ (العلم بالسبب يورث العلم بالمسبّب). والتلازم بين الأمرين لا يعني أنّ الآيات منحصرة في أسباب نزولها لا تتعدّاها، وإنما مرويات النزول لا تتعدى نماذج للتمثيل للآيات، وإلّا فهي متعالية عليها ومستغرقة لها ولمثيلاتها وغيرها، وفق القاعدة المحدّدة في الباب، وهي: «أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب»؛ درءًا لآفة الحصر والقول بالتاريخية. في هذا السياق المنهجي يقول ابن تيمية: «والآية التي لها سبب معيّن، إذا كانت أمرًا أو نهيًا، فهي متناولة لذلك الشخص ولغيره ممن كان بمنزلته، وإن كان خبرًا بمدح أو ذم، فهي متناولة لذلك الشخص ومن كان بمنزلته»[6].
نفس الأمر ينسحب على (الناسخ والمنسوخ)، إذ القول به في الأصل يرجع إلى كون آيات القرآن تنزّلت مفرّقة ولم تنزل دفعة واحدة، فاقتضى الأمر تعلّق النسخ بها بمختلف أوجهه المعتبرة في الباب؛ سواء تعلق (النسخ) بالتربية وإعداد مسالك الكمال الإيماني والأخلاقي للناس، أو تعلّق بالتخفيف ورفع الحرج والمشقة عن المكلَّفين تيسيرًا عليهم مراعاةً لأحوالهم، ونحو ذلك.
س4. من أهمِّ حقول الاجتهاد التراثي التي خلّفت اجتهادات تفسيرية عديدة ومتنوّعة حقلُ (علم الكلام)، بصرف النّظر عن مذاهبه وفِرَقه؛ إِذْ كان من أهم ما استند إليه في التفسير اتّباع مسلك (التأويل) بدلالاته المعهودة مع المتأخّرين؛ سواء كان اتّباعه صراحة أو ضمنًا. من منظوركم، ما جدوى هذا المنهج في تفسير النصّ القرآني؟ خصوصًا إذا استحضرنا بعض قطعيات حقائق الوحي؛ ككون القرآن «تبيان» و«بيان مبين»، فضلًا عن خوض (علم الكلام) في قضية (خَلْق القرآن)، وعموم ما يتعلق بالله تعالى من (غيبيات) يعجز العقل عن إدراك ماهياتها.
أ/ سالم زنو:
نستحضر في مقام الإجابة عن هذا السؤال العواملَ الداخلية لنشأة (علم الكلام)، والتي يرجع بعضها إلى النصّ الشرعي ذاته، من حيث دلالاته التي يقدّمها حول مسائل الاعتقاد التي تندرج ضمن مباحث (علم الكلام) وقضاياه، وخاصّة ما تعلّق منها بـ(السمعيات) أو (الخبريات)؛ كالأسماء والصفات، والملائكة والجنة والنار، وطبيعة التعامل مع النصوص الواردة بشأنها، وتفسير الخفي والمتشابه منها، ونحو ذلك، فضلًا عن جملة المستجدات التي انبثقت على إثر التفاعل الثقافي مع المخالف في التصوّر والاعتقاد، من مختلف الثقافات الوافدة بفضل التلاقي والتفاعل قبل وبعد عهد الترجمة المؤسسي.
ثم إنّ دين الإسلام لمّا جاء بأحكام عقدية تنتظم ما ينبغي أن يعتقده المسلم في الله -سبحانه وتعالى- وأسمائه وصفاته وأفعاله، والنبوّة والمعاد ونحوها =لم يجد الساحة خالية من أفكار وتصوّرات حول هذه المفاهيم الكلية الشاملة، وإنما وجد عقائدَ وأفكارًا تنتمي إلى تراث ديني سابق له، كان يمثّل وحيًا أو مرجعية موجهة للفكر الإنساني وحركته في الكون والحياة، وربط علاقته بالإله الحقّ المتصرّف فيه، وقد احتدم الجدال بين العلماء من المسلمين والرهبان ورجال الدين المسيحي حول الكثير من المفاهيم والتصوّرات ذات الطابع العقدي، ونشأت نتيجة لذلك عدّة موضوعات كلامية، بل إنّ أهم مشكلة في (علم الكلام) قد انبثقت من هذا الخلاف، وأعني مشكلة (خَلْق القرآن)، علاوة على أحبار اليهود ومختلف أهل الديانات الوضعية ذات التوجّه التشبيهي التجسيدي في علاقة الإنسان بالإله. وفي سياق الجدل الإسلامي المسيحي، أجمع المسيحيون على أنّ كلمة الله في دلالتها على السيد المسيح قديمة، وهذا يعني أنها تشارك الله في الألوهية، أمّا المسلمون -فتأكيدًا على إنسانية المسيح- قد أنكروا (قِدم كلمة الله) في دلالتها على المسيح، ثم انتقل البحث إلى كلام الله بوجهٍ عامٍّ.
إنّ (علم الكلام) من هذا المنظور لم يكن وليدَ ترفٍ فكري واتباع هوى، ورغبة في اقتحام النهي الوارد بشأن الجدال والمراء في الدّين، والخوض فيما أمسك فيه السلف من الغيبيات أو من المتشابه، وإنما ظهر كباقي العلوم الإسلامية التي انبثقت عن القرآن الكريم وتفرّعت عنه، ودعت إليها الضرورة العلمية والفكرية، لاستمرار الدين على حقيقته مصونًا من التحريفات وأباطيل وشبهات المغرضين، حيث نجد القرآن الكريم الذي هو الأصل الذي تفرّعت عنه العلوم الإسلامية بكلّ أصنافها يعرض -إجمالًا أو تفصيلًا- لكثير من القضايا التي تعتبر النواة والأساس والمنطلق الأول لـ(علم الكلام). إلا أنه في العديد من اجتهادات بعض المدارس والمذاهب الكلامية، خصوصًا في بعض مراحل زيغها المنهجي والمعرفي، أن أصحابها أطلقوا أعنّة العقل فيما لا يمكن للعقل أن يدركه أو أن يحيط به؛ ليس من باب نفي قدرات العقل على الاكتشاف والبناء، فالعقل منزلته في القرآن لا تنكر، ولكن من باب عجز العقل عن تقحّم ما لا يستطيع إدراكه من الغيبيات المطلقة، وعدم التقيّد بما ثبت عن الرسول -عليه الصلاة السلام- والصحابة والتابعين، خصوصًا بعد توالي الثقافات الوافدة على الفضاء المعرفي الإسلامي، بعد توالي عهد الترجمات في تاريخ الفكر الإسلامي. وهذا الانحراف المنهجي، ما زالت آثاره سائدة بين الناس؛ إذ يتولى نظّارٌ كثرٌ إحياءها وإعادة الكلام فيها من جديد، باعتبارها من أصيل الفكر الإسلامي، كما هي دعوى المعتزلة الجدد والباطنية الجدد، خصوصًا في منهج التعامل مع آيات القرآن تفسيرًا وتأصيلًا للأحكام.
س5. من أهم ما يوصف به التفسير التراثي من منظور (القراءات الحداثية)؛ مجموعة من الصفات، دالة في عمومها على نفي جدواه المنهجية والمعرفية في السياق الإسلامي المعاصر، الأمر الذي أسلمهم إلى وضع مَعْلَمٍ منهجي أساسي، وهو (القطيعة المطلقة مع التراث التفسيري)، ومن تلك الصفات أنه تفسير تاريخي، تفسير ذَرّي تجزيئي، تفسير يوغل في التفاصيل الجزئية، خصوصًا في تفسير آيات القصص القرآني ونحو ذلك. في رأيكم، إلى أيّ حدّ يمكن الاعتداد بهذه الإطلاقات؟ وكيف تُعطِّل -إن صحّت- قطعيات حقائق الوحي؛ كـ(العالمية) و(الإنسانية) و(الوحدة المتكاملة المتجانسة)، ناظم (العِبر) والقيم المكتنزة في القصص القرآني ونحو ذلك؟
أ/ سالم زنو:
انبرى في العصر الحديث نفرٌ من المفكّرين ممن حملوا لواء تحديث العلوم الشرعية تحت مرتكزات فكرية وإنسانية واجتماعية، محاولين التعاطي مع جوانب الضعف والوهن في التفسير وعلومه، أحيانًا تحت وقع الصدمة مع الغرب وحداثته الفكرية، والانبهار بمقولات العقل والعلم من غير نظر في السياق الذي نشأت فيه، وأحيانًا أخرى بصدق رغبة وحسن نية، جاعلين من القصور المنهجي والمعرفي لبعض جوانب درس التفسير التراثي، منطلقًا للنقد وأساسًا للدعوة إلى تجديده، وباعثًا موضوعيًّا يدفع بهم نحو بناء متن منظور تفسيريّ جديد يتجاوز المساوئ المعرفية لسلفه. وعليه كانت الدعوة لتجديده، وصرف الجهد نحو الاشتغال بقضايا فكرية واجتماعية وإنسانية طارئة، وجعله ينبسط على الواقع من خلال إلباسه معانِيَ فكرية وإنسانية واجتماعية نهضوية أو حداثية.
وفق هذا المنحى وتأثرًا بالمنهج الحداثي المنقول في النظر والقراءة، ذهب العديد من الباحثين إلى انتقاد النصوص الدينية والمدونات التفسيرية الناشئة عنها، وبيان قصور معارفها ومناهجها عن بلوغ ما تتضمّنه مناهج العلوم الإنسانية من معطيات ومداخل معرفية عقلانية قادرة على نقد المعارف الإنسانية والاجتماعية، وإبانة ما بها من اختلال، ولأن ذلك يحول دون عملية التقدّم ويعيقها، ويمنع مساعي التحديث والانخراط في عناصر الحداثة غير القابلة للاجتناب، كان لزامًا أن تنتقد النصوص الدينية وتعاد قراءتها، وأن تضفى عليها معانٍ عقلانية حداثية، لجعلها موفية بتحقيق مساعي التحديث الشاملة للمجتمع، ومن ثم كانت الدعوة إلى إعادة قراءة النصوص بشكلٍ ينسجم مع الحاضر وآليات الفكر الحداثي الغربي المعاصر.
غير أن بعض تلك الدراسات لم تصدر عن رؤية واضحة أو تضع معالم جلية يمكن أن يبنى عليها هذا العلم من جديد، وكأنما كان غرضها من خلال تلكم الاطلاقات التي تحدثتم عنها الهدم لا البناء، والرد لا القبول، وذلك غاية جهدها، ومنتهى وسعها، ولا تكليف بما فوقه، مع أنّ بعض بواعث الهدم المأخوذة مسلّمة في أدبيات كثير من المجدّدين لا يمكن أن تجعل أساسًا للبناء، أو لبنة في صرح التجديد.
إنّ بعض تلك الاختلالات واضحة في العديد من المتون التفسيرية التراثية، خصوصًا التأسيسية والمطوّلة منها، إلا أن إحداث القطيعة معها بدعوى وجود الاعتلالات المنهجية والمعرفية ليس منهجًا مرضيًّا في الباب، فبغضّ الطّرف عن إصابات الاجتهاد التراثي التفسيري وهي كثيرة ومتعددة، فإن إحداث هذه القطيعة يلغي أهم مبدأ من مبادئ الإنجاز الإبداعي، وهو مبدأ الإمكان، كما أنه يقتضي استبدال التراث التفسيري بتراث أجنبي وافد، بالنظر إلى أن الإنسان في اجتهاده وبحثه لا يتمكن من التجرّد عن التراث مطلقًا. فكان بالتبع أن ينصرف الجهد نحو تحقيق الإصلاح المنهجي والمعرفي تطويرًا وإكمالًا، لا تنقيصًا وتزهيدًا، وهذا في حقيقة الأمر يشمل مطلق الاجتهادات الإنسانية في باب النظر.
المحور الثاني: القراءات الحداثية لآيات القرآن ومأزق الاختيار المنهجي بين الاحتكام إلى قطعيات حقائق الوحي المنزل والمناهج التأويلية الحداثية الغربية.
س6. الناظر في متون القراءات الحداثية لآيات القرآن، أول ما يلحظه التعدّد في توصيف (القراءة)، إِذْ تارة أولى توصف بـ(الحداثية)، وتارة ثانية بـ(الجديدة)، وتارة ثالثة بـ(المعاصرة)، وتارة رابعة بـ(النقدية) وغير ذلك. نسألكم -قبل الجواب عن معنى ومقتضيات هذا التعدّد في الوصف- عن تحديد إجمالي لهذا النوع من (القراءة) لآيات القرآن.
أ/ سالم زنو:
يرجع اختلاف التسمية ووصف (قراءة القرآن) بالأساس إلى اختيارات منهجية، وفق تحديدات مأصولة بناء على الاجتهاد الشخصي تارة، وتارة أخرى منقولة عن واقع سياقي أنموذجي في أعين بعض النُّظّار. وكونها ترجع إلى اختلافات الاختيارات المنهجية، مردّه إلى ما يستند إليه النُّظّار في فضاء الفكر الإسلامي المعاصر لتحقيق (قراءات آيات القرآن)، أو ما أنتج في ظلالها من التفسيرات منذ اكتمال التنجيم والنزول بوفاة الرسول -عليه الصلاة والسلام-. فمثلًا تجد محمد أركون يصف في الغالب (قراءاته للقرآن) بـ(الحداثية) و(النقدية)، وعلّة ذلك، أن الوصف بـ(الحداثية) يرجع إلى الاستناد إلى المنقول الحداثي الغربي، خصوصًا ما تعلّق بالعلوم الإنسانية والاجتماعية ونحوها. وعلّة الوصف بـ(النقدية) مردّه إلى أن محمد أركون يتعامل مع مقروئه بعين النقد؛ سواء تعلّق بالقرآن أو بالإنتاج التفسيري دون تمييز، بالنظر إلى أنّ أيّ نصّ لا يسلّم بصحته وسلامته إلا إذا أخضع لمحكّ الدراسة النقديّة التاريخية الجذرية الصارمة.
في نفس السياق، تجد أن محمد شحرور وصف قراءته للتنزيل الحكيم بـ(القراءة المعاصرة)، بالنظر إلى الاختيار المنهجي الكلي القائم على أن آيات القرآن، يجب أن نجد لها مصاديق اتصال حقيقي واقعي بمختلف إشكالات ومشكلات العالم المعاصر، وليس أن يكون ذلك وقفًا على العرب والمسلمين وحدهم؛ سواء في زمن النزول أو في مختلف أزمنة التأويل؛ لذا، فإنّ مختلف قراءاته لآيات القرآن تندرج ضمن هذا الناظم الكلي، ونفس الأمر ينسحب على (القراءة الجديدة) أو (الفهم الجديد) لمحمد عابد الجابري، أو (التفسير الفلسفي) لأبي يعرب المرزوقي، أو (القراءة الائتمانية) لطه عبد الرحمن، أو (القراءة التأويلية) لنصر حامد أبو زيد، وغيرهم.
س7. تنوّعت القراءات الحداثية لآيات القرآن بعد النصف الثاني من القرن العشرين، خصوصًا بعد هزيمة 1967م، الأمر الذي جعل مجال التفسير يُقتحم من قِبل نظّار من تخصّصات معرفية وعلمية متعدّدة، غير ما عُهد في تاريخ التفسير أزمنة المعرفة الموسوعية، الذي كان منحصرًا إلى حدٍّ ما في أهل العلوم الشرعية. لو تحدّدون لنا جملة الأسباب التي أنشأت القراءات الحداثية بتعدّدها وتنوّعها في السياق الإسلامي المعاصر.
أ/ سالم زنو:
لقد كانت الاستئنافات التجديدية في درس التفسير انفعالًا لفعل عوامل عدّة، منها الأوضاع الاجتماعية والفكرية الطارئة، التي عرضت نفسها على المجتمع نتيجة اللقاء بين الشرق والغرب، ومن ثم فإنّ الفضاء المعرفي الوثوقي الذي تشكّلت فيه المتون التفسيرية قد تراجع أمام الفضاء المعرفي الحديث المبني على المنهج الحسي التجريبي، وذلك حين اتصل الشرق الإسلامي بالغرب فأخذ يستقي من مناهله العلمية، المتبنية للحسّ والتجربة، وترك الاعتراف بوجود ما لم يثبت وجوده بالتجربة الحسيّة، وربما ألحق العقلَ في عدم الاعتراف بغير المحسوسات، ولم يكن ذلك التراجع للعلم القديم عن ثلم فيه أحدث في الدّين خرقًا اتسع على راتقه، واقتضى إزاحته، بل عن إسقاطات العلوم الطبيعية والاجتماعية والإنسانية ومناهجها على العلوم الإسلامية.
وكان من آثار تلك المباشرة الهجومُ على العلوم الإسلامية التي كانت تدرس في مراكز العلم الإسلامية؛ ليتم إخراجها من دائرة العلم، مقابل التبشير بالعلم الجديد الذي يتمرّد على الدّين ويدخله في معترك الشكوك، هذا إن لم يقذف به في عالم الأساطير بتعبير أحدهم، وكان من بواكير آثار هذا الفضاء المعرفي السعيُ إلى إيجاد قراءات جديدة لنصوص القرآن الكريم لما ظهر لبعضهم أنه يتناقض مع معطيات العلم الحديث. فدخل على المسلمين كثير من الوهن والانهزام النفسي أمام العلم الحديث، والتسليم للمستشرقين بكثيرٍ من أصولهم التي بنوا عليها شبهاتهم في إنكار بعض الغيبيات التي أخبرت بها الشرائع، وتأولوها بتأويلات باطنية متعسفة، كما هو الشأن بالنسبة للمدرسة العقلية التي أسّسها جمال الدين الأسدآبادي المشتهر بالأفغاني، وإن كانت جهودها لا تنكر في الدفاع عن الإسلام وصدّ هجمات المستشرقين وشبهاتهم.
وهكذا لم يسلم المنتسبون للعلم والمعرفة الشرعية من اللوثة الفكرية الدخيلة، فمعجزات الأنبياء المعدودة من الخوارق التي تستند عليها نبوّاتهم، غير معترفٍ بها عند المبرزين من علماء الدين، مثل الشيخ محمد عبده، والشيخ رشيد رضا...، وقد تابعهم في ذلك العديد من الدارسين نتيجة الثلم المحدَث في منهج البحث التراثي المزاح لصالح العلم الجديد.
س8. يُرجع العديد من الباحثين أهمّ أسباب مناشئ النظر الحداثي في آيات النصّ القرآني لثلاثة أسباب؛ الأول: يتصل بالتفسير التراثي لكونه تاريخيًّا غير ملائم للمرحلة، الأمر الذي يفضي إلى (الانقطاع) عنه كلية. الثاني: يتصل بكون القرآن نصًّا إنسانيًّا عالميًّا، الأمر الذي يفرض إعادة قراءته باستمرار. الثالث: يتصل بالإنتاج الحداثي الغربي لكونه من المشترك الإنساني العام، الأمر الذي يتعيّن الاستناد إليه في سبيل إنجاز قراءة حداثية للقرآن. ما تقييمكم لهذه الأسباب الموجبة للقراءة الحداثية لآيات النصّ القرآني؟ وإلى أيّ حدّ حققت ما أخذته على التفسير التراثي، خصوصًا ما يتعلّق بمحدد (عالمية) نصّ وحي القرآن؟
أ/سالم زنو:
إنّ الفضاء المعرفي المعاصر قد تغيّر عن سابقه الذي تشكّلت فيه المتون التفسيرية الأولى، إذ دخل الإنسان في القرنين الأخيرين إلى واقع فكري جديد، استأثر فيه الإنسان بالمركزية، وأصبح مقياسًا لكلّ شيء ومرجعًا للمعنى، وصار السعي وراء اليقين فعلًا لا طائل منه، وعملًا لا تُرجى له فائدة، فَقَدْ فُقِدَ الجزم الفلسفي والعلمي في الفضاء الفكري الجديد، فاستولت حالة انعدام الجزم واليقين على جزء من الفكر البشري، وفي سياق هذا الفضاء المعرفي برزت إلى السطح كثير من القضايا والإشكاليات، ولا شك أنّ لمثل هذه المعارف آثارًا وتبعات تشمل كلّ الأطر والمجالات الفكرية، فهي تنال من مجمل فروع المعرفة الشرعية، من عقائد وعبادات وأخلاق، بحيث لا تُبْقِي قدسيةً لمعتقد، ولا يقينيةً لمبدأ، ولا ثباتًا لمعرفة، ولا أقول إن الأخذ بهذه المعارف يبطل عالمية القرآن، بل هي معارف تقوم في أغلبها على إقصاء الوحي، لولا ما كتبه الله تعالى له من الحفظ.
من المعلوم أيضًا أنّ لكلّ اجتهاد تفسيري كان أو غيره، دواعِيَ تقتضيه، إلا أن (القراءات الحداثية) وإن كانت من بين أهم أسبابها ما ورد محددًا في السؤال، إلا أن الملاحظ، في ضوء استحضار محدّدات حقائق الوحي القاطعة، أن السبب الثاني الموجب لها والمتعلّق بإعلاء إنسانية وعالمية وكونية آيات القرآن قد أنتج عن ذلك مجموعة آفات منهجية ومعرفية، أفضت إلى نقيض ما تعصبوا به ليعيدوا (قراءة القرآن) من جديد، ومن أهمها؛ أولًا: فهم كونية وعالمية القرآن وفق النموذج الغربي الحداثي، بوصفه أنموذجًا أمثل في الوجود الإمكاني الإنساني، بناء على ما حصّلوه واستوعبوه من معارفه. ثانيًا: تعطيل العديد من الأحكام النصيّة القرآنية أو تحريف دلالاتها، بدعوى أنها لا تتوافق مع هذا الأنموذج الإمكانيّ السياقيّ، خصوصًا ما اتصل منها بما يسمى بالحدود الشرعية، قضايا الحرية، قضايا المرأة والطفل ونحوها. الأمر الذي أدى إلى تَكوثُر تفسيرات وقراءات آيات القرآن بتعدّد النّظار؛ إذ لا تكاد تجد إجماعًا حول بعض التفسيرات عكس ما كان يحدث في التفسير التراثي الذي قطعوا معه كلية. وهذا بقدر ما يفقد المنهج اعتباره الموضوعي فإنه لا يراعي عالمية وإنسانية القرآن كما يحدّدها بنفسه.
س9. لا أحد يشك في أنّ من بين الدراسات الحديثة والمعاصرة للقرآن، الدراساتِ الاستشراقية التي ما تزال تتعدّد وتتنوّع، خصوصًا تلك المتصلة بماهية آيات النصّ القرآني، والتي استندت في عموم أنظارها إلى ظنيات المناهج والمعارف الحديثة في النظر. من منظوركم، كيف تجلّت مصادرة قطعيات حقائق وحي نصّ القرآن في الفضاء البحثي الاستشراقي؟ وما مدى تأثير محصول النظر الاستشراقي على القراءات الحداثية للقرآن في فضاء الفكر الإسلامي المعاصر؛ سواء من خلال الاقتصار على بعض الأعلام، أو من خلال إيراد بعض الأفكار العامة؟
أ/ سالم زنو:
إنّ أساس القرآن عقيدته، ومكمن الاعتقاد إنما هو الإيمان بالله -عز وجل- ووحدانيته، وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ولا مطمع في تحقيق شيء من أحكام الشريعة الإسلامية إن لم تكن هذه الحقائق العقدية مركوزة في القلوب، ومن أجلِ ذلك ألّف علماؤنا -رحمهم الله- المطوّلات والمختصرات المختلفة في إقامة الأدلة والبراهين على وجود الله ووحدانيته وإثبات النبوّة والبعث، وردِّ شُبَه المبطلين، واستحضروا لذلك الدليل النقلي كتابًا وسُنّة وإجماعًا، مع إعمال موازين الأنظار العقلية.
وإذا كان من شروط صحة الإيمان أن يكون قائمًا على دعائم اليقين، لا شوائب التقليد والاتباع كما تقرّر عند علماء التوحيد، وكان إدراك حقائق الاعتقاد على ما هي عليه في الواقع مطلبًا شرعيًّا، فإن منهج البحث المتبع لبلوغ ذلك الإدراك ينبغي أن يكون منهجًا علميًّا دقيقًا موفيًا بالإيصال إلى الحقيقة المبحوث عنها، بعيدًا عن الظنّ والحدس والوهم.
لذلك، فالمسلِم ينطلق من مسلَّمة تضمُّن الوحي لحقائق ثابتة مطابقة لنفس الأمر، ومن ثم نسلّم بصدقية الإلهيات والنبوات والسمعيات في الواقع الخارجي، أي: وجود حقائق عقدية مطلقة مطابقة لموضوعها متضمنة في الوحي.
هذا، وإنّ النسق المعرفي والفضاء الفكري الذي ظهر فيه بدء تدوين التفسير في القرون الأولى، يعدُّ بحقّ فكر سيادة الجزم والحقيقة، بحيث إنّ البحث عن الحقيقة كان نمطًا فكريًّا سائدًا على التفكير، وفي هذا المجال من اليقين والجزم اكتسب علم التفسير خصوصيته، من التصديق بأن هذا النصّ المفسّر الموجود بين دفتي المصحف، هو كلام الله، المتعبد بتلاوته، المنزل على رسوله محمد -صلى الله عليه وسلم-، المنقول إلينا بالتواتر، قبل أن يتأثر درس التفسير بالفضاء المعرفي الحديث الذي يعدُّ فقدان الجزم واليقين أهم خصائصه، وإن الانسياق والتبعية لمناهج المستشرقين في مناهجهم المصادرة لحقائق وقطعيات الوحي؛ (المنهج التاريخي، الذي يرجع موضوعات الدراسة إلى عناصر مادية وإلى عوامل تاريخية، المنهج التحليلي الذي يقضي على الطابع الكلي لموضوع الدراسة، والإسقاطي الذي يخضع للهوى والانطباعات الشخصية، والأثر والتأثر الذي يرجع موضوعات الدراسة إلى مصادر خارجية من بيئات ثقافية أخرى)، كلّ تلك المناهج تؤدي قطعًا إلى مناقضة وإبطال عقيدتنا في الوحي المنزل، وفي العلوم الناشئة حوله.
س10. من المعلوم أنّ منهج النظر الحداثي الغربي في النصّ الديني، يعتبر خصوصية سياقية صريحة؛ إِذْ إن مناهج النظر الحداثي في النصّ الديني أُنشئت تبعًا للتحوّلات الجذرية التي شهدها السياق الغربي، فكان بسبب ذلك، أنّ منهج النظر في النصّ الديني تقيّد بالمحدّدات الآتية: التسليم بتحريف النصّ الديني، نسبية وتعدّدية دلالات وأحكام النصّ الديني، كون محمولات النصّ الديني متصلة بالشأن الفردي الخاصّ، النظر في النصّ الديني باعتباره مادة ألسنية وسميائية دون استحضار مصدره-قائله، كون النصّ الديني على مستوى البناء الدلالي والمحتوى الدلالي قام على قاعدة التناص، كون النص الديني عبارة عن تجربة النبي أو الرسول ونحو ذلك. في نظركم، كيف تجلّت هذه المحددات المنهجية أو غيرها في محصول القراءات الحداثية للنصّ القرآني؟ وما آثار تنزيلها على آيات القرآن، خصوصًا في علاقتها بقطعيات حقائق وحي نصّ القرآن المنافية لها؟
أ/ سالم زنو:
لقد سار فريق من الباحثين إلى بتر مناهج هذا الفضاء المعرفي المعاصر عن سياقها وظروفها وأوضاعها الخاصة التي شكّلتها وتشكّلت فيها، وتطبيق بعض منها، وخاصة مناهج العلوم الإنسانية والاجتماعية، بفروعها ومناهجها المتعدّدة، (المنهجية الألسنية، والمنهجية التاريخية، والمنهجية الاجتماعية، والمنهجية الأنثروبولوجية، وهو ما يسمى بالإبستمولوجيا التعددية) على السياق الإسلامي وعلومه، والذي يختلف بمعطياته وظروفه وأوضاعه عن تلك التي أوجدت لها تلك الحلول، ومن ثم تحويل الدين ومعه قطعياته المعلومة من الدين بالضرورة؛ عقائد، وأحكام، وقيم، ومفاهيم، أو ما يسميه أركون بــ«المدونة النصيّة الكبرى الاعتقاد بأن القرآن هو الوحي الذي يجسد كلام الله حرفيًّا، والاعتقاد بنقل هذا الكلام من قِبَل محمد -صلى الله عليه وسلم- إلى البشر، ثم الاعتقاد بصحة الأحاديث النبوية التي تشكّل النصّ الثاني المقدّس للإسلام والتي تعلو على كلّ نقد تاريخي...» إلى علم إنساني كسائر العلوم الإنسانية والاجتماعية، ونتاج فاعلين اجتماعيين، وتحويل التوحيد إلى موضوع من موضوعات علم النفس والاجتماع لتحديد نشأة الأفكار الدينية في ظروف نفسية واجتماعية معيّنة، ومحاولة دراستها من خلال الحوادث التاريخية، أو الوقائع الاجتماعية، أو إرجاعها إلى الإبداع الشخصي أو الأثر الخارجي، تحقيقًا للحداثة الفكرية، في مناقضة صريحة لطبيعة العلوم الإسلامية، باعتبارها وحيًا، أو علومًا ناشئة عن الوحي، لا تقبل دراستها كموضوعات تاريخية.
على الجملة نقول: إن الحديث عن تجديد مناهج قراءة القرآن من خلال مناهج النظر الحداثي، يستلزم عرض مداخل التجديد المدعو إلى تطبيقها في هذا الباب، إمّا إضافةً لمباحث ومناهج جديدة، أو نقدًا لنظيراتها من القديمة، ذلك أن قصور بعض المناهج في فهم القرآن أمر ظاهر، لكن محاولة الوقوف على الأسباب واستكناه الضعف فيه محلّ نظر، وإلقاء اللوم على المفسّرين تجنٍّ ومغالاة؛ فهم قد عاشوا عصرهم وأجابوا عن أسئلته تنزيلًا للقرآن على واقعهم، وليسوا مسؤولين عن تخلّفنا وعدم قدرتنا على مجابهة إشكالاتنا المنهجية والمعرفية، ومسايرتنا لإفرازات الحضارة، وليس لازما أن ينطبق اجتهادهم آليًّا على أسئلتنا الراهنة، أو يردّ الشُّبه الواردة حديثًا.
س11. العديد من النُّظّار في فضاء القراءات الحداثية للقرآن استعانوا ببعض تلك المحدّدات المنهجية والمعرفية السالفة الذِّكْر كما هي عليه في السياق الغربي، دون نقد ولا اعتراض ولا بحث في سؤال المجانسة بين المنقول المنهجي وخصوصية النصّ المقروء-القرآن ونحو ذلك، ومنهم على سبيل التمثيل: نصر حامد أبو زيد، محمد أركون، عبد المجيد الشرفي، الطيب التزيني، الصادق بلعيد، عبد الكريم شروس، محمد عابد الجابري، محمد شحرور، وغيرهم. لو تكشفون لنا كيف تجلّت تلك المحدّدات المنهجية الحداثية في قراءةٍ واحدةٍ من القراءات الحداثية للقرآن، باستحضار قطعيات حقائق الوحي؟
أ/ سالم زنو:
يستند هذا الفريق إلى المستجدّات والتطوّرات الحاصلة في مجال الفلسفة والعلوم في الغرب، من اجتماعية وإنسانية ولغوية وغيرها، ويبنون نتائج أبحاثهم عليها، موقنين ومسلِّمين بضرورة تعرّضنا لنوبات هذه التطوّرات والشبهات، من غير أن نعيش أسبابها، وقد كانت العلوم الإنسانية ومعارفها مثل علم النفس والأخلاق واللغة... مصدر الكثير من الإشكالات المصادمة لقطعيات الوحي.
وقد تلقّف هذا الفريق مناهجَ البحث في العلوم الإنسانية المعاصرة على أنها الحكم العدل في العقليات، وإليها مردّ العمليات والعلميات، وبنوا محاولاتهم في التجديد على أسسها وأركانها، وقعّدوا قواعدهم على هديها وبرهانها، فكان لزامًا أن يكون منتهى العقل الإسلامي تحت سقف العقل الحديث، وأن يُتهم بالقصور، والوقوع تحت وطأة الأسطورة والخرافة، وأن تُرمى النصوص الدينية بشُبَه التاريخية والإنسانية، ومن أجلِ مجابهة هذه التحديات المعرفية التي تفرضها مناهج العلوم الإنسانية، واستعادة الوظيفة الدفاعية التي يمكن أن يقوم بها علم الكلام في مجابهة فلسفات التأويل الحديثة-السيمياء والهرمنيوطيقا، وما حملته من الشُّبَه الحديثة في تعاملها مع النصّ الديني، وهي شُبه يلزم عنها معانٍ عقديّة؛ مثل القول بتاريخية النصوص، وأنسنته، وتغييب مفهوم الوحي، ومصدره، وواسطته، والنبوّة... وغيرها من مقتضى المعاني العقدية التي لزمت عن توظيف مناهج العلوم الإنسانية الحديثة المستعان بها في تحليل النصوص وتفسير مدلولاتها.
في هذا السياق يندرج مشروع المقاربات الحديثة للنصّ، والمتبني لمناهج البحث في العلوم الإنسانية المعاصرة كمدخل لنقد وقراءة النصوص الدينية، في سعي إلى إيجاد قراءات جديدة للنصّ الديني بهدف تفكيكه وإعادة بنائه بشكلٍ ينسجم مع الحاضر وآليات الفكر المعاصرة، بجعل النصّ مؤطرًا بالفهم البشري المحكوم بالتعدّد والتحوّل، ما يؤسّس لباطنية جديدة تميع الفهم وتسيله ولا تُبقِي للدّين اسمًا ولا رسمًا، وقد أثار هذا الاتجاه العديد من المسائل والقضايا الجانبية ذات الاتصال بالعقيدة؛ مثل نقد الغيبيات، وأسطرة النصّ وأنسنته، والقول بالتناص، والتسوية بين النصوص والمعتقدات والأديان، وتغييب مفاهيم النبوة والوحي، ومصدر الوحي، وواسطة الوحي...، ويعدُّ محمد أركون ونصر حامد أبو زيد ومَن اقتفى أثرهم مِن رُوّاد هذا الاتجاه.
المحور الثالث: القراءات الحداثية لآيات القرآن وحدود الاستفادة منها في بناء منهج النسق التفسيري المعاصر وفق معيار تحكيم قطعيات حقائق الوحي.
س12. من بين أهم الاجتهادات النقديّة التي تولّت الكشف عن عيوب واعتلالات حضور محصول النظر الحداثي الغربي في القراءات الحداثية للقرآن في السياق الإسلامي المعاصر =تجد اجتهاد طه عبد الرحمن وغيره. هلّا بيّنتم لنا كيف استند النقد الطهائي إلى قطعيات حقائق الوحي لبيان أعطاب هذه القراءات ونواقصها؟
أ/ سالم زنو:
يُعَدّ طه عبد الرحمن أحد أبرز النُّظّار الذين اجتهدوا في تقديم (قراءة حداثية) لبعض جوانب وآيات القرآن، وفق مراعاة السياق المعرفي العربي الإسلامي، وقد ورد نقده لبعض (القراءات الحداثية)، بين يدي الوضع التأسيسي لتقديم قراءته البديلة.
في الفصل الرابع من الباب الثاني من مصنّفه: (روح الحداثة)[7]، تناول طه عبد الرحمن بالنقد والتقويم ما سمّاه بــ«القراءات الحداثية المقلدة البِدْعية الانتقادية ذات الإبداع المفصول»، في مقابل «القراءة الحداثية الإبداعية الاعتقادية ذات الإبداع الموصول» التي يؤسّسها. وارتكز في نقده بالأساس على إبراز المداخل المنهجية في (القراءة الحداثية المقلّدة) التي تصادم قطعيات حقائق وحي آيات القرآن، وفي المقابل اعتبرها تتقيّد بخصوصية السياق المعرفي للحداثة الغربية بمختلف تحوّلاتها. وقد حصر خططها المنهجية في ثلاث؛ فالأولى سمّاها بـ(خطة التأنيس) أو (الأنسنة)، والثانية وَسَمها بـ(خطة التعقيل) أو (العقلنة)، والثالثة وصَفها بـ(خطة التأريخ) أو (الأرخنة). من باب التمثيل نتناول الخطة الأولى، وهي التي تقوم في أصلها على «نقل آيات القرآن من الوضع الإلهي إلى الوضع الإنساني، قصد رفع عائق القدسية»، والمتمثّل في (اعتقاد أنّ القرآن كلام إلهي مقدّس)، باستخدام مجموعة من العمليات المنهجية، كـ(حذف عبارات التعظيم)، واتباع (مسلك الاستبدال)؛ كاستبدال (الخطاب النبوي) بـ(الخطاب الإلهي)، استبدال (العبارة) بـ(الآية)، (التسوية في رتبة الاستشهاد بين الكلام الإلهي والكلام الإنساني) ونحو ذلك. وقد أدّت هذه (العمليات المنهجية التأنيسية) إلى جعل القرآن مجرد (نصّ لغوي) مثله مثل أيّ نصّ لغوي آخر. وقد ترتبت عن هذه (المماثلة اللغوية) بين القرآن والنصوص البشرية مجموعة من النتائج، منها: (استقلال النصّ القرآني عن مصدره) أو (قائله)، (عدم اكتمال النصّ القرآني)، (ارتباط القرآن بالسياق الثقافي لزمن النزول)، (الوضع الإشكالي للنصّ القرآني) ونحو ذلك. والتركيز على هذه الخطة من منظور طه عبد الرحمن، ما هو في حقيقة أمره إلا استجابة لأحد مقوّمات الواقع الحداثي الغربي، وهو (الاشتغال بالإنسان وترك الاشتغال بالإله)، قصد (التصدّي للوصاية الروحية للكنيسة). و(خطة التأنيس) من منظور (القراءة الحداثية المبدعة)، ليست كـ(خطة التأنيس المقلدة)، إذ هي لا تقصد (محو القدسية)، باعتبار ذلك أحد أهم الحقائق القطعية المتعلقة بالقرآن التي تقيم ماهيته، وإنما تقصد أساسًا إلى (تكريم الإنسان)، التي تقتضي (إلغاء كلّ تقديس في غير موضعه). وبالتبع، يمكن تعريف (خطة التأنيس المبدعة)، أنها عبارة عن «نقل الآيات القرآنية من وضعها الإلهي إلى وضعها البشري تكريمًا للإنسان»، وهذا النقل من منظور طه عبد الرحمن، ليس فيه أيّ (إضعاف للتفاعل الديني)، وكذلك لا ينطوي على أيّ (إخلال بالفعل الحداثي). وبالنظر إلى أن (خطة التأنيس المبدعة) تشتغل ببيان وجوه (تكريم الإنسان) في النصّ القرآني، باعتبار أن (تكريم الإنسان يعدُّ أصل الأصول القيمية للقرآن)، تكون بذلك أكثر تغلغلًا في الحداثة من (خطة التأنيس المقلدة).
س13. يسود تصوّر عام، يتبناه مجموعة من النُّظَّار في فضاء الفكر الإسلامي المعاصر، قائم على أساس الرفض الكلي لما ينتجه الفكر الغربي الحداثي، خصوصًا لما يكون ذا صلة بتفسير آيات القرآن، وفي مقابل هذا، تجد الدعوة إلى الاكتفاء بالمنهج التراثي في التفسير والتأصيل، بناء على مجموعة من الاختيارات المنهجية والمعرفية المتعدّدة. من منظوركم، ما صحة هذا التوجّه المعرفي في تأسيس قراءة جديدة للنصّ القرآني، تحكيمًا لقطعيات حقائق الوحي، خصوصًا تلك المتعلقة بالعالمية أو الكونية ونحوها؟
أ/ سالم زنو:
إدراكًا لواقع المأزومية الحضارية التي دخلت فيها الأمة الإسلامية، كان لزامًا أن تظهر محاولات لتغيير الوضع الطارئ وتجاوز الواقع المتردّي، وتحقيق التحديث المنشود على مستوى الفكر والواقع، وقد مثّل التراث في علاقته بالفضاء المعرفي الطارئ المنطلق والأساس لتجاوز تلك الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والفكرية التي يعيشها المجتمع، وذلك إمّا من موقف إيجابي، بالوصل معه كلية، والاكتفاء بالحلول الذاتية، أو من موقف انتقائي وتلفيقي بين التراث ومعطياته، والواقع وإنجازاته، أو من موقف سلبي نقدي أو تحليلي، يقوم على نقد العلوم التقليدية بيانًا لنشأتها وتطوّرها، ثم إعادة بنائها وفهمها كي تتمكّن من استيعاب الواقع ومكوناته، وتتجاوز واقع مأزوميته، في عملية توحي تصريحًا وتلميحًا بأنّ التراث سبب تأخر المسلمين، وأنه يعيق عملية التحديث، أو التوفيق بين التراث والعصر، وربما بين الدين والعلم، والإسلام والحداثة، ومن ثم وجوب عقلنته وتأهيله للدخول في عصر الحداثة، بإعادة تفسيره وفقًا لحاجات العصر.
إلا أنّ التوجه المعرفي الذي نراه الأليق لقراءة القرآن الكريم، ليس ذلك الذي يستند إلى إقامة التضاد والتنافي بين ثنائيات؛ التراث والحداثة، القديم والجديد، والأنا والآخر...، وإنما ذلك الذي يعتمد على التكامل بين كلّ ذلك، وتجاوز الحصر المنهجي؛ بمعنى أن نتجاوز -ونحن ندبج هذه الأفكار- فكرة الهدم الكلي لكلّ معطيات المتون التفسيرية باعتبار قِدَمها أو حداثتها، أو باعتبارها ذاتية أو وافدة، والشيء إنما يستجاد ويسترذل لجودته ورداءته في ذاته لا لقِدَمه وحدوثه، أو كونه لنا أو لغيرنا، فهذه أوصاف إضافية تتعاور الماهيات، ولا تأخذ شرطًا في الحكم عليها أو شرطًا في تصورها، ومن هنا يظهر أن كثيرًا من الأحكام الصادرة في هذا الباب تحمل من الهضم والحيف ما لا يخفى على منصف.
س14. تعتمد القراءات الحداثية للقرآن في عمومها على قاعدة منهجية كلية، وهي تعدّد المداخل المنهجية في مقاربة النصّ القرآني، قصد تحقيق أكثر من استنطاق ممكن لآيات القرآن؛ تجاوزًا لآفة الحصر المنهجي، خصوصًا إذا أخذنا بعين الاعتبار تكوثر المستجدات والنوازل بمختلف تعلقاتها الموضوعية والمجالية. نسألكم عن حدود الاستفادة من التعدّد المنهجي في تفسير النصّ القرآني، وما منهج ضبطه وتقييده، تقيدًا بمبدأ الإحكام القرآني، ودرءًا للتعدّد اللانهائي لدلالات آيات القرآن المفضي للتلاعب اللامحدد واللامحدود؟
أ/ سالم زنو:
إنّ مسألة الاستعانة بكلّ ما هو موضوع ومتداول من المناهج يطرح تساؤلات عدّة، من جهة أن أغلبها غير موثوق في يقينيتها وموضوعيتها، وإنما هي معارف تأويلية تمتزج فيها الذات بالموضوع، لذلك وجدنا أنّ كثيرًا ممن تجرّد للتشخيص انتهج منهجًا تجزيئيًّا اختزاليًّا ينمّ عن ذاتية تطلب تأييدًا لفكرة محدّدة تعوزها المقدّمات، ولا شك أنّ الباحث إذا خَطِئ أو أخطأ في التشخيص استلزم ذلك الخطأ في المداواة والعلاج الذي يقترحه، ولعلّ هذا ما يفسّر لنا خفوت هذه الدعوات، وعدم تجاوز النظرية إلى التطبيق، ولو رُمْنا الإنصاف -وذلك قصدنا- لقلنا بأن الدعوة إلى التجديد غاية تتطلّب إلى اليوم الاطلاع الواسع على التراث، قصد استيعابه واستئناف البناء عليه، لا القطع معه، وأغلب كتابات ومطارحات هذا الباب إنما تنسج على منوال الاستشراق في المناهج، في قطيعة تامة عن المناهج الموروثة، وإن لم تبلغ -فيما قرأت- مُدّ أحد المفسرين القدامى ولا نصيفه.
لذلك نجد أنّ المنهج المتّبع من بعض الدارسين في القراءات المتعدّدة لنصوص القرآن الكريم غير موضوعي؛ لأنه منهج تجزيئي اختزالي يستعجل النتائج دون تحقيق المقدمات، ويتناول مباحثه بالوصف العنواني المشوب بخلفية فكرية، وشوائب تاريخية مستحضرة في الأحكام المستصدرة له أو عليه، في قصْر له على بعض أفراده، بقياس فاسد المادة، يأخذ الجزئي محلّ الكلي، أو العرضي مكان الذاتي.
فلندع هذا، فمن اجتهد فله أجرُ الاجتهاد، ولكن المؤسف أنّ أكثر مَن تصدَّى لنقد الحصاد التفسيري لم يكن مؤهلًا لذلك، فأبسط الشروط وأوّلها وهو الإلمام التفصيلي بالعلوم الدينية. وهذا الشرط غير متحقّق في كثير ممن تعاطى نقد متون التفسير.
[1] يقول الله تعالى: {وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ}[النحل: 103].
[2] يقول الشافعي: «ومِن جِماع علم كتاب الله العلم بأن جميع كتاب الله تعالى إنما نزل بلسان العرب... والقرآن يدل على أن ليس من كتاب الله شيء إلا بلسان العرب». الرسالة، تحقيق وتخريج وتعليق: عبد اللطيف الهميم وماهر ياسين الفحل، دار الكتب العلمية، بيروت- لبنان، ط2، 2009، ص77، 81-84. يقول الشاطبي: «وإنما البحث المقصود هنا أن القرآن نزل بلسان العرب على الجملة، فطلب فهمه إنما يكون من هذا الطريق خاصّة... فمن أراد تفهّمه فمن جهة لسان العرب يُفهم، ولا سبيل إلى تطلّب فهمه من غير هذه الجهة... فإن قلنا إن القرآن نزل بلسان العرب وإنه عربي لا عجمة فيه؛ فبمعنى أنه أنزل على لسان معهود العرب في ألفاظها الخاصّة، وأساليب معانيها». الموافقات في أصول الشريعة، أبو إسحاق الشاطبي، شرح وتخريج: عبد الله دراز، دار الكتب العلمية، بيروت- لبنان، ط، 2011، (1/ 49-50).
[3] القانون في تفسير النصوص: بيان مناهج وقواعد وضوابط تفسير وشرح النصوص الدينية في الإسلام، دار الكتب العلمية، بيروت- لبنان، ط1، 2006، ص235-236. وقد أخذ العلماء من تلك قواعد من هذه (الخصوصية)، كما يؤكد السريري، «وتلك الخصوصية هي كون هذه النصوص وحيًا، وكون بعضها يؤثر في مدلول بعض، وكونها بلسان عربي مبين». نفسه، ص236.
[4] يقول الله تعالى: {وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ}[النحل: 44].
[5] صحيح البخاري، كتاب التفسير، حديث رقم: 4776.
[6] مقدمة التفسير، شرح: ابن العثيمين، المكتبة الإسلامية للنشر والتوزيع، القاهرة- مصر، ط1، 2006، ص269-270.
[7] روح الحداثة المدخل إلى تأسيس الحداثة الإسلامية، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء- المغرب، ط1، 2006، ص175-206. الحوار أفقًا للفكر، طه عبد الرحمن، الشبكة العربية للأبحاث والنشر، بيروت- لبنان، ط1، 2013، ص88-91.
مواد تهمك
-
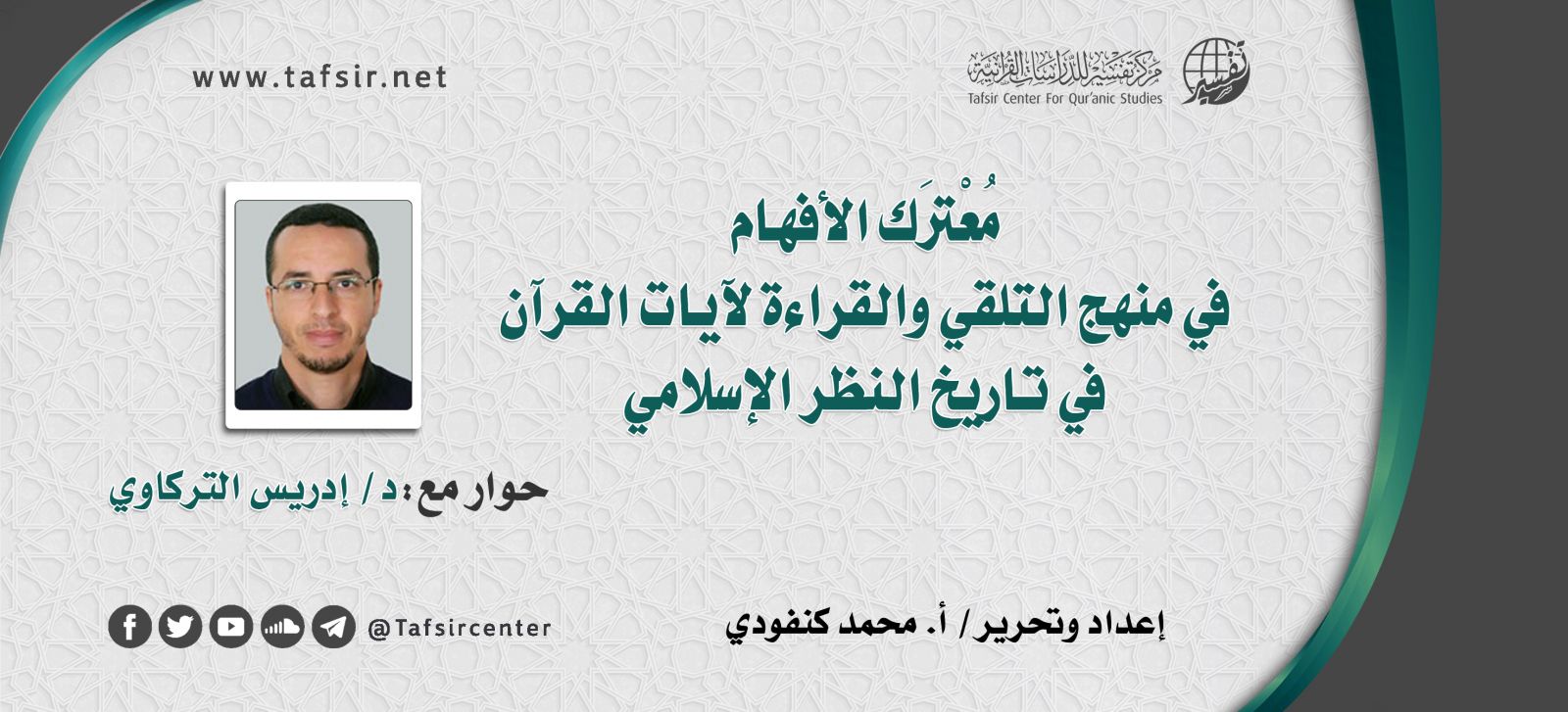 مُعتَرك الأفهام في منهج التلقِّي والقراءة لآيات القرآن في تاريخ النظر الإسلامي
مُعتَرك الأفهام في منهج التلقِّي والقراءة لآيات القرآن في تاريخ النظر الإسلامي -
 طه عبد الرحمن؛ وإمكان تقديم قراءة حداثية للقرآن الكريم
طه عبد الرحمن؛ وإمكان تقديم قراءة حداثية للقرآن الكريم -
 القراءات الحداثية للقرآن (9) محمد أركون والرهان الإبستمولوجي للقراءة
القراءات الحداثية للقرآن (9) محمد أركون والرهان الإبستمولوجي للقراءة -
 قراءة القرآن من منظور طه عبد الرحمن؛ عرض وتحليل (2-4)
قراءة القرآن من منظور طه عبد الرحمن؛ عرض وتحليل (2-4) -
 قراءة القرآن من منظور طه عبد الرحمن؛ عرض وتحليل (1-4)
قراءة القرآن من منظور طه عبد الرحمن؛ عرض وتحليل (1-4) -
 التفسير الفلسفي للقرآن (6)، تفسير آيتي سورة الإسراء، من منظور التفسير الفلسفي المعاصر لأبي يعرب المرزوقي
التفسير الفلسفي للقرآن (6)، تفسير آيتي سورة الإسراء، من منظور التفسير الفلسفي المعاصر لأبي يعرب المرزوقي


