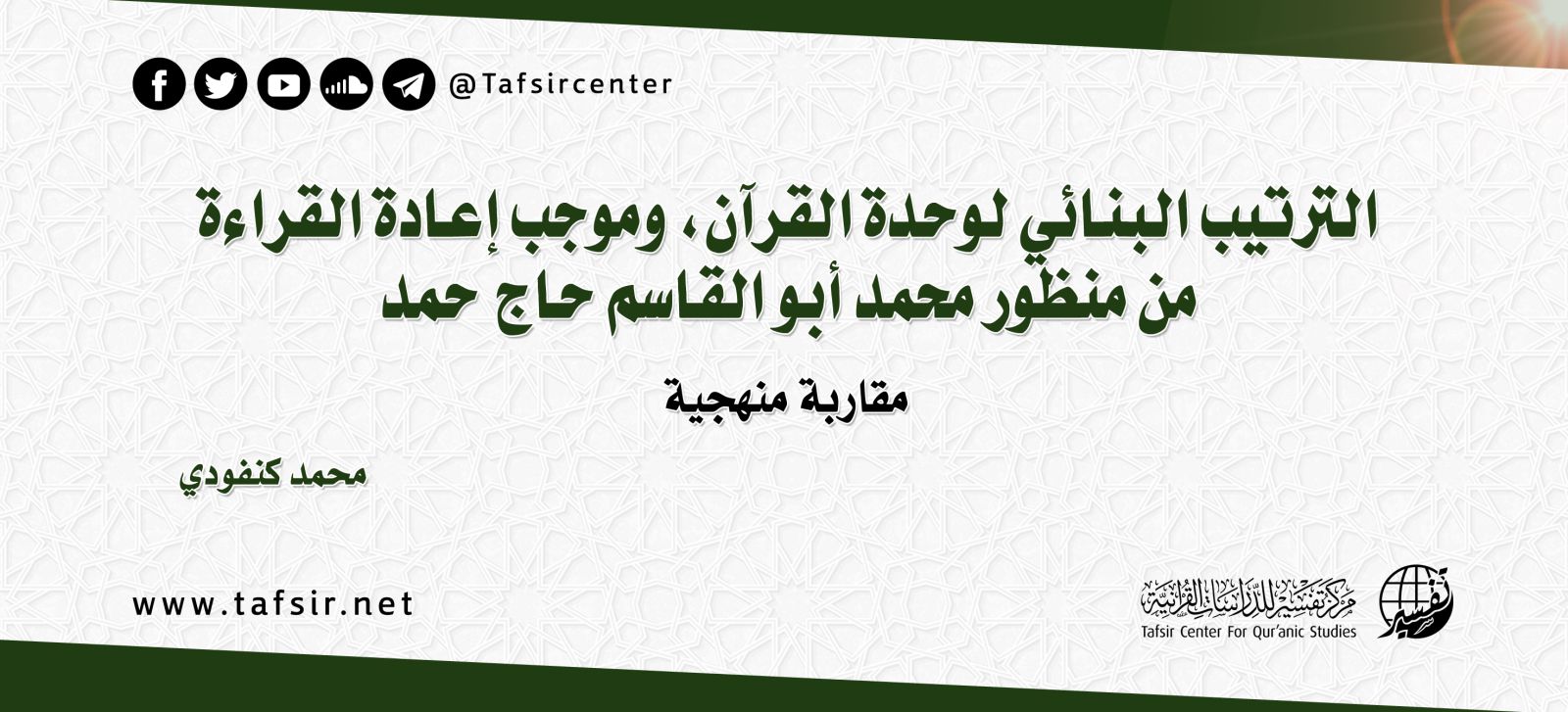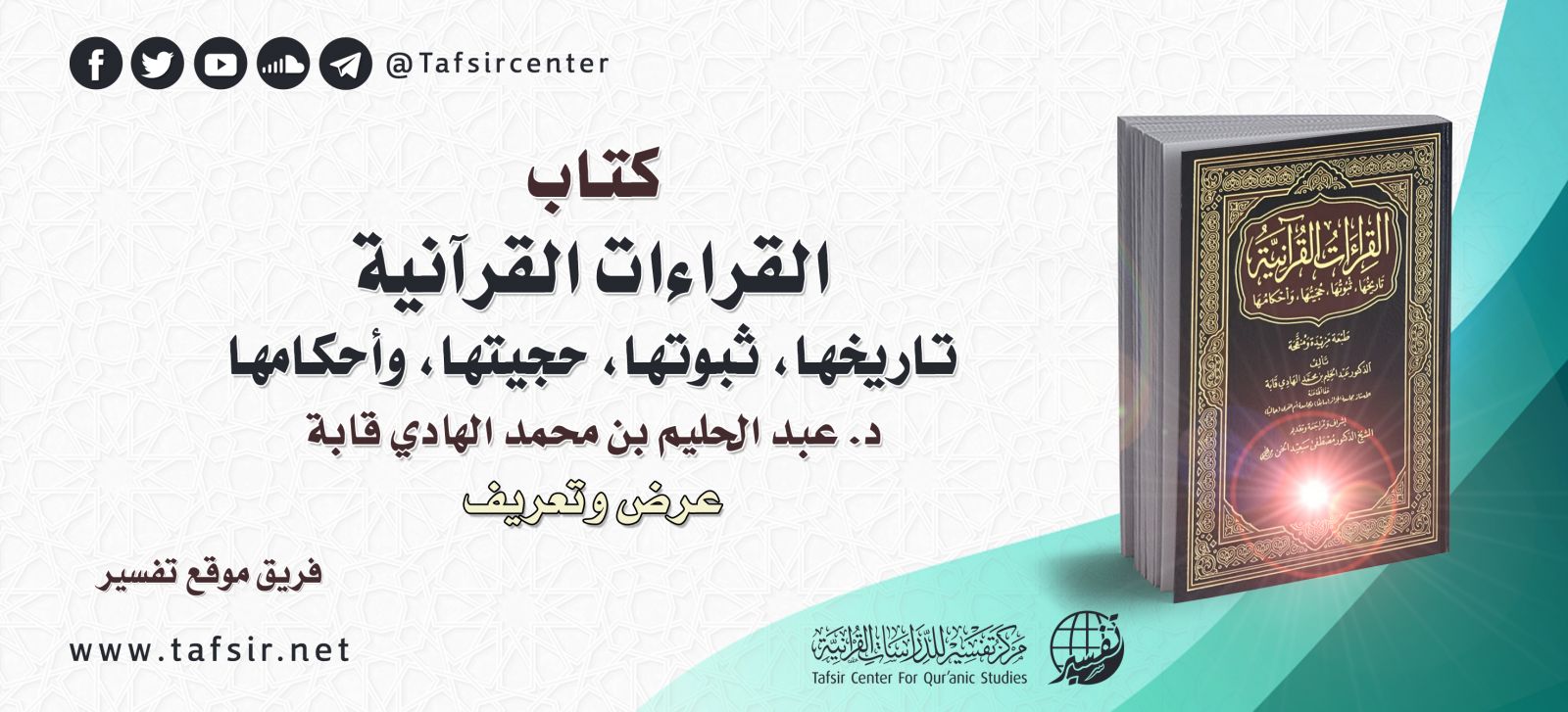القراءات الحداثية للقرآن (9) محمد أركون والرهان الإبستمولوجي للقراءة
القراءات الحداثية للقرآن (9) محمد أركون والرهان الإبستمولوجي للقراءة
الكاتب: طارق محمد حجي

حاولنا في المقال السابق عن المفكر الجزائري محمد أركون[1] أن نُحدِّد الملامح العامة لقراءته للقرآن، فحاولنا أن نُبرِز كيف أنّ خطابه يُعدّ -بصورة كبيرة- تكثيفًا وبلورة وتعميقًا لكثير من أبعاد القراءة الحداثية للقرآن، خصوصًا في تعامله مع فكرة (التاريخية) من جهة رهانها الإبستمولوجي الطامح لتغيير طبيعة النصّ القرآني و(زحزحته) من حقل اللاهوت والإبستيم العلمي القديم إلى الحقل العلمي الحديث بإبستيمته الخاصّة، عبر ترسانة مفاهيمية جديدة يؤطَّر فيها النصّ القرآني، [(الخطاب النبوي)، (الظاهرة القرآنية)، (الظاهرة الإسلامية)، (المدونة النصيّة المغلقة)، (الوحدات النصيّة المتمايزة)، (مجتمعات الكتاب)، (الكتاب المقدّس/ الكتاب العادي)]، وعبر عدّة منهجية متنوعة ما بين الأنثربولولجي والألسنيات والسيميائيات يُشغِّلها عليه، وكذا في تعامله مع (العقل) في القرآن أو (مفاهيم الحساسية والإدراك بتعبيره) والذي قرأه وفقًا لـ(تزامنيته الخاصّة) بغية الابتعاد به عن التلفيقية الشائعة في خطاب النهضة والتي تُسقِط دلالة مفهوم العقل الحديث على مفهوم العقل في القرآن وهي التلفيقيّة والإسقاطية التي استمرت حتى في بعض القراءات الحداثية للقرآن -مثل قراءة أبو زيد والجابري ويوسف الصدّيق كما أوضحنا في تناولنا لهم- والتي تنتمي معرفيًّا لسياق التأسيس الثاني للنهضة برفضه للتلفيق كرهان حاسم للخطاب كما أوضحنا في المقالات السابقة.
كذلك فقد حاولنا هناك إبراز رؤية المفكّر الجزائري لطبيعة النصّ القرآني كنصّ (ذي بنية ميثية)، وللغة النصّ القرآني كلغة رغم أنها تستخدم اللغة العادية بتراكيبها النحوية والصرفية إلّا أنّ علاقتها بالوحي تجعل لها طبيعتها الخاصّة، (فهي اللغة المتعالية ذات القدرة الهائلة على التعالي بالأحداث وطمس تاريخيتها)، وتكون أقرب للمنطق الشعري منها للمنطق العقلاني، وكذا رؤيته للطريقة المثلى -وفقًا له- للتعامل مع النصّ القرآني والتي تتجاوز البروتوكولات الطقسية والإيمانية إلى البروتوكول الألسني النقدي الذي لا يريد تقديم تفسير جديد للقرآن يضاف إلى التفسيرات السابقة؛ الإيمانية التبجيلية السائدة عربيًّا وإسلاميًّا من جهة، أو الاستشراقية الفيلولوجية السائدة غربًا والمحبوسة في وضعانية القرن التاسع عشر من جهة أخرى، بقدر ما يريد تقديم تفسير/ نقد/ تفكيك للنصّ غرضه تفكيك آليات اشتغال النصّ القرآني الذي «مثله مثل التوراة والإنجيل هو نصّ يُقرأ من خلال روح البحث والتساؤل؛ لأنها يمكن أن تُحبِّذ حصول التقدم الحاسم في ما يخصّ معرفة الإنسان»[i].
في هذا المقال الثاني عن أركون سنحاول تتبّع تطبيق أركون لهذا البروتوكول الألسني-النقدي الذي يقترحه بتقنياته المنهجية الدقيقة، في سورتي الفاتحة والعلق تحديدًا، والتي بالإضافة إلى كونهما يَبرُز فيهما تطبيق أركون لمنهجياته في قراءة القرآن، فكذا يَبْرُز فيهما اشتباكه مع المدونة التفسيرية التراثية عبر تفسير الفخر الرازي للفاتحة[2]، واشتباكه مع التعامل الاستشراقي مع القرآن والإسلام والعدّة المنهجية التي يُوظِّفها لدراسته؛ مما يجعل تناولنا لقراءته هاتين السورتين محاولة للاقتراب أكثر من كيفية تطبيق أركون لرؤيته عن القرآن والإطار الجديد الذي يؤطِّره فيه؛ من حيث طبيعة النصّ القرآني وطبيعة اللغة القرآنية، وكيفية تطبيقه للمنهجيات التي يتوسَّلها ويُشغِّلها على النصّ، كذا الاقتراب أكثر من فاعلية الرهان الإبستمولوجي لفكرة التاريخية المركزي في خطابه، بحيث نرى أثر هذا التأطير الجديد الذي يقوم به للنصّ القرآني على فعل القراءة، كذا سنحاول تبيُّن تلك الأهداف التي يبغيها أركون من وراء قراءته هذه، وعلاقة هذه الرهانات برهانات خطاب أركون العامة، وكذا برهانات القراءة الحداثية في المجمل.
سورة الفاتحة، بروتوكولات القراءة:
يبدأ أركون في قراءته لسورة الفاتحة ببيان ما يقصد بالبروتوكولات الثلاثة المفترضة للقراءة: البروتوكول الطقسي، والبروتوكول التفسيري، ثم البروتوكول الألسني-النقدي الذي يقترحه هو.
فيُحدِّد أركون (بروتوكول القراءة الطقسية أو الشعائرية) بأنها «القراءة الوحيدة الصالحة من وجهة نظر الوعي الإسلامي، فالمسلم إِذْ يكرر الكلمات المقدّسة للفاتحة، يعيد تحيين أو تجسيد اللحظة التدشينية التي تلفّظ أثناءها النبي بكلمات الفاتحة لأول مرة. وهذا يعني أنه يلتقي من جديد بالحالة العامة للخطاب الخاصّ بالمنطوقة الأولى. إنه يلتقي من جديد بالمواقف الشعائرية، والتواصل الروحي مع جماعة المؤمنين الحاضرين والغائبين، وبالالتزام الشخصي لكلّ مؤمن بالميثاق الذي يربطه بالله... فلا يعود هناك أيّ معنى للمسافة التاريخية الحقيقية ولا للمسافة الجغرافية التي تفصل شخصًا عن النبي... فهو تواصل يتحدى المكان والزمان والعقلانية الخاصّة بالخطاب (العلمي)»[ii].
أما البروتوكول التفسيري فيقصد به أركون تلك المدونات التفسيرية الطويلة التي أُنْتِجَتْ على مدى قرون التراث الإسلامي، ويعتبر أركون أن تفسير الفخر الرازي (مفاتح الغيب) هو من أكثر هذه المدونات غزارة؛ لاستفادته من البلورة العقائدية للقرون الستّة السابقة، وكذا من مجمل نتاجات الثقافة الإسلامية في مختلف المساحات في كتابته لتفسيره.
وهنا لا بد من الإشارة لتفريق مهم قام به أركون في تعامله مع سور القرآن، ويتجلى هنا بصورة خاصّة في قراءته لسورة الفاتحة يتصل بعلاقة هذين البروتوكولين ببعضهما وعلاقتهما بالبروتوكول الذي يقترحه؛ حيث يعتبر أركون أنّ ثمة منطوقتين للقرآن، منطوقة أولى خاصّة بوضعية التلفظ النبوي الأولى للوحي، وبالنسبة للفاتحة فهي المنطوقة التي تتموضع فيها الفاتحة في رقم ما بين 1 إلى 46، ومنطوقة ثانية وهي المنطوقة (المعتمدة على هيئة الطريقة الجماعية) -بتعبير يستعيره من ليفي شتراوس- أي: المصحف العثماني (بالتعابير اللاهوتية) -وهو جزء من تفريقه بين (الظاهرة القرآنية) و(الظاهرة الإسلامية)-، وهي بالنسبة للفاتحة تلك التي تُعطي لها موقعًا افتتاحيًّا في القرآن يعمل على تعديل انبنائية المنطوقة الأولى لانبنائية جديدة تمامًا، هذا الموقع الجديد للفاتحة في المنطوقة الجديدة يولِّد -وفقًا لأركون- دلالاتٍ ومعانِيَ خاصةً مختلفةً عن تلك التي يثيرها موقعها الكرونولوجي في المنطوقة الأولى غير الممكن الوصول لها[3]، وهذه المعاني والدلالات الجديدة هي التي يُكرِّسها البروتوكول التفسيري والشعائري المتداخلان والمعتمدان على بعضهما في تكريس معانٍ محددةٍ ونهائيةٍ للنصّ وفي تكريس قواعد وإستراتيجيات تفسيرية غير قابلة للزحزحة.
في مقابل هذين التعاملين مع القرآن أو مع سورة الفاتحة تحديدًا يطرح أركون بديله الألسني-النقدي، والذي يقسمه إلى ثلاث عمليات أو ثلاث لحظات: اللحظة اللغوية، واللحظة التاريخية، واللحظة الأنثروبولوجية.
يقوم في اللحظة الأولى اللغوية بتحليل التجلي اللغوي لسورة الفاتحة، فيدرس الضمائر والأسماء والأفعال والعلائق والإيقاع والنظم ومجمل البنية اللغوية-الألسنية لسورة الفاتحة، والتي تتيح لنا فهم خيارات المتكلم أو الناطق، فدراسة عملية القول أو النطق وفقًا للتعبير الألسني ما هي إلا تهيئة وإعداد لفهم المعنى المقصود من قِبل المتكلم.
ويصل أركون من خلال تحليل البنيات النحوية في سورة الفاتحة لإمكان التمييز بسهولة بين أربع لفظات أو أربع وحدات للقراءة القاعدية، ثم سبع لفظات للإخبارية، ويقوم بتوزيعها بهذا الشكل:
1- بسم الله. 1- الرحمن الرحيم.
2- الحمد لله. 1- رب العالمين.
2- الرحمن الرحيم.
3- مالك يوم الدين.
3- إياك نعبد وإياك نستعين.
4- اهدنا الصراط المستقيم. 1- صراط الذين أنعمت عليهم.
2- غير المغضوب عليهم.
3- ولا الضالين.
ليصل أركون بهذا لكون هذه النويات الأربع تحتوي على النموذج العاملي القائم في كلّ سرد لغوي أو حكاية، أي: (الفاعل، الموضوع/ المرسل، المرسل إليه، المعارضون، الأنصار، أو المساعدون)، أي: ما يسميه بالبنية المركزية للتحالف المقدّس، المشكلة لما يسميه -استعارة من لاهوت الكتاب المقدّس- بالنواة التبشيرية القرآنية[iii].
ويختم أركون هذه اللحظة أو المرحلة بالتساؤل حول مضمون ووظيفة المعنى الأخير طبقًا للتراث التفسيري، وكذا بالتساؤل حول إمكانية إطلاق حكم حول درجة المطابقة بين المعنى الأخير الذي يفترضه النصّ التأسيسي الأول، وبين المعنى الأخير المتلقى أو المُجمَع عليه في التفسير التقليدي.
لينتقل أركون بعد هذا للّحظة التاريخية، والتي يتشابك فيها مع التاريخ التفسيري عبر تفسير الرازي للفاتحة، ومن خلال استخدام الرازي كنموذج ومبلور للقراءة التفسيرية الكلاسيكية فإن أركون يعتبر أن ثمة خمس إستراتيجيات تتحكم بالقراءة التفسيرية:
وهي (النسق اللغوي أو الشيفرة اللغوية)، و(النسق الديني الشيفرة الدينية: مجمل المبادئ اللاهوتية والعقدية والطقوس والشعائر)، و(النسق الرمزي الشيفرة الرمزية: قدرة القرآن على تحفيز الخيال)، و(النسق الثقافي: وهو استلهام كلّ ما وصلت إليه الثقافة العربية والإسلامية)، و(النسق التأويلي أو الباطني: وهو الأهم حيث وجود معنى نهائي وأخير للنصّ هو أمر لا يرقى إليه الشك عند الوعي الإسلامي كلّه)، وهي بالطبع مسألة يستشكلها أركون ليتساءل عن مدى إمكان أن نطلق حكمنا على المعنى الأخير في القرآن.
يهدف أركون بهذه المرحلة التاريخية التي يتشابك فيها مع الإستراتيجيات التفسيرية الحاكمة للمدونة التفسيرية التراثية في رأيه لتشكيل تيبولوجي للمعنى عن طريق معارضة الأصلي بالثقافي، والرمز بالعلامة، ولتربية الفكرية بالإيدلوجي، واللغة المثالية أو المجازية باللغة العقلانية المركزية المنغلقة على ذاتها)[iv].
ثم تأتي اللحظة الأنثروبولوجية في قراءة أركون، وهي اللحظة التي يحاول فيها أركون تطبيق نتائج الأنثربولوجي على النصّ القرآني في معارضة لهذا الاحتكار الغربي لهذا الحقل المعرفي.
في هذه اللحظة يقوم أركون بفتح النصّ القرآني عبر الفاتحة على إشكالات الأصل البدئي والحدود الجذرية؛ مثل الموت والحياة، والمقدّس والعنف، والزمن والحب، والقيمة والامتلاك، والخوف والأمل، والإحساس بالذنب، والتي تحيلنا كلّها إلى مسألة الكينونة أو الوجود، وفيها يتولّد المعنى ويتشكّل وينبني، وينهدم، ويستحيل، ويتقلص، ويتسع، وهذا الأصل البدئي الذي لا يمكن التوصّل له إلا عبر اللغة الدينية وإيحائيتها.
وهنا يعارض أركون المنهج الفيلولوجي السائد استشراقيًّا في التعامل مع القرآن بمنهجه الأنثربولولجي، فيرى أن كلّ كلمة من كلمات الفاتحة ولو تعاملنا معها أنثروبولجيًّا لا فيلولوجيًّا فإنها -وفقًا لأركون- تتعدى كونها إشارة إلى عائد ما، بل إنها تحيل إلى ذروة أو إلى عدّة ذرى قصوى للإنسان؛ فالحمد لله...الرحيم: تحيل إلى علم الأصول الأنطولوجية. ومالك يوم الدين: تحيل إلى علم الأخرويات. وإياك نعبد وإياك نستعين: تحيل إلى الطقوس والشعائر. واهدنا الصراط المستقيم: تحيل إلى علم الأخلاق. والذين أنعمت عليهم: تحيل إلى علم النبوة. وغير المغضوب عليهم: تحيل إلى التاريخ الروحي للبشرية، وموضعات رزانية الشر المعالجة في القصص المتعلقة بالشعوب والأقوام القديمة.
فمفردات الفاتحة وبناها النحوية عامة جدًّا، ومنفتحة جدًّا على كافة ممكنات المعنى[v].
ويريد أركون عبر هذه القراءة الأنثربولوجية للفاتحة أن يعيد العلاقة مع الأسئلة الأصلية أو البدئية. نعيدها في ما وراء (أو في ما فوق) التعاليم التي كان التراث الإسلامي عبر القرون قد اعتقد بضرورة فرضها بصفتها تحديدات أرثوذوكسية ومقدّسة للحقيقة الموحى بها[vi].
ويضرب على هذا مثالًا بالتعارض الكائن بين (الذين أنعمت عليهم/ غير المغضوب عليهم)، فالتفسير التقليدي وفقًا لأركون ومعتمدًا على المقولات اللاهوتية والميتافيزيقية والأخلاقية والنفسانية والمنطقية يشكّل نمطين متضادين من أنماط الإنسان: نمط الإنسان الصالح، ونمط الإنسان المكرّس للشّر. في استسلام من التفسير الموروث للمقولات والقوالب الثنوية، والأفلاطونية المحدثة، والأرسطوطاليسية.
يقيم أركون في مواجهة هذا التفسير ومن خلال تواصله الجديد مع الحدود القصوى والأصول البدئية، تعامل ينطلق من الصلاة المرفوعة إلى الله المندرجة في التوتر بين الأمل والخوف المولد للإحساس بالذنب؛ ليفتح للإنسان أمل أن يكون في عداد الذين أنعم الله عليهم، فيحال القائل إلى شرطه الخاصّ ككائن منخرط في وجود مصنوع من الخير والشر، وهو يعي بأن النهاية غير مؤكدة أو غير مضمونة، وأنها تعتمد على هيئة عليا تحكم، فإما أن ترضى على الشخص أو تدينه بشكل لا مرجوع عنه[vii].
سورة العلق، أركون ومنهجيات الاستشراق:
كما أن لقراءة أركون لسورة الفاتحة أهميتها في بيان رؤيته لاشتغاله الخاصّ الذي يقترحه وللاشتغال التفسيري التقليدي وللقراءة الإيمانية كما يراها، كذا لبيان تطبيقي لاعتراضاته على المنهج الفيلولوجي ومدى قدرة هذا المنهج على اكتشاف أبعاد النصّ القرآني، فإن لاشتغال أركون على سورة العلق أهمية كبيرة من حيث قدرته على بيان اشتباك أكبر مع التراث الغربي المتعامل مع النصّ القرآني وللمنهجيات السائدة في هذا التعامل، وكذا من حيث قدرته على بيان الترسيمة الجديدة من المفاهيم التي يؤطّر فيها أركون النصّ القرآني ومدى فعاليتها في تغيير طبيعة النصّ القرآني كرهان أساس لاشتغال أركون.
يحلّل أركون سورة العلق عبر أربعة جوانب كبرى: التحليل النحوي أو القواعدي، وتركيبة الخطاب القرآني المجازية، وبنيته السيميائية، وتداخليته النصانية. فيرى أركون أن التركيبة اللغوية للقرآن وشبكة الضمائر التي تؤسّس الفضاء الأساس والمتواصل والمنتظم للتواصل والمعنى في كلّ الخطاب القرآني متبدية تمامًا في سورة العلق، حيث يتبدّى في هذه السورة الله كذاتٍ فاعلة أساسية حيث يشكّل الأصل الأنطولوجي والمرجع النهائي لجميع المخلوقات والنشاطات والمعاني والأحداث، والنبي كمن يوجه إليه الأمر ويمثل الوسيط بين الله والإنسان، والإنسان باعتباره الكائن المصطفى إلهيًّا كهدف نهائي ومخاطب أخير بجميع المبادرات أو الأوامر والوصايا، وثمة توتر دائم في القرآن بين (نحن) أي: الله. وبين (هو وهم) أي: الإنسان أو الناس. وهدف الوحي هو هداية الناس إلى الصراط المستقيم، الذي يقود في النهاية إلى النجاة في الدار الآخرة، أما أولئك الذين يواجهون الله بالعصيان والتمرد فقد وجه إليهم الخطاب عن طريق ضمير الغائب لكي يرعووا أو يفهموا بشكلٍ أفضل مكانتهم أو مصيرهم المحدد. ويشير أركون إلى أن هذا الوضع ليس تقابلًا ثنائيًّا بين قطبين، بل بالأحرى «جدلية مستمرة من التوتر الصراعي الذي ينبثق من خلاله الوعي بالذنب والخطيئة»؛ ولهذا أهميته حيث يتحول الإنسان بهذا «إلى وعي، وذات مفكرة مسؤولة أخلاقيًّا وشرعيًّا»[viii].
وأما التركيبة المجازية -والمتبدية في العلق في كلمات، مثل: (لنسفعًا بالناصية، الزبانية، ألم يعلم بأن الله يرى)، فيرى أركون أن لها أهمية كبيرة في إضاءة النصّ القرآني، وكشف ظلال المعاني، أو الرمز الكبير بتعبير يستعيره أركون من نورثروب فراي، ورغم هذا فوفقًا لأركون لا يوجد أيّ محاولة بلورة نظرية في التركيبة المجازية للقرآن لا تراثيًّا ولا في الزمن الحديث، ففي التراث الإسلامي انحصر التعامل مع القرآن على التفسير الحرفي من جهة، أو على استخدام القرآن كتُكَأة للشطحات الصوفية والغنوصية من جهة أخرى، أمّا في الزمن الحديث فلا يزال القرآن يعاني من إهمال التبحّر الأكاديمي الاستشراقي في تطبيق أدوات الألسنيات الحديثة ومفاهيمها على الخطاب القرآني، ومن هيمنة التعامل الفيلولوجي المقصر عن بلورة نظرية حديثة عن المجاز، هذا التقصير الذي يتبدى في أعمال نولدكه وبلاشير ووانسبرو وماسون وباريت.
كذلك يشير أركون لأهمية الدروس المنهجية والإبستمولوجية التي نتعلمها لو استطعنا تحديد البنية السيميائية لأنماط الخطاب القرآني، النمط النبوي، والنمط الحكمي، والنمط السردي القصصي، والنمط الترتيلي أو التسبيحي، والنمط الإقناعي، والنمط الجدالي أو الصراعي، فهذه البنية السيميائية توجه كلّ مستويات المعنى الخاصّة بكلّ وحدة نصية قرآنية[ix].
كذلك يشير أركون لأهمية ملاحظة التداخلات النصانية والتي تنكشف بتسييق القرآن في تاريخ المدة الطويلة ووصله بمدونات الشرق القديم وهو ما يتبدّى في كثير من سور القرآن خصوصًا سورة الكهف التي تتداخل نصانيًّا وفقًا لأركون مع أساطير جلجامش والإسكندر، وجميع هذه القصص المنتمي للمخيال الثقافي المشترك والأقدم لمنطقة الشرق الأوسط القديم[x].
منهجيات جديدة؟
في المثالين اللذَين ذكرنا هنا، مثال قراءة أركون لسورة الفاتحة، وقراءته لسورة العلق، وفي اشتغال أركون على (العجيب المدهش) في القرآن والقصص القرآني وطبيعة النصّ والذي تناولناه في المقال السابق عنه، قام أركون باستخدام عدة منهجية مُتَّسِعَة عارض بها التقليدَيْن؛ العربي والإسلامي من جهة، والاستشراقي من جهة أخرى، وقام بتأطير القرآن في طبيعة جديدة يلحقها بناء مفاهيمي ومنهجي جديد، ونستطيع أن نجمل نظرتنا لاشتغال أركون الذي عرضنا له في المقالتين عبر طرح تساؤلين رئيسين على هذا الاشتغال؛ التساؤل الأول: هل بالفعل تجاوز أركون من حيث الإطار المنهجي والأدوات المنهجية طرائق الاستشراق التي طالما انتقدها في كتاباته خصوصًا في قضيتي الحياد تجاه الظاهرة الدينية واستبعاد الإيمان عن أن يكون موضوعًا للفهم، واستخدام وتفعيل منهجيات أكثر جدة وكفاءة في دراسة الإسلام والقرآن تتماشى مع التطوّر الحاصل في دراسات الكتاب المقدّس، أم ظلّ أركون حبيس الطرائق ذاتها؟
التساؤل الثاني، وهو مرتبط كذلك بالتساؤل الأول كما سيتبين في السطور القادمة: بأيّ قدر كان اهتمام أركون بـ(كيف يقول النصّ القرآني؟)، والذي اعتبرناه في المقال السابق أكبر اهتمامات أركون -حائلًا أمام الاهتمام بـ(ما الذي يقوله النصّ القرآني؟)، وعلاقة هذا كذلك بالمنهجيات التي ينتهجها ويقترحها أركون لقراءة القرآن؟
بالنسبة للتساؤل الأول، فإنّ أركون كان قد تحدّث عن ما أسماه بـ(دمج الإيمان)[xi] داخل الدراسة العلمية للظواهر الدينية، واعتبر أن هذا المبدأ المنهجي يستطيع تجاوز الحياد الاستشراقي ووضعانية القرن التاسع عشر في التعامل مع الظواهر الدينية عبر التأكيد على ضرورة أخذ الباحث للموضوع الديني بجديّة تتناسب مع كونه ظاهرة موضوعية ككافة الظواهر الأخرى، وهذا الكلام شديد الوجاهة من الناحية النظرية لم نَرَ له ربما أثرًا من جهة التطبيق، فنحن لا نرى أيّ فارق بين مآلات هذا المبدأ المنهجي بالطريقة التي عرضها أركون وبين طريقة التناول الاستشراقي أو الوضعاني للظاهرة الدينية، وهذا لأن أركون وكما نفهم ومن مثالين محددين، مثال تناوله سورة الفاتحة، والمثال الآخر تعليقه على كتاب (رب القبائل) للمستشرقة الفرنسية جاكلين شابي، لم يتجاوز هذا الموقف المُنتَقَد والمرفوض من قِبَله بل ظلّ حبيسه، فأركون حين يدرس البنية اللغوية لسورة الفاتحة وما تثيره من أثر على القارئ والمخاطب، يجعلها (تُسكن من قبل القراءة وتُحرِّض على احتفال الرغبة)[xii]، فإنّنا نجده يؤكِّد على ضرورة عدم الوقوع في حبائل هذه الرغبة، ويكرِّر نفس حديث ذاك الموقف عن الالتزام بالمسافة بين الدارس والمدروس، (التي توفِّرها تقشفية الألسنيات النقدية) كما يُعبِّر، ويقف عند هذه المسافة فلا يحاول اقتحامها لاكتشاف هذه الرغبة وما تعنيه وما تؤسّس له، بل يصرّ على الموقف المحايد الدارس فقط لـ(طريقة بناء النصّ) لهذه الرغبة، فكأنّ أركون يقع هنا بين ثنائية الخضوع لحبائل هذه الرغبة/ الحياد تجاهها، ويستبعد تمامًا إمكان وضرورة فهم ما تؤسّسه من معنى، أليس هذا الموقف هو ذات الموقف القديم الذي لا يرى في الظاهرة الدينية معنًى يحتاج للاستكشاف بل مساحة من الجهل- الغواية- الفتنة ينبغي الاحتراس منها والسيطرة عليها؟!
الأمر يتضح بصورة أكبر في تناول أركون لكتاب شابي، فبالأساس ينتظم تعليقه على عملها حول دمج شابي لبعض المفاهيم المنهجية المعاصرة الخارجة عن العدّة المعهودة للمؤرخ الكلاسيكي مثل المخيال الديني والرمز، ويعتبر أن الفائدة في هذا الاستخدام هو قدرته على تحقيق دراسة تزامنية أدق للنصّ ولطريقة بنائه تربطه بسياقه التاريخي المحدد وبالطرائق التي يوفرها هذا السياق في بناء المعنى، ونحن نتساءل هنا ما فائدة نقد حياد الاستشراق أو وضعانية القرن التاسع عشر طالما لم يتغير الموقف من الظاهرة، حيث إنّ القرآن هنا يظلّ هو الوثيقة المطلوب تحقيق تاريخها، والابتعاد عن أثرها لدراستها (موضوعيًّا)، والتغاضي عن فهم معناها في مقابل دراسة طريقة بنائها المرتبطة بسياقها التاريخي، وهذا هو نفس الهدف الفيلولوجي العتيق المُنتَقَد من قِبَل أركون، والأهم أن هذا هو ما يتعارض تمامًا مع منطق ما يخايل به أركون من منهجيات حديثة خصوصًا في علوم الأديان وفي الألسنيات، حيث تنطلق هذه الأخيرة من تحليل الظواهر الدينية بما في ذلك النصوص الدينية بما هي ظواهر معنى بالأساس كما يُعبِّر إلياد[4]، بغية فهمها كانزياحات كبرى في تاريخ الإنسانية تخلق أنماطًا جديدة للعيش وطرائق جديدة للوجود وفضاءات أكثر ثراءً للمعنى، ورغم حديث أركون كثيرًا عن أهمية العوالم التي يخلقها الدّين إلا أننا لا نجد لهذا صدًى في تحليلاته، فلا نجد تساؤلًا عن هذا المعنى المراد عيشه، أو محاولة لاستكشاف هذه العوالم التي يؤسسها.
إِنّ المعنى هاهنا وللمفارقة يفقد معناه، حيث إنّ المعنى المطلوب دمجه في الممارسة العلمية وفقًا لتنظيرات أركون يتم تطبيقيًّا حبسه وراء زجاج على الباحث أن يقف خلفه بحجة (العلاقة النقدية)، وهذا لا يتعارض فقط مع ما يشي به حديث أركون من حمل خطابه موقفًا منهجيًّا جديدًا ينطوي على تحرير لهذا المعنى، وفتح للذهن الحديث من أجل دراسته و(دمجه)، لكن -وهذا هو الأهم- يتعارض مع ما تفترضه المناهج هذه من طبيعة هذا المعنى وطبيعة عملية استكشافه، من حيث هي طبيعة تأويلية في عمقها تفترض تداخل الباحث مع موضوعه وانفتاحه عليه والسماح لهذا الموضوع كذلك بالانفتاح على عالمه هو الخاصّ، مما يجعل أيَّ حديث عن اصطناع مسافة بين الذات والموضوع حديثًا (خاليًا من المعنى)!
ولعلّ هذا يذهب بنا للتساؤل الثاني الذي طرحناه على اشتغال أركون، وهو بأيّ قدر أثَّر اهتمامه باستكشاف طريقة عمل القرآن (بناء العالم وخلق المعنى) على الاهتمام بما يقوله القرآن ويؤسّسه (المعنى الذي يخلقه)؟
في ظننا أن الاهتمام بكيف يقول النصّ قد حجب تمامًا ماذا يقول النصّ، ورغم أننا نتفق مع أركون في مبدئية هذه الخطوة -خطوة تحديد (كيف يقول النصّ؟) وأهميتها الشديدة- إلا أنها تظلّ في الأخير خطوة مبدئية عليها ألّا تحجب الخطوة الأهم والأساس (ماذا يقول النصّ؟)، وهذا انطلاقًا من نفس المناهج التي يتحدث عنها أركون، ومن استحضار اشتغال نفس الأسماء التي يذكرها مرارًا في سياق نقاشاته و(شكاياته) عن حال الدراسات القرآنية في الغرب مقارنة بالدراسات اليهودية والمسيحية، فالمؤكد أن إيمانويل ليفيناس وبول تيليش وبول ريكور الذين يذكرهم مرارًا أركون بمناهجهم الظاهراتية والـتأويلية المطبقة في اليهودية والمسيحية ورغم اهتمامهم الكبير بـ(كيف يقول) التوراة والإنجيل، قد اهتموا كثيرًا بـ(ماذا يقول) التوراة والإنجيل، وباستكشاف العوالم التي تخلقها هذه النصوص للعيش كما نرى هذا بكلّ وضوح فيما قدموه من تأويليات رفيعة للكتاب المقدّس وللإنجيل.
كما أنّ اهتمام هؤلاء الدارسين للمفاهيم المنهجية المعاصرة الغائبة عن الاستخدام الوضعاني والاستشراقي الكلاسيكي -مثل مفاهيم (المخيال)، (الرمز)، (الوجود الأصيل)- لم يقف عند هذا الحدّ شديد الجزئية والفيلولوجية من إثبات صلة نصّ بتاريخٍ ما كما يشير أركون في تعليقه على كتاب شابي، بل على العكس، حيث استطاعوا عبرها التحرك بالظاهرة الدينية خارج منظور (الحقيقة- الكذب)، و(الصواب- الخطأ) الذي خلقته وضعانية القرن التاسع عشر، انطلاقًا من كون العوالم الدينية تحوي حقائق ربما أكثر صلابة من الواقع ذاته وأكثر أصالة واتساعًا من الانحصار في هذه الثنائيات[5]، مما يعني أن استخدامهم لمثل هذه الأدوات والمناهج مثَّل تجاوزًا حقيقًّا للموقف الوضعاني العتيق لم نجد عند أركون إلّا انتقادًا نظريًّا له وشكاية متكررة منه.
هذا التفاوت بين تطبيقات أركون وبين ما يدعو إليه من مناهج ورؤى، لم يقف عن حد تفويت الإطار المنهجي الذي تفترضه المناهج المعاصرة التي يدعو لها والانحباس في ذات الموقف المنهجي القديم فحسب، بل تجاوز هذا لتفويت الاستخدام التطبيقي لهذه المنهجيات في المساحات التي تفترض هذا، أو الاستخدام غير الثري لها في ظننا في مساحات أخرى.
فمثلًا في دراسته للفاتحة، نجد أركون ينظر لـ(القراءة الشعائرية) نظرة تبعد تمامًا عما تفترضه المناهج التي يدعو لها، حيث تفترض هذه المناهج أن الشعائر جزء من (بنية الدين الأساس)، مما يعني عدم إمكان التخلي في التحليل عن استحضار البُعد الطقسي للظواهر وللنصوص الدينية؛ لكونها بُعدًا من أبعاد الظاهرة ذاتها[6]، بحيث إن عزل هذا البُعد الشعائري هو تغيير لماهية الظاهرة المدروسة، ورغم حديث أركون عن أهمية القراءة الشعائرية للقرآن في أكثر من موضع تماشيًا مع منطق هذه المناهج، وإعطائها دورًا مهمًّا كمستوى من مستويات وحدة النصّ[7]، إلا أنه لا يستخدمها كبُعد من أبعاد القرآن له دوره في فهم معناه واستكشاف العالم الذي يؤسّسه، فلا يلتفت أركون لكون القرآن نصًّا يقدّم ذاته ككلام الله الأزلي القائم في أُمّ الكتاب (الأركتيب السماوي)، ويكرس هو ذاته شعائريته بدعوته الدائمة لتلاوته كذكر الله الدائم والأخير، وإذا كانت التلاوة الشعائرية لأيّ نصّ ديني ليست أداءً له، بل هي نمط عيش وتحيين عالم ديني خاصّ مراد خلقه من قِبَل هذا النصّ، فإن الأمر يزداد بالنسبة للإسلام حيث إن العالم الديني الذي يقترحه القرآن هو عالم يقع (البيان الإلهي) في قلبه، كلّ هذا يضاعف أهمية هذا البُعد في قراءة القرآن ويحتم الالتفات إليه في تحليله، لكن للمفارقة، فإن كلّ هذه الآفاق التي تنفتح للفهم بالانتباه لهذا البعد الشعائري وباستحضاره في تحليل النص كبُعد من أهم أبعاده، يفوتها أركون بمحاولته تجاوز هذه القراءة كقراءة مُعِيقة عن فهم النصّ!
كذلك يتناسى أركون في محاولته تحديد (طبيعة النصّ القرآني) كون القول الديني هو تجلٍّ سردي لألوهةٍ ما، مما يعني ضرورة تحديد سمات الألوهة الإسلامية كخطوة مبدئية في سبيل تحديد طبيعة القرآن، -مثلما فعل ريكور في تعامله مع نصّ التوراة على سبيل المثال[8]-، فتسييق القرآن في (مجتمعات الكتاب) كما يفعل أركون، كان يتطلب منه ربما البحث عن حضور القرآن كآخر تجليات الإله الإبراهيمي الذي يسرد[xiii]، بما أن السرد هو (وساطة غير مكتملة) بين البرهان والتخييل، وأن ينطلق من هذه النقطة لفهم طبيعة القرآن، فلعلّ استحضار مثل هذه المقاربات والمناهج -استحضارها بالفعل وليس بمجرد الحديث النظري عنها- كان سيغير نظرة أركون عن (ميثية النصّ القرآني)، وسيجعل أركون لا يلجأ لمجرد الشكاية من مقدار صحة ومتانة تقنيات غريماس ومدى إمكان تطبيقها على النصّ القرآني[xiv]، فالسرد ليس الميث، وسرد القرآن ليس برهانًا أرسطوطاليسيًّا لكن لا يلزم من هذا كونه ميثًا، لكن لأن أركون ظلّ محصورًا داخل هذه الثنائيات برهان/ ميث، عقل أرسطي/ عقل شعري، وداخل الاختيار من المقاربات القائمة، فقد انتهى به الأمر لاعتبار القرآن ذا بنية ميثية، وإلى اعتبار القصص القرآني -رغم أن أركون انتبه قليلًا للفرق بين القصة القرآنية والقصة الأسطورية من حيث تكريس القصة القرآنية لتعالي الإلهي- له نفس آليات الحكاية الأسطورية لمجرد وجود تشابهات بين طريقتي السرد، وتناسى نمط حضور السرد وعلاقته بالنظام العقدي كمحددات أساسية لطبيعة السرد لإله سمته السرد[9]، وهذا في ظنّنا عزوف عن الأهم وفقًا للخطاب ذاته ورهاناته المعلنة واهتمامه الأساس الملحّ عليه، أي: سؤال (كيف يشتغل النصّ ويؤسّس معناه؟) والذي يفترض محاولة بلورة نظرية عن طبيعة القرآن، وما يتصل بهذا من طبيعة السرد القرآني وطبيعة القصّة وانغراس هذا في نمط الألوهة التي يقترحها النصّ.
لو حاولنا الآن أن نجمل موقفنا تجاه اشتغال أركون الذي قادنا إليه طرح هذه التساؤلات على خطابه، سنقول: إننا لو وافقنا أركون على أهمية وثراء المنهجيات التي يدعونا لتطبيقها وقبل هذا اختلاف موقفها عن الموقف الاستشراقي والوضعاني، ولو وافقنا على إمكان تطبيقها على النصّ القرآني بل وأهميته ومدى ما يَعِد به من خلق فضاءات جديدة للفهم، فسنظلّ مختلفين معه في مقدار خروجه هو من هذه السياجات التي انتقدها والوقوف موقفًا جديدًا بالفعل من الظاهرة المدروسة، كما سيظلّ التساؤل قائمًا حول مدى كفاءة وثراء تطبيقه لهذه المنهجيات بالفعل ومقدار الاستفادة الحقيقية منها.
وربما هذا يجعلنا نتساءل حول فائدة هذا الحديث الدائم لأركون عن المنهجيات والعلوم دون التعامل الثري معها، إنّ حديث أركون الاعتذاري الدائم عن عدم وجود وقت من أجل استكمال مشاريع العمل ومقترحات البحث قد يُفهم في بعض السياقات، لكن غير ممكن أن تظلّ المفاصل الرئيسة للمشروع الناظمة لفعل القراءة -مثل طبيعة النصّ مثلًا- غير مُحرَّرَة بصورة متماسكة! أيكون رهان الزحزحة قد سيطر على اشتغال أركون لدرجة أنه لم يُعقه عن بلورة نتائج مهمّة فحسب بل كذلك أعاقه عن بلورة المفاهيم الأساس التي أراد تأطير القرآن فيها من أجل إنجاز هذه (الزحزحة من الإبستيم القديم) ذاتها بصورة متماسكة يتجلى فيها بالفعل أثر المنهجيات الحديثة التي يريد تشغيلها على القرآن؟!
أركون، المنهجيات الحديثة والقرآن:
بما أن أركون يُكثِّف ويُعمِّق -كما حاولنا أن نُبرِز في مقالَتينا عنه- مجمل محدِّدات وأبعاد القراءة الحداثية للقرآن، فإن خطابه ربما يكون هو الأنسب كفضاء لنقاش قضية رئيسة في هذا الخطاب، وهي القضية التي قلنا إنّ أركون قد أَولاها هي تحديدًا الاهتمام الأكبر، ألَا وهي التاريخية ورهانها الإبستمولوجي والذي يعني القيام بتغيير طبيعة النصّ القرآني والقيام بتأطير جديد لطبيعته عبر تسييقه في حمولة مفاهيمية جديدة تنتمي لحقل العلوم الحديثة لتهيئته لتطبيق منهجيات هذه العلوم عليه.
فنحن نريد التساؤل هنا حول مدى قدرة هذا التأطير الجديد المفاهيمي فالمنهجي للقرآن الذي قام به أركون -أو دعى إليه- على فتح آفاق جديدة لدرس النصّ القرآني، وعن مدى مشروطية ذلك، بمعنى هل بالفعل لا يمكن فتح ممكنات وآفاق جديدة لدرس النصّ القرآني إلا عبر تغيير طبيعة النصّ؟ هل طبيعته المُستقِرة في المدونة التقليدية كنصّ أزلي مفارق هي التي تُعارِض هذا؟ وهل لا يمكن استلهام المنهجيات الحديثة في قراءة القرآن دون أن نقوم بتغيير طبيعته؟
بالطبع هذه الأسئلة نحن نسألها في مرحلة لاحقة لهذه النتيجة التي عرضناها في المقالات السابقة، عن كون القراءات الحداثية انتقائية في منهجياتها التي تُطبِّقها على النصّ، كما أنها تستخدم في الغالب منهجيات لم يَعُد لها هذا الألق الكبير ولا القدرة التفسيرية الكبرى المُبرِّرَة للهاث وراء تطبيقها حتى في السياق الغربي المُنشِئ لها ذاته، لكن بما أن أركون يُصر دومًا على استخدام المنهجيات الأكثر جدة، ويقيم جداله مع الخطاب الاستشراقي على أساس تغييب هذا الأخير -الإسلام عن الدرس عبر المنهجيات الأحدث والأكثر قدرة على التعامل مع الظاهرة الدينية ومع النصّ القرآني بصورة أكبر من تلك المنهجيات الموروثة من وضعانية القرن التاسع عشر؛ لهذا ولما ذكرنا عن رؤيته لرهان التاريخية الإبستمولوجي، فإنّ خطابه هو المساحة الأنسب ربما لنقاش القضية الأعم والأشمل وهي قضية تطبيق منهجيات حديثة في دراسة الإسلام وفي دراسة القرآن، ومدى مشروطية تغيير طبيعة النصّ من أجل فتح آفاق درسه وتحرير إمكانات المعنى فيه.
بدايةً فنحن نظنّ أنّ قضية مثل قضية المنهجيات الحديثة وإمكان تطبيقها على دراسة الإسلام أو دراسة القرآن، هي قضية لا يحسن فيها النقد المبدئي، أي: النقد الذي يرفض مبدئيًّا ومنذ اللحظة الأولى تطبيق منهجيات حديثة على النصّ؛ انطلاقًا من اختلاف السياق المعرفي المنشئ لهذه المناهج عن السياق المعرفي الذي وجد فيه النصّ، -حيث إننا لا نتفق مع فكرة أنّ ثمة سياقًا معرفيًّا غربيًّا شاملًا مؤطّرًا لكلّ المنهجيات على تنوعها الجذري أحيانًا-، وإنما في ظنّنا فإنّ منهج التناول والنقاش الأمثل لقضية كهذه هو تفكيكها لعدد من الإشكالات، أو بمعنى أدقّ إرجاعها للإشكالات المُؤطِّرة لها والتي وحدها تعطيها حضورها ودلالتها، والتي يمكن لنا تناولها كثلاثة إشكالات أساسية، الإشكال الأول هو الرهان المُتغيَّى من تطبيق منهجيات حديثة على النصّ القرآني، الإشكال الثاني هو مدى دقّة هذا التعبير تعبير استخدام منهجيات حديثة للدلالة على ما يقوم به الخطاب الحداثي في تناوله للقرآن، والإشكال الثالث حقيقة عدم التَوَفُّر على دراسة متماسكة للمنهجيات التقليدية التي نشأت حول القرآن في التقليد الإسلامي الطويل والمتنوع.
فبالنسبة للإشكال الأول: فإنّ تطبيق منهجيات حديثة على القرآن له داخل الخطاب الحداثي رهانات مُحدَّدة، ليست مُنحصِرَة في هاجس الفهم وفتح آفاق الدرس وحدها، بل كما قلنا مرارًا فإنّ لهذا الخطاب بتطبيقه هذه المنهجيات رهانات خاصّة مرتبطة برؤيته لتاريخ التنوير الغربي وأسباب إخفاق التنوير في السياق العربي الإسلامي، بحيث تكون قراءته للقرآن عبر هذه المناهج محاولة لتجاوز ما يعتبره سمات خطاب النهضة المعيقة لإنجاز التنوير؛ خصوصًا التلفيق والتجاور والتساكن بين الأنظمة المعرفية، ومحاولة منه لتجاوز صيانة بعض مساحات العقل والوجدان عن تطبيق بعض المنهجيات الحديثة عليها، وهذا عبر تحويل الفكر الغربي لأداة منهجية مُشغَّلة على القرآن كأعمق مساحات الوجدان الديني والعقل المعرفي المُؤسِّس لأنظمة المعرفة. وفي ظننا فإنه لا يمكن نقاش إشكال المنهجيات الحديثة وتطبيقها على القرآن خارج الوعي بهذا الرهان، فلهذا الرهان آثاره في اختيار منهجيات مُحدَّدة ورفض منهجيات أخرى، أو في تشكيل المنهجيات المستعارة بحيث تؤدي لنتاجات مُرادة مُسبَقًا تُمثِّلها الأفكار والقيم المركزية لخطاب التنوير العربي، فقضية تطبيق منهجيات حديثة على النصّ ليست قضية أدواتية محضة بل هي قضية تتعلق بمنظور أوسع لقضايا التنوير والنهضة والإصلاح والدين وموقعه في هذا السياق.
وهذا يذهب بنا للإشكال الثاني، حيث إنّ هذا الدال (منهجيات حديثة) هو دال من أكثر دوال الخطاب الحداثي عمومية وغموضًا، حيث يحيل لعالم لا ينتهي ولا يتوقف للحظة من المنهجيات التي لا تني تنشأ وتتطور وتتعقد وتتداخل يومًا بعد يوم، وربما هذا ما يشير إليه أركون نفسه حين يكرّر بأنه واعٍ تمامًا للخلافات بين المدارس في المنهجيات التي يستخدمها، وحين يُحدِّد موقفه بأنه لن يحصر نفسه داخل مدرسة واحدة بشكل أرثوذوكسي للاستفادة من مجمل المدارس، هذا الاستخدام الغامض لمفهوم المنهجيات الحديثة وعدم تقديم المبررات الكافية لاستخدام منهج دون آخر أو للتلفيق بين المناهج يكشف بصورة كبيرة عن كون عملية استلهام المناهج الغربية الحديثة هي عملية سلبية للغاية بعيدة عن أيّ إبداع، أو استشكال أو نقد أو تبيئة، وهذا لغلبة (رهان الاستخدام) المُنغرِس في سياقات الخطاب المعرفية المرتبطة بتصوّر الخطاب لذاته ولموقعه في تاريخ التنوير ومسيرته، على (رهان الفهم)، (رهان تكريس فهم موضوعي حقيقي بالتراث وبالإسلام وبالقرآن)، بل إنّ هذه السلبية تجعل الفهم العلمي والموضوعي المُعلَن دومًا من قِبَل رواد الخطاب كخصيصة تميزه عن الخطاب النهضوي والإصلاحي -أو (التأسيس الأول للنهضة)- مجرد رداء وطلاء لا أكثر[10].
وهذا ما يتجلى بوضوح في الإشكال الثالث، فإذا كان عدد لا بأس به من المنهجيات المعاصرة في علم الأديان وفي قراءة النصوص هي تطوير لمنهجيات نشأت حول الكتاب المقدّس -الذي لا يبلغ تاريخه التفسيري الحدّ الكبير لو قارنّاه بالمدونات وبالتقليد التفسيري الناشئ حول القرآن- ألا يكون الأَولى لرواد القراءة الحداثية في محاولتهم تكوين (فهم موضوعي وعلمي) القيام باستكشاف ثم تطوير الممكنات القائمة في التقليد الإسلامي من أجل بلورة منهجيات معاصرة للتعامل مع الأديان ومع النصوص؟ -ليس الإسلام وحده ولا القرآن وحده، فالعقول (المبدعة)؛ مثل ريكور وتيليش وليفيناس انطلقوا من دراسة نصوصهم الدينية وأديانهم الخاصة نحو بلورة رؤى ومقاربات أصبحت تُطبَّق على أديان ونصوص أخرى بكفاءة كبيرة هي التي دعت لمحاولة استعارتها-، أو حتى أن يُبذَل جهد في محاولة إنجاز تبيئة حقيقية ومثاقفة رصينة لهذه المنهجيات المعاصرة مع المنهجيات التقليدية التفسيرية المتروكة دون بلورة تكشف حدودها وإمكاناتها وآفاقها؟!
إنّ تثوير النصّ القرآني وتجديد معانيه وتحريره من (التَكَلُّس) و(المعاني المكرورة) قد يشترط بالفعل استلهام كلّ الثقافة المتاحة في عصرٍ ما، لكن في إطار مثاقفة وحوار حقيقي بين المناهج لا في إطار انتقاء وإسقاط وتوظيف لمنهجيات حديثة بغرض إلباس الدعاوى الأيديولوجية رداءً علميًّا برانيًّا.
والأهم أنّ هذا لا يتطلّب بحالٍ القيام بتغيير لطبيعة النصّ القرآني، فرغم أن تغيير طبيعة النصّ يُنظر إليه في سياق القراءات الحداثية، على اعتباره تجديدًا جذريًّا في بناء الخطاب يتجاوز عملية التلفيق والإسقاط التي يُوسَم بها الخطاب النهضوي والإصلاحي، إلا أن هذا -وكما بينّا في المقال السابق- مرتبط فحسب بموقف الحداثة من (الذاكرة الأزلية) ومن الأركتيبات التي تنظر لها كـ(أصنام ذهنية) مشوّشة على نور (العقل الفطري)، مما يجعل النصّ بطبيعته المستقرة هذه عائقًا أمام الحداثة لا بد من إزالته، أمّا فتح آفاق النصّ للفهم فلا علاقة له بهذا التغيير في طبيعة النصّ.
وربما من أجل توضيح عدم المشروطية هذه بين إخراج ممكنات النصّ القرآني وبين طبيعة النصّ فنحن نحتاج للاطلاع بصورة واسعة على محاولات تجديدية في سياق الدرس القرآني تنطلق من طبيعة النصّ المُستقِرَّة في المدونة التقليدية، -وهي محاولات غائبة عن الاستشكال والحوار في خطاب القراءة الحداثية كالعادة!- ففي ظنّنا فإنّ هذا كفيل بإسقاط وتجاوز تلك الحمولات التقييمية -الأيديولوجية- التي تحصر (التجديدية) بالقراءات الحداثية[11]، وبيان أن استكشاف آفاق وممكنات النصّ القرآني، وفتحه على آفاق الكينونة والوجود كما يتحدث أركون مرارًا، لا يشترط القيام بهذا التغيير، بل ربما يفترض عدم القيام به!
[1] انظر المقال الأول بعنوان: (القراءة الحداثية للقرآن (8)، محمد أركون والرهان الإبستمولوجي للقراءة؛ أولًا: طبيعة النصّ القرآني)، على هذا الرابط: tafsir.net/article/5185
[2] بالطبع هذا تجوّز كبير منا أن نعتبر مجرد هذا التناول غير المعمّق ولا المتسع لتفسير الرازي للفاتحة هو نوع من اشتباك مع التفسير التقليدي، والحقيقة أنه لو عبّرنا بدقّة فلا يوجد أيّ اشتباك حقيقي للقراءات الحداثية مع أيٍّ من التأويليات الكلاسيكية، وهي سمة سنتناولها تفصيلًا في مقال (الخلاصات) في نهاية هذه السلسلة.
[3] نحن نستغرب حديث أركون عن استحالة التوصّل لحالة المنطوقة الأولى، فلو كان المقصود عدم القدرة على عيشها كما هي مرة أخرى، فهذا طبيعي، لكن ما نظنه مهمًّا في مسألة البُعد الشفهي للمنطوقة الأولى واختلافه عن البُعد الكتابي للمنطوقة الثانية، أي: طريقة الأداء الشفهي للنصّ، بسكتاته العميقة، فإن هذا البعد -وكما يقول أركون نفسه- استمر وتأبَّد في الممارسة الشعائرية للقرآن، بل نحن نستطيع القول أن جزءًا كبيرًا من مجهود التراث الإسلامي الناشئ حول القرآن، في علوم رسم المصحف وعلم القراءات، وعلوم الأداء، كان في محاولة الحفاظ على هذه العلامات المُحدِّدة للقول الشفوي من أجل استعادته في تلاوة النصّ شعائريًّا وفي فهم النصّ كذلك. انظر: القرآن من التفسير الموروث إلى تحليل الخطاب الديني، ص38.
[4] يرى إلياد أن دراسة الظواهر الدينية وإن كانت تستخدم منهجيات تاريخية أو أثنوغرافية إلا أنه لا بد لمؤرخ ودارس الأديان أن ينتهي ظواهريًّا بتعبيره، حيث إنه يدرس في الأخير ظواهر معنى، ومن هنا دعوته لتلك التوليفة المنهجية التي أضحت أساسًا في بلورته لعلم الأديان العام، وانتقاداته الدائمة للمناهج الاختزالية التاريخية والاجتماعية في دراسة الظاهرة الدينية، وتنبيه على كون الأديان ورغم أنها تتجلى تاريخيًّا وفي سياقات مخصوصة إلا أنه لا يمكن حصر معناها في هذه السياقات، ومن اهتمامه لـ(لتأويل الخلاق) كجزء من عملية استكشاف معنى الظواهر الدينية، فالتحليل التاريخي للظاهرة الدينية لا يقول لنا في النهاية ما هي التجربة الدينية حقيقة، انظر: البحث عن التاريخ والمعنى في الدين، مرتشيا إلياده، ترجمة: سعود المولى، المنظمة العربية للترجمة، بيروت، ط1، 2007، ص50، 134.
[5] في كتابه (الإسلام والتحليل النفسي) كان فتحي بن سلامة قد تعرض لتوصيف فرويد للدين كـ(وهم) مرتبط بجزع الطفولة، واعتبر فتحي أن مقولة الوهم لا بد من النظر لها بشكل يتخطى كونها مقولة خاصّة بالخطأ والصواب أو بالحقيقة كمطابقة لواقع، إلى كونها مقولة تتعلق بالمستحيل الذي يُداوَى عبر نجاعة الخيال، حيث يفترض بن سلامة أن الجزع الطفولي هو حقيقة أكثر رسوخًا من أيّ عقلنة ثانوية لها؛ لذا فهي لا تحل عبر العقلنة، بل عبر نجاعة الخيال، نحن نذكر هذا المثال فحسب من أجل إيضاح الفرق بين التفهم المنهجي الحقيقي للظاهرة المدروسة الذي يظهر في تناول بن سلامة وبين التفهم المنهجي الذي يبدو وكأنه أشبه بترضية والذي يظهر مرارًا عند أركون. الإسلام والتحليل النفسي، فتحي بن سلامة، ترجمة: رجاء بن سلامة، دار الساقي، بيروت، ط1، 2008، ص60.
[6] كما قلنا مسبقًا فإنّ دارسي الأديان يعتبرون أن البنية الأساس للدين هي المعتقد والشعائر والسرد، والأخلاق والتشريعات هي من المكونات الثانوية، مما يجعل النصّ الديني (بما هو قول سرديّ يسرد حكاية الأصل وتاريخ النجاة ويذكر بالمآل ويطلب تلاوته شعائريًّا ويتضمن وصايا وتشريعات) هو تجلٍّ لمجمل البنية الأساس والمكونات الثانوية، فضلًا عن ارتباط هذا التجلي بالقداسة ذاتها بتجليها الوجوبي والوجودي على ما ذكرنا سابقًا، كلّ هذا يجعل عزل القول الديني عن الشعائر وعن السرد وعن سمات الإله، قائل هذا القول هو إخراج لهذا القول عن طبيعته.
[7] كما ذكرنا في المقال الأول عن أركون، فإننا نستطيع القول أنّ أركون يعتبر أن ثمة مستويين لوحدة النصّ القرآني، الأول نابع من النصّ ذاته، والثاني ناتج من الوحدة المضفاة عليه عبر التعامل الشعائري معه، ونستطيع إضافة بُعد ثالث وهو التلقي الإسلامي في التجربة التاريخية له كنصّ له وحدة، وبالإمكان متابعة هذا النقاش حول الوحدة بين أركون وعدد من الكتاب الغربيين، في مناقشة دراسته حول العجيب المدهش في القرآن، المنشورة في كتابه، الفكر الإسلامي، قراءة علمية، ترجمة: هاشم صالح.
[8] لبول ريكور الفيلسوف الفرنسي دراسة عن الهرمنيوطيقا التوراتية والهرمنيوطيقا الفلسفية حاول فيها تبيان السمات الخاصة للقول التوراتي وهرمنيوطيقاه والعلاقة الجدلية بين الهرمنيوطيقا الفلسفية والهرمنيوطيقا اللاهوتية والتي هي لعبة علاقات متناقضة كما يقول تصير فيها الهرمنيوطيقا التوراتية تابعة للفلسفية، ثم تعود لتصبح هي منظمتها، ويتناول هنا ريكور سمة السرد كسمة مركزية للإله التوراتي الذي يجعل الإله أكبر فاعل في تاريخ الخلاص، وهو ما يفرقه تمامًا عن إله الفلسفة الإغريقية، وهذه الدراسة منشورة في كتابه من النصّ إلى الفعل. انظر: من النصّ إلى الفعل، أبحاث التأويل، بول ريكور، ترجمة: محمد برادة، وحسان بورقية، عين للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية، القاهرة، ط1، 2001، فصل (هرمنيوطيقا فلسفية، وهرمنيوطيقا توراتية)، من ص91.
[9] إذا كان ريكور اعتبر السرد سمة من سمات الإله التوراتي، فإننا نستطيع القول أنّ طبيعة السرد تختلف وفقًا لصورة الإله في كلّ دين، حيث إنّ السرد هو تجلي هذه الألوهة، مما يجعله حتمًا يحمل سماتها في بنيته وطبيعة حضوره ذاتها، حتى قبل تفاصيل العمليات السردية التي يقوم بها.
[10] الحقيقة نحن حين نتأمّل هذا التأسيس الثاني للنهضة، نجد أن موقع الحداثة لم يتغير فيه، حيث ظلت مجموعة القيم والمعايير المنظور إليها كنتاج كوني للحداثة مرادة كهدف لهذا الخطاب دونما استشكال أو نقد، لكن الذي اختلف هو نمط تنزيلها في الواقع العربي، حيث ارتأى هذا التأسيس الثاني كون التنزيل الفوقي غير ممكن، مما يتطلب تجذير هذه القيم داخل أعمق مساحات الواقع العربي، في منظومته للمعنى ذاتها؛ لذا فقد حاول هذا التأسيس القيام بتوطين هذه القيم كما يعبر عبد المجيد الشرفي، وهذا في ظننا لا يمكن أن يكون عكس التلفيقية، بل هي تلفيقية مضاعفة، فبدلًا من قراءة القيم الحديثة من فوق صفحة النصّ، تم تحويلها لمقاصد له أو مغاز أو مساحة غير مكتشفة، وهذا يعتبر تلوينًا وطلاءً للتلفيقية برداء علمي لا غير، وهذا ما يفسر بقدرٍ ما هذا التنوع في الأزياء المستوردة لإخفاء العيب نفسه، أي: عيب التلفيق.
[11] لهذا فنحن وبعد انتهاء هذا المسار -مسار (القراءات الحداثية)- فإننا سنقوم بتقديم مسارات جديدة؛ مسار للقراءات الشيعية المعاصرة، ومسار للقراءات القرآنية نحاول فيها توضيح كيف يسير هذا الجدل والذي لا حلّ له عند الحداثيين سوى تغيير طبيعة النصّ بصورة ربما تُؤسِّس الجدة على أساس طبيعة القرآن (كنص أزلي) ذاتها.
[i] القرآن من التفسير الموروث إلى تحليل الخطاب الديني، محمد أركون، ص121.
[ii] نفسه، ص120.
[iii] نفسه، ص133.
[iv] نفسه، ص139.
[v] نفسه، ص143.
[viii] نفسه، ص31.
[ix] نفسه، ص36.
[x] نفسه، ص40.
[xi] الفكر الإسلامي واستحالة التأصيل، نحو تاريخ آخر للفكر الإسلامي، ترجمة: هاشم صالح، دار الساقي، ط1، 1999، ص42.
[xii] نفسه، ص135.
[xiii] من النص إلى الفعل، أبحاث التأويل، بول ريكور، ترجمة: محمد برادة، وحسان بورقية، عين للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية، القاهرة، ط1، 2001، ص93.
[xiv] الفكر الإسلامي قراءة علمية، محمد أركون، ص203.
كلمات مفتاحية
الكاتب:

طارق محمد حجي
باحث مصري له عدد من المقالات البحثية والأعمال المنشورة في مجال الدراسات القرآنية.
مواضيع ذات صلة
((المعلومات والآراء المقدَّمة هي للكتّاب، ولا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع أو أسرة مركز تفسير))