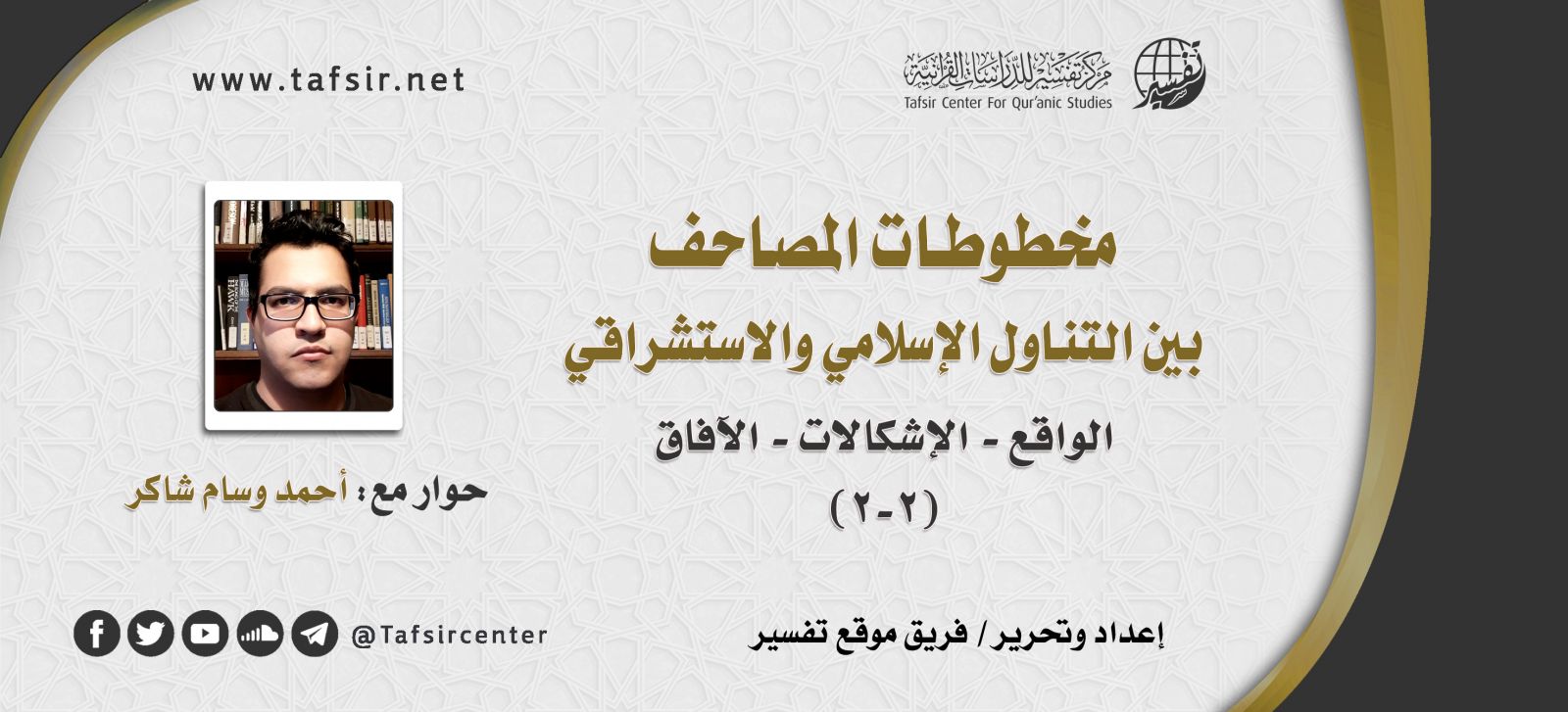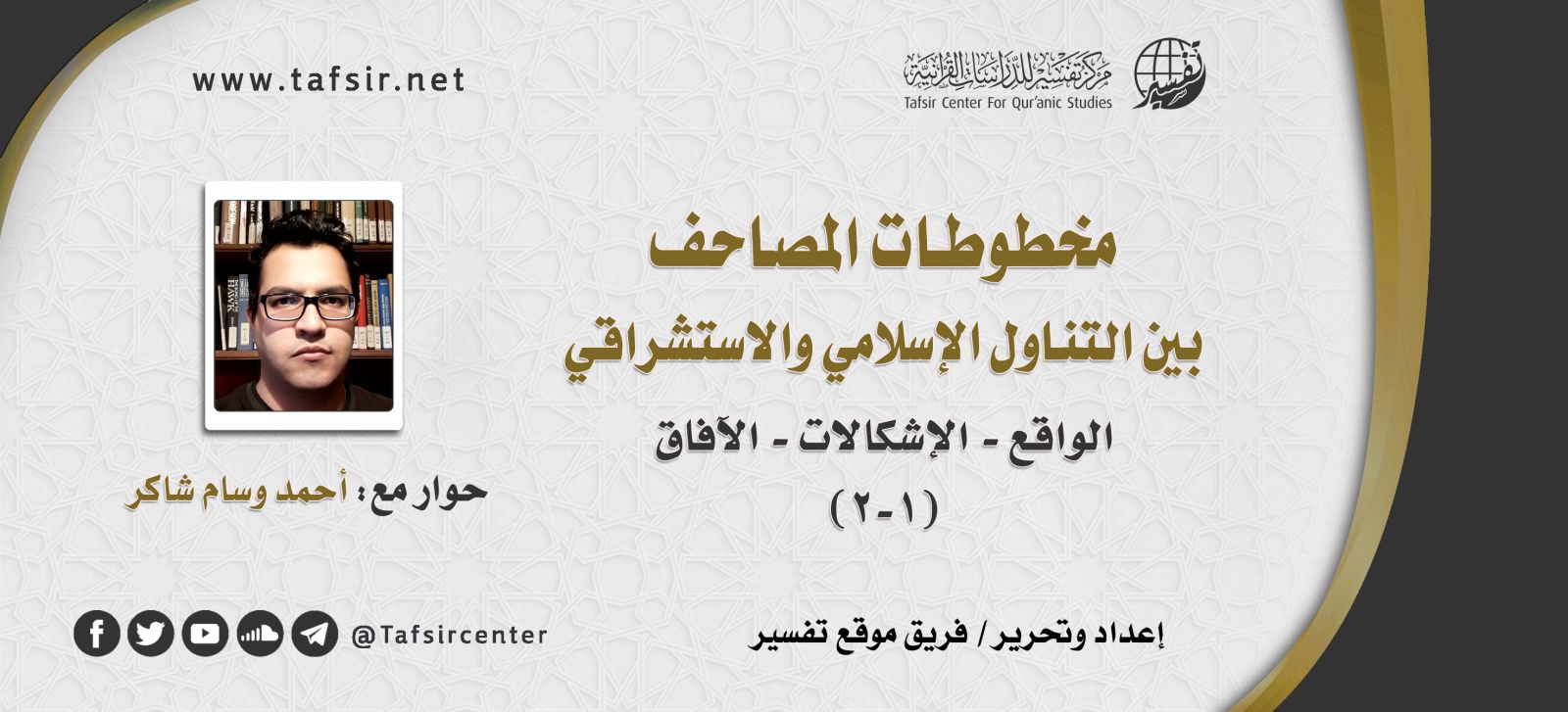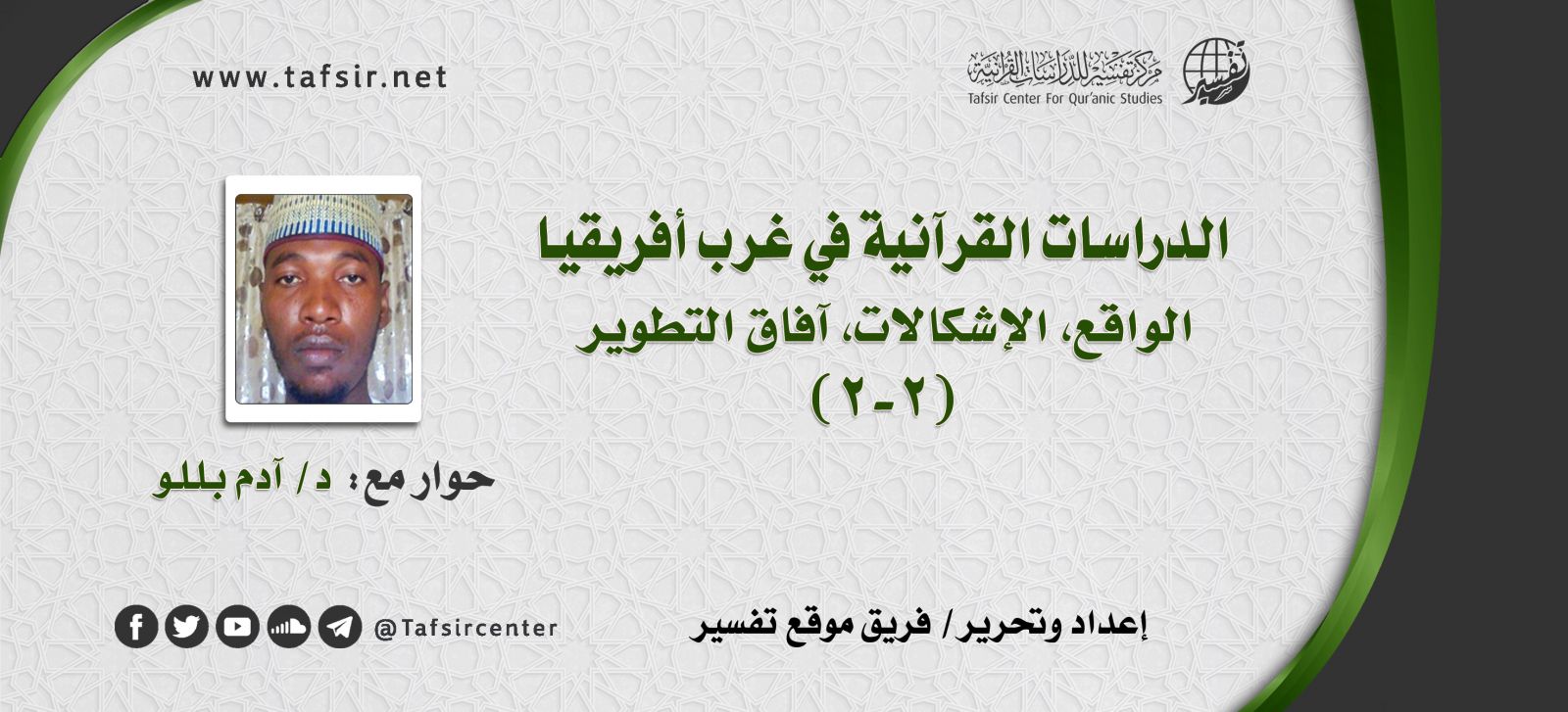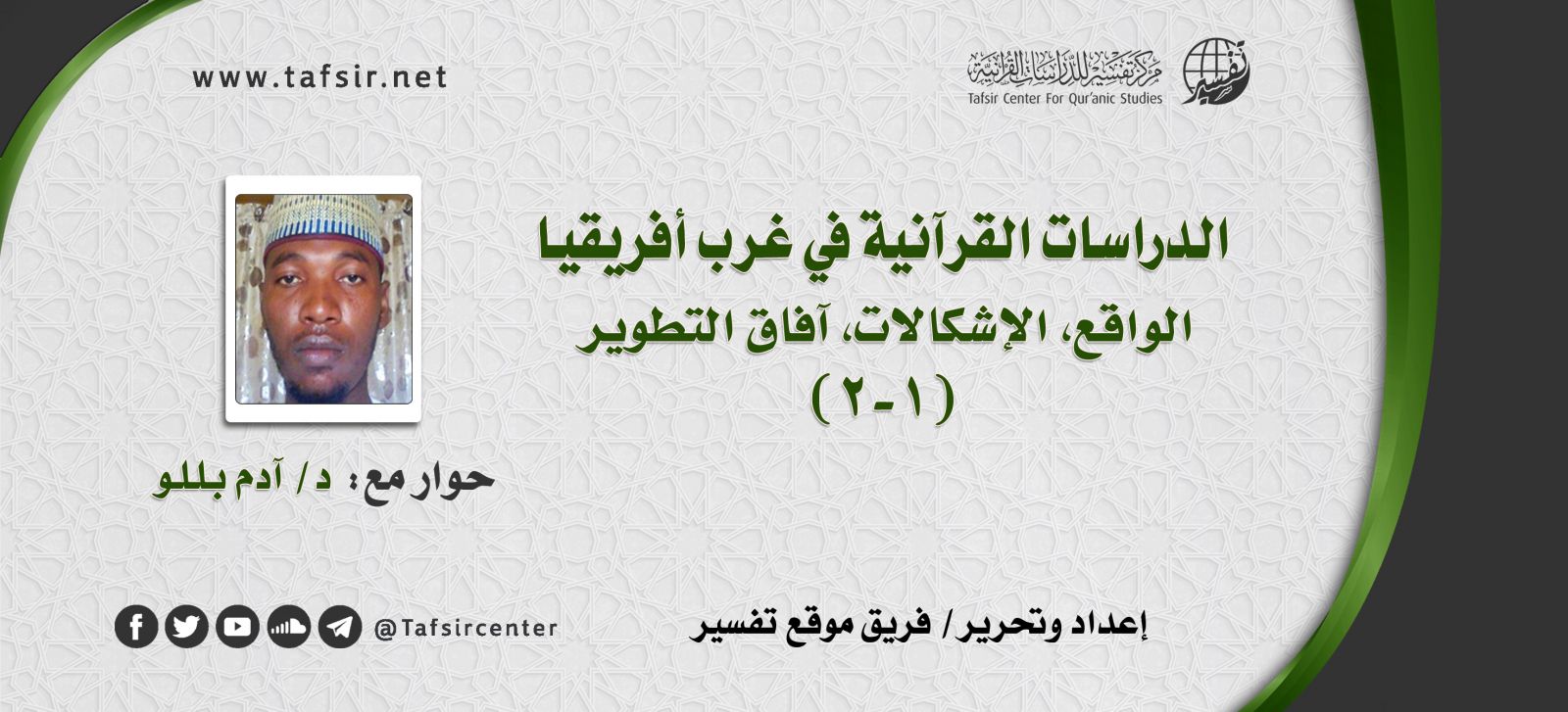علم التفسير وأهم الإشكالات
علم التفسير وأهم الإشكالات
إعداد: فريق موقع تفسير

مقدمة:
يُعَدّ علم التفسير أحد العلوم الإسلامية بالغة الأهمية، وقد انطلقت شرارتُه منذ بدايات المجتمع المسلم، ثم تتابعت فيه الكتابات وتراكمت بصورة بالغة السّعة. وبرغم شرف هذا العلم وقيمته الكبيرة إلا أنه اشتهر بأنه من العلوم غير الناضجة؛ ما يدلّ على وجود إشكالات في مسيرة هذا العلم، وأنه لا زال بحاجة إلى الكثيرِ من الجهود حتى يستقيم أمره.
ويعدّ الدكتور/ محمد صالح سليمان من أصحاب الاشتغال العلمي المتعلّق بجوانب مهمّة في ساحة التفسير، حيث تعرّض لمعالجة الاختلاف في التفسير، وذلك في دراسته: (اختلاف السلف في التفسير؛ بين التنظير والتطبيق)[1]، وكذلك عالج النقد في تفسير ابن عطية، وذلك في كتابه: (الصناعة النقديّة في تفسير ابن عطية)[2]، كما أنه شارك مؤخرًا في دراسة حول قواعد التفسير بعنوان: (التأليف المعاصر في قواعد التفسير؛ دراسة نقدية لمنهجية الحكم بالقاعدية)، وكذلك للدكتور/ صالح عناية بالجانب المفاهيمي تحديدًا في التفسير والإشكالات المتعلّقة به كما في بحثيْه: (مفهوم التفسير بين صُلْب التفسير وتوابعه)[3]، و(تفاوت مفهوم التفسير؛ الدلائل والآثار ومنهج التعامل)[4].
وفي ضوء ذلك فقد توجّهنا إلى الدكتور/ صالح في هذا الحوار (علم التفسير وأهم الإشكالات) بجملة أسئلة متنوّعة حول إشكالات علم التفسير، حتى نتعرّف على وجهة نظره إزاءها وكيفية التعامل معها، وقد جاءت إجابات الدكتور/ صالح مسهبةً ومتوسّعةً في بيان الإشكالات ومسالك معالجتها؛ ما جعل الحوار مادة دسمة للسَّبْح في إشكالات علم التفسير، تلكم القضية التي لا تحظى بكبير معالجة رغم أهميتها.
وفيما يلي نصّ الحوار:
نصّ الحوار
س1: علم التفسير من أجَلِّ العلوم الإسلامية، ولا يخفى أنّ النهوض بالعلوم الشرعية وتثويرها ورصد إشكالاتها من أَوْلى الأولويات، وقد ارتأينا أن يدور هذا الحوار معكم حول أبرز إشكالات هذا العلم الشريف، خاصّة وأنه يشتهر بعدم النضج والاحتراق؛ ففي تقديركم، ما المدخل الرئيس الذي لا بُدّ من الانطلاق منه في تحديد هذه الإشكالات؟
د/ محمد صالح سليمان:
ثمة فارق لا يخفى بين الكلام عن (التفسير) كبيانٍ لمعاني الآيات القرآنية، وعن (علم التفسير) الذي يتناول التفسير كعلم له مقدماته ومبادئه ومصطلحاته ومفاهيمه ومصنفاته وتطوّراته وغير ذلك مما يتم تناوله في الحديث عن العلوم بشكلٍ عامّ.
وإن المدخل الرئيس للكلام على إشكالات علم التفسير يعتمد في نظري على الانطلاق من واقع علم التفسير ذاته من حيث هو؛ ذلك الواقع الذي يمتد زمانًا لأكثر من ألْف عامٍ، ويمتد مكانًا ليشمل أقطار العالم الإسلامي كلها من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب قبل أن تنال أقطارَ هذا العالم يدُ التقسيم والتقزيم، ويتّسع موضوعًا ليشمل كافّة ما يتعلّق بعلم التفسير تعلّقًا قريبًا أو بعيدًا من تفاسير أو مختصرات أو حواشٍ أو رسائل في تفسير آية أو آيات أو سورة، أو مؤلفات نظرية تتناول علم التفسير أو كتبه أو مداخله أو أدواته أو علاقاته أو أربابه والمصنِّفين فيه أو أنواع التصنيف فيه أو غير ذلك، مما يشكِّل بمجموعِهِ الواقعَ الفعلي لعلم التفسير الذي حفرته مسيرةُ الزمن بهذا العلم وما تعلّق به، ويجسّد بتكامليته الصورة الحقيقية الكلية لعلم التفسير التي فرضها واقعه لا الصورة الافتراضية القاصرة التي رسمناها نحن أو رسمها لنا غيرنا.
إنّ الولوج في تحديد إشكالات العلم من مدخل واقع علم التفسير يعني النظرة إلى علم التفسير باعتباره ميراثًا علميًّا تشاركَت الأمة كلّها -على اختلاف أزمنتها وبلدانها ومناهجها ومذاهبها وأحوالها وتقلباتها الاجتماعية والسياسية والاقتصادية...إلخ- الإسهامَ فيه، ثم آلَ بعضُ ذلك التراث إلى أهل الأزمنة المتأخّرة بصحيحه وسقيمه وغثّه وسمينه، ومصطلحاته ومفاهيمه...إلخ.
وإنّ التسليمَ بكون علم التفسير وغيره ميراثًا علميًّا أمرٌ له ما وراءه في النظر لإشكالات علم التفسير، فليس هو مجرّد تسليم نظري شفوي يُتداول بين الـمَعْنِيِّين والمهتمّين بعلم التفسير، وإنما هو تسليم تترتّب عليه آثار وتُبنى عليه أمور لازمة لا يمكن الانفكاك عنها في سياق البحث في إشكالات العلم، من أبرزها: تحديد الوظيفة الرئيسة لأهل هذا الزمان تجاه التراث التفسيري، وأنه يلزمهم ما يلزم الوارث تجاه إرثه قبل تقسيمه وتوزيعه؛ من الإحصاء والحصر والوصف والتصنيف والتحليل والتحرير، والتدقيق في كافّة ما يتعلق بعلم التفسير زمانًا ومكانًا وإنتاجًا وأعلامًا ومصطلحًا ومفهومًا وتأثيرًا وتأثرًا، وتوافقًا واختلافًا، وقضايا وموضوعات، وسياقات زمانية ومكانية، ومناهج وتيارات ومذاهب، وغير ذلك مما يصعب حصره، وكلّ هذا وغيره لازمٌ لكلّ من خاض غمار البحث في علم التفسير أيًّا كان بحثه وأيًّا كان ميدانه ليحصل التصوّر السليم لعلم التفسير عبر الزمن، وليتمكّن الورثة من رسم خارطة ذلك العلم الدقيقة بكافّة معالمها وملامحها وتعاريجها، وتحرير إشكالات علم التفسير المركزية الكبرى، وترتيب سُلّم أولويات قضاياه وموضوعاته، وضبط آليات التعامل معه، وغير ذلك مما يستلزمه تحقيق الفهم الصحيح والتصوّر المنضبط لذلك العلم ومسيرته عبر التاريخ وتحديد الإشكالات الحافّة به.
وإذا كان فهم ذلك الإرث التفسيري هو الخطوة الأولى وقاعدة الانطلاق في النظر لإشكالات العلم، فينبغي أن نفرِّق بين مقامين:
الأول: مقام التقريب لمجملات العلم ومعالمه.
الثاني: مقام التحرير والضبط للعلم.
أمّا الأول فيُحتاج إليه في بناء التصوّرات العامة عن العلم، والوصف المجمَل لمعالمه وملامحه، وغير ذلك من النُّـبَذ والمتفرّقات التي يُحتاج إليها كمداخل أوّلية في ميدان التعليم والتدريس على سبيل الاختصار، وتيسير مبادئ العلم للمبتدئين، وفي مثل هذا لا مناص لنا من اللجوء لبعض الإسهامات أو المؤلَّفات التي يمكن أن تفيد في ذلك الجانب من تعريفات أو تقسيمات أو وصف عامّ مختزل لمسيرة العلم أو التعريف ببعض مؤلفاته أو غير ذلك مما هو قائم الآن ومتداول، وفي مثل هذا ينبغي الإغضاء والتسامح عمّا يقع في هذه الكتابات من تعميمات أو تسييقات زمانية أو مكانية، أو تقسيمات تاريخية، أو تصنيف للعلم أو غير ذلك، كما لا يُتطلّب في أمثال هذه المداخلِ التحريرُ والتحقيقُ، كما ينبغي كذلك إفهام المتعلمين والدارسين لهذه المداخل أنها تقريبية، الغرض منها تحصيل تصوّر مجمَل، لا اعتماد كلّ ما فيها كمُسَلَّمات ومقرَّرات معرفية معبرة عن واقع علم التفسير.
أمّا المقام الثاني: وهو مقام التحرير والتحقيق والضبط لعلم التفسير؛ مسيرة ومصطلحات ومفاهيم وقضايا وغير ذلك مما يستلزمه حسن الفهم ودقّة الضبط لذلك الإرث، فذلك ميدان البحث، الذي يشتغل فيه الورثة بضبط إرثهم وحصره وتوصيفه وتصنيفه وتحليله وتكشيفه وغير ذلك مما يلزم لحسن التصوّر للإرث التفسيري الموصِل لحسن فهمه وضبطه المؤهل للإضافة عليه ومواصلة الإبداع فيه.
ولا يسوغ منهجيًّا لأهل هذا المقام الثاني -مؤسّسات وأفراد- النزول إلى الواقع التقريبي ولا الانطلاق منه ولا التأسيس عليه، ولا النظر لعلم التفسير من خلال مجملات هذا الواقع التقريبي، ولا الاعتماد على تعميماته، ولا اعتباره معبِّرًا عن الواقع الفعلي لمسيرة علم التفسير الممتدة؛ لأنه واقع مبني على التسامح والتجوُّز في كثيرٍ من مناحيه لاعتبارات ومقاصد سبق بيانها، ويشتدّ الإشكال ويتعاظم يوم يذوب الفرق بين المقامَيْن، فينمحي المقام الثاني من الأذهان والتصوّرات، ويحصل لأربابه التأطّر بالمقام الأول ذي الواقع التقريبي، والتقوقع داخل سياجه، والانحباس تحت سقفه، وتوهّم أنه واقع حقيقي معبّر عن مسيرة علم التفسير واتجاهاته ومناهجه ومصنّفاته طوال هذه القرون المتطاولة، وأن الإرث التفسيري بهذا الاجتزاء والاختزال والتعميم والإطلاق وغير ذلك مما يتسم به المقام الأول =قد تم فهمه وضبطه وتحرير مرتكزاته وإشكالاته وتاريخه ومناهج أئمته وطبقات أربابه، وذلك لا شك إتيان للبيوت من ظهورها، وقفز على التراث، وتوهّم لغير الحقيقة.
ولكن الإشكال أنّ المقام التقريبي للإرث التفسيري، والمداخل الأوّلية، والعرض المجمل صار في واقعنا المعاصر هو المعبِّر عن واقع العلم، وصار هو السقف الذي يقبع تحت ظلّه غالب المؤسسات البحثية الرسمية وغيرها، وصار التراثُ التفسيري بتاريخه وامتداده ومصنفاته ومصطلحاته ومناهج أعلامه وما يحمله من إشكالات تحتاج إلى تفكيك وتحليل وتحرير =منظورًا إليه من ثقب ضيق أو من عدسة مصغّرة، وتخلّقتْ لدى الكثيرين قناعات ينطق بها واقعهم العملي بأن مرحلة الفهم للتراث والتأريخ والوصف المتكامل له قد انتهت وتعيَّن تجاوزها؛ ولذا كثرت المصادَرَة على التراث التفسيري، وإطلاق الأحكام النقديّة عليه، واتهام أربابه بتسرّبِ الخرافات إليهم على غفلةٍ من الزمن ونقلِهم لها وهم غافلون ساذجون، ووصف اشتغال المفسِّرين بالقراءات والإعرابات والاحتمالات بأنه صارفٌ للأمة عن الهداية ومنحرفٌ بها عن المقاصد الربانية، وتعالت الأصوات بتنقية علم التفسير وتطهير مصنّفاته من الخرافات والخزعبلات، وكثرت الدعوات الموسومة بـ(التجديدية) للإرث التفسيري، وصار كلّ طرح جديد تجديدًا، وصار البحث في التدبُّر والهدايات والتفسير الموضوعي ومقاصد القرآن والإعجاز العلمي هو باب التجديد، وما نزال في انتظار المزيد، وصار البحث في مصطلحات التفسير وتاريخه وإشكالاته الكبرى مرفوضًا بدعوى أنه رجوع للوراء، وأن أمثال هذه الأفكار قُتِلت بحثًا، وما قَتَلها إلا السطحية والقبوع تحت سقف المداخل وزيف التعميمات غير المنضبطة والنظرات الانتقائية.
س2: في ضوء الانطلاق من مسيرة علم التفسير بتكامليته عبر التاريخ والذي تفضلتم ببيانه في الإجابة السابقة؛ في تقديركم، ما الإشكالات الرئيسة لعلم التفسير بشكلٍ مجمَل؟
د/ محمد صالح سليمان:
يمكن إجمال هذه الإشكالات في ضوء ما يأتي:
1. ندرة الضبط والتحرير لمصطلحات علم التفسير ومفاهيمه في الإرث التفسيري، ذلك الضبط الذي يتجاوز التعميمات والإطلاقات غير المنضبطة، كما يتجاوز الوحدة المفهومية فيما تعدّدت دلالته، والوحدة المصطلحية فيما اتحدت دلالته وتعدّدت مصطلحاته، والوحدة المتوهّمة بين أرباب التفسير فيما لم يتفقوا على دلالته، كما يُعنى ذلك الضبط بالتنبّه لآثار الدلالات والمفاهيم وانعكاساتها على الواقع النظري والتطبيقي.
2. غياب التأريخ الدقيق لمسيرة علم التفسير، ذلكم التأريخ الذي يتجاوز مجرد العرض والسرد المجمل إلى الرصد الدقيق لحركة العلم عبر الزمن، وتتبع أطواره ومساراته، وتأثيره وتأثراته، وأدواته ومصادره وكيفيات توظيفها، ومساحات الإبداع والتجديد، والجمود والتقليد وغير ذلك مما من شأنه رسم الخط الزمني لمسار العلم عبر الزمن.
3. عدم اعتماد التنظير لبعض قضايا العلم على استقراء الواقع التطبيقي الماثل في التفاسير خاصّة، وغلبة الافتراضات النظرية التي تجافي الواقع التطبيقي أو لا تكون معبرة عنه بصورة دقيقة محرّرة.
4. غياب التكشيف لنصوص التفاسير والفهرسة لقضاياها ومسائلها، والتصنيف لمادتها والتحليل لمضامينها وغير ذلك مما يثوّر مادة الإرث التفسيري، ويبرز قضاياها ومصطلحاتها، ويرتّب أولويات النظر فيها.
5. غياب التأصيل لمناهج المفسّرين تأصيلًا محكمًا لمنهجية كلّ مفسّر استقلالًا ووفق تصوّر متكامل للمرتكزات المنهجية الكلية التي يتشكّل من خلالها منهج المفسر، دون التأطّر في ذلك التأصيل بقوالب ثابتة يتم تنزيلها على كافة التفاسير، ودون الاعتماد على الإطلاقات المجملة أو الأوصاف الانتقائية.
6. عدم إقامة البناء النظري لأصول التفسير وقواعده، لعدم سبق الأوائل لإنجاز تأليف نظري في ذلك الميدان كما هو الشأن في أصول الفقه مثلًا، ولكون المؤلفات المعاصرة في الأصول والقواعد احتفت بها إشكالات كثيرة كما أثبتته بعض الدراسات واعتمَد عملها على الاجتهاد الشخصي فلم تتخلق عنها المعايير التي يمكن القول باعتمادها في تأسيس أصول التفسير وقواعده وضبط منطلقاته ومداخله.
7. عدم ضبط العلاقات القائمة بين علم التفسير وغيره من العلوم الأخرى، وتحديد رتبة هذه العلاقات ومواطن تداخلها وتمايزها بشكلٍ دقيقٍ.
8. عدم بروز المعايير الضابطة لأوجه الصلة بين الإنتاج العلمي المعاصر وبين الإرث التفسيري؛ لما لهذه المعايير من أهمية في ضبط أوجه الصلة بالتراث، وتحرير مراتبها وأولوياتها، وتوجيه دفّة الاشتغال المعاصر بالتراث، وكيفيات التعامل معه تجاوزًا أو نقدًا أو التزامًا أو إضافةً أو تجديدًا، وفق رؤية منهجية متكاملة لا تنقم على موروثها فتنفلت منه، ولا تقدّسه فتنحبس فيه.
وثمة إشكالات أخرى إلّا أن هذه تمثّل أبرزها وأظهرها بصورة مجملة.
س3: لجانب المصطلحات والمفاهيم أهمية كبيرة في أيّ ميدان معرفي؛ في تقديركم، ما أبرز الإشكالات التي ترونها في ذلك الجانب في علم التفسير؟
د/ محمد صالح سليمان:
تمثل المصطلحات ومفاهيمها المعبّرة عنها المفاتح الرئيسة للإرث التفسيري ولغيره من العلوم، فالمصطلحات هي بوابة العلم وخزانته التي تكتنز جُلّ قضاياه بداخلها؛ ولذا فضبط هذه المصطلحات وتحريرها وتحديد الإشكالات المتعلّقة بها، والآثار المترتبة عليها له أهميته البالغة. والناظر في الإرث التفسيري يجده حافلًا بثروة ضخمة من المصطلحات والمفاهيم، التي يشكّل تحريرها وتحديد مدلولاتها وضبط مفاهيمها أوّل مدخل من مداخل حُسن الفهم لذلك الموروث.
وتحرير المصطلحات وضبط مفاهيمها في الإرث التفسيري أكبر من أن يختزل في مجرّد النقل للمصطلحات أو نقل بعض تعريفاتها، أو اختيار تعريف منها وترجيحه على ما سواه، أو تعميم تعريف منها وفهم الموروث التفسيري كلّه من خلال ذلك التعميم، بل يتعيّن قبل الدخول إلى ساحة المصطلحات والقطع بدلالة منها أو ترجيحها أو اختيار تعريف منها =ضبط المداخل المنهجية للنظر في المصطلحات؛ ابتداءً بضبط الغاية من هذا النظر، وهي تبيّن دلالة المصطلحات ومفاهيمها بنفس صورتها القائمة في الواقع الموروث لا وضع دلالة لها، وضبط الغاية من ذلك التبيّن وهي ضبط المفاهيم ومعرفة مآلاتها العملية وآثارها على قضايا التفسير وموضوعاته ومناهج المفسّرين، ومرورًا بالنظر في مفهوم المصطلح، وتحرير كونه متّحِد الدلالة أو متعدّد الدلالات، ورصدًا لبداية صكّ المصطلح أو المصطلحات المعبّرة عن هذا المفهوم، وتتبعًا لكافة المصطلحات المستخدَمة للدلالة على نفس المفهوم وإحصاءً لها، والنظر في أكثرها شيوعًا، ودراسة الفروق بينها، ورصدًا لاتفاق العلماء أو اختلافهم تجاه ذلك المفهوم، وبيان محلّ توافقهم واختلافهم، والنظر في آثار ذلك الاختلاف وتحديدها، وتحرير آثارها، إلى غير ذلك مما يلزم بحثه.
وقد يُظَنّ للوهلة الأولى أنّ أمر المصطلحات ومفاهيمها وتحريرها في الإرث التفسيري تمّ الفراغ منه، وأن الواجب يقتضي مجاوزة ذلك إلى ما بعده، ولكن المتأمل للواقع لا يجد أن ذلك تحقّق، بل تم التعامل مع كثير من المصطلحات بصورة شكلية أو بطريقة خاطئة. ولأضرب مثلًا هنا على عجالة بالمصطلح المركزي للتفسير وهو مصطلح «التفسير» أو «علم التفسير»، فإن الناظر للواقع يجد أن غالب البحوث المعاصرة -وبحوثي منها- عندما تتعرّض لذلك المصطلح تكتفي بنقل تعريفات الزركشي وأبي حيان وغيرهما ثم توازن بين التعريفات وتختار أحدها، مع كون الأمرِ في الإرث التفسيري لو التزَمْنا توصيفه ورسم خارطته في ذلك =أكبرَ من هذا التناول الساذج، ومع كون الغرضِ من ضبط التعريف تبيُّنَ المفهوم في الواقع التراثي لا كما نتصوّره نحن، فالإرث التفسيري فيه التفريق بين مصطلح «التفسير» ومصطلح «علم التفسير» كما هو صريح عند الكافيجي في (التيسير)، وعند الحسن اليوسي في (القانون)، وكما هو ظاهر تعريفات المتأخِّرين كأبي حيان والزركشي وسياقات تعريفهم، بل إن الكافيجي يرى أن مصطلح «علم التفسير» له إطلاقات ثلاثة، يجاوز اثنان منها المعنى الشائع لعلم التفسير، وقد خصّ اليوسي مصطلح «علم التفسير» بالمباحث المدونة في كتب علوم القرآن، ونفَى انطباق هذا المصطلح على الممارسة التطبيقية للتفسير الممثلة في كتب التفاسير، وربما يتقارب مع هذا عنونة السيوطي لكتابه بــ(التحبير في علم التفسير)، فهل كان معنى علم التفسير عنده في هذه العنونة مرادفًا لمعنى علوم القرآن الذي استخدمه لاحقًا في عنونة كتابه (الإتقان)، أم أنّ ثمة فرقًا بينهما تبيَّن له لاحقًا؟!
وإذا جاوزتَ هذا رأيتَ مصطلح «التفسير» يتجلّى لك في مقام آخر بدلالات أخرى ومعانٍ متغايرة عن كلّ ما مضى؛ ففي مبحث التفريق بين «التفسير» و«التأويل» يذكر بعضهم أن «التفسير» ما كان منقولًا عن الصحابة خاصّة؛ لسماعهم من رسول الله أو لمعايشتهم له ومشاهدتهم نزول الوحي، وأمّا التأويل فعمَّن بعدهم. ولعلّ هذا المفهوم للتفسير هو الذي جعل أبا إسحاق النظَّام ينتقد الأقوال الواردة عن غير الصحابة حيث قال: «لا تسترسلوا إلى كثير من المفسّرين، وإن نصبوا أنفسهم للعامة، وأجابوا في كلّ مسألة؛ فإن كثيرًا منهم يقول بغير رواية على غير أساس، وكلما كان المفسّر أغرب عندهم كان أحبّ إليهم، وليكن عندكم عكرمة، والكلبي، والسدّي، والضحّاك، ومقاتل بن سليمان، وأبو بكر الأصم، في سبيل واحدة»[5]، وليس غرضنا مناقشة مضامينه، وإنما المراد رصد المفهوم ودلالته في بعض تقلباته، وهو نفس المعنى الذي اعتمده الماتريدي تسمية لكتابه: (تأويلات أهل السُّنة)، بعد أن قدّم بمقدمة ليس فيها إلا بيان الفرق بين التفسير والتأويل.
وقد صرّح السيوطي باعتماد هذه الدلالة كذلك دون غيرها في تفسيرٍ كاملٍ صنّفه، وهو كتابه: (ترجمان القرآن)[6]، وهو نفسُه لمّا ألّف (الدُّر المنثور) سمّاه تفسيرًا أيضًا مع عدم اقتصاره على تفسير الصحابة -وتضمُّنه لأقوال التابعين وأتباعهم- كما فعل في (ترجمان القرآن)، وهذا يعني أن مفهوم التفسير عنده في الترجمان ليس هو نفسه في الدُّر، وإذا نظرنا نظرًا آخر لمفهوم التفسير داخل المصنفات الحديثية فسيظهر لنا أن مفهوم «التفسير» الذي تُنْقَل تعريفاته ويُرجّح بينها ليس هو نفس مفهوم التفسير في تلك المصنفات، بل المفهوم فيها أشمل وأوسع، إلى آخر ذلك مما لا يتسع بسطه هنا.
فهل يسوغ بعد هذا ادعاء وحدة مفهوم التفسير في التراث كلّه، أو مراكمة تعريفات فوق بعضها وادّعاء أنها كلّها تعريفات لمعرَّف واحد هو التفسير، دون تنبّه لسياقاتها وتاريخها ومرادات أصحابها، ودون مراعاة لتفريقهم بين «التفسير» و«علم التفسير» أو بين «التفسير والتأويل»، أم هل يسوغ بعد ذلك كلّه تصوّر أن نقاش مصطلحات التفسير والتأويل مجرد نقاش جدلي دون التنبّه للآثار التي ترتبت عليه في النظر والتصنيف والاتجاهات العلمية، أو تصوّر أن هذا النقاش الجدلي الموهوم يُحْسَم الأمر فيه بمجرد نقل تعريفات واختيار أحدها، مع كون هذه التعريفات يحصل الظنّ الغالب بكونها ليست متواردة على محلّ واحد، حتى يصح سردها والترجيح بينها، وما قيمة الترجيح النظري الذي نرجّحه في بحوثنا لتعريفٍ من بين هذه التعريفات، وهل هو ترجيح يجاوز نظر الباحث إلى ما وراء ذلك، وهل يمكن التأسيس على هذا الترجيح أيًّا كان في محاكمة التراث التفسيري كلّه إليه وفهمه من خلاله، وقد رأينا تنوع الدلالة في مفهوم التفسير حتى عند المفسِّر الواحد بتعدّد مؤلفاته في التفسير وتأسّس كلّ منها على مفهوم، وهل يسوغ بعد هذا القول بتوسُّع المعرِّفين في تعريف التفسير ونقد تعريفاتهم بأنهم أدخلوا ما هو من علوم القرآن في التفسير كما قرّر ذلك بعض الفضلاء؟
وهل يمكن بعد هذا كلّه ادّعاء أننا حرّرنا مصطلح التفسير الذي نتسامى بالانتساب إليه، وهو المصطلح الذي عليه مدار الفنّ تنظيرًا وتطبيقًا، أم يليق بعد ذلك كلّه التغني بتلك الدعوى العريضة القائلة أن أمثال تلك الموضوعات قُتلت بحثًا؟! وما قَتَلها إلا التعميم غير المنضبط، والنظرات الانتقائية، والقفز على التراث، والمصادرة على مضامينه، ومحاولة تسييقها كلّها مساقًا واحدًا دون استقراء واستقصاء وتحليل وتحرير وتدقيق.
س4: يمثّل التأريخ لعلم التفسير أهمية كبيرة، فما أبرز الإشكالات التي تحتفّ بالتأريخ لعلم التفسير؟ وما أبرز المقترحات التي ترونها في هذا الجانب؟
د/ محمد صالح سليمان:
إنّ التأريخ لعلم التفسير يمثّل أحد المحاور المركزية الكبرى التي يلزم العناية بها لفهم مسيرة العلم الزمانية، وإقامة صورته التي فرضها واقعه الزماني، ورصد سياقاته الزمانية التي كان لها تأثير فيه، ولا شك أن التأريخَ لتراث علمي تجاوز إنتاجه أكثر من ألف عام تنوّعت فيها الأزمنة وتعدّدت فيها السياقات واختلفت فيها الأماكن وتبايَنَت فيها مذاهب المصنِّفين وأصولهم =أمرٌ عسيرٌ جدًّا، وتزداد مهمّة التأريخ عسرًا يوم يكون التأريخ شاملًا للإرث التفسيري بتمامه؛ من ممارسات تطبيقية تشمل التفاسير والمختصرات والحواشي...إلخ، أو قضايا نظرية تتعلّق بالتفسير ومفاهيمه وأدواته وعلاقاته وأعلامه وغير ذلك، ويبلغ العسر منتهاه والمشاقّ غايتها يوم يتخطى التأريخ مجرد السرد والعرض أو الحصر لأسماء المصنَّفات والمؤلَّفات إلى رصد نشأة العلم وانتقالاته وأطواره، وإشكالاته المركزية التي أسهمت في تثويره، ومظاهر الاهتمام به تدريسًا وتعليمًا وتصنيفًا، ورصد الأحداث التاريخية وأثرها المركزي على كافة ما يرتبط بعلم التفسير وغير ذلك مما يلزم المتصدي لتأريخ علم التفسير.
وإذا كان ما سلف متعلقًا بمشاقّ اتساع الإرث التفسيري المؤرَّخ له وامتداداته ومتطلباته، فثمة إشكالات أخرى تتعلّق بمنهجية هذا التأريخ، خاصة وأن المؤرَّخ له -وهو علم التفسير- ليس نسيجًا واحدًا سلك مسلكًا واحدًا على مرِّ التاريخ، بحيث يمكن عرضه عرضًا كليًّا شاملًا، بل هو متشعّب تشعبًا كبيرًا؛ ولذا لا بدّ من ضبط منهجية التأريخ للإرث التفسيري ودراسة إشكالات ذلك التأريخ ورسم مساراته.
ولعلّ من أبرز الأمور الدالّة على أهمية الضبط للمنهجية وتصوّر الإشكالات ما يأتي:
- عدم ضبط المداخل التاريخية للتفسير وتشعّبها: وذلك إشكال من أكبر الإشكالات التي تعترض طريق المؤرِّخين للعلوم بشكلٍ عام، والمسمى بالتحقيب التاريخي للعلوم، فإذا أردنا التأريخ للتفسير من حيث كونه ممارسة فعلية وتطبيقية فثمة مداخل كثيرة؛ فهل سنعتمد التأريخ للتفسير وفق التقسيم الزمني للعصور بأن نؤرخ للتفسير في العصر النبوي ثم في عصر الصحابة وهكذا، أو بأن نؤرخ لمجموعة قرون كالتفسير في القرون الثلاثة، أو بأن نؤرخ للتفسير في عصر الخلفاء ثم في العصر الأموي، أم سنعتمد التقسيم المكاني فنؤرخ للتفسير في مكة مثلًا أو في المدينة أو في الشام أو في مصر...إلخ، أم سنعتمد النظر للتفسير من حيث التدوين فنؤرخ للتفسير قبل التدوين أو بعده، أم سنعتمد تصنيفًا معيّنًا للتفسير فنؤرّخ وفقًا له، فما هو ذلك التصنيف، وما معاييره، وهل هو واحد أم متعدّد، فهل هو تصنيف بسِمات معيّنة في التفسير كمن يصنف التفسير لمأثورٍ ورأي، أم هو تصنيف وفق المسلك العقدي كتفاسير أهل السُّنة أو تفاسير المعتزلة أو تفاسير الشيعة...إلخ، أم هو تصنيف لمجموع سمات معيّنة في التفسير ننعت كلّ مجموعة منها بنعت المدارس ثم نؤرخ لهذه المدارس، أم هو تصنيف لمراتب المادة التفسيرية بحيث نقسم التفسير لصُلْبٍ وتبَعٍ ثم نؤرّخ لمسار الاهتمام بالصُّلْب ثم مسار الاهتمام بالتَّبَع، أم هو تصنيف بحسب مقاصد المؤلفين من بيان المعنى أو بيان الأحكام أو بيان كلّ ما يخصّ الآية من لطائف وقراءات وإعراب وأحكام...إلخ، أم سنعتمد كلّ تلك المداخل أو بعضها، وكثير من هذه المداخل التاريخية حاصل فيها الجدل بين المؤرخين للعلوم وبيان لإشكالاتها؛ ذلك أن كثيرًا من هذه المداخل لا يستقيم التأريخ للتفسير كلّه من خلالها لتشعّب تاريخ التفسير وامتداده وعدم إحاطة هذه المداخل بتشعباته، كما أنّ المراد أن تكون هذه المداخل تابعة للتفسير عند إرادة التأريخ لها، لا أن يكون هو تابعًا لها فنقع في تخصيص التاريخ بالتفسير بدلًا من تخصيص التفسير بالتاريخ كما أشار إلى نحو ذلك الرافعي في كلامه عن تاريخ الأدب.
وكلّ ما تقدّم من إشكالات مختصّ بالتفسير من حيث كونه ممارسة تطبيقية، أمّا التأريخ لعلم التفسير في تنظيره وقضاياه وعلاقاته فله مداخل أخرى غير تلك التي سلفت، فالتأريخ للمفهوم له مداخله ومتطلباته والتأريخ لعلاقات التفسير بغيره من العلوم وحدود التمايز والافتراق بينها في واقع التراث التفسيري له مداخل أخرى، وهكذا قضايا التفسير وموضوعاته لها مداخلها التاريخية، وللدكتورة فريدة زمرد في هذا بحث بعنوان: «نحو دراسة علمية لتاريخ التفسير وتطوّره».
- عدم وحدة التفسير المؤرَّخ له في الواقع التراثي: إنّ من الإشكالات التي يواجهها المتصدي للبحث في تاريخ التفسير تفاوتَ دلالات التفسير في استعمالات العلماء، وتعدّد صوره، واختلاف مناحيه، سواء كان ذلك التفاوت أو التعدّد مردّه إلى اختلاف مفهوم التفسير بين العلماء أو اختلاف صور التوظيف للمادة التفسيرية، وتفاوت نظر المصنِّفين لها أو لغير ذلك؛ فالتفسير لم يسلك مسلكًا واحدًا على مرّ التاريخ، ولم يتأطّر في صورة واحدة، بل كان متعدّد الدلالات مفهومًا، ومختلف المناحي توظيفًا، فمسيرته عبر التاريخ حافلة بكثير من التباينات؛ ولذا فصِحّة التأريخ له تحتّم أن يكون التأريخ على وزان التفسير نفسه تباينًا وانعطافًا، وتعرجًا واستقامة؛ ولذا فالمتصدي لميدان التأريخ للتفسير إمّا أن يساير التفسير فينعطف تأريخه مع المنعطف، ويتّسع مع المتّسع، ويتّحد مع المتّفق، ويتفاوت مع المختلف، فيسلم له تأريخه، وإمّا أن يعطي مسيرة التفسير ظَهْرَه فيؤرِّخ بعيدًا عنها، ولا سبيل له حينئذ إلا اللجوء لمجرد مصطلح «التفسير» أو الاكتفاء بمعناه اللغوي؛ لأنه المصطلح الذي تتوافق كلّ الإسهامات والمدونات التفسيرية في الانتساب له، فيعتمد المصطلح أساسًا لتأريخه ومنطلقًا له؛ ذاهلًا أو متناسيًا أن هذا التوافق المصطلحي توافق صوري لا يمكن التأسيس عليه، لكونه يموج باختلاف مفاهيمي واسع، أو تختلف صور توظيفه.
إنّ اعتماد مجرد مصطلح التفسير أساسًا للتأريخ يعني أن التأريخ لم يبدأ ولم ينطلق؛ لأن اتحاد المصطلح لا يعني اتحاد المفاهيم والمضامين والمقاصد، بل واقع التفسير قائم على التفاوت والتباين؛ ومن ثم فمفهومه لا يتوارد على محلّ واحد؛ ولذا فالتوافق بين المحدِّثين والمفسِّرين مثلًا في مصطلح التفسير لا يعني أن مرادهم به متّحد أو متقارب، بل التوافق بين المفسّرين أنفسهم في مصطلح التفسير لا يعني توحّد مفهومه عندهم.
يقول محمد أنور الكشميري؛ مبينًا مفهوم التفسير عند البخاري في صحيحه: «اعلم أن تفسير المصنِّف ليس على شاكلة تفسير المتأخِّرين في كشف المغلقات وتقرير المسائل، بل قصد فيه إخراج حديثٍ مناسب متعلّق به، ولو بوَجْه»[7].
وقال رشيد أحمد الكنكوهي: «الذي ينبغي التنبّه له أن التفسير عند هؤلاء الكرام أعمّ من أن يكون شرح كلمة، أو تفصيل قصة مما يتعلّق بالكلام، أو بيان فضيلة، أو بيان ما يقرأ بعد تمام السورة، ولا أقلَّ من أن يكون لفظ القرآن واردًا في الحديث، وكون الأمور المتقدّمة من التفسير ظاهرة، وإنما الخفاء في هذا الأخير، والنكتة فيه أن لفظ الحديث يفسّر لفظ القرآن؛ بحيث يُعلم منه أن المراد في الموضعين واحد، وكثيرًا ما ينكشف معنى اللفظ بوقوعه في قصة كلام، ولا يتّضح مراده لو وقع هذا اللفظ في غير تلك القصة، فإذا لاحظ الرجل الآية والرواية معًا كانت له مكنةٌ على تحصيل المعنى، والله تعالى أعلم»[8].
وقد قرّر ابن تيمية هذا تقريرًا مطولًا في (جواب الاعتراضات المصرية على الفتيا الحموية)[9]، وهذه تقريرات في غاية النفاسة تفيد اتساع مفهوم التفسير عند بعض المصنِّفين في الحديث، واختلاف دلالته لديهم، كما يفيد تفاوت مادة التفسير لديهم عن مادة التفسير عند المفسرين؛ إذ يُدرجون فيها ما لا يُدرجه المفسرون، وإذا كان الأمر كذلك، فليس من الصواب محاكمتهم إلى مفهوم المفسّرين أو غيرهم؛ لأن هذا مفهومهم الخاصّ الذي كان من أسباب نشأته أن مقاصدهم من ذكر التفسير في كتبهم ليست هي مقاصد المفسّرين في تفاسيرهم، وإن حصل بينها نوع اشتراك، وهذا يفتح بابًا لمراجعة الكتابات المعاصرة في تأريخ التفسير وتدوينه، والتي تشير إلى أن تدوين التفسير كان من ضمن مراحله الأولى: تدوينه في كتب الحديث، فهذا إنما يصح عند تقارب مفهوم التفسير أو اتحاده في تلك المراحل، لا عند تباين مفهومه بينهم واختلاف مقاصدهم في النظر للتفسير؛ إِذْ ليس التفسير الموصوف بذلك هو نفسه التفسير في كتب السُّنة، كما أن ذلك يفتح باب النقد لكلّ الكتابات التي قسمت التفسير لأطوار ومراحل معتمدة على مجرّد مصطلح التفسير فحسب، متناسية أن التفسير الذي يتنزل عليه جهدها التاريخي وتصنيفاتها التاريخية كافة ليس واحدًا ولا متحدًا حتى يصلح تواردها على تقسيمه إلى أطوار ومراحل.
وثمة إشكالات أخرى متعلّقة بتاريخ التفسير كالإشكالات المتعلّقة بمكونات علم التفسير الرئيسة ومحاوره المركزية في جانبيه النظري والتطبيقي وكيفية امتلاك زمامها ليكون التأريخ للتفسير متجهًا للمقومات والمرتكزات لا للفرعيات والثانويات، وكالإشكالات المتعلّقة بضبط التأريخ للثوابت والمتغيّرات في مسيرة العلم، فثمة قضايا اتسمت مسيرتها بكثير من الانتقالات، وبألوان من التطوّر حتى استقرت في مرحلة زمنية على صورة معيّنة، فكيف يمكن التأريخ لتلك الأطوار وفهم كلّ طَوْر منها في سياقه الزمني؛ كالقراءات مثلًا واختلاف أطوارها ومراحلها وكيفية التأريخ لذلك بوضع كلّ طَوْر من أطوار القراءات في نصابه وفهمه في إطاره وسياقه الزمني، وعدم تعميم المقاييس المعتمدة في طور متأخّر للقراءات كمعيار ثابت لها يحاكم التاريخ السابق كلّه إليها، وكالإشكالات المتعلقة بكيفية الضبط للمراحل المفصلية في تاريخ التفسير التي شكّلت نقلة نوعيّة في التفسير أو أورثت أثرًا سلبيًّا، ورصد الأسباب التي أسهمت في تأثيرها وانتقالها بمسيرة العلم، وضبط معايير الحكم على تلك النقلات بعيدًا عن الأهواء، وكيفية الدراسة لآثار تلك النقلات على مسيرة العلم، وغير ذلك من إشكالات يحتاج إليها البحث في تاريخ التفسير.
س5: لا شك أن استخلاص مناهج المفسّرين من الأهمية بمكان، وقد كثرت العناية في كثير من الجامعات عبر الرسائل العلمية بدراسة مناهج المفسّرين واستخلاصها، فهل ترون أنه تمّ الوفاء بمناهج المفسّرين وتمّ استخلاصها، أم لكم رأي مختلف؟
د/ محمد صالح سليمان:
مناهج المفسِّرين من أهم المباحث التي عليها مدار تطوّر علم التفسير، باعتبار أن صحّة الفهم للتراث التفسيري وحسن التلقي له تفتقر إلى الحذق بطرائق المفسِّرين، والتبصّر بمقاصدهم، والوعي بدقائق ممارساتهم التفسيرية، وقد أصاب هذا المحورَ من محاور التفسير كثيرٌ من الذّبول والضُّمور في الواقع المعاصر، الذي أنتج قناعةً لدى بعضهم بكون البحث في مناهج المفسّرين قد انتُهِي منه وتمّت مجاوزته، ولعلّ من أسباب ذلك:
أ) كون كثير من الدراسات التي اشتغلت بمناهج المفسّرين حصرَت نفسها داخل الإطار العامّ الذي أرساه الشيخ محمد حسين الذهبي -رحمه الله- في كتابه: (التفسير والمفسرون) الذي لم يكن يسعه في كتابه هذا إلا ذلك الوصف العامّ لمسيرة التفسير وكتبه وبعض النُّـبَذ العامة الصالحة لبناء تصوّرٍ مجملٍ تقريبيّ عن كتب التفسير وأسمائها وأسماء مصنِّفيها وبعض ملامحها العامة، وذلك يتوافق في الجملة مع أهدافه العامة والكثرة الكاثرة من التفاسير المختلفة التي يريد العرض لها على اختلاف تصنيفاتها ومسالكها.
وليس المقصود بانحصار كثير من البحوث داخل إطار الشيخ الذهبي -رحمه الله- النقل الحرفي لكلامه، بل التزام أفكاره العامة نفسها في العرض، واعتبار هذه الأفكار هي الممثّلة لمنهج المفسِّر والموفية به، مما جعل مفهوم مناهج المفسّرين منحصرًا داخل عناصر معيّنة وأفكار مسبقة.
ب) عدم ضبط مفهوم المنهج بشكلٍ دقيقٍ، واختزاله أحيانًا في مقدّمات المفسِّر أو في بعض نصوصه المصرّحة بموقفه من قضية معيّنة، مع أن الأصل أن المنهج لا يُطلب من مجرّد نصوص المفسّر، بل يطلب من استقراء صنيعه في جُلّ تفسيره بحسب القضية المدروسة أو في تفسيره كلّه، من كيفية نقله للنصوص، وكيفيات توظيفه لها، وطرائق الاستدلال عنده، والأدوات التي اعتمدها، ومسالك النقد والترجيح لديه، وتأثره بالمصادر أو الأشخاص، ودرجات هذا التأثّر ومدى سريانها على مادته العلمية، والآثار التي نجمت فعليًّا عن مذهبه الفقهي أو انتمائه العقدي أو ترتّبت على ترجيحه لقول معيَّن في مسألة معينة، وكيفية إيراده للأخبار، والمدرسة التي ينتمي إليها في قبول الأخبار أو نقدها، وكيفية توظيفه للمرويات الضعيفة، وغير ذلك مما هو متعلّق بأمور لا يمكن أن ينصّ المفسّر عليها.
ومن الإشكالات المتعلقة بالبحث في مناهج المفسرين غير ما سبق:
- عدم الضبط لمقومات المنهج الخاصّ بكلِّ مفسِّر:
إنّ عدم الوضوح لمقومات استخلاص منهج المفسِّر وبنائه من أهم الإشكالات التي تظهر لنا عند محاولة الاشتغال بمناهج المفسرين، وذلك أمر من الأهمية بمكان وليس هذا موضع تحريره، لكن حسبي أن أشير إلى شيء من وجهات النظر الخاصّة تجاه ذلك الإشكال الذي يمثّل عصب الاشتغال بمنهج أيّ مفسِّر، وخارطة البيان لمنهجه.
وفي سبيل محاولة التأمّل في هذا الإشكال فمن المهم بدايةً أنه ليس ثمة إطار عامّ أو عناصر مخصوصة يمكن فرضها على كافة كتب التفسير لاستخلاص مناهج المفسّرين، واعتبار الوفاء بجميعها قيدًا ملزمًا لبيان منهج كلّ مفسّر، وإنما يقتضي المنهج السليم أنْ تَفرض مضامينُ كلّ تفسير ومقاصدُه الرئيسة نفسَها على كلّ من يروم استخلاص منهج المفسّر، وأن تَرسم المضامينُ الغالبةُ والمقاصدُ الكليةُ في كلّ تفسير خارطةَ الاشتغال بمنهج كلّ مفسّر، لا أن تُرسم خارطة الاشتغال بالمنهج بعناصر محدّدة سلفًا وثابتة دومًا تتحوّل إلى قوالب يجد الباحث نفسه ملزمًا بتعبئتها، وذلك غير مانع من أن تكون ثمة عناصر حاضرة دومًا عند البحث في منهج كلّ مفسر؛ لأن المراد استلهام العناصر من التفسير لا فرضها عليه.
ثم إنّ ضبط مقومات المنهج عند كلّ مفسّر لا يتحقّق إلا بالاستقصاء والاستقراء الكامل لتفسيره، استقصاء لا يقف عند نصوص الكتاب، بل استقصاء ينظر في ذلك التفسير نظرًا كليًّا شاملًا من حيث زمان تأليفه ومكان تأليفه والظروف المحتفَّة بمؤلِّفه، ومن حيث الضبط للمقصد الرئيس لذلك المفسِّر، هل هو نقل الأقوال التفسيرية بنفس صورتها المسندة، أم تصنيف تلك الأقوال تصنيفًا مجملًا، أم تصنيف تلك الأقوال بجمع ما تقارب منها في الدلالة على معنى واحد ووضع تبويب يشمل مجموع تلك الآثار، أم الإضافة على ذلك بالموازنة بين تلك الأقوال، وإبراز عللها ودلائلها، والتصحيح والتضعيف وإبراز مسوغات كلٍّ، أم العناية بتتبع الأحكام الفقهية والاختصار في ذكر الأقوال، أم بيان دقائق النظم وفنون البلاغة، أم غير ذلك مما تفيده المضامين الغالبة على الكتاب.
- إهمال المقصد الرئيس للمفسِّر عند دراسة منهجه:
إنّ كل مفسّر له مقصد رئيس أو مجموعة مقاصد رئيسة عليها مدار تفسيره، فأول ما يتعيّن عند دراسة منهجه استخلاص هذا المقصد وبيانه وإبراز كافة الدلائل الدالة على كونه مقصدًا للمفسّر، ثم تسليط الدراسة لمنهج المفسّر على هذا المقصد أو هذه المقاصد، والنظر في وسائل تحقيقه لهذا المقصد، والأدوات التي وظّفها في تحقيقه، وكيفيات توظيفه لها، وطرائق استدلاله، وغير ذلك مما يبرز منهجه في مقصده الرئيس، فلا يصح عند دراسة منهج الطبري مثلًا إهمال مقصده الرئيس في جمع أقوال السلف وتصنيفها وتبويبها والموازنة بينها، ودراسة منهجه في أحكام القرآن؛ لأنه لم يكن قاصدًا للعناية بأحكام القرآن وتحرير مداخلها ودلائلها كما هو الشأن عند القرطبي، ولا يصح دراسة منهج القرطبي مثلًا في نقله لأقوال السلف أو تحريره للمعاني التفسيرية ونقاشه لها وترجيحاته فيها؛ لأن هذا لم يكن مقصدًا رئيسًا له، وهكذا.
وثمة إشكالات كثيرة تتعلّق بهذا المحور؛ كدراسة منهج المفسّر دون ضبط مفهوم التفسير عنده ومحاكمته إلى تعريفٍ يعتمده الباحث، وكتطلُّب منهج المفسّر دفعة واحدة دون تنبّه لدقّة المنهج وتشعّبه، وعدم إمكانية البناء المتكامل له إلّا عبر تتابع مجموعة من الأعمال عليه، وكدراسة منهج المفسّر كوحدات متفرّقة لا يُدرى ما الرابط بينها، وكدراسة منهج المفسّر دون ضبط الأصول الكلية الممتدة في طول تفسيره، والقواعد المعتمدة لديه، وغير ذلك.
كما أنّ مما يفيد في ضبطِ المنهجِ النظرَ في موارد المفسّر شفوية كانت أو مكتوبة، ورصد أكثرها تأثيرًا عليه، وتتبع كيفية استفادته منها وتصرفه فيها وإحالته عليها، والنظر كذلك في مذهبه اللغوي والعقدي والفقهي ومدى انتماءاته اللغوية والعقدية والفقهية.
س6: شاركتم مؤخرًا في دراسة نقديّة حول التأليف المعاصر في قواعد التفسير[10]، فما مرئيّاتكم تجاه أصول التفسير وقواعده، وهل ترون أنه قد تمّت إقامة علم أصول التفسير وعلم قواعد التفسير على نحوٍ منهجي منضبط؟
د/ محمد صالح سليمان:
الأصول والقواعد تمثلان ركنًا ركينًا في كلّ علم من العلوم، وحتى تتنزّل الإجابة على هذا السؤال على مواضعها، وتوضع في نصابها وتُفهم وفق مقاصدها فلا بدّ من بيان مجموعة من المرتكزات:
أولها: أن الإرث التفسيري الماثل في كتب التفسير خاصّة مؤسَّس على أصول وقواعد أقام المفسرون صَرْحَ تفاسيرهم عليها، وضبطوا ممارستهم التفسيرية في ضوئها، غير أنهم لم يلتزموا التصريح بتلك الأصول والقواعد، ولم ينصّوا على معظمها، وليس معنى عدم نصّهم عليها خلوّ التفسير منها، بل كانت الأصول والقواعد ماثلة في أذهانهم سارية في تطبيقاتهم.
ثانيها: البناء النظري التأسيسي لأصول التفسير لم يَجُدْ علينا التاريخ فيه حتى الآن -بحسب علمي- بمؤلفات تأسيسية متقدّمة في الأزمنة الأولى على وزان ما حصل في أصول الفقه من تأليف الشافعي كتابه (الرسالة)؛ ولذا لا يمكن القول أن معالم أصول التفسير ومرتكزاته الرئيسة تم تأسيسها وضبط ملامحها وإرساء منطلقاتها في كتابات نظرية قديمة.
ثالثها: البحث التاريخي كما في دراسة (أصول التفسير في المؤلفات)[11]، أثـبَتَ خلوَّ التاريخ من مؤلفات تحمل عنوان أصول التفسير حتى القرن الثالث عشر الهجري، اللهم إلا ما كان من إشارة لابن القيم يُفهم منها أنه كتب تحت هذا العنوان، وأمّا ما عدا ذلك فالمؤلفات المعنونة بهذا العنوان بدأ ميلادها في القرن الثالث عشر الهجري، ولعلّ مما يتوافق مع تلك النتيجة أنك لا تجد المؤلِّفين في علوم القرآن؛ كالزركشي والبلقيني والسيوطي وابن عقيلة ذكروا ذلك المصطلح أو أفردوه بنوع خاصّ من أنواع علوم القرآن، كما أنك تجد الفراهي كذلك ينادي بتأسيس علم مستقلّ لأصول التأويل وضرورة استقلاله عن أصول الفقه، ولازم ذلك أنه لم يره قائمًا ومتمايزًا.
رابعها: البناء النظري لأصول التفسير في ضوء ما سبق صار متطلبًا من المتطلبات المعاصرة المهمّة التي يتعيّن النهوض بها ضبطًا لأصول العلم وإرساءً لمرتكزاته، ولا شك أنّ أول طريق البناء النظر في الجهود السابقة في ذلك الميدان، وخاصّة المؤلفات التي اتخذت من أصول التفسير عنوانًا لها ووسمًا عليها، وقد ثبت أن هذه المؤلفات متفاوتةٌ تفاوتًا كبيرًا في مفهوم أصول التفسير وموضوعاته وقضاياه ومسالك التأليف فيه وغير ذلك، وأنها تآليف لم يمكن الوقوف على المعايير المعتمَدة لديها في ضبط أصول التفسير موضوعًا ومفهومًا واستمدادًا؛ ولذا لا يمكن النسج على منوالها وتتميم مسارها، فهي اجتهادات شخصية تأسّست على الاجتهاد الشخصي لكلّ مؤلِّف، لا يسمح واقعها ولا يساعد على القول بتأسّس علمٍ لأصول التفسير تتابعت هذه المؤلفات على إقامة معالمه ورسم منطلقاته بحيث يتشكّل من مجموع تتابعها علم أصول التفسير.
خامسها: القول بأن أصول التفسير في العصر الحاضر صارت علمًا مستقلًّا متمايزًا، وأن قواعد التفسير صارت علمًا كذلك، هو قول عاطفي لا يساعده الواقع العلمي والتاريخي للتأليف في أصول التفسير؛ فالعلوم لا تتحقّق عِلْميّتها بمجرد منح الأفراد لها وَسْم العِلْمية، ولا بالرغبة في جعل مجموعة من الموضوعات عِلْمًا، ولا بالتقديم لتلك الموضوعات بالمبادئ العشرة للعلوم، وإنما يحصل هذا بتتابع الدرس والاهتمام العلمي المتواصل والنمو المتتابع عبر الامتداد الزمني لمجموعة من القضايا؛ ليتشكّل بمجموع هذا كلّه وغيره العلمُ وتكون ولادته ولادة طبيعية.
سادسها: كلّ ما سبق بشكلٍ مختصرٍ تم تفصيله في دراسَتَي الأصول والقواعد؛ يؤول بنا إلى القول بأن أصول التفسير في صورتها النظرية التأسيسية غير قائمة وغير موجودة، وأنها ما زالت تحتاج إلى بناء، وتحتاج قبل البناء إلى ضبط مداخل البناء وضبط مسالكه وتحديد غاياته، وتصوّر عقباته، وإرساء منهجية استخلاص تلك الأصول -ومثلها القواعد- من رحم التراث التفسيري.
ودعوى أن أصول التفسير أو قواعده في صورتها النظرية قائمة ومقرّرة وأنها صارت علمًا؛ دعوى تفتقر لأدلة إثباتها ومقوّمات تصحيحها، وهي دعوى تستند للواقع المعاصر الماثل في المؤلفات في أصول التفسير وقواعده خصوصًا، ولا تثبت أمام النقاش المنهجي حول بناء الأصول والقواعد وكيفياته، فما مفهوم الأصول والقواعد المقصودة، ومن الذي قرّر مفاهيمها وضبط المراد منها، هل هم المعاصرون أم المفسرون، وهل مجرد وضع المفاهيم من المعاصرين كافٍ لاعتمادها، أم لا بد من التثبّت من صحة سريان ذلك المفهوم في جُلّ التراث التفسيري، وعدم مصادمته له، وما المراد من التفسير الذي يُدَّعى أن أصوله وقواعده قُرِّرت، وهل يصلح تعميم ذلك المراد على كافة التراث التفسيري ونسبته لكافة المفسّرين، وما معيار الحكم بكون هذا أصلًا أو ليس أصلًا، وما مقدار الاتفاق والاختلاف القائم بين المفسّرين تجاه أصل من الأصول، أو قاعدة من القواعد، وهل استوت كافة التفاسير في منطلقاتها ومداخلها وغاياتها حتى يمكن القول بوجود أصول كلية للتفسير؟ وهل كتُب التفسير هي محلّ الاستخلاص للأصول والقواعد أم يدخل غيرها معها، وما كيفية الاستخلاص للأصول والقواعد، وما معايير الحكم على صحة ذلك الاستخلاص للأصول والقواعد، وما ضابط نسبة ذلك الأصل أو القاعدة للتفسير، وهل تلك الأصول والقواعد منصوص عليها في كتب التفسير كما هو الشائع في التصور المعاصر، أم هي كامنة في قلب الممارسات التطبيقية تحتاج إلى استقصاء واستقراء وضبط وتحليل؟ وغير ذلك من الأسئلة التي تَطرح نفسها كمداخل لبناء أصول التفسير وقواعده لا ينبغي أن يُختلف فيها.
وحسبك مثلًا في الإشارة إلى أهمية الانطلاق من الإشكالات السابقة وعدم الركون إلى التعميمات المألوفة =النظر في تفسير السلف إن أردت وضع أصل أو قاعدة متعلقة به، فيا ترى وَفْق أيّ منظور ستضع الأصول والقواعد الضابطة لهذا التفسير، أَوَفْق منظور الطبري الذي يعتدّ بقول الواحد من الصحابة أو التابعين أو أتباعهم ويعتبره ممثِّلًا لأهل التأويل؟ أم وَفْق منظور ابن تيمية الذي يرى أن الحجة في إجماع السلف لا في قول آحادهم، أو في إجماع الصحابة؟ وهل يمكن تنزيل ذلك التنظير الأصولي لابن تيمية في إجماع السلف أو الصحابة على واقع الآثار التفسيرية التي يندر أن تجد فيها مثل هذا الإجماع؟ وهل سنعتمد في ضبط الأصول والقواعد المتعلقة بالخروج عن أقوال السلف مذهبَ الطبري الذي ينتقد الخروج عن أقوالهم حتى لو كان القول غير مناقض لأقوالهم؟ أم سنعتمد التنظيرَ القائل بقبول الأقوال الخارجة عن أقوال السلف إذا كانت غير مناقضة؟ وكيف سيكون موقفنا إزاء أصول الطبري وقواعده إذا لم نأخذ بمذهبه؟ وهل سنضبط الأصول أو القواعد التفسيرية في النَّسْخ وفق المفهوم الذي حرّره ابن تيمية للسلف، أم وفق المفهوم الذي حرره الطبري؟ وهذه أمثلة يسيرة لعالِمَيْن يمكن تصنيفهما ضمن اتجاه تفسيري واحد وهو الاعتداد بأقوال السلف، فما بالنا بغيرهما في هذه المسائل وغيرها، وكيف سنضع الأصول والقواعد المتعلقة بأسباب النزول، هل وفق التقنين اللفظي الذي وضعه الشيخ الزرقاني للصريح من الأسباب وغير الصريح منها الذي يتصادم مع الواقع الفعلي لآثار السلف في النزول، أم وفق رؤية السلف لأسباب النزول التي لمّا تحرّر بشكل منهجي يمكن التأسيس عليه في ضبط الأصول والقواعد؟ وقبل ذلك وبعد ذلك هل سنبني الأصول والقواعد من الموروث التفسيري نفسه أم سنبنيها من خلال تصوراتِنا ومقاييسنا ثم نحاكم الإرث التفسيري إليها؟
إن كلّ هذه الإشكالات -وهذا قبسٌ منها- دالّ على أننا أمام إشكالات منهجية تأسيسية لا يسعنا غضُّ الطرف عنها ولا تجاوزها، وهي تؤول بنا تلقائيًّا إلى أن تكون الخطوة الأولى ضبط مداخل البناء وتحديد منطلقاته؛ لأن كلّ تجاوز لتلك الخطوة يُنتِج معرفةً مشوّهة وتصورات مبتسرة لا تنفع شيئًا في مسيرة العلم، بل تُؤَخِّر أكثر مما تقدِّم.
س7: يكثر الكلام عن التجديد في التفسير في العصر الحاضر وكذا المسارات البحثية التي توصف بأنها من باب التجديد في التفسير، فكيف ترون هذا الاهتمام بالتجديد؟ وما ملامح التجديد وآثاره على علم التفسير؟ وكيف يمكن بناء معايير الحكم به؟
د/ محمد صالح سليمان:
الكلام عن التجديد في التفسير هو كلام عن التجديد في علم من العلوم الشرعية المعتبرة، وثمة فارق بين الكلام عن التجديد كمطلب علمي بحثي يستحضر الشروط المنهجية للتجديد، وبين الكلام عن التجديد كمطلب دعوي لتقريب هدايات القرآن للناس، وبثِّ تعاليمه بينهم وبيان مسالك الحياة به...إلخ، ولا شك أنّ ربط الناس بالقرآن ونشر هداياته بينهم هدفٌ نبيل ومقصد جليل تحتاجه الأمة في كلّ أزمنتها، وبخاصّة في أزمنة تتابُع الشبهات، وتوالي الفتن والملمّات؛ وأمّا النظر إلى التجديد من جهة كونه مطلبًا علميًّا فغير مقبول تأسيسه على أساس عاطفي أو عبارات برّاقة، وإنما لا بدّ من انضباطه بشروط واستناده إلى معايير واحتكامه إلى مقاييس يقاس بها، من تحديد محلّ التجديد أو محالّه، وكيفية تفعيله، وتحرير الصلة بينه وبين القديم، ومعرفة مواطن الإضافة فيه، وغير ذلك.
وإذا كان الكلام عن التجديد كمطلب علمي وضرورة معرفية تمسّ إليها الحاجة في مسيرة العلوم، فإننا نحتاج أن نحدّد مفهوم هذا التجديد، وألوانه وصوره، والوزن النسبي لكلّ لون من ألوانه في بنية علم التفسير ومرتكزاته الكلية، كما نحتاج إلى تحديد المعيار الذي نستطيع به فهم ذلك التجديد «ومعرفة أيّ منحًى من مناحي التفسير يقصد إليه المعتنون بالتجديد، وأيّ مفهوم تواردوا عليه في التجديد؛ حتى نستطيع أن نبني -على الأقلّ- مسار التجديد ونضبط مداخله ونحيط بكلياته فينضبط السير فيه، وتتضح أولوياته ومراتبه، وضوابط تقييمه وتقويمه، وإلّا فالمفسرون الذين تم انتقادهم من قِبَل مدرسة التجديد كانوا يُعَدّون من أئمة التجديد في أزمنتهم وما بعدها إلى الآن؛ كالطبري، وابن عطية، والزمخشري، وأبي حيان، وغيرهم، فكيف يصحّ الانتساب للتجديد، وكيف يصح نفيه عن مفسّر أو عالم على وفق هذا التفاوت؟! إلا أن يكون المراد بالتجديد (الإتيان بجديد) فذلك شيء آخر حقيق بأن يسمى (الجديد) في التفسير لا (التجديد) في التفسير»[12].
وقد ظهر من الإجابات السابقة في هذا الحوار أن علم التفسير من حيث هو ميراث علمي لا يزال يحتاج إلى جهود كثيرة حتى يمكننا القول أنّ القاعدة الصلبة التي سيقوم عليها بنيان التجديد تمّ تأسيسها وإرساؤها، تلك القاعدة الصلبة المتمثلة في تحقيق الفهم المنهجي للتراث التفسيري عبر ضبط مصطلحاته ومفاهيمه، وتحرير تاريخه، وإقامة مناهج أربابه، وبناء أصوله وقواعده، فإن لم يتحقّق ذلك الفهم ولو بصورة غالبة، فليس ثمة قاعدة يتأسّس عليها التجديد، ولا دعائم يقوم عليها.
على أن الناظر في جُلّ المضامين التي تُطرح باسم التجديد سيجد أن معظم تلك المضامين تتناول أمورًا وقضايا لا تتعلّق بمناهج التفسير ولا بأصوله ولا بقواعده ولا بتاريخه، فهو تجديد لا يعمل في مرتكزات التفسير ولا في دعائمه ولا في صُلبه، ولا يلامس بنية التفسير، ولا يثوِّر مضامينه، ولا يدرس علاقاته وتأثيراته ومؤثراته، فيبقى أن وزنه النسبي في علم التفسير ضئيل ضئيل، وكلّ تجديد لم يلامس بنية التفسير ومرتكزاته فهو تجديد ثانوي هامشي لا تجديد جوهري حقيقي.
«إنّ التوجُّه للتجديد في غاية الأهمية، لكن العلم الذي نريد تجديده إذا لم نستطع تحديد المكونات الرئيسة له، وتمييز أصله من فرعه، وصُلبه من حواشيه، وأسسه من مكملاته، وغير ذلك، فكلامنا عن التجديد يحتاج لتجديد؛ لأننا لا نستطيع -والحالة هذه- تحديد مناحي التفسير ومستوياته ومراتبه، ولا تحرير أيّ تلك المراتب أولى بالتجديد، كما لا نستطيع تقويم التجديد، ولا الموازنة بين جهود التجديد ولا تحديد الأوزان النسبية لكلّ منها؛ لأنّا لا ندري أيّها كان في أسس العلم ومعاقده ومفاصله، ولا أيّها كان في فروعه وحواشيه ومكملاته، وكيف يستوي في الاتصاف بتجديد التفسير من يشتغل في صُلب التفسير ومعاقده الكبرى، ومن يشتغل بما دون ذلك»[13].
إنّ حمَلة لواء التجديد في تلك الأزمنة المتأخّرة لِتُسَلَّم لهم تلك الدعوة التجديدية =كان لا بدّ لهم من نقد التراث التفسيري ليكون ذلك مسوِّغًا لهم للكلام في التجديد، فالتراث التفسيري في نظرهم يحتاج إلى تنقية من الأحاديث الضعيفة، وإلى تطهير كتب التفسير من الخرافات والإسرائيليات التي يزعمون أنها تسلّلت إلى المفسرين على غفلة من الزمن، وهو كذلك تراث غارق في دقائق الإعراب وتكثير الاحتمالات، صارف للناس عن هداية القرآن ومقاصده العالية، متورِّط كثيرٌ من مصنِّفيه في إنكار القراءات المتواترة... وأمثال تلك الانتقادات التي لم تؤسَّس على فهم تاريخ العلم، ولا رَصْد أطوار القراءات ومراحلها، ولا على الوعي المنهجي بكيفية التوظيف للمرويات الضعيفة، ومراتب هذا التوظيف وأغراض المفسّرين منها ومواطن إصابتهم أو خطئهم، وغير ذلك مما يطول بيانه.
وقد ذكرتُ بعض الإشكالات المرتبطة بمفهوم التفسير وعلاقته بالتجديد في بحث: «تفاوت مفهوم التفسير»، بما لا يناسب التطويل به هنا.
[1] أصلها رسالة ماجستير، نوقشت عام 1428هـ بقسم التفسير، بكلية أصول الدين، بجامعة الأزهر الشريف، وأُجيزت بتقدير ممتاز مع التوصية بالطباعة، وقد نُشرت الطبعة الأولى منها عن مركز تفسير عام 1436هـ-2015م.
[2] أصلها رسالة دكتوراه، نوقشت عام 1434هـ بقسم التفسير، بكلية أصول الدين، بجامعة الأزهر الشريف، وأُجيزت بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى. وقد صدر الكتاب عن مركز تفسير عام 1437هـ-2016م.
[3] ضمن بحوث مؤتمر المغرب الذي انعقد بعنوان: «بناء علم أصول التفسير؛ الواقع والآفاق»، بمدينة فاس عام 1436هـ-2015م.
[4] بحث منشور بمجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية، العدد 192، الجزء الأول، السنة 53، رجب 1441هـ.
[5] الحيوان، للجاحظ (1/ 228).
[6] حيث قال: «...حتى صنفت في تعليقاته كتبًا شتى، منها التفسير الملقب: (ترجمان القرآن) وهو الوارد بالإسناد المتصل عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه الذين شاهدوه وتلقوا منه الوحي والتنزيل، وسمعوا منه التفسير والتأويل، وقد تم -ولله الحمد- في خمس مجلدات... وهذا لعمري هو التفسير، فإن الكلام في معاني القرآن ممن لم ينزل عليه ولا سمع من المنزل عليه، إنما هو رأي محض، فإن كان موافقًا للقواعد فهو التأويل، وإن خرج عنها وأخطأ المراد فتحريف وتبديل»، قطف الأزهار في كشف الأسرار، للسيوطي (ص:89 إلى 91).
[7] فيض الباري على صحيح البخاري (5/ 186).
[8] لامع الدراري على جامع البخاري (9/ 45).
[9] جواب الاعتراضات المصرية (ص:4-7).
[10] دراسة (التأليف المعاصر في قواعد التفسير؛ دراسة نقديّة لمنهجيّة الحكم بالقاعدية)، من إصدارات مركز تفسير للدراسات القرآنية: tafsir.net/publication/8018.
[11] دراسة (أصول التفسير في المؤلفات؛ دراسة وصفية موازنة)، من إصدارات مركز تفسير للدراسات القرآنية: tafsir.net/publication/7981.
[12] بحث: تفاوت مفهوم التفسير، الدلائل والآثار ومنهج التعامل، د/ محمد صالح (ص:40)، مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية، العدد 192، الجزء الأول.
[13] بحث: تفاوت مفهوم التفسير، الدلائل والآثار ومنهج التعامل، د/ محمد صالح (ص:40-41)، مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية، العدد 192، الجزء الأول.
كلمات مفتاحية
ضيف الحوار

محمد صالح سليمان
دكتوراه في التفسير وعلوم القرآن- جامعة الأزهر، ومدير الشؤون العلمية بمركز تفسير، أشرف على عدد من المشروعات العلمية المنشورة.
مواضيع ذات صلة
((المعلومات والآراء المقدَّمة هي للكتّاب، ولا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع أو أسرة مركز تفسير))