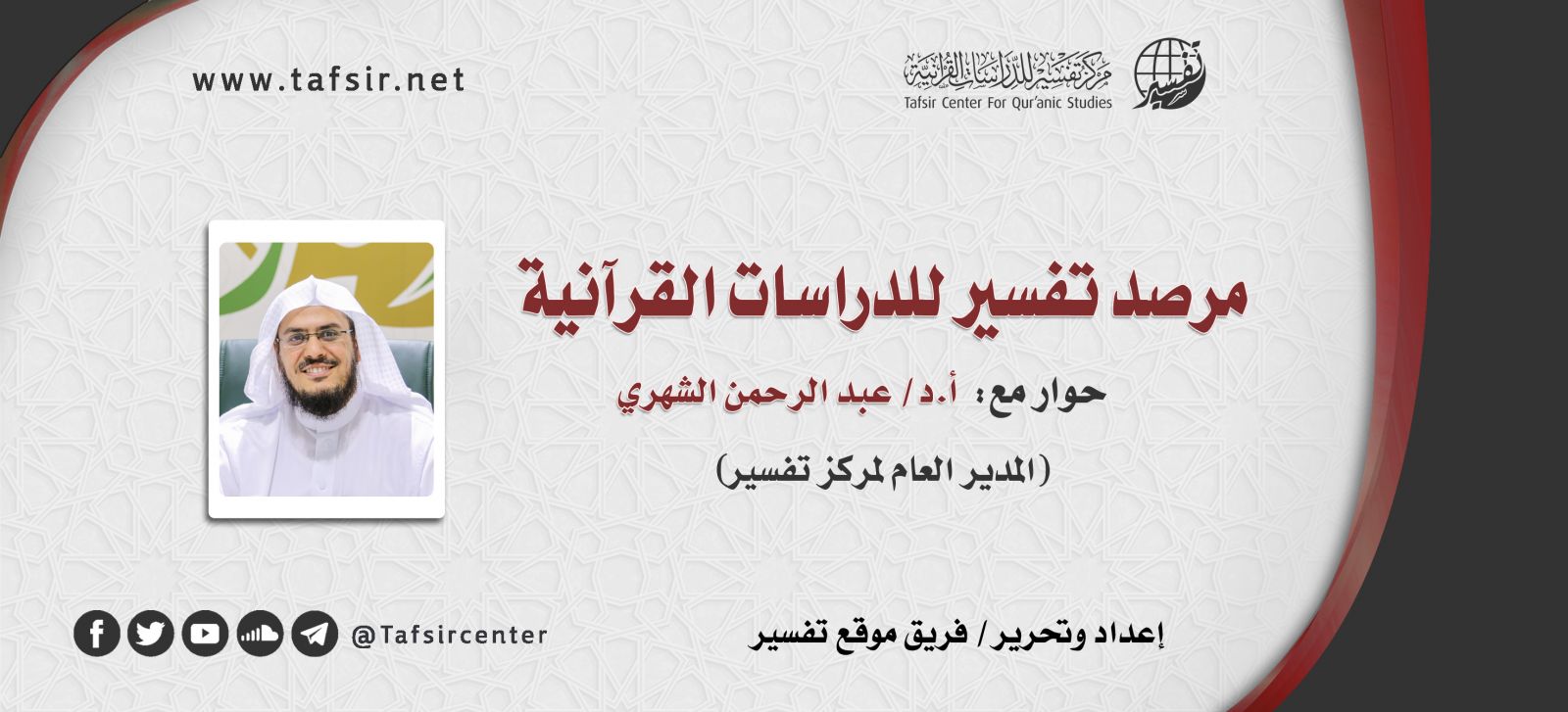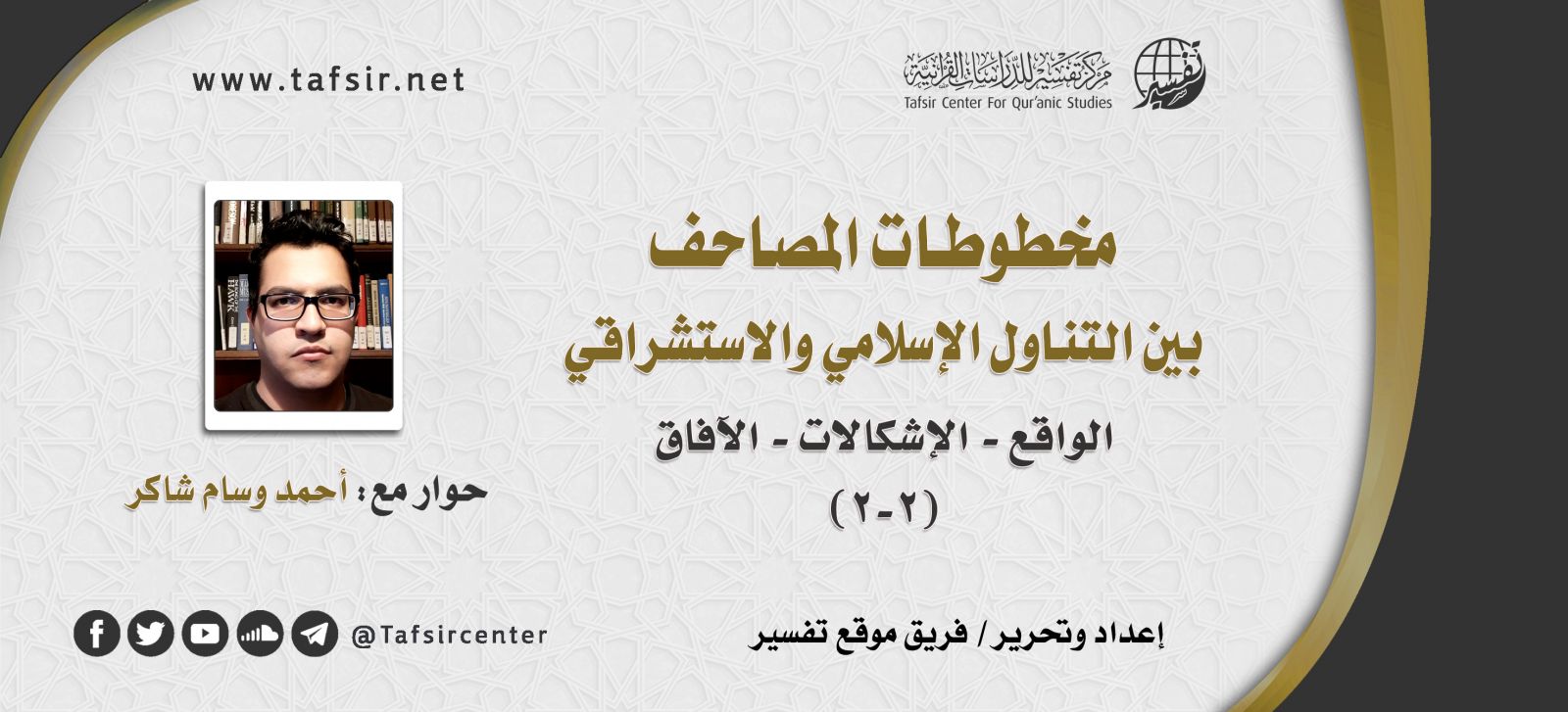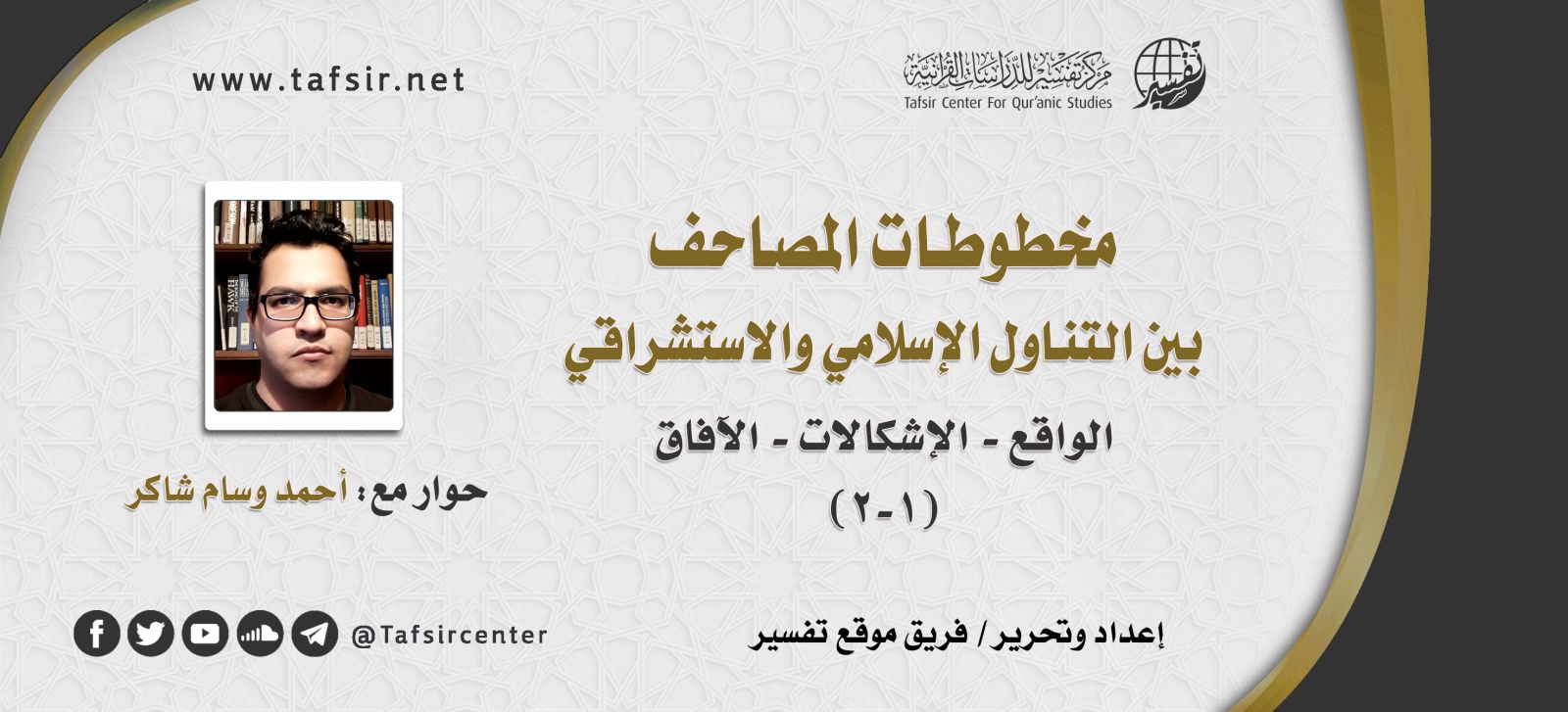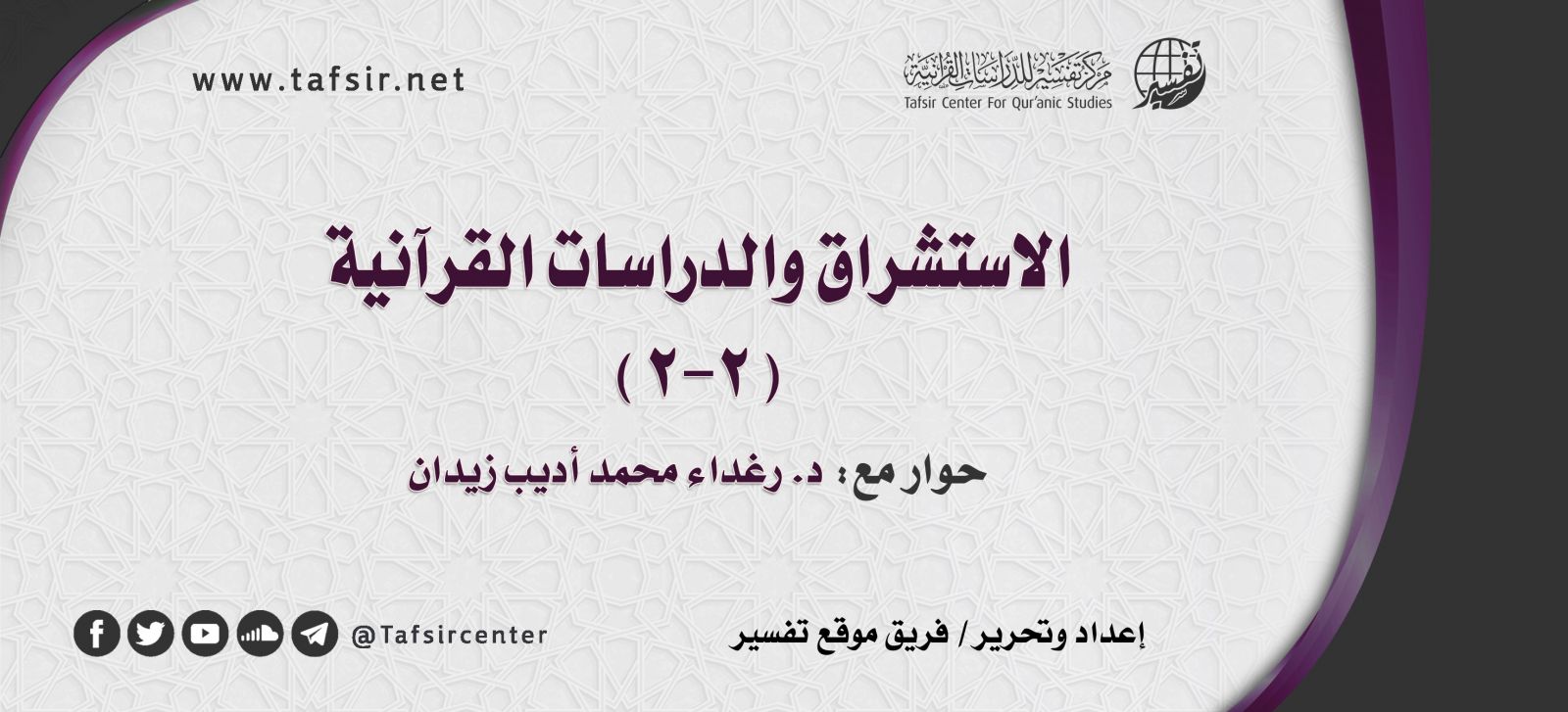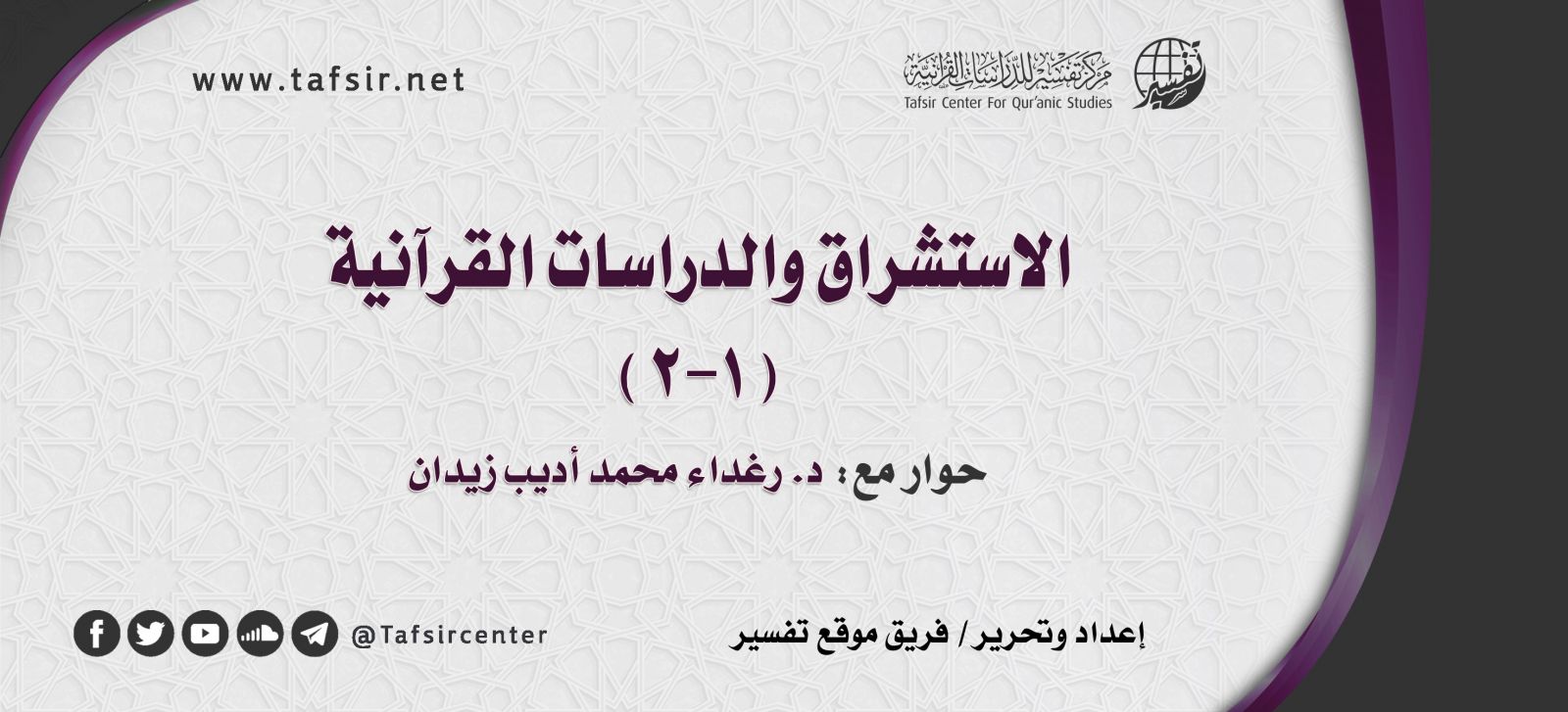مُعتَرك الأفهام في منهج التلقِّي والقراءة لآيات القرآن في تاريخ النظر الإسلامي
مُعتَرك الأفهام في منهج التلقِّي والقراءة لآيات القرآن في تاريخ النظر الإسلامي
إعداد: محمد كنفودي
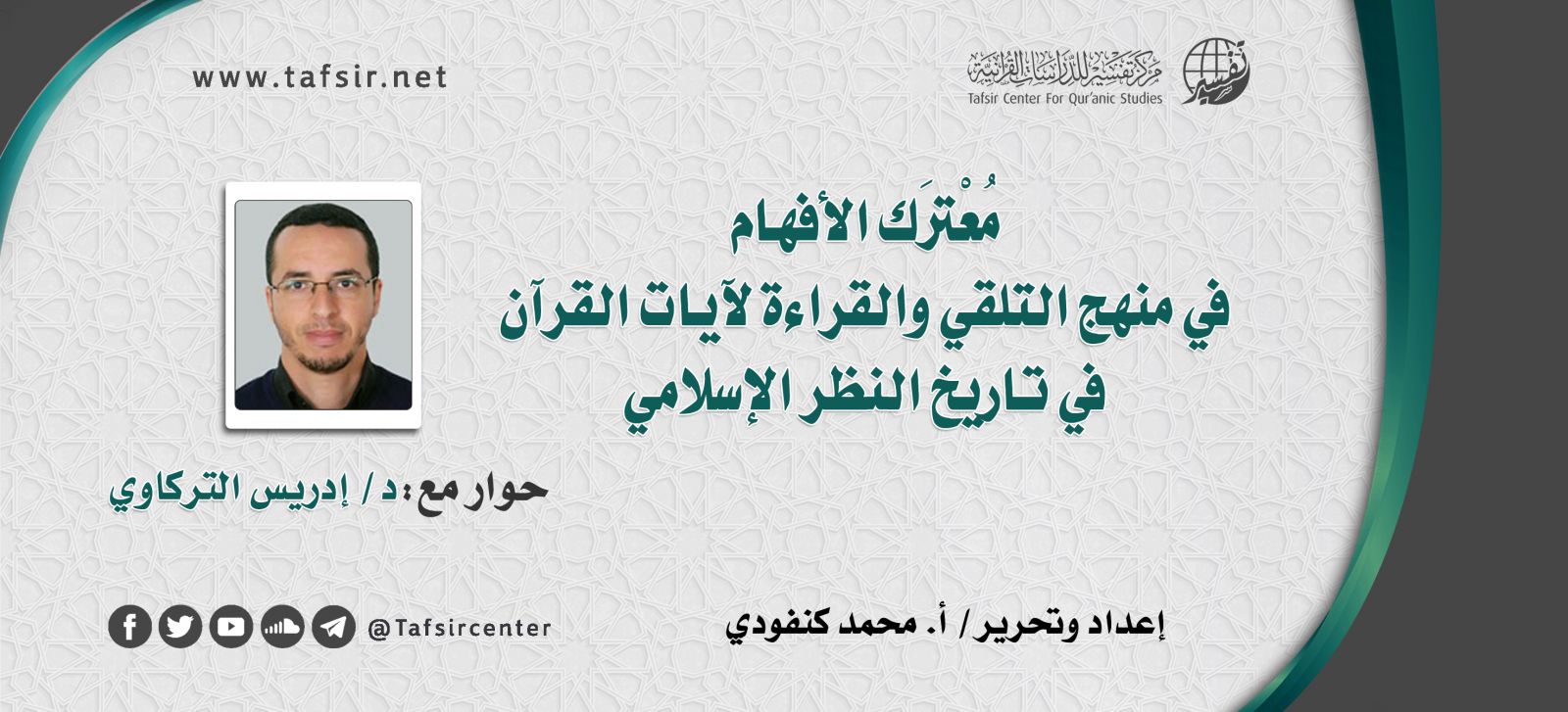
مقدمة:
رغم ما نسمع من دعوات عديدة لتجديد مناهج النظر في القرآن من مختلف الاتجاهات والتيارات في الفكر العربي المعاصر، إلّا أن الاهتمام بقضية التلقّي العملي للقرآن يظلّ اهتمامًا ضئيلًا لو قورن بالخلافات النظريّة والفلسفية التجريدية التي يُقرأ النصّ في سياقاتها، ولعلّ في هذا إهدارًا لسمة الهدى التي تشكّل أحد أهم سمات النصّ القرآني وأحد محدّدات علاقتنا به، حيث يتوقّف الهدى على تلقٍّ شامل لكلّ أبعاد النصّ في كلّ أبعاد الوجود الإنساني.
لذا فإنّ علاقتنا بالتراث التفسيري وتجربة تلقي النصّ القرآني منذ عهد النبوة لا بد أن لا تتوقف عند الأُطُر المنهجية والأدواتية المنشغلة بكيفية قراءة النصّ وتحصيل معانيه، بل لا بد أن تتّسع لتشمل كيفية تلقيه عمليًّا وسلوكيًّا وأخلاقيًّا، كما أن تقييمنا لدعوات التجديد في الفكر المعاصر لا بد أن لا تتوقف كذلك عند حدّ كفاءة المناهج والأدوات، بل أن تتخطى هذا للسؤال عن مدى قدرة هذه المناهج على تفعيل قراءة حيّة وتلقٍّ فاعلٍ بالنصّ، من هنا يمكن لتلقينا المعاصر للنصّ أن يصبح أكثر ارتباطًا بالتلقي الأول له، والذي استطاع الامتثال والتفعيل لرؤيته الكلية والتفصيلية، النظرية والعملية، دونما انفصال.
وفي هذا الحوار مع الدكتور إدريس التركاوي -باعتباره من المشتغلين بالدراسات القرآنية؛ سواء في متجليها التراثي أو المعاصر- توجَّهْنا له ببعض الأسئلة حول عملية تلقي النصّ القرآني نظريًّا وعمليًّا في تلقيه الأول وفي أزمنة التأسيس المنهجي، وفي إمكان تلقٍّ معاصرٍ قويمٍ للنصّ:
وقد أتى حوارنا معه على ثلاثة محاور؛ المحور الأول: آيات القرآن ومنهج التلقي القرائي الأوّل زمن النبوة والنزول، حيث دار الحديث حول التلقي الأول للقرآن الكريم ودور النبي -صلى الله عليه وسلم- في بيان عملية التلقي العملي للقرآن الذي يجعله كتابًا يجمع بين الشمول والخصوص، ووضع القوانين العامة وإدارة الجزئيات الخاصّة، ويؤلّف بين النظر والعمل، فيسدّد العمل بالنظر ويحمي النظر من العطالة بتوجيهه للعمل. أمّا في المحور الثاني: المناهج التأسيسية القرائية لتلقي آيات القرآن أزمنة الوضع التأصيلي في تاريخ الفكر الإسلامي، فقد ألقى الضوء على عملية نشأة الأسس المنهجية لقراءة القرآن الكريم والتي تُعدّ لَبِنة رئيسة في تحويل التلقي الأول إلى تلقٍّ مؤسس منهجيًّا وعلميًّا من أجل استمرار عملية الاستهداء بالنصّ القرآني مع تغير الوقائع والنفوس. أمّا في المحور الثالث والأخير: مقتضيات إنشاء مقومات النظر القرائي الجديد في أفق تدشين سياق تلقٍّ إسلاميّ معاصر، تناول فيه بعض الدعوات المعاصرة للتجديد ومدى قدرتها على تحقيق تلقٍّ نافع للنصّ من عدمه، كما اختُتِم الحوار بالتعريج على الاجتهاد الخاصّ للشيخ فريد الأنصاري كمنهج تطبيقي تغيَّا الجمع بين الدّقة المنهجية وبين إبراز الأهمية الكبرى للتلقي العملي والسلوكي.
نص الحوار
المحور الأول: آيات القرآن ومنهج التلقي القرائي الأوّل زمن النبوّة والنزول:
س1. من المعلوم أن القرآن كتابُ عملٍ وتطبيقٍ، وليس كتاب نظر وتجريد، كما قرّر الشاطبي في الموافقات وغيره. ما العلامات الكبرى التي تجلَّى بها هذا الناظم الكلي في آيات الأمثال القرآنية والآيات العقدية والتشريعية والقصصية والأخلاقية ونحوها، حسب التصنيف الموضوعي المتداول لآيات القرآن؟
د/ إدريس التركاوي:
لا شك أنّ البحث في مناهج تفسير القرآن كان -ولا يزال- هو البوابة الخطيرة المنفتحة على جميع واجهات التدافع الحضاري في القديم والحديث، فهو كلام الله الذي أعجز البشرية على أن يأتوا بمثله، وفي ذات الوقت يُعَدّ الدستور المتكامل المحفوظ الذي استطاع مواجهة كلّ التحديات ووضع اللبنات لتفسير كلّ الظواهر. أليس هو كلام الله خالق هذه البشرية؟!
ومن هنا تفطّنَت جميع المذاهب الفكرية والعقدية والأيديولوجية إلى أنّ الصراع الحضاري سيكون منوطًا-بلا شك- بالدخول في حلبة الصراع حول فهم هذا الكتاب، وتجسيد مقتضياته في الواقع السلوكي والعمراني. من هنا سارع كثيرٌ منهم منذ البداية ليضع مناهج منبثقة عن تصوّره للكون والحياة يطوّع لها نصوص القرآن لخدمة أغراضه ومآربه التي تؤطّرها نظرته الفلسفية والفكرية. وفي خِضَمّ الأخذ والرد ومحاولة مصادرة الفهم الصحيح في نظر كلّ فرقة؛ حاول كثير من العلماء والنظّار في القديم والحديث وَضْعَ معايير منهجية للنظر ابتداءً في هذا الكتاب المهيمن الحاكم قبل الحديث عن مساطر فهمه واستنباط قِيمه وأحكامه، معايير كلية لا تفتأ تأخذ هويتها من المرجعية الإسلامية المتوازنة، باعتبارها ليست نظرية فلسفية متطرفة ولا رؤية تمتح من واقعية الفلسفة المادية الجدلية المفرطة.
بهذا المعنى نفهم حقيقة كون القرآن كتابًا عمليًّا؛ معنى ذلك أنه عملي وواقعي في مقابل تجريد المذاهب الفلسفية التي كانت تحلّق في الفضاء بعيدًا عن عمران المكلفين، غير أن واقعيته من ناحية أخرى ليست كواقعية الفلسفة المادية اليهودية والرومانية التي أخلدت إلى الأرض متجرّدة من القِيم والمثُل العليا، ولعلّ هذا هو الناظم والمعيار الذي يمكن استصحابه لفهم محاور القرآن من قيم وتشريعات وأخلاق...، فلو تتبعتَ مثل هذه الأمور أو شيئًا منها لألفيتَ أنها تجمع بين تأصيل الحكم الكلي للحادثة أو الفعل ثم تبيّن حقيقته في واقع التنزيل خاصّة لكنه بيان جزئي محدود، تاركة تفصيله للسُّنة النبوية الشريفة باعتبارها مذكرات إجرائية تفسيرية. وأما القصص والأمثال فلها طابع التكميل، بحيث تصف ظرفية وقوع القصة وملابساتها ثم ترتّب عليها الحكم المعياري كما ارتضاه الإسلام بصيغته المتوازنة كما قلنا قبل؛ فهذا معنى عملية وواقعية القرآن وإلّا فإنّ أغلب السور جاءت لتسطير كليات نظرية خاصّة في القرآن المكي كما قرر الشاطبي وابن تيمية، تاركة التفاصيل والجزئيات للسُّنة باعتبارها تجسيدًا عمليًّا له؛ وبهذه الصيغة المتوازنة يمكن القول: القرآن فلسفة عملية.
س2. التلقي العملي الأوّل لآيات القرآن، تجسّد في أعمال الرسول -عليه الصلاة والسلام- بوصفه أسوة حسنة وأنموذجًا كاملًا. ما أبرز المعالم التي حدّدت التلقي العملي لآيات القرآن من لدن الرسول -عليه الصلاة والسلام-؟
د/ إدريس التركاوي:
بداية ينبغي أن نفهم أن تلقي النبي -عليه الصلاة والسلام- للقرآن كان شفهيًّا نظريًّا وعمليًّا؛ فالأول يعلمه الجميع وكانت له كيفيات ومعالم معيّنة. أمّا الثاني فلم يكن تحكمه منظومة من الهيئات المتباينة، بل كانت أخلاق الرسول -صلى الله عليه وآله وسلم- كلّها عملية إذا استثنينا التلقي الأول، وهو تلقٍّ محدودٌ زمنيًّا ومكانيًّا؛ لذا نجد أن شريط التلقي العملي كان مستغرقًا لجميع حياته باعتباره المجسّد الرسمي لمقتضيات الوحي في كلّ شيء أخلاقًا وتشريعًا، وفي علاقاته الشخصية والعامّة الداخلية والدولية وحتى فيما لا تشريع فيه. كلّ هذا كان مجالًا لتصرفات النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- العملية المجسّدة لمقتضيات الوحي في الخارج.
ومن ناحية ثانية لا ننسى أن القرآن كتاب بطبيعته عملي يدعو إلى التحلّي بالكليات العملية القيمية الإيجابية والابتعاد عن القيم السلبية المذمومة، ولأن الفترة كانت فترة تدافع حضاري وعملي بين إمبراطوريات شتّى؛ مثل الإمبراطورية الفارسية والرومانية، وبعض المملكات العربية سواء القريبة من الجزيرة العربية أو البعيدة عنها؛ كان لا بد للرسول -صلى الله عليه وسلم- أن ينتقي منهجًا أقوى للدخول والفوز بهذا التدافع منخرطًا في وسائله كما هي في الواقع، ولم يكن عليه أن يخترع وسيلة خارجه. ومن هنا بادَر إلى أرفع وسيلة وأعظمها خطورة، وهي وسيلة الاقتداء والتأسّي والاتباع مستلهمًا إيّاها من القرآن وبشكل تلقائي؛ لأنه لمّا كان القرآن ليس كتابًا فلسفيًّا حجاجيًّا نظريًّا بل عمليًّا امتثاليًّا، كان من المتوقع أن تكون وسيلة تبليغه منطبعة بنفس تلك الصفة.
وهناك مظهر ثالث مهمّ يتجلى في العلاقة الحميمية الاتصالية التي نسجها الوحي بين القرآن والرسول -صلى الله عليه وسلم-؛ إذ لم يكن أحدهما بعيدًا عن الآخر بل كان الأول يمدّ الثاني بكلّ ما يساعده في دعوته تشريعيًّا وسلوكيًّا، متابعًا له ومعقبًا ومناظرًا ومعايشًا لجميع الأحداث والتوترات الرمزية والواقعية التي كان يعيشها الرسول -صلى الله عليه وسلم- بوصفه داعية إلى الله. هذا الاتصال بين الذّاتين -وإن كانت كلّ واحدة مستقلّة عن الأخرى- عبّرت عنه السيدة عائشة -رضي الله عنها- حينما سُئلت عن خُلقه فقالت: «كان خُلُقه القرآن»، هكذا على سبيل الاستغراق دون فرق بينهما من هذه الناحية. فضرورة الاقتداء والتأسّي وطبيعة القرآن باعتباره كتاب هداية ودعوة وليس فلسفة مجردة =كانت أهم موجبات تلقي النبي -عليه الصلاة والسلام- العملي لهذا الكتاب، وهي العلامات والموجبات التي شيّدت مظاهره في الواقع.
س3. اهتدى الجيلُ الأولُ أثناء تلقّي آيات القرآن، بما تمثّل تحققًا في أعمال الرسول -عليه الصلاة والسلام- فعلًا وتركًا. لو بيّنتم لنا أهم ما تفتّق ونشأ عن هذا التلقي من قِبَل الصحابة -رضي الله عنهم- في أزمنة محاولات التأسيس المنهجي، خصوصًا على المستوى التفسيري والأصولي والفقهي والمقاصدي والأخلاقي.
د/ إدريس التركاوي:
عهد الصحابة لم يكن بالطبع عهد تأسيس منهجي بصورة كبيرة، بل كانت المرويات اللفظية والسلوكيات النبويّة يتلقّفونها مباشرة ويعيدون ذوبها في بوتقة التفكير اللغوي الفطري الذي كان يحكمهم، دون أن يتكلّفوا تفريقًا منهجيًّا بين هذا العلم أو ذاك. وطبيعي هذا الأمر بالنظر إلى نشأة كلّ علم كما هو معلوم في تاريخ العلوم ونشأتها؛ إذ تبدأ العلوم بالرواية وتحدث توترات علمية وحضارية تدفعها إلى التفريق والتصنيف ورصد الحدود، وكذلك كانت حال العلوم الشرعية.
نعم؛ كانت بدايات التأسيس المنهجي -سيّما في علمي الحديث والفقه في القرن الثاني- مستفيدة ولا شك مما وضعه الصحابة تلقائيًّا من روايات فقهية وأخلاقية، وبما رصدوه من قواعد نقديّة بسيطة تمحّص الصادق من الكاذب في الروايات، وتعرّض بالموضوع والمدلِّس (بكسر اللام)، وترجح من بين الأحكام ما وافق الدليل القرآني أو ما جرى عليه العمل من سُنة رسول الله -عليه الصلاة والسلام-؛ لذا، وعند تأسيس المذاهب الفقهية حاول كلّ مذهب فقهي الالتزام بمدرسة ترجع إلى الصحابة في نهاية المطاف؛ كمدرسة ابن مسعود ومدرسة ابن عباس وغيرهما من المدارس التي تفرّقت في الأمصار في مكة والمدينة والعراق والشام ومصر...وغيرها. فكانت أسس مذهب مالك في الفقه منبنية على مذهب زيد بن ثابت في مدرسة المدينة وابن عباس في مكة. وأسّس أبو حنيفة مذهبه على قواعد مدرسة ابن مسعود بالعراق، وهكذا سائر المذاهب مستفيدة مما سطره الصحابة. ومن الفقه والحديث واللغة تفتّقت كلّ العلوم الأخرى من أصول وأخلاق ومقاصد...إلخ. غير أنها جاءت متأخّرة لاعتبارات تصحيحية أو لظاهرة الانشقاق التي شهدتها جميع العلوم الإنسانية والكونية مثل الفلسفة والرياضيات، كما هو معلوم في فلسفة العلوم وتاريخها.
المحور الثاني: المناهج التأسيسية القرائية لتلقي آيات القرآن أزمنة الوضع التأصيلي في تاريخ الفكر الإسلامي:
س4. من المعلوم أن الوضع التأسيسي أو المدرسي تسبقه في الغالب اجتهادات أوليّة ممهدة، التي ذلّلت الصعاب للتأسيس المنهجي في جملة مجالات الاجتهاد التراثي الإسلامي، خصوصًا في حقل تفسير آيات القرآن. نلتمس منكم أن تحددوا جملةً من الاجتهادات الممهدة للتأسيس التراثي التفسيري.
د/ إدريس التركاوي:
طبعا هناك تفاسير أغلبها لم يزل مخطوطًا أو فُقِد، تُنْسَب لعلماء بداية القرن الهجري الثاني وعلى امتداد القرنين الثاني والثالث، حيث جمعت أقوالهم وتراثهم في مجال التفسير، وكانوا به ممهِّدين لمن تفرّغوا بشكلٍ مباشرٍ لتدوين الكتب كالطبري وغيره من علماء القرن الرابع الهجري، نذكر من بينهم:
- تفسير مجاهد (104هـ).
- تفسير مقاتل (150هـ).
- تفسير الثوري (161هـ).
- تفسير يحيى بن سلام (200هـ).
- معاني القرآن للفراء (207هـ).
- تفسير عبد الرزاق (211هـ).
- معاني القرآن للأخفش (215هـ).
س5. اشتغل أهلُ التفسير أزمنة التأسيس في سبيل وضع عدّة مفاهيمية وحزمة إجرائية تتغيَّا تحقيق غرضين متلازمين: عصم التلقي والنظر في آيات القرآن عن أمرِ التقويل التعسّفي والقول تشهيًا، وإصابة المعنى الموضوعي السياقي لآيات ومفاهيم القرآن. لو بينتم لنا في هذا السياق، أهم أسباب الاشتغال لتحقيق هذا المشروع، أو التلازم في فضاء النظر التفسيري، الذي كان يعمّ -شمولًا كما هو معلوم- حقولًا معرفية إسلامية متنوعة وعديدة تعدُّد الاجتهاد التراثي العربي الإسلامي.
د/ إدريس التركاوي:
المعتزلة والفلاسفة وأرباب التصوف الغنوصي الباطني والمتطرفون من الشيعة والأشاعرة وغيرهم كثير ممّن ابتعدوا كثيرًا في التأويل أو قليلًا؛ كلّهم كانوا بتأويلاتهم يتدافعون لرصد المناهج السليمة لتفسير القرآن، سيّما وأن التفسير بالمأثور لم يكن يفي بالمقصود مع تداخل العلوم النقلية والعقلية وتمازجها. ومع استقلال التفسير عن الحديث حيث كان تابعًا له فانفصل مع أول تفسير ظهر يجمع بين الرواية والنقد العقلي وهو تفسير الطبري، كما حقّق ذلك الشيخ الفاضل ابن عاشور في محاضراته في التفسير، ولأن التفسير يُعَدّ بحر العلوم ومحضنها جميعًا؛ قلتُ: لهذه الأسباب كلّها بادر كثيرٌ من نظّار الفِرَق من أهل السنة أو الطوائف المعتدلة إلى بيان حدود التداخل والاختلاف بين تلك العلوم وبين علم التفسير، ولتلافي خلطها به، باعتبارها خطوة منهجية ضرورية يمكن عدّها ضابطًا للمجالَيْنِ معًا، مجال التفسير حتى لا ينسب إليه إلّا ما هو ضروري أو شبه ضروري في جلب المعنى المراد الذي ينبني عليه تكليف عملي أخلاقي أو تربية قلبية أو إعجاز، وما خرج عن هاته الأثافي الثلاث صار إدخاله فيه حشوًا. وهي نظرية الشاطبي وابن تيمية وقبلهما الجرجاني بتقعيده كليات البلاغة والنحو العاصمة من الفهوم اللغوية الزائغة أو الجاهلة، وغيرهم كثير.
ثم هو ضبط لمجال علوم الشريعة بوصفها روافد تصبّ فيه حتى لا تضيع هويتها وتتداخل مطالبها، ولا يهمّنا التفصيل في هذا هنا فلا نطيل بالحديث عنه.
على هذا المنوال صارت كلّ محاولة في تقعيد القواعد والمساطر الكلية، فظهر ما يسمى بأصول التفسير والتآليف فيه قديمًا وحديثًا.
ثم بهذا المنهج أيضًا سيتمكن الناظر في القرآن من إصابة المعنى السياقي المراد كما جاء في سؤالكم أو مقاربته، أي من خلال مراعاة المنهج التكاملي في صيغته الكلية بين علم التفسير وسائر العلوم مع مراعاة الحفاظ على المطالب المشكّلة للهوية العلمية لكلّ منهما؛ إذ رُبَّ قواعد متنافرة فإذا رحلَت إلى غير إطارها تداخلَت وتكاملَت في جلب المطلوب والمساعدة عليه.
وأضرب لك مثالًا: خذ معي مثلًا قاعدة النَّظْم، وقاعدة سبب النزول، وقاعدة العامّ الأصولية. فهي ثلاث قواعد مختلفة؛ الأولى محضنها البلاغة، والثانية علوم القرآن، والثالثة أصلها لغوي لكنها نضجت في الفقه والأصول. انظر ماذا حدث؟ في القديم كان النَّظْم يساعدنا على فهم سياق الحدث أو الظاهرة أو الفعل، وكان سبب النزول يساعد في إناطة الحكم بمتعلقه من تلك الظواهر والأفعال دون تجاوزها، أمّا العام فكان يربط المعنى بعموم اللفظ ويوسع من دائرته، غير أنه كان يجهز على طبيعة القاعدتين السابقتين ويقابلهما إلى درجة التنافر في سياق الترجيح. لكن حين رحلت هاته القواعد من مجالاتها إلى التفسير صار لها شأن آخر عند بعض النظار المبدعين من مثل الشاطبي والجرجاني والمازري وابن العربي وابن تيمية. هؤلاء اتفقوا وبأساليب مختلفة على سبك نوع من العموم يوافق القاعدتين سموه بعموم الاستعمال. أي: إنّ الحكم الوارد في الحادثة لا هو خاصّ بها فيضيع العموم اللفظي، ولا هو عام عمومًا لفظيًّا فيضيع السبب الصحيح الذي أُنيطت به. فهو عموم نوعي يحافظ على النَّظْم بقدر ما يوسّع من دلالات الأفراد التي فيها مماثلة أو شبهة من الفرد الذي أنيط به الحكم أول مرة. ثم من ناحية أخرى يُعَدّ هذا التخريج الدلالي منهم فرصة للقضاء على ما يسمى اليوم بالتاريخانية التي تقرّر ربط الحكم بتاريخ وقوعه، أي: بالتقوقع على سبب النزول فقط.
وهكذا تجد كثيرًا من القواعد والكليات التي اكتشفها النظّار لتنظيم المجال التفسيري وجعلِ العلوم خادمة له على قدر موضوعه ومطالبه ودون الخروج عنها تفاديًا لما سقطت فيه كثير من التفاسير.
وفيه فرصة أيضًا لنسف التقسيم الكلاسيكي المتداول: هذا تفسير بالرأي، وهذا تفسير بالمأثور.
س6. بعد النظر في التَّرِكَة التي خلّفها التلقي التفسيري في النظر التراثي، خصوصًا أزمنة الوضع التأسيسي، تجدها في عمومها تنقسم إلى قسمين: قسم يتّصل بالجانب المنهجي-قوام استناد النظر، وقسم يتصل بالجانب المعرفي-محصول النظر. إلى أيّ حدّ يمكن الاستفادة من تلك الاجتهادات بقسمَيْها، في سبيل وضع تأسيس معاصر يلبي مقتضيات ضرورة التلقّي الجديد لآيات القرآن، بالنظر إلى أنّ الكثير من أسباب إنشاء تلك التركة تغيّرت، واستجدّ ما لم يَكُ متداولًا وقتئذٍ؟
د/ إدريس التركاوي:
كباقي جميع علوم الشريعة؛ من مثل الفقه والتصوّف واللغة والحديث، كانت المدونة المعرفيّة هي السابقة في الوجود على الآليات المنهجية، وبحكم طبيعة العرب البدوية الذين تلقوا القرآن من النبيّ -عليه الصلاة والسلام- بسليقتهم المحكومة بالتفوّق اللساني عن باقي الأمم؛ لذا كانوا ينتجون هذه المعرفة تلقائيًّا بتفاعل مع لغة القرآن وهي لغتهم في نهاية المطاف، لكن بعد انتهاء الصّدر الأوّل حدثت دوافع حضارية ودينية وأخلاقية دفعت بالجيل الثالث والرابع إلى تأصيل قواعد نقديّة ومنهجية تواجه الخلل والخطل اللذَيْن دخَلا العلوم الأولى. وقد تطوّر ذلك -وبتمازج علوم دخيلة معها- فوصلت إلى ما وصلت إليه من نضج في القرن الرابع والخامس وما بعدهما قبل فشوّ التقليد، وإن كان بين الفينة والأخرى يبزغ مجدِّدٌ فرقدٌ في سماء الإبداع.
هذه إشارة لا بد منها لنبني عليها. ثم نرجع الآن إلى الجواب عن سؤالك، ذلك أن حدود الاستفادة من المنظومتين معًا هو إشكال حقيقي معاصر ظهر منذ عقود خلَت، وذلك أن كلّ مدرسة وضعت آليات للاستفادة بحسب توجّهها الفكري والعقدي. وهذا الذي اضطر كثيرًا من العلماء والمفكّرين الصادقين إلى السؤال عن المنهج السليم. والحقّ أن هذا المنهج رهين -أولًا- بقيمٍ أخلاقية ينبغي التحلّي بها راجعة إلى الصدق والحيادية والموضوعية، هذا أولًا. وثانيًا: من وجهةِ نظري المتواضعة وبعد بحثي في مناهج تلك المدارس ظهر لي أن الاهتمام بالشقّ التربوي والقيمي مهم جدًّا في إرساء منهج تفسيري متوازن؛ لأن القرآن -كما أسلفتُ- هو كتاب هداية ودعوة إلى صناعة الشخصية المسلمة التي تعبد الله وتطبق أوامره الاستخلافية في الخارج بالقصد الأصلي، وهذا يفهم منه ضرورة الاهتمام ببناء النفس والفرد قبل بناء المجتمع والأمّة، تمامًا كما حدث في القرآن المكي في مقابلة القرآن المدني. أمّا من ناحية الآليات فأظنّ -والله أعلم- أنّ المدخل المقاصدي المراعي لوحدة سور القرآن ولاستقلالها مهمّ جدًّا، وهو الإشكال الذي نشتغل عليه حاليًا، وله تداعيات وموجبات كثيرة تدعو إلى إعطائه الأولوية، لا يسمح بها المقام لطولها. ولكن أهمها نجده مفهومًا من ذات القرآن نفسه وليس خارجًا عنه. ذلك أن كلّ سورة نُلْفِي لها مقاصد كلية وجزئية وأغراضًا تجمع بين تذوّق إعجازها وبين الاهتمام الخاصّ بتربية النفس البشرية وفق ظلالها وشخصيتها وإطارها المعرفي والجمالي مستقلّة نوعًا ما عن سائر السور؛ وإن كان بين الجميع وحدة لا تنكر لأنها وحي والوحي لا يتعدّد، ومن ثم فعودة الناس إلى هذا المنهج يقلّل من الخلاف في الآليات المنهجية ومن سيطرة التقسيم الكلاسيكي القديم لمناهج التفسير من كون هذا تفسير بالمأثور وهذا تفسير بالرأي. وقد اهتم بعضُ المعاصرين بشيء من هذا النوع التفسيري؛ مثل محمد عبد الله دراز وسيد قطب والنورسي وفريد الأنصاري، ومن القدماء نجد الفراهي والبقاعي وغيرهم...، مع استحضار -طبعًا- الثوابت، سواء كانت معرفية مثل النصوص التفسيرية المجمع عليها، أو منهجية مثل كليات اللغة واللسان والفقه والأصول والكلام...، غير أن شحن التفاسير بإحداها أو بغيرها أخرج القرآن عن كونه قرآنًا وجعله كتاب تفسير وليس كتاب تدبّر، مع أن هذه الثانية هي المقصودة في منهج التلقي السليم كما كان في الصدر الأول وكما نبّه عليه القرآن نفسه. وهذا المنهج سيساعدنا أيضًا على مراعاة تغيُّر الظاهرة البشرية في العصر الحاضر ويعيننا على المحافظة على ما ينبغي الحفاظ عليه من كليات وقواعد، وتغيير ما تدعو الضرورة إلى تغييره مما يتمحور حول الجزئيات مناط التغير والتبدّل في كلّ عصر. والله أعلم.
المحور الثالث: مقتضيات إنشاء مقوّمات النظر القرائي الجديد في أفق تدشين سياق تلقٍّ إسلامي معاصر:
س7. استند أهل القراءات الجديدة للقرآن، إلى أن النظر التفسيري التراثي لم يَعُد صالحًا للمرحلة المعاصرة؛ إذ ليس بمكنته أن يحقّق مصاديق رسالة القرآن في بُعدها العالمي والإنساني، بالنظر إلى هيمنة المحدّد التاريخي في النظر وتلقي آيات القرآن؛ لذلك كان لا بد من القطيعة المطلقة معه، لتأسيس عصر تلقٍّ جديد في السياق الإسلامي المعاصر. ما تقييمكم المنهجي لهذا المنظور الكلي لأصحاب القراءات الجديدة للقرآن؟
د/ إدريس التركاوي:
فيما سبق من الأسئلة أشرتَ إلى إشارة مهمّة تتعلّق بكيفية الاستفادة المنهجية من التراث لسبك آليات عاصمة للذهن ومقومة للفهوم لإنشاء تفسير يواكب التحديات ولا يذوب في الأحداث، هذا هو مدخلنا هنا لبيان إشكال القراءات المعاصرة في النظر إلى التفسير التراثي القديم، كلّ هؤلاء الذين تفضّلتَ مشكورًا بسردهم كانت فكرتهم واحدة، هي سبكُ آليات تفسيرية جديدة، وإن تفاوتت نظرتهم إلى التراث؛ إذ منهم من يدعو إلى مقاطعته كليًّا، ومنهم من ينادي بتهذيبه، ومنهم من هو دون ذلك. والحقّ -كما أسلَفْنا سابقًا- هو اعتماد النظر الكلي بحسب ما يوفره لنا الاستقراء واعتماد الآليات المقطوع بها لسبك هذه الكليات التفسيرية، فتراثنا في الحقيقة هو جزء من هويتنا نحن المسلمين، ولا يمكن مقاطعته نهائيًّا. والدليل هو أن هؤلاء إمّا اخترعوا ما اخترعوه مستفيدين من التراث ثم عادوا عليه بالنقض؛ كاللئيم الذي ينكر كرم الكريم. وإمّا مغرمون بآليات ودعوات غربية ملحدة أو علمانية أو فلسفية مغرضة. مع أنّ الغرب نفسه يوثّق تاريخيًّا وعلميًّا في جُلّ علومه راجعًا إلى التراث وإلى أعلامه؛ مثل ابن رشد والغزالي وابن سينا وابن خلدون وغيرهم كثير. نكتفي بهذا الدليل لنبيّن أنّ في تراثنا زخمًا معرفيًّا ومنهجيًّا لسبك كليات (بقدر ما تحافظ على هويتنا وثوابتنا في ذلك التراث) قادرة أيضًا على التأقلم مع متغيّرات العصر، ولأن الكلي هكذا طبيعته يجمع بين الثابت والمتغيّر. وبهذا المنهج نحاكم التراث وتلك القراءات معًا، فما كان يخدم لنا نظرية الكلي المستقرأة قَبِلناها، وما لا فلا.
وباشتغالي في أصول التفسير التراثية خاصّة مدّة لا تقلّ عن العقد من الزمن فأنا مؤمن بأنّ تراثنا هو مجال إبداعنا، أحبَّ مَن أحب وكَرِهَ مَن كَرِه، وبأن جُلّ تلك القراءات يطبعها الأحادية في التفكير والركون إلى الأيديولوجية ورد الفعل والتخمين، ولا تنبني على مراعاة النظر الكلي؛ فلهذا تحتاج إلى توجيه حقيقي متين.
س8. الناظر في حصيلة ما قدّمته القراءات الجديدة لبعض آيات القرآن، أنك تجدها في عمومها محدّدة بجملة معالم منهجيّة، من أهمها: الولع بنقل وتقليد الجاهر الحداثي الغربي منهجيًّا ومعرفيًّا، مع السعي لتسويغه بمسالك شتى. إيجاد دلالات لبعض آيات القرآن تخالف المعهود الإجماعي للتراث الإسلامي، بل تخالف أحيانًا منصوص الشرع الإسلامي. تأسيس مناظير ومقاربات جديدة لتلقٍّ جديد لآيات القرآن في السياق المعاصر. لذلك، فهل من الممكن تأسيس عصر تلقٍّ جديد للقرآن وفق المحددات المنهجية الحاكمة لنظر أهل القراءات الجديدة للقرآن، ولو من باب الاستئناس بها؟
د/ إدريس التركاوي:
صحيح هذا سؤال يُعَدّ استمرارًا وتفصيلًا لسؤالك السابق آنفًا، ذلك أن الاستئناس بهذه القراءات المعاصرة ليس من باب كونها قراءات علميّة موضوعية ومحايدة كما يدّعي جُلّ أصحابها بكذب أو بجهل، وقد علمت -بحُكم بحثك فيها- أنها قراءات من ورائها دسيسة. قلتُ: ليس من هذا الباب ولكن من باب كونها تمتح من قواعد بعض العلوم الإنسانية التي اخترعها العقل الإنساني. والظاهرة الإنسانية من هذه الجهة تتشابه في أنماط التفكير والاستنباط والنظر فلا جرم كانت ستحصل تقاطعات ولو قليلة بينها، ومن ثم وجب على كلّ من يحاول في تأسيس تفسير معاصر أو وضع أصوله أن يستصحبها وينظر فيها بنظرة نقديّة متوازنة؛ للاستفادة منها عمومًا كأيّ مجهود بشري، ووفق النظر الكلي الذي سبق أن أشرت إليه. فمثلًا يمكن رصد كليات لغوية مستوعبة مستفيدة من المدارس اللسانية الحداثية في بعض مظاهرها. مثلما استفادت علوم الشريعة سابقًا من علم المنطق الذي يُعَدّ علمًا دخيلًا على تراثنا. وأنت تعلمُ أن النظّار انقسموا في اعتماده؛ منهم مَن عدّه بدعة وأوجب استبعاده، ومنهم مَن أوجب الرجوع إليه بحجّة أنه علم عاصم للذهن وموضوعي عقلي حيادي، وأن لا ثقة في علم مَنْ لم يُحط به، كما قرّر الغزالي في المستصفى. وتوسطت طائفة -والحقّ معها في نظري- فقررتْ إمكانية الاستفادة مع التهذيب والتشذيب ووفق معايير لا تخلّ بالعقيدة والهوية ما دامت حقيقته منبثقة من الفلسفة اليونانية كما تعلم. وهكذا الأمر هنا أيضًا، فالعلّة تنسحب بنفس الوصف المؤثّر، ولا فارق بين الأمرين في جميع العلوم حيث يحدّد الثابت والمتغيّر وفق النظر الكلي، وينظر في المتغير على وزانه لانتقاء اللائق منه في الحالة الراهنة وفي كلّ الأحوال.
كما لا أنسى أن أنبه إلى أمر ذي بال في هذا الصدد، ذلك أن غالب المجدّدين في تراثنا ممن حظوا بعناية فائقة من النظّار والباحثين كان تجديدهم مستندًا على هذا المنهج؛ منهج اعتماد الكليات والقواعد الكلية لأنها تسهّل عليهم أمر تأسيس قواعد العلم، وفي ذات الوقت تساعدهم في نقد ما ينبغي نقده من الجزئيات على شرط أن تكون تلك الكليات حقيقية ومستقرأة. ولك أن تمثّل هنا بالشافعي في رسالته؛ إذ كلّها قوانين كلية شبّهها الرازي في كتابه (مناقب الشافعي) بكليات أرسطو في المنطق، ومثلها كليات أبي البقاء الكفوي وكتاب سيبويه وخصائص ابن جني لضبط مجاري اللغة نحوًا وصرفًا ودلالة. ومثلها كليات الجرجاني التي وضعها كما بيَّن في دلائله لضبط النظر بقواعد النحو والبلاغة في القرآن متجاوزًا جزئيات البلاغة حتى نسب إليه أنه مؤسّس علم البلاغة. ومثله ابن خلدون في رصده كليات التاريخ والعمران متجاوزًا النظرة الجزئية الروائية في الحكم على الظواهر. وأخيرًا نجد الشاطبي في رائعته (الموافقات) معتمدًا على الكليات -كما نصّ على ذلك- في رصد الأصول وتوجيه الخلاف فيها ونخل المقطوع من المظنون، والأروع عنده أنه استصحب هذه الكليات لتأسيس منهج جديد في النظر إلى أصول تفسير القرآن بصورة لا تجدها عند غيره قطعًا. وقد أشرتُ إلى كلّ هؤلاء الأعلام وغيرهم في رسالتي للدكتوراه؛ إذ المقام يطول في سردهم وسرد إبداعاتهم ومناهجهم التجديدية في العلوم وعلاقتها بالتفسير محور حديثنا.
س9. ليكون حوارنا تطبيقيًّا؛ نعمد إلى إعمال النظر الحواري في بعض المقولات المنهجيّة لأهل القراءات الجديدة للقرآن، وإلى أيّ حدّ يمكن اعتمادها لتأسيس تلقٍّ جديد لآيات القرآن في المرحلة المعاصرة؟ ومنها: يقول محمد شحرور: «المعرفة أسيرة أدواتها»[1]. يقول طه عبد الرحمن: «لا دخول للمسلمين للحداثة إلّا بحصول قراءة جديدة للقرآن الكريم؛ لتدشين الفعل الحداثي الإسلامي الثاني، ومعيار هذا الحصول هو أن تكون هذه القراءة الثانية قادرة على توريث الطاقة الإبداعية في هذا العصر، كما أورثتها القراءة المحمدية في عصرها»[2]. يقول محمد أركون: «الحقيقة الدينية بحاجة إلى إعادة القراءة والتأويل من جديد، لكي تساير التطور الحاصل»[3]. يقول محمد عابد الجابري: «اختلاف الآراء لا يطعن في الحقيقة المحمولة في طيات النص القرآني، بل هو دليل على أن ثمة -فعلًا- حقيقةً تعيّن البحث عنها، وإعادة بنائها من جديد»؛ لذلك، لا بد من التخلّص من «المسبقات بوصفها عوائق معرفية»[4].
د/ إدريس التركاوي:
أبدأ بما ختمتَ به سؤالك: كلمة الجابري «التخلّص من المسبقات». في الحقيقة إنّ كثيرًا من القراءات جعلت التخلّص من مسبقات التراث شرطًا جوهريًّا، وتقاطعت معظمها في هذه الحيثية. ولكن عند تطبيق نظرياتها قد لا نتّفق معها؛ لأنّ المسبقات -كما قلنا- تحتمل الثابت والمتغيّر، ما هو كلي وما هو جزئي، ما يمكن الاختلاف فيه وما لا يمكن، حيث ترسو الإجماعات الحقيقية القطعية سواء كانت إجماعات على الحكم أو على الفهم. وجدير بالذِّكر هنا أن هذه الإجماعات لم تكن مجرّدة عن تفكير الصدر الأول، بل كانت مستندة على توارث عملي تداولي طبقةً عن طبقة في السند العالي كما يعبر المحدِّثون من عهد رسول الله -عليه الصلاة والسلام- إلى يومنا هذا؛ مثل إجماعهم على قواعد وأصول العبادات والأخلاق والمعاملات مما كان متداولًا ويستحيل نسفه. ثم يأتي في الطبقة الثانية الإجماع على الفهم لورود فعل الصحابة والتابعين وعدم خلاف العلماء فيه ولو لم يكن تفسيرًا نبويًّا أو سُنّة عملية، مثل الرِّدة وكثير من الحدود والتعازير. ثم تأتي المرتبة الثالثة وهي مناط حديثنا هنا بالأساس وهي الكليات الاجتهادية الاستقرائية المستنبطة من الكتاب والسُّنّة وفتاوى الصحابة والتابعين والعلماء، عقلية كانت أو عملية أو غيرهما.
فهذه المراتب الثلاث هي الثابتة، ومسالك ثبوتها كثيرة لا يمكن الإحاطة بها هنا، ومَن جَهِلَها قال بخرص وكذب أو بجهل في قواعد الدين. وهذا شأن أغلب القراءات التي أشرتَ إليها في سؤالك. وقد كان منها الكثير في القديم مثل الباطنية والمتعصبين من الظاهرية والشيعة والأشاعرة والمعتزلة، ومن كلِّ فرقةٍ فرقةٌ. فلا عجب أن نجد التاريخ يعيد نفسه في عصرنا الحاضر؛ إذ الإنسان بما هو إنسان معرَّض لنزوات التعصب والنفاق والكذب بما غرز فيه من رغبات الشهوة وميولاتها. ويُعَدّ شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- مِن أروع العمالقة الذين نقدوا هذه القراءات القديمة في شتى العلوم، مؤسّسًا لقراءات متوازنة لا تخرج عن هوية السلف وتواكب تجديدات الخلف.
س10. من علماء المغرب المعاصرين الذين اشتغلوا كثيرًا وفي مصنفات عديدة على قضية التلقي الحي لآيات القرآن، خصوصًا في بُعْده التربوي والتعبدي، ذلكم هو فريد الأنصاري [1960-2009]. ذلك أن من أهم كتبه: (مجالس القرآن؛ مدارسات في رسالات الهدى المنهاجي للقرآن الكريم من التلقي إلى البلاغ. مجالس القرآن من التلقي إلى التزكية. بلاغ الرسالة القرآنية من أجلِ إبصارٍ لآيات الطريق). نريد في ختام حوارنا معكم -والدائر حول هذه الفكرة المهمة؛ التلقي الحي والعملي للقرآن- لو حددتم لنا الصُّوَى والعلامات الكبرى لمثل مشروع الأنصاري، ومدى قدرتها على أن تسهم في تأسيس عصر تلقٍّ جديد لآيات القرآن، يروم الاستئناف الشهودي والإصلاح الوجودي.
د/ إدريس التركاوي:
الأستاذ فريد الأنصاري رجلٌ تربويّ ومجددٌ دعويّ بامتياز، ومشروعه مجالس القرآن -وسائر كتبه في الحقيقة- يُعدّ حقًّا مادة خصبة للاشتغال حول تأسيس أصول تفسير معاصر يراعي الشروط المنهجية والمعرفية التي أشرنا إليها سابقًا، وأهم ما يمكن الاهتمام به في مشروعه أمران اثنان:
أحدهما: أنه مشروع تدبُّري وليس كتابًا تفسيريًّا، عودًا منه بالتداول القرآني إلى العهد النبوي ووفق منهجه الكلي. وقد أشرت سابقًا أن القرآن الكريم -سيّما في الفترة المكية- كان يركّز على إصلاح النفس البشرية، وهو أقوى تحدٍّ تعيشه البشرية إلى اليوم؛ فالإنسان ونفسه يمثلان روح الحضارة وقلبها، إذا صلحَا صلح العمران وإذا فسدَا فسد. حتى إذا لانت القلوب لله وتوحيدِه، وانقادت له على المستوى النفسي الفردي، وتشرّبت معاني الإيمان به وخضعت لمنهجه في التصور والسلوك؛ حينئذ يسهل إكمال البناء مما يتعلّق بالسياسة المدنية والاجتماعية والحضارية. وهذا الذي تكفّل به القرآن المدني بوضع كلياته تاركًا للسُّنة التفصيل؛ فمشروع الأنصاري ينطلق بمنهج قرآني دعوي تربوي وعلى هذا الوزان تمامًا.
ثانيًا: تبسيطُ مناهج التدبّر وجعلُها في متناول الجميع حتى ينتشر القرآن بين الناس وفي القلوب، فإذا أردنا أن نفسّر القرآن ونروِّض أنفسنا عليه وجب علينا تدبّره أولًا؛ ولأن التفسير صناعة تخصصية غير متيسّر للجميع بخلاف التدبّر.
فإذن أروع ما يوجد في مشروع الأستاذ -رحمه الله- هو هذا الشقّ المتعلّق بصناعة التدبّر التربوي، وهو لُبُّ القرآن ومقصده من الإنسانية وليس من المسلمين فقط. لكن يمكن تطوير هذا المنهج بجعله مادة مهمّة لتأسيس تفسير تربوي يحافظ على الكليات بقدر ما يراعي الظاهرة البشرية في تقلباتها الوجودية، وأظنّ أن لهذا التفسير الأولوية في عصرنا الحاضر كما أشرتُ لك سابقًا.
ففي الختام نقول بأن عصرنا بات يمثّل اليوم نقطة الذروة في التدافع الحضاري بين الأمم. والأمة الإسلامية -وبحكم الخيرية التي وهبها الله- ملزَمة اليوم بمواكبة تحديات هذا التدافع، ومجابهة كلّ قنوات الفساد العلمي والأخلاقي التي باتت تتسرّب إليها شيئًا فشيئًا، وتنخر نسيج وحدتها النفسية والاجتماعية. وإذا كان القرآن هو السبب في إصلاحها وإنقاذها قديمًا، فلا جرم ستكون أيّة محاولة في الإصلاح بعيدًا عنه محاولة فاشلة، كما يدّعي اليوم بعضٌ ممن يعطي للقضايا الاجتماعية والسياسية والاقتصادية كلّ الاهتمام، وقد علم مما أشرنا سابقًا أن ذلك يُعدّ خرمًا لميزان الأولويات في المنهج الإصلاحي القرآني، الذي يركّز في البداية على الإصلاح التربوي والنفسي المتعلّق بقيم الإنسان من حيث هو إنسان، وما سواه يأتي تلقائيًّا وبشكلٍ تبعي، والعكس غير صحيح. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
[1] الدولة والمجتمع، الأهالي، دمشق. سوريا، ب.ت، ص204، 236.
[2] روح الحداثة؛ المدخل إلى تأسيس الحداثة الإسلامية. المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء. المغرب، ط1، 2006، ص193.
[3] الفكر الأصولي واستحالة التأصيل؛ نحو تاريخ آخر للفكر الإسلامي. ترجمة وتقديم: هاشم صالح، دار الساقي، بيروت. لبنان، ط3، 2007، ص220.
[4] مدخل إلى القرآن الكريم، ج1، في التعريف بالقرآن، دار النشر، الدار البيضاء. المغرب، ط1، 2006، ص18، 84.
كلمات مفتاحية
ضيف الحوار

إدريس التركاوي
حاصل على دكتوراه أصول الفقه والشريعة من جامعة ابن زهر بالمغرب، وله عدد من المؤلفات والمشاركات العلمية.
مواضيع ذات صلة
((المعلومات والآراء المقدَّمة هي للكتّاب، ولا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع أو أسرة مركز تفسير))