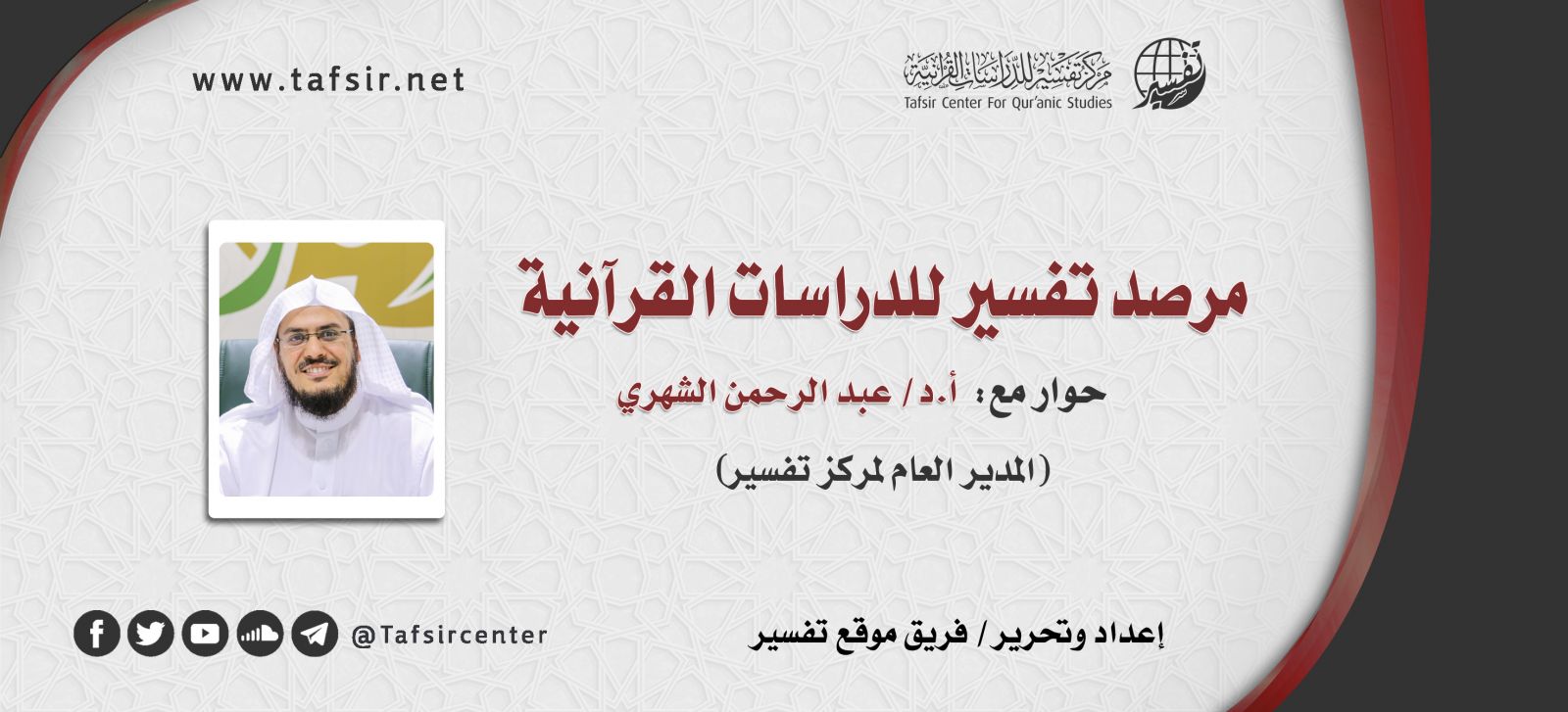تفسير السلف؛ مفهومه وأهميته وبعض القضايا المتعلقة به (1-2)
تفسير السلف؛ مفهومه وأهميته وبعض القضايا المتعلقة به (1-2)
إعداد: فريق موقع تفسير

مقدمة:
يمثّل تفسير السلف ثروة تفسيرية شديدة النفاسة، كما أنه يحظى بتمايز ظاهر في مدونة التفسير، وقد اهتم العديد من العلماء عبر التاريخ بهذا التفسير والعناية به بصور مختلفة، حيث قاموا بجمع مروياته وتصنيفها والموازنة بينها، وغير ذلك.
ومن المعلوم أن تفسير السلف يحتفُّ به عدد من القضايا المتنوعة؛ من مثل طبيعة مفهوم التفسير الذي برز في تفسير السلف، وكذلك بعض المصادر التفسيرية التي حواها كالإسرائيليات والتي لاقت نقدًا شديدًا من قِبَل بعض العلماء قديمًا وحديثًا، وكذلك مسألة أسانيد هذا التفسير وإشكالية التعامل مع ضعيفها، وغير ذلك من القضايا الكثيرة المتعلقة بهذا التفسير.
وفي هذا الحوار مع الدكتور/ عبد الرحمن المشدّ، نتوجه بجملة تساؤلات وقضايا مثارة حول تفسير السلف؛ وذلك بغية تسليط الضوء على هذه القضايا، وبيان الموقف في التعامل معها، لا سيما وأن ضيف الحوار قد عُرِف باشتغاله بتفسير السلف، لا سيما تفسير الصحابة، وصدرت له دراسة موسَّعة في هذا الصدد بعنوان: «المفسرون من الصحابة؛ جمعًا ودراسة وصفيَّة».
وقد جاء حوارنا مع د/ المشدّ موزعًا على خمسة محاور؛ المحور الأول: تفسير السلف؛ المفهوم وأبرز أسباب الأهمية. والمحور الثاني: مسائل جدليَّة حول تفسير السلف. والمحور الثالث: تفسير السلف وبناء أصول التفسير. والمحور الرابع: تفسير الصحابة. والمحور الخامس: تفسير السلف، وأهم الآفاق البحثية.
وهذا الجزء الأول من الحوار يدور حول المحورين: الأول والثاني.
نص الحوار
المحور الأول: تفسير السلف؛ المفهوم وأبرز أسباب الأهمية:
س1: يعاني مفهوم التفسير من اتساعٍ وعدم وحدة بين المفسِّرين؛ حيث تتباين المادة التفسيرية في تصانيف التفسير بشكلٍ ظاهرٍ جدًّا، فهل هناك مفهوم غالب لتفسير السّلَف يمكن الوقوف عليه؟ وما هو مفهوم (السّلَف) حين نتحدث عن تفسير السلف؟
د/ عبد الرحمن المشدّ:
لا شك أنّ تحرير المصطلحات وضبط المفاهيم من القضايا التي ينبغي الاهتمام بها في العلوم، وهي من أعسر وأعقد وأشقِّ القضايا، وبخاصّة في حقل الدراسات القرآنية، والذي لا تكاد تُبْصِر فيه اهتمامًا ظاهرًا بهذه القضية، على الرغم من النّقلة النوعية التي حظيت بها الدراسات القرآنية في العقود الأخيرة من حيث الاهتمام وكثرة التأليف، ولا شك أن عدم ضبط هذه القضية ينتج عنه كثرة أكبر من التصورات الخاطئة والنتائج المغلوطة، ويجعل العديد من هذه المؤلفات في مَهَبِّ الريح!
وقد اجتهد علماء التفسير وعلوم القرآن منذ القِدَم وعلى مَرّ العصور في تحديد مفهوم علم التفسير، ولكن بالنظر إلى صنيعهم يمكننا ملاحظة ثلاثة أمور:
الأول: التبايُن بين المفاهيم التي وضعوها لعلم التفسير من حيث التنظير.
الثاني: التبايُن في تطبيقاتهم للمفاهيم التي وضعوها لعلم التفسير.
الثالث: نقد المفسِّرين لبعضهم كثيرًا في تطبيق مفهوم التفسير.
وينتج عن هذه الأمور الثلاثة نتيجة لازمة؛ وهي أن علماء التفسير ليسوا متفقين في تحديد مفهوم التفسير، لا من حيث التنظير، ولا من حيث التطبيق، بل إن كثيرًا منهم يخالف بين تنظيراته وبين تطبيقاته، وينتقد غيره فيما وقع هو فيه أيضًا.
ولذلك فليس من سديد النظر أن يعمد الباحث إلى الاجتهاد في وضع مفهومٍ لهذا العلم ثم يجعله معيارًا يحاكم به المفسِّرين، بل إنّ النظر الصحيح يقتضي أن يكون تحديد مفهوم التفسير من خلال واقع التطبيقات العملية للمفسِّر في تفسيره.
ولا شك أن هذه الطريقة تحتاج وقتًا طويلًا وجهدًا كبيرًا، إلّا أن العمل بغيرها والاكتفاء بالتنظير والبُعد عن الساحة التطبيقية في كتب التفسير سيوصل إلى نتائج غير حقيقية لا تعبِّر عن الواقع.
وبالنظر إلى واقع تفسير السلف يتبيَّن أنه قد اشتمل على معلومات كثيرة ومتنوعة في كلّ ما له صلة بالقرآن، ولكن بتأمل هذه المعلومات والتدقيق فيها يتّضح أن الغالب عليها هو ما يتعلّق ببيان المعنى، دون ما كان خارجًا عن ذلك من نحو استنباط الأحكام، وذِكر الفوائد واللطائف، وغير ذلك.
ويظهر ذلك جليًّا بالأرقام والإحصاءات في تفسير الصحابة -رضي الله عنهم-، وكنت قد صنَّفت مروياتهم التفسيرية حسب مصادرهم في كتابي: (المفسرون من الصحابة -رضي الله عنهم-)، وقد بلَغَت مروياتهم التفسيرية قرابة عشرة آلاف أثر.
وقد تبيَّن عند تصنيف تفسير الصحابة -رضي الله عنهم- بناءً على مصادرهم أنهم نحوا في أغلبه إلى بيان المعاني، وكانت نسبة اعتمادهم في ذلك على اللغة تقدّر بنسبة (15,5%)، وبأسباب وأحوال النزول بنسبة (13%)، وبأخبار بني إسرائيل بنسبة (10%)، وبالقرآن بنسبة (3%)، وبالسُّنة بنسبة (1,3%)، وبتاريخ العرب بنسبة (0,6%)، وأمّا الآثار المتبقية والتي نسبتها (56%) فقد جاءت في التفسير بالرأي -على ما اصطلحته في البحث-، وأكثرها أيضًا مما يخصّ بيان المعنى، وقليل منها ما يخصّ غير ذلك، من نحو: الاستشهاد، واستنباط الأحكام، والفوائد، والمواعظ، واللطائف، وغيرها مما ليس فيه بيان للمعنى.
ومما يُنتبه له أن السلف كانوا يعبّرون عن التفسير بتعبيرات عديدة؛ كالتأويل، والفقه، والمعرفة، والبيان، وغير ذلك.
وأمّا عن مفهوم السّلَف، فإنه في اللغة يعني التقدُّم والسَّبق، ولذلك جاء في بعض الآثار الواردة عن بعض التابعين إطلاقهم للفظ (السلف) على الصحابة -رضي الله عنهم-، فكل مَن تقدَّمك يُعتبر لك سلفًا.
وأمّا مفهوم السلف عندما نتحدّث عن تفسير السلف فالمراد به على المشهور من أقوال العلماء أنهم ثلاث طبقات: طبقة الصحابة -رضي الله عنهم-، وطبقة التابعين، وطبقة أتباع التابعين. وهم الطبقات الخيِّرة من أجيال هذه الأمة المباركة، كما ورد في حديث النبي -صلى الله عليه وسلم-: «خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم».
والغالب من عملِ المفسرين إطلاق هذا المفهوم على هذه الطبقات الثلاث، ويطلق بعض المفسرين أحيانًا لفظ (السلف) على الصحابة -رضي الله عنهم-، ولفظ (الخَلَف) على التابعين، ولكن العمل في غالبه على إطلاق لفظ السلف على الطبقات الثلاث المعروفة، وقد ينزلون إلى الطبقة التي تليهم لكنه قليل ونادرٌ جدًّا.
س2: من المتعارف عليه لدى الدارسين إخراج طوائف اللغويين ممّن كتبوا في معاني القرآن من أمثال الفرّاء والزجّاج من مفهوم مصطلح تفسير السلف، فما هي أبرز أسباب ذلك؟
د/ عبد الرحمن المشدّ:
إذا نظرنا إلى المعيار الزمني فسنجد جماعة من اللغويين قد عاصروا جماعة من أتباع التابعين، فمثلًا قطرب (ت: 206هـ) النحوي، عاصر مقاتل بن سليمان (ت: 150هـ) وسعيد بن أبي عروبة (ت: 156هـ) وسفيان الثوري (ت: 161هـ)، وثلاثتهم من أتباع التابعين، فبالمعيار الزمني سنعتبره هو وأمثاله من اللغويين ضمن طبقة السلف.
وأمّا إذا نظرنا إلى الواقع العملي لكتُب التفسير فإننا نجد تفريقًا عند المفسرين بين طبقات السلف الثلاث وهؤلاء اللغويين؛ فالطبري مثلًا يذكر كثيرًا أقوال السلف -وهم مَن يسميهم بأهل التأويل- في مقابل أقوال اللغويين، مما يعني أن هناك فرقًا بينهما.
ويظهر هذا التفريق أيضًا عند المفسِّرين الذين قصدوا إلى جمع أقوال السلف، فتجدهم يقتصرون على نقل ما ورد عن طبقات السلف الثلاث دون مَن بعدهم من اللغويين؛ كالسيوطي في (الدر المنثور) والذي قصد إلى جمع التفسير المأثور عن النبي -صلى الله عليه وسلم- وطبقات السلف الثلاث، ولم يُدرِج أقوال اللغويين.
وأبرز أسباب التفريق بين طبقة السلف وأقوال اللغويين وعدم إدراجهم في مصطلح السلف في التفسير هو غلَبة الجانب اللغوي في تفسير هذه الطبقة من اللغويين، بخلاف طريقة السلف الذين غلب على تفسيرهم جوانب أخرى، ولم يقصدوا إلى البيان اللغوي للألفاظ بشكلٍ خاصّ كما فعل اللغويون، وإنما كان الغالب عليهم التفسير على المعنى واعتماد مصادر أخرى غير اللغة في بيانهم؛ كاعتمادهم البيان بالقرآن، والسُّنة، والأخبار، وأسباب النزول.
وهذه المصادر التي اعتمدها السلف، وإن كان اللغويون يعتمدونها أيضًا إلّا أنه غلب عليهم اعتماد مصدر اللغة بشكلٍ أكبر، وقلّت عندهم الجوانب الأخرى التي اعتنى بها السلف.
وإذا نظرنا مثلًا إلى طبقة الصحابة -رضي الله عنهم- فإننا نجد الآثار التي بيَّنوا فيها المدلول اللغوي للألفاظ تعتبر نسبتها (15%) فقط من مجموع الآثار الواردة عنهم، وأمّا اللغويون فجُلّ بيانهم هو الجانب اللغوي للآيات.
وبسبب غلَبة هذا الجانب اللغوي على طبقة اللغويين أنكر عليهم بعض معاصريهم من العلماء هذه الطريقة التي اعتبروها تخالف طريقة السلف في التفسير، والأخبار في الدلالة على هذا كثيرة، منها ما حُكي عن الأصمعي (ت: 216هـ) أنه عاب على أبي عبيدة (ت: 209هـ) لتأليفه كتاب (مجاز القرآن)، وقال عنه: يفسر كتاب الله برأيه! فسأل أبو عبيدة عن مجلس الأصمعي أي يوم هو؟ فركب حماره في ذلك اليوم ومرّ بحلقة الأصمعي، فنزل عن حماره وسلّم عليه وجلس عنده وحادثه، ثم قال له: يا أبا سعيد ما تقول في الخبز، أيّ شيء هو؟ قال: هو الذي نأكله ونخبزه. فقال له أبو عبيدة: فسّرتَ كتاب الله برأيك؛ فإن الله قال: {أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا}[يوسف: 36]، فقال الأصمعي: هذا شيء بَانَ لي فقُلْتُه، لم أفسّره برأيي. فقال أبو عبيدة: والذي تعيب علينا كلّه شيء بَانَ لنا فقلناه ولم نفسّره برأينا، ثم قام فركب حماره وانصرف!
س3: كان لجيل السلف اعتناء ظاهر بالتفسير، فما هي أبرز ملامح هذا التفسير من خلال بحثكم، لا سيما التي قد يتمايز بها عمّا جاء بعده؟
د/ عبد الرحمن المشدّ:
«لله دَرُّ السلف، ما كان أوقفهم على المعاني اللطيفة التي يدأبُ المتأخرون فيها زمانًا طويلًا ويُفنون فيها أعمارهم، ثم غايتهم أن يحوموا حول الحِمَى»[1]، وقد تميَّز تفسير السلف بأمور كثيرة، بل إنّ تفسير كلّ واحد منهم له سماتٌ خاصّة به، فأحيانًا يغلب الجانب الوعظي على أحدهم، وأحيانًا يغلب الجانب الفقهي، وأحيانًا يغلب تنزيل الآيات على الواقع ومعالجتها له، وغير ذلك من ميزات بحاجة إلى رصد وتتبُّع وتحليل.
ولكن لو نظرنا نظرة كلية إلى أبرز الملامح التي اشتركوا فيها عمومًا وتميزوا بها عمَّن بعدهم، فيمكن تلخيص ذلك في النقاط الآتية:
1. جزالة اللفظ مع اتِّساع المعنى.
2. العناية بالمعنى الإجمالي دون الخوض في التفاصيل.
3. العناية بالمعنى السياقي للآية.
4. قِلَّة العناية بالمعنى اللغوي للآية.
5. سهولة الصياغة وقِلَّة استخدام الألفاظ الغريبة.
6. العناية بملابسات الآية والأحداث التي احتفَّت بها عند نزولها.
7. استخدام أساليب عديدة لتقريب المعنى؛ نحو أسلوب السؤال، والتكرار، والخطاب، والقَسَم، والأمر، والتقسيم، والتوكيد، والتمثيل بالأشياء المحسوسة، وغير ذلك من الأساليب التي يمكن تتبعها ودراستها.
س4: ما هي أبرز أسباب أهمية هذا الإرث التفسيري لجيل السلف من وجهة نظركم؟
د/ عبد الرحمن المشدّ:
تكمن أهمية الإرث التفسيري لجيل السلف في جانبين رئيسين؛ الجانب الأول يتعلق بالحقبة الزمنية التي عاشوا فيها، والجانب الثاني يتعلق بأشخاصهم.
أمّا الجانب المتعلّق بالحقبة الزمنية، فقد خُصّوا بخصائص فريدة لم يشاركهم فيها غيرهم، وإنما مَثلهم ومَثل مَن جاء بعدهم كما قال الشاعر:
نزلوا بمكة في قبائل نَوفَل * ونزلتُ بالبَيداء أَبْعَدَ مَنْزِلِ
وتتمثَّل هذه الخصائص عند طبقة الصحابة -رضي الله عنهم- في أمور، منها: وجودهم في عهد النبوّة وزمن نزول الوحي، وشهودهم تنزُّلات القرآن على النبي -صلى الله عليه وسلم- ومعايشتهم للأحداث التي نزل فيها، ومعرفتهم بأحوال مَن نزل فيهم القرآن.
وتتمثَّل هذه الميزات أيضًا عند طبقة التابعين في قُرْبِهم من زمن الوحي، وأخذِهم للتفسير عن الصحابة -رضي الله عنهم-، ونقلِهم لهذه الأحوال عن الصحابة -رضي الله عنهم-؛ وكذا عند طبقة أتباع التابعين في نقلها عن التابعين.
وأمّا الجانب المتعلّق بأشخاص السلف عمومًا فيتمثَّل في أمور، منها: سلامة صدورهم، وحسن قصدهم وفهمهم، ومعرفتهم باللغة التي نزل بها القرآن، وعدم وجود التعصبات المذهبيَّة واتِّباع الهوى عندهم، وقِلَّة الخلافات الحقيقية بينهم لصدورهم جميعًا في التفسير والبيان من منبع واحد؛ فمصادرهم واحدة، وقصدهم واحد.
المحور الثاني: مسائل جدلية حول تفسير السلف:
س5: بالرغم من الأهمية التي يُوليها الدارسون للتفسير لمقولات السلف في التفسير إلّا أنّ حضور المرويات الإسرائيلية في هذا التفسير يمثّل أحد جوانب النقد التي يصوِّبونها إليه، لا سيما تفاسير التابعين وأتباعهم، فما رأيكم حول هذه النقطة؟ وهل تمثّل فعليًّا ثغرة في هذا التفسير؟
د/ عبد الرحمن المشدّ:
إنّ المُطالِع والمُتابِع للدرس التفسيري وتطور مجالات البحث فيه خلال العقود الأخيرة يلحظ أن ثمة قضايا خطيرة برزت وأُثيرت وَفق تصورات مغلوطة في فهم التراث أحيانًا، وأحيانًا أخرى وَفق تطبيقات حماسية لنصوص التراث، والعجيب أن النتائج التي تؤول إليها هذه القضايا تتناقض في نتائجها ومآلاتها تناقضًا تامًّا.
ولبروز بعض هذه القضايا دوافع حماسيَّة، ولبعضها دوافع وأسباب أخرى جرَّاء الواقع السياسي والاجتماعي الذي تعيشه الأمة الإسلامية منذ عقود.
وقد أخذت قضية الإسرائيليات مكانًا كبيرًا في العقود الأخيرة، وأُلِّفت فيها العديد من الكتب، ونوقشت فيها الكثير من الرسائل الأكاديمية التي هدفت إلى تنقية كتب التفسير والروايات من الأخبار الإسرائيلية، واعتبرت وجودها عيبًا في الراوي أو المفسِّر الذي يوردها.
بل بلغ الأمر أنْ نَصَبَ بعض الأكاديميين ولاءه وبراءه بناءً على هذه القضية، ولا أزال أتذكّر أحدَ المناقشين عندما قال للباحث: «إنّ رسالتك هذه تُعَدُّ طبَقًا ذهبيًّا للمستشرقين؛ لما تضمَّنته من أخبار إسرائيلية»، وذلك بسبب أن رسالته كانت في جمع تفسير بعض السلف، فكانت بطبيعة الحال متضمِّنة لأخبار إسرائيلية وردت عنهم، بل واشترط المناقِش على الباحث أن يحذف الأخبار الإسرائيلية من الرسالة حتى تُقْبَل ويحصل على الدرجة العلمية، وفَعل الباحث ما طُلب منه مضطرًّا.
وإننا لنحسن الظنّ بأمثال هؤلاء، ونعلم أنّ دافعهم في ذلك -غالبًا- هو الغَيرة على الدِّين، بَيْدَ أن المسائل العلمية لا تُعالَج بالغَيرة وحدها، ولا بالحماس وحده، بل تُعالج بالعلم والحُجة، وكم ضيّع الحماس غير المنضبط بالعلم من أُمَمٍ ومن أجيال!
وهذه القضية وردت فيها نصوص نبوية واضحة تفيد الإذن في رواية هذه الأخبار الإسرائيلية وفق ضوابط محدَّدة في قبولها، وحكى الصحابة -رضي الله عنهم- هذه الأخبار بناءً على هذا الإذن النبوي، وحكاها عنهم التابعون وأتباعهم، ثم ضمَّن أئمة التفسير هذه الأخبار في تفاسيرهم ضمن أُطُر محدَّدة وأهداف مقصودة.
ومن المعلوم أن الحكمَ على الشيء فرعٌ عن تصوره، وأن النقد يكون بنَّاءً إذا كان قائمًا على أصول علمية منضبطة؛ أوّلها فهم المسألة واستيعابها جيدًا بالتأنِّي في تأمُّلها، وفكِّ ألفاظها، والوقوف على مراميها، دون عَجَلة أو تعصُّب.
فعندما نجد مثلًا حَبْر الأمة عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- وهو الذي دعا له النبي -صلى الله عليه وسلم- بالفقه في الدّين وتعلُّم التأويل، وشهد له كبار الصحابة -رضي الله عنهم- بالعلم والفقه، عندما أجده يحكي سِتَّ مائةٍ وثلاثةً وستين (663) خبرًا إسرائيليًّا، أي ما يمثِّل قُرابة (10%) من مجموع رواياته التفسيرية، وعندما نجد عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه-، والمشهور عنه شِدّته على طلّابه وتربيتهم، وحرصه الشديد على حماية جناب الدِّين؛ كموقفه الصّعب في البداية مثلًا من جمع المصحف بقيادة زيد بن ثابت -رضي الله عنه-، وقد شهد له النبي -صلى الله عليه وسلم- بالعلم، وأمَر صحابته بأخذ القرآن عنه، فعندما أجده يحكي اثنين وتسعين (92) خبرًا إسرائيليًّا، أي ما يمثِّل قُرابة (8%) من مجموع رواياته التفسيرية، وعندما أقف على مثل هذا من هؤلاء الكبار الذين لا نشك في غيرتهم على الشريعة وحفظِ جنابها أكثر من كلّ أحد، والذين لا نشك في فهمهم وأمانتهم، ثم نجد أيضًا أئمة التابعين يروون عنهم هذه الأخبار، ثم تابعيهم من أتباع التابعين يروونها عن التابعين، ثم يأتي أئمة التفسير المحققون الأفذاذ بعدهم ويتلقَّفون هذه الأخبار ويوظِّفونها في تفاسيرهم؛ كالطبري (ت: 310هـ)، وابن أبي حاتم (ت: 327هـ)، وابن عطية (ت: 547هـ)، وأبي حيان (ت: 745هـ)، وابن كثير (ت: 774هـ)، وغيرهم من الأئمة المحققين.
فعندئذٍ ليس من العقل أن تُسَفَّه وتُجَهَّل الأُمةُ بأسرها، وليس من الإنصاف أن يُهْدَم كلام هذه الأجيال كاملة من لدن السلف الصالح ومرورًا بأئمة أربعة عشر قرنًا مضت من تاريخ الأمة الإسلامية المباركة؛ بسبب قراءة سطحية، أو فكرة تنقدح في الذهن، أو اعتقادٍ مسبَقٍ أيًّا كانت أسبابه ودوافعه، أو حماسٍ وغَيرة غير مقيَّدة بالعلم، بل الواجب على المنصِف والحال هذه أن يتبصَّر أولًا صنيع أئمة السلف، وكيفية تعامل العلماء المحرِّرين مع كلام السلف، ويُجهِدَ ذهنه في فهمه، ويطيل النظر في تأمُّله وسَبْر أغواره، ليقف على قصدهم من إيراد هذه الأخبار، وأسباب ذلك، وكيفية توظيفهم لها، لا أن يبادر بالنّكير والنقد دون تصوّر سليم للموضوع أصلًا.
والذي يظهر باختصار في هذه القضية من خلال بحثي في تفسير السلف ومعايشتي له فترة طويلة، ومن خلال تتبع صنيع المفسرين وتعاملهم تجاه هذه الأخبار الإسرائيلية =أنّ السلف والأئمة حكوا هذه الأخبار وفق ضابطين:
الأول: أن السلف حكوا هذه الأخبار مستندين إلى الإذن النبوي في ذلك، وملتزمين بضوابطه في جواز التحديث عن بني إسرائيل فيما لا يعارض الشريعة، وفي التوقف عن تصديقهم أو تكذيبهم فيما ليس عندنا فيه خبر يثبته أو ينفيه، ومن خلال تتبعي لمرويات الصحابة -رضي الله عنهم- خاصّة لم أقف على روايتهم لأخبار إسرائيلية تناقض ما ورد في شريعتنا.
الثاني: أن المفسرين عند حكايتهم لهذه الأخبار لم يقصدوا ذكرها بكلّ تفاصيلها الدقيقة عند إيرادهم لها، بل المراد من ذكرها هو مجمل الخبر؛ لبيان قضية معيَّنة في الآيات، كما يُستدل بالبيت الشعري أو الأبيات من القصيدة والتي قد تكون فيها معانٍ مستقبحةٌ، ولكن يُستدل بها على بيان لفظة معيَّنة أو تجلية أسلوب معيَّن، فهكذا الأمر تمامًا في الأخبار الإسرائيلية، ولا يلزم من روايتها قبول كلّ ما فيها من تفاصيل الخبر، بل المراد مجمل الخبر لبيان قضية معينة، وأحيانًا لا يمكن بيان الآية دون الاعتماد على الخبر الإسرائيلي لكشف معناها، وأمثلة ذلك كثيرة كما في قصة السامري، وفتنة سليمان -عليه السلام-.
ومن الطريف في قضية تفاصيل الأخبار الإسرائيلية أن أحد المناقشين لباحث في الماجستير ظلَّ يحقِّق مع الباحث الذي يناقشه في رسالته، وكانت في جمع مرويات تفسيرية للسلف، فظلَّ المناقِش يقرأ عليه كلّ صغيرة وكبيرة في الأخبار التي أوردها، ويسأله هل كذا صحيح؟ هل كذا صحيح؟ وكان منها أن سليمان -عليه السلام- كان يقضي بين الناس وبين البهائم، فسأله المناقِش: كيف كان سليمان يقضي بين البهائم؟! وهل يعقل أن يجلس خصيصًا للبهائم ليقضي بينها؟ وهل هذا يليق بنبي الله...إلخ، وبعيدًا عن أنه ليس من الصواب أن نقف عند كلّ كلمة في الخبر، فلا أدري أين وجه الغرابة في هذا وقد علَّم اللهُ سليمانَ أغرب من هذا؛ فقد علَّمه منطق الطير، وأسمعه حديث نملة مع أخواتها، فتبسم ضاحكًا من قولها!
ولا يزال هذا الموضوع بحاجة إلى تتبُّع دقيق، واستقراء حقيقي لآثار السلف وكتب التفسير، ودراستها وتحليلها للوقوف على آلية وكيفية توظيفهم لهذه الأخبار، وهذا العمل ليس بسهل، بل يحتاج إلى تضافر جهود المؤسسات العلمية والمراكز البحثية إلى بحثِ مثل هذه القضايا وحلّ هذه الإشكالات بشكلٍ علمي صحيح بعيدٍ عن التعصب، أو النظرة السطحية في معالجة الإشكال، ويستفاد في هذا من ملف الإسرائيليات المنشور على موقع مركز تفسير، والذي احتوى على نظرات مهمّة في معالجة الموضوع.
وأخيرًا، فمن القضايا المهمّة التي برزت في العقود الأخيرة أيضًا، ولا تزال بحاجة إلى تتبع تاريخي، وتقويم علمي رصين: قضية أسانيد التفسير، والإعجاز العلمي في القرآن، وقضايا التدبر وما يتعلق به، نسأل الله أن يعيننا ويوفقنا للمساهمة في شيء نافع في ذلك.
س6: من الأسباب -كذلك- التي تُضعِف هذا التفسير وتقلّل من قيمته لدى كثير من الباحثين هو إشكال ضعف الإسناد، ففي ضوء اشتغالكم بتفسير السلف كيف ترون هذه المسألة؟
د/ عبد الرحمن المشدّ:
لا أزال أؤكد على أننا لم نَنشأ فجأة في القرن الرابع عشر وما بعده وحدنا، بل نحن أمّة لها تراث علمي عريق، لو أفنى الواحد منا عمره كاملًا حتى يحيط بعلمٍ واحدٍ إحاطةً كاملة، ويفهم كُتُبَه كما أراد مؤلِّفوها، ويقف على دقائقها؛ لَمَا كفاه، فلا بد أن نحترم هذا التراث، وليس في ذلك أقلّ من أن نفهمه كما أراده أصحابه، أو نحاول فنُعذر.
وقد سبقَنا أئمة عظام وأعلام كبار لهم شأوهم ومنزلتهم في شتى العلوم، وكما قال أبو عمرو بن العلاء -رحمه الله-: «ما نحن فيمن مضى إلّا كبقلٍ في أصول نخلٍ طوال»، ومن دعا إلى التحرير والتجديد قبل أن يفهم التراث فهمًا جيدًا فقد سَفِه نفسه، وتمنَّى على الله الأماني.
ففي مثل هذه القضايا لا بد أن نرجع إلى أئمة الفنّ المعني بالمسألة، ونتأمَّل كلامهم وتطبيقاتهم للموضوع في مؤلفاتهم حتى نفهم تنظيراتهم فهمًا سليمًا، وهذا ليس أمرًا هيِّنًا ولا سهلًا، بل فيه من الصعوبة ما فيه، ويحتاج إلى الصبر الطويل، واستدامة النظر، وتدقيق وتقليب العبارات، وتتبع واستقراء واستنطاق للنصوص.
ولا شك أن الإسناد وما يتبعه من مسائل إنما هي قضايا تختصّ بعلم الحديث وتؤخذ منه، فلا بد إذن أن نرجع إلى هذا الفنّ وننظر نظرًا صحيحًا في كيفية تناول علمائه للمسألة.
وهذا الموضوع لم تكن فيه إشكالية لدى جمهور العلماء السابقين، وبعضهم كانوا أئمة في الحديث والتفسير معًا؛ كالطبري (ت: 310هـ)، وابن أبي حاتم (ت: 327هـ)، واللذَين على تفسيرهما المعوَّل بقدرٍ ليس لغيرهم في علم التفسير.
فالإشكال إنما جاء من بعض المتأخرين الذين صوَّروا الموضوع على أن فيه منهجين؛ منهجًا متشددًا، ومنهجًا متساهلًا في الحكم على الأسانيد. أو أن هناك منهجًا للمحدِّثين في التعامل مع أسانيد التفسير، ومنهجًا لغير المحدّثين، وهذا تصور مخالف للواقع مخالفة كاملة، وإنما وقع الإشكال عند المتأخرين بسبب عدم مراعاتهم وتصورهم لمنهج المحدّثين بصورته الكاملة.
وقد أسَّس علماء الحديث منهجًا متكاملًا ودقيقًا فيه من المرونة ما يخوِّله للتعامل مع كافة الأخبار على اختلاف أنواعها؛ فاعتبارهم لقبول الخبر أو رفضه ليس مقصورًا على النظر الظاهري للإسناد فحسب كما يصوّره بعض المعاصرين، بل إن علماء الحديث في تعاملهم مع الخبر -أيًّا كان نوعه- يراعون جوانب أخرى أيضًا؛ كالمعنى، وغرض المصنِّف، والقرائن الخاصة بالخبر. ولكلّ جانب من هذه الجوانب تفصيلات دقيقة لا بد من مراعاتها جميعًا، وهي أمور لا تنفك عن بعضها، وبمقدار النقص في النظر لتلك الجوانب كلّها يكون المنهج النقدي غير صحيح ونتائجه غير سليمة.
وقد نَتَجَ عن هذا الاتجاه المعاصر خروج مؤلَّفات حُذف منها الكثير من مرويات التفسير بحجة ضعفها، وظهرت مؤلفات تُعنى بجمع ما صحَّ من المرويات -وفق تصورهم-، وهذه جناية كبيرة في حقّ التراث، ومسخٌ شنيعٌ لعلم التفسير، وتضييع له.
هذه ملامح المنهج العامّ باختصار لطريقة العلماء في التعامل مع هذه القضية، ولا تزال هذه القضية المهمّة بحاجة إلى مزيد من البحث والتدقيق والدراسة بالاستقراء والتتبع لجميع كتب التفسير، كلّ على حِدة، لجمع تنظيراتهم، وتحليل تطبيقاتهم، والوقوف على منهجهم بدقّة في تعاملهم مع الآثار من هذه الحيثية، ومعرفة مجالات توظيفهم لها، وغير ذلك من دقائق لا تظهر إلّا بطول الصبر والتأمل، وعمق التحليل، ودِقَّة النظر.
وجدير بالذِّكر أن هذا المنهج المغلوط لبعض المعاصرين في تصوير هذه القضية لم تَطَلْ عواقبه علم التفسير فحسب، بل تعدَّى في ذلك إلى بقية العلوم التي مبناها على الأخبار؛ كالسيرة، فخرج ما يسمى بـ: (صحيح السيرة)، وحتى الأحاديث المرفوعة وقع في الحكم عليها والتعامل معها خللٌ كبيرٌ جرَّاء هذا المنهج، ولربما في قادم الأيام يتسرّب هذا المنهج فيَطال الشعرَ وكتُبَ الأدب منه نصيبٌ، فهذا المنهج يذكِّرني بقصة تُذكر عن أحد العرب يسمى: (عِجل بن لجيم)، كان له فرس جواد، فقيل له: إنّ لكلّ فرس جواد اسمًا، فما اسم فرسك؟ فقال: لم أسمِّه بعدُ، فقيل له: فسمِّه، ففَقَأَ إحدى عينيه، وقال: قد سميته الأعور!! أرادوا حماية العلم فأضاعوه!
س7: كذلك من الإشكالات المثارة حول تفسير السلف مسألة تضعيف العديد من أهل الحديث لكثيرٍ من رجاله لا سيما مَنْ هم في طبقة التابعين وأتباعهم، كيف ترون هذا الإشكال وكيفية التعامل معه؟
د/ عبد الرحمن المشدّ:
هذا الكلام صحيح في ذاته عند مَن يقولونه، ولكنه يشبه مَن وقف على قوله تعالى: {فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ}[الماعون: 4]، ولم يُكمل ما بعدها، فكما أشرتُ في الفقرة السابقة من أن هناك عدّة جوانب يُعنى علماء الحديث بالنظر إليها جميعًا عند نظرهم للخبر لتحديد قبوله أو رفضه، ومن هذه الجوانب نظرهم في الإسناد، ونظرهم في الإسناد يتضمن أمورًا عديدة، منها معرفة الرواة قوةً وضعفًا، وغير ذلك.
ولكن تضعيف أهل الحديث لراوٍ معيَّن إنما يعنون به ضعفه في رواية الحديث، فلا يلزم ضعفه في بقية العلوم، فقد يكون غير موثَّق في رواية الحديث لكنه إمامٌ في غيره؛ كالتفسير أو القراءات أو اللغة أو غير ذلك، وأمثلة هذا كثيرة، فمِن ذلك الإمامُ عاصم بن أبي النجود (ت: 127هـ) صاحب القراءة المشهورة إلى اليوم، كان متقِنًا للقراءة، ثبتًا فيها، ولكن كان واهيًا في الحديث، وكذلك تلميذُه وربيبُه حفص بن سليمان (ت: 180هـ) أشهر مَن أخَذ الرواية عنه كان ضعيفًا كذلك في الحديث، لكنه إمام في القراءة، بخلاف الإمام الأعمش سليمان بن مهران (ت: 148هـ) مثلًا؛ فقد كان متقنًا في رواية الحديث ثبتًا فيها، ولكن كان ليِّنًا في القراءة، وقراءته تعتبر ضمن الشواذ عند القرّاء، وهكذا في كلّ وقت، يكون العالم إمامًا في فنٍّ، ومقصِّرًا في غيره، وهذا أمر فطريٌّ مُشاهَد في دنيا الناس في كلّ وقت؛ فإنك تجد الرجل بارعًا في الطِّب، ولا يفقه شيئًا في الهندسة، فلا ترفض أخذ الطِّب منه لضعفه في الهندسة، بل تقتصر على أخذ ما يتقنه فحسب، وغير ذلك مما لا يحتاج إلى تدليل.
وعلماء الحديث تنبهوا إلى هذا الملحظ، وتنظيراتهم في ذلك واضحة، وكذلك تطبيقاتهم أصدق ما يدلّ على تمييزهم لتخصص العالِم، ومعرفتهم في أيّ فنٍّ هو ثقة، وفي أيّ فنّ يكون ضعيفًا فلا يؤخذ منه.
س8: تمثِّل مسألة حُجِّية تفسير السلف قضية خلاف واسعة أُثِير حولها جدل بين العلماء منذ قديم، وبالتالي بين المعاصرين، خاصّة فيما يتعلّق بالموقف من إحداث قولٍ جديد مخالِف مخالَفة تضاد لمقولات السلف، فما هو الموقف الذي ترونه من هذه القضية؟
د/ عبد الرحمن المشدّ:
هذه المسألة في الحقيقة مهمّة جدًّا، ومن المعلوم أن الاحتجاج بفهم السلف مسألة قديمة، تشكّلت منذ عصر الصحابة -رضي الله عنهم- وتناقلها العلماء والأئمة عبر القرون، وقد أشرتُ فيما سبق إلى فضل السلف وميزاتهم التي كانت السبب في تفضيلهم على غيرهم، وعلى حجّية فهمهم.
وجاءت في ذلك آثار عديدة؛ ومن ذلك قول عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه-: «إن الله -جل وعلا- نظَر في قلوب العباد، فوجد قلب محمد -صلى الله عليه وسلم- خير قلوب العباد، فاصطفاه لنفسه، فابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد-صلى الله عليه وسلم-، فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيّه، يقاتلون على دينه، فما رأى المسلمون حسنًا؛ فهو عند الله حسنٌ، وما رأوا سيئًا؛ فهو عند الله سيِّئ»[2]، وقال عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- في مناظرته للخوارج: «أتيتكم مِن عند أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم-؛ المهاجرين والأنصار، ومِن عند ابن عمّ النبي -صلى الله عليه وسلم-، وعليهم نزل القرآنُ؛ فَهُمْ أعلَمُ بتأويله منكم»[3]، وغير ذلك من آثار عديدة يطول ذكرها، وهي موجودة في مظانّها لمَن تتبعها.
وذهب العلماء في بيان المقصود بهذه الآثار إلى أن الفهم الصحيح للكتاب والسُّنة هو الفهم الذي اتفق عليه السلف جميعًا وأجمعوا عليه، لا ما ذهب إليه أفرادهم، وأن كلّ فهمٍ يخالف ما أجمع عليه السلف فهو فهمٌ خاطئ، وحكموا على مَن خالف إجماعهم بالضلال والانحراف، فهذه قاعدة جليلة وعظيمة.
وتفسير القرآن تشمله هذه القاعدة التي ضبط العلماء بها فَهْم هذه الآثار، ولكن عند التأمل يقف الناظر على آثار أخرى تدعو للتأمل في كتاب الله -عز وجل-، وتدلّ على أن له وجوهًا أخرى يفقهها المرء حسبما حباه الله من العلم والفهم في كتابه، ومن ذلك ما قاله أبو جحيفة السوائي -رضي الله عنه- لعليّ بن أبي طالب -رضي الله عنه- يومًا: «هل عندكم شيء مما ليس في القرآن؟ -أو: ما ليس عند الناس؟- فقال له عليٌّ -رضي الله عنه-: والذي فلَق الحبة وبرأ النسمة ما عندنا إلّا ما في القرآن، إلّا فهمًا يُعطَى رجلٌ في كتابه، وما في الصحيفة. قال: وما في الصحيفة؟ قال: العقل، وفكاك الأسير، وأن لا يُقْتَل مسلم بكافر»[4]، وقال أبو الدرداء -رضي الله عنه-: «لا تفقه كلّ الفقه حتى ترى للقرآن وجوهًا كثيرة»[5]، وغير ذلك من النصوص الواردة بالحثّ على تثوير القرآن، واحتمالية استخراج وجوه أخرى منه، وهذه النصوص بحاجة إلى جمع وتدبُّر.
وبناءً على ذلك فإذا كان القول الجديد في التفسير معتبرًا ولكنه يناقض ويُبْطِل إجماع السلف واتفاقهم؛ فلا يصح القول به، أمّا إذا كان معتبرًا ولم يناقض ويبطل إجماع السلف واتفاقهم؛ فلا بأس بالقول به.
وقد أشار الطبري (ت: 310هـ) إلى هذا في مقدمة تفسيره، فقال: «فأحقُّ المفسرين بإصابة الحقّ في تأويلِ القرآن الذي إلى عِلم تَأويله للعباد السبيلُ =أوضحُهم حُجة فيما تأوَّل وفسَّر... كائنًا مَن كان ذلك المتأوِّل والمفسِّر، بعد أن لا يكون خارجًا تأويلُه وتفسيرُه ما تأوَّل وفسَّر من ذلك عن أقوال السلف من الصحابة والأئمة والخلف من التابعين وعلماء الأمة»[6].
وممارسات الطبري التطبيقية في ثنايا كتابه تؤكّد هذا الضابط الذي أشار إليه في مقدمته، فكثيرًا ما يخطِّئ القول وإن كان له وجهٌ، وينبّه على أن سبب تخطئته له مخالفته اتفاقَ السلف والنقل المستفيض عنهم، ومن ذلك قوله: «وهذا القول مع خروجه من أقوال أهل العلم، قولٌ لا وجهَ له... ولا خلاف بين أهل التأويل جميعًا أن هذه الآية نزلت على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في سبب قتل ابن الحضرمي وقاتله»[7]، ومن ذلك قوله أيضًا: «وإذْ كان ذلك كذلك، وكان لا اختلاف في ذلك بينهم ظاهر، وكان ما كان مستفيضًا فيهم ظاهرًا حجة = فالواجب -وإن احتمل ذلك معنى غير الذي قالوا- التسليمُ لما استفاض بصحته نقلهم»[8].
بل إن الطبري يخطِّئ القول المخالف لإجماع السلف حتى إن كان واردًا عن بعض أفرادهم -ومن منهجه أنه يَعْتَبِر اتفاقَ الأكثرِ إجماعًا-، وأغلب المواضع التي وقفتُ عليها عنده بهذه الصورة كانت في بيان أقوالٍ متعلقة بأحكام في الآية، ومن ذلك قوله: «فأمّا الذي ذكر عن محمد بن أبي موسى، فإنه مع خروجه من قول أهل التأويل، بعيدٌ مما يدلّ عليه ظاهر التنزيل»[9]، وقوله: «وأمّا الذي رُوي عن طاوس عن ابن عباس، فقولٌ لِمَا عليه الأمة مخالفٌ. وذلك أنه لا خلاف بين الجميع: أنْ لا ميراث لأخي ميتٍ مع والده. فكفى إجماعُهم على خلافه شاهدًا على فساده»[10]، وقوله: «وأمّا من قال: عنى بذلك: ما ذبحه المسلم فنسي ذِكر اسم الله، فقول بعيد من الصواب؛ لشذوذه وخروجه عما عليه الحجة مجمعة من تحليله، وكفى بذلك شاهدًا على فساده»[11].
ومن أمثلة المواضع التي ذكر فيها الطبري قولًا محتملًا عن أهل اللغة يخالف أفراد السلف دون إجماعهم، واعتبره الطبري سائغًا ولم يتبعه بنقد أو تخطئة، قوله: «وقد قال بعضهم: إنهم كانوا غير مؤمنين بشيء، وإنما قيل: (فقليلًا ما يؤمنون)، وهم بالجميع كافرون، كما تقول العرب: قلّما رأيت مثل هذا قط»[12].
وهذه المسألة بحاجة إلى مزيد من البحث والتنقيب، وتتبع صنيع الأئمة في كتبهم، وإنما اعتمدتُ ما ذكرته من تفسير الطبري نظرًا لما تميَّز به من عنايته بمدلولات المعاني، وجَعْلِه من تفسير السلف مادةً أساسية بنى عليها كتابه.
ولا يخفى على المطّلع أنه لكي تنضبط هذه المسألة انضباطًا تامًّا، فلا بد من المعرفة بمواطن إجماع السلف واتفاقهم في التفسير، وهو مشروع بحاجة إلى تضافر الجهود لإقامته، وكذلك جمع ودراسة ما صرَّح المفسرون باتفاقهم على معناه، ولكن مثل هذه المشاريع بحاجة إلى بناء متين، وآليات مدروسة، حتى تؤتي ثمرتها، وتخرج معبّرة عن آراء المفسّرين حقيقة وفق مرادهم واصطلاحهم، لا خيالًا في ذهن الباحث كما في العديد من البحوث والدراسات التي تناولتها.
س9: اعتاد الباحثون تقسيم المفسّرين من السلف إلى مدارس واتجاهات، وقد كان لبعض الدارسين المعاصرين في المجال تحفّظات على هذا التقسيم وأنه غير واقعي، فما هو تقييمكم لهذا التقسيم ومدى واقعيته في تفسير السلف؟
د/ عبد الرحمن المشدّ:
بدايةً، فإن هذا التقسيم بهذه الصورة تقسيمٌ معاصرٌ، ولم يوجد عند السابقين من الأئمة مَن قسَّم المفسّرين من السلف إلى مدارس واتجاهات، فلا تكاد تجد هذا لا في كتب التراجم، ولا في كتب التفسير وعلوم القرآن، وإنما يعتبرون تفسير السلف بطبقاتهم الثلاث في مكانة واحدة، وعلى نهج واحد.
والتقسيم بالمدارس والاتجاهات والمذاهب وغيرها من ألفاظ مشابهة يوحي بوجود تباين واختلاف في المنهج بين هذه المدارس، كما يقال في الفقه مثلًا: (مذهب الأحناف، ومذهب الشافعية)، ويقال في الخلاف العقدي مثلًا: (مذهب المعتزلة، ومذهب الرافضة)، وكما يقال في النحو: (مذهب البصريين، ومذهب الكوفيين) وغير ذلك، فإن هذه المذاهب يوجد بينها تباين واختلاف في المنهج والأصول، فساغ تقسيمها، أمّا تقسيم تفسير السلف إلى مدارس واتجاهات فيعتريه إشكالات عديدة:
أولها:أن منهج السلف في التفسير منهج واحد، ومصادرهم متّحدة، وليس بينهم اختلاف وتباين في المنهج يسوّغ تقسيمهم إلى مدارس واتجاهات.
ثانيها:الذين وضعوا هذه التقسيمات يقسِّمون المدارس إلى ثلاث: مدرسة مكة، ومدرسة المدينة، ومدرسة العراق. ويقسمون العراق أحيانًا إلى: مدرسة البصرة، ومدرسة الكوفة، ويلحقون أحيانًا الطائفَ بمكة، فيلاحظ أنهم بنوا تقسيماتهم بناء على الأماكن، ولعلهم تأثروا في ذلك بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية (ت: 728هـ) عن أن أعلم الناس بالتفسير أهل مكة، وأهل الكوفة، وأهل المدينة، ويتضح هذا جيدًا في تقديم الشيخ محمد حسين الذهبي (ت: 1379هـ) مثلًا لهذا المبحث في كتابه: (التفسير والمفسرون) بكلام ابن تيمية عن أعلم الناس بالتفسير، وهذا ليس دقيقًا؛ فإن ابن تيمية يتحدَّث عن الأعلم والأشهر بالتفسير، وليس في كلامه أنه يرى تباين مناهجهم، ولا تقسيمهم إلى مدارس أو مذاهب.
ثالثها: وهذه نقطة تابعة لسابقتها، وهي أن هذا التقسيم على المدارس فيه إشكال آخر؛ ذلك أن العديد من السلف تنقلوا إلى عدّة أماكن ناشرين علمهم، ففي أيّ مدرسة يصنَّف مَن أقام في أكثر من مكان كعليّ بن أبي طالب -رضي الله عنه- مثلًا فقد أقام بالكوفة وباليمن، وابن عباس -رضي الله عنه- كذلك أقام بمكة وبالطائف وبالكوفة؟! وفي كلّ مكان كان لهم طلاب يأخذون عنهم العلم.
ويؤيد تأثر هذا التقسيم المعاصر في تقسيمات هذه المدارس بكلام ابن تيمية أنهم وضعوا مدارس توافق أسماء الأماكن التي ذكرها، على الرغم من أن السلف لم يكونوا في هذه الأماكن فحسب، بل كانوا في أماكن عديدة غير المذكورة كالشام، واليمن، ومصر، وغير ذلك.
[1] الإتقان في علوم القرآن، للسيوطي (3/ 291).
[2] مسند أحمد (3600).
[3] سنن النسائي (8522).
[4] صحيح البخاري (6903).
[5] جامع معمر بن راشد (20473).
[6] جامع البيان (1/ 93).
[7] جامع البيان (4/ 301-302).
[8] جامع البيان (9/ 480).
[9] جامع البيان (9/ 262).
[10] جامع البيان (7/ 45).
[11] جامع البيان (12/ 85).
[12] جامع البيان (2/ 331).
كلمات مفتاحية
ضيف الحوار

عبد الرحمن المشدّ
حاصل على دكتوراه التفسير وعلوم القرآن من الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، وله عدد من المشاركات العلمية.
مواضيع ذات صلة
((المعلومات والآراء المقدَّمة هي للكتّاب، ولا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع أو أسرة مركز تفسير))