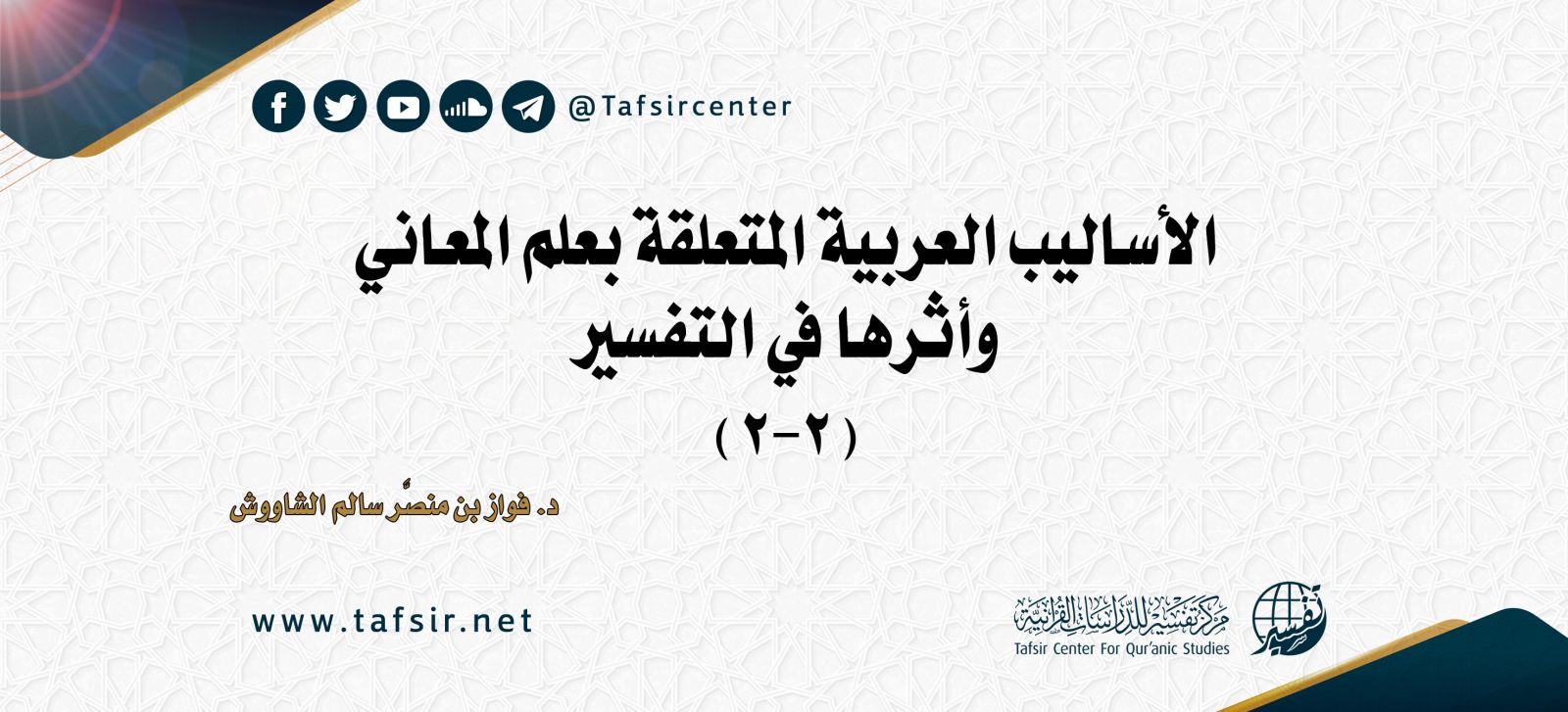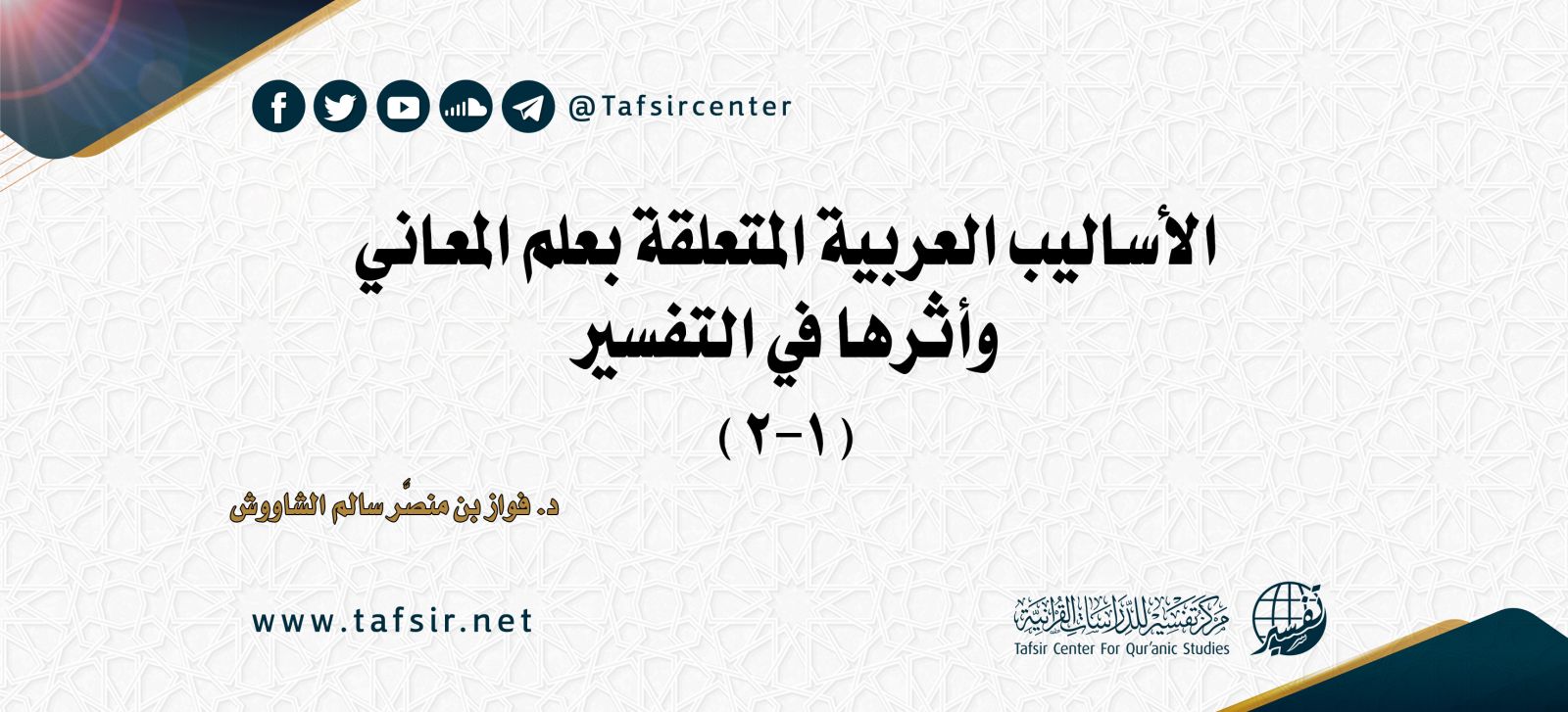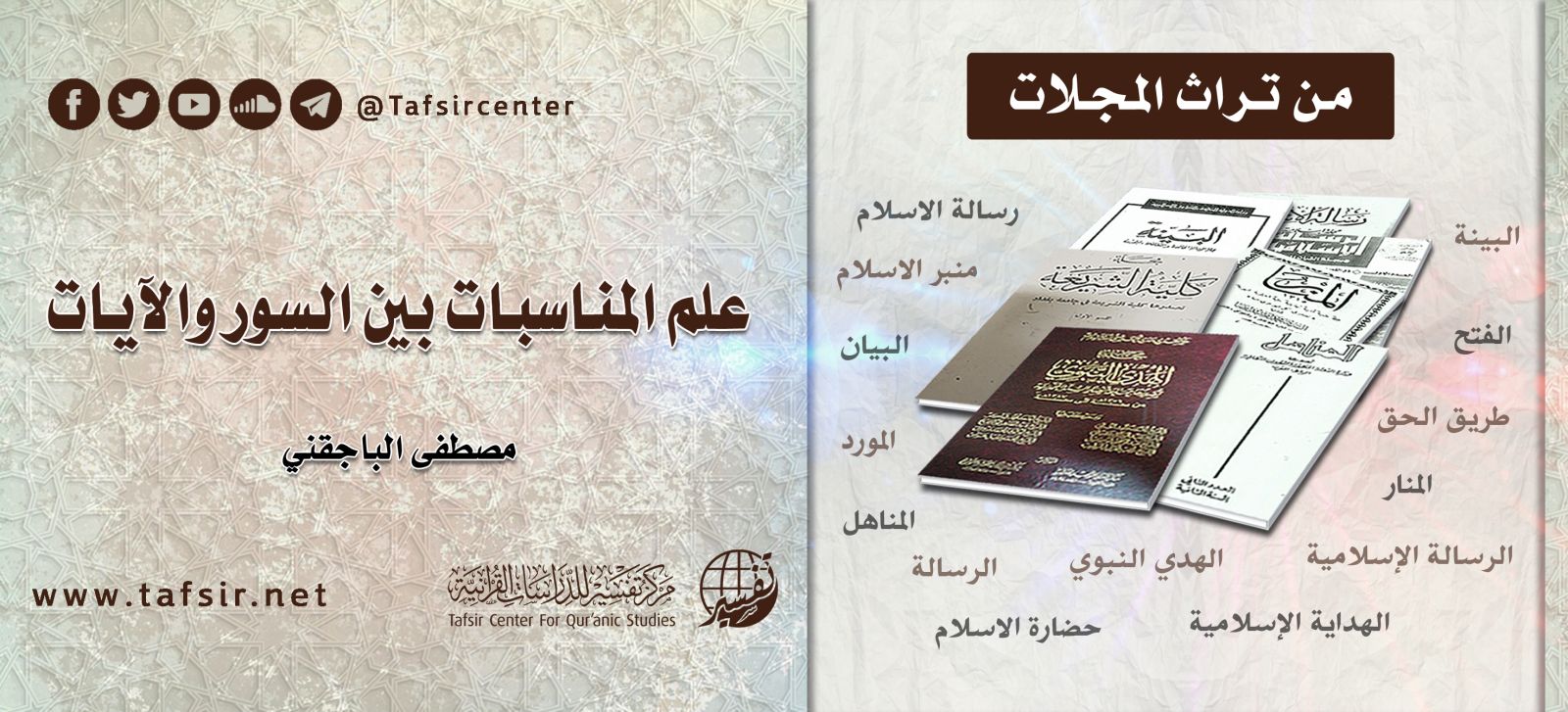سلسة التفسير الفلسفي للقرآن (2): «التفسير الفلسفي للقرآن» بين تاريخ الفكر الإسلامي وتأسيس المرزوقي
«التفسير الفلسفي للقرآن» بين تاريخ الفكر الإسلامي وتأسيس المرزوقي
الكاتب: محمد كنفودي

نتناول في المقالة الثانية، التي هي بمثابة مدخلٍ ممهدٍ لبقية المقالات الآتية؛ التفسير الفلسفي في التاريخ الإسلامي، وموقع اجتهاد أبي يعرب المرزوقي منه، محاولين استكشاف طابع هذا الموقع التأسيسي لمحاولة أبي يعرب. لذا فإننا سنحاول الإشارة ولو الموجزة -وهو ما لا تسمح بأكثر منه مقالتنا المختصرة- إلىحضور المنظور الفلسفي في تاريخ مقاربات أو تفاسير نصّ القرآن الكريم في فضاء الاجتهاد الإسلامي، فضلًا عن بيان طبيعته، وما اعترضه من صعوبات منهجية ومعرفية، وما تخلله من أعطاب ومآزق، في سياق تاريخ الفكر الإسلامي قديمه وحديثه، بالقدر الذي يعين على بيان موقع «التفسير الفلسفي لأبي يعرب» في هذا التاريخ.
يقول أبو يعرب المرزوقي: «لكنّ التفسير الفلسفي لا ينبغي أن يرفض لأنه فلسفي، بل علّة الرفض ينبغي أن تكون لأنه ليس فلسفيًّا كما ينبغي أن يكون»[1].
منذ تأسيس المذاهب أو المدارس في تاريخ الفكر الإسلامي، مع بدايات أزمنة التأسيس الجنينيّة الأولى، تنوعت أضرُب تفسير نصوص القرآن الحكيم، بتمايز مناهج التأصيل التفسيري، فظهرت بالتّبع في تاريخ تفسير النصّ القرآني عدّةُ مناهج أو مناظير عامّة[2]، أهمها:
أولًا: منهج التفسير اللغوي أو البياني.
ثانيًا: منهج التفسير التشريعي أو الحُكمي.
ثالثًا: منهج التفسير القصصي أو التاريخي.
رابعًا: منهج التفسير الإشاري أو الرمزي.
خامسًا: منهج التفسير المقاصدي أو الحِكَمي.
سادسًا: منهج التفسير الفلسفي أو العقلي التأويلي.
وكلُّ منهجٍ من مناهج التفسير تلك، إلا وتولّت بيانها تنظيرًا وتطبيقًا مصنفات عدة قديمًا وحديثًا[3]. إلا أنه يلاحظ في سياق تاريخ التفسير أن مناهج التفسير الثلاثة الأولى توسّع القول بها والبحث فيها أكثر من مناهج التفسير الثلاثة الأخيرة[4]؛ فمنهج «التفسير الفلسفي» مثلًا، كان دومًا محطّ نقد ورفض قديمًا وحديثًا، بالنظر إلى عدّة اعتبارات عامة، أهمّها:
1- إطلاق العنان للعقل وتأملاته، خصوصًا لما يتعلق الأمر بموضوع نصوص القرآن الخبرية المتعلقة بـ«عالم الغيب». وقد شهد تاريخ الفكر الإسلامي منذ بواكيره الجنينية الأولى صراعات بلغت حدّ التكفير المتبادل، وأحيانًا أخرى حدّ الاقتتال الدموي، بين أنصار «النقل» وشيعة «العقل». وتُعَدّ هذه الثنائية تاريخيًّا من أهم الإشكالات التي قتلت جهودًا وألهت عقولًا وضيّعت أوقاتًا، وتسبّبت في إزهاق أرواح، وهي ما زالت غالبة على مستوى منهج النظر والتصنيف[5]. وقد اجتهد أبو يعرب المرزوقي وغيره قديمًا وحديثًا في سبيل إصلاح العطب منهجيًّا ومعرفيًّا[6].
2- إنّ التفسير الفلسفي في عمومه لم يكن منضبطًا بمنهج وقواعد علمية موضوعية محررة؛ إذ كان في غالب أمره عبارة عن تأملات عقلية ذاتية تحكمية، صادرة عن مجموعة أفراد أو مذاهب منبوذة من قِبَلِ أهل السلطة المعرفية، أو قل: أهل الوصاية في المجتمع العربي الإسلامي[7].
3- إنّ التفسير الفلسفي لنصوص القرآن كان يستند في كثير من أسسه المنهجية أو المعرفية على «المنقول الفلسفي اليوناني»، بالنظر إلى أنه لم يكن عبارة عن تصورات عقلية مجردة، بل كان في كثير من معالم جوهره انعكاسًا لواقع أو لخصوصية فكرية أو حضارية تاريخية[8].
4- استقرّ اجتهاد الفكر الإسلامي منذ أزمنة التأويل التأسيسية الأولى على ناظم منهجي كلي عام مفاده: «النهي عن تفسير القرآن بالعقل المجرد»، بالاستناد على مجموعة من النصوص الحديثية، وعدّة آثار صادرة عن أجيال «خير القرون» الثلاثة الأولى[9]. والتفسير الفلسفي كما هو معلوم؛ لبّه قائم على منهج التأويل العقلي. ويلاحظ في تاريخ الفكر الإسلامي أنّ منهج التفسير الفلسفي كان يتقاطع -وأحيانًا أخرى يتطابق- مع منظور التفسير العقلي في مقابل التفسير النقلي-الأثري، فكان كلّ من جنح أو غلّب منهج التفسير العقلي عدّ من أهل منهج التفسير الفلسفي؛ فصار تفسيره منبوذًا، أو على الأقلّ محطّ تحذير.
إنّ هذه المحددات وغيرها كثير مما لم يذكر؛ جعلت منهج التفسير الفلسفي، إن لم يكن موضوع رفض وردّ، فهو على الأقل محطّ تحذير وتنبيه إلى عواقبه المفضية إلى دائرة ما سماه إمبيرتو إيكو بـ«التأويل المفرط»[10]، الذي هو أساس «التلاعب اللامحدد واللامحدود» بجواهر نصوصِ القرآن دلالة وحكمًا، فيفقد النصّ القرآني بالتّبع تعاليه التأسيسي المعياري، وتضيع خصائص إنيته الذاتية، إن لم يؤسّس منهج تفسير موضوعي يتلاحم مع ذلك كلّه.
إنّ رفض المنظور الفلسفي لتفسير نصوص القرآن في بعض نصوص التراث الإسلامي لم يكن رفضًا للمنظور الفلسفي في حدّ ذاته، بل كان الرفض يقوم في الغالب أساسًا على إخضاع نصوص القرآن لمقررات فلسفية منقولة مُحمّلة خارجية عن نَسَقِه أو نَفَسِه العام، أو مناقضة لدلالاته وأحكامه النصية السياقية[11]. خصوصًا أن المنظور الفلسفي المنقول لم يكن مجرد منهج أو منظور للتفسير، بل كان في صلبه يقوم على جملة مضامين معرفية موجهة للمنهج على مستوى التأسيس والتنزيل معًا؛ ذلك أن ما سُمِّيَ تاريخيًّا بـ«الفلاسفة» في تاريخ الفكر الإسلامي[12]، قد شكّل المنظور الفلسفي اليوناني المنقول لديهم بعد عهد الترجمة تحديدًا صلب منظورهم المنهجي والمعرفي معًا[13]. والمنظور الفلسفي اليوناني كما هو معلوم قد تأسّس في زمنٍ تأويليٍّ ذي محدداتٍ خاصّة، أهمها غياب الوحي المنزّل الباقي على أصله الأول المنزّل به.
وعليه؛ فإن المنظور الفلسفي المنقول ليس مجردًا عن السياق الزمكاني، والسياق المعرفي ورؤيته للوجود، وآفاقه الكلية والجزئية؛ لذلك اهتم جَمْعٌ من العلماء القدامى في سبيل تأسيس منظور فلسفي، يتحدد بناءً على السياقات التي نشأت عن النصّ القرآني ورؤيته التي أسسها للوجود والمصير؛ فظهرت اجتهادات فلسفية كانت أقرب إلى الرؤية القرآنية المأصولة منها إلى الرؤية اليونانية المنقولة، أو غيرها من الرؤى الفلسفية المستوردة[14]. لذلك، اعتبر كثيرٌ من الباحثين المعاصرين أن «علم الكلام» مثلًا يشكّل عمدة المنظور الفلسفي الإسلامي، فضلًا عن إنتاجات واجتهادات علماء كثر في مجالات معرفية إسلامية أخرى[15].
بناءً على ما سلف، فإن تحقيق النظر في التفسيرات الفلسفية للذين اشتهروا باسم الفلاسفة في تاريخ الفكر الإسلامي، يستطيع الناظرأن يخلص إلى أنها تأرجحت بين آفتين؛ الأولى: تسويغ رؤية المنقول اليوناني من خلال إخضاع نصوص القرآن للتأويل ولو كان مُفرطًا. الثانية: بُعدها عن رؤية القرآن الحكيم ومنظوره للوجود والمصير بُعدًا جليًّا صريحًا[16].
نفس الجدل الذي حكم منهج تفسير القرآن بمنظور المنقول الفلسفي اليوناني ورؤيته للوجود، هو إلى حدٍّ ما يتقاطع -أو قل: يتطابق- مع منهج تفسير نصوص القرآن بمنظور المنقول الفلسفي الغربي المعاصر ورؤيته للوجود. فمن المفكرين من اجتهد في سبيل إيجاد كلّ ما من شانه إحداث القطيعة المطلقة معه جملة وتفصيلًا، منهجيًّا ومعرفيًّا[17]، ومنهم من اجتهد في سبيل إيجاد ما يسوغ أخذه أو نقله والأخذ به جملة وتفصيلًا، منهجيًّا ومعرفيًّا[18]، ومنهم من اجتهد في سبيل التمييز بين ما يتوافق مع منظور ورؤية القرآن؛ فيقبل بوصفه من المشترك الإنساني العامّ، وما لا يتوافق معه؛ فيرفض بوصفه خاضعًا لمحددات وسياقات خاصّة، توقيفًا أو تلفيقًا[19]. إلا أن الفرق بين الأمس واليوم، هو أن القدامى كانوا في مستوى «الحدث الفلسفي»، وأحيانًا أخرى قد تجاوزوه بمنظور أو رؤية إبداعية راقية محكمة منهجيًّا ومعرفيًّا. أما أهل الفكر الإسلامي المعاصر فهم لم يتمكّنوا بَعْدُ من إنشاء إبداع فلسفي معاصر في مستوى «الحدث الفلسفي» المعاصر، أو في مستوى «النسق الفلسفي» لنصّ وحي القرآن إلا نادرًا، إذ هم في الغالب بين آفتين؛ الأولى: آفة الانبهار الذي ولّد تقليدًا تعبديًّا تقديسيًّا[20]. الثانية: آفة الخوف على مقومات الهوية الخاصّة، الذي ولّد إدبارًا وقطيعة مطلقة، وأحيانًا أخرى انغلاقًا تامًّا. إلا أنّ هذه القاعدة العامّة حَكَمَتْهَا في الغالب عللٌ تاريخية ومعرفية، بنيوية وظرفية، عامّة وخاصة معًا[21].
بناءً على الوصف العام لهذه الوضعية ظهر مجموعة من المفكرين المعاصرين من أهل الفكر الإسلامي المعاصر، اجتهدوا في سبيل الخروج أو التحرر من تلك الوضعية المأزومة، نحو التمهيد لأساسيات الإبداع المعتبر، ما دام أن التفلسف المحرر يمكن اعتباره أحد أهم ما يفضي إلى الإبداع المعتبر، من باب وضع الأبنية الأساسية للاجتهاد الفلسفي، الذي يعكس بعض متجليات رؤية الإسلام للوجود وقضاياه، بمنهج إبداعي مأصول غير منقول، ما دام أن الفلسفة في أصلها لا تناصب الدين العداء، وعلى رأسهم على سبيل المثال لا الحصر: محمد إقبال[22]، محمد باقر الصدر[23]، طه عبد الرحمن[24]، وأبو يعرب المرزوقي وغيرهم. وما يهمنا حصرًا هو اجتهاد أبو يعرب المرزوقي الفلسفي المتصل بالقرآن، الذي سيكون مدار متن هذه المقالات تباعًا. لذلك، سيكون الرهان متعلقًا بمدى قدرة الاجتهاد اليعربي على تحقيق هذا الهدف المنشود، في إطار العدّة المنهجية التي ينطلق منها.
وعليه يمكن القول: إنّ أيّ تفسير لنصّ القرآن؛ سواء كان فلسفيًّا أو غيره، له شروط أو مواصفات لقبوله أو رفضه، ليست متعلقة بنوعه، بل تتعلق أساسًا بـ:
1- مراعاة الخصائص والمحددات المنهجية والمعرفية العامة التي تعكس ماهية إنيّة نصّ وحي القرآن الحكيم[25].
2- مراعاة رؤية القرآن الإنسانية الواسعة الجامعة لقضايا الوجود والمصير الإنساني في مختلف مراحله، واللاحمة لأفراد نوعه[26].
3- مراعاة الإنشاء الإبداعي الجمالي لنصّ القرآن الحكيم دلالة وحكمًا[27].
فأيّ تفسير بالتبع ألغى أو عطّل ذلك تصريحًا أو تلميحًا عدّ لاغيًا، من أي جهة صدر، وفي أي زمنٍ تأويليّ انبثق، ما دام أن القرآن الحكيم ليس مجرد نصّ أو مادة لغوية تفسّر وتقرأ بكلّ ما هو متاح أو متوفر منهجيًّا أو معرفيًّا، بل هو نصٌّ كاملُ السيادة الذاتية والموضوعية، التي حددها هو لا من ينطق عنه بالوكالة المزعومة، وكأنه من جنس النصوص التاريخانية القاصرة، وليس نصًّا متعاليًا راشدًا حاملًا ومحمولًا؛ من حيث إنه موسوم بناظم أو محدد «الإعجاز»، كما ورد التنصيص على ذلك في القرآن الحكيم نصًّا[28].
إنّ منهج التفسير الفلسفي إن كان وجوده في تاريخ الفكر الإسلامي خافتًا بالنظر إلى عدة عوامل بنيوية وظرفية[29]؛ ففي المرحلة المعاصرة يعد تأسيس منهج لتفسير فلسفي معاصر لنصّ القرآن من أولى الضرورات الملقاة على عاتق الاجتهاد الإسلامي التأسيسي أو المؤسس؛ بالنظر إلى الاعتبارات الآتية:
1- إنّ تنويع وتعديد مناهج تفسير نصّ القرآن موضوعيًّا من خلال مداخل جديدة، يعد أحد العوامل الأساسية لتثوير دلالات وأحكام نصّ القرآن داخليًّا، بعيدًا عن أيّ نقل قاصر، أو تأويل مفرط، أو تسويغ مسبق.
2- إنّ دلالات نصوص القرآن ليست مستنفذة أبدًا تأويلًا أو سريانًا؛ فكلما تنوعت مداخل أو مناهج التفسير، إلا وأثمر ذلك جديدًا، خصوصًا إذا كان منهج التفسير بعيدًا عن مطلق المعينات الخارجية المُحمّلة شأن التفسير الفلسفي؛ فيتحقق بالتبع إعجاز القرآن المتعلق تحديدًا بمحور الخطاب القرآني، إنه الإنسان في مطلق الزمان.
3- إنّ نصّ القرآن يعدّ استخدام العقل فريضة أساسية[30]، وأهم مجالاتها نصوص القرآن، بشرط إذا كان الاجتهاد التفسيري الفلسفي منضبطًا، دون إهدار لخصوصية القرآن، أو تجاوز لحدود العقل المتعلقة حصرًا بعالم الشهادة وما له به صلة مباشرة أو غير مباشرة[31].
4- إنّ القرآن إِذْ كان يعدّ نسقًا بنائيًّا أو وحدة متكاملة لا فراغ ولا نقص فيها، فإن من شأن منهج التفسير الفلسفي القائم أساسًا على مفهوم النّسق أن يؤسّس لنصوص القرآن دلالات نسقية توحيدية نظرًا وعملًا، بعيدًا عن قانون الدلالات الذرية التجزيئية[32].
في هذا السياق العام وسياقات جزئية أخرى يأتي اجتهاد أبي يعرب المرزوقي، القائم على تأسيس منهج تفسير فلسفي نسقي معاصر لنصوص القرآن الحكيم، بأفق إنساني كوني أرحب وأوسع، بعيدًا عن مطلق أنواع التأثيرات لمجمل أنواع الخطابات السائدة في العالم الإسلامي، التي هي في غالبها إما تاريخانية أو مذهبية أو قومية ضيقة، وقد ضربت عليها بتعبير محمد أركون «سياجات دوغمائية مغلقة»[33]، فغاب أو غيّب عنها التأسيس لمنظور إبداعي استخلافي شهودي إنساني كوني لاحمٍ، يمتح مادته التأسيسية الأولى من نصوص القرآن الحكيم وسنة الرسول -عليه الصلاة والسلام- الصحيحة، والاجتهاد «الحيّ» من التراث الإسلامي وعموم التراث الإنساني[34].
خاتمة
لعلّ قارئنا الكريم يكون قد تبيّن له معنا أن لاجتهاد أبي يعرب أهميةً خاصةً؛ حيث إنه لا يقف كتفسير فلسفي إلى جوار غيره من التفاسير داخل نفس النوع في التاريخ الإسلامي قديمًا وحديثًا، بل إنه يضع محاولته في سياق التأسيس لهذا النوع التفسيري، ولتلافي عيوبه القائمة فيه قديمًا وحديثًا، بحيث يتأسّس منهجيًّا ومعرفيًّا على نصوص القرآن الحكيم وسنة الرسول -عليه الصلاة والسلام- الصحيحة لا على «المنقول الفلسفي اليوناني»، منغرسًا في الاجتهاد «الحيّ» من التراث الإسلامي، فيستطيع التأسيس لمنظور إبداعي استخلافي شهودي إنساني كوني لاحم.
وهذه المعايير والنواظم التي ذكرنا طوال المقال، والتي تشكّل معايير كون تفسير ما تفسيرًا فلسفيًّا وليس تأملًا عقليًّا أو سبحًا فكريًّا؛ هي الأساس الذي وضعه أبو يعرب لتفسيره، لكن يبقى السؤال الذي ستجيبنا عليه المقالات القادمة، وهو: هل نجح أبو يعرب في محاولته هذه للتأسيس؟ وهل هذه المحددات والنواظم حكمت تفسيره بالفعل؟ وبأيّ قدرٍ تمّ هذا؟
الكلمات المفتاحية للمقالة
وردت في المقالة الثانية مجموعة من الكلمات-المفاهيم الأساسية، التي هي عبارة عن مفتاح لقراءة نصّ المقالة، ونذكر أهمها فيما يأتي:
- مفهوم «التأويل المُفرط-البعيد-الغريب»، ويقصد به: منهج من مناهج النظر التفسيري للنصّ القرآني، يأتي بدلالات ومعاني لا تتوافق مع النصّ المقروء سياقًا ومقصدًا.
- مفهوم «المنقول المحمّل-المعينات التاريخية المحمّلة»، ويقصد به: مختلف ما يعتمده ناظر في تفسير نصّ القرآن، بالتوسل بما هو تاريخي أو متحيّز أو مُحايث.
- مفهوم «التاريخانية-التراث الاجتهادي الميّت»، ويقصد به: كلّ ما انقضت فعاليته وجدواه النظرية والعملية، أو المنهجية والمعرفية؛ بحيث إنه لم يعد صالحًا في السياق الاجتهادي المعاصر.
- مفهوم «التفسير التجزيئي-الذري»، ويقصد به: منهج تفسيري، يقوم على النظر إلى نصوص القرآن مفصول بعضها عن بعض استقلالًا.
- مفهوم «أزمنة التأويل التأسيسية»، ويقصد به: مختلف الإبداعات المنهجية أو المعرفية، التي تأسست في الأزمنة الأولى في تاريخ الفكر والاجتهاد الإسلامي.
[1] فلسفة الدين من منظور الفكر الإسلامي، أبو يعرب المرزوقي، بيروت، لبنان، دار الهادي، ط1، 2006، ص194.
[2] سواء كانت المدارس أو المذاهب فقهية أو كلامية أو غيرهما. مع العلم أنّ منهج تفسير النصّ القرآني بدأ في النشوء مع الصحابة، خصوصًا مع ابن عباس [ت: 68هـ] ومسائل ابن الأزرق. (هو أبو راشد نافع بن الأزرق، رئيس إحدى فرق الخوارج الأزارقة. انظر: الملل والنحل، الشهرستاني، القاهرة، مصر، المكتبة التوفيقية، ب. ت، ج1، ص133-135).
[3] بالرغم من كلّ ما كُتب عن تاريخ ومناهج التفسير في تاريخ الفكر الإسلامي، يقطع محمد أركون بغياب تاريخ استقصائي شامل لمجال التفسير، يجمع بين همّين معرفيين؛ الأول: يلامس التطور المعرفي للتفاسير منذ البدايات الجنينية الأولى للدرس التفسيري. والثاني: يرصد شروط ممارسة العقل الإسلامي لعمله الإبداعي؛ لتلافي الخلط بين مستويات دلالات نصوص القرآن. الفكر الإسلامي نقد واجتهاد، محمد أركون، ترجمة وتعليق: هاشم صالح، بيروت، لبنان، دار الساقي، ط4، 2007، ص93، 94.
[4] حصر أبو يعرب المرزوقي أصناف التفسير التراثي في خمسة: التفسير بـ«الآثار وعموم الأخبار المروية»، التفسير بـ«علوم اللسان العربي»، التفسير بـ«النسق النظري للوجود»، التفسير بـ«النسق العملي للوجود»، والتفسير «الجامع». فلسفة الدين من منظور الفكر الإسلامي، أبو يعرب المرزوقي، ص196، 197. وكان ابن خلدون [ت: 808 هـ]، قد حصر مناهج التفسير التراثي، فتحدث عن «التفسير النقلي»، وبيّن عيوبه وأعطابه، و«التفسير المستند إلى علوم اللسان العربي»، وبيّن أعطابه ومآزقه أيضًا، إلا أنه اعتبرها دون الأولى. المقدمة، ابن خلدون، بيروت، لبنان، دار الفكر، ط. 2004، ص421، 422. إلا أن أبا يعرب المرزوقي بيّن أن عرض ابن خلدون ليس علميًّا بالقدر الكافي، فهو لم يأتِ على ذكر أهم مناهج التفسير التي ظهرت إلى حدودِ زمنه، وعدم ذكرها راجع إلى موقف عقدي رسمي، لا يقيم اعتبارًا لما عداها من مناهج التفسير. أما سكوته عن «التفسير الفلسفي»؛ فراجع أولًا إلى عدم وجود تفسيرٍ فلسفي كامل للقرآن، وراجع ثانيًا إلى أن ما يسمي بـ«التفسير الفلسفي» لا يعدو أن يكون من باب إسقاط المنقول الفلسفي على نصوص القرآن. فلسفة الدين من منظور الفكر الإسلامي، أبو يعرب المرزوقي، ص190، 191. وقد حصر أحمد أمين [ت: 1954] أنواع التفسير في ثلاثة فقط؛ «التفسير بالمأثور»، و«التفسير بالاجتهاد» أو «الرأي»، و«التفسير بالمعهود الخبري لأهل الكتاب». فجر الإسلام، أحمد أمين، بيروت، لبنان، دار الكتب العلمية، ط1، 2004، ص194- 196.
[5] قد بيّن تهافتها الكثيرُ من العلماء والفلاسفة قديمًا وحديثًا؛ كابن تيمية قديمًا في موسوعته الموسومة بـ«درء تعارض العقل والنقل»، أو «موافقة صحيح المعقول لصريح المنقول»، وكذا ابن رشد في: «فصل المقال»، وكذا طه عبد الرحمن في مصنفه: «سؤال العمل؛ بحث عن الأصول العملية في الفكر والعلم»، وغيرهم كثير.
[6]من أهم القضايا المنهجية والمعرفية التي أعاد النظر فيها أبو يعرب المرزوقي فلسفيًّا من باب إعادة التأسيس؛ تجد: علاقة العقل بالنقل أو النقل بالعقل. والتفسير الفلسفي المعاصر للقرآن الذي قدّمه هو في جوهره تفسير فلسفي بالعقل، كما سنفصّل القول في أسس ذلك في لاحق المقالات؛ إذ قد اجتهد أبو يعرب المرزوقي في سبيل حَسْم القول فيها، وتخليص الفكر الإسلامي من جملة أوْهام منهجية ومعرفية متعلقة بها، أو التي تثيرها أو تعْلق بها قضية «النقل» و«العقل» بتعبير أهل علم الكلام، أو «الحكمة» و«الشريعة» بتعبير ابن رشد [ت: 595]، أو «صحيح المنقول» و«صريح المعقول» بتعبير ابن تيمية [ت: 728]. نجتهد في هذا السياق في سبيل إجمال منظور أبي يعرب المرزوقي لقضية «العقل» و«النقل». إنّ «النقل» بوصفه مقابلًا لـ«العقل» يقصد به الأمر الذي يكون من وضع واضع فَيُقبل كمعطى وَيُروى كخبر، أو هو كلّ ما لا ينتسب إلى ما هو طبيعي، أو هو المعطى المضموني في كلّ معرفة إنسانية، أو هو المعطى الشكلي. فتكون العلوم نقلية بوصف موضوعاتها، أما شكلها؛ طبيعة التنسيق التي تخضع لها مضموناتها، فإنه شكلٌ نظريّ علمي. وقد حدد «العقل الصريح» بـ«العقل المجرد» من كلّ مضمون معين، أو هو المعنى المصدري الذي هو صوغ المعطيات. أما «النقل الصحيح» فهو «النقل المجرد» من مضمون معيّن أو معناه المصدري؛ بمعنى أن الحقيقتين مطلوبتان في عملية التصحيح والتصريح، وليستا حاصلتين قبلهما. فلا يبقى أيّ معنى للتوفيق بين «العقل» و«النقل». وهذا عكس الذين يحصرون العلم في الجمع والتوفيق بينهما بالتأويل. من هذا الحَيْثُ، لا يمكن أن يحدث التناقض الصريح بين «النقل» و«العقل»، إلا إذا انحطّ كلٌّ منهما إلى شكلين من أشكال الشعوذة، فيفضي الأمر إلى الطرق المسدودة في التعامل معهما؛ رد «العقل» إلى «الوحي»، أو رد «الوحي» إلى «العقل». وكلّ واحد من الموقفين ظنّ أن كليهما متعيّنًا فيما تُصَوِّره عين الحقيقة الواردة في تجربة الشريعة، أو عين الحقيقة الواردة في تجربة الطبيعة، ولما كانت متعددة أدت إلى حروب سجالية لا نهاية لها، فضلًا عمّا في ذلك من التسليم بالثنائية ثم نفي حقيقتها. ومن هذا المنظور أيضًا اعتبر أبو يعرب المرزوقي، أن الخلاف بين الأشاعرة والمعتزلة، هو خلاف حول التعارض فيما يتعلق بمجالين؛ أحدهما: معرفي، يتعلق بالعلاقة بين التجربة والفرض؛ بمعنى إذا تعارض «الفرض العقلي» و«الخبر النقلي». وثانيهما: قيمي، يتعلق بالعلاقة بين «حكم القيمة» و«حكم الواقع»، أو ما يسمى بمسألة «التحسين» و«التقبيح». تجليات الفلسفة العربية، أبو يعرب المرزوقي، ص62, تحديات وفرص، أبو يعرب المرزوقي، ص31، 35، النخب العربية وعطالة الإبداع في منظور الفلسفة القرآنية، أبو يعرب المرزوقي، ص60، شروط نهضة العرب والمسلمين، أبو يعرب المرزوقي، ص13، 14، الجلي في التفسير، ج3، أبو يعرب المرزوقي، ص117، 118. في السياق يقول أبو يعرب المرزوقي: «وإنه لمن السخف الزعم بأن الدين الإسلامي عقلي؛ بمعنى كونه خاليًا من الأسرار التي يحار فيها العقل. فلو صحّ لكان العقل بهذا المعنى وحده كافيًا، ولاستغنينا عن الوحي مطلقًا، فلا تكون حاجة لأن يُبدأ ولا لأن يُختم. الدين الإسلامي عقلي بمعنى كونه يجعل من هذه الأسرار مصدر كلّ الفنون التي تمثل المُحفّز الدائم للعقل، لئلا تأخذه السِّنات القاتلة، فيكون دائم التيقظ والبحث». شروط نهضة العرب والمسلمين، أبو يعرب المرزوقي، ص136، وفي العلاقة بين الشعر المطلق والإعجاز القرآني، أبو يعرب المرزوقي، ص37.
[7] يقول أبو يعرب المرزوقي: «ولما كانت التفاسير الصوفية المتفلسفة ليست فلسفية بحقّ، فإنّ الردّ عليها ليس ردًّا على التفسير الفلسفي؛ بل هو ردّ على التفسير الموظّف لبعض المضامين الفلسفية الميتة في عصرٍ ما». فلسفة الدين من منظور الفكر الإسلامي، أبو يعرب المرزوقي، ص194، 195. ومن أهم التفاسير الفلسفية التي تمت محاربتها بكلّ الوسائل، بدعوى أنها من باب تعطيل أو إلغاء الدلالة الصحيحة -الاعتبارية-، تجد: التفسير الصوفي، وتفسير إخوان الصفا، والتفسير الباطني، وتفسير المعتزلة والشيعة وغير ذلك. وينشأ ذلك الموقف العدائي في الغالب من قِبَل المذهب (عقديًّا كان أو فقهيًّا) المهيمن على أهل السلطة السياسية الرسمية، كما هو معروف في التاريخ الإسلامي. انظر: فضائح الباطنية، وتهافت الفلاسفة لأبي حامد الغزالي [ت: 505].
[8] يدرج في ذلك ما سماه أبو يعرب المرزوقي بـ«فلسفة أرسطو النظرية» بتوسط «المشائية العربية»، و«فلسفة أفلاطون العملية» بتوسط «الإشراقية العربية»، وهما معًا يرتدان إلى «الأفلاطونية المحدثة الهلنستية» الجامعة بين «الفلسفة» و«الأديان الشرقية» مُنَزَّلة كانت أو طبيعية. فكانت بالتبع مشكل المشاكل بالنسبة للفكر الإسلامي، خصوصًا على مستوى شروط التخلص منها. فلسفة الدين من منظور الفكر الإسلامي، أبو يعرب المرزوقي، ص194، 195. الأمر الذي أفرز تقليدًا وتبعية للفكر اليوناني المنقول، كما نصّ على ذلك طه عبد الرحمن. من الإنسان الأبتر إلى الإنسان الكوثر، طه عبد الرحمن، بيروت، لبنان، المؤسسة العربية للفكر والإبداع، ط1، 2016، ص71، 72.
[9] من أهم تلك النصوص التي استند إليها في تأسيس «النهي الشرعي» عن التأويل العقلي، نذكر ما روي عن ابن عباس أن رسول الله -عليه الصلاة والسلام- قال: (مَنْ قَالَ فِي القُرْآنِ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَلْيَتَبَوأْ مقعَدَهُ مِنَ النّارِ). سنن الترمذي، حديث رقم 2950، سنن النسائي، حديث رقم 8084، وغيرهما. وهذا الأمر؛ سواء صح الحديث أو لم يصح، مما لا يختلف حوله اثنان قطعًا. وقوله أيضًا: (مَنْ قَالَ فِي القُرْآنِ بِرَأْيِهِ فَأَصَابَ فَقَدْ أَخْطَأَ). سنن أبي داود، حديث رقم 3652، سنن الترمذي، حديث رقم 2952، وغيرهما. وهذا، مما لا يقبله عاقل مقدِّر لأولى بديهيات المنهج العلمي قطعًا. إنّ هذه المنقولات لا تنتظم في ناظم منهجي محكم معقول صريح؛ ذلك أن الرسول -عليه الصلاة والسلام- لم يرد فيما صحّ عنه إلا تفسير آيات معدودة، فضلًا عن أن الصحابة الذين اشتهروا بالتفسير التأسيسي كان التعويل من قِبَلهم على التفسير بالاجتهاد العقلي التأويلي أو بالرأي، كابن عباس مثلًا، فضلًا عن كلّ من فسر آيات القرآن من المفسرين [انظر للتفصيل في قضية تأويل النصّ القرآني في لاحق المقالات]. وعليه يمكن القول: إنّ التفسير بالعقل إذا أحكم منهجه كان محمودًا إذا توافقت دلالات التفسير المتوصل إليها مع نصّ القرآن. وقد بيّن ابن العربي [ت: 543] القول الفصل في تفسير القرآن بالعقل أو بالرأي، وأساسه سلامة المنهج. انظر: قانون التأويل، ابن العربي، دراسة وتحقيق: محمد السليماني، تونس، دار الغرب الإسلامي، ط2، السحب الجديد، 2010، ص366 - 368. وقد نصّ أيضًا الشاطبي [ت: 790] على أنّ إعمال الرأي أو النظر العقلي في نصّ القرآن؛ منه ما هو مذموم، ومنه ما هو ضروري، وأساس ذلك كلّه سلامة المنهج، مع العلم أنه رجح التحذير منه بالتوسل بروايات ومأثورات تراثية. الموافقات في أصول الشريعة، الشاطبي، شرح وتخريج الأحاديث: عبد الله دراز، وضع التراجم: محمد عبد الله دراز، بيروت، لبنان، دار الكتب العلمية، ط8، 2011، ج3، ص315 وما بعدها.
[10] التأويل والتأويل المفرط، إمبيرتو إيكو، ترجمة: ناصر الحلواني، بيروت، لبنان، مركز الإنماء الحضاري، ط. 2009. قد حدد إيكو مواصفات «التأويل المفرط» الذي يلغي خصوصية النصّ المقروء، ويعظم الأمر لما تكون ساحته النصّ الديني أو المقدس، ومنها: مخالفة التأويل لطبيعة النصّ المؤول، التحديد المسبق لمعنى النصّ المؤول، إحداث التأويل الارتياب في المعنى اليقيني للنصّ المؤول، ونحو ذلك. التأويل والتأويل المفرط، إمبيرتو إيكو، ص15، 17، 19، 87، 118.
[11] قد بيّن ابن تيمية على سبيل المثال -الذي يستلهمه أبو يعرب المرزوقي هو وابن خلدون كثيرًا- أن الأصل في النظر الفلسفي مأصولًا كان أو منقولًا؛ عدم تناقضه مع النصّ الشرعي الصحيح الصريح تناقضًا بيّنًا، ما دام أنه قائم على إعمال النظر والتجرد المطلق عن تقليد غير المعصوم، ومما يدل على ذلك قوله: «فمن تبحّر في المعقولات، وميّز بين الشّبهات والبّينات؛ ثبت له أن العقل الصريح أعظم الأشياء موافقة لما جاء به الرسول -عليه الصلاة والسلام- وأخبر به. وكلما عظمت معرفة الرجل عظمت موافقته لما جاء به الرسول -عليه السلام-... إنّ العقل كلما أمعن في التحقيق كان أوفق للشرع الذي جاء به الرسول -عليه السلام-». وقوله أيضًا: «ما عند هؤلاء مما يسمونه عقليات هو في نفس الأمر تقليديات، قلدوا ما ليس بمعصوم». درء تعارض العقل والنقل، أو موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول، ابن تيمية، تحقيق: محمد رشاد سالم، ب. ت. ج5، ص316. فالنصّ الشرعي الصحيح إذًا -حسب ابن تيمية- يمكن أن «يُخبر بمُحارات العقول، لا بمُحالات العقول». درء تعارض العقل والنقل، ابن تيمية، ص296، 297، ص314. والمنهج في ناظمه العام قد عمل على تأسيسه ابن خلدون في: المقدمة، ص493.
[12] مثل: الكندي والفارابي وابن سينا وابن رشد وغيرهم؛ لذلك دعوا إلى ما سمي بـ«التوفيق» بين نصوص الشرع الحكيم ونصوص الفلسفة اليونانية، من خلال منهج التأويل الذي أفاض ابن رشد في تعريفه والاستدلال عليه شرعًا في مصنفه: فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال. إلا أن ما تمّ أَخْذه عليه أنه كان مقلدًا للمنقول اليوناني؛ سواء في ترجماته، أو في تصوراته، حتى رُوي عن ابن سبعين [ت: 669] أنه قال: «لو أن أرسطو قال: الإنسان قائم وقاعد في نفس الوقت، لقال ابن رشد بذلك». الحوار أُفقًا للفكر، طه عبد الرحمن، بيروت، لبنان، الشبكة العربية للأبحاث والنشر، ط1، 2013، ص74، 75.
[13] بيّن كلٌّ من طه عبد الرحمن وأبو يعرب المرزوقي شروط أو قوانين الترجمة التي تسهم في التمهيد للتجاوز الخلاق والإبداع النوعي حسب مقتضيات المجال التداولي العربي الإسلامي. انظر: روح الحداثة؛ المدخل إلى تأسيس الحداثة الإسلامية، طه عبد الرحمن، بيروت، لبنان، المركز الثقافي العربي، ط1، 2006، ص143 وما بعدها، والحوار أفقًا للفكر، طه عبد الرحمن، ص65 وما بعدها، وأشياء من النقد والترجمة، أبو يعرب المرزوقي، بيروت، لبنان، جداول، ط1، 2012، ص55 وما يليها.
[14] خصوصًا ما تجده عند من لم يشتهر بوصف فيلسوف من عموم المفسرين والفقهاء والأصوليين والحكماء التأسيسيين وغيرهم.
[15] بالنظر إلى أن علم الكلام الأول الذي نشأ في أزمنة التأويل الأولى أو في «مرحلة المتقدمين»، لم يكن المنقول اليوناني تحديدًا قد سرى في شرايينه، أو اتخذه أرضية أوليّة للبناء المنهجي والمعرفي، عكس ما سيحدث لاحقًا في «مرحلة المتأخرين»، حسب التمييز الذي أقامه ابن خلدون. انظر: المقدمة، الفصل العاشر في علم الكلام، ص440 وما بعدها. وإن كان لأبي يعرب المرزوقي موقفه الخاصّ ممّا يسمى بـ«علم الكلام»؛ إذ ينصّ على أن المسائل الكلامية تعدّ هروبًا من التكليف الشرعي الحقيقي، وتحريفًا جوهريًّا لمعنى الرسالة الخاتمة، بالنظر إلى الغلوّ فيما فوق «طور العقل» من عالم الغيب، الذي جعل كلّ قضاياه لا تقبل الحسم العلمي، بل وحتى البتّ المنطقي؛ لأنها من باب «الغيب الوجودي»، الذي هو «عين المتشابه»، كما يتم تفصيله في لاحق المقالات. الجلي في التفسير، استراتيجية القرآن التوحيدية ومنطق السياسة المحمدية، ج1، مقومات الاستراتيجية والسياسة المحمدية، أبو يعرب المرزوقي، تونس، الدار المتوسطية للنشر، 2010، ص32، وحرية الضمير والمعتقد في القرآن والسنة؛ قراءة نقدية لأسس الفكر الكلامي وبعض أنصاره الجدد، أبو يعرب المرزوقي، تونس، الدار المتوسطية للنشر، ط1، 2008، ص14. هذا الموقف الرافض لعلم الكلام، بالنظر إلى المنهج المتبع في النظر التأصيلي تجد أنّ غيره من المعاصرين لهم مواقف أخرى؛ فطه عبد الرحمن مثلًا، قد اجتهد في سبيل تطوير علم الكلام، خصوصًا تلك البحوث والمقالات التي ما تزال حيّة صالحة للاستلهام والاعتبار، كما يظهر ذلك في مختلف كتبه: في أصول الحوار وتجديد علم الكلام، وتجديد المنهج في تقويم التراث، واللسان والميزان.
[16] إنّ جملة التفسيرات الفلسفية لبعض النصوص القرآنية وقتئذٍ قد عملت على تثبيت الفكر اليوناني المنقول أكثر من تفجير دلالات نصوص القرآن المجردة. وكلما كان التفسير محكومًا بتسويغ الجاهز من الفكر المذهبي أساسًا، إلا وكان ذلك بعيدًا عن أن يسمى تفسيرًا؛ سواء بالمعنى الفلسفي أو غيره، كما سنرى تفصيل ذلك في مقومات التفسير الفلسفي من منظور أبي يعرب المرزوقي في لاحق المقالات.
[17] شأن أبو يعرب المرزوقي وطه عبد الرحمن وعبد الوهاب المسيري [1938-2008] وغيرهم، من الذين اجتهدوا في سبيل تأسيس أنساق فكرية عربية أو إسلامية عصرية أو حداثية، أو من الذين أبدعوا خارج رؤية ومناهج الفكر الغربي الحديث والمعاصر.
[18] شأن محمد أركون ونصر حامد أبو زيد وغيرهما من الذين تبنوا الفكر الغربي الحديث والمعاصر منهجيًّا ومعرفيًّا كما هو في سياقه الخاصّ.
[19] وهذا كما يقتضي المنهج السليم في التعامل مع مختلف الاجتهادات الإنسانية مأصولة كانت أو منقولة. وقد بيّن طه عبد الرحمن منهج التعامل مع المنقول عمومًا. انظر: روح الحداثة؛ المدخل إلى تأسيس الحداثة الإسلامية، طه عبد الرحمن، ص13، 14.
[20] روح الحداثة؛ المدخل إلى تأسيس الحداثة الإسلامية، طه عبد الرحمن، ص190-191-192؛ وبؤس الدهرانية؛ النقد الائتماني لفصل الأخلاق عن الدين، طه عبد الرحمن، بيروت، لبنان، الشبكة العربية للأبحاث والنشر، ط1، 2014، ص131 وما بعدها. والتقليد على العموم كما هو معلوم لا إبداع معه، بل يعدّ عائقًا موضوعيًّا لتحقيق أيّ نسبة من نسَب ومراقي الإبداع المُجرّد.
[21] فمن العلل التاريخية توهّم الكثير بأن ما خلّفه العلماء أو علماء السلف كافٍ للاستغناء عمّا سواه. ومن العلل الظرفية توهّم الكثير بأن الفكر الغربي إن أُخِذَ نقلًا وتنزيلًا مَسَخَ وقوّضَ شخصية وهوية الوجود الإسلامي، خصوصًا بعد ما فعله الاستعمار والتنصير. ومن العلل المعرفية توهم الكثير بأن الفكر الغربي يعدّ مجرد فرع من فروع أصل الفكر والمعرفة الإسلامية. ومن العلل البنيوية توهم الكثير أيضًا بأن ما عند المسلمين من رأسمال رمزي كافٍ لاجتراح مخارج نوعية لمختلف الأزمات.
[22] محمد إقبال[ت: 1938]، من أهم ما كتبه محمد إقبال المتصل بالتفسير -التأمل الفلسفي- للقرآن، تجد مصنفه المعنون بـ: تجديد التفكير الديني في الإسلام، ترجمة: عباس محمود، مراجعة: عبد العزيز المراغي ومهدي علام، دار الهداية، ط2، 2000.
[23] محمد باقر الصدر [ت: 1980]، من أهم ما كتبه محمد باقر الصدر المتصل بفضاء التفسير، تجد: المدرسة القرآنية، التفسير الموضوعي والتفسير التجزيئي في القرآن الكريم، بيروت، لبنان، دار التعارف للمطبوعات، ط3، 1981، والمدرسة القرآنية، السنن التاريخية في القرآن الكريم، بيروت، لبنان، دار التعارف للمطبوعات، ط. 1989. فضلًا عن مجموعة من الكتب المتصلة بفضاء الفكر الإسلامي، مثل: فلسفتنا، واقتصادنا، ومجتمعنا، والأسس المنطقية للاستقراء، ودروس في علم الأصول.
[24] طه عبد الرحمن [ولد سنة: 1944]،أغلب كتابات طه عبد الرحمن تتصل بالمنطق وفلسفة اللغة والأخلاق، إلا أن في بعض منها يقارب النصّ القرآني أو أحد مواضيعه الأساسية مقاربات فلسفية، فمثلًا في مصنفه: روح الحداثة؛ المدخل لتأسيس الحداثة الإسلامية، قد خصص فيه فصلًا سماه بـ«القراءة الحداثية للقرآن والإبداع الموصول». وفي كتابه: روح الدين من ضيق العَلْمانية إلى سعة الائتمانية، تناول فيه من منظور إسلامي «العلاقة بين الدين والسياسة». وفي كتابه: سؤال العمل؛ بحث عن الأصول العملية في الفكر والعمل، بيّن في الفصل الخامس منه تفصيلًا معنى «الثقل» في الآية: 4 من سورة المزمل. وفي كتابه: دين الحياء من الفقه الائتماري إلى الفقه الائتماني، تناول جملة من المواضيع المتصلة بالقرآن، منها: تفسيره لآية الحجاب، من سورة الأحزاب: 59، في الجزء الثالث منه. وهكذا الأمر في جملة من كتبه.
[25] خصوصًا المحدد الغربالي الأساسي، وهو «التصديق» و«الهيمنة»، المؤسس على الآية: 50، المائدة.
[26] من أهم ما تتأسس عليه ثنائية الغيب والشهادة وصلة العقل بهما؛ لذلك حصر أبو يعرب المرزوقي دائرة التأويل في عالم الشهادة، ونفاه عن الغيب بنوعيه؛ غيب القرآن وغيب الخلق، كما سنبين ذلك في مقالات التأويل والمتشابه.
[27] إِذْ كلّ معنى نصّي قرآني بقدر ارتقائه الإبداعي يكون ارتقاؤه الجمالي؛ إذ هما صنوان لا يفترقان، نظير الإبداع والجمال في الخلق الرباني.
[28] تأمل النصوص الآتية: [يونس: 38]، [هود: 13]، [البقرة: 22]، [الإسراء: 88].
[29] فمن العلل البنيوية، تجد أن التفسير التأسيسي قد هيمن عليه قانون «الرواية». ومن العلل الظرفية، تجد أن بعض الفلاسفة قد عمدوا إلى نقل فلسفة الغَيْرِ جاهزةً كما هي باسم منظور «التفلسف».
[30] تعدّ فريضة استخدام «العقل» من أهم الفرائض الغائبة في فضاء الفكر الإسلامي المعاصر، بدليل ضعف الإبداع ونِسَبه ومراقيه، وتجذّر عائق التقليد بمختلف صوره. ومن المعلوم أن الأمم لا تبدع إلا من خلال استخدام «العقل» في النصوص والظواهر مادة ورمزًا، نظامًا وقيمًا. (تأمل النصوص القرآنية الآتية: [يونس: 101]، [النساء: 81]، [العنكبوت: 19]، [ص: 28]). وقد اهتم طه عبد الرحمن وأبو يعرب المرزوقي وغيرهما بسبل التمهيد لإمام الإبداع ومحاربة مسالك التقليد؛ خصوصًا على مستوى النظر الأصيل، كما سنجلي الأمر لاحقًا.
[31] اهتم ابن خلدون ببيان مجال العقل وحدوده في علاقته بالشرع المنزل تأصيلًا نظريًّا غاية في الإحكام النسقي، فقال: «واعلم أن الوجود عند كلّ مدرك في بادئ رأيه أنه منحصر في مداركه لا يعدوها، والأمر في نفسه بخلاف ذلك، والحق من ورائه. ألا ترى الأصم كيف ينحصر الوجود عنده في المحسوسات الأربع والمعقولات، ويسقط من الوجود عنده صنف المسموعات... فإذا علمت هذا فلعلّ هناك ضربًا من الإدراك غير مدركاتنا؛ لأن إدراكاتنا مخلوقة محدثة، وخلق الله أكبر من خلق الناس، والحصر مجهول، والوجود أوسع نطاقًا من ذلك...». المقدمة، ابن خلدون، ص441. «وذلك أن مدارك صاحب الشريعة أوسع؛ لاتساع نطاقها عن مدارك الأنظار العقلية، فهي فوقها ومحيطة بها لاستمدادها من الأنوار الإلهية، فلا تدخل تحت قانون النظر الضعيف والمدارك المُحاط بها. فإذا هدانا الشرع إلى مدرك فينبغي أن نقدمه على مداركنا ونثق به دونها ولا ننظر في تصحيحه بمدارك العقل ولو عارضه؛ بل نعتقد ما أمرنا به اعتقادًا وعلمًا، ونسكت عمّا لم نفهم من ذلك، ونفوّضه إلى الشارع ونعزل العقل عنه». المقدمة، ابن خلدون، ص493.
[32] هيمن النظر العقلي «الذري التجزيئي» على مختلف إنتاجات المعرفة في تاريخ الفكر الإسلامي، وقد نبّهإلى خطورة وآثار ذلك كلّ من: مشكلة الأفكار في العالم الإسلامي، مالك بن نبي [ت: 1973]، ترجمة: بسام بركة وأحمد شعبو، بيروت، لبنان، دار الفكر المعاصر، ط10، 2011، ص128، والاتجاهات الحديثة في الإسلام، المستشرق هاملتون جيب [ت: 1971]، ترجمة: هاشم الحسيني، بيروت، لبنان، دار مكتبة الحياة، ط. 1966، ص10 وما بعدها. في هذا السياق رصد حسن جابر ثلاثة مناهج لتفسير القرآن؛ الأول: منهج التفسير «التجزيئي». الثاني: التفسير «الموضوعي». الثالث: التفسير «البنائي» أو «البناء الكلي». وقد بيّن أعطاب المنهجين الأولين معًا، في حين ارتضى منهج التفسير الثالث. ويقصد به: «أخذ نصوص القرآن كوحدة معرفية وتشريعية مترابطة ومنسقة، يشدّ بعضها بعضًا، وفق بناء مكتمل ومتناغم لا يعتريه تهافت ولا يعرض له تصدّع. وينطلق هذا المنهج من مسلمة أساسية مفادها: (أن هذا القرآن واحد، وقد صدر عن واحد). فهو كلٌّ مترابط، يفسر بعضه بعضًا، ويخدم الجزءُ الكلَّ، والكلُّ الجزءَ، في وحدة متّسقة لا تعرف التعارض ولا التباين». المقاصد الكلية للشرع ومناهج التفسير، حسن جابر، القاهرة، مصر، مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي، ط1، 2007، ص31.
[33] تحرير الوعي الإسلامي نحو الخروج من السياجات الدوغمائية المغلقة، محمد أركون، ترجمة وتقديم: هاشم صالح، بيروت، لبنان، دار الطليعة، ط1، 2011، ص208، والهوامل والشوامل حول الإسلام المعاصر، محمد أركون، ترجمة وتقديم: هاشم صالح، بيروت، لبنان، دار الطليعة، ط1، 2010، ص35 وما بعدها. ويقصد بالمفهوم على وجه الإجمال،أن تُحكم مناهج التفكير بمحددات اجتهادية إنسانيةعامة؛ بحيث يمنع الخروج عن حدودها ومقتضياتها، وإلا عُدّ الخارج عنها خارجًا عن الدين نفسه أو مارقًا منه، وتُلصق به قولًا وقائلًا شتى أنواع التهم الدينية، كالكفر والفسق والبدعة والزندقة والخروج والمروق من الدين ونحو ذلك.
[34] من المفاهيم التي تحتاج إلى تأسيس نظري محكم، مفهوم «التراث الحي» و«التراث الميت»؛ سواء في سياق تاريخ الفكر الإسلامي أوعموم الفكر الإنساني، من خلال وضع قوانين عامة مجردة؛ ليكون التعامل مع النص التراثي أقرب إلى المنهج العلمي، وأبعد عن التحيّز أو التعامل الإيديولوجي أو المذهبي. ويقصد بـ«الحي من التراث» على وجه العموم، جملة الأفكار والأنساق المنهجية والمعرفية، التي تظلّ فاعلة في فضاء نظر الفكر الاجتهادي، حتى ولو انتمى مبدعها إلى زمن تأولي ماضٍ. فهي بالتبع أشبه بالتراث المتعالي منها بالمتحيز الزمكاني. وقد تحدث محمد أركون عن مفهوم «التراث الحي»، ويقصد به في هذا السياق على وجه الإجمال أن التراث ليكون من ناظم ما هو «حي»، حدد له ثلاثة شروط: تحقق وجود الاستمرارية، الثبات والديمومة، التكرار الوجودي. الفكر الأصولي واستحالة التأصيل نحو تاريخ آخر للفكر الاسلامي، محمد أركون، ترجمة وتعليق: هاشم صالح، بيروت، لبنان، دار الساقي، ط3، 2007، ص283.
كلمات مفتاحية
الكاتب:

محمد كنفودي
باحث مغربي حاصلٌ على إجازة في الدراسات الإسلامية، درجة الماجستير في فقه المهجر أصوله وقضاياه وتطبيقاته المعاصرة، وله عدد من المؤلفات العلمية والمقالات المنشورة في مجلات ودوريات ومراكز بحثية.
مواضيع ذات صلة
((المعلومات والآراء المقدَّمة هي للكتّاب، ولا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع أو أسرة مركز تفسير))