كتاب البيان في مباحث من علوم القرآن
للشيخ عبد الوهاب غُزلان
عرض وتعريف
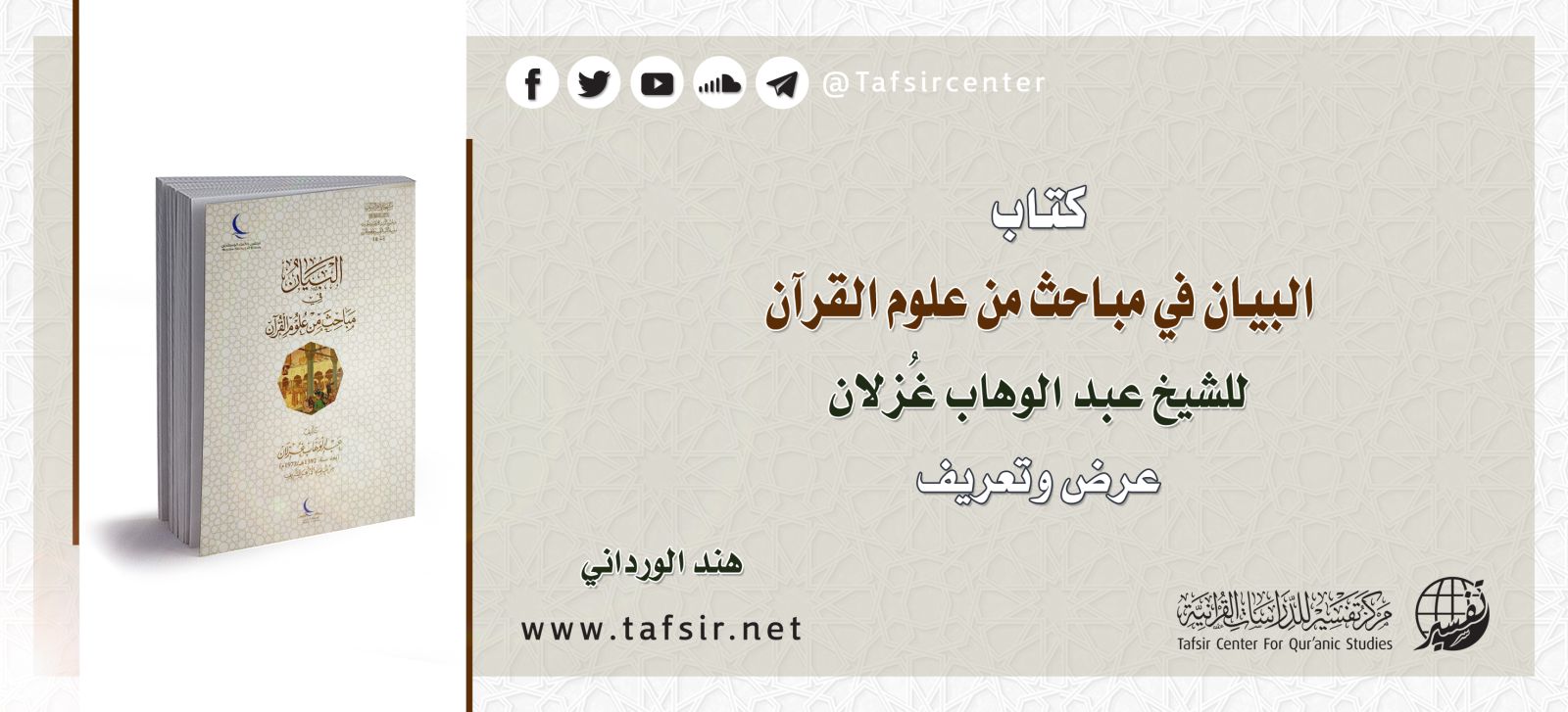
تمهيد:
يمرّ الزمانُ ولا تنقضي عجائبُ القرآن، وما زال ينبوعه عذبًا رقراقًا لكلّ من رام ماءه السّلسال. قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ يَسَّرْنَا القُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ﴾ [القمر: 22]، فسخّر -سبحانه وتعالى- لخدمة كتابه رجالًا مخلصين، حملوا على عاتقهم إيصال مقاصد القرآن ومعانيه لجماهير المسلمين، فتنافس العلماء في بيان آياته ونَشْر علومه وتوضيح أحكامه. وقد حظيتْ علوم القرآن باهتمامٍ كبيرٍ من قِبَل الباحثين، فتنوّعتْ فيها التآليف بين المتقدّمين والمتأخّرين، وفي هذا المقال نتناول بالعرض والتعريف كتاب (البيان في مباحث من علوم القرآن)، لفضيلة الشيخ/ عبد الوهاب غُزلان[1] -رحمه الله تعالى-. والداعي إلى اهتمامنا بعرض هذا الكتاب كونه أحد أهم المصادر المرجعية التي اعتمدتْ عليها كثير من مؤلَّفات علوم القرآن المعاصرة؛ فنعرِّف بهذا الكتاب، ونسلِّط الضوء على منهجه ومحتوياته، كما نعرض لأهميته وأبرز مزاياه.
القسم الأول: كتاب (البيان في مباحث من علوم القرآن)؛ عرض وبيان:
بيانات الكتاب:
اسم الكتاب: البيان في مباحث من علوم القرآن.
المؤلف: فضيلة الشيخ/ عبد الوهاب غُزلان -رحمه الله-.
الناشر:
- النشر الأصلي:
طُبِعَ الكتاب فور صدوره سنة 1382هـ/ 1962م بمطبعة دار التأليف- مصر.
- إعادة نشره:
أعاد الأزهر الشريف بالتعاون مع مجلس حكماء المسلمين بالإمارات العربية المتحدة نشر هذا الكتاب بحلّة قشيبة محقّقة (وهي الطبعة التي سنعتمد عليها في هذا التقرير).
الطبعة الأولى: 1445هـ= 2024م.
عدد الصفحات: 680 صفحة.
السبب الباعث على التصنيف:
كان قد عُهِدَ إلى الشيخ غزلان تدريس مقرّر علوم القرآن لطلبة السنة الأولى بكلية أصول الدين جامعة الأزهر، فرأى أن يضع كتابًا مستقلًّا يتحرّى فيه توفية الشرح في كلّ مقام ويوضح فيه الغرض المقصود من هذا العلم. قال المصنِّف: «فإنه لـمّا أُسنِدَ إليّ دراسة المنهج المقرّر في علوم القرآن للسَّنة الأُولى من كلية أصول الدين بجامعة الأزهر، رأيتُ أن أضع في هذا المنهج كتابًا أتحرَّى فيه إعطاء المعنى حقّه من الشرح في كلّ مقام؛ حتى يجيء كتابًا وافيًا بالغرض المقصود من هذا العِلْم، وسمّيته: (البيان في مباحث من علوم القرآن)، وأدعو اللهَ -جلّ وعلا- أن يعينني على إتمامه، وأن يجعله خالصًا لوجهه؛ إنه تعالى نِعم المعين ونِعم المجيب»[2].
منهج الكتاب:
بدأ المؤلِّف كتابه بمقدمة منهجية تأسيسية حول علوم القرآن، انطلق من بعدها إلى مناقشة عدد من المباحث المختارة في علوم القرآن، حيث يفتتح كلَّ مبحث من مباحث الكتاب بعرض التعريفات الخاصة به لغةً واصطلاحًا، ويبين فوائد دراسة هذا المبحث، ومن ثَمَّ يبدأ في عرض التفاصيل، ويهتم بعرض الآراء المختلفة حول كلّ مبحث، ويوضح الرأي الراجح طبقًا للدليل لديه، ثم يردّ على أبرز الشبهات المشهورة التي تعترض هذا المبحث.
محتويات الكتاب:
جاءت محتويات الكتاب في مقدمة تأسيسية وستة مباحث، تحت كلّ منها عدد من الموضوعات، كالآتي:
أولًا: المقدمة:
وهي مقدمة تأسيسية حول القرآن الكريم وعلومه وبيان أنواع هدايته إجمالًا، وقد جاءت في نحو سبعين صفحة، متضمّنة خمسة عشر موضوعًا، كالآتي: «القرآن والعقيدة، القرآن وتحرير العقول، الباعث للعلماء على تأليف علوم القرآن، معنى كلمة (علم) لغةً واصطلاحًا، القرآن لغةً وشرعًا، أسماء القرآن، تعريف القرآن بالمعنى الشرعي وذِكْر محترزات القيود، القرآن عَلَمُ شخص وعَلَمُ جنس، إطلاقات القرآن عند المتكلمين، ماذا يُراد بلفظ (علوم القرآن)؟ تعريف (علوم القرآن) وموضوعه وفوائده، متى عُرِفَت الأبحاث التي تسمّى علوم القرآن؟ طائفة من المؤلَّفات في الأبحاث القرآنية، منهج التأليف في كلّ بحث على حدة، متى جُمعت هذه الأبحاث في مؤلفات خاصة؟».
ثانيًا: مباحث مختارة من علوم القرآن:
وتضم ستة مباحث من علوم القرآن، تناولها الكاتب بالتفصيل، متطرقًا إلى عدد من الموضوعات، وهي:
المبحث الأول: نزول القرآن:
وهو أطول مباحث الكتاب، جاء في مائة وعشرين صفحة، متضمنًا عددًا من الموضوعات، من أبرزها: (كيفية نزول القرآن والأقوال الواردة فيه، تلقّي القرآن باللفظ والمعنى، تنجيم القرآن ودليله وحكمته، أوّل ما نزل من القرآن وآخر ما نزل منه، أسباب النزول، طريق معرفة سبب النزول، فوائد معرفة سبب النزول، الصور التي في اللفظ المنزل وسببه وحكم كلّ صورة).
المبحث الثاني: المكي والمدني:
وفيه: (فائدة معرفة المكي والمدني، الطريق إلى معرفة المكي والمدني، ضوابط المكي والمدني).
المبحث الثالث: جمع القرآن:
وفيه: (جمع القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كتابة الصحابة للقرآن، جمع القرآن في عهد أبي بكر، جمع القرآن على عهد عثمان، مقارنة تتعلّق بجمع القرآن في العهود الثلاثة).
المبحث الرابع: آيات القرآن وسوره:
تحدّث فيه الكاتب عن: (توقف معرفة الآيات على التوقيف، الخلاف في عدد آيات القرآن وسببه، فوائد معرفة الآيات، ترتيب آيات القرآن، معنى السورة، مذاهب العلماء في ترتيب السور).
المبحث الخامس: رسم المصحف:
وتضمّن الموضوعات الآتية: (الكتابة عند العرب في الجاهلية وصدر الإسلام، كتابة القرآن، أمثلة على خصائص رسم المصحف، آراء العلماء في التزام الرسم العثماني وهل هو توقيفي أو اصطلاحي؟ فوائد اتّباع هذا الرسم، حكم نقط المصحف وشكله).
المبحث السادس: آداب تلاوة القرآن وآداب حمَلته:
وتضمّن عددًا من النقاط، من أبرزها: (ما ورد في حُسن الصوت بالقرآن، مذاهب العلماء في التطريب بالقرآن، ما ينبغي للقارئ أن يأخذ به نفسه حال القراءة، أمور مختلف فيها بين العلماء، آداب ختم القرآن).
أهمية الكتاب وأبرز مزاياه:
يعدّ كتاب (البيان في مباحث من علوم القرآن) أحد أبرز مؤلَّفات علوم القرآن المعاصرة؛ فالشيخ غُزلان كان سابع العلماء الذين أفردوا كتبًا خاصة بهذا العلم في العصر الحديث[3]، ومن هنا اكتسب الكتاب أهمية كبيرة جعلته مرجعًا لمن بعده من المؤلِّفين والباحثين. يتحدّث الدكتور فضل حسن عباس -رحمه الله- عن مدى استفادته من هذا الكتاب، فيقول في كتابه (إتقان البرهان): «وهو كتابٌ دقيق فيما عرض له من مسائل، محكم العبارة، وقد أفدتُ منه في مواضع كثيرة من هذا الكتاب»[4]. ويشير إليه الأستاذ موسى شاهين لاشين في كتابه (اللآلئ الحسان)، فيقول: «وبعد السيوطي فترت الهمم وتوقّفت النهضة في هذا العلم، حتى جاء هذا العصر، وتقرّرت دراسة علوم القرآن بوصفه فنًّا مستقلًّا في كليات الأزهر وتخصّصاته العليا، وألَّفوا وأسهبوا، وكان لهم فضل كبير في تطوّر هذا الفنّ وصياغته في أسلوب عصري رصين نذكر منهم بالإعجاب والتقدير: الشيخ طاهر الجزائري وكتابه المسمّى (التبيان في علوم القرآن)، والشيخ محمود أبو دقيقة ومذكرته في علوم القرآن لطلبة تخصّص الدعوة والإرشاد، والشيخ محمد عليّ سلامة وكتابه (منهج الفرقان في علوم القرآن)، والشيخ محمد عبد الله دراز وكتابه (النبأ العظيم)، والأستاذ محمد محمد أبو شهبة وكتابه (المدخل لدراسة القرآن)، والشيخ عبد الوهاب غزلان وكتابه (البيان في مباحث من علوم القرآن)»[5].
ومن أبرز مزايا الكتاب:
1- الدقة والإحكام:
عرض المؤلِّف -رحمه الله- مباحثَ الكتاب بدقة محكمة ومهارة مُلفِتَة، ونرى ذلك من خلال عرضه واستدلاله بكتب التراث القويةِ العبارة، وكأنما عايش كُتّابها واستوعب طرقهم ومناهجهم، حتى كأنّ استحضار أقوالهم أمرٌ يسير جدًّا بالنسبة إليه. ومثاله ما جاء في كلامه عن العلاقة بين عموم اللفظ وخصوص السبب. يقول المؤلِّف: «قال الغزالي بعد أن ذكر أنّ العلماء اختلفوا في أنّ العِبرة بعموم اللفظ أو بخصوص السبب: "وقد يُعرَف بقرينة اختصاصه بالواقعة؛ كما إذا قيل: كلّم فلانًا في واقعة. فقال: والله لا أكلمه أبدًا. فإنه يُفْهَم بالقرينة أنه يريد ترك الكلام في تلك الواقعة لا على الإطلاق". وذكر الشوكاني أنه إذا قام دليل يقضي بقصر العام على سببه فلا نزاع لأحد من العلماء في قصره على سببه عملًا بالدليل. وقد صرح السيوطي بأنّ كلًّا من الفريقين يقيّد رأيه بأن لا يقوم الدليل على عكسه، وإلا وجب العمل بمقتضى الدليل»[6].
مثال آخر: قوله في مذاهب العلماء في ترتيب السور: «والقول بأنه اجتهادي نسبه السيوطي والزركشي إلى جمهور العلماء، وخالفهما الألوسي، فنسب القول بالتوقيف إلى جمهور العلماء. وذهب البيهقي ووافقه السيوطي إلى أنه توقيفي فيما عدا الأنفال وبراءة؛ فإن ترتيبهما كان باجتهاد من عثمان ووافقه عليه الصحابة. قال السيوطي: ومالَ ابن عطية إلى أنّ كثيرًا من السور كان قد عُلِمَ ترتيبها في حياته كالسبع الطوال والحواميم، والمفصل... ثم قال: "وقال أبو جعفر بن الزبير: الآثار تشهد بأكثر مما نصّ عليه ابن عطية، ويبقى منها قليل يمكن أن يجري فيه الخلاف، كقوله: اقرءوا الزهراوين؛ البقرة وآل عمران [رواه مسلم]، وكحديث سعيد بن خالد: "قرأ -صلى الله عليه وسلم- بالسبع الطوال في ركعة [رواه ابن أبي شيبة في مصنفه]»[7].
2- الاستنباط والتحليل:
من مميزات الكتاب أن المؤلِّف لا يكتفي بسرد المعلومة، وإنما يربطها بسياقها الزمني ويوضح ملابساتها، وهو منهج يضمن السلالة في الطرح والعدالة في النقد بما يُعرَف بالاستنباط والتحليل، ومثاله: أنه لم يكتفِ بذِكْر أن الصحابة كانوا حريصين على حفظ كتاب الله وتلاوته، بل أرجع ذلك إلى عدة عوامل؛ منها الطبيعية ومنها الاجتماعية ومنها الدينية. يقول المؤلِّف -رحمه الله-: «أمّا ما يرجع إلى ظروف العرب أنفسهم، فإن بيئتهم الطبيعية وما فيها من سماء صافية وشمس مشرقة وصحراوات واسعة يندفع فيها ضيق الصدر وانقباض النفس، كانت بمزاياها هذه لها أثرها الكبير في نشاط أذهانهم وصفاء قرائحهم وحدّة خواطرهم، وبهذه الصفات يكون تهيؤهم للحفظ أقوى واستعدادهم أكمل. وهناك عامل آخر كان له أثره في سلامة ملَكة الحِفْظ عندهم وقوّتها وبُعدها عن أسباب الضعف؛ ذلك أنهم كانوا في عصر نزول القرآن بعيدين عن الترف قانعين بضروريات الحياة، فلم يكن عندهم من مهامّ الدنيا ما يملأ وقتهم ويستنفد جهدهم ويرهق أفكارهم، ولا ريب أنه كلّما كان الإنسان أبعد عن الشواغل كان أقدر على الحفظ، وكان ما يحفظه أقرب إلى الثبات والاستقرار. هذان عاملان يرجع أحدهما إلى بيئة العرب الطبيعية، ويرجع ثانيهما إلى طرف من حياتهم الاجتماعية... وهناك عوامل أخرى هي ذات الشأن الكبير في هذا المقام لتعلّقها واتصالها بالقرآن نفسه، وهذه العوامل منها ما هو خاصّ بالرسول صلى الله عليه وسلم، ومنها ما هو خاصّ بالصحابة رضي الله عنهم، ومنها ما هو مشترك بين الجميع...»[8].
مثال آخر: استخدامه منهج الاستنباط في الاستدلال على كتابة القرآن بحرف قريش خلال الجمع العثماني. قال المؤلِّف -رحمه الله-: «فكان المتيسّر هو كتابته على حرف واحد، وكان حرف قريش أَوْلَى بالاختيار من غيره؛ لأنه الأصل في نزول القرآن كما قلنا، ولأن لغة قريش هي أفصح لغات العرب؛ فإنّ العرب كانوا يجتمعون في مشاعر الحج بمكة بلد قريش، وكانوا يجتمعون كلّ عام في الأسواق القريبة منها كعكاظ ومجنّة وذي المجاز للمفاخرة والتجارة والتحكيم، فتهيأ لقريش عن طريق اجتماعهم بالعرب في هذه المواطن كلّ عام أن يهذِّبوا لغتهم بأخذهم من لغات القبائل الوافدة عليهم ما خفّ على اللسان وحَسُن على السمع، حتى لطفتْ لهجتهم، وجاد أسلوبهم، واتّسعت لغتهم لأنْ ينزل بها كلام الله المعجز»[9].
3- الاهتمام بالفوائد والعلل:
يهتمّ الكتاب بعرض فوائد دراسة كلّ مبحث؛ مما يعزّز استيعاب المباحث وفهمها، ويعطي مزيد تشويق للقارئ كي ما يُقبِل عليها. ومنها: بيانه الحكمة من تنجيم القرآن الكريم، وفائدة العلم بأوّل ما نزل وآخر ما نزل، وفوائد معرفة سبب النزول، وفائدة معرفة المكي والمدني، وفوائد معرفة الآيات، وفوائد اتّباع الرسم العثماني. ولا يكتفي المؤلِّف بذِكْر علل وفوائد المباحث، بل قد يبين كذلك العلة في ترتيب بعض فصول كتابه، فيقول في مبحث النزول: «قُدِّمَ هذا البحث لأنه هو الأصل الذي ينبني عليه غيره من أبحاث علوم القرآن؛ إِذْ إنها جميعًا متفرعة على نزول القرآن، فكان من المناسب تقديمه على سائر الأبحاث»[10]، وكلّ هذا مما يدلّ على احترامه لعقلية القارئ.
4- الردّ على الشبهات:
لم يكتفِ الكاتب ببيان وعرض المباحث، بل أفرد مساحة كبيرة لبيان أشهر الشُّبهات التي قد تعترض كلّ مبحث، وقد أُوتي -رحمه الله- من قوة الحُجّة ما أهَّله لترتيب الردود وإقناع القارئ بسهولة ويُسر، فعوّضه اللهُ -سبحانه وتعالى- بنور البصيرة عن نور البصر، ولله -عز وجل- في خلقه شؤون.
ومنها: ردّه على منكري أنّ ألفاظ القرآن من عند الله، فيقول بعد ردّه بالأدلة النصية والعقلية عليهم: «فتبين بما سبق فساد استدلالهم من وجهين، وكفى بذلك ردًّا مفحمًا وتجهيلًا مخزيًا، وبما قدّمناه لك في هذا البحث يثبت ما يأتي: أ- تدلّ آيات كثيرة من القرآن على أن جبريل -عليه السلام- تلقّى القرآن بلفظه ومعناه، وأوحاه اللهُ إلى النبي صلى الله عليه وسلم بلفظه ومعناه، مثل قوله تعالى: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾ [يوسف: 2]، وقوله: ﴿وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ المُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ﴾ [التوبة: 6]. ب- ليس هناك مانع من العقل يدلّ على امتناع أن يكون في قدرة الملَك إثبات الألفاظ في القلب. ج- تدلّ بعض آيات القرآن على وقوع ذلك، بل إنّ ما استدلّوا به على الامتناع يدلّ بأدنى تأمل على الوقوع»[11].
وكذلك ردّه على الطاعنين في تواتر آخر التوبة، يقول: «والذي أراه في هذه المسألة أنه يجب أن يُراعَى ما يأتي: 1- لا يمكن أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد خصّ أبا خزيمة بتبليغ هاتين الآيتين؛ لأن الخروج من عهدة التبليغ لا يتحقّق بتبليغ واحد فقط؛ فإن الواحد يجوز عليه أن ينسى ويجوز عليه أن يقصِّر في التبليغ... 2- إجماع الصحابة على كتابتهما في المصحف لا يمكن أن يكون مستندهم فيه رواية واحدٍ فقط؛ فإنّ الخصوصية التي تلزم القرآن ولا تنفك عنه هي أنه تتوفّر الدواعي على نقله؛ لاختصاصه بمزايا تحمل على ذلك، وهي إعجازه والتعبد بتلاوته...»[12].
ورغم قوّة الكتاب وأهميته الكبيرة إلا أننا ننعى على الكاتب اقتصاره على بعض المباحث دون غيرها، فيكفي أن تعلم أنّ مبحثين ضخمين أساسيين؛ كمبحثي (الوحي والأحرف السبعة)، لم يتعرّض المؤلِّف للأول إطلاقًا، ولم يذكر الثاني سوى في صفحة ونصف الصفحة، مما زاد هذا المحور التباسًا على القارئ، وكان من المهم في مثل هذا الكتاب التصدِّي لهذين المبحثين، فهما من لُبّ علوم القرآن.
خاتمة:
طوَّفنا في هذا المقال حول كتاب (البيان في مباحث من علوم القرآن)، للشيخ عبد الوهاب غزلان -رحمه الله-؛ فعرضنا محتويات الكتاب، ومنهجه، وبينَّا جانبًا من أهميته وأبرز ما ورد فيه من المزايا، ورغم أن الكتاب كان مقررًا على طلبة السنة الأولى في كلية أصول الدين بجامعة الأزهر، في فترة الستينيات من القرن الماضي، ورغم اقتصاره على عدد محدود من المباحث، إلا أنّ الكتاب لا يصلح -من وجهة نظري- للمبتدئين في زمننا المعاصر، خصوصًا بعد تخفيف المناهج الشرعية في التعليم الأزهري؛ فهو حقًّا وجبة دسمة لا يسهل هضمها إلا على العلماء والمتخصّصين، فرحم اللهُ الشيخَ عبد الوهاب غزلان، وأعان بالتوفيق كلّ مَن سعى لخدمة كتاب الله، والحمد لله ربّ العالمين.
[1] هو عبد الوهاب عبد المجيد غُزلان، البصير بقلبه، المولود في محافظة البحيرة بمصر يوم الاثنين الثالث عشر من شهر شعبان لسنة 1324هـ، الموافق الأول من أكتوبر لسنة 1906م، التحق بمعهد الإسكندرية الأزهري بعد إتمام حفظه للقرآن الكريم، فحصل منه على الشهادتين الابتدائية والثانوية، ثم التحق بكلية أصول الدين شُعبة التفسير والحديث، واستمر بها حتى نال الإجازة العالية بتفوق سنة 1354هـ= 1935م، عمل بعد تخرجه مدرسًا في المعاهد الأزهرية، وحصل على الشهادة العالمية (الدكتوراه) في التفسير سنة 1360هـ= 1941م، ثم عُيِّن ضمن هيئة التدريس بكلية أصول الدين سنة 1370هـ= 1951م، وتدرّج في المناصب حتى نال درجة الأستاذية. من شيوخه: الشيخ محمود أبو دقيقة، والشيخ محمد أحمد عرفة، ومن أبرز تلاميذه: د. فضل حسن عباس، د. نور الدين عِتر، د. أحمد معبد عبد الكريم. لا يُعلَم له مؤلَّف سوى كتاب (البيان في مباحث من علوم القرآن) الذي بين أيدينا، غير أنه اشترك مع زميليه بالكلية؛ أستاذ التفسير وعلومه أحمد السيد الكومي، وأستاذ الحديث وعلومه محمد عبد الوهاب بحيري في عمل تقرير عن كتاب (الجمع الصوتي الأول للقرآن الكريم، أو المصحف المرتل: بواعثه ومخطّطاته) للبيب السعيد (ت: 1408هـ= 1988م)، وكان صدور هذا التقرير سنة 1387هـ= 1968م. أمّا عن وفاة الشيخ فلا نعلم تاريخًا محدّدًا لوفاته، لكن المؤكّد أنه كان حيًّا في 1392هـ= 1972م، حيث حضر مناقشة رسالة الدكتوراه لتلميذه فضل حسن عباس، وعليه يكون قد تُوفي في السنة نفسها أو بعدها بقليل، فرحمه الله تعالى رحمة واسعة.
انظر: البيان في مباحث من علوم القرآن، عبد الوهاب غزلان، تحقيق: مجموعة من العلماء بمكتب إحياء التراث الإسلامي- مشيخة الأزهر، مجلس حكماء المسلمين، أبو ظبي، الطبعة الأولى: 1445هـ= 2024م، (م 23- 30) [باختصار].
وانظر أيضًا: التعريف بالشيخ عبد الوهاب غزلان، ملتقى أهل التفسير، بقلم الدكتور ياسر مرسي:
https://mtafsir.net/threads/التعريف-بالشيخ-عبدالوهاب-غزلان.89317//
[2] انظر: البيان في مباحث من علوم القرآن، ص3.
[3] أولهم: الشيخ طاهر الجزائري، وتلاه الشيخ محمود أبو دقيقة، والثالث: الشيخ محمد عليّ سلامة، والرابع: الشيخ محمد عبد العظيم الزرقاني، والخامس: الشيخ محمد عبد الله دراز، والسادس: الشيخ محمد أبو شهبة. [انظر: البيان في مباحث من علوم القرآن، ص: (م 8)].
[4] إتقان البرهان في علوم القرآن، فضل حسن عباس، (1/ 11- 12).
[5] اللآلئ الحسان في علوم القرآن، موسى شاهين لاشين، ص8.
[6] انظر: البيان في مباحث من علوم القرآن، ص191.
[7] البيان في مباحث من علوم القرآن، ص352.
[8] البيان في مباحث من علوم القرآن، ص232- 233.
[9] البيان في مباحث من علوم القرآن، ص326- 327 (باختصار).
[10] البيان في مباحث من علوم القرآن، ص77.
[11] البيان في مباحث من علوم القرآن، ص98.
[12] البيان في مباحث من علوم القرآن، ص268- 269 (باختصار).


