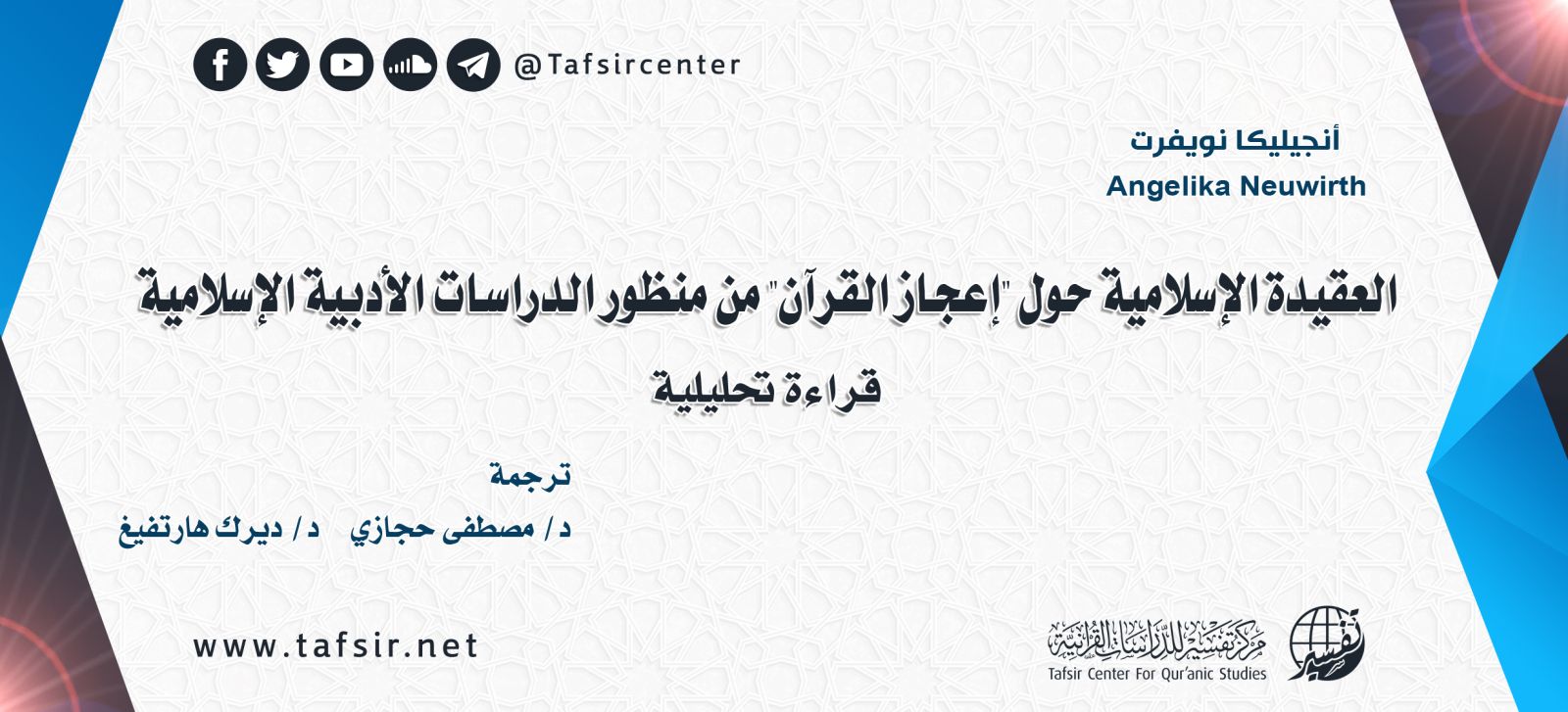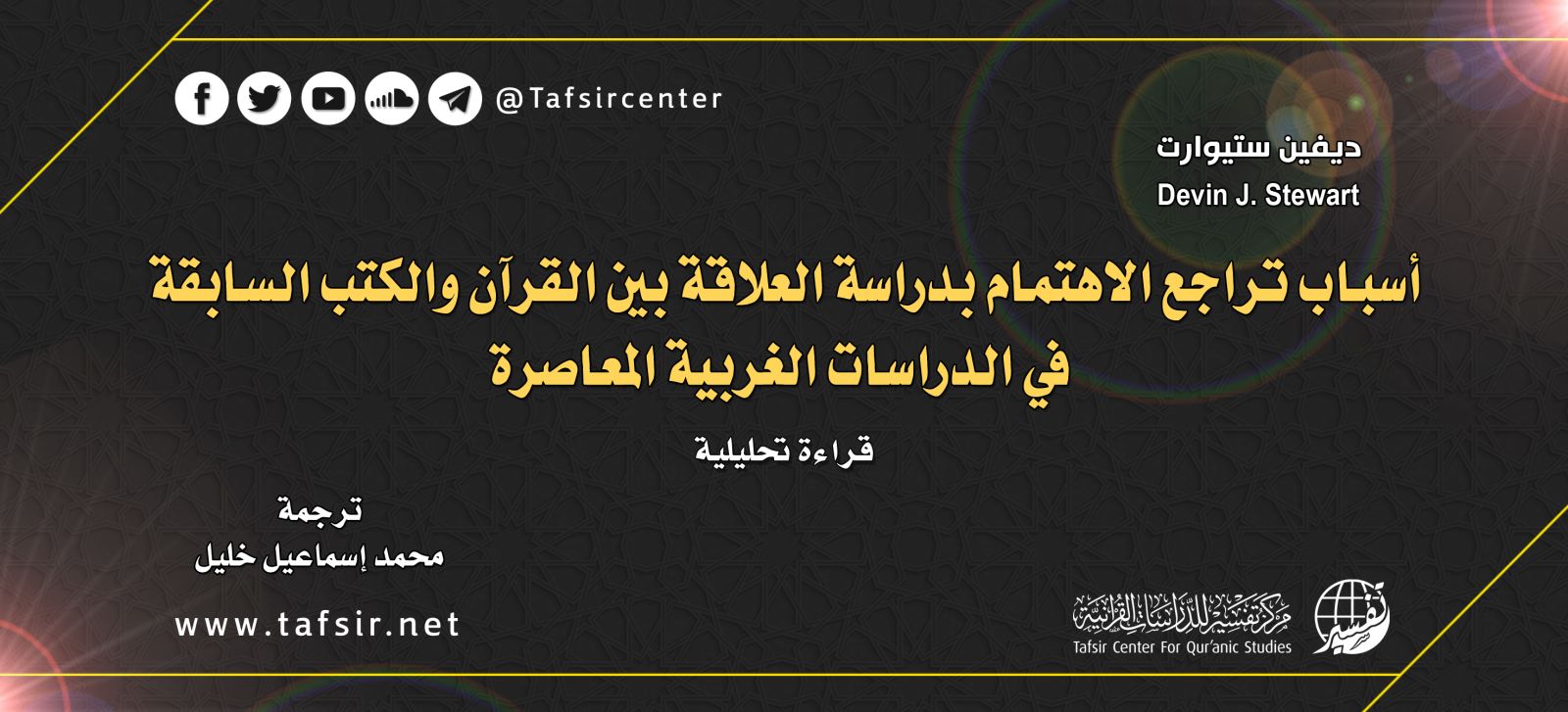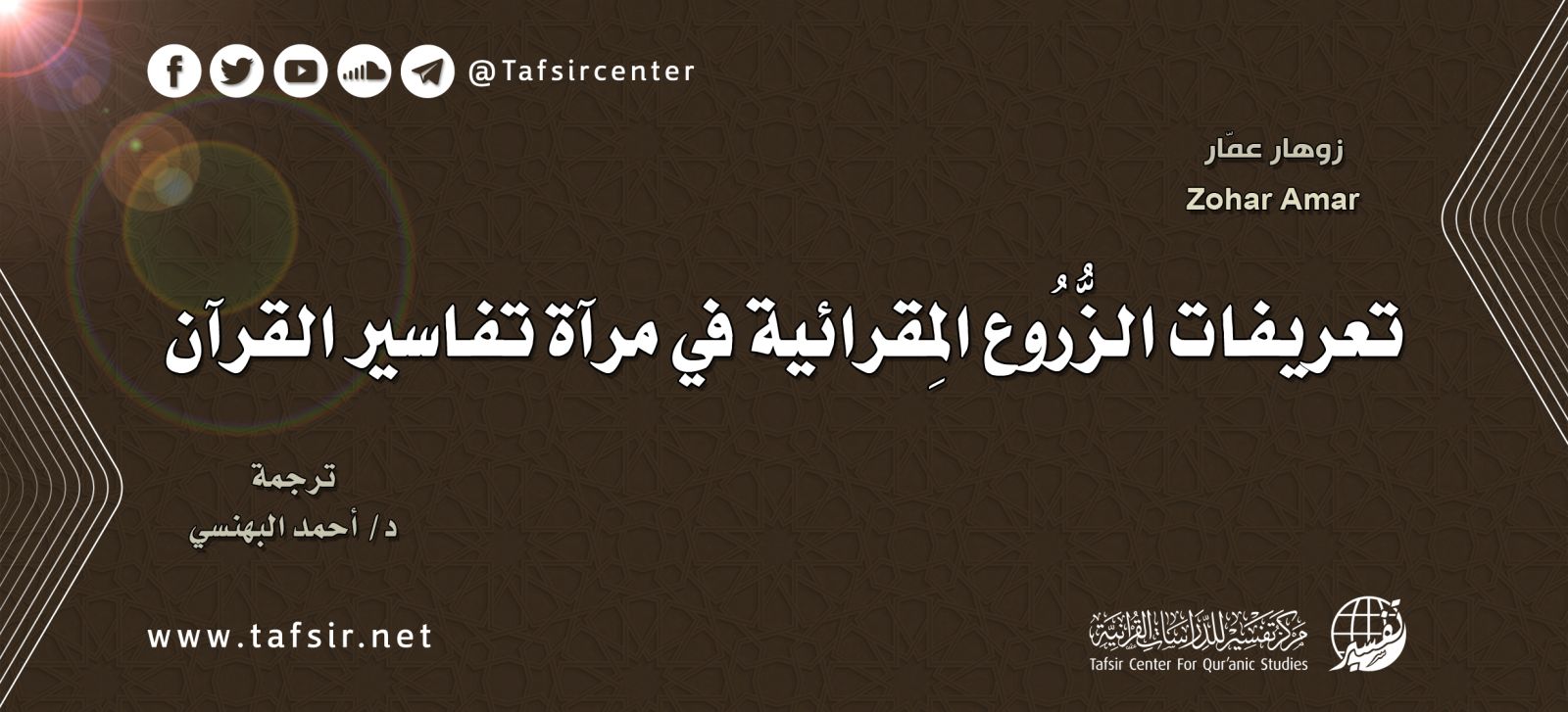النصّ المقدّس، الشعر، وصناعة المجتمع: قراءة القرآن كنصٍّ أدبي. لأنجيليكا نويفرت
قراءة القرآن كنصٍّ أدبي. لأنجيليكا نويفرت

يمكننا في الدراسات القرآنية، صوغ مُزْحة مماثلة لتلك المُزْحة القديمة في الدراسات الكتابية التي تقول: «ما هي أهم اللغات السامية؟ الألمانية». فبرغم العدد الكبير للدراسات القرآنية المكتوبة بالعربية والإنجليزية، إلا أن أهمّ الإسهامات الدراسية الغربية في دراسة القرآن كُتبت بالألمانية، بداية من أعمال جيجر[1] ونولدكه[2] وفلهاوزن[3] وغيرهم في القرن التاسع عشر، حتى يومنا هذا.
وقد حصل تقدّم عظيم في العقود الأخيرة في ترجمة الدراسات القرآنية المكتوبة بالألمانية إلى الإنجليزية، مما وفّر على غير الألمان جهدَ البدء من الصفر مرّة أخرى، وهو ما حدث للأسف -وما سيستمر في الحدوث- كثيرًا. فقد تُرجم للإنجليزية كتاب جولدتسيهر[4] مذاهب التفسير الإسلامي (1920) عام 2006. وكذلك في 2013 تُرجم للإنجليزية كتاب نولدكه تاريخ القرآن (1860، 1909-1937)، الذي بإمكاننا القول بأنه أهمّ أعمال الدراسات القرآنية الغربية. كما أسهمت الموسوعة القرآنية -جزئيًا- في إتاحة وصول الدراسات القرآنية الألمانية على مدى قرنٍ ونصف من الزمان لقاعدة جمهور أوسع. وحتى الآن فإنّ عملية الترجمة لم تنتهِ حتى بالنسبة إلى الأعمال الأقدم؛ فدراسات مهمّة مثل الدراسات القرآنية لإبراهام هوروفيتز (1926)، والقصص التوراتية في القرآن لهاينريش شباير[5] (1931) لم تترجم بعد. يعتبر المجلد الحالي إسهامًا مهمًّا لهذه العملية، والأهمّ من ذلك أنه يجمع أربع عشرة ورقة من الأوراق البحثية لأنجيليكا نويفرت المنشورة بين عامي 1990 و2012، سبع منها نُشرت في مختلف الأعداد المُحرّرة، والتي -حتى الآن- لم تتوفر سوى باللغة الألمانية.
وبمقدمة للكاتبة، جعل ذلك المجلد الأفكار الرئيسة لنويفرت في المتناول بينما ينتظر الباحثون في هذا المجال ترجمة لكتابها القرآن كنصّ من العصور القديمة المتأخرة: مقاربة أوروبية (2010)، الذي يلخص الدراسات القرآنية الغربية حتى الآن، وربما الكتاب الوحيد في هذا المجال الذي يمكن للمرء أن يقول بأنه حل محل (تاريخ القرآن) لنولدكه. (يأمل المرء أن يختلف مصير هذا العمل عن مصير كتابها (دراسات حول بنية السور المكية 1981-2007) الذي لم يُترجم ولم يحظَ بالاهتمام الذي يستحقه).
وفي تقديمها للعمل (ص19، ص40) وفي أولى دراساتها «لا من الشرق ولا من الغرب تحديد موقع القرآن في تاريخ الدراسات» (ص3، ص52) توضّح نويفرت مقاربتها بشكلٍ عامٍّ للقرآن مع إعطاء موجز للدراسات القرآنية في أوروبّا، وتظهر نتائج ذات صلة بها في الدراسات الثلاث عشرة الأخرى. تقدّم الدراسات المنشورة في هذه المجموعة العديد من الأفكار التي تعدّ بمثابة جسر لفهم كتابها «القرآن كنصّ من العصور القديمة المتأخرة»، وبالتالي، فإنّ إصدارهم يمثّل فرصة للتفكُّر بشكلٍ عامٍّ في مناهج نويفرت وأسسها التفسيرية واستنتاجاتها الأصيلة.
وجدير بنا الإشارة إلى أن ميزة أساسية في منهج نويفرت هي استخدامها المفرِط للدراسات السابقة، والألمانية على وجه الخصوص، والتي تجاهلها غيرها. ولقد أُهْمِلَت الدراسات القرآنية في هذا المجال؛ بسبب الحواجز اللغوية من جهة، ومن جهة أخرى بسبب ندرة بعض الدراسات المبكّرة. ومن الممكن إيعاز الاستخدام المتقطّع للدراسات السابقة إلى افتقار الحقل إلى التتابع.
وفي هذا السياق تعطي نويفرت اهتمامًا خاصًّا للتشتّت الذي تسبب به تهجير العلماء اليهود من ألمانيا النازية في ثلاثينيات القرن العشرين، ولكن يمكننا إضافة أن أغلب الباحثين في علوم القرآن من الأوروبيين والأمريكيين الشماليين في ثلاثينيات القرن السالف، فضلًا عن مترجمي النصّ المقدّس، قد تخصصوا في مجالات فرعية أخرى من الدراسات الإسلامية والعربية، لكنهم عملوا في الدراسات القرآنية كمشروع فرعي وفي عزلة نسبية. وبشكلٍ أقرب إلى صناعة بدائية تفتقر إلى المعيارية، مَالَت الدراسات القرآنية بسهولة لتركّز على نفسية النبيّ أو التفاسير القرآنية على يدِ عددٍ صغيرٍ من الباحثين. لم يكن هنالك أيّ برنامج دراسي أو منهاج للدراسات القرآنية غربًا، ولم يضع الباحثون في مجال الدراسات القرآنية في اعتبارهم أيّة قاعدة معتمدة للكتابات العلمية، أو لمجموعة مهارات محددة مطلوبة منهم لولوج هذا الحقل؛ أسفر عن ذلك: تقدّم الدراسات القرآنية -كتخصص- على نحوٍ متقطّع ومتردّد، وخروج أجيال لا تمتلك القاعدة التي بُنيت عليها أعمال أسلافهم. ويبدو أنّ الوضع قد تغيّر على مَرّ العقدين الأخيرين، فمع تأسيس مجلة الدراسات القرآنية في لندن، ومشروع كوربس كورانيكوم في برلين، وجمعية الدراسات القرآنية في الولايات المتحدة، ومع نشر موسوعة القرآن، أصبحت الدراسات القرآنية مجالًا فيه التواصل المنتظم والتدريس وشبكات الاتصال والدوائر البحثية قاعدة أكثر منها استثناء، ومن هنا فصاعدًا، يأمل المرء أن ينتج عن هذا الإطار المؤسسي باحثون ودراسات بشكلٍ مستمرٍّ ومنتظمٍ. ورغم أن هذا لا يضمن تقدمًا سلسًا، إلا أنه من المرجّح أنّ الباحثين الجدد في المجال سيجدون أمرَ تحديد الأعمال المُنجزة في الدراسات الغربية المبكّرة يسيرًا، بما في ذلك الدراسات المنشورة بالألمانية. (وما زال هذا يتسبّب في إهمال عددٍ كبيرٍ من الدراسات المكتوبة بالعربية وغيرها من اللغات الإسلامية، والتي تهمل عادة بسبب المزيد من حواجز التواصل).
لا تشارك نويفرت الكُتّاب الآخرين في الدراسات القرآنية ممانعتهم العنيدة لتقبُّل الاختلافات الأيديولوجية والمنهجية السابقة، الأمر الذي أضرَّ باستمرارية وتراكم الدراسات القرآنية. فقد تُرِكَتْ دراسات ماتعة وأصيلة في مهبّ ريح النسيان بعد نقدها من قِبَلِ المراجعين بسبب بعض السّمات المحدّدة التي تجاوزت خطًّا أيدولوجيًّا وهميًّا، وهكذا تم تجاهل الإسهامات الفعلية والمقترحات المطروحة. ويعتبر كتاب دافيد هاينريش مولر[6]: الأنبياء في صورتهم الأصلية (1896) مثالًا ساطعًا على ذلك. وقد تجاوز مولر الحدود حين ادّعى أن الأساطير البابلية القديمة والنصّ التوراتي المقدّس والسور القرآنية وحتى الجوقات اليونانية قد صيغت على هيئة مقطوعات من الشعر الغنائي، محتجًّا بأن هذا البناء الشعري كان من سمات الخطاب النبوي السامي منذ أزمان غابرة. ورفض الباحثون الذين استاؤوا من هذه الأطروحة الراديكالية هذا الكتاب رفضًا صارمًا، ولكن اعتراضهم الجوهري الأساسي كان ضعيفًا وتعسفيًّا نوعًا ما: بأنّ ادعاءه حول المقطوعات الشعرية ليست منتظمة بشكلٍ كلّي، فتتفعّل على سبيل المثال على الأوزان 6, 8, 7 بدلًا من 8, 8, 8.
وبتنحية واقع أنّ مثل هذا الاعتراض كان ممكنًا التعبير عنه بأكثر من طريقة - جانبًا، فإنّ مولر قد قدم العديد من الملاحظات القيّمة حول القرآن والتركيب البنائي للسور والعلاقة بين مقاطعها/ أجزائها، والتي كانت معقولة إلى حدٍّ ما برغم عدم تقبُّل المرء لتعريفه للمقطوعة الشعرية. ومن وجهة نظري، تعتبر نويفرت هي الباحثة الوحيدة في مجال تاريخ الدراسات القرآنية التي حَقّقَت استخدامًا سليمًا لعمل د.هـ. مولر، والذي ظهر بوضوح على خلفية كتابها دراسات حول تكوين السور المكية. المجلد الحالي يظهر كثيرًا من الحالات المماثلة، مثل بحثها حول الوصايا العشر في القرآن، الأمر الذي يوضح كيف لم تكتفِ كثيرٌ من الدراسات الحديثة بالتجاهل التامّ للدراسات المبكرة لهيرشفيلد[7] وشباير، بل فشلَتْ أيضًا في الاستشهاد ببعضها بعضًا.
وتستخدم نويفرت في المسائل المنهجية كلامًا واضحًا غير متوارٍ: «يجب أن ينصبّ اهتمام المُفسر على النصّ القرآني نفسه في المقام الأول». وتُولي هذه الدراسة (الأدبية) اهتمامًا لشكلِ النصّ وتكوينه وأساليبه وبلاغته وغيرها من الخصائص التي ترتكز عليها. وهي تُعارِض هذه الدراسات (التاريخية) و(اللغوية)، التي تبدأ خارج النصّ وتفرض عليه هياكل أو قواعد غريبة، وتنتج تفسيرات غير دقيقة على أقلّ تقدير. وبشكلٍ عامّ، هناك تيار من نفاد الصبر تجاه اللغويين والمؤرخين (مثال ص21)، هؤلاء الذين يتخطّون حدودهم بإصدارهم عبارات نَزِقة حول النصّ القرآني دون اتخاذهم الوقت الكافي لإجراء تحليل باطني شامل للنصّ. والمغزى أنهم ليسوا قادرين على ذلك، إِذْ إن هذا المجال هو المجال المناسب لعلماء الأدب الموهوبين بالحسّ النقدي المناسب لهذا العمل.
ليس من المفاجئ إذن أنْ يظهر الشعر في تحليل نويفرت بشكلٍ واضحٍ. وتعزو كلمة (الشعر) في عنوان المجموعة إلى السمات الشعرية في النصّ القرآني التي لا ينبغي على المترجمين التغافل عنها، وإلى الأساليب الشعرية السابقة للإسلام والتي تلقي الضوء على سمات قرآنية بعينها. وتشير (نويفرت) إلى الربط بين فكرة (الأمم الخالية) في القرآن و(الأطلال) في القصيدة الشعرية. كما أنها تلفت الانتباه إلى غير ذلك من الأمثلة، مثل: مقارنة معارضة النبيّ في السورة (17-22 الإسراء)، مع صورة شخصية اللائم -في الشعر الجاهلي- الذي ينتقد البطل/ الصعلوك على المخاطرة من منظور عملي[8]. كما تتضمن الدراسات الموجودة في الكتاب كثيرًا من الأمثلة على القراءات الأدبية المتبصرة/ المتعمقة، خصوصًا تحليل سلسلة الأقْسَام (جمع قَسَم) في مفتتح كثير من السور المكية (الصور والاستعارات في الأجزاء الاستهلالية للسور المكية، ص102-137)، والتي تربط بين الأفكار التي استحضرتها الأقْسَام وبين الأفكار المقدّمة في هياكل تلك السور.
كما تجادل نويفرت من أجل الاستفادة النقديّة من التراث الإسلامي، بما يشمل التفسير والسيرة، بدلًا من تجنبهما باعتبارهما اختراعًا متأخرًا، وهو المنهج الذي اتخذه بعض الباحثين في المجال والرافض لدراسة القرآن من خلال منظور التعليقات/ التفاسير المتزايدة حوله، والتي يرونها تنتقص التركيز على القرآن، أو ساقطة في فتنة (نظرية التلقّي)، أو متساهلة في قبول وجهات النظر التقليدية عن السلطة. عمومًا، فإنّ تحقيقاتها (نويفرت) تعمل على خَلْق استخدامٍ حريصٍ وانتقائِيّ للتفسير وغيره من المؤلفات المعنيّة بعلوم القرآن، معتمدة إلى حدٍّ كبيرٍ على التحقيق المستقلّ في النصّ. والوحدة الأساسية للتفسير هي السورة أكثر من الجملة أو الآية أو القصة/ الوحدات السردية، والتي يتساهل الآخرون في الاستشهاد بها دون إعارة الانتباه إلى السياق الذي تتضمنه. فقد هدفت السورة منذ البداية إلى وحدة التبليغ والاستقبال. وشرطٌ أساسيٌّ لدراسة القرآن دراسة أدبية جادة، هو الاستدلال على معنى المقاطع الأقصر من السورة من الرسائل التي تؤديها للسورة ككلّ وتركيزها على السورة ككلّ، أكثر من التركيز على وحدات أقصر مبتسرة من السياق العامّ للنصّ. هذا على الرغم من وجود الزيادات وغيرها من الغرابات النصيّة، التي تعتبر دلالات على التعديل أو التنقيح. وكانت هذه الزيادة من وجهة نظرها ثمرة نمو الحوار مع المتلقي، وهكذا أصبحت الزيادة جزءًا لا يتجزأ من النصّ المعتمد.
وتحاجج نويفرت عن قراءة لا تزامنية لسور القرآن، باعتبار القرآن سجلًّا لتفاعلات معقَّدة بين المبشِّر ومجتمعه، وقد تغيّر النصّ بمرور الوقت كما تغيّر المجتمع، وهي لا تقبل كرونولوجية نولدكه بوضعها كما هي، ولا غيرها من دراسات التراث الإسلامي الكرونولوجية، معترفة بأنّ أمر الكرونولوجي الصوتية غير محسوم بعدُ. وتدعم نويفرت فكرة إمكان إنتاج مثل هذه الكرونولوجيا، وواحدة من مهامّ مشروع كوربس كورانيكوم هي استحداث كرونولوجيا جديدة، ستبدو كما لو أنها نسخة معدَّلة من كرونولوجيا نولدكه بنفس الفترات الزمنية الأربع: الفترة المكية في أوّلها وأوسطها وآخرها، والفترة المدنية. ويمكن للمرء في الوقت الراهن أن يقوم بتطبيق الدراسات اللاتزامنية حول موضوعات معيّنة، مثلما هي الحال في مناقشتها لروايات مريم ويسوع التي يعتبر تأريخها النسبي آمن (مريم ويسوع: موازنة البطاركة الإنجيليين. إعادة قراءة لسورة مريم في سورة آل عمران ص159-384) ومناقشتها حول معالجة موسى في (السرد كسيرورة للتثبيت: قصة موسى مقروءة من منظور التاريخ المتطور للقرآن). ومع وجود نقاد الشكل الكتابي، ترى نويفرت أهمية كبيرة لتحديد الوضعية الاجتماعية للسورة [9] Sitz im Leben من أجل تقديم تفسير جادّ. وقد كان التحوّل الرئيس في دراستها اللاتزامنية وثيق الصلة بالوعي المتزايد بالنصوص والعقيدة اليهودية والمسيحية.
واقترح كلود جيليو[10] رأيًا قائلًا بأن القرآن يضمّ بعض مظاهر العمل الجماعي وليس مؤلَّفًا بصورة فردية؛ إِذْ يجمع القرآن سجلًّا لمحادثات معقدة بين المُبَشِّر وجمهوره، بما فيها من حجج واتهامات واعتراضات وردود، مُظهرة تكيّف الأفكار ونموّها عبر الزمن. وفي هذا الأساس شديد الحركية ترسخ القرآن عبر عملية التثبيت فحسب. وبالاعتماد على منهج النقد المعتمد لـ(بريفارد تشايلز)، فرّقت نويفرت بين القرآن المُثبَّت، الذي توقّف عن التطور وأصبح مُفسَّرًا بطرق تقليدية محددة وفقًا للتراث الإسلامي، والقرآن قبل تثبيته الذي تطوّر على مختلف المراحل. وترتبط أطروحتها الأكثر جرأة وأصالة بهذا التطور، والذي تراه له صلة بصناعة المجتمع. ويتشابه عملها في بعض جوانبه مع المفسرين الألمان أمثال رودولف بولتمان[11] في Formgeschichte والذي استخدم النقد الشكلي للأناجيل الإزائية ليُلقِي الضوء على تشكيلِ المجتمع المسيحي المبكر Gemeindebildung. وتفرِّق نويفرت بين مختلف مراحل تطوّر المجتمع، كلّ منها يرتبط بالسورة بشكلٍ أو نوع معيّن، وكلّ منها يرتبط بمرحلة من تطوّر الشعائر الإسلامية. وبالنسبة إليها فإنّ سياق العبادة هو الوضعية الاجتماعية الأساسية؛ في المرحلة الأولى: ربما قد أبلغ الرسول رسالة الوحي إلى عددٍ صغيرٍ، كما هو متمثلٌ في السور المكية الأولى، وشدَّدت السور في هذه المرحلة على مكة وحرم الكعبة ووضع العرب وعاداتهم، وقد تشابه أسلوب هذه السور مع أسلوب الكُهّان في الجاهلية. وتقترح نويفرت أنّ من الممكن أن تكون هذه السور تمَّ أداؤها باتصالٍ مع الأشكال المكية للعبادة في أوقات محدَّدة من اليوم، وتُشير نويفرت إلى كثيرٍ من الآيات المرتبطة بصلاة طقسية، تصاحبها قراءة القرآن أو الرسالة كدليل على ذلك.
في المرحلة الثانية: الفترة المكية المتأخّرة، تحوَّل الاهتمام إلى التقليد الكتابي، اتخذت الأيمان الاستهلالية موقعًا واضحًا من النصّ المقدّس، وشغلت قراءة الفاتحة منصب الافتتاح لأيّ طقس ديني. والسور الأطول في هذه الفترة والتي قدّمت قصص أنبياء الكتاب المقدّس شكّلَت أساس الصلاة الطقسية/ الليتورجية، تشابهت الصلاة مع الطقوس اليهودية والمسيحية حيث قُرئت على المصلين أجزاءٌ من الكتاب المقدّس بصوت جهوري، وتغيّر الأسلوب ليصبح الكتاب المقدس أكثر ثقلًا. وظهرت ميزة نصيّة جديدة وهي خواتم الآيات بجُملٍ تقدِّم في الغالب ملاحظة غير مباشرة تحثّ المتلقي على التفكُّر في الله وأوامره وتنفيذ هذه الأوامر، ومن الواضح أنه قد تمَّ تسجيل رسائل الوحي كتابةً من قِبل المجتمع، وجاء مع ذلك التشديد على السلطة المرهونة بالكتابة، ومع التشديد على الكتابة، حُوِّلَت القِبلة إلى القدس، وتركَّز الاهتمام على الأرض المقدّسة بدلًا من جزيرة العرب.
جاءت المرحلة الثالثة: أثناء الفترة المدنية، التي شهدت نشوء نوعٍ جديد من السور، وهي سور الخطابات. فقد مثّلَت خطابات النبيّ تحوُّلًا في طبيعة العبادات الجماعية، وانخفضَت أهمية القصص التوراتية، كما أفسح التركيز على الطقوس القائمة على التقليد التوراتي مجالًا للتركيز على مخاوف المجتمع المعاصر. وأخيرًا، فإن النوع الأساسي الأخير من السور هو السورة الطويلة، المتمثلة في السور المدنية الأطول والتي لا تقدِّم بعضها هيكلًا تركيبيًا واضحًا، وتتضمن أجزاءً تتناول العديد من الموضوعات المختلفة. وبينما العملية التي تمَّ بها الجمع ما زالت غامضة، فإنها تعكس مرحلة حيث كان يجب افتراق طرُق كلٍّ من السورة وطقوس العبادة[12]، حيث كانت السور أطول من أن تشكِّل جزءًا من طقوس العبادة. بينما السور الأطول كانت بمثابة بلاغات عامّة تتعلق بالرسائل الاجتماعية والسياسية الملحّة، اعتمد المؤمنون على السور الأقصر للأغراض الليتورجية.
وتختلف نويفرت في كثيرٍ من الحالات مع استنتاجات جاء بها المستشرقون سابقًا، فتّتفق مع الرؤية التقليدية عندما تبرّر رؤيتها للأدلة النصيّة غير المأخوذة في الاعتبار في المصادر التقليدية. فتتفق -على سبيل المثال- مع الرؤية التقليدية القائلة بأن تلك السَّبْع المثاني المذكورة في سورة الحِجْر؛ إنما تشير لسورة الفاتحة، وقد رفض كثيرٌ من الباحثين المتقدِّمين هذه الرؤية، ومن الواضح أن هذا التقليد تسبّب في التلاعب في نَصّ الفاتحة ليصبح عدد آياتها سبعًا بدلًا من ستٍّ؛ لكي تتفق مع الآية المذكورة[13]. واقترح هوروفتس، وغيره مِنْ بعدِه، أن هذه السبع المثاني تشير إلى قصص العقاب التي ظهرت مِرارًا في القرآن. علاوة على ذلك، فإنها تجادل بأنّ استخدام الرقم (سَبْعة) هنا أمر تقريبي، وأن آثار نصّ سورة الفاتحة في سورة الحِجْر تُثْبِت الرؤية القائلة بأن الآية (87) من سورة الحِجْر إنما تشير إلى سورة الفاتحة. وقد عبّر المستشرقون عن شكوكهم حول الآية الأولى من سورة الإسراء، المرتبطة برحلة إسراء النبيّ إلى القدّس، مقترحين أنها -الآية- ربما أُضيفت للسّورة لاحقًا، منوِّهين إلى عدم تتطابق قافية هذه الآية مع قوافي الآيات التالية لها.
وبرغم ذلك، فإنّ نويفرت تجادل على أساس الدليل النصّي المذكور لاحقًا في السورة باعتباره حقيقيًّا وأنه يربط النبي بالقدس بطريقة مباشرة. وفي حين أنني أراه احتمالًا بعيدًا أن تكون السبع المثاني إشارةً للفاتحة، أو إشارة سورة الإسراء لرحلة الإسراء بالنبي إلى القدس (الرحلة الليلية)، إلا أنه من الضروري الآن أن نعالج الأمر بحجج مضادة أكثر جوهرية.
وقد انتقدت نويفرت المختصّين بالسيريانيات -من بعد صدور كتاب كريستوف لكسنبرج[14] الصادر بالألمانية سنة 2000- والذين سعوا خلف إيجاد عناصر سيريانية/ آرامية في النصّ القرآني. فبينما تتّفق على أنّ القرآن قد تأثّر بالنصوص المسيحية، فإنها ترى الباحثين المهتمّين بتعيين تناصٍّ سيريانيٍّ -إيجاد ترابط ما بين النصوص السيريانية وبعض المقاطع القرآنية- قد تمادوا في الأمر كثيرًا. وتقول إنهم تجاهلوا بشكلٍ عامٍّ السياقات القرآنية التي تظهر فيها هذه العناصر المسيحية وتفشل في النظر في كيفية إعادة تشكيلها لأغراض بلاغية ولاهوتية بعينها. كذلك فإنّ المختصّين بالسيريانيات وقعوا في خطأ راديكالي في صوغ تحقيقاتهم، بانتهائهم إلى محاولة إظهار القرآن تحفة مقلّدة للاهوت المسيحي أكثر من كونها استجابة لاهوتية أصيلة للفكر اليهودي والمسيحي وغيرهما من الأفكار الرائجة أثناء هذه الفترة. وبالنسبة إليَّ، فإنّ الخطر الذي تراه نويفرت في مثل هذا الخطاب مبالَغٌ فيه؛ إِذْ يمكننا النظر للدراسة الغربية للقرآن باعتبارها خوض حرب تاريخية خاصّة بالتأثّر التكويني للقرآن، فأكّد بعض الباحثين -مثل: جيجر وسبيرو وهورفتس[15] وتوري وشباير وغيرهم- التأثير اليهودي، بينما أكّد غيرهم على التأثير المسيحي، مثل: ويلهانسون وأندريا[16]وبيل وغيرهم. وقد بالغ كِلَا الفريقين، خاصّة عند إنكار كلّ منهما لدليل الآخر، أو التقليل من شأنه. والدراسات السيريانية ليست ظاهرة جديدة، ولكنها تقدّم ببساطة آخِر تأرجُح للبندول نحو التأثير المسيحي، وقد تمادوا كثيرًا في جدالهم وغالوا في تقدير مدى التأثير المسيحي، ولكنهم على غرار مَن سبقوهم في كِلا حَدَّي الجدال، قد أشاروا إلى بعض الأمثلة الجديدة للعلاقة بين القرآن والنصوص السابقة له، كما ألقوا ضوءًا جديدًا على فقرات محدّدة من القرآن.
والجدال الواقع بين الجانبين هو -حتمًا- ثنائية خاطئة، حيث إِنّ القرآن يعتمد بشكلٍ واضحٍ على التقليدين اليهودي والمسيحي، وذلك يشمل التناخ -الكتاب المقدس العبري-، والأناجيل، والنصوص اليهودية والمسيحية المتأخرة. كما تجاهل كِلا الطرفين -في كثير من الأحيان- التقاليد الوثنية قبل الإسلام التي تركت تأثيرًا جليًّا في القرآن. كما تنادي نويفرت بمنهج أكثر إنصافًا؛ وللقيام بذلك، فإنها تتبنى مصطلح (العصور القديمة المتأخرة) كنوع من الاختزال، والذي يخدم الكثير من الأهداف في الوقت ذاته؛ أولًا: لأنه يشير إلى أنّ القرآن اعتمد على التقاليد اليهودية والمسيحية والوثنية والتوفيقية، دون التشديد على تأثير أيّ تقليدٍ منها في إقصاء تأثير التقاليد الأخرى. ثانيًا: لأنه يتفادى الادعاء القائل بالاقتباس المباشر، أو الحذف العشوائي من النصوص اليهودية أو المسيحية، مقترحًا -عوضًا عن ذلك- أنّ القرآن قد قام على مجموعة من المواد المتداولة في هذا الزمن بشكلٍ عامّ في ثقافات الشرق الأدنى. وثالثًا: لأنه يضع القرآن في منزلة متساوية مع كلّ من التناخ والعهد الجديد، متجنبًا اعتبار القرآن نصًّا مشتقًا؛ لفهمه يجب تحديد (مصادره) الرئيسة. ولكن على العكس، فالقرآن عمل أصيل، يُضمّن رموزَ وقصصَ ومفاهيمَ التقاليد التوراتية وغيرها من تقاليد الشرق الأدنى، ويتجاوب معها بطريقة ديناميكية معقدة. ولعلّ أبرز إسهاماتها في مسألة مصادر القرآن، هي اهتمامها بالمزامير؛ فتناقش أن سورة الرحمن (55) متأثرة بالمزمور (136)، وسورة النبأ (78) متأثرة بالمزمور (104).
تسهّل تلك الدراسات النموذجية تقديم نظرة عامّة على الإسهامات الرئيسة لأنجيليكا نويفرت في مجال الدراسات القرآنية، وستُمكِّن الباحثين من التجاوب مع أعمالها والتبحُّر فيها بطريقة مثمرة؛ فالترجمات الإنجليزية متقَنة، إِذْ تَعَهَّد بها مترجمون آخرون في البداية، ثم راجعَتْها المؤلِّفة بنفسها. وبالنسبة إلى (سلسلة إذا) فإنها تشير إلى سلسلة من الجُمَل الشرطية التي تمثل واحدة من التراكيب الأساسية في القرآن (ويدعوها بيل بمقاطع إذا)، ومن رأيي فإن مصطلح: (الشروط السابقة) أفضل؛ إِذْ تشير إلى علامات القيامة، والبعث، والحساب. كما تكون "Series ofoaths" أفضل كتعبير عن "Oath clusters"، إِذْ جاءت في ترتيب متسلسل، غير عشوائي. الأخطاء الطباعية في الكتاب نادرة وهي المرصودة تاليًا:
[1] إبراهام جيجر (1810- 1874) هو مستشرق ألماني وحبر يهودي، وصاحب أهمية كبيرة في تاريخ الإصلاح اليهودي، حيث يعتبر رائد الإصلاحية اليهودية في العصر الحديث، وتمحورت دراساته حول فقه اللغات الكلاسيكية العبرية والسيريانية وحول العهد القديم، طالما آمن جيجر بالمركزية اليهودية في الأديان الكتابية وبمدى تأثير الكتاب المقدّس على المسيحية والإسلام، وربما أشهر كتبه في هذا السياق: «ماذا أخذ محمد من اليهودية». (قسم الترجمات).
[2] تيودور نولدكه (1836- 1930)، شيخ المستشرقين الألمان كما يصفه عبد الرحمن بدوي، درس عددًا من اللغات السامية: العربية، والعبرية، والسيريانية، وآرامية الكتاب المقدّس، ثم درس -وهو طالب في الجامعة- الفارسية والتركية، وفي العشرين من عمره حصل على الدكتوراه عن دراسته حول «تاريخ القرآن»، وهي الدراسة التي قضى عمره في تطويرها، وقد صدر الجزء الأول من «تاريخ القرآن» في 1909، وعمل عليه مع نولدكه تلميذه شفالي، ثم صدر الجزء الثاني عن تحرير تلميذه فيشر عام 1920، وصدر الجزء الثالث عام 1937 عبر تحرير تلميذه برجستشر ثم برتزل. كذلك درس نولدكه «المشنا» وتفاسير الكتاب المقدّس أثناء عمله معيدًا في جامعة جيتنجن، له إلى جانب كتابه الشهير «تاريخ القرآن» كتب حول اللغات السامية، منها: «في نحو العربية الفصحى»، و«أبحاث عن علم اللغات السامية»، عمل أستاذًا في جامعة كيل ثم جامعة اشتراسبورج. كتابه «تاريخ القرآن» مترجم للعربية، حيث ترجمه: جورج تامر، وصدر عن منشورات الجمل، بيروت، 2008. (قسم الترجمات).
[3] فلهاوزن (1844- 1918) مستشرق ألماني مسيحي، من أبرز الباحثين في تاريخ الكتاب المقدّس، وله نظريات خاصّة في تشكّل العهد القديم -خصوصًا أسفار موسى- وكذا في النقد الشكلي للأناجيل، لا تزال ذات أهمية كبيرة في دراسات العهدين القديم والجديد إلى الآن، حصل على الدكتوراه من جامعة جرتفسيلد وعين فيها أستاذ كرسي، ثم بسبب نتائج بحوثه اضطر لمغادرتها، فدرس في جامعات ماربورج وجيتنجن، واستمر في الأخيرة حتى تقاعده عام 1912، له اهتمام بصدر الإسلام والخلافة الأموية، كتب في هذا السياق: «أحزاب المعارضة السياسية الدينية في صدر الإسلام»، 1903، وترجمه للعربية: عبد الرحمن بدوي، وصدر عن مكتبة النهضة المصرية، و«الدولة الإسلامية وسقوطها»، وقد ترجمه للعربية: محمد عبد الهادي أبو ريدة. (قسم الترجمات).
[4] جولدتسيهر (1850- 1921)، مستشرق مجري يهودي، تلقى تعليمه في جامعة بودابست ثم برلين ثم ليبستك، وفي عام 1870 حصل جولدتسيهر على الدكتوراه الأولى وكانت عن تنخوم أورشلي أحد شراح التوراة في العصور الوسطى، وعين أستاذًا مساعدًا في عام 1872، وبعد رحلة دراسية برعاية وزارة المعارف المجرية في فيينا ثم ليدن ثم في القاهرة (حيث حضر بعض الدروس في الأزهر) وسوريا وفلسطين، وفي عام 1894 عين أستاذًا للّغات السامية بجامعة بودابست، له عددٌ كبيرٌ من الآثار، أشهرها: «العقيدة والشريعة في الإسلام، تاريخ التطوّر العقدي والتشريع في الدّين الإسلامي» و«مذاهب التفسير الإسلامي»، والكتابان مترجَمان للعربية؛ فالأول ترجمه وعلق عليه: محمد يوسف موسى، وعلي حسن عبد القادر، وعبد العزيز عبد الحقّ، وقد طبع أكثر من طبعة، آخرها طبعة صادرة عن الهيئة العامة للكتاب، القاهرة، 2013، بتقديم: محمد عوني عبد الرؤوف. والثاني كذلك مترجم، ترجمه: عبد الحليم النجار، وصدر في طبعة جديدة عن الهيئة العامة للكتاب، القاهرة، 2013، بتقديم محمد عوني عبد الرؤوف، وله كتابٌ مهم عن الفقه بعنوان: «الظاهرية: مذهبهم وتاريخهم» وهو أول بحوثه المهمّة حول الإسلام حيث صدر في 1884، كذلك فقد ترجمت يومياته مؤخرًا، ترجمها: محمد عوني عبد الرؤوف، وعبد الحميد مرزوق، وصدرت عن المركز القومي للترجمة، القاهرة، 2016. ونظنّ أن في هذه اليوميات فائدة كبيرة لفهم الكثير من أبعاد فكر جولدتسيهر ورؤيته للإسلام ودافع دراسته له ولمساحات الاشتغال التي اختارها في العمل عليه. (قسم الترجمات).
[5] هاينريش شباير (1897- 1935)، مستشرق ألماني، درس في جامعة فرانكفورت مع هورفتس، وحصل على الدكتوراه منها عام 1921، وهو أستاذ في المدرسة الحاخامية بجامعة برسلاو، واهتماماته الأساسية تتعلق بالقصص التوراتي وعلاقته بالقرآن، أشهر كتاباته في هذا كتابه الذي نشر عام 1935 بعد وفاته «القصص التوراتي في القرآن»، وفيه مقارنة تفصيلية للقصص التوراتي مع القرآن، وقد ترجم نبيل فياض بعض فصوله للعربية، في كتاب بعنوان «قصص أهل الكتاب في القرآن»، وصدر عن دار الرافدين، عام 2018. (قسم الترجمات).
[6] ديفيد هاينريش مولر (1849- 1912) مستشرق نمساوي، أستاذ اللغة العربية بجامعة فيينا، أشهر كتبه «الأنبياء في صورتهم الأصلية، 1896». (قسم الترجمات).
[7] هارتفنغ هيرشفيلد (1854- 1934)، يهودي ألماني، حاصل على الدكتوراه من جامعة اشتراسبورج عام 1878، هاجر بعدها إلى لندن ليصبح أستاذًا للغات السامية بالكلية اليهودية بلندن، ثم مدرسًا للغة العبرية والنقوش السامية بكلية الجامعة بجامعة لندن، معظم دراساته تدور حول القرآن وصلته باليهودية، أولها دراسته للدكتوراه «العناصر اليهودية في القرآن»، و«أبحاث جديدة في تأليف وتفسير القرآن». (قسم الترجمات).
[8] لتوضيح تلك المقارنة نقول: إنه في الشعر الجاهلي، وتحديدًا شعر الصعاليك، طالما كان الشاعر/ البطل/ الصعلوك يواجه انتقادات من قِبل شخصية خيالية أو حقيقية هي (اللائم) أو (العاذل)، وكان الانتقاد يتمّ دومًا على أساس كون الصعلوك لن يجني شيئًا من خروجه على أعراف المجتمع إلا الحرمان من حماية القبيلة وما توفّره من أمان، وكان الصعلوك يرى أن حريته وتفرّده أولى من أن يعود ليندرج تحت مظلّة المجتمع وأعرافه، فالصعلوك متمرد على المجتمع، واللائم هو صوت المجتمع لإعادة التئام الجماعة القبَلية، فالمقارنة هنا مع آية (الإسراء) والتي تتحدث عنها نويفرت تقوم مبدئيًّا على اعتبار النبيّ محمد من خلال لفظ المجتمع والخروج على أعرافه وعقائده هو في وضعية الصعلوك الذي يتلقى باستمرار نصيحة العاذل بالعودة، لكنها تعيد تشكيل الأدوار في القصيدة الجاهلية انطلاقًا من قيم النصّ الجديد، فالآية القرآنية باستعادتها لفظ «مذموم ومخذول»، توضح أن النبيّ لو عاد لآلهة قومه سيكون هو المخذول والمتروك؛ وهذا لأنه في هذه الحالة سيخرج من الأمان الحقيقي الذي يوفّره الله لعبده، فلم يَعُد اللائِم والمهدِّد بالخذلان هو القبيلة بل أصبح الله؛ حيث إن القبَليّة تراجعت كنمط في تنظيم المجتمع وإعطاء الهوية والتعريف؛ لذا لم يعد المهدَّد بالخذلان هو تارك القبيلة بل تارك عبادة الواحد، وبذا أصبح اللوم مستحقًّا، في هذه الوضعية اللائم على حقّ ولا يلوم من منظور عملي ونفعي، والصعلوك لم يَعُد البطل، ولعلّ هذا يتفق تمامًا مع نظرة نويفرت للعلاقة بين القرآن وصناعة المجتمع المسلم. (قسم الترجمات).
[9] هذا المصطلح مستخدم في النقد الكتابي، ويعني -تحديدًا- سياق إنشاء نصٍّ ما، ووظيفته، والغرض منه في هذا السياق، وهو أشمل مما قد يفهم من الوضعية الاجتماعية، ولا يوجد مقابل إنجليزي دقيق له؛ لذا أثبته الكاتب كما هو بلغته الألمانية في نصه. (قسم الترجمات).
[10] كلود جيليو، مستشرق فرنسي وأحد الآباء الدومنيكان، وهو أستاذ الدراسات العربية والإسلامية في جامعة إكس أون بروفانس- مارسيليا بفرنسا منذ عام 1989 وحتى تقاعده في عام 2006، ولد جيليو في السادس من يناير عام 1940، وقد حصل على دكتوراه الدولة في سبتمبر عام (1982) من جامعة السوربون Paris-111، وكانت أطروحته بعنوان: (جوانب المخيال الإسلامي الجمعي من خلال تفسير الطبري)، والتي أشرف عليه فيها أستاذه: محمد أركون. وهو باحث في معهد الأبحاث والدراسات حول العالم العربي والإسلامي (IREMAM)، ومشرف ومحرر لعدد من المجلات البحثية المتخصصة كمجلة أرابيكا (Arabica)، غزير الإنتاج، وله عددٌ كبيرٌ من الكتابات حول تاريخ القرآن والتفسير، وأشرف على العديد من الرسائل الأكاديمية والأعمال العلمية. (قسم الترجمات).
[11] رودولف بولتمان (1884- 1976) فيلسوف ولاهوتي ألماني، وأستاذ دراسات العهد الجديد في جامعة ماربورغ وأبرز الأسماء الحاضرة في النقاشات اللاهوتية المسيحية واللوثرية تحديدًا في النصف الأول من القرن العشرين، من أبرز مطبِّقي نظرية نقد الشكل على الكتاب المقدّس، ومن أبرز الدعاة لكسر أساطير الإنجيل، وله نظرية لاهوتية تجمع بين نقد الكتاب المقدّس وبين تفعيل أفكار هيدجر عن التاريخانية أو التزامن والوجود الأصيل في فهم التجربة الدينية المسيحية المعاصرة. (قسم الترجمات).
[12] هناك انتقادات عديدة لفكرة نويفرت عن القرآن ككتاب ليتورجي، أي: نصّ صلوات مرتبط بأداء طقوس معيّنة، هذه الانتقادات قائمة بالأساس على وجود طقوس لا يُقرأ فيها أجزاء محددة ومعيّنة من القرآن، بل ربما لا يوجد مثل هذا إلا في مثال الفاتحة مما يجعله استثناءً لا قاعدة يمكن عليها بناء تصوّر عن القرآن ككتاب ليتورجي، فضلًا عن ما في هذه النظرة من تضييع لسمات واضحة في النصّ منذ البداية يصف بها نفسه كهُدى ورحمة وبيان وتحدي، وليس مجرد كتاب صلوات؛ لذا فإنّ الحديث عن افتراق حتمي لاحق بين الشعائر والنصّ غير دقيق، بل الأَوْلَى الحديث عن انفصال قائم من البدء حيث لا يوجد ما يبرّر غير هذا، ونود الإشارة هنا لكون القرآن يحمل بالفعل سمة شعائرية لكن بمعنى أنه يُتْلَى كشعيرة، لا أنه يحضر ككتاب أوراد في الشعائر كما هي فرضية نويفرت المرتبطة بتصوّر للوضعية الأولى للمسلمين تقرِّبه من المسيحية الشرقية. (قسم الترجمات).
[13] هذا الحكم الذي يذكره ستيورت بالغ الغرابة، وإلا فمِن أين له معرفة أنّ آيات الفاتحة كانت ستًّا وأنه زِيد فيها لتصبح سبعًا حتى تتوافق مع إشارة سورة الحِجْر؛ فالعلماء متّفقون على أنّ عدد آيات سورة الفاتحة سبع آياتٍ، وإنِ اختلفوا في تحديد الآية السابعة؛ فالبعض يعدُّ البسملة هي الآية الأولى، ويجعل قوله تعالى: {صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} آية واحدةً وهي السابعة، والبعض لا يعتبر البسملة آية ويقسم هذه الآية إلى آيتين، والغرض أنّ العدد سبعًا أمرٌ محلّ اتفاق. (قسم الترجمات).
[14] كريستوف لكسنبرج، هو اسم مستعار لكاتب ألماني، أصدر عام 2000 كتابًا بعنوان: «قراءة آرامية سيريانية للقرآن: مساهمة في فكّ شفرة اللغة القرآنية»، وتحدّث فيه عن وجود نسخة مبدئية من القرآن «قرآن أصلي» كتب بلغة مزيج بين العربية والآرامية وكانت تمثّل كتابًا ليتورجيًّا لطائفة يهودية/ مسيحية عربية، وقام بتحديد عدد من هذه الكلمات التي لها -في ظنّه- أصل آراميّ سيرياني، وقد ترجَمْنا ضمن ملف (تاريخ القرآن) عرضًا نقديًّا لهذا الكتاب لعالم الساميات الفرنسي فرنسوا دى بلوا، على هذا الرابط: tafsir.net/translation/28 (قسم الترجمات).
[15] يوسف هورفيتس (1874- 1932) مستشرق ألماني، درس في جامعة برلين، وعين فيها أستاذًا عام 1902، ثم عين أستاذًا للغات السامية بجامعة فرانكفورت عام 1914، وهذا حتى وفاته، اهتماماته الرئيسة تدور حول المغازي والتاريخ الإسلامي، حقّق بعض الكتب، أهمها «المغازي» للواقدي، وكانت رسالته للدكتوراه حولها، من كتبه الشهيرة «الجنة في القرآن» وهو كتاب صغير فيه اشتغال فيلولوجي على معجم الجنة في القرآن، ترجمه للعربية: محسن الدمرداش، وصدر عن منشورات الجمل، بغداد، بيروت، 2016. (قسم الترجمات).
[16] تور أندريه (1885- 1947)، مستشرق سويدي، هو أستاذ تاريخ الأديان في جامعة ستوكهولم، وراعي كنيسة أبسالا وأسقف لينكوبينغ ووزير للشؤون الدينية، يعتبر أندريه واحدًا من أهمّ المستشرقين الذين بلوروا فكرة التأثير المسيحي في الإسلام، حيث يَعْتَبِر للمسيحية أثرًا في كلّ ما يتعلّق بالإسلام في نشأته، حيث يعتبر أنّ النبي محمدًا أخذ معرفته شفاهة عن بعض مسيحيي الجزيرة، وكذلك في نشأة التقاليد اللاحقة الحافّة بالإسلام مثل التصوّف. له عددٌ من الكتابات المهمّة في المسيحية وفي التصوّف وعلم النّفْس وتاريخ الأديان والسّيرة، على رأسها كتابه: «المسيحية الدين الكامل» وكتابه: «محمد حياته وعقيدته»، الصادر عام 1830، وهو كتاب واسع الانتشار تُرْجِم إلى لغات عدّة، وكتابه عن التصوف الإسلامي الذي طبع عام 1947 بعد وفاته، وهو مُتَرْجَم إلى العربية بعنوان: «التصوف الإسلامي»، ترجمه: عدنان عباس علي، وصدر عن دار الجمل، كولونيا (ألمانيا)، عام 2003. (قسم الترجمات).
كلمات مفتاحية
الكاتب:

ديفن ج. ستيوارت - DEVIN J. STEWART
أستاذ الدراسات الإسلامية واللغة العربية وآدابها بجامعة إيموري، تتركز اهتماماته على القرآن والشريعة الإسلامية.
مواضيع ذات صلة
((المعلومات والآراء المقدَّمة هي للكتّاب، ولا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع أو أسرة مركز تفسير))