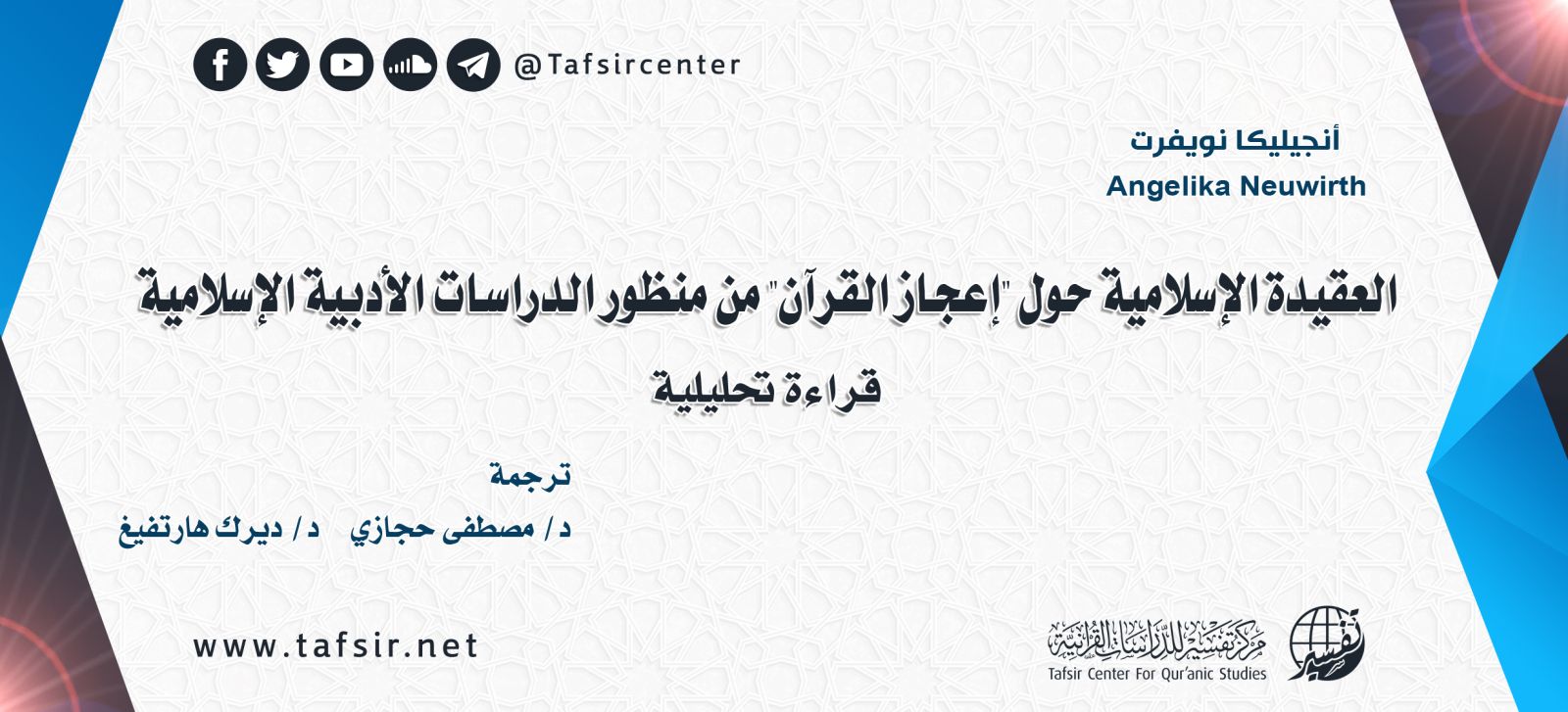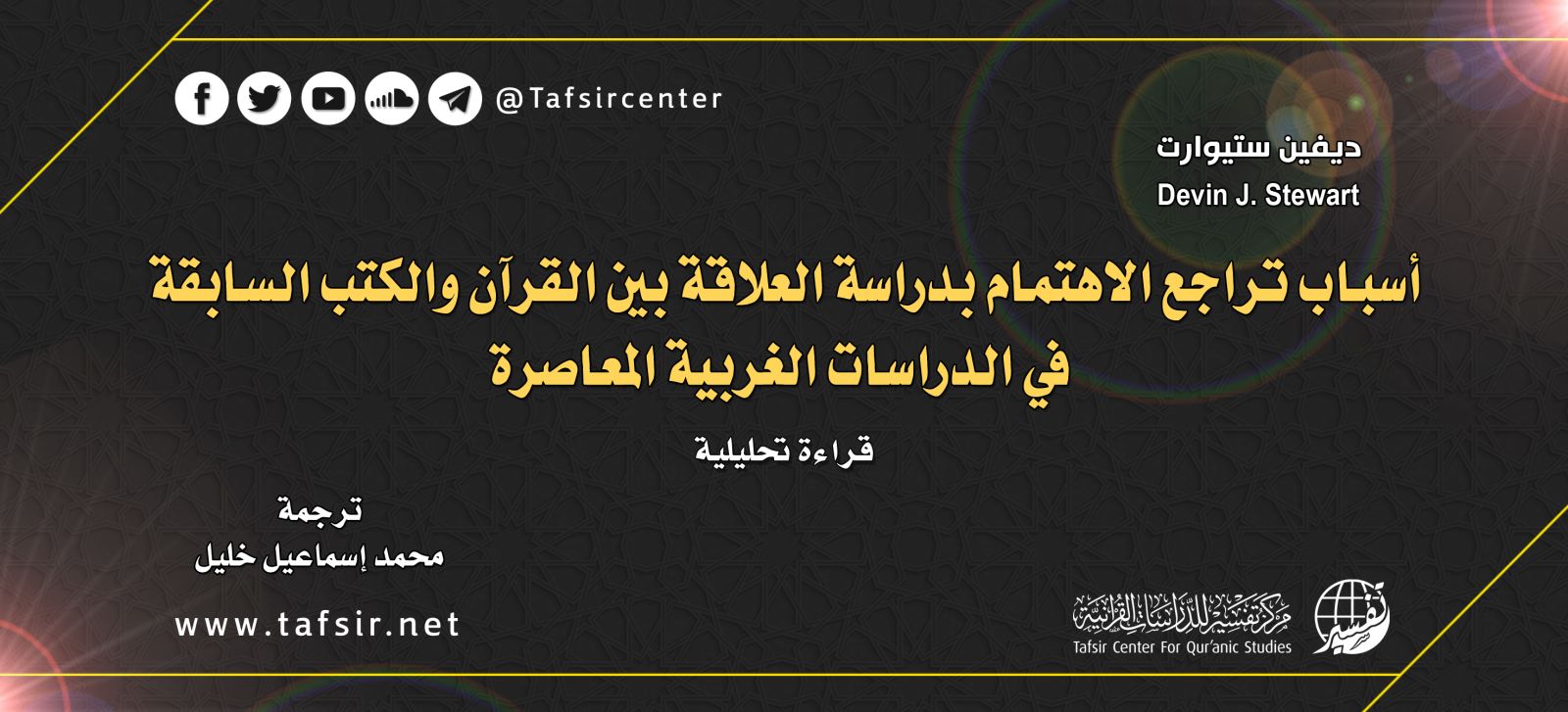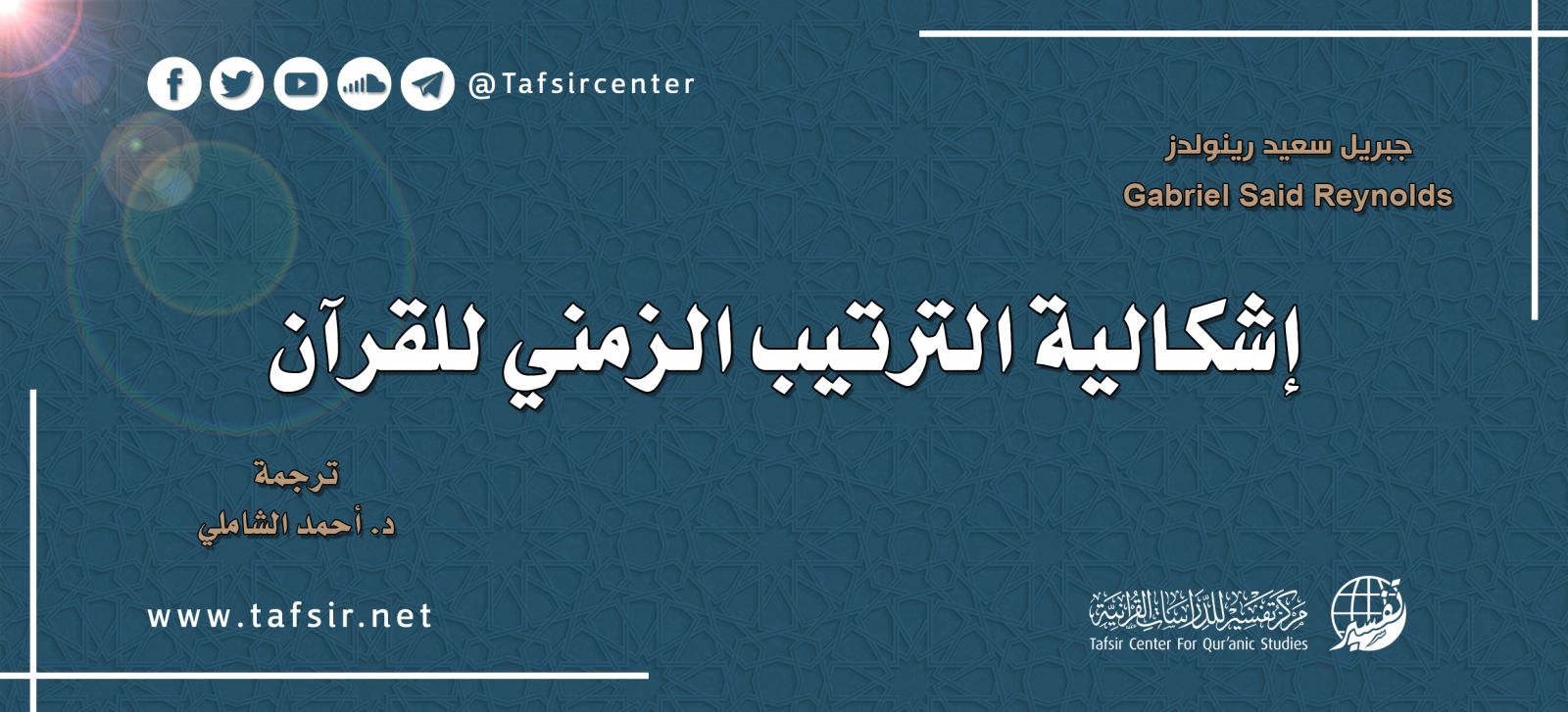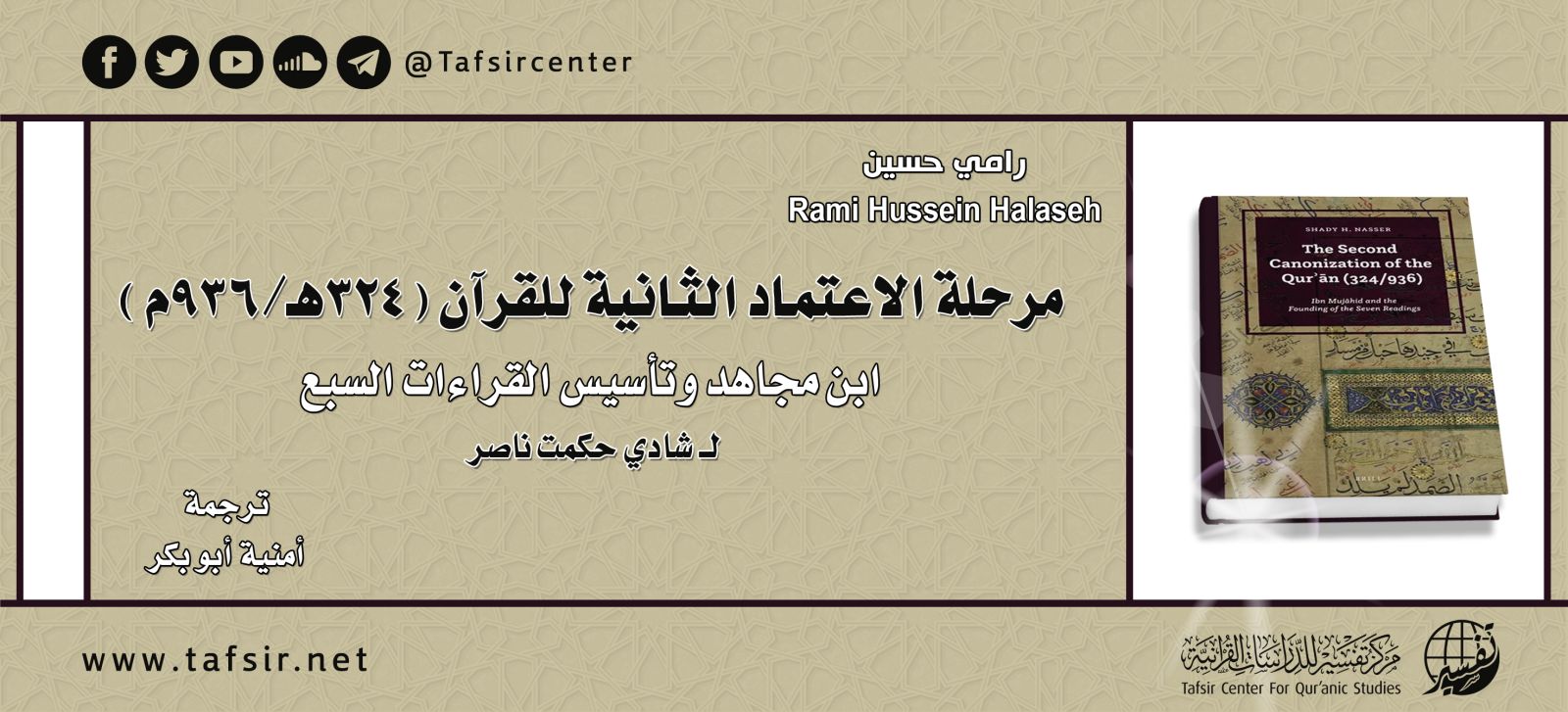قراءة آرامية سريانية للقرآن: ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ في فك شفرة ﻟﻐﺔ اﻟﻘﺮآن؛ لكريستوف لكسنبرج
ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ في فك شفرة ﻟﻐﺔ اﻟﻘﺮآن
لكريستوف لكسنبرج

عنوان هذا الكتاب ينبئ عن (قراءة) جديدة للقرآن، والعنوان الجانبي يَعِدُ بالإسهام في فكّ شفرة لغة القرآن. وقد تلخصت أطروحات الكاتب بدقّة في مُوجَزِه التمهيدي (ص299-307): «إنّ القرآن ليس مكتوبًا بالعربية، بل بلغة مزيج تجمع العربية والآرامية، التي كانت مستعملة في مكة في زمان محمد -صلى الله عليه وسلم-، وكانت مكة في الأصل مستوطنة آرامية». و(يؤكد) هذه الحقيقة أن اسم (مكة) في أصله آرامي من (mâkkQâ)، بمعنى (منخفض). وقد تم تدوين تلك اللغة المزيج من البداية في مخطوطات مجردة[1]، أي: بغير علاماتِ تشكيلٍ أو نقاطِ إعجام نميّز بها لاحقًا بين الباء والتاء والنون والياء...إلخ. وينفي الكاتب وجود تقليد شفهي موازٍ لتلاوة القرآن. أما العربية الفصحى فتنحدر من جهة أخرى (لم يخبرنا من أين). ولم يستطع العرب فهم القرآن الذي عرفوه كما هو الآن من مخطوطات مكتوبة ولا مجردة، فأعادوا تأويل المخطوطات في ضوء لغتهم هم، فهذه (القراءة الآرامية) للقرآن المعروضة تاليًا تُعِين على إعادة استكشاف معناه الأصلي.
قد يكون من النافع التّفْرقة فورًا بين ما هو جديد وما ليس بجديد في هذه الأطروحات، فقد تناظر علماء المسلمين في الحقبة الكلاسيكية بالفعل في مسألة إن كانت هناك مواد لغوية غير عربية في القرآن (آرامية، فارسية...إلخ). ارتضى بعض العلماء على الأقل ممن كانوا أوسع أفقًا على وجودها؛ إذ بما أن الله تعالى خلق كلّ اللغات، فليس ثمة مانع من استعماله لكلمات من لغات أخرى في وحيه. وقررت المعرفة اللغوية الحديثة -بالتأكيد بحلول منتصف القرن 19- أن اللغة العربية -سواء في القرآن أو في نصوص أخرى- تحوي عددًا كبيرًا من الألفاظ الدخيلة من لهجات آرامية متعددة (سيريانية، بابلونية...إلخ). كانت الآرامية اللغة الثقافية الرئيسة للمنطقة بين سيناء ونهر دجلة لأكثر من ألفِ عام، وكان لها تأثير معتبر على كلّ لغات المنطقة، بما فيها العبرية التي دُونت بها الأجزاء اللاحقة من العهد القديم. شارك العرب في حضارة الشرق الأدنى القديمة، وكثير منهم كانوا يهودًا أو نصارى، وبالتالي فليس من داعٍ للاندهاش من حقيقة أنهم اقترضوا بكثرة من الآرامية، لكن هذا لا يجعل من العربية «لغة مزيج».
وأما الجديد في أطروحة لكسنبرج[2] فهو دعواه بأن أجزاء كبيرة من القرآن ليست عربيةً صحيحةً نحويًّا، وإنما تحتاج لأن نقرأها قراءة آرامية، بما يعني النهايات الإعرابية وما إلى ذلك؛ وبالتالي لا يكون القرآن نصًّا عربيًّا (نحويًّا) ذا كلمات دخيلة آراميًّا، بل هو مؤلَّف بلغة اصطلاحية تمزج بين العناصر التركيبية للغتين مختلفتين، ولسوف نتحقق من مدى معقولية هذه الأطروحة في حينها.
والركن الرئيس الثاني لأطروحة الكاتب هو أنه، بما أن الأجيال اللاحقة (المتأخرة) من المسلمين لم تستطع فهم الاصطلاحات العربية-الآرامية في كتابهم المقدّس، كانوا مجبرين على إضافة علامات تشكيل ونقط للنصّ عشوائيًّا؛ ليكون مفهومًا جزئيًّا بالعربية (الفصحى)، مخترعين بذلك تقليدًا شفهيًّا مزعومًا لتبرير تلك القراءة الجديدة. ولإعادة اكتشاف المعنى (الأصلي) نحتاج لنبذ نقاط التشكيلِ في النصّ التقليدي، وإيجاد قراءة أخرى، هذا النوع من الحجاج ليس جديدًا بدوره؛ فقد تم تتبعه في السنوات الأخيرة في سلسلة مقالات لـ(جاي آي بلامي)، المستعرب من أمريكا الشمالية، بالإضافة للكتاب (ذي السمعة السيئة) الذي ألَّفه عالم اللاهوت الألماني غونتر لولينغ[3][4]. ومن المستغرب أن أيًّا من هذَين لم يُذكرا في قائمة مراجع لكسنبرج، وهذا كذلك مما سنتعرض له بالنقاش خلال هذا العرض، وعلى أيَّة حال، فإنّ كتابًا يعلن في تصديره (ص9) أن الكاتب اختار ألَّا يناقش «كافة [كذا قال] الأدبيات المتعلقة»؛ لأن تلك الأدبيات «لا تكاد تسهم بشيء يُذكر في المنهجية الجديدة المعروضة هنا»، لَهُوَ كتابٌ يثيرُ -للمتأمل من الخارج- تساؤلات عن مدى نزاهته العلمية.
لكن لنُلقِ نظرة على بعض الأمثلة على (المنهجية الجديدة) للمؤلف؛ وبسبب الطبيعة اللغوية التقنية لهذه المناقشة، فسوف أستعمل نظامًا ساميًّا مطردًا: الترجمة الحرفية -النقحرة (نسخ الحروف ونقلها من نظام كتابة إلى نظام كتابة آخر) - (بالخط السميك) والكتابة الصوتية (التفريغ النصي) للكلمة (بالخط المائل)، لكلا اللغتين العربية والسيريانية. وهذا النظام يختلف عن كلّ من النظام الذي اتبعه مؤلف الكتاب قيد العرض، والنظام الذي تتبعه هذه الدورية.
إحدى البنود الرئيسة لنظرية لكسنبرج عن (اللغة المزيج الآرامية/العربية) هو الاحتجاج بأن الألِف الأخيرة للكلمة في عدد من المقاطع القرآنية لا تدلّ على حالة النصب في العربية المنتهية بـ(-an)، وإنما على الخاتمة الآرامية المعبرة عن الحالة القطعية (-â في المفرد أو -ê في الجمع). وفي صفحة 30 يناقش الكاتب الآيتين (24) من سورة (هود)، و(29) من سورة (الزمر)، حيث تُقرآن في (القرآن الحالي): {هَلْ يَسْتَوِيانِ مَثَلًا}، باعتبار الكلمة الأخيرة منصوبة على التمييز. يظنّ المؤلف أنه يدخل تحسينات على معنى الآية لو أن: {مَثَلًا} اعتبرت (كتابة صوتية) لكلمة الجمع السيريانية (mtl’(maQlê، وبالتالي يكون معنى الجملة: «هل يستويان (مثنى!) أمثلة (جمع!)» وبترجمتها للعربية المعاصرة، فسيصير معنى الجملة القرآنية (افتراضًّا): «هل يستويان المَثَلان». ومن المحقق أن غالب طلبة السنة الأولى من دارسي اللغة العربية سيعرفون أنّ هذا التركيب ليس عربية فصيحة ولا معاصرة، بل هو ببساطة خاطئ. لكن حتى بدون هذه الزلَّة، من الصعوبة بمكان الزعم أن (قراءة آرامية/سيريانية) يمكن أن تحسّن من فهم النصوص القرآنية بأيِّ صورة.
في صفحة 37، يناقش الكاتب آية: {...إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ دِينًا قِيَمًا...}[الأنعام: 161]. فإذا كانت {دينًا قيمًا} منصوبة على التمييز، فسنحتاج لترجمتها على نحو: «حقًّا، لقد وجهني ربي لطريق مستقيم متوافق مع دين راسخ». أو إذا افترضنا تركيبًا مختلطًا (هدى + حرف الجر إلى + المنصوبين) فيمكن أن تعني: «...إلى طريق مستقيم، دين راسخ».
افتراض مؤلفنا يقوم على أن الصعوبة النحوية للتأويل الأخير يمكن تخفيف وطأتها باعتبار {دينًا قيمًا} لا كمنصوب عربي، بل كاشتقاق من السيريانية dyn’ qym’، التي يترجمها «اعتقاد راسخ». لكن حتى مع ذلك، فالكاتب يغفل حقيقة أن الكلمة الآرامية dînâ، بخلاف الكلمة العربية dînun لا تعني حقيقةً: (اعتقاد، دين)، وإنما (حكم، جملة) فحسب. وكلمة (دين) العربية ليست مستعارة من الآرامية، بل من الفارسية الشرقية dên (وبالأفستية daênâ-).
في صفحة 39 وما يليها، يربط الكاتب بين اللفظة القرآنية المشكلة: {حنيفًا}، والآرامية hanpâ (وتعني: وثني)، وعلى وجه التحديد بعقيدة بولين عن كون إبراهيم نموذج الخلاص للوثنيين. وقد حاججت مؤخرًا في مسألة مشابهة، في محاضرة قدمتها في صيف عام 2000، ونُشرت ختامًا في نشرة كلية الدراسات الشرقية والأفريقية Bulletin of the School of Oriental and African Studies، العدد 65 (2002)، صفحة 16 - 25، لكن خلافًا للكسنبرج لم يَفُتْنِي أن أذكر أن هذه المسألة قد طرحها من زمن طويل مرجليوث[5] وأهرنز، ولا وقعتُ في حماقة الادّعاء -كما يفعل المؤلف في صفحة 39- بأن كلمة:{حنيفًا} العربية هي «إعادة تدوير» لكلمة hnp’ السيريانية، على الرغم من حقيقة أن البنية العربية فيها مدّ بالياء لا أثر له في السيريانية.
لكن في منظور كاتبنا، فاللواحق الآرامية –â و –ê «صريحان» في القرآن، لا بالألِف وحدها، بل بالهاء كذلك. وبالتالي (ص 34) فكلمة: (خليفة) العربية (xalîfatun) هي (الكتابة الصوتية) للكلمة السيريانية: (hlyp’(hlîfâ. مع الأسف، لم يقدِّم المؤلف تعليلًا في هذه (الكتابة الصوتية) لسبب عدم كتابة الهاء الحنجرية h بنفس مطابقتها العربية h، بل بـ x.
في صفحة 35، يناقش الكاتب اللفظة القرآنية للملائكة (ملئكة)، وقراءتها التقليدية تكتب malâ’ikatun. يظن الكاتب أن هذه هي حقًّا اللفظة السيريانية للملائكة، ويقدِّم تهجئتها بالحروف السيريانية (صحيحة): ml’k’، ويكتبها صوتيًّا (خطأ) malâkê. والواقع أن التلفظ الصحيح في السيريانية هو malaxê (حيث الألِف الأولى منقولة من البنية القديمة *mal’ax-) وعلى كلّ حال، فلا الهجاء السيرياني ولا التلفظ الصحيح ولا حتى تشكيل الكاتب الخاطئ للكلمة، يفسرون ألِف المدّ العربية في الجمع. ويمضي الكاتب في زعمه أن مُسلَّمة (النطق الآرامي/السيرياني) للجمع القرآني مؤكدة (gesichert/مضمونة) في (العربية الحديثة) للشرق الأدنى malâykê. وهذه فوضى عريضة، فالحق أن المفرد العربي (ملائكٌ أو ملكٌ) في جميع الاحتمالات مستعار من الآرامية mal’ax- أو malax-، لكن الجمع (ملائكةٌ malâ’ikatun ) بنية عربية معتادة بالكامل، ويُمثّل لها كتابيًّا بـ(ملئكة)، بالهجاء القرآني المعتاد الذي يسقط الألف الداخلية. وبنية (العربية الحديثة) التي يتكلم عنها (وبتعبير أصح الشامية)، هو المتوقع من تلك اللهجة التي تعكس البنية الفصيحة لـ(ملائكة) بالإمالة الفلسطينية للألِف لِـيَاءٍ (وأجد تبريرًا صغيرًا لكتابتها الصوتية –e)، ولا علاقة لذلك بالجمع السيرياني malaxê.
لكن بمجرد أن تم تقرير فرضية (اللغة المزيج)[6] للقرآن كمُسلَّمة، يظن الكاتب بجلاء أنه من الممكن مقابلة أيّ كلمة عربية بأدنى شبيه لها في السيريانية، ثم يحدّد معناها من معجم السيريانية بدل العربية. وبالتالي ففي صفحة 196 وما بعدها، يقول بعشوائية تمامًا: إنّ الكلمة العربية العادية جدًّا (ضَرَبَ) مشتقة من الفعل السيرياني traf، الذي يعني ضمن ما يعني: «يضرب، يتحرك، يهز (أجنحته)...إلخ». ونجد بروكلمان في مؤلفه (المعجم السيرياني)، صفحة 290، يقارنه بفعل tarafa بمعنى: (يصد). ولا يبدو من المحتمل أن الجذر الآرامي له أيّ صلة بالفعل العربي: (ضَرَبَ)؛ والمطابقة بين d/t وb/p(f) بالتأكيد ليست معيارية في المشتقات السامية، وربما سيكون من المدهش أكثر أن تعتبر كلمة دخيلة، لكن هذه الصعوبة لا تمنع الكاتب من عزو معاني الكلمة السيريانية لمختلف مواضع ورود كلمة: (ضرب) في القرآن.
ثم في صفحة 283، يزعم الكاتب أن الفعل العربي: (طغى)، بمعنى: (يتمرد، يستبد...)، ليس فيه نفحة عربية باستثناء حرف الغين، وإنما هو مشتق من الكلمة السيريانية tʿa، ثم يتخير من قاموس سيرياني معنى: (ينسى) لينسبه لمواضع: (طغى) في القرآن. والحقّ أنّ الجذر العربي فيه غين (غ)، بينما الآرامية فيها عين (ع)، وهذا يبين بجلاء أنّ الكلمة العربية ليست مستعارة من الآرامية، وإنما هما كلمتان ساميّتان متقاربتان. وعلى أيّة حال، فالمعنى المعتاد للكلمة السيريانية tʿa هو (يخطئ، أو يُغرر به...)، مع أن: (ينسى) من معانيها كذلك. وبالتالي فحتى لو أن الفعل العربي كان دخيلًا من السيريانية، لن يكون ثمة ما يثير الاهتمام بالمعنى الجديد الذي نسبه له الكاتب.
سأقتبس مثالًا أخيرًا للكاتب من (القراءة الآرامية/السيريانية) -التي ينتهجها- للنصّ القرآني. الكلمة الأخيرة في الآية (19) من سورة العلق هي: {اقترب}، التي كان معناها مفهومًا دائمًا على أنه: (ادْنُ) (فعل أمر)، لكن الكاتب في صفحة 296 يظن أن معناها: (شارك في القربان المقدس)؛ لأنه يرى أن: {اقترب} هي «بلا شك دخيلة» من الفعل السيرياني eQkarrab، والذي يعني (ادْنُ)، وعلى وجه التحديد: «(يدنو من المذبح) ليتسلم القربان المقدّس»؛ وليدعم هذا، يقتبس -في صفحة 298 في أعقاب بعض الإشكالات التحريرية مرتين- فقرة من (كتاب العين)، يَرِد فيها أن الفعل العربي: (تَقَرَّبَ) يستعمل صريحًا في معنى: «تسلم قربانًا مقدّسًا (نصراني)». لكن ذلك التوكيد المزعوم يهد حجة المؤلف من أصلها؛ فالاصطلاح التقني العربي المسيحي (المعروف بالفعل) (تَقرَّبَ)، هو حقًّا ترجمة مقترضة من السيريانية eQkarrab، بنفس بنية جذر الكلمة، أي: الجذر (قَرُبَ) مع السابقة (تَ). وليس ثمة سبب جيد لافتراض أن ذات الفعل السيرياني اقترض بالكامل للمرة الثانية كجذر (ببنية مختلفة) في (اقتربَ).
كلُّ الأمثلة التي اقتبستها يمكن أن تُبسَط بتوسع مضاعف، لكن لعلّها كافية؛ فهي تبين ما هو أقل إثارة للجدل، أو على أيّة حال الجزء الأقل خيالية في حجاج الكاتب، الجزء الذي يطبق فيه (قراءة آرامية/سيريانية) لنصّ القرآن التقليدي بذاته، لكن الكتاب يتجاوز ذلك الغرض، فما أن قرر الكاتب -كما يظن- أن القرآن مؤلَّف بـ(لغة مزيج) من الآرامية/العربية، يمضي ليتلاعب بعلامات النَّقْط والشَّكْل في النصّ التقليدي، لينشئ قرآنًا جديدًا بالكامل، ثم يسعى لفكّ شفرته بمعاونة معرفته بالسيريانية (المذبذبة جدًّا في الغالب كما لاحظنا). ولا شكّ في أنه بدون علامات النَّقْط والشَّكْل يصير القرآن بالفعل نصًّا مبهمًا للغاية، ولا شكّ كذلك أن إمكانية إعادة نقطه وشكله تحتمل عددًا لا نهائيًّا من فرص تأويل النصّ المقدّس، بالعربية أو أيّ لغة أخرى يختارها المرء. لكنني أعتقد أن أيّ قارئ يودّ تحمّل عناء خوض غمار (القراءة الجديدة) للكسنبرج في عددٍ كبيرٍ من الفقرات المناقشة في كتابه؛ سينتهي لخاتمة أن (القراءة الجديدة) لا تحتمل معنى أجود من القراءة العربية المعتادة للنصّ التقليدي، وإنما هي قراءة ذات جاذبية محتملة فقط من حيث كونها جديدة، أو ربما ينبغي أن أقول من حيث كونها شاذّة[7]، وليس من جهة كونها تلقي بأيّ ضوء على معنى القرآن أو تاريخ الإسلام[8].
ومن الضروري في الختام أن نقول شيئًا ما عن التأليف أو بالأحرى عدم التأليف، أي: استعمال اسم مستعار للمؤلف. أشارت مقالة منشورة في النيويورك تايمز في الثاني من مارس 2002 (وبالتالي هي واسعة الانتشار على الإنترنت) لهذا الكتاب على أنه من تأليف (كريستوف لكسنبرج: عالم باللغات السامية القديمة في ألمانيا)[9]. وأعتقد أنه قد تبيّن لنا بجلاء من هذا العرض أن المؤلف المعنيّ ليس (عالمًا باللغات السامية القديمة)، وإنما هو شخص يتكلم لهجةً عربيةً ما كما يبدو، وله فهم مقبول بالعربية الفصحى وإن لم يَخْلُ من عيوب، ويعرف السيريانية بما يكفي ليكون قادرًا على استعمال القاموس، لكنه خلوٌّ من أيّ فهم حقيقي لمنهجية اللغويات السامية المقارنة، وكتابه ليس نتاج عالمٍ بل هاوٍ.
وتمضي مقالة النيويورك تايمز لتقرّر أن (كريستوف لكسنبرج اسم مستعار)، لتشابهه بذلك بسلمان رشدي، ونجيب محفوظ، وسليمان بشير. متحدثة عن «التهديد بالعنف والتحرّج العام في حرم الجامعات الأمريكية من نقد الثقافات الأخرى». ولست متأكدًا عمَّا يعنيه كاتب المقالة تحديدًا بقوله: «في ألمانيا». فوفقًا لمعلوماتي، (كريستوف لكسنبرج) ليس ألمانيًّا بل لبنانيًّا مسيحيًّا. ومن ثم فهذه ليست مسألة إقدام باسل من عالم بفقه اللغة، انطمر وسط كتب مغبرة للغات مغمورة في مكانٍ ما في مقاطعات ألمانيا؛ ثم اضطر لنشر نتائجه تحت اسم مستعار ليتلافى تهديدات القتل من مسلمين متطرفين مسعورين، أيْ باختصار: (رشدي) آخر يطلّ من بُرْج عاجيّ. دعُونا لا نبالغ في شأن الحرية الأكاديمية فيما لا زلنا نحبّ أن نسميه ديمقراطياتنا الغربية. لكن لا عالم لغويات -ولو لغويات عربية- من أوروبا أو أمريكا الشمالية يحتاج إلى أن يخفي هويته (أو هويتها)، ولا له (أو لها) حقيقةً أيّ حقّ في ذلك. فمثل هذه المسائل لا بد أن تناقش على الملأ، لكن الأمور مختلفة جدًّا بالطبع في الشرق الأدنى.
[1] المقصود بالمخطوطات المجردة، أي: الخالية من النقط والإعجام والشَّكْل والعدّ والتحزيب والتقسيم، وقد آثرنا إثبات هذا التعبير لكونه الأكثر استخدامًا في وصف المصاحف السابقة على النّقط والشَّكْل، وإن كانت الكلمة الإنجليزية في النصّ الأصلي تعني بالأساس منقوصة أو غير كاملة، وهو التعبير الذي قد يشكل ولا يؤدي الغرض. (المترجمة).
[2] كريستوف لكسنبرج، هو اسم مستعار لكاتب، أصدر عام 2000 كتابًا بعنوان: (قراءة آرامية سيريانية للقرآن؛ مساهمة في فكّ شفرة اللغة القرآنية)، وتحدّث فيه عن وجود نسخة مبدئية من القرآن (قرآن أصلي) كتب بلغة مزيج بين العربية والآرامية، وهو الذي يتم تناوله في هذه العرض. (قسم الترجمات).
[3] غونتر لولينغ (1928-2014)، لاهوتي بروتستانتي ألماني، تركزت دراساته في بدايات الإسلام، حيث حاول إثبات فرضيته عن كون الإسلام تطور أصلًا عن نحلة لجماعة مسيحية كانت تسكن مكة، وأن القرآن هو تطور لاحق للتراتيل المسيحية المستخدمة من هذه الجماعة، له عدد من الكتب في هذا السياق منها:
Kritisch-exegetische Untersuchung des Qur'antextes. Erlangen, 1970
دراسة تفسيرية نقدية للنص القرآني.
Über den Ur-Qur'an. Ansätze zur Rekonstruktion vorislamischer christlicher Strophenlieder im Qur'an. Erlangen: Lüling, 1974
حول القرآن الأصلي، مقاربات لإعادة بناء التراتيل المسيحية قبل الإسلام في القرآن.
[4] الإشارة هنا لكتاب (حول القرآن الأصلي، 1974) لغونتر لولينغ، وهو كتاب من أهم الكتب التي فتحت الباب لمثل أطروحات لكسنبرج، بتشكيكها في التأريخ التقليدي للمصحف، وطرحها لافتراضات «مجانية» عن وجود نصّ قرآني أصلي محتجب كان يمثّل بالأساس كتابًا لجماعة دينية مسيحية في الغالب، وقد تلقّف أطروحته وأسّس عليها الكثيرون، بل كانت إلى جانب كتاب وانسبرو (الدراسات القرآنية، مصادر ومناهج تفسير النصوص المقدّسة، 1977)، أساسًا لظهور الفرضيات التنقيحية اللاحقة عن هوية المسلمين الأوائل وكون الإسلام هوية متأخرة أضفيت على أمة متدينة تحاول الانفصال بهوية خاصة -غالبًا مسيحية أو مسيحية/يهودية تحاول الانفصال عن المسيحية البيزنطية-، مع أسماء مثل كرون وكوك ويهودا دي نيفو، وفرضية لولينغ تفصيلًا تجعل القرآن كتابًا متراكبًا من عدة طبقات: حيث تمثل الطبقة الأولى والأعمق فيه مجموعة ترانيم مسيحية تخصّ مسيحيي مكة فيما قبل النبي محمد، ثم طبقة ثانية تحوي التعديلات التي تمت في عهد محمد لتنسجم مع مبادئ الإسلام الناشئ، ثم طبقة ثالثة تحوي الإضافات الإسلامية في عهد محمد، ثم طبقة رابعة تحوي تلك التعديلات التي قام بها المسلمون في ما بعد محمد أثناء تحرير الخط العربي. والغريب أن هذه الفرضيات توجد دون وجود أيّ أدلة عليها، إلَّا التخرُّص بوجود مسيحي منظم في مكة عشية الإسلام، وهو ما لا يوجد دليل عليه، وإلَّا الافتراض بكون تجريد المصاحف الأولى كان خلوًّا من أيّ تقليد شفهي مصاحب للنصّ المكتوب يضبط قراءته، مما يتيح إمكان التعديل والتغيير خطأً أو وهمًا أو في سبيل الضبط في إطار قواعد العربية، وهذا الافتراض الأخير لا يخالف فقط حقيقة وجود مثل هذا التقليد كما هو ثابت، وإنما كون وجود مثل هذا التقليد أساسي في ظل فرضية تجعل القرآن -أصلًا- كتابًا شعائريًّا يُتلى في مناسبات ليتورجية محددة ومتكررة، فكأنّ هذا الكلام يعني أن القرآن كان كتابًا متداولًا شفهيًّا في الشعائر، وفي نفس الوقت لا يوجد تقليد شفهي لتناقله يضبط قراءته في ظلّ إمكانات تعديل غير منضبطة! (قسم الترجمات).
[5] ديفيد صمويل مرجليوث (1858-1940)، مستشرق بريطاني شهير، درس الآداب الكلاسيكية واللغات السامية في جامعة أكسفورد، وعيّن بها أستاذًا في عام 1889، له العديد من النشرات والترجمات في التراث الإسلامي؛ فقد ترجم للإنجليزية قِسمًا من تفسير البيضاوي (1894)، وقسمًا من تاريخ مسكويه (تجارب الأمم) (1920)، ونشر رسائل المعري (1898)، و(معجم الأدباء) لياقوت الحموي (1907-1927). وله كذلك عدد من الكتب حول تاريخ الإسلام، مثل: (محمد ونشأة الإسلام، 1905)، و(الإسلام، 1911)، و(العلاقات بين العرب واليهود، 1924)، وله نظرية حول الشعر الجاهلي تقول بانتحال معظم هذا الشعر في عصور ما بعد الإسلام، وقد تأثر بها طه حسين الأديب المصري (1883-1973م). (قسم الترجمات).
[6] فرضية اللغة المزيج التي يقوم عليها كتاب لكسنبرج هي أحد أكثر المواضع التي تعرّضت لانتقادات في نظريته؛ وهذا لعدم وضوح ما يقصد بهذا التعبير، ما عدا أنه يقصد أن علاقة العربية بالآرامية لم تكن علاقة احتواء لغةٍ ما -العربية بالأساس- لبعض الكلمات من المعجم الآرامي، بمعنى أنه يحدّدها بشكلٍ سلبي، لكن ما هي طبيعة هذه العلاقة بين اللغتين بصورة إيجابية فهذا ما لا يقوله لكسنبرج، وربما يمكن إرجاع هذا لما يراه فرنسوا دي بلوا كاتب هذا العرض والمتخصص في الساميّات، من أن لكسنبرج -كما يرجح- ليس عالمًا بالساميّات القديمة، إلا أن فريد دونر المستشرق الأميركي يرى أن عدم تحديد، أو بالأحرى ما يسميه التحديد السقيم لهذا المفهوم من قِبَل لكسنبرج هو أمر مقصود، والغرض منه بالأساس جَعْل هذه الكلمات في القرآن التي تقارب صوتيًّا كلمات المعجم الآرامي غير خاضعة لأيّ بنية قواعدية عربية أو آرامية، مما يفتح له الباب فيما يرى دونر (لظنون نزوية)، فهذا المفهوم يبدو «كذريعة يستخدمها لكسنبرج من أجل تفسير مستبد للنصّ». انظر: القرآن في أحدث البحوث الأكاديمية: تحديات وأمنيات، فريد دونر، ضمن كتاب (القرآن في محيطه التاريخي)، ترجمة: سعد الله السعدي، دار الجمل، كولونيا (ألمانيا)، بغداد، ط1، 2012، ص73. (قسم الترجمات).
[7] لعلّ هذا الوصف يتقارب تمامًا مع وصف المستشرق الألماني شتيفان فيلد لذات الفرضية بأنها أحد (الفرضيات المثيرة) التي نشأت في سياق التعامل مع التاريخ الإسلامي وفقًا لما يسميه منهج الصفحة البيضاء، وهو المنهج المتزايد مع التشكيك التنقيحي في كلّ المصادر التراثية الإسلامية واعتبارها مجرد تزييف وَرِع غير ممكن الاعتماد عليه في بناء معرفة موثوقة بهذا التاريخ، مما يخلق فراغًا يتم ملؤه عبر أمثال هذه الفرضيات. انظر: شتيفان فيلد، تاريخ القرآن: لماذا لا نحرز تقدمًا، ترجمة: حسام صبري، منشورة على قسم الترجمات بموقع تفسير ضمن الملف الأول (الاتجاه التنقيحي)، ص17، على هذا الرابط: tafsir.net/translation/7 . (قسم الترجمات).
[8] عطفًا على التعليقات السابقة، فكتاب لكسنبرج يعتبر من أشهر الكتابات التي نشأت حول النصّ القرآني وتاريخه في سياق ملء الفراغ الذي نتج عن التشكيكات التنقيحية في المعرفة الاستشراقية المتكوّنة من خلال الاعتماد على المصادر الإسلامية التراثية؛ لذا فقد اهتم الكثيرون بهذا الكتاب، رغم الخلاف على نتائجه وأحيانًا على بنيته المنهجية والاستدلالية ومدى عمق اشتغاله، وهذا لأن هذا الكتاب -ورغم مواطن ضعفه- يكثّف الكثير من الإشكالات الاستشراقية المعاصرة، كما يستعيد بعض الآراء الكلاسيكية عن تأثيرات مسيحية أو يهودية في النصّ القرآني، وإنما وفقًا لسياق الجدالات المعاصرة بالطبع، وقد عقدت جامعة نوتردام عام 2005 مؤتمرًا -والذي نتج عنه كتاب (القرآن في سياقه التاريخي)- حول الاتجاه التنقيحي وأطروحاته، من أجل تقويم نقدي لها، وكان في القلب منه أطروحة لكسنبرج، التي تكثّف القضايا المركزية التي أضحت موضع تساؤل أساس في الاستشراق المعاصر، مثل: القرآن الأصلي، هوية المسلمين الأوائل، لغة القرآن، طريقة نقل القرآن، السياق التاريخي للقرآن، دراسة القرآن في سياق الأزمنة العتيقة المتأخرة. (قسم الترجمات).
[9] لا يمكن هاهنا إغفال الإشارة لكون كتاب لكسنبرج قد أخذ شهرة كبيرة في الأوساط غير العلمية بسبب بعض النتائج التي توصل لها في كتابه، خصوصًا ما يتعلق بالحُور العين، وتفسيره لها بأنها تعني بالأصل (عناقيد العنب)، وهي النتيجة التي تم تلقفها في سياق صحفي ساخر، ومن الجيّد جدًّا في هذا العرض لفرنسوا دي بلوا الابتعاد عن هذه النتائج المشتهرة وتحليل النتائج الأكثر كشفًا عن اشتغال لكسنبرج ومدى دقته العلمية. (قسم الترجمات).
كلمات مفتاحية
الكاتب:

فرانسوا دي بلوا - François de Blois
باحث فرنسي، يعمل كباحث زميل في جامعة كوليج بلندن، وهو أستاذ الدراسات الإيرانية في جامعة هامبورغ من 2002، إلى 2003. اشتغاله الأساس على اللغات السامية القديمة واللغة الإيرانية وتاريخ الأديان في الشرق الأدنى في العصور القديمة والوسطى.
مواضيع ذات صلة
((المعلومات والآراء المقدَّمة هي للكتّاب، ولا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع أو أسرة مركز تفسير))