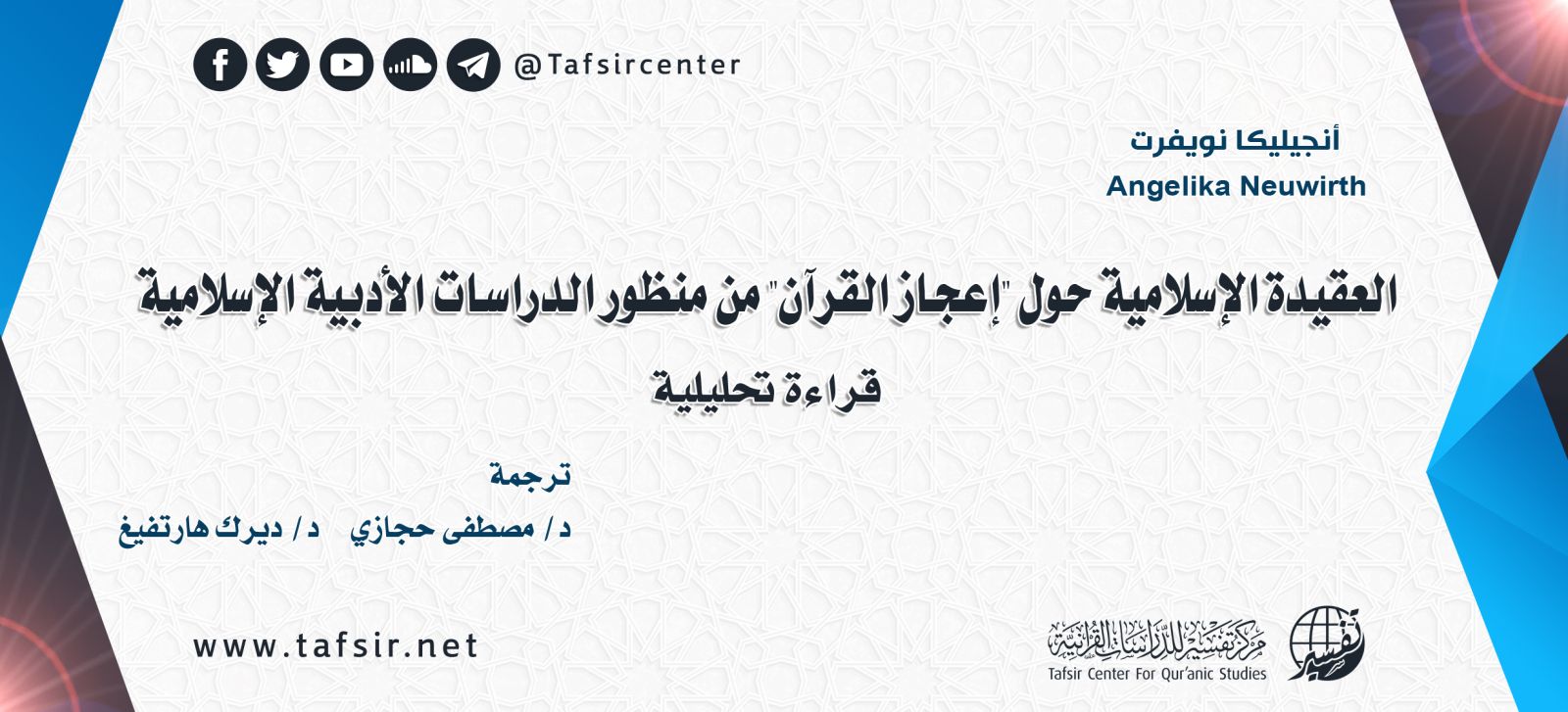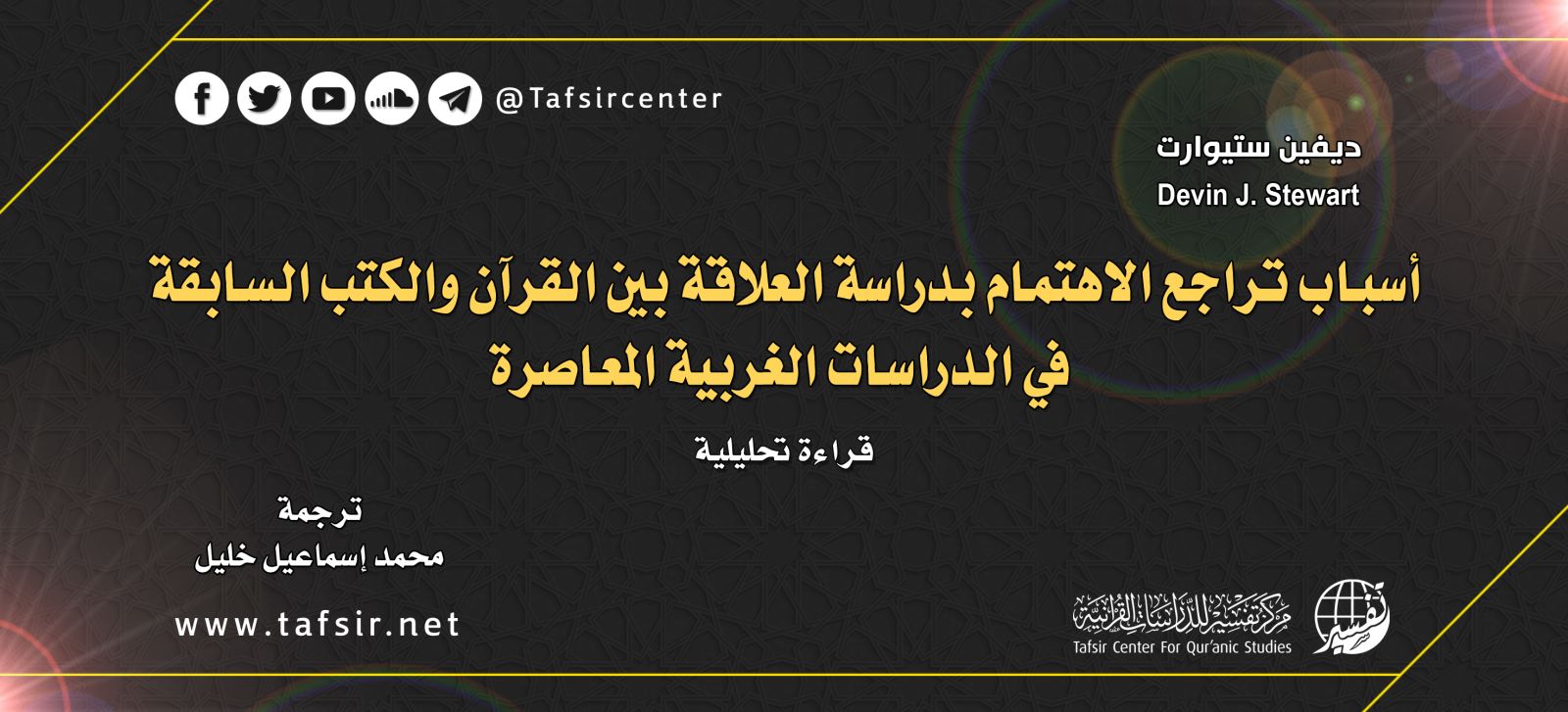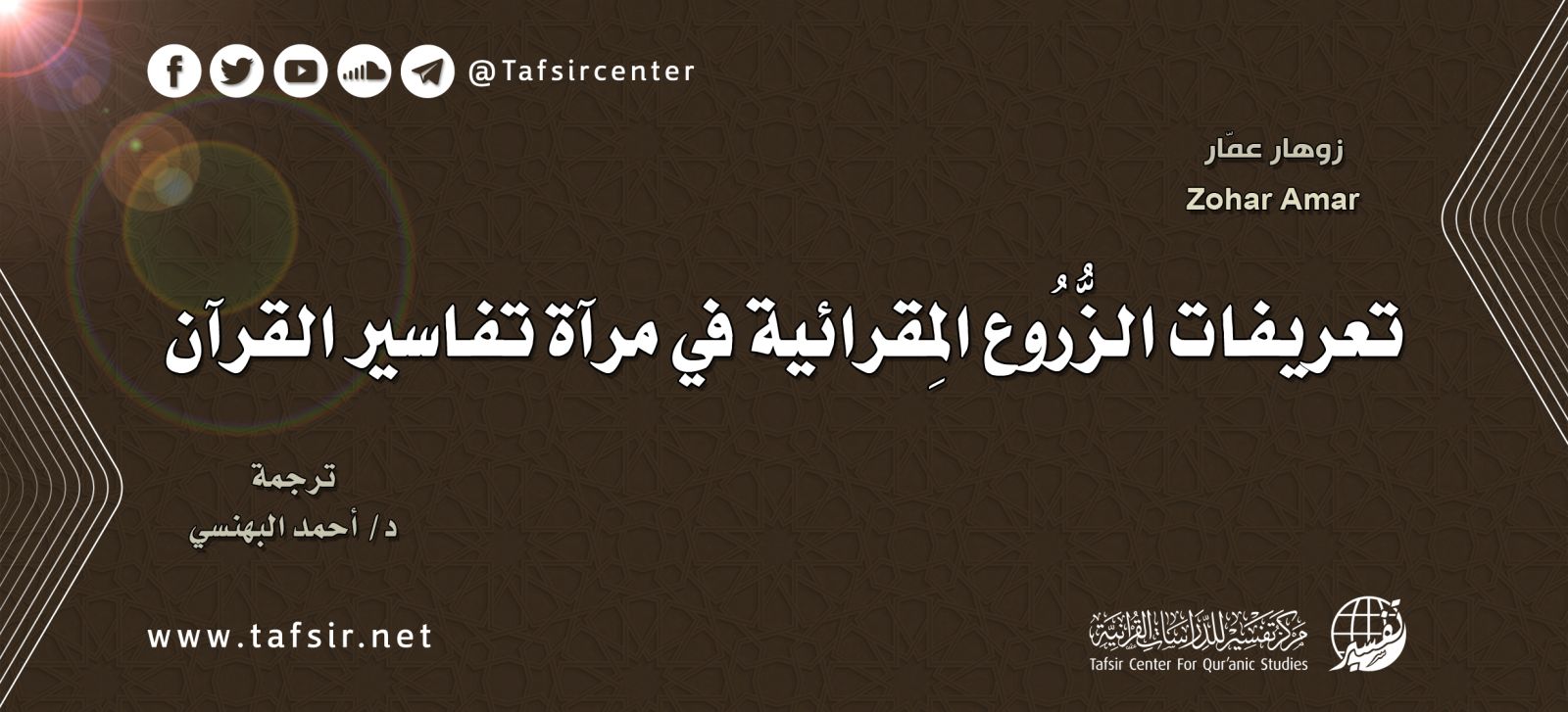دراسة القرآن أم "القرآن المفسّر"؛ قراءة في كتاب (القرآن المفسّر: ترجمة وتفسير جديدان)
قراءة في كتاب (القرآن المفسّر: ترجمة وتفسير جديدان)
الكاتب: بروس فودج - BRUCE FUDGE

دراسة القرآن أم "القرآن المفسّر"
قراءة في كتاب (القرآن المفسّر: ترجمة وتفسير جديدان)[1][2][3]
(1)
يتسم كتاب القرآن المفسّر (The Study Quran) بالجدّة والمحافَظة الشديدة في آن. وهو مُنجَزٌ مذهل جاء نتيجة جهد جماعي استثنائي، ويضمّ ترجمةً للقرآن مُذيَّلةً بتفسير موسَّع انتقاه المحرّرون في الأساس من التفاسير القرآنية العربية الوسيطة. ويحوي أيضًا مقالات عن عدّة موضوعات ذات صِلَة، إلى جانب مخطّط زمني وخرائط لأنحاء الجزيرة العربية والمنطقة فضلًا عن الغزوات (بدر، أُحُد، الخندق، إلخ). ولهذا الكتاب غايتان: تقديم مجموعة من الآراء التفسيرية التي حفل بها التراث، فضلًا عن إسهامه الخاصّ في الترجيح والانتقاء من تلك الآراء. فإلى أيّ مدى حقّق هذا الهدف؟ بصفة عامة، أرى أنه حقّقه جيدًا. فليس هناك شَكّ في فائدته ليكون مرجعًا في المتناول يقدّم قدرًا هائلًا من العلوم والمعارف القرآنية. وبالقدر ذاته من الأهمية تأتي تلك القضايا التي يثيرها الكتاب، ربما دون قصد، فيما يتعلّق بتاريخ التفسير والدراسة الأكاديمية للإسلام. وما موقعه [الكتاب]، إنْ كان له موقع، في حقل الدراسات الإسلامية؟ وكيف يمكن استخدامه؟ وكيف للمرء تقديم مراجعة له في مجلّة علمية؟
(2) ما هو "القرآن المفسّر"؟
بدايةً، كيف يمكننا تعريف «القرآن المفسّر» على وجه التحديد؟ يشرح رئيس هيئة تحرير الكتاب سيّد حسين نصر في المقدّمة أنه قد وُضِع على نمط الكتاب المقدّس المفسّر من هاربر- كولنز (The Harper Collins Study Bible)، دونما مزيدٍ من التوضيح. وهنا لا بدّ أن نستحضر أنّ هناك إرثًا كبيرًا من طبعات الكتاب المقدّس الصادرة باللغات العامّية مصحوبةً بتفسير له، وموجَّهة لاستخدام القارئ العامّي غير الدّارس لعلوم اللاهوت. وأولى هذه الطبعات وأشهرها هي طبعة جنيڤ الصادرة عام 1560م. ويُقال إنّ الملك جيمس الأول (James I) قد اعترض على هذه البدعة الكالڤينية، لا على الترجمة فحسب، بل أيضًا على الحواشي وما حوته من تعليقات خطيرة؛ ومن هنا جاءت نسخة الملك جيمس [الشهيرة] من الكتاب المقدّس، دون تعليقات وتفسير.
وأشهر إصدارات للكتاب المقدّس المفسّر تمثّل مدارس تفسيرية مختلفة. وأنجح تلك الإصدارات هو الكتاب المقدّس المفسّر من سكوفيلد (The Scofield Study Bible)، الذي نُشر عام 1909م (بعنوان: الكتاب المقدّس المرجعي من سكوفيلد [The Scofield Reference Bible])، واتّبع النمط الذي سارت عليه نسخة جنيڤ. فالنصّ مصحوب بتعليقات وجداول وخرائط مختلفة لإرشاد القارئ؛ والنسخة تفترض وجود علاقة مباشرة بين القارئ والنصّ، مع تدخّلات كهنوتية محدودة؛ وقد أعادت مطبعة جامعة أكسفورد نشره مؤخّرًا لما يحوي من تعليقات وإحالات مرجعية مفيدة. وكما هو الحال مع نسخة جنيڤ من الكتاب المقدّس، يقدِّم هذا النصّ أيضًا رؤية لاهوتية معيّنة، ألا وهي التدبيرية (dispensationalism)، وفيها ينقسم التاريخ البشري إلى عدد من الحقب وَفق خطّة إلهية.
ويتبنّى العمل الأصلي المنشور عام 1964م بعنوان: الكتاب المقدّس المفسّر من هاربر (The Harper Study Bible) وجهةَ نظر إنجيلية محافظة أيضًا. أمّا النسخة الأحدث (التي نُشرت طبعتها الأولى عام 1993م) بعنوان: الكتاب المقدّس المفسّر من هاربر- كولنز (The Harper Collins Study Bible)، فليست تتبنّى وجهةَ النظر هذه. وبصفته النموذج الذي حَذا حذوه كتابنا الذي نطرح مراجعةً له هنا [أي: القرآن المفسّر]، كان الكتاب المقدّس المفسّر عملًا مسكونيًّا (جامعًا للطوائف) في مقاربته ويتناول تطوّرات حديثة في أشكال مختلفة من النقد الكتابي. وبالمثل، فإن القرآن المفسّر هو ثمرة عمل أكاديمي، ويقرّ بمختلف أشكال الانتماء الإسلامي؛ السنّي والشيعي والصوفي، إضافةً إلى التنويعات المختلفة ضمن هذه التسميات العريضة.
هل كان هناك نظير لهذا الكتاب في التراث الإسلامي؟ هناك العديد من التفاسير المختصرة، وأبرزها تفسير الجلالين الشهير، لكلٍّ مِن جلال الدين المَحلّي (ت: 864هـ= 1459م)، وجلال الدين السيوطيّ (ت: 911هـ= 1505م). ولكن هذا التفسير يفترض في قارئه إلمامًا معرفيًّا بدرجةٍ ما ووعيًا بالاصطلاحات الفنّية، فضلًا عن أنّ تركيزه محدود للغاية، فيتناول بالتفسير كلمات أو عبارات بعينها. وهناك أيضًا محاولات معاصرة لتقديم نسخ مبسَّطة من التفاسير التراثية، مثل صفوة التفاسير لمصنّفه محمد عليّ الصابوني (وُلد 1930م)[4]. وعادةً ما يجد المرء معاني بعض الكلمات بهامش المصحف، ويبدو من الشائع أيضًا وجود كتاب أو آخر من كتب أسباب النزول بهامشه. وهذه الحواشي تشير إلى أشهر المعاني والترجيحات في تفسير أو تأويل الآيات القرآنية؛ من منظور معجميّ ومن جهة السياق الذي نزلتْ فيه في حياة النبيّ. أمّا القرآن المفسّر فشيءٌ مختلف تمامًا.
نجد في المقدّمة التي كتبها نصر العديد من الإشارات إلى أهداف الكتاب وأغراضه:
سيرتكز على التراث الإسلامي؛ ليتيح لقرّائه الاطلاع على الأساليب المختلفة التي فهم المسلمون بها القرآن وفسّروه على مدى القرون الأربعة عشر. (صxl).
وهناك هدف آخر نُصّ عليه، وهو تقديم ترجمة «للغة العربية القرآنية نفسها، لا محض تفسيرات لتك اللغة»، مع تقديم «لمحة من البلاغة التي لا تُضاهى» للغته تلك.
والتفسيرُ المصاحبُ هدفُه أن يأخذ القرّاء إلى مساحة تتجاوز المعنى الحرفيّ للنصّ عند الحاجة، وتوضيح الآيات العسيرة على الفهم، والكشف عن المعاني الخفيّة للآيات عندما يستدعي الأمر ذلك، وتقديم تفسير معقول لتنوّع الآراء والتفسيرات في المسائل الفقهية والكلامية والروحية والتاريخية التي نُقِلَت عن المصادر الإسلامية التقليدية المختلفة. ونأمل أن يُسهم هذا العرض في تفاعل القرّاء على مستوياتٍ مختلفة مع القرآن، وفي إزالة التصوّرات الخاطئة المنتشرة في بعض الأوساط غير الإسلامية التي ترى أنّ المسلمين لا يتناولون القرآن بالنظر والتدبُّر ولا يتفاعلون معه فكريًّا لاعتقادهم أنه كلمة الله، مع أنّ القرآن نفسه يدعو قرّاءه إلى التأمُّل فيه والتدبُّر في تعاليمه.
وتفسيرنا، وإن كان يستند إلى التفاسير التراثية الكلاسيكية، ليس مجرّد انتقاءات مستلّة من تلك الكتب؛ بل هو عملٌ جديد. فالنصّ الذي نقدّمه تطلَّب الترجيح بين تضمين النصوص السابقة أو استبعادها، إضافةً إلى تقديم تفسيرنا الخاصّ في بعض المواضع، مما هو غير موجود -على الأقلّ بالشكل ذاته- في المصادر القديمة.
وبالتالي، فتفسيرنا تفسير جديد، يستند تمامًا -مع ذلك- إلى الفكر الإسلامي التقليدي، والتراث التفسيري السابق. ونحن -لا المفسّرون السابقون- مَن تقع علينا المسؤولية التامّة عن محتواه، الذي يحوي -مع ذلك- العديد من الاستشهادات من التفاسير التقليدية التي رجعنا إليها (صxliii- xliv، والتشديد مضاف).
ويوضّح نصر أنّ هذا التفسير شأنٌ إسلاميٌّ خالص، وأن جميع المشاركين فيه مسلمون، وأنه مع كون الكتاب «يقوم على أعلى درجات البحث العلمي، فلن يخضع أو يتّبع المزاعم الواردة في الدراسات التي يقدّمها الباحثون الغربيون من غير المسلمين»، الذين ربّما تناولوا جوانب مختلفة من القرآن «ولكنهم لا يرونه كلمةَ الله ووحيًا منه» (صxl).
لذا فإنّ القرآن المفسّر يمثّل ترجمة جديدة للقرآن وتفسيرًا مستقًى في الأساس من خلاصات موجزة من آراء مفسّري العصر الوسيط. وبالتالي، يعدّ هذا العمل -ضمن التراث التفسيري- خلاصةً للمعارف السابقة؛ وبوصفه عملًا شعبيًّا، كما قد تصفه جامعتي، فقد نجح في ذلك. وبقدر إضافته الجديدة الواعية، فإنها تأتي في نطاق التفسيرات الجديدة لآيات بعينها، وهي تفسيرات نابعة من منظور إيماني أو داخلي. فينبغي لنا أن نرى في الكتاب مصدرًا أوليًّا، وبيانًا لنهج مجموعة المسلمين في تفسير القرآن، ومرحلة أخرى في تاريخ ذلك التفسير.
ولكن بالرغم من الصبغة الإسلامية التامّة لهذا العمل وذلك الجهد المبذول للاعتماد على التراث التفسيري والإضافة إليه، لا يتشابه القرآن المفسّر مع أيّ تفسير إسلامي سابق، بل مع نوع (الكتاب المقدّس المفسّر). وهذا التشابه ليس في التفسير نفسه، بل في شكل العمل وبنيته، وفي مقاربته للنصّ.
(3) ماذا يحوي "القرآن المفسّر"؟
لعلّ أبرز سمات القرآن المفسّر هي ذلك القدر الاستثنائي من العمل المبذول فيه، فضلًا عن الحاجة إلى تنسيق جهود المشاركين فيه. بل إنّ تقديم ترجمة مباشرة للقرآن هي نفسها مهمّة شاقة، لكن الترجمة لا تمثّل سوى البداية في هذا الكتاب. فلا شكّ أنّ التفسير هو المعلَم الأبرز، ويشغل من الكتاب ما يمثّل ثلاثة أمثال أو أربعة أمثال نصّ الترجمة، وربّما أكثر من ذلك. والكتاب يسرد 41 تفسيرًا، بدءًا من تفسير مقاتل بن سليمان (ت: 150هـ= 767م)، وانتهاءً بتفسير ابن عاشور (ت: 1394هـ= 1973م)، والطباطبائي (ت: 1402هـ= 1981م). ومعظم هذه التفاسير سُنيّة، لكن هناك تمثيل للتفاسير الشيعية فضلًا عن عدد من التفاسير الصوفية. وقد حاول محرّرو الكتاب الحدّ من «التفسيرات التي هي محض تكهُّنات أو خيالات بحتة، إضافةً إلى الرؤى القائمة على الأساطير والحكايا الشعبية» (صxliv). والأهمّ من ذلك أنهم استبعدوا عمدًا «التفسيرات الحداثية أو الأصولية التي ظهرت في أجزاء من العالم الإسلامي في القرنين الماضيين» (صxl).
وأيّ قارئ واعٍ سيلحظ تلك المفارقة المتمثلة في الزعم باستبعاد التفسيرات «الحداثية» في حين أن التفسير الوارد في القرآن المفسّر هو -حيثما بدا- نتاج زمنه الخاصّ إلى حدّ كبير. ومع أنّ التجديد لا يتجلّى في كلّ صفحة، لكنه موجود، وهو غير مقتصر على التفسير وحده، بل يصل إلى بنية الكتاب نفسه. وبالتالي فإنّ أبرز سمات الكتاب هي ما نتج عن ذلك من توتّر بين التجديد وبين احترام التقليد والتراث.
الترجمة في عمومها دقيقة ونجحت في نقل معاني الكلمات إلى أقرب مقابل إنجليزي. ولكن تبقى بعض المصطلحات غير مترجمة، مثل: جزية، نسيء، ظِهار، حنيف... إلخ. وهناك بعض المحاولات لإضفاء شيء من القِدَم واستخدام لغة عتيقة (مِن قبِيل استخدام تعبيرات unto, thy, thee, وغيرها)، ولكنها تظلّ محاولات متواضعة نسبيًّا وغير ملحوظة. والسِّمات الشِّعرية أو الأدبية للقرآن لا تتضح بسهولة، لكن الترجمة البارعة الحرفية إلى حدّ ما مناسبة -بلا شك- لربط النصّ بالتفسير. وقد نتج عن ذلك ترجمات غير مألوفة، من قبِيل ما جاء في ترجمة الآية 177 من سورة البقرة: Rather, piety is he who believes in God، التي يمكن مقارنتها بترجمة محمد أسد "but truly pious is he who believes in God"، أو ترجمة آرثر أربري "True piety is this: to believe in God". فعلى الأقلّ لم تُهْمِل الترجمة صعوبة التعبير القرآني ﴿وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللهِ﴾، غير أنّ التفسير لم يتناول هذه النقطة[5].
ومع هذه القائمة الطويلة من المصادر، فإنّ أكثر التفاسير التي استقى منها الكتاب هي تفسير الطبري (ت: 310هـ= 923م)، والقرطبي (ت: 671هـ= 1272م)، وفخر الدين الرازي (ت: 606هـ= 1210م). وهذا أمر مفهوم؛ فالتفاسير المتاحة شيءٌ لا يُحصى، وليس هناك من طريقة لتوظيف جميع التفاسير الواردة في تلك القائمة بشكلٍ متّسق. وهذه التفاسير الثلاثة أعمالٌ علمية هائلة، تحوي كثيرًا من الآراء السابقة عليها أو تلخّصها، وفي تفسير الرازي ولعٌ بتناول الأوجه التي تحتملها معاني الآيات، وهو أمرٌ يروق كثيرًا من قرّاء اليوم. وقد ألقى حجم المهمّة بقيودٍ متنوّعة على المحرّرين، وهذا أحدها. ومن القيود الأخرى غياب النصّ القرآني بالعربية، وهو أمر كان لا بدّ منه ربّما، لكنّه أمرٌ كاشف ذو دلالة.
ويميل التفسير الوارد في القرآن المفسّر إلى اتباع التفاسير التقليدية السائدة، لكن هناك العديد من الاستثناءات. ويبدأ هذا من الفاتحة، أُولى سور القرآن. فيناقش الكتاب مسألة ما إذا كانت البسملة (التي تُستهلّ بها جميع السور سوى واحدة [وهي سورة التوبة]) تمثّل جزءًا من السورة أم لا، وينتقل بعد ذلك إلى ماهية البسملة نفسها. ثم يعقب ذلك خمس صفحات مكثّفة وكلّ منها ينقسم إلى عمودين، تدور حول أسماء الله والصراط المستقيم، جُلّها مأخوذ من تفاسير سابقة. وعندما يأتي الحديث عن الآية الأخيرة من السورة، نجد الكتاب يستشهد بالرأي الشائع بأنّ ﴿المَغْضُوب عَلَيْهِمْ﴾ و﴿الضَّالِّينَ﴾ هم اليهود والنصارى، على الترتيب، ولكنّ الكتاب يشير (في صفحة 11) إلى أنّ هذا الرأي يستند إلى حديث نبوي «وإن كان لا يأتي في أعلى درجات الصحّة». وفيما يبدو تفسيرًا أصيلًا، يتناول الكتاب الآية على النحو الآتي:
حين نفهم ﴿الصِّراط المُسْتَقِيم﴾ بأنه المسار الرأسي الصاعد نحو الله، فيمكننا القول بأنّ ﴿المَغْضُوب عَلَيْهِم﴾ إشارة إلى أولئك الذين يسلكون مسارًا فيه هبوط ونزول ونَأْي بهم عن الله، أمّا ﴿الضَّالِّينَ﴾ فيتعرّجون في مسار أفقي بعيدًا عن ذلك الذي يصعد بهم إلى ﴿العليّ﴾ القدير. وبالتالي فهذه الاحتمالات الثلاثة تتوافق مع الأبعاد الثلاثة للمكان، وترمز لجميع الاحتمالات الواردة في الحالة البشرية.
ومع كون القرآن المفسّر تفسيرًا تقليديًّا في العموم، يمكننا القول إنّ هناك سمة مميّزة له، وهي محاولته الكشف عن جوانب اللُّطف والرّقة والاعتدال في القرآن، ومن ثَمّ الحاجة إلى تقليص مصطلحات من قبيل «الغضب» واحتمالات وَصْم الجماعات الدينية الأخرى. وبالمثل، نجد الأمر ﴿اتَّقُوا اللهَ﴾ يُترجَم إلى "reverence God" [بجِّلوا/ وقِّروا الله] أو "be mindful" [كونوا على وعي بمقام الله]، بينما معظم الترجمات السابقة كانت تدور حول "fear God" [خافوا الله] أو تعبيرات من هذا القبِيل. فبالطبع يحاول الكتاب أن ينأى بنا عن معاني الخوف والغضب.
ولأن المحرّرين كانوا منشغلين إلى حدٍّ ما بشيءٍ من الإصلاح والتجديد، فسيندفع كثيرٌ من القرّاء إلى تعقّب كيفية تناول الكتاب للآيات الجدلية، التي تتعارض في ظاهرها مع الفضائل الشائعة اليوم ومبادئ المساواة بين الجنسين وحقوق الإنسان. ويمكننا هنا السير مع هؤلاء لنرى بأنفسنا. فالاهتمام بهذه الآيات ليس مجرّد فضول، ففي هذه الآيات الحساسة تحديدًا تكمن الإستراتيجية التفسيرية التي يتبعها الكتاب ومنها يمكن استنباطها.
وتأتي ترجمة الآية 34 من سورة النساء على النحو الآتي:
Men are the upholders and maintainers of women by virtue of that in which God has favored some of them above others and by virtue of their spending from their wealth. Therefore the righteous women are devoutly obedient, guarding in [their husbands’] absence what God has guarded. As for those from whom you fear discord and animosity, admonish them, then leave them in their beds, then strike them. Then, if they obey you, seek not a way against them. Truly God is Exalted, Great.
ويبدأ التفسير بالقول إنّ «هذه الآية هي أوضح بيان لدَور الرجل وسُلطته في العلاقة الزوجية، بوصفه القائم على الأسرة، من جهة مسؤوليته عن الإنفاق على زوجته». ومع أنّ آيات أخرى «توحي بالتبادلية في العلاقة بين الزوج والزوجة (سورة البقرة: 187، 233)»، فإنّ هذه الآية «تشير إلى تراتُبية -من منظورٍ ما- بين الطرفين، على الأقل من الناحية الاجتماعية (انظر أيضًا سورة البقرة: 228)». وهذا الإقرار الضمنيّ بأنّ القرآن ينصّ على عدم المساواة بين الجنسين، بما يتعارض مع الـمُثُل المعاصرة في أمريكا الشمالية، تصحبه محاولات مختلفة للتخفيف من عدم المساواة هذا؛ فنجد الكتاب يركّز على مسؤوليات الزوج لا على تبعيّة المرأة.
ويشير إلى أنّ الآية تضع عبء الإثبات على عاتق الزوج، بمعنى أنّ اتخاذ خطوة ضد الزوجة لا يكفي لمجرّد الخوف من الفتنة والعداوة. بل عليه أن «يتيقّن» من ذلك، لا بمجرّد الشكّ، كما جاء في تفاسير القرطبي والطبري والطبرسي (ت: 548هـ= 1153م). ومما يتعلق بهذا، إستراتيجية تخفيف النبرة أو إضفاء شيء من الغموض عليها: فيُقال إن الآية «تشير إلى تراتُبية»، لا «تأمُر» أو «تفرض» أو «تنصّ» أو أيّ شيء يعني الإيجاب؛ وهي تراتُبية جنسانية/ جندرية «من منظورٍ ما»، مما يثير التساؤل عن المنظورات الأخرى.
والمسألة الأكثر حساسية هي مسألة ضرب الزوج زوجته: ﴿وَاضْرِبُوهُنَّ﴾. فهنا مجددًا لا ينفي محرّرو الكتاب أنّ الضرب الجسدي مقصود، ولكنهم يطرحون أقوالًا تحدّ من العنف المحتمل من وراء الآية. ففي البداية يرجعون إلى مصادر مرجعية من خارج القرآن؛ منها سبب نزول الآية والأحاديث التي تبيِّن كيف أنّ النبيّ لم يضرب زوجاته قطّ، والأحكام الفقهية المناهضة للضرب. ثم يأتي السؤال: أيّ نوع من الضرب؟ لا بدّ أن يكون «دون عنف»؛ وأنْ لا يترك أثرًا؛ مع الإشارة إلى الضرب بـ«السِّواك»؛ فليس المقصود العقاب، بل تغيير سلوك الزوجة.
وهناك أيضًا فقرة تطرح تفسيرًا أحدث يرى أن الفعل (ضرَبَ) في هذه الآية يحمل معنى مختلفًا، وأنّ المقصود ليس الضرب الجسدي. ويخلص الكتاب إلى أن هذه المحاولات «غير مقنِعة بشكل تام». ومع ذلك، ففي إحدى المقالات الواردة في نهاية الكتاب، وهي المعنونة «الأخلاق القرآنية وحقوق الإنسان والمجتمع»، لا تنفي مارية ماسي -وهي من محرّري الكتاب- احتمالات هذا التحوّل الدلالي، وتضيف جانبًا آخر للمسألة؛ وهو أن الآراء حول هذه الآية (كما هو الحال مع مسائل أخرى) متأثرة بالأفكار «الغربية». وتضيف «بقدر ما يبدو هذا مسيئًا لدى الآذان الغربية، في ضوء التجريم الغربي لجميع الأشكال الجسدية للعنف المنزلي، [...]» (ص1795، وانظر أيضًا ص1785، 1794، 1804).
وبالأسلوب نفسه يجرى تناول النقاط الجدلية الأخرى حول وضع المرأة، مثل القسم الأول من الآية 34 من سورة النساء: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ﴾[6]، أو حقّ الرجل في الزواج من أربع زوجات (الآية الثالثة من السورة نفسها). ولكون التفسير مرتبكًا حيال هذه الآيات، فهو يحاول التخفيف من القراءة الواضحة لها. والأهم أنه ليست هناك محاولة لنفي المعنى الأساسي للنصّ، وليست هناك جهود مباشرة للحدّ من تطبيق الآيات والزعم -مثلًا- أنها محصورة بالظروف الاجتماعية أو السياسية في شبه الجزيرة العربية في القرن السابع الميلادي، وإن كان بالإمكان الإشارة إلى مثل تلك الأقوال. وبالتالي فالتأويل الذي يتبعه الكتاب متّسق في إقراره بعصمة النصّ القرآني كاملًا، وفي عدم توظيف المعايير الأخلاقية المعاصرة لتجاوز الوحي في بعض المواضع[7].
على سبيل المثال، يكرّر التفسيرُ الوارد حول الآية الثالثة من سورة النساء ذلك القولَ نفسَه بأنّ الآية ليست «إجازة جديدة للتعدّد»، وإنما هي كبحٌ للممارسات التي سادت قبل ظهور الإسلام. (ومع ذلك، يمكن للمرء الإشارة إلى أن التفاسير ليست المصدر الوحيد حول الأعراف التي كانت قائمة قبل الإسلام). والأهم من ذلك هو التأويل الذي يُوظّفه الكتاب: نقل أهمية الموضوع الذي تتناوله الآيات من قضايا الجندر (النوع الاجتماعي) إلى مسائل العدل والنظام الاجتماعي.
تدور الآية كلّها حول قضية العدل؛ فلا هي تدعو إلى التعدّد أو ترفضه مطلقًا، وإنما تنصح بالصورة التي تحقّق بأفضل طريقة المعاملة العادلة للأيتام والزوجات وغيرهم ممن يعولهم المرء. (ص190).
وانتقالًا من مسألة الجندر إلى العنف، لننظر إلى الآية 33 من سورة المائدة:
﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾.
يأتي تفسير الآية دون إحجام عن تقديم النبي في صورةٍ غير جذّابة، مع درجةٍ عالية من النزوع إلى الانتقام. ويشير إلى سبب نزول الآية حين زعم بعضهم اعتناق الإسلام ثم قتلوا الراعي وسرقوا الإبل التي أرسلها معهم النبي.
لقد أمر النبي بالإمساك بهم، وقيل: إنه أمر بقطعِ أيديهم وأرجلهم، وبِسَمْلِ أعينهم، ثم إلقائهم في العراء حتى ماتوا (تفاسير القرطبي والطبري والواحدي). فنزلت هذه الآية، لتضع عقوبةً لمثل هذه الجرائم، وهي العقوبات الأربع الواردة هنا: قطع الأيدي والأرجُل من خِلاف، أو القتل، أو الصَّلْب، أو النفي [...]. (ص293).
من ناحية أخرى، فإن إستراتيجية التفسير هنا تقوم، مجددًا، على إحداث نقلة في الحديث عن موضوع الآية. فيُورد الكتاب أنّ بعض المفسّرين يرون أنه نظرًا لكون المجرمين الذين تتحدّث عنهم الآية مرتدّين، فإنّ العقوبات الواردة فيها تنطبق على المرتدين عمومًا. «ومع ذلك، يبدو واضحًا أن العقوبات القاسية في هذه الآية تتعلّق تحديدًا بأولئك الذي يرتكبون جرائم مختلفة بصفاقةٍ وبوحشية استثنائية وعنفٍ وإرهاب للناس غير مسبوقَين». ثم يطرح الكتاب سلسلة من الآراء، ونرى هناك ميلًا للبدء بالأكثر عُرضةً للرفض إلى أن نصل إلى القراءات المقبولة للنصّ. ولتقديم عرض جزئي للآراء التي تناولت وحشية العقوبة الواردة في الآية 33 من سورة المائدة، يمكننا قراءتها بوصفها: 1) «توضيحًا في ضوء أفعال النبي أو حتّى تبنِّيًا لها»، أو بداية لحدوث تحوّل في الموضوع، أو بوصفها 2) «نقد جزئي وإلغاء للشدّة التي اتسَم بها ردّ فعل النبيّ»، أو بوصفها -أخيرًا- 3) «حظر ضمني للتعذيب (تفسير القرطبي)؛ وقد نأى النبي -في الحقيقة- عن أيّ نوع من التعذيب، سواء قبل هذا الحادث أو بعده (تفسير القرطبي)».
وبالتالي، ففي حين أن المفسِّرين السابقين ربما فهموا المسألة على أنها إنزال للعقوبة، يؤكّد «القرآن المفسّر» على تقليص نطاق تلك العقوبة. ومن خلال تعيين سبب النزول، تميل الآراء التفسيرية التي يُوردها الكتاب إلى التخفيف من حدّة هذا الحكم شيئًا ما. ومع أنه ليس هناك إطلاقًا أيّ نفي للقسوة الكامنة في الآية، فإنها تتناقض بوضوح مع الرؤية التي يتبنّاها محرّرو الكتاب الذين يؤكّدون على مسألة العدل والتناسُب لا العنف والعقاب. وكما يُسْهِب الكتاب في البيان، فقد يكون لتفسيراتهم المفضَّلة بعض السوابق في التراث. غير أنّ العدل والتحرّر من القمع لم يكونَا في حدِّ ذاتهما من بين الإستراتيجيات التأويلية لدى مفسِّري العصر الوسيط.
ومثال آخر في الآيتَين: 80- 81 من سورة الأعراف:
﴿وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ * إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ﴾.
لقد فهم المفسِّرون الأوائل هذه الآية على أنها تشير إلى الشذوذ الجنسي، ولكنها قد تحمل مزيدًا من الخفايا والدقائق، كما يرى القرآن المفسّر.
لقد دفع السلوك الوحشي لأهل سدوم -كما جاء في الكتاب المقدَّس وكذلك في الآيات: 77- 79 من سورة هود، والآيات: 67- 71 من سورة الحِجر- بعضًا إلى الاعتقاد أنّ جُرْمَ قوم لوطٍ الحقيقيَّ كان هو اللّواط القسري، لا العلاقات الجنسية المثلية القائمة على التراضي. ومع أن الآية 81 [من سورة الأعراف] -وكذلك آيات أخرى؛ كما في الآيتَين: 165- 166 من سورة الشعراء، والآية 55 من سورة النمل، والآية 29 من سورة العنكبوت- تركِّز على اشتهاء الرجال ﴿مِنْ دُونِ النِّسَاءِ﴾، فإنّ الصلفَ والعنفَ الذي اتّسم به سلوكُهم وسعيُهم لإشباع رغبتهم متضمَّنان بوضوح في قصة لوط الواردة في الآيات: 77- 80 من سورة هود. (ص436، والتشديد في الأصل).
وتبدو هذه محاولة لإيجاد نوع من القبول للمثلية الجنسية، ولكن نظرًا للإقرار بأنّ آيات أخرى تشجب هذا الفعل من إقامة علاقات جنسية بين الذكور، فلستُ متأكّدًا من أن الحديث عن «اللواط القسري» هنا قد يساعد حقًّا في المسألة. ولكنه يوضّح مجدّدًا أن محرّري الكتاب -على ما يبدو- يجدون أنفسهم حائرين ما بين احترام النصّ والتراث من جهة، وما بين مراعاة التيار النسوي وحقوق الإنسان والأقليات من جهة أخرى. وإذا كانت هذه المقالة ترتكز على الأمثلة الأكثر شيوعًا عن القسوة في القرآن؛ فذلك لأن هذه الحالات هي أكثر ما يتّضح فيها الإستراتيجية التفسيرية [للكتاب].
ومن نتائج إستراتيجيات التخفيف والإدماج أننا نجد الكتاب في بعض الآيات يقدِّم مجموعة من الآراء التي تكاد تكون غير متوافقة فيما بينها (ومثال ذلك: أنّ المثلية الجنسية أمرٌ سيئ، أو أن الاعتداء الجنسي العنيف هو وحده السيئ؛ أن التعذيب محظور، بينما سَمْل الأعين مُباح للقصاص والانتقام). فما معنى أن الكتاب يطرح هذه الطائفة من الآراء المتباينة؟ كيف للقارئ أن يحكم ويختار الصواب؟ لقد اعتادت التفاسير القرآنية الإبقاء على عدد من الآراء المختلفة، ولكن في العموم (وهناك دومًا استثناءات) كان نطاق الاختلاف محدودًا إلى درجة كبيرة.
لن يجد المسلم الذي يحتاج توضيحًا حول هذه النقاط وغيرها بُغيته هنا، فليست هناك إشارات حول طرائق الاستدلال التي نتجت عنها الآراء التي يُوردها الكتاب، باستثناء الحالات التي تتناول مبادئ العدل والسلام[8]. ومع ذلك، فلا شكّ أنّ هذا مردُّه جزئيًّا إلى أسباب عملية، نظرًا لحجم المشروع، ولكن هذا قد يدفع المرء إلى التساؤل عن الفائدة المرجوّة من الدفع بطائفة من الآراء التفسيرية دون تقديم الأدلّة التي انبثقت منها هذه الآراء. فهذا الأمر لا يحجب عنّا الأدلة التي قامت عليها تلك الآراء فحسب، بل يجعلنا عُرضةً لعددٍ لا نهائي من القيود، من قبيل ما ذكرنا آنفًا: «دفع البعضَ إلى الاعتقاد»، وتناوُبٍ ما بين «بعض المفسّرين/ عدد من المفسّرين/ كثير من المفسّرين يرون/ يقولون/ يطرحون»، أو «يُقال»، أو «من الممكن»، أو «غالبًا»، أو «أحيانًا»، إلخ. ومن الواضح أن هذا يعود، في جانبٍ كبير منه، إلى بنية الكتاب، والحاجة إلى الإيجاز والاختصار والشمول، ولكن بعد صفحاتٍ وصفحاتٍ من الغموض والإبهام، كنت أتوق إلى شيء أكثر قوةً وحسمًا.
ومن المساحات التي يتّخذ فيها الكتاب موقفًا ما مسألة حدّ الزنا. فالآية الثانية من سورة النور تحدّد الجَلْدَ عقوبةً للزنا، ولكن الإجماع الفقهي في الإسلام اختار الرجمَ حتى الموت ليكون العقوبةَ الملائمة، استنادًا إلى عدد من الأحاديث المرويّة عن النبيّ، إضافةً إلى عدد من الأخبار عمّا جرى العمل به في عهد الخلفاء الأوائل. ويبذل محرّرو الكتاب جهدًا كبيرًا لتوصيف أدلة الرّجم من خارج القرآن، ويسردون قائمة بأسباب مختلفة لكونها -من وجهة نظرهم- أدلّة غير متّسقة وبالتالي لا يمكن الدفاع عنها. فلماذا اختار محرّرو الكتاب اتخاذ موقف من الرّجم مع إقرارهم بأنّ القرآن يبدو مؤيّدًا لعدد من الممارسات الأخرى غير العصرية؟ ربما كان هذا لأن الحُكم في هذه الحال [أي حُكم الرجم] لم يرِد في القرآن (أو لم يعُد في القرآن على كلّ حال)[9]. وهم لا يقولون إن هذه الممارسة وحشية؛ بل يرفضونها على أُسس فقهية أو منطقية، لا على أُسس أخلاقية. وقد أدان نقّاد الكتاب انفصالَ أسلوبه في التفسير عن الإجماع الفقهي الراسخ، متّهمين محرّريه بإساءة فهم الأحاديث النبوية والمناهج الفقهية[10].
ومع اجتناب الفصل في هذا المثال تحديدًا، أُشير إلى أن هذه الخلافات ليست مثار دهشة على الإطلاق. فتفسير القرآن ليس سوى جانب واحد من جهد علميّ كبير. فالتراث الفكري للتفسير شيءٌ يتجاوز محضَ التناول المباشر للقرآن، ولكن هذا لا يتجلّى في الكتاب، الذي هو تفسيرٌ للقرآن من أشخاصٍ لم يكن يُعتقد في السابق أنهم مؤهلون لكتابة تفسير. وعلى الرغم من كلّ الجهود التي بذلها محرّرو الكتاب لتقديم لمحة عن الأصالة والتنوّع اللذَيْن اتسمت بهما الجهود العلمية السابقة، فإنّ أولئك الذين يُعتقد عادةً أنهم مؤهّلون لكتابة تفسير للقرآن سيستهجنون كثيرًا من جوانب هذا الكتاب الجديد.
ماذا عن أُولى الآيات المكية؟ تلك التي لا تكاد تحوي شيئًا من الأحكام، ولكنها تنشغل بتصورات وأفكار مدهشة وقوية، وأحيانًا غامضة؟ بم يخبرنا الكتاب عن آيات الوحي المبكّرة؟
هناك يتجلّى مكمَنُ الضعف في المقاربة الحرفية للترجمة. فإذا كانت الترجمة المباشرة والحرفية قد أفادت في كثير من الجهد التفسيري، لكنها هنا تصبح عائقًا أكثر منها عنصرَ إيضاح؛ لأن الجانب الجمالي ضروريّ لإيصال الرسالة. وإليك ترجمة الكتاب للآيات: 6- 11 من سورة القارعة:
As for one whose scales are heavy, / he shall enjoy a life contenting. / And as for one whose scales are light, / An abyss shall be his mother. / And what shall apprise thee of her? / It is a raging fire.
وقارنها بترجمة أربري:
Then he whose deeds weigh heavy in the Balance shall inherit a pleasing life, but he whose deeds weigh light in the Balance shall plunge in the womb of the Pit.
And what shall teach thee what is the Pit? A blazing Fire!
في بعض الأحيان يكون للتفسير شيءٌ من اليأس حيال [معنى] هذه الآيات. ففي تفسير الآية 11 ﴿نَارٌ حَامِيَةٌ﴾، نجده يذكر أنه قد قيل: إن هذه الآية تعني النارَ التي وصلت أقصى درجات الحرارة الممكنة (الشوكاني)، وأنّ أيّ نارٍ إذا ما قُورِنَت بها لن تكون حامية (الرازي).
أو حين يتناول الآيتَين الأولى والثانية من سورة الشمس: ﴿وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا * وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا﴾؛ إذ نجد الكتاب يعلّق على الآية الثانية كما يأتي:
يمكن القول إنّ في هذه الآية تلميحًا إلى أنّ نورَ القمر ليس سوى انعكاس لضياء الشمس (ابن كثير، والقرطبيّ، والرازي) أو أن الهلال الوليد، الذي يظهر في مستهلّ كلّ شهر عربيّ، يتجلّى في الأفق بالقرب من مَغرِب الشمس، ثم يغرب في أعقابها (ابن كثير، والقرطبيّ). وبالإمكان أيضًا القول إنّ هذه الآيةَ إشارةٌ إلى اختلاف مدارَي الشمس والقمر، وتوظيف ذلك في حساب عدد السنين. (ص1519).
قد نقرّ بصعوبة نقل اللمحة الجمالية في اللغة العربية، ولكن هل بإمكاننا التغاضي عن هذا التفسير الركيك؟ نعم، بإمكاننا؛ لأن صنعة التفسير نفسها نثريّة للغاية، وليس هذا الكتاب إلا إعادة إنتاج للنظرات التفسيرية السابقة، التي نادرًا ما ناقشت الجوانب الجمالية للوحي[11]؛ فللتفسير -كحقل ونوع خاصّ من التأليف- حدوده الخاصّة. ومع أنّ بمقدورنا دومًا العثورَ على استثناءات جزئية (أو زعمَ ذلك)، فإنّ السِّمات الشِّعرية والوعظية للقرآن لا تتجلّي دومًا في التفاسير؛ إِذْ عادةً ما يشحب بريقُ الآيات الوعظية تحديدًا -التي لها قوّتها الذاتية- في المصنّفات التفسيرية التي تُعنى في المقام الأول بالجانب الفكري [للقرآن]، فضلًا عن أنّ عجز التفاسير عن نقل قوّة الرسالة القرآنية يبرز بشكلٍ أوضح خلال الترجمة. وربما كان علينا هنا أن نضيف أنّ معظم المسلمين ربما يتذّوقون القرآن بصورة أفضل من خلال خصائصه الجمالية والوعظية.
يمتاز القرآن المفسّر عن التفاسير التراثية بطريقة تناوله للأديان الأخرى. وقد أشرت بالفعل إلى تفسيره للآية السابعة من سورة الفاتحة، حيث يجري إغفال الربط التقليدي للفئتَين اللتين تتحدث عنهما الآية باليهود والنصارى. كذلك، ففي نهاية الكتاب، وتحديدًا عن الحديث عن الآية الثالثة من سورة الإخلاص: ﴿لَمْ يَلِدْ ولَمْ يُولَدْ﴾، يقرّ الكتاب بأن «هذه الآية تُفسَّر على أنها إنكارٌ لكون المسيح "ابن الله"»، ولكنّه يرى أنّ «التصوّر المسيحيّ للبنوّة لا يتطابق مع تصوّر الوثنيّين العرب الذين تنتقدهم بعض الآيات الأخرى لنسبتهم الولدَ إلى الله (وعادةً ما يجعلون له البنات)، كما في الآية 57 من سورة النحل [...]. وبالتالي، فإنّ محاولات ربط هذه الآية بالنقاش حول المسيحية ضعيفة نوعًا ما [...]» (ص1580).
لكن هناك أمثلة أخرى تنطوي على أحكامٍ إيجابية بشأن صحة أديانٍ غير الإسلام. وهناك بعض التأييد لهذه المواقف في القرآن نفسِه وفي التفاسير، ولكنها بالطبع تظلّ مواقف تشكِّل انفصالًا عن التقليد [التفسيري]. ومن أبرز الأمثلة الصارخة على ذلك ما جاء في تفسير الآية 199 من سورة آل عمران:
﴿وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾.
مَن هم أهل الكتاب المؤمنون هؤلاء؟ يقرّ الكتاب أن بعض التفاسير ترى أنهم ليسوا سوى بعض الأفراد بعينهم، مثل عبد الله بن سَلَام الذي اعتنق الإسلام، أو نجاشيّ الحبشة الذي آوَى [في بلادِه] بعضَ المسلمين [الأوائل] قبل الهجرة إلى المدينة. لكنّ محرّري الكتاب يتجاوزون هذا الرأي، ليقدِّموا الآية في إطارٍ أكثر شمولًا (ص187):
من الممكن تفسير هذه الآية بأنها تشير إلى توكيد الحقائق التي -وفقًا للإسلام- تتفق عليها جميع الأديان الصحيحة: الإيمان بالله الواحد، والحساب الأخروي، وقيم العدل والرحمة [بين الناس] في الدنيا، وغيرها من المسائل المماثلة.
(ولست على ثقةٍ إن كانت هذه رؤيةً موسَّعة حول «الأديان الحقّة» أم رؤيةً محدودة لها). ثم يواصل محرّرو الكتاب القول:
ربما كان هناك احتمال ثالث، غالبًا لم يتناوله المسلمون إلّا مؤخرًا؛ وهو أن بإمكان المرء أن يظلّ مسيحيًّا مع إقراره بنبوّة محمد وصِدْق ما أُوحي إليه.
وفي مواضع أخرى، لا سيما عند الآية: 48 من سورة المائدة، يؤكّد الكتاب أنّ الأديانَ المختلفة، بطوائفها وشرائعها وطقوسها، صادرةٌ عن العناية الإلهية. فالآية لا تتعلّق باليهود والنصارى فحسب، بل تطرح فكرة عامة تتصل بجميع الأديان. وكما تنصّ الآية: ﴿لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا﴾، ربما كانت لجميع الطوائف الدينية المختلفة طقوسٌ وشرائعُ مختلفة، «جعلها» الله لهم، وكلُّ ديانةٍ مستقلةٌ في شرائعها عن غيرها من الديانات، حتى وإن كانت الحقائق الدينية والمبادئ الأساسية واحدةً (ابن كثير، والقرطبيّ، والرازي، والطبري).
إنّ القولَ بأنّ هناك مسارات نحو الحقيقة والنجاة بخلاف الإسلام قولٌ له ما بعده، ولا يُستهان به[12]. فهو يتعارض مع الروح العامة للتفاسير الوسيطة، وإن لم يكن غائبًا تمامًا عنها (وقد أشار الكتاب إلى هذا). وبالطبع سيرحّب بعضهم بهذا التفسير، بينما سيُصْدَم آخرون لكون دليلٍ إسلاميٍّ إلى التفاسير القرآنية يبدو كأنه يرى نظمًا عقائدية مشروعة لا تتطلَّب الإيمان بنبوّة محمد أو القرآن نفسه. وأكرّر أنه ليس لي اتخاذ موقف حيالَ هذه المسألة، ولكني أودّ تنبيه كِلَا الجانبَين [المرحِّبين بهذا التفسير وغيرهم] إلى أنّ النظرة الوحدويّة (المسكونية) لهذا الكتاب (القرآن المفسّر) تخفّفها حقيقة أنه يجعل جميع «الأديان» تبدو -على نحوٍ مثير للريبة- مشابهةً للإسلام؛ فلها أنبياء وميثاق وبها «ما يراه [القرآنُ] لبَّ جميع المواثيق، ألا وهو الخضوع التامّ لله»[13].
(4) "القرآن المفسر" وعلم التفسير:
تركّز غالبية التفاعلات مع الكتاب والمراجعات التي تتناوله على تفسيره لآياتٍ بعينها وتناوُله لبعض الموضوعات، ونطاق المعاني التي يقدّمها. لكن هناك قضايا بنيوية أبعد من ذلك، تشكّل ماهية الكتاب وطبيعته. وربما من المبتذل القول إنه يعكس الثقافة التي أنتجته، لكن التفاسير القديمة ليست مصدر التأثير الوحيد في شكل الكتاب ومحتواه.
وقد اتهم بعضُ النقّاد الكتابَ، وكبير محرّريه تحديدًا [حسين نصر]، بأنهم من أتباع مدرسة «الحكمة الخالدة»[14] (Perennialism) أكثر منهم مسلمين. وهذا المصطلح يشير إلى مدرسة فكرية ترتبط بعددٍ من المفكّرين؛ منهم[15]: رينيه غينو (René Guénon)، وفرِثْيُوف شُوون (Frithjof Schuon)، وترى أن هناك حقائق كونية عامة تشترك فيها جميع أديان العالَـم، الأمر الذي يعني بوضوح أنه ليس هناك دينٌ واحد يحتكر الحقيقة. ولستُ مؤهَّلًا لتعيين الحكمة الخالدة على هذا النحو، ولكن قطعًا من أبرز الطرق التي يميِّز بها الكتاب نفسه هي رؤيته الوحدوية سواء تجاه الطوائف الإسلامية المختلفة أو الأديان الأخرى[16]. فمن جانبي قد أقول إنّ أوضَح تأثير «غير إسلامي» في الكتاب ليس هو «المدرسة التقليدية» (Traditionalism) أو «الفلسفة الخالدة»، ولكنّه شيءٌ أقلّ غرابة. فالكتاب يتّسم برؤية بروتستانتية للدِّين. وربّما كان لـ«تعددية الخلاص»[17](Soteriologicalpluralism) أثرُها في فهم بعض الآيات، ولكن البروتستانتية حدّدت معالمَ شكل الكتاب وبنيته. وأعني بهذا أنّ الرؤى المعاصرة للدِّين، لا سيما في الغرب وإن لم يقتصر الأمر عليه، تميل إلى اتّباع النموذج البروتستانتي الذي يتخذ التجربة الأوروبية اللاحقة على عصر التنوير معيارًا ومثَلًا، حتى صار مفهوم «الإيمان» (faith) مرادفًا لمفهوم «الدين» (religion). والكتاب يتوافق مع هذا النموذج؛ مع أنه -في الوقت ذاته- يرتكز على -ويُسهِم في- تراث تفسيري يقوم على تصوُّر مختلف تمامًا للدين وللعلاقة بين نصوص الوحي والمؤمنين بها.
وأوضحُ وجهٍ للتشابه مع البروتستانتية هو التركيز على النصّ المقدّس نفسه، وعلى علاقة المؤمن الفرد -من دون واسطة- مع ذلك النصّ. وهذا هو سبب وجود «النصوص المقدسة المفسّرة» (study scriptures)، بدءًا بطبعة جنيڤ من الكتاب المقدّس. وصيغة «النصّ المفسر» تتطلّب تقديم المعلومات بطريقة يفهمها القارئ غير المتخصّص، وتقييم ذلك النصّ وتقديم أحكام قيمية بشأنه على نحوٍ ما. ومما يرتبط بهذا المبدأ الأساسي فكرة أنّ السلطة الدينية تقوم على النصّ المقدّس، مع التأكيد على الإيمان والعقيدة بوصفهما أهم عناصر الانتماء والممارسة الدينية، إضافةً إلى اتخاذ موقف مناهض للتراتُبية [الكنسية]. ويُعتقَد أن من النتائج (غير المقصودة) لهذه المقاربة التسامح مع التنوّع الديني واحترام الحرية الفردية في الاعتقاد[18][19].
ومع أنّ الكتاب يسعى إلى تقديم مواد من مصنفات التفسير، وهو الأمر الذي أجاد فيه على نحوٍ باهر؛ نجده في الوقت ذاته يُخالف هذا التراث التفسيري. فمن الواضح أن الاهتمام بالنصّ المقدس والقارئ يدفع الكتاب إلى التركيز على «معنى» النصّ. وقد يكون هذا واضحًا بديهيًّا، ولكنه ليس كذلك من الناحية التاريخية. فربما كان المعنى السهل للنصّ هو الاستثناء لا القاعدة.
غير أنّ «المعنى» ليس سوى جزء من التفسير؛ وإلا ما كانت هناك حاجة إلى الاستمرار في تصنيف التفاسير. ولننظر لكون الكتاب يقتبس بكثافة من ثلاثة تفاسير بعينها. فهذا في الأساس لأن المعنى الأساسي للآيات لم يشهد كثيرًا من التغيير بعد الفترة التكوينية. صحيح أن طبيعة حقل التفسير تغيّرت، لكن شرح الآيات وتفسيرها لم يتغيَّر كثيرًا. وقد كانت للتفاسير أولويات أخرى، وكانت تؤدّي مهامّ أخرى؛ إِذْ من أولوياتها الحفاظ على النصّ وروايته عبر الأجيال. ففي ثقافة تقوم على المخطوط، كان كثير من الاهتمام العلمي منصبًّا ببساطة على عملية النّسخ، لكن المخطوطات كانت عرضةً للضياع بسهولة، وكان التضارب والاختلاف بين النصوص أمرًا شائعًا ويصعب تعقّبه. أمّا في عصر الطباعة فلم يصبح ضمان الحفاظ على النصوص ووحدتها أسهل بكثير فحسب، بل صار العلماء والباحثون أقدر على تكريس مزيد من الوقت والجهد للقراءة والتأمُّل، مما أدى ربما إلى زيادة الاهتمام بـ«معنى» النصّ و«جلائه»[20]. والعصر الحالي يمثّل فترة انتقالية جارية، مع خضوع منتجات ثقافة المخطوط لتقنيات الطباعة وكذلك للوسائط الرقمية أيضًا.
وفي حالة كتابنا هذا، فأحد الدلائل على هذه الفترة الانتقالية هو التجاهل النسبي للقراءات المختلفة. هل صحيح أن ما كان يُقصد منه أن يكون ضمانةً لتواتر النقل الصحيح صار الآن يُعَدّ عائقًا؟ يستشهد الكتاب كثيرًا بقراءات مختلفة (وفي موضع واحد على الأقل ينقل عن «مصحف» أُبيّ [ص1563]). وقد يشعر المرء أن فكرة القراءات المختلفة تشكّل تهديدًا لمصداقية الوحي أو دقّته. لذا فإن محمد مصطفى الأعظمي، في مقالته الواردة في الكتاب بعنوان: «الرؤية الإسلامية للقرآن» (The Islamic View of the Quran)، يفضّل استخدام مصطلح «القراءات المتعددة» (multiple readings) على «القراءات المختلفة» (variant readings) لكَون الأخيرة توحي بحالة من اللا يَقين حول القراءة «الصحيحة»، بينما كلّها -في هذا التصور- «صحيحة». ففي مقدمة العمل، يقول نصر إنه «ليس هناك سوى قرآن واحد، مع تبايُنات أقلّ في كلّ الأحوال مما هو موجود في أيّ نص مقدّس آخر» (صxxxiv)، وهو تباهٍ ينمّ فيما يبدو عن قلقٍ ما[21].
مِن أبرزِ الوظائف الأخرى للتفسير تعزيزُ مقاربات أو رؤى أيديولوجية معينة، والاختلاف التقليدي بين التفسير بالمأثور والتفسير بالرأي مثال واضحٌ على ذلك، فكلُّ مدرسةٍ من المدرستَيْن تدعو إلى طريقةٍ ما في تناول القرآن، لا سيما من جهة المصادر والأساس الذي ترتكز عليه الأقوال التفسيرية. ولكن الأمر قد يتعلّق أيضًا بالآراء الكلامية (التسيير والتخيير، والعدل الإلهي) أو الانتماء المذهبي (من تشيُّع وتصوُّف، أو غير ذلك من الآراء والمصادر). قد تكون هذه المسائل واضحةً تمامًا في بعض الأحيان، وقد لا تكون كذلك في أحيان أخرى، لكن هناك دومًا نوعٌ من التفرُّد والخصوصية، شيءٌ يبرّر تصنيفَ تفسيرٍ جديد. وهذه الأهمية التي يحظى بها المنهج والمقارَبة [التفسيرية] تعني أنّ هناك اختلافًا كبيرًا بين ما يصلنا حين نقرأ في القرآن المفسّر أنّ رأيًا ما قد ورَد في تفسير الطبري وبين قراءة تفسير الطبري نفسه. فحين يسرد الطبري عددًا من الأقوال المختلفة، ثم ينتقي منها ما يراه الأصوب، يكون لدى القارئ إلمامٌ بالآليّة والمعايير التي سار عليها (استنادًا -في الغالب- إلى أقوال السابقين)، وبالأساس الذي وصل بناءً عليه إلى ترجيح قولٍ ما. وأرى أن هذه العملية -من اختيار المصادر وإعمال النظر- تتساوى -على الأقلّ- في أهميتها بالنسبة لصنعة التفسير مع النتائج التي يصل إليها المفسِّر. ومع ذلك، فهذه الأُسس تكاد تغيب تمامًا عن القرآن المفسّر. ولكني أعود فأكرّر أن الكتاب لا يمكنه تقديم كلّ شيء؛ فللاعتبارات العملية دورها هنا. ولكن من المهم أن نعي ما لا يمثّله الكتاب؛ وهو أنه ليس، بحالٍ من الأحوال، بديلًا عن التفاسير الوسيطة التي ينقل عنها.
فالتفاسير القرآنية لا تتناول معنى الآية فحسب، بل جميع أشكال المعارف المتّصلة بها: ما عُرف عن سبب نزولها، وما استُخدِم من ألفاظها في الشِّعْر الجاهلي، وأصوب الطرق في قراءتها والنطق بحروفها؛ وباختصار كلّ شيء يتعلّق بالآية. ومن خلال قراءة الأعمال الكبرى في التفسير، يشعر المرء أن هدفها الحفاظ على كلّ المعارف المتعلقة بالنصّ؛ وهو أمر -بداهةً- يفوق التركيز على المعنى فحسب.
ومن الجوانب المهمّة في التفسير مما أغفله القرآن المفسّر الجانب اللغوي. فالكتاب لا يحوي النصَّ العربي للقرآن، وهو ما يمثّل عقبةً كلامية؛ نظرًا لأن «قرآنًا» دون تلك اللغة هو -بالمعنى الدقيق لمفهوم القرآن- ليس هو القرآن. ولكن حتى لو أغفلنا الجانب الكلاميّ (اللاهوتي)، تبقى هناك مشاكل فيلولوجية نتيجة هذا الإغفال؛ فبغضّ النظر عن التنوّع في المصنفات التفسيرية، يندُر ألّا يكون لعلوم العربية -من جهة قواعد اللغة والنحو، فضلًا عن الصّرف والمُعجميّة تحديدًا- دورٌ رئيس فيها. ومع أن جُلّ هذا النقاش شديد التخصّص، ولا يكاد يهم الغالبية العظمى من المسلمين عبر التاريخ، أو لا يكادون يستوعبونه، لكنه يظلّ عِماد التفسير. ومع أن المرء لا يودّ أن يبدو مفرطًا في النقد، فلا مناص من القول إنّ التفسير كحقل معرفي ونوع خاصّ لا يكاد يظهر في القرآن المفسّر. وهذه نقلة هائلة في طريقة تناول القرآن؛ ولها توجُّه متوقّع، وهو سهولة الوصول والولوج إلى النصّ، أي نحو تسهيل فهم القارئ العامي للنصّ، ونحو اعتبار فهمِ ذلك العاميّ فهمًا وافيًا له مشروعيته. وربما كان غياب النصّ العربي لقيودٍ تتعلق بالنشر، ولكن من الخطأ الاعتقاد أنّ هذا هو العامل الوحيد وراء غيابه؛ لأن بنية العمل ومنهجيته ترتكز تمامًا على القراءة بالإنجليزية. فألاحظ، على سبيل المثال، أن الاستعانة بهذا الكتاب لأغراض تعليمية عادةً ما تعطينا ملخصًا للآراء والأقوال التفسيرية، ولكن إذا ما برز سؤال يثيره النصّ العربي للقرآن، فإنّ الكتاب يكاد يكون عديم الفائدة[22]، وهنا يتجلّى عمق مركزية اللغة الإنجليزية.
وعلى أصعدة أخرى، قد يكون الكتاب أقرب إلى التراث التفسيري. فمع أن معظم المسلمين عبر التاريخ لم ينشغلوا بغوامض النحو، لكنهم كان يقدِّرون الجانب الجمالي في القرآن وعظمة رسالته وسلطانها على النفوس. وهنا يعمل التقاء التفسير (بوعيٍ) والبروتستانتية (بدرجةٍ أقلّ) على تقويض هذا التقدير للجوانب الجمالية والوعظية للنصّ المقدّس. وهكذا، فمن المفارقات أنّ الكتاب الذي جاء ترويجًا لحقل فكري حقيقي، يُغْفِل ما كان في السابق جانبًا شائعًا فيه.
وتستدعي صيغة (الكتاب المفسّر) بعض المقارنات المهمّة بين الكتاب المقدّس والقرآن. فالحواشي والهوامش التوضيحية في الكتاب المقدّس المفسّر قليلة وغير ظاهرة نسبيًّا، لكنها في القرآن المفسّر تأخذ ما يصل إلى 80٪ من الصفحة في المتوسط. وبالتالي فالرسالة الحتمية التي يبثها الكتاب [إلى قُرّائه] هي أنّ القرآن نصّ صعب الفهم، يتطلّب شروحًا مطوَّلة. فلا يمكن، أو لا يجب، أن يقوم بمفرده، وهو أمرٌ فهمه المسلمون دومًا وكان أحد الأسباب التي جعل المسار العلمي الإسلامي يتخذ المنحى الذي اتخذه.
ربما لا تتجلّى علاقة الكتاب الغامضة بالتراث الذي يزعم تقديمه أكثر منها في حقيقة أن النبيّ ليس له حضورٌ كبيرٌ في مقدّمة الكتاب والمقالات المرفقة به، ولكنه دائم الحضور في التفسير. وكثير من التفسير يتطلّب ما هو أكثر من معرفة عابرة بسيرة النبي، ولكن محرّري الكتاب لا يذكرون ذلك. فلماذا التناقض؟ من البديهي أن السيرة المبسطة أو الحديث المبسط سيكون مشروعًا أعقد بكثير. إنّ أفكار القرآن هي قطعًا أيسر في الوصول إليها من الحديث/ السُّنّة، وألين وأطوَع للمحرّرين، وأنسب للعموميات التي يرغب محرّرو الكتاب في الترويج لها. غير أني بالطبع لا أنكر مركزية القرآن أو أهمية تفسيره، وإنما أقترح أن التفسير قد حظي باهتمام مُفرط غير مبرّر في الأكاديميا الغربية[23]، ومردُّ ذلك تحديدًا هو ما أفترض من تشابهه مع شروح الكتاب المقدّس.
ووَفقًا لِما يورِده كبير محرّري الكتاب، فإنّ الكتاب نفسه تفسير «حداثي»، ومثار الاهتمام الأكبر به يكمن في المعضلات التي يواجهها تحديدًا. لكن الصراع الدائر بين الولاء للتراث وبين الحاجات والضغوط المعاصرة ليس بالأمر الجديد. وأتصوَّر أن هذا الصراع يمثّل ظاهرةً درَسها ودرَّسها محرّرو الكتاب -وجميعهم تعلّموا في أقسام الدين أو أقسام الدراسات الدينية بجامعات أميركية وكندية، أو يشغلون مناصب فيها- مرارًا وتَكرارًا.
وقد يتساءَل المرء، إذن، عمّا إذا كانت البيئة الأكاديمية التي يعمل فيها محرّرو الكتاب قد أثّرت على هذا العمل، وكيف جاء هذا التأثير إن كان ثمة تأثير من هذا النوع، لكن الجواب أنّ هذا التأثير ضئيل، فلا تكاد تظهر أيّ إشارة إلى الدراسات العلمية الحديثة. قد تكون النظرة إلى الأديان الأخرى، بهذا القدر من التوجّه الوحدوي، مثيرةً للدهشة لدى الزملاء من غير المتخصّصين في الدراسات الإسلامية؛ فضلًا عن وجود قدرٍ لا بأس به من الاستشهاد بآيات الكتاب المقدّس، مع إشارات إلى كلمات عبرية؛ ولكن في العموم لا يبدو أنّ هناك توظيفًا للدراسات العلمية الحديثة حول اللغات الساميّة أو تاريخ الشرق الأدنى أو دراسة ظاهرة الدِّين نفسها. وربما هذا أمرٌ متوقّع؛ فالكتاب في نهاية المطاف شأن إسلامي، وهو في هذا الصدد عمل محافظ. ولكن يبدو أن هناك قلقًا دائمًا من مسألة الابتداع. ومن ذلك مثلًا ما يتعلّق بالإشارات المتعدّدة إلى شبه الجزيرة العربية في عصر ما قبل الإسلام. من أبرز الأمثلة على ذلك ما جاء في تفسير الآية 38 من سورة المائدة: «وَفْقَ ما جاء في تفسير القرطبي، فإنّ قطعَ اليد كان عقوبةً للسرقة في عهد الجاهلية». ومع كامل التقدير لهذا المفسِّر الكبير، لنا أن نتساءل إن كان أندلسيٌّ من القرن الثاني العشر الميلادي، عاش في مصر، يمثّل المصدرَ الأنسَب لاستقاء معلوماتنا عن عادات العرب في عصر ما قبل ظهور الإسلام[24]؛ ولنا أن نتساءل أيضًا إن كانت الدراسات المعاصرة ليست لها أهمية في هذا السياق. قد أتفهّم تحاشي تلك الأسئلة التي ربما أثارت حالةً عقدية دوغمائية، ولكن أليست هناك مساحة محايدة؟ قد تكون هناك أسباب عملية لذلك؛ إِذْ لا يمكن للمرء أن يقتبس كلّ شيء، وهذا الكتاب يستند إلى التراث التفسيري تحديدًا. لكن في الوقت ذاته، في هذا الموضع وغيره، يبثّ الكتاب شيئًا من الانعزالية، كما لو أن بعض جوانب العالم الحديث لا ينبغي أن يُترَك لها المجال لتؤثر في تفاعل المرء مع القرآن.
ومن المجالات التي هي قطعًا خارج نطاق التناول أيُّ شكل من أشكال النقد النصِّي؛ إِذْ لا جدال في صحة الوحي الإلهي وعصمة نقله وتواتره. ولا غرابة في هذا، ولكن له بعض الأثر على جمهور القرآن المفسّر. فللقرآن الكثير من السِّمات اللافتة للنظر، من قبيل خصائصه اللغوية، وآياته التي تحتمل عدّة أوجه، والإشارات الغامضة، والتناقضات الداخلية، وغيرها؛ لكن من أراد نقاش هذه المسائل فعليه أن يبحث في كتاب آخر [بخلاف هذا الكتاب]. وإذا كان من أهدافه «إزالة التصوّرات الخاطئة المنتشرة في بعض الأوساط غير الإسلامية التي ترى أن المسلمين لا يتناولون القرآن بالنظر والتدبُّر ولا يتفاعلون معه فكريًّا لاعتقادهم أنه كلمة الله»، فإنّ من الإنصاف الإشارة إلى أن هناك حدودًا لهذا النظر والتدبُّر.
فهناك عدد من الموضوعات التي لا يطرحها الكتاب، وإن كانت هذه الموضوعات هي أبرز ما يجول بأذهان كثيرين (من غير المسلمين بالتأكيد، ولكن من المسلمين أنفسهم أيضًا بلا شك). وأنا أستفيض في هذه النقطة لا من باب النقد وإنما لأني أرى أن هذا الولاء لمسألة العصمة في نقل كلمة الله وتواترها أحد السِّمَات المميِّزة لا لحقل التفسير وحده وإنما للإسلام نفسه، وهو من العناصر التي يشترك فيها القرآن المفسّر مع ما سبقه من تفاسير. فمع أن انقطاعه عن التراث واضح في جوانب، هناك في ولائه ما هو أكثر من الاستشهاد بالتفاسير التقليدية إِذْ يتجلّى إصراره الأكيد على عصمة النصّ، كما أشرتُ آنفًا، في تلك الحالات التي تتعارض فيها القناعات الراسخة المُحتفى بها مع نصوص لها ما لها من الحفاوة والتبجيل. لذا فليس الأمر بالتأكيد أنّ الكتاب يتجاهل الأسئلة الصعبة، ولكنه يختار تناوُلَ المسائل الأخلاقية لا تلك النقدية- التاريخية.
وأيّ شخصٍ لديه إلمام بالمسائل المتعلّقة بالقرآن سيجد في الكتاب شيئًا ما للاشتباك معه. وليس للمرء أن يتوقّع إجماعًا؛ نظرًا لحجم المهمّة وتعقُّدها؛ فعلى الرغم من الرؤية الوحدوية التي سعى إليها محرّرو الكتاب، تبقى الحقيقة التي لا مراء فيها أنّ الإنسان لا يمكن أن يُرضي جميع الأطياف، وأن هناك مسائل شديدة الحساسية على المحك.
لقد حذّرت الطبقة الكهنوتية في أوروبا القرون الوسطى من مخاطر القراءة الفردية [للنصّ الديني] دون مساعدةٍ من أهل العلم من رجالات الكنيسة. وقد كان الصعود اللاحق للعديد من الطوائف التي تمركزت حول أفرادٍ بعينهم[25]، ولكلٍّ منها قراءتها الخاصّة، من دلائل صدق هذا التحذير. فلا عجَب أنّ بعض قرّاء القرآن المفسّر قد يعلّقون عليه مثلما فعل الملك جيمس حين علّق على طبعة جنيڤ من الكتاب المقدّس قائلًا إن «بعض الحواشي شديدة الاجتزاء، ويُجانبها الصواب، وهي مثيرة للفتن، وتستدعي كثيرًا من الأفكار الخطيرة والمخاتلة»[26].
وعلى الرغم من ادعاءات الكتاب (لا سيما في المقدمة) أنه يقتفي أثر التراث [التفسيري]، فإنه يقدّم ما اعتادت التفاسير دومًا تقديمه، بدرجاتٍ متفاوتة؛ وهو تبجيل المرجعيات السابقة والنقل عنها مع إضافة شيء جديد. وانتقاد هذه التفاسير ليس بالأمر الجديد؛ إذ التذمُّر والشكوى من الأقران والأسلاف أمرٌ له جذوره أيضًا. فقد شكا جلال الدين السيوطي من إفراط المفسّرين في طرح التأويلات حول الآية السابعة من سورة الفاتحة: ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾؛ إِذْ قال: «رأيتُ في تفسير قولِه -سبحانه وتعالى-: ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾ نحوَ عشرةِ أقوال، مع أنّ الواردَ عن النبيّ -صلّى الله تعالَى عليه وسلم- وجميع الصحابة والتابعين ليس غير اليهود والنصارى»[27]. فهنا، وفي العديد من المواضع الأخرى، يجد القرآن المفسّر نفسه في الجانب المخالف لما ذهب إليه السيوطي، ولكنه يجد كثيرًا من السالكين لهذا الجانب. وهكذا، فالانفصال عن التراث جزء منه.
[1] العنوان الأصلي للمقالة:
Study the Quran or The Study Quran?
نُشرت في:
Journal of the American Oriental Society 138.3 (2018).
جدير بالذكر أن الترجمة الحرفية لعنوان المقالة هي (دراسة القرآن أم قرآن الدراسة)، و"قرآن الدراسة" هو عنوان الكتاب الذي يقدم فودج مراجعة له في هذه المقالة، إلا أننا عدلنا عن هذه الترجمة في عنوان المقالة وكذلك في العنوان الفرعي المضاف للتوضيح، وآثرنا أن نترجم عنوان الكتاب بـ"القرآن المفسّر" حيث إنها أكثر تعبيرًا عن طبيعة الكتاب كما توضِّح مقدمة محرريه وكذلك كما يوضِّح تناول فودج له ومقارنته بالكتب المقدسة المفسّرة غربيًّا أو ببعض التفاسير المبسّطة في السياق الإسلامي، وهذه الترجمة لا تغيِّب المقابلة التي يقصدها فودج من عنوانه الأصلي بل ربما تبرزها بصورة أكبر، حيث يقابل فودج بين دراسة القرآن على نمط الدراسات الغربية وما يرتبط بها من نواحٍ فيلولوجية وتاريخية وبين اتجاه الكتاب -الصادر ضمن حدود الأكاديميا الغربية- لتقديم معنى القرآن ضمن تقليد تفسيري إسلامي حيّ، وهو ما توضحه ترجمة العنوان بهذا الشكل أكثر من الترجمة الحرفيّة، كذلك فقد أضفنا العنوان الفرعي لتوضيح موضوع المقالة. (قسم الترجمات).
[2] ترجم المقالة: إسلام أحمد، مترجم وباحث، له عدد من الأعمال المنشورة.
[3] هذه المقالة مراجعة لكتاب: القرآن المفسّر (The Study Quran)، الذي حرّره كلٌّ من سيد حسين نصر وتشانر داغلي ومارية ماسي وجوزيف لُمبارد ومحمد رُستم؛ وصدر عن دار هاربر وان في نيويورك عام 2015م، ويأتي في 1996 صفحة إضافةً إلى المقدّمات، ويُباع بستّين دولارًا للنسخة. وأودّ هنا أن أشكر وليام غراهام (William Graham) وديڤيد هولِنبرغ (David Hollenberg) ولويزا شيا (Louisa Shea)، لتعليقاتهم على هذه المراجعة، ولكن لا يتحمّل أحدٌ منهم مسؤولية الآراء الواردة فيها.
[4] تُوفي -رحمه الله- في 19 آذار/ مارس 2021م. (المترجم).
[5] وكذلك في الآية 89 من سورة البقرة: ﴿وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى...﴾.
[وجدت التفسيرَ يتناولها، ويتحدث عن faith in God، فلا أفهم سبب هذا القول الذي جاء به الكاتب. (المترجم)].
[6] قارن هذا بترجمة كلٍّ من:
أربري: Men are the managers of the affairs of women.
ومحمد أسد: Men shall take full care of women.
وبكثال: Men are in charge of women.
وعبد الحليم: Husbands should take good care of their wives.
[7] في مقالتها عن الأخلاق القرآنية، تحدّد مارية ماسي خمسة مبادئ لنظرة النصّ المقدّس إلى الحقوق والمسؤوليات والأخلاق، ولكنها لا تخلط بين هذه المبادئ وبين المقاربة التفسيرية لنصوص الوحي. ويتجلّى تأويلها الخاص بوضوح في هذه الفقرات، لا سيما فيما يتصل بالآية رقم 34 من سورة النساء (ص1794- 1796 من الكتاب).
[8] لا يدّعي الكتاب أنه يتناول المسائل المعاصرة لمسلمي اليوم. وهناك ميل ملحوظ للجوانب الروحية، ومحاولات قليلة أو منعدمة لجعل التراث التفسيري عمليًّا. فعلى سبيل المثال، لن يهمّ حقًّا معرفة أنّ الحد الأدنى لقيمة المسروقات لكي تُقطَع اليد كما تنصّ الآية 38 من سورة المائدة هو «ما يساوي سعر درع» (ص295).
[9] هناك بعض مَن يزعمون وجود ما يسمّونه «آية الرَّجم»، التي لم تُدرَج في النسخة النهائية من المصحف (وذلك -في أحد الأقوال- لأنّ ورقة النخيل التي كُتِبَت عليها أكلتها ماعز أو شاة). انظر:
Th. Nöldeke and F. Schwally, Geschichte des Qorāns, 2nd ed. (Leipzig: Dieterich’sche Verlagsbuchhandlung, 1909), 1: 248–52.
[10] على سبيل المثال:
G. F. Haddad, in The Muslim World Book Review 36.3 (2016): 20–25; M. Vaid, at muslimmatters.org/2015/12/14/the-study-quran-a-review.
[11] مع غياب السمات الشعرية [للقرآن] عن الكتاب، فإنه يبذل جهدًا محمودًا في نقل الجوانب الأخرى. ففي بقية تفسيره لسورة الشمس، على سبيل المثال، نجده يقدّم كثيرًا من المعلومات فيما يتعلّق بالإشارة إلى الروح وناقة ثمود.
[12] وإذا أردنا مثالًا آخر لاستكمال الصورة، فلننظر إلى الآية 85 من سورة آل عمران: ﴿وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ﴾، التي غالبًا ما تُترجَم إلى: Whosoever seeks a religion other than Islam, it shall not be accepted of him؛ لكن القرآن المفسّر ترجم ﴿الإسلام﴾ إلى "submission"، وجاء في التفسير أن «المسألة في هذه الآية تدور حول ما إذا كان هذا الإسلامُ لله قد يشمل آخرين غير أتباع النبيّ محمد» (ص153- 154).
[13] من المقالة المصاحِبة التي كتبها جوزيف لُمبارد بعنوان: «الرؤية القرآنية للتاريخ المقدّس والديانات الأخرى» (The Quranic View of Sacred History and Other Religions)، ص1784.
[14] الحكمة الخالدة أو الفلسفة الخالدة (perennial philosophy/ perennialism / perennial wisdom)، هي فلسفة ترى أنّ جميع التقاليد الدينية ذاتُ أصلٍ واحد وحقيقةٍ واحدة أزلية، انبثقت منها المعارف والعقائد والأديان كافة. (المترجم)
[15] كلاهما أسلَم واتخذ اسمًا عربيًّا: عبد الواحد يحيى وعيسى نور الدين أحمد، على الترتيب. (المترجم)
[16] ليست هناك صلة بين النقطة التي أثيرها هنا وبين ما إذا كانت التفسيرات لها ما يُبرّرها في المُعطيات القرآنية؛ فالنقطة التي أطرحها هي عن مجرّد التبايُن مع التفاسير القديمة.
[17] هذا المصطلح مُستقى من مُبين وحيد. انظر الهامش رقم 10.
[18] من الواضح أني لا أقول -بحال من الأحوال- إن التنوع أو قيام المرء بتفسير النصوص المقدَّسة بنفسه، أو حرية الدِّين هي أمور تنفرد بها المسيحية البروتستانتية أو الغرب، أو أيّ شيء من هذا القبيل. انظر على سبيل المثال:
D. MacCulloch, The Reformation: A History (New York: Viking, 2003), 651–56; J. Pelikan, Reformation of Church and Dogma (1300–1700), The Christian Tradition, vol. 4 (Chicago: Univ. of Chicago Press, 1984), 323–25; idem, Whose Bible Is It? A Short History of the Scriptures (London: Penguin, 2005), 176–77.
[19] يهتم كثير من الدارسين المعاصرين ومنهم ترافيس زاده وفودج نفسه بتأثير البروتستانتية على عزل القرآن عن التفسير في الدراسات الغربية، وبالتالي عدم الاهتمام بدراسة التفسير كجزء من عملية فهم النصّ، وكذلك أثرها على نشأة اتجاهات في الدراسات الغربية تتعامل مع النصّ وحده بحيث تحلّل بنيته الداخلية الأدبية التركيبية والموضوعية بعيدًا عن التفاسير المنتجة تراثيًّا (الاتجاهات الأدبية)، وقد حاول ترافيس زاده بيان أثر هذا على الكتب التقديمية حول القرآن، وفي هذه المقالة يوسع فودج هذا الأثر ليشمل كذلك الدراسات التي تصدر عن المسلمين في البلاد الغربية. راجع: الدراسات القرآنية والمنعطف الأدبي، ترافيس زاده، ترجمة: هدى عبد الرحمن النمر، وراجع: دراسة التفسير القرآني في الحقبة الإسلامية الوسيطة والاستشراق الحديث، بروس فودج، ترجمة: مصطفى هندي. (قسم الترجمات)
[20] حول الآثار الفكرية للطباعة، انظر:
MacCulloch, Reformation, 68–73, (لا سيما ص72).
ومصطلح الجلاء (intelligibility) هو المصطلح الذي استخدمه مايكل كوك في:
M. Cook, The Koran: A Very Short Introduction (Oxford: Oxford Univ. Press, 2000), 26.
[21] جاء في موضعٍ آخر، وبروح تنافسية مماثلة: «ربّما ليس هناك نصٌّ مقدَّس في أيّ ديانة يحفظه كثير من الناس غَيبًا كالقرآن» (صxxxvi).
[22] على سبيل المثال، تسرد المقالةُ الواردة في الكتاب بعنوان: «اللغة العربية القرآنية»، التي كتبها محمد عبد الحليم، عشرَ حالاتٍ -على الأقل- من «الالتفات»، ولكنّ التفسير الذي يقدّمه الكتاب لم يُشِر سوى إلى اثنتَين من تلك الحالات العشر (وهما ما جاء في الآية الخامسة من سورة الفاتحة وفي الآية 162 من سورة النساء).
[23] يرى فودج أنّ الدراسة الغربية للتفسير فيها الكثير من المشكلات المركزية، وقد حاول تحليل الأُسس المنهجية للدراسة الغربية للتفسير والإشكالات التي تنطوي عليها في عمل سابق، وهذا الاهتمام بالتفسير يظلّ -وفق فودج- اهتمامًا ضمن جزء صغير داخل حقل صغير بالأساس هو حقل دراسات القرآن.
أمّا حديث فودج عن كون الاهتمام بالتفسير هو ذاته اهتمام مبالغ فيه، فالمقصود به دراسته باعتباره يمثّل للقرآن ما تمثّله تفاسير الكتاب المقدّس الحاخامية (الآجاداية والهالاخية) -كما يتجلّى في دراسات وانسبرو وجوردون نيكل وسيناي وغيرهم-، ويمكن إضافة هذا الاعتبار ضمن السببين المركزيين الذي اعتبرهم سابقًا وراء تغييب حقل التفسير عن الدراسة الحقيقية، حيث يدرس التفسير هنا كجزء من تاريخ الكتاب المقدّس نفسه وليس كحقل له خصوصية واستقلال، والتي تجسّدها وفق فودج دراسات جولدتسيهر وجيليو. راجع: دراسة التفسير في الحقبة الإسلامية الوسيطة والاستشراق الحديث، بروس فودج، ترجمة: مصطفى هندي، موقع تفسير. (قسم الترجمات)
[24] لوجهة نظر حول مدى إمكان الاستفادة من التفاسير الإسلامية في بناء صورة عن الجزيرة العربية بل عن الشرق الأدنى القديم، راجع مقالة فراس حمزة:
Tafsı¯r and Unlocking the Historical Qur’an: Back to Basics? FERAS HAMZA. (قسم الترجمات)
[25] كأنّ هذه إشارة إلى الطوائف المسيحية التي برزت بعد حركة الإصلاح (Reformation)، ومنها اللوثرية والكالڤينية. (المترجم)
[26] مقتبَس في:
A. Nicholson, God’s Secretaries: The Making of the King James Bible (New York: HarperCollins, 2003), 58.
[27] مقتبَس في: حاجي خليفة، كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، تحقيق: محمد شرف الدين يالتقايا ورفعت بيلگه الكليسي، مجلدان (إسطنبول: مطبعة المعارف، 1941- 1943م)، مج1، ص431.
كلمات مفتاحية
الكاتب:

بروس فودج - BRUCE FUDGE
أستاذ اللغة العربية في جامعة جينيف السويسرية، تتركز اهتماماته وعمله في مجال الهرمنيوطيقا والتفاسير الإسلامية الكلاسيكية.
مواضيع ذات صلة
((المعلومات والآراء المقدَّمة هي للكتّاب، ولا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع أو أسرة مركز تفسير))