كتاب (منهج تدبّر القرآن كطريق للنهوض الحضاري المنشود) للدكتور/ فؤاد البنّا
عرض وتقويم
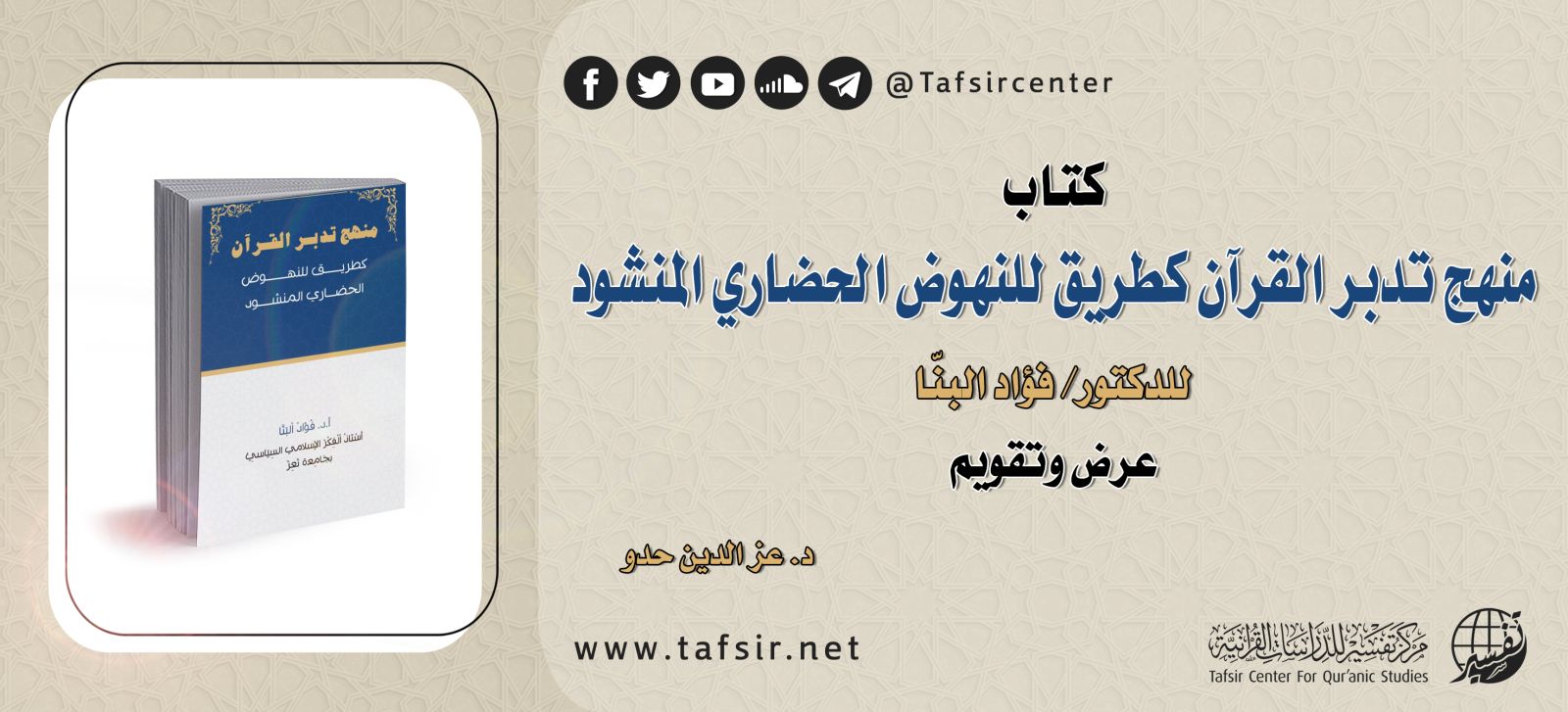
تمهيد:
يظلّ القرآنُ الكريمُ -في وعي أُمّتنا الإسلامية وتاريخها- المرجعَ الأعلى الذي تستمدّ منه معانيها وقِيَمها وشرائعها، غير أنّ طبيعة العلاقة معه قد عرفتْ أنماطًا متعدّدة من التلقّي الحضاري الشامل الذي صاغ أجيال الصدر الأوّل إلى أنماط يغلب عليها الحِفْظ والتلاوة أو البحث الأكاديمي الجزئي. من هذا المنطلق برزت الحاجة إلى دراسات تُعيد وَصْل الأمّة بروح قرآنها، لا باعتباره نصًّا يُتلى فحسب، بل بوصفه منطلقًا لصناعة النهضة وإصلاح الواقع. وفي هذا السياق يأتي كتاب الدكتور فؤاد البنّا: (منهج تدبّر القرآن كطريق للنهوض الحضاري المنشود)، محاوَلة واعية لطرح التدبّر بكونه فريضة شرعية وضرورة عقلية، وبكونه أيضًا مدخلًا أساسًا لإحياء مشروع الإصلاح.
تأتي هذه المقالة لعرض هذا الكتاب وتقويمه في آنٍ واحدٍ؛ فتبدأ ببيان معطياته الأساسية من حيث الهدف والمنهج والمحتوى، ثم تنتقل إلى مساءَلة بنائه العلمي ورصد ميزاته وإيجابياته، قبل أن تتوقّف عند الملاحظات النقدية التي يمكن أن تفتح أُفقًا لمزيد من الإغناء والتطوير. والغاية من ذلك ليست مجرّد التعريف بالكتاب، بل الإسهام في إثراء النقاش العلمي حول موضوع التدبّر القرآني، بما يمثّله من تقاطع بين المعرفة التفسيرية والتربية الإيمانية والفكر الإصلاحي.
أولًا: كتاب منهج تدبر القرآن؛ عرض وبيان:
- بيانات الكتاب:
العنوان: منهج تدبّر القرآن كطريق للنهوض الحضاري المنشود.
المؤلِّف: أ.د/ فؤاد البنّا.
جهة النشر: أكاديمية البيان للتعليم القرآني - ماليزيا.
سنة النشر: 1447هـ/ 2025م.
المراجع والمنقح: د. عبد الوهاب عامر.
الترقيم الدولي: EISBN: 978- 629- 99491- 4- 5
ومؤلِّف الكتاب هو الأستاذ الدكتور/ فؤاد البنّا، مفكِّر يمنيّ متخصّص في الفكر السياسي الإسلامي، حاصل على بكالوريوس في التربية عام 1990م، وتدرّج أكاديميًّا حتى نال درجة الأستاذية. يُعرف برؤيته الوسطية المستقلّة، وله نشاط واسع في التأليف والكتابة، حيث أصدر أكثر من 50 كتابًا وآلاف المقالات. يتمتّع بحضور بارز على منصّات التواصل الاجتماعي، ويشارك بانتظام في المؤتمرات والندوات العلمية، وهو عضو في عدد من الهيئات الفكرية؛ منها الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين.
- هدف الكتاب:
يعلن المؤلِّفُ في مستهلّ كتابه هدفَه المركزي من هذا العمل؛ بحيث يرى أنّ «حال أمّة المسلمين في هذا العصر يثير الأسَى والحزن... فقد ضعفتْ بعد قوّة، وذلَّتْ بعد عِزَّة، وتفرّقتْ بعد وحدة». وينتهي إلى أنّ السبب الجوهري لهذا التراجع لا يكمن في قلّة الموارد أو ضعف الطاقات، وإنما في «المنهج الذي يعامل به المسلمون القرآن الكريم». وعليه، فإنّ مقصود الكتاب الأساس هو ترسيخ فكرة أنّ التدبّر فريضة غائبة، وأنّ استعادتها هي البوصلة الكُبرى للنهوض المنشود.
- منهج الكتاب:
اتّبع المؤلّف في معالجته منهجًا يتّسم بالوعي والوضوح؛ فهو ينطلق من تحليل النصوص القرآنية نفسها، ويستعين بالسنّة النبوية وأقوال السّلف الصالح، ويستحضر التاريخ الإسلامي الأوّل باعتباره النموذج الأمثل لتفعيل القرآن الكريم في الواقع. يقول في هذا الصّدد: «الوعي بهذا المنهج هو الطريق الأكيد لإصلاح المجتمعات الإسلامية وصناعة النهضة الإسلامية المنشودة». كما عقد المؤلِّف مقارنة بين ما تحقّق في المجتمع القرآني الأوّل من آثار عملية للتدبّر، وما يعانيه المسلمون اليوم من غياب لهذه الثمار. ولأجل ذلك خصّص مباحث كاملة لنقد القراءات المنحرفة أو المنقوصة، كـ«القراءة الحرفية الظاهرية» و«القراءة الباطنية المتكلّفة».
- محتويات الكتاب:
جاء الكتاب في ثلاثة فصول رئيسة تسبقها مقدّمة وتمهيد، وتلحقها خاتمة ونتائج. والهيكل التفصيلي كما يأتي:
الفصل الأول: القرآن صانع النهضة الإسلامية الأولى:
المبحث الأوّل: جاذبية القرآن وتأثيره على الناس؛ وفيه مطالب عن أثر القرآن في أوائل العرب مشركين ومسلمين، وفي الغربيين منصفين ومتحاملين.
المبحث الثاني: التفاعل مع القرآن في المجتمع الإسلامي الأوّل؛ وتناول ثلاثة مطالب: دور العقل في قراءة القرآن، دور القلب في قبول القرآن، ثم طريقة التلقّي للتطبيق.
هذا الفصل يبرهن على أنّ النهضة الأُولى كانت ثمرة مباشرة للتعامل مع القرآن منهجًا وفكرًا وسلوكًا.
الفصل الثاني: القراءات المنقوصة والمشوّشة لفهم وتفسير القرآن الكريم:
المبحث الأوّل: القراءات المنقوصة؛ وفيه مطالب عن القراءة الحرفية الظاهرية، والقراءة الباطنية المتكلّفة.
المبحث الثاني: تناقل المرويات الموضوعة والإسرائيليات؛ ويبحث في أثر الروايات الموضوعة والضعيفة في كتب التفسير، وما أدخلَتْه من تشويش على التدبّر.
المبحث الثالث: المبالغة في توسيع الدلالات على حساب المعاني؛ وفيه مناقشة لتضخّم العلوم الخادمة على حساب المقصد التدبري، والخَلْط بين التدبر والتكلّف.
هذا الفصل يمثّل نقدًا لِما شابَ التفسير من انحرافات أو مبالغات حجبتْ أثر التدبّر المنشود.
الفصل الثالث: التدبّر القرآني والنهوض الإسلامي المنشود:
المبحث الأوّل: التدبّر فريضة نقلية وضرورة عقلية؛ وفيه مطالب عن التدبّر باعتباره أمرًا شرعيًّا واحتياجًا عقليًّا.
المبحث الثاني: ثمار التدبّر؛ عُرِضَت فيه ثمار عقلية وقلبية وعملية، تؤكّد شمولية التدبّر وأثره في صناعة الفرد والمجتمع.
المبحث الثالث: التدبّر بين الأقفال والمفاتيح؛ وفيه مطالب عن أقفال التدبّر التي تعطِّل أثر القرآن، والمفاتيح التي تيسِّر استجلاء هداياته.
هذا الفصل يُعَدّ لُبّ الكتاب؛ إِذْ يربط التدبّر بمشروع النهضة الحضارية الشاملة، ويقدّمه باعتباره أداة للإقلاع الحضاري. وقد لخّص المؤلِّف فكرته بقوله: «فتدبُّر القرآن هو الطاقة التي يمكن أن تدير دينامو الأمّة في طريق الإقلاع الحضاري المنشود».
إنّ العرض الإجمالي للكتاب يكشف عن غاية واضحة، وهي إبراز التدبّر باعتباره منهجًا إصلاحيًّا شاملًا، وربطه بمشروع النهضة الحضارية المنشودة. يقول المؤلِّف في إحدى عباراته الجامعة: «فتدبّر القرآن هو الطاقة التي يمكن أن تدير دينامو الأمّة في طريق الإقلاع الحضاري المنشود». وبهذا ينخرط الكتاب بفاعلية في صُلْب النقاش الراهن حول أزمة الأمّة الإسلامية ومأزقها، مقدّمًا منهج التدبّر القرآني لا بوصفه عملًا فرديًّا روحانيًّا فحسب، بل على اعتباره مشروعًا جماعيًّا لإحياء الفكر والحياة معًا.
ثانيًا: كتاب منهج تدبّر القرآن؛ نقد وتقويم:
- مميزات الكتاب:
- أوّل ما يشدّ انتباه القارئ في هذا الكتاب هو وضوح الفكرة المركزية وجرأة الطرح؛ فالدكتور البنّا لم يتعامل مع التدبّر باعتباره عملًا مستحبًّا أو ممارسة وجدانية عابرة، بل رفعه إلى مصافّ الواجب الشرعي والعقلي، حيث يصرّح بجلاء أنّ «التدبر فريضة نقلية وضرورة عقلية» (ص: 144). هذا التحويل من دائرة (الاستحباب) إلى دائرة (الوجوب) يشكّل نقلة فكرية واضحة؛ إِذْ جعل التدبر شرطًا لا غنى عنه لإقامة صِلَة حقيقية بالوحي. وبهذا التصوّر، يثبت الكتاب فرادته بين كثير من الأدبيات القرآنية المعاصرة، والتي غالبًا ما تقف عند فضائل التدبّر دون أن تضعه في قلب المشروع النهضوي للأمّة.
- تكمن الميزة الثانية للكتاب في شموليته المنهجية التي اعتمدها الكاتب؛ فقد انبنى خطابه على أرضية متينة تمتدّ من النصّ القرآني إلى الحديث النبوي، ومن تجارب الصحابة -رضوان الله عليهم- إلى التاريخ الإسلامي، ومن اجتهادات المفسِّرين إلى معطيات الواقع المعاصر. فهو يقرّر أنّ: الوعي بهذا المنهج هو الطريق الآكد لإصلاح المجتمعات الإسلامية وصناعة النهضة الإسلامية المنشودة. ومن هنا، يمكن القول: إنّ الكتاب يبرز بوصفه محاولة لصياغة منهج كلّي في التعامل مع القرآن الكريم، يدمج بين المقاصد الكبرى والجزئيات العملية، وبين الثوابت الدينية ومقتضيات العصر، وهذه الرؤية تجعل التدبر عند صاحبها مشروعًا جماعيًّا ممتدًّا، لا يقتصر على الإثراء الروحي للفرد، بل يتعدّاه إلى صناعة مجتمع راشد وحضارة متوازنة.
- ومن أبرز المميزات التي تلفت نَظَر القارئ في الكتاب القوّة البلاغية للأسلوب؛ فقد جمع المؤلِّف بين المعالجة العلمية القائمة على التوثيق والتحليل، وبين لغة خطابية مشحونة بالصور الوجدانية والعبارات الاستنهاضية، مما يضفي على النصّ حيوية خاصّة. يقول الكاتب: «القرآن الكريم هو الذي أخرج العربَ من ظلمات الجهل إلى نور العلم، ونقَلهم من الشتات والتمزّق إلى الاعتصام والتوحّد، وقادهم من دوائر الضعف والوهن والذلّ إلى مساحات القوة والفاعلية والعِزَّة» (ص: 15)، وهي عبارة تعكس روحه الإصلاحية وتبرز نظرته التوظيفية للقرآن الكريم، بوصفه مصدرًا للطاقة الحضارية وإعادة تشكيل الواقع، لا مجرّد كتاب للتلاوة والتبرّك. فالكاتب من خلال هذا المزج بين العقلانية والوجدانية تمكَّن من توسعة خطابه ليشمل شريحة واسعة من القرّاء: من الباحث الأكاديمي إلى المثقف العام، ومن طالب العلم إلى القارئ المتطلّع للتجديد.
- وأخيرًا، يتّسم الكتاب بإضافة مميزة تتمثّل في الربط بين التدبّر القرآني والنهوض الحضاري، وهي علاقة لم تأخذ هذا القَدْر من التركيز من قبلُ؛ ففؤاد البنّا لا يكتفي بالتذكير بفضل التدبّر، وإنما يتجاوز ذلك ليربطه بسؤال النهضة ذاته، معتبرًا أنّ جوهر أزمة الأمّة يكمن في «اختلال منهج التعامل مع القرآن الكريم». وهكذا يصبح الكتاب حلقة وصل بين علوم القرآن والدراسات الحضارية والفكرية، وهو ما من شأنه أن يفتح أفقًا جديدًا للبحث في كيفية استعادة الأمّة لفاعليتها من خلال القرآن.
- ملاحظات على الكتاب:
مع ما يُحْسَب للكتاب من نزعة إصلاحية ووضوح في المقصد والمنهج؛ فإن القراءة المتأنّية لمتنه تكشف عن جُمْلة من الملاحظات العلمية والمنهجية:
1) غلبة البُعْد الوعظي على التحليل المنهجي في مواضع مؤثّرة:
في مطلع الفصل الأوّل، يتّخذ المؤلِّف عبارات تقريرية عالية النبرة من قَبِيل: أنّ القرآن الكريم «نَقَلَهُم من هامشِ الحياةِ إلى قِمَّةِ الحضارة، ومن ذَيْلِ القافلةِ البشريةِ إلى ناصيتها، ... إلى ذروةِ الحريّةِ والعِزَّةِ والسُّؤدُد» (ص: 15). مثل هذه النصوص بعباراتها الانفعالية العالية «هامش الحياة/ قمة الحضارة»، «ذيل القافلة/ ناصيتها»، «ذروة الحرية والعزة والسؤدد» تميل إلى الخطاب التحفيزي أكثر من التفكيك التحليلي الممنهج المطلوب؛ إِذْ تنتقل سريعًا من تقرير الأثر إلى تبنّي نتائجه من غير إعمالٍ لأدوات التحليل والقياس، أو مقارنة تاريخية دقيقة. ويزداد هذا النَّفَس عند استدعاء الشواهد التاريخية والوعظية في «جاذبية القرآن وتأثيره» (من ص: 17 فصاعدًا)، حيث يغلب على المشهد الطابع العاطفي والتأثّر، على حساب التفكيك النقدي لآليات التأثّر ومجالاته.
2) تشخيصٌ دقيق لعلل (القراءات المنقوصة) يقابله قِلّة نماذج تطبيقية تُظهِر كيفية التفعيل الواقعي للتدبّر:
يقدّم المؤلِّف مقاطع نافعة في نقد القراءة الحرفية الظاهرية، والباطنية المتكلّفة، وخطورة الإسرائيليات، والخلط بين التدبّر والتكلّف، وتحوّل العلوم الخادمة إلى غاية (انظر مباحث الفصل الثاني: من ص: 94 وما بعدها، ومواضع 125- 140، ثم 133- 140 في «التمييز بين التدبر والتكلّف» و«تحوّل العلوم الخادمة إلى غاية»). هذا التشخيص كافٍ لبناء (مشروع نهضوي)، لكنّ القارئ لا يجد بالقدر الكافي (نماذج حالة) من الواقع المعاصر تُبيّن بالتحديد: كيف يوظّف منهج التدبر المطروح في مناهج التربية، أو في دوائر صناعة السياسات، أو في معالجة القضايا الاقتصادية والاجتماعية. فتبقى الإشارات عامة، وكان بالإمكان -تجويدًا للكتاب- أن تُعزّز بنماذج تطبيقية مدروسة، تُظهِر أثر التدبّر في صناعة القرار أو إصلاح المؤسّسات.
3) محاولةُ ضبط الفروق بين التدبّر والتفسير والتزكية... لكنها لم تُترجم إلى معايير تشغيلية واضحة:
يخصّص المؤلِّف مبحثًا لتمييز التدبر عن (التكلّف) (ص: 136 تقريبًا)، ويتعرض لحدود القراءة الحرفية والباطنية (نحو ص: 107 و124). إلا أنّ هذه الحدود لا تتحول إلى (بروتوكول عمل)، أو مصفوفة معايير قابلة للتطبيق (مثل: معايير النصّ/ السياق/ المقاصد/ علائق الآيات/ اختبارات المعنى)، وهو ما يترك مساحةً من التداخل العملي بين التدبّر والتفسير والتعليم الإيماني. القارئ المتخصّص كان ينتظر (آلةَ ضبط) تساعده في التمييز بين ما يُعَدّ تدبرًا مشروعًا وما يُعَدّ تفسيرًا تخصصيًّا أو وعظًا ترغيبيًّا.
اجتهد الكاتبُ في محاولة تحديد الفوارق بين التدبّر والتفسير أو التأويل المتكلّف، لكنه لم يوفّق في تحويل هذه التحديدات إلى معايير عملية تضبط الحدود بشكلٍ صارم. فهو مثلًا يرى أنّ التدبّر ليس هو التفسيرَ التفصيلي لكلّ لَفْظ، ولا هو استخراج المعاني الباطنة التي لا يدلّ عليها السياق، وإنما هو نظرٌ إجماليّ في دلالات الآيات، يُبصِّر القلوب بمراد الله، ويُعِين العقول على الاهتداء بهدي القرآن (راجع ص: 136- 139).
كما يتعرض لحدود القراءات الباطنية والحرفية التي تصرف النصّ عن مقاصده (راجع ص: 107، 124). تحمل هذه التنبيهات قيمة تحذيرية مهمّة؛ إِذْ تكشف عن أخطار الانحراف في الفهم، إلا أنّها تبقَى أقرب إلى التوصيف العام منها إلى تقديم إطار منهجي مُحكم للقارئ.
ربما كان من المفترض -خاصّة عند القرّاء المتخصّصين- أن يختم هذا التعرّض بصياغة (إطار عمل) أو (مصفوفة معايير) تساعد في التمييز بينَ:
- التدبرِ بوصفه تفاعلًا وجدانيًّا وعقليًّا مع النصّ.
- والتفسيرِ باعتباره تحليلًا تخصصيًّا يحتاج أدوات علوم القرآن.
- والتزكيةِ والتعليمِ الإيماني اللذَيْن يقومان على الوعظ والترغيب.
غياب إطار عمليّ على نحو ما ذكرنا، أبقَى بعضَ المواضع عُرْضَةً لأكثر من قراءة، وتركَ المجال مفتوحًا للتداخل بين هذه الحقول، بحيث لا يجد القارئ دائمًا (أداة ضبط) دقيقة تحدّد له متى يكون في دائرة التدبّر ومتى يتجاوزها إلى دوائر أخرى.
4) حضور لافت للخطاب الإنشائي يقابله نقص في الأدوات المنهجية:
يحتلّ الخطاب الوجداني مكانة بارزة في الفصل الثالث من الكتاب؛ إِذْ يصرّح المؤلِّف في مركز أطروحته بأنّ «التدبر فريضة نقلية وضرورة عقلية»، وأنّ «الوعي بهذا المنهج هو الطريق الآكد لإصلاح المجتمعات وصناعة النهضة» (المبحث الأول من الفصل الثالث، ص: 146 وما بعدها). ثم يتوسّع في بيان ثمرات التدبّر على ثلاثة مستويات: عقلية، وقلبية، وعملية، (بدءًا من ص: 196 وما يليها حتى ص: 217)، حيث يقرّر في معرض مناقشة الثمار العقلية والعملية أنّ التدبر «يحرّر العقول مِن أَسْرِ التقاليد ويبعثها على التفكير المستقلّ»، ثم يؤكّد على «خشوع القلب وانبعاث الطمأنينة» عند مناقشة الثمار القلبية.
هذا العرض، على قُوّته في الاستنهاض وإبراز مركزية التدبّر، يتّسم بطابع إنشائي معياري أكثر من كونه يستند إلى أدوات تحليلية أو مؤشّرات منهجية عملية. فالمؤلِّف يكتفي بإيراد النتائج بصيغة تقريرية عامة، دون أن يرفقها بآليات تمكّن القارئ من رصد أثر التدبّر أو تقييمه بصورة عملية. فقد كان من الممكن على سبيل المثال أن يقدّم معايير لرصد أثر التدبّر في تنمية التفكير النقدي، أو تحسين السلوك المؤسّسي، أو تعزيز المشاركة المدنية.
النتيجة، يجد القارئ نفسه أمام بناء فكري قويّ وملهم، إلّا أنّه لا يجد في المقابل (أدوات تشغيلية) تضبط كيفية الانتقال من الدعوى إلى التطبيق، مما يجعل حضور الخطاب الإنشائي يغلب على الطابع المنهجي التطبيقي.
5) استدعاءٌ لمدوّنة تراثية مع حضور محدود للأدبيات الحديثة المنهجية:
يمتاز الكتاب بغزارة استدعائه للنصوص المرجعية؛ من القرآن الكريم، والسنّة النبوية، وأقوال السلَف، بل ويستعين أحيانًا ببعض المفكرين المعاصرين في إبراز الأثر الوجداني للخطاب القرآني خاصّة، كما في حديثه عن تأثيره العميق في أوائل العرب. هذا الزخم التراثي يعطي الكتاب قوةً تأصيلية واضحة، وامتدادًا في السياق الإسلامي الكلاسيكي.
إلا أنّ القارئ المتخصّص يلحظ محدوديةً بيِّنةً في الانفتاح على الأدبيات الحديثة ذات الصِّلَة الوثيقة بموضوع الكتاب؛ فمجالات معرفية مثل نظريات القراءة والتأويل الحديثة، وعلوم التعلّم، وسوسيولوجيا التدين، والدراسات القرآنية المعاصرة؛ نادرًا ما تجد لها حضورًا في متن الكتاب، رغم أنّ (التدبر) في جوهره يتقاطع مع هذه المجالات تقاطعًا مباشرًا.
كان من شأن استحضار هذه الإسهامات أن يُعزّز الكتاب بأدوات منهجية ومعايير قياس معاصرة، تُوازن بين التأصيل التراثي والمقاربات العلمية الحديثة، وتسمح ببناءِ تصوُّرٍ أكثر تكاملًا لعملية التدبر؛ تصوُّر يُعْنَى بتقويم الأثر، وتنمية المهارات، وتحويل الفكرة من خطاب وعظي إلى ممارسة قابلة للرصد والتقييم.
إلا أنّ النتيجة كانت: حضورًا أصيلًا وقويًّا للمدوّنة التراثية، يقابله ضعف في الإفادة من المنجز البحثي الحديث، وهو ما يترك فجوة بين قوّة الاستدعاء التاريخي وضعف الانفتاح المنهجي.
6) اعتراف المؤلِّف بسعة الموضوع يترتب عليه تضييقٌ في نطاق المعالجة العملية:
يُشير المؤلِّف في أكثر من موضع من المتن ويصرّح بأنّ موضوع تدبّر القرآن الكريم يتّسم بسعة بالِغة وتشعّب واضح، الأمر الذي يجعل معالجتَه معالجة شاملة أمرًا متعذّرًا في إطار دراسة واحدة خاصة (انظر ص: 7 على سبيل المثال)، بل يحتاج -حسب تعبيره- إلى «عدد من الدراسات» المتكاملة، ومن ثمّ قدّم عمله الحالي بوصفه خطوة تأسيسية أُولى في سبيل ترتيب مداخل الإصلاح وتوضيح معالم المنهج. يكتسي هذا الاعتراف قيمة علمية مهمّة؛ إِذْ يعكس وعي الكاتب بحدود مشروعه وبتعقيدات المبحث الذي يتناوله، كما يجنّبه الوقوع في ادّعاء الإحاطة الكاملة. غير أنّ هذا الإقرار، من زاوية منهجية، يفسّر جزئيًّا محدودية ما تضمّنه الكتاب من أدوات عملية للتفعيل ووسائل منهجية لقياس الأثر؛ إِذْ ظلّت هذه الجوانب دون مستوى التطلّعات التي يثيرها العنوان، والذي يوحي بطرحٍ أكثر تفصيلًا وملامسةً للبُعد التطبيقي.
7) تكرار الرسالة الجوهرية مقابل غياب بناء تنظيري متكامل:
يتكرّر التأكيد على مركزية التدبّر ووجوبه الشرعي والعقلي في مواضع متعدّدة من الكتاب (من مطالع الفصل الثالث حتى الخاتمة)، ممّا يُظْهِر بوضوح أن هذا هو جوهر الرسالة التي يحاول الكاتب ترسيخها. إلّا أنّ هذا التكرار لا يصحبه دومًا تعمّق كافٍ في بناء (نظرية التدبر) من حيث مبادئها الإجرائية ومناهج اختبار المعنى، مما قد يترك لدى القارئ المتخصّص حاجته إلى فصل تنظيريّ أدقّ يربط بين مباحث (الأقفال والمفاتيح) (نحو ص: 234- 254) ومنهجية إنتاج الدلالات العملية.
8) قضايا التعليم القرآني مثالًا: تشخيصٌ قويّ بلا خريطة تنفيذية:
يقول المؤلّف: «الناظر في حال الأمّة اليوم سيشاهد جهودًا وطاقات مقدَّرة تُصرف في اتجاه التفاعل مع القرآن، لكن المخرجات ما تزال دون حجم المدخلات بكثير. إنّ بلدان المسلمين تضمّ مئاتٍ من المدارس القرآنية (مدارس التحفيظ)، وتُخرج هذه المدارس سنويًّا الملايين من الحفّاظ للقرآن كليًّا أو جزئيًّا... غير أنّ كثيرًا من هؤلاء يكادون لا يختلفون عن غيرهم من المسلمين، حيث لم يتميّزوا بالفكر والوعي والفاعلية التي كان يتّسم بها أهل القرآن من السّلف الصالح... لكن أكثرهم لم ينجحوا في (صناعة الحياة) للأسف الشديد» (ص: 10). بحيث ينبّه إلى مفارقة تضخّم مدارس التحفيظ وخريجيها مقابل محدودية الأثر الحضاري (يُناقَش هذا تحت دواعي الدراسة والواقع التعليمي في المتن، حيث تُذكَر أعداد المدارس والحفّاظ والنتائج دون بلوغ صناعة الحياة بالمستوى المأمول). التنبيه مهم، لكن القارئ ينتظر بعده (خارطة تفعيل) تربط بين التدبّر وتصميم المنهاج، وأدوار المعلّم، وإستراتيجيات التقويم، ومعايير الأداء المؤسّسي.
خاتمة:
تعرّضنا في هذه المقالة لكتاب (منهج تدبّر القرآن كطريق للنهوض الحضاري المنشود)؛ فعَرَّفْنَا به، وبمؤلِّفه، ومنهجه، ومحتوياته، وقدّمْنَا تقويمًا يبرز مزاياه وعيوبه.
في الجُمْلة، يقدّم الكتاب إضافة معتبرة في حقل الدراسات القرآنية المعاصرة؛ إِذْ ينقل التدبّر من دائرة الممارسة الوجدانية الفردية إلى مقام «الفريضة النقليّة والضرورة العقليّة»، ويربطه ربطًا مبدئيًّا بمشروع النهوض الحضاري، وهو ما يصرّح به المؤلِّف بوضوح في صدر الكتاب.
وتكشف القراءة النقدية، في المقابل، عن محدوديةٍ في تحويل هذه الرؤية إلى معايير تشغيلية وأدوات قياس قابلة للتطبيق المؤسّسي، وعن حاجة إلى قدر أكبر من التوازن بين التأصيل التراثي والانفتاح المنهجي على مناهج القراءة الحديثة. وعليه، يظلّ الكتابُ خطوةً تأسيسية جديرة بالاعتبار، تفتحُ المجالَ أمام دراسات أكثرَ تفصيلًا وتطبيقية، بحيث يتحوّل خطابُ التدبّر من نداءٍ استنهاضيّ عامّ إلى منهجٍ إصلاحيّ قابلٍ للتفعيل والقياس.


