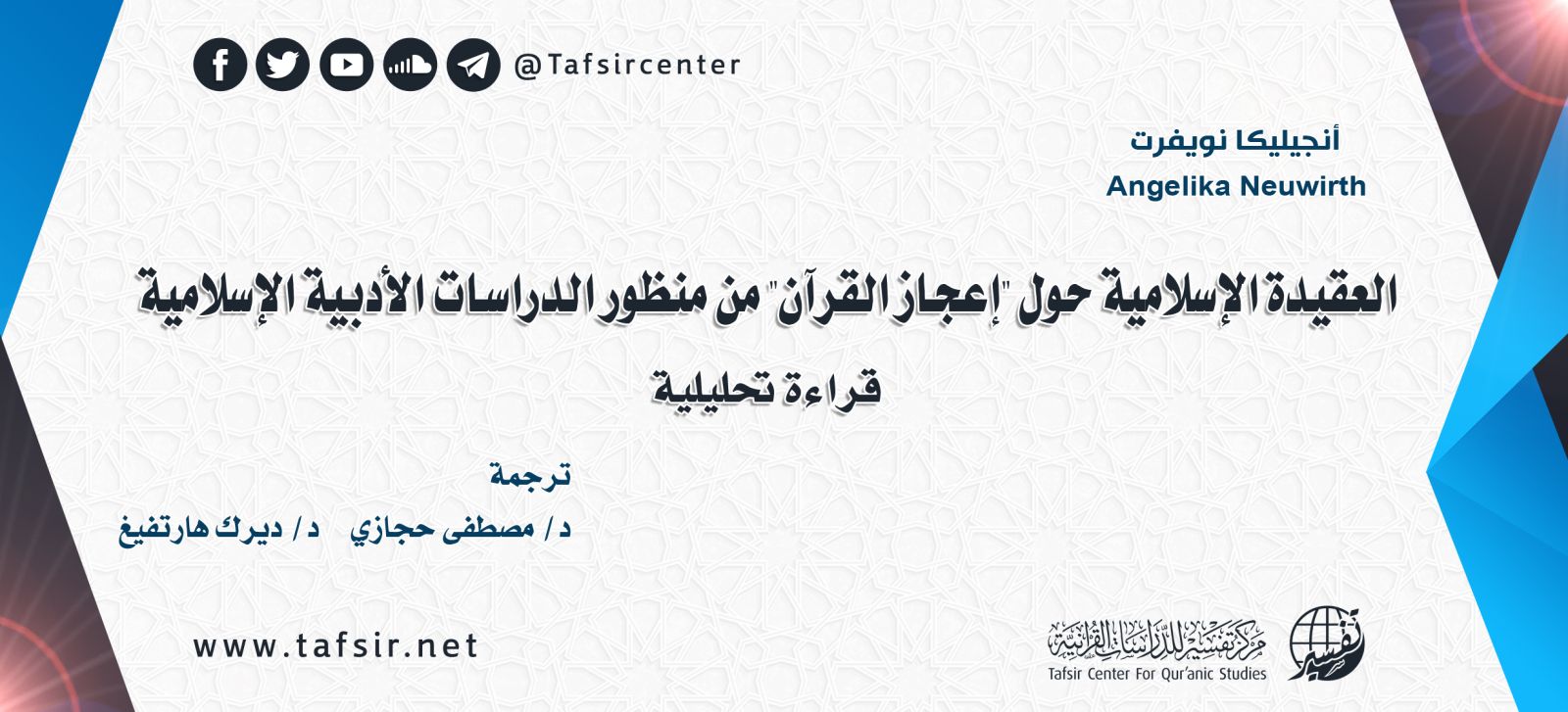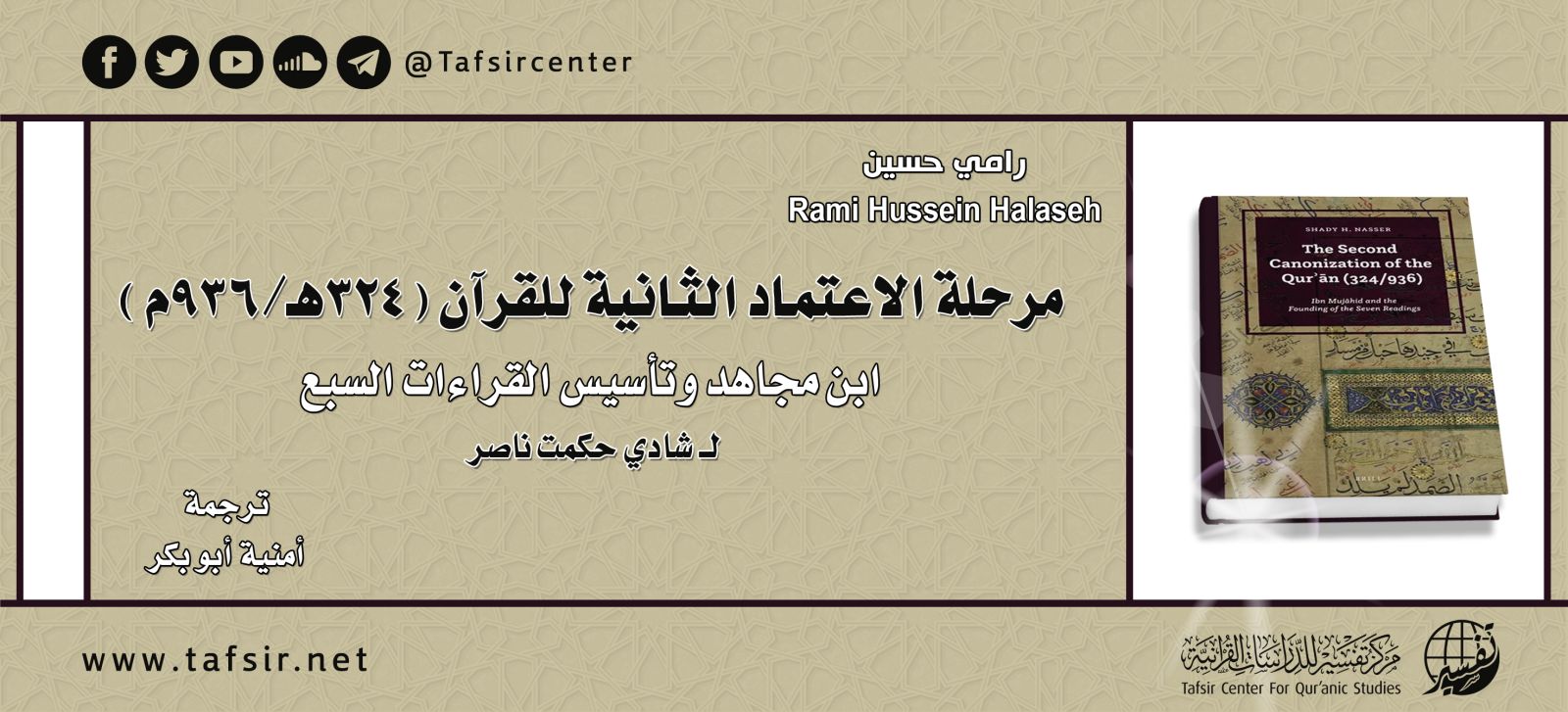عرض كتاب: محمد والمؤمنون؛ حول نشأة الإسلام لـ فرد دونر
محمد والمؤمنون: حول نشأة الإسلام
لـ فرد دونر
الكاتب: جاك تانوس - JACK TANNOUS

عرض كتاب
(محمد والمؤمنون: حول نشأة الإسلام)[1][2]
لـ "فرد دونر"[3]
يذهب بعضُ الباحثين إلى أنّ مجال التاريخ الإسلامي المبكّر قد هيمنت عليه النقاشاتُ المحتدمة حول سؤال الأصالة والموثوقية والبحث عن الأصول: أصالة ذلك العدد الهائل من الأحاديث المنسوبة إلى النبيّ، ومدى موثوقية المصادر الإسلامية المتأخّرة نسبيًّا في ما تقدّمه لنا من معلومات عن القرن السابع الميلادي، والطبيعة الدقيقة لنشأة الإسلام؛ أي: ما هي الغايات والأهداف «الحقيقية» [للنبي] محمد؟ في أواخر السبعينيات من القرن الماضي، رفضَ كتابُ مايكل كوك[4] وباتريشيا كرون[5] ذو الطابع الاستفزازي المسمى بـ«الهاجرية»[6]=السرديةَ التي تقدّمها الآثار الإسلامية حول نشأة الإسلام، وحاول كتابة تاريخ الإسلام المبكّر بالاعتماد على مصادر غير إسلامية. لقد سعى كِلَا الباحثَيْن إلى الخروج من عباءة التقليد والمرويات، ورؤية ما الذي سينتج من النظر إلى الحركة الدينية التي بدأها النبي محمد كما رآها الآخرون. كانت النتيجة عبارة عن رحلة في غابة من التخيّلات البحثية الجامحة التي ذهبتْ إلى أن جذور الإسلام ترجع إلى حركة يهودية مسيانية، ابتدأها المسلمون الأوائل (أو "الهاجريون" كما أطلق عليهم كوك وكرون، متأثّرين بأعراف التسمية الخاصّة بالمصادر المسيحية في العصور الوسطى) الذين سرعان ما أسّسوا لقطيعة مع اليهودية وساروا في اتجاه منفصل، وهو ما أثمر في النهاية ما نعرفه اليوم باسم «الإسلام».
بخلاف المصفّقين والمتحمّسين لهذه الأطروحة من الهواة الناشطين على الشبكة العنكبوتية، والمنافحين عنها من ذوي الدوافع الدينية =فلا أحد اليوم -ولا حتى كوك وكرون أنفسهم- يعتقد أنّ صورة الإسلام المبكّر المطروحة في كتاب الهاجريون هي صورة دقيقة. بيدَ أن الأثر الذي أحدثه الكتاب لم يُـمْحَ؛ ففي هذا الكتاب صغير الحجم تمكّن كوك وكرون من الكشف -بطريقة مثيرة- عن معضلة عويصة؛ وهي معضلة كان دارسو الإسلام على دراية بها لبعض الوقت، ألا وهي أنّ المصادر التي نعتمد عليها في بناء سردية عن نشأة الإسلام هي مصادر متأخّرة، وأحيانًا ما تكون مكتوبة بعد قرون من الأحداث التي تزعم أنها تصفها، وينقض بعضُها كلامَ بعض، وتظهر عليها علامات التحيّز الطائفي والحذف والتغيير الذي تحركه دوافع دينية. وإذا طُبّقت نفس المعايير الصارمة والمتشكّكة التي سبق تطبيقها على التاريخ المسيحي المبكّر على مصادر التاريخ الإسلامي المبكّر فسيتبيّن أنّ جزءًا كبيرًا من السردية التقليدية عن نشأة الإسلام ليس سوى سراب. حاول جون وانسبرو[7] -الباحث الأمريكي الذي درّسَ باتريشيا كرون عندما كانت طالبة جامعية في سوس SOAS [كلية الدراسات الشرقية والإفريقية بجامعة لندن]- تطبيقَ آليات النقد الكتابي والأدبي على المرويات الإسلامية المبكّرة، بيدَ أن الشُّهرة الواسعة التي حظي بها كتابه وكثرة الإحالة إليه في الأبحاث والدراسات تعود إلى الغموض والإلغاز الجذاب والمتكرّر في كتابه (والذي يبدو أنه مقصود) أكثر مما تعود إلى كون أطروحته قد فُهمت بدقّة فعلًا[8]. وإذا كان تقويمنا لكتاب الهاجريون ينصبّ على كونه كتابًا يقدّم حُجّة متماسكة تفضي إلى نتيجة محدّدة؛ فيمكننا القول بكلّ ثقة إنه قد فشل في هذه المهمة[9]. ولكن على مستوى تحفيزه لمزيد من البحث والكتابة والنقاش، وخاصة من خلال دفع دارسي الإسلام إلى النظر أبعد من المصادر العربية والتحوّل إلى الآداب الغنية للشرق الأوسط التي كانت موجودة قبل وأثناء وبعد ظهور الإسلام؛ فلا شك أن الهاجريون هو أحد تلك الكتب النادرة التي تركت بصمتها العميقة على المجال.
يعود النهج المتشكّك في الموثوقية التاريخية للمرويات الإسلامية إلى ما قبل عهد وانسبرو وكوك وكرون؛ إِذْ قد سبقهم إلى هذا المضمار جوزيف شاخت[10] (ت: 1969)، تلك الشخصية البارزة في تاريخ ودراسة الشريعة الإسلامية. ومن قبل شاخت، هناك جولدتسيهر[11] (ت: 1921)، ذلك البحّاثة الذي يعدّ في كثير من الأحيان الأب الروحي للدراسات الإسلامية الحديثة في الغرب[12]. أظهر شاخت وجولدتسيهر أن العديد من الأحاديث المنسوبة إلى النبي محمد واعتبرها المسلمون موثوقة وذات سلطة معيارية كانت في الواقع اختلاقات متأخّرة عكست الوضع الثقافي والسياسي في الشرق الأوسط بعد فترة طويلة من وفاة النبي. وقد تلقّف كوك وكرون مِعْوَل الشّك الذي أعمله شاخت وجولدتسيهر في المرويات والآثار الشفوية في المصادر الإسلامية -وخاصّة المصادر الفقهية- وأعملوه في التاريخ؛ حتى ليمكننا القول: إنّ كوك وكرون قد حصَدَا -وبشكلٍ أخصّ كرون- ما زرعه شاخت وجولدتسيهر[13].
فرد دونر -المدرّس بقسم لغات وحضارات الشرق الأدنى في جامعة شيكاغو- هو أحد المؤرِّخين البارزين المتخصّصين في الإسلام المبكّر في العالم الناطق باللغة الإنجليزية. لمع نجم دونر على إثر كتابه الأول «الفتوحات الإسلامية المبكّرة»[14]؛ وعلى الرغم من مرور ثلاثين عامًا على نشرها، لا تزال تلك الدراسة هي عمدة الباحثين في هذا الموضوع. إذا كان من الممكن تصنيف الباحثين في مجال التاريخ الإسلامي المبكّر إلى معسكرين متعارضين؛ معسكر التنقيحيين (الذين ينظرون إلى المصداقية التاريخية لما بين أيدينا من المصادر العربية بعين الريبة بسبب الصعوبات المتعدّدة التي تواجهها تلك المصادر)، ومعسكر التقليديين أو معارضي الاتجاه التنقيحي (الذين يتبنّون نظرة أكثر إيجابية تجاه موثوقية هذه المصادر)؛ فإن دونر ينتمي إلى المعسكر المعارض للاتجاه التنقيحي، بل في الواقع قد نعدّه عميد هذا الفريق. لقد بذل دونر قدرًا كبيرًا من الجهد في بناء مقاربة للتاريخ الإسلامي المبكّر تشقّ طريقًا وسطًا بين شكّيّة كرون المتطرّفة والتأييد غير النقدي للسردية التقليدية[15]. إذا كنت تريد منهجًا ينظر في أصول نشأة الإسلام بصورة نقدية، ويعترف بالمشاكل الموجودة في المصادر، بيدَ أنه مع ذلك لا يزال قادرًا على استخدام تلك المصادر والاستفادة منها؛ فإنّ دونر هو المؤرِّخ الأمثل في هذا المنهج. لقد برز دونر وكرون بين جيل العلماء الناطقين باللغة الإنجليزية الذين وُلدوا بعد الحرب العالمية الثانية باعتبارهما يمثّلان منهجين متعارضين وموقفين متباينين تجاه الآثار الإسلامية المبكّرة ومدى فائدتها في إعادة البناء التاريخي.
في هذا السياق الأكاديمي للمناقشات حول مصداقية الآثار والمرويات الإسلامية المبكّرة، تأتي ضرورة قراءة أحدث كتب دونر: «محمد والمؤمنون: حول نشأة الإسلام». لا يحتوي الكتاب على حواشٍ أو هوامش سفلية، بل يحتوي فقط في نهايته على «ملاحظات وقائمة كتب لمزيد من القراءة»، وهو مكتوب بأسلوب سهل ومباشر بدرجة كبيرة؛ وذلك لأنّ الجمهور الذي يستهدفه دونر هم غير المتخصّصين المهتمين بالموضوع. على مدار 224 صفحة، أعاد دونر سرد قصة الإسلام المبكّر من أوائل القرن الثامن، مازجًا بين الرؤى المعيارية السائدة لما حدث وتعديلاته التنقيحية على السردية التقليدية[16]. يمكنني القول: إنّ أجزاء كثيرة من الكتاب -خاصّة وصف دونر للفتوحات الإسلامية المبكّرة التي تمثّل أحد مجالات خبرته- هي أوضح المقاربات التي أعرفها عن جوانب مختلفة من التاريخ الإسلامي المبكّر وأقربها للفهم.
افتتح دونر كتابه بمقدّمة بَيّن فيها غايته من تصنيف هذا الكتاب؛ لقد درج الباحثون الغربيون على تفسير نشأة وصعود الإسلام باستحضار مجموعة متنوّعة من العوامل تتراوح بين الاقتصادية والاجتماعية والقومية، بيدَ أن العامل الديني لم يكن في الحسبان. ومن هنا فإن ما ميّز مقاربة دونر هو اعتباره أنّ الإسلام المبكّر كان ظاهرة دينية، وأنّ الفاعلين الذين صنعوا التاريخ الإسلامي المبكّر كانت تحركهم دوافع دينية: «إنني مقتنع بأنّ الإسلام بدأ على صورة حركة دينية، وليس حركة اجتماعية أو اقتصادية أو (قومية). لقد جسّدت تلك الحركة تحديدًا الاهتمام الشديد بتحقيق الخلاص الشخصي من خلال العمل الصالح، ولم يكن المؤمنون الأوائل مهتمين بالقضايا الاجتماعية والسياسية إلا من جهة ارتباطها بمفاهيم التقوى والسلوك القويم اللازمَيْن لضمان الخلاص» (ص12).
هذه القناعةُ بأنّ الدِّين -وليس أيّ شيء آخر- هو مركز التاريخ الإسلامي المبكّر حاضرةٌ باستمرار في مختلف ثنايا الكتاب. على أحد المستويات، يمكن النظر إلى الكتاب باعتباره إعادة توصيف مُمنهجة؛ ففي كلّ مسألة يختار دونر قراءة الأمور على أنها مدفوعة بعوامل دينية وتقوية، حتى عندما تبدو التفسيرات الأخرى للسلوك على نفس القدر من القوة، إن لم تكن أقرب للمعقولية.
على غرار العديد من الكتب والمقرّرات الجامعية حول نشأة الإسلام، يقدّم لنا الفصل الأول مناقشة للوضع السياسي والثقافي في الشرق الأوسط والجزيرة العربية قبل بدء النبي مهمّته. نرى هنا مجموعة مألوفة من الشخصيات؛ المونوفيزيين أنصار الطبيعة الواحدة وخصومهم أنصار الطبيعتين؛ البيزنطيين والساسانيين [الروم والفرس]، وشبه الجزيرة العربية المحصورة بين قوتين عظميين، والمنظمة على أُسُس قبَليّة.
في الفصل الثاني المعنون بـ«محمد وحركة المؤمنين»، يصبح موقف دونر الفريد تجاه الإسلام المبكّر أكثر وضوحًا. يقدّم هذا الفصل ملخّصًا متقنًا للفهم الإسلامي لحياة الرسول وسيرته المبنية على الآثار المنقولة، متبوعًا بنقاش صريح جدًّا حول المشكلات المرتبطة بهذه السردية (منها مثلًا: «أن ذلك الكمّ الهائل من المرويات التي استُخلص منها هذا المخطط العام لحياة النبي محمد =يحوي الكثير من التناقضات، والكثير من الحكايات المشكوك فيها، لدرجة أن العديد من المؤرِّخين أصبحوا متردّدين في قبول أي منها على ظاهره» (ص51)). بيدَ أن دونر لا يرغب في إلغاء كلّ اعتبار لهذه المصادر؛ بمعنى أن هناك بالفعل مشاكل في المصادر الإسلامية، ولكن وسط هذا الكمّ من المرويات الواهية هناك بعض الآثار التي يذهب إلى أنها تعود بالفعل إلى الحقبة المبكّرة ويمكن استخدامها في إعادة البناء التاريخي[17].
توفّر المصادر غير الإسلامية التي عاصرت الحقبة المبكّرة تقريبًا تأكيدًا قويًّا للعناصر الأبسط في السردية الإسلامية؛ وهي أنّ محمدًا كان موجودًا بالفعل وأنه تزعّم حراكًا[18]. ولكن بالنسبة إلى دونر، فإنّ أهمّ مصدر تاريخي هو في نفس الوقت أهم مصدر ديني؛ أي القرآن، وفي هذا الصدد فإنّ الآراء القائلة بأنه حتى القرآن أصله متأخّر (لاحق) ويرجع إلى ما بعد وفاة النبي بفترة طويلة =مرفوضة. وهكذا أسّس دونر تصوّره العام عن المعتقدات المبكّرة للنبي محمد وحركته الدينية على أساس متين هو القرآن، وهذا هو مفتاح فهم كلّ المسارات الأخرى التي سلكها دونر في الكتاب. من خلال التمسك الوثيق بالقرآن، فإن القصة التي يريد دونر روايتها هي أنّ الإسلام لم يكن يملك في البداية وعيًا ذاتيًّا بخصوصية كونه «الإسلام» على الإطلاق، بل كان بالأحرى حركة إصلاح ديني عالمية وتوحيدية ركزت على التقوى وتتمتع بإيمان قوي باليوم الآخر الذي اقترب موعده. وفقط بعد عقود من وفاة النبي ظهرت بوادر شيء يشبه إلى حدّ بعيد ما نُطلق عليه «الإسلام» اليوم، كاشفًا عن نفسه من وراء أقنعة التاريخ باعتباره التقليد الإسلامي، حيث حاول فصل نفسه وتمييزها عن الجماعات الدينية الأخرى في الشرق الأوسط.
إذا لم يكن محمد وأتباعه قد اعتبروا أنفسهم «مسلمين» بالمعنى الذي نفهمه نحن اليوم، فأيّ شيء كانوا على وجه الدقة؟ لقد كانوا يعرّفون أنفسهم بأنهم «مؤمنون» وليسوا «مسلمين»، ويقول دونر في هذا الصدد: إنّ كلمة «مسلم» وردت في القرآن أقل من خمس وسبعين مرة، بينما تظهر كلمة «مؤمن» في ما يقرب من ألف موضع. لقد كان التوحيد هو ركن العقيدة الأساسي في حركة محمد؛ إِذْ «كان المؤمنون مكلّفين بالاعتراف بوحدانية الله قبل كلّ شيء، وقد كانت رسالة التوحيد الصارم هي عظة القرآن التي شدّد عليها بلا هوادة، كما حثّ المخاطبين به على معرفة الله وطاعة أوامره» (ص58). إلى جانب هذا، يعطينا القرآن رؤى إضافية عن نظرة هؤلاء المؤمنين الأوائل للعالم؛ فقد آمنوا بالأنبياء والنبوّات، وآمنوا بالوحي المكتوب المنزّل من عند الله، وآمنوا بالملائكة أيضًا.
ومع ذلك، كانت تلك الحركة مدفوعة بما هو أكثر من مجموعة من العقائد أو الأفكار؛ إِذْ كان هناك أيضًا تكليف بأنواع معينة من السلوك، فقد كان على المؤمنين أن يعيشوا حياة صالحة، ومن ثم خُوطبوا بالتواضع ومساعدة الفقراء، والحفاظ على الصلاة، وصيام رمضان، والحج. ويستشهد دونر أيضًا بالأوامر القرآنية بارتداء الملابس المحتشمة والامتناع عن أكل لحم الخنزير أو شرب المسكرات وغيرها من التكاليف، باعتبارها أدلة على أن المؤمنين كانوا مكلّفين بمنظومة أخلاقية صارمة على المستوى الشخصي جعلتهم في حالة نُفرة من الآثام التي رأوها في كلّ مكان من حولهم. وعلى حدّ تعبير دونر، فإنّ «المؤمنين كانوا مهتمين بالابتعاد عمّا اعتبروه شرًّا متفشيًا في العالم من حولهم، ورغبوا في العيش وفقًا لمعايير سلوكية أرفع» (ص66). ومع ذلك، فإنّ السلوك الأخلاقي الصارم لهؤلاء المؤمنين الأوائل لم يخلُ من الاعتدال؛ إِذْ إنهم مع تمسّكهم بمعايير أخلاقية عالية، كانوا حريصين أيضًا على تجنب المبالغة في الزهد الذي يفرض على صاحبه الانسحاب الكامل من العالم، وهذا ما اتّسمت به طوائف مسيحية بارزة في الشرق الأدنى في العصور القديمة المتأخّرة. فعلى العكس من ذلك، كان على المؤمنين أن يكونوا حاضرين ومؤثّرين في العالم.
حسب ما يرى دونر، كانت «المسكونيّة» أو «العالمية» من أهم سمات حركة المؤمنين الأوائل. فمع أن المؤمنين ربما رأوا أنفسهم متميزِين عن الطالحين من حولهم -المشركين أو المسيحيين أو اليهود- يرى دونر أنّ هذا لم يمنع أن يكون اليهودي أو المسيحي الذي يلتزم بمعايير السلوك القويم جزءًا من الحركة؛ لأنهم كانوا أيضًا من الموحّدين. ويرى دونر أن «مردّ هذا الانفتاح الطائفي أو ما يمكن وصفه بالعالمية يرجع إلى أن الأفكار المركزية بالنسبة للمؤمنين وإصرارهم على الالتزام الصارم بالتقوى لم يكن بأيّ حال من الأحوال مناقضًا لمعتقدات وممارسات بعض المسيحيين واليهود» (ص69)؛ إِذْ يمكن للمرء أن يكون مؤمنًا ومسيحيًّا أو يهوديًّا، كما يمكن أن يكون مسيحيًّا أو يهوديًّا دون أن يكون مؤمنًا. ويمكن للمرء أن يكون مؤمنًا دون أن يكون مسيحيًّا أو يهوديًّا. يمكننا القول: إنّ مفتاح الانتماء [لجماعة المؤمنين] هو الإيمان بإله واحد والالتزام بالمعايير الأخلاقية الصارمة. وفي تلك المرحلة المبكّرة جدًّا، كان مسمى «مسلم» يشير فقط إلى مجموعة فرعية من حركة المؤمنين؛ فـ«المسلم» هو «الموحّد المؤمن بالقرآن» الذي لا ينحدر من خلفية يهودية أو مسيحية، ثم تطوّرت دلالة الكلمة لاحقًا لتشير إلى شخص ينتمي إلى دين مختلف عن المسيحية واليهودية.
أورد دونر العديدَ من السمات الأخرى لحركة المؤمنين الأوائل؛ فقد كان محمد هو زعيمها، وكان يُنظر إليه على أنه نبي يأتيه الوحي من السماء. كما اتّسمت تلك الحركة أيضًا بنزوع أخروي قوي، حيث اعتقد المؤمنون على ما يبدو أن القيامة قد اقتربت بشدّة. كان هذا الإحساس الشديد بنهاية العالم وقرب يوم الحساب أمرًا أساسيًّا في قدرة حركة المؤمنين على حشد أتباعها وحثّهم على العمل؛ فلكونهم «مقتنعين بأن العالم من حولهم غارق في الخطيئة والفساد، شعروا بالحاجة الملحّة لضمان خلاصهم من خلال العيش بالتزام صارم بتكاليف الوحي؛ لأنّ الساعة قد تأتي بغتة في أيّ لحظة» (ص79). ويشير دونر إلى أنه إذا قبلنا التقسيم التقليدي للسور القرآنية إلى مكية ومدنية، يصبح من الواضح أن معظم الآيات القرآنية المشحونة بوصف مشاهد وأهوال اليوم الآخر موجودة في السور التي نزلت في العهد المكي. وهذا ما قاده إلى القول بأن «تأسيس مجتمع [المؤمنين الأوائل] في المدينة كان إيذانًا ببداية عهد جديد من الاستقامة، ومن ثم كانوا يشهدون بالفعل أمارات وبوادر القيامة نفسها» (ص81).
كانت السمة الأخيرة لحركة المؤمنين هي النزعة القتالية؛ إِذْ لم يكن المؤمنون مكلّفين فقط بحراسة الفضيلة والالتزام بالسلوك الوَرِع في حياتهم، بل كان عليهم أيضًا أن ينشروا شريعة الله في العالم من حولهم، حتى لو تطلّب ذلك استعمال القوّة. «يبدو هذا وكأنه برنامج يهدف إلى تأسيس ملكوت الله على الأرض؛ أي: نظام سياسي (أو على الأقل مجتمع) يقوم على الوصايا والتكليفات المنصوص عليها في القرآن، والتي يجب أن تحلّ محلّ النظام السياسي الفاسد للبيزنطيين والساسانيين» (ص85).
بعد أن حدّد دونر ملامح نظرة المؤمنين للعالم، خصّص ما تبقى من أجزاء «محمد والمؤمنون» لتعقّب مجتمع المؤمنين وهم يتحوّلون تدريجيًّا إلى مسلمين. تطلّبت رواية قصة هذا التحوّل من دونر الخوض في رحلة عبر العقود الأولى مما يُنظر إليه تقليديًّا على أنه تاريخٌ «إسلامي»؛ أيّ الفتوحات والنزاعات على الخلافة والحروب الأهلية [الفتن]، إلا أنّ روايته تتسم بنوعٍ من الإلتواء؛ فهو حريص على التحدّث عن الفاعلين في تلك الحقبة باعتبارهم «مؤمنين» وليسوا «مسلمين»، وفي كلّ منعطف يفسِّر أفعالهم بالإشارة إلى ملامح «حركة المؤمنين» التي سبق أن أوضحها في الكتاب. إنّ اعتبار المسلمين الأوائل منتمين إلى «حركة المؤمنين» يحمل العديد من النتائج المفيدة لأطروحة دونر، إِذْ يمكنه -كما يقترح- أن يفسِّر كيف تمكّن أتباع محمد من غزو مساحات شاسعة من الأراضي بسرعة كبيرة، وقد فعلوا ذلك بقليل من العنف على ما يبدو. فحسب ما يرى دونر، حدث هذا لأن المؤمنين أنفسهم تحرّكوا باعتبارهم حَمَلة رسالة التوحيد، وقد حملوا تلك الرسالة لشعوبٍ موحِّدة، وكلّ ما طلبوه منهم هو دفع الجزية والإيمان بإله واحد والالتزام بمعايير السلوك الأخلاقي القويم، وهي نفس المعايير التي كانت تعتبرها تلك الشعوب مُثلًا عُليا. علاوة على ذلك، أسهم الطابع المسكوني العالمي لحركة المؤمنين في إتاحة الفرصة أمام اليهود والمسيحيين في الأراضي المفتوحة للانضمام إليها.
يؤكّد دونر أنّ الحديث عن هؤلاء المؤمنين الأوائل باعتبارهم «مسلمين» وتسمية حركتهم بـ«الإسلام» قبل أواخر القرن السابع أو أوائل القرن الثامن هو في الواقع وصفٌ «غير دقيق من الناحية التاريخية» (ص195)؛ إِذْ لم تبدأ عملية إعادة التعريف الدقيقة للمصطلحات إلا بعد تلك الحقبة المتأخّرة، وهو ما ضيّق في النهاية حدود جماعة المؤمنين وأدّى إلى استبعاد اليهود والمسيحيين. يذهب دونر إلى أن عملية تضييق حدود الجماعة وإعادة تعريف المصطلحات قد وقعت في عهد عبد الملك بن مروان (685- 705)؛ فخلال حكمه انتهت الحرب الأهلية [الفتنة] الثانية، وبعد أكثر من عقد من الاقتتال القاسي داخل مجتمع المؤمنين، تمكّن زعيم الجماعة أخيرًا من تركيز اهتمامه على تحقيق الأهداف والمُثُل الأصلية لحركة المؤمنين. لذلك؛ شرع عبد الملك مثلًا في إعادة إرسال حملات عسكرية لفتح أراضٍ جديدة وتوسيع رقعة الأراضي التي تدين بشريعة الله. لكن دونر يقترح أنه بعد سنوات من الفتنة والحرب الأهلية في مجتمع المؤمنين، لم تكن مجرّد العودة إلى أساسيات حركة المؤمنين كافية لعبد الملك؛ إِذْ كان بحاجة إلى إيجاد طريقة لجمع الشتات وإعادة تنشيط جماعة المؤمنين ولـمّ شملهم الممزّق ودعم شرعية حكمه وحكم آله بني أمية. كانت هذه الحاجة هي ما دفع عبد الملك إلى الشروع في سلسلة من الإجراءات والتحوّلات في بؤرة تركيز الجماعة، وهي التحوّلات التي أدّت إلى ظهور الإسلام. أُعيد تعريف «المؤمن» ليكون مرادفًا لكلمة «مسلم»، واستُبعد المسيحيون واليهود بطريقة لم يسبق لها مثيل، كما كانت هناك زيادة في تأكيد المؤمنين/ المسلمين على أهمية محمد والقرآن في نظرتهم للعالم، وهو ما ظهر بوضوح شديد مثلًا في إعادة تصميم المسكوكات المعدنية لتتخلّى عن التصاوير البيزنطية والساسانية -التي استعملها المؤمنون/ المسلمون من قبل- واستبدالها باقتباسات من القرآن غالبًا ما كانت معادية للثالوث في مضمونها. ويرى دونر أيضًا أن جزءًا من سياسة التأكيد على القرآن كان اتخاذ عبد الملك لقبًا ذا صدى قرآني هو: خليفة الله. كما كانت هناك إجراءات أخرى تنذر بأن دائرة الاندماج في حركة المؤمنين كانت تضيق أكثر فأكثر؛ فقد رُفضت بعض العقائد المسيحية الكبرى -خاصة الثالوث- وتجلَّى ذلك في بناء قبة الصخرة التي أبرزت بصورة كبيرة الآيات الرافضة للثالوث من القرآن[19]. كما شهدت تلك الفترة تطوّر وتثبيت ممارسات مثل الصلاة والصوم والحج، والتي يعود أصلها إلى حياة محمد؛ وثمة ممارسات أخرى -مثل صلاة الجمعة- قد يكون أصلها قد بدأ في تلك الفترة[20]. علاوة على ذلك؛ شجّع الأمويون تأليف وصياغة تاريخ خلاص إسلامي فريد، يسرد للجماعة قصةً عن جذور نشأتها تؤكّد على طابعها الإسلامي، وليس جماعة المؤمنين؛ وبالمثل تحكي روايات الفتح الأحداث من منظور المسلمين وليس المؤمنين. إن ما بدأ كحركة إصلاحية توحيدية مفتوحة لكلّ مَن يؤمن بإله واحد ويلتزم بالسلوك القويم؛ قد صار الآن دينًا جديدًا هو الإسلام، الخصم والمنافس للمسيحية واليهودية.
كتب ألبرت شفايتسر: «لا توجد مهمّة تاريخية تكشف عن معدن المرء الحقيقي مثل كتابة حياة يسوع»[21]؛ وربما يمكن قول شيء مشابه عن كتابة حياة محمد. ليس من الصعب التكهّن بما يؤدي إليه الطريق الذي اختار دونر سلوكه في تصنيف كتابه؛ إِذْ بصرف النظر عن الخطوات التي اتخذها في سياق المناقشات المتخصّصة الدائرة بين دارِسِي الإسلام، فمن الواضح أنه يتغيَّا المساهمة في إيجاد مساحة شرعية لإسلام استيعابي ومتسامح في عالم اليوم من خلال البحث عن صورة هذا الإسلام في القرن السابع، حيث بدأ كلّ شيء. إذا كانت الصورة الأقدم للإسلام هي إسلامٌ عالمي قادر على استيعاب أيّ شخص يؤمن بإله واحد ويتمسّك بفكرة التقوى والعمل الصالح -وهي صورة لو وُجِدت ربما تحمل تشابهًا غريبًا في بعض النواحي مع الكنيسة البروتستانتية التقليدية المعاصرة- فإنّ مثل هذا الاكتشاف سيكون هدية ثمينة للّيبراليين في الغرب، وهو ما سيجعل الإصلاحيين المسلمين اليوم هم الأحقّ بوصف السّلفية؛ لأنهم -وليس الوهّابيين أو الإخوان المسلمين- هم من يسعى فعلًا إلى إعادة المجتمع الإسلامي إلى بداياته الحقيقية.
ومع ذلك، فليس من السهل دائمًا الجمع بين السياسة الحصيفة والمقاربة التاريخية الجادة؛ فمهما كانت أهداف دونر الجديرة بالثناء والاستحسان، تظلّ هناك العديد من المشكلات الخطيرة في كتابه. المشكلة الأولى -وربما الأخطر- هي عدم وجود أدلّة على العديد من الادعاءات التي يطلقها[22]؛ إنّ هشاشة وضحالة الأُسس التي بُنيت عليها أدلة جزء كبير من الصور التي يقدّمها دونر لن تتضح لغير المتخصِّصين بسبب افتقار النصّ إلى الهوامش والإحالات، ومع ذلك تتضح هذه المشكلات في بعض المواضع من مجرّد القراءة البسيطة للكتاب. فعلى سبيل المثال، إذا نظرنا في إحدى الدعاوى الرئيسة التي أكّد عليها دونر كثيرًا وهي أنّ الكلمتين «مؤمن» و«مسلم» قد أُعيد تعريفهما تحت حكم عبد الملك لاستبعاد اليهود والمسيحيين (203- 204)، سيتبيّن أن تلك الدعوى لا تقوم إلا على دعامتين أضعف من بعض؛ الأولى تتمثّل في إشارات عابرة لممارسات تسمية من مصادر عربية غير محدّدة، والثانية هي في الأساس مناقشة للمنطق الكامن وراء استخدام كلمات «مؤمنون» و«مهاجرون» و«مسلم» دون إحالة واضحة إلى أيّ نصوص بعينها باستثناء القرآن. ثم يكتب دونر: «بالنظر إلى معرفتنا الراهنة، لا يسعنا إلا التكهّن بسبب حدوث هذا التحول في هوية المؤمنين» (ص204). بعبارة أخرى؛ نحن هنا أمام ادعاء رئيس ومركزي في أطروحة الكتاب، ليس هناك سوى القليل من الأدلة المؤيّدة له، ثم يليه اعترافٌ بأن السبب المقدّم لحدوث هذا التحوّل في التعريف الذاتي -الذي لم يثبته المؤلِّف أصلًا- مبنيٌّ على التخمين والتكهّن[23]. في الحقيقة، هذه ليست الدعوى المركزية الوحيدة المبنية على محض التخمين، بل إنّ الكتاب مشحونٌ بالعبارات الدالة على الاحتمالية والحكم بمجرّد الظن[24] دون أن يكون هناك ما يكفي من الأدلة التي تدعمها، وهو ما يزعزع ثقة القارئ في صدق الصورة التي يحاول دونر رسمها. وفي حالات أخرى، يبدو أنّ ادعاءات دونر تتناقض فعليًّا مع الأدلة التي بين أيدينا؛ فمن المفترض أن يكون الإسلام -وفقًا لدونر- قد وُلِد من حركة المؤمنين في أواخر القرن السابع وأوائل القرن الثامن، وفي هذه المرحلة بدأت الحركة في إقصاء المسيحيين وإظهار موقف أكثر عدائية تجاه العقائد المسيحية. بيد أنّ الحوليّات المارونية -وهي وثيقة سريانية يعود تاريخها إلى ستينيات القرن السادس- تشير إلى أنه بحلول عام 660م، حاول الخليفة معاوية إصدار عملة معدنية بدون الصليب المسيحي المطبوع عليها، وهو ما يعني أن الناس آنذاك قد رفضوا تداولها[25]. بناءً على ذلك؛ هل يمكن القول إنّ التمثّلات الظاهرة للهوية الطائفية في الإسلام المبكّر كانت أقلّ وضوحًا [من صورته اللاحقة] نظرًا لأن المسلمين الأوائل باعتبارهم أقلّية صغيرة وضعيفة كانوا يحكمون أغلبية أكبر بكثير، ومن ثم كان عليهم أن يدركوا مدى ما ستثيره الأعمال الطائفية والاستفزازية العلنية -مثل محو الرموز المسيحية من العملات- من مشاعر معادية لدى الجماهير الغفيرة من غير المسلمين؟
إنّ الدليل الرئيس الذي يحرّك كتاب «محمد والمؤمنون» هو قراءة دونر المعمّقة للقرآن وصورة حركة المؤمنين المستمدة من تلك القراءة. هنا؛ لا يختلف دونر كثيرًا عن باتريشيا كرون التي انخرطت في قراءة مشابهة للقرآن دون الرجوع إلى مصادر رئيسة أخرى. بيدَ أن النتيجة التي توصّلت إليها كرون اعتمادًا على قراءتها المعمّقة للقرآن هي أنّ القرآن نفسه قد وُضع كلّه -أو على الأقلّ جزء منه- خارج شبه الجزيرة العربية[26]، وهو الرأي الذي لن يتّفق معه دونر بلا شكّ[27]. ومن ثم؛ فإنّ القراءات المعمّقة للقرآن يمكن أن تؤدي إلى نتائج مختلفة جذريًّا. علاوة على ذلك، فإنّ قراءة دونر تلك تعاني من مشكلة غياب السياق؛ إِذْ لا يوجد أيّ استحضار على الإطلاق للسياق في أيٍّ من الآيات التي اختارها لبيان معتقدات المجتمع المبكّر، ومع ذلك من المفترض أن آيات القرآن قد نزلت على محمد في عدد من السياقات المختلفة على مدار عقود، ومن ثم يظهر أن للقرآن معالجات مختلفة تجاه نفس الموضوع[28]. علاوة على ذلك، يظهر في المرويات الإسلامية إدراكٌ لعدد من التعارضات بين آيات القرآن، وهو ما سعتْ إلى التعامل معه من خلال القول بأن بعض الآيات تنسخ آيات أخرى. ومن هنا يبيّن أحد الكتب المهمّة في علوم القرآن أنه «لا ينبغي لأحد أن يفسّر كتاب الله إلا بعد معرفة الناسخ والمنسوخ»[29]، والحكمة العلمية القديمة تقول: إنّ النص بدون سياق خدّاع ومظنّة الزّلل، وهذا خطر واضح وحاضر في عامة مواضع استعمال دونر للقرآن.
وإذا تجاوزنا مشكلة غياب السياق، فإنّ الأمر الأكثر إشكالية في قراءة دونر للقرآن هو اعتماد حجّته على الانتقال من «ما يجب أن يكون» إلى «ما هو كائن بالفعل»؛ بمعنى أنّ تصوره للمعتقدات والسلوكيات الفعلية لجماعة المؤمنين ككلّ = مستمدٌّ من الوثيقة المعيارية وما فيها من أوامر ونواهٍ؛ رغم أنه ليس من الواضح أبدًا عدد الأشخاص الذين آمنوا بالفعل وطبّقوا حقًّا أوامر القرآن ونواهيه. فمع كلّ ما نعرفه، من المحتمل ألا تكون جماعة المؤمنين -التي تمثّل مدار كلّ أطروحات الكتاب تقريبًا- إلا مجرّد ثلة قليلة من الناس، أو ربما محمد نفسه فقط[30].
تصبح حجة دونر حول تلك الجماعة الغامضة وغير المحدّدة (وغير القابلة للتحديد) أكثر إشكالية عندما يذهب إلى وجود انقسامات أيديولوجية داخلها من أجل التعامل مع الآيات التي لا تنسجم مع رؤيته لطبيعة حركة المؤمنين، لتكون تلك الانقسامات المفترضة بمنزلة المناورات التي تهدف إلى الحفاظ على سلامة نظريته. يُفترض أنّ حركة المؤمنين التي تصوّرها دونر كانت في البداية ذات طابع عالمي/ استيعابي ومفتوحة لكلّ من المسيحيين واليهود، بيدَ أنّ إحدى المشكلات المباشرة التي تنشأ من هذا الرأي هي أنّ القرآن يحتوي على آيات تنتقد عقيدة الثالوث، وعلى وجه الخصوص هي نفس الآيات التي وُضعت في مكان بارز على قبة الصخرة والتي أوردها دونر في ملحق الكتاب. تشير مثل هذه الآيات إلى أنّ حركة المؤمنين في تلك الفترة المبكرة جدًّا لا يمكن أن تكون بالطابع العالمي الاستيعابي الذي يعزوه إليها دونر. في صدر الكتاب، اعتُبرت تلك الآيات المعبّرة عن المُبَايَنة الطائفية غير ذات أهمية كبيرة[31]، ولكن فيما بعد اكتشفنا أنه «بالنسبة لأولئك المؤمنين الذين كانوا ينزعون نحو التمسك بمسألة وحدانية الله، لا بد أنّ عقيدة الثالوث المسيحية كانت دائمًا ما تمثل مشكلة» (ص213)[32]. لذلك؛ ما يبدو هنا هو أنه كان هناك بعض المؤمنين المنفتحين على انضمام المسيحيين إلى الحركة، بينما كان هناك آخرون يرفضون ذلك؛ بمعنى أنه كان هناك جناح مناهض للعالمية الاستيعابية داخل حركة المؤمنين تمكّن بطريقة ما من تمثيل آرائه في نصّ القرآن. لكن لا يوجد دليل يدعم أيًّا من هذه النتائج سوى الحقائق التي أوجدتها قراءة دونر للقرآن. ومجدّدًا نكرّر أنه في ظلّ عدم وجود طريقة لمعرفة عدد المؤمنين الموجودين بالفعل، من المستحيل التعرّف بدقّة على ما تعنيه إشارات الكتاب إلى تركيبة وبنية تلك الجماعة، إِذْ إننا أمام نوع من التوتّر أو الانقسام لا تدعمه سوى وسائل البناء التفسيري[33].
تزداد حِدّة تلك المشكلة عندما نحاول بناء تصوّر عن عدد أفراد جماعة المؤمنين من خلال النظر في المصادر التقليدية. عندما هاجر محمد ومَن معه إلى المدينة المنورة عام 622م، لم يكن عدد جماعة المؤمنين يزيد عن مائة شخص، ثم عندما عاد إلى مكة بعد ثماني سنوات في عام 630م لفتحها، كان على رأس جيش مكوّن من حوالي 10000 رجل[34]. إذن؛ معظم المؤمنين الجُدد قد دخلوا إلى الجماعة في حدود سنة 630 وكان عددهم أكبر مما كان عليه حتى سنة 622. وعندما أصبح من الواضح أنّ محمدًا قد أحكم هيمنته على غرب شبه الجزيرة العربية، بدأت قبائل بأكملها تدخل في الإسلام أفواجًا. في الواقع، يُعرف عام 630م في التقليد الإسلامي بأنه «عام الوفود» بسبب ما شهده من دخول قبائل بأسرها في الإسلام. إذا كان من الممكن الوثوق بهذه المصادر بأيّ شكلٍ من الأشكال، فمن الصعب أن نرى كيف يمكن للجماعة المثالية التي يتصوّرها دونر والمكوّنة من المؤمنين شديدي التديّن أن تعكس وجود مجموعة كبيرة من الأشخاص الذين تحوّلوا إلى الإسلام بالجملة. يعترف دونر بأن معظم المؤمنين الأوائل ربما كانوا أُميين ولا يعرفون سوى القليل جدًّا عن أفكار الحركة التي انضموا إليها مؤخرًا (ص77)، بيدَ أنّ الآثار المترتبة على هذا الاعتراف المهم لم تتبيّن بالكامل في الكتاب. في الحقيقة، يمكننا تقديم تفسير أبسط وأفضل توثيقًا للعديد من المسائل التي تفسرها نظرية دونر إذا عزوناها لظواهر التحوّل الجماعي، والأُمية، والجهل بالكثير من المحتوى الفعلي للقرآن وتعاليم محمد، عوضًا عن نظرية دونر الأكثر تعقيدًا والمبنية على وجود حركة إصلاح توحيدية ذات طابع عالمي استيعابي، بيدَ أنها أفلتت ببساطة من مرصد التاريخ ثم دُرست معالمها خلال التقليد اللاحق (على الرغم من أن النظرية الأبسط ربما تكون أقلّ فائدة من الناحية السياسية).
في جميع أجزاء الكتاب، يُستخدم مصطلحَا «الموحّد» و«التوحيد» باعتبارهما أحد الأُسس المركزية في حركة المؤمنين، مع قدرة المسيحيين واليهود على الانضمام إلى الحركة لأنهم أيضًا كانوا موحّدين. ولكن ليس من الواضح أنّ محمدًا نفسه كان موحّدًا في بداية رسالته النبوية؛ ففي «حادثة الغرانيق» الشهيرة، تلا محمد آيات من القرآن أجازتْ طلب الشفاعة من ثلاثة أوثان معبودة معروفة في مكة. لم يدرك محمد أنه لم يكن من المقبول طلب تلك الشفاعة من الأوثان حتى بيّن له جبريل لاحقًا، وهو ما يشير إلى أنه كان يؤمن بأكثر من إله واحد في تلك المرحلة من حياته. الآيات المعنيّة هنا منسوخٌ لفظها من القرآن، ولا نعرف عنها شيئًا إلا من خلال التقليد الإسلامي نفسه، الذي من الصعب جدًّا القول إنه اخترع هذه القصة المحرجة[35][36]. ما يعنيه هذا بالنسبة لأطروحة الكتاب هو أن حركة المؤمنين لا يمكن أن تكون توحيدية -على الأقلّ في البداية- بالمعنى التي يريد دونر أن يسقطه عليها.
بيدَ أن ثـمة مشكلة أعمق في استخدام دونر مقولَتَيْ «التوحيد» و«الموحّد»؛ فهما مقولتان صِيغتا حديثًا، واستعمالهما في سياق العصور القديمة المتأخّرة يتصادم مع التتابع التاريخي. استَخدم مفهومَ «التوحيد» لأول مرة الفيلسوفُ الأفلاطوني من جامعة كامبريدج هنري مور في عام 1660م؛ واستَخدم مفهومَ «الموحّد» لأول مرة الأفلاطوني رالف كودوورث في عام 1678م[37]. كما أنه لا توجد كلمة تشير إلى«التوحيد» أو «الموحّد» في السريانية[38]، والكلمات اليونانية المعبّرة عن «التوحيد» (μονοθεϊα)، و«الموحّد» (μονοθεϊτης)، و«توحيدي» (μονόθεος) لا وجود لها على الإطلاق في قاموس ليدل Liddell وسكوت Scott وجونز Jones المعتمد بين اليونانية والإنجليزية[39]. وأمّا كلمة (μονοθεϊα) التي تعني اليوم «التوحيد»، فكان أول ظهور لها في المعجم اليوناني الآبائي Patristic Greek Lexicon لـ "لامب" Lampe، وهناك عُرّفت بأنها تعني: «ألوهية واحدة»[40]. وبالبحث عن هذه المصطلحات الثلاثة في المكنز الضخم Linguae Graecae -الذي يحوي أكثر من 100 مليون كلمة، ويستهدف استيعاب كافة المؤلِّفين اليونانيين من هوميروس إلى سقوط القسطنطينية- تبيّن أنّ مفردتي الموحّد μονοθεϊτης والتوحيد μονοθεϊα ظهرتَا فيه مرة واحدة فقط، والمرتان كلتاهما في كتاب من القرن الرابع عشر ألّفه نيكيفوروس جريجوراس بعنوان: «التاريخ الروماني Historia Romana». وليس من الواضح أنّ المسيحيين واليهود والمسلمين/ المؤمنين في القرن السابع قد صنّفوا أنفسهم وفق المقولات التصنيفية عينها التي ظهرت لاحقًا ضمن تصنيفات أنماط الدّين في بدايات الحقبة الحديثة، ومن ثم شعروا بشيء من الصِّلَة والقرابة بينهم. في الواقع، العكس هو ما يحدث في كثير من الأحيان؛ إِذْ كلّما كان الأشخاص والجماعات أكثر تشابهًا ازدادت شدّة اختلافاتهم الدقيقة[41].
اختار دونر استعمال كلمة (monotheism) مقابلًا لـ«التوحيد»[42]، ومن المفترض أنه يستحضر هنا دلالة المصطلح العربي (التوحيد)، بيدَ أن هذا المصطلح لم يرِد في القرآن، ولا الفعل المشتق منه (وحَّد)[43]. ومن ثم؛ فإنّ الترجمة الأدقّ والأقرب للصواب هي استعمال (unitarianism) مقابلًا لـ«التوحيد» بدلًا من (monotheism)، وهي ترجمة تبرز أن هذا المصطلح هو المقابل النقيض لكلمة أخرى مرتبطة بالمسيحية؛ وهي التثليث، مما يجعل الحمولة الطائفية للمصطلح وتعبيره عن المباينة والانفصال أكثر وضوحًا. يرتبط التوحيد بكلمة «واحد»، بينما يرتبط التثليث بكلمة «ثلاثة»، والتناقض بين هذين المصطلحين يمكن رؤيته في عدد من آيات القرآن مثل: ﴿لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا إِلَهٌ وَاحِدٌ﴾ [المائدة: 73]. ومحصلة هذا كلّه أننا إذا غيّرنا كلمتي (monotheism) و(monotheist) بالمصطلحات الأدقّ (unitarianism) و(unitarian) في كلّ مواضع الكتاب، فإنّ الطابع العالمي والاستيعابي لحركة الإصلاح التوحيدية لن يصل بنا إلى أنها حركة استيعابية مفتوحة أمام المسيحيين على الإطلاق. من الواضح أن الإيمان بإله [جوهر إلهي] واحد (monotheism) هو أمر مشترك بين جميع المسيحيين واليهود والمؤمنين؛ ولكن ما هو غير واضح وما لم يُظهره دونر هو أنّ المسيحيين واليهود والمؤمنين لم يكن لديهم رؤية توحيدية unitarianism مشتركة على الإطلاق. ولإثبات فرضيته حول هذا الطابع الاستيعابي لحركة المؤمنين، يحتاج دونر إلى تقديم حجّة تثبت شيوع الميل إلى النظرة التوحيدية [المناقضة للثالوث] (unitarianism) على نطاق واسع بين المسيحيين في الشرق الأدنى في العصور القديمة المتأخّرة، وهو ما فشل في القيام به[44]. بدلًا من ذلك؛ يحاول دونر أن يتحدّث عن «الصياغات المونوفيزية والنسطورية لعقيدة التثليث»، والتي ربما جعلتها أقرب لتوحيد المؤمنين/ المسلمين، لكن من الواضح أن دونر غير واعٍ بأن النسطورية والمونوفيزية -وكلها مصطلحات غير ذات قيمة لأطروحته[45]- كانَا بالأساس مواقف كريستولوجية تعبر عن الخلافات بين مواقف النساطرة والمونوفيزيين والخلقيدونيين تجاه مسألة طبيعة المسيح، وليس الثالوث[46].
فوق كلّ ما سبق، فهناك مشكلات خطيرة أخرى؛ فالمؤمنون -وفقًا لدونر- لديهم الدافع لتوسيع أراضيهم لأنهم يريدون نشر شريعة الله في العالم من حولهم الذي يعتبرونه واقعًا في الآثام والخطايا. لكن لا يبدو أن الخطيئة والغرق في الآثام والتنزّه عنها هي موضوعات رئيسة في القرآن[47]، وهو ما يعني أنه ليس هناك الكثير من الأوامر والنواهي لفرضها في هذا الصّدد؛ إِذْ من بين أكثر من 6200 آية في القرآن، يقول التقليد إنّ حوالي 500 منها تتناول بالفعل مسائل الأحكام والتكاليف الشرعية، هذا بجانب أنّ العلماء أنفسهم مختلفون في عدد آيات الأحكام، فذهب بعضهم إلى أنها 350 آية، واختار آخرون أنها 600 آية[48]. ومعظم آيات الأحكام تلك يقع في باب العبادات، ليكون مجموع الآيات التي تتناول موضوعات تشريعية واقعية هي 80 آية تقريبًا[49]. علاوة على ذلك، فإنّ الأحكام التكليفية التي قرّرها القرآن لم تأتِ على غرار المدوّنات التشريعية التي تحاول تغطية جميع جوانب الحياة البشرية، بل بالأحرى -كما قال نويل كولسون-: «غالبًا ما كانت على شكل حلول عارضة لمسائل جزئية، ولم تستهدف تغطية موضوعٍ عامّ بشكلٍ شاملٍ»[50]. وعليه، يجب قراءة إشارات دونر المتكرّرة إلى حاجة المؤمنين لنشر شريعة الله في ضوء هذه الإحصائيات؛ كما يجب أيضًا قراءتها في ضوء الأرقام الأخرى مثل الأعداد الكبيرة التي أشرنا سابقًا إلى تحوّلها أفواجًا إلى حركة المؤمنين والذين -باعتراف دونر نفسه- لم يكن لديهم سوى معرفة سطحية جدًّا بالإسلام/ رسالة المؤمنين وآيات الأحكام الثمانين أو نحوها من شريعة الله التي من المحتمل أنّ مضمونها كان ذا صِلة بتلك الأعداد الكبيرة من غير المسلمين الذين غزاهم جيش المؤمنين. في الواقع، ينتاب المرءَ شعورٌ في بعض الأحيان أن دونر لا يكتب عن المسلمين الأوائل بل عن الأسينيين[51] الذين كانوا متحمّسين للقانون اليهودي، وعاشوا منفصلين عن الجماعات اليهودية الأخرى باحثين عن القداسة والتنزه عن الآثام؛ «إنّ حقيقة أن المؤمنين كُلِّفوا أحيانًا بدفع الكفارات مع كونها تؤكّد كيف كانت تلك الجماعة تركز -من حيث المبدأ- على الحفاظ على نقائها الداخلي، فإنها تبيّن أيضًا أنهم كانوا يتطلعون بقدر الإمكان إلى بناء جماعة تلتزم بأرفع معايير التقوى الصارمة؛ حتى يميزوا أنفسهم عن العالم الآثم من حولهم، وهو ما يحقّق لهم الخلاص في الآخرة» (ص64). ومع ذلك فقد كتب أحد الباحثين البارزين في الفقه الإسلامي: «بشكل عام، أقَـرّ القرآن العادات والمؤسّسات القائمة في المجتمع العربي، ولم يُدْخِل عليها سوى التغييرات التي اعتُبرت ضرورية»[52]. كما أشارت مراجع بارزة أخرى في الشريعة الإسلامية إلى انتشار شرب الخمر بين المسلمين الأوائل -حتى بين أعلمهم بأحكام القرآن- وهو ما يعدّ دليلًا على واقع تلك الفترة المبكّرة، حتى «ليمكن للمرء أن يفترض بشيء من الثقة أنه بصرف النظر عن بعض المساحات التي نظّمها القرآن بشكلٍ كامل وبشيء من التفصيل (مثل الزواج، والطلاق، والميراث، وغيرها)، ففي ذلك الوقت لم يكن هناك سوى اهتمام ضئيل بإنشاء نظام إسلامي من التشريعات الأخلاقية»[53]. يعيدنا كلّ هذا إلى أسئلة طرحناها سابقًا؛ مَن هم هؤلاء المؤمنون الذين يتحدّث عنهم دونر كثيرًا؟ كم كان عددهم؟ أين وُجدوا؟ أين يمكن العثور عليهم بين جماهير المتحوِّلين لجماعة المؤمنين الذين لم يعرفوا سوى القليل عن المحتوى الفعلي للقرآن؟ وما هو المضمون الدقيق للشريعة القرآنية التي كانوا يحاولون نشرها؟ وكيف ميّزتهم هذه الشريعة بصورة واضحة وجعلتهم في مكانة متفردة بعيدًا عن الأنظمة البيزنطية والساسانية[54] «الآثمة» التي أشار إليها دونر في أكثر من موضع؟
لقد كتب فرد دونر كتابًا واضحًا ومباشرًا، وسرد-بمهارة كبيرة- قصة مُقْنِعة، تُشْعِر المرء بالسعادة لأنه من السهل أن يفهمها أيّ شخص غير متخصّص، وكذلك سيستقبلها بحفاوة بالغة أولئك الذين يتفقون معه في أفكاره السياسية. بيدَ أن تلك القصة لم تبتعد كثيرًا عن الطابع التنقيحي المتطرّف الذي وسم كتاب الهاجريون، وبها نفس القدر من الخيال والتوهّم. وإذا نظرنا إلى افتقار كتاب «محمد والمؤمنون» إلى التوثيق الدقيق، وخلوّه من الهوامش الشارحة والمثيرة للإعجاب التيزيّن بها مؤلِّفَا الهاجريون كتابَهما؛ سنجد أن دونر -الذي بذل جهدًا كبيرًا للتغلب على الاتجاه التنقيحي- قد غرق في مستنقع من التكهّنات التاريخية، ولم تسفر جهوده -وهنا المفارقة- إلا عن سردية أقلّ تماسكًا وإقناعًا من الناحية التاريخية على مستويات عدّة مما قدمه كوك وكرون في كتابهما الذي جسّد الدافع العلمي مُبرِزًا-على طريقة: بضدّها تتبيّن الأشياء- الكثيرَ من جوانب القصور في صنعته البحثية.
[1] العنوان الأصلي للمقالة هو:
Donner, Fred M. Muhammad and the Believers: At the Origins of Islam. Cambridge, Massachusetts and London: The Belknap Press of Harvard University Press, 2010.
وقد نشرت في: Expositions 5.2 (2011)
[2] ترجم هذه المقالة: مصطفى هندي، باحث ومترجم، له عدد من الأعمال المنشورة.
[3] فرد دونر Fred Donner ـ(1945-...): مستشرق أمريكي، وُلِد في واشنطن، حصل دونر على الدكتوراه من جامعة برنستون في دراسات الشرق الأدنى في سنة 1975، ثم أصبح رئيس المعهد الشرقي وقسم لغات وحضارات الشرق الأدنى بجامعة شيكاغو، تتركّز دراساته في الإسلام المبكّر، له عدد من الكتب، منها:
-The Early Islamic Conquests, ACLS Humanities E-Book, 1981
«الفتوحات الإسلامية المبكرة»
-Narratives of Islamic Origins: The Beginnings of Islamic Historical Writing (Studies in Late Antiquity and Early Islam, No. 14), Darwin Press, Incorporated; Third Printing edition, 1998.
وقد ترجم للعربية بعنوان: «الروايات السردية عن الأصول الإسلامية، بدايات الكتابة التاريخية الإسلامية، ترجمة: عبد الجبار ناجي، المركز الأكاديمي للأبحاث، الطبعة الأولى، بيروت، 2019». (قسم الترجمات).
[4] مايكل كوك Michael Cook، (1940م-...): مؤرخ أمريكي، بالأساس درس التاريخ والدراسات الشرقية في كينجز كوليدج، كامبريدج، ثم في كلية الدراسات الشرقية والإفريقية (SOAS) بجامعة لندن، وهو أستاذ قسم دراسات الشرق الأدنى في جامعة برنستون منذ 2007م، من أهم كتبه بالإضافة لكتابه الشهير مع باتريشيا كرون «الهاجريون»: كتاب «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الفكر الإسلامي»، وهو مترجم للعربية، حيث ترجمه: رضوان السيد وخالد السالمي وعمار الجلاصي، وصدر عن الشبكة العربية للأبحاث والنشر، في طبعة أولى عام 2009م، وفي طبعة ثانية عام 2013م، كما ترجم مؤخرًا كتابه «أديان قديمة وسياسة حديثة، الخلافة الإسلامية من منظور مقارن»، ترجمه: محمد مراس المرزوقي، وصدر عن الشبكة العربية للأبحاث والنشر، عام 2017م، كما ترجم كتابه حول النبي محمد والقرآن للعربية بعنوان: «محمد نبي الإسلام»، ترجمة: د/ نبيل فياض، دار الرافدين، الطبعة الأولى، بيروت، 2017. (قسم الترجمات).
[5] باتريشيا كرون Patricia Crone (1945م- 2015م): مستشرقة أمريكية من أصل دانمركي، وتعدّ أهم رواد التوجه التنقيحي، وصاحبة أفكار ذائعة الصيت حول تاريخ الإسلام المبكّر وتاريخ الإسلام؛ حيث تشكّك في كون القرآن الذي بين أيدينا يعود إلى القرن السابع الميلادي، كما تشكّك في كون الإسلام قد نشأ في مكة الحالية، لها عدد من الكتب المهمّة، على رأسها «الهاجريون» مع مايكل كوك (1977م)، وهو مترجم للعربية، حيث ترجمه: نبيل فياض، وصدر عن المركز الأكاديمي للأبحاث تحت عنوان: «الهاجريون؛ دراسة في المرحلة التكوينية للإسلام»، بيروت، 2015م، وكتاب «تجارة مكة وظهور الإسلام» (1987م)، وهو مترجم للعربية أيضًا، حيث ترجمته: آمال محمد الروبي، وصدر عن المركز القومي للترجمة، مصر، 2005م. (قسم الترجمات).
[6] Crone, Patricia, and Michael Cook. Hagarism: The Making of the Islamic World (Cambridge: Cambridge University Press, 1977).
[7] جون وانسبرو John Wansbrough، (1928م- 2002م): مستشرق أمريكي، يعتبر هو رائد أفكار التوجه التنقيحي، وتعتبر كتاباته منعطفًا رئيسًا في تاريخ الاستشراق؛ حيث بدأت في تشكيك جذري في المدونات العربية الإسلامية وفي قدرتها على رسم صورة أمينة لتاريخ الإسلام وتاريخ القرآن، ودعا لاستخدام مصادر بديلة عن المصادر العربية من أجل إعادة كتابة تاريخ الإسلام بصورة موثوقة، ومن أهم كتاباته:
Quranic Studies: Sources and Methods of Scriptural Interpretation, Oxford University Press, 1977.
«الدراسات القرآنية؛ مصادر ومناهج تفسير النصوص المقدسة» (1977م)، ومنشور على موقع تفسير عرض لهذا الكتاب كتبه كارول كيرستن، ترجمة: هند مسعد.
The Sectarian Milieu: Content and Composition of Islamic Salvation History, 1978
الوسط الطائفي: محتوى وتشكل «تاريخ الخلاص» الإسلامي. (قسم الترجمات).
[8] John Wansbrough, Quranic Studies: Sources and Methods of Scriptural Interpretation (Oxford: Oxford University Press, 1977; repr. Amherst, NY: Prometheus Books, 2004) and The Sectarian Milieu: Content and Composition of Islamic Salvation History (Oxford and New York: Oxford University Press, 1978; repr. Amherst, NY: Prometheus Books, 2006). See Andrew Rippin’s anecdote (2004, xiii) about Wansbrough being unapologetic for having written a “difficult” book with Quranic Studies
[9] كتب وانسبرو نفسه مراجعة نقدية للكتاب؛ انظر:
“Patricia Crone and Michael Cook: Hagarism: the making of the Islamic world,” Bulletin of the School of Oriental and African Studies 41 (1978), 155–156.
[10] جوزيف شاخت Joseph Schacht، (1902- 1969): أحد أهم المستشرقين الألمان، درس اللاهوت واللغات الشرقية في جامعة ليبتسك وجامعة برسلاو، حصل على الدكتوراه من جامعة برسلاو (1923)، وفي (1929) صار أستاذ كرسي بجامعة فرايبورج، وهو معروف لدى المثقفين والدارِسين المصريين في فترة الثلاثينيات؛ حيث انتدب عام (1934) للتدريس في الجامعة المصرية (جامعة القاهرة حاليًا) لتدريس فيلولوجي اللغة العربية والسيريانية، شارك في الإشراف على الطبعة الثانية من (دائرة المعارف الإسلامية)، وقد تنقّل من ألمانيا إلى مصر إلى إنجلترا إلى هولندا ثم استقر به المطاف في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية حيث عمل كأستاذ في جامعة كولومبيا منذ (1959) وإلى وفاته، اهتمامات شاخت الرئيسة كانت بالفقه والقانون والشريعة الإسلامية، ثم بالحديث النبوي، وله فرضيات حول الفقه الإسلامي؛ أشهرها كونه قد تأثّر في نشأته بالفقه الروماني، كما له في الحديث فرضية تسمى بنظرية المدار، والمدار مصطلح حديثي يعني الراوي الذي تلتقي عنده الأسانيد، وقد وظّف شاخت هذا المصطلح في نظرية تَعْتَبِر أن الأحاديث وُضعت في القرن الثاني الهجري، وأن مدار الإسناد هو -غالبًا- واضع الحديث، وطالما أثارت نظرياته -وخصوصًا نظرية المدار- انتقادات بعض المستشرقين، هذا رغم إعجاب معظمهم بها، قامت هذه الانتقادات على أساس ضعف حضور المدوّنة الحديثية في بلورة شاخت لنظريته، واعتماده الكبير على كتب الفقه: مثل كتاب (الأم) للشافعي، ومؤخرًا صدر لفهد الحمودي كتابٌ بعنوان: (نقد نظرية المدار) وضّح فيه مواطن ضعف هذه النظرية الشهيرة، وأصل الكتاب رسالة دكتوراه تحت إشراف وائل حلاق، وقد ترجم كتاب الحمودي للعربية، بعنوان: (إعادة رسم خارطة النظريات الغربية حول أصول الشريعة الإسلامية)، ترجمة: هيفاء الجبري، الشبكة العربية للأبحاث، بيروت، لبنان، ط1، 2014.
من أهم آثاره: (الإسلام، توبنغن، 1931)، و(أصول الفقه المحمدي، أكسفورد، 1950) - ترجم للعربية بهذا العنوان، ترجمة: رياض الميلادي ووسيم كمون، دار المدار الإسلامي، ط1، بيروت، 2018-، وقد نَشر وحقّق عددًا من الكتب الفقهية، منها: (الحيل في الفقه) لأبي حاتم القزويني، وكتاب (اختلاف الفقهاء) للطبري. (قسم الترجمات).
[11] جولدتسيهر Ignác Goldziher، (1850- 1921): مستشرق مجَري يهودي، تلقّى تعليمه في جامعة بودابست ثم برلين ثم ليبستك، وفي عام 1870 حصل جولدتسيهر على الدكتوراه الأولى، وكانت عن تنخوم أورشلي أحد شرّاح التوراة في العصور الوسطى، وعيّن أستاذًا مساعدًا في عام 1872، وبعد رحلة دراسية برعاية وزارة المعارف المجَرية في فيينّا ثم ليدن ثم في القاهرة (حيث حضر بعض الدروس في الأزهر) وسوريا وفلسطين، وفي عام 1894 عُيّن أستاذًا للّغات الساميّة بجامعة بودابست.
له عددٌ كبيرٌ من الآثار، أشهرها: "Vorlesungen über den Islam"، (العقيدة والشريعة في الإسلام، تاريخ التطور العقدي والتشريع في الدين الإسلامي)، وSchools of Koranic Commentators، (مذاهب التفسير الإسلامي)، والكتابان مترجمان للعربية؛ فالأول ترجمه وعلّق عليه: محمد يوسف موسى، وعليّ حسن عبد القادر، وعبد العزيز عبد الحق، وقد طُبع أكثر من طبعة، آخرها طبعة صادرة عن الهيئة العامة للكتاب، القاهرة، 2013، بتقديم: محمد عوني عبد الرؤوف، والثاني كذلك مترجم، ترجمه: عبد الحليم النجار، وصدر في طبعة جديدة عن الهيئة العامة للكتاب، القاهرة، 2013، بتقديم: محمد عوني عبد الرؤوف، وله كتاب مهم عن الفقه بعنوان: (The Ẓāhirīs: Their Doctrine and Their History : a Contribution to the History of Islamic Theology) (الظاهرية: مذهبهم وتاريخهم)، وهو أول بحوثه المهمّة حول الإسلام حيث صدر في 1884، وقد ترجم للعربية بهذا العنوان، ترجمة: محمد أنيس مورو، نماء للبحوث والدراسات، ط1، القاهرة، بيروت، 2021، كذلك فقد ترجمت يومياته، ترجمها: محمد عوني عبد الرؤوف، وعبد الحميد مرزوق، وصدرت عن المركز القومي للترجمة، القاهرة، 2016، ونظنّ أن في هذه اليوميات فائدة كبيرة لفهم الكثير من أبعاد فكر جولدتسيهر ورؤيته للإسلام ودافع دراسته له ولمساحات الاشتغال التي اختارها في العمل عليه.
[12] يمكن ذكر باحثين آخرين في هذا المجال مثل اليسوعي البلجيكي البحّاثة: هنري لامنس (ت: 1937)، لكن الأثر الأوسع والأعمق هنا كان من نصيب أعمال جولدتسيهر وشاخت المتشكّكة تجاه الحديث النبوي.
[13] أعملت كرون المنهج المتشكّك تجاه نشأة الإسلام في كتاباتها اللاحقة أكثر مما فعله كوك. انظر على سبيل المثال كتابَيْها:
Slaves on Horses: The Evolution of the Islamic Polity (Cambridge and New York: Cambridge University Press, 1980)و Meccan Trade and the Rise of Islam (Princeton: Princeton University Press, 1987). كما يعدّ مقالها: “How did the quranic pagans make a living?” Bulletin of the School of Oriental and African Studies 68 (2005), 387–399 أحدث الأمثلة على توجهها الشكّي والهدمي تجاه السردية التقليدية عن نشأة الإسلام. وفيما يتعلق بكوك، فقد واصل إعمال منهجه الشكّي أيضًا تجاه التاريخ الإسلامي المبكر في: Early Muslim Dogma: a source-critical study (Cambridge and New York: Cambridge University Press, 1981).
[14] Fred McGraw Donner, The Early Islamic Conquests (Princeton: Princeton University Press, 1981).
[15] انظر كتابه: Narratives of Islamic Origins: The Beginnings of Islamic Historical Writing (Princeton: Princeton University Press, 1998).
[16] يمكن الوقوف على عرض علمي أوسع لبعض الأفكار الرئيسة في كتاب «محمد والمؤمنون» في بحث لدونر بعنوان: “From Believers to Muslims: Confessional Self-Identity in the Early Islamic Community,” Al-Abhath 50– 51 (2002– 2003), 9– 53
[17] يدخل عمل دونر هنا ضمن سياق أوسع لعمل بعض المؤرِّخين على إعادة النظر في المناهج الإسلامية في التدوين وفي المرويات الإسلامية وتقويم هذه المناهج والمرويات ومدى إمكان الاعتماد عليها في بناء صورة دقيقة لتاريخ الإسلام المبكر في مواجهة التشكيك التنقيحي الكلّي والمجاني، من هؤلاء غريغور شولر والذي يتحدّث كذلك عن أن معظم المرويات الإسلامية وفقًا له ضعيفة إلا أنها تحمل نواة أصيلة وصلبة وحقيقية يمكن الاعتماد عليها في بناء سردية دقيقة حول تاريخ الإسلام المبكّر، وقد طبق هذا في دراسته لمرويات جمع القرآن، ووصل من خلال هذا التطبيق لموثوقية روايات الجمع وموثوقية السردية الإسلامية حول تاريخ القرآن. راجع: تدوين القرآن، ملاحظات على أطروحتي بورتون ووانسبرو، غريغور شولر، ترجمة: محمد عبد الفتاح، موقع تفسير. (قسم الترجمات).
[18] تؤكّد السرديةَ الإسلاميةَ وتفاصيلَها كثيرٌ من الأدلة الإيبغرافية وكذلك من النصوص غير الإسلامية المعاصرة للدعوة، وقد اعتمد على هذه الأدلة بعض الباحثين ذوي المنزع التنقيحي مثل بريمار، حيث أشار في كتاب (تأسيس الإسلام) لكون بعض الكتابات البيزنطية قد أشارت للعرب باعتبارهم عرب محمت، أي: عرب محمد، وأن هذه الكتابات كانت واعية ومدركة لكون محمد هو نبي العرب أو السارسين. انظر: «تأسيس الإسلام بين الكتابة والتاريخ» ألفريد لويس دي بريمار، ترجمة: عيسى محاسبي، دار الساقي، بيروت، ط1، 2009م، ص161، 163. (قسم الترجمات).
[19] حظيتْ نقوش قبة الصخرة باهتمامٍ كبيرٍ من الدارسين الغربيين باعتبارها دليلًا إيبغرافيًّا مبكرًا حول تطور الإمبراطورية الإسلامية وحول وضع القرآن داخلها، مما جعلها عرضة لكثير من التحليلات، وصحيح أن هناك تحليلات نزعت -كتحليلات كروب- لاعتبار النقوش دليلًا على التدوين المتأخر للقرآن، إلا أن ثمة آراء أخرى حول نفس النقوش لا تتفق مع فرضيات كروب، فمثلًا يرى بريمار أن هذه الأدلة تشير إلى أن ملوك بني أمية الأوائل كانوا يحاولون خَلْق مركز ديني مواجه لمكة، في المقابل قامت ويلان بدراسة موسّعة للنقوش على القبة وكذلك لتقليد رسم النقوش في هذه الفترة واستطاعت أن تتوصّل لكون النقوش دليلًا على ترسخ سلطة النصّ بالفعل، وكذلك على وجود تقليد سابق يعود إلى منتصف القرن السابع يتعلّق بكتابة ونسخ وزخرفة المصحف. انظر: الشاهد المغفول عنه، دليل على التدوين المبكّر للقرآن، إستل ويلان، ترجمة: محمد عبد الفتاح، موقع تفسير. (قسم الترجمات).
[20] وَفق الدراسات الاستشراقية الغربية عن الشعائر الإسلامية مثل دراسات ميتفوخ وكارل هاينريش بيكر، فإنّ شعيرة صلاة الجمعة بدأت بالفعل في العصر النبوي ولم تتأخر إلى عهد الأمويين، والخلاف الذي أثاره بعض الدارِسين فيما يتعلّق بدور الأمويين في الجمعة يتعلّق بمسألة المنبر بالأساس وإلقاء الخطبة وقوفًا أو جلوسًا وليس بالصلاة ذاتها، حيث يفترض بيكر كون الجمعة لم تكن تتم باستخدام منبر بالمعنى الحديث ولم يكن يقف عليه النبيّ بل باستخدام كرسي للجلوس وعصا، ويدرس هذا في ضوء تقاليد الحكم والقضاء في الجزيرة، ويرى أن الجلوس على المنبر والذي قام به بنو أمية لتأكيد سلطتهم السياسية والروحية، أثار خلافًا بين المتدينين الذين رأوا في ذلك اقتناصًا لسلطة النبي، والذين فضلوا الوقوف في إلقاء الخطبة، الغرض من استحضار هذا الخلاف بأكمله هنا -وبعيدًا عن مدى دقة افتراضات بيكر- الإشارة لكون الدراسات الغربية تميل في معظمها لقدم شعيرة الجمعة وليس كما يقترح الكاتب. (قسم الترجمات).
[21] Albert Schweitzer, The Quest of the Historical Jesus: A Critical Study of its Progress from Reimarus to Wrede, trans. W. Montgomery (London: A. & C. Black, 1910), 4.
[22] في بعض الأحيان، لا تختلف التكهنات التاريخية غير الموثقة عن الخيال والوهم التاريخي، وهو ما نراه مثلًا في قول دونر: «يجب أن يكون علي بن أبي طالب -الذي ربما كان له تأثير أكبر من أيّ شخص على سكان المدينة المنورة- قد قُتل لأنه كان يرى نفسه أحق بمنصب الخلافة الذي تقلّده عثمان» (ص157).
[23] إنّ تغيّر المسميات التي كان يطلقها مَن هم خارج الحركة عليها لا يرتبط بالضرورة بتحوّلٍ في تعريف الحركة لنفسها.
[24] من ذلك مثلًا: «ربما تمثّلت إحدى الصعوبات التي واجهها محمد مع اليهود -الذين كانوا مسيطرين على أحد الأسواق الرئيسة في المدينة المنورة- من رغبته في فتح سوق جديد في المدينة لمساعدة المهاجرين الجدد» (ص45)؛ «لفترة وجيزة، ربما أطلق محمد على حركته اسم (الحنيفية)، وذلك على الأرجح إشارة إلى نوع التوحيد الغامض الذي ساد قبل الإسلام، ولكن يبدو أن هذا الاستخدام لم ينتشر على نطاق واسع» (ص58)؛ «ربما رفض بعض اليهود فكرة أنّ محمدًا -الذي عرفوه ويمكنهم رؤيته وسماعه- سيكون في نفس مستوى آبائهم القدامى» (ص77) [المقصود الأنبياء الآباء في اليهودية: إبراهيم، وإسحاق، ويعقوب]؛ «في الواقع، من المحتمل أن الهجرة بهذا المعنى الأوسع كانت بمنزلة العلامة الأبرز المعبّرة عن الانتماء الكامل لجماعة المؤمنين، مثلها مثل المعمودية بالنسبة للمسيحيين» (ص86)؛ ربما شعر بعض المؤمنين بالحاجة الملحّة لمحاولة تأمين السيطرة على مدينة القدس... ومن المحتمل أن المؤمنين قد شعروا بذلك لأنهم كانوا في طور بناء (جماعة المخلّصين) الصالحين، ومن ثم عليهم أن يثبّتوا وجودهم في القدس في أسرع وقت ممكن» (ص97)؛ «لقد أخذنا في الاعتبار أيضًا طبيعة التوسّع؛ وذلك لأن تركيز المصادر على البُعد العسكري للتوسّع قد حجب طبيعته كحركة إصلاح توحيدية ربما لم تجد العديد من المجتمعات المحلية سببًا لمعارضتها، لأنها لم تكن مكروهة منهم من الناحية العقائدية» (ص142)؛ «ربما كانت هذه القناعات الأخروية هي القوة التي دفعت بعض المؤمنين إلى ترك شؤونهم اليومية المعتادة والانخراط في الحملات البعيدة والشاقة لنشر أوامر كلمة الله، وهي ما يطلق عليه عادةً "الغزوات/ الفتوحات الإسلامية"» (ص197)؛ «من المحتمل أنه أراد أن يذكّر نفسه بأن الحَكَم العَدْل الذي لا معقّب لحكمه، مالك يوم الدين، ذلك اليوم الذي سيرث فيه الله الأرض ومن عليها... قد تكون رغبته في رفع هذا السيناريو إلى مرتبة عالية هي التي دفعته إلى الأمر ببناء أحد أروع الأعمال المعمارية الإسلامية المبكّرة، ذلك المبنى الفخم في القدس الذي يُطلق عليه عادةً (قبة الصخرة)... ولذلك يبدو من المعقول أن نفترض أن قبة الصخرة والمباني المصاحبة لها ربما تكون قد شُيّدت لتهيئة مسرح رائع لأحداث القيامة» (ص199).
[25] انظر:Andrew Palmer, et al., The Seventh Century in the West-Syrian Chronicles (Liverpool Liverpool University Press, 1993), 32. يقدّم دونر إشارة يُحتمل أنها تحيل إلى هذه الفقرة (213) لكنه لا يسهب في الحديث عنها، وذلك على الأرجح بسبب أنها تطرح صعوبات عديدة أمام محاولته إعادة بناء تاريخ حركة المؤمنين.
[26] انظر مقالها: “How did the quranic pagans make a living,” Bulletin of the School of Oriental and African Studies 68.3 (2005), 387–389.. ، ينصبّ تركيز كرون في هذا المقال فقط على مسألة: كيف كان يكسب خصومُ محمد الوثنيون عيشهم؛ ولقد دفعتها الإجابة الظاهرة التي تحيل إلى زراعة الزيتون مع عدم إمكان زراعته في غرب الجزيرة العربية إلى القول بأن أجزاء من القرآن يجب أن يكون لها أصول خارج غرب شبه الجزيرة العربية.
[27] انظر تعليقاته على فرضية «الأصول المتأخرة» للقرآن، ص54- 56.
[28] مثلًا: تحظر الآية 43 من سورة النساء على المسلمين الصلاة وهم سكارى، بينما الآية 219 من سورة البقرة: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ﴾ تظهر موقفًا مختلطًا تجاه الخمر؛ حيث تثبت منافعه، مع كونه محرمًا لأن إثمه أكبر مِن نفعِه، أمّا آية المائدة فتسمي الخمر بأنه ﴿رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ﴾ وتأمر بتجنّبه، في نفس الوقت، تذكر الآية 15 من سورة محمد أنّ في الجنة أنهارًا من خمرٍ ﴿لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ﴾.
[29] انظر: جلال الدين السيوطي، الإتقان في علوم القرآن، مجلد 2، (دمشق/ بيروت: دار الكتب العلمية، 1420/ 2000)، ص700 (نقل هذا القول عن أئمة قالوا به ولم يسمِّهم).
[30] انظر الأدلة التي جمعها جولدتسيهر على وجود جهل واسع النطاق بالمحتوى الفعلي للإسلام بين العديد من المسلمين الأوائل في: Muslim Studies (Muhammedanische Studien), vol. 2, trans. C.R. Barber and S.M. Stern (London: George Allen and Unwin, 1971), 39– 40.، ويمكن بسهولة إيراد أضعاف مثل هذه الأدلة.
[31] يشير دونر إلى «قلة الآيات القرآنية التي تهاجم عقيدة الثالوث صراحة» (ص77).
[32] لاحظ هنا قوله: «يجب أن يكون» مع أنه لا يوجد دليل على هذا الادعاء.
[33] ربما تعكس الإشارات إلى مسخ اليهود إلى خنازير (مثل التي تظهر في الآيات: 65 من سورة البقرة، و60 من سورة المائدة، و166 من سورة الأعراف) وجهات نظر جناح آخر من حركة المؤمنين كان غير متقبّل لإدماج اليهود في الجماعة؟
[34] انظر مدخل مونتغمري وات في الطبعة الثانية من دائرة المعارف الإسلامية تحت عنوان: «هجرةHidjra»، حيث قدّر عدد المهاجرين بسبعين بعد إخراج محمد وأبي بكر وعليّ وزوجاتهم. وللاطلاع على حجم جيش محمد، انظر:
A. Guillaume, trans., The Life of Muhammad: A Translation of Isḥāq’s Sīrat Rasūl Allāh (Oxford: Oxford University Press, 1955), 545.
[35] للاطلاع على حادثة الغرانيق واعتبار محمد متبعًا للهينوثية [أي عبادة إله واحد أساسي، دون إنكار وجود أو احتمالية وجود آلهة أخرى أدنى منه] انظر:Maxime Rodinson, Mohammed, trans. Anne Carter (New York Pantheon, 1971), 96– 97, 106– 107.. انظر أيضًا مناقشة مونتغمري وات لهذه الحادثة وما إذا كانت تعكس أن محمدًا انتمى لفصيلة من المشركين في:Muhammad: Prophet and Statesmen (London: Clarendon, 1961), 60– 65.، وحول حادثة الغرانيق بشكلٍ عام انظر:
Mohammed Shahab Ahmed, The Satanic Verses Incident in the Memory of the Early Muslim Community. An Analysis of the early Riwāyahs and their Isnāds, (PhD diss., Princeton University, 1997).
[36] يشير الكاتب هنا إلى ما يُعرف في الدراسات الكتابية بمعيار الحرج، والمقصود بمعيار الحرج هو اعتبار القصص المنقول عن التاريخ المبكّر لديانةٍ ما موثوقًا تاريخيًّا إذا مثّل إحراجًا للسردية الشاملة عن المؤسّس ومع ذلك لم يتم حذفه أو معارضته أثناء بناء هذه السردية، والمثال على هذا في المسيحية هو حدث صلب المسيح، حيث يرى الدارسون أنّ الصلب يمثل إشكالًا محرجًا للسردية المسيحية حيث إنها تشوش على كون المصلوب هو المسيح، فوفقًا للكتاب المقدّس «المعلَّق ملعونٌ من الله»، إلا أن بقاء القصة ومنذ مصادر الأناجيل المبكِّرة (المصدر Q) وإلى الأناجيل الأربعة المعتمدة يدل وفق هؤلاء الباحثين على موثوقية القصة بالفعل، ويعتبر الكاتب أنّ ذكر الغرانيق في المصادر الإسلامية وحده دليل على صحتها وفق هذا المعيار، وهذا يتجاهل بطبيعة الحال المعايير الخاصّة التي تم وضعها للتأكد من المرويات في السياق الإسلامي، فضلًا عن كون معيار الحرج ذاته قد تعرّض لنقد الكثير من الدارِسين الكتابيين لسيرة المسيح.
وصحة قصة الغرانيق أمر تبنّاه بعض المستشرقين مثل تور أندريه وبلاشير، وهو ما رأى فيه بعض المعاصرين بُعدًا واضحًا عن المنهج النقدي وكذلك عن المنطق التاريخي، ويرى جعيط أن ضعف المناهج التاريخية عند معظم كاتبي تاريخ الدعوة من الغربيين سببٌ رئيس في قبول مثل هذا القصص الذي يخالف منطق التاريخ، وينتقد جعيط القصة على أساس إعادة قراءة كلّ الأحداث المحيطة بالقصة ليثبت عدم الاتساق بينها، فهذه القصة تذكر عند من يقبلها من المستشرقين في إطار الحديث عن تسوية ارتآها النبي مع أشراف مكة لتخفيف التضييق المضروب على أصحابه، يعيد جعيط بناء الأحداث فيقول إنه لا يوجد دليل تاريخي بالأصل على أن أصحاب النبي قد ضُيِّق عليهم أو استُمِيلوا أو هُدِّدُوا بالتهجير قبل «النجم»، وأن المنطقي والأقرب للواقع هو أن التضييق بدأ بعد «النجم» لا قبلها، هذا لأنه ورغم وضوح المحتوى التوحيدي في القرآن من أول لحظة وفقًا للتورخة الاستشراقية نفسها للقرآن، إلا أن النجم هي أول سورة يظهر فيها ما يمكن أن نسميه تبعًا لإسمان بسمة التوحيدية كدين- مضادّ، أي أن سورة النجم هي أول سورة يظهر فيها التسخيف من آلهة قريش بكل وضوح ﴿إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا﴾؛ لذا فالطبيعي أن التعذيب بدأ بعدها لا قبلها، وفقًا لهذا يعيد جعيط تفسير ما حدث بأنه بالفعل كان ثمة مساومة قبل نزول النجم، لكن الأقرب لمنطق الأحداث أن مَن عرضها هم قريش لا النبي، فقريش هي التي عرضت عبادة إله محمد بشرط أن تُعبد معه آلهتهم؛ هذا لأن الديانة الوثنية القرشية ليست دينًا مضادًّا، فقبول إله وافد لا يمثّل إشكالًا لبنيتها انطلاقًا مما يسميه إسمان «إمكانية الترجمة»، فجاءت الآيات القرآنية تعلن رفضها التام لهذا الإشراك الذي يخالف طبيعة الإسلام كدين توحيدي شديد الصرامة في التنزيه، هذا وفقًا لجعيط ترتيب أكثر منطقية للأحداث. انظر: التمييز الموسوي أو ثمن التوحيدية، يان إسمان، ص27، 28. وانظر: في السيرة النبوية -2- (تاريخية الدعوة المحمدية في مكة)، هشام جعيط، دار الطليعة، بيروت، ط1، 2007، ص280، وربما من المفيد الاطلاع على الفصل كاملًا والمعنون بـ«قصة الغرانيق وضبط مسار الأحداث». (قسم الترجمات).
[37] Nathan MacDonald, “The Origin of ‘Monotheism,’” Early Jewish and Christian Monotheism, eds. Loren T. Stuckenbruck and Wendy E.S. North (London/New York: T&T Clark International, 2004), 204–205.
[38] والدليل على ذلك أن تلك الكلمة مثلًا لا تظهر إلا مرة واحدة في القاموس السرياني المختصر Compendious Syriac Dictionary لـ"جيسي باين سميث"Jessie Payne Smith (Oxford: Oxford University Press, 1903) وفيه لم تظهر باعتبارها مفهومًا له تعريف، بل ظهرت في ترجمةٍ لجملة:(men ḥad Alāhā masṭe’ lan) والتي معناها: «يُخرِجنا من التوحيد»"(monotheism)" (372, s.v., sṭā). ولكن الترجمة الحرفية الأدق والأصوب لـ (ḥad Alāhā هي: «إله واحد». أمّا (monotheism) فليست موجودة في الملحق اللاتيني في Lexicon Syriacum, 2nd ed. (Halle: Niemeyer, 1928) لكارل بروكلمان.
[39] H. G. Liddell, R. Scott, and H. S. Jones, Greek-English Lexicon with a Revised Supplement, 9th ed. (Oxford: Oxford University Press, 1996).
[40] G. W. H. Lampe, A Patristic Greek Lexicon (Oxford: Oxford University Press, 1961), 882, s.v. μονοθεϊα
[41] Anton Blok, “The Narcissism of Minor Differences,” 115–135 in idem., Honour and Violence (Cambridge: Polity, 2001).
[42] يجدر هنا توضيح ما يعنيه المؤلِّف بهذا التفريق بين المعتقد الإسلامي والمسيحي في التوحيد. عند النظر في قانون الإيمان المسيحي سنجد نصّه كما يأتي:
(نؤمِن بإلهٍ واحِد، آب ضابط الكل... وبربّ واحد يسوع المسيح، ابن الله الوحيد، إله حقّ من إله حقّ، مولود غير مخلوق، مساوٍ للآب في الجوهر... ونؤمن بالروح القدس، الرب المحيي، المنبثق من الآب والابن، الذي هو مع الآب والابن، يُسجد له ويُمجّد) [اقتصرتُ على مواضع الشاهد فقط].
فالتوحيد المسيحي يُقصد به الإيمان بـ«جوهر» إلهي واحد؛ هذا الجوهر الواحد مصدره الآب ضابط الكلّ، وبما أنّ الابن مولودٌ منه فهو من نفس جنسه؛ ولذلك صرّحوا بأنه «مساوٍ للآب في الجوهر»، ونفس الشيء بالنسبة للروح القدس المنبثق من نفس جنس الآب؛ فهم ثلاثة في العدد، واحد في الجوهر الإلهي. هذا النوع من التوحيد هو ما يُعبّر عنه بـ monotheism أي: الإيمان بجوهر إلهي واحد، وهو ليس مناقضًا لعقيدة الثالوث.
أمّا التوحيد الإسلامي، فليس فيه أيّ تعدد، لا على مستوى الجوهر الإلهي ولا على مستوى الأقنوم؛ بمعنى أنه إلهٌ واحد وجوهر إلهي واحد، وكلّ ما سواه فهو مخلوق حادث مفتقرٌ إليه. هذا النوع من التوحيد يمكن أن يُعبّر عنه -تجوزًا- بـ unitarianism؛ لأنّ معنى هذه الكلمة في الأساس معدودٌ ضمن الهرطقات المسيحية التي تؤمن بأن يسوع المسيح ليس مساويًا للآب في الجوهر، فهي مناقضة للثالوث من جهة أنها لا تعترف بالمساواة الكاملة بين الآب والابن والروح القدس في الجوهر الإلهي؛ ولذا ذهب الكاتب إلى أفضلية هذا المصطلح لبيان مناقضة التوحيد الإسلامي للثالوث. على العكس من monotheism التي لا تعكس هذا التناقض، بل تقتصر على ما يمكن بوجهٍ ما عده مشتركًا بين الديانات التوحيدية وتنفرد به عن غيرها من الديانات التي تؤمن بتعدد الجوهر الإلهي نفسه. (المترجم).
[43] انظر مدخل دانيل جيماريه في الطبعة الثانية من دائرة المعارف الإسلامية تحت عنوان: «توحيد Tawḥīd»؛ ومن المحتمل أنه كان يستحضر أيضًا مفهوم الحنيفية. ولكن على الرغم من دراية دونر بهذا المفهوم (ص71) وتعريفه له، يظلّ معناه غامضًا. (انظر مدخل مونتغمري وات في الطبعة الثانية من دائرة المعارف الإسلامية تحت عنوان: «حنيف Ḥanīf»).
[44] كان بإمكانه محاولة البحث عن المسيحيين اليهود في القرن السابع، كما فعل شلومو بيِنز مثلًا في: “Notes on Islam and on Arabic Christianity and Judaeo-Christianity,” Jerusalem Studies in Arabic and Islam 4 (1984), 135– 152.، وعلى الرغم من إشارة دونر إلى «المسيحيين غير الثالوثيين» (ص70) إلا أنه لم يتوسع في تلك النقطة ولم يناقش تبعاتها.
[45] Sebastian P. Brock, “The ‘Nestorian’ Church: A lamentable misnomer,” Bulletin of the John Rylands Library 78 (1996 [1997]), 53–66.
[46] ربما يكون الجدل حول التقديسات الثلاثة أو التريصاجيون (Trisagion) استثناءً من هذا التصريح، وهذا الجدل هو مثالٌ تداخلت فيه الخلافات حول الثالوث مع الخلافات المتعلقة بطبيعة المسيح. بيدَ أنني أرى أنه من المضلل أيضًا -رغم شيوع ذلك- اعتبار أنّ كريستولوجيا النساطرة أو المونوفيزيين قد جعلت جماهير المسيحيين في الشرق الأوسط من بعض النواحي أكثر تقبّلًا لعقيدة القرآن التي تنزع عن المسيح أيّ صفة ألوهية. ولكن لا يوجد بين مَن أعرفهم من الباحثين -وبالتأكيد بين مَن أعرفهم من اللاهوتيين- من قدّم مثل هذه الحجة حول تثليث النساطرة أو المونوفيزيين.
[47] وردت كلمات «الإثم» و«الخطيئة» ومشتقاتهما في القرآن كلّه أقلّ من 50 مرة، وأمّا الكلمات والأفعال المتعلقة بمفهوم التنزه عن الآثام فقد ظهرت عشر مرات فقط في القرآن.
[48] للوقوف على من ذهب إلى أنها 350، انظر: Mohammad Hashim Kamali, Principles of Islamic Jurisprudence, 3rd ed. (Cambridge: Islamic Texts Society, 2003), 26.، وفيما يتعلق بالقول إنها 600 انظر: N. J. Coulson, A History of Islamic Law (Edinburgh: Edinburgh University Press, 1964), 12.، وللاطلاع على القول بأنّ المحتوى التشريعي في القرآن يساوي نظيره في أسفار موسى الخمسة انظر: S. D. Goitein, “The Birth Hour of Muslim Law? An Essay in Exegesis,” The Muslim World 50 (1960), 24.، ومع ذلك، يجب الإشارة إلى أنه من الناحية المطلقة (وليس المقارنة)، فإنّ المحتوى التشريعي للقرآن أقلّ بكثير من الشريعة الموسوية نظرًا لأنه أصغر من التوراة.
[49] Coulson, History of Islamic Law 12.
[50] Coulson, 13.
[51] الأسينيون هم طائفة دينية يهودية عاشت قبل قرن من المسيحية وفي بداية المسيحية، ويظن أنهم كاتبو ما بات يعرف بمخطوطات قمران، إلا أنّ ثمة خلافات بين الباحثين في فهم حدود هذه الطائفة الدينية وعلاقتهم بالمخطوطات، حيث تتعارض بعض النتائج الواردة عن تحليل مخطوطات قمران مع الملامح التي حدّدها المؤرخون الرومان مثل يوسفيوس وبليني وفيلون لهذه الجماعة الدينية، خصوصًا مسألة الموقف من الحرب ومن النساء، قد أدى هذا لتشعّبٍ في الآراء حول العلاقة بين المخطوطات والأسينيين وحول حدود هذه الطائفة، فقد مال بعضهم إلى اعتبار أنّ جماعة الأسينيين هي فضاء ديني أوسع من تحديدات المؤرّخين القدامى، حيث تمثّل جماعة أكثر انتشارًا واتساعًا، وبالتالي رأَى ألرجو أن مخطوطات قمران تخصّ أحد أفرع هذه الحركة الواسعة فحَسْب، في حين رأَى بعضهم الآخر مثل وايزنمان ومايكل وايز أن هذه اللفائف ربما لا تخصّ الأسينيين من الأساس، ورأَى ويلسون أنها ربما تخصّ المسيحية المبكّرة. كذلك فثمة خلافات في تفسير المقصود بـ«الأسينيين» وفي فهم مجموعة المصطلحات القريبة منها مثل النصارى (المحافظون على العهد) وكذلك تحديد كون الكلمة آرامية أو يونانية أو عبرية، حيث يغير هذا معناها مما قد يربطها ببعض الجماعات الأخرى مثل «المعالجين» -وهي طائفة يهودية أخرى في نظر بعضهم، أو ربما أحد أفرع الأسينيين في نظر آخرين-، ويرتبط كلّ هذا الخلاف بالخلاف في تحديد طبيعة المجتمعات الدينية لهذه الفترة والعلاقة بين هذه الجماعات ومعنى انتماء الفرد إلى إحداها، وهذا يعقّد فهم ملامح هذه الجماعة وعلاقاتها بالمخطوطات. للتوسع انظر: الطوائف اليهودية في زمن كتابة العهد الجديد، راندال إيه. وايس، ترجمة: د. عادل زكري، مدرسة الإسكندرية، ط3، القاهرة، 2019، ص200- 206. وانظر: أهل الكهف، مخطوطات البحر الميت، هالة العوري، رؤية، ط1، القاهرة، 2021، ص33- 41، 55- 61، 70، 71، 74، 75. وانظر: مقدمة كتاب، التوراة، كتابات ما بين العهدين، مخطوطات قمران- البحر الميت، 1، الكتب الأسينية، حُقق بإشراف: أندريه دوبون- سومر ومارك فيلوننكو، ترجمة: موسى ديب الخوري، دار الطليعة الجديدة، ط1، سوريا، 1998. (قسم الترجمات).
[52] Kamali, Principles of Islamic Jurisprudence 26.
[53] Wael B. Hallaq, The Origins and Evolution of Islamic Law (Cambridge: Cambridge University Press, 2005), 40.
[54] See, e.g., 85, 88.
الكاتب:
مواضيع ذات صلة
((المعلومات والآراء المقدَّمة هي للكتّاب، ولا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع أو أسرة مركز تفسير))