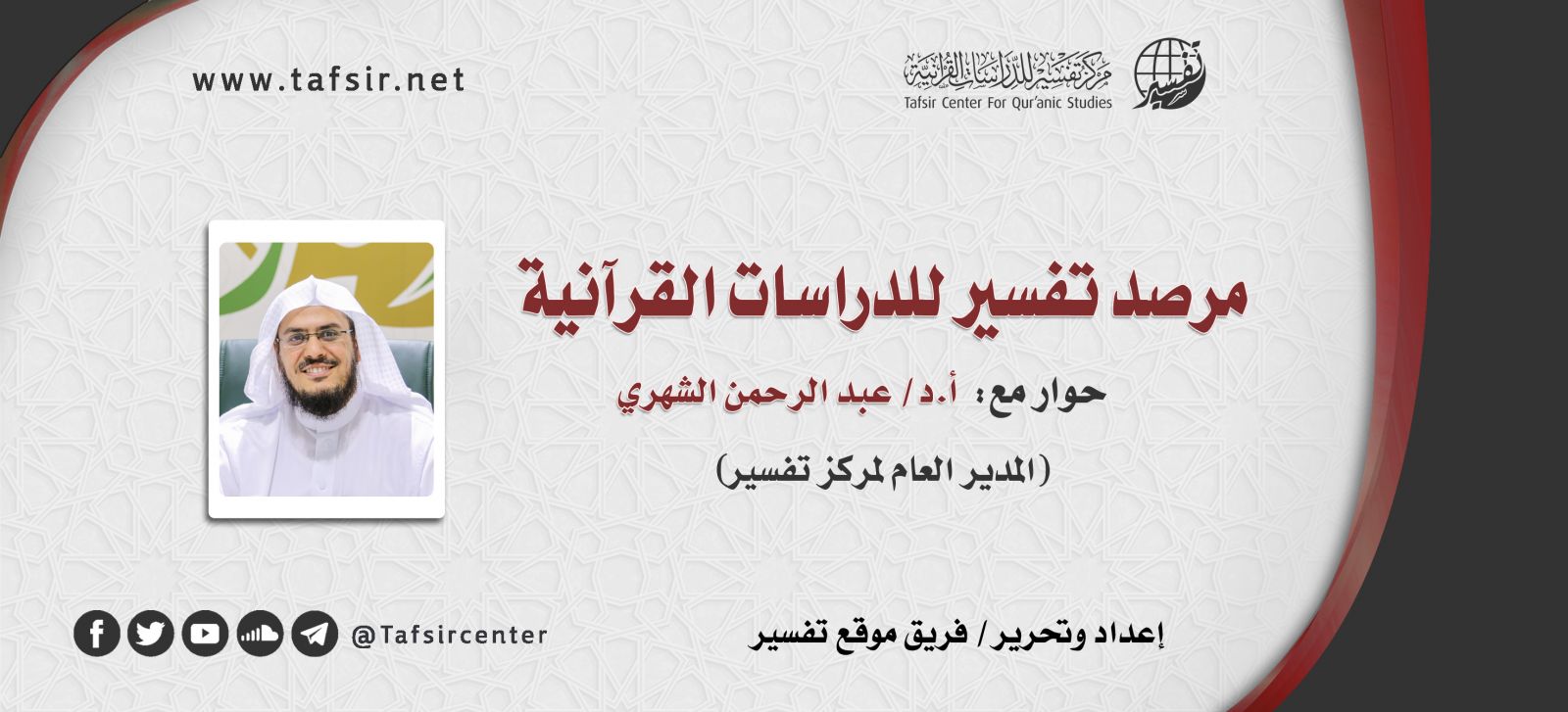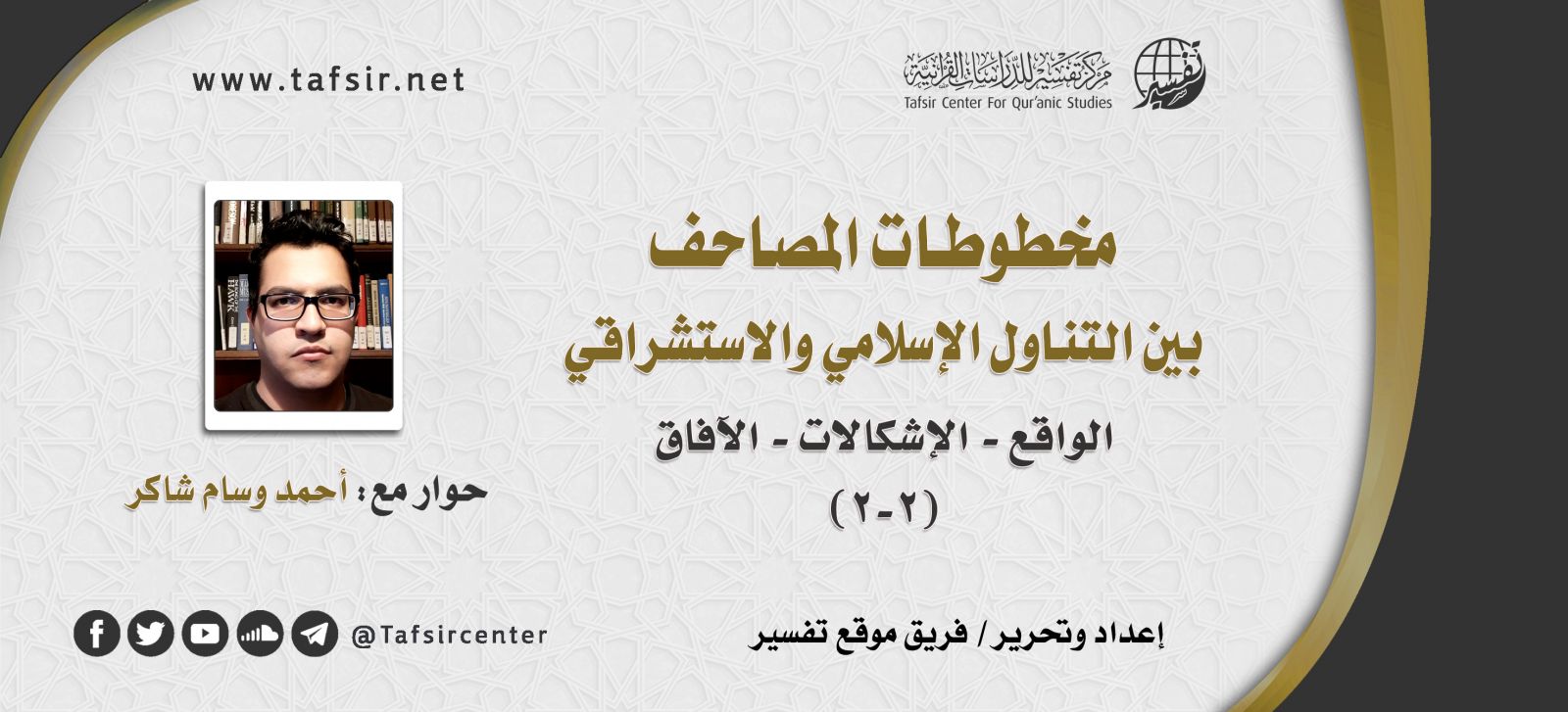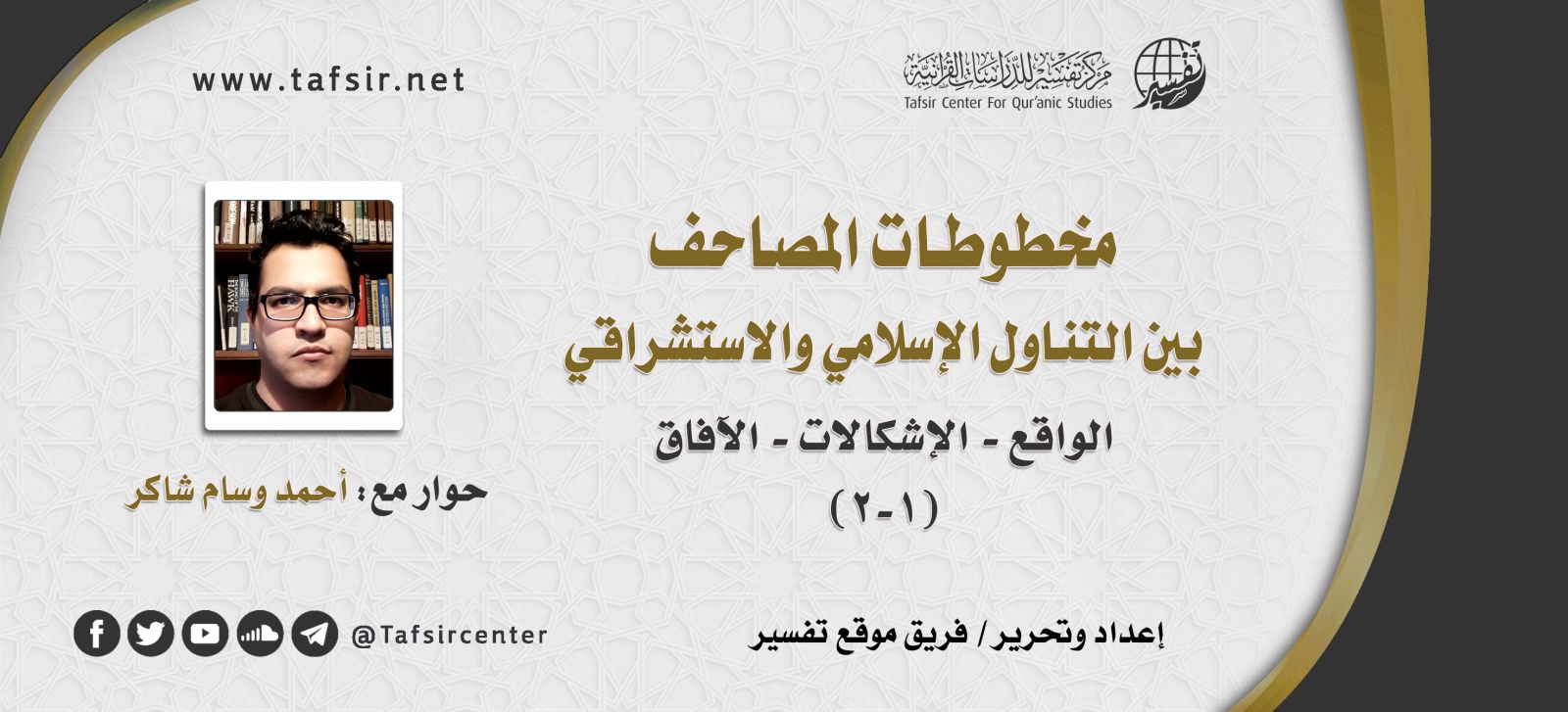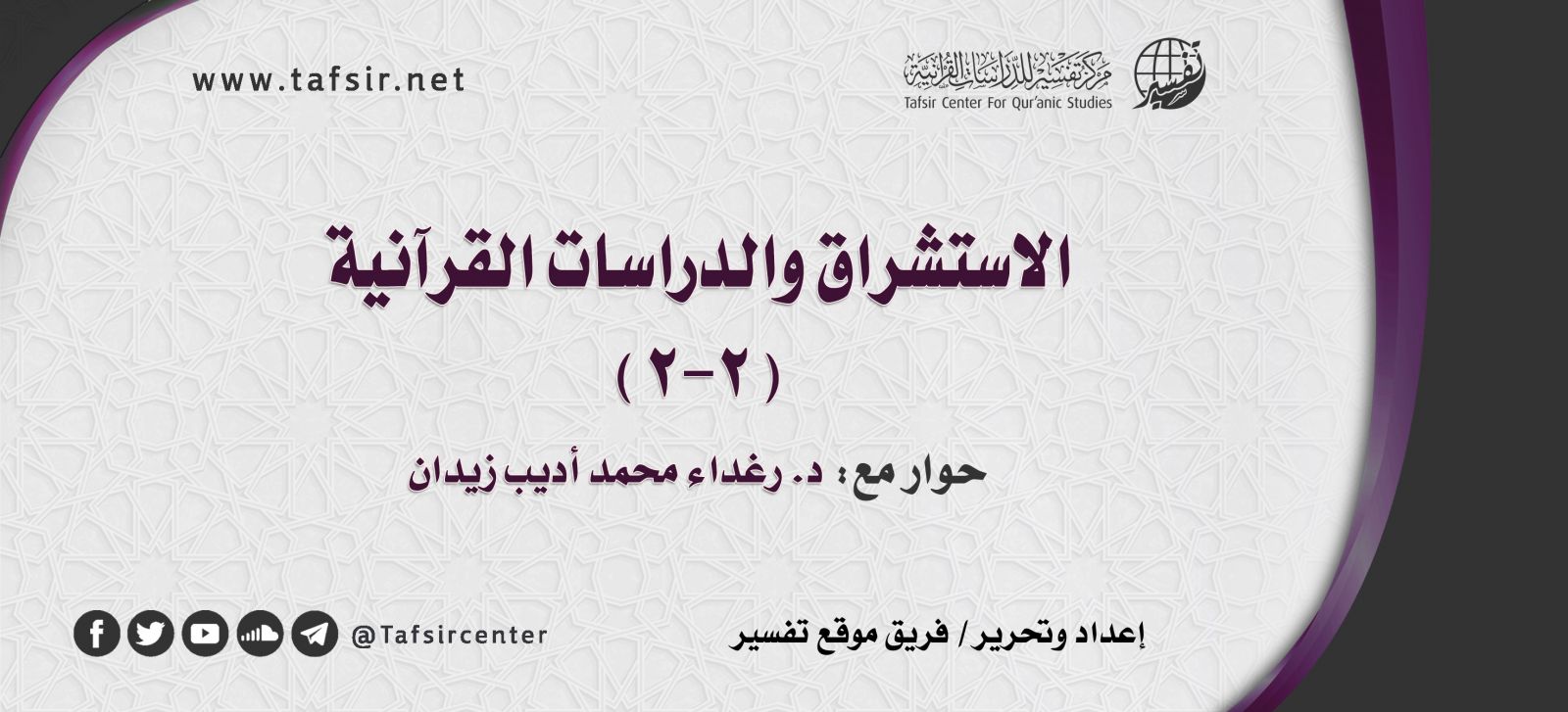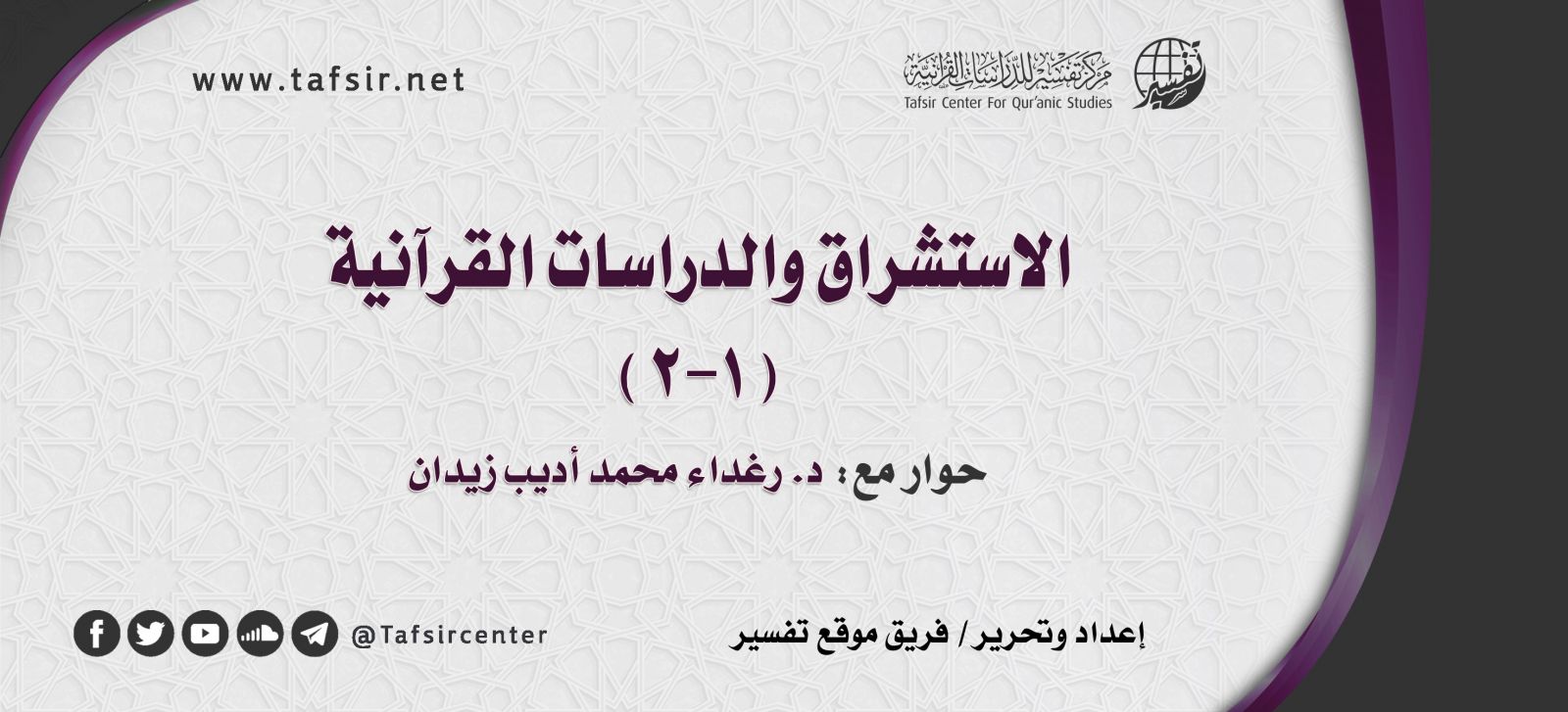مقتضيات النظر التفسيري لآيات القرآن الحكيم في السياق الإسلامي المعاصر
مقتضيات النظر التفسيري لآيات القرآن الحكيم في السياق الإسلامي المعاصر
إعداد: محمد كنفودي

مقدمة:
يقع موضوع تفسير النصّ القرآني وكيفية استكشاف دلالاته، وبحث أُطر ومناهج ضبط هذه العملية =ضمن الهموم العلميّة والفكرية للدرس الإسلامي المعاصر؛ إِذْ لا يمكن تصوُّر وجود نسق معرفي إسلامي معاصر لا يستند بدءًا إلى القرآن وينطلق منه ويتحرك في أُفق دلالاته ومقاصده وغاياته؛ لذا يظلّ تناولُ التفسير سواء التراثي منه أو المعاصر وكذلك القضايا المثارة في العصر الحديث حوله أو حول استنباط الدلالات من القرآن أمرًا غايةً في الأهمية.
في هذا الحوار توجَّهْنَا بمجموعة أسئلة حول هذه القضية إلى الدكتور: مراد المرابط، صاحب الاشتغال بمدونة التفسير حول هذه القضايا الملحَّة.
وقد أتى حوارنا معه على ثلاثة محاور؛ المحور الأول: التفسير في التراث الإسلامي؛ نشأته وأهم أعلامه وأبرز منهجياتهم، حيث تناول نشأة التفسير بعد زمن الصحابة، وأهمّ المفسرين في تاريخ التفسير وتنوع منطلقاتهم ومناهجهم، ومدى إمكان الاستفادة من منهجهم في بناء نسق معرفي حضاري معاصر. والمحور الثاني: الدعوات لإعادة النظر في التراث التفسيري وفي مناهج قراءة القرآن، حيث تناول هذه الدعوات وأسباب ظهورها ومدى مقدار الجِدَة فيها. والمحور الثالث: ابن عاشور والتفسير المقاصدي للقرآن، حيث دار الحديث فيه حول التفسير المقاصدي ومنهجية ابن عاشور في تفسيره كأحد روّاده، وكذا أدوات التفسير المقاصدي ودوره في بلورة رؤية كلية للنصّ في إطار بناء نسق معرفي معاصر، كما اختتم الحوار باقتراح لضبط السيولة المعاصرة في عملية الاجتهاد وخصوصًا في تفسير النصّ.
نص الحوار
المحور الأول: التفسير في التراث الإسلامي؛ نشأته وأهمّ أعلامه ومنهجيّاتهم:
س1. (التفسير) باعتباره نظرًا في آيات النصّ القرآني، ربما يكون تَبَلْوَر أكثر مع نشوء المذاهب والمدارس الإسلامية الأولى في تاريخ الفكر الإسلامي. كيف تنظرون لمرحلة نشوئه وزمن انبثاقه الأول في تاريخ التفاعل مع القرآن الكريم؟
د/ مراد المرابط:
شاء الله -جل جلاله- أن يكون هذا القرآن كتابًا معجِزًا في مبتدئه ووسطه وختامه نصًّا وزمانًا ومكانًا، فاختار الحقُّ سبحانه أن لا يترك المعصومُ -صلى الله عليه وسلم، الذي هو المرسَل وصاحب الرسالة- تفسيرًا منقولًا عنه من مفتتح الكتاب إلى خاتمته، وهذا في حدّ ذاته يندرج في سياق الإعجاز الكامل لهذا الكتاب؛ لأنه لو ترَك تفسيرًا كاملًا مجموعًا لكان حدًّا لهذا الكتاب، ولكان أُفُقُه القرآني ومستقبله الإعجازي مضمحلًّا أو ناقصًا، وهذا من الحكمة الخفية في أنّ جزءًا يسيرًا من السُّنة هو الذي اهتم بتفسير آيات الكتاب، رغم أن كثيرًا من الأحكام المسجلة فيه بيّنَتْها السُّنة، لكن المعلوم في حقل الدراسات القرآنية أن آيات الأحكام لا تتجاوز من الكتاب ما نِسبته خمسة إلى عشرة بالمائة في أحسن الأحوال.
يتأسّس على ذلك أن النبي -صلى الله عليه وسلم- ترك وراءه جيلًا من الصحابة الرواحل الذين حملوا القرآن وحملوا معه علومه وتاريخه والتحوّلات التي طرأَت على الخلفاء حتى انشرحَت صدورهم لجمعِه الجمع الأخير على عهد سيدنا عثمان بن عفان -رضي الله عنه-، فكانت مدارس قائمة الأركان في التفسير لدى الصحابة؛ كمدرسة عبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عباس، ومدرسة أبيّ بن كعب وغيرهم كثير.
هذه المدارس انتشرت في الحجاز والكوفة والبصرة ومصر، ونَشرَت معها الموروث التفسيري الذي وَرِثته عن جناب المصطفى -صلى الله عليه وسلم- أو الذي اجتهدت فيه بما أوتيت من فتح ربّاني، ومن أدوات علمية ومنهجية لتثوير القرآن واستكناه درره ولآلئه.
ومع دخول عصر التدوين في القرن الثاني للهجرة ونشأة المذاهب الفقهية انصبّ اهتمام العلماء -باعتبارهم أصحاب الريادة والقيادة- نحو قضايا الفقه العملي، لكن ذلك لم يغيِّب الدرس التفسيري باعتباره آلة في الفهم عن الله واستنباط الأحكام التكليفية. فالفقه اشتغالٌ بالقرآن الكريم إلى جانب المصادر الأخرى، والتفسير هو في الأصالة اشتغال بالقرآن الكريم كذلك.
ومع ذلك حافَظ التفسيرُ على استقلاليته العلميّة فبدأت فيه التآليف والمدوّنات؛ من الفرّاء (ت: 207هـ) إلى أبي عبيدة (ت: 210هـ)، إلى غيرهما من الأوائل الذين وُجدت لهم تآليف في هذا العلم الذي شوّشَت عليه مجموعة من المنغِّصات، منها:
- أنه علمٌ لا سَنَد له، ومن ذلك ما نُقل عن الإمام أحمد أنه قال: «ثلاثة علوم لا أصل لها: التفسير، والمغازي، والسِّيَر».
- اختلاطه بالروايات الإسرائيلية؛ مما أَدخل فيه كثيرًا من الزيادات التي لا أصل لها أو الموضوعة أصالةً.
- انصراف عموم العلماء إلى الاهتمام برواية الحديث ودرايته، مع قِلّة اهتمامٍ بدراية القرآن الكريم مما سيُسمَّى بعد ذلك بعلم التدبر القرآني.
- غلَبة الاهتمام بالقرآن الكريم في جانب حفظه وتجويده وقراءاته، بينما لم تستمر مدارس فكرية مهمومة بالتدبر القرآني والتفسير البياني واللغوي والمقاصدي.
س2. تجلى النظر التفسيري في آيات النصّ القرآني في مجالات بحثية تراثية عديدة، مثل: الفقه والكلام، باعتبار محورية القرآن في التأسيس التراثي. ولا شك، كما كان لهذا أثر جيّد في استكشاف معاني القرآن وربطها بحاضر المسلمين الواقعي والفكري، لكن هل كان لما يمكن اعتباره تحكُّمَ منطلقاتِ هذه الحقول في النظر التفسيري أثرٌ في استكشاف المعنى القرآني؟
د/ مراد المرابط:
أشرتُ سلفًا إلى أن التفسير علمٌ انطلق في مدارس أسّسها الصحابة وتتلمذ فيها التابعون، لكن الاهتمام بالتفسير بدأ ينضب مع عصر التدوين وظهور المذاهب الإسلامية في القرن الثاني للهجرة، فانصبّ اهتمام الناس على الفقه العملي للأحكام مما يشتغل الفقه ببيانه مسترشدًا بنتائج النظر في القرآن الكريم لأخذ المعاني منه مباشرة، وكان الفقهاء السبعة بالمدينة المنورة الذين ترجع إليهم الرياسة في الفقه والفتوى يمتلكون الأدوات المنهجية والعلمية للتعامل مباشرة مع كتاب الله تعالى، بما حفظوه من علم وبما أوتوه من بصيرة النظر والاستنباط للأحكام مباشرة من القرآن الكريم.
إنّ من أهم ملامح التراث الفقهي؛ سواء المتعلق بنقول الفقهاء الكبار: (أبي حنيفة، ومالك، والشافعي، وأحمد) لأحاديث المصطفى -صلى الله عليه وسلم- مما تضمّن تفسيرًا للقرآن الكريم، أو نظرًا تدبريًّا (وإن كانت النقول في هذا قليلة)، أو فقهًا منهم بُنِي على استنباط مباشر من كلام الله تعالى؛ أن ذلك كان -أساسًا- جزءًا من التفسير، ولهذا توجهت كثير من الدراسات الحديثة إلى جمع ما تفرّق عند هؤلاء الأعلام وغيرهم من أهل المدارس المندثرة من تراث تفسيري ثَـرٍ. فالفقه والتفسير سارَا في خط متوازٍ، مع غلَبة علم الفقه باعتباره الثمرة التي تهيّئ الحكم للمكلّف وتستنبطه.
أمّا علم الكلام، فتلك قصة أخرى؛ ذلك أن الطوائف الإسلامية لمّا شرعَت في الذَّبّ عن معتقداتها أمام موجات الزندقة والمذاهب الباطلة كانت كلّها ترفع راية واحدة وشعارًا أوحد، وهو العودة إلى القرآن الكريم، الأصل الأصيل والركن الأثيل، فالقائل بالجبر يبحث عن الآيات التي تسند قوله والقائل بمطلق الاختيار يلتمس الدليل من كتاب الله، وهذا من المزالق المنهجية الكبيرة التي وقعت وقتئذ، إذ تنصرف تلك المدارس العَقدية الكلامية إلى تأسيس معتقداتها خارج السياق القرآني والنسق المهيمن والتأسيس الرباني، وعندما تجهدها المناظرات والمحاجّة الكلامية تضطر للعودة إلى القرآن؛ لكن هذه المرة ليس من أجل التأسيس وإنما من أجل البحث عما يسند المذهب والاتجاه الكلامي.
فلو أن التأصيل الكلامي انطلق من كتاب الله مع نشدان الهدى فيما رُوي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- وصحابته في تفسير القرآن؛ لكان ذلك أدعى إلى حفظ ماء وجه تلك المذاهب وعدم حاجتها إلى ليّ أعناق الآي لخدمة فُهومٍ انبثقت خارج سياق القرآن الكريم، وبعضها استنجد بالمنطق الأرسطي والنظر الغنوصي ليؤسّس فلسفته ويبني نموذجه التفسيري.
وعمومًا فقد تداخل علم الكلام مع علم التفسير حتى صار من الأدوات التي يحتاج إليها المفسّر، كما أخبر بذلك الإمام السيوطي معللًا ذلك بقوله: «لِما في القرآن من الآيات الدالة بظاهرها على ما لا يجوز على الله»[1].
س3. لو تُلقون لنا الضوء على أهم التفاسير التراثية ومناهجها، وكذلك كيفية استلهام اجتهاداتها في بناء نسق معرفي إسلامي معاصر، وهل نستطيع القول بوجود تتابع في هذا الجهد التفسيري في العصر الحاضر؟
د/ مراد المرابط:
إذا تحدثنا عن أعلام التفسير القدامى فإنه يمكن الإشارة إلى عدّة مفسرين برعوا وتفننوا في بيان النصّ القرآني؛ نجد منهم الإمام أبا جعفر الطبري، والإمام ابن كثير، والإمام القرطبي، والإمام جار الله الزمخشري، والإمام ابن عطية الأندلسي، والإمام القاضي ابن العربي المعافري، والإمام القرطبي وغيرهم كثير، وكلهم سلكوا مسالك متباينة في التفسير، فمنهم من اعتمد المأثور وألغَى أو قلّل من الرأي، ومنهم من غلَّب الرأي والتأويل، كما أن منهم من نزع إلى التفسير اللغوي أو البلاغي أو الإشاري أو غير ذلك.
والحقيقة أنّ كلّ تلك التفاسير والمدارس عالةٌ على أب المفسرين ورائدهم الأول، وهو الإمام ابن جرير الطبري (ت: 310)، وقد كان -رحمه الله- سبّاقًا إلى كثير من القضايا، كما أن له قدرة فائقة على الجمع والتنقيح والنقد، فهو موسوعة متكاملة في التفسير المأثور، وعنده إبحار في قضايا عقلية، فهو برزخ بين بحري النقل والعقل، وأهم ما يلفت نظري فيه هو أنه يعطي قارئه ومتأمله سوانح لتعلُّم ملَكة الاستنباط، سواء تعلّق الأمر بالأحكام الفقهية أو المقاصد التشريعية أو غيرها. ومعلوم أن تفسير ابن جرير كان إلى الإطناب والتوسّع أقرب، لكنّ صاحبه اختصره وهذّبه لما رأى من فتور الهمم، هذا في زمانه -رحمه الله- وقد قال حينها: «إنّا لله، ماتت الهمم».
ويمكن بيان ملامح منهج ابن جرير في تفسيره من خلال العناصر الآتية:
- التفسير بالمأثور من الحديث أو أقوال الصحابة والتابعين.
- الترجيح بين الروايات التفسيرية إذا تعارضَت في ظاهرها.
- الرجوع إلى إجماعات الأمة والترجيح بها.
- اهتمامه بالقراءات ورجوعه إلى الأصح منها.
- استدلاله بالإسرائيليات: وهذا مما يلاحظ على تفسيره -رحمه الله-، لكن الشيخ المحقّق محمود شاكر قد نبّه إلى كلّ تلك الملاحظ وكشف سليمها من سقيمها.
- إعراضه عما لا فائدة فيه: وهذا من قصدية الكتاب وقصدية مؤلفه.
- اعتماده اللسان العربي في التفسير: وهذا يظهر في ترجيحه المعروف والمألوف من كلام العرب على ما عدَاه، واعتماده على الشعر الجاهلي خير دليل على ذلك؛ لأنه ضمَّ معاني من لسان العرب ومعهودها في الخطاب.
- وقفاته الطويلة عند آيات الأحكام الفقهية: ومعلوم أن ابن جرير كان شافعيًّا ثم أصبح صاحب مذهب مستقلّ؛ ولذلك فهو يعرض أقوال الفقهاء المشهورين ثم يختار لنفسه رأيًا فقهيًّا بناءً على أصول ومسالك.
- خوضه في علم الكلام: فابن جرير متكلِّم بارع، تصدَّى للردّ على المعتزلة والقدرية بأسلوب علمي متين يجمع بين اعتماد أصول النظر السنّي في مسائل العقيدة والمجادلة بالحجة العقلية لدعاة التحرّر من النقل.
هذا التفصيل في منهج ابن جرير مقصود عندي لبيان أن هذا الرجل كانت له قدم السّبْق في التأسيس لمنهج تفسيري سوف يتطوّر أكثر فأكثر مع مَن جاء بعده، كما أنّ لابن جرير سَبْقًا في التنبيه على قواعد تفسيرية كبرى؛ كقاعدة اعتبار السياق والترجيح به، وقد قال -رحمه الله-: «غيرُ جائزٍ صرفُ الكلام عما هو في سياقه إلى غيره، إلّا بحُجّة يجب التسليم لها؛ مِن دلالة ظاهر التنزيل، أو خبر عن الرسول -عليه السلام- تقوم به حجة، فأما الدعاوَى فلا تتعذر على أحد»[2]، لكن لا شك أن كلّ المدارس التفسيرية استلهمت شيئًا مما بدأ به ابن جرير في منهجه الرصين هذا. وعلى ذلك الأساس فالفكرُ المعاصر أيضًا في حاجة إلى اعتبار التراث التفسيري لهؤلاء الأعلام جزءًا لا يتجزأ من النسق المعرفي المتجدِّد الذي تُواجِه به الأمة جميع الانزلاقات الفكرية والتشوُّهات العلمية والمنهجية.
هذا عن الشخصيات التراثية التأسيسية، أمّا الشخصيات المعاصرة التي أبدعَت في التفسير بنظر كلّي فأحسب أنها قليلة في زماننا هذا، وهم عندي لا يزيدون على العشرة في أحسن الأحوال؛ أذكر منهم الشيخ بديع الزمان النورسي، والشيخ عبد الله دراز، والإمام سيد قطب، والشيخ الدكتور فريد الأنصاري، رحمهم الله جميعًا.
وإن كنت متحدِّثًا عن أحدهم فإني أختار العلّامة المغربي فريد الأنصاري -أسبَغ عليه المولى وافر الرحمات- هذا الرجل الذي توجّهَت دراساته العلمية في بدايات بحوثه الجامعية إلى ما يسمى عندنا في المغرب بعلم المصطلح؛ وهو علم مغربي النشأة؛ محَّض له الدكتور العلّامة الشاهد البوشيخي -حفظه الله- وقته وجهده ووجّه إليه ثُلّة من الباحثين فأبدعوا فيه، ومنهم الشيخ فريد، فكانت أطروحته لِنَيل الدكتوراه ثمرة من ثمار هذه المدرسة، وهي بعنوان: (المصطلح الأصولي عند الإمام الشاطبي)، لكن الرجل توجّه فيما بعد إلى الدراسات القرآنية وأبدع فيها إبداعًا منقطعًا، استفاد فيه من بعض الجهود التأسيسية، ولم يعتبر إبداعه تفسيرًا وإنما هو من علم التدبر القرآني، وصاغ ذلك المنهج وفق رؤية رباعية عالج بها كثيرًا من السور القرآنية، وقد طُبعت في ثلاثة مجلدات باسم: (مجالس القرآن)؛ ورؤيته تلك تتأسّس على تقديم السورة أو المقطع القرآني بمنهج رباعي الأضلاع:
- كلمات الابتلاء.
- البيان العامّ.
- الهدى المنهاجي.
- مسالك التخلُّق.
فكان مشروعه مخاطِبًا الوجدان المسلم للرقيّ بمستوى تدبُّره، ومخاطبًا العقل المسلم لإعادة تشكيل الشخصية الإسلامية وفق الرؤية القرآنية الكلية، فكانت رسالاته التي يستنبطها من الآيات موجهة مباشرة إلى الجانب السلوكي العملي، وكأنها مرآة لانعكاس شلال القرآن وأنواره على النفس المؤمنة.
ولعلّنا نُفرد لهذا الجهد المبارك وقفات في محطات حوارية أو مقالات علمية مقبلة؛ لأنه جهد يستحقّ منّا كلّ تعريف وبيان؛ لأن المسلم المعاصر محتاج إلى مثل هذه الكتابات التي توقظ الضمير الحي وتوجِّه إلى العمل، ولا خير في علم ليس تحته عمل.
نسأل الله تعالى أن يقيّض لهذا المشروع مَن يتمّه بأكمل صورة وأحسن بيان.
المحور الثاني: الدعوات لإعادة النظر في التراث التفسيري وفي مناهج قراءة القرآن:
س4. ما مسوِّغات هذه الدعاوى المتكوثرة، وكيف تقيّمون دعوتها المشتركة المتعلقة بإعادة النظر في التراث التفسيري، والتي أسلَمَتْهم إلى عدم التمييز بين (حيّ التراث) و(ميّته)، أو عدم التمييز بين المَوْقِد ورَماده، خصوصًا اجتهادات من يرى أن الإبداع في التفسير رهين تدشين البدء من جديد، دون مراعاةٍ لمقتضيات ناظم (التراكم)؟
د/ مراد المرابط:
هناك عدّة مسوِّغات لهذه الدعاوى الكثيرة والمتكوثرة كما سميتموها، أذكر منها تمثيلًا لا حصرًا:
- محاولة تقليد الغرب في حداثته.
- السير على مَهْيَع الاستشراق وأذنابه في العالم الإسلامي مضمونًا ومنهجًا: فتجد الطاعنين في القرآن الكريم من هذا اللون من المفكرين إنما يعيدون إنتاج خطاب المستشرقين نفسه، بل أَعجب أحيانًا لوجود الاعتراضات نفسها والأسئلة نفسها التي أنتجها المستشرقون وأكَلَ عليها الدهر وشَرِب.
- الانبهار النفسي والانهزام الوجداني والعقلي أمام اجتهادات أكاديمية في دراسة عموم النصوص البشرية؛ كالمدرسة الهيرمينوطيقية، والمدارس اللسانية واللغوية الحديثة.
- عدم فهمِ الطبيعة المنهجية والإسناد الرباني لهذا الكلام، وأجزِمُ أنّ كثيرًا ممن يعتبرون أنفسهم دارسين على المنوال الذي ذكَرْنا لم يقرؤوا القرآن الكريم دون خلفية أو رؤية قَبْلية، أي: قرؤوه دون أن يتركوا وجدانهم وذواتهم تتفاعل مباشرة مع كلام الله سبحانه، فهذا وحده -إن تحقق فعلًا- كافٍ ليعيدوا النظر في عدد من الأفكار المستنسَخة عن غيرهم.
أمّا عن تقييمي العامّ لهذه الدعاوى، فالحكم على الشيء فرع عن تصوّره، يترتب على ذلك أن تصوُّرنا لمجموع القراءات المعاصرة للقرآن الكريم يمكن أن ينشطر إلى ثلاثة اتجاهات:
1. اتجاه جمد على المأثور، واعتبر أن كلّ اجتهاد في التفسير هو إضافة لا مزية لها، ولا فائدة كبيرة تُرجَى من ورائه، فما ترك السابقون للّاحقين من أمرٍ في التفسير إلّا بيّنوه.
2. اتجاه انفتح على كلّ ما هو جاهز من الدراسات الغربية؛ بمناهجها وقواعدها ونظراتها وعدّتها التي طبقتها على ما عندها من نصوص العهدين القديم والجديد، وما عندها من تراث أدبي وفني، وهذا الاتجاه يَعتبر التراث جزءًا من الماضي الذي لا حاجة إلى الالتفات إليه، وإنما لا بد من تجديد الوسائل والمقاصد، ومن تجديد الذوات والأدوات، من قراءة جدّية للقرآن بمعزل عن أيّ شروط أو ضوابط أو نقول أو تراث...
3. اتجاه لم يتجاوز التراث التفسيري، لكنه اشتغل به مجددًا في وجهتي روايته ودرايته، فانصب هذا الاتجاه على نخلِ المأثور وتنقيته مما شابه من إسرائيليات[3] وروايات ضعيفة وموضوعة، ومن الزيادات الكلامية والبيانية والاجتماعية وغيرها، والتي كُتبت على هامش النصّ التفسيري وهي في مجموعها استطرادات تفيد المدقّق المتخصص لكنها لا تفيد مجموع الأمة.
وهذا الاتجاه لم يكتفِ بهذا الجهد العلمي المشهود، وإنما اشرأَبَّ إلى الاستنجاد بعلوم إضافية لإعادة قراءة النصّ القرآني القراءة الراشدة؛ وأهم تلك العلوم: علم المقاصد وعلم الواقع، فالأول يفيد في معرفة مسلكيات الوصول إلى المعاني الكلية والنظر القصدي في الكتاب، سواء تعلّق الأمر بمقاصد القرآن الإجمالية أو بمقاصد السور أو بمقاصد الأحكام القرآنية الجزئية، وعِلم الواقع يفيد في معرفة كيفية تنزيل الهدايات القرآنية والرسالات والبلاغات الربانية على واقع المسلمين المتغير، والذي يجرّ وراءه حمولة تاريخية ونفسية واجتماعية باختلافاتها إيجابًا وسلبًا.
س5. إذا صحّت إعادة النظر في (التراث التفسيري) باعتباره اجتهادًا تاريخيًّا، كأيّ اجتهاد إنساني مرتبط بسياقه. فهل تصح منهجيًّا دعوات بعض أهل (القراءات الجديدة) الداعية إلى إعادة النظر في آيات النصّ القرآني؛ سواء على مستوى إعادة ترتيب آياته، أو في علاقته بنصوص (التوراة) و(الإنجيل)، أو بواقع (زمن النبوّة) و(النزول) تاريخيًّا؟
د/ مراد المرابط:
في كتاب الله تعالى وفي الصحيح من أحاديث سيدي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ما يقطع الشك باليقين، فكثير من القضايا إنما التفصيل فيها والردّ على قائليها إنما هو من باب إعادة النقاش إلى مرحلة الصفر، ومعلوم أن مِثل هذا المنحى العلمي لا يقدِّم العلم وإنما يُلهيه عن وظيفة الارتقاء، وهذه العملية في حدّ ذاتها لا تضرّ إن كانت موجهة لمن رام التعلّم، لكن الحال أن هؤلاء لا يريدون أن يتعلموا إنما يريدون أن يشككوا وينقلوا إشكالات ليست من صنيعهم أو تفكيرهم ابتداء، إنما هم نقَلة عمن سلَف من المستشرقين وتلامذتهم.
س6. ودّع العالم العربي والإسلامي هذه الأيام المفكر السوري الدكتور محمد شحرور[4]. ما رأيكم فيما قدّمه من اجتهادات منبثقة عن إعادة النظر في القرآن، خصوصًا تلك الاجتهادات التي خالف بها الفكر الجمعي السائد عند المسلمين منذ أزمنة بعيدة؟
د/ مراد المرابط:
هذا المفكر واحد من الذين قرؤوا القرآن قراءة حداثية محاولين استعارة بعض الأدوات التحليلية والمنهجية الغربية في مؤلفه (الكتاب والقرآن: قراءة معاصرة)، و(القصص القرآني)، وغير ذلك من مؤلفاته المنتشرة.
والحقيقة أن الحكم على أمثال هؤلاء الباحثين يقتضي ضرب المثل من كتاباتهم ليتبين للقارئ استقامة منهجهم من عَوره، ورشد فكرهم من شذوذه وخَرفه.
هذا الرجل فسَّر التسبيح على أنه العوم في الماء، فلم يفرّق بينه وبين السباحة، فالتسبيح عنده يفسَّر بجدل هلاك الشيء، وقد نسب آية من سورة الصافات إلى سورة يونس، وكفى بهذا ضعفًا منهجيًّا وعلميًّا تسدّ ثلمته مجرد ضغطة زر في زمن التطور التكنولوجي وسرعة الحصول على المعلومة، فهو حاول أن يجد رابطًا بين التسبيح وصراع المتناقضات الذي هو في الأصل نظرية هيكلية طوّرها ماركس وغيره فيما سمّوه بالديالكتيك، فالباحث المبتدئ لا يجد أدنى علاقة بين التسبيح الذي يدور على معاني التعظيم والتنزيه والدعاء والصلاة والعبادة، وغير ذلك مما هو في هذا المنحَى وبين صراع المتناقضات، فلا ندري هل الملائكة حين تسبح تتصارع داخليًّا وتتطور؛ فما أغربها من أقوال وأحوال!
ومن ذلك اعتباره المتشابه من النعم التي ذكرها الله تعالى والمعروشات وغير المعروشات كلّ ذلك من المتناقضات، والحال أن منطق اللغة يردُّ تفسيره ويُبعده، فهي أقرب إلى المختلفات وهذا حالها، فأيّ تناقض بين عنب أحمر وأسود وأصفر، ولهذا فهذه الفهوم أبعد ما تكون عن الرؤية القرآنية التي تقدّم لك الكون والحياة كلًّا متكاملًا متناغمًا يخدم بعضه بعضًا، ويسخّر بعضه لخدمة بعض من أجل تحقيق التوازن والاستخلاف.
ويبدو أنّ قراءةً في كثير من نصوصه تكشف ولَعَهُ بالتناقض وتفسير كثير من آيات الذِّكر الحكيم به، فتراه يفسر لك قوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَى}[الأنعام: 95] بقانون صراع المتناقضات؛ مفسرًا فلق بخَلَق لمجرد اتحادهما في حرفين، وهذا من أغرب ما سمعت، وكأنّك تسوِّي بين قرأ وذرأ.
وعمومًا يمكن القول إن محمد شحرور قد اجتمعت في قراءته عدّة جوانب تخرم المنهج العلمي، وعلى رأسها:
- تحامله الواضح على التراث التفسيري للأمة.
- إرادته الواضحة في مخالفة إجماعات الأمة في التفسير.
- تكلُّفه المبالغ فيه وتحميله النصّ ما لا يحتمل أصالةً.
- لوكه أقوال المستشرقين وآراءهم في القراءة التشطيرية وغيرها.
- إسقاطه السياق ودلالاته من اعتباراته العلميّة والمنهجية.
لا أريد أن أثقل بذكر نماذج كثيرة من شروح وتناقضات هذا الرجل في قوله عن القرآن الكريم، ولا أريد أن أحوّل هذا الحوار المقتضب إلى تفصيل طويل في كتاباته وما وقع فيها من طوام وارتباكات علمية ظاهرة، وإنما قصدي أن ألفِت الانتباه إلى أن كثيرًا من المتصدرين للكلام في كتاب الله إمّا أنهم تنقصهم المقومات العلمية للقول في القرآن ببصيرة، وإما أنهم تشرّبوا أيديولوجية معيّنة فانغمسوا بها في بحر القرآن، وهذا الكتاب المبارك مرآة كاشفة؛ مَن دخله بقصد غير سليم انكشف أمره للخلائق وظهر فحش قوله وانسداد أفقه التدبري والعلمي؛ وإنما ينفتح هذا الكتاب للطالبين الحقّ الراغبين في نور يضيء ظلمات الحياة. {وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ}[الشورى: 52].
المحور الثالث: ابن عاشور[5] والتفسير المقاصدي للقرآن:
س7. محمد الطاهر بن عاشور من أهم المجتهدين في حقل التفسير خصوصًا، وحقولٍ ذات صلة بالقرآن عمومًا. وأنتم قد أنجزتم بحثكم للدكتوراه حول التفسير المقاصدي في المرحلة الحديثة، لو تحدِّثوننا عن الضوابط المنهجية التي يتأسّس عليها اجتهاد ابن عاشور في حقل تفسير آيات القرآن.
د/ مراد المرابط:
تفسير (التحرير والتنوير) هو أضخم تفسير معاصر على الإطلاق، وقد أبدع فيه صاحبه إبداعًا منقطع النظير، وكتبه بنفَس طويل غير مستعجل في إخراجه أو إظهاره، وهذا من أسباب تماسكه ودقته وشموله؛ فابن عاشور -رحمه الله- مكث يكتب في هذا التفسير ما يقرُب من أربعة عقود من الزمن، فتُلْفِي فيه عصارة نظرات الرجل وصولاته العلمية والتدبرية؛ ولهذا فقد صحبتُ الكتاب في مرحلة الإجازة والماستر قراءة لبعض أجزائه، ووجدتُ بعض الباحثين قد حاول قَبلي أن يلج غمار جمع مادته التفسيرية المتعلقة بالمقاصد، وأن يُظهِر بذلك منهج الشيخ الراسخ في التفسير المقاصدي، لكن كلّ تلك المحاولات لم تتمّ لِما رأى أصحابها من صعوبة قراءة سِفر طويل ومتماسك اللغة والأسلوب والمضمون العلمي، فلما وصلتُ مرحلة الدكتوراه أحسستُ بأن الله -جل جلاله- وكأنه اختارني لهذا العمل، فوجدتُني مندفعًا إليه رغم وعورة مسالكه، ووُفِّقتُ لقراءة الكتاب بأكمله في قُرابة السَّنة والنصف، مع ما صاحَب ذلك من تجميع مادته العلمية وتقسيمها وسبرها لإعادة قراءتها وترتيبها وتحليلها ومقارنتها بغيرها، وأحسب أن هذا العمل لم يَسبق إليه أحد من الباحثين حسب الجهد الاستقرائي الذي قمت به لمعرفة بعض الأعمال المشابهة لعملي في العالم الإسلامي، والحقيقة أني لم أجد أحدًا قام بالعمل نفسه، وهذا من المدد الإلهي والتوفيق الرباني لهذا العبد المذنب الفقير.
أَدلِف إلى سؤالكم الدقيق، ومدخل الإجابة عن سؤالكم هو مقدمات تفسير (التحرير والتنوير) التي لخص فيها الإمام ابن عاشور -رحمه الله- ضوابط منهجية متعددة أسّس عليها القول في تفسير كتاب الله تعالى، ويمكن أن أجمل لكم أهم تلكم الضوابط فيما يأتي:
1.ضوابط منهجية للتفسير بالرواية: وفَحْص منهج ابن عاشور يُفضِي إلى هذه النتيجة، وهي أن التفسير بالرواية يتأسّس على تسعة أقطاب:
- تفسير القرآن بالقرآن.
- تفسير القرآن بالسنة.
- تفسير القرآن بأقوال الصحابة.
- تفسير القرآن بأقوال التابعين.
- التفسير بأسباب النزول.
- التفسير بالقصص.
- التفسير بالناسخ والمنسوخ.
- التفسير بالقراءات.
- التفسير بأقوال من التوراة والإنجيل تعضيدًا لا تأسيسًا.
2. ضوابط منهجية للتفسير بالدراية: وتلك الضوابط يمكن جمعها في ستة: الشعر، واللغة (التفسير اللفظي والإعراب)، وإعجاز القرآن، وآيات الأحكام ومقاصدها، والمذاهب الاعتقادية، وما يسندها من أقوال فلسفية.
وبناء على ذلك فإن ابن عاشور لم يترك ضابطًا من الضوابط -سواء تعلّق بالرواية أو الدراية- إلّا أخذ به واجتهد في ضوئه؛ ولهذا كما قلتُ جاء تفسيره مستوعبًا وموسوعيًّا؛ والحديث عن هذه الضوابط بشكل تفصيلي لا يسعه مثل هذه الحوارات، وإنما المقصود عندي أن أنبّه إليها عمومًا، ويكفي من القلادة ما أحاط بالعنق.
س8. من المعلوم أن النظر الاجتهادي عمومًا، وفي آيات النصّ القرآني خصوصًا، نظرٌ يحتكم إلى ضوابط منهجية محكمة. هلّا حددتم لنا بعض الخطوات التي يمكن الاستعانة والتوسّل بها لتحقيق استنطاق جديد لآيات القرآن من المنظور المقاصدي، بوصفه نظرًا كليًّا.
د/ مراد المرابط:
الدخول إلى هذا القرآن من باب الافتقار إلى الله تعالى وتجديد النية على الاهتداء بهديه والاستمداد من أنواره هو أول شرط في هذا الطريق الطويل، الذي لا يقدر على الصبر على لأوائه إلّا مَن تلقَّى ابتلاءات كلمات الله، تليه أمارات أخرى لا بد منها متعلقة بالجانب الأدبي والوجداني؛ كتلقِّي كلام الله باعتباره وحيًا لا باعتباره مصحفًا؛ فالتلاوة المصحفية التي تَعتبر القرآن جزءًا من التاريخ نزل في مكان وزمان بعينه وانتهى الأمر، لها أجرُها وبركتها، لكنها لا تبلغ شأو القراءة التي تستحضر دائمًا أن المتكلِّم بهذا القرآن هو الله -جل جلاله- الحي، ومِن ثَمّ فالوحي حياة، إذ الحي لا يَفْنَى سبحانه، وكلامه نصّ حي وما دونه من النصوص كلها ميتة إلّا إنْ بَثَّ فيها الإنسان نَفَسًا جديدًا بالمدارسة والتحليل والنقد.
ولا يفتح القرآن أبوابه أبدًا للمتعصبين وأصحاب الأهواء، فقراءاتهم لا تعدو أن تكون حركة يسيرة في مكانٍ ضيّق؛ ذلك أن أُفقها المعرفي والوجداني والحضاري ضئيل جدًّا إذا ما قورن بالقراءة الراشدة المستبصرة.
واعتماد القراءة المقاصدية للنصّ القرآني ترتكز على جملة أمور محقِّقة لذلك النظر الكلي في سور وآي الذِّكر الحكيم، منها: التفريق بين التفسيرات الجزئية والمعنى الكلي؛ فأنت عندما تقرأ البقرة تجد بها مواضيع متشعِّبة وكثيرة، لكنها سورة كالشجرة لها جذور وأغصان وأوراق وثمار، إنها شخصية مستقلة ومتميزة؛ ولهذا فجميع ما فيها من جزئيات تفسيرية وقضايا تفصيلية تُفْهَم في ضوء كلياتها التشريعية والعقدية. ومِن تلكم الأَمارات كذلك تتبُّع مراحل التنزيل، وجَمْع النصوص في الموضوع الواحد لمَن رام فَهْم ذلك الموضوع على هدى من الله تعالى.
ولا يتحقق كلّ ذلك إلّا إذا سلك القارئ مسالك هادية إلى المعنى، وعلى رأسها مسلك الاستقراء ومسلك التدبر.
س9. تعلمون أن العالم بأسْرِه، عربيًّا كان أو إسلاميًّا أو غير ذلك، تنتشر فيه آفات شتى في مختلف مجالات الحياة؛ ثقافية واجتماعية وسياسية واقتصادية ونحوها، مِن أهمّها (القول بالهوى)، أو (القول بغير الاجتهاد المُخمّر) في آيات القرآن، مما أفضى إلى تسيُّب وسيولة. في نظركم، ما المقترح الذي من خلاله يتحكم في هذه الآفة، والتي تعظم آثارها في زمن وفرة وسائل التواصل؟
د/ مراد المرابط:
الهوى مُنافٍ للهُدَى، وهو حجابٌ وسدٌّ منيع يحُول بين صاحبه وبين المعنى السديد، وبتعبير البيداغوجيين هو عائق سيكولوجي بين الذات والموضوع فهمًا واستيعابًا وتمثلًا، وعلى ذلك الأساس أرى أن اتّباع الهوى من أكبر ما يطمس البصيرة ويكسر مرآة النظر؛ ولهذا نبّه الله تعالى إلى خطورته فقال: {وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ}[القصص: 50].
واتّباع الهوى هذا لا حلّ له إلّا بأن يجدِّد صاحبه نيّته في طلب الحقّ والاهتداء بمَن سلف من الصحب الكرام الذين قدّموا لنا دروسًا بليغة في تعاملهم مع كتاب الله إخلاصًا، واقتباسهم من أنواره مستبدلين بلباس الهوى لباس التقوى والهدى: {وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ}[الأعراف: 26].
ثم إنّ اتّباع الهوى قرين التعصب والجهل، فكلما تعلّم الإنسان أكثر وعلم عن الله وعن مراد الله تحلَّى بميزة الربّانيّة التي أشار إليها الحقّ سبحانه بقوله: {وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ}[آل عمران: 79].
هذا هو البُعد الفردي في الموضوع، أمّا البُعد الجماعي والمؤسسي فهو أن يَـترك صاحبُ القصد الحسَن في الأخذِ من أنوار القرآن كلَّ داعية هوى فلا يأخذ منه ولا يستمِد؛ وإنما يتركه للمؤسّسات المسؤولة؛ رسمية كانت أو شعبية لِتردّ عليه وتنتقده بالأدوات العلمية المطلوبة؛ وهنا لا بد أن أُشير إلى أن الدول الإسلامية مطالَبة اليوم -وفي ظِلّ التحديات الراهنة- بتأسيس المراكز العلمية الرصينة وإعطاء زمامها للعلماء الربانيين؛ ليقودوا الأمة إلى ما فيه خيرها وصلاحها، ولا يكون العمران الحقيقي ماديًّا ومعنويًّا إلّا إذا كان مُنطلَـقه القرآن، وقَصْده صناعة الإنسان على عين الرحمن وبكلمات الرحمن.
[1] الإتقان، السيوطي (2/ 181).
[2] جامع البيان، الطبري (16/ 16).
[3] يمكن الاطلاع على نقاش أوسع لمسألة الإسرائيليات في التفسير، في ملف الإسرائيليات على الموقع، والذي تناوَل مناحي مختلفة للنظر في حضورها في كتب التفسير. (موقع تفسير).
[4] توفي محمد شحرور يوم السبت 21 دجنبر 2019، بدولة الإمارات العربية المتحدة، ودفن بدمشق-سوريا، له العديد من الدراسات القرآنية المعاصرة، وكنا قد أنجزنا مجموعة مقالات للتعريف باجتهاده، نُشرت بمركز تفسير وغيره.
[5] محمد الطاهر بن عاشور، علّامة تونسي (ت: 1973م). له مجموعة مصنفات، منها: تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد، مقاصد الشريعة الإسلامية، أصول النظام الاجتماعي في الإسلام، أليس الصبح بقريب، كشف المغطى، النظر الفسيح، فضلًا عن مصنفات لغوية وأدبية وغيرها.
كلمات مفتاحية
ضيف الحوار

مراد المرابط
حاصل على الدكتوراه في الدراسات الإسلامية، وله عدد من المشاركات العلمية.
مواضيع ذات صلة
((المعلومات والآراء المقدَّمة هي للكتّاب، ولا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع أو أسرة مركز تفسير))