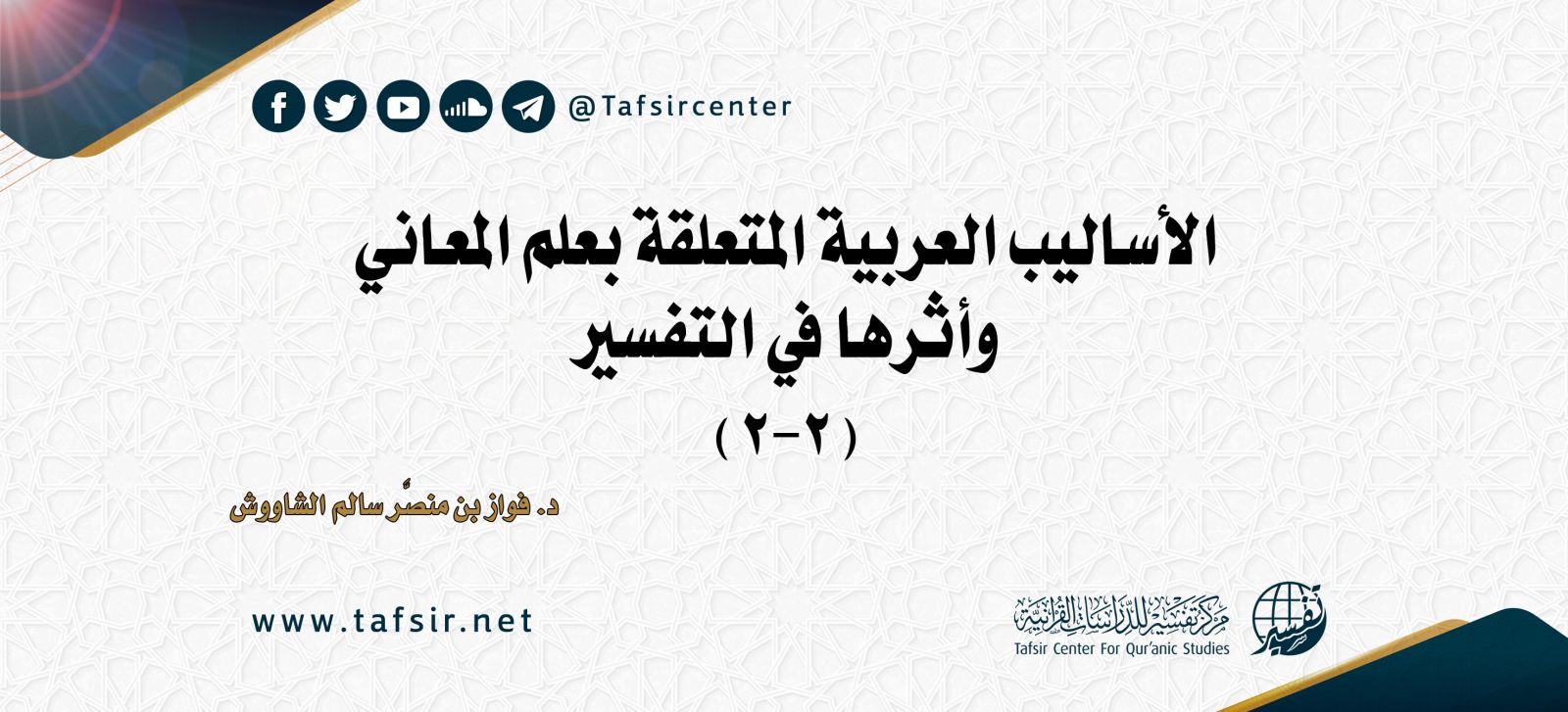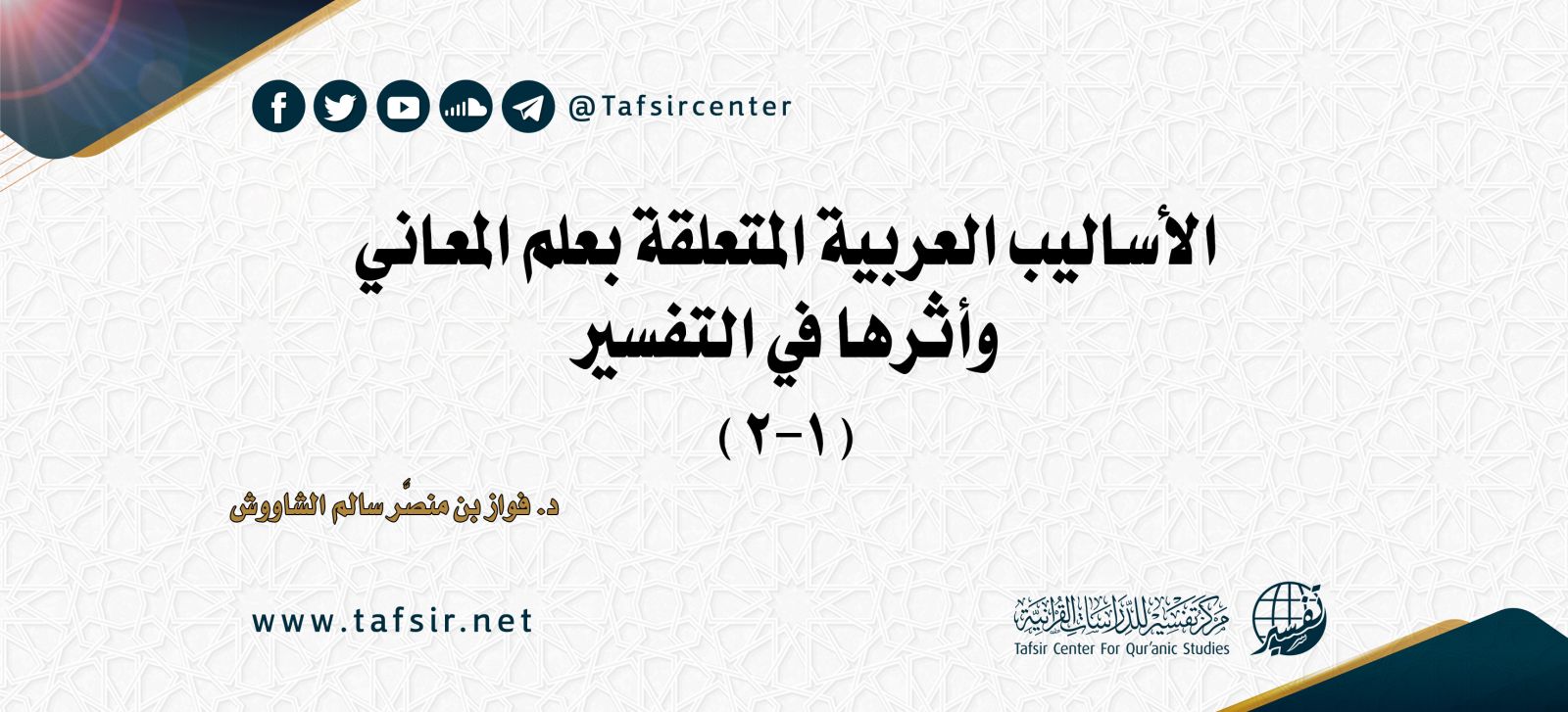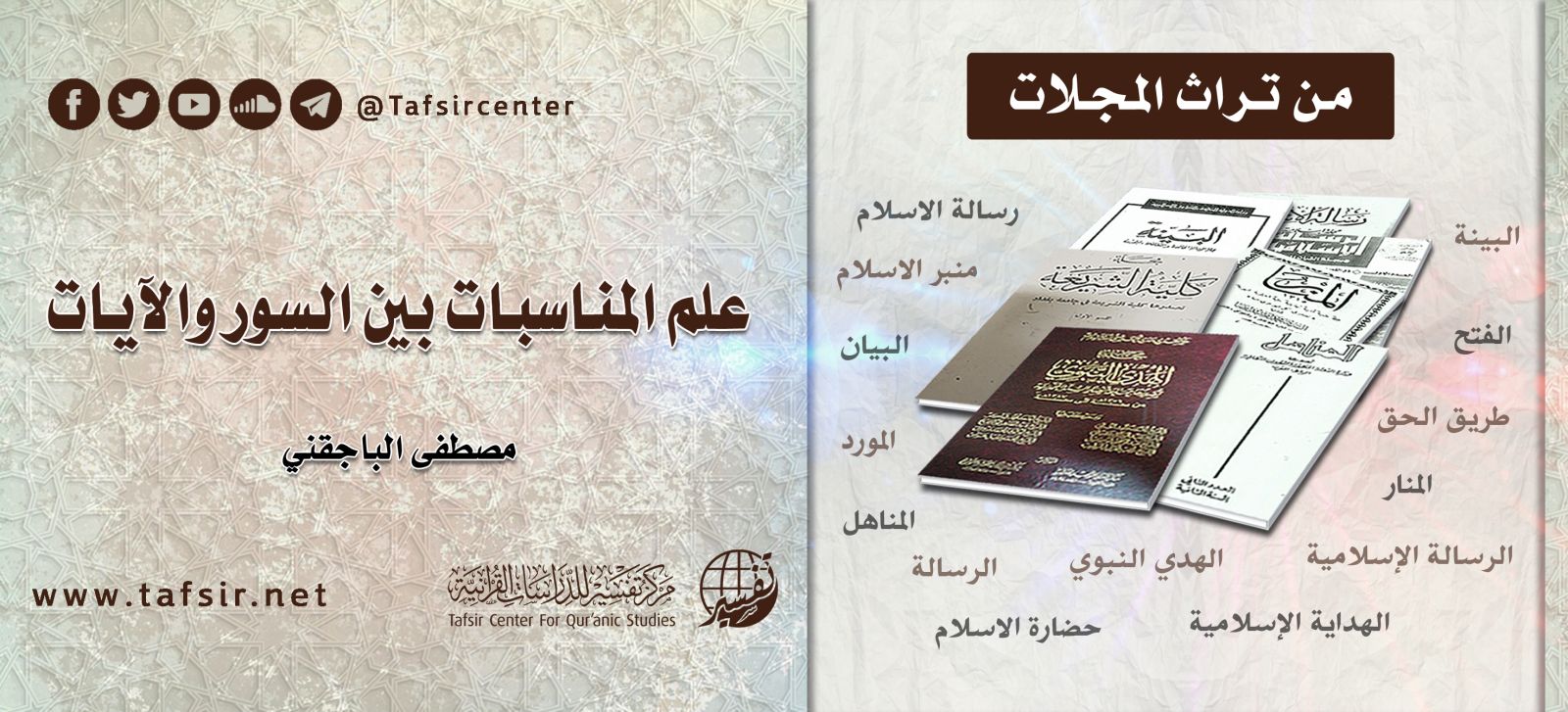وقفة نقدية مع بحث: الإسرائيليات في التفسير بين ضرورة التوظيف وإمكان الاستغناء
وقفة نقدية مع بحث: الإسرائيليات في التفسير بين ضرورة التوظيف وإمكان الاستغناء
الكاتب: محمود عبد الجليل روزن

الحمد لله بالإسلام، والحمد لله بالإيمان، والحمد لله بالإحسان، والحمد لله بالقرآن، وأشهد أن لا إله إلا الله جليل الشَّان، عظيم السلطان، واسع الإحسان، سبحانه؛ ما أتمَّ برهانَه! وما أحْكَمَ بيانه! وما أبلغَ قرآنَه!
وأشهد أن محمدًا عبده المصطفى ونبيه المجتبى، وأصلّي وأسلّم عليه كما يحب ربنا ويرضى، وبعد:
فقد وقفتُ على بحث أخي الكريم الدكتور خليل محمود اليماني: «الإسرائيليات في التفسير بين ضرورة التوظيف وإمكان الاستغناء؛ قراءة تحليلية لمقولات المفسرين في جواب السامريّ في سورة طه».
وهو بحث يؤسِّس لحُجّةٍ مُستقلّة في قضيةٍ شائكةٍ لطالما شغلت الساحة العلمية عامّة، والتفسيرية خاصّة، وهي توظيف الإسرائيليات في التفسير. وقد قرأتُه أوَّلًا قراءة سريعةً أثارت في ذهني بعض الأسئلة والإشكالات، فَعُدْتُ إليه بقراءة متأنّية كان من ثمرتها هذه المقالة، التي لا تعني اختلافي مع مجمل التقريرات التي توصَّل إليها أخي الكريم الدكتور خليل في المطلب الثالث من بحثه[1]، ولكن قد أختلفُ مع الطريقة التي أسَّس بها لهذه النتيجة.
وإني لمقتنعٌ بأنَّ الحوار الجادّ المتّزن هو أفضل ما يُمَحّص الحُـجَّة ويُقوّمها، وأن حِكمة الله -عز وجل- وسُنَّتَه في التقدير قد تكون بألَّا يُوَفِّق إلى الحقِّ جملةً واحدةً؛ ولكنّه يوفِّق إلى أسبابه ومقدِّماته، فيتمهَّد الطريق إليه بقولٍ فيه شيءٌ من الخطأ، ولكن لم يكن في الإمكان إصابة الحقّ إلّا عن طريق اقتراح هذا الخطأ أوَّلًا ثم اطِّراحه؛ فيكون لمقترحه شيءٌ من الفضل في إدراك الصواب بعدُ.
وعليه؛ فهذه المقالة لا تتناول بالنقدِ البحث المشار إليه كلّه، وإنما يتركّز نقدي في ثلاث وقفات:
الأولى: عدم إطالة الباحث الكريم النّفَس في تحرير المقصود بالإسرائيليات والتعليل للتعريف الإجرائي الذي ارتضاه بقَدْرٍ تطمئن إليه نَفْس القارئ:
ولا تخفى أهمية هذا الأمر عمومًا في دراسة القضية التي تصدَّى لها البحث، غير أنها ذات أهمية نسبيّة في الموضع الذي وقع عليه اختياره، وهو جواب السامريّ في سورة (طه)؛ إذ إنّ المرويّات التي استند إليها المفسرون له ليس لها ذِكْرٌ في التراث المكتوب المتداول لليهود، والقصة واردة على صورة مختلفة تمامًا لا يجوز اعتقاد صحتها في الإصحاح الثاني والثلاثين من سفر الخروج، ولعلَّ ما استند إليه المفسرون تسرّب للناس من روايات القصَّاصين[2].
فالوارد في الإصحاح الثاني والثلاثين من سفر الخروج فيه زعم أنَّ هارون هو الذي صاغ لهم العجل في أكاذيب كثيرة! وليس فيها ذِكْرٌ لشيء مما في كتب التفاسير عن السامريّ، وزعمهم أنَّ هارون -عليه السلام- هو الذي صاغه من الباطل الذي لا يتردّد مسلمٌ في إبطاله ولو لم يرد في القرآن الكريم ذكرٌ للقصة أصلًا.
والذي يُهِمُّنا -بالدرجة الأولى- من كلِّ هذا الركام من القصص أنَّ ذِكر جبريل -عليه السلام- ودوره في القصة -فهو الذي يكشط قشرة الإبهام عن النصّ، وهذا لُبُّ محلّ النزاع- لا وجود له هنالك.
وقد يقال: إن المقصود بالإسرائيليات التراث الإسرائيلي كلّه الشفوي منه والمكتوب[3]، فنقول: إذا كان التراث المكتوب الـمُقَدَّس محرَّفًا بهذه الصورة الفجّة فكيف بمرويات القُصّاص التي لا خُطُم لها ولا أزمّة؟! وهل فزع علماء الحديث لتدوين السُّنة وابتكار علم الإسناد إلّا مما رأوا من أثر القُصّاص، ولم ينقضِ قرنان بعدُ على وفاة الرسول -صلى الله عليه وسلم-، فكيف بتراث قُصّاص اليهود -على مخالفته لما في التوراة- بعد مرور نحوٍ من ألفَيْ عام على وفاة موسى-عليه السلام-؟![4]
وقد يقول قائل: إنَّ لكلّ علم أسانيده، فلا يصح مثلًا أن نُعمل قواعد نقد أسانيد الأحاديث في نقد أسانيد التفاسير والسيرة، فلكلِّ علمٍ قواعده.
ونحن نُسلِّم بشيءٍ من ذلك، ولكن الأمر هاهنا ليس على هذه الصورة؛ لأنَّنا لسنا بصدد إثبات أسانيد هذه المرويات إلى ابن عبّاس -رضي الله عنهما- وتلاميذه مثلًا، ولكننا بصدد إثباتها إلى المصادر التي أخذ منها هؤلاء. فعندما نروي أثرًا موقوفًا عن ابن عباس -رضي الله عنهما- في التفسير، نقول: لكلّ علمٍ قواعده، ولكن الأثر هاهنا يتجاوز ابن عباس -رضي الله عنهما-، ولو رَوَى ابن عباس حديثًا مرفوعًا في التفسير فلن نستطيع أن نحجر على المحدثين أن يُعملوا قواعدهم لبحث ثبوته إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-، فإذا توصلوا بقواعدهم إلى أنَّه شديد الضعف أو موضوعٌ فلن يقال ساعتها: بل نأخذ به في التفسير، ونؤسّس عليه المعاني منسوبةً إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-؛ لأن لكلِّ علم أسانيده!
وغاية ما نسلّم به أنَّ هناك مُشكِلًا مفاده: كيف يتوارد الجمّ الغفير من الصحابة والتابعين وكبار المفسرين على اعتماد تلك المرويات كأداة تفسيرية ثم نطّرحها نحن؟!
وهذا يُعيدنا إلى أصل الإشكال في قضية التفسير بالإسرائيليات: ماهيته وحدوده وضوابطه، وهل هي أداة بيان أصيلة أم أداة معضِّدة، فكأننا عدنا بالتساؤل الذي انطلقنا به.
وفي تقديري؛ إذا أردنا أن نختار موضعًا نبحث من خلاله هذه القضية فيجب أن يكون الموضع المختار قد جاوز قنطرة الثبوت في التراث الكتابي على نحوٍ أكثر وثوقًا، وهو ما لا يتوفّر لهذا الموضع الذي اختاره الدكتور اليماني.
الثانية: هل يكفي مثالٌ واحدٌ للجزم بالنتيجة التي توصَّل إليها البحث؟
يرى الدكتور اليماني أن دراسة الموضع الواحد الذي درسه، وهو (جواب السامري في سورة طه) يكفي لتقرير تلك النتيجة.
يقول -حفظه الله-: «وغير خافٍ أنّ تناول الإشكالية قيد البحث من خلال نموذجٍ واحدٍ قد يُستشكَل في قدرته على حسم الجدل لصالح أيٍّ من المنحيَيْن... إلا أنّه يبدو كافيًا من وجهة نظرنا في دعم أحدهما بصورةٍ كبيرةٍ؛ إِذْ من المقرّر أنَّ من يدّعي ثبوت أمرٍ ما يكفيه نصٌّ واحدٌ لثبوت ما ادّعاه، وأنّ مَن ينفي أمرًا فعليه سبر كلّ أدلة الإثبات ونفيها جميعًا لتحقق له دعواه، ومن ثَمَّ فإن هذا النموذج الذي سنقوم بتحليله يكفينا في إثبات ما سيقرّره البحث بعد التحليل»[5].
فنقول: قد لا يجادَل في أنَّ الموضع الواحد كافٍ لتقرير نتيجة حاسمة في علم دون آخر، فالمنطق الرياضي مثلًا يقبل هذا، إذا أثبتنا ببرهان واحد صحيح أنَّ قياس الزاوية (س) يساوي خمسًا وأربعين درجة؛ فهذا قاضٍ ببطلان أيّ قياس آخر.
ولكن من الصعب أن نتعامل مع هذه القضية المتعلّقة بالتفسير بمثل هذا المنطق الرياضي، فالقرآن -كما يقال- حمَّال أوجهٍ، والبيانُ نسبيٌّ، ويبقى هناك المُحْكَم والمتشابه، وإنْ كان المحكم أُمّ الكتاب ومعظمه، وقد يقول المخالف بعد أن يجتهد في تقرير معنى الآية دون توظيف الإسرائيليات: (هذا قولي، له حظُّه من الاحتمال، وهذا قولك قد يرد عليه كذا وكذا، ولسنا بين قولين أحدهما مُطّرح بيقين، والآخر مقبول بيقين، وإلّا.. ما كان للخلاف محلٌّ أصلًا).
فلا بأس أن يبقى الموضع الواحد من المتشابه، فقصاره أن يكون كالحروف المقطعة، ونحن إذا لم نقطع فيها بتفسير يحسم الجدل حول معانيها، ويُقلِّص عدد الأقوال والأطروحات التفسيرية لها، فما المشكلة أن يكون هذا الموضع الواحد منها؛ دون أن يُحمل الذي يعتقد عدم ضرورة توظيف تلك الأداة التفسيرية في التفسير على ضرورة اعتقاده؟
لكن إن تقرّر أن هذه الأداة التفسيرية تمثِّل عامل حسمٍ وترجيحٍ وتعضيدٍ بالارتفاق على دراسة أكثر من موضع، وتكرَّر ذلك بحيث يصبح الفكاك منه هروبًا من الالتزام باللازم، أو اعتراضًا بلا طائل =فعندها يكون التأسيس للنتيجة متينًا صلبًا سالـمًا من المؤاخذة، مقبولًا من المنصفين.
الثالثة: نقد تحليل جواب السامريّ:
ولو سلَّمنا جدلًا للباحث الكريم بإمكانية تقرير مثل هذه النتيجة من دراسة موضعٍ واحد، فإنَّ هذا التقرير لا بد أن يرتفق على بناءٍ أصيلٍ ذي قاعدتين:
الأولى: التحليل الوافي للمنتَج. والثانية: تثوير القرآن واقتراح محتملاتٍ أخرى للحلِّ. فلا يقوم فقط على تحليل المنتج التفسيري، وإنما يقوم على تثوير القرآن وعدم الاستسهال في تحليل الإشكالات، وسبر دلالات الألفاظ وردّ النظير إلى نظيره، ورصد الإشكالات الحقيقية وتوليدها. وحينها إذا صحَّ لنا قولٌ له حظٌّ من الاحتمالِ، دون الاضطرار إلى توظيف الإسرائيليات، وسَلِمَ من يقين الإبطال، بطل ما بَنى عليه الدكتور اليماني -حفظه الله- نتيجته.
وقد يترتّب على هذا التقريرِ الدخولُ إلى منطقة تفسيرية أخرى شائكة، وهي: ما مدى جواز إحداث قولٍ تفسيريٍّ لم يقل به السلف؟ وما المقصود بمصطلح السلف هنا؟ وهل يُقْصَد به تعيينٌ لأفرادٍ معيَّنِين مؤطَّرِين بإطار زمانيٍّ محدود؟ أم أنَّه يتّسع ليشمل مَن كان على منهجهم في الفهم دون حدٍّ زمانيٍّ؟
والمقام يضيق عن تقرير ما أعتقده في هذا الأمر، ولكن لنمضِ بعيدًا في تثوير الموضع محلَّ الدراسة من خلال طرح بعض الأسئلة:
السؤال الأول: هل صاغ السامريُّ العِجْلَ، أم أنَّ دوره اقتصر على إلقاء القبضة؟
السؤال الثاني: ما معنى {عِجْلًا جَسَدًا}؟
السؤال الثالث: ما خُوارُه؟
فنجد من السلف مَن ذهب في إجابة السؤال الأول إلى أنّ السامريّ صاغ العِجل، وممن رُوِي عنه ذلك عليٌّ وابن عباس[6]-رضي الله عنهم-، وقتادة[7]-رحمه الله-. وهو قول له حضوره البَيِّن في كتب التفاسير؛ حتى مَن يوظّف المرويات الإسرائيلية في تفسير هذه القصة.
فمِن ذلك قول أبي إسحاق الزجّاج: «وكان قد عَمِله كما تُعمل هذه الآلات التي تُصوِّت بالحِيَل، فجعله في بيتٍ وأعلمهم أنَّ إلههم وإله موسى عندي»[8].
وفي إجابة السؤال الثاني في معنى: {جَسَدًا} ذهب بعض المفسرين إلى أنَّه الذي لا رُوح فيه. وهو مذهبٌ له حضوره في التفاسير[9]، ويمثله قول ابن عاشور: «والجسد: الجسم الذي لا روح فيه، فهو خاصّ بجسم الحيوان إذا كان بلا روح، والمراد أنه كجسم العجل في الصورة والمقدار، إلا أنه ليس بحيٍّ، وما وقع في القصص أنه كان لحمًا ودمًا ويأكل ويشرب؛ فهو من وضع القصّاصين، وكيف والقرآن يقول: {مِنْ حُلِيِّهِمْ}[الأعراف: 148]، ويقول: {لَهُ خُوَارٌ}[الأعراف: 148، وطه: 88]، فلو كان لحمًا ودمًا لكان ذِكره أدخل في التعجيب منه»[10].
وفي إجابة السؤال الثالث أنَّ خواره من مقتضى الصنعة، ويمثله قول مجاهد: «حفيفُ الريح فيه خُوارُه»[11]. ورجّحه الزجّاج بقوله: «والذي قاله مجاهد من أنّ خواره حفيف الريح فيه، أسرع إلى القبول؛ لأنَّه شيء ممكن»[12].
وفي مقابل هذه الاختيارات، فهناك مَن ذهب إلى أنَّ فعل السامريّ قد اقتصر على مجرد إلقاء القبضة في الحفرة التي قذف فيها بنو إسرائيل حليّهم، فخرج العجل حيًّا يخور.
ولا يُهِمُّنا هنا أن يكون القول بأنه صاغه تمثالًا يخور على مقتضى الصنعة هو القول الراجح -وإن كنا نراه كذلك- ولكن يُهِمُّنا أن نُثبت أنَّه من قول السلف. فإذا سلَّمنا بهذا الإثبات لم يبقَ للقبضة ذاتها أثـرٌ في إخراج العجل، ويترتب على ذلك أنَّ أيَّ قراءة تثويرية منضبطة للآيات يمكن أن يَدَّعي صاحبها أنَّها مؤسَّسة على أقوالٍ لبعض السلف.
فإذا مضينا في التثوير وتبنّينا القول الذي رجّحناه؛ لم يكن مُشكلًا أن يكون معنى: {بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوا بِهِ}[طه: 96]، أنه يُخبر بإتقانه لصناعة التماثيل دون غيره من بني إسرائيل.
ولا يبعد أن يُقال: إنَّما اختصّ بالاطّلاع على الكيفية الهندسية التي يُمكن أن يصدر بها التمثال صوت الخوار وحذقها، فلا ضرورة إلى افتراض أنَّه كان الصانع الوحيد في بني إسرائيل الخارجين من مصر، فبنو إسرائيل كانوا بمثابة الخدم الممتهنين لدى المصريين، وقيامهم بمثل هذه الحِرَف والصناعات معقول متصوَّر بل هو الأقرب إلى الذهن، ولكنّه اختصّ بمشاهدة خواصّ الصنّاع المصريين وهم ينفّذون تلك الحيلة في بعض التماثيل المخصوصة فحذقها منهم، فذلك بصره بما لم يبصر بنو قومه. والله أعلم.
كذلك يدلُّ ظاهر الآيات على أنَّ السامريَّ ألقى شيئًا بالفعل كما ألقوا، وذلك قولهم: {فَكَذَلِكَ أَلْقَى السَّامِرِيُّ}[طه: 87]، ثم جاءت معالجته للحُليّ ليصنع منه التمثال بعد الإلقاء، وهذا كله منسجم مع ظاهر ألفاظ الآيات. ولا ينبغي أن يَرِد عليه شيء.
فلا مراء في أنَّ القبضة التي قبضها حقيقية، وبغير ذلك لا تلتئم ألفاظ الآيات، ويبقى فيها شيءٌ من المناكدة.
والآن نأتي إلى موضع الإشكال، وهو قوله: {فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِنْ أَثَرِ الرَّسُولِ}[طه: 96].
وهاهنا أسئلة:
- مَن الرسول المقصود؟
- ما معنى قبض السامريّ قبضة من أثر هذا الرسول؟
- هل لتلك القبضة خصوصية حقيقية؟
- وإن كانت لها خصوصية حقيقية، فهل أخبرهم السامريُّ بها، أم أبقاها لنفسه؟
وللإجابة على السؤال الأول اعتمادًا على القرآن فقط نقول: لم يجرِ ذكرٌ لجبريل -عليه السلام- ولم يَرِد ما يدلّ على أنَّه المعهود الذهني لإطلاق {الرسول}، ولا يكفي هنا أن نقول إنَّ القرآن قد يُطلِق على جبريل وصف (رسول) فموضع النزاع أن يراد معهودًا ذهنيًّا، لا أن يقع وصفًا غير مُعَرّف يدلُّ عليه السياق كما في سورة التكوير، أو معهودًا حضوريًّا كما في سورة مريم.
ولا يتقوّى بأن يقال -كما قال الدكتور اليماني[13]- بأنَّ بني إسرائيل كانوا يعرفون جبريل، نعم كانوا يعرفون أنَّ هناك ملَكًا يقال له جبريل، ولكن أن يكون معهودًا ذهنيًّا للفظة {الرسول} فهذا باب آخر تمامًا، ولا إخال هذا خافيًا.
والسامريُّ لم يفسّر شيئًا لموسى، ولا لمن معه، فيبقى كلامه بالنسبة لهم مُبهمًا كما هو بالنسبة لنا، ولنتخيل أنَّ أحدنا بين يدي موسى -عليه السلام- يسمع قول السامري: «قبضت قبضة من أثر الرسول»، فهل يفهم منه ما يراد أن يُفهم: أنَّ السامريَّ رأى جبريل -عليه السلام- على الوصف المذكور يخضرّ الرمل الأجرد من وقع حافره، فوقع في رُوعه أن يقبض قبضة فيحتفظ بها[14]، لعلّه يستفيد منها فيما بعد بصورة أو بأخرى، في فرصةٍ قد تأتي وقد لا تأتي، ينتهز فيها غياب موسى -عليه السلام- لسبب أو لآخر، فيجرّب تجربةً الاحتمالات العقلية لفشلها أضعاف أضعاف احتمالات نجاحها؟!
إذَنْ لنذهب إلى الفرض الأقرب إلى المنطق، وهو أنَّ المقصود بالرسول موسى -عليه السلام-، وإنما كان الأقرب للمنطق؛ لأننا إن تصورنا أنَّ هذا الموقف قد حدث بين يدي رسولنا -صلى الله عليه وسلم-، وأحد معاصريه يقول: «فقبضت قبضة من أثر الرسول» ما وقع في ذهن السامعين إلا أنَّه يريد الرسول -صلى الله عليه وسلم-، وهل يُستشكل أنَّ أصحاب موسى كانوا ينادونه بالرسالة؟
فإن سلَّمنا بذلك فهل يصير قوله: {فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِنْ أَثَرِ الرَّسُولِ}[طه: 96] ذا معنى، وهل يفهمون منه شيئًا؟
نعم يفهمونه تمام الفهم إذا كان قد أخبرهم مسبقًا قبل أن يُلْقِي القبضة بما يعتزم عمله من استدعاء روح الإله للتجسُّد -بزعمه- في صورةٍ يُخرجها لهم بصياغة الحُليّ، وأوهمهم أنَّ القبضة التي سيلقيها -بعد أن يلقوا هم ما معهم من حليٍّ- هي قبضة لها خصوصية؛ لأنها من أثر موسى، وأنهم قد عاينوا منه معجزات حسية مشهورة لا حصر لها من أول بعثته إليهم، وفي أثناء وجودهم في مصر وعند خروجهم منها. ومثل هذا -ولا شكَّ- يجعلهم يعتقدون في آثار موسى -عليه السلام- وأنَّ لها تأثيرًا، وهذا موجودٌ في كلِّ الأمم، وفي أمتنا نرى حرص الكثيرين على التبرُّك بكلّ ما يقال إنه أثـرٌ من آثار النبي -صلى الله عليه وسلم-، ونسبة التأثير العجيب لها من شفاء أصعب الأمراض، وقضاء أعسر الحاجات، بل وآثار مَن دونه من الصالحين والمنسوبين إلى الولاية.
فإذا أَدخل عليهم السامريّ بالوهم أنَّ أيَّ أثرٍ من آثار موسى -عليه السلام- يُمكن أن يستدعي روح الإله في العجل لكونها من أثر موسى كان متصورًا أنَّ بعض ضعاف الإيمان ممن تعلقوا بالصور وطالبوا موسى أن يجعل لهم إلهًا كآلهةِ الذين مرُّوا عليهم يعكفون على أصنامهم، وأقدامهم لـمَّا تجفَّ من ماء اليمِّ الذي نجوا منه، وأطبق على عدوّهم =يمكن أن تدخل عليهم هذه الحيلة. فلا وجه لاستبعاد وقوعه منهم، وخصوصًا إذا انضمَّ إليهم المفسدون الذين يريدون أن يجدوا طريقهم لإفساد بني إسرائيل، وهم الذين حذَّر منهم موسى هارونَ -عليهما السلام- حين استخلفه؛ بقوله: {اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ}[الأعراف: 142]، ولو كان الأمر مُقتصرًا على المغرَّر بهم فحسب لكفاهم زجر هارون لهم لينزجروا، ولكنهم بلغوا من الإعراض عنه والتصدِّي له ما أفاده قوله: {إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي}[الأعراف: 150]، وفي هذا جواب على ما قد يقال: وما الذي يعود على السامريّ من كلِّ هذا؟ فهو أحد المفسدين الذين حذّر موسى أخاه منهم. والله أعلم.
ولو رُدَّ إمكان استجابتهم لهذه الحيلة بالاستبعاد العقلي، فإنَّه يبعد في العقل أنهم يظنون أنَّ العجل إلههم حقيقةً، ولو استحال لحمًا ودمًا، وما تخييل السحرةِ منهم ببعيدٍ، وإنما أدخل عليهم أنَّ روح الإله حلَّت في العجل، ومن هنا ساغ في نفوسهم الضعيفة أن يتّخذوه إلهًا. وكذا كثير من عَبَدة الأوثان وعَبَدة البقر لا يعتقدون أن الأوثان والبقر آلهتهم في الحقيقة، ولكنهم يعتقدون أن روح الإله تـحـُلُّ فيها، فيؤلهونها ويسجدون لها؛ تعالى الله عمَّا يقول الظالمون علوًّا كبيرًا. وهذا قائمٌ نراه في زماننا رأي العين، فأيُّ ذلك يُستبعد؟!
إذن؛ فالذي نذهب إليه أنَّ السامريَّ قد أضلّهم عامدًا متعمِّدًا، فهو رجل ذو براعةٍ وحذق بصناعة التماثيل تعلَّمها من المصريين[15]، وذو بصرٍ خاصٍّ بالحيلة الهندسية التي تجعل التمثال يُصدر صوتًا، فدبَّر حيلته مُعتمدًا على مهارته تلك، ثم أوهمهم أنَّ الخوار الصادر عن العجل إنما كان لأنَّ روح إله موسى تلبّست العجل؛ تعالى الله عما يقولون علوًّا كبيرًا. فصدّقوا ذلك وتنادوا به: {فَقَالُوا هَذَا إِلَهُكُمْ وَإِلَهُ مُوسَى فَنَسِيَ}[طه: 88]، قاله السامريُّ فقالوه بعده.
فهو لم يكن ليخاطر بالتجربة، وإنما أحكم صنعته وعمد إلى إضلالهم بذلك. واختار أن يصنعه على صورة العجل لمكان العجل في الديانة الفرعونية وتمرّسه بصنع التماثيل من هذا النوع حتى صار يتقنها، ويحذق الحيل المتعلقة بها.
وإنك لن تجد -إن شاء الله- من ألفاظ الآيات ما يُعَكِّر على هذا الفهم، بل إنَّ ألفاظ الآيات تعضده، فقد ذكر إضلال السامريّ لهم: {وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ}[طه: 85]، وفرّعوا إلقاءه على إلقائهم، فكأنّه كان تابعًا لإلقائهم، وهذا ينسجم مع ما أوهمهم به من خصوصية قبضة الرسول التي بين يديه: {فَكَذَلِكَ أَلْقَى السَّامِرِيُّ}[طه: 87]، فالفاء تُشعر بذلك دون الواو، وقوله: {فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا}[طه: 88]، يدلُّ على المعالجة المقصودة، لهدف مُعْلَنٍ منتَظر، قال ابن عاشور: «والإخراج: إظهار ما كان محجوبًا. والتعبير بالإخراج إشارة إلى أنه صنعه بحيلة مستورة عنهم حتى أتمّه»[16].
فهذا منسجمٌ مع ما ذهبنا إليه غاية الانسجام، على عكس قول من قال: إنه ألقاها اعتمادًا على حَدْسٍ أُلقي في رُوعه فتشكَّل العجل على وَفْق حدسه الغريب، أو جوَّزت له نفسه أنَّه يكون فكان!
وقوله: {عِجْلًا جَسَدًا} أشرنا قبلُ إلى أنَّ المراد به: التمثال الجماد الذي لا روح فيه، و{لَهُ خُوَارٌ} هي الفتنة الحقيقية التي جعلتهم يفتتنون بالتمثال لا مجرد إخراجه، فهم قد عاينوا آلاف التماثيل في مصر، ولذلك لـمَّا أبطل القرآن توهُّمهم قال: {أَفَلا يَرَوْنَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا}[طه: 89]، وقال: {أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لا يُكَلِّمُهُمْ وَلا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا}[الأعراف: 148]، فإن كان يُصدر صوتًا فما يمنعه أن يُكلِّمهم ويجيبهم؟!
ويكون قوله: {بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوا بِهِ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِنْ أَثَرِ الرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي}[طه: 96] ذكرًا للسبب والكيفية معًا. فالسبب أنه من تسويل النفس؛ أي: زيَّنت لي نفسي هذا الأمر. ولا مزيد لدينا -هاهنا- عن قول أخينا الدكتور اليماني -حفظه الله-: «وإنَّ المتأمل للفظة التسويل في القرآن يلاحظ أنها ترد في موارد الذمّ وتزيين ما ليس بزين، وما هو باطل في أصله ومنكر وفيه هوًى تقوم النفس أو الشيطان بتزيينه لصاحبه، وتحسينه ليجترحه ويقوم به»[17].
وكما ترى، فكلُّ هذا متحقَّق جليٌّ على الذي نقترحه.
وأمَّا إخباره بالكيفية: أنَّه استغلَّ حذقه بالصياغة وبراعته في جعل التمثال يُصدر صوت الخوار مُوهمًا إياهم أنَّه من أثر الرسول؛ لا من أثر المعمول.
وعليه؛ لا يبقى موقع الفاء في {فَقَبَضْتُ} مشكلًا.
وقوله: {مِنْ أَثَرِ الرَّسُولِ} ساغ مع أنَّه يخاطبه، على حدّ قول مَن يوقّر أميره، فيخاطبه: ماذا يقول أميرنا في كذا، وبم يأمرنا الأمير؟ وقول من يخاطب شيخه: ماذا يقول شيخنا في كذا وكذا؟
وقريب منه في القرآن مع اختلاف النكتة: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالاتِكَ اللاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ}[الأحزاب: 50].
ولعلّه كان يقول (الرسول) مُواجهًا الحضور من بني إسرائيل مشيرًا في الوقت نفسه إلى موسى.
ولا يبعد أن يقال: إنَّ الله تعالى قد أوحى إلى موسى بتفاصيل القصة كلّها حين قال له: {قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ}[طه: 85]، وإنما استجوبه موسى بمحضر من بني إسرائيل؛ ليكون إقراره على نفسه بالضلال والإضلال والتحايل أدعى لإبطالِ باطله وكشف زيفه. فكأنَّ موسى يسأله فيُسمعه السامريُّ، ثم يأمره موسى بمواجهة جمهورهم لإسماعهم الجواب. وبهذا يُجْمَع بين القراءة بالغيبة والخطاب في {يَبْصُرُوا}[18]، فخاطب موسى مرة، وخاطب جمهور الحاضرين مرّة[19]. ولا يخفى أنَّ القول صدر في موقفٍ واحدٍ، والجمع بين القراءتين يقتضي تكراره، فلعلَّ هذا وجهه. والله أعلم.
والآن نأتي إلى تحليل ثلاثة ألفاظ قد يبدو أنها مترادفات: (قذف، ونبذ، وألقى)، وقد استعملت ثلاثتها في السياق الذي بين أيدينا للتعبير عن فِعْلٍ واحدٍ. وقد يُقال إنَّ التنويع فيها للتفنُّن، ولم يُقصد فيها دقيقُ فروق، ولا بأس بهذا القول، ولكن الأصل أنَّها إذا اجتمعت في السياق افترقت في المعنى بعض الافتراق، وهذا ما نستروح به للقول الذي ذهبنا إليه.
قال تعالى حكاية عن قولهم لما عبّروا عن إلقاء حليِّهم: {قَالُوا مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا وَلَكِنَّا حُمِّلْنَا أَوْزَارًا مِنْ زِينَةِ الْقَوْمِ فَقَذَفْنَاهَا}[طه: 87]، فعبّر بالقذف -والله أعلم- لأنهم حملوها من زينة المصريين وليست هي لهم، فكأنَّهم رأوا أنها ليست حِلًّا لهم، ويشعر بذلك لفظ (أوزارًا)[20]. والقذف الرّمي البعيد، ولاعتبار البُعد فيه قيل: منزل قَذَفٌ وقَذِيفٌ، وبلدة قَذُوفٌ: بعيدة، كما استعير القَذْفُ للشّتم والعيب[21].
ولما عبّروا هم عن إلقاء السامري؛ قالوا: {فَكَذَلِكَ أَلْقَى السَّامِرِيُّ}[طه: 87]، ولم يقولوا: فكذلك قذف السامري، والإلقاء فيه اعتناءٌ؛ فهو طرح الشيء حيث تلقاه[22]، أو حيث يَلقى غَرضَك من إلقائه. فكأنّهم عبّروا عمَّا أوهمهم به السامريُّ من خصوصية هذه القبضة، وأنَّه إنما ألقاها لتُلاقي الغرضَ الذي أخبرهم به، فرأوا طرحَهم قذفًا، وطرحَه إلقاءً.
ثم لما عبَّر السامريُّ عن فعله قال: {فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِنْ أَثَرِ الرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا}[طه: 96]، والنبذ مُشعِرٌ بقلة الاعتداد[23]، وهذا هو المتوقع منه؛ إذ إنَّه لا يعوّل على ما نبذه أكثر مما يُلَبِّس عليهم بنسبة الأثر إليه، فهو في قرارة نفسه -وإن تظاهر بغير ذلك- لا يعتدُّ بتلك القبضة لا في قليلٍ ولا كثيرٍ.
وبعدُ، فلا أدّعي الصواب المطلق في الطرح الذي طرحتُه، ولكن مجرد إقرار المخالف باحتماله؛ صالحٌ لنقض ما أسَّس عليه أخي الدكتور اليماني طرحَه.
ولا يَرِد على هذا الفهم شيء إلّا ويمكن إيراد مثله على مَن وظَّفوا الإسرائيليات في هذا الموضع؛ إلا القول بمخالفة تفسير السلف في جُزءٍ منه. وهذا خارج محلّ النزاع؛ لأن محلّ النزاع في صلاحية هذا الموضع بمفرده من سورة (طه) في إثبات أن تكون الإسرائيليات طريقًا واحدًا لتفسير بعض ألفاظ القرآن الكريم.
وعليه؛ ففي تقديري، فإنَّه لا يكفي الارتفاق على الموضع الذي اعتمده فضيلة الدكتور خليل اليماني للقطع بالنتيجة التي خرج بها، ولا غنى عن دراسة موسّعة للقضية، بمنهجية مُقنّنة.
وختامًا؛ أسأل اللهَ العلي العظيم أن يبارك في جهد الشيخ الكريم وعلمه، وأن يكتب لنا وله الأجر والقبول، وأن يوفقنا وإياه وجميع مشايخنا وعلمائنا إلى العلم النافع والعمل المتقبَّل، وأن يُرينا الحقَّ حقًّا ويرزقنا اتّباعه، وأن يرينا الباطل باطلًا ويرزقنا اجتنابه.
وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين
[1] انظر: الإسرائيليات في التفسير بين ضرورة التوظيف وإمكان الاستغناء (ص64). وسأكتفي بعد ذلك في الإحالة إلى بحث الدكتور اليماني بكلمة (البحث).
البحث منشور بـ (قسم البحوث) بالموقع، ويمكن مطالعته عبر الرابط: tafsir.net/research/25.
[2] انظر: التحرير والتنوير (16/ 296)، والعهد القديم سفر الخروج الإصحاح الثاني والثلاثون، ترجمة الجامعة الأنطونية (ص143-145). والكتابات التي وقفتُ عليها -في حدود علمي واطلاعي- تنفي وجود التفاصيل الكثيرة المذكورة في كتب التفسير في التراث الكتابي المكتوب، وهناك إشارات قليلة متفرّقة للقصة في بعض الكتب والأبحاث لا تشي بالكثير في القصة، بَلْه ما يدخل منها في محلّ النزاع؛ لذا لم أرَ التطويل بالإشارة إليها. ولا غنى عن سؤال المتخصصين في هذا المجال.
[3] مع أنّ الظاهر لي أنَّ ذلك يخالف التعريف الذي يرتضيه الدكتور اليماني؛ لتقييده الإسرائيليات بما ورد ذكره في كتب بني إسرائيل (انظر: البحث: ص2، حاشية 1). والله أعلم.
[4] على أقل التقديرات فإنَّ ميلاد موسى -عليه السلام- قبل نحو 1300 سنة من ميلاد المسيح، أي: قبل نحو 1900 سنة من ميلاد النبي -صلى الله عليه وسلم-، 1950 سنة من وفاته -صلى الله عليه وسلم-. وبالنظر إلى أنَّ تداول هذه المرويات في الساحة العلمية الإسلامية بدأ بعد وفاة النبي -صلى الله عليه وسلم-، ولم يبلغ ذروته إلّا بعد ذلك بفترة؛ فنستطيع أن نُقدّر الفترة بين واقعة السامريّ وانتقالها كمرويات للتفسير القرآني بأكثر من ألفي عام على أقلّ تقدير.
[5] البحث (ص5).
[6] انظر على سبيل المثال: تفسير ابن أبي حاتم (7/ 2430).
[7] انظر على سبيل المثال: تفسير الطبري (16/ 139).
[8] معاني القرآن وإعرابه للزجاج (2/ 377).
[9] انظر على سبيل المثال: تفسير مقاتل (3/ 38)، والكشف والبيان للثعلبي (18/ 45)، والهداية إلى بلوغ النهاية (7/ 4684).
[10] التحرير والتنوير (9/ 110).
[11] انظر: تفسير الطبري (16/ 150).
[12] معاني القرآن وإعرابه للزجاج (3/ 372).
[13] انظر: البحث (ص38، 39).
[14] مع أنَّ المنطق يقضي بأن يقع في رُوعه أنَّ التأثير للراكب أو للفرس أو للحافر لا للتراب، فتأمَّل! ثم تأمل أيضًا أنَّنا لو سلَّمنا بأنَّه رأى جبريل ولم يره سائرهم، فكيف لم يروا هم الأرض تخضرّ في إثر حافر الفرس مع أنهم كانوا في أرض يغلب عليها قلة النبات، وأمر كهذا يكون ملحوظًا للجميع؟!
[15] وذهب بعضهم إلى أنَّه كان من القبط، وقد خرج مع بني إسرائيل؛ لتعلُّقه بهم أو لصناعة يصنعها لهم. انظر: التحرير والتنوير (16/ 280).
[16] التحرير والتنوير (16/286).
[17] البحث (ص54).
[18] قرأ حمزة والكسائي وخلف بالخطاب، والباقون بالغَيبة. انظر: النشر في القراءات العشر (5/ 1807)، طبعة الدكتور الجكني.
[19] يذكر العهد القديم أن عدد بني إسرائيل حين خرجوا من مصر كان نحوًا من ستّمائة ألف نسمة. فإذا اجتمع أعيانهم في هذا المجلس فلا غرو أنَّهم كانوا من الكثرة بحيث لا يسمعون منه إلا بشيء من المجاهرة.
[20] قال الطبري: «ذلك أن بني إسرائيل لما أراد موسى أن يسير بهم ليلًا من مصر بأمر الله إياه بذلك، أمرهم أن يستعيروا من أمتعة آل فرعون وحليّهم، وقال: إن الله مُغْنِمُكم ذلك، ففعلوا، واستعاروا من حليّ نسائهم وأمتعتهم». [تفسير الطبري 16/ 135-136]. وفي الإصحاح الثاني عشر من سفر الخروج ما يدلّ عليه. فلعلّ هذا هو المدخل الذي دخل منه السامريّ إلى حَملهم إلى إلقاء الحليِّ، أن يثير عليهم شبهة الحرام فيها، فيسهل عليهم طرحها، وخصوصًا إذا أوهمهم أنَّه يمكن أن يصنع منها ما تَحـُلُّ فيه روح الربّ بزعمه، وأزَّهم استبطاؤهم عودة موسى -عليه السلام-. ونحن هنا لا نستدلُّ بالإسرائيليات، فالقول الذي ذهبنا إليه مؤسَّس دونها، وهي تفيد مزيد البيان، لا أصله، وهذا كلُّه لا يأتي على محلّ النزاع. والله أعلم.
[21] انظر: المفردات للراغب الأصفهاني (ص662).
[22] انظر: المفردات للراغب الأصفهاني (ص745).
[23] انظر: المفردات للراغب الأصفهاني (ص788).
كلمات مفتاحية
الكاتب:

محمود عبد الجليل روزن
الأستاذ المساعد بقسم علوم وتقنية الأغذية بجامعة دمنهور - مصر، وحاصل على عالية القراءات، وله عدد من المؤلفات والبحوث العلمية المنشورة.
مواضيع ذات صلة
((المعلومات والآراء المقدَّمة هي للكتّاب، ولا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع أو أسرة مركز تفسير))