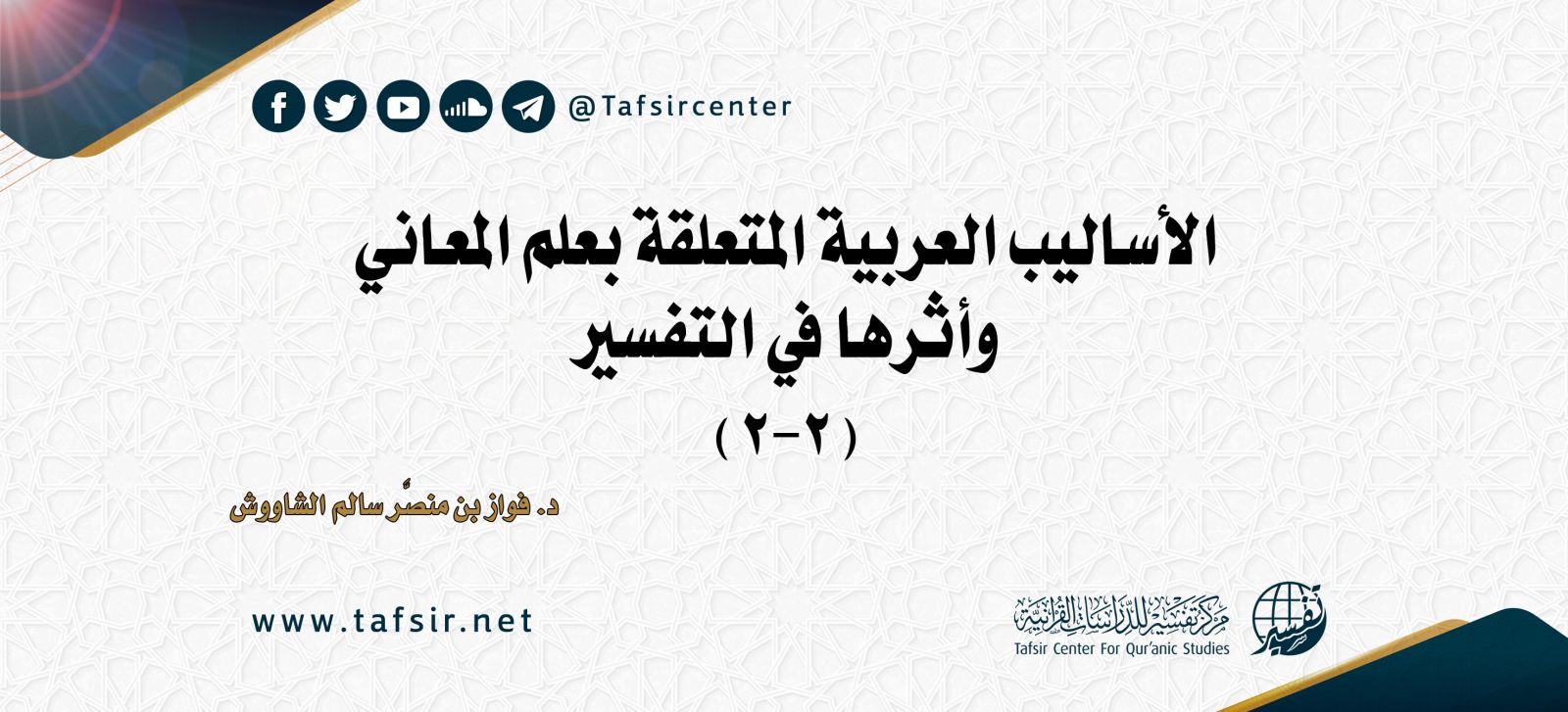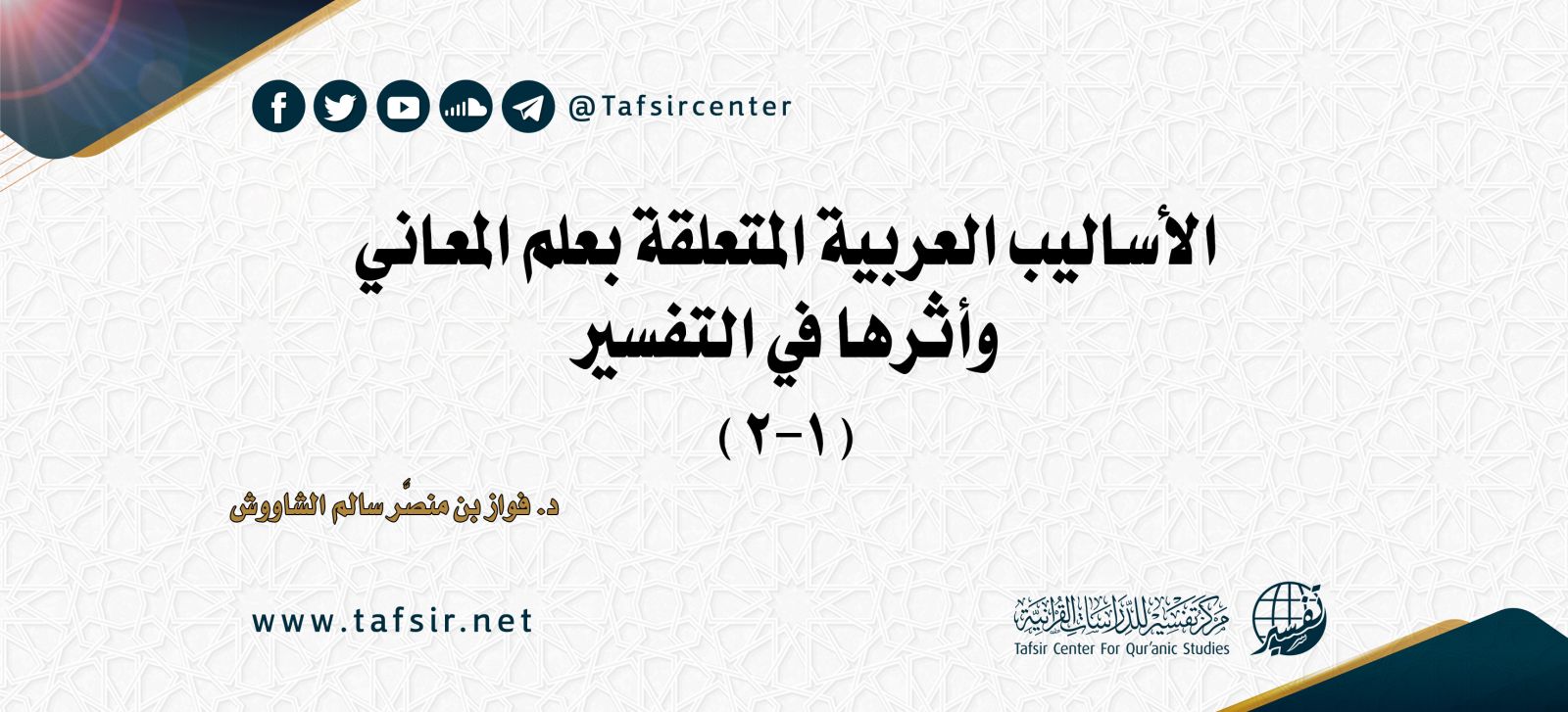الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير للدكتور محمد أبو شهبة
عرض وتقويم
الكاتب: محمود حمد السيد

بين يدي الموضوع:
موضوع الإسرائيليات من أكثر الموضوعات إشكالًا في علم التفسير، وعلى الرغم من شيوع النقد للإسرائيليات تنظيرًا في العديد من المؤلفات والمقولات إلَّا أننا يمكننا القول بوجود تبايُن للرؤَى تجاه هذا الموضوع، ما بين مؤيّد ومعارض، فثَمّ مفسِّرون قد حشدوا هذه المرويات الإسرائيلية في تفاسيرهم ووظّفوها في بيان معاني القرآن الكريم، وقد كان هذا الخطّ سابقًا في الطرح على الخطّ الناقد لهذه المرويات؛ إذ يرجع إلى السلَف الصالح من الصحابة والتابعين، وإلى أمثال الطبري وغيره من المفسرين المتقدّمين، فهؤلاء جميعًا رووا الإسرائيليات، ولم يجدوا غضاضة في ترجيح الأقوال التفسيرية المستقاة منها، ولا في الاقتصار عليها في بعض المواطن من كتاب الله تعالى، وظلّ الأمرُ على هذا مدةً لم يتخلّق تجاه المرويات الإسرائيلية في التفسير كثيرُ نقدٍ أو استهجان، بل لم يكن للفظة الإسرائيليات كبيرُ حضور في بعض التفاسير المتقدّمة، فمن يتصفح تفسير الطبري كلّه لا يكاد يقع إلا على مواطن محدودة جدًّا ورَدَ فيها هذا اللفظ، ولم يحط به نقد من قِبَل الطبري -رحمه الله-، ثم إنّ النظر لهذه المرويات قد اختلف بمرور هذه الحِقبة وما بعدها، فبدأ النقد للمرويات الإسرائيلية في الظهور شيئًا فشيئًا، وأخذ ينمو ويتزايد إلى أن انعقد تمامه فصار الغالبَ -إن لم يكن الوحيد- على التوجُّه العام عند النظر لهذه المرويات وتناولها، وبدا النقد لها صريحًا من خلال كثيرٍ من التنظيرات عند ابن تيمية وابن كثير وغيرهما من العلماء والمفسّرين، ثم في العصر الحديث وامتدادًا لهذا الخط الرافض للإسرائيليات ظهرت العديد من المؤلفات الناقدة للإسرائيليات في التفسير، وتعالت الدعوات بضرورة تنقية كتب التفسير منها، وبُولِغ في رفضها للحدِّ الذي جعل البعض يطالب بتحريق هذه التفاسير التي تحويها، وللحدّ الذي جعل تصفيتها منها مسارًا علميًّا في عدد من الجامعات تحت مسمَّى «الدخيل في التفسير».
ويُعدّ كتاب (الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير) أحد أصداء هذا التوجّه الرافض للإسرائيليات، وعليه نسلط الضوء في هذه المقالة.
بين يدي الكتاب:
يُعد كتاب (الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير) من أهمّ الكتب المعاصرة التي صُنفت في موضوع الإسرائيليات وأشهرها، ألَّفَه محمد بن محمد بن سويلم أبو شُهبة (المتوفى: 1403هـ) أحد أساتذة التفسير وعلوم الحديث في الأزهر الشريف، وقد لقي هذا الكتاب ذيوعًا وانتشارًا واسعًا في ظلّ حالة الرفض العام للإسرائيليات فترةَ تأليفه وما بعدها، فكان -ولا يزال- عمدة للباحثين في الإسرائيليات، وتخلَّقَت عَبْرَهُ العديدُ من الرؤى والأفكار تجاه هذا الموضوع.
ولا شك في أنّ الكتاب يعدُّ مرجعًا مهمًّا جدًّا لكلّ باحث في الإسرائيليات؛ لِمَا حفل به من تنظيرٍ وتطبيقٍ خاصّ بها، ولأنه يُعَدّ خلاصة للفكر الناقد للإسرائيليات في التفسير، فقد استفاد أبو شهبة -رحمه الله- مما قاله سابقوه تنظيرًا وتطبيقًا وبنَى على ذلك كتابه، فلا غرو كان الكتاب من أهم الكتب في هذا الباب.
وينخرط الكتاب بشكلٍ واضحٍ وبإعلام مؤلفه منذ البدء في رفض الإسرائيليات وبيان زيفها وبطلانها وضرورة البُعد عنها وتجنبها عند تفسير كلام الله تعالى، وبالتالي فكلّ ما ناقشه المؤلف في هذا الكتاب من مواطن تفسيرية فيها مرويات إسرائيلية فإنما ناقشها في هذا السياق: بيان بطلانها ومخالفتها لصحيح العقل والنقل، إعذارًا منه وتحذيرًا. وهذه هي غاية الكتاب وهدف مؤلفه الرئيس، قال -رحمه الله-: «فقد رغب إليَّ فضيلة الأستاذ الدكتور الشيخ: عبد الحليم محمود، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية بالجامع الأزهر المعمور بالعلم والعلماء، أن أُوَلِّف كتابًا أُبين فيه الإسرائيليات المبثوثة في كتب التفاسير، مع تزييفها وبيان بطلانها، وقد صادف هذا البحث المفيد هوًى في نفسي...»[1].
ولتحقيق هذه الغاية اتخذ المؤلف -رحمه الله- المنهج النقدي منهجًا رئيسًا في معالجة الموضوع ومعالجة المواطن التفسيرية التي ورَدَ فيها إسرائيليات، كما حرص على حشد كلّ ما أمكنه حشده من أوجه النقد ومقولات العلماء السابقين في ردِّ الإسرائيليات وبيان بطلانها وبطلان التفسير المبنيّ عليها في كلّ المواطن التي أوردها.
وقد عالج المؤلف موضوع كتابه في ثلاثمائة وثمان وأربعين (348) صفحة، شاملة المقدمة والفهارس.
محتويات الكتاب:
استهلّ المؤلف -رحمه الله- كتابه بمقدمة أبَان فيها عن سبب تأليفه الكتاب وما أحاط بذلك من ظروف وملابسات، وأبان فيها كذلك عن خطورة الإسرائيليات وما جَنَتْهُ على الإسلام وأهله وتفسير القرآن من جنايات؛ إذ أظهرَت الإسلامَ «بمظهر الدّين الذي يشتمل على الخرافات والتُّرَّهات»[2]، وكَشَفَ عن الاتجاهات المختلفة تجاه هذه المرويات والكتب التي حوَتْها؛ فمِن داعٍ إلى تحريق هذه الكتب، ومن داعٍ إلى جمعها وإخفائها عن الناس، ومن داعٍ إلى بيان هذه الإسرائيليات والتنصيص عليها وبيان بطلانها، وهو الخطّ الذي انخرط فيه المؤلف -رحمه الله- ودعا إليه ويندرج فيه كتابه الذي بين أيدينا، ثم ختم هذه المقدمة ببيان معالم منهجه في معالجة هذا الموضوع.
ويمكننا بالنظر إلى محتوى الكتاب بعد هذه المقدمة أن نقسمه قسمين:
الأول: نظري:
استعرض فيه المؤلف -رحمه الله- معنى التفسير والتأويل ومعنى الإسرائيليات، والمراد بالموضوعات، والمنهج الذي يجب أن يُتَّبع في تفسير القرآن، والتفسير بالمأثور، وأقسامه، والتفسير بالرأي والاجتهاد، المقبول منه والمردود، ومدارس التفسير، ودخول الوضع والإسرائيليات في التفسير بالمأثور، وأسباب ذلك، وما وُجِّه إلى هذا النوع من التفسير من نقد، والآثار السيئة التي خلَّفَتْها هذه الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير وغيرها.
ثم عرَض لما قام به حفَّاظ الحديث وأئمة النقد والتعديل والتجريح من جهاد مشكور في التنبيه على الموضوعات والإسرائيليات في كتب التفسير عَبْر بيانه لطرق الرواية وأحوال الرواة الذين رووا التفسير المأثور عن الصحابة ومن التابعين، ثم عرَض لأشهر كتب التفسير بالمأثور، مبينًا بإيجاز قيمة كلّ كتاب من جهة الرواية، ولأشهر كتب التفسير بالرأي المقبول، من حيث اشتمالها على الموضوعات والإسرائيليات قلَّة أو كثرة[3].
وقد استحوذ هذا القسم على ما يقارب مائة وخمسين (150) صفحة.
واعتبر المؤلف -رحمه الله- هذه المقدمات النظرية على طولها لا بد منها «حتى يكون القارئ على بيِّنة من أمر هذه المباحث، التي ستسلمه إلى المقصد الأصلي من الكتاب في غير اقتضاب»[4].
الثاني: تطبيقي:
وهو مقصود الكتاب الأَصلي، عرَض فيه المؤلف -رحمه الله- لقرابة أربعين موطنًا من القرآن الكريم ذُكر فيها مرويات إسرائيلية، وقام في كلّ موطن من هذه المواطن ببيان بطلان المرويات الإسرائيلية وما فيها من منكرات لا تتفق مع صحيح النقل والعقل، وخطأ التفسير المبنيّ عليها، وكان منهجه -رحمه الله- في تناول هذه المواطن كالتالي:
- يُعَنْوِن لكلّ موطن بعنوان يستهلُّه غالبا بـ«الإسرائيليات في...»، ويعيِّن الموطن: (هَمّ يوسف، قصص الأنبياء،...إلخ).
- يَعرض لما جاء بشأن الموطن القرآني أو الآية من مرويات إسرائيلية، وينقل المرويات بنصها أحيانًا، ويُجملها اختصارًا أحيانًا أخرى.
- يبيِّن ما حوَتْه المرويات من منكرات ومخالفات، وينقل أقوال العلماء الذين ردُّوها.
- يبيِّن التفسير الصحيح للقرآن في بعض هذه المواطن.
ومن أمثلة المواطن التي ناقشها المؤلف -رحمه الله-:
الإسرائيليات في قصة هاروت وماروت، الإسرائيليات في بناء الكعبة: البيت الحرام والحجر الأسود، الإسرائيليات في قصة التابوت، الإسرائيليات في عِظَم خَلْق الجبارين وخرافة عوج بن عوق، الإسرائيليات في ألواح التوراة، إسرائيلية مكذوبة في سبب غضب موسى لمَّا ألقى الألواح، الإسرائيليات في سفينة نوح، الإسرائيليات في قصة يوسف -عليه السلام-.
وبعد أن فرغ المؤلف من عرض هذه المواطن ومناقشتها انتقل إلى نقاش الموضوعات في كتب التفسير، فاستهلّ بمقدمة مختصرة بين يدي الموضوع، ثم عرَض لثمانية مواضع من كتاب الله وَرَدَ بشأنها موضوعات، وقد تنوّعت بين أحاديث مرفوعة للنبي -صلى الله عليه وسلم- في فضائل سور القرآن، وفضل عليّ -رضي الله عنه-، وقصة زواجه -صلى الله عليه وسلم- من زينب بنت جحش، وبعض أسباب النزول، وبعض القراءات الشاذة المنسوبة لبعض العلماء، فبيَّنَ -رحمه الله- اختلاق كلّ هذه المرويات وبطلانها.
ثم جاءت خاتمة الكتاب.
أبرز مزايا الكتاب، وأبرز المآخذ:
يقتضي تتميم الفائدة من عَرْض هذا الكتاب أن نذكر أبرز ميزاته وشيئًا من المآخذ عليه، وذلك كالتالي:
أبرز المزايا:
كما بيَّنّا مِن قبلُ فإنّ الكتاب لا غنى عنه لكلّ باحث في شأن الإسرائيليات، فهو مرجع رئيس في بحث الموضوع ونقاشه، وقد أتاح عمل المؤلف فيه ومنهجيّته في تناوله عددًا من الميزات التي تؤكد أهميته في بابه، ومنها ما يلي:
* جمعه لعددٍ كبيرٍ من المواطن التفسيرية التي ورَدَ بشأنها مرويات إسرائيلية، وتعيين هذه المواطن والمرويات في مؤلَّف مستقلّ.
* نقاشه لكلّ موطن من هذه المواطن على حِدَة.
* تفسيره لبعض هذه المواطن بتفسيرٍ غير هذا المبنيّ على المرويات الإسرائيلية.
* جَمْعه لكلامِ كثيرٍ من أهل العلم حول هذه المواطن، لا سيما المضَعِّفين لها ولِمَا انبَنى عليها من تفسير.
وبالجملة فمِن أهم ميزات الكتاب أنه كتاب تطبيقي، تخطَّى التنظير لقضية الإسرائيليات إلى التطبيق العملي على مواطنها من كتاب الله وكتب التفسير، كما قام بتفسير عدد من هذه المواطن تفسيرًا بديلًا للوارد بشأنها في المرويات الإسرائيلية، ويتّصل بهذا الأمر بيانه لطرق الرواية وأحوال الرواة الذين رووا التفسير المأثور، وبيان ما قاله بشأنها أرباب الحديث ونقّاد الرواية، وكلّ هذا من شأنه تيسير التعرّف على مواطن الإسرائيليات في كتب التفسير والتعرّف على أوجه النقد الموجَّه إليها روايةً ودرايةً، وذلك في عددٍ كبيرٍ من المواطن ناهز الأربعين موطنًا، مما يؤكّد على أهمية الكتاب في هذا الباب، بغضِّ النظر عن مدى صحة أو خطأ ما توصَّل إليه المؤلف من نتائج، وطريقة توسُّله.
أبرز المآخذ:
موضوع الإسرائيليات موضوع طويل الذّيل، وتحتفُّ به العديد من التساؤلات والإشكالات، ونحن نظنّ أنّ كلّ إشكال من إشكالاتها قد يحتاج إلى معالجة خاصّة ومنفردة، حتى يمكننا الحكم صحةً أو خطأً على هذه المرويات الإسرائيلية، وعلى توظيف بعض المفسّرين لها في تفاسيرهم، وبنائهم التفسير عليها. والطريقة التي عالج بها المؤلف -رحمه الله- الموضوع ينتابها عددٌ من الملحوظات التي تشغب على تحقيق هذه الغاية، ومنها ما يلي:
- اتساع نطاق البحث: بيَّنّا أنّ من ميزات هذا الكتاب أنه جمع عددًا كبيرًا من المواطن التي ورد بشأنها إسرائيليات، وقد كان هذا طبيعيًّا في إطار الهدف الذي انتهض المؤلف له، وهو التنبيه على الإسرائيليات في كتب التفسير وبيان بطلانها، وهذه وإن كانت ميزة فهي في الوقت نفسه عيب قد أخلَّ بمعالجة هذه المواطن معالجة موعبة وعميقة، فليس الأمر بهذه السهولة التي تجعلنا نورِدُ كلّ هذه المواطن ثم نرميها رمية واحدة يمكن اختزالها في مخالفة هذه المرويات للعقل وضعف ثبوتها ونقد بعض العلماء لها، فبعض هذه المواطن يحتاج إلى نقاشات موسَّعة أكثر من هذا الذي قام به المؤلف -رحمه الله-؛ فمثلًا: هَمّ يوسف -عليه السلام- بامرأة العزيز موطن يحتاج إلى بسط، ففيه إجماع من السلف الذين يُحْتَكَم إلى قولهم في التفسير، كما أنّ ظاهر القرآن يؤيّده ليس فقط المرويات الإسرائيلية[5]، بل إننا لا نكون مُبعِدين إذا قلنا: إنه من أقوى الأقوال من جهة ظاهر القرآن وصحيح اللغة، وكلّ ما قيل مِن قولٍ غيره ففيه مَطْعَن مِن لغة أو مخالفة لبعض أصول التفسير وقواعده، وبمطالعة النقد الموجَّه للتفسير المبنيّ على المرويات الإسرائيلية في هَمّ يوسف -عليه السلام- نجد أنه مبني في أساسه على مخالفة ما وردَ لعصمة الأنبياء، وهو نقد أجنبي عن إطار العمل التفسيري وأسس ممارسته، ويلزم منه -إذا تُؤمِّل- مخالفةُ بعض ما أُصِّل من هذه الأسس؛ كمخالفة إجماع المفسرين من السلف، والخروج عن أصحّ وجوه اللغة إلى بعض الأقوال التي فيها مغامز من قِبَلها، وغير ذلك[6].
والمقصود أنّ مثل هذه المواطن تحتاج إلى بسط ونقاش موسَّع؛ لنردَّ قولًا له كثير من الشواهد، والمؤلف لم يكن يعمق النظر على هذا النحو في مواطن كهذه، بل إنه قد اكتفى في نقاش بعض المواطن بمناقشة سريعة لا يمكن الاكتفاء بمثلها في مثل هذه الأمور، لا سيما وبعض المواطن قد تصدَّى لتقرير ما جاء بشأنها من إسرائيليات بعضُ المفسّرين[7].
- في هذا الكتاب إشكالٌ منهجيٌّ كبيرٌ، وهو أنه معَنْون بالإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير، ومَن يطالعه من مقدّمته وحتى خاتمته لن يفهم سوى أن هذه المرويات أورَدَها المفسّرون في كتبهم وفسَّروا بموجبها القرآن الكريم، ولكننا إذا طالعنا بعض المواطن التي نصبها المؤلف -رحمه الله- دليلًا على هذا فسنجد أنه كان يورد بعض التفاصيل المنكرة التي حوَتْها بعض المرويات ثم يبيِّن ضَعفها وبطلانها، متعجبًا ومستنكرًا إيراد المفسرين لها، ونحن هنا نريد أن نقرّر أمرًا مهمًّا، وهو أن المفسرين -لا سيما الطبري ومَن نحَى نحوه- إنما يوردون هذه المرويات ويستلُّون من مجموعها معنًى، ثم هم لا يبالون كثيرًا ببعض أو بكثير من التفاصيل التي تحويها هذه المرويات، فإنها غير مقصودة لهم مطلقًا، ولكن المقصود هو المعنى الذي يستلّ من جملة النظر في هذه المرويات، فمثلًا أورد المؤلف -رحمه الله- الإسرائيليات في عِظَم خَلْق الجبّارين وخرافة عوج بن عوق[8] التي اشتملت عليها كتب التفسير عند تفسير قوله تعالى: {قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَنْ نَدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا}[المائدة: 22]، ثم أخذ يبيِّن زيفها ومناقضتها للمعقول والمنقول، وقال بعد أن أوردَ الإسرائيليات في الصفات الخَلْقية لعوج هذا: «وسواء أكان عوج بن عوق شخصية وجدت حقيقة، أو شخصية خيالية، فالذي ننكره هو: ما أَضْفَوه عليه من صفات وما حاكُوه حوله من أثواب الزّور والكذب والتجرؤ على أن يُفَسَّر كتاب الله بهذا الهراء، وليس في نصّ القرآن ما يشير إلى ما حَكَوه وذَكروه، ولو من بُعدٍ، أو على وجه الاحتمال»[9].
وقد أوردَ المفسرون هذه الروايات فعلًا، ولكن لنتأمل كيف تعاملوا معها، ولنأخذ صنيع الطبري -رحمه الله- أنموذجًا[10]، قال في تفسير الآية: «هذا خبر من الله -جلّ ثناؤه- عن جواب قوم موسى -عليه السلام- إذ أمرَهم بدخول الأرض المقدّسة: أنهم أبَوا عليه إجابته إلى ما أمرَهم به من ذلك، واعتلّوا عليه في ذلك بأن قالوا: إنّ في الأرض المقدّسة التي تأمرنا بدخولها، قومًا جبارين لا طاقة لنا بحربهم، ولا قوة لنا بهم، وسموهم (جبّارين)؛ لأنهم كانوا لشدّة بطشهم وعظيم خلقهم -فيما ذُكر لنا- قد قهروا سائر الأمم غيرهم.
وأصل (الجبّار) المصلح أمْرَ نفسه وأمْرَ غيره، ثم استُعمل في كلّ مَن اجترَّ نفعًا إلى نفسه بحقٍّ أو باطل طلبَ الإصلاح لها، حتى قيل للمتعدي إلى ما ليس له -بغيًا على الناس، وقهرًا لهم، وعتوًّا على ربه- (جبّار)، وإنما هو (فعَّال) من قولهم: (جبَرَ فلان هذا الكَسْر)، إذا أصلحه ولأَمَه، ومنه قول الراجز:
قد جبرَ الدينَ الإلهُ فجَبَر وعوَّر الرحمنُ مَن ولي العَوَر
يريد: قد أصلح الدينَ الإلهُ فصلح. ومن أسماء الله -تعالى ذكره- (الجبار)؛ لأنه المصلح أمْرَ عباده، القاهر لهم بقدرته»[11].
ثم راح الطبري -رحمه الله- يذكر المرويات التي بلَغَتْه في عِظَم خلق هؤلاء القوم، والتي نقَل بعضَها المؤلفُ، ونحن نلاحظ هنا أن ابن جرير قدَّم لهذا ببيان معنى الجبار وأصلها في لغة العرب ثم أوردَ المرويات في عِظَم خلقهم، فلا يمكن هنا أن يقال إنّ ابن جرير يعتقد صحة ما في هذه المرويات من تفاصيل خلق هؤلاء القوم بما جاء في المرويات، أو أنه يفسر القرآن بموجبها، ولا هو اختص عوجَ هذا بحديث، وإنما جاء ذكره في معرض المرويات التي حكاها، هو فقط يستنبط منها أنّ وصفهم بالجبارين هنا كان لعِظَم خلقهم وقوتهم مع شدّة طغيانهم وبطشهم، أما تفاصيل خلقهم فإنه لا يعنيه كثيرًا، ولو كان يعنيه لفعَل ابن جرير في هذا فِعْلَه في كلّ موطن يُختلَف فيه بين الأقوال، فمعلوم أنه قد ذكر في مقدمة تفسيره أنه سيُورد الخلاف ويرجّح بينه، وقد التزم هذا في غالب تفسيره، والمرويات التي وردت في شأن هؤلاء القوم والتي تبيِّن عِظَم خلقهم مختلفة في تفاصيلها، ومع هذا فالطبري لم يعلّق ولم يرجّح؛ لأنه غيرُ مَعْنيّ بهذه التفاصيل، وهذا منهجه في غالب المواطن التي من هذا القبيل.
وبعد هذا البيان والتوضيح نقول: إنه كان لزامًا على المؤلف أن يتحرّى الدّقة فيما ينسُبه للمفسرين بشأن الإسرائيليات، فهم لا يعتبرون هذه التفاصيل، وإنما يستلُّون معاني من مجمل المرويات، فإن كان نقده لهم لمجرد روايتهم لها فكان عليه بيان ذلك، أمّا القول بأنهم يُورِدون هذه التفاصيل مفسرين بها القرآن فقولٌ غير دقيق ولا يعبِّر عن واقع الحال؛ ولذا نجد كثيرًا من المفسرين إذا انتهوا إلى مثل هذا قالوا: (وقد قيل:...) ويُوكِلون علمه إلى الله. وهذا مَلحظ خطير للغاية في هذا الكتاب، بل هو مَعْقِد إشكال في كثير إن لم يكن جميع ما كُتِب من نقد للإسرائيليات، ونظنّ أن تصويب النظر لهذه التفاصيل هو ما حفَّز الهِمم تجاه هذه المرويات، بما نتج عنه حالة سخط كبيرة لدى مُطالِعي كتُب التفسير، وهذا إنما يصح إذا نُظر للإسرائيليات بشكلٍ عامٍّ كأخبار، أمَا وإنها قد أُلْصِقَت بالتفسير وخُصّت به في كتاب، فالواجب إذن تَبَيُّن ما قصَد إليه المفسرون من توظيف لهذه المرويات، والتعامل معهم وَفْقه فقط، والتمييز عند نقدهم بين المقامات المختلفة: مقام الرواية، ومقام التوظيف، ومقام الترجيح والتبنِّي.
- طريقة معالجة المواطن مجافية لروح علم التفسير:
بيان معاني القرآن الكريم هو صُلب عملية التفسير وأساسه، والتفسير علمٌ مستقلّ له خصوصيته وله حيثياته التي تميِّزه عن غيره من العلوم، وبالتالي فيجب على مَن يتصدى لمعالجة قضاياه أن يعالجها من داخل هذا البيت وفي رحابه، وبتأمُّل معالجة المؤلف لكثيرٍ من المواطن التي أوردها بل للموضوع برُمَّته فسنجدها معالجة بعيدة -نوعًا ما- عن روح علم التفسير، ولعلّ هذا قد اتضح -شيئًا ما- من خلال النقطتين السابقتين، وهو أكثر وضوحًا عند النظر لأغلب أوجه النقد التي بنَى عليها المؤلف نظره للمرويات، والتي يمكن إجمالها في:
o مخالفة العقل؛ لِمَا في هذه المرويات من الغرائب والعجائب والمنكَرات الظاهرة.
o مخالفة المتقرّر من عصمة الأنبياء، ومتقرّر الاعتقاد في صفات الله وملائكته.
o ضَعف ثبوت هذه المرويات، واستدعاء المقولات الحديثية حولها.
فهذه الوجوه هي ما يدندن حوله المؤلف في غالب نقده، ولكن تفسير القرآن الكريم عملية معقَّدة ومتشابكة، ويحتفُّ بها الكثيرُ من الأدلة والدلالات التي توجه الآيات إلى معانٍ معيَّنة، وتجعل بعض المعاني أقوى من بعض، وعند النظر لما أصَّلْناه من أنّ المفسرين يستلُّون من المرويات معاني، فإنّ هذه المعاني توضع في ميزان المفسِّر كأقوال، وعلى المفسِّر أن يُعْمِل فيها مِعْوَله بحسب مقرّرات هذا العلم: من مراعاة اللغة في جانبها، وأقوال النبي -صلى الله عليه وسلم- فيما يختصّ به بيانه، وتفسير القرآن بالقرآن وما أُصِّل بشأنه من تقريرات، ودلالة السياق، وأسباب النزول وأقوال الصحابة والتابعين وحُجِّيتها، وكثير من الأمور الأخرى التي ينبغي أن يدور النقاش في فلَكها، وهو ما يفتقده الناظر في هذا الكتاب.
- أطال المؤلف -رحمه الله- في القسم النظري من الكتاب بما يمكن اعتباره استطرادًا خارجًا عن الموضوع، فقد استغرق هذا القسم ما يزيد على مائة وخمسين (150) صفحة، لا يتعلق بالإسرائيليات منها سوى صفحات قليلة، بيَّن فيها المؤلف معنى الإسرائيليات وأقسامها وبعض ما يتعلق بها، والباقي في بيان أمور تتتعلق بالتفسير ومدارسه وأقسامه وغير هذا مما بيَّنّاه في عرض محتويات الكتاب، وكان أَولى بالمؤلف إمّا الاقتصار على التطبيق يَسبقه تنظير مختصر عن الإسرائيليات، وإمّا التوسع في التنظير قبل التطبيق، ولكن في خصوص موضوع الإسرائيليات وليس التفسير عمومًا وما يتصل به.
- أكثر المؤلف -رحمه الله- من نقد المرويات الإسرائيلية لمخالفتها العقل، ومخالفة العقل دلالة يستدلّ بها العلماء في تضعيف الأقوال والآراء، ولكن التوسُّع في استخدامها -لا سيما في خصوص موضوع الإسرائيليات- قد يكون خاطئًا؛ ذلك أنّ المقصود في التفسير كما بيَّنا هو المعنى وليس التفاصيل التي تمتلئ بها هذه المرويات، وأيضًا فبنُو إسرائيل قد عُلِم عنهم وعن زمانهم بما ثبت في القرآن والسنة كثرةُ الأمور العجيبة والتي لو عُرِضَت على العقل لَرُبما ردَّها أيضًا: كرفع الجبل، ونزول مائدة من السماء، وسَيْر الحجر بثوب موسى -عليه السلام-. وكلّ ذلك ثابت بالقرآن وبالسنة الصحيحة، فالواجب مراعاة هذا البُعد، حتى لا يتم الاعتماد على دلالة العقل والارتكان إليها بقدرٍ أكبر مما تستحقه.
- في الكتاب تعميم غير موضوعي للنتائج والأحكام من خلال عبارات يُوردها المؤلف في ثنايا كلامه، فالمؤلف الذي ذكر في مقدمته أنّ هذا الموضوع ليس بالأمر الهيِّن الذي يقوم به فرد واحد ولكنه يحتاج إلى جهود متعاونة متضافرة من جماعة متخصصين في الأصلَيْنِ الشريفين: القرآن والسنة، وعلومهما وغيرهما من العلوم الإسلامية[12]، نراه قد استلَّ هذه المرويات من كتب التفسير ثم كال التُّهَم لمُورِدِيها بغير تفريق بين حِقبة السّلف وما تلاها، أو بين المفسرين تمييزًا لبعضهم عن بعض، فالكلُّ مخطئ إذ أوْرَدَ هذه المرويات، هكذا دون دراسة لمنهج كلّ حقبة أو كلّ مفسر! كما أنه خاض في جوانب متعددة حديثية وتفسيرية وتاريخية.
- لم يبيّن المؤلف -رحمه الله- معايير اعتباره لمرويَّة من المرويات أنها إسرائيلية، وكان يكتفي في مدخل كلّ موطن بالقول إنه يظنّ أن هذا عن أهل الكتاب أو أنه من الإسرائيليات المنكَرة ونحو هذا من العبارات، وبما أنّ كتابه قد حوَى هذا الكَمَّ الكبيرَ من المواطن والمرويات، فكان الأَولى بيان منهجه في استخلاصها والحكم عليها بأنها إسرائيلية.
هذه بعض المآخذ المختصرة والكلّية على الكتاب. والملحوظاتُ التي يمكن أَخْذُها على تناول المؤلف -رحمه الله- بل وعلى جُلّ مَن تناولَ الإسرائيليات بهذه الطريقة -كثيرةٌ، وفيما ذُكر كفاية، غير أننا نودُّ التأكيد على أن دراسة الإسرائيليات بهذه الطريقة المتحيّزة منذ البداية ضدّ هذه المرويات وعَبْر أدوات وطرق خارجة عن صلب عملية التفسير التي هي نظر في معاني القرآن، كما في كتاب أبي شهبة وغيره من الكتب المشابهة سيؤول إلى إشكالات ولن يحلَّ إشكال الإسرائيليات المعرفي؛ ذلك أننا أمام مرويات تَتَابَع كثيرٌ من السلف على إيرادها إبّان تناولهم لمعاني القرآن الكريم، ثم نحن أمام مفسِّرين أجلَّاء أوردوا هذه المرويات واعتمدوا فَحْواها، وكلّ ما يقال في سياق تبرير صنيعهم غير مقنع تمامًا، ولا يمكن قبوله ببداهة العقل؛ إِذْ لا يُعْقَل أنَّ الصحابة أو التابعين أو أئمةً في العلم والتفسير من أمثال الطبري -وهُمْ مَنْ هُمْ علمًا بالدين وعملًا به- تسلَّلَت هذه المرويات إلى ألسنتهم وإلى كتُبهم في حين غفلةٍ، وهُم غيرُ مُدرِكين لِمَا تحمله من منكَرات أو مخالفات ظاهرة لا تخفى ربما على أحد عوام المسلمين!
ثم إنَّ القول بعدم الحاجة لهذه المرويات قول على إطلاقه غير دقيق، ولو كان صوابًا لانفكَّ منها هؤلاء المفسرون وما رجعوا إليها ووظفوها[13].
إنَّ كثيرًا من المفسِّرين لم يستطع تجاوز هذه المرويات على الرغم من إبداء بعضهم تحفظًا تجاهها، وهذا ما اشتكى منه الشيخ الذهبي -رحمه الله- في كتابه، قال -رحمه الله-: «إذا نحن تتبَّعْنا كتُبَ التفسير على اختلاف مناهجها، وتبايُن مشاربها، وجدنا الكثير منها يذكُر أصحابُها في مقدماتها مناهجَهم التي نهجوها في تفاسيرهم، ووجدنا طائفة منهم غير قليلة تذكر من منهجها: أنها سوف تَضْرِب صفحًا عن ذِكر الإسرائيليات في تفسيرها، ومع ذلك نرى غالب هؤلاء الذين وَعَدوا بنبذ الإسرائيليات وعدم إقحامها تفاسيرَهم يتورطون في ذِكرها، لا ليُحذِّروا منها، ولا ليُنبِّهوا على كذبها، وإنما يذكرونها -وكأنها وقائع صادقة وحقائق مسلَّمة- بلا نقد لها، وبغير أسانيدها التي تُيسِّر لمَن ينظر فيها معرفة صِدقها من كذبها، بل لا أكون مبالغًا، ولا متجاوزًا حدّ الصدق إن قلتُ: إنَّ كتب التفسير كلَّها قد انزلق مؤلِّفوها إلى ذكر بعض الإسرائيليات، وإنْ كان ذلك يتفاوت قلَّة وكثرة، وتعقيبًا عليها وسكوتًا عنها»[14].
فهلَّا سَألْنا أنفسنا: لِمَ انزلق الجميع إلى ذكرها؟ أوَليس هؤلاء أرباب هذا الفنّ وأكثر الناس علمًا به وممارسةً له؟ هل انخدع الجميع في هذه المرويات بهذه الطريقة على ظهور نكارة كثير منها؟ أم خفي علينا نحن من العلم ما نحتاج إلى تبيُّنه؟! ألَا يدعونا هذا إلى مراجعة الأمر برُمَّته والتبيُّن الدقيق لدور هذه المرويات وأهميتها في التفسير وأدلّة إعمالها عند كلّ مفسّر، لا أن نمضي في سبيل التشنيع عليها ضاربين بنهج كثيرٍ من المفسرين عَبْر العصور المتتابعة عرض الحائط؟
لا بد أنّ في الأمر ما فيه مما يستدعي نظرًا مغايرًا ودراسات أكثر عمقًا وارتباطًا بحيثيات علم التفسير ومضامين مدوّناته ومناهج مؤلِّفيها، وهذا ما ندعو إليه في هذه المقالة والملف الذي تندرج فيه، وإنْ لم نفعل فسيبقى الإشكالُ عالقًا؛ بين القبول المطلَق كما في صنيع بعض المفسرين، والرفض المطلَق كما في الكتاب الذي بين أيدينا وغيره.
[1] الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير (ص: 4).
[2] الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير (ص: 5).
[3] الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير (ص: 10) بتصرف يسير.
[4] الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير (ص: 10).
[5] نقصد هنا ما أفادته المرويات الإسرائيلية من أن يوسف هَمَّ بامرأة العزيز همًّا بعزم، بقطع النظر عن تفاصيل المرويات في بيان كيفية همِّه -عليه السلام-.
[6] من أشهر ما قيل في تفسير الآية -بعيدًا عن المرويات الإسرائيلية- أنّ في الآية تقديمًا وتأخيرًا، والتقدير: (ولقد همت به، ولولا أنْ رأى برهان ربّه لهَمَّ بها)، وهو ما رجَّحه المؤلف في مناقشته لهذا الموطن من التفسير، ومن المعلوم أنهم اختلفوا في جواز تقديم جواب لولا عليها، وردَّه كثيرٌ من المفسرين، وجوَّزه البعض، ولكن المقصود هنا أن ما أفادته المرويات الإسرائيلية لم يُطعن فيه من هذه الجهة -جهة اللغة- كما طعن في هذا القول، فهو إذن أسلم من هذا الذي رجَّحه المؤلف، إن غضَضْنا الطرف عن موضوع العِصمة. وقيل: (إنّ همّ يوسف كان خاطرًا نفسيًّا مما لا يؤاخذ به المرء)، وقد تُتُـبِّع أيضًا، وليس هذا موطن بسط النقاش في الأقوال ولا ترجيح بعضها على بعض، وإنما المقصود بيان قوة القول المأخوذ من الإسرائيليات وفقًا لقواعد التفسير، مما يحتاج في نقاشه وردِّه إلى كثيرٍ من البسط، لم يقم به المؤلف -رحمه الله-.
[7] ينظر صنيع المؤلف في تعليقه على موطن وسوسة إبليس لآدم وحواء وتلبُّسه في الحيَّة (ص: 180)، وهو من المواطن التي أصَّل لها الطبري تأصيلًا قويًّا ورائعًا، وفيه شبه إجماع من السلف، لم يخالف إلا ابن إسحاق على سبيل الشكّ، وقد ناقشه الطبري -رحمه الله-، ينظر: تفسير الطبري (1/524) وما بعدها.
[8] ينظر: (ص: 184) وما بعدها.
[9] الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير (ص: 187).
[10] أكثَرْنا من الحديث عن الطبري والاستدلال به في هذه المقالة؛ لِمَا له من مكانة كبيرة في التفسير، ولأنه أحد أبرز مُورِدي الإسرائيليات المؤسّسين لمعاني القرآن وَفْقَها، ولأنه -وهذا الأهمّ- أكثر المفسرين في نظرنا طردًا لمنهج التعامل مع هذه القضايا، واتساقًا في التعامل معها في طول التفسير وعَرْضه. وفي تعامل كثير من المفسرين مِن بعده مع هذه المرويات نوع اضطراب، ولبيانه موضعٌ آخر لعلّه يتيسر في مقالة مستقلة إن شاء الله تعالى.
[11] تفسير الطبري (10/171، 172).
[12] الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير (ص: 6، 7).
[13] لمزيد من التوضيح ينظر بحث: الإسرائيليات في التفسير بين ضرورة التوظيف وإمكان الاستغناء، منشور على موقع مركز تفسير على هذا الرابط: tafsir.net/research/25.
[14] الإسرائيليات في التفسير والحديث (ص: 95).
كلمات مفتاحية
الكاتب:

محمود حمد السيد
باحث في التفسير وعلوم القرآن، شارك في عدد من الأعمال العلمية المنشورة.
مواضيع ذات صلة
((المعلومات والآراء المقدَّمة هي للكتّاب، ولا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع أو أسرة مركز تفسير))