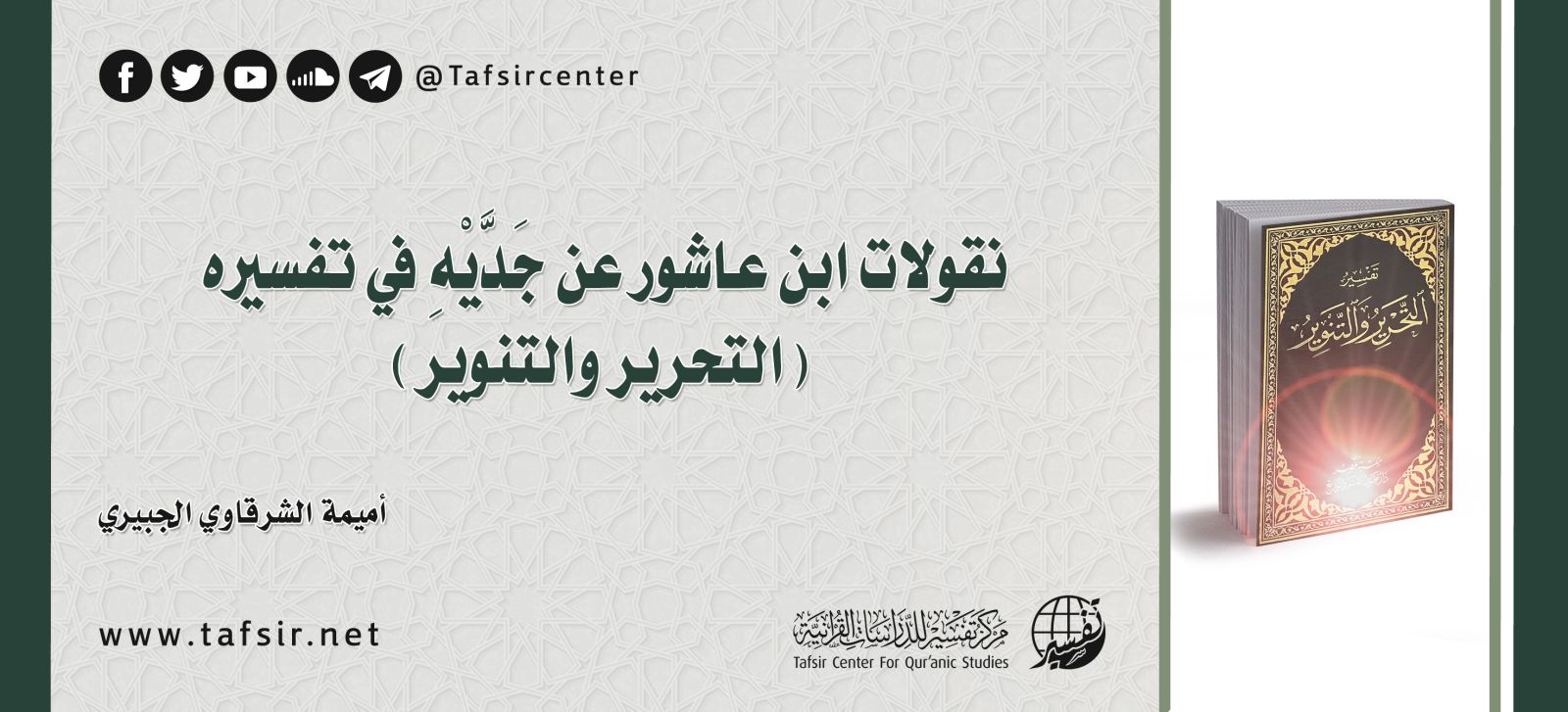قراءة نقدية لتأصيل ابن تيمية لتوظيف الإسرائيليات في التفسير (1-3)
منطلقات ابن تيمية في بحث المسألة؛ عرض وتحليل
الكاتب: خليل محمود اليماني

تمهيد:
يُعَدّ حضور المرويّات الإسرائيلية وتوظيفها في تفسير السلف أحد أبرز أبواب الدَّرْس التفسيري التي أثارت نقاشًا وجدلًا واسعًا حولها، فهي من أكثر مياسم الجدل وأنساق الإشكال في باب التفسير التي تناوبَتْ عليها الأقلامُ وقاربَتْها العديدُ من الكتابات والدراسات القديمة والمعاصرة.
والناظر في هذه المسألة لا يفتأ يلاحظ الفجوة الهائلة بين الواقع التنظيري والواقع التطبيقي لهذه المرويات في تفسير السّلف وكتب التفسير التي اعتنت بإيراد مقولاتهم من أمثال الطبري وغيره، ففي الواقع التطبيقي نلحظ أنّ هذه المرويات مثَّلَت حضورًا طاغيًا في تفسير السلف؛ حيث تتابعوا على توظيفها في التفسير بصورة ظاهرة، وكذلك بعض أئمة التفسير المبرّزين من أمثال الطبري وابن عطية وغيرهم، وفي الواقع النظري هناك نقد ظاهر لدى العديد من الدارسين قديمًا وحديثًا لتوظيف هذه المرويات في التفسير، وأنها بلا جدوى ولا أهمية ويمكن الاستغناء عنها، كما أن هذا النقد يغلب عليه الإجمال في التناول ومهاجمة إيراد الروايات الإسرائيلية وتوظيفها، دون بيان لأُطُر التوظيف لهذه المرويات والمنهج الذي حَكَم مَن قاموا بتوظيفها، وكيفيات ذلك ومسالكه عندهم؛ ومن هنا يمكننا أن نقرِّر ما ذكرَتْه مقدمةُ كتاب (مراجعات في الإسرائيليات) من أنَّ «جُلّ مَن ناقش المفسِّرين في الإسرائيليات من المعاصرين قرَّر النتيجة وأصدر الحُكم بخطَئِهم قبل تبيُّن مراداتهم وفَهْم أغراضهم...، وشاهِدُ ذلك أنك لو سألْتَ أحدَ المنتقِدين عن عِلَّة إيراد المفسِّر لتلك الأخبار، أو كيفية إيراد المفسِّر لها...، ما وجدْتَ جوابًا يشفي الغليل»[1].
ولهذا كان من المهمِّ النظر في هذا التأصيل النظري لهذه المرويات، وتأمُّل كيفيات مقاربته للمسألة، وطرائق معالجته وتناوله لها، لا سيما وأن الساحة تخلو من أي مقاربات تقويمية لهذا التأصيل تبحث منطلقاته وتحلّل الأُسس المنهجية التي قام عليها صرح مقولاته.
ومِن أبرز مَن اعتَنى بالتقعيد والتأصيل للمرويات الإسرائيلية في التفسير لدى السلف من القُدَامَى على نحو متوسِّع هو ابن تيمية -رحمه الله-، حيث انبرى للكتابة عنها وتحرير القول فيها، لا سيما في مقدمته الشهيرة بــ«مقدمة في أصول التفسير»[2].
وسبب كتابة ابن تيمية لهذه المقدمة -كما يقول في بدايتها- هو طلب البعض منه أن يكتب لهم «مقدمة تتضمّن قواعد كلية، تُعِين على فَهْم القرآن ومعرفة تفسيره ومعانيه، والتمييز في منقول ذلك ومعقوله بين الحقّ وأنواع الأباطيل، والتنبيه على الدّليل الفاصل بين الأقاويل؛ فإنّ الكتب المصنَّفة في التفسير مشحونة بالغَثِّ والسمين، والباطل الواضح والحقّ المبين»[3].
ومن بين القضايا التي تعرَّض لها ابن تيمية في مقدمته مسألة المرويات الإسرائيلية في تفسير السلف، حيث اعتَنى بالكلام عليها والتأصيل لها اعتناءً ظاهرًا، فقام بتقسيم المرويات وبيان درجة الاحتجاج بها، ومسالك روايتها في تفسير السلف، وطرَح بشأنها بعض المقررات النظرية؛ كبيان أنها تُذْكَر للاستشهاد لا الاعتقاد، وأنها كانت في جوانب غير مؤثِّرة ليس من ورائها كبير فائدة، وغير ذلك مما أَوْرَد مما سيأتي تفصيله.
وقد حظِي التأصيل التّيْمي بحضور ظاهر لدى مَن قارب المسألة بَعده؛ فغالب بَحَثَةِ المسألة ممَّن جاؤوا بعده -بِغَضّ النظر عن مواقفهم من هذه المرويات الإسرائيلية نقدًا أو دفاعًا عن مُورِدِيها- يلتزمون تقسيمَه الثلاثي للمرويات الإسرائيلية، ويتَّكِئُون على تأصيله من أنَّ حضور هذه المرويات في التفسير كان للاستشهاد، وأنه كان في جوانب غير مؤثِّرة في الدّين، وغير ذلك مما أَورَدَه في مقدمته[4]؛ ولذا فإنّ دراسة التأصيل التّيْمي هي على الحقيقة دراسة لجُلِّ التأصيل النظري حول المسألة.
وسوف نسعى في مقالاتنا هذه لدرس البحث والتناول التَّيْمي لتوظيف المرويّات الإسرائيلية في تفسير السلف وتقويمه؛ لنتبيَّن الموقف من هذا البحث وما له وما عليه.
وفي هذه المقالة الأولى سنقوم بتحرير المنطلق العامّ للمعالجة التيميّة لهذه المسألة، وبيان ذلك على النحو التالي:
المرويات الإسرائيلية في تفسير السلف ومنطلق النّظر لها عند ابن تيمية[5]:
إنّ المتأمِّل لكلام ابن تيمية حول مسألة الإسرائيليات في تفسير السلف يجد أنه يَنْصَبُّ على التعاطي مع المرويات باعتبارها مجالًا لنقل المضامين والمعلومات بصورة نقليّة بحتة، لا استدلاليّة تقوم على توظيف المرويّة ومعلوماتها في بيان المعنى تبعًا لقرائن ومسوِّغات تكون لدى المفسِّر، وسوف ننقل نصّ كلامه بِطُولِهِ من مقدمته في التفسير التي أصَّل فيها للموضوع، ونعلِّق عليه بما يُبرِز طريقته التي ذكَرْنا في النظر للمرويات الإسرائيلية في التفسير، ثم نتبعه بعد ذلك بتحليل بعض مقولاته الأخرى وتأصيلاته المؤكِّدة لذلك، وبيان ذلك على النحو التالي:
يقول ابن تيمية -رحمه الله-: «الاختلاف في التفسير على نوعين: منه ما مستنده النقل فقط، ومنه ما يُعلَم بغير ذلك؛ إِذ العلم إمّا نقل مصدَّق وإمّا استدلال محقَّق، والمنقول إما عن المعصوم وإما عن غير المعصوم، والمقصود بأنَّ جنس المنقول سواء كان عن المعصوم أو غير المعصوم، وهذا هو النوع الأول، منه ما يمكن معرفة الصحيح منه والضعيف، ومنه ما لا يمكن معرفة ذلك فيه. وهذا القسم الثاني من المنقول، وهو ما لا طريق لنا إلى الجزم بالصِّدق منه، عامَّتُه مما لا فائدة فيه، فالكلام فيه من فضول الكلام.
وأما ما يحتاج المسلمون إلى معرفته، فإنّ اللهَ نَصَبَ على الحقّ فيه دليلًا، فمثال ما لا يفيد ولا دليل على الصحيح منه: اختلافهم في لون كلب أصحاب الكهف، وفي البعض الذي ضَرَب به موسى من البقرة، وفي مقدار سفينة نوح وما كان خشبها، وفي اسم الغلام الذي قتَله الخضر، ونحو ذلك. فهذه الأمور طريق العلم بها النقل، فما كان من هذا منقولًا نقلًا صحيحًا عن النبي -صلى الله عليه وسلم- كاسم صاحب موسى أنه الخضر فهذا معلوم، وما لم يكن كذلك بل كان مما يُؤخَذ عن أهل الكتاب؛ كالمنقول عن كعب ووَهْب ومحمد بن إسحاق وغيرهم ممن يَأخُذ عن أهل الكتاب، فهذا لا يجوز تصديقه ولا تكذيبه إلَّا بحُجّة، كما ثبت في الصحيح عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (إذا حدَّثكم أهلُ الكتاب فلا تُصدِّقوهم ولا تُكذِّبوهم، فإمّا أن يحدِّثوكم بحقٍّ فتُكذِّبوه، وإما أن يحدِّثوكم بباطل فتُصدِّقوه)...والمقصود أنَّ مثل هذا الاختلاف الذي لا يُعلَم صحيحُه ولا تُفيد حكاية الأقوال فيه، هو كالمعرفة لِمَا يُرْوَى من الحديث الذي لا دليل على صحّته، وأمثال ذلك.
وأما القسم الأول الذي يمكن معرفة الصحيح منه فهذا موجود فيما يُحتاج إليه ولله الحمد، فكثيرًا ما يوجد في التفسير والحديث والمغازي أمورٌ منقولة عن نبينا -صلّى الله عليه وسلّم...»[6].
ومن خلال النصّ السابق لابن تيمية نلاحظ ما يلي:
أولًا: يجعل ابنُ تيمية مرجع الاختلاف في التفسير على نوعين: النقل، والاستدلال؛ إذ العلم -كما ذَكَر- إما نقل مصدَّق وإما استدلال محقَّق، وقد انصبَّ كلامُه فيما أَورَدْنا في النوع الأول، إلا أنه بعد ذلك أفاض في الكلام على النوع الثاني؛ حيث قال: «وأمّا النوع الثاني من مستندَي الاختلاف، وهو ما يُعلم بالاستدلال لا بالنقل، فهذا أكثر ما فيه الخطأ من جهتين...»[7].
ثانيًا: قَسَم ابن تيمية الاختلاف الراجع إلى النقل -من حيث القدرة على التحقُّق من صحته وضعفه سواء كان واردًا عن المعصوم أو غيره- إلى قِسمَين: الأول: ما يمكن معرفة صحيحه من ضعيفه. الثاني: ما لا يمكن معرفة صحيحه من ضعيفه. ثم بيَّن بعض الأمور التي تتعلق بالقِسم الثاني؛ أبرزها:
الأول: أنَّه لا طريق للبَتِّ في أمر صحته.
الثاني: لا فائدة منه والكلام فيه فضول.
الثالث: أنه لا تقوم الديانة به.
وظاهر جدًّا مما سبق أنَّ منطلَق نَظَر ابن تيمية للمرويات الإسرائيلية في التفسير قائم على أنها تمثِّل مادة معلوماتية ينقلها المفسّر ضمن التفسير، وشاهِدُ ذلك ما يلي:
أولًا: مقابلته في الخلاف في التفسير بين النقل والاستدلال، وجَعْله الوارد عن المرويّات -كالاختلاف الحاصل في التفسير في لون كلبِ أصحاب الكهف وغيره- ضِمْنَ الأول، وهذه المقابلة مشكلة في التفسير ولا واقع لها كما سنبيِّن لاحقًا؛ إذ الاختلاف في التفسير مرجعه استدلالي بالأساس؛ لأننا متى جاوَزْنا النقل عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في التفسير -وهو قليل جدًّا- فإن سائر ما عدا ذلك من مقولات تفسيرية يُنْتِجها المفسّرون هي اجتهاد منهم لا أكثر تبعًا لقرائن واستدلالات تتعلق بهم. إن هذه المقابلة التي ذكرها ابن تيمية وجَعْله المرويات الإسرائيليات ضمن الأول تعني بوضوح:
- أنَّ المفسرين من السّلف قاموا بنقل مضامين المرويات الإسرائيلية ومعلوماتها في التفسير.
- صار لدينا -تبعًا لنقلهم- تفسير نقليّ مستقِلّ بذاته ومُستمَد من المرويات الإسرائيلية يقابل مقولاتهم التفسيرية الاستدلالية.
وهذا ظاهر جدًّا في أنَّ مبنى النظر عنده للمرويات الإسرائيلية أنها تحمل مضمونًا يقوم المفسرُ بنقله وإيراده في التفسير.
ثانيًا: قَسَم ابن تيمية الخلاف الراجع للنقل إلى ما يُعرف صحيحه من ضعيفه لوروده في الأحاديث النبوية كاسم صاحب موسى وأنه الخضر، وما لا يعرف فيه ذلك لوروده عن المرويات الإسرائيلية. وجَعْلُه معيار معرفة الصحة والضعف أساسًا لتقسيم ذلكم الخلاف -دالٌّ على نظرته النقلية عن المرويات؛ ذلك أنه أضحى لديه تفسيرًا منقولًا نقلًا محضًا عنها، وحيث إنه يريد بيان الموقف من هذا الخلاف والتعامل معه، فمن الطبيعي أن يرجع المعيار في التقسيم للقدرة إلى معرفة الصحة والضعف في المرويات المنقول عنها، وإلَّا فالمقولات التفسيرية والمعاني المُنتَجة اجتهادًا لا يكون معيار قسمتها من زاوية ضبط التعامل معها من الأدوات التي وُظِّفَت في إنتاجها، وإنما من خلال قرائن الاستدلال ذاتها.
ثالثًا: كلامُهُ عن القسم الثاني من الخلاف الراجع للنقل والذي تقع فيه المرويّات الإسرائيلية، وأنه لا سبيل للبَتِّ في صحته، وأنه لا فائدة فيه ولا تقوم به الديانة -دالٌّ كذلك على نظرته النقلية عن المرويات؛ للآتي:
- المعاني التفسيرية الاجتهادية يكون الموقف منها إمّا القبول لها أو الردّ أو التوقُّف في شأنها بحسب الدلائل التي بين أيدينا، ولا يكون الموقف منحصرًا في التوقّف وعدم القدرة على البتِّ في شأن صحتها، اللهم إلا لو كانت منقولةً نقلًا محضًا عن مصدر لا يمكننا معرفة صدق مضمونه من عدمه، وبالتالي تأخذ حكمه.
- لا مدخل لتقييم المرويات الإسرائيلية والولوج لمضامينها وبيان أنَّ استيعابها فضول، أو مقابلتها بالمنقولات الشرعية وبيان أنها دونها وأنها بلا فائدة في الدِّين إلا إذا كانت تمثِّل حضورًا في التفسير، وجرى النقل المباشر عنها.
ومن هاهنا فإنَّ كلامَ ابن تيمية عن القسم الثاني وجَعْله لا طريق للبتِّ في صحته كالمرويات الإسرائيلية ذاتها ومقابلته بالمنقول الشرعي وبيان أنه دونه وأن الكلام فيه فضول وأنه بلا فائدة في الدِّين -دالٌّ بوضوح على تبَنِّيه النظرة النقلية عن المرويات الإسرائيلية، وأن صنيع المفسرين كان قائمًا على الاستمداد المحض من مادة المرويات والنقل عنها.
ومما يدلّ كذلك على أن منطلَق نَظَرِ ابن تيمية للمرويّات الإسرائيلية في التفسير قائم على أنها تحمل مضمونًا ينقله المفسِّر في التفسير، ما يلي:
الأول: تأصيلاته ومقرّراته النظرية حول المرويّات الإسرائيلية في تفسير السلف:
فقد نظّر ابن تيمية للمرويات الإسرائيلية في تفسير السلف في مقدمته وقرّر بشأنها بعض التأصيل النظري، والذي يدلّ عند تأمُّله على ما قرَّرناه مِن منطلَقه؛ وذلك على النحو التالي:
أولًا: قوله بأنّ الإسرائيليات تُرْوَى للاستشهاد لا للاعتماد والاعتقاد:
فهذه المقولة قد قرَّرها ابن تيمية بوضوح، حيث قال: «غالب ما يرويه إسماعيل بن عبد الرحمن السُّدِّي الكبير في تفسيره عن هذَين الرَّجُلَين: ابن مسعود وابن عباس، ولكن في بعض الأحيان ينقل عنهم ما يحكونه من أقاويل أهل الكتاب التي أباحها رسول الله -صلى الله عليه وسلم-... ولهذا كان عبد الله بن عمرو قد أصاب يوم اليرموك زامِلتَيْن من كتب أهل الكتاب، فكان يحدِّث منهما بما فهمه من هذا الحديث من الإِذْن في ذلك، ولكن هذه الأحاديث الإسرائيلية تُذْكَر للاستشهاد لا للاعتقاد...»[8].
والمتأمل لهذه المقولة يجدها تأتي متّسقة تمامًا مع النظر التيمي السابق للمرويات؛ فالمرويات لـمَّا كان مناط النظرِ محكومًا بأنها تمثّل موردًا ينهل منه المفسِّر المعلومات وينقلها في التفسير فلا بد أن تكون مادةً استشهادية فقط ولا يعتقد مضمونها، فهذه المرويات مما لا يُعلم صِدْقُه مِن كَذِبِه؛ وبالتالي فغاية المفسِّر أن يَسْتَشْهِدَ بها على أمرٍ مقرَّرٍ عندنا لا يَسْتَدِلَّ بها؛ لأنها مادة يتعذَّر إمكان التأسيس تبعًا لها، وكذلك لا يعتقد بصحة مضامينها.
ثانيًا: تقسيمه للمرويات الإسرائيلية باعتبار مضمونها:
يقسم ابن تيمية المرويات الإسرائيلية في التفسير بشكلٍ ثلاثي؛ وأنَّ منها ما عَلِمْنَا صحتَه مما بأيدينا مما يشهَد له بالصدق فذاك الصحيح، وأنَّ منها ما علمْنَا كذبه بما عندنا مما يخالفه وأنه المرفوض الذي لا يجوز قَبُوله ولا روايته، وأن منها ما هو مسكوت عنه لا من هذا القَبِيل ولا من هذا القبيل، فلا نؤمن به ولا نُكَذِّبه وتجوز حكايته.
يقول ابن تيمية: «هذه الأحاديث الإسرائيلية تُذْكَر للاستشهاد لا للاعتقاد، فإنها على ثلاثة أقسام:
أحدها: ما عَلِمْنا صحته مما بأيدينا مما يشهد له بالصدق فذاك صحيح.
والثاني: ما علمنا كَذِبه بما عندنا مما يخالفه.
والثالث: ما هو مسكوت عنه لا من هذا القَبِيل ولا من هذا القَبِيل، فلا نؤمن به ولا نكذِّبه وتجوز حكايته؛ لما تقدم. وغالب ذلك مما لا فائدة فيه تعود إلى أمرٍ ديني؛ ولهذا يختلف علماء أهل الكتاب في مثل هذا كثيرًا، ويأتي عن المفسِّرين خلاف بسبب ذلك، كما يذكرون في مثل هذا أسماء أصحاب الكهف، ولون كلبهم، وعِدَّتهم، وعصا موسى من أيّ الشجر كانت، وأسماء الطيور التي أحياها اللهُ لإبراهيم، وتَعْيِين البعض الذي ضُرِب به القتيل من البقرة، ونوع الشجرة التي كلَّم الله منها موسى، إلى غير ذلك مما أبهمه اللهُ في القرآن، مما لا فائدة في تَعيِينه تعود على المكلَّفِين في دنياهم ولا دينهم، ولكنَّ نَقْل الخلاف عنهم في ذلك جائز»[9].
وهذا التقسيم قائم بوضوح على النظر للمرويات باعتبارها مجالًا لاستمداد المعلومات؛ إذ مبناه على النَّظَر لمضامين المرويات ذاتها، والحُكم على كلّ مضمون والواجب إزاءه في كلّ قسم؛ ولهذا جرى تقسيمها ثلاثيًّا بحسب ذلك؛ فما وافق منها شَرْعَنا قَبِلْناه وجوَّزْنا روايته، وما خالفه ردَدْناه ومنَعْنا حكايته، وما لم نجد في موافقته أو مخالفته دليلًا قاطعًا توقَّفْنا فيه وجوَّزْنا روايته.
إنه تقسيم يستحضر المضامين ويؤسّس المعيار اللازم إزاء الحكم على الخبر الإسرائيلي ذاته ومضمونه وما يحمله من معلومات؛ ولهذا تجد ما يقاربه لدى بعض العلماء قَبْل ابن تيمية ممن اعتنوا بتأطير الإفادة والنقل لبعض المعلومات عن هذه المرويات بصورة عامّة، ومن ذلك قول ابن حزم -رحمه الله- وهو بصدد بيان موقفه من المعلومات والمضامين الواردة في هذه المرويات: «ما نزل القرآن والسُّنة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- بتصديقه صدَّقْنا به، وما نزل النصّ بتَكْذِيبه أو ظهر كذِبُه كذَّبْنا به، وما لم ينزل نصّ بتصديقه أو تكذيبه وأمكن أن يكون حقًّا أو كذبًا لم نصدِّقهم ولم نكذِّبهم وقلنا ما أمَرَنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن نقوله»[10].
ومن هاهنا، فإنّ هذا التقسيم المضموني للإسرائيليات ذاتها واستحضاره في التفسير دالٌّ على انطلاقة ابن تيمية النقلية عنها في التفسير، وإلَّا فإنّ تقسيمها باعتبارها أداة موظَّفة في بيان المعنى يكون ليس باعتبار مضمونها في ذاتها، وإنما علَاقتها بالبيان ذاته، وارتباطها بمساحات مخصوصة منه مثلًا أو بنوع معيَّن من الآيات أو غير ذلك من الاعتبارات التي تدور في فلَك البيان ودورها فيه، فالمفسِّر المستدِلّ والموظِّف لبعض الأدوات في التبيين كالأشعار الجاهلية أو غيرها، لا صلة له أصلًا بمضامين هذه الأدوات التي يُبيِّن من خلالها ويَستدِلُّ بها ومقدار موافقتها أو مخالفتها للشرع، ولا تُناقَش المسألة معه من هذه الزاوية أبدًا، إلَّا لو تصورناه ناقلًا نقلًا مباشرًا لمضامين المرويات.
ثالثًا: قوله إنّ غالب رواية الإسرائيليات مما لا فائدة له في الدّين:
يقول ابن تيمية -كما مرّ معنا في تقسيمه السابق للمرويات الإسرائيلية-: «...والثالث: ما هو مسكوت عنه لا مِن هذا القَبِيل ولا من هذا القبيل، فلا نؤمن به ولا نكذِّبه وتجوز حكايته؛ لما تقدّم. وغالب ذلك مما لا فائدة فيه تعود إلى أمرٍ ديني؛ ولهذا يختلف علماء أهل الكتاب في مثل هذا كثيرًا، ويأتي عن المفسّرين خلاف بسبب ذلك، كما يذكرون في مثل هذا أسماء أصحاب الكهف...، إلى غير ذلك مما أبهمه اللهُ في القرآن، مما لا فائدة في تَعيِينه تعود على المكلَّفِين في دنياهم ولا دينهم، ولكنَّ نَقْل الخلاف عنهم في ذلك جائز».
إنَّ حديثَ ابن تيمية عن قيمة المرويات الإسرائيلية التي يجوز روايتها وأنَّ مضامينها بلا فائدة وأنَّ الدِّين غنيّ عنها ولا يحتاجها -ظاهرٌ جدًّا في حضور منطلَق النقل عن المرويات في التفسير عنده، وإلَّا فأدوات المفسّر في البيان من شعر جاهلي وغيره لا تعقد مقارنة بين مضامينها والمضامين الشرعية؛ لأنه مستدِلٌّ بها وموظِّفٌ لها لا ناقلٌ عنها. إنّ نزوع ابن تيمية لبيان قيمة المرويات التي يجوز روايتها، وأنّ يقرر بشأنها مثل هذا التقرير وأنها لا تحمل فائدة في الدِّين، سببه نظرته النقلية عنها في التفسير لدى السلف، وبالتالي تصدَّى لبيان درجة هذا النقل وأنه بلا كبيرِ جدوى ولا يسدُّ حاجةً في الشريعة، وأنه تعلّق ببيان مبهَمات لا يعود على المكلَّفِين فائدة دينية أو دنيوية من وراء تَعيِينها، حتى لا يفتح بابًا للظنّ بنقص الدين وحاجته لمكمّلات، لا سيما وأنّ الأمر متعلِّق بالسلف.
ثانيًا: تأصيله لمسألة عصمة الأنبياء من الذنوب:
تتابَع السلفُ في تفاسيرهم للمَواطن التي تتعلق بالأنبياء وما تعرَّضوا له من فِتن على التصريح بهذه الفتن وذِكْرها وبيانها، وهم في ذِكر مقولاتهم يستحضرون المرويات الإسرائيلية، ومن ذلك كلامهم على فتنة داوود وأنها كانت في المرأة، وتفسيرهم لهَمِّ يوسف وأنه كان في حَلِّه لسراويله وإقدامه على مواقعة امرأة العزيز، وغير ذلك مما هو معلوم. وقد كانت تفسيرات السلف لجُلِّ هذه المواطن بمثابة إجماعات تفسيرية ظاهرة؛ حيث أطبقوا -بمختلف طبقاتهم- على ذِكر ذلك، ولم يَرِد عنهم قول غيره في التفسير[11].
وقد كانت هذه المَواطن من أكثر المواطن التي استشكلها نَقَدَة المرويّات الإسرائيلية في التفسير من أمثال الرازي وغيره، حيث تتعارض مع رؤيتهم لعصمة الأنبياء وعدم جواز وقوع مثل هذه الذنوب منهم، وبالتالي يقطعون برفض المرويّات وتوجيه سهام النقد لمن أوردها بصورة بالغة الشدّة، بدعوى أنها تحمل مضمونًا خادشًا لمقام النبوة والواجب إزاء عصمتهم، ويرُدُّون مقالة السلف باعتبارها مما أخذوه ونقلوه عن مرويات بني إسرائيل المعارِضة لديننا.
ومسألة عصمة الأنبياء من الذّنوب كانت إحدى المسائل العَقدية التي اعتَنى ابن تيمية بطرقها في كتاباته وتوسّع في الكلام والتدليل عليها، لا سيما وأنه اتّجه فيها لقولٍ مخالفٍ للعديدِ ممن سبقه من العلماء كما هو معلوم؛ حيث نحا إلى القول بأن عصمة الأنبياء تكون في عدم الإقرار على الذنوب مطلقًا لا في عدم فعلها منهم، ومن ذلك قوله: «والقول الذي عليه جمهور الناس وهو الموافق للآثار المنقولة عن السلف إثبات العصمة من الإقرار على الذنوب مطلقًا»[12].
وقد توسّع ابن تيمية في بيان هذا الرأي وشرح دلائله، وقد اعتمد في إثباته إجمالًا على استقراء النصوص الشرعية، حيث بيَّن أنّ القرآن الكريم يصرِّح بذِكْر ذنوب للأنبياء، وعلى استغفارهم وقبول توبتهم منها[13]، وأن الأحاديث والآثار تؤكِّد أنّ التوبة النصوح ترفع العبد لأعظم مما كان عليه، وبالتالي فإن ارتكاب الذنب ليس قادحًا في عصمة النبي أبدًا طالما أنه تاب منه وقُبِلت توبته.
يقول ابن تيمية: «...وكذلك ما احتجُّوا به من أنّ الذنوب تنافي الكمال، أو أنها ممَّن عَظُمَت عليه النعمة أقبحُ، أو أنها تُوجِب التنفير أو نحو ذلك من الحجج العقلية، فهذا إنما يكون مع البقاء على ذلك وعدم الرجوع، وإلَّا فالتوبة النصوح التي يَقبلها اللهُ يرفعُ بها صاحبَها إلى أعظم مما كان عليه، كما قال بعض السلف: كان داوود -عليه السلام- بعد التوبة خيرًا منه قبل الخطيئة. وقال آخر: لو لم تكن التوبة أحبّ الأشياء إليه لَمَا ابتلَى بالذنب أكرم الخَلق عليه. وقد ثبت في الصحاح حديث التوبة: «لَلَّهُ أفرح بتوبة عبده من رجلٍ نزَل منزِلًا...»، وقال طائفة من السلف منهم سعيد بن جبير: إنّ العبد ليعمل الحسنة فيدخل بها النار، وإنّ العبد ليعمل السيئة فيدخل بها الجنة؛ يعمل الحسنة فيُعجَب بها ويفتخر بها حتى تُدخِله النار، ويعمل السيئة فلا يزال خوفُه منها وتوبته منها حتى تُدخِله الجنة... وفي الكتاب والسُّنة الصحيحة والكتب التي أُنزلت قبل القرآن مما يوافق هذا القول ما يتعذّر إحصاؤه»[14].
والمتأمِّل في معمار التأصيل التيمي للمسألة يجده خاليًا تمامًا من الاحتجاج بإجماع السلف في التفسير على التصريح بنسبة الذنب للأنبياء وتواترهم على ذلك، كما في تفسيرهم لفتنة داوود وهَمِّ يوسف مثلًا، واكتفاءه بالإشارة للآثار النظرية عنهم والمؤكِّدة لأفضلية حال العبد بعد التوبة النصوح لا غير. فعلى الرغم من لجوء ابن تيمية للاحتجاج بمقولات السلف التفسيرية واهتمامه بالاعتماد عليها في نقاشاته العقدية بصورة رئيسة، وكذلك قوة الاحتجاج بها في مسألة عصمة الأنبياء من الذنوب على نحو خاصّ وظهوره، إلا أنه عزف عن الاستناد لذلك وتقرير المسألة من خلاله.
وعزوف ابن تيمية عن اللجوء لأحد أبرز مستنداته في التأصيل لعصمة الأنبياء من الذنوب وأمضاها -ربما- في بيان خطأ الرأي المقابل له، وأنه مخالف لإجماع السلف، واعتماده على مطلق تحليل النصوص والآثار النظرية للسلف لا التفسيرية= هو منطلقه في النظر للمرويات الإسرائيلية في التفسير؛ فابن تيمية يراهم نَقَلَة في التفسير عن المرويات، لا أنَّ ما ذَكروه هو خلاصة رأيهم التفسيري للآية والمعبِّر عن موقفهم منها؛ ولهذا فإنّ ما نقلوه:
- لا يؤسّس نظرًا شرعيًّا بذاته يُستنَد في الاحتجاج به في التقرير والتأسيس للمسألة، وإنما غايته التعضيد والتأنيس لما هو مقرّر في ديننا بإزائها لا أكثر؛ فالإسرائيليات ليست من الأدلة الشرعية، وغايتها كما يقول ابن تيمية أنها: «يُعتضَد بها ولا يُعتمَد عليها»[15]، و«تُذكَر على وجه المتابعة لا على وجه الاعتماد عليها وحدها»[16].
- يجب محاكمته للنصوص الشرعية فمتى وافقها قُبِل ومتى خالفها رُدّ؛ وفي ضوء هذا يُفهَم عدم استشكال ابن تيمية لما نقَله السّلف في بعض المواطن المتعلقة ببعض الأنبياء -مما فيه إثبات ذنبٍ لهم- كما في حال داوود وسليمان -عليهما السلام- وغيرهما؛ كونه نقلًا دائرًا في فلَك الشرع وما تدلّ عليه النصوص؛ إذ نسبة الذّنب لهم صرَّح بها القرآن، وكذلك استشكاله وحُكمه بالردِّ على بعض ما نقلوه في شأن بعض الأنبياء كيوسف -عليه السلام-[17]؛ إذ لم يَرَ نسبة الذنب له صريحة في القرآن، وهو ما سنفصل فيه القول في مقالتنا التالية.
والغرَض أنَّ عزوفَ ابن تيمية عن الاستناد إلى حُجية إجماع السلف في التفسير على نسبة الذنب للأنبياء وردَّه لبعض الوارد عنهم -مُظْهِرٌ على نحو جليٍّ منطلَقَه النقليّ عن المرويات الإسرائيلية في التفسير[18]، وهو الموقف الذي يتبنَّاه إزاء المرويات الإسرائيلية بصورة عامّة لا في ميدان التفسير فحسب، فابن تيمية دَأب على ترديد ذلك، وأن هذه المرويات مثَّلَت مجالًا للنقل المحض في غير ما موضع من كتبه ونقاشاته المتعددة لبعض المسائل مما يتعالق مع المرويات الإسرائيلية؛ ومن ذلك:
- يقول ابن تيمية: «الإسرائيليات يُعتضَد بها ولا يُعتمَد عليها»[19]، «الإسرائيليات إنما تُذكَر على وجه المتابعة لا على وجه الاعتماد عليها وحدها»[20]، وكذلك أورد ابن تيمية خبرًا إسرائيليًّا وهو بصدد مناقشته لمسألة التوسُّل، فقال: «ورُوِي في كتاب الحلية لأبي نُعَيم أن داوود قال: بحقّ آبائي عليك إبراهيم وإسحاق ويعقوب، فأوحى الله -تعالى- إليه: يا داوود، وأيّ حقّ لآبائك عليّ؟»، ثم علَّق عليه بقوله: «وهذا وإن لم يكن من الأدلة الشرعية فالإسرائيليات يُعتضد بها ولا يُعتمد عليها»[21].
- وأيضًا قوله في ردِّه على البكري، منكِرًا عليه استدلاله بالحديث الذي يرويه، عن استشفاع آدم بالنبي -صلى الله عليه وسلم-: «هذا الحديث وأمثاله لا يُحتَجُّ به في إثبات حكم شرعي، لم يسبقه أحد من الأئمة إليه... فإنّ هذا الحديث لم ينقله أحد عن النبي -صلى الله عليه وسلم- لا بإسناد حسن، ولا صحيح، بل ولا ضعيف يُستأنس به، ويُعتضَد به، وإنما نَقَلَ هذا وأمثالَه -كما تُنقَل الإسرائيليات التي كانت في أهل الكتاب وتُنقَل عن مثل كعب، ووَهْب، وابن إسحاق، ونحوهم- مَنْ أخَذ ذلك عن مُسْلِمَة أهل الكتاب أو غير مُسْلِمَتِهم كما رُوي: أن عبد الله بن عمرو وقعت له صحف يوم اليرموك من الإسرائيليات، وكان يحدِّث منها بأشياء»[22].
- كذلك قوله: «والمقصود هنا أنّ ما دخل في هؤلاء [يعني الفلاسفة القدامى] من دين الحنفاء الذي بَعث اللهُ به رسله فهو أقلّ مما دخل في الإسلام من دين اليهود والنصارى؛ ولهذا لم يكن على عهد الصحابة والتابعين مَنْ أدخلَ شيئًا من دين هؤلاء، بل كان يوجد مَن ينقل عن أهل الكتاب وعلمائهم مثل كعب ووَهْب ومالك بن دينار ومحمد بن إسحاق، ومثل ما ينقله عبد الله بن عمرو عن الكتب التي أصابها يوم اليرموك، وإنما استجاز لهذا لِمَا رواه البخاري في الصحيح عنه أنّ النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: بلغوا عني ولو آية، وحدِّثوا عن بني إسرائيل ولا حرج...»[23].
خاتمة:
ظهر لنا من خلال ما سبق أن منطلَق النظر عند ابن تيمية للمرويات الإسرائيلية في التفسير كان قائمًا على أنها تمثِّل مجالًا للنقل وأخْذِ المعلومات، وأنّ المفسرين من السلف كانوا مجرد نَقَلَة عن هذه المرويات لا موظِّفين لها في بيان المعنى.
ولا شك أنّ التصور بأن المفسِّرين كانوا نَقَلَة يبدو غريبًا جدًّا في ضوء تصوّرنا للعمل التفسيري، والذي يقوم على الاستدلال رأسًا لا النقل؛ إذ المفسِّر ليس إخباريًّا ينقل ويروي، وإنما هو يسعى لتبيين نَصٍّ له دلالات لفظيّة محدَّدة وقرائن سياقيّة وغير ذلك، وما يستحضره من مرويات وأشعار وغيرها هي أدوات يوظِّفها في التبيين لا ينقل عنها، وما يُورِدُه من مقولات هي مقولات تفسيرية تمثِّل ثمرة رأيه واجتهاده في التبيين، لا أنها مجرد نقول تُحَاكَم تبعًا للمصادر التي استُلَّتْ منها قَبُولًا أو ردًّا أو توقُّفًا، وإلَّا فإننا تبعًا لهذا النظر النقلي عن المرويات سنندفع لمحاكمة مقالة السّلف في التفسير باعتبارها أضحت منقولًا من مصدر أجنبيّ تُحَاكَم تبعًا لشَرْعِنا قَبُولًا أو ردًّا أو توقُّفًا، وأن نستدلّ لها لا بها، وأننا كذلك سنكون ملزَمِين بِرَدِّ بعض ما ذكروه حال حكمنا بالرفض على المصدر وأنه مما لا تَحِلُّ روايته، وهو ما سيضعُنا في إشكال آخر إزاء كيفية تتابع السَّلَف على نقل ورواية ما لا تَحِلّ روايته وما يخالِف الشرعَ، والمفترَض أنهُم أعلمُ الناس بالشّرع والدّين وبهم يُحْتَجُّ في تقريره.
إنّ هذه الإشكالات تثير تساؤلًا حول هذا المنطلق الذي تبنَّاه ابن تيمية في مقاربته للمرويات الإسرائيلية في التفسير ومدى صحته في بحث المسألة من خلاله، وهو ما سيكون محلًّا لنقاشنا في المقالة التالية.
[1] مراجعات في الإسرائيليات، من إصدارات مركز تفسير، ص(10).
[2] هذه التسمية ليست من وضع ابن تيمية، وإنما هي مِن وَضْع جميل الشطِّي -مفتي الحنابلة-، وقد لاقَت هذه المقدمة شهرةً كبيرةً جدًّا، حيث عقد حولها عدد من الأعمال العلمية، وتوارد على التعليق عليها عددٌ كبيرٌ من الشُّرّاح.
[3] مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية، دار مكتبة الحياة، بيروت- لبنان، ط: 1400هـ- 1980م، ص(7).
[4] يراجع حضور التأصيل التيمي عند محمد حسين الذهبي، ورمزي نعناعة، ومحمد أبو شهبة، وكذلك في بحوث ومؤلَّفات الدكتور مساعد الطيار، والدكتور نايف الزهراني، وغيرهم ممن تكلموا في المسألة أو تعاملوا معها.
[5] سوف يلاحظ القارئ تطويلًا منّا في تحرير ذلكم المنطلَق وبيانه عند ابن تيمية من أكثر من طريق؛ كونه أساسًا لما يأتي بعده من مناقشة في بقيّة المقالات.
[6] المقدمة، ص(20-26)، بتصرف يسير.
[7] مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية ص(31).
[8] المقدمة، ص(42).
[9] مجموع الفتاوى، (364/13- 366).
[10] الفصل في الملل والأهواء والنحل، (160/1).
[11] يراجع تفسيرهم مثلًا لفتنة داوود وسليمان وهَمّ يوسف في تفسير الطبري، وسيأتي معَنا تفصيل لذلك في المقالة التالية.
[12] مجموع الفتاوى (10/ 293).
[13] يقول ابن تيمية مثلًا وهو بصدد مناقشة عصمة الأنبياء من الذنوب: «والله -تعالى- لم يذكر في القرآن شيئًا من ذلك عن نبيّ من الأنبياء إلَّا مقرونًا بالتوبة والاستغفار، كقول آدم وزوجته: {رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ}[الأعراف: 23]، وقول نوح: {رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُنْ مِنَ الْخَاسِرِينَ}[هود: 47]، وقول الخليل -عليه السلام-: {رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ}[إبراهيم: 41]، وقوله: {وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ}[الشعراء: 82]، وقول موسى: {أَنْتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ * وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ}[الأعراف: 155، 156]، وقوله: {رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي}[القصص: 16]، وقوله: {فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ}[الأعراف: 143]، وقوله -تعالى- عن داوود: {فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ * فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبٍ}[ص: 24، 25]، وقوله -تعالى- عن سليمان: {رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ}[ص: 35]» مجموع الفتاوى (10/ 296).
[14] مجموع الفتاوى (10/ 295).
[15] مجموع الفتاوى (1/ 343).
[16] مجموع الفتاوى (5/ 464).
[17] يقول ابن تيمية: «وأما ما يُنقَل من أنه حَلَّ سراويله وجلس مجلس الرجل من المرأة، وأنه رأى صورة يعقوب عاضًّا على يده وأمثال ذلك؛ فكلُّه مما لم يُخبِر اللهُ به ولا رسولُه، وما لم يكن كذلك فإنما هو مأخوذ عن اليهود الذين هم من أعظم الناس كذبًا على الأنبياء وقدحًا فيهم، وكلّ مَن نقَلَهُ من المسلمين فعنهم نقَلهُ، لم ينقل من ذلك أحدٌ عن نبيِّنا حرفًا واحدًا». مجموع الفتاوى، (297/10).
[18] قد يقال إن ابن تيمية كان يسعه -جريًا على منطلقه- الاستناد حتى لمجرّد نَقْل السلف ذاته، وأنه مظهر لموقفهم من المسألة في العديد من المواضع، إلا أنه ابتعد عن ذلك -فيما يبدو- لحُكمه على وقوع بعض النقل الخاطئ عنهم في بعض المواضع وردّه لإجماعهم فيه، وهو ما يجعل موقف السلف النقلي بذلك لا يخلو من تعارض بَيِّنٍ، ولا يتركب منه اتساقٌ منهجيّ يمكن التأسيس عليه في المسألة، وهو ما قد يعكس عليه الحجة بتمامها بكلّ يُسْرٍ حالَ استنَد إليها؛ ولهذا انصرف عن الاحتجاج به.
[19] مجموع الفتاوى (1/ 343).
[20] مجموع الفتاوى (5/ 464).
[21] مجموع الفتاوى (1/ 343)
[22] الرد على البكري (2/ 581).
[23] الرد على البكري (2/ 582، 583).
كلمات مفتاحية
الكاتب:

خليل محمود اليماني
باحث في الدراسات القرآنية، عضو هيئة تدريس بجامعة الأزهر، له عدد من الكتابات والبحوث المنشورة.
مواضيع ذات صلة
((المعلومات والآراء المقدَّمة هي للكتّاب، ولا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع أو أسرة مركز تفسير))