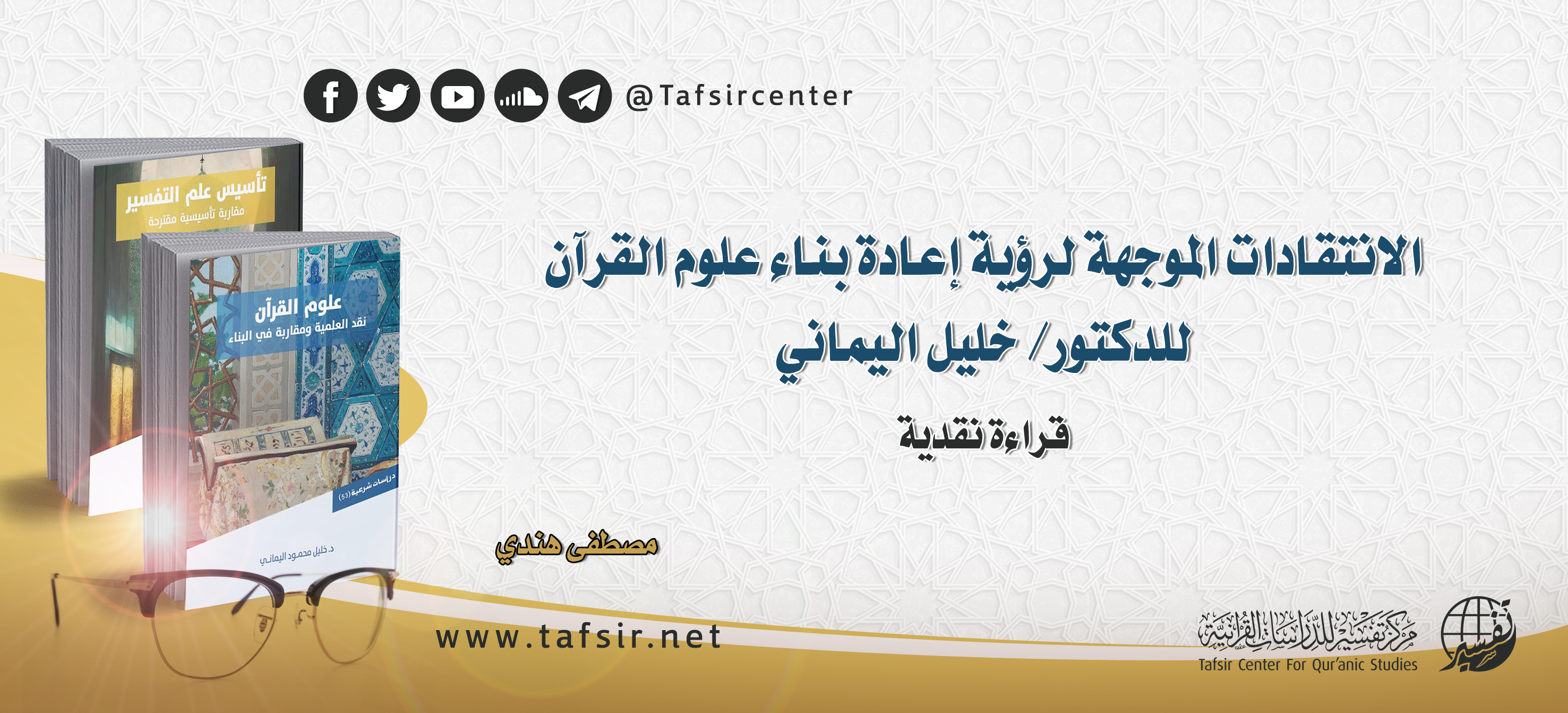الإعجاز الغيبي في القرآن بين الإثبات والنفي (1-3)
الإعجاز الغيبي في القرآن بين الإثبات والنفي (1-3)
الكاتب: محمود عبد الجليل روزن

تنبعثُ هذه المقالة في التوفيق بين آراء المتكلمين في بعض مشكلات إعجاز القرآن الكريم؛ خلوصًا إلى محاولة تثبيت وجهٍ أصيل من أوجه إعجاز القرآن، وهو الإعجاز الغيبيّ، إذ هال بعضَ الباحثين السُّيولةُ المتصاعدةُ في عدّ أوجه إعجاز القرآن دون قيدٍ ولا ضابطٍ، فكان منهم أن نَفَوْا أن يكون في القرآن معجزٌ إلا البلاغة والنظم؛ فنَفَوْا أوجهًا تتابع علماء الأمة على عدِّها من إعجاز القرآن الكريم، ومنها الإعجاز الغيبيّ معقد حديثنا.
فالمقصد الرئيس لهذه المقالة هو: إثبات أنَّ إخبار القرآن بالغيبِ مُعجِزٌ على المعنى الذي قاد إلى استظهاره النَّظرُ المنهجيُّ، ومن ثَمَّ التأهُّل للإجابة عن سؤال: هل يدخل الإخبار بالغيب في جملة المتحدَّى به من القرآن الكريم أم لا؟
ولم تتطرَّق المقالة للتقويم التفصيليّ لما يدخل في الـمُعجِز وما لا يدخل، وإن كانت قدَّمت ضابطًا عامًّا يمكن التأسيس عليه لبناء المعيار الصحيح الصالح للاضطلاع بهذه المهمة.
كما تؤكّد المقالة ابتداءً أنَّه مهما اختلفت الأقوال في شأن أوجه إعجاز القرآن، ومهما استجدّت الآراء؛ فإنَّ الإعجاز البياني هو أساس كلِّ إعجاز قرآنيّ، ففي بيان القرآن تستكنّ كل وجوه إعجازه الأخرى الصحيحة، وعلى أساس ما ندرك من تراكيبه ومفرداته يكون تصوُّرنا لآيات الله تعالى في مضمونها الذي نبحث عنه[1].
وعليه؛ فالمقالة ستنتظم -بإذن الله- في ثلاثة أجزاء متسلسلة، كل منها يعالج جانبًا من الإشكال، وبيانها كالآتي:
الجزء الأول: بعد التمهيد وضبط المصطلحات والحدود، يجيب عن سؤال: هل في القرآن الكريم إعجازٌ غيبيٌّ؟
الجزء الثاني: يجيب عن سؤال: هل يدخل الإخبار بالمغـيّبات في جملة المتحدَّى به؟
الجزء الثالث: ردّ بعض ما يُستشكل أو يَرِدُ على إجابة السؤال الثاني[2].
تمهيد:
يتجاذب تفسيرَ إعجاز القرآن -في الجملة- ثلاثةُ مذاهب: 1- فبينَ مَن ينفي أن يكون القرآنُ معجِزًا بغير النَّظم والبيان[3]، وغالبًا ما يُطلق عليه الإعجاز اللغوي أو الإعجاز البلاغي أو إعجاز النَّظم، أو الإعجاز البياني. 2- وبين مُتوسِّعٍ في إثبات ألوانٍ من الإعجاز لا تقوم بها الحُجَّة، ولا ترتكز على أصولٍ مستقيمة في النَّظَر. 3- يأتي المذهب الوسط منذ ابتكار الكلام في قضية إعجاز القرآن، وهو أنَّ للقرآن وجوهًا من الإعجاز تتجاوز إعجاز النَّظم والبلاغة، مع الوقوف بحَذَر أمام بعض وجوه الإعجاز التي يقول بها المتوسِّعون.
ولا يليق في هذا المقام المختصر أن نمثِّل بأمثلة دون أن نسوق حُجَجَ النُّظَّار وحجج مخالفيهم، وسيكون لذلك -إن شاء الله- مقامه ومقاله.
غير أنَّ جُلَّ التفاوت في الإثبات والنفي لألوان من إعجاز القرآن الكريم راجعٌ إلى عدم ضبط مفهومه وحدوده، فالحقُّ أنَّ المثبت والنافي قد يكونان على حقٍّ كلُّهم إذا احتُكم في الفصل بينهم إلى الحدود التي وضعها كلٌّ منهم لتعريف إعجاز القرآن.
والحقيقة الواضحة التي قد يُغفل عنها أنَّ حدود المفاهيم وضوابطها ومعايير اعتبارها تُكتَشَف ولا تُخترَع، فإذا رامَ باحثٌ اختراعَ ما حقُّه الاكتشافُ خرج عن نطاق البحث المنهجيّ المنضبط إلى ما يُشبه الذَّوقَ النسبيَّ الخاصَّ الذي قد يُوافَق عليه وقد لا يُوافَق.
وعليه؛ فإنَّ أوَّل منطلق لتقويمِ النَّظَر إلى ألوان إعجاز القرآن الكريم أن تُحرَّر ضوابطُه وتخطَّطَ حدودُه استكشافًا لا اختراعًا.
وتُلمِحُ القضيةُ من وجهها للمفرِّق بين ثلاثة مفاهيم حاضرةٍ في الكلام على براهين النبوة، يسقط باستظهارها -في تقديري- كثيرٌ من الاختلاف بين طوائف المتكلِّمين في اشتراط التحدِّي للمعجزة، وما يلزم منه من إسقاط كثير من معجزات النبي -صلى الله عليه وسلم- التي لم يَـتحدَّ بها. ويتأسَّس على هذا الطرحِ البناءُ الصحيحُ لبيان أوجه إعجاز القرآن الكريم، وضبط ما يدخل فيها وما يخرج منها.
وفيما يأتي نستعرض بإيجاز تلك المفاهيم الثلاثة.
الأول: مطلق مفهوم الآية:
وهي العَلَامة على صدق النبي -صلى الله عليه وسلم-، وبرهان نبوّته.
ولا يشترط للعلامة أن تكون مما يفوق قدرة المخلوقين على الإتيان به أو بمثله، كما كان صدقُ النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- وأمانتُه قبلَ نُبوَّته آيةً على أنَّه رسولٌ، فكان ذلك حاديًا كافيًا لكثيرٍ ممَّن آمنوا به وصدّقوه -صلى الله عليه وسلم-، وكما وقع في المسائل التي سأل هرقلُ عنها أبا سفيان -رضي الله عنه-، وكانت كافية لأن يقول: «فإن كان ما تقول حقًّا فإنه نبيٌّ [وفي رواية: فسَيَمْلِكُ موضعَ قدمَيَّ هاتين]، وقد كنتُ أعلمُ أنه خارجٌ، ولم أكن أظنُّ أنه منكم، فلو أنِّي أعلمُ أنّي أَخْلُصُ إليه لأحببتُ لقاءَه [وفي رواية: لتجشَّمتُ]، ولو كنتُ عنده لغَسَلْتُ عن قدَمَيْه»[4].
الثاني: مفهوم الـمُعجزة:
وهي الآية التي يَعجِز المخلوقون عن الإتيان بها من عند أنفسهم، وإنما يؤيِّد بها الله -عز وجل- المرسلين -صلوات الله عليهم- برهانًا على صدق رسالتهم.
فالمعجزة: برهان صدق المخبِر يعجز غيره عن الإتيان بمثله بإطلاقٍ.
وعليه، فالآية أعمُّ من الـمُعجزة، فكلُّ معجزةٍ آيةٌ، ولا عكس.
ومعجزة القرآن كامنةٌ في الدلائل القاطعة بتعيُّن كونه من عند الله تعالى؛ لعجز مَن سواه -سبحانه وتعالى- عن الإتيان بمثله.
وإعجاز القرآن: احتواؤه شكلًا وجوهرًا ومضمونًا على ما يُعجَزُ عن الإتيان بمثله من عند غير الله تعالى.
ولـمَّا كان القرآن يستعمل لفظ (الآية) و(البرهان)، و(السلطان) للدلالة على مفهوم المعجزة، ولما كان السَّواد الأعظم من آيات الرسل مُعجزاتٍ لا يُقدر على الإتيان بمثلها؛ جاز إطلاق المعجزة على الآية، والآية على المعجزة، ولا غضاضة في ذلك؛ فالأول اصطلاح القرآن، والثاني صفةٌ غالبةٌ، فإن اقتُصر عليه جاز من باب إطلاق الصفة على الموصوف، فهذا من الاصطلاح الذي لا مُشاحَّة فيه، ما دام الفرق بينهما مُستحضرًا عند الحاجة.
المفهوم الثالث: مفهوم الإفحام بالتحدِّي:
وهو أن يُدعَى المكذِّب بالمعجزة إلى الإتيان بمثلها فيُبلِس وينقطع، فيتحقّق صدقُ الرسول.
والصواب الذي دلَّ عليه النقل والنَّظر أنَّ المعجزة مُتحقِّقة بالتحدِّي أو دونه، فهي لا تفتقر إلى التحدِّي لتكون معجزة.
فانفلاقُ البحر لموسى -عليه السلام- وانفجار الحَجَر بضربة عصاه باثنتي عشرة عينًا، وفرار الحجَر بثوبه، ونبع الماء من بين يدي النبيّ محمدٍ -صلى الله عليه وسلم-، وانشقاق القمر، وحنين الجذع ونحو ذلك؛ مُعجزاتٌ، إذ يَعجِز أن يأتي بها غيرُ مؤيَّد من عند الله تعالى، ومع ذلك لم يتَحدَّ النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- بغير القرآن، ولم يتحدَّ موسى -عليه السلام- بشيء من المعجزات المذكورة. فاشتراط التحدِّي يُسقط جُلَّ المعجزات[5].
فالمعجزةُ تُعجِز مَن رامَ الإتيان بمثلها ولو من غير تحدٍّ، فإذا طالبه صاحب المعجزة بالإتيان بمثلها فانقطع وأُفحِم، فهو أمعن في البرهان على صدق المتحدِّي. فهذا هو مفهوم الإفحام بالتحدّي، وهو زائد عن مفهوم الإعجاز كما ترى.
فالتحدّي قدر زائد عن الإعجاز، إذ عجْزُ الـمُتحدَّى حاصلٌ قبل التحدّي، كما هو حاصلٌ بعده، ولكن إذا تحدّاهم فأُبلسوا وانقطعوا جاز أن نسمّيه إفحامًا.
فإفحام القرآنِ: إبلاس المتحدَّى بالإتيان بمثله.
ومما يتّضح به الأمر تمثيلًا: أنَّ رجلًا إذا أراد أن يحمل حملًا ثقيلًا فلم يستطع صحَّ أن يُسمّى عاجزًا، والحمل مُعجزه، فإذا باراه رجلٌ فحمل حملًا ثم تحدَّاه أن يحمله أو يحمل مثله، فحاول فلم يستطع؛ فهو فوق عجزه مُفحَم خاسرٌ للتحدِّي.
وعليه، فكلّ مُفحِمٌ مُعجِزٌ، ولكن لا يتحقّق الإفحام إلا بعد التحدِّي. وإعجاز القرآن سابقٌ للتحدِّي به، ويجوز أن نقول: الإعجاز لازمٌ، والتحدّي طارئٌ، «ولا بد أن نقرّر هنا أنَّ مفهوم الإعجاز كان قائمًا وواردًا من أول يوم نزلت فيه الآيات الأولى من سورة العلق»[6].
ويجب أن يُعلَم أنَّ عدم إقرار المتحدَّى بإبلاسه، وتشغيبه بالتُّهَم، والادّعاء الأجوف بالقدرة عليه، والإتيان بتفاهاتٍ يدّعِي بها المعارضة؛ كل ذلك لا يُغيّر حقيقة إبلاسه، كما لم يُغيّر حقيقة إبلاس الإنس والجنّ وعجزهم أن يأتوا بمثل القرآن دعوى المخالف قديمًا وحديثًا أنه سِحرٌ وشِعرٌ وافتراءٌ، وهَذَيَان مسيلمة، والفرقان الأمريكي... ونحو ذلك مما هو معلوم بطلانه وسقوطه للمخالف قبل الموافق.
هل في القرآن الكريم إعجازٌ غيبيٌّ؟
بناءً على ما تقدّم، فإنّه يكفي لإثبات الإعجاز الغيبي في القرآن أن نجد فيه إخبارًا بغيوبٍ يستحيل -بإطلاقٍ- على البشر الإخبار بها، أو يستحيل على مَن كان مثلَ النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يُخبر بها من عند نفسه.
والـمُعجزة قد تكون برهانًا في نفسها بغضِّ النَّظر عن ظرفها وملابساتها، كما كان إحياء الموتى وخَلْق الطير بإذن الله برهانًا على كَوْن المسيح -عليه السلام- رسولًا من عند الله -عز وجل- إذ لا يقدر على ذلك في الحقيقة إلا الله -عز وجل-. ووجه البرهان فيها أنَّها لما كانت خارجة عن قدرة المخلوقين كانت دليلًا على أنَّها من عند الخالقِ -عز وجل-، فإذا اقترن ذلك بإخبار الرسول بأنَّها من عند الله -عز وجل- وأنَّه مرسلٌ لإبلاغ رسالة الله -عز وجل- قامت عليهم الحُجَّة، فيحيا من حييَ عن بينة ويهلك من هلك عن بيّنة.
وقد تكون المعجزة برهانًا على صدق مَن جاء بها لحالٍ معيّنة مُلابِسة لظرف المجيء بها، كحملِ مريم بالمسيح -عليهما السلام- فحملُ المرأة البالغة أمرٌ ممكن إذا جامعها بالِغٌ، ولكن غير المعتاد أن تحمل دون ذلك، فتلك آيتُها ومُعجزتُها.
وقد يتكلم الرضيعُ مُبكِّرًا عن أنداده، ولكن أن يتكلَّم في أسبوع وضعه فهذا خارجٌ عن المعهود، ثم أنْ يتكلَّمَ بحديثٍ كحديث عيسى -عليه السلام- في مهده، فهذا أمرٌ مُعجِزٌ خارقٌ لا محالة، فهذا وجه كونه برهانًا على صدق نبوّته، وعلى براءة والدته.
وأن يتكلَّمَ القارئُ المعلَّمُ الذي وقف عمره لطلب العلم ببعض ما استفاده من علوم السابقين والباقين فيُخبر بما لا يعلمه إلا الصفوة المعلِّمون؛ فذلك أمرٌ مطروقٌ مقدورٌ. وأمَّا أن يفعل ذلك مَن استفاض العلمُ بأنَّه لا يقرأ ولا يكتبُ، ولم يجلس يومًا ليطلب هذه العلوم على أربابها، ولم يسمعها من نقَلتِها، ولم يتكهَّن؛ فهذا مُعجِزٌ خارجٌ عن قدرات الإنس والجنّ، فإذا كانت الأخبار التي يُحدِّث بها مما اندرس علمه إلا على صفوة الصفوة، أو مما طوته الأزمان الغابرة، وتراكم عليه غبار النسيان، فيأتي بها على ما كانَ؛ فهذا أقومُ بالإعجاز، لا يتوقّف عاقلٌ في القول بأنَّه مُعجزٌ لا محالةَ.
وإذا كانت تلك الأخبار مما لا سبيل إلى معرفته أصلًا بما لدى البشر ومَن في مقدورهم الاستعانة بهم كالجنِّ، من علومٍ وفنونٍ ومعارف وقدرات؛ كالأخبار عن الغيب، والأخبار عن الحوادث الماضية التي حُرّفت أو تنوسيت تمامًا، وكالكوائن المستقبلة، ثم تتقدّم علوم البشر وتتنوّع مآخذها ومناهجها فلا يوجد في القرآن مصادمٌ لحقائقها[7]؛ بل يجدون به أخبارًا يُتحقَّق صدقُ وقوعها كلها بعدُ بما يستجدُّ لديهم من معارف وعلومٍ، وبما ينكشف عنه مَرُّ الزمن؛ فهذا هو المنتهى في الإعجاز، لا سيما والمخبَر به من هذه الأنواع كثيرٌ جدًّا، وليس خبرًا واحدًا ولا اثنين ولا نحو ذلك مما يمكن أن يقال فيه: حدسٌ مصيبٌ، أو نبوءة مُوفَّقة، أو صُدفة مُواتية.
فإذا نزَّل الـمُنصِفُ هذه الحقيقةَ على القرآن الكريم حَكَم لا محالة بأنَّه كتاب مُعجِزٌ من هذا الوجه؛ أعني الإخبارَ بالمغيَّبات، ما كان منها ضاربًا في القِدَم، وما كان منها مستقبلًا، وما كان منها كامنًا في السرائر فيجلّيه ويفضحه، وغير ذلك من صنوف الغيوب.
فهو وجهٌ من وجوهِ الإعجاز القرآني لأسبابٍ؛ منها:
الأول: أنَّ الجائي به أميٌّ غير معلَّم.
الثاني: أنَّ بعض الأخبار الماضية التي يذكرها تندُّ عن علوم الصفوة، فلا تتوقَّف عند حدِّ علومهم، بل تتجاوزها وتُصوِّبها، ثم لا يملك المنصفون منهم إلا أن يُقرّوا بصوابه وبخطئهم، وبعُلوّه عليهم وهيمنته.
الثالث: أنَّ بعض هذه الأخبار الماضية مما كان علمه وقت نزول القرآن منطويًا عن البشرية جمعاء، ولم يكن مُدوَّنًا في صحفٍ يمكن الوصول إليها وقتئذٍ، ولم يكن مما يتناقله الرواة؛ بل ربما كانت مروياتهم وحسبانهم بعكس ما أثبته، فلما تطاول العُمُر بالبشرية تحقَّق لديهم بعلومهم المبتكرة صِدقُ ما أخبر به، فأقروا بأنَّهم مسبوقون.
الرابع: أنَّ الأخبار المستقبلة الكثيرة التي أخبر بها لم تزل تقع واحدةً تلو الأخرى على الوجه الذي نبَّأ به، لا يزيدها تقدُّم العلوم إلا تأكُّدًا، وتسليمًا بصحّتها، «ولا يكون ذلك على الاتفاق مع كثرة ما أخبر به عن الغير في الأمور المستقبلة فوجد مخبره على ما أخبر به من غير خُلف، وذلك لا يكون إلا من عند الله تعالى العالم بالغيوب؛ إذ ليس في وُسع أحدٍ من الخلق الإخبار بالأمور المستقبلة، ثم يتفق مخبر إخباره على ما أخبر به من غير خُلف لشيء منه»[8].
الخامس: أنَّ كلَّ ذلك متساوقٌ أوله مع آخره في ائتلافٍ تامٍّ، لا يتّفق وقوعه -فيما قضت به العادة- في كتابٍ بشريٍّ به هذا العدد الهائل من المعلومات، فهذا داخلٌ فيما يصحّ أن يُطلق عليه إعجاز الائتلاف المشار إليه في قوله تعالى: {أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا}[النساء: 82].
ومن هذا الائتلاف أنَّ الحقائق المذكورة فيه منسجمة مع السنن والقوانين الكونية الطبيعية؛ وهذا لا يكون إلا إذا كان مُنزِلُ الكتاب المسطور هو خالقَ الكون المنظور وفاطِرَه.
قال الطِّيبي شارحًا: {لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا}[النساء: 82]؛ أي: «لكان الكثير منه متناقضًا، قد تفاوت نظمه وبلاغته ومعانيه، فكان بعضه بالغًا حد الإعجاز، وبعضه قاصرًا عنه يمكن معارضته، وبعضه إخبارًا بغيب قد وافق المخبر عنه، وبعضه مخالفًا، وبعضه دالًّا على معنًى صحيح عند علماء المعاني، وبعضه بخلافه. فلما تجاوب كله بلاغة معجزة فائتة لقوى البلغاء، وتناصر صحة معانٍ وصدق إخبار؛ عُلم أنه ليس إلا من عند قادر يقدر على ما لا يقدر عليه غيره، عالم بما لا يعلمه أحد سواه»[9].
فالإعجاز الغيبي إذن وجهٌ أصيلٌ من وجوه إعجاز القرآن، سواء قلنا بأنَّه داخلٌ فيما هو متحدًّى به أم لا، وعلى ذلك تعاقبت كلمة جمهور المتكلّمين من علماء الأمة في إعجاز القرآن. وكانت هذه الحقيقة جليَّة للإمام الخطابيّ (ت 388هـ)، وهو مِن أوّل مَن وصَلَنا كلامُهم في إعجاز القرآن، ورغم أنَّه يذهب إلى عدم دخول الإخبار بالمغيّبات في جملة المتحدَّى به؛ فإنه يقرّر دخوله في أوجه إعجاز القرآن الكريم.
قال: «وزعمَتْ طائفة أنَّ إعجازه إنما هو فيما يتضمنه من الإخبار عن الكوائن في مستقبل الزمان نحو قوله سبحانه: {الم * غُلِبَتِ الرُّومُ * فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ * فِي بِضْعِ سِنِينَ}[الروم: 1- 4]، وكقوله سبحانه: {قُلْ لِلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَى قَوْمٍ أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ}[الفتح: 16]، ونحوهما من الأخبار التي صدَّقَت أقوالَها مواقعُ أكوانها. قلت: ولا يُشَكُّ في أنَّ هذا وما أشبهه من أخباره نوعٌ من أنواع إعجازه، ولكنه ليس بالأمر العام الموجود في كل سورة من سور القرآن، وقد جعل سبحانه في صفة كل سورة أن تكون معجزة بنفسها لا يقدر أحدٌ من الخلق أن يأتي بمثلها: {فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ}[البقرة: 23] من غير تعيين، فدلّ على أنَّ المعنى فيه غير ما ذهبوا إليه»[10].
فهو يقرُّ بوضوح بأنَّ هذا نوعٌ من أنواع إعجازه، ولكنّه لا يُسلَّم بعمومه لعدم وقوع الإخبار بالمغيّبات في كلِّ سورة، وآخرُ المتحدّى به سورةٌ كما هو معلوم.
وبغضِّ النَّظر عن دقَّة هذا الأمر[11]؛ فلعلَّ الإمام لو فرَّق بين مفهوم الإعجاز والإفحام لجاءت عبارته خالية من شبهة التناقض، ولأغلق باب الخلاف حول اشتراط التحدّي للمعجزة قبل أن يفتحه الباقلانيّ، وقد كان قريبًا جدًّا من ذلك. والله أعلم.
وتأمّلْ قوله: «فتفهَّم الآن واعلمْ أنَّ القرآن إنما صار مُعجزًا؛ لأنه جاء بأفصح الألفاظ في أحسن نظوم التأليف مضمنًا أصحَّ المعاني من توحيدٍ له -عَزَّت قدرته-، وتنزيه له في صفاته، ودعاء إلى طاعته، وبيان بمنهاج عبادته من تحليل وتحريم، وحظر وإباحة، ومن وعظ وتقويم وأمر بمعروف ونهي عن منكر، وإرشاد إلى محاسن الأخلاق، وزجر عن مساوئها، واضعًا كلَّ شيءٍ منها موضعه الذي لا يُرى شيءٌ أولى منه، ولا يُرى في صورة العقل أمرٌ أليق منه، مودعًا أخبار القرون الماضية، وما نزل من مثلات الله بمن عصى وعاند منهم، منبئًا عن الكوائن المستقبلة في الأعصار الباقية من الزمان، جامعًا في ذلك بين الحُجَّة والمحتجّ له، والدليل والمدلول عليه؛ ليكون ذلك أوكد للزوم ما دعا إليه، وإنباء عن وجوب ما أمر به، ونهى عنه. ومعلوم أنَّ الإتيان بمثل هذه الأمور، والجمع بين شتاتها حتى تنتظم وتتَّسق؛ أمرٌ تعجز عنه قوى البشر، ولا تبلغه قدرتهم، فانقطع الخلق دونه، وعجزوا عن معارضته بمثله أو مناقضته في شكله. ثم صار المعاندون له ممن كفر به وأنكره يقولون مرة: إنه شِعرٌ، لما رأوه كلامًا منظومًا، ومرة سِحرٌ، إذ رأوه معجوزًا عنه، غير مقدور عليه، وقد كانوا يجدون له وقعًا في القلوب وقرعًا في النفوس يُريبهم ويحيّرهم، فلم يتمالكوا أن يعترفوا به نوعًا من الاعتراف، ولذلك قال قائلهم: إنّ له حلاوة وإن عليه طلاوة، وكانوا مرة لجهلهم وحيرتهم يقولون: {أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا}[الفرقان: 5]، مع علمهم أن صاحبه أميٌّ وليس بحضرته مَن يُملي أو يكتب، في نحو ذلك من الأمور التي جماعها الجهل والعجز»[12].
وكذلك الزركشي (ت 794هـ) ذكر في وجوه إعجاز القرآن ما فيه من الإخبار عن الغيوب المستقبلة مما أخبر به بأنه سيقع فوقع، ولم يكن ذلك من شأن العرب. وكذا ما تضمَّن من إخباره عن قصص الأولين وسائر المتقدمين حكايةَ مَن شاهدها وحضرها. وذكر أنَّ هذين الوجهين مردودان بأنه يستلزم أن الآيات التي لا خبر فيها بذلك لا إعجاز فيها، وهو باطل فقد جعل الله كل سورة معجزة بنفسها. ثم قال: «نَعَم، هذا والذي قبله من أنواع الإعجاز؛ إلا أنه غير منحصر فيه»[13].
فالإعجاز الغيبي عنده مُعتبَر، على ألَّا ينحصر فيه الإعجاز؛ لأنَّ حصره فيه يجعل بعض السُّور لا إعجاز فيها؛ لأنَّ الـمُتحدَّى به سورةٌ.
وكذلك الإمام الطاهر بن عاشور (ت 1393هـ) فإنه عدَّ الجهة الثالثة من جهات إعجاز القرآن ما أودع فيه من المعاني الحكمية والإشارات إلى الحقائق العقلية والعلمية مما لم تبلغ إليه عقول البشر في عصر نزول القرآن وفي عصور بعده متفاوتة، وذكر في الجهة الرابعة ما انطوى عليه من الأخبار عن المغيّبات مما دلَّ على أنه منزل من علام الغيوب[14]. ثم ذكر قرب نهاية هذا البحث أنَّ «هذه الجهة من الإعجاز إنما تثبت للقرآن بمجموعه، أيْ: مجموع هذا الكتاب؛ إذ ليست كل آية من آياته، ولا كلّ سورة من سوره بمشتملة على هذا النوع من الإعجاز، ولذلك فهو إعجاز حاصل من القرآن، وغير حاصلٍ به التحدِّي إلا إشارةً نحو قوله: {وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا}[النساء: 82]»[15].
ولم يزل العلماء مُتتابعين على عدِّ الإعجاز الغيبيّ من وجوهِ إعجاز القرآن الكريم، فقال الرماني (ت 384هـ): «وجوه إعجاز القرآن تظهر من سبع جهات: ترك المعارضة مع توفُّر الدواعي وشدة الحاجة، والتحدي للكافة، والصَّرفة، والبلاغة، والأخبار الصادقة عن الأمور المستقبلة، ونقض العادة، وقياسه بكل معجزة»[16].
ثم بيّنها فقال: «وأمّا الأخبار الصادقة عن الأمور المستقبلة فإنه لمّا كان لا يجوز أن تقع على الاتفاق؛ دلَّ على أنها من عند علّام الغيوب، فمِن ذلك قوله -عز وجل-: {وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ}[الأنفال: 7]، فكان الأمر كما وعد من الظفر بإحدى الطائفتين: العير التي كان فيها أبو سفيان، أو الجيش الذين خرجوا يحملونها من قريش، فأظفرهم الله -عز وجل- بقريش يوم بدر على ما تقدم به الوعد. ومنه قوله تعالى: {الم * غُلِبَتِ الرُّومُ * فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ}[الروم: 1- 3]، ومنه: {هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ}[التوبة: 33، والصف: 9]، ومنه: {فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ * وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ}[البقرة: 94، 95]، ومنه: {فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ}[البقرة: 23، 24]، ومنه: {سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ}[القمر: 45]، ومنه: {لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ}[الفتح: 27]، ومنه: {وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ}[الفتح: 20]، ثم قال: {وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا}[الفتح: 21]»[17].
وقال أبو بكر الباقلاني (ت 403هـ): «في جملة وجوه إعجاز القرآن: ذكر أصحابنا وغيرهم في ذلك ثلاثة أوجه من الإعجاز؛ أحدها: يتضمن الإخبار عن الغيوب، وذلك مما لا يقدر عليه البشر، ولا سبيل لهم إليه...»[18].
وقال مكيّ بن أبي طالب (ت 437هـ): «ومن إعجازه ما فيه من علوم الغيب التي لم تكن وقت نزوله ثم كانت ومنها ما لم تكن بعدُ. ومنها ما كانت ولم يكن أحد يعرفها في ذلك الوقت، فنزل علمها وتفسيرها في القرآن؛ كخبر يوسف وإخوته، وخبر ذي القرنين، وأهل الكهف، وإخبار الأمم الماضية والقرون الخالية، التي قد اندرس خبرها وعدم عارف أخبارها، وغير ذلك... فنزل القرآن بتبيانها ونصها على ما كانت عليه»[19].
وذكر القاضي عياض (ت 544هـ) أوجه إعجاز القرآن، فعدَّ الوجه الثالث منها «ما انطوى عليه من الإخبار بالمغيّبات، وما لم يكن ولم يقع فوجد كما ورد على الوجه الذي أَخبر؛ كقوله تعالى: {لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ}[الفتح: 27]، وقوله تعالى: {وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ}[الروم: 3]، وقوله: {لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ}[التوبة: 33، والفتح: 28، والصف: 9]، وقوله: {وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ}[النور: 55]؛ الآية، وقوله: {إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ}[النصر: 1]؛ إلى آخرها. فكان جميع هذا كما قال؛ فغَلبَت الرومُ فارس في بضع سنين، ودخل الناس في الإسلام أفواجًا، فما مات -صلى الله عليه وسلم- وفي بلاد العرب كلها موضعٌ لم يدخله الإسلام، واستخلف اللهُ المؤمنين في الأرض، ومكَّن فيها دينهم ومَلَّكَهم إياها من أقصى المشارق إلى أقصى المغارب... وقوله: {إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ}[الحجر: 9]، فكان كذلك لا يكاد يُعدُّ مَن سعى في تغييره وتبديل محكمه من الملحدة والمعطِّلة لا سيما القرامطة، فأجمعوا كيدهم وحولهم وقوّتهم اليوم نيِّفًا على خمسمائة عام فما قدروا على إطفاء شيء من نوره، ولا تغيير كلمة من كلامه، ولا تشكيك المسلمين في حرف من حروفه والحمد لله... وما فيه من كشفِ أسرار المنافقين واليهود ومقالِهم وكذِبِهم في حَلِفِهم وتقريعهم بذلك كقوله: {وَيَقُولُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ}[المجادلة: 8]، وقوله: {يُخْفُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ مَا لَا يُبْدُونَ لَكَ}[آل عمران: 154]؛ الآية، وقوله: {وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ}[المائدة: 41]؛ الآية، وقوله: {مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَاعِنَا لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ}[النساء: 46]. وقد قال مُبديًا ما قدَّره الله واعتقده المؤمنون يوم بدر: {وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ}[الأنفال: 7]. ومنه قوله تعالى: {إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ}[الحجر: 95]، ولما نزلت بشَّر النبي -صلى الله عليه وسلم- بذلك أصحابه بأنَّ الله كفاه إيّاهم، وكان المستهزئون نفرًا بمكة يُنفّرون الناس عنه ويؤذونه فهَلكوا، وقوله: {وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ}[المائدة: 67]، فكان كذلك على كثرة مَن رامَ ضرَّه وقصَد قَتْله. والأخبار بذلك معروفة صحيحة».
ثم ذكر الوجه الرابع فعدَّ فيه «ما أنبأ به من أخبار القرون السالفة والأمم البائدة والشرائع الداثرة مما كان لا يَعلم منه القصةَ الواحدةَ إلا الفذُّ من أحبار أهل الكتاب الذي قطع عمره في تعلُّم ذلك، فيورده النبي -صلى الله عليه وسلم- على وجهه، ويأتي به على نصّه فيعترف العالم بذلك بصحته وصدقه، وأن مثله لم ينله بتعليم، وقد علموا أنه -صلى الله عليه وسلم- أميٌّ لا يقرأ ولا يكتب، ولا اشتغل بمدارسة ولا مثافنة، ولم يغب عنهم ولا جهل حالَه أحدٌ منهم. وقد كان أهل الكتاب كثيرًا ما يسألونه -صلى الله عليه وسلم- عن هذا فينزل عليه من القرآن ما يتلو عليهم منه ذِكرًا؛ كقصص الأنبياء مع قومهم، وخبر موسى والخضر ويوسف وإخوته وأصحاب الكهف وذي القرنين ولقمان وابنه وأشباه ذلك من الأنباء، وبدء الخلق، وما في التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى مما صدَّقه فيه العلماء بها، ولم يقدروا على تكذيب ما ذكر منها؛ بل أذعنوا لذلك، فمِن موفَّقٍ آمن بما سبق له من خيرٍ ومن شقيٍّ مُعاند حاسد، ومع هذا لم يُحكَ عن واحد من النصارى واليهود على شدة عداوتهم له وحرصهم على تكذيبه وطول احتجاجه عليهم بما في كتبهم وتقريعهم بما انطوت عليه مصاحفهم وكثرة سؤالهم له -صلى الله عليه وسلم- وتعنيتهم إياه عن أخبار أنبيائهم وأسرار علومهم ومستودعات سيرهم وإعلامه لهم بمكتوم شرائعهم ومضمَّنات كتبهم؛ مثل سؤالهم عن الروح وذي القرنين وأصحاب الكهف وعيسى وحكم الرجم وما حَرَّم إسرائيل على نفسه وما حُرِّم عليهم من الأنعام ومن طيباتٍ كانت أُحِلَّت لهم فحرِّمت عليهم ببغيهم، وقوله: {ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ}[الفتح: 29]، وغير ذلك من أمورهم التي نزل فيها القرآن فأجابهم وعرّفهم بما أُوحي إليهم من ذلك، فما أنكروا ذلك ولا كذّبوه، بل أكثرهم صرَّح بصحةِ نبوته وصدقِ مقالته واعترف بعناده وحسَده إيَّاه؛ كأهل نَجْرانَ وابن صُوريا وابنَيْ أخطب وغيرهم. ومَن باهَتَ في ذلك بعض المباهتة وادَّعى أن فيما عندهم من ذلك لما حكاه مخالفةً دُعِي إلى إقامة حجته وكشف دعوته فقيل له: {قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ * فَمَنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ}[آل عمران: 93- 94]، فقرَّع ووبَّخ ودعا إلى إحضارِ ممكِنٍ غير ممتنِعٍ، فمِن معترفٍ بما جحده، ومتواقحٍ يُلقِي على فضيحته من كتابه يدَه، ولم يؤثَر أن واحدًا منهم أظهر خلافَ قوله من كتبه ولا أبدى صحيحًا ولا سقيمًا من صُحفه. قال الله تعالى: {يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ}[المائدة: 15]؛ الآيتين».
ثم عدَّ من غير هذين الوجهين «آيًا وردت بتعجيز قوم في قضايا، وإعلامهم أنهم لا يفعلونها، فما فعلوا ولا قدروا على ذلك؛ كقوله لليهود: {قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ}[البقرة: 94]، قال أبو إسحاق الزجاج: في هذه الآية أعظم حجة وأظهر دلالة على صحة الرسالة؛ لأنه قال لهم: {فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ}، وأعلمهم أنهم لن يتمنوه أبدًا؛ فلم يتمنَّه واحدٌ منهم... فصَرَفهم الله عن تمنّيه وجزَّعهم؛ ليُظهر صِدقَ رسوله وصحَّةَ ما أَوحى إليه؛ إذ لم يتمنه أحد منهم، وكانوا على تكذيبه أحرص لو قدروا، ولكن الله يفعل ما يريد. فظهرت بذلك معجزاته وبانت حجته... وكذلك آية المباهلة من هذا المعنى حيث وفد عليه أساقفة نجران وأبَوا الإسلام، فأنزل الله تعالى عليه آية المباهلة بقوله: {فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ}[آل عمران: 61]، فامتنعوا منها ورضوا بأداء الجزية، وذلك أن العاقب عظيمهم قال لهم: قد علمتهم أنه نبي، وأنه ما لاعن قومًا نبيٌّ قط فبقي كبيرهم ولا صغيرهم. ومثله قوله: {وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا}[البقرة: 23، 24]، فأخبرهم أنهم لا يفعلون كما كان. وهذه الآية أَدخَلُ في باب الإخبار عن الغيب، ولكن فيها من التعجيز ما في التي قبلها»[20].
وكذا القرطبي، عدَّ من وجوه إعجازه «الإخبار عن الأمور التي تقدّمت في أول الدنيا إلى وقت نزوله من أميٍّ ما كان يتلو مِن قبله من كتاب، ولا يخطُّه بيمينه، فأخبر بما كان من قصص الأنبياء مع أممها، والقرون الخالية في دهرها، وذكر ما سأله أهل الكتاب عنه، وتحدَّوه به من قصص أهل الكهف، وشأن موسى والخضر -عليهما السلام-، وحال ذي القرنين، فجاءهم وهو أميٌّ من أمّة أُمِّيَّة، ليس لها بذلك علمٌ بما عرفوا من الكتب السالفة صحته، فتحققوا صِدقه»[21].
وقال ابن تيمية (ت 728هـ): «ومعجزاته -صلى الله عليه وسلم- تزيد على ألف معجزة، مثل انشقاق القمر وغيره من الآيات، ومثل القرآن المعجز... ومثل إخباره بالغيوب التي لا يعلمها أحدٌ إلا بتعليم الله -عز وجل- من غير أن يُعلِّمه إيّاها بشرٌ. فأخبرهم بالماضي مثل قصة آدم ونوح وإبراهيم وموسى والمسيح وهود وشعيب وصالح وغيرهم، وبالمستقبلات. وكان قومه يعلمون أنه لم يتعلم من أهل الكتاب، ولا غيرهم، ولم يكن بمكة أحدٌ من علماء أهل الكتاب ممن يتعلم هو منه، بل ولا كان يجتمع بأحد منهم يعرف اللسان العربي، ولا كان هو يحسن لسانًا غير العربي، ولا كان يكتب كتابًا، ولا يقرأ كتابًا مكتوبًا... ولكن المقصود هنا ذِكر بعض ما في القرآن من أنه كان يخبرهم بالأمور الماضية خبرًا مفصَّلًا لا يعلمه أحد إلا أن يكون نبيًّا، أو مَن أخبره نبيٌّ، وقومه يعلمون أنه لم يخبره بذلك أحد من البشر، وهذا مما قامت به الحجة عليهم، وهم مع قوة عداوتهم له وحرصهم على ما يطعنون به عليه لم يمكنهم أن يطعنوا طعنًا يُقبل منهم، وكان علمُ سائر الأمم بأنّ قومه المعادين له المجتهدين في الطعن عليه لم يمكنهم أن يقولوا: إن هذه الغيوب علّمها إيّاه بشر، فوجب على جميع الخلق أنّ هذا لم يعلمه إياها بشر. ولهذا قال تعالى: {تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا}[هود: 49]»[22].
ومن العلماء المتأخرين الذين أبانوا عن هذا المذهب بأنصع بيان الشيخ محمد رشيد رضا (ت 1354هـ)؛ إذ ذكَر لإعجاز القرآن سبعة وجوهٍ؛ أولها: إعجاز القرآن بأسلوبه ونظمه. والثاني: إعجاز القرآن ببلاغته. والثالث: إعجاز القرآن بما فيه من علم الغيب. والرابع: إعجاز القرآن بسلامته من الاختلاف. والخامس: إعجاز القرآن بالعلوم الدينية والتشريع. والسادس: إعجاز القرآن بعجز الزمان عن إبطال شيء منه. والسابع: إعجاز القرآن بتحقيق مسائل كانت مجهولة للبشر[23].
والناظر في هذه الوجوه يرى أنَّ مَردَّ الخمسة الأخيرة منها -بصورة أو بأخرى- إلى الإعجاز الغيبي.
ثم قال: «والحق الذي يقال في هذا المقام: أنّ ما أيّد اللهُ تعالى به رسلَه من الآيات الكونية كان مناسبًا لحال زمانِ كلٍّ منهم وأهله، وقامت الحجة على مَن شاهَد تلك الآيات في عهده ثم على مَن صدَّق المخبرين من بعده، وقد علم الله تعالى أن سلسلة النقل ستنقطع، وأن ثقة بعض المتأخرين به ولا سيما بعد انقطاع سلسلته ستَضعُف، وأن دلالتها على الرسالة ستُنكَر، فجعل الآية الكبرى على إثبات رسالة خاتم النبيين عِلمية دائمة لا تنقطع، وهي هذا الكتاب المعجز للخلق بما فيه من أنواع الإعجاز السبعة التي ذكرناها، وبينّا أن كل واحد منها آية بيِّـنة لمن ألقى السمع وهو شهيد، وكان مستقلًّا مطلقًا من أسْرِ النظريات المادية وقيود التقليد، إذ لا يَـتصور عاقلٌ يؤمن برب العالمين أن يَصدُر هذا الكتاب المشتمل على هذا القدر السَّنِيع[24] من المعاني، في هذا الأسلوب البديع والنظم المنيع من المباني من رجلٍ أميٍّ ولا متعلِّمٍ أيضًا، إلا أن يكون وحيًا اختصه به الرب -عز وجل-، ناهيك به وقد جزم بعجز الإنس والجن عن أن يأتوا بمثله، ثم تحداهم بأن يأتوا بسورة من مثله، فهذا التحدِّي حجةٌ مستقلة على نبوة محمد -صلى الله عليه وسلم- بصرف النظر عن المتحدَّى به ما هو. وكل نوع من تلك الأنواع السبعة الثابتة للقرآن حجةٌ مستقلة في نفسها، وحجةٌ أنهضُ وأقوى باعتبار أميّة مَن جاء بها، فإن أمكَن تمحُّل المراء والجدل في بعض الوجوه التي ذكرنا لإعجازه، فهل يمكن ذلك في جملتها أو في كلٍّ منها؟ كلّا»[25].
ولو ذهبنا نستقصي العلماءَ القائلين بذلك في كلِّ عصر ومِصر على اختلاف مذاهبهم ومدارسهم فلن توفي بذلك الطروس، ولجاء من ذلك ملء خزانة، ولكن فيما ذكر كفاية ومقنع[26].
ولا إخالُ المخالفَ ينازعُ في هذا إلا أن يكون من جهة الاسم، لا من جهة الـمُسمَّى، فعبارة الأستاذ محمود شاكر «أنَّ ما في القرآن من مكنون الغيب، ومن دقائق التشريع ومن عجائب آيات الله في خلقه، كل ذلك بمعزل عن هذا التحدي المفضي إلى الإعجاز، وإن كان ما فيه من ذلك كله يعدّ دليلًا على أنَّه من عند الله تعالى، ولكنه لا يدلّ على أنَّ نظمه وبيانه مباين لنظم كلام البشر وبيانهم، وأنَّه كلام ربِّ العالمين، لا كلام بشر مثلهم»[27]، جَعلَت الإعجازَ تاليًا للتحدّي، والتحدي مُفضيًا إلى الإعجاز، فدلَّت قطعًا على أنَّه يعني بالإعجاز ما نعنيه بالإفحام والإبلاس، كما أكَّدت أنَّ ما في القرآن من مكنون الغيب ودقائق التشريع وعجائب الآيات في الخلق دليلٌ على أنَّه من عند الله تعالى. ولا مصير لذلك إلا إذا استبان صدقُها، واستحالةُ اطّراد صدقِ الراجم بالغيب في مثلها، فيُقطع بضرورة كونه من عند الله تعالى؛ لعجزِ البشر عن اختلاقها، وهذا هو معنى الإعجاز على ما حرَّرته المقالة.
نعم؛ إنَّني -في الحقيقة- لا أستشكلُ صنيع الأستاذ شاكر -رحمه الله- بقدر ما أستشكلُ صنيع مَن اختار أنَّ التحدّي شرطٌ للإعجاز، وأنَّ المتحدَّى به من القرآن هو البلاغة والنظم فقط، ثم هو يَعُدُّ لإعجاز القرآن الكريم أوجهًا. فلازمُ الأمرين ألّا يوجد مُعجِزٌ في القرآن إلّا النظم والبلاغة وما إليهما، وهذا ما سار عليه الأستاذ شاكر -رحمه الله-. وأمَّا صنيع الأوَّل فلا يُحمل إلا على المسامحة، وإلا ففيه عدم ضبط حقائق المفاهيم وحدودها ومقاديرها والاصطلاحات الدالَّة عليها.
وخلاصة القول:
إنَّ القرآن الكريم بما ينطوي عليه من الإخبار بالمغيّبات التي لا يستطيع أن يأتي بمثلها مخلوقٌ؛ آيةُ صدقٍ وشاهِدُ عدلٍ على أنَّ الجائي به رسولُ الله إلى الإنس والجنّ. وإنَّ ذلك لمن أوجه إعجاز القرآن الكريم؛ لعجز المخلوقين إنسهم وجنّهم أن يأتوا بحديثٍ مثله يُخبر فيتحقق صدقه، ويطّرد وقوع خبره، وعلاوة على ذلك «فإعجازه من هذه الجهة للعرب ظاهر، إذ لا قِبل لهم بتلك العلوم، كما قال الله تعالى: {تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا}[هود: 49]، وإعجازه لعامّة الناس أن تجيء تلك العلوم من رجلٍ نشَأ أميًّا في قوم أُميِّين، وإعجازه لأهل الكتاب خاصة؛ إذ كان ينبئهم بعلوم دينهم مع كونه أميًّا، ولا قِبَل لهم بأن يدَّعوا أنهم علَّموه؛ لأنه كان بمرأى من قومه في مكة بعيدًا عن أهل الكتاب الذين كان مستقرهم بقرى النضير وقريظة وخيبر وتيماء وبلاد فلسطين، ولأنه جاء بنَسْخِ دين اليهودية والنصرانية، والإِنحاء على اليهود والنصارى في تحريفهم، فلو كان قد تعلَّم منهم لأعلنوا ذلك وسجَّلوا عليه أنه عَقَّهم حقَّ التعليم»[28].
[1] انظر: عربية القرآن، للدكتور عبد الصبور شاهين، مكتبة النافذة، مصر، ط1، 2006م (ص84).
[2] لا يفوتني أن أتقدّم بخالص الشكر والتقدير لأخي العزيز فضيلة الباحث الدكتور خليل اليماني -حفظه الله تعالى- على اطلاعه على مسوّدة المقالة، وإثرائه إيّاها بملحوظاته ومناقشاته.
[3] خير مَن يُمثّل هذا المذهب هو العلّامة الأستاذ محمود شاكر في تقديمه لكتاب (الظاهرة القرآنية) للمفكر الكبير مالك بن نبيّ، رحمهما الله تعالى. وسيأتي في ثنايا المقالة -بإذن الله- الجواب عن جملة كلامه.
[4] أخرجه البخاري في صحيحه (ح7، ح4553)، ومسلم (ح1773).
[5] وهو رأي ابن حزم وابن تيمية وغيرهم. انظر: الفصل في الملل والأهواء والنِّحَل، لابن حزم، ط مكتبة الخانجي، القاهرة (5/ 5-6)، وفيه يقول: «لو كان ما قالوا لسقطت أكثر آيات رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؛ كنبعان الماء من بين أصابعه، وإطعامه المئين والعشرات من صاع شعير وعَنَاق، ومرة أخرى من كسر ملفوفة في خمار، وكتَفْلِه في العين فجاشت بماء غزير إلى اليوم، وحنين الجذع، وتكليم الذراع، وشكوى البعير والذئب، والإخبار بالغيوب، وتمر جابر، وسائر معجزاته العظام؛ لأنه -عليه الصلاة والسلام- لم يتحدَّ بذلك كله أحدًا، ولا عمله إلا بحضرة أهل اليقين من أصحابه -رضي الله عنهم-»، في أوجه أخرى مذكورة ثَمَّ. وانظر: النبوات، لابن تيمية، ط أضواء السلف، الرياض، ط1، 1420هـ= 2000م (2/ 794- 795). وفيه يقول: «عامّة معجزات الرسول -صلى الله عليه وسلم- لم يكن يتحدَّى بها ويقول: ائتوا بمثلها. والقرآن إنما تحداهم لمّا قالوا إنه افتراه، ولم يتحدّهم به ابتداءً، وسائر المعجزات لم يتحدَّ بها، وليس فيما نُقِلَ تحدٍّ إلا بالقرآن؛ لكن قد عُلم أنهم لا يأتون بمثل آيات الأنبياء. فهذا لازمٌ لها، لكن ليس من شرط ذلك أن يقارن خبره».
[6] عربية القرآن، للدكتور عبد الصبور شاهين (ص83).
[7] قد يُظَنُّ أنَّ سلامة القرآن من مصادمة الحقائق العلمية المستقرة أمرٌ هيّن، إذ لم يكن عليه إلا أن يتجنَّب الخوض في مُبهَمات العلوم، وغوامض المعارف، وأسرار الكون، وخفايا العلم؛ فيكون في مأمنٍ من ذلك، ولكن -على العكس- تقصَّد القرآن الكريم ذكر كثير من أسرار الكون وظواهره وتعمَّده؛ كخلق السماوات والأرض، وخلق الإنس والجنّ والملائكة، وسَوْق السحاب، وإزجائه، ومراكمته، ونزول الغيث، وظواهر الفَلَك والأجرام السماوية، وتكوُّن الأجنَّة ومراحل تطوُّرها، وعالم النبات، والبحار، والجبال... وغير ذلك الكثير، ومع هذا كلّه لم يُسقط العلم كلمة من كلماته، ولم يصادم جزئية من جزئياته. وما من كتاب من وضع البشر عرض لتنبؤات بهذه الكثرة في هذه المجالات إلا وأبطلها مَرُّ الزمان، واستقرارُ الحقائق العلمية. فالقولُ بإعجاز القرآن لخُلوِّه من الخطأ العلميّ حقٌّ؛ لنزول القرآن بمعلوماتٍ كان أهل عصر تنزيله يجهلونها أو كانوا يعتقدون فيها غير ما أخبر به القرآن عنها. انظر: خصائص القرآن الكريم، للدكتور فهد الرومي، ط3، طبعة وقفية (ص75، 76)، والعلم وحقائقه بين سلامة القرآن الكريم وأخطاء التوراة والإنجيل، للدكتور سامي عامري، إصدار مركز رواسخ، ط1، 1441هـ= 2019م (ص45، 46).
[8] أحكام القرآن، للجصاص (2/ 8).
[9] فتوح الغيب في الكشف عن قناع الغيب، للطيبي، نشرة جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، ط1، 1434هـ= 2013م (8/ 31- 32). فإعجاز الائتلاف هذا له جوانبُ عديدة؛ منها: 1- عدم وقوع تناقُض داخليّ فيه. 2- عدم مصادمته للحقائق الكونية. 3- ما أشار إليه الزرقاني وغيره من «أنَّ القرآن الكريم تقرؤه من أوله إلى آخره، فإذا هو محكَم السرد، دقيق السبك، متين الأسلوب، قوي الاتصال، آخذٌ بعضُه برقاب بعضٍ في سوره وآياته وجمله، يجري دم الإعجاز فيه كلِّه مِن ألِفه إلى يائه، كأنه سبيكة واحدة، ولا يكاد يوجد بين أجزائه تفكُّك ولا تخاذل، كأنه حلقة مفرغة أو كأنه سمطٌ وحيد، وعقد فريد، يأخذ بالأبصار، نُظمت حروفه وكلماته، ونسقت جمله وآياته، وجاء آخره مساوقًا لأوله، وبدَا أوله مواتيًا لآخره». انظر: مناهل العرفان في علوم القرآن، للزّرقاني، مطبعة عيسى البابي الحلبي، ط3 (1/ 60). وبالجملة؛ فهذا النوع من الإعجاز حقيق بالاستقصاء والتصنيف والتجلية بضرب الأمثلة.
[10] بيان إعجاز القرآن، للخطابي، ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن، ط دار المعارف بمصر (ص23، 24).
[11] سيأتي الردّ على هذا الاستشكال في الجزء الثالث من المقال بإذن الله.
[12] بيان إعجاز القرآن، للخطابي (ص27، 28).
[13] انظر: البرهان في علوم القرآن، للزركشي، ط دار إحياء الكتب العربية، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، ط1، 1376هـ= 1957م (2/ 95- 96).
[14] التحرير والتنوير، لابن عاشور، الدار التونسية للنشر، 1984م (1/ 104- 105).
[15] التحرير والتنوير، لابن عاشور (1/ 129).
[16] النكت في إعجاز القرآن، للرماني، ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن (ص75).
[17] النكت في إعجاز القرآن، للرماني (ص110، 111).
[18] إعجاز القرآن، للباقلاني، نشرة المعارف، تحقيق: السيد أحمد صقر، ط8، 2017م (33، 34)، وانظر: (ص48- 50) منه.
[19] الهداية إلى بلوغ النهاية، لمكيّ بن أبي طالب، نشرة مجموعة بحوث الكتاب والسنة - كلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة الشارقة، حُقّق في عدّة رسائل جامعية بإشراف الدكتور الشاهد البوشيخي، ط1، 1429هـ= 2008م (6/ 4286).
[20] انظر: الشفا بتعريف حقوق المصطفى، للقاضي عياض، ط عبد الحميد أحمد حنفي (1/ 221- 226).
[21] الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي، نشرة دار الكتب المصرية، القاهرة، تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، ط2، 1384هـ= 1964م (1/ 74).
[22] الجواب الصحيح لمن بدّل دين المسيح، لابن تيمية، نشرة دار العاصمة، السعودية، تحقيق: علي بن حسن - عبد العزيز بن إبراهيم - حمدان بن محمد، ط2، 1419هـ= 1999م (1/ 399- 403).
[23] انظر: تفسير المنار، محمد رشيد رضا، نشرة الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1990م (1/ 165- 180).
[24] السَّنِيع: الحَسَن. انظر: تهذيب اللغة (2/ 62).
[25] تفسير المنار، محمد رشيد رضا (1/ 182- 183).
[26] وانظر على سبيل المثال لا الحصر: تخجيل من حرَّف التوراة والإنجيل (2/ 729)، والسيف المسلول، للسبكي (ص509)، وفتح الباري، لابن حجر (6/ 583)، وبهجة المحافل وبغية الأماثل في تلخيص المعجزات والسير والشمائل، للحرضي (2/ 208)، ومعترك الأقران في إعجاز القرآن، للسيوطي (1/ 239- 242)، والإتقان، للسيوطي (4/ 19)، ومناهل العرفان، للزّرقاني (2/ 367- 389)، والمعجزة الكبرى، لأبي زهرة (ص65)، والتحرير والتنوير، لابن عاشور (1/ 104- 105)، والنبأ العظيم، للدكتور دراز (98- 99).
[27] مداخل إعجاز القرآن الكريم، للأستاذ محمود شاكر، مطبعة المدني (ص158، 159).
[28] التحرير والتنوير، لابن عاشور (1/ 129).
كلمات مفتاحية
الكاتب:

محمود عبد الجليل روزن
الأستاذ المساعد بقسم علوم وتقنية الأغذية بجامعة دمنهور - مصر، وحاصل على عالية القراءات، وله عدد من المؤلفات والبحوث العلمية المنشورة.
مواضيع ذات صلة
((المعلومات والآراء المقدَّمة هي للكتّاب، ولا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع أو أسرة مركز تفسير))