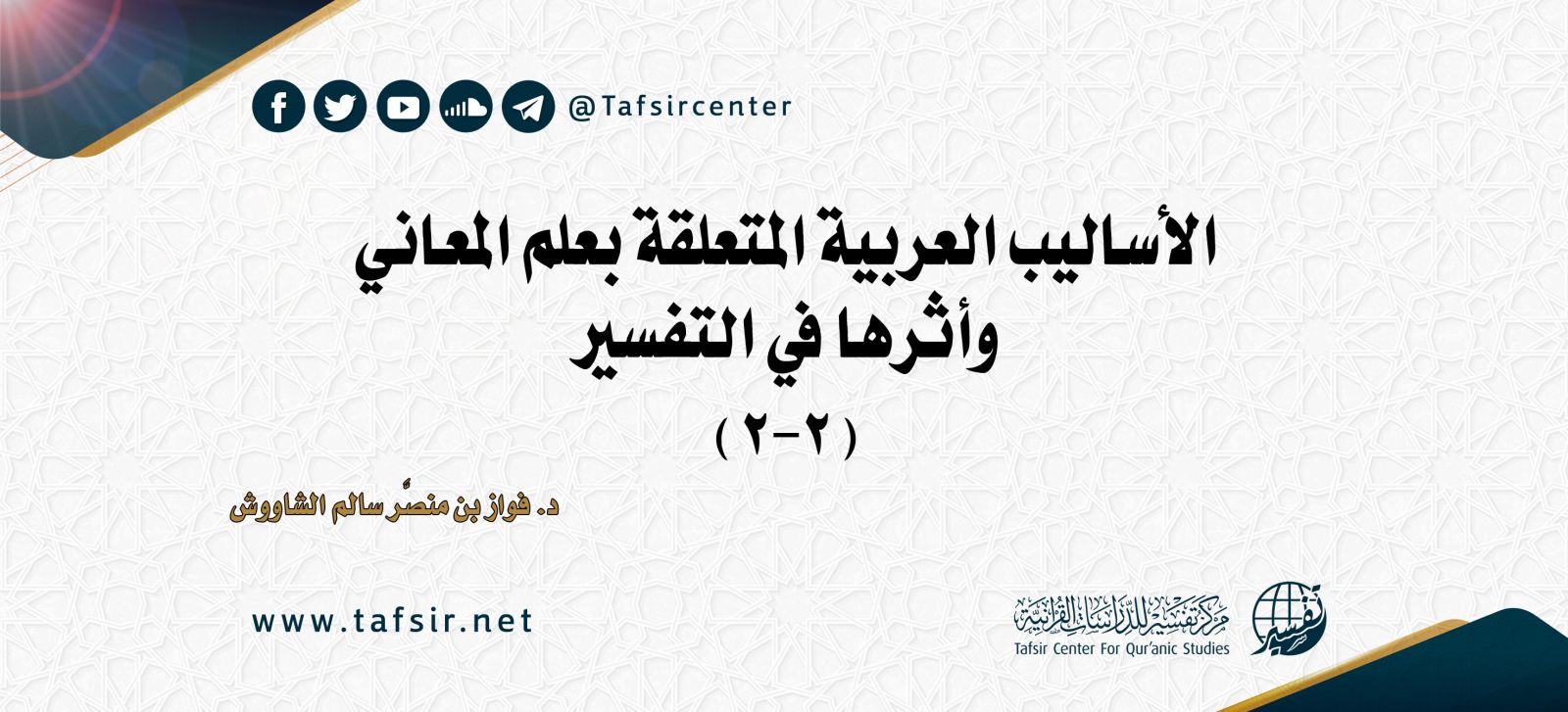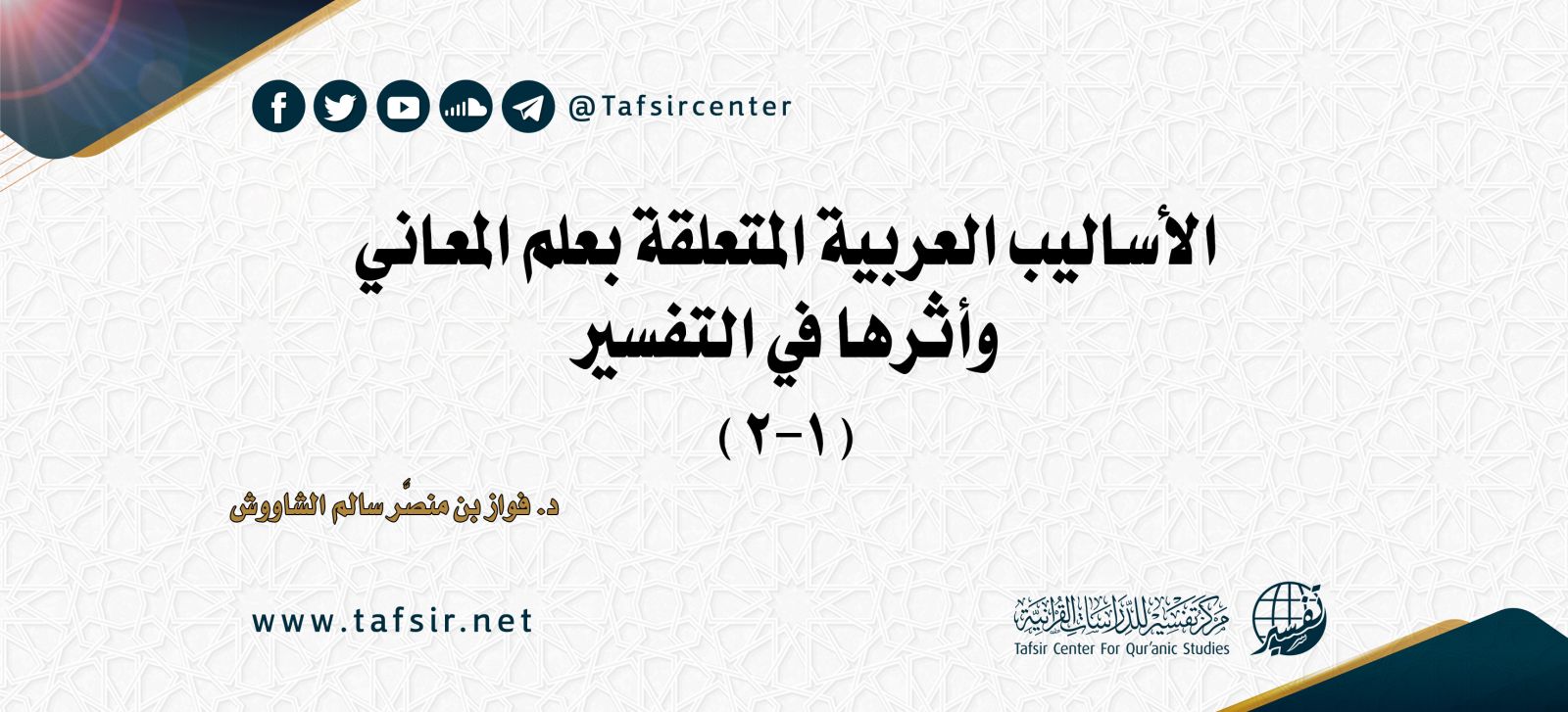التلقي النقدي لصناعة التفسير عند الفخر الرازي، مسوغات النقد ودوافعه
التلقي النقدي لصناعة التفسير عند الفخر الرازي، مسوغات النقد ودوافعه
الكاتب: محمد عبيدة

توطئة:
أهمية التفسير الكبير للفخر الرازي ومكانته:
حَظِي النصّ القرآني في التراث العربي الإسلامي باهتمام كبير، وتبوَّأ مكانة عُلْيَا لم يدانِه فيها نصّ آخر؛ نظرًا لطبيعته الإلهية، ولمحوريته في الحياة الإسلامية هدايةً وتشريعًا وسَنًّا للقيم الأخلاقية. فكان النصّ القرآني -إلى جانب السُّنة النبوية- نصًّا تأسيسيًّا، تأسّس عليه التراث العربي الإسلامي؛ ونتيجة لهذه المكانة المحورية، استأثر القرآن الكريم باهتمام العلماء من مختلف التوجُّهات والمذاهب، فدُرِس من جوانبه المتعدّدة: من حيث نقله وشروط صحة هذا النقل، ومن حيث ضبطه ورسمه وقراءاته، ومن حيث جوانبه الدلالية المتعدّدة ومستوياتها، ومن حيث تفسيره ومعرفة سياقاته الزمنية والمكانية وظروف نزوله...؛ فتشكّلت موسوعة من المعارف التي انتظمت لاحقًا على يد الزركشي ثم السيوطي تحت مسمّى علوم القرآن. ولم تكن هذه الموسوعة مجرّد تجميع متنافر لهذه العلوم؛ إذ يكشف تحليلها عن انتظامها وفق منهجية تراعي مختلف جوانب النصّ القرآني في بُعده التكويني والنصي والتأويلي[1]. وقد شكّلت هذه العلوم ذخيرة للمفسرين، استمدوا منها أدواتهم في التفسير، واستعانوا بها في سعيهم إلى الكشف عن المعاني المتضمنة في القرآن.
وقد بلغت التفاسير مبلغًا كبيرًا في التنوع من حيث الأصول والمرتكزات؛ إذ كانت صادرة عن مرجعيات مذهبية متعدّدة، أسهمت في تكوين مناهج التعامل مع النصّ، وآليات تفسيره وتأويله، كما تميزت بتنوُّع المركزيَّات المعرفية المستندة إليها، فمنها تفاسير ركّزت على الجانب النحوي واللغوي عمومًا، وأخرى على الجانب الفقهي، وثالثة على الجانب العقدي والكلامي...، وقد كان التركيز على جانب محدد من جوانب النصّ القرآني راجعًا إلى التكوين المعرفي للمفسِّر الذي يغلب عليه الانشغال بجانب معيّن من جوانب المعرفة، فيجعله مركز اهتمامه في التفسير.
ولما كان (الكلام) علمًا مركزيًّا في التراث الإسلامي لدى كثير من المدارس الكلامية، باعتباره العلم الذي يثْبت العقائد الإسلامية والذي يحدّد (أصول الدين) ويدافع عنها؛ فقد اهتمت هذه الفِرَق بالتفسير وسَعَت لتوظيفه نصرةً لمقالاتها ونقدًا لمقالات الخصوم، ليصبح علم التفسير مجالًا للجدل العقدي بين الفِرَق، فوجدنا أنفسنا أمام مناهج متعدّدة، تراوحت ما بين مناهج تميل إلى الظاهر، وأخرى إلى الباطن، ومناهج تعمل على الوصل بينهما، وأخرى تفصل بينهما... ولكل منها منطلقاته ومرجعياته، ومسلّماته التأويلية، وقواعده في التفسير[2].
وفي هذا السياق، يحتلّ تفسير الفخر الرازي موقعًا متميزًا بين التفاسير التراثية. وترجع أهميته إلى مجموعة من الخصائص التي اتَّسم بها هذا التفسير؛ فمؤلفه أحد كبار المتكلمين في الفكر الكلامي الإسلامي، وهو إلى جانب منزلته العالية في الكلام يُعَدّ من كبار الأصوليِّين، إلى جانب إحاطته بمجموعة من العلوم والمعارف السائدة في عصره؛ فاستثمر هذه المرجعيات في تفسيره، فجاء تفسيرًا مستوعبًا لمختلف الإشكالات والمسائل التفسيرية: الكلامية والفلسفية واللغوية والفقهية والأصولية. كما أنه لم يدّخر جهدًا في توظيف هذه المعارف والآليات التفسيرية في الدفاع عن اختياراته الكلامية؛ فكان مصدرًا مهمًّا للمفسرين الذين جاءوا من بعده، فاعتمد عليه القاضي البيضاوي في تفسيره، وخاصّة في مسائل الكلام والحكمة[3]، واستفاد منه أبو حيان الغرناطي، وغيرهما كثير.
وقد امتاز تفسير الرازي إلى جانب هذه الخصائص بصناعته التفسيرية المتميزة؛ إذ لم يلتزم بما درج عليه المفسرون من قبله: فتوسّع كثيرًا في إيراد المسائل والجواب عنها، وناقش كثيرًا من المسائل العلمية التي لا تُنَاقَش عادةً في علم التفسير، وأدخل كثيرًا من معطيات المعارف الفلسفية لدى كلامه في تفسير بعض الآيات. وقد تعرّض تفسير الرازي لنقدٍ كثيرٍ خاصة في بعض الأمور المتعلّقة بصناعته التفسيرية التي جنح إليها، وفي هذه المقالة سنحاول الخطو إلى معالجة ذلك، وبيان خصائص الصناعة التفسيرية بشكلٍ عام لنتبيّن صنيع الرازي، وخصائص هذه الصناعة عنده، وكيف تلقَّاها العلماء، وأسباب النقد الذي وجّهوه لها، وما كان وراءه من مسوغات ودواعٍ، وفيما يأتي بيان ذلك:
1. خصائص الصناعة التفسيرية عند الفخر الرازي:
1.1. خصائص الصناعة التفسيرية:
تمتاز الصنعة التفسيرية بمجموعة من الخصائص، وسنركز في هذه المقالة على خصيصتين لارتباطهما بموضوع بحثنا، وهما: أعراف صناعة التفسير، والبُعد الاستشكالي فيه.
1.1.1. الأعراف العلمية في الكتابة التفسيرية:
وهذه الأعراف تتأطّر بقواعد صناعة العلم في التراث الإسلامي، وهي قواعد تحدّد العلاقات النسقيَّة بين العلوم الإسلامية؛ ففي الصنعة التفسيرية ليس من صميم اشتغال المفسِّر التدليل على صحة القرآن وثبوت نقله، ولا التدليل على صحة معانيه، أو إلهية مصدره وكونه معجزًا؛ إِذْ هذه القضايا تُنظر في مباحث العقائد والكلام، ونتائج هذا البحث تؤحذ مسلَّمة في التفسير، فإِنْ نَظَر فيها المفسّر أثناء تفسيره عُدّ ذلك منه خروجًا عن الصنعة التفسيرية وإخلالًا بأعرافها. يقول أبو حيان الغرناطي: «قد تكلَّم المفسرون هنا في حقيقة النَّسْخ الشرعي وأقسامه، وما اتُّفِق عليه منه، وما اختُلِف فيه، وفي جوازه عقلًا، ووقوعه شرعًا، وبماذا يُنسَخ، وغير ذلك من أحكام النسخ ودلائل تلك الأحكام، وطوَّلوا في ذلك. وهذا كلُّه موضوعُه علمُ أصول الفقه، فيُبْحَث في ذلك كلّه فيه. وهكذا جرَت عادتُنا: أنَّ كلّ قاعدة في علمٍ من العلوم يُرْجَع في تقريرها إلى ذلك العلم، ونأخذها في علم التفسير مسلَّمة من ذلك العلم، ولا نطوِّل بذكر ذلك في علم التفسير، فنخرج عن طريقة التفسير»[4].
ويقول ابن الحاجب: «... وهي المقدمات التي يتألّف منها قياسات منتجة لمسائل ذلك العلم، وهي إمّا بيّنة بنفسها وإمّا مسلَّمة في ذلك العلم غير مبرهَن عليها فيه؛ لبناء مسائل ذلك العلم عليها، سواء كانت مسلَّمة في نفسها أو مقبولة، على أن يبرهَن عليها في علم آخر»[5].
ويقول الغزالي: «فإذن الكلامُ هو المتكفِّل بإثبات مبادئ العلوم الدينية كلّها، فهي جزئية بالإضافة إلى الكلام. فالكلام هو العِلم الأعلى في الرتبة؛ إذ منه النزول إلى هذه الجزئيات... وذلك أنه ما من علم من العلوم الجزئية إلّا وله مبادئ تؤخذ مسلَّمةً بالتقليد في ذلك العلم، ويُطلَب برهانُ ثبوتها في علمٍ آخر»[6].
ويقول الفخر الرازي شارحًا إشارات ابن سينا وتنبيهاته: «واعلم أن مبادئ العلم الجزئي إنما يُبَرْهَن غالبًا في العلم الكلي الذي فوقه، وقد يُبَرْهَن مبادئ العلم الكلي الفوقاني في العلم الجزئي التحتاني نادرًا، لكن بشرط ألّا يقع الدور، ثم لا يزال مبادئ العلم الجزئي مبرهنًا في مبادئ العلم الكلي الفوقاني إلى أن ينتهي إلى العلم الذي موضوعه الموجود من حيث هو موجود، ويبحث عن لواحقه الذاتية، وهو العلم الذي يسمى بالفلسفة الأولى»[7].
إذن، يتضح من هذه النقول أن علم التفسير إنما يأخذ نتائج العلوم الأخرى مسلَّمة ويبني عليها، وبالتالي فهو ذو طبيعة تسليمية، ولا يصح في هذا السياق مطالبته بإثبات المسلّمات التي ينهض عليها؛ لأن في هذا خروجًا عن القصد منه، وإدخالًا لقضايا علومٍ أخرى فيه، وهذا ما لا تسوِّغه الأعراف العلمية التراثية، كما لا يسوغه المنطق الداخلي لهذه العلوم. بل إن الرازي -وهو موضوع دراستنا- كثيرًا ما كان يخرق هذا العرف حين يستطرد في أبحاث كلامية أو أصولية، وهو ما جرّ عليه بعض النقد -كما سنراه-. والدرس الذي نفيده من هذه الممارسة المعرفية التراثية درس منهجي أساس، يقضي باحترام الحدود المنهجية لكلّ علم، وتحديد مجال اشتغاله، والابتعاد عن الفوضى المعرفية، إلى جانب العلاقات النسقيّة بين العلوم وانبناء بعضها على نتائج بعض، وهذه الدروس جديرة بالتثمين، ونحن في أمسّ الحاجة إليها في واقعنا المعرفي الراهن.
1.1.2. البُعد الاستشكالي في التفسير:
كان لدى علماء التفسير والقرآن وعيٌ بطبيعة الإشكالات التي قد تطرأ على ذهن القارئ للقرآن فتثير عنده شبهة تعترض إلهية القرآن، أو صحة نقله، أو عدم اتساق أجزائه، أو نقص بلاغته؛ ونتيجة لهذا الوعي لجأ المفسرون إلى عرض هذه الاعتراضات وتوجيهها والردّ عليها. وللتمثيل على هذه السمة، نورد هذا المقطع من تفسير سورة الفاتحة عند إمام المفسرين ابن جرير الطبري، حيث يقول: «فإن قال قائل: وكيف قيل: {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ}[الفاتحة: 5]، فقُدِّم الخبرُ عن العِبادة، وأُخِّرَتْ مسألةُ المعونة عليها بعدَها؟ وإنما تكون العبادة بالمعونة، فمسألةُ المعونة كانت أحقّ بالتقديم قبلَ المُعَان عليه من العمل والعبادة بها.
قيل: لمَّا كان معلومًا أن العبادة لا سبيلَ للعبد إليها إلّا بمعونة من الله -جلّ ثناؤه-، وكان محالًا أن يكون العبد عابدًا إلّا وهو على العبادة مُعَانٌ، وأن يكون مُعانًا عليها إلّا وهو لها فاعلٌ =كان سواءً تقديمُ ما قُدِّم منهما على صاحبه. كما سواءٌ قولُك للرجل إذا قضى حاجَتَك فأحسنَ إليك في قضائها: «قضيتَ حاجتي فأحسنتَ إليَّ»، فقدَّمتَ ذِكر قضائه حاجتَك، أو قلتَ: «أحسنتَ إليَّ فقضيتَ حاجتي»، فقدَّمتَ ذِكر الإحسان على ذكر قضاء الحاجة؛ لأنه لا يكون قاضيًا حاجتَك إلّا وهو إليك محسنٌ، ولا محسنًا إليك إلّا وهو لحاجتك قاضٍ. فكذلك سواءٌ قول القائل: اللهم إِنّا إيّاك نعبُدُ فأعِنَّا على عبادتك، وقوله: اللهم أعنَّا على عبادتك فإِنّا إيّاك نعبُدُ»[8].
وعند الثعلبي: «فإن قيل: فأين الخبر عن قوله: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ}[البقرة: 234]؟ قيل: هو متروك؛ فإنه لم يقصد الخبر عنهم. وذلك جائز في الاسم، يُذكَر ويكون تمام خبره في اسم آخر، أن يقول الأول ويخبر عن الثاني، فيكون معناه: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا}، كقول الشاعر:
بني أسد إنّ ابنَ قيس وقَتْلَه *** بغير دمٍ دارُ المذلّةِ حلّت
فألغى ابنَ قيس وقد ابتدأ بذِكره، وأخبر عن قتله أنه ذُلٌّ، وأنشد:
لعلِّيَ إنْ مالَتْ بِيَ الريحُ مَيْلَةً *** على ابنِ أبي ذِبّانَ أنْ يَتَندَّمَا
فقال: لعلِّي، ثم قال: يتندَّما؛ لأن المعنى فيه عدا قول الفرّاء. وقال الزجّاج: معناه: (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجًا أزواجهم يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ). وقال الأخفش: خبره في قوله: {يَتَرَبَّصْنَ}، أي: يتربصن بعدهم»[9].
ولكن مع هذا الوعي فإن معالجة مثل هذه الاعتراضات ينبغي أن يظلّ محكومًا بنسق الفنّ وأعرافه، بحيث لا يتحوّل ميدان التفسير لساحة تقرير مسائل وقضايا يجري تقريرها في فنون أخرى؛ فيقع الاختلاط وتذهب حدود التمايز بين الفنون.
1.2. خصائص الصنعة التفسيرية عند الرازي:
1.2.1. خرق أعراف الصنعة التفسيرية:
يمثّل تفسير الرازي خرقًا لأعراف الصنعة التفسيرية، ويتجلى هذا الخرق في مظهرين؛ الأول: الاتساع في توظيف العلوم والمعارف؛ إذ لا يكتفي الرازي ببيان المعنى المراد من الآية، بل يتوسّع في ذكر المسائل وتفريعها. والمظهر الثاني: توظيف المعارف الفلسفية في التفسير. وهذان المظهران انفرد بهما الرازي عن التفاسير السابقة عليه، وهو الأمر الذي أحدث جدلًا بين اللاحقين عليه؛ نظرًا لطريقته في التفسير التي خرجت عن أعراف المفسرين في توظيفه للفلسفة عند تفسيره للآيات الكونية، فمِن منتقِدٍ لهذه الطريقة في التفسير إلى مبالِغٍ في بيان أهميتها. وتأتي هذه السمة عند الرازي لولوعه بالاستطراد، ولطبيعة تكوينه المعرفي، إذ كان يتسم بسمتين؛ أولًا: كثرة إيراد الشكوك والاستشكالات والاشتغال بالردّ عليها. وثانيًا: موسوعيته وسعيه للاستقصاء قدر الإمكان وحصر المسائل. فبالنسبة إلى السمة الأولى، نلفاها حاضرة في غالب كتبه الكلامية، بل أحيانًا يجتهد في تحرِّي الحُجَج للخصم والإشكالات ويُحسِن تنظيمها على الوجه الأقوى قبل الردّ عليها، وهذا جَرّ عليه بعض النقد[10]. وبالنسبة إلى الثانية، فقد كان الرازي رأسًا في الصناعة الكلامية، كما كان له انشغال كبير بكتب ابن سينا الفلسفية، فلم يكن الرازي ملتزمًا تمامًا بأشعريته؛ إذ أضاف إلى مرجعيته الأشعرية مرجعيات كلامية وفلسفية أخرى، مشكِّلًا اتجاهًا تفرَّد به، اتّبعه فيه متأخرو الأشاعرة، وخاصة متكلمو العجم. يقول ابن تيمية -وهو أكبر مناقشي الرازي وخصومه في الفكر الكلامي الإسلامي، ومن أكابر مؤرخي المقالات- موضحًا مصادر الرازي الكلامية والفلسفية: «والرازي مادته الكلامية من كلام أبي المعالي والشهرستاني؛ فإن الشهرستاني أخذه عن الأنصاري النيسابوري عن أبي المعالي، وله مادة قوية من كلام أبي الحسين البصري، وسلك طريقته في أصول الفقه كثيرًا، وهي أقرب إلى طريقة الفقهاء من طريقة الواقفة. وفي الفلسفة مادته من كلام ابن سينا والشهرستاني أيضًا ونحوهما، وأمّا التصوف فكان فيه ضعيفًا كما كان ضعيفًا في الفقه؛ ولهذا يوجد في كلام هذا -أي: الرازي- وأبي حامد ونحوهما من الفلسفة ما لا يوجد في كلام أبي المعالي وذويه، ويوجد في كلام هذا وأبي المعالي وأبي حامد من مذهب النفاة المعتزلة ما لا يوجد في كلام أبي الحسن الأشعري وقدماء أصحابه»[11].
1.2.2. تجليات خرق أعراف الصنعة التفسيرية عند الرازي:
1.2.2.1. إنتاج الإشكالات التأويلية الكلامية:
أفرز التوظيف الكلامي في علم التفسير مجموعة من الإشكالات التأويلية، من أهمها: إشكال التعارض بين العقل والنقل[12] (قانون التأويل)، وإشكال المحكم والمتشابه[13]، وإشكال الظاهر والباطن[14]. وقد حضرت هذه الإشكالات لدى الفخر في تفسيره حضورًا بارزًا، فهي لا تحضر عنده كقضايا مضمرة تمارس تأثيرها أثناء التفسير، بل يحرّر الرازي الكلام في هذه الإشكالات ويحقّق موقفه منها، ثم يفسر الآيات بناءً عليها.
1.2.2.2. الاستطراد في السجال الكلامي:
يبرز الرازي عناية كبيرة بأقوال خصومه المذهبيين، وخاصّة من المعتزلة، والكرامية وأهل الإثبات عمومًا الذين ينبزهم بـ(المشبهة) والفلاسفة، وهذا راجع إلى بيئته التي عاش فيها، فبالنسبة إلى المعتزلة فقد عاش الفخر في بلاد ما وراء النهر قريبًا من خوارزم عاصمة المعتزلة التي زارها وكانت له مناظرات معهم. على أن اهتمامه بالمعتزلة ليس لكونهم فقط الخصوم التقليديين للأشاعرة، بل لاستفادته من جهودهم في علم التفسير؛ إذ للمعتزلة عناية به، ولهم فيه تصانيف كبيرة، منها تفسير الرماني، والأصم، والزمخشري، إلى جانب تأويلات القاضي عبد الجبار الهمداني[15].
وأمّا بالنسبة إلى الفلاسفة، ففي التفسير حضور بارز للسجال المعرفي للمشّائين[16]، وخاصة مع ابن سينا، الذي عُنِي الرازي بكتبه تلخيصًا وتنقيحًا ونقدًا. وقد جَرّ عليه هذا نقدًا من اللاحقين عليه، كما سنرى.
وبالنسبة إلى الكرامية والمثبِتة من السُّنة عمومًا، فقد حاورهم الفخر كثيرًا وكانت له سجالات كثيرة معهم، وقد ناقش الرازي مقالات الكرامية في عدّة مواضع من تفسيره، وخاصة في آيات الصفات كالاستواء[17]، ولهم مذهب كلامي ميّال إلى الإثبات والمبالغة فيه، مما جعل الرازي ينبزهم بالتشبيه والتجسيم في تفسيره.
1.2.2.3. الاستطراد في الفلكيات:
من مظاهر خرق أعراف الصناعة التفسيرية لدى الرازي الاستطرادُ في ذكر قضايا المسائل الفلكيات في تفسيره لغير حاجة ملحَّة، من ذلك مثلًا كلامه في المسألة الخامسة من تفسيره لقوله تعالى في الآية 29 من سورة البقرة: {هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَماواتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ}، إذ استطرد الفخر في ذكر الأفلاك وترتيبها وطُرق معرفتها، ثم انتقل إلى مناقشة الفلاسفة في دليل حصرها وإمكان وجود غيرها[18].
ولدى تفسيره لقوله سبحانه في الآية 164 من سورة البقرة: {إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ}، عقَد الرازي أربعة فصول في الأفلاك؛ الأول: في ترتيب الأفلاك. الثاني: في معرفة الأفلاك. الثالث: في مقادير الحركات. الرابع: في كيفية الاستدلال بها[19]. وقبل تفصيل القول بها، استشهد الرازي بحكاية لعمر بن الحسام الذي «كان يقرأ كتاب المِجِسْطِيّ على عمر الأبْهَرِيّ، فقال بعض الفقهاء يومًا: ما الذي تقرؤونه؟ فقال: أفسِّرُ آية من القرآن، وهي قوله تعالى: {أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا}[ق: 6]، فأنا أفسِّرُ كيفية بُنْيانها، ولقد صَدَقَ الأبهريُّ فيما قال؛ فإنّ كل مَن كان أكثر توغُّلًا في بحار مخلوقات الله تعالى كان أكثر علمًا بجلال الله تعالى وعظمته»[20].
1.2.2.4. الاستطراد في الفقهيات:
تكثر استطرادات الرازي الفقهية في التفسير؛ إذ كثيرًا ما يَستطرِدُ إلى الجدل الفقهي وذِكر الأقوال والاحتجاج لها أو الاعتراض عليها. ومن الطريف هنا أن نشير إلى أن الرازي كان واعيًا بأنّ أعراف الصناعة التفسيرية تقتضي عدم التوسع في ذكر الفقهيات فيه، إذ يقول منتقِدًا أبا بكر الرازي الجصاص: «ثم إنّ أبا بكر الرازي أخَذ يتمسَّك في إثبات مذهبه بالأحاديث والأقْيِسَة. ومَن تكلَّم في أحكام القرآن وجَبَ أنْ لا يذكر إلّا ما يستنبطه من الآية، فأمّا ما سوى ذلك فإنما يليق بكتب الفقه»[21]. لكنه مع ذلك يُسْهِب في ذكر الخلاف الفقهي، ومن ذلك مثلًا تفسيره لقوله تعالى في الآية 196 من سورة البقرة: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ}، إذ ذَكَر الرازي كثيرًا من مسائل الحج والعمرة والخلاف فيها[22] مما حقّه أن يكون في كتب الفقه لا التفسير.
2. نقد مسلك الاستطراد المعرفي عند الرازي:
يمكن تصنيف منتقِدي مسلك الرازي في تفسيره إلى صنفين؛ الصنف الأول: من مخالِفيه في الأصول ومسائل الاعتقاد. والصنف الثاني: أشاعرة المغرب والأندلس. فما مسوغات نقد هذا المسلك لدى الصنفين؟
1.3. نقد المخالفين للفخر الرازي:
ممن انتقد مسلك الرازي في توظيف الفلسفة في التفسير: ابن أبي الحديد المعتزلي، الذي يقول عن تفسير الرازي مستغربًا: «ولا أقول هذا مبالغة؛ فإن هذا المصنف -يعني الرازي- قد فسّر القرآن العزيز، بكتاب كبير نحو عشرة مجلدات، أكثرها على القواعد الحكمية، وهو من عجائب الدنيا، وما رأينا قبله مثله. فإنّا عَهِدْنا كتب التفسير يقال فيها: قال عليّ وابن عباس. وهذا يقول عند ذكر الآية: قال الفارابي وقال ابن سينا، ولا حول ولا قوة إلّا بالله»[23].
إنّ استغراب ابن أبي الحديد هنا نابع من ملاحظته لخرق الفخر للكتابة التفسيرية التي التزمت بأعراف محددة، وهي الاعتماد على الأحاديث وآثار الصحابة وروايات السلف؛ في حين يجنح الرازي إلى المعارف الفلسفية ليدخلها في تفسيره؛ وهي المعارف التي كانت تعدُّ مخالفة للأصول الإسلامية في السياق الكلامي قبل الغزالي. على أن هذا الحرص على صفاء المعرفة الإسلامية من مخالطة الفلسفة كان قد برز لدى المعتزلة قبل الرازي؛ إذ منذ زمن الغزالي حذّر ابن الملاحمي من توظيف الفلسفة في الفقه وأصوله[24].
ومن المنتقدين لهذا المسلك أيضًا: ابن تيمية الحرّاني الحنبلي، حيث يقول: «ولهذا لمّا صار كثيرٌ من أهل النَّظَر -كالرازي وأمثاله- ليس عندهم إلّا قولُ الجهمية والقَدَرية والفلاسفة، تجدهم في تفسير القرآن وفي سائر كتبهم يذكرون أقوالًا كثيرة متعدّدة كلّها باطلة، لا يذكرون الحقّ، مثل تفسيره للهلال، وقد قال تعالى: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ}[البقرة: 189]، فذَكر قولَ أهل الحساب فيه، وجعله من أقوال الفلاسفة، وذَكر قولَ الجهمية الذين يقولون: إنّ القادر المختار يَحْدُث فيه الضوءُ بلا سببٍ أصلًا ولا لحكمةٍ. وكذلك إذا تكلَّم في المطر يذكُر قولَ أولئك الذين يجعلونه حاصلًا عن مجرَّد البخار المتصاعد والمنعقِد في الجو، وقولَ من يقول: إنه أحدَثه الفاعلُ المختار بلا سببٍ، ويذكُر قولَ من يقول: إنه نزَل من الأفلاك. وقد يرجِّح هذا القولَ في تفسيره، ويَجزِم بفساده في موضعٍ آخر. وهذا القول لم يقلْهُ أحد من الصحابة ولا التابعين لهم بإحسان ولا أئمة المسلمين. بل سائرُ أهل العلم من المسلمين من السلَف والخلَف يقولون: (إن المطر نزل من السحاب). ولفظُ (السماء) في اللغة والقرآن اسمٌ لكلّ ما عَلَا»[25].
فابن تيمية هنا يعترض على تفسير الرازي للهلال ولنزول المطر بالمعارف الفلسفية بعيدًا عن اللغة وعن معهود المخاطَب الأول بالنصّ (السلف الصالح من الصحابة والتابعين)؛ وهذا النقد التيمي للفخر الرازي ليس نقدًا نابعًا عن مجرد المخالفة العقدية لهذه الأقوال، ولكنه أيضًا نقد (تداولي)، ينطلق من مبدأ أساس هو أنّ فهم أيِّ خطاب -بما فيه الخطاب القرآني- يتطلب فهم ألفاظه بمعهود المتخاطبين وما يفهمونه من لغتهم، ذلك أن المتكلِّم يبين عن مراده بالألفاظ التي يستعملها المخاطَب؛ وبالتالي، فلفظ المطر يُفهم بمعهود المخاطبين بالقرآن لا بمعنى حادث متأخر عنهم لم يكونوا يعرفونه، ولا حاجة لتفسيره باصطلاحات الفلاسفة.
1.4. نقد أشاعرة المغرب للفخر الرازي:
إذا كان من الطبيعي أن يُنْتَقَد الرازي من قِبَل خصومه التقليديين في هذا المسلك، فإننا نجد منتقِدين لتفسيره من داخل المدرسة الأشعرية؛ إذ نجد ثلاثة أعلام من أعلام الأشعرية، وهم: أبو حيان، والشاطبي، والسنوسي. قد انتقدوا توسُّعه في إيراد المسائل وإدخال مجموعة من المعارف -وخاصة الفلسفية منها- التي لا تشتد إليها حاجة المفسّر في تفسيره. يقول أبو حيان الغرناطي: «وهكذا جرَتْ عادتُنا: أنّ كل قاعدة في علم من العلوم يُرْجَع في تقريرها إلى ذلك العلم، ونأخذها في علم التفسير مسلَّمة من ذلك العلم، ولا نطوِّل بذكر ذلك في علم التفسير، فنخرج عن طريقة التفسير، كما فعله أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي، المعروف بابن خطيب الريّ، فإنه جمَعَ في كتابه في التفسير أشياءَ كثيرةً طويلة لا حاجة بها في علم التفسير؛ ولذلك حُكِي عن بعض المتطرفين من العلماء أنه قال: فيه كلُّ شيء إلّا التفسير»[26].
ففي هذا النصّ ينبّه أبو حيان إلى مبدأ معرفي أساسي في العلوم التراثية، وهو أخْذُ علمٍ معيّن مبادئَ مسلَّمة -دون مناقشتها- من علم آخر يتولى إثباتها، لكن الرازي يخرق هذه القاعدة في تفسيره حسب أبي حيان، وهذا سبب مؤاخذته.
لكن، هل توسُّعُ الرازي في توظيف المعارف التي لا يحتاج إليها المفسر ضرورةً =سببٌ كافٍ لتسويغ هذا النقد؟ في نظرنا هذا الصنيع من الرازي ليس سببًا كافيًا لتعليل هذا الموقف، وهنا يسعفنا الشاطبي؛ إذ يقدِّم نقدًا لمسلك الرازي التفسيري القائم على التوسّع في إيراد المعارف -وخصوصًا الفلسفية منها-؛ ففي الموافقات يذكر الشاطبي إيرادًا لبعض العلماء في ضرورة تطلُّب كلّ العلوم سواء أتعَلّقَ بها العمل أم لا، وأجاز تطلُّبَ السحر والطلسمات؛ والأرجح هنا أنه يقصد الرازي[27]، ثم ساق بعدها مباشرة الحكاية التي ذكرها الرازي في تفسيره عن اليهودي الذي يعلِّم المسلم علم الهيئة، ليعقب بانتقاده استدلالَه بها[28]، ذلك أنّ علم التفسير حسب الشاطبي مطلوب «فيما يتوقف عليه فهم المراد من الخطاب، فإذا كان المراد معلومًا، فالزيادة على ذلك تكلُّف، وهو معنى إفرادي لا يقدح عدم العلم به في علم المعنى التركيبي في الآية»[29]. ويورد قولَ عمر: «أيها الناس تمسكوا بديوان شعركم في جاهليتكم فإن فيه تفسير كتابكم»، ليستنتج أن «تفسير قوله تعالى: {أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا}[ق: 6]، بأن المقصود به هو علم الهيئة الذي ليس تحته عمل؛ غير سائغ. ولأن ذلك من قبيل ما لا تعرفه العرب، والقرآن إنما نزل بلسانها وعلى معهودها، وهذا المعنى مشروح في كتاب المقاصد بحول الله»[30].
كما أبطل الشاطبي الاستدلال بقوله تعالى: {أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ}[الأعراف: 185]، حيث يقول: «وأن قوله تعالى لا يدخل فيه من وجوه الاعتبار علومُ الفسلفة التي لا عهد للعرب بها ولا يليق بالأُمّيين الذين بُعث فيهم النبي الأمّي -صلى الله عليه وسلم- بملّة سهلة سمحة. والفلسفة -على فرض أنها جائزة الطلب- صعبة المأخذ وعرة المسالك بعيدة الملتمَس، لا يليق الخطاب بتعلُّمها كي تتعرف آيات الله ودلائل توحيده للعرب الناشئين في محض الأمية، فكيف وهي مذمومةٌ على ألسنة أهل الشريعة، منبَّهٌ على ذمّها بما تقدَّم في المسألة»[31].
وبعد هذا يقرِّر الشاطبي أن ما يتوقف عليه معرفة المطلوب قد يكون له طريق تقريبي يليق بالجمهور؛ فبالنسبة إلى التصورات، فإن تعريف حدود الشريعة -كالملك والكوكب وغيرها- يكون بالألفاظ والمعاني والطرق البيانية العربية لا بالحدود الفلسفية؛ لبُعْدِها عن أفهام الجمهور ولاستحالة معرفة الحقائق بسبب كثرة الذاتيات وغموضها وصعوبة حصرها. وأمّا التصديقات، فطريقة الشريعة استعمالُ استدلالات من مقدمات بدهية أو قريبة من البدهي لا القياسات المركّبة[32].
إنّ الشاطبي إذن يُرْجِع رَفْض مسلك الرازي إلى أسباب ثلاثة؛ الأول: يعود إلى موقف تداولي، وهو فهم الخطاب انطلاقًا من العادات الكلامية والاستعمالات اللغوية للمخاطَبِين (وهنا يتفق الشاطبي مع ابن تيمية). والثاني: رَفْض التوسع والاقتصار على ما يُحتاج إليه في التفسير. والثالث: إدخال الفلسفة في التفسير. على أن هذا الرفض لإدخال الفلسفة في التفسير لكونها تخالف مقرّرات الشريعة نجده عند السنوسي، وإنْ كان كلامه ينتقد هذا المسلك في علم الكلام لا في الفلسفة، يقول: «وَلْيحذَر المبتدئ جهده أن يأخذ أصول دينه من الكتب التي حشيت بكلام الفلسفة، وأُولع مؤلِّفها بنقل هَوَسهم وما هو كفر صراح من عقائدهم التي ستروا نجاستها بما يَنْبَهِم على كثير من اصطلاحاتهم وعباراتهم التي أكثرها أسماء بلا مسميات؛ وذلك ككتب الإمام الفخر في علم الكلام، وطوالع البيضاوي ومَن حَذَا حذوهما في ذلك»[33].
إنّ مبدأ الرفض إذن عند أبي حيان والشاطبي والسنوسي واحد، وهو مخالفة المضامين الفلسفية للمقررات الشرعية. وهذا النقد ناتج عن موقف هؤلاء الثلاثة من الأشعرية الجديدة، التي بدأت معالمها بالتشكُّل منذ الغزالي، ووصلت إلى اكتمالها على يد الرازي ومَن تبعه من المتأخرين؛ كما أن الجامع بينهم أنهم منتمون جغرافيًّا إلى المغرب والأندلس؛ ذلك أن أشاعرة المغرب والأندلس ظلوا متوجسين من إقحام الفلسفة في الكلام، وبقوا مرتبطين بأشعرية الجويني. وقد ظلّ هذا واضحًا في الكتب الكلامية المغربية التي ارتبطت بإرث الجويني، وخاصة: الإرشاد؛ تلخيصًا وشرحًا، ولم يُعرف عنهم ارتباط بمدرسة الرازي في الغالب. يقول السبكي في طبقات الشافعية الكبرى: «وهذان الإمامان -أعني إمامَ الحرمين وتلميذَه الغزالي- وصَلَا من التحقيق وسعة الدائرة في العلم إلى المبلغ الذي يَعرف كلُّ منصفٍ بأنه ما انتهى إليه أحد بعدهما، وربما خالفَا أبا الحسن في مسائل من علم الكلام، والقومُ -أعني الأشاعرة لا سيما المغاربة منهم- يستصعبون هذا الصنع، ولا يرون مخالفةَ أبي الحسن في نقيرٍ ولا قطمير»[34].
«وهؤلاء -يعني المغاربة- كلهم عندهم بعض تحامُل على الإمام -يعني الجويني- من جهتين:
إحداهما: أنهم يستصعبون مخالفةَ الإمام أبي الحسن الأشعري ويرونها هجنةً عظيمة، والإمامُ لا يتقيَّد لا بالأشعري ولا بالشافعي لا سيّما في البرهان، وإنما يتكلم على حسب تأيدة نظرِه واجتهادِه، وربما خالَف الأشعريَّ وأتى بعبارة عالية على عادة فصاحته، فلا تحتمل المغاربة أن يقال مثلها في حقّ الأشعريِّ، وقد حكينا كثيرًا من ذلك في شرحنا على مختصر ابن الحاجب.
والثانية: أنه ربما نالَ من الإمام مالك -رضي الله تعالى عنه-، كما فعل في مسألة الاستصلاح والمصالح المرسَلة وغيرها. وبهاتين الصفتين يحصل للمغاربة بعض التحامل عليه، مع اعترافهم بعلوّ قدره، واقتصارهم -لا سيما في علم الكلام- على كتبه، ونهيهم عن كتب غيره»[35].
يحدّد السبكي في هذا النصّ علّة انتقاد المغاربة للجويني، وخاصّة في الفقه؛ لانتقاده للإمام مالك، ولكونه يخرج عن أقوال الأشعري في العقائد. والمغاربة يلتزمون في العقائد بمذهب الأشعري لا يكادون يخرجون عنه، لكنه يشير إلى أنهم رغم انتقادهم له إلّا أنهم يقتصرون على كتبه وينهون عن غيرها. وبالتالي، فهذا يفسر لنا سبب انتقاد الشاطبي وأبي حيان والسنوسي للفخر الرازي؛ إذ إنه بمسلكه هذا يخالف الموقف الكلامي المتقدِّم النابذ للفلسفة، لِما فيها من المخالفات للأصول الاعتقادية السُّنّية. كما أنه لا يكتفي بالقصد من علم التفسير كما هو معهود في الصنعة التفسيرية، أي: الاكتفاء بالكشف عن المراد.
3. خاتمة:
ظهر معنا أنّ لفنّ التفسير أعرافًا في تعاطيه والكتابة فيه، وقد تبيّن كيف أن الرازي خرَق هذه الأعراف وخرج عليها ما جَرّ عليه نقدًا كثيرًا من العلماء؛ فقد اتسم الرازي في كتابته التفسيرية بالتركيز على القضايا الكلامية، وقد تجلى هذا التركيز في: إنتاج الإشكالات الكلامية؛ كالمحكم والمتشابه وقانون التأويل والظاهر والباطن، وفي توظيف التفسير للاستدلال على صحة الموقف الكلامي والردّ على المخالفين. كما اتسم باتساعه في إيراد الاستشكالات والرد عليها، واستطراده في مناقشة كثير من المسائل التي حقها أن تؤخذ مسلَّمة في التفسير وتُبحَث في علوم أخرى، إلى جانب توظيفه للمعارف الفلسفية في التفسير.
وجاء نقد هذا المسلك في التفسير عند الرازي من فريقين؛ الفريق الأول: خصومه المذهبيون؛ كابن أبي الحديد وابن تيمية. والفريق الثاني: أشاعرة المغرب والأندلس.
- وقد ركّز ابن أبي الحديد في نقده على جانبين: خَرْق أعراف صناعة التفسير، وإدخال الفلسفة فيه. وأمّا ابن تيمية فركّز على النقد التداولي؛ إذ رأى أن تفسير القرآن يجب أن يراعي مقتضيات التخاطب وأعراف المخاطبين ومعهودهم زمن النزول، ولا ينبغي حمل معاني الألفاظ الشرعية على الدلالات الحادثة بعد زمن النزول.
- وأمّا نقدُ أشاعرة المغرب والأندلس للرازي فقد تركَّز على خرقه لأعراف صناعة التفسير، ولمبدأ استقلال كلّ علم بمسائله، وانبناء بعض العلوم على نتائج بعضها الآخر؛ كما اتجه أيضًا إلى إدماجه للفلسفة في التفسير لمخالفتها لسنن العرب في المعرفة والبيان، ولتعارضها مع الاعتقاد الأشعري المترسِّخ بالمغرب والأندلس، وهو الاعتقاد الذي ارتبط بأشعرية الجويني والتزم بها وحافظ عليها.
[1] ينظر في هذا السياق سَعْي الأستاذ محمد الحيرش إلى نمذجة علوم القرآن وفق هذه الأبعاد الثلاثة في: النص وآليات الفهم في علوم القرآن، دار الكتاب الجديد المتحدة، بيروت، ط1، 2013.
[2] ترجع هذه التقسيمات للباحث ياسر المطرفي، انظر: العقائدية وتفسير النصّ القرآني، مركز نماء، ط1، بيروت، 2016.
[3] يقول حاجي خليفة: «تفسيره: هذا كتاب عظيم الشأن، غني عن البيان، لخّص فيه من (الكشاف) ما يتعلق بالإعراب والمعاني والبيان، ومن (التفسير الكبير) ما يتعلق بالحكمة والكلام. ومن (تفسير الراغب) ما يتعلق بالاشتقاق وغوامض الحقائق ولطائف الإشارات». كشف الظنون عن أسامي الفنون، ج1، دار الكتب العلمية، 2008، ج1، ص186.
[4] البحر المحيط في التفسير، أبو حيان الغرناطي، تح: صدقي جميل، دار الفكر، بيروت، 1420، ج1، ص547.
[5] تحفة المسؤول، ابن الحاجب، تح: الهادي بن الحسين شبيلي، دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث - دبي، الإمارات، ط1، 1422هـ، ج1، ص136-137.
[6] المستصفى من علم الأصول، الغزالي، تح: حمزة بن زهير حافظ، شركة المدينة المنورة للطباعة، ج1، ص 16.
[7] لباب الإشارات والتنبيهات، للرازي، ومعه كشف التمويهات، للآمدي، تح: أحمد فريد المزيدي، دار الكتب العلمية، ص370.
[8] جامع البيان في تفسير آي القرآن، ابن جرير الطبري، مؤسسة الرسالة، ط1، 2000، ج1، ص163.
[9] الكشف والبيان عن تفسير القرآن، الثعلبي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط1، 2002، ج2، ص184.
[10] يقول ابن حجر مثلًا: «ورأيتُ في الإكسير في علم التفسير للنجم الطوفي ما ملخصه: ما رأيت في التفاسير أجمع لغالب علم التفسير من القرطبي ومن تفسير الإمام فخر الدين إلّا أنه كثير العيوب، فحدثني شرف الدين النصيبي عن شيخه سراج الدين الشرمساحي المغربي أنه صنف كتاب (المآخذ) في مجلدين بيَّن فيهما ما في تفسير الفخر من الزيف والبهرج وكان ينقم عليه كثيرًا، ويقول: يورد شُبه المخالفين في المذهب والدّين على غاية ما يكون من التحقيق، ثم يورد مذهب أهل السُّنة والحق على غاية من الوهاء. قال الطوفي: ولعمري إن هذا دأبه في كُتبه الكلامية والحكمية»، لسان الميزان، دار البشائر الإسلامية، ط1، 2002، ج6، ص320.
[11] بغية المرتاد، ابن تيمية، تح: موسى الدويش، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، السعودية، ط3، 1995، ص450-451.
[12] انظر مناقشته لقانون التأويل في التفسير الكبير، ج2، ص298، وفي ج22، ص9.
[13] انظر مناقشته لقضية المحكم والمتشابه عند كلامه في التفسير الكبير على قوله تعالى: {وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللهُ}، ج7، ص137.
[14] انظر مناقشته للباطنية في التفسير الكبير، ج2، ص257.
[15] اعتمد الرازي في تفسيره كثيرًا على تفاسير المعتزلة، وخاصة الكشاف للزمخشري، وعلى تفسيرات القاضي عبد الجبار وتفسير الأصم.
[16] انظر مناقشة الرازي لمسألة الأفلاك التسعة في التفسير الكبير، ج1، ص24؛ وفي ج2، ص381.
[17] انظر مناقشته للاستواء في ج11، ص262، وفي ج12، ص495، وفي الصفات الخبرية ج15، ص432.
[18] انظر: التفسير الكبير، ج2، ص381.
[19] انظر: التفسير الكبير، دار إحياء التراث العربي، ط3، 1420، بيروت، لبنان، ج4، من ص154 إلى 162.
[20] التفسير الكبير، ج4، ص154.
[21] التفسير الكبير، ج10، ص27.
[22] انظر هذه المسائل في التفسير الكبير، ج5، من ص296 إلى 343.
[23] ابن أبي الحديد، نقلًا عن كتاب المحصل للرازي، تح: حسين أتاي، دار التراث، القاهرة، ط1، 1411، ص48.
[24] نشير هنا إلى الصراع التاريخي بين المعتزلة والأشاعرة مع الغزالي ومن جاء بعده، أي: بعد إدماج الفلسفة في علم الكلام، وهذا أغضب المعتزلة. وفي هذا السياق يقول ابن الملاحمي الخوارزمي معرِّضًا بالأشعرية: «ثم الذي حداني على تصنيف هذا الكتاب... أني نظرتُ في زماننا إلى كثير من المتفقهة حرصوا على تحصيل علوم هؤلاء الفلاسفة المتأخرين -يعني الفارابي وابن سينا-، ومنهم فرقة ينتسبون إلى التمسك بمذهب الشافعي، فاعتدوا أن ذلك يكسبهم على الوقوف على التحقيق حتى في علوم الفقه وأصوله». انظر: تحفة المتكلمين، ابن الملاحمي، تح: الأنصاري ومدلونغ، ص3. وانظر أيضًا: اتصال الكلام بالفلسفة: فلسفة ابن سينا، فرانك غريفل، تهافت الفلاسفة للغزالي، وتحفة المتكلمين لابن الملاحمي، المرجع في تاريخ علم الكلام، زابينه شميتكه (إشراف)، تر: أسامة شفيع السيد، مركز نماء، بيروت، 2019، ج2، ص751.
[25] منهاج السنة النبوية، ابن تيمية، تح: محمد رشاد سالم، جامعة الإمام محمد بن سعود، ط1، 1986، ج5، ص439.
[26] البحر المحيط، أبو حيان الغرناطي، ج1، ص547.
[27] الرازي يرى شرف العلم في ذاته حتى السحر، وألّف فيه: (السر المكتوم).
[28] الموافقات، الشاطبي، تح: عبد الله الدراز، المكتبة التجارية الكبرى، مصر، ج1، ص51.
[29] الموافقات، الشاطبي، ج1، ص53.
[30] الموافقات، الشاطبي، ج1، ص54.
[31] الموافقات، الشاطبي، ج1، ص55.
[32] الموافقات، الشاطبي، ج1، ص56.
[33] شرح أمّ البراهين، السنوسي، تقديم: عصام أنس الزفتاوي، مؤسسة العلامة، ط1، القاهرة، 2015، ص19.
[34] طبقات الشافعية الكبرى، تح: محمود الطناحي وعبد الفتاح الحلو، مكتبة هجر، ط3، 1413، ج6، ص244.
[35] طبقات الشافعية الكبرى، ج5، ص192-193.
كلمات مفتاحية
الكاتب:

محمد عبيدة
حاصل على ماجستير النص الأدبي وفنونه، وأستاذ اللغة العربية للتعليم الثانوي التأهيلي.
مواضيع ذات صلة
((المعلومات والآراء المقدَّمة هي للكتّاب، ولا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع أو أسرة مركز تفسير))