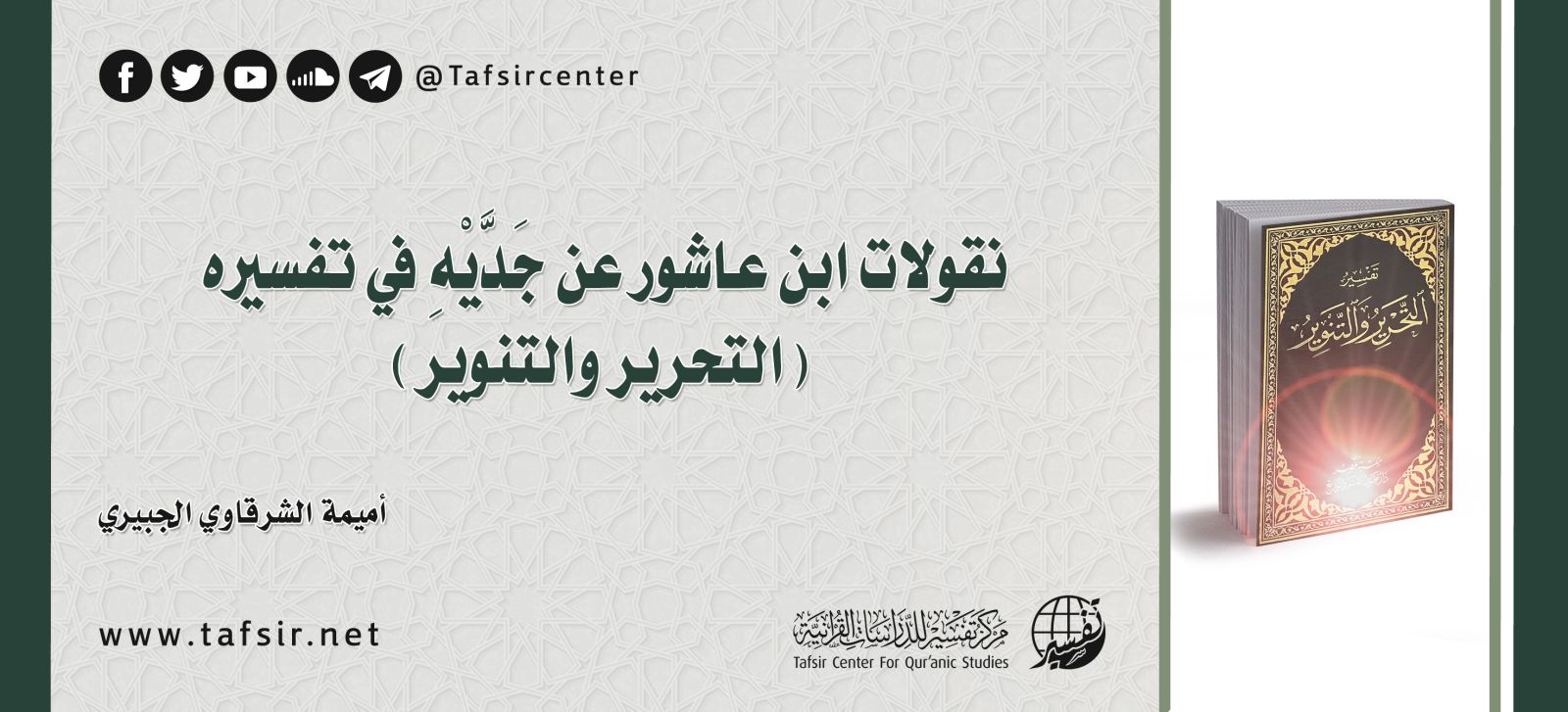التفسير السياقي عند ابن تيمية؛ قراءة نظرية تطبيقية
التفسير السياقي عند ابن تيمية؛ قراءة نظرية تطبيقية
الكاتب: محمد عبيدة

المقدمة:
تأتي هذه المقالة لتنظر في موقف ابن تيمية حول التفسير، وتأسيسه النظري لهذا الموقف. ويأتي هذا التركيز على موقف ابن تيمية لكونه يسلط الضوء على مسألة المراد وكيفية معرفته، وكيفية التعامل مع انفتاح دلالة النص القرآني؛ وهي مسألة محورية في السياق المعاصر، خاصة وأنّ كثيرًا من المساعي التفسيرية السائدة اليوم في الخطاب العصري والحداثي، تلغي من اعتبارها مسألة مراد المتكلّم، ومحوريته في الفهم، وتكتفي بما تحتمله الألفاظ من دلالات، الأمر الذي يؤدي إلى «سيولة تأويلية»، وانفتاح لا نهائي للدلالة، وضياع للقصد من النص، وفقدانه لدلالاته المركزية. وتبرز أهمية ابن تيمية من كونه أحد أبرز من نظّروا لمسألة المراد، وعدم الاكتفاء بالاحتمالات الدلالية للفظ، وضرورة تعيين المراد؛ وهذا الاهتمام من ابن تيمية راجع بالدرجة الأولى إلى اشتباكه المعرفي مع تأويلات المتكلمين لبعض المواضع من القرآن، الأمر الذي أثار انتباهه إلى ضرورة النظر في مراد المتكلم، واعتبار كل ما يعين على تحديده في التفسير، خاصة وأنه لاحظ أن بعض التأويلات الكلامية كثيرًا ما جنحت إلى حمل الألفاظ على معانٍ بعيدة، لمجرد احتمال اللفظ لها، وإن كان السياق القرآني يلغيها من الاعتبار.
وبهذا، نرى أن معالجة ابن تيمية للإشكال تظل تحتفظ براهنيّتها، خصوصًا في السياق المعاصر الذي برزت فيه العديد من القراءات الحداثية والمعاصرة الداعية إلى إنتاج تأويلات جديدة، تتوافق مع تطورات الواقع المعاصر. فكيف نظر ابن تيمية لمسألة المراد؟ وما الأسس التي بنى عليها مبدأ الكشف عن المراد؟ وما الآليات الكاشفة عنه لديه؟ هذا ما سنتعرف عليه في هذه المقالة.
وقبل الشروع في ذلكم الغرض يلاحظ أننا سنجعل مقاربتنا للتفسير السياقي عند ابن تيمية حاوية للتنظير والتطبيق عند ابن تيمية؛ فذاك أدعى لتكامل النظر، وعليه فستأتي المقالة مقسومة لقسمين؛ أحدهما للتأسيس النظري، والآخر لاستعراض التطبيق التيمي.
القسم الأول: التفسير السياقي عند ابن تيمية؛ التأسيس النظري:
أولًا: التفسير من حيث هو كشف عن المراد:
تتأسّس نظرية ابن تيمية التأويلية -بغضّ النظر عن تحرير مفهوم التفسير عند ابن تيمية- على مبدأ أساس يتمثّل في الكشف عن المراد، وتوظيف كل ما يُعِين على تعيينه وتحديده، وفي التخلي عن الرؤى المسبقة في التفسير، والحرص على عدم تدخلها في عمليات التوجيه والتأويل والترجيح.
يرى ابن تيمية أنه لفهم أيّ نص لغوي ومعرفة مراداته وقصوده، فإنه قد لا يكفي في بعض الحالات الاقتصار على بنائه النصي، وعلاقاته التركيبية والدلالية والمعجمية والصرفية؛ بل لا بد من تحقق جملة أمور (خارج-لغوية)، منها:
- معرفة عادات المتكلم واستعمالاته.
- المعرفة بأحوال المتكلم.
- المعرفة بظروف الخطاب وسياقاته والأحوال التي جرت فيه.
- العلم بأعراف المخاطبين ولغاتهم وعاداتهم وتصوراتهم.
ولما كان النص القرآني الكريم نصًّا لغويًّا، فقد استلزم فهمه البحث في هذه الأمور، والاستعانة بها لكشف مراداته وقصوده التي هي موضوع علم التفسير. وبما أن علم التفسير قائم أساسًا على كشف المراد[1]، فقد فطن ابن تيمية -كغيره من المفسرين القدامى- إلى عدم كفاية المعرفة بأنساق لغة النص القرآني الدلالية والتركيبية والمعجمية وحدها لفهم مراداته، بل لا بد من الاستعانة بهذه المشيرات السياقية التي أشرنا إليها في تعيين هذه المرادات. وفي هذا يقول ابن تيمية: «ومن هنا نشأ الاضطراب بين الناس في مسألة كلام الله ومسألة أفعال الله فصاروا يحملون ما يسمعونه من الكلام على عرفهم، فغلط كثير منهم في فهم كلام السلف والأئمة بل وفي فهم كلام الله ورسوله؛ والواجب على من أراد أن يعرف مراد المتكلم أن يرجع إلى لغته وعادته التي يخاطب بها ليُفسّر مرادَه بما اعتاده هو من الخطاب فما أكثر ما دخل من الغلط في ذلك على من لا يكون خبيرًا بمقصود المتكلم ولغته»[2].
ويقول أيضًا في نص آخر: «واعلم أن من لم يحكم دلالات اللفظ ويعلم أن ظهور المعنى من اللفظ تارة يكون بالوضع اللغوي أو العرفي أو الشرعي إمّا في الألفاظ المفردة وإمّا في المركبة، وتارة بما اقترن باللفظ المفرد من التركيب الذي يتغير به دلالته في نفسه، وتارة بما اقترن به من القرائن اللفظية التي تجعلها مجازًا، وتارة بما يدل عليه حال المتكلم والمخاطب والمتكلم فيه وسياق الكلام الذي يعيّن أحد محتملات اللفظ أو يبين أن المراد به هو مجازه، إلى غير ذلك من الأسباب التي تعطي اللفظ صفة الظهور وإلّا فقد يتخبط في هذه المواضع»[3].
من هنا، كان ابن تيمية واعيًا بضرورة توظيف كل ما يُعِين على تعيين مرادات النص القرآني، فلجأ إلى توظيف كثير من المعطيات الدينية والثقافية في فهم القرآن الكريم، خاصة عند إلحاحه على مراعاة لغة العرب وأعرافهم وعاداتهم؛ فلم يقصر هذه العادات على الجانب اللغوي واللساني فقط كما مرّ معنا، بل تعدّاه إلى عادات العرب الثقافية، وتصوراتهم، ونظراتهم إلى الوجود. ولهذا التوظيف كما أشرنا مسوغات تداولية تتعلق بفهم الخطاب القرآني؛ ذلك أن من شروط فهم الكلام ومعرفة مراد المتكلم به: معرفة عاداته في الكلام، واستعمالاته اللغوية، وحمل الألفاظ على تلك الاستعمالات. ولمّا كانت بعض الاستعمالات لا يتوقف فهمها على مجرد الدلالات اللفظية والمعجمية، تطلّب الأمر البحث في دلالاتها الثقافية والعرفية... إلخ.
ثانيًا: التأسيس للكشف عن المراد:
أ. التأسيس المعرفي-التداولي لحجية فهم السلف:
في سياق التأسيس:
عاش ابن تيمية في عصر استقرت فيه التقاليد التأويلية الكلامية -وخاصة الأشعرية- بمناهجها وآلياتها. غير أنه -وانطلاقًا من اعتقاده السلفي- رأى ميلًا عن طرائق السلف في الفهم؛ خاصة فيما يتعلق بنصوص صفات الله تعالى وأفعاله. ورأى أنّ خللًا قد داخل مناهج التأويل، فتعيّن عليه (تصحيح الخلل)، من خلال العودة إلى فهم السلف وطرائقهم في الفهم. وقد كانت الأشعرية زمن ابن تيمية قد استقرت وانتشرت وصار لها الغلبة؛ كما كانت الأشعرية حينها متأثرة إلى حد بعيد بمقررات الإمام الفخر الرازي الكلامية والتأويلية. وفيما يتعلق بالتأويل، فالرازي قد عُرف عنه القول بظنية النصوص القرآنية، لحاجتها إلى اجتماع شروط عشرة يعسر اجتماعها، وبالتالي، فلا مناص من اعتماد الدلائل العقلية وجعلها أصلًا ثم تأويل النصوص وفق مقتضاها. كما عُرف عن الرازي في تأسيس التقديس ردّه لكثير من الأحاديث والأخبار لدلالتها على التجسيم حسب وجهة نظره التنزيهية. وفي هذا السياق الجدلي الكلامي، سعى ابن تيمية إلى إبراز أنّ الدلائل النقلية تفيد اليقين، لا من جهة نقل اللغة، ولكن من جهة فهم الصحابة؛ كما دافع عن حجية الحديث النبوي في التفسير أيضًا.
والذي يهمنا في هذا السياق معرفة كيف دافع ابن تيمية عن حجية فهم السلف من جهة، وكيف بيّن أسبقية فهم السلف على الفهم اللغوي-الفيلولوجي من جهة أخرى.
التأسيس التداولي:
خصص ابن تيمية كتابه: (جواب الاعتراضات المصرية على الفتيا الحموية) للردّ على الاعتراضات التي وجهها إليه قاضي القضاة شمس الدين السروجي[4]؛ وهي اعتراضات تدور حول نصوص الصفات وكونها محتملةً لأنها ظواهر وليست نصوصًا قاطعة، وكونها معارضة بالقواطع العقلية التي تحتم تأويلها[5]. ويهمنا من ردّ ابن تيمية على السروجي تأسيسه النظري لحجية فهم السلف، وكونه الطريق الأقوم لفهم نصوص الوحي. وقد تنوعت حجج ابن تيمية بين النصوص القرآنية التي تثبت تفسير النبي -عليه السلام- للقرآن للصحابة، وبين الحجج العقلية. وفي هذا الصنف الثاني، يكشف ابن تيمية عن الأسس التي أقام عليها منهجه في اعتماد تفسير السلف.
يرى ابن تيمية في هذا الكتاب أنّ للمؤشرات السياقية خارج-اللغوية دورًا حاسمًا في الكشف عن مراد المتكلم؛ وانطلاقًا من هذا الموقف التداولي، يؤسس ابن تيمية حجية فهم السلف للقرآن الكريم، ومن ثم يعتمد على أقوالهم في التفسير. إنّ العلم بمرادات الوحي عند ابن تيمية لا يتم إلا بالمعرفة بلغة الوحي وظروف تنزيله وأحوال المتكلم والمخاطبين زمن النزول. وهذه الشروط لا تتوفر إلا في الصحابة. يقول: «الوجه الرابع: أن أصحابه المعروفين هم الذين نزل القرآن بلغتهم، فإنّ لغات العرب وإنِ اشتركت في جنس العربية فبينها افتراق في مواضع كثيرة، والنبي -صلى الله عليه وسلم- لمّا خاطب أهلَ اليمن كتب إليهم بلغةٍ هي غريبة بالنسبة إلى لغة قريش، والقرآن نزل بلغة قريشٍ ونحوِهم من أهل الحاضرة والبادية، وأولئك هم خواصُّ أصحابه، فلا يحتاجون في معرفة لغتهم وعادتهم في خطابهم إلى شعر شاعر غيرهم، فضلًا عمن يكون حدَثَ بعدَهم.
الوجه الخامس: أن الصحابة سمعوا من النبي -صلى الله عليه وسلم- من الأحاديث الكثيرة، ورأوا منه من الأحوال، وعلموا بقلوبهم من الأمور ما يُوجب لهم من فهم ما أراد بكلامه ما يتعذرُ على مَن بعدهم. فليس من سمع ورأى وعلم حالَ المتكلم كمن كان غائبًا، ولم يرَ ولم يسمع منه، ولكن عَلِمَ بعض أحواله وسَمِع بواسطةٍ. وإذا كان الصحابة سمعوا لفظه وفهموا معناه كان الرجوع إليهم في ذلك واجبًا متعينًا، ولم يُحتَجْ مع ذلك إلى غيرهم»[6].
يلحّ ابن تيمية في هذا النقل على أمرين بالغي الأهمية؛ الأول: أنّ القرآن نزل بلغة الصحابة وأهل مكة خاصة، فهم أولى الناس بفهمه؛ لكونه نزل بلغاتهم وعاداتهم الكلامية، ولأنهم أعرف الناس بظروف النزول وأسبابه، وبحال النبي -عليه السلام- وهو يتلوه ويبلّغه ويبينه. وبما أن هذين الشرطين التداوليين لم يتحققا إلا في جيل الصحابة وتابعيهم الذين تلقوا عنهم هذا الفهم، فقد صار من الواجب الاعتماد على أفهامهم.
والثاني: أن فهم السلف عنده مقدَّم على استعمالات العرب اللغوية وعاداتهم وأعرافهم؛ لأن قبائل العرب متعددة، ولغاتهم متعددة بتعدد القبائل، إلى حد أن بعض الصحابة قد استشكل بعض الألفاظ في بعض رسائل النبي -عليه السلام- إلى أهل اليمن، والقرآن إنما نزل بلغة قريش؛ لذلك، كان فهم الصحابة أولى من توظيف عادات العرب وأعرافهم واستعمالاتهم اللغوية.
ويؤكد هذا الإلحاح على شدة اعتماد ابن تيمية على الأساس التداولي في فهم الخطاب؛ ذلك أن مجرد العلم بلغة المتكلم لا يكفي إذا لم يقترن معه العلم بالمتكلم وأحواله والملابسات التي أحاطت به أثناء التخاطب. وهذا لم يتحقق في كل العرب، بل في فئة منهم، هي فئة الصحابة الذين شهدوا التنزيل.
وينبغي أن نشير إلى أنّ إلحاح ابن تيمية على مسألة المراد يرجع إلى خلفيته المعرفية التي يستند إليها، وهي خلفية وصفية، تقوم على وصف ما يحصل بين المتخاطبين في اللغة الطبيعية، دون أيّ سعي إلى تأسيس نظري أو معياري للفهم. والذي يؤكد هذا المنحى الوصفي عند ابن تيمية أنه في نظرية المعرفة عمومًا، يستند إلى طرائق بني آدم التي اتفقوا عليها في البحث والنظر؛ فرفضه للمنطق كأساس معياري للفكر راجع إلى كون البشر قبل أرسطو وبعده لم يكونوا محتاجين إليه في تأسيس علومهم ومعارفهم، وأنهم فُطروا على طرائق معرفية محددة، وكل خروج عنها خطأ محض[7]؛ لأن ما اتفق عليه عقلاء بني آدم لا يكون إلا حقًّا[8]. ولمّا كان الناس متفقين على أن الفهم يتم بمعرفة المراد، وعلى أن المراد يتم الوصول إليه بما ينصبه المتكلم من قرائن وعلامات تشير إلى مقصوده، وبحمل ألفاظه على المعاني التي اعتاد استعمالها فيه، وبالظروف والأحوال المحيطة بعملية التخاطب، ولمّا كان الناس يفهمون بعضهم بهذه الطرائق ويتواصلون بها، لزم أن تستعمل هذه الطريقة في فهم القرآن أيضًا[9]. ولمّا كان الصحابة أكثر الناس تحققًا بهذه الشروط، لزم الأخذ بتفسيرهم.
وإذن، فابن تيمية حين أسس لحجية السلف كان منطلقًا من أساس لغوي-تداولي متين، ولم يكن تأويله راديكاليًّا أو متشددًا لمجرد التشدد والجمود والتقليد المحض. فالأخذ بفهم السلف نتيجة منطقية لهذه الأسس التداولية والمعرفية. وبهذا، ساغ لابن تيمية محاكمة التأويلات الكلامية والصوفية في ضوء موافقته أو مخالفته لفهم السلف، ويصير كل قول مخالف لأقوالهم -مخالفة تضاد لا تنوُّع- ساقط الاعتبار.
ب. فهم ألفاظ الوحي وفق استعمال المخاطبين زمن النزول:
كانت لابن تيمية عناية شديدة بألفاظ الوحي، وبالحفر في دلالاتها زمن النزول، والكشف عن تطوراتها التاريخية، والإضافات أو التخصيصات الدلالية التي مسّتها عبر التطور التاريخي. وهذه العناية مؤطرة بتصوره التداولي؛ إذ كان ابن تيمية حريصًا على تجنُّب حمل ألفاظ الوحي على معانٍ حادثة بعد زمن النزول؛ وبالتالي، كان يسعى إلى إزالة تلك الطبقات الدلالية التي ترسّبَت مع مرور الزمن، وتغيّر استعمال تلك الألفاظ لدى المتكلمين والأصوليين والفلاسفة. بل بحثُهُ في دلالات الألفاظ واستفصالُه فيها أشهرُ من أن يُذكر هنا؛ كبحثه في دلالة لفظ التأويل في القرآن، والتنبيه إلى خطأ حَمْلِه على المعنى الحادث له في الصناعة الكلامية، وكتأويله لمعنى الكلمة، والتنبيه إلى خطأ حملِها على اللفظ المفرد الحادث في الصناعة النحوية، وكلفظ الجسم والذات وغيرها.
لكن، هذا الاهتمام بألفاظ الوحي يظل عند ابن تيمية مرتبطًا بتفسير السلف وفهمهم؛ فمجرد الاعتماد على معاني الألفاظ المستعملة عند العرب -كما أشرنا سابقًا- لا يكفي لفهم الوحي؛ ذلك أن القرآن لم يترك الألفاظ على معانيها الأصلية المستعملة عند العرب، بل أجرى تعديلات دلالية عليها، إمّا بتوسيع مدلولاتها، أو تضييقها وقصرها على بعض معانيها. من هنا، ففهم السلف مقدَّم على الاستعمال العربي لهذه الألفاظ؛ يقول ابن تيمية:
«من المعلوم أن جنس ما دلَّ على القرآن ليس من جنس ما يتخاطب به الناس في عادتهم، وإن كان بينهما قدرٌ مشترك،فإنّ الرسول جاءهم بمعانٍ غيبية لم يكونوا يعرفونها، وأمَرَهم بأفعالٍ لم يكونوا يعرفونها، فإذا عبّر عنها بلغتهم كان بين ما عناه وبين معاني تلك الألفاظ قدرٌ مشترك، ولم تكن مساويةً لها، بل تلك الزيادة التي هي من خصائص النبوة لا تُعرَف إلّا منه»[10].
وبالتالي، فحتى العلم بمعهود العرب يظل غير كافٍ في العلم بمرادات القرآن؛ لأن القرآن قام بمجموعة من التعديلات الدلالية والإضافات في المعنى، التي لا تعلم بمجرد اللغة. وهذا الذي يشير إليه ابن تيمية هو ما يعبر عنه الأصوليون بالحقائق الشرعية، ويقصدون بها أن القرآن قد غيَّر في أوضاع اللغة، ونقَل الألفاظ عن معانيها اللغوية إلى معانٍ شرعية جديدة. وهذه المعاني لا شك أن أعلم الناس بها هم الصحابة.
وأمّا إذا اعترض معترض عليه بظنية روايات السلف وكونها من طريق الآحاد، فإن ابن تيمية يردّ بأن الظنية في نقل اللغة أكثر منها في نقل مرويات السلف؛ فإن العلم باللفظ الغريب منقول عن الآحاد، أو قد يكون استعمالًا خاصًّا لأحد الشعراء في الجاهلية، أو مجازًا، أو فهمًا خاصًّا لأحد العلماء بلسان العرب؛ وعمومًا، فالظن يتطرق إلى النقل عن العرب أكثر مما يتطرق إلى مرويات الصحابة والتابعين الذين توافرت الهمم على نقل تفاسيرهم وعلومهم أكثر مما توافرت في نقل اللغة، كما أن مرويات الآحاد في نقل اللغة أكثر منها في نقل مرويات السلف التي تواترت بمعانيها وتعددت طرقها... وأيضًا، فإن الاعتماد على القوانين اللسانية من تركيب وتصريف يداخله الظن من حيث إن واضع القانون النحوي قد يغفل عن بعض الظواهر اللغوية عند تقنينها، فليس الاعتماد على أوضاع النحو والتصريف بيقينيّ عند ابن تيمية[11]. وبالتالي، فلتضييق الاحتمالات وتعيين المراد لا بد من الاعتماد على أفهام السلف.
ت. المرويات التاريخية بوصفها معطيات سياقية:
إذا كان ما ذكرناه في الأعلى هو المسلك المعتمد لدى ابن تيمية في التعامل مع القرآن الكريم وتفسيره، فإنه لجأ إلى توسيع مجال توظيف المعرفة السياقية، خاصّة فيما يتعلق بقصص الأنبياء، وأخبار القرون الماضية؛ وتأتي أهمية هذه الموارد في أنها تضع الآيات القرآنية في سياق نزولها، وتضيء معرفتنا بأحوال الأقوام الذين نزلَت فيهم، وأديانهم ومعتقداتهم وعاداتهم، وتعين على كشف المراد من الآيات، وتضيق مجال التأويل وانفتاح الدلالة على الاحتمالات، كما أنها تحجب (التوظيف المذهبي) للآيات أحيانًا. وبتتبع الموارد المعرفية التي وظّفها ابن تيمية في تأويله لبعض النصوص القرآنية، يمكن الوقوف على نوعين من هذه الموارد السياقية:
- المرويات الإسرائيلية.
- الأخبار والمرويات التاريخية.
ورغم أن ابن تيمية يذهب إلى ضرورة توظيف هذه المعارف السياقية في فهم القرآن الكريم، لكونها تُعِين على تعيين المراد كما أسلفنا؛ إلا أنه يعود فيشترط الصحة في هذه المرويات التاريخية قبل توظيفها؛ نظرًا لكونها تشتمل على الصدق والكذب؛ ولا يصح عنده توظيف أيّ مورد تاريخي -سواء أكان من الإسرائيليات أم من كتب الأخبار والمقالات أم من كتب الحديث- ما لم يتم التحقق من صدقيته التاريخية؛ فشرط التحقق من الصدق التاريخي سابق على التوظيف الاستدلالي لها في التفسير؛ يقول: «وقد جعل بعض الناس معرفة التاريخ من المقالات، ولعمري إنها لداخلة فيما يقص من أحوال الناس وأفعالهم؛ ولكن الشأن في تمييز الصدق منها من الكذب والاعتبار بالصدق منها، كما قال تعالى: {لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى}[يوسف: 111]، فدل على أنّ فيما يقصه الناس في تواريخهم ومقالاتهم ومذاهبهم ما هو مفترًى لا حقيقة له؛ فكُتُب المؤرخين الذين لا يقصدون الكلام على الآراء والديانات فيها ما يشتمل على الصدق والكذب، وهي أكثر التواريخ التي لم توزن بتمييز أهل المعرفة بالمنقولات، وكذلك الكتب التي يُذكَر فيها مقالات الناس وآراؤهم ودياناتهم فيها ما يشتمل على الصدق والكذب، وهي ما لم توزن بنقد مَن يخبر المقالات، وكذلك تعمُّد الكذب قليل في أهل العقول والديانات المصنِّفين لتواريخ السِّيَر»[12].
هذا المبدأ المعرفي حاسم عند ابن تيمية في قبول المعرفة التاريخية التي توظَّف في التفسير؛ فإن كانت مشكوكًا في صحتها أو غير موثوقة، أو داخَلها الكذب أو التحريف، استحال عندها توظيفها في التفسير، ولربما أدت إلى إساءة الفهم أيضًا؛ وفي ورقة أخرى سنقف على أحد الأمثلة التي تشبث فيها ابن تيمية بضرورة صحة المعرفة التاريخية، خاصة في ما يتعلق بالإسكندر، وما رواه عنه الإسلاميون من الأخبار.
ومما يدل على هذا المسلك النقدي لابن تيمية أنه أشاد بتفسير الطبري، الذي امتلأ من إيراد المرويات التاريخية والإسرائيليات عن الأمم القديمة، في حين انتقد الثعلبي ووصفه بأنه حاطب ليل؛ وهذا راجع إلى اختلاف طبيعة تعاطي كل منهما معها، إذ كان تعاطي ابن جرير محكومًا بالحذر والوعي النقدي، خلافًا لتعامل الثعلبي الذي اكتفى بالسرد دون تعليق. وهذا التعامل النقدي جعل تفسير ابن جرير -وهو المحدث والمؤرخ واللغوي- أرفع التفاسير وأجلّها عند ابن تيمية. لذلك، فالإسرائيليات، عنده معتبرة، لكن بحذر نقدي، لاختلاط الحق فيها بالباطل. وهذا المنهج ليس مقصورًا عنده على الإسرائيليات، بل في المرويات التاريخية الأخرى أيضًا كما مرّ معنا، وفي الروايات الحديثية.
بعد أن كشفنا عن التأسيس التأويلي لابن تيمية، وارتباطه بالكشف عن المراد، وإلحاحه على اعتماد فهم السلف، وتأسيسه التداولي لحجيته، سنسعى في القسم التالي بإذنه تعالى إلى بيان مسالك ابن تيمية التطبيقية وكيفية تعامله مع بيان المراد والموارد اللازمة للوصول إليه.
القسم الثاني: التفسير السياقي عند ابن تيمية؛ نظرة في التطبيق التيمي:
سنعمل في هذا القسم على استعراض جانب من تطبيقات ابن تيمية التفسيرية التي تبرز نظرته للوصول إلى مقصود النص والمراد منه والأدوات اللازمة لذلك، وهو ما سنقوم به من خلال النظر في تفسيره لمحاجّة إبراهيم -عليه السلام- لقومه وإبطال عبادتهم للأجرام العلوية، ولقصة ذي القرنين.
أولًا: قصة استدلال إبراهيم -عليه السلام- على ربوبية الله:
1. تأويل الأُفول في قول الخليل -عليه السلام- مع قومه: {لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ}:
يُجمِع أهلُ التفسير على أنّ قوم إبراهيم -عليه السلام- هم الصابئة، كما يُجمعون على أنهم كانوا يشركون مع الله تعالى عبادة الكواكب، ويبنون لها الهياكل. وقد ظل للصابئة وجود بالعراق وحران ودمشق طيلة الأزمنة الإسلامية الوسيطة، وقد خالطهم العديد من العلماء بالفِرَق والآراء والديانات. لذلك، فقد كان للمفسرين مورد مهم يتعلق بقصة سيدنا إبراهيم. غير أننا نلحظ أنه -رغم هذه المعرفة بالصابئة- إلا أنّ بعضًا من المفسرين ذهب في تأويل قوله تعالى: {فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا}[الأنعام: 76] إلى السكوت عن هذه (المعرفة)، وركّزوا على التأويل اللغوي، باستثمار الاحتمالات اللغوية التي تتيحها الآيات. يقول الحق سبحانه حاكيًا موقف إبراهيم مع قومه في سورة الأنعام: {وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ * فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ * فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِنْ لَمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ * فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ * إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ}[الأنعام: 75- 79].
يقول الزمخشري في تفسير الآيات: «وكان أبوه وقومه يعبدون الأصنام والشمس والقمر والكواكب، فأراد أن ينبههم على الخطإ في دينهم، وأن يرشدهم إلى طريق النظر والاستدلال، ويعرفهم أن النظر الصحيح مؤدّ إلى أنّ شيئًا منها لا يصح أن يكون إلهًا؛ لقيام دليل الحدوث فيها، وأن وراءها محدثًا أحدثها، وصانعًا صنعها، ومدبرًا دبّر طلوعها وأُفولها وانتقالها ومسيرها وسائر أحوالها، {هَذَا رَبِّي} قولُ مَن يُنصِف خصمَه مع علمِه بأنه مبطل، فيحكي قوله كما هو، غير متعصب لمذهبه؛ لأنّ ذلك أدعى إلى الحق وأنجى من الشغب، ثم يكرّ عليه بعد حكايته فيبطله بالحجة، {لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ} لا أحب عبادة الأرباب المتغيرين عن حال إلى حال، المتنقلين من مكان إلى مكان، المحتجبين بستر»[13].
ويقول ابن عطية: «ثم عرض إبراهيم عليهم من حركته وأُفوله أمارة الحدوث، وأنه لا يصلح أن يكون ربًّا، ثم في آخر أعظم منه وأحرى كذلك، ثم في الشمس كذلك، فكأنّه يقول: فإذا بَانَ في هذه المنيرات الرفيعة أنها لا تصلح للربوبية فأصنامكم التي هي خشب وحجارة أحرى أن يبين ذلك فيها، ويعضد عندي هذا التأويل قوله: {إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ}[الأنعام: 78]»[14].
يؤول الزمخشري وابن عطية -رحمهما الله- استدلال إبراهيم بكونه استدلالًا بالحدوث، لأنّ الأُفول حركة، والحركة تغيُّر، والتغيّر من صفات الأجرام والأجسام؛ ولمّا كان الإله منزَّها عن الجسمية والحركة والانتقال والتغير، لزم أن لا تكون هذه الأجرام آلهة، ولزم أن تكون مخلوقة لإله غير متغير ولا حادث.
يرى ابن تيمية أن هذا التأويل قد اعتراه النقص من جهة عدم مراعاته لسياق الآية، ولطبيعة الثقافة السائدة زمن النبي إبراهيم -عليه الصلاة والسلام-، كما سنبين بإذنه تعالى.
2. التأويل السياقي لقصة إبراهيم عليه السلام:
انتهج ابن تيمية في تأويله للآيات السابقة مسلكًا سياقيًّا انطلق فيه من البحث اللغوي الفيلولوجي، ساعيًا إلى تحديد المقصود باللفظ زمن نزول الوحي؛ كما استند إلى مقتضيات السياق النصي الذي وردت فيه الآيات؛ وإلى السياق القرآني العام باعتباره نصًّا واحدًا متماسكًا؛ وإلى المعطيات الثقافية والدينية المتوفرة عن قوم إبراهيم -عليه السلام-؛ يقول ابن تيمية: «فقد أخبر الله في كتابه أنه من حين بزغ الكوكبُ والقمر والشمس وإلى حين أُفولها لم يَقُل الخليلُ: لا أحب البازغين ولا المتحركين ولا المتحولين ولا أحب من تقوم به الحركات ولا الحوادث، ولا قال شيئًا مما يقوله النفاة حين أفل الكوكب والشمس والقمر. (والأفول) باتفاق أهل اللغة والتفسير هو المغيب والاحتجاب بل هذا معلوم بالاضطرار من لغة العرب التي نزل بها القرآن وهو المراد باتفاق العلماء؛ فلم يقل إبراهيم: {لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ}[الأنعام: 76] إلّا حين أَفل وغاب عن الأبصار فلم يبقَ مرئيًّا ولا مشهودًا، فحينئذٍ قال: {لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ}»[15].
يمكن إجمال اعتراضات ابن تيمية على تأويل لفظ الأُفول بالحدوث في:
أ. تأويل الأُفول بالحدوث لم يُعرف عن أهل التفسير من السلف:
يعترض ابن تيمية على تفسير الأُفول بالحدوث بكونه لم ينقل عن السلف، وهو ما يعني بطلانه. وهذا البطلان ليس ناتجًا عن كونه ليس منقولًا عنهم، بل لكونه يتعارض -حسب ابن تيمية- مع ما تواتر عنهم في باب الصفات وإثباتها؛ فمقتضى هذا التأويل أنّ الله منزَّه عن الانتقال، وهذا يتعارض مع الأحاديث والأخبار التي تحدثت عن نزول الله تعالى إلى السماء الدنيا كلّ ليلة، وعن غيرها من الأخبار؛ كما يتعارض مع إثبات الصفات التي يعتبرها المتكلمون تركيبًا أو من لوازم الجسمية التي ينزّه عنها الباري تعالى... وهذا التعارض يعني سقوط هذا التأويل وبطلانه ابتداء؛ لاستحالة قبول تأويل يناقض فهم السلف من الصحابة والتابعين، لكونهم أعلم بمرادات الخطاب كما بينّا في القسم السابق.
ب. حمل لفظ الأُفول على معنى حادثٍ بعد زمن النزول:
يعزز ابن تيمية الاعتراض السابق بمبدأ تداولي آخر، وهو اشتراط حمل ألفاظ الوحي على المعنى المعروف لدى المخاطبين الأُوَل، سعيًا إلى تجنُّب الوقوع في إساءات الفهم، وفي الاستعمال الخاطئ للألفاظ، وتحميلها دلالات لم تكن لتدل عليها. ويسبب إغفال هذا المبدأ إساءة للفهم، خاصة وأن دلالات اللغة متحركة ومتغيرة، فتُصبح للّفظ دلالات جديدة واستعمالات مغايرة عبر الزمن. من هنا، تأتي أهمية الحفر في تاريخ اللفظ وتطور دلالاته واستعمالاته عبر الزمن، وعلى هذا الأساس يشترط ابن تيمية في حمل اللفظ على المعنى أن يكون اللفظ موضوعًا لذلك المعنى ومعروفًا لدى المخاطبين باللغة زمن التخاطب، وإلا امتنع الفهم؛ وبالتالي، فلفظ الأفول لا يدل في لغة العرب على الحدوث بل على الغروب، وحمل لفظ الأفول على الحدوث لكونه حركة اصطلاح لغوي خاص بالمتكلمين، وحادث بعد زمن النزول بقرون؛ ولا بد من حمل اللفظ على المعنى المستعمل فيه زمن التخاطب، والمعلوم في عرف المخاطبين.
ت. دلالة النَّظْم، والسياق الداخلي للآيات:
لم يقف ابن تيمية عند حد التحليل الفيلولوجي للفظة الأُفول، بل مضى في هذا النص ليبين أن حمل لفظ الأفول على معنى الحركة لا ينسجم مع سياق الآيات الداخلي؛ فيلاحظ ابن تيمية في هذا المستوى أن حمل لفظ الأفول على الحدوث لا ينسجم مع سياق المحاورة، بل يؤدي إلى اضطراب الاستدلال فيها وإلى عدم الاتساق؛ فإذا كان إبراهيم يستدل على حدوث الشمس والقمر بالحركة، فلماذا لم يستدل بطلوع هذه الأجرام وحركتها في السماء وانتظر إلى حين غروبها؟ إذ لو كان قصده الاستدلال بالحركة لاكتفى بأدنى حركة للأجرام، ولاستدل بمجرد طلوعها دون الانتظار إلى حين الغروب. وإذن، فهذا يدل على عدم قصده الاستدلال على الحدوث، بل على أحقية الله بالعبادة والقصد والطلب، ودلالة الأفول على هذا المراد واضحة جلية، إذ إنّ الله أولى بالقصد والطلب، لكونه حاضرًا دائمًا لا يغيب، بخلاف هذه الأجرام التي تحضر حضورًا مؤقتًا وتغيب، فيمتنع طلبها حال غيابها. يقول ابن تيمية: «وقوله: {لا أُحِبُّ الآفِلِينَ}[الأنعام: 76] كلام مناسب ظاهر، فإنّ الآفِل يغيب عن عابده فلا يبقى وقت أفوله من يعبده ويستعينه وينتفع به، ومن عبد ما يطلب منه المنفعة ودفع المضرة فلا بد أن يكون ذلك في جميع الأوقات، فإذا أفل ظهر بالحس حينئذ أنه لا يكون سببًا في نفع ولا ضر فضلًا عن أن يكون مستقلًّا»[16].
ث. دلالة السياق النصي العام:
في هذا المستوى، يركّز ابن تيمية على استقراء مختلف السياقات القرآنية التي وردت فيها قصة إبراهيم -عليه السلام- مع قومه، ليتحصل لديه من مجموع هذه السياقات النصية إدراك المراد من المحاورة؛ وهو هنا يتعامل مع القرآن باعتباره وحدة نصية كبرى تنسجم وحداته النصية وتتماسك وتتضافر.
وبالعودة إلى هذه السياقات القرآنية، يجد ابن تيمية أن القرآن الكريم كان ينسب لقوم إبراهيم الشرك، لا تعطيل الصانع؛ يقول: «ولكن كان قومه يعبدون الكواكب مع اعترافهم بوجود رب العالمين وكانوا مشركين يتخذ أحدهم له كوكبًا يعبده ويطلب حوائجه منه كما تقدم الإشارة إليه؛ ولهذا قال الخليل -عليه السلام-: {أَفَرَأَيْتُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ * أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمُ الْأَقْدَمُونَ * فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ}[الشعراء: 75- 77]، وقال تعالى أيضًا: {قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ}[الممتحنة: 4]، فأمَر سبحانه بالتأسِّي بإبراهيم والذين معه في قولهم لقومهم: {إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ}. وكذلك ذكر الله عنه في سورة الصافات أنه قال لقومه: {فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ}[الصافات: 87]، وقال لهم: {أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ * وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ}[الصافات: 95، 96]. فالقوم لم يكونوا جاحدين لربّ العالمين، ولا كان قوله: {هَذَا رَبِّي} هذا الذي هو خَلَق السماوات والأرض على أيّ وجه قاله سواء قاله إلزامًا لقومه أو تقديرًا أو غير ذلك، ولا قال أحد قط من الآدميين أنّ كوكبًا من الكواكب أو أن الشمس والقمر أبدعت السماوات كلها».
فابن تيمية هنا، وانطلاقًا من قوله تعالى: {إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ}[الشعراء: 77]، بيّنَ أنّ قوم إبراهيم إنما كانوا مشركين فقط، وأن الخليل إبراهيم استثنى اللهَ تعالى من عداوته دون بقية آلهتهم. وهنا تظهر فاعلية النظر إلى القرآن الكريم من حيث هو نص واحد، يفسّر بعضه بعضًا، ويعضد بعضه بعضًا؛ فلا يكفي النظر إلى الآية في ذاتها، وبمعزل عن سياقها، كما لا يكفي الاعتماد على الاحتمالات الدلالية للآية، بل لا بد من النظر في مختلف سياقات ورود القصة، ومدى ملاءمة الاحتمال لتلك السياقات وتناسبه معها.
وهنا يلاحظ أن ابن تيمية يعتمد تفسير القرآن بالقرآن من جهة، ومن جهة أخرى، يعتمد على التتبع الزمني الذي يضعه القرآن الكريم للكشف عن تطور الشرك عبر التاريخ. فانطلاقًا من النصوص التي تؤكد على أولية رسالة نوح، رأى ابن تيمية أن أول شرك في الأرض كان تقديس الأولياء والصالحين، ثم بتتبع الرسالات، وجد أن النوع الثاني من الشرك (المتأخر زمنيًّا) سيظهر مع قوم إبراهيم -عليه السلام-، والمرتبط بعبادة الهياكل الموضوعة للأفلاك والأجرام السماوية. وفي مرحلة لاحقة سيأتي تعطيل الصانع مع فرعون موسى -عليه السلام-[17]. وقد أفاد هذا التتبع التاريخي-القرآني ابن تيمية في فهم لفظ الأفول وفي ضعف تأويله بالحدوث، من حيث إنّ قوم إبراهيم -عليه السلام- لم يكونوا في حاجة إلى إثبات وجود الله تعالى بنص القرآن، إذ كانوا مؤمنين بوجوده، بل كان جدال إبراهيم معهم حول أحقية الله تعالى بالتفرد بالعبادة والطلب، وأن هذه الكائنات بنفسها محتاجة لله، كما أنها تغيب وتأفل ولا تبقى دائمًا، فلا تحضر حين احتياج العبد للطلب منها، وأمّا الله فهو دائم الحضور.
على أن ابن تيمية لم يقف عند حدود التحليل والتتبع الداخلي للتطور الزمني للشرك في القصص القرآني، بل انتقل إلى تدعيمه بالشواهد والمرويات التاريخية، والمعرفة السائدة في عصره عن تاريخ الأقوام والملل. وهو ما سنبينه في الفقرة الموالية:
ج. السياق الثقافي والديني- توظيف المرويات التاريخية:
ينتقد ابن تيمية تأويل المتكلمين لمحاورة إبراهيم -عليه السلام- لغفلتها عن هذا المبدأ، فيستحضر رؤية قوم إبراهيم إلى العالم، وتصوراتهم عن علاقته بالإله، وبالآلهة الأخرى، ليؤكد استغناءهم أصلًا عن إثبات وجود الله. بداية، ينبه ابن تيمية إلى وجود صنفين من الصابئة؛ الصابئة الحنفاء الموحدون، وهم الذين مدحهم الله في القرآن، وابن تيمية يستند هنا على المرويات عن السلف، وعلى ما يرويه وهب بن منبه الذي يصفه بأنه «من أعلم الناس بأخبار الأمم»[18]. والصابئة المشركون الذين بُعِث فيهم إبراهيم -عليه السلام-؛ وفيهم يقول: «لكن الحق أن إبراهيم لم يقصد هذا، ولا كان قوله: {هَذَا رَبِّي}[الأنعام: 76] إنه ربّ العالمين، ولا اعتقَدَ أحد من بني آدم أن كوكبًا من الكواكب خلق السماوات والأرض، وكذلك الشمس والقمر، ولا كان المشركون -قوم إبراهيم- يعتقدون ذلك، بل كانوا مشركين بالله يعبدون الكواكب، ويدعونها، ويبنون لها الهياكل، ويعبدون فيها أصنامهم، وهو دين الكلدانيين والكشدانيين والصابئين المشركين، لا الصابئين الحنفاء، وهم الذين صنف صاحب [السر المكتوم في السحر ومخاطبة النجوم] كتابه على دينهم. وهذا دين كان كثيرٌ من أهل الأرض عليه بالشام والجزيرة والعراق وغير ذلك، وكانوا قبل ظهور دين المسيح -عليه السلام- وكان جامع دمشق وجامع حران وغيرهما موضع بعض هياكلهم؛ هذا هيكل المشتري، وهذا هيكل الزهرة. وكانوا يصلون إلى القطب الشمالي، وبدمشق محاريب قديمة إلى الشمال»[19].
يوظّف ابن تيمية هنا المعرفة التاريخية المنحدرة من الأقوام السابقة التي استوطنت بلاد الشام والعراق، كما يوظف المعرفة الأثرية، من خلال بقايا آثار المعابد القديمة بدمشق، والتي تتجه إلى الشمال، حيث يقيم الصابئة صلواتهم نحو القطب الشمالي؛ كما اعتمد ابن تيمية أيضًا على شهادات بقايا الصابئة الذين سكنوا بغداد وبقوا على دينهم ولم يسلموا إلى زمنه؛ يقول: «وبقايا هذا الشرك في بلاد الشرق في بلاد الخطا والترك يصنعون الأصنام على صورة النمرود ويكون الصنم كبيرًا جدًّا ويعلقون السبح في أعناقهم ويسبحون باسم النمرود ويشتمون إبراهيم الخليل. وكان من النفر القادمين إلى دمشق سنة 699 تسع وتسعين وستمائة بعض هؤلاء وهو يجمع بين أن يصلي الصلوات الخمس وبين أن يسبح باسم نمرود، وهذا أيضًا مذهب كثير من هؤلاء المتفلسفة وعلمائهم وعبّادهم يصلون الصلوات الخمس ويعبدون الشمس والقمر أو غيرهما من الكواكب ومن هؤلاء طوائف موجودون في الشام ومصر والعراق وغير ذلك»[20].
إن لجوء ابن تيمية لهذه الموارد لجوء مؤطر -كما أسلفنا- بنظريته التداولية في الفهم، التي يؤدي فيها سياق الموقف إلى جانب وأحوال المتكلم والمخاطبين وأعرافهم وعاداتهم دورًا مهمًّا جدًّا في كشف مراد المتكلم من النص وتعيينه. وقد جنّبه هذا الاعتماد على المعرفة السائدة في عصره عن أحوال الحضارات الشرقية القديمة واعتقاداتها إساءةَ تأويل هذه المحاورة القرآنية، والابتعادَ عن مراد إبراهيم -عليه السلام- منها، وهو المزلق التأويلي الذي وقع فيه بعض المفسرين من المتكلمين، حين قصروا نظرهم على العبارة اللغوية، بمعزل عن سياقها الثقافي الذي وردت فيه.
ثانيًا: دور السياق التاريخي للنص في نقد المطابقة بين ذي القرنين والإسكندر الأكبر:
في النموذج السابق، كان المسعى الأساس توضيح أن موقف ابن تيمية من المرويات التاريخية وللفيلولوجيا كان مؤطّرًا بتصوره عن الفهم والتأويل، من حيث هما سعي إلى الكشف عن المراد، ومن ثم، فإن الباب يظل مفتوحًا أمام مختلف القرائن السياقية-النصية وخارج-النصية لأجل الكشف عن هذا المراد؛ مما يجعل توظيف هذه المرويات في القلب من اشتغال ابن تيمية على القصص القرآني.
وأمّا في هذا المثال، فإن القصد يتجه نحو إثبات أن موقف ابن تيمية من هذه المرويات لا بد أن يتقيد بشروط الصحة التاريخية، وإلّا قاد هذا التوظيف إلى منزلقات تأويلية، وإلى إساءة فهم بعض الآيات في القصص. ففي قصة ذي القرنين، ذهب بعض المفسرين إلى أنّ ذا القرنين هو الإسكندر المقدوني، لكن ابن تيمية وقف أمام هذا التفسير وقفة نقدية، مبينًا الاختلافات بين الرجلين، بالاستناد إلى المصادر التاريخية عن الإسكندر.
1. التأويل الفلسفي لقصة ذي القرنين:
ذهب كثير من المفسرين إلى القول أنّ ذا القرنين -عليه السلام- هو الإسكندر المقدوني، مستندين في ذلك إلى الرواية المسندة إلى وهب بن منبه. وقد رجح كثير منهم أن يكون ذو القرنين هو الإسكندر لكون مُلك هذا الأخير امتدّ إلى آسيا وأفريقيا، ولمّا كان ذو القرنين قد بلغ مشرق الأرض ومغربها، فقد وجد المفسرون في هذا التشابه دليلًا على كون الشخصيتين شخصية واحدة. على أن ما يلفتنا من أقوال المفسرين، موقف الفخر الرازي -رحمه الله تعالى- حيث ذهب إلى كون ذي القرنين هو الإسكندر، غير أنه سرعان ما ذكر اعتراضًا وجيهًا على هذا القول رغم ترجيحه له؛ إذ تذكُر كتب التواريخ أن الإسكندر كان تلميذًا لأرسطو، وهذا يلزم منه أن يكون مذهب أرسطو هو الحق، وهذا بعيد (والرازي -كما هو معلوم- يرى بطلان الفلسفة المشائية). غير أن الرازي وقف عند هذا الحد؛ يقول الرازي: «والقول الأول أظهر لأجل الدليل الذي ذكرناه، وهو أن مثل هذا الملك العظيم يجب أن يكون معلوم الحال عند أهل الدنيا؛ والذي هو معلوم الحال بهذا الملك العظيم هو الإسكندر، فوجب أن يكون المراد بذي القرنين هو هو، إلا أن فيه إشكالًا قويًّا، وهو أنه كان تلميذ أرسطاطاليس الحكيم، وكان على مذهبه، فتعظيم الله إياه يوجب الحكم بأن مذهب أرسطاطاليس حق وصدق، وذلك مما لا سبيل إليه، والله أعلم»[21].
فالرازي في هذا النص اعتمد على التشابه التاريخي بين ذي القرنين الذي بلغ المشرق والمغرب، والإسكندر الذي افتتح البلدان شرقًا وغربًا أيضًا. كما اعتمد على قرينة تاريخية أخرى، وهي تواتر ذِكر الملوك العظماء، ولا بد أن يبقى ذِكر ذي القرنين في كتب الأخبار، إذ من غير المعقول أن يتجاهل المؤرخون ذِكر رجل بهذه الصفات العظيمة والملك الكبير. غير أن الرازي عاد وأورد اعتراضًا قويًّا على هذا التأويل، وهو كون الإسكندر كان تلميذًا لأرسطو ومعظِّمًا له، وهو ما يقتضي أن تكون فلسفة أرسطو هي الحق؛ لأن الله امتدح ذا القرنين، وهذا يقتضي امتداح مذهبه وطريقته؛ لكن، لا يمكن أن تكون فلسفة أرسطو هي الحق لمناقضتها للوحي في أصولها. غير أن ما تحرج منه الفخر الرازي لم يكن ليحرج الفلاسفة الإسلاميين من المشائية، فكان أن أخذوا بهذا القول بأريحية تامة؛ فنجد في تتمة صوان الحكمة أخبارًا كثيرة موضوعة على الإسكندر تنسب له التوحيد والفضائل والزهد... ففي منتخب صوان الحكمة، يعقد أبو سليمان المنطقي فصلًا تحت عنوان: «الإسكندر الملك، وهو ذو القرنين»[22] ، ثم أورد أخبارًا عديدة منسوبة إليه، تنطق بالتوحيد والحكمة؛ منها مثلًا رسالته إلى أُمّه عند شعوره بدُنوّ أَجَلِه: «مِن عبد الله الإسكندر، المستولي على أقطار الأرض بالأمس، وهو اليوم -هنيها- إلى أولومفياس»[23]، ومنها أيضًا: «ثم جعل يقول وهو يجود بنفسه: رب أنلني رضاك، فكل ملك باطل سواك»[24].
ومن المعاصرين من طابق بين الرجلين، ولعل أبرز هؤلاء المفكر الحداثي التونسي يوسف الصديق، الذي رأى -انطلاقًا من موقفه من القرآن وكونه خطابًا عقلانيًّا- أن القرآن استثمر بعض المعطيات الأسطورية السائدة في محيطه الثقافي ليصوغ حكاية ذي القرنين[25]، وهي تؤكد على أن القول القرآني يلزمنا بالانخراط في زمن انحسر فيه التنزيل السماوي ليخلي المكان إلى الإنسان الذي بات وحده القادر على رسم مساره. وهكذا ليس أنسب من نموذج الملك الفيلسوف كما صورته جمهورية أفلاطون، يصلح لاتخاذه قدوة ومثالًا في أزمنة لم يَعُد فيها رسل الله موجودين بين البشر[26].
2. نقد ابن تيمية للمطابقة بين ذي القرنين والإسكندر:
جريًا على منهجه في اعتماد المعطيات الثقافية والدينية والتاريخية المتعلقة بالأقوام الذين قص الله تعالى علينا أخبارهم، سعى ابن تيمية إلى محاكمة القول بالمطابقة بين شخصيتي ذي القرنين والإسكندر، في ضوء المعطيات المعرفية السائدة في عصره عن زمن ذي القرنين، والتصورات الدينية في عصره، وفي عصر اليونان الذين سبقوه، ليخلص إلى أن هذه المطابقة خاطئة قطعًا؛ يقول: «وكان المشركون يعبدون الأصنام المجسَّدة التي لها ظل، وهذا كان دين الروم واليونان، وهو دين الفلاسفة أهل مقدونيَّة وأثينة، كأرسطو وأمثاله من الفلاسفة المشائين وغيرهم، وكان أرسطو قبل المسيح بنحو ثلاثمائة سنة، وهو وزير الإسكندر بن فيلبس اليوناني المقدوني، التي تؤرخ له التاريخ الرومي من اليهود والنصارى، وهذا كان مشركًا يعبد هو وقومه الأصنام، ولم يكن يسمى ذا القرنين، ولا هو ذا القرنين المذكور في القرآن، ولا وصل هذا المقدوني إلى أرض الترك ولا بنى السد، وإنما وصل إلى بلاد الفرس. ومن ظن أن أرسطو كان وزير ذي القرنين المذكور في القرآن فقد غلط غلطًا تبين أنه ليس بعارف بأديان هؤلاء القوم ولا بأزمانهم. فلما ظهر دين المسيح -عليه السلام- بعد أرسطو بنحو ثلاثمائة سنة في بلاد الروم واليونان، كانوا على التوحيد إلى أن ظهرت فيهم البدع، فصوروا الصور المرقومة في الحيطان، جعلوا هذه الصور عوضًا عن تلك الصور»[27].
ويقول أيضًا: «والمشهور المتواتر أن أرسطو وزير الإسكندر بن فيلبس كان قبل المسيح بنحو ثلاثمائة سنة وكثير من الجهال يحسب أن هذا هو ذو القرنين المذكور في القرآن ويعظم أرسطو بكونه كان وزيرًا له كما ذكر ذلك ابن سينا وأمثاله من الجهال بأخبار الأمم»[28].
ينتقد ابن تيمية في هذه النصوص التفسير القائل بالمطابقة بين الرجلين، لكونه يهمل المعرفة التاريخية والعقائدية والدينية المرتبطة بقوم الإسكندر؛ فدينيًّا، تواتر عن الإسكندر المقدوني أنه كان مشركًا ولم يكن موحِّدًا، وكان على دين اليونانيين من قومه، كما أن المنقول عن اليونانيين وعن أهل مقدونية -موطن الإسكندر الأصلي- أنهم عانوا السحر والتنجيم وعبدوا الأصنام، ولم يكونوا موحِّدين؛ خلافًا لذي القرنين الذي يصفه القرآن الكريم بأنه كان موحدًا لله. وبهذا، فإن المرويات التي يوردها الفلاسفة الإسلاميون، والتي تنسب التوحيد إلى الإسكندر خاطئة قطعًا؛ لكونها أخبارًا منقطعةً أولًا، وبدون أسانيد تثبت إلى من نقلت عنه، وثانيًا -وهذا هو الأهم- لأنها تتعارض مع المتواتر والمشتهر، ومع طبيعة التصورات الدينية السائدة في اليونان زمن الإسكندر.
وأمّا زمنيًّا: كان الإسكندر متأخرًا زمنيًّا عن ذي القرنين بمُدَدٍ متطاولة.
وأمّا تاريخيًّا: لم يثبت أن الإسكندر لقب بذي القرنين، ولا أنه وصل إلى بلاد الترك، ولا أنه بنى بها السدّ، بل أبعد ما ذهب إليه: بلاد فارس.
وإلى جانب هذه الدلائل التي اعتمدها ابن تيمية، فقد ألمح إلى السبب الذي دفع إلى تبنّي الفلاسفة الإسلاميين إلى هذا القول، وهو رغبتهم في تعظيم قدر أرسطو، باعتباره وزيرًا لذي القرنين ومعلِّمًا له. وهذا التعليل هو الذي دفع الفخر الرازي إلى استشكال المطابقة بين ذي القرنين والإسكندر والتوقف في الأمر. ويبدو أن ابن تيمية كان مطلعًا على هذه المرويات التي نسبت التوحيد إلى اليونان؛ إذ أشار في بعض المواضع من كتبه إلى هذه المرويات وبيّنَ زيفها وخطأها، خاصة تلك التي غالت وجعلت الفلاسفة أنبياء أو تلامذة للأنبياء. وبهذا يمكننا فهم السبب في شدة ابن تيمية على بعض المفسرين الذين أوردوا هذه الأخبار عن الإسكندر دون تمحيص؛ لما فيها من غفلة عن خفيّ (مقاصد الفلاسفة) من هذا التأويل. وإذا دققنا النظر في موقف ابن تيمية من المرويات التي ينسبها الفلاسفة الإسلاميون إلى فلاسفة اليونان أو إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-، فسنجد موقف ابن تيمية نابعًا أساسًا من هذا الحذر النقدي، خاصة إذا علمنا أن توظيف الفلاسفة للمرويات المختلقة أمر حاصل ومتحقق، إذ -كما يقول الدكتور عبد الرزاق محمد- «ظهرت المغالاة في خلع النبوة على بعض قدماء الفلاسفة، أو ادّعاء صلة بين الأنبياء وبينهم، والإكثار من رواية الصلوات والأدعية والتسابيح عنهم، والمؤلفات التي وضعت في تقييد ما روي من الآداب والمواعظ والحكم القصار مملوءة بمثل هذا»[29].
ولا شك أن مرويات الفلاسفة هذه ستثير الرّيبة في ما يتعلّق بتفسيرهم لذي القرنين، وقد تَمَكَّن ابن تيمية من إبطالها من خلال العودة -كما أشرنا- إلى التصوّرات الدينية لليونان وتاريخ الإسكندر وما تواتر عنه، ومن خلال التنبيه إلى عدم خلوّ هذا التفسير من المسبقات التي توجّه عمليات التأويل، وما قد تحدثه من تعسّف في التأويل.
وإذن، فمجرد التشابه الظاهر بادئ النظر بين ذي القرنين والإسكندر لا يعني تطابق الرجلين؛ فلا بد من النظر في أحوال الأقوام، من أديان ومعتقدات وعادات وأحداث. وهذا التسرع في المطابقة بين الرجلين هو الذي دفع ابن تيمية إلى انتقاد ما سماه بـ: «الجهل بأخبار الأمم» وبـ: «تواريخ الأنبياء». وهنا يبرز جليًّا أهمية المعرفة بالتصورات الدينية والثقافية والأحداث التاريخية للأقوام الذين نزلت فيهم السور القرآنية؛ وهو الأمر الذي يمكن من فهم أدق للقصص القرآني، وتجنب الإسقاط التاريخي المتسرع، الذي قد يكون محكومًا بنوازع عقدية خفية، أو برغبة مسبقة توجه التأويل.
خاتمة:
في نهاية هذه المقالة نخلص إلى أن ابن تيمية -وانطلاقًا من نهجه التداولي في الفهم باعتباره كشفًا عن المراد- كان موظّفًا للتفسير السياقي، وملحًّا على توظيفه، وناقدًا لغيابه في بعض تأويلات المفسرين. وقد كان ابن تيمية في تطبيقاته التفسيرية منسجمًا مع تصوره النظري الذي صاغه عن الفهم والتفسير؛ فرأينا كيف وظّف ابن تيمية استعمالات العرب اللغوية لتحديد معنى الأفول، ولتخطئة حمل الأفول على الحركة والتغير، وكيف بيّنَ أنّ حمله على التغيّر غير منسجم مع السياق النصي الخاص ونظم الآيات، وغير منسجم أيضًا مع السياق النصي العام في كامل النص القرآني، وكيف أنه يتعارض أيضًا مع ما تواتر من أخبار عن معتقدات قوم إبراهيم -عليه السلام-.
كما تخلص المقالة إلى أن تفضيل ابن تيمية لتفسير السلف كان لدواعٍ تداولية تتعلق باستعمال اللغة، وأولوية فهم المخاطبين للنصوص والخطابات المبنية وفق أعراف جماعتهم اللغوية ورؤيتهم إلى العالم، فأبرزنا حججه اللغوية والعقلية على وجوب الأخذ بتفسير السلف، ونقده اللغوي-التداولي للاقتصار على مجرد معهود العرب ولسانها، وبيانه أن كل اعتراض توجه على مرويات السلف بوصفها آحادًا ظنية، فالاعتراض به على نقل اللغة أولى.
ومن خلاصات المقالة أيضًا أنّ ابن تيمية وظّف المرويات التاريخية سواء الإسرائيلية أو الإخبارية في تفسيره للقصص القرآني، وأنّ توظيفه لها كان منسجمًا مع تصوره التداولي الذي يعطي للمقامات التخاطبية وأحوال المتكلم والمخاطبين دورًا فاعلًا في الفهم والكشف عن المراد. وهذا ما مكنه الاحتجاج على صحة تأويله بما نقل من مرويات عن الصابئة، واعتمد في تقسيمه لهم إلى موحدين ومشركين على أبرز رواة الإسرائيليات، وهو وهب بن منبه، ووَصَفه بأنه من أعلم الناس بأخبار الأمم. كما أن تشدّده في قبول المرويات الإسرائيلية كان منسجمًا مع خلفيته الحديثية النقدية، ومع معرفته بمقدار الوضع والتحري أو الخطأ في جانب النقل التاريخي، مما جعله يشترط الصحة قبل التوظيف. وقد أثبت ابن تيمية نجاعة هذا المنهج حين زيف مرويات الفلاسفة الإسلاميين عن الإسكندر، وبيّنَ كيف أنها تناقض ما تواتر عن الإسكندر وقومه من الشرك ومعاناة السحر والتنجيم وغيرها.
إننا ومن خلال ما سبق، يظهر لنا أن التفسير السياقي الذي ألحّ عليه شيخ الإسلام له أهميته الكبرى في واقعنا المعرفي، الذي يجنح لعزل النص عن فهمه في ضوء واقعه التداولي والسياقات التي احتفّت به، وإنتاج تأويلات جديدة للنص في ضوء واقعه، الأمر الذي يقود حتمًا للانفلات التأويلي الذي لا ضابط له ولا خطام؛ ومن ثم توصي المقالة بأهمية العناية أكثر بالطرح التيمي التفسيري في هذا الجانب لِما له من أهمية في مساجلة أمثال هذه الأفكار.
[1] يراجع: مقاربة في ضبط معاقد التفسير؛ محاولة لضبط المرتكزات الكلية للعلم ومعالجة بعض إشكالاته، خليل محود اليماني، مقالة منشورة على وقع تفسير على الرابط التالي: tafsir.net/article/5299.
[2] الصفدية، تقي الدين بن تيمية الحراني، تح: محمد رشاد سالم، مكتبة ابن تيمية، مصر، ط2، 1406هـ، (2/ 84).
[3] الفتاوى الكبرى، تقي الدين بن تيمية الحراني، تح: حسين محمد مخلوف، دار المعرفة، بيروت، لبنان، 1398هـ- 1978م، (8/ 276).
[4] ورد ذكر السروجي في: جواب الاعتراضات المصرية على الفتيا الحموية، تقي الدين بن تيمية، تح: محمد عزيز شمس، دار عالم الفوائد، مكة المكرمة، ط1، 2008، ص157.
[5] المرجع نفسه، ص4.
[6] المرجع نفسه، ص15.
[7] نقض المنطق = الانتصار لأهل الأثر، تقي الدين بن تيمية، تح: عبد الرحمن بن حسن قائد، دار عالم الفوائد- مكة المكرمة، ط1، 1435هـ، ص282.
[8] بيان تلبيس الجهمية تقي الدين بن تيمية، تح: مجموعة من المحققين، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، ط1، 1426هـ، (4/ 521).
[9] يقول ابن تيمية في بيان التلبيس (8/ 464): «فالطفل إذا صار فيه تمييز عَلِم مراد أبيه وأمه بما يخاطبانه به، وفهمه لمراد الأم أسبق إليه من العلم بالأدلة العقلية النظرية، فإن هذا مما يعلم به مراد المتكلم اضطرارًا ولا يتوقف فهم الصغير لكلام مربيه (أبيه وأمه وغيرهما) لا على نقل اللغة والنحو والتصريف ولا على نفي المجاز والإضمار والتخصيص والاشتراك والنقل والمعارض العقلي والسمعي، بل يعلم مرادهم بكلامهم اضطرارًا لا يشك فيه، ثم سائر بني آدم يخاطب بعضهم بعضًا ويفهم مرادهم من غير احتياج إلى شيء من تلك المقدمات، ويكتبون الكتب إلى الغائب الذي لا يراهم ولا يرى حركاتهم فيعلمون مراد الكاتب اضطرارًا في أكثر ما يكتبه، وإن كان بعض ذلك قد يظن أو لا يفهم لكن الأغلب أنهم يعلمون مراده اضطرارًا».
[10] المرجع نفسه، ص17.
[11] المرجع نفسه، ص19.
[12] الردّ على البكري، تقي الدين بن تيمية الحراني، تح: محمد علي عجال، مكتبة الغرباء الأثرية المدينة المنورة، الطبعة: الأولى، 1417، (1/ 181).
[13] الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، أبو القاسم محمود بن عمر بن أحمد، الزمخشري جار الله (المتوفى: 538هـ)، دار الكتاب العربي- بيروت، ط3، 1407هـ، (2/ 40).
[14] المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن عطية الأندلسي المحاربي (المتوفى: 542هـ)، تح: عبد السلام عبد الشافي محمد، دار الكتب العلمية- بيروت، ط1، 1422هـ، (2/ 313).
[15] جامع الرسائل، تقي الدين بن تيمية الحراني، تح: محمد رشاد سالم، دار العطاء- الرياض الطبعة: الأولى 1422هـ- 2001م، (2/ 51).
[16] بغية المرتاد في الردّ على المتفلسفة والقرامطة والباطنية، تقي الدين بن تيمية الحراني، تح: موسى الدويش، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، ط3، 1415هـ/ 1995م، ص374.
[17] جامع الرسائل، لابن تيمية، (2/ 54).
[18] الردّ على المنطقيين، دار المعرفة، بيروت- لبنان، ص445.
[19] شرح حديث النزول، ابن تيمية، المكتب الإسلامي، بيروت، لبنان، ط5، 1977، ص166.
[20] الردّ على المنطقيين، ص284.
[21] مفاتيح الغيب، فخر الدين الرازي، دار إحياء التراث العربي- بيروت، ط3- 1420هـ.
[22] صوان الحكمة وثلاث رسائل، أبو سليمان المنطقي، تح: عبد الرحمن بدوي، طهران، 1974، ص152.
[23] المرجع نفسه، ص166.
[24] المرجع نفسه، ص167.
[25] هل قرأنا القرآن؟، يوسف الصديق، تر: منذر ساسي، الطبعة العربية، دار محمد علي للنشر، تونس، ط1، 2013، ص230.
[26] هل قرأنا القرآن؟، ص232.
[27] الجواب الصحيح لمن بدّل دين المسيح، تقي الدين بن تيمية الحراني، تح: علي بن حسن وآخرون، دار العاصمة، السعودية، ط2، 1419هـ/ 1999م، (1/ 346).
[28] الردّ على المنطقيين، ص182.
[29] في الآراء الطبيعية لمتكلمي الإسلام ومقاصدها الإلهية، عبد الرزاق محمد، مركز نماء للبحوث والدراسات، بيروت- لبنان، ط1، 2018، ص23.
كلمات مفتاحية
الكاتب:

محمد عبيدة
حاصل على ماجستير النص الأدبي وفنونه، وأستاذ اللغة العربية للتعليم الثانوي التأهيلي.
مواضيع ذات صلة
((المعلومات والآراء المقدَّمة هي للكتّاب، ولا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع أو أسرة مركز تفسير))