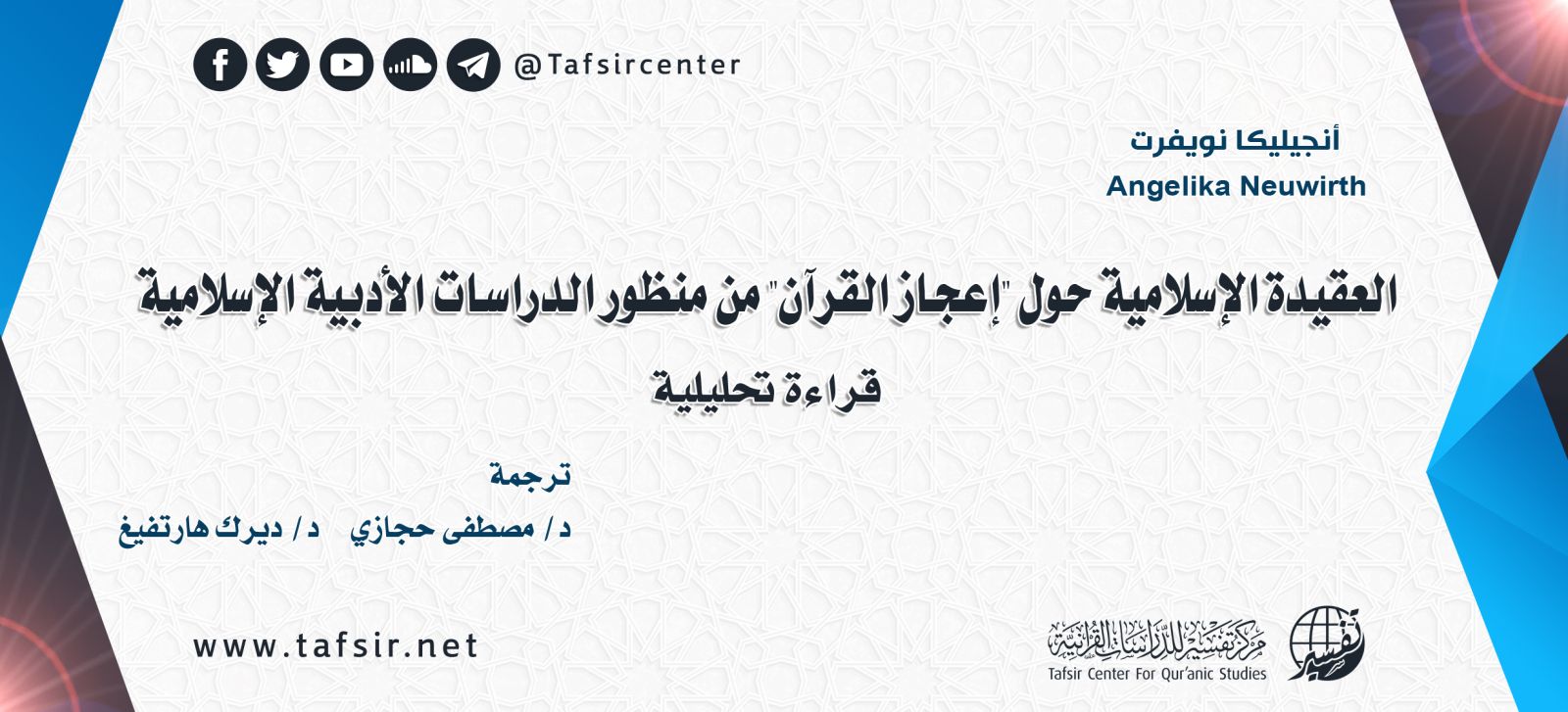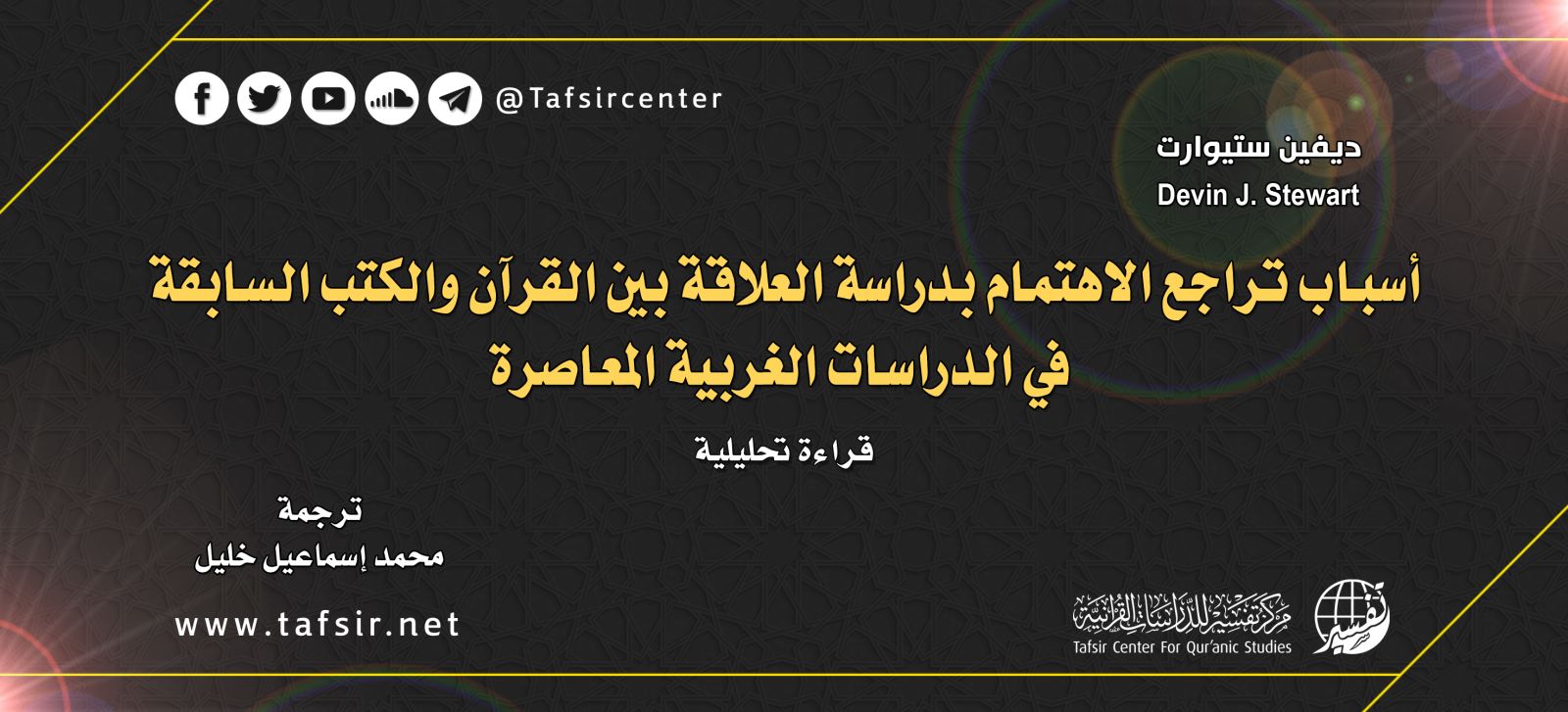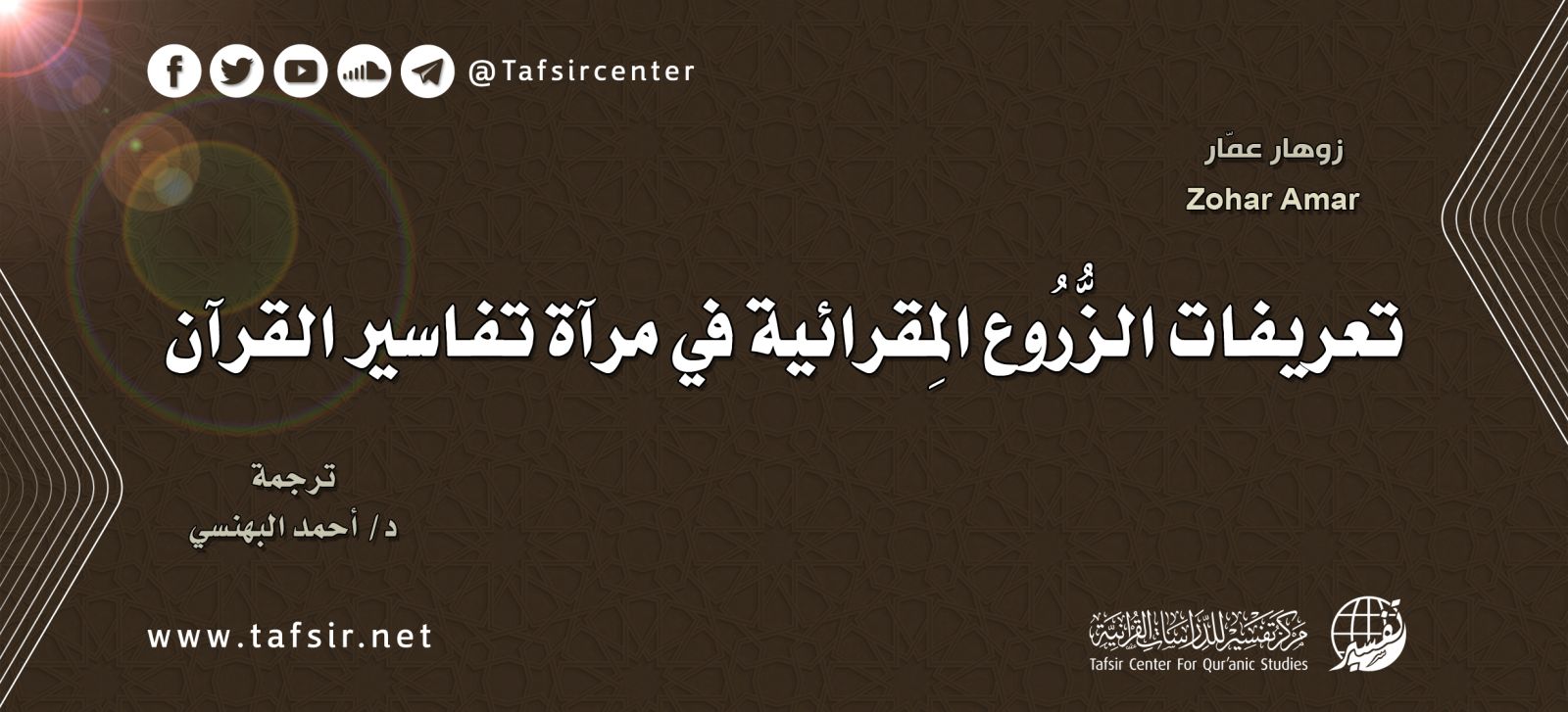القرآن في أوروبا؛ قراءة في التعامل الأوروبي مع القرآن في بدايات العصر الحديث
قراءة في التعامل الأوروبي مع القرآن في بدايات العصر الحديث
الكاتب: جان لوب - Jan Loop

مقدمة[1]:
تُعَدّ ترجمات القرآن إلى اللغة اللاتينية ثم اللغات الأوروبية الحديثة من أهمّ مراحل التفاعل الغربي مع القرآن، ولا شك؛ فإنّ هذه الترجمات نشأت وفق أهداف جدلية ودينية وسياسية بالأساس، كما يظهر في «عتبات: عناوين، مقدمات، حواشي، تعليقات» هذه الترجمات، حيث تضمّنَت في معظمها تأطيرًا تفنيديًّا للقرآن وعرضًا عامًّا للسيرة النبوية والتاريخ الإسلامي من خلال المنظورات السائدة في العصر الوسيط وبدايات العصر الحديث عن الإسلام وعن النبي -صلى الله عليه وسلم- مما جعلها في مرحلة لاحقة عرضة للانتقاد بعدم العلمية.
إلا أنه وفي الآونة الأخيرة بدأ اهتمام الكثير من الدارسين الغربيين يتّجه لدراسة التفاعل الغربي مع القرآن من وجهة تأثيره في تطوّر الفكر الغربي نفسه بدلًا عن دراسة تأثُّر القرآن بهذا التفاعل، حيث يتمّ الالتفات لفعالية القرآن المترجَم داخل النقاشات الغربية؛ المسيحية- المسيحية، والمسيحية- اليهودية حول حدود «المعتقد القويم» و«الهرطقة»، ويتمّ النظر إليه ولعملية ترجمته والجدال حوله كجزء من جدالات الهوية وتعريف الذّات، وجدالات الاندماج داخل أوروبا بالنسبة لليهود، بل لم تتوقف محاولات تتبع هذه الفعالية والأهمية على سياق الجدل الديني، بل امتدَّت لبحث أثر القرآن في دراسة تاريخ الكتاب المقدس وتاريخ العبرية، فضلًا عن تأثيره على الدراسات الأدبية والإنسانية للمدوّنات الدينية الكبرى والتي تتخطى الكتب التوحيدية إلى غيرها «مثل الإلياذة والأوديسة».
هذه المقالة هي مقدّمة لعددٍ كاملٍ من مجلة الدراسات القرآنية يدور حول «القرآن في أوروبا»، وفيها يعرض جان لوب تاريخ التفاعل الغربي مع القرآن في سياق صِلة القرآن بالكتاب المقدّس، حيث يلقِي الضوء على ترجمة روبرت كيتون وإعادة نشر ببلينادر لها، وموقع هذه الترجمة المهم في أوائل الفكر الحديث الجدلي والديني والمعرفي العام، وكذلك إشكالاتها الكثيرة، وكيف تطوّر النظر للقرآن ولصِلته بالكتاب المقدّس بعد انتشار هذه الترجمة، كذلك موقع القرآن في كثير من مساحات الجدل حول تاريخ العبرية وحول تاريخ الكنيسة في الشرق وتاريخ المسيحية وبعض أفكارها المركزية مثل (التثليث) وحول الكتاب المقدّس وطبيعته وتركيبه وأسلوبه.
إنّ هذه المقالة تلقِي ضوءًا مهمًّا على نمط اشتغالٍ بحثي غربي متنامٍ، يُعيد النظر في تاريخ تفاعل الغربيين مع القرآن، وينظر للقرآن باعتباره -بوجهٍ ما- أحد أساسات تطوّر الفكر الأوروبي الحديث معرفيًّا، وهو نمط اشتغال واسع ولا يقتصر فحسب على التأريخ للفكر العلمي والدراسات البحثية، بل يتخطّاه لبحث أثر القرآن في أوروبا والغرب بشكلٍ أكثر اتساعًا يشمل ميادين الثقافة والفنّ والسياسة[2]، مما يجعل من المهم للقارئ العربي الاطلاع على هذا الاشتغال.
يُعْنَى هذا العدد الخاصّ من مجلة الدراسات القرآنية بتاريخِ التفاعلات الأوروبية الغربية مع القرآن، بدايةً من باكورة الترجمات اليونانية في القرن التاسع وصولًا إلى الإصدارات اليهودية حول القرآن في مطلع القرن العشرين. وتعود فكرة هذا العدد إلى وقت انطلاق مؤتمر (ترجمة القرآن) الذي نظّمه مركز تاريخ الدراسات العربية في أوروبا بمعهد فاربورج في السادس عشر من مارس لسنة 2012[6]. وبعد مرور عامين من انعقاد هذا المؤتمر أُقيمت ورشة بعنوان: (توظيف التفسير في ترجمة القرآن) انبثق عنها تشكيل مجموعة بحثية دولية تطوّرت إلى مشروع بحثي طموح حول القرآن في أوروبا (القرآن الأوروبي)[7].
وتقدّم المقالات العشر الصادرة في هذا العدد الخاصّ إطارًا مهمًّا للبحوث المستقبلية في هذا المجال. ونظرًا لورود ملخّص لهذه المقالات في الجزء المخصّص لذلك في صدر هذا العدد، فلن أتناولها هنا بالتفصيل. وتأتي هذه المقالات التي كتبها أَعلامٌ بارزون في هذا التخصّص لتسلِّط ضوءًا جديدًا على مجموعة من السياقات اللغوية والدينية والعلمية والسياسية التي شهدت انتشار القرآن في العالم الغربي الأوروبي. وتقرّ بوجه خاصّ بوجود حافزَيْن قويَّين يدفعان الأوروبيّين لقراءة القرآن وترجمته، هما: التفاعل الجدلي مع الإسلام، علاوة على الرغبة الأوروبية في التعرّف بصورة أكبر على دينٍ جَسَّد تهديدًا أساسيًّا لتماسك هذه القارة من الناحية السياسية والدينية، ومع ذلك لا يقتصر الأمر على هذين الدافعين، بل يتجاوزهما بكثير. وتُبرِز بعضُ مقالات هذا العدد حقيقةَ الدور الأساسي للقرآن في الجدل الدائر بين المجموعات الدينية المسيحية، وفي الخطابات التي يتعيّن عدّها مقوِّمًا أساسيًّا في تشكيل الهوية الذاتية اليهودية والمسيحية منذ بواكير العصور الوسطى حتى وقتنا الحاضر. ومن الإسهامات الأصيلة في هذا الصدد ما كتبته سوزانا هيشل (Susannah Heschel) بعنوان: ‘Nineteenth-Century Jewish Readings of the Qur’an’ «قراءات يهودية في القرن التاسع عشر للقرآن». وتشير في مقالتها إلى المسارات الجديدة الملهمة للبحوث المستقبلية التي تُعْنَى بدراسة دور القرآن في فهم التاريخ اليهودي والمسيحي وفي تشكيل هوية أوروبية متعدّدة الثقافات في القرنين التاسع عشر والعشرين.
وتميط كثير من هذه المقالات اللثام عن كنزٍ ثمينٍ من المعلومات غير المستغلّة التي من شأنها أن تمنحنا تصوّرات جديدة حول التاريخ العلمي والديني والاجتماعي للقرآن في أوروبا. ويُعَدّ اكتشاف روبرتو توتولي لترجمة يونان زيكندورف (Johann Zechendorff) الأصلية التي ترجم فيها القرآن للغة اللاتينية سنة 1632 في دار الكتب بالقاهرة =واحدًا من أهم الاكتشافات في الآونة الأخيرة. ويظهر في هذه المخطوطة النصّ العربي منسوخًا إلى جانب ترجمة لاتينية؛ ولذا فهي دليل مهمّ يمكن الاستناد إليه في دراسة الإمكانات والقيود الفنية للدراسات القرآنية في أوروبا مطلع القرن السابع عشر على نحو ما رأيناه في مقالتين: واحدة كتبها راينهولد جلي (Reinhold Glei)، والأخرى لروبرتو توتولي. ولم تكن هناك ترجمات أخرى مشهورة متداولة سنة 1632 سوى ترجمة الإنجليزي روبرت الكيتوني (Robert of Ketton) التي تعود لسنة 1143. وتولَّى تنقيح هذه الترجمة مصلح زيورخ المتخصّص في الدراسات العبرانية (تيودور ببلياندر - Theodor Bibliander) وطُبعت سنة 1543 على يد يوهانس أوبورينوس (Johannes Oporinus) في بازل. وكما أبيِّن في هذا المدخل، فقد جاءت هذه الترجمة موجَّهة ضد الكنيسة الرومانية بنفس القدر الذي كانت موجهة به ضدّ الإسلام، وسرعان ما أُدرِجَت ضمن دليل الكتب المحرّمة بعد نشرها، وهي حقيقة لم تمنع الكُتّاب الكاثوليك من الاستعانة بها لغياب بدائل أخرى. واعتمد اليسوعيون المجريون على نسخة ببلياندر بشكلٍ كبيرٍ كما ذكر بول شور (Paul Shore)، وكذلك الوفد اليسوعي الذي جلب معه نسخة منها إلى البلاط المغولي سنة 1580. وحتى قبل انتشار الترجمة اللاتينية للقرآن على نطاق واسع في أوروبا بفضل النسخة المطبوعة من تحرير ببلياندر، كانت هناك ترجمات جزئية ضمن إصدارات يغلب عليها الطابع الجدلي تتناول الحدود الفاصلة بين المعتقد القويم والهرطقة. وفي دراسة كريستيان هيجل (Christian Høgel) نجده يسلِّط الضوء على عمل بيزنطي يستهدف الهراطقة في القرن الثاني عشر، كتبه إيثيميوس زيغابينوس (Euthymios Zigabenos) بعنوان: "Panoplia dogmatike"، واشتمل على اقتباسات من ترجمات يونانية للقرآن نُقلت إلى اللغة اللاتينية. وتكشف Mercedes García-Arenal مرسيدس غارسيا أرينال، وكاسيا ستارسزكا (Kasia Starczewska)، وريان زبيتش (Ryan Szpiech) عن ترجمات قرآنية إلى اللغة الإسبانية جاءت ضمن مؤلَّفات مسيحية جدلية وأعمال ركزت على التحوُّل الديني. وظهرت ترجمة فرنسية للقرآن على يد أندريه دي ريير (André Du Ryer) سنة 1647 وهي ترجمة مباشرة من العربية دون لغة وسيطة[8]. وتفوّقت على نسخة ببلياندر في انتشارها وسرعان ما تُرجمت إلى لغات عدّة. وقد استَخدَم هذه الترجمة عدد قليل من الباحثين المحيطين بالمستشرق الفرنسي الكبير بارتيلمي هربلو (Barthélemy d’Herbelot) أثناء إقامته في توسكانا. وأصدروا ترجمة جماعية لمواضع قرآنية حفظتها لنا مخطوطة قصيرة كانت موضوعًا لدراسة بيير ماتيا توماسينو (Pier Mattia Tommasino). وبعد مرور خمسين عامًا على صدور الطبعة الأُولى من ترجمة دي ريير الرائدة، كنّا على موعد سنة 1698 مع ترجمة جديدة تحلّ محلّها من إعداد لودوفيكو ماراتشي (Ludovico Marracci) بعنوان: (Alcorani textus universus) أو «النصّ القرآني المكتمل». وقد هيمنَت نسخة ماراتشي على الترجمات الغربية طوال قرن من الزمان بحسب ما ورد في مقالة ألاستير هاملتون (Alastair Hamilton)[9]. وركّز هاملتون في دراسته على تلقّي المناطق البروتستانتية الأوروبية لترجمة ماراتشي، وكيف أن الدراسات القرآنية في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر تراوحت بين خصومة طائفية وتعاوُن فيما بين الطوائف. وختامًا تأتي مقالة ألكسندر بيفيلاكو (Alexander Bevilacqua) بالاشتراك معي لتبيّن استمرار الحضور القرآني القوي في الجدالات الثقافية والدينية والسياسية الأوروبية حتى في القرن الثامن عشر بعد أن هدأت الخصومات الطائفية وتراجعت حِدّة الضغوط العثمانية.
ونأمل في أن تسفر المقالات الصادرة في هذا العدد الخاصّ عن انطلاق حوار يتجاوز فكرة كون القرآن ظاهرة دخيلة في الأساس على الثقافة الدينية في أوروبا. وتبحث الدراسات الواردة في هذا العدد في شتى طرق تعاطي الكثير من الجماعات الأوروبية مع القرآن على مدار عقود من الزمان. وتبيِّن مدى تجذُّر القرآن وترسُّخه في الخطابات الأوروبية، ليس من منطلق كونه أداة جدلية ووسيلة إقصاء ومُفاصَلة فحسب، بل بوصفه نصًّا مرجعيًّا في الدراسات التاريخية. وفي الوقت الذي تأتي فيه دراسة توم بورمان (Tom Burman) حول قرّاء القرآن وغيرهم من الدومنيكان في القرن الثالث عشر لتذكِّرنا بأنّ الإسلام والقرآن لم يكونا بالضرورة محور اهتمام الناس في كلّ زمان ومكان، فإنّ المقالات الصادرة ضِمن هذا العدد تبيِّن بوضوح دور القرآن البارز في تشكيل الهوية الدينية والثقافية في أوروبا.
وأتناول في هذا المدخل الترجمة اللاتينية الرائدة في العصور الوسطى لروبرت الكيتوني والنسخة المنقَّحة منها التي أصدرها ببلياندر ضِمن عمله: (Machumetis Saracenorum principis, eiusque successorum vitae, ac doctrina, ipseque Alcoran) «حياة محمد، قائد السارسين، وخلفائه، مع ترجمة للقرآن» 1534. وبفضل هذه الطبعة المنقَّحة المبكِّرة أضحت ترجمة روبرت الكيتوني من أكثر الترجمات الأوروبية للقرآن انتشارًا ومطالعة. وتسعى دراسة الحالة هذه إلى تتبّع مصير الطبعات اللاتينية وترجماتها المتعدّدة باللهجات المحلية المختلفة، وتمعن النظر في طريقة توظيف ترجمة ببلياندر في الجدل الدائر في الأوساط المسيحية في المشهد الأوروبي الحديث المبكّر الذي خيّم عليه انقسام ديني شديد. كما تُولِي عناية خاصّة بطرق التفاعل مع القرآن والتي كانت حاسمة في تشكيل هوية ذاتية للطوائف الدينية المختلفة. قصة قرآن روبرت كيتوني وببلياندر توضح لنا العمليات المختلفة التي تبرزها دراسات أخرى في هذا العدد الخاصّ. وتشير جميعها إلى حقيقة جلية بالنظر إلى القرآن في خضمّ التحوّلات التي شهدها في انتقاله من العالم الإسلامي والعربي إلى مجال الترجمة باللغة اللاتينية واللغات العامية المختلفة في أوروبا، وفي إطار قراءته وتوظيفه وتكييفه داخل السياقات اليهودية والأوروبية، ومفاد هذه الحقيقة أننا نواجه نوعًا نصيًّا خاصًّا sui generis هو القرآن الأوروبي[10].
نسخة ببلياندر:
اعتمد ببلياندر في إخراج نسخته على ثلاث مخطوطات من الترجمة اللاتينية التي أعدَّها الإنجليزي روبرت الكيتوني في حقبة العصور الوسطى، وتحديدًا سنة 1143 بعنوان: " Lex Mahumet pseudoprophetae" أو «شريعة محمد النبي الزائف»[11]. ومع عِلْمِنَا بعدد من الترجمات اللاتينية للقرآن التي تداولها الناس في صورةٍ مخطوطةٍ في تلك الحقبة، إلا أنّ ترجمة الكيتوني التي عُنيت بإعادة صياغة المعاني وما تلاها من نصوص بلغات عامية مختلفة اعتمَدَت عليها كان لها بالغ الأثر في تشكيل انطباع القارئ الأوروبي عن القرآن لفترة ممتدة من الزمان.
وعلى مدار القرون، واجَهَ القارئ الأوروبي للقرآن نصًّا بعيدًا كلّ البُعد عن الأصل العربي من حيث الأسلوب والدلالة والتركيب [النَّظْم] ومستوى المادة نفسها. أمّا على مستوى النَّظْم والتركيب، فقد سار النصّ وفق ترتيب خاصّ للقرآن إلى (‘azoaras’) لا يتفق مع التقسيم المعهود على حسب السور في الأصل العربي؛ إِذْ إنّ روبرت الكيتوني لم يَعُدّ سورة الفاتحة ضِمن سور القرآن؛ بل جعلها مجرّد دعاء افتتاحي، ثم قسّم السور الطوال إلى عدّة سور أصغر، متبعًا أسلوب التحزيب، الذي وجده على ما يبدو في واحدة من المخطوطات التي اعتمد عليها[12]. ونتيجة لذلك جاءت نسخته القرآنية مشتملة على 123 azoaras بدلًا من 114 سورة[13]. وعلى الصعيد اللغوي، كشفَت الكثير من الدراسات التي تناولت ترجمة روبرت العديد من مواضع الخلل الدلالي، فضلًا عن أخطاء في القراءة، ومبالغات مغرضة، تفاقمتْ جميعها بفعل أسلوب إعادة الصياغة الذي عمد فيه روبرت إلى «نقل ما جاء في مطلع العديد من المقاطع القرآنية إلى نهايتها والعكس؛ وبهذا غيّر معاني الألفاظ القرآنية؛ وقام في كثير من الأحيان بإغفال ما كان صريحًا في النصّ والاقتصار على ما كان ضمنيًّا»[14].
ومع ذلك نجد الدراسات الحديثة التي تناولت ترجمة روبرت الكيتوني تصرّ على تقييم أكثر محاباة لواحدة من الترجمات التي تظلّ على ما فيها من عِلَّات مَعْلَمًا بارزًا في تاريخ القرآن الأوروبي. وفي هذا السياق يرى أوليسي ثيثيني (Ulisse Cecini) أنّ طريقة إعادة الصياغة التي سار عليها روبرت الكيتوني في ترجمته، والتي تجمع في طيّاتها الكثير من التفاسير المأخوذة من التراث التفسيري الإسلامي، هي أقلّ حَرْفيّة في نقل النصّ لكنها مع ذلك تعبّر عن الأصل بصورة أفضل من الترجمات اللاتينية المبكّرة[15]. وقد أجرى توم بورمان لأوّل مرة تحليلًا لهذه الترجمة وخرج من ذلك بنتيجة مفادها أنّ روبرت الكيتوني استخدم أسلوبًا رفيعًا أشبه بأسلوب الوعظ والخطابة حاول فيه محاكاة البلاغة القرآنية[16].
ويُرَجَّح أن يكون السبب في اختيار ببلياندر لترجمة روبرت الكيتوني أنها النسخة التي أُتيحت له[17]؛ ولم يكن على علم بالعربية ولا بمقدوره الحكم على دقة الترجمة. جدير بالذِّكْر أنّ تيودور ببلياندر ويوهانس أوبورينوس واجَها معارضة كبيرة من السلطات المحلية عند محاولة طباعة القرآن في بازل، ولم تخرج هذه الطبعة للنور إلا بعد جولات واسعة من النقاشات وعلى إثر تدخّل من كبار المصلحين أمثال مارتن لوثر وفيليب ملانكتون، إلى أن وافقت السلطات أخيرًا على نشر هذه الترجمة القرآنية.
وإذا كانتْ محاولة طباعة القرآن مثار جدل دائم في العالم المسيحي، فإنّ معارضة نشر الكتاب الإسلامي المقدّس لم تكن منطلقة دومًا من بواعث أيديولوجية أو لاهوتية فحسب. فإذا نظرنا إلى ما حدث في بازل على سبيل المثال، وجدنا الدافع وراء هذه المعارضة خصومات وعداوات شخصية تجاه أوبرينوس[18].
ولا بدّ أن طباعة القرآن في القرنين السادس عشر والسابع عشر كانت عملًا مُربحًا وتنافسيًّا أيضًا. ويمكن استخلاص هذا من قصة النجاح الذي أحرزته طبعة ببلياندر. فقد ظهرت الطبعة الأُولى من ترجمته اللاتينية للقرآن سنة 1543 ثم صدرت في طبعة منقحة سنة 1550. وفي ظلّ النُّسَخ العديدة التي ظلّت محفوظة في المكتبات حتى يومنا هذا، لا بد أنّ كِلا العملَيْن قد طُبعا بأعداد هائلة. وقد تُرجمت نسخة ببلياندر إلى عدد من اللغات المحلية، وخرجت في صورة مخطوطة أو مطبوعة. وحتى قبل صدور الطبعة الثانية المزيدة من ترجمة ببلياندر، كانت قد تُرجمت إلى اللاتينية وتولَّى طباعتها الناشر وبائع الكتب الفينيسي أندريا أريفابيني (Andrea Arrivabenee)[19]. وفي سنة 1616 يأتي القس اللوثري ﺳﺎﻟﻮﻣﻮن ﺷﻔﺎﻳﻐﺮ (Salomon Schweigger) ليترجم هذه النسخة الإيطالية إلى اللغة الألمانية لتُعاد طباعتها من جديد في سنة 1623، 1659، 1664. وفي سنة 1641 تصدر ترجمة هولندية لهذه النسخة الألمانية[20]. وعلاوة على ذلك، شهدت السنوات الأخيرة اكتشاف عدد من الإصدارات المخطوطة باللغتَيْن العبرية والإسبانية[21]. ولذا، كان على القارئ الأوروبي الذي يودّ الاطلاع على القرآن بلغة محلية في القرن السادس عشر ومطلع القرن السابع عشر أن يقنع بترجمة منقولة عن ترجمة أخرى قبلها أو حتى عن ترجمتين دون أن يدرك هذه الحقيقة في الغالب الأعمّ. وقد زعم أندريا أريفابيني على الغلاف الداخلي لطبعته أنها مترجمة عن العربية مباشرة[22]. وليس هذا الزعم سوى «صيغة ترويجية»؛ فقد اعتمدت هذه الترجمة في الحقيقة على نسخة ببلياندر. وبالنظر إلى دراسات بيير ماتيا توماسينو لهذه الترجمة وأثرها الثقافي نجده يبرهن على ضرورة نسبتها إلى جيوفاني باتيستا كاستروداردو (Giovanni Battista Castrodardo) من مقاطعة بِلُّونة الإيطالية، الذي كان قد ترجم قبلها عملًا تاريخيًّا للغة الإيطالية وكتب تعليقًا على الكوميديا الإلهية لدانتي[23]. ويبدو أنّ ﺳﺎﻟﻮﻣﻮن ﺷﻔﺎﻳﻐﺮ صاحب الترجمة الألمانية قد انخدع بالعبارة الترويجية التي كتبها أريفابيني وبالتقييم الذي صدر عن اثنين من الخبراء ممن ترجمَا النسخة اليونانية وكانَا على عِلْم بالعربية فأكّدا خلال إقامته في القسطنطينية (1578- 1581) على صحة الترجمة الإيطالية[24]. وقد قضى عدة سنوات في ألمانيا يبحث بلا جدوى عن نسخة من النصّ الذي رأى أنه أفضل ترجمة قرآنية متاحة في الأسواق. وفي مقدّمته لترجمة القرآن التي جاءت بعنوان: "Alcoranus Mahometicus" ذكر أنه وقع على نسخة بطريق الصُّدْفَة بعد سنوات من البحث الحثيث[25]. جدير بالذِّكْر أن ﺷﻔﺎﻳﻐﺮ لم يحظَ بفرصة الرجوع إلى طبعة ببلياندر، وقد رُوِّجَت دعوى الأصالة على جُلّ قرّاء الطبعات الأربع لترجمته التي ظهرت بين عامي 1616، 1664 فضلًا عن الترجمة الهولندية لها سنة 1641. وهذه الترجمة الهولندية تحديدًا اعتمدَت على ترجمة شفايغر الألمانية التي فصَلتها عن العربية مراحل ثلاث، لكنها تبنَّت نفس الإستراتيجية الترويجية فادّعت «النقل مباشرة من العربية إلى الألمانية... ثم من الألمانية إلى الهولندية»[26].
لا شكّ أنّ دعوى الأصالة والصحة كانت عاملًا مهمًّا في رواج هذه الترجمات. وإذا كان بعض القرّاء المثقفين من أمثال جوزيف إسكاليجيه (Joseph Justus Scaliger)، أو المستعرب توماس إربنيوس (Thomas Erpenius)، لاحظوا اعتماد هذه الترجمات على إرث روبرت كيتوني وتيودور ببلياندر، وكانوا على دراية بمواطن النقص والخلل فيها، فإنّ الأمر مختلف بالنسبة للقارئ العادي، فلا بد أنّ الانطباع الذي تكوّن لديه أنه يطالع ترجمة أصيلة ودقيقة لكتاب المسلمين المقدّس[27]. والحقّ أنهم كانوا يطالعون ترجمة لترجمة أخرى تنقل ترجمة قرآنية تعود للعصور الوسطى، بعبارة أخرى كانت هناك مراحل عدّة تفصِل بين النصّ الذي في حوزتهم والأصل العربي الذي ادّعى نقله.
قراءة القرآن في ضوء الكتاب المقدّس:
مما يدعم القول بأنّ القرآن الأوروبي يشكّل تقليدًا نصيًّا بذاته ما يتجلَّى بالفعل في المخطوطات المبكّرة فضلًا عن الإصدارات المطبوعة على مَرّ القرون من أنّ النصّ القرآني محاطٌ بضرب من النصوص الحافة paratexts المتغيّرة والمتنوّعة في طبيعتها، من مقدّمات، وتفنيدات، وحواشٍ وتعليقات - تضعه في منظورات أيديولوجية مختلفة. والهدف من هذا الإطار بحسب توم بورمان «تيسير فهم النصّ والتحكّم في طريقة فهمه»[28].
ويُعَدّ الكتاب المقدّس والتفسير اللاهوتي المسيحي له أول منظور يُقرأ القرآن في ضوئه، وهو المنظور الأكثر شيوعًا؛ إِذْ يستحضر القرآن الكتاب المقدّس والقصص الكتابي على نحو متكرّر، ويتّخذ الوحي الإسلامي لنفسه موقعًا مصدِّقًا للتراث اليهودي المسيحي ومكمِّلًا له، وأحيانًا مصوِّبًا لِما يزعمه من تحريف وتبديل وقع على يد اليهود والمسيحيين[29]. وتقدّم الحواشي التفسيرية التي نراها في طبعة ببلياندر مقارنة مفصّلة بين القرآن والكتب المقدّسة السماوية إلى جانب «وصف منهجي لمحتوى القرآن وتصويبات للمواضع القصصية التي يخرج فيها عن الرواية الكتابية»[30]. ونجد بعض مترجمي نسخة ببلياندر اللاتينية من القرآن يتابعونه في حواشيه مع إدخال بعض التغييرات والزيادات التي تناسِب رسالتهم الأيديولوجية المراد نقلها[31]. ونرى هذه الطريقة متّبعة في أعمال أخرى. فهذا قس لوثري في ماربورغ، هو هاينريش لوشتر (Heinrich Leuchter)، في كتابه (Alcoranus Mahometicus) الذي صدر سنة 1604 يقدّم جامعًا موجزًا للقرآن اعتمد فيه على نسخة ببلياندر اللاتينية. وعلى سبيل التفنيد يضع النصوص القرآنية جنبًا إلى جنب مع الرؤية الكتابية في الموضوع ذاته[32].
ولم يقتصر الأمر على تقييم القرآن وفق نموذج النصوص الكتابية على مستوى المحتوى فحسب، بل على مستوى الأسلوب كذلك. وقد اتخذ ريكولدو دي مونتي (Riccoldo da Monte) من اختلاف الأسلوب بين القرآن والكتاب المقدّس دليلًا يدحض دعوى القرآن بشأن مصدره الإلهي، فكان مما قال: «ليس القرآن شرعة من الله؛ نظرًا لخلوِّه عن النمط أو الأسلوب المعهود في الشريعة السماوية»[33]. والقرآن مكتوب بوزن وقافية ولا تجد في أيّ موضع من النصوص الكتابية -التي يقرّ القرآن نفسُه بأنها سماوية- مثلَ هذا الأسلوب الموزون والمقفَّى[34]. ويُعَدّ ريكولدو حالة استثنائية بين القرّاء الأوروبيين للقرآن في العصور الوسطى؛ إِذْ كان بمقدوره القراءة بالعربية. ومع ذلك استندت مقارنته إلى نسخة لاتينية من الكتاب المقدّس، ولا علم له بالعناصر الشِّعْرية أو الأسلوبية في النصوص الكتابية العبرانية.
كما أنّ هذه المقارنات تُسَلِّم بأنّ القرآن والكتاب المقدّس لهما نفس السِّمَة الكتابية والجودة النصِّية؛إِذْ يُنظر إلى القرآن كنصّ مكتوب، يمكن ترجمته، وتحريره والتحشية عليه وطباعته بنفس طريقة التنقيح النقدي التي تعامَل بها متخصِّصو الدراسات الإنسانية في مطلع العصر الحديث مع النصوص الكتابية. وفي مستهلّ القرن الثامن عشر، شرع أندرياس أكولوثوس (Andreas Acoluthus) أستاذ اللغة العبرية في كلية سانت إليزابيث في مدينة بريسلاو/ فروتسواف في إعداد نسخة متعدّدة اللّغات من القرآن على غرار الكتاب المقدّس[35]. وإذا كان هذا النهج الفيلولوجي المقارن قد أسهم بشكلٍ كبيرٍ في تحسين الفهم الأوروبي للقرآن من ناحية لغوية، فقد حال دون تقدير للطبيعة الديناميكية شبه الشفاهية للوحي الإسلامي، علاوة على الأهمية التعبدية للتلاوة ولكتابته في نمط مخطوط [المصحف]. وفضلًا عن ذلك، زاد من صعوبة فهم القارئ الأوروبي للتجربة الحسِّيّة والمتعة الجمالية التي يثيرها القرآن عند قراءته أو تلاوته والتغنّي به[36].
القرآن الأوروبي في سياق الجدل المسيحي:
لا يُعَدّ القرآن الأوروبي مجرّد نتاج للترجمات ولمحاولات الوصول إلى تصوّر أكثر دقّة عن الإسلام فحسب، بل هو بشكل جوهري نتاج صور شتى من التوظيف الأوروبي للقرآن في الجدل المسيحي. فلقد كان للقرآن دور أساسي في محاولات تمييز العقيدة القويمة عن الهرطقة والابتداع، وفي تثبيت الأفكار الدينية المسيحية، ومواجهة الخصوم الدينيين داخل المسيحية وإفحامهم، وفي تعزيز الافتراضات التاريخية أو تقويضها. بعبارة أخرى، حظي القرآن منذ العصور الوسطى بدور محوري في تشكيل الهويات الأوروبية، الثقافية والدينية والسياسية.
وطبعة ببلياندر وشبكة النصوص التي تنبثق منها يمكن أن تكون نموذجًا توضيحيًّا في هذا الصدد. فليستْ مجرّد عمل كان الباعث عليه والمحرّك له هو خطر الانقضاض العثماني الوشيك؛ بل إنّ هذا السِّفْر الجامع هو ثمرة حَمْلة دعائية إصلاحية مبكّرة، وقد قُرئ مرارًا وتكرارًا في عدد من السياقات الجدلية في فترة شهدت صراعًا دينيًّا غير مسبوق. وبفضل الترجمة اللاتينية التي وضعها ببلياندر، أصبح كتاب المسلمين المقدّس متداولًا في وقت كانت فيه الهوية المسيحية الأوروبية مهدّدة بكثير من القوى الداخلية والخارجية. وعلى عكس ما هو شائع، فإنّ المعرفة التي أتاحها عمل ببلياندر لم ينحصر توظيفها في فهم الخصم الخارجي ممثلًا في الجيران المسلمين في أوروبا الوسطى ومنطقة البحر المتوسط وفي محاولة النَّيْل منه ومجابهته؛ بل لعلّ الأهم من هذا كلّه أنّ الترجمة اللاتينية للقرآن أتاحت مفاهيم جدلية قوية لفهم الخصوم الداخليين من المسيحيين واليهود وتشويههم ومجابهتهم. ونتيجة لذلك، فقد طُمِسَت الحدود الفاصلة بين المسيحية واليهودية والإسلام في بعض الأحيان إبّان القرنين السادس عشر والسابع عشر.
ومنذ البداية، كانت القراءة الطائفية لكتاب ببلياندر مدفوعة بارتباطه بقادة الإصلاح الألماني - السويسري، ملانكتون ولوثر وببلياندر نفسه. ففي الجزء الذي جاء بعنوان: «رسالة إلى القراء»، يختم ملانكتونالحديث بإشارة عدوانية تضاهي التهديد الذي تواجهه المسيحية على يد الإسلام بذلك الذي تتعرّض له من البابا في روما، فيقول[37]:
ختامًا، حريٌّ بنا أن نفطن إلى عظيم غضب الله، الذي ترك هذا الوباء القبيح ينتشر وأخضع العالم كلّه لهذه السلطة القميئة عقابًا للبشر على عصيانهم. ويجب على المتّقين أن يحزنوا ويأسَوْا لهذا الغضب ويبذلوا الوسع في دفعه وتخفيف وَطْأتِه بالتوبة والدعاء. لقد تعرّضَت الكنيسة على مدار قرون طويلة للدمار والخراب بفعل هذا الوباء المحمدي، وبفعل الوثنية البابوية الرومانية، ولأجل هذا وحتى لا تزول للأبد، بَثَّ فيها الربُّ نور الإنجيل من جديد، حتى ينجو بعضهم من الغضب الأبدي. لكن حين تحين نهاية العالم (وهي وشيكة) سوف تتضاءل الكنيسة. فتعالوا نبتهل إلى الربِّ أن يقمع قُوَى الشرّ التي تحوم في الإمبراطوريات الكافرة، وأن يزيل الكفر والوثنية والشرور، وليتمجّد اسمه ولتتحرّر كنيسته من كلّ شر. آمين.
وفكرة ملانكتون في تعرُّض الكنيسة الحقّة لهجوم من جبهتين؛ جبهة كاثوليكية وجبهة القوات التركية[38]، علاوة على تفسير هذا الحصار من منظور أخروي =أمرٌ شائع في الكتابات البروتستانتية والثقافة الشعبية. فقد روّج ملانكتون وغيره من المصلحين لمفهوم «المسيح الدجال المزدوج» ممثلًا في التُّرك شرقًا والبابوية الرومانية غربًا[39]. وقد ظهرت الفكرة في واحدة من سلسلة أعمال فنية لماتياس جيرونج (Matthias Gerung)، والتي تناول فيها أحداث نهاية العالم، وتبدو مستوحاة من رؤية مارتن لوثر التي تضاهِي بين القرارات البابوية والقرآن في كتابه (Vom Kriege wider die Türken) أو «في الحرب ضدّ الأتراك»سنة 1528- 1529[40].
وقد كان التوظيف الجدلي للقرآن من قِبَل ببلياندر أكثر تعقيدًا بعض الشيء لكنه لم يكن أقلّ تأثيرًا. وفي مقدّمته الدفاعية «دفاع عن نشر القرآن» يعرض تقييمًا للظروف التاريخية التي أدّت إلى ظهور الإسلام وانتشاره، يلمح فيه القارئ المعاصر اتجاهًا مناوِئًا للكاثوليكية. ويرى ببلياندر أنّ مدعي النبوّة يمكنهم إغواء الناس حين لا يكون هناك اهتمام بمعرفة الكتاب المقدّس وحين تكون الأولوية لتفسيرات السلطات الكنسية ومكاسبهم الشخصية. ويقول في هذا الصدد[41]:
هؤلاء الذين يُضِلُّون الناس لا يتورّعون عن الكذب على الربّ والقول زورًا بأنَّ أكاذيبهم هي كلمة الربّ وأنها مأخوذة من الكتب المقدسة - وهذا ما فعله محمد أيضًا. لكن إذا ما قُورِنَت وُعودهم المغالية بما في الكتاب المقدّس، ندرك أنهم يحاربون كلمة الربّ، وأنَّ كلام الروح القدس قد حُرّف إلى معنى غريب.
ونادَت رسالة ببلياندر في وجه الهجوم العثماني الوشيك وتعرّض الكثير من المسيحيين للإسلام بضرورة إصلاح الكنيسة والمجتمع المسيحي. وتكرّرت هذه الرسالة في عدّة كتابات بروتستانتية في ذلك الزمان، ومفادها: أنّ هذا الانحلال الأخلاقي والديني الذي يعاني منه العالم المسيحي هو السبب الرئيس في انتصار العثمانيين والدِّين الإسلامي[42].
ونظرًا لهذه القدرة الهدّامة التي حظيت بها طبعة ببلياندر في وجه الكنيسة الكاثوليكية سرعان ما انضمّت هي الأخرى إلى دليل الكتب المحرّمة. وأوضح دليل الكتب المحرّمة لسنة 1564 الذي نُشر بعد فترة وجيزة من انعقاد مجمع ترنت أنَّ الكتاب قد اشتمل على مواضع خطيرة؛ منها ما ورد في المقدّمات وفي حواشي ببلياندر[43].
لكن الانتشار الواسع لطبعة ببلياندر هو دليل أيضًا على مدى توظيف القرآن بكثرة في الجدل المسيحي الداخلي وفي الكتابات المناوِئة للدِّين الإسلامي. وقد مهّد توماسينو الطريق لهذا السياق المتمرِّد والمشحون سياسيًّا الذي ظهرت فيه ترجمة كاستروداردو الإيطالية ونشرها أندريا أريفابيني. وكان هذا الكتاب بمثابة سفر جامع سهل المنال والتداول يتناول الإسلام وتاريخه والوضع الراهن للإمبراطورية العثمانية. وقد أهداه إلى السفير الفرنسي الرابع لدى الدولة العثمانية غابرييل دي لويتز (Gabriel de Luetz،1547- 1553). وكان السفير والناشر كلاهما على علاقة وثيقة بالدوائر الإنجيلية في مدينة البندقية وبالمصلحين الإيطاليين، الذين رأوا في السلطان سليمان والفرنسيين حلفاء لهم إبّان حرب شمالكالدي (1546- 1547)[44].
الشكل 1: ماتياس جيرونج، رمزية حصار الكنيسة من القوات الكاثوليكية والأتراك، نحو سنة 1558[45].
وفي زمن العداوة الطائفية والانقسام السياسي هيمن نمطٌ واحدٌ من الخطاب الجدلي على الأدبيات الشّعبية والنصوص العلمية تجسَّد في ربط الخصم المسيحي بالإسلام أو التُّرك العثمانيين. وشهدنا الكتيبات العامية والرسائل الجدلية اللاتينية ومجموعة هائلة من الكتابات التي تقع في منزلة بين هاتين المنزلتَيْن توظّف مجالًا ناميًا هو أدب الرحلات، وغيره من روايات العيان عن المجتمع (التركي) وثقافة الترك ودينهم بحثًا عن مادة مناسبة لهذه المقارنات الجدلية. وجاء ظهور نسخة ببلياندر من الترجمة القرآنية اللاتينية ليعزّز المعرفة مِن أجلِ هذه المقارنات الجدلية، واستخدمها المؤلِّفون من شتى الاتجاهات الطائفية على نطاق واسع[46].
جليٌّ أنَّ الترجمة قد استُخْدِمَت في دوائر الإصلاح البروتستانتي المحيطة بتيودور ببلياندر، ومن ذلك على سبيل المثال ما رأيناه عند هاينريش بولينجر (Heinrich Bullinger) الذي رأى هو الآخر أنَّ البابا والتُّرك وجهان لعملة واحدة، وصوَّر هذا في دراما أبوكاليبسية (أخروية) تجلَّت فيها هذه الحقيقة عيانًا للمراقبين في القرن السادس عشر. ولم يكتفِ بهذا الحد، بل سار على خطى ببلياندر فراحَ يُبرز أوجه الشّبه بين المسلمين وحركة مجدّدي المعمودية[47]. وهذا هاينريش لوشتر يضيف في كتابه (Alcoranus Mahometicus) عمودًا مستقلًّا بجوار ملخّصه للقرآن يوضِّح فيه مواطن الشّبه المزعومة بين تعاليم محمد الكفرية وبين العقيدة البابوية[48]. ولقد كانت طبعة ببلياندر مصدر إلهام أساسي لكثير من الجدليين في إنجلترا. فرأينا جون فوكس (John Foxe) يستعين بها عند تناول تاريخ الترك في كتابه: الأعمال والآثار "Acts and Monuments". وترى إليزابيث إفيندن (Elizabeth Evenden) وتوماس فريمان (Thomas Freeman) أنَّ ارتباط جون فوكس بأوبورينوس في بازل كان له أثـرٌ كبيرٌ في تناوُل الترك في كتابه التاريخي، وأنَّ هذا الارتباط هو ما جعله يستعين بطبعة ببلياندر الجامعة علاوة على كتاب آخر بعنوان: "De Origine et rebus gestis Turcorum" مِن تأليف لاونيكوس تشالكوكونديليس (Laonikos Chalkokondyles)، نشره أوبورينوس أيضًا[49].
لقد أضحت المقارنة بين الإسلام والكاثوليكية الرومانية فكرة جدلية راسخة في الدعاية المناوِئة للكاثوليكية الرومانية وفي خطاب تعريف البروتستانتية بذاتها[50]. لكن كُتّاب الكاثوليكية الرومانية في إنجلترا وفي القارة بأسْرِها لم يرغبوا في ترك الساحة منفردة لخصومهم يحتكرون فيها توجيه هذا الاتهام الأيديولوجي الخطير بالارتباط بالترك، فرأينا سيلًا عارمًا من المنشورات الجدلية الكاثوليكية تنطلق من نفس المنطلق وتتبنَّى ذات الفكرة[51]. ومن الملاحَظ أنَّ الكثير من الجدليين ومؤلِّفي النّشرات الكاثوليكية اتخذوا بدورهم من طبعة ببلياندر مصدرًا أساسيًّا. وثمة استثناء وحيد يبرز في هذا الصدد هو Guillaume Postel غيوم بوستل وكتابه الذي جاء بعنوان: "Alcorani seu legis Mahometi et Evangelistarum concordiae liber " أو «كتاب في الانسجام بين القرآن أو قانون محمد والإنجيليين»، وقد صدر سنة 1543، ويجسِّد النموذج الكاثوليكي للمقارنات الجدلية بين البروتستانت والهرطقة الإسلامية[52]. واعتمد هذا الكتاب على ترجمة بوستل نفسه لجُلّ القرآن (إن لم يكن كلّه)[53].
ليس هناك بلاء يواجه العالم بأسْرِه أخطر من القرآن، وسوف أبيِّن من خلال عبارات مختارة من كِلا الجانبين أنَّ محمدًا يسير على خطى اللوثريين ويسوق حججًا ضد الكنيسة المسيحية هي ذاتها التي يحاول (الإنجيليون) الآن بكلّ وسيلة ممكنة ترويجها ونشرها.
بالنسبة لكثير من المؤلِّفين الكاثوليك الذين اتبعوا طريقة بوستل لكن لم يكن بمقدورهم الوصول للنصّ الأصلي، فإنَّ ترجمة ببلياندر اللاتينية للقرآن -رغم إدراجها ضمن دليل الكتب المحرّمة بعد نشرها بقليل- كانت مصدرًا يستقون منه المعلومات بصورة متكرّرة وأمكنهم توظيفها ضدّ مصلح زيورخ ورفاقه في شمالي أوروبا.
وفي عام 1597 قدّم ويليام رينولدز (William Rainolds) مقارنة بين الهراطقة الجدد والتُّرك هي الأشمل. ففي كتابه الذي جاء بعنوان: (Calvino-Turcismus) في أكثر من ألفِ صفحة لم يعتمد على الترجمة اللاتينية فحسب، بل أفاد من مقدمة ببلياندر الدفاعية والكتابات الأخرى المُلحَقة. أمّا فلوريمون دي رايموند (Florimond de Raemond) فكتبَ سنة 1605 رسالة صغيرة مناوِئة للبروتستانت بعنوان: (Historia de ortu, progressu, et ruina haereseon huius saeculi) تناوَل فيها تاريخ النشأة والتقدّم وزوال الهرطقات في هذا العصر، كما استعرض أوجه الشّبه؛ بدايةً من المغالاة في الاعتماد على الكتاب المقدّس، وصولًا إلى استخدام العنف في نشر العقائد، وقد استند في هذا إلى ما قرأه في ترجمة ببلياندر القرآنية والكتابات البروتستانتية[54]. ودأبَ الجدليون الرومان على استخدام الألفاظ القرآنية فيما يكتبونه عن خصومهم البروتستانت، ورأينا في الجزء الثاني من كتاب بعنوان: "Anatomia Lutheri" لمؤلِّفه يوهان بيستوريوس (Johann Pistorius) صدر سنة 1598 ما ادّعاه من أخطاء إسلامية ظاهرة في مفهوم لوثر عن الثالوث، بل في النمط الذي سار عليه لوثر في كتابة تعاليمه حين جعلها على شكل السور[55]. ولعلّه استوحَى هذه الفكرة من جورجيوس إيكر (Georgius Ecker) الذي قدّم سنة 1591 عقيدة لوثر على أنها القرآن اللوثري في سبع عشرة سورة. وفي سنة 1642 ظهر كتاب باللغة الإنجليزية بعنوان: قرآن لوثر، وزعم كاتبه أنه ترجمة لعمل مفقود مناوِئ لجماعة عُرفت باسم «الهوغونوتيون»، كتبه الكاردينال الفرنسي چاك داڤى دوپيرون (Jacques-Davy Duperron). وبحسب مترجمي النسخة الإنجليزية فقد طُبع هذا الكتاب في فرنسا قُبَيل موت الكاردينال سنة 1618، لكن أغلب النُّسخ أو جميعها قد دُمِّرَت على يد الهوغونوتيين[56]. ومهما يكن الأمر، فلا بد أنَّ مؤلِّف الكتاب قد وقف على ترجمة ببلياندر القرآنية وأفاد منها بشكلٍ واسع في كتابة هذا المصنَّف الذي يُفصِّل في ستين نقطة أوجُهَ الاتفاق بين اللوثرية والإسلام[57]. وكما هو الحال في منشورات كاثوليكية أخرى، لا تكون المقارنة في أغلبها بين لوثر ومحمد، وإنما يُقارن لوثر بالراهب بحيرى الذي يَنسب إليه بعضُهم دورًا ما في تأليف القرآن[58]. وفي البداية يقتبس المؤلِّف ما يزيد عن عشرين مقطعًا قرآنيًّا اعتمدت عليه هذه الرسالة، وكلّها مأخوذة من طبعة ببلياندر[59].
كان من بين الأهداف المفضّلة التي انصبّ عليها هجوم الجدليين من أنصار الكاثوليكية الرومانية (وكذلك بعض اللوثريين) في أواخر القرن السادس عشر ومطلع القرن السابع عشر، هذه الصِّلة الأيديولوجية المشتبه فيها بين الكالفينيين في جنيف وزيورخ، وهذه الأعداد المتزايدة ممن يعتنقون أفكارًا مناوِئة لعقيدة التثليث، وقد صرّح بعضُهم بتأييده فكرة الكريستولوجيا القرآنية أو طبيعة المسيح بحسب الرؤية القرآنية. وكان هناك خوف من أن تتحوّل الهرطقة الكالفينية في نهاية المطاف إلى اعتناق الإسلام. وذهب جون كوبينجر (John Copinger) في كتاب له بعنوان: "Theatre of Catholique and Protestant Religion" أو «مسرح الديانة الكاثوليكية والبروتستانتية» في سنة 1620 إلى أنَّ الكالفينية تؤدِّي بالمرء مباشرة إلى تبنِّي مواقف مناوِئة لعقيدة التثليث، ورفضِ ألوهية المسيح وتبجيلِ القديسين، وهو ما يعني باختصار التحوُّل إلى الإسلام[60]. وتأكيدًا لكلامه هذا، استشهد بعدد من الكالفينيين ممن «رحلوا إلى القسطنطينية وهناك أعلنوا إسلامهم. ورأى أنَّ دين الكالفينية يميل مباشرة إلى الإسلام، وأنَّ هؤلاء الناس قبل أن يغادروا الإمبراطورية الرومانية المقدّسة قد أفسدوا العديد من الدعاة وكبار المبشِّرين الذين أصبحوا بدورهم مسلمين[61] وباتوا يعلِّمون الناس القرآن في جرمانيا»[62]. وخصّ بالذِّكْر مِن بين هؤلاء ميغيل سيرفيت (Miguel Servet)، وجورجيو بياندراتا (Giorgio Biandrata)، وفيرنيك ديفيد (Ferenc David)، وآدم نويزر (Adam Neuser)، وآخرين. ولعلّ آدم نويزر أشهر مثال لعالِم لاهوتٍ مسيحي يُعارِض التثليث وله خلفية كالفينية، ثم يهاجر إلى إسطنبول وهناك يتحوّل إلى الإسلام، وإن اضطر إلى ذلك على ما يبدو إنقاذًا لحياته[63]. ورغم أنَّ سيرفيت وبياندراتا وديفيد وغيرهم من رافضي التثليث في القرن السادس عشر لم يتحوّلوا إلى الإسلام، إلا أنهم وظَّفوا القرآن في تأييد عقائدهم المناوِئة للتثليث.
أمّا ميغيل سيرفيت في رسالته الجدلية المناوِئة لعقيدة التثليث بعنوان: (استعادة المسيحية من جديد) (Christianismi Restitutio)، والتي صدرت سنة 1553، فقد استشهد بالقرآن في جرأة واضحة دعمًا لدعواه في أنَّ عقيدة التثليث هي هرطقة متأخّرة وليست جزءًا من تعاليم المسيح الحقيقية[64]. ويتّضح من هذه الاستشهادات التي تتطابق مع هذا التقسيم الفريد للسور أنَّ سيرفيت هو الآخر استعان بنسخة من ترجمة ببلياندر اللاتينية للقرآن. وخلص مما قرأه فيها إلى أنّ هرطقة التثليث هي مصدر الخلاف والشقاق المستمر بين أفراد الجماعة المسيحية المبكّرة، وأنهم قبلها عاشوا في وحدة وانسجام. وكان مما قاله[65]:
تُبَيِّن السورة الرابعة [البقرة في تقسيم المصحف: الآية 253] وقوع اختلافات لا حصر لها في فترة لاحقة، حول أشياء لم يكن هناك نزاع أو خلاف بشأنها مِن قبلُ. وتأتي السورة العشرون [يونس، العاشرة في تقسيم المصحف، الآية 19] لتؤكّد نفس المعنى في أنّ المسيحيين كانوا أمّةً واحدة، ثم وقع الخُلف والانقسام بينهم حين ظهر فيهم تعدّد الآلهة.
وتتكرّر هذه الدعوى في فصل عن (الصواب والخطأ في مفهوم الإله الواحد، والأب، والروح والقدس)[66]. وقد جُمعت هذه النشرات المتفرّقة لتخرج في إصدار مشترك للكنائس التوحيدية في ترانسيلفانيا وبولندا سنة 1568، لتصبح واحدة من أكثر الوثائق تداولًا في الترويج للعقائد الأساسية للكنائس التوحيدية التي سرعان ما ازدهرت في منطقة هابسبورغ الحدودية مع الإمبراطورية العثمانية[67]. ويلخِّص الفصل الثالث -الذي تناول (نشأة التثليث وتطوّره) ولا يُعرف كاتبه على وجه اليقين- الحُجّةَ الأساسية التي وردت في الكتاب الأوّل لميغيل سيرفيت عن استعادة المسيحية، ويشير إلى السور الإضافية المأخوذة من ترجمة ببلياندر اللاتينية للقرآن[68].
حظيت الترجمة اللاتينية للقرآن بدور أساسي في هذه الكتابات التوحيدية تجسَّد في دعم الدعاوَى الدينية المركزية. وإذا كانت الإشارات القرآنية والإسلامية التي وردَت في غالبية الكتابات الجدلية في عصر الخصومة الطائفية تشكّل الهوية عبر فكّ الارتباط والمفاصَلة، فإنّنا نرى هنا نشرات توحيدية تُوظَّف فيها الإشارات القرآنية مِن أجلِ التحديد الإيجابي للهوية الدينية لجماعة مسيحية. وهو أمر لم يَغِب عن خصوم الحركة المناوِئة للتثليث في الدوائر البروتستانتية والكاثوليكية الرومانية. فقد شاع اتهام ميغيل سيرفيت وأتباعه، وفاوستو سوزيني (Fausto Sozzini) ومَن أيّدَه بالتأثُّر بالقرآن والدعوة إلى الدِّين الإسلامي. ورأينا أثناء محنة سيرفيت سنة 1553 كيف اتهمه كالفين بدراسة القرآن بهدف الهجوم على المسيحية وهدمِها[69]. وهي تهمة كرّرها بولينجر في مقدّمته للكتاب الرابع لجوسياس سيملر (Josias Simler) عن «المخلِّص وابن الربِّ الأزلي يسوع والروح القدس في مواجهة منكري التثليث القدامى والجدد»[70]. وينقل يوهانس بيتريوس (Johannes Petricius) سنة 1600 عن طبعة ببلياندر اللاتينية لإثبات التوافق العام بين القرآن وتعاليم فاوستو سوزيني[71]. وقبل ذلك بعامين، كتب علماء اللاهوت الكالفينيين الهولنديين فرانسيسكوس جوماروس (Franciscus Gomarus)، وفرانسيسكوس جونيوس (Franciscus Junius)، ولوكاس تريلكاتيوس (Lucas Trelcatius)، تقريرًا عن الكتابات المناوِئة لعقيدة التثليث التي جُلِبَت إلى ليدن لأغراض تبشيرية على يد الرحّالة أندرزيچ وچدوسكى (Andreas Wojdowski) أحد الرعيل الأوّل البولنديين من أنصار العقيدة التجديدية السوسنية. وحُكِم على هذه الكتابات بأنها قريبة من التعاليم الإسلامية وتهدم الإيمان بألوهية المسيح[72]. وكانت فكرة تَوافُق العقيدة التجديدية السوسنية مع الإسلام أو تأثُّرها بالقرآن لا تزال متداولة في القرن الثامن عشر. فقد زعم ماتيرين فيسسريه لاكروز(Maturin Vessiere La Croze) أنّ أتباع الحركة التوحيدية في مبدأ أمرهم وظهور حركتهم «اعتمدوا على القرآن كأحد المصادر الكلاسيكية لديانتهم»[73].
جدير بالذِّكْر أنَّ ميغيل سيرفيت ومؤلّفي كتاب: (De falsa et vera unius Dei Patris Filii et Spiritus Sanctus cognitione) قد استخدموا القرآن كوثيقة تاريخية تعزّز رؤيتهم المتنازع فيها بشأن التاريخ العقدي للكنيسة المسيحية. وإذا كان هذا التوظيف لنصّ هرطقي للغاية في دراسات التاريخ الكنسي جاء بمثابة فضيحة لمؤيديه من الجانبين الكاثوليكي والبروتستانتي، فإنّ المنهجية المتَّبَعة لم تكن منهجية جديدة أو فريدة؛ بل هي نفسها التي سار عليها ببلياندر في مقدّمته الدفاعية وساقها كسبب محوري دعاه لإخراج هذه النسخة القرآنية، فوجدناه يقول[74]:
جزء من التاريخ -أي التاريخ الكنسي- هو كشف تعاليم محمد وما جاء به من أمور أخرى حتى يمكن أن نفهم بوضوح مَن كان سببًا في إغواء العرب أوّلًا، وقد ازدهرت فيهم كنائس المسيح من قبل، ثم إغواء الكثير من المسيحيين، حتى انصرفوا عن ولائهم للكنيسة الكاثوليكية وصاروا ألدَّ خصومها، ونفهم ملابسات هذا الأمر، والبراهين التي استند إليها والأسلوب الذي اتّبعه.
ومناداة ببلياندر بضرورة توظيف القرآن بهذا الشكل في دراسة تاريخ الكنيسة قد وجدَت آذانًا مصغية عند يوهان هاينريش هوتنجر (Johann Heinrich Hottinger) الذي كان واحدًا ممن خلفوه في المدرسة الإصلاحية (Schola Tigurina) فالتزم بها بطريقة أكثر منهجية، وكان متأثِّـرًا بعمل ببلياندر في شغفه بالعربية واهتمامه بالإسلام[75]. ويُعَدّ تاريخ «المحمدية» وتطوّرها جزءًا لا يتجزّأ من تاريخ الكنيسة كما سجّله هوتنجر في أجزاء تسعة تحت عنوان: "Historia Ecclesiastica". وقد أضاف إلى كلّ فصل بداية من القرن السابع قسمًا بعنوان: "De Muhammedismo"، تناوَل فيه التطوّرات السياسية في العالم الإسلامي والصراع العسكري بين القُوى المسيحية والإسلامية، فضلًا عن التطوّرات العلمية والدينية. والتزامًا بما اقترحه ببلياندر استُخدِمَت المصادر العربية، وفي مقدمتها القرآن، للوصول إلى تصوّر لواقع الكنيسة المسيحية في الشرق الأدنى، ولفهم أسباب التدهور والتراجع الذي لحق بها. وكما فعل ببلياندر، فإنَّ هذا العمل التاريخي لهوتنجر قد رسم صورة قاتمة عن حالة المسيحية في القرن السابع والانشقاقات التي ضربتها والهرطقة التي لحقت بها، مما مهّد الطريق أمام بزوغ فجر الإسلام وانتشاره. ومن المدهش أن نرى هوتنجر يستخدم نفس المنهج الذي سار عليه ميغيل سيرفيت ومؤلِّفو كتاب: (De falsa et vera)، لكنه يخلص منه إلى نتائج مناقضة لِما توصَّلوا إليه. ويتخذ من الهجوم القرآني المتكرّر على التثليث دليلًا على أنّ هذه العقيدة قديمة، اعتنقها الناس منذ ظهور المسيحية في الشرق. وعلى الجانب الآخر فإنَّ سكوت القرآن عن الكثير من الممارسات والشعائر الكاثوليكية الرومانية والأسرار المقدّسة الأكثر إثارة للجدل، وعدم اتهام المسيحيين الشرقيين بعبادة القساوسة والرهبان أو الأوثان، والاحتفال بالقربان المقدّس، أو الإيمان بعقيدة الاستحالة [تحول جوهر الخبز وجوهر الخمر إلى جوهر جسدِ المسيح ودَمِه عبر فعالية الروح القدس في طقس الأفخارستيا] أو بالسلطة الأسقفية العامة للبابا، كلّ هذا دليل عند هوتنجر على أنّ هذه الممارسات لم تكن قد ترسَّخت بعدُ في القرن السابع؛ ولذا فهي هرطقات متأخّرة[76].
ولم يقتصر توظيف القرآن في الجدالات التي شهدها عصر المذهبية وتشكّل الطوائف على المقارنات الجدلية وإعادة البناء التاريخي للتاريخ العقدي. فقد كان للقرآن دور محوري في إعادة البناء البروتستانتي للأُسس الكتابية للمسيحية، ويمثل هذا عنصرًا مركزيًّا في المشروع البروتستانتي لتقويض الزعم البابوي في احتكار السلطة العقدية. ويبرز هذا الدور من جديد في المقدّمة الدفاعية لتيودور ببلياندر التي يصرِّح فيها بأنَّ القرآن هو الكتاب الأنسب لتعلُّم العربية[77]. وبوصفه المرجع النحوي والمستودع اللغوي للعربية فإنَّ القرآن، جنبًا إلى جنب مع الشِّعْر العربي، كان حاضرًا بشكلٍ أساسي في بدايات الدراسة الحديثة للّغة العربية[78]. وتجلَّى هذا بوضوح في الدوائر الاستشراقية البروتستانتية التي انطلقت فيها دراسة العربية من رغبةٍ في الوصول لفهمٍ أفضل للنصوص العبرية في العهد القديم[79]. ومن هذا المنطلق، رأَى العديد من علماء العبرية البروتستانت في هذا الأمر ضرورةً لا مفر منها للخروج بنتائج لاهوتية سليمة، وشرطًا لازمًا لوضع حَدّ للخلافات الطائفية[80]. ومن هنا كانت الخصومة الطائفية إحدى العوامل المحرّكة لأُولى الدراسات الأوروبية الحديثة للّغة العربية. وفي القرن السابع عشر حين شهدنا تحسُّنًا في الدراسات العربية بفضل زيادة المعرفة الفنية والتجريبية، أصبح التوظيف الطائفي العقدي للقرآن أكثر تعقيدًا هو الآخر. وفي منتصف القرن السابع عشر أعدّ هوتنجر نسختين مصوَّرتين أو أكثر من مخطوطات قرآنية بالخطّ الكوفي والمغربي ما زالت محفوظة حاليًا في مكتبة الجامعة في جرونينجن وكاسل. أمّا مصوَّرة كاسل فقد رُوعي فيها دقة أكبر وأُهديت إلى ناخب البلاتينات في الإمبراطورية الرومانية المقدسة كارل لودفيغ (Karl Ludwig)[81]. واستُخدِمَت هذه المخطوطة في إخراج مصوَّرة ثالثة على يد المتخصّص في اللغات الإثيوبية هيوب لودولف (Hiob Ludolf)، وهي موجودة الآن بمكتبة جامعة فرانكفورت[82]. وخرجَت جميع هذه النماذج المصوَّرة للنور إِثْـر مشاورات بين خبراء الأثريّات وهذه المكتبات، فقد طلب سباستيان شوبنجر (Sebastian Schobinger) خبير الأثريات في سانت جالنمِن هوتنجر كتابة تقرير متخصّص عن المخطوطتين سنة 1645، وكذلك طلبت مكتبة الجامعة في كاسل من لودولف كتابة تقرير هو الآخر عن النسخة المصوَّرة التي في حوزتهم سنة 1680[83]. ومع ذلك، كان لهذه المخطوطات دور مركزي أيضًا في النقاشات العلمية التي دارَت حول القضايا التاريخية والدينية الجدلية، وبخاصّة تلك التي تتعلّق بتاريخ الخط العبري. وفي حالة هوتنجر فإنَّ مصوَّرة المخطوطة القرآنية المكتوبة بالخط الكوفي القديم التي ظهرت فيها علامات الإعراب والشكل استُخدِمَت دليلًا ماديًّا على وجود هذه العلامات في الخطَّين العربي والعبري منذ القِدَم، وأنها ليست متأخّرة لم تظهر إلّا على يدِ الماسوريين كما زعم عددٌ من المتخصّصين في الفيلولوجيا وتاريخ اللغات في أواخر القرن السادس عشر [84]. وكان هذا جزءًا من مهمّة هوتنجر طوال حياته لإثبات أسبقية الخط العبري ومنزلته، فقد ظلّ يدافع عنه ضدّ محاولات تقديم الخط السامري عليه بوصفه الصورة الأقدم للكتابة على نحو ما قرّره باحثون من أمثال جوزيف اسكاليجيه، وجان مورين (Jean Morin) ولويس كابيل (Louis Cappel). وبعد نصف قرن من الزمان ونتيجةً للمناهج العلمية المختلفة وتراجُع حدَّة التوترات الطائفية، أرسل الباحث اللوثري لودولف في فبراير سنة 1690 مصوَّرة منفصلة من مخطوطات كاسل لزميله إدوارد برنارد في أكسفورد[85]. وكان برنارد قد نشر في السنة السابقة مخططًا بيانيًّا[86] أرجع فيه جميع الخطوط الموجودة إلى الخط السامري[87]. وفي نهاية القرن السابع عشر، شاع تصوُّر حول ثبوت تاريخية الخط العبري بين كثير من الباحثين في الدراسات الشرقية من كلّ الأطياف، لينضمّ إلى قناعة متنامية بثبوت النصوص الكتابية من الناحية التاريخية بوجهٍ عامّ. وكان للقرآن دور مهمّ في هذه العملية كدليلٍ مادي تجسَّد في المخطوطات القرآنية المكتوبة بالخطّ الكوفي القديم، وبوصفه مستودعًا لغويًّا للعبرانية التوراتية ووثيقة ثقافية أسهمَت في تسليط الضوء على السياق التاريخي الذي نشأت فيه النصوص الكتابية والمجتمع المسيحي المبكِّر.
ومع ذلك فكما أكّدتُ بالاشتراك مع ألكسندر بيفيلاكوفي دراسة لنا عن القرآن في أوروبا إبّان القرن الثامن عشر، ليست القضية هنا من قَبِيل العَلْمَنة في مسارٍ خَطِّي[88]. فإنَّ أدوات البحث التاريخي قد صُقلت وتطوَّرت في سياقات الجدل المشحون دينيًّا للقرنين السادس عشر والسابع عشر، ولا تزال تُستخدم إلى يومنا هذا في أغراض جدلية ودفاعية. ولعلّ أبرز مثال على ذلك هو لودوفيكو ماراتشي الذي تُعَدّ ترجمته للقرآن تطوُّرًا ملحوظًا ومَعْلَمًا بارزًا في المحاولات الأوروبية الغربية لفهم القرآن فهمًا صحيحًا من الناحية الفيلولوجية. وكما يخبرنا ألاستير هاملتون كان ماراتشي ممثلًا مرموقًا للكنيسة الكاثوليكية الرومانية «استهجَن البروتستانتية وأظهَر التزامه وتفانيه لأجل كنيسته».
وعلاوة على ما سبق، بات من الممكن إيجاد مساحات من التفاعل مع القرآن بعيدًا عن الأغراض الجدلية في السياقات الدينية. وتصوير سوزانا هيشل للمشهد اليهودي والإسلامي وحال الدراسات القرآنية في القرن التاسع عشر يدلّ على الدوافع الدينية الكثيرة التي كانت حاضرة في التفاسير والترجمات اليهودية للقرآن.
لقد ظلَّ القرآن بالنسبة للباحثين والفلاسفة وعلماء الأديان والكُتّاب الأوروبيين أداة مفيدة للنظر في القضايا والشؤون الدينية والسياسية الملحّة. ورأينا في القرن الثامن عشر كيف وُظِّفَت الإشارة إلى الإسلام في نقد المسيحية أو الكنيسة أو السياسات الأوروبية. ويُعَدّ جون تولاند، ومونتسكيو، وجاك روسو، وفولتير مجرّد نماذج لمشاهير الكُتّاب الذين وَظَّفوا القرآن أو معرفتهم بالإسلام في تناولهم لقضايا داخلية. وكما يتّضح من المقالات الواردة في هذا العدد، لم يكن كتاب المسلمين المقدس مجرّد (الآخر)، بل كان حاضرًا بقوة في النقاشات التي تناولت الذات الأوروبية في سياقات دينية وسياسية وفلسفية وثقافية متنوّعة. ويمكن أن يكون مفهوم «القرآن الأوروبي» أداة مفاهيمية منتجة وأصيلة تتيح لنا وللأجيال القادمة التفكير بطرق مبتكرة في هذا التاريخ المشترك للمسيحية واليهودية والإسلام، وفي الدور المركزي الذي باشَرَه القرآن في عمليات إعادة التكوين الإبستمولوجي (المعرفي) التي تجسِّد جوهر أوروبا الحديثة.
[1] قام بكتابة المقدمة، مسؤولو قسم الترجمات بموقع تفسير.
[2] يُراجَع في هذا السياق: جيفرسون والقرآن، الإسلام والآباء المؤسسون، دينيس أ. سبلبيرغ، ترجمة: فؤاد عبد المطلب، جداول للنشر والتوزيع، مؤمنون بلا حدود، ط1، بيروت، 2015، ورغم غموض النتائج النهائية لهذا الكتاب حول علاقة جيفرسون بالقرآن، إلا أنّه يعبِّر عن اهتمام ببحث هذه الصِلَة، وهو اهتمام نابع في سياق الكتاب من التغيرات الديموغرافية في المجتمع الأمريكي وحضور المسلمين في كثير من المساحات والأدوار الاجتماعية والسياسية، والتي دفعت لمحاولة استكشاف الوجود الأقدم للقرآن والإسلام في الفكر الغربي وبحث أثره في هذا الفكر بمختلف مناحيه.
[3] العنوان الأصلي للمقالة هو (The Qur’an in Europe: The European Qur’an) وقد نشرت في (Journal of Qur’anic Studies 20.3 (2018): 1–20)، كمقدِّمة للعدد كما يذكُر المؤلف.
وجدير بالذكر أن الترجمة الحرفية لعنوان المقالة هو (القرآن في أوروبا: القرآن الأوروبي)، إلا أننا آثرنا تعديله ليكون (القرآن في أوروبا، قراءة في التفاعل الأوروبي مع القرآن في بدايات العصر الحديث) فهذا أكثر تعبيرًا عن اشتغال المقالة.
[4] كاتب هذه المقالة هو (Jan Loop) جان لوب، وهو أستاذ التاريخ الحديث والثقافات الدينية في كلية اللاهوت بجامعة كوبنهاجن، وباحث رئيسي في مشروع (القرآن الأوروبي)، وتتركَّز اهتماماته في دراسة العلاقة بين الإسلام والمسيحية واليهودية في بدايات العصر الحديث، (قسم الترجمات).
[5] ترجم هذه المقالة، د/ حسام صبري، مدرس بجامعة الأزهر، كلية اللغات والترجمة قسم الدراسات الإسلامية باللغات الأجنبية (اللغة الإنجليزية)، قام بترجمة عدد من الكتب والبحوث، منها: ترجمة كتاب (مصاحف الأمويين)، فرنسوا ديروش، عن مركز نهوض للبحوث والدراسات، بيروت، 2023.
[6] فعاليات هذا المؤتمر والتسجيلات المرئية للمداخلات منشورة على الموقع الإلكتروني لمعهد فاربورج على الرابط الآتي:
https://warburg.sas.ac.uk/research/research-projects/encounters-orienteos/projects-encounters-orient-eos/translating-quran.
ويمكن الاطلاع على تقرير حول المؤتمر من إعداد تشارلز بورنيت في مجلة الدراسات القرآنية (Journal of Qur’anic Studies)، العدد (14/ 2).
[7] ضمّت هذه المجموعة في تشكيلها الأساسي البروفيسور مرسيدس غارسيا أرينال (Mercedes García- Arenal، مدريد)، والبروفيسور جون تولان (John Tolan، مدينة نانت)، والبروفيسور روبرتو توتولي (Roberto Tottoli، نابلس)، فضلًا عنّي. وبعض الأفكار الواردة في هذا البحث هي ثمرة النقاش الذي دار بين أعضاء المجموعة.
[8] للوقوف على خبر ترجمة أندريه دي ريير، يُنظر:Hamilton and Richard, André du Ryer.
[9] أحد الأسباب الرئيسة لأهمية ترجمة ماراتشي تأتي من كونها ثنائية اللغة، أي أنها تضمّنت النصّ العربي ذاته مشكلًا ومنقطًا، وهذا كان مهمًّا في سياق جدالات الصِّلة بين العربية والعبرية وجدالات قدم الكتابة العبرية، كما سيتحدث الكاتبان في هذه المقالة. (قسم الترجمات)
[10] أودّ أن أُعرب عن شكري وتقديري لكلّ من ألاستير هاملتون وتشارلز بورنيت لِما أبدياه من ملاحظات على هذا البحث. كما أتوجّه بالشكر لدونكان فروست لمساعدته في تحرير هذه المقالات.
[11] هذا هو العنوان الذي ظهر في أقدم مخطوطة وصلَت إلينا من ترجمة روبرت الكيتوني والمحفوظة في المكتبة الوطنية الفرنسية برقم MS Arsenal 1162، ورقة 26. وللوقوف على وصف مفصَّل لهذه المخطوطة، يُنظر:
Martin, Catalogue, vol. 2, pp. 315–317.
ولمعرفة المزيد عن المخطوطات التي اعتمد عليها ببلياندر، يُنظر:
Bobzin, Der Koran im Zeitalter der Reformation, pp. 222–236. See also d’Alverny, ‘Deux traductions’, and Cecini, Alcoranus latinus.
[12] يُنظر: Bobzin, Der Koran im Zeitalter der Reformation, pp. 226–228.
[13] عَدّ ببلياندر سورة الفاتحة؛ ولذا اشتملت نسخته على 124 سورة.
[14] نقلًا عن الملخص الممتاز لتوم بورمان الذي أوجز فيه نقد يوحنا الأشقوبي أو خوان دي سيغوبيا لترجمة روبرت اللاتينية للقرآن؛ يُنظر:
Burman, Reading the Qur’an, p. 31.
وللوقوف على مواضع الخلل الدلالي، يُنظر:
Hagemann, ‘Die erste lateinische Koranübersetzung’.
[15] Cecini, Alcoranus latinus, p. 171.
[16] Burman, Reading the Qur’an, pp. 34–35.
[17] جلب يوهانس (Johannes of Raguse) مخطوطة من ترجمة روبرت الكيتوني من القسطنطينية إلى مجمع بازل سنة 1437. وموضعها غير معلوم، كما أحضر نسخة عربية من القرآن لا تزال محفوظة حتى يومنا هذا في مكتبة جامعة بازل برقم إيداع: (MS. A III 19). يُنظر:
Bobzin, Der Koran im Zeitalter der Reformation, p. 223 and 237.
[18] هناك إشارات متكررة لهذا الأمر في مقدمة تيودور ببلياندر للترجمة. وأيّد هارتموت بوبتسين هذا الرأي، يُنظر:
Bobzin, Der Koran im Zeitalter der Reformation, particularly pp. 208–209.
[19] L’Alcorano di Macometto.
[20] للوقوف على تاريخ مفصّل لترجمات القرآن، ينظر الباب السادس من مرجع أكسفورد للدراسات القرآنية بعنوان: القرآن في ضوء السياق: الترجمة والثقافة، وبخاصة ما جاء في الفصل الخامس والثلاثين لزياد المرصفي، بعنوان: ترجمات القرآن باللغات الغربية. وسوف يصدر هذا المرجع عن دار نهوض قريبًا. (المترجم)
[21] يُنظر:
Den Boer and Tommasino ‘Reading the Qur’an’.
[22] ‘Tradotto nuovamente dell’Arabo in lingua Italiana’.
[23] Tommasino, The Venetian Qur’an.
[24] Schweigger, Alcoranus Mahometicus, Vorrede.
[25] Schweigger, Alcoranus Mahometicus.
[26] De Arabische Alkoran door de Zarazijnsche en de Turcksche prophete Mahomet … Ut de Arabische spraecke nu nieuwelijcks in Hoogh- duytsch ghetranslateert … Ende wederom uyt het Hooghduytsch in Nederlantsche spraecke ghestelt.
[27] Bobzin, Der Koran im Zeitalter def Reformation, p. 264.
[28] Burman, Reading the Qur’an, p. 61.
[29] يُنظر:
Reynolds, The Qur’an and the Bible.
[30] Bibliander, Apologia, 4r.
[31] بالنظر إلى الحواشي على الطبعات القرآنية المطبوعة والمخطوطة، نجدها تكشف عن السياقات التي قُرئ فيها القرآن. وربما كان من المثير إعداد دراسة مقارنة للاختلافات في النصوص المحيطة بالنصّ القرآني في تراث ببلياندر وروبرت الكيتوني. ولعلّ الأبرز في هذا الصدد هي طبعة شفايغر الصادرة سنة 1616 التي خَلَتْ من جزء النقد والتفنيد، بل واشتملت على تعليقات وحواشٍ محايدة تمامًا. وقارن على سبيل المثال ما ورد من تعقيب على أحد المواضع في السورة الثالثة والثلاثين، فنجد ملاحظات جدالية عند ببلياندر، وتابعه على ذلك أريفابيني في نسخته، أمّا ترجمة شفايغر لسنة 1616 فجاءت موجزة محايدة، في حين أنّ طبعة 1659 اكتفت بالتلخيص.
[32] Leuchter, Alcoranus Mahometicus.
وقفتُ على هذا العمل الرائع لهاينريش لوشتر بفضل لوت بروير (Lot Brouwer) التي تُعِدّ أطروحة دكتوراه عن شفايغر.
[33] ‘Quod Alcoranum non est lex dei, quoniam non habet stilum et modum cum alijs convenientem’ (da Montecroce, ‘Confutatio Alcorani seu legis Saracenorum’, p. 293).
[34] ‘Videmus enim in divina scriptura deum loquentem cum Moyse et cum aliis prophetis, et nunquam rhythmus vel versibus his loquentem’ (p. 295)
ويُنظر:
Loop, ‘Divine Poetry’, p. 463.
[35] Acoluthus, Tetrapla Alcoranica sive.
وللوقوف على خبر أكولوثوس، يُنظر:
Hamilton, ‘To Rescue the Honour of the Germans’.
[36] يُنظر:
Loop, ‘Divine Poetry?’.
ومع ذلك تجدر الإشارة إلى أنّ أكولوثوس هو مَن قدّم للقارئ الأوروبي أحد الأوصاف المبكّرة للتجربة الجمالية والبلاغية التي يحظى بها المسلمون عند قراءة القرآن أو سماعه.
[37] يُنظر النصّ الأصلي لدى:
Melanchthon, Praemonitio ad lectorem, fol. Ɋ2
[38] شاع في الكتابات الغربية استخدام لفظ الترك في إشارة إلى المسلمين، وحين أعاد ﺳﺎﻟﻮﻣﻮن ﺷﻔﺎﻳﻐﺮ (SalomonSchweigger) ترجمة النسخة الإيطالية لأريفابيني إلى الألمانية أسماها: قرآن التُّرك، مما يدلّ على التحوّل في إطلاق لفظ «التُّرك» على المسلمين (وكان الاصطلاح الشائع من قبل الساراسين)، وذلك نتيجة للتهديد العسكري العثماني في أوروبا الوسطى. (المترجم)
[39] يُنظر:
Loop, Johann Heinrich Hottinger, p. 32.
[41] يُنظر النصّ الأصلي لدى:
Bibliander, Apologia, sig. ß5v.
وقد ترجم تشارلز بورنيت مقدّمة ببلياندر الاعتذارية، ونعتزم تحريرها وتصديرها بمقدّمة وإضافة بعض الحواشي والتعليقات. وأودّ أن أُعرب عن خالص شكري لتشارلز بورنيت لإتاحة الفرصة لي في استخدام ترجمته عند كتابة هذه المقالة.
[42] يُنظر:Kaufmann, ‘Türckenbüchlein’, p. 43
[43] Tommasino, The Venetian Qur’an, p. 36.
[44] Tommasino, The Venetian Qur’an.
[45] جاءت هذه السلسلة بطلب من الكونت أوتو هاينريش سنة 1544 لإرفاقها كصور توضيحية للترجمة الألمانية لتعليق سباستيان ماير على سِفر الرؤية. للوقوف على معلومات حول ماير ورؤيته لسِفر الرؤية، ينظر:
Backus, Reformation Readings of the Apocalypse, pp. 18–23.
وحقوق النشر محفوظة لأمناء المتحف البريطاني.
[46] يُعَدّ غيوم بوستل (Guillaume Postel) استثناء من هذه القاعدة، فقد اعتمد على ترجمته الشخصية، كما سيأتي معنا لاحقًا.
[47] Bibliander, Apologia, sig. ß5, Bullinger, Der Türgg, Avir- v. See Campi, ‘Probing Similarities and Differences’, p. 110.
[48] جاءت هذه المقارنة في عمود منفصل بعنوان:
‘Haereses et Haeretici quibuscum suo Alcorano’.
[49] Evenden and Freeman, Religion and the Book in Early Modern England, pp. 80–82.
ويُنظر أيضًا:
Schmuck, ‘The ‘Turk’ as Antichrist’.
[50] يُنظر:
Dimmock, Mythologies of the Prophet Muhammad, p. 89.
[51] يُنظر:
Highley, Catholics Writing the Nation
وبخاصة الفصل الثالث الذي جاء بعنوان:
‘Turks, Northerners, and the Barbarous Heretic’.
[52] ثمة تحليل مفصَّل لهذه المسألة لدى:
Bobzin, Der Koran, pp. 365–497.
[53] يُنظر:
Postel, Alcorani seu legis Mahometi et Evangelistarum concordiae liber, p. 13
[54] أستخدم الطبعة الصادرة في باريس سنة 1610، وترِد المقارنة فيها في الصفحات: 457- 467. ويُنظر أيضًا:
Heath, ‘Islamic Themes’.
[56] Luthers Alcoran, pp. 5–6.
ويُنظر أيضًا:
Dimmock, Mythologies of the Prophet Muhammad, pp. 93–94; Highley, Catholics Writing the Nation, pp. 61–62.
[57] Luthers Alcoran, p. 2.
[58] المرجع السابق، ص27.
[59] المرجع نفسه، ص22- 25.
[60] يُنظر: Highley, Catholics Writing the Nation, p. 63.
[61] من جديد، نرى استخدام لفظة التُّرك هنا، وكما مرّ مِن قبلُ فإنَّ هذا اللفظ يمثل مرحلة انتقالية في الحديث عن المسلمين. (المترجم)
[62] Copinger, The Theatre, p. 81.
[63] Mulsow, ‘Fluchträume und Konversionsräume zwischen Heidelberg und Istanbul’; Pirnát, Die Ideologie, p. 125.
[64] مفهوم التثليث مرفوض تمامًا في القرآن كما يتضح في السورة الحادية عشرة والثانية عشرة والثامنة والعشرين، حيث يُبيِّن محمد أنَّ هذه الآلهة الثلاثة التي يشركونها مع الله لم تكن معروفة لآبائهم وأنهم أبناء الشيطان (بعلزبول)، وقد عبدوه من دون الله، يُنظر:
Servet, Christianismi Restitutio, pp. 35–36.
[65] المرجع السابق، ص35.
[66] وعنوانه: (De falsa et vera unius Dei Patris Filii et Spiritus Sanctus cognition) يُنظر: Hughes, ‘In the Footsteps of Servetus’.
[67] للوقوف على خبر هذا العمل، يُنظر: مقدمة أنتال بيرنات (Antal Pirnát) للعمل الذي تولّى تحريره بعنوان: De falsa et vera unius Dei patris.
[68] Pirnát, De falsa et vera unius Dei patris, p. 38.
[69] Calvin, Opera quae supersunt omnia, 8.765, 777
ويُنظر أيضًا:
Loop, Johann Heinrich Hottinger, p. 209.
[70] Simler, De aeterno Dei filio Domino, sig. ƴ3r.
[71] يُنظر: Daugirdas, Die Anfänge des Sozinianismus, p. 226.
[72] يُنظر: المرجع السابق، ص212.
[73] de la Croze, ‘Historical and Critical Reflections’, p. 212,
ويُنظر:
Meggitt, ‘Early Unitarians and Islam’.
[74] Bibliander, ‘Apologia’, sig. Ɋ4v
[75] يُنظر في هذا كتاب لي بعنوان:Johann Heinrich Hottinger
[76] Hottinger, Historiae Ecclesiasticae, pp. 59–60.
[77] Bibliander, Apologia, sig. ß 1r
[78] يُنظر: Hamilton, ‘The Qur’an as Chrestomathy’.
[79] في بداية الحقبة الحديثة للعالَم الكاثوليكي الروماني كان هناك اتجاه على ما يبدو نحو جعلِ اللغة العربية لغة مسيحية وتعلُّمها وتدريسها من واقع كتابات مسيحية. وقد لفت بونيفاسيوس اميرباخ (Bonifatius Amerbach) الأنظار إلى هذه الإمكانية في السياق الجدلي الذي سبق صدور طبعة ببلياندر. يُنظر:
Bobzin, Der Koran im Zeitalter der Reformation, p. 192; Girard, ‘Teaching and Learning Arabic’.
[80] Loop, Johann Heinrich Hottinger, pp. 9–10.
[81] المرجع السابق، ص122- 130.
[82] محفوظة برقم فهرسة: MS Ff. H. Ludolf II 32 Fasc. F Nr 1.
[83] لا يزال تقريره محفوظًا مع المخطوطة بمكتبة الجامعة في كاسل برقم فهرسة: MS orient Anhang 31.
[84] للوقوف على هذا الرأي وما يحيط به من جدل، يُنظر:
Loop, Johann Heinrich Hottinger, pp. 122–130.
[85] ينظر: مخطوطة بمكتبة بودلي، برقم: (MS Smith 5)، الأوراق: 167- 169.
[86] يُنظر: Orbis eruditi Literatura a charctere Samaritico deducta
[87] Bernard, Orbis erudite.
وأعتزم مناقشة هذه الجزئية بالتفصيل في عملٍ آخر.
[88] يُنظر أيضًا:
Bevilacqua, The Republic of Arabic Letters.
كلمات مفتاحية
الكاتب:
مواضيع ذات صلة
((المعلومات والآراء المقدَّمة هي للكتّاب، ولا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع أو أسرة مركز تفسير))