الاستشراق والدراسات القرآنية (2-2)
الدراسات القرآنية الغربية
.jpg)
مقدمة:
هذا هو الجزء الثاني من الحوار الذي أجرته الأستاذة ليلى ثمراوي مع الدكتور التجاني بولعوالي، والذي يتناول ظاهرةَ الاستشراق والدراسات القرآنية الغربية، وبعد أن تناول الجزء الأول[1] مفهوم الاستشراق، ومحاولات تحديدها، ومقاربات دراسته شرقًا وغربًا، يتناول هذا الجزء دراسات القرآن الغربية، فيتناول الطبيعة المعرفية لهذه الدراسات، وأهم المناهج التي تستخدمها، ونشأتها وتطورها، كما يتناول أثر التغير الحاصل في الاستشراق على الدراسات القرآنية، واهتماماتها ومناهجها، كذلك يلقي الضوء على أهمّ التطوُّرات المعاصرة في سياق الدراسات القرآنية، ممثَّلة في المشاريع البحثية الكبرى التي تشهدها ساحتها.
المحور الثاني: الدراسات القرآنية الغربية:
س1: ما جذور الاهتمام الاستشراقي بالدراسات الإسلامية والقرآنية؟
د/ التجاني بولعوالي:
عادةً ما يُربط الاهتمام اللاهوتي والأكاديمي الأوروبي بالدراسات الإسلامية والقرآنية بمراحل تاريخية محدّدة، كان لها أثر كبير على العلاقات الجيوسياسية بين المسلمين والمسيحيّين. وقد استُخدمت هذه الدراسات الأوروبية والمسيحية، التي سُتعرف لاحقًا بالاستشراقية، كأدوات في هذا الصِّراع السياسي، ما يَعني أنّ العامل السياسي كان في المركز، بينما كان الجدل حول الإسلام والبحث في حقيقته مجرّد هامش ووسيلة. وهنا نستحضر ثنائية السُّلطة والمعرفة في الاستشراق كما نَظَّر لها إدوارد سعيد، حيث كانت معرفة المستشرقين التقليديين خادمة لسُلْطة المستعمِرين الأوروبيين. ولعلّ هذه السِّمَة ظَلَّت حاضرة في مُعظم الدراسات الاستشراقية التقليدية، مع بعض الاستثناءات، خصوصًا في الاستشراق الألماني والهولندي.
ولم تَسلم جذور الاهتمام الاستشراقي بالدراسات الإسلامية والقرآنية من تأثير ثنائية السُّلْطة والمعرفة، رغم اختلاف السياقات التاريخية والجغرافية. وعادةً ما يتركّز هذا الاهتمام على المرحلة اللاهوتية الجدلية في القرون الوسطى، لا سيّما مع انطلاق الحروب الصليبية بأمر البابا أوربان الثاني في 1096م، حيث كان الهدف الأساس دينيًّا تبشيريًّا. فقد وقفَت أوروبا المسيحية ككتلة موحدة لمحاربة الإسلام، ليس فقط كعدوّ إستراتيجي وعسكري يهدّد المصالح الأوروبية، بل كمنافس لاهوتي للنصرانية أيضًا. وهذا يعني أنّ ثنائية السلطة والمعرفة كانت متجذّرة منذ هذه المرحلة المبكّرة، حيث استُخدمت المعرفة لاكتشاف نقاط قوّة العدوّ الإسلامي وضعفه، ومن ثم اعتماد الإستراتيجية الأنسب لمواجهته والانقضاض عليه.
وفي هذه المرحلة المبكِّرة ظهرتْ أول ترجمة أوروبية للقرآن باللاتينية على يد روبرت القيطوني في 1143م، ولم تكن لأجل المعرفة الخالصة أو للجدل اللاهوتي فقط، بل لتحقيق أهداف سياسية وعسكرية مخفية خلف قناع ديني. وقد ظلَّت هذه الترجمة طوال أربعة قرون مخطوطة في نُسخ متعدّدة، تُتداول داخل الأديرة فقط، حتى قام ثيودور بيبلياندر بطبعها في سويسرا في 1543م، وقدّم لها كلٌّ من مارتن لوثر وفيليب ميلانختون.
ولا يمكن تجاهل ظهور مصنّفات عديدة في هذه المرحلة كانت تهدف إلى تفنيد الإسلام وتقويض ثوابته العقدية، أبرزها رسالة توما الإكويني الشهيرة تحت عنوان: (الخلاصة ضد الوثنيين) (1259- 1265)، والمقصود بالوثنيين هنا المسلمون، حيث قدّم القرآن كمصدر (هرطقة) يجب دحضها.
واستمرّ هذا النمط من التعاطي مع القرآن في مرحلة النهضة الأوروبية، مع تحوّل تدريجي في نظرة المستشرقين إلى الإسلام والقرآن، خصوصًا مع انطلاق النهضة الإنسانية بين القرن الخامس عشر والثامن عشر. في هذه المرحلة توسّعت الأطماع الإمبريالية الأوروبية في أمريكا وإفريقيا وآسيا، وكانت القوى العظمى آنذاك، لا سيّما فرنسا وبريطانيا، في حاجة ماسّة لمعرفة طبيعة البلدان المستهدفة، فبدأت الدراسات اللغوية والثقافية، ثم الدراسات الإثنوغرافية والأنثروبولوجية لاحقًا. وقد أدّى المستشرقون الأوائل دورًا محوريًّا في التمهيد للحركة الإمبريالية المبكّرة.
أمّا الاهتمام بالقرآن الكريم فتمّ في إطار دراسة لغات الشرق (العربية، السريانية، العِبرية) وكراسي الدراسات العربية في الجامعات الأوروبية، والتي كان النصّ القرآني يشكِّل أحد مصادرها المهمّة، وإن لم يكن محورها الوحيد. وظهرت ترجمات جديدة للقرآن إلى اللغات الأوروبية، حيث ظلّت ترجمة روبرت القيطوني مرجعًا للمترجمين لجهلهم اللغة العربية، حتى صدرت أول ترجمة مباشرة من العربية إلى الفرنسية على يد أندري دي ريور في 1647. ومع هذا التطوّر المنهجي، ظلّ الهدف الدفاعي اللاهوتي المسيحي حاضرًا لدى معظم المستشرقين.
ولا يكتمل الحديث عن هذه الجذور دون الإشارة إلى المرحلة الأكاديمية الحديثة في القرنين التاسع عشر والعشرين، حيث ازدهرت الفيلولوجيا والدراسات التاريخية في أوروبا، وبدأ النظر إلى القرآن كنصّ تاريخي يُخضع للمناهج النقدية كما حدث مع الكتاب المقدّس. ويُعزى الفضل في تأسيس هذا التوجّه إلى نولدكه وغولدزيهر؛ اللذَيْن درسَا القرآن في إطار المقارنة الدينية والتاريخية. ولم يكن الاهتمام بالتراث الإسلامي لأهداف أدبية أو أكاديمية فقط، بل برزت الأهداف الاستعمارية والسياسية أيضًا؛ إِذْ ساعد فَهْمُ النصوص الإسلامية القوى الاستعماريةَ في إدارة الشعوب المسلمة، ويُعَدّ سنوك هرخرونيه -مهندس الاستعمار الهولندي في إندونيسيا- أبرز مثال على هذا النهج في القرن العشرين.
وبناءً على ما سبق، يظهر أنّ دوافع الاهتمام الاستشراقي بالدراسات الإسلامية والقرآنية كانت متعدّدة: اللاهوتية الجدلية للردّ على الإسلام، والمعرفية لدراسة لغات وثقافات الشرق، والاستعمارية للسيطرة على خيرات الشعوب الأجنبية. وفي النهاية، كانت السُّلطة هي المحرك الأساس للاستشراق، حيث تضافرت الدوافع الدينية والثقافية واللغوية لصالح الدافع السياسي والإستراتيجي، جاعلة المعرفة الاستشراقية خادمة للسلطة الاستعمارية.
س2: كيف وظَّف المستشرقون التقليديون المنهج التاريخي والفيلولوجي في قراءة النصّ القرآني؟ وهل يواصل المستشرقون الجُدد الاعتماد على مثل هذه المناهج أم أنهم استحدثوا أدوات نقدية بديلة؟
د/ التجاني بولعوالي:
قبل الإجابة عن هذا السؤال الوجيه، يقتضي المقام توضيح أحد المصطلحات المفتاحية الواردة فيه، وهو مصطلح الفيلولوجيا، الذي يُقدَّم في الدراسات العربية غالبًا بصورة مبهمة، وأحيانًا غير دقيقة. من الناحية الاشتقاقية (الإيتيمولوجية) ينحدر هذا المصطلح من الكلمة اليونانية القديمة فيلولوجيا philología التي تعني حرفيًّا (حبّ الكلمة). أمّا في الاصطلاح، فيشير إلى ذلك الحقل المعرفي الذي يُعنى بدراسة اللغة في ضوء نصوصها التاريخية المكتوبة أو المنقولة شفويًّا، بهدف الكشف عن تطوّر اللغة ورصد تاريخها عبر تحليل النصوص والوثائق القديمة. وهذا ما يجعل الفيلولوجيا عِلْمًا متداخلًا مع جُملة من التخصّصات مثل النقد الأدبي والتاريخ واللسانيات وعِلْم الاشتقاق، كما أشار إلى ذلك فرديناند دي سوسير في كتابه (محاضرات في اللسانيات العامة). ومن ثمّ، فهي تحمل أبعادًا متعددة: لغوية، تتعلّق بتحليل المفردات والتراكيب والقواعد؛ وتاريخية، عبر تتبّع تطوّر اللغة عبر العصور؛ ونصيّة، ترتبط بتحقيق النصوص القديمة ومقارنة المخطوطات؛ وثقافية، تتحدّد في فهم اللغة ضمن سياقاتها الحضارية والفكرية.
ومِن أبرز الإشكالات الاصطلاحية التي تعترض الباحث في مفهوم الفيلولوجيا، تداخله مع مصطلحات أخرى قريبة منه؛ ما يجعل بعض الباحثين والمترجمين لا يوفّقون في اختيار المعادل العربي المناسب. ويُشار هنا بخاصّة إلى مصطلحَي: علم اللغة وفقه اللغة. ولرفع هذا اللَّبْس، ينبغي القول أنّ عِلم اللغة هو المعادل لمصطلح اللسانيات Linguistics، التي تعني الدراسة العلمية للّغة بوصفها نسقًا قائمًا بذاته، وتركّز على خصائص اللّغة وأبعادها الصوتية والصرفية والنحوية والدلالية والتداولية والتطبيقية. وتختلف اللسانيات عن الفيلولوجيا من حيث كون الأولى تدرس اللغة كبنية حيّة مستقلّة عن النصوص أو عن تاريخها، بينما تُعنى الفيلولوجيا أساسًا بالنصوص المكتوبة وتطوّرها التاريخي.
أمّا فقه اللغة، فيعني في التراث العربي معرفة اللغة في عُمقها؛ مفرداتها واشتقاقاتها واستعمالاتها وأساليبها وأسرارها. بينما في الاستعمال الأوروبي القديم كان قريبًا في معناه من الفيلولوجيا، أي: دراسة اللغات والنصوص القديمة مقارنةً وتحليلًا. ويلاحظ أن مصطلح فقه اللغة يُستعمل في الدراسات العربية المعاصرة أحيانًا كمعادل للفيلولوجيا، رغم الاختلافات الاشتقاقية والدلالية والمعرفية بينهما.
وقد نشأ مصطلح الفيلولوجيا تاريخيًّا لدراسة النصوص اليونانية واللاتينية القديمة، ثم توسّع مع الاستشراق ليشمل النصوص الساميّة (العِبرية، الآرامية، العربية). ومنذ القرن التاسع عشر ارتبط بالمنهج التاريخي- النقدي الذي طبّقه المستشرقون، لا سيّما الألمان، على النصوص المقدسة (التوراة، الإنجيل، القرآن).
وفي إطار هذا المنهج تعامَل روّاد الاستشراق، مثل نولدكه وغولدزيهر وبلاشير، مع القرآن بوصفه نصًّا تاريخيًّا نشأ في سياق القرن السابع الميلادي، نافِين صِلته بالوحي الإلهي، ومعتبرين محمدًا هو مؤلِّف النصّ. وسعوا إلى إعادة ترتيب السور والآيات وفق تسلسل زمني مفترض (مكّي/ مدني، مبكّر/ متأخّر)، متجاوزين الترتيب العثماني. ومن أمثلة ذلك التصنيف الزمني للنصوص القرآنية وربطها بمراحل السيرة النبوية، كما فعل نولدكه في كتابه: (تاريخ القرآن). وكان الهدف من هذا التصنيف فهم القرآن بوصفه نتاج تطوّر فكري وديني، شبيه بمسار تكوّن الكتاب المقدّس في الدراسات التوراتية.
وفي المقابل، استُخدمت المقاربة الفيلولوجية للكشف عن جذور الألفاظ القرآنية (عربية، آرامية، عِبرية، حبشية...)، ولإجراء مقارنات بين القرآن والنصوص السابقة؛ كالعهدَيْن القديم والجديد والشِّعْر الجاهلي. وتجدر الإشارة هنا إلى غولدزيهر الذي رأى أنّ بعض المفردات القرآنية مستعارة من المسيحية الشرقية أو اليهودية الحاخامية. ولم يكن الهدف من ذلك مجرّد التفسير اللغوي، بل إثبات أنّ القرآن لم يتكوّن في فراغ، بل كان حصيلة تفاعل ثقافي ولغوي مع محيطه.
أمّا في الدراسات الاستشراقية المعاصرة، فلا يزال المنهجان التاريخي والفيلولوجي حاضرَيْن؛ إِذْ يوظَّفان كآليتَيْن أساسيتَيْن لوضع النصّ القرآني في سياقه الثقافي واللغوي. ومن أبرز الأمثلة غابرييل سعيد رينولدز، الذي اعتمد المقارنة الفيلولوجية بين القرآن والكتاب المقدّس في كتابه: (القرآن وخلفيته الكتابية) (2010). ويمكن الإشارة أيضًا إلى نيكولاي سيناي الذي واصَل البحث في تاريخ النصّ وطبقاته في كتابه: (القرآن: مقدمة نقدية تاريخية) (2017). ومع ذلك، لم يقتصر المستشرقون الجُدد على هذين المنهجين، بل وسّعوا مقارباتهم من خلال أدوات جديدة؛ كالمقاربة الأدبية والهرمنيوطيقية عند أنجليكا نويفرت التي درست القرآن كنصّ أدبي حيّ ضمن أدب الشرق الأدنى المتأخر، والمقاربات السيميائية والبنيوية التي تنظر إلى القرآن كنظام رمزي متكامل، بالإضافة إلى المقاربة الأنثروبولوجية- السوسيولوجية، كما عند فريد دونر في كتابه: (محمد والمؤمنون).
وعلى هذا الأساس، يمكن القول أنّ المستشرقين التقليديين اعتمدوا أساسًا على المنهجين التاريخي والفيلولوجي لإثبات التأثيرات الخارجية على القرآن، سواء من النصوص الكتابية السابقة أو من الأدب الجاهلي، وإعادة بنائه زمنيًّا لفهمه بوصفه نتاج تطور فكري وديني. أمّا المستشرقون الجُدد، فلم يهملوا هذه المناهج، لكنهم أضافوا إليها مقاربات متعددة: نقدية، وأدبية، وهرمنيوطيقية، وسيميائية، وأنثروبولوجية. وهو ما يعني أن المنهج التاريخي والفيلولوجي لا يزال حاضرًا في الدراسات القرآنية الغربية المعاصرة، لكن ضمن منظومة أوسع وأكثر تنوعًا من المناهج.
س3: ما أوجه القصور المنهجي في المقاربات التاريخية والفيلولوجية من وجهة نظركم؟ وهل ثمة منهجية تراعي خصوصية النصّ القرآني دون الوقوع في فخّ التحيّز الثقافي؟
د/ التجاني بولعوالي:
إنّ الدراسات الاستشراقية عمومًا، والمقاربات الاستشراقية على اختلافها، سواء كانت تاريخية أو فيلولوجية أو غيرها، تنطلق في الغالب من خارج النصّ أو الظاهرة التي تدرسها. وأعتقدُ شخصيًّا أنّ هذا هو مكمن قصورها، ليس المنهجي فحسب، بل الإبستيمولوجي والثقافي أيضًا، وهو الأخطر. إِذْ كيف يمكن لمن يقف خارج النصّ أو الظاهرة أن يدرسها دراسة سليمة، وهو لا يدرك خفاياها وأبعادها الداخلية، ولا يحيط بظروفها وعواملها الحقيقية؟!
ولعلّ المثال الأوضح على ذلك اللغة العربية، التي تُعَدّ العتبة الأساس لولوج النصّ القرآني؛ فمن دون إتقانها دلالةً وتركيبًا ونحوًا وإعرابًا، وفهم مستوياتها النفسية والثقافية والاجتماعية، يستحيل على الباحث أن يفهم خطابها على الوجه الصحيح. وهنا يبرز السؤال: كم عدد المستشرقين القدامى والمعاصرين الذين اشتغلوا بالدراسات القرآنية وكانوا متمكّنين حقًّا من العربية؟ وهل كان جميع مَن درس القرآن من المستشرقين الغربيين على مستوى رفيع من إتقان العربية، ليس في النحو والمعجم فحسب، بل أيضًا في بلاغتها وإيحاءاتها الثقافية وخفاياها النفسية والدلالية؟ إنّ النظر إلى النصّ من الخارج أو عن بُعد لا يُمكّن الباحث إلا من رؤية بعض الجوانب الشكلية السطحية، وهذا ما حصل بالفعل مع كثير من المستشرقين الأكاديميين الذين انشغلوا بالدراسات العربية والإسلامية من دون أن يزوروا بلدًا عربيًّا، أو يتواصلوا باللسان العربي، أو يحتكُّوا بالواقع العربي. ومثال ذلك شيخ الاستشراق الألماني وأبو الدراسات القرآنية تيودور نولدكه، الذي لم يَزُر في حياته بلدًا عربيًّا أو إسلاميًّا، رغم أنّ تخصّصه الأكاديمي كان منصبًّا بالأساس على لغات هذه البلدان وتاريخها وكتبها المقدّسة.
من هنا، لا يمكن أن نتوقع من المستشرقين الذين تخصّصوا في القرآن الكريم دراسات موضوعية، وأكثرهم لم يُتقن العربية، وبعضهم لم يَزُر بلدًا عربيًّا قط، وآخرون لم يقضوا سوى فترة وجيزة في بلد عربي. بينما على النقيض من ذلك، يشترط في دراسة الكتاب المقدّس أن يتقن الباحثُ لغاته الأصلية؛ كالعِبرية والآرامية واليونانية.
ويُضاف إلى هذا القصور اللغوي والمعرفي قصور آخر يتمثّل في طريقة التعامل مع النصّ القرآني؛ إِذْ غالبًا ما يُختزل إلى مجرّد وثيقة تاريخية تُجرّد من أبعادها الإلهية والتعبدية والروحية، وتُعتبر حصيلة لسياقات تاريخية فقط. وهو ما يلغي الدور الديني والوظيفي للقرآن في حياة المسلمين، فلا يُنظر إليه بصفته وحيًا مؤسِّسًا، بل مجرد نصّ استشهادي لا أكثر. كما أنّ الاعتماد على المقارنات مع النصوص اليهودية والمسيحية (المدراش، التوراة، الأناجيل...) يؤدي إلى قراءة (من الخارج)، وكأنَّ القرآن مجرّد إعادة إنتاج لِما سبقه، دون اعتبار لقطيعته وتجديده. أمّا المقاربة الفيلولوجية فتنشغل بالكلمات وأصولها على حساب بنية النصّ الداخلية وترابطه البلاغي والدلالي الذي يتجاوز حدود المفردة.
وتجاوزًا لهذه المحدودية في المقاربة الفيلولوجية، برزَت في الغرب مناهج معاصرة متنوّعة في دراسة القرآن، منها المقاربة البنيوية الأدبية كما في أعمال أنجليكا نويفرت وميشيل كويبرس، حيث يُقرأ القرآن بوصفه خطابًا أدبيًّا متماسكًا ذا بنية سردية وشِعْرية خاصّة، لا مجرّد تجميع عشوائي للآيات. ومنها المقاربة التداولية التي تفهم النصّ في سياق التلقّي الأول (العصر النبوي) دون أن تختزله في كونه انعكاسًا لذلك السياق؛ إِذْ تنتبه إلى البُعد الخطابي: كيف يخاطب القرآن متلقّيه ويؤثر في وعيهم. وهناك أيضًا المقاربة التفسيرية المقارنة، التي تركز على التواشج الثقافي والديني (التوراة، الإنجيل، الأدب السامي) دون إنكار خصوصية القرآن، ويظهر ذلك في أعمال غابرييل سعيد رينولدز الذي يرى القرآن في حوار مع النصوص السابقة لا مجرّد نسخة عنها. فضلًا عن ذلك، ظهرت مقاربة عَبْر ثقافية تشجع على إشراك باحثين مسلمين وغربيين في مشاريع مشتركة لتفادي الرؤية الأُحادية.
ومع ذلك، تبقى معظم هذه المقاربات القرآنية الجديدة، رغم تجاوزها للمقاربات التقليدية الجدلية والفيلولوجية والتاريخية، قاصرة ما لم تتخلَّ عن تحيّزها المنهجي والثقافي في دراسة القرآن الكريم وفق ما هو مقرّر في المصادر الإسلامية الأصيلة. وهذا ما يرفضه غالبية المستشرقين المعاصرين، الذين لا يزالون ينظرون إلى القرآن إمّا كنصّ أدبي، أو كنتاج بشري للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، أو كاستنساخ للكتب السابقة. وهو ما ينزع عنه قداسته ومصدره الإلهي وإعجازه اللغوي والبياني والعلمي، ويحوّله إلى مجرّد وثيقة بشرية. لذا، فإنّ هذه المقاربات -على الرغم من تطورها المنهجي والتحليلي- تظلّ خارجية في جوهرها، تُجرّد القرآن من خصوصياته الإلهية والروحية والتعبدية والإعجازية والاجتماعية- الثقافية.
س4: ما أثر الاستشراق الجديد على الدارِسين للقرآن الكريم وعلومه من العرب والغربيين؟ وما أهمّ التحوّلات التي طرأت في تعاطي الاستشراق الجديد مع القرآن الكريم؟
د/ التجاني بولعوالي:
في الحقيقة، تتنوّع آثار الاستشراق؛ قديمة وجديدة، على المشتغلين بالدراسات القرآنية من العرب والمسلمين ومن الغربيين. ويمكن التمييز في هذا الصدد بين ثلاثة مواقف رئيسة:
الموقف الأول: وهو الموقف الرافض أو المتحفِّظ إزاء ما يصدر عن المستشرقين من مقاربات ودراسات حول الإسلام والقرآن والحديث وغيرها. وغالبًا ما يتّخذ هذا الموقف طابعًا دفاعيًّا، حيث ينظر إلى الاستشراق الجديد بريبة ويضعه في خانة التشكيك؛ لكونه يطعن في الوحي القرآني ويرفض نبوّة محمد صلى الله عليه وسلم. وقد أدّى ذلك إلى التشبّث بالقراءات التقليدية دون الإفادة من منجزات البحث الاستشراقي والأكاديمي الغربي.
الموقف الثاني: وهو موقف وسطي نسبيًّا، ولا يقبل أصحابه الكثير من الرؤى والقراءات التي يقدّمها المستشرقون، غير أنهم ينفتحون على مناهج الاستشراق في مقاربة القرآن (التاريخية، السوسيولوجية، المقارنة بالنصوص الكتابية)، إمّا بتبنِّيها جزئيًّا أو باستثمارها بشكلٍ نقدي. ومن الأمثلة على ذلك محمد عابد الجابري في: (مدخل إلى القرآن الكريم)، ونصر حامد أبو زيد في: (مفهوم النصّ). ولا يمكن إدراج هؤلاء بالضرورة ضمن النّسق التقليدي؛ لأنهم مارسوا نقدًا مزدوجًا شمل التراث الإسلامي ذاته، بما فيه علوم القرآن والتفسير، إمّا من منطلق فلسفي إبستمولوجي أو هيرمينوطيقي أو تاريخي.
الموقف الثالث: ذو طابع توفيقي؛ حيث يوظِّف بعضُ الباحثين العرب والمسلمين مناهج حديثة مستلهمة من الاستشراق الجديد ومن الدراسات العربية والإسلامية في الغرب، لكن مع الحفاظ على خصوصية القرآن النصِّية والإيمانية والإعجازية. ومن الأمثلة على ذلك: عبد الله دراز في: (النبأ العظيم)، وطه عبد الرحمن في: (الفلسفة الائتمانية).
أمّا الباحثون الغربيون، فيمكن التمييز بينهم أيضًا؛ فبعضهم أحدث قطيعة شبه تامة مع الدراسات الاستشراقية الكلاسيكية، وبعضهم احتفظ بجوانب منهجية منها (خاصة الفيلولوجية والنقد التاريخي)، وأضاف إليها أدوات جديدة، فيما لا يزال آخرون يجترُّون القراءات الاستشراقية التقليدية للقرآن، كما نجد عند بعض الاعتذاريين المسيحيين.
وعلى العموم، لا يمكن للباحث أن يَغفل عن التحوّلات المهمّة التي طرأت في تعاطي الاستشراق الجديد مع القرآن الكريم، والتي أثّرت بوضوح في المشتغلين الغربيين بالدراسات القرآنية، مِن طلبة وباحثين وأساتذة ومتخصّصين.
وأبرز هذه التحولات يتمثّل في الانتقال من الجدل إلى الحوار؛ إِذ تراجع الاستشراق الجديد عن نزعة التشكيك المطلق في الوحي القرآني، واتجه إلى قراءة القرآن باعتباره نصًّا أدبيًّا- ثقافيًّا جديرًا بالدراسة. أنجليكا نويفرت -على سبيل المثال لا الحصر- تصف القرآن بأنه نصّ محوري في ثقافة الشرق الأدنى المتأخّر، لا مجرد وثيقة تاريخية. كما لم نَعُد نجد الاستعمالات اللغوية المسيئة التي كانت حاضرة لدى كثير من المستشرقين القدامى، حيث كان يُقزَّم الإسلام ويُشْتَم القرآن ويُنْعَت النبي -صلى الله عليه وسلم- بأوصاف سلبية.
ثم إنّ الاستشراق الجديد ابتكر مناهج وأدوات بحثية متعدّدة، فأصبحنا اليوم أمام تعدّدية منهجية، إِنْ جاز التعبير؛ وأمام الما-بين التخصّصات والمنهجيات، حيث ظهرَت اتجاهات تستثمر النقد الأدبي، والسيميائيات، ونظريات التلقّي، إلى جانب المقاربات التاريخية والفيلولوجية الكلاسيكية.
ومِن التحوّلات البارزة أيضًا إطلاق مشاريع عالمية للدراسات القرآنية، جعلت القرآن يُدْرَس كجزء من التراث الإنساني المشترك، لا كموضوعِ جدل ديني فقط كما كان في السابق. هذه المشاريع تنفتح على مختلف التجارب البحثية حول العالم، وتستقطب المتخصّصين من شتى الخلفيات. ورغم ما يُوجَّه إليها من نقد، لا يمكن إغفال جوانبها الإيجابية، مثل: الارتقاء بالخطاب القرآني إلى مستوى كوني، والاعتراف بقيمته، وحِفْظ المخطوطات القرآنية، وترجمته إلى لغات العالم.
وفي المحصلة، يمكن القول أنّ الاستشراق الجديد ترك أثرًا مزدوجًا، فقد فتح أمام العرب والمسلمين آفاقًا جديدة للبحث، لكنه دفع بعضهم أيضًا إلى ردود فعل دفاعية، فيما جعل الغربيين أكثر انفتاحًا على القرآن باعتباره تراثًا إنسانيًّا عالميًّا.
س5: هل يمكن الحديث عن تنميط في طرق التناول أو إنتاج خطابات تفسيرية متشابهة رغم اختلاف الخلفيات؟
د/ التجاني بولعوالي:
في السؤال السابق، تبيّن أنّ الاستشراق الجديد أحدث تحوّلًا نوعيًّا في ميدان الدراسات القرآنية مقارنة بالاستشراق التقليدي. فبينما ركّز المستشرقون الكلاسيكيون مثل نولدكه وغولدزيهر على إعادة بناء تاريخ النصّ القرآني اعتمادًا على المنهج الفيلولوجي والنقد التاريخي، اتجهت المقاربات الحديثة نحو توسيع دائرة المناهج، مستعينة بأدوات النقد الأدبي، والدراسات السيميائية، والأنثروبولوجيا. هذا التحوّل انعكس بشكلٍ واضح على كلٍّ من الباحثين العرب والغربيين في مقاربتهم للنصّ القرآني وعلومه، غير أنّ هذه التطوّرات لا تخلو من آفة التنميط، التي تكاد تتجلّى في معظم ما كتبه المستشرقون المعاصرون المتخصّصون في الدراسات القرآنية، كما انعكس ذلك على بعض الدارِسين العرب والمسلمين الذين تبنّوا الخطاب الاستشراقي، ومِن أبرزهم محمد أركون في قراءته الجديدة للقرآن.
ويتجلّى هذا التنميط على مستويين رئيسين؛ أوّلهما: اعتبار القرآن محكومًا بالضرورة بالسياق التاريخي والثقافي للقرنين السادس والسابع الميلاديين، بحيث لا يُنظر إليه كظاهرة مستقلّة أو فريدة. وثانيهما: المقارنة المتكرّرة بين القرآن والنصوص السابقة، سواء كانت يهودية أو مسيحية أو سريانية، باعتباره امتدادًا أو إعادة إنتاج لها.
وعلى الرغم من تفاوت الخلفيات الفكرية للمستشرقين المعاصرين، سواء كانت لاهوتية، علمانية أو إصلاحية، يظلّ الإنتاج العلمي متشابهًا في اعتماده على أدوات محدّدة، تشمل النقد التاريخي، والتحليل الأدبي، والمقارنة النصِّية. وهكذا، فإنّ التحوّل المنهجي في الاستشراق الجديد لم يُنقِذ الدراسات القرآنية من الوقوع في نوع من الانغلاق المنهجي والمعرفي، يكرّس رؤية محدودة للنصّ القرآني ويحدّ من إدراك خصوصياته الفريدة.
س6: إلى أيّ مدى يمكن اعتبار كتاب تيودور نولدكه (تاريخ القرآن) عملًا تأسيسيًّا في حقل الدراسات القرآنية الغربية الحديثة؟ ثم كيف أثّر هذا الإطار المنهجي على الأجيال اللاحقة من المستشرقين والباحثين الغربيين والعرب في حقل الدراسات القرآنية، خاصّة فيما يتصل بمسائل التوثيق، والترتيب الزمني للسور، وتحليل السياقات التاريخية للنصّ؟
د/ التجاني بولعوالي:
عندما أنهيتُ قراءة كتاب (تاريخ القرآن) بأجزائه الثلاثة لتيودور نولدكه وتلامذته، لم أجد أفضل من المثل العربي المشهور: تمخّض الجبلُ فوَلَد فأرًا. أبدأُ أوّلًا بتقديم فقرة تعريفية بهذا المشروع المبكّر في الدراسات الاستشراقية القرآنية، ثم أوضح موقفي النقدي من هذا العمل.
استغرق إنجاز هذا المؤلَّف ثمانية عقود؛ إِذْ قدّمه نولدكه أوّلًا كأطروحة دكتوراه سنة 1865، بعد أن وضع نواته عام 1860، وقد حاز به جائزة مجمع الكتابات والآداب بباريس تحت عنوان: (أصل وتركيب سور القرآن). ثم أعاد صياغته بعنوان آخر هو: (تاريخ النصّ القرآني). وقد تناول فيه قضايا نشأة النصّ القرآني وجَمْعه وروايته، إضافة إلى البحث في التسلسل التاريخي للسور مع اقتراح ترتيب مغاير للترتيب المتعارف عليه. ومع تقدّم العمر شَعر نولدكه بالعجز عن إتمام الكتاب، ففوّض تلميذه فريدريش شفالي بمراجعته. غير أنّ الأخير لم ينجز سوى مقدّمة لِما كتبه أستاذه، وانصرف إلى إعداد الجزء الثاني الخاصّ بجمع القرآن، غير أنّ وفاته في 1919 حالت دون نَشْره. فتابع أوغوست فيشر العمل وأجرى بعض التصحيحات، ثم انتقلت المهمّة إلى غوتهلف برغشترسرن الذي توفي سنة 1934 قبل إتمام الجزء الثالث، ليكمله تلميذه أوتو بريتسل سنة 1937. وهكذا خرج الكتاب إلى النور بعد مسار طويل امتد عبر ثلاثة أجيال من المستشرقين الألمان.
ويتّضح من ذلك أنّ القرآن أرهق نولدكه وتلامذته وتلامذة تلامذته؛ إِذْ تتابعوا على تأليف هذا المشروع طوال ثمانية عقود، ومات الواحد منهم تلو الآخر دون استكماله. ورغم ذلك، اعتُبر الكتاب مرجعًا أساسيًّا ورائدًا لدى المستشرقين، مع أنه لم يأتِ بجديد؛ إِذْ لم يتجاوز تجميع ما دوّنه علماء المسلمين في علوم القرآن، مع بعض الإضافات النقدية، أهمها اقتراح ترتيب جديد للسور. وسأكتفي هنا بثلاث قضايا مثيرة للجدل انتقد فيها نولدكه القرآن، رغم أن المصادر الإسلامية قد حسمتها منذ قرون.
تتمثل المسألة الأولى في تشكيكه بحقيقة القرآن؛ إِذ اعتبره نصًّا غير مكتمل، اختلط فيه الوحي بالحديث العادي والقدسي، وزعم أنّ المسلمين الأوائل لم يكونوا يميزون بدقة بين القرآن والأحاديث القدسية والأقوال العادية. أمّا الثانية فترتبط بالقصص القرآني؛ إذ ذهب إلى أنّ المواضع التي تصف الإسلام بأنه دين إبراهيم تعود للفترة المدنية، وأنّ محمدًا عندما خاب أمله في اعتراف أهل الكتاب به تشبّث بدين إبراهيم ذي المكانة الرفيعة لديهم، وأسقط الأسلوب التوراتي على القصص القرآني. في حين تكمن الثالثة في الحروف المقطعة التي سمّاها (المبهمة)، ورأى أنها ليست سوى علامات ملكية لنُسَخٍ قديمة استُخدمت في أول جمع للقرآن على يد زيد بن ثابت، فتحوّلت لاحقًا إلى جزء من النصّ بسبب الإهمال، بل وزعم أنها قد تشير إلى أسماء أشخاص، مثل: ألر للزبير، والمر للمغيرة، وطه لطلحة، وحم ون لعبد الرحمن.
وأرى أن نولدكه لو كان قد تضلّع في اللغة العربية وتعمّق في علوم القرآن، لَما وقع في مثل هذه التفسيرات التي لا تختلف عن أطروحات الاستشراق القديم ذات الطابع التبشيري. وحتى في تقسيمه التاريخي للقرآن إلى أربع مراحل، لم يقدّم جديدًا؛ فكما يشير الباحث أمجد الجنابي، فإنّ هذا التصنيف يرجع في أصله إلى أبي القاسم محمد بن حبيب النيسابوري في كتابه: (التنبيه إلى فضل علوم القرآن)، حيث صنّف مراحل النزول إلى ثلاثٍ بمكة وواحدة بالمدينة، وجاء فيه: «مِن أشرف علوم القرآن عِلْم نزوله وجهاته وترتيب ما نزل بمكة ابتداءً، ووسطًا، وانتهاءً، وترتيب ما نزل بالمدينة كذلك». وقد نقله المستشرق فايل، ثم أخذه عنه نولدكه واشتهر به دون أيّ إشارة إلى مصدره الأصل.
ومع ذلك، لا يمكن إنكار الأثر الكبير لكتاب نولدكه في الدراسات القرآنية، سواء على الاستشراق الغربي اللاحق أو على الفكر العربي المعاصر؛ فقد أسهم في تكريس النظر إلى القرآن كنصّ تاريخي قابل للدراسة النقدية على غرار النصوص الأدبية القديمة، ورسّخ فكرة نزوله في مراحل متعاقبة، ما جعل الباحثين الغربيين يتعاملون معه تعاملًا تحليليًّا ينزع عنه صفة القداسة. أمّا في الساحة العربية، فقد دفع كثيرًا من الباحثين إلى الانخراط في المناهج التاريخية النقدية، إمّا رفضًا أو استيعابًا، وأسهم بصورة غير مباشرة في تحفيز مشاريع تفسيرية حديثة تراعي البُعد التاريخي والسياقي.
س7: إلى أين وصل اليوم الاشتغال بالقرآن الكريم في الاستشراق المعاصر؟ هل ثمة نماذج معينة من المستشرقين الجدد تواصل الطريق الذي خطّه المستشرقون القدامى في الدراسات القرآنية؟
د/ التجاني بولعوالي:
يظلّ الاستشراق الجديد وفيًّا لمجموعة من المنطلقات الإبستيمولوجية والمنهجية التي أرساها المستشرقون القدامى، رغم الإضافات التي جاء بها المستشرقون المعاصرون الذين اشتغلوا بالقرآن الكريم. ويتجلّى هذا التأثر في أدوات النقد التاريخي والمقاربة الفيلولوجية التي تظلّ حاضرة في أغلب الدراسات الاستشراقية المعاصرة، غير أن هذا التأثّر تتفاوت درجاته من تيار إلى آخر ومن مستشرق إلى آخر. ولا يمكن استيعاب هذا السؤال إلا من خلال استبانة خارطة التوجّهات الغربية المعاصرة في دراسة القرآن.
ويتحدّد أوّل هذه التوجّهات في النقد التاريخي والتطوري، الذي يمثّله باحثون مثل فريد دونر وأندرو ريبين، حيث يواصلان دراسة النصّ القرآني في سياق التاريخ الإسلامي المبكِّر، محاولين فهم تطوّر النصوص الدينية والتقاليد الشفوية في جزيرة العرب. وهذه المقاربة تحافظ على جوهر المنهج التاريخي التقليدي، لكنها أكثر مرونة في تقييم المصادر والاحتمالات.
أمّا التوجّه الثاني فيتمثّل في المنهج الأدبي والهرمنيوطيقي، الذي يمثّله باحثون مثل أنجليكا نويفرت وجبريل سعيد رينولد؛ إِذْ يركّزان على النصّ القرآني باعتباره نصًّا أدبيًّا وتعبديًّا في آنٍ واحد، مع دراسة بنيته الداخلية وسياقاته الثقافية واللسانية في أواخر العصور القديمة. وتجاوزت هذه المقاربة الاكتفاء بالمقارنة الفيلولوجية مع النصوص الساميّة الأخرى.
ثم تأتي المقاربات الرقمية والاعتماد على البيانات الضخمة، كما تمثّلها المشاريع القرآنية في الغرب مثل: كوربوس كورانيكوم، والدراسات القرآنية الرقمية عن بُعد، حيث تُحلَّل نصوص القرآن بوسائل رقمية تسمح برصد أنماط التكرار، والتشابهات بين الآيات، والارتباطات مع مصادر أخرى بطريقة منهجية دقيقة.
وإلى جانب ذلك، تجدر الإشارة إلى استمرار بعض المسارات التقليدية لدى بعض المستشرقين الجدد، مثل: التحليل التاريخي والفيلولوجي عند هارالد موتسكي ومايكل كوك.
وبناء على ما سبق، يمكن القول أنّ الدراسات الاستشراقية القرآنية الجديدة تمزج بين إرث المستشرقين القدامى والمنهجيات الحديثة؛ فمِن جهةٍ هناك استمرار للمنهج التاريخي والفيلولوجي، ومن جهةٍ أخرى هناك تطويرات تقوم على الأدب المقارن، والنقد الأدبي، والتحليل الرقمي، والدراسات الثقافية.
س8: ماذا عن المشاريع الأوروبية والغربية المعاصرة الخاصة بالدراسات القرآنية، مثل الكوربس كورانيكوم والقرآن العالمي، وغير ذلك؟
د/ التجاني بولعوالي:
عادةً ما كان البحث الأكاديمي العربي يركّز على الإسهام الفردي للمستشرقين الذين اشتغلوا بالإسلام عامة وبالقرآن الكريم خاصة؛ لذلك نجد أن بعضهم، ولا سيّما مَن حظي بترجمة أعماله إلى اللغة العربية، أصبحوا مشهورين لدى الباحثين العرب، مثل: كارل بروكلمان، وجوستاف لوبون، ومكسيم رودنسون، وتيودور نولدكه، ورينهارت دوزي، وغيرهم. غير أنّ الاستشراق الجديد لم يَعُد يعتمد فقط على الإسهامات الفردية، بل ظهرت مراكز متخصّصة وأُطلقت مشاريع أوروبية وغربية في الدراسات القرآنية تضم عشرات الباحثين، وتمثّل اتجاهًا بحثيًّا متطورًا يجمع بين النقد التاريخي والتحليل الأدبي والثقافي، وغالبًا ما يوظف أدوات رقمية ومقاربات متعدّدة التخصصات.
ومن أبرز هذه المشاريع Corpus Coranicum، الذي أطلقته أكاديمية برلين-براندنبورغ للعلوم تحت إشراف المستشرقة الألمانية أنجليكا نويفرت. يهدف المشروع إلى دراسة النصّ القرآني في سياقه التاريخي والأدبي ضمن فضاء الشرق الأدنى في أواخر العصور القديمة، وربطه بالمصادر اليهودية والمسيحية والنصوص الساميّة الأخرى. كما يسعى إلى تقديم إصدار نقدي رقمي متكامل للقرآن، مرفق بالهوامش والشروحات التاريخية. وتعتمد منهجيته على التحليل التاريخي واللغوي والنصِّي والرقمي، مع تركيز خاصّ على النقد النصِّي والمقارنة بين المصادر. وقد أثمر المشروع عن قاعدة بيانات علمية شاملة تجمع بين النصّ القرآني والمخطوطات المبكّرة، بما يتيح تتبّع التأثيرات الثقافية والدينية في تشكّل النصّ.
أمّا مشروع IQSA – International Qur’anic Studies Association (القرآن العالمي)، الذي تأسّس سنة 2012، فيمثل إطارًا دوليًّا يجمع باحثين مسلمين وغربيين متخصِّصين في الدراسات القرآنية. يهدف المشروع إلى تعزيز الطابع التعدّدي والمقارن في دراسة القرآن، وتطوير أُطر علمية جديدة لفهمه من منظور تاريخي وأدبي وثقافي. كما ينشر أبحاثًا متخصصة عبر مجلّته العلمية JIQSA، معتمدًا على الدمج بين النقد التاريخي، الأدب المقارن، الدراسات اللغوية والرقمية، فضلًا عن تحليل النصوص في سياقاتها الثقافية المتنوعة.
وإلى جانب هذين المشروعَيْن، هناك مبادرات أخرى بارزة، مثل: Bibliotheca Coranica في فرنسا، التي تسعى إلى تجميع الدراسات القرآنية القديمة والحديثة وربطها في منصة رقمية، وكذلك سلسلة Qur’anic Studies Series الصادرة عن دار أكسفورد للنشر، والتي تغطي مختلف مجالات النقد التاريخي والتحليل الأدبي للقرآن. ومشروع القرآن الأوروبي EuQu، الذي اشتغل بالكتاب المقدّس الإسلامي في الثقافة والدِّين الأوروبيين ما بين 1150 و1850، وهو عبارة عن سلسلة كتب محكمة. ويُحلل القرآن الأوروبي الدور المهمّ الذي أدّاه القرآن في تشكيل التنوّع والهوية الدينية الأوروبية في العصور الوسطى وبدايات العصر الحديث، وهو دور متأصّل بعمق في الفكر السياسي والديني لأوروبا، وجزء من التراث الفكري.
ويضاف إلى ذلك مشروع GloQur، المموَّل من قِبَل مجلس البحوث الأوروبي (ERC) وتحتضنه جامعة فرايبورغ في ألمانيا بإشراف المستشرقة جوهانا بينك. ويهتمّ هذا المشروع بترجمات القرآن الكريم باعتبارها وسيلة مركزية لفهم المسلمين لدينهم في العصر الحديث. ويركز على الأبعاد التاريخية والتفسيرية والاجتماعية والسياسية للترجمة، وظروف إنتاجها واستخدامها محليًّا وعالميًّا. كما يدرس دور المؤسّسات الرسمية والحركات العابرة للحدود، وتأثير اللغات الأوروبية والإسلامية الكبرى، ويسعى لرسم خريطة للتفاعل بين التراث التفسيري القرآني والبيئات اللغوية المتنوعة في ظلّ العولمة والوسائط الجديدة. وقد سبق لي أن شاركتُ فيه العام الماضي (2024) بمحاضرة حول الترجمات الهولندية المبكّرة للقرآن الكريم في القرن السابع عشر.
ورغم ما يُوجَّه إلى هذه المشاريع القرآنية العالمية مِن نقد، لا يمكن إغفال جوانبها الإيجابية؛ فهي تنطبع في مجملها بسمات مشتركة، أبرزها التعامل مع القرآن باعتباره نصًّا متعدّد الأبعاد؛ تاريخيًّا، لغويًّا، أدبيًّا، ثقافيًّا ودينيًّا. كما تعتمد على المنهجيات الرقمية وقواعد البيانات الضخمة لفهم النصوص، وتمزج بين البحث الغربي التقليدي القائم على الفيلولوجيا والنقد التاريخي وبين المناهج الحديثة في الدراسات الأدبية والاجتماعية والثقافية. وإلى جانب ذلك، تعزّز هذه المشاريع التعاون العلمي بين الباحثين المسلمين والغربيين، بما يفتح آفاقًا جديدة لتجاوُز التحيّزات الثقافية والمنهجية في مقاربة القرآن وعلومه. بالإضافة إلى حِفْظ المخطوطات القرآنية، وترجمته إلى لغات العالم، والارتقاء بالخطاب القرآني إلى المستوى الكوني.
[1] يمكن مطالعة الجزء السابق على هذا الرابط: tafsir.net/interview/42.


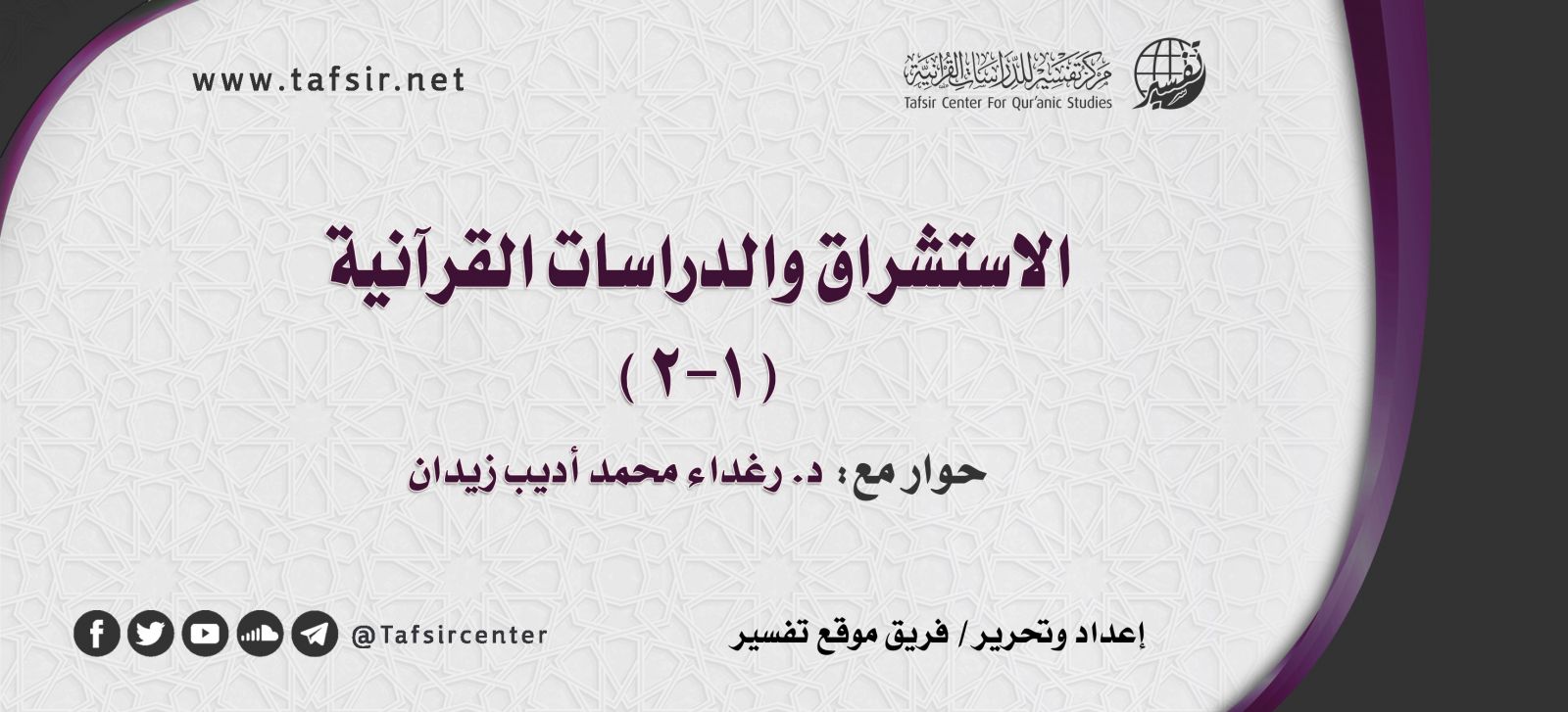 الاستشراق والدراسات القرآنية (1-2)
الاستشراق والدراسات القرآنية (1-2)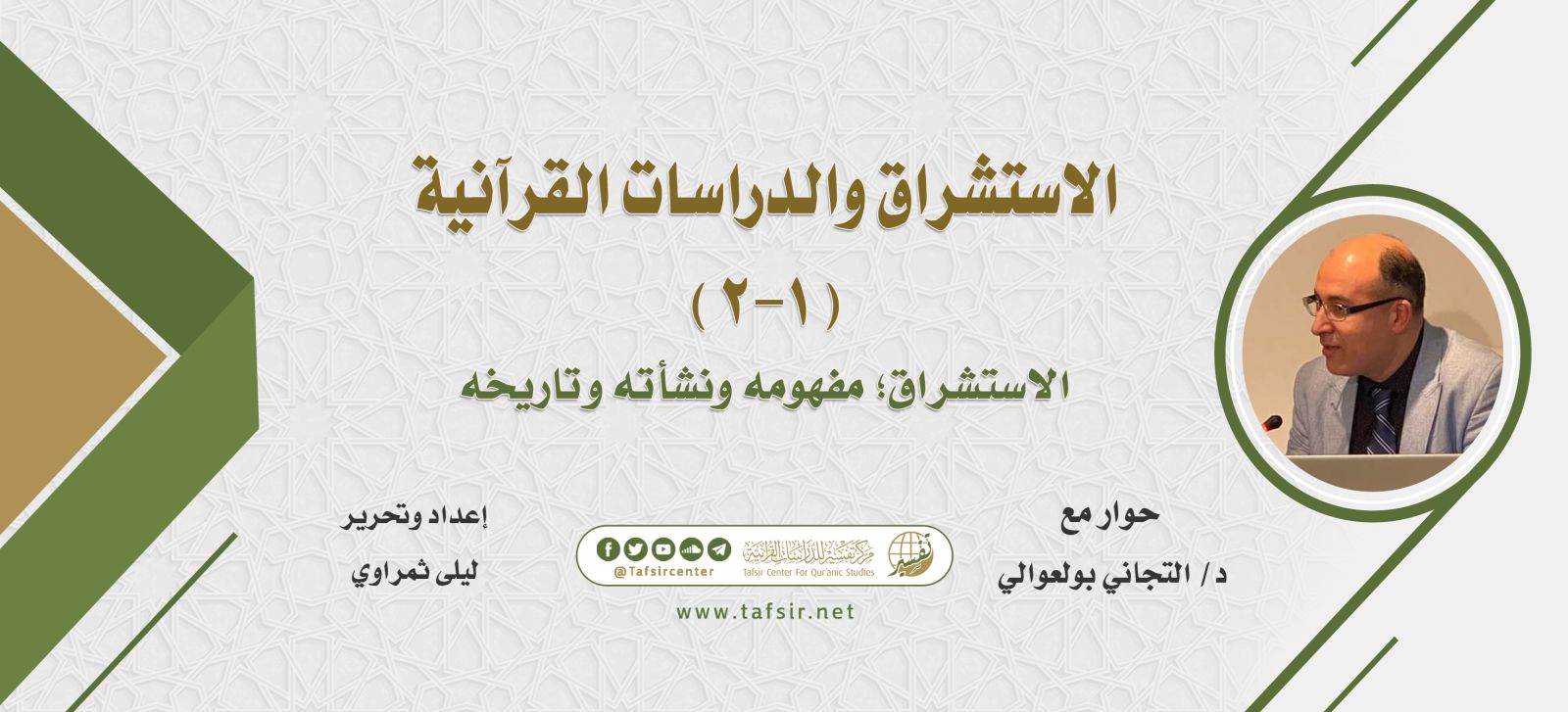 الاستشراق والدراسات القرآنية (1- 2) الاستشراق؛ مفهومه ونشأته وتاريخه
الاستشراق والدراسات القرآنية (1- 2) الاستشراق؛ مفهومه ونشأته وتاريخه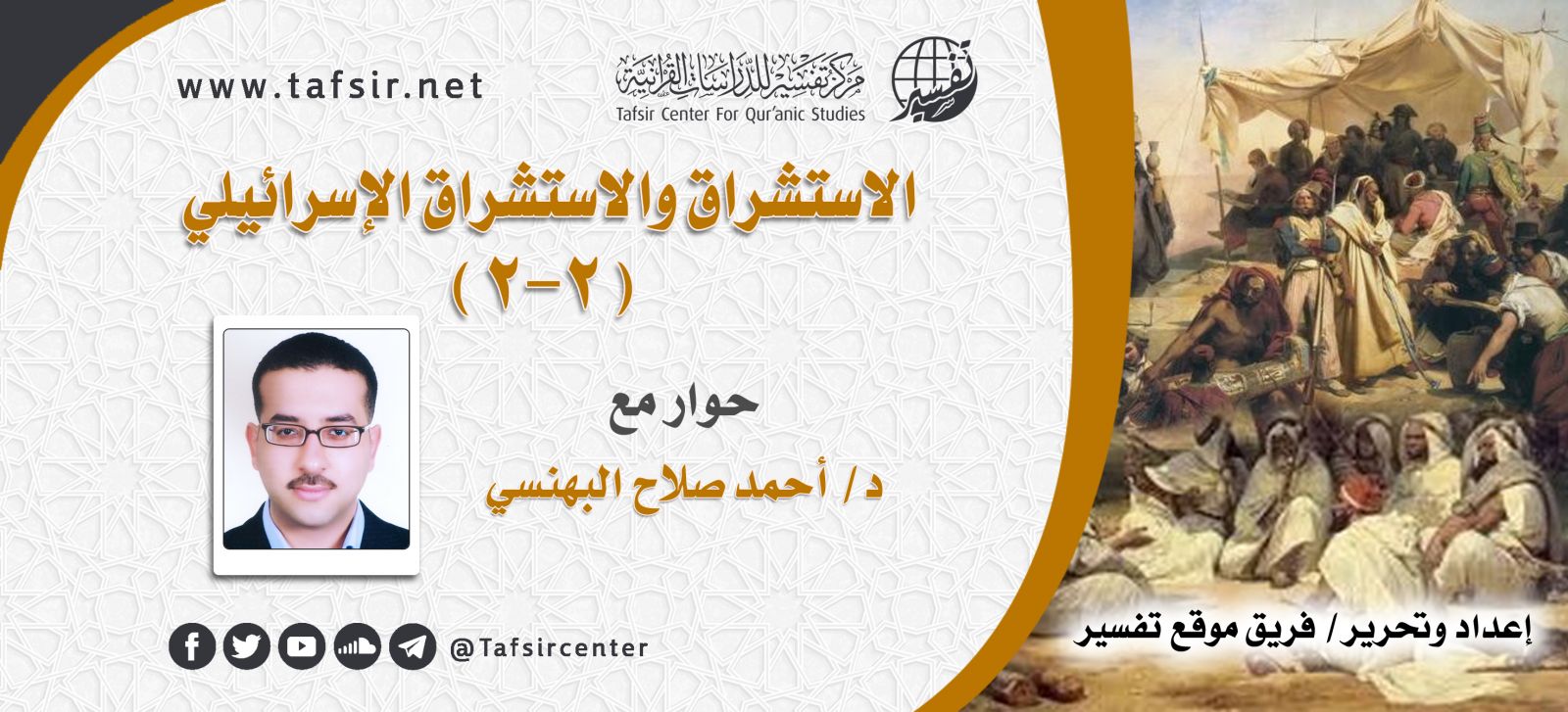 الاستشراق والاستشراق الإسرائيلي (2-2)
الاستشراق والاستشراق الإسرائيلي (2-2)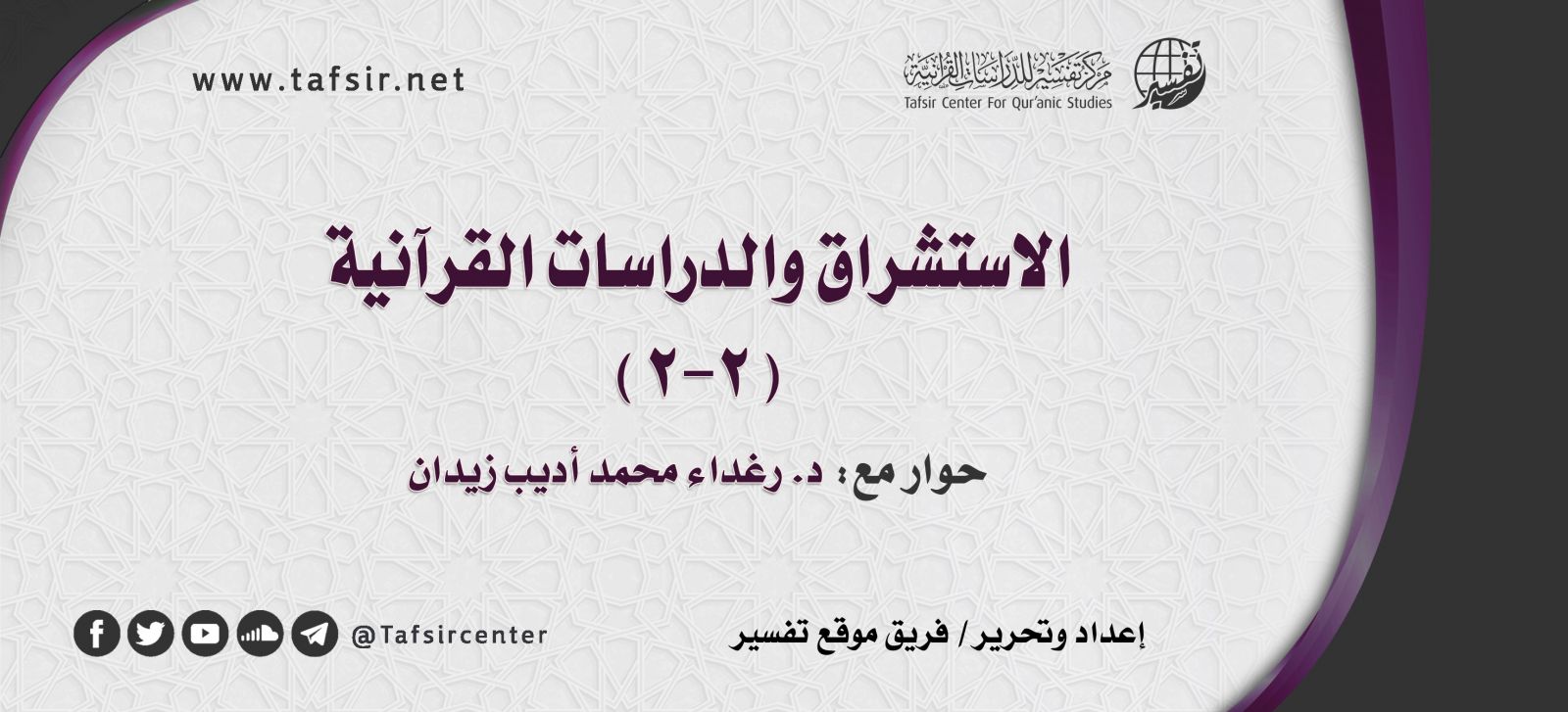 الاستشراق والدراسات القرآنية (2-2)
الاستشراق والدراسات القرآنية (2-2)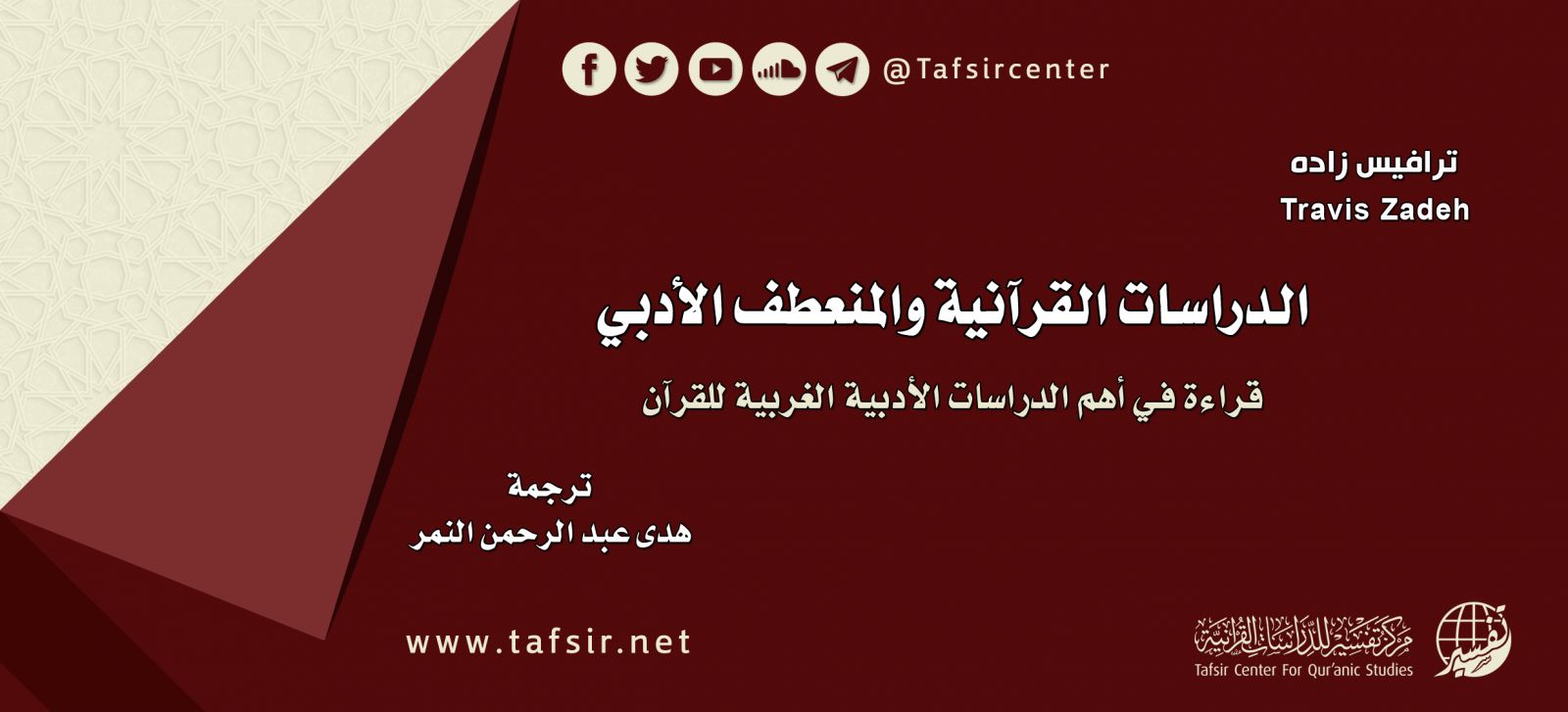 الدراسات القرآنية والمنعطف الأدبي؛ قراءة في أهم الدراسات الأدبية الغربية للقرآن
الدراسات القرآنية والمنعطف الأدبي؛ قراءة في أهم الدراسات الأدبية الغربية للقرآن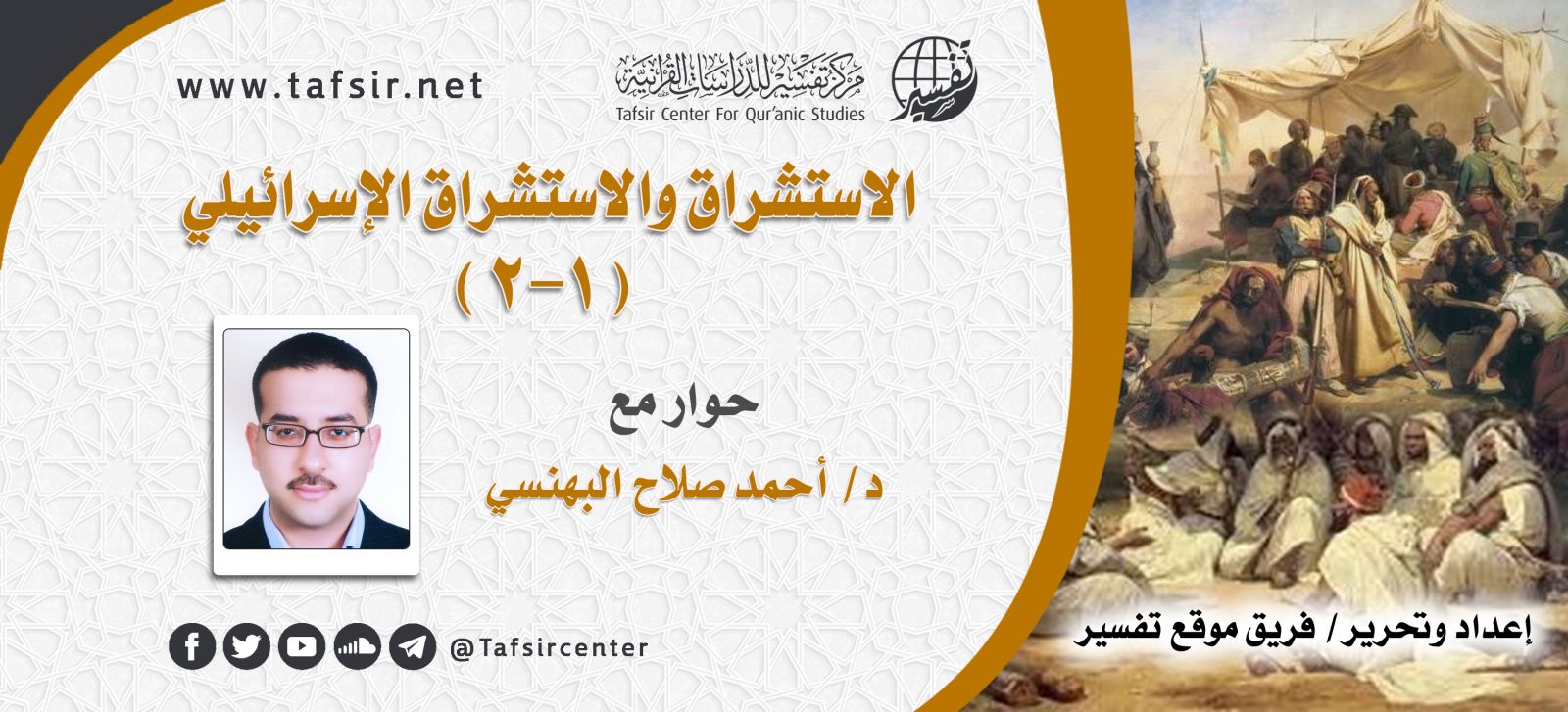 الاستشراق والاستشراق الإسرائيلي (1-2)
الاستشراق والاستشراق الإسرائيلي (1-2)