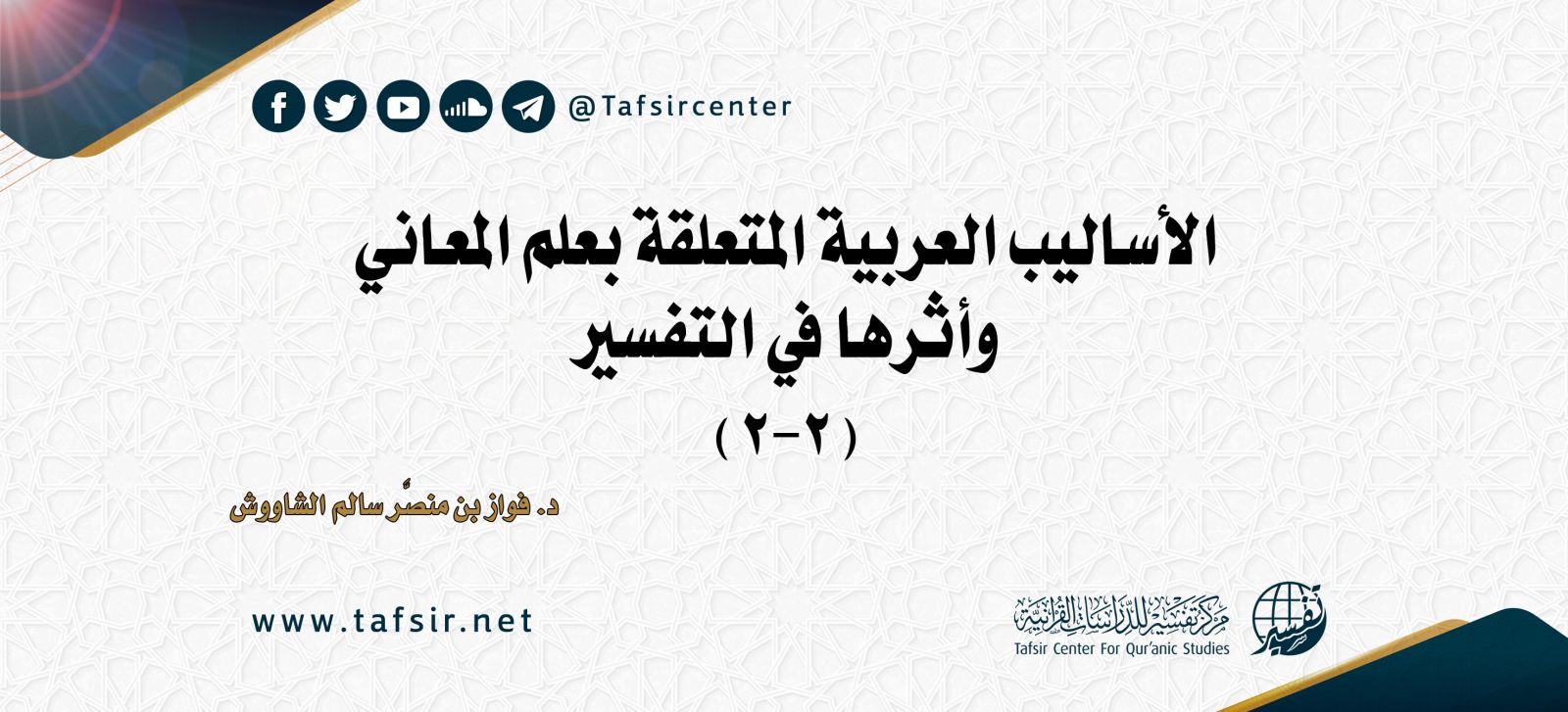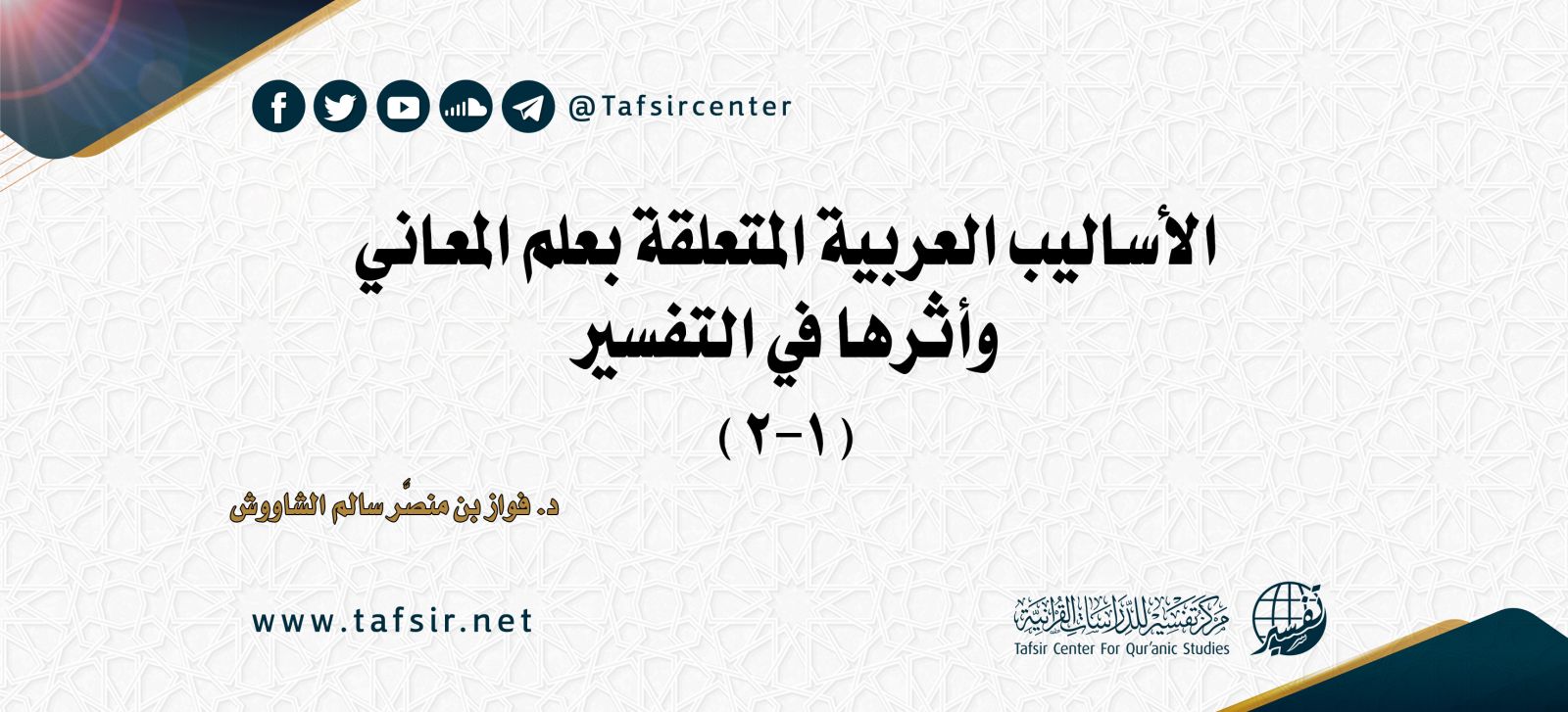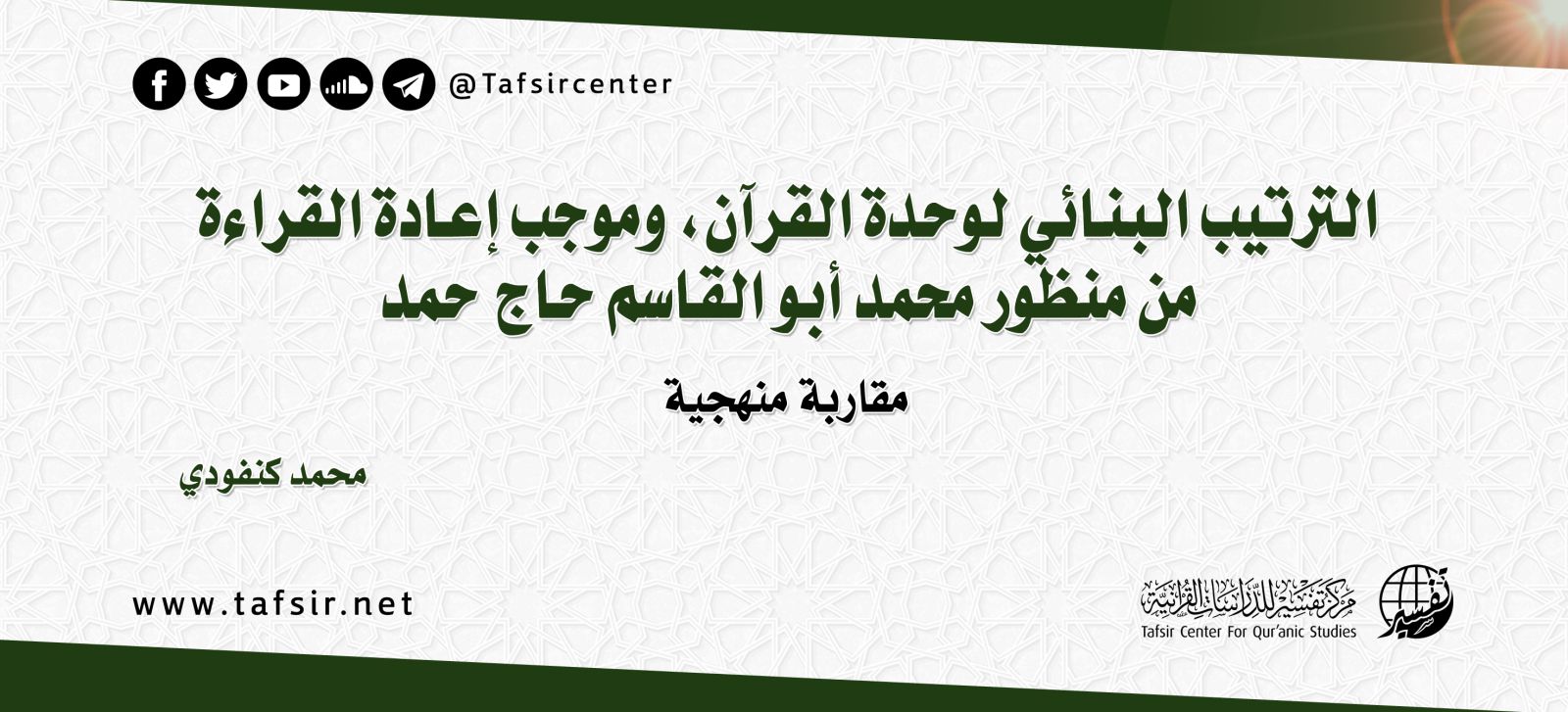مقاربة في ضبط معاقد التفسير
مقاربة في ضبط معاقد التفسير
الكاتب: خليل محمود اليماني

للعلوم فترات قوّة وضعف وأطوار حركة وركود، وهي تصاب بالترهُّل وتعتريها إشكالات ومآزق معرفية لأسباب متعدّدة تعوّق نموّها وتقعُد بها عن دركِ أهدافها وبلوغ غاياتها، كما تتعرّض لانسداد آفاقها المعرفية فتصاب بالتكلُّس والتأزّم وفقدان الحيوية...إلخ؛ ومن ثم كان من السنن الماضية في شأن العلوم دوامُ حاجتها للتجديد، وإعادة النظر في شأنها، وتقييم مسيرتها ومساراتها، وإعمال معاول الهدم والبناء في ساحاتها؛ كي تتكامل مسيرة العلوم ويتتابع نموّها وتتمكّن من تحقيق غاياتها.
وإنّ علم التفسير ربما من أولى العلوم الإسلامية التي تحتاج لمثل هذا الصنيع؛ لكثرة الإشكالات المركزية الكامنة فيه والتي تمسّ جوهره ومرتكزاته: كعدم انضباط حيثيّته ومفهومه، وقلّة الجهود الرامية لوضع تصورات تكفل حلّ ضبط مرتكزاته ومعاقده بصورة متكاملة منذ قديم ما سمح بتفاقم العديد من الإشكالات بصورة واسعة في ساحة هذا الفنّ كما سنبيّن.
وفي ضوء اشتغالي المطوّل بهذا الفنّ -وبنائه النظري- وتأملي لإشكالاته ومسالك التعامل معها، فإنني سأحاول أن أقدّم في هذه المقالة طرحًا يُعِين على ضبط المرتكزات الرئيسة لفنّ التفسير، ويعالج بعض الإشكالات المهمّة الناجمة عن عدم انضباط هذه المرتكزات، وهو ما نستهلّه أولًا بإطلالة على الإشكالات المركزية في ساحة هذا العلم، وفيما يأتي بيان ذلك:
لا شك أن تحرير إشكالات العلم له أثرٌ مهمٌّ في حُسْن التعاطي مع معالجة هذه الإشكالات ورسم المسارات البحثية اللازمة للنهوض بذلك، وسوف يأتي كلامنا في هذا الموضوع مقسمًا إلى قسمين؛ أحدهما لعرض هذه الإشكالات من وجهة نظرنا، والآخر مناقشة لبعض الدراسات التي عُنيت بهذا الجانب وتقييم لحصادها.
أولًا: إشكالات علم التفسير؛ ضبط وتحرير:
يعاني علم التفسير من إشكالات مركزية فيما يتصل به من حيث هو فنّ؛ أبرزها بنظرنا اثنان[1]:
الإشكال الأول: عدم انضباط حيثيّة التفسير:
لعلّ من المألوف في سير العلوم هو اختصاصها بحيثيّات محدّدة يكتسب بها كلّ فنّ تمايزه عن غيره؛ مادة وموضوعًا ومسائل؛ إِذْ هذه الأمور يجري تفريعها وتشقيق الكلام فيها في ضوء حيثيّة المجال ذاته لا غير. كما أن مفاهيم العلوم تتشكّل في ضوء هذه الحيثيّة وتعبر عنها؛ ولذا كان مفهوم العلم معبرًا عن حيثيّة هذا العلم ودالًّا على خصوص اشتغاله.
وإذا كان مفهوم العلم يكتنز الحيثيّة، فإن اصطلاح العلم يكتنز المفهوم؛ فمفهوم العلم يتخلّق أولًا في ضوء المشغل المعرفي والحيثيّة القائمة للمجال، ثم تأتي مرحلة الوضع الاصطلاحي في حياة العلم والتي يوضع فيها للعلم اصطلاح خاصّ يترجم صورة مفهومه ويعبر عنه؛ فعلاقة الاصطلاحات بمفاهيمها ليست اعتباطية كما الحال في الكلمات وما تدلّ عليه، وإنما تكون هناك صلات مخصوصة بينها وبين المفاهيم التي تعبر عنها، وهذه الصلات يسهل لحظها في ضوء تأمّل صورة المفهوم التي يحملها اصطلاح العلم.
وإذا كانت هذه الأمور من البديهيات في نسقِ تشكُّل الفنون، فإنّ الناظر في علم التفسير يجد أنه يفتقد بصورة شديدة الظهور لحضور مثل هذا النسق في ساحته؛ فقد وُلِدَ علم التفسير وانطلق وتمدّد واقعه التطبيقي واتّسع وكثرت فيه التآليف، وفاضت في رحابه التصانيف، وإنّ الناظر في منتوجه لا يكاد يظفر بحيثيّة محرّرة ومنضبطة للمجال يجري تعاطي الكَتَبة في المجال في ضوئها ويحصل بينهم التتابع في خدمتها من مناحٍ متعددة بحسب طبيعة مشاغلهم المعرفية كما الحال في مختلف الفنون، وإنما يغلب على الناظر لحظ درجة بالغة التفاوت والتباين بين أرباب الفنّ لحيثية التفسير. وهذا الأمر يدلّ عليه دلالة واضحة جملة أمور؛ أهمها:
أولًا: مادة التفسير في المؤلفات وتباينها:
إنّ مادة العلم هي الثمرة الحقيقة للعلم والمترجمة لمحصوله والمبينة لاشتغاله، فيمكن للمرء من خلال نظره في هذه المادة أن يستشرف بيُسْر حيثية المجال وغاياته وطبيعة الأهداف التي يسعى إليها، وإن التفسير يقوم على بيان النصّ القرآني، إلا أن الناظر في مادة هذا التفسير في المؤلفات يجدها بالغة التباين وواسعة الاختلاف[2].
إننا وفي ضوء ظهور حيثيات المجالات العلمية، نلحظ أنّ المشتغلين بها تكون لهم غايات محدّدة وملامح اشتغال بينها اختلاف وتباين ولكن تجمعها دائرة واحدة هي الدائرة التي تمثّلها حيثية المجال ذاته؛ فالفقه مثلًا يهتم باستخراج الأحكام من النصوص والأدلة الشرعية، وبداخل هذا المشغل المعرفي قد تتنوّع مشاغل الفقهاء في الممارسة الفقهية ذاتها، فقد يغلب على بعضهم إنتاج المعرفة الفقهية ذاتها واستخراج الأحكام واستنباطها، وقد يهتم بعضهم بالترجيح والموازنة أو يهتم بجمع الأقوال وتصنيفها، أو ينشغل بالتقعيد والتأصيل... إلى آخر تلك المشاغل التي مهما اختلفَتْ وتنوّعت إلا أنها تظلّ ظاهرة الصلة بالأحكام الشرعية، والتي هي ثمرة المجال وحصاده الذي يمثّل مادته، وكذلك ظاهرة الصلة بالمشغل المعرفي الضابط للمجال، ولكننا متى يمّمْنا وجوهنا صوب التفسير وجدنا الأمر على خلاف ذلك؛ فالتفسير تتباين فيه طبيعة الدائرة الحاكمة لنسق الاشتغال التفسيري ذاته ولا يجمعها جامع كما يظهر جليًّا مِن تأمُّلِ مادة التفسير في التصانيف التفسيرية؛ فهناك مفسِّر تدور مادته التفسيرية في فلَك المعاني وتقريرها، وهناك مفسِّر آخر تَبْرُز في مادته العناية ببيان المقاصد العامة للنصّ في التشريع ومنهجه إزاء شؤون الحياة والمجتمع، وثالثٌ تظهر في مادته العناية بالجانب الوعظي الهدائي، ورابعٌ يغلب عليه البحث في استخراج الأحكام وتحريرها... إلى آخر تلك الصور من المادة، والتي يظهر بينها التضاد والاختلاف وعدم وجود حيثية محدّدة يتم تناول النصّ القرآني من خلالها ويتتابع المفسرون على الكلام فيها، وإنما هي جملة أمور بالغة السّعة وتتضمن عددًا من الحيثيات المتضاربة، كما يظهر فيها وقوع التداخل مع حيثيات فنون أخرى في ساحة التفسير، لا سيّما ما يتعلق ببحث الأحكام الشرعية وما يتصل بذلك من تقريرات والذي هو مشغل معرفي لفنون أخرى.
ثانيًا: تباين مفهوم التفسير:
الناظر في تعريفات التفسير يلحظ بجلاء أن هذا المصطلح يكتنف مفهومَه خلافٌ ظاهر بين قاصرٍ لهذا المفهوم على تبيين المعاني وكشفها كما نجده خاصّة عند الكافيجي[3] والدكتور مساعد الطيار[4]، وبين موسعٍ له ليشمل أمورًا أخرى كسردِ الحِكَم واستخراج الأحكام...إلخ، كما نجده عند أبي حيان[5] والزركشي[6] ومحمد عبده[7]وابن عاشور[8].
وبغضّ النظر عن معيارية تعريفات التفسير وكيفيات وضعها، ومدى انضباط محاكمة التراث التفسيري من خلالها[9]، إلا أنّ هذا الاختلاف بين المعرِّفين يدلّ بشكلٍ أو بآخر على وجودِ قدرٍ من التباين في تصوّر مفهوم العلم وحدوده، وهو ما يؤشّر بقدرٍ بيِّنٍ كذلك على اختلاف حيثيّة التفسير ذاتها وخصوصية المساحة التي يُنظر فيها للنصّ وما يراد تحديدًا من وراء الاشتغال التفسيري.
ومما يلحق بهذا الإشكال أنّ التفسير ليس له اصطلاح محدّد بين الكَتَبة، فهناك من يستعمل (التفسير) عَلَمًا على المجال، وهو الغالب، وهناك من يذكر (التأويل)، وهو أمر -بغضّ النظر عن دلالته على اختلاف مفهوم العلم من عدمه- يَشِي بعدم استقرارِ العلم بصورة عامة وتبلورِ اصطلاحٍ محدّدٍ يترجِم صورة مفهومه ترجمة محرّرة كما هو الشأن في العلوم.
ومكمن الإشكال أن التفسير (المختلف في حيثيته) تمدّد الواقع البحثي في ساحته بصورة واسعة، وقامت فيه جهود نظرية ومسارات بحثية وفقًا لحيثيات مختلفة.
ولا شك أن هذا الأمر شديد الخطر في الفنّ متى تأمّلنا لوازمه المنهجية؛ فتبعًا لأيّ حيثية يمكننا تصوّر مادة العلم وفهم نسق التعامل مع موارده وجِهات استمداده، وتبعًا لأيّ حيثية سيتم تصوّر مفهوم التفسير تبعًا لها ساعة الحديث عن هذا التفسير أو التأريخ له أو التقعيد النظري لممارسته أو محاولة تجديده، وما معايير الترجيح والاختيار وأسباب اختصاص أحد هذه الحيثيات بالتفسير دون سواها؟
الإشكال الثاني: عدم انضباط طبيعة المعنى التفسيري:
من الإشكالات الرئيسة في ميدان التفسير هو ما نجده من خلافٍ في مفهوم المعنى التفسيري ذاته؛ فلدينا في ممارسة التبيين التي تدور حول المعنى خاصة عدّةُ مفاهيم كذلك؛ فهناك التبيين السياقي واللغوي والإشاري، وهو ما يظهره جليًّا تقسيم ابن القيم للتفسير، حيث قال:
«وتفسير الناس يدور على ثلاثة أصول:
- تفسير على اللفظ، وهو الذي ينحو إليه المتأخرون.
- وتفسير على المعنى، وهو الذي يذكره السلف.
- وتفسير على الإشارة والقياس، وهو الذي ينحو إليه كثير من الصوفية وغيرهم»[10].
وإذا ما جاوزنا مسلك الإشارة؛ كونه ليس تفسيرًا يبيّن المراد أصالة من الكلام قولًا واحدًا، فإنّ الناظر يلحظ تباينًا ظاهرًا في مفهوم المعنى التفسيري ذاته وطبيعته؛ فالتبيين اللغوي (التفسير على اللفظ) يميل للتركيز على دلالات الألفاظ وإنتاج معطى للمعنى يدور في هذا الفلَك، وأمّا التبيين السياقي (التفسير على المعنى) فلا يكون بيانًا لمجرد الدلالات اللغوية للألفاظ، وإنما لمجموع الألفاظ وانتظامها معًا، أي: ذكر المراد السياقي المتحصّل من مجموع الكلام ككلّ.
وإنّ وقوع الخلاف في المعنى التفسيري بهذه الصورة يمثّل إشكالًا ظاهرًا له تداعياته الكثيرة على تصوّر المعنى والذي هو ثمرة التفسير ومحصلته الرئيسة، وكيفيات النظر لهذا المعنى والشروط اللازمة لممارسته؛ إذ لا بدّ من الاستقرار في تصوّر ثمرة العلم بوضوح لضبط النظر لشروطها وعدّتها اللازمة لتحصيلها...إلخ مما يجعل العلم ينطلق انطلاقة صحيحة، وهو غير حاصل في فنّ التفسير.
الإشكال الثالث: عدم انضباط مفهوم المفسّر وأدوات التفسير:
في ضوء عدم انضباط حيثية التفسير فمن المتوقع جدًّا أن يكون لهذا انعكاس ظاهر على مفهوم المفسّر وأدوات المفسّر؛ فمفهوم المفسّر وطبيعة الدور المحدّد الذي يقوم به في التفسير من المتوقّع أن يعتريه قدر من الضبابية في ضوء عدم وجود حيثية محدّدة للفنّ تمثّل إطارًا حاكمًا لتناول ومعالجة النظار فيه، فهل يجب على المفسّر أن يرتبط عمله بدائرة المعنى وما يتعلّق بذلك من صور الاشتغال المتنوّعة، أم أنه يجب مثلًا أن يتخطى ذلك ليهتم بذِكْر المواعظ والهدايات الإيمانية التي تُعين على كيفية الحياة بالنصّ القرآني، وكذلك هل المفسّر مطالب مثلًا بأن يهتم باستخراج الأحكام واستنباطها وما يتعلق بذلك؟ وأيضًا هل يندرج في عمل المفسّر بحث مقاصد التشريع في النصّ، وإبراز وجهة القرآن ومنهجه إزاء القضايا التي يعالج بها مشكلات الحياة المتنوعة؟ وغير ذلك من الأمور التي نراها في واقع مدونة التفسير ومصنفاته.
وذات الأمر يتعلّق بأدوات التفسير؛ ففي ضوء عدم انضباط حيثية التفسير صارت أدوات التفسير غير محرّرة؛ فلكلّ اشتغال ومهمّة مما سلف ذكره طرائق اشتغال معيّنة وأدوات خاصّة ربما تتباين بصورة كبيرة جدًّا مع غيرها.
ولا شك أن ضبابية المهمّة المطلوبة من المفسّر وكذا أدوات التفسير تعوق بصورة ظاهرة تحويل التفسير لصناعة محدّدة الملامح ولها نسق تحصيل معرفي يمهّد إليها، وإنما يكون التفسير معها ساحة واسعة ليس لها جهات استمداد محدّدة ويحتاج من يلج هذه الساحة إلى معارف متنوعة لا حدود لها ولا أدوات ضابطة لممارستها، وهو أمر ظاهر الإشكال في نسق الفنون على صُعُد مختلفة.
إننا، وفي ضوء ما سبق، يظهر معنا عميق إشكالات علم التفسير، وأنه يتعذّر تصوّر معاقده الرئيسة من حيث هو مجال له حيثية ومفهوم ومعطى محدّد الملامح من وراء ممارسته وللمشتغل به دور محدّد، كما أن لممارسته جملة أدوات معيّنة، وهو الأمر الذي يؤثّر بصورة رئيسة على معاقد أخرى مركزية في ساحة الفنّ، لا سيّما تصور البناء النظري للتفسير والعمل على تأصيل معيّن باعتباره ضابطًا للممارسة التفسيرية، خاصّة ونحن أمام ممارسات عديدة وصور متنوّعة ومختلفة للتفسير، وكيفية التعامل مع التراث التفسيري وهو بهذا الشكل، وما محددات هذا التعامل وطبيعة الأحكام التي سنسقطها عليه في ضوء اختيار دلالة محددة،...إلى آخر ذلك من الإشكالات.
ثانيًا: الدراسات التي عُنيت بإشكالات التفسير؛ نظرات نقدية:
هناك بعض الدراسات والدارسين الذين اشتبكوا مع إشكالات التفسير وحاولوا التصدي لها، وفيما يأتي نعرض بصورة مجملة لهذه الجهود والموقف المنهجي من محصولها في التعاطي مع هذه الإشكالات:
أولًا: بحث «تفاوت مفهوم التفسير؛ الدلائل والآثار ومنهج التعامل»، للدكتور الفاضل/ محمد صالح سليمان[11]، وهو بحث تصدَّى لمناقشة حالة الاختلاف في مفهوم التفسير، وطَرح انعكاسات لحالة الاختلاف في التفسير يقلّ الانتباه إليها، وشدّد على ضرورة مراعاتها في مناحٍ بحثية مهمّة؛ كبحث مفاهيم المفسرين ودراسة مناهجهم...إلخ. وهذا أمر بالغ الأهمية في ضوء وجود حالة التفاوت في الفنّ، ويفضي لانعكاسات سلبية كثيرة حال تم تجاوزه. ويلاحظ على هذا البحث أنه لم يضع حلولًا كلية لمعالجة إشكالية اختلاف التفسير، بل تماهَى مع حالة الاختلاف بصورة زادتها إشكالًا؛ فالبحث انتهى في ضوء واقع اختلاف مادة التفاسير وتعريفات التفسير إلى نفي وجود القدر المشترك في المفهوم -والمتمثّل في بيان المعنى- وأنه لا يمثّل إطارًا ضابطًا لعمل المفسرين؛ بحجّة أن اتفاقهم في القدر المشترك لم يمنع اختلافهم في اندراج القدر الزائد عنه في مفهوم التفسير أو عدم اندراجه؛ ومن ثم صار التفسير وكأنه بلا أيّ ملامح واضحة، وهو أمر غير مسلّم؛ خاصّة وأن اختلاف التعريفات لا يفضي لنفي القدر المشترك كما يصوّر البحث، فضلًا عن صعوبة مناقشة الواقع التطبيقي للتفسير من خلال تحكيم تعريفات معيّنة ربما تكون معيارية الكثير منها في التعبير عن واقع التفسير محلّ نقد وتشكيك، وأيضًا قد يُعترض بقوة على دعوى انفكاك سائر مادة الكثير من التفاسير عن خدمة المعنى وتقريره، فحتى مع اعتبار أن بعض المادة قد يقع فيه الزيادة عن المعنى في بعض التصانيف كما هو مقرّر، إلا أن اعتبار مادة التفاسير مع ذلك كما لو كانت زيادات تؤسّس لمفاهيم مختلفة كلية يظلّ أمرًا ظاهر الإشكال، ولا يدلّ عليه النظر في واقع التفاسير، كما أنّنا حتى مع القول بوجود بعض التفاسير التي قد يظهر فيها النحو لتأسيس مفهوم جديد -وهو ما لا ننكره-، فإن ذلك لا يقارن بالتآليف الأخرى للتفسير من حيث عدد الحضور، وبالتالي فلا نعدّه مثار تشغيب بيِّن على وجود نواة لملامح مركزية للعلم متمثلة في المعنى التفسيري، وظهور هذه النواة في الامتداد التطبيقي في المسار العام لمادة التفاسير وفي العديد من مصنفاته.
ووقوع هذا الإشكال في البحث سببه بنظري الانطلاق في مدخل النظر لإشكال حالة الاختلاف في التفسير من تفاوت المفهوم وليس من تفاوت حيثية التفسير؛ فإثبات الثانية أقطع للجدل في عدم انضباط حدود العلم وأدعى في ذات الوقت لطرح مقاربة تفضي لحلّ إشكالات العلم والفصل في حالة الاختلاف الحاصلة فيه وبيان صحيحها من ضعيفها؛ لأن العلم لا بدّ له من حيثية ضابطة، وهو المسار الذي سلكناه في هذه المقاربة، وأمّا إثبات الأول فلا يدلّ بصورة قاطعة على حالة الاختلاف الحدِّي في واقع العلم نفسه وأنه بلا ملامح واضحة، كما أنه -حتى مع التسليم به- فإنه يدفع للتماهِي -كما وقع في البحث- مع حالة الاختلاف في التفسير، واعتبار الرفض لأيّ دلالة معينة وأنها خارجة عن حدّ التفسير هو مصادرة على الواقع التاريخي للعلم وأنه بلا أيّـة ملامح ضابطة، كما يدفع لأن يكون واقع التفاوت والاختلاف في الفنّ هو الحاكم على الفنّ ذاته وليس العكس، وهو أمر ظاهر الغلط ويتعارض مع نسقية الفنون في ذاتها، ويزيد من بقاء حالة الاختلاف في ساحة التفسير، ويجعل دائرتها تنداح دون أن تنتهي عند حدّ، ولا يدفع في اتجاه مجاوزة هذه الحالة وحلّها بصورة جذرية.
ثانيًا: يُعَدّ الدكتور/ مساعد الطيار من أبرز المعاصرين إثارة لقضية مفهوم التفسير؛ حيث ناقش تعريفات التفسير، ورجّح تقييدها ببيان المعاني دون ما وراء ذلك، وأفرد لذلك تأصيلًا ظاهرًا في بعض تآليفه[12]، ويلاحظ بخصوص هذا الصدد ما يأتي:
- التأسيس النظري عند الدكتور مساعد لبناء المفهوم واختياره -وكذا من تكلموا في هذه القضية بعده[13]- يرتكز على أن بناء المعنى قدر مشترك بين تعريفات التفسير، وأنه الأساس الذي يُبنى عليه غيره من الأمور الأخرى التي تذكر في هذه التعريفات من استخراج الأحكام والحكم وغيرها، وهو تأصيل لا يعين على حلّ إشكال مفهوم التفسير بصورة محرّرة؛ لأنه لا ينطلق من معايير لمحاكمة المفاهيم المطروحة، وإنما هو مجرد اختيار له ما يسوّغه لكنه لا يمنع غيره.
وسبب ذلك فيما يبدو هو عدم النظر في حيثية المجال وتحريرها، فالمفهوم يكتنز الحيثية كما أسلفنا، إلا أننا حال اختلفنا في مفهوم العلم -كما الحال في التفسير- فالنظر لحيثية المجال يكون ضرورة في البتّ في المفاهيم وبيان أَولاها بتمثيل العلم، وأمّا إهمال ذلك ومحاولة طرح مقاربة للحلّ من خلال المفاهيم المختلفة وأنّ أحدها يمثّل دائرة الصُّلْب في معلومات التفسير وبقيتها تَبَع؛ فإنه وإن أبرز أهمية لجانب المعنى عمّا فوقه في ساحة التفسير إلا أنه غير قاطع في تخصيص التفسير ذاته بهذا الصُّلْب دون ما وراءه ويبقى معه الجدل المفهومي قائمًا ومستمرًّا[14].
- إشكال المعنى التفسيري لم يحظَ بالمناقشة في طرح الدكتور مساعد، رغم شدّة مركزيته في ضبط النظر للتفسير ودلالته، وكذلك انصبّ طرحه في مفهوم التفسير على مجرد اختيار دلالة معينة دون التعرّض لتأمُّل نسقِ الفنّ بتكامليته وفق المفهوم المرجح في التفسير وطرح قراءات لهذا النسق في ضوء ذلك؛ مِن تأمُّلِ أدوات التفسير وكيفية التعامل مع مصنفات التفسير، وغير ذلك، وهو ما حال دون أن يكون هذا الطرح الذي قام به طرحًا تقويميًّا متكاملًا لعلم التفسير وضابطًا لنسقه، وإن كان قد فتح الباب أمام القيام بذلك ومهّد له بصورة ظاهرة.
ثالثًا: كَتب الدكتور/ محمد يسري كتابًا لطيف الحجم حول المبادئ العشرة لعلم التفسير وأسماه: (التقرير للمبادئ العشرة في علم التفسير)[15]، وقد رجّح أن التفسير باعتباره اللقبي هو: «علم بيان معاني مفردات القرآن العظيم وتراكيبه»[16]، إلا أن اختياره لهذا المفهوم لم يقترن بمعايير منهجية محرّرة؛ ولذا كان رأيًا لا يمنع غيره كما الحال في طرح د/ مساعد، كما أن هذا الكتاب لم يبرز نسقية مبادئ علم التفسير في ضوء هذا الاختيار على نحو محرّر له مرتكزاته المنهجية، وإنما غلب عليه محاولة تسييقها في ضوء واقع الفنّ، وهو ما صدّه عن تحرير إشكالات العلم وحال بينه وبين الاشتباك معها وإعادة ترتيب وضعية العلم بصورة متكاملة، إلا أنه وبرغم ذلك يعدُّ محاولة تسهم بصورة عامة في إثراء التفاكر في جانب يعاني ندرة شديدة في الكتابة البحثية فيه.
رابعًا: ظهر مؤخرًا كذلك كتاب: «صناعة التفكير في التفسير»[17]، وقد حوى أربعة أبحاث: «صناعة الدليل في علم التفسير»، «صناعة الصياغة في علم التفسير»، «صناعة التوجيه في علم التفسير»، «صناعة التجديد في علم التفسير». وقد ركّز الكتاب على المعنى التفسيري؛ بيانًا لأدلة فهمه، والمسالك العلمية لصياغته، وطرائق ومآخذ فهمه، وسبل تجديده، إلا أن معالجة الكتاب لم تأتِ تثويرية لإشكالات التفسير كما هو متوقّع في ضوء عنوان الكتاب، فلم تُعْنَ بتسليط الضوء على إشكالات الفنّ في سائر المجالات التي تعرضت لها وتحاول وضع محدّدات منهجية للتعامل معها ورسم الآفاق ومسارات البحث اللازمة لهذه المجالات؛ فالبحث الأول -وهو أطولها- لم يعالج أدوات التفسير وإشكال البناء النظري للمعنى التفسيري وكيفية القيام به، ولكنه نحا مباشرة لمحاولة ترتيب المتوفّر من هذا البناء وصياغته نظريًّا بطريقة تقارب المتّبَع في النسق الأصولي[18]. وأمّا البحث الثاني فانصبّ على استعراض مسالك صياغة المعنى عند بعض المفسرين. وأمّا الثالث فاعتنى بمسألة توجيه الأقوال وتتبّع نشأتها ومناهج بعض المفسرين فيها. وأمّا الرابع والأخير فقد تناول مسألة التجديد في التفسير وبيان أهميته ومجالاته وضوابطه[19].
وفي ضوء ما سبق يظهر أن الجهود التي عُنيت بالتفسير وإشكالاته يعتورها إشكالات عديدة، وأنها لم تتمكن من معالجة هذه الإشكالات؛ ولذا فإننا سنجتهد فيما يأتي في طرح مقاربة متكاملة لمعالجة الإشكالات المركزية لعلم التفسير، وكذلك بعض الإشكالات المهمّة التي تفرّعت عنها.
ثالثًا: معاقد التفسير؛ تحرير وتأصيل:
إنّ ضبط المعاقد الرئيسة للتفسير يأتي على رأس أولويات الجهود البحثية فيه، وذلك حتى يستقر لنا تصوّر التفسير في ذاته أولًا ويغدو فنًّا بيِّن القسَمات وواضح الملامح والهيئات، ثم يسهل ترتيب السير فيه بعد ذلك ويكون على هدى وبصيرة؛ وهذه المعاقد كالآتي:
أولًا: تحرير حيثية التفسير وضبط مفهومه.
ثانيًا: تحرير طبيعة المعنى التفسيري.
ثالثًا: تحرير مفهوم المفسِّر.
رابعًا: تحرير أدوات التفسير.
وقبل الشروع في طرح ما لدينا إزاء هذه المعاقد تجدر الإشارة لأمرين:
الأول: سنجعل طرحنا في هذه المعاقد وما سنرجّحه فيها مؤسّسًا على معايير منهجية واضحة، بحيث يكون لطريقة تعاملنا معها وما نختاره إزاءها جملة مبرّرات ومسوّغات، ولا يكون الطرح مجردَ رأيٍ لا يمنع غيره كما نجده في بعض الأطروحات التي حاولت التعامل مع بعض هذه المعاقد كما مرّ، وهو ما يفيد بصورة كبيرة في إثراء وتعميق التثاقف حول طبيعة المعايير المنهجية اللازمة لحلّ إشكالات علم التفسير وتحرير معاقده الكلية وتقويم الاجتهادات المقدَّمة إزاء ذلك.
الثاني: المعاقد الثلاثة الأُول بينها تراكب وترابط ظاهر، ولكننا سنفرد الكلام عن كلّ واحد منها باستقلال ليتّضح شأنه بصورة أكبر وترتيب مسلك معالجته.
أولًا: تحرير حيثيّة التفسير:
وهذه نقطة جوهرية ورئيسة جدًّا؛ إذ سائر تصورات الفنّ وما يأتي الكلام فيه بعد ذلك من تصوّر أدواته وآليات ممارسته...إلخ، مرتبط بها غاية الارتباط وقائم عليها غاية القيام.
وإنّ للعلوم عند تأملها جانبين رئيسين؛ «أحدهما خفيٌّ، والآخر ظاهر، فأمّا الأول: فيكمن في المشاغل الرئيسة التي أفضَت إلى ولادة العلم ذاته، والسياقات العامة والغايات الكبرى التي أدّت إلى انفجار ينبوعه وبزوغ نبتته، ويمكن تسميته بـ(مسالك صناعة الفنّ ذاته). وأمّا الآخر: فيتعلق بالقواعد الحاكمة لنسق الممارسة والمنجز المعرفي داخل الفنّ ومتابعة العطاء فيه، وهذا ما يمكن تسميته بـ(قواعد الممارسة العلمية في الفنّ).
فهذان الجانبان هما أساس وجود الفنّ وتداوله؛ فالجانب الأول يمثّل الهاجس المعرفي الذي حفز العقل الإسلامي ودفعه لإنتاج الفنّ ذاته [أسباب وجود العلم وتشكّل حيثيته وغاياته الكبرى]، وأمّا الآخر فيمثّل التجسيد العملي للمعرفة في داخل الفنّ [قواعد العلم وضوابط ممارسته]»[20].
ولا شك أننا متى أردنا تحرير حيثية المجال بدقّة فإن علينا العَوْد إلى الجانب الأول؛ إذ هو الإطار الحاكم للفنّ والسبب في وجوده، والذي في ضوئه تجري محاكمة الجانب الثاني ومساراته محاكمة كلية، وتبيّن مقدار وفاء محصوله بخدمة الفنّ وتحقيق أغراضه، وتبيّن ما في هذا المحصول من فجوات وثغرات ونقاط قوة وضعف.
إنّ مادة التفسير متشعبة ومتعدّدة وفق حيثيات ودلالات كثيرة كما أسلفنا، وتبدو ظاهرة التداخل في بعض مساحاتها مع مجالات معرفية أخرى لها اشتغال بالنصّ القرآني كالفقه والأصول، ولكي نحدّد حيثية التفسير بدقّة، فإننا سننظر لجانبين رئيسين:
أولًا: موقع علم التفسير بالنسبة لخارطة العلوم الإسلامية المشتغلة بالنصّ القرآني والمشغل المعرفي الذي يتكامل به معها في هذا الاشتغال.
ثانيًا: الواقع التفسيري للأجيال الأُولى في التفسير.
واللجوء لهذين الجانبين له أهميته المنهجية البيّنة في تحرير ما نحن بصدده؛ فموقع التفسير كعلْمٍ في خارطة العلوم الإسلامية المشتغلة بالنصّ القرآني ظاهر جدًّا في التبصّر بحيثيّة علم التفسير وتحرير الحيثيّة الخاصّة به وضبطها؛ فالقرآن هو أساس الحياة الإسلامية ومصدر شرعتها، وقد نشأت العلوم الشرعية لخدمة هذا الكتاب وضبط التعامل معه من مناحٍ متعدّدة، وهي متكاملة في تحقيق هذا الضبط والنهوض به من مداخل وزوايا متنوعة، بحيث يحصل للعقل المسلم تغطية معرفية لسائر تلكم الجوانب التي يحتاج إليها عند التعامل مع القرآن؛ فهمًا له واستنباطًا منه، وغير ذلك، وبالتالي فإنّ الرجوع لنسق العلوم وتأمّل حيثياتها يتيح -بلا شك- معرفة المشغل المعرفي الذي يتعلّق بالتفسير ذاته.
وأمّا الرجوع للواقع التفسيري للأجيال الأولى فهو ظاهر كذلك؛ لأن الممارسة المعرفية للأوائل والطبقات المتقدّمة في الفنون تكون أكثر تعبيرًا عن المشاغل المعرفية الخالصة للفنون، وأقرب دومًا للالتصاق بحيثيات هذه العلوم وخدمة أغراضها دون توسع، بخلاف ما يأتي بعد ذلك مما يقع فيه الاستطراد والزيادات التي تفرضها عوامل عديدة في مسيرة العلوم.
وبذلك يمكننا منهجيًّا تحرير حيثية التفسير والكشف عنها وتحرير الدلالة الأكثر تعبيرًا عن اصطلاحه من بين سائر الدلالات التي نتجت عبر التاريخ، وفيما يأتي نبيّن حيثيّة التفسير في ضوء هذين الجانبين:
أولًا: موقع علم التفسير بالنسبة لخارطة العلوم الإسلامية المشتغلة بالنصّ القرآني:
لمختلف العلوم الإسلامية علاقات متنوّعة مع القرآن الكريم، ومسالك عمل متباينة بحسب طبيعتها وطبيعة أغراضها، وإن الناظر في علم التفسير في وسط شبكة هذه العلوم يظهر له سريعًا أنه ينفرد بجانب معرفي خاصّ، وهو تحرير المراد من النصّ والكشف عنه.
يقول الكافِيجي: «لكلّ علم من العلوم المخصوصة كالفقه والأصول والنحو والصرف.. إلى غير ذلك؛ موضوع يُبحث فيه عن أحواله، فيكون لعلم التفسير موضوع يُبحث فيه عن أحواله، فموضوعه كلام الله العزيز، من حيث إنه يدلّ على المراد؛ وإنما قـيّد بهذه الحيثية ليكون ممتازًا عن موضوع العلم الآخر؛ فإن الكتاب داخل -إن لم يقيّد بها- تحت موضوع علم الأصول، من حيث إنه يستفاد منه الأحكام إجمالًا، ويندرج أيضًا -إن لم يتقيد بها- تحت موضوعات علوم أُخَر، بحسب اعتبار حيثيات أخر»[21].
يقول عبد القادر حسين عن الفَرْق بين التفسير وأصول الفقه: «علم أصول الفقه جاء لبيان كيفية التعامل مع النصوص وكيفية تفسيرها، سواء أكانت قرآنية أو غيرها...، إلا أن علم أصول الفقه ألصق بالأحكام وأفعال المكلفين؛ فهو يدرس الحاكم الذي هو الله والحكم الذي هو خطابه والمحكوم الذي هو المكلف...، فهو أخصّ من قواعد التفسير من هذه الجهة، فالتفسير شامل للقرآن الكريم بما فيه من عقائد أو أحكام أو أخبار وقصص. كما أنه من جهة أخرى أعمّ من قواعد التفسير؛ إِذْ يدرس قضايا الرواية وأخبار الآحاد وقضايا التكليف والافتراضات العقلية كمسائل التكليف بما لا يطاق ونحوها...، وقواعد التفسير أعمّ من أصول الفقه؛ إذ لا تختصّ بالأحكام وأفعال المكلفين، ومن ناحية أخرى هي أخصّ؛ هي منصبّة على النصّ القرآني بشكلٍ خاصّ فلا تدرس القياس ولا الاستحسان...، وإن تعرّضَت لشيء من ذلك فليس لذاته إنما يكون مساعدًا لتفسير النصّ القرآني»[22].
إنّ التفسير يعاني مفهومه من تفاوتٍ دلالي واسع يمتد من بيان المعنى إلى استخراج الأحكام والنظر في الحِكم والمقاصد التشريعية وسرد اللطائف البيانية والإعرابية والنكات البلاغية وغيرها، وهذا التفاوت معلومٌ وظاهرٌ من واقع مادة التفسير في مصنفاته وكذا واقع تعريفات التفسير كما أسلفنا، إلا أننا رغم تفاوت دلالات التفسير وتشعّب مادته يمكننا أن نميّز دوائرها بصورة عامة إلى دائرتين رئيستين:
الأولى: دائرة بيان المعنى.
الثانية: دائرة ما فوق بيان المعني من استنباط الأحكام وسرد المواعظ...إلخ.
وهاتان الدائرتان لهما ظهور بيّن في تعريفات التفسير وكذلك في واقع مصنفات التفسير التي ينشغل بعضها بصورة ظاهرة بتقرير المعاني ولا يزيد عن ذلك، وبعضها يتوسّع -على تفاوتٍ بينها في ذلك- فيستخرج الأحكام الشرعية والتصوّرات القرآنية إزاء القضايا...إلخ[23].
ونحن متى نظرنا للتفسير وعلاقته بالفنون الأخرى من خلال هاتين الدائرتين فيمكننا أن نلحظ بوضوح أن التفسير -تبعًا للدائرة الأولى- ستكون حيثيته المميزة له في خارطة الفنون هي توضيح المعنى بغضّ النظر عن وجود خلاف في هذا المعنى ذاته كما ذكرنا. وأمّا في الدائرة الثانية فستتداخل معنا في بعضها بصورة بيّنة حيثياتُ العديد من الفنون الأخرى لا سيّما الفقه والأصول، ويتعذّر علينا القبض بوضوح على حيثية متميزة للتفسير؛ من هاهنا فإن حيثية التفسير -في ضوء واقع شبكة العلوم- «يجب أن تقوم على هذه الدائرة؛ لأن حيثيات العلوم تقوم على القدر المفارق للفنّ عن غيره»[24].
وأمّا ما نجده في ساحة التفسير من أمور أخرى؛ كذكر المواعظ واستخراج الأحكام والحِكم والمناهج...إلخ فهو وإن لم يندرج تحت فنٍّ بعينه في العلوم الشرعة، فإن انتسابه للتفسير يجب أن يُتأمل في ضوء حيثية التفسير ذاته ومقدار جدواه فيها، فضلًا عن أن بعضه يظهر فيه ما يستأهل أن يفرد بحيثية خاصّة؛ كبحث المقاصد وغيرها، فتكون مجالات جديدة قائمة برأسها.
ثانيًا: الواقع التفسيري للأجيال الأولى في التفسير:
وهذا في مجال التفسير يتمثّل رأسًا في التفسير المتعلّق بطبقة السلف -رضوان الله عليهم أجمعين- (الصحابة والتابعين وأتباع التابعين)[25]، فرجال هذه الطبقة هم «أول علماء المسلمين تعرضًا لبيان ألفاظ القرآن وآياته، وكلّ مَن جاء بعدهم فهم سلفٌ له»[26]، ويعدُّ تفسيرهم البداية الفعلية لممارسة التفسير واشتداد نسق هذه الممارسة، وبرغم الامتداد الزماني لتفسير هذه الطبقة إلا أنه يمثّل وحدة متكاملة لها تمايزها عمّا جاء بعدها؛ ولذا يبرُز الحديث عنها بصورة مستقلّة دومًا في التحقيب للتفسير ومحاولات التأريخ له، وكذلك في ذكر المادة التفسيرية حيث تتم الممايزة بين تفسير السلف وما تلاهم من ممارسة تفسيرية.
ولمّا كان تفسير السلف هو الممثِّل الأول لممارسة التفسير فإن النظر في مادة هذا التفسير وتأملها يتيح لنا تصور الهاجس المعرفي الذي يسيطر على الممارسة التفسيرية ويكمن خلفها، وكذا طبيعة الدلالة التفسيرية التي برزت في نتاجهم التفسيري.
والمتأمّل في تفسير السلف يجده يدور بصورة عامة على تبيين المراد تحديدًا دون توسّع فيما وراء ذلك من استخراج الأحكام والهدايات واللطائف... إلى آخر ما نجده في كثير من مصنفات التفسير.
يقول السيوطي: «ولمّا كان هذا التفسير المشار إليه [تفسير السلف]...، ليس فيه إعراب، ولا سِرٌّ بياني، ولا نكتة بديعة، ولا استنباط حكم، إلّا نادرًا...»[27].
ومما يدلّل على أن تفسير السلف ينحو لتوضيح المراد، لا التوسّع فيما وراء ذلك =هو مطالعة مروياتهم، والتي يظهر فيها الاهتمام بتحرير المراد دون توسّع فيما وراءه، وكذا اشتغال الأئمة من الجامعين للمعاني والمحرِّرين لمادتها بمقولات السلف؛ كما نجده عند الطبري وابن عطية، مما يبرز دوران مقولات السلف على المعاني[28].
وفي ضوء ما تحرّر من وضعية علم التفسير في شبكة العلوم الشرعية واشتغاله على بيان المعنى وتحريره، وكذا ما ظهر من دوران تطبيق الأجيال الأولى للتفسير في هذا الإطار؛ فإنّ ذلك يُبْرِز بصورة واضحة أنّ حيثية التفسير هي تبيين المعنى لا غير، وأن المفاهيم المطروحة للتفسير في هذا الإطار هي الأظهر بتمثيل العلم، وأنّ ما جاوز ذلك في تعريفات التفسير وفي المادة الواردة في مصنفات التفسير فإنه يمثّل خروجًا عن نسق الفن وحيثيته، وستأتي الإشارة لبيان الموقف خاصّة من مادة التفاسير المتوسّعة والتي يظهر فيها زيادة على تقرير المعنى وكيفيات التعامل معها.
ثانيًا: تحديد المعنى التفسيري وطبيعته:
تتمثّل إحدى الإشكالات الرئيسة لفنّ التفسير في الخلاف في طبيعة المعنى التفسيري -كما أسلفنا- ما بين المعنى اللغوي والمعنى السياقي والمعنى الإشاري، وهو الأمر الذي أفضى إلى وقوع إشكالات عديدة جدًّا في ساحة النظر للمعنى التفسيري والذي يمثّل حاصل التفسير ذاته وثمرته النهائية كما أسلفنا.
وإنّ المتأمل في كيفية حلّ هذه الإشكالية يجده يكمن بصورة رئيسة في تأمل الفعل التفسيري ذاته من ناحية، وكذلك تفسير السلف من ناحية أخرى وكيفياته؛ فالأول من باب التأمّل النظري المجرّد للممارسة التفسيرية وما يصدق عليه فيها، والثاني باعتبار مركزيته في النظر للممارسة التفسيرية كما سبق.
فأمّا تفسير النصّ القرآني فلا يمكن بحال أن يكون المعبِّر عنه هو البيان الإشاري والذي لا يعدو حاصل المعنى فيه عن كونه استنباطًا لإشارات معيّنة ليست تفسيرًا للنصّ ذاته ولا تجلية لمعناه والمراد منه أصالة، وهو ظاهر.
وأمّا مجرد البيان اللغوي لدلالات الألفاظ، فإنه وإن دخل في مسمى التفسير باعتباره بيانًا للألفاظ، إلا أنّ دلالات الألفاظ موجودة في المعاجم وأمرها معروف؛ ما يجعل من مجرّد الوقوف عليها ليس فيه كبير إفادة ولا تمايز بياني معيّن للنصّ يستأهل أن يكون التفسير معه له حيثية خاصّة ظاهرة الاستقلال عن البيان اللغوي.
وأمّا بيان المراد السياقي فهو ما يُظْهِر قصد المتكلم ومراميه من وراء ذكر الألفاظ، ولا شك أنّ في تجلية هذا المعنى السياقي خصوصيةً وتمايزًا، وبه يصبح للتفسير حيثية خاصّة من حيث هو فنّ يبحث عن استكناه المراد الكلي التركيبي من وراء مجموع الألفاظ، وهو أمر مختلف تمامًا عن مجرّد البيان لدلالات الألفاظ ذاتها؛ ومن ثم فإن هذا المعنى هو الخليق دون غيره بالتفسير.
وصحيح أن المعنى اللغوي قد يتقاطع كثيرًا مع المعنى السياقي، ويكون بيان الثاني هو الأول ذاته، إلا أن المعنى التفسيري السياقي ليس بالضرورة أن يكون هو المعنى اللغوي دائمًا، فهُمَا وإنْ تقاطعَا في أحيان كثيرة إلّا أن بينهما تمايزًا، ولكلّ منهما شروطه وأدواته واعتباراته في الممارسة والإنتاج كما سيأتي، ولا يكون المعنى اللغوي المجرد هو المعنى التفسيري المراد إلّا بدليلٍ ظاهرٍ، وإلّا فالأصل خلافه، وهو ما توسّعنا في بيانه في غير هذا الموضع[29].
وإذا كان ما يقرّره النظر في طبيعة الفعل التفسيري هو اختصاص هذا الفعل بتحرير المراد التركيبي السياقي دون اللغوي والإشاري، فإنّ المتأمّل في تفسير السلف -وهو التفسير الممثِّل للممارسة الأولى للتفسير- يجده يقرّر ذات الأمر، وهو ما صرّح به ابن القيم نفسه في قسمته للتفسير كما سبق؛ إذ جعَله في مقابل البيانَيْن؛ اللغوي والإشاري.
وهذا الأمر ظاهرٌ جدًّا في تفسير السلف، ويلحظه بيُسر كلُّ ناظر في تفاسيرهم، وكيف أنها تتسم بذِكْر المراد التركيبي للكلام، وهو ما يجعل كثيرًا من المنشغلين بالتبيين اللغوي في ساحة التفسير يستشكلون أقوالهم أحيانًا ويعتبرونها مخالفة لظواهر دلالات اللغة؛ وما ذلك إلا لأنها ليست أقوالًا لغويةً وذكرًا لدلالات الألفاظ، وإنما هي أقوالٌ سياقية تبرُز في صورة لوازم غالبًا ينتجها السياق الكلي للكلام ومؤشراته[30].
وفي ضوء ما تحرّر في هذه النقطة وسابقتها يلاحظ ما يأتي:
أولًا: عُرّف التفسير بأنه بيان المعنى في بعض الأطروحات التي عُنيت بطرح تعريفٍ محددٍ للتفسير، لا سيّما طرح الدكتور مساعد الطيار، إلا أنه يمكننا القول بأن التعريف الأَوْلى بمفهوم التفسير يمكن أن يكون: (بيان المعنى المراد)، لا بيان المعنى[31]؛ وذلك أن التعريف ببيان المعنى لا يظهر معه ما يدلّ على طبيعة التبيين التفسيري ولا ما يشير لخصوصية المعنى التفسيري الناتج عنه، ويمكن تنزيله على صور أخرى من التبيين غير التفسيري؛ كالتبيين اللغوي مثلًا، وهو عيب ظاهر الإشكال.
وأمّا التعريف بـ(بيان المعنى المراد) فإنه يتجاوز هذا الإشكال بوضوح، حيث تظهر معه خصوصية الممارسة التفسيرية، وأن المعنى التفسيري هو معنى سياقي يتجه لبناء المراد من الكلام لا ذكر دلالات الألفاظ، وهو أمر بالغ الأهمية في ضبط النظر للممارسة التفسيرية وخصوصية المعنى التفسيري وافتراقه عن غيره من المعاني، ومن المهم دلالة التعريف بناء عليه.
ثانيًا: عملية بيان المراد التركيبي تحتاج لأدوات خاصّة -كما سيأتي- ونسق اشتغال معيّن، وبالتالي فإنّ دلالة اصطلاح التفسير عليها مما يحتاج إلى تأمل، لا سيّما وأنه لا يترجِم خصوصية المعنى الناتج عنها، ولا يُبْرِز تمايز هذه العملية عن مجرّد التبيين اللساني اللغوي لدلالات ومعاني الألفاظ كما هو الشأن في اصطلاحات العلوم، بل إنه ربما يكون من أسباب الإشكال في عدم لحظ خصوصية المعنى التركيبي وتمايزه عن غيره؛ فاصطلاح التفسير يُبقي ممارسة الكشف عن المراد في حدود الكشف اللغوي العام، فتبدو هذه الممارسة وكأنها لم تنتقل ليكون لها نسق خاصّ تتمايز به عن هذا الكشف اللغوي؛ ومن ثم يلزم برأينا وَضْع اصطلاح معبّر عن مفهوم هذا النسق من الكشف.
ولعلّ اصطلاح التأويل أقرب في التعبير عن عملية الكشف عن المراد؛ لِما يفيده من تجلية اختصاص هذا الكشف بتحرير قصد المتكلّم ومراده من وراء كلامه، وأمّا ورود كلمة التفسير في عبارات السلف -فبغضّ النظر عن تحرير المراد بها، وهل هو المعنى اللغوي العام للمفردة أم غير ذلك- فإن الأقرب فيه ألا يكون معبرًا عن اصطلاح العلم المتعلّق ببيان المراد، وإلا فاصطلاح العلم ينشأ متأخرًا بعد تشكُّل مفهومه، والإمام الطبري نفسه لم يصدِّر باصطلاح التفسير في ذكر الأقوال، وإنما لجأ لاصطلاح التأويل والذي استعمله كذلك في عنونة كتابه: (جامع البيان عن تأويل آي القرآن)، وهذا الصنيع مما يحتاج لتأمّل، خاصة وأن الطبري جمع مقولات السلف ووازن بينها وتعاطى التفسير من خلالها فقط، ومرحلته أقرب لبدء ظهور الوضع الاصطلاحي، وبالتالي فإنّ اختياره للتأويل ربما يكون فيه محاولة النّزع لوضع اصطلاحٍ يترجم صورة مفهوم العلم الذي تحرّر عنده، فيكون تركه لاصطلاح التفسير ظاهرًا في عدوله عنه ورؤيته أن اصطلاح التأويل هو المعبر عن الممارسة التي ظهرت صورتها النموذجية في تفسير السلف، وهذه النقطة وامتداداتها لا تزال محلّ بحث عندي[32].
ثالثًا: تحديد مفهوم المفسِّر:
لا شكّ أن هذه النقطة لها أهميتها الكبيرة؛ حتى يكون لدينا محدّدات واضحة لمن يصحّ أن نطلق عليه لقب المفسّر، خاصّة مع كثرة التأليف التفسيري وتصدِّي العديد للكتابة فيه قديمًا وحديثًا.
وفي ضوء ما تحرّر من حيثية التفسير فإن المفسِّر هو المشتغِل بتبيين المعنى المراد، وهذا الاشتغال يشمل جوانب عديدة؛ فمنه ما يتعلّق بإنتاج المعنى المراد ذاته، ومنه ما يتعلّق بالموازنة والتحرير بين هذه المعاني، ومنه ما يتعلّق بالجمع والترتيب لمادتها...إلى آخر ذلك من صور الاشتغال العلمي الممكن في دائرة التبيين للمعنى المراد.
وأمّا مَن لا يَظهَر في تصنيفه التفسيري اشتغالٌ بالمراد لا إنتاجًا ولا تحريرًا ولا جمعًا...إلخ، فإنّ إطلاق لقب المفسِّر عليه وتصنيفه في عداد المفسرين لا يخلو من نظر؛ لأنه ليس صاحب اشتغال تفسيري على الحقيقة حتى يُصَنَّف في رجال الفنّ وضمن زمرتهم ويكون كتابه من جملة الكتابات في الفنّ.
إنّ الاشتغال ببيان المراد هو ضابط حيازة لقبِ المفسّر، وصحيح أن درجة هذا الاشتغال ببيان هذا المراد مما يتفاضل فيه المفسّرون ويقع بينهم التمايز فيه، إلا أنّ وجوده في ذاته ونهوض العالِم بالتصدِّي للاشتغال فيه -بغضّ النظر عن رتبة هذا التصدي ومساحته- كافٍ في منح العالِم لقب المفسّر وعَدِّه ضِمن جملة المفسرين.
رابعًا: تحرير أدوات التفسير:
في ضوء ما تحرّر معنا قبلُ من دوران حيثية التفسير ومفهومه على تبيين المعنى المراد، فإننا سنحاول في هذه النقطة تأمّل طبيعة الأدوات الموصلة لهذا المراد والتي تُيَسِّر تحصيله وتقريره، وسنرتكز في ذلك على تأمّل تفسير السلف والموارد الموظَّفة فيه؛ كونه يمثّل التجلي الأبرز لحيثية التفسير التي ذكرنا وممارسة التفسير باعتباره تجلية للمراد من الكلام كما مرّ معنا.
ومن خلال اشتغالنا بتفسير السلف والأدوات الموظّفة في إنتاجه يمكننا القول -وإن كان الأمر بحاجة لمزيد بحث- أن هذه الأدوات ترجع لما يأتي:
أولًا: النظائر القرآنية.
ثانيًا: القراءات القرآنية.
ثالثًا: الأحاديث النبوية.
رابعًا: لغة العرب.
خامسًا: مرويات الأخبار التاريخية.
سادسًا: السياق.
وهذه الأدوات منها ما لا ينفكّ عن الممارسة التفسيرية بحال؛ كالسياق واللغة، واللذان يمثلان أدوات قَبْلية لا غنى عنها لإنتاج المراد وتحصيله، ومنها ما يوظَّف في مواطن دون مواطن؛ وهي بقية الأدوات، والتي يكون بينها تفاوت في مقدار المساحات التي يجري توظيفها في التفسير وإنتاجه.
وتجدر الإشارة هاهنا لأمور:
أولًا: إننا متى نظرنا في عملية بناء المعنى المراد ذاتها من خلال هذه الأدوات وجدنا أنها عملية تركيبية تقوم على التوظيف المتزامن والمتعالق في ذات الوقت لمجموعة من الأدوات، ولا تنفرد أداة واحدة منها بإنتاج المعنى المراد من النصّ أبدًا.
ثانيًا: تشتمل اللغة على عددٍ من الأمور والجوانب، ولا شك أن بناء المعنى المراد يحتاج إليها ولكن بقدرٍ معيّنٍ؛ إِذْ هذا المراد يكفي فيه من اللغة بنظرنا ما يُعِين على ضبط القواعد العامة للكلام العربي ومعرفة مواقعه، وكذا حُسن تصوّر دلالات الألفاظ (المعنى المعجمي واللساني)، وأمّا التوسّع فيما وراء ذلك من التدقيقات الإعرابية والنحوية والبلاغية فهذه يحتاج إليها المشتغل بدلالات الألفاظ لا تحرير المعنى المراد.
ثالثًا: المرويات التاريخية تكتنز جملة أدوات؛ فهي تشمل كلّ خبر تاريخي يفيد في التفسير؛ كمرويات النزول، والسِّيَر والمغازي، وأحوال العرب، والإسرائيليات، ومرويات التاريخ العام فيما يتّصل بما طرقه النصّ القرآني من أحداث ووقائع تاريخية.
رابعًا: توظيف هذه الأدوات في بيان المراد يتم بصورة اجتهادية من المفسّر، ولكن بعض هذه الأدوات يكتنز -وإن كان بصورة قليلة- تفسيرًا منصوصًا عليه ينقله المفسّر، لا سيّما السُّنّة والتي تحوي بعض التفسيرات النبوية المباشرة.
خامسًا: قَلَّت العناية جدًّا بإنتاج المعنى المراد بعد السلف؛ إذ غلب التبيين اللغوي على مسار التفسير وصار أساسًا في مسلك التبيين، وإليه المرجع الرئيس في الممارسة التفسيرية.
يقول الزمخشري: «...ولا يغوص على شيء من تلك الحقائق إلّا رجلٌ قد برع في عِلْمَيْن مختصَّيْن بالقرآن؛ وهما: علم المعاني، وعلم البيان. وتمهَّلَ في ارتيادهما آونة، وتعبَ في التنقير عنهما أزمنة...»[33].
يقول أبو حيان: «فعكفتُ على تصنيف هذا الكتاب، وانتخاب الصَّفْو واللُّباب، أجيلُ الفكر فيما وضع الناس في تصانيفهم...، وأضيف إلى ذلك ما استخرجَتْه القوةُ المفكِّرة من لطائف علم البيان، المُطْلِعِ على إعجاز القرآن، ومن دقائق علم الإعراب المُغْرِب في الوجود أيّ إغراب، المقتنِص في الأعمار الطويلة من لسان العرب وبيان الأدب؛ فكم حَوى من لطيفةٍ فكري مستخرجُها، ومن غريبةٍ ذهني منتجُها، تحصّلَت بالعكوف على علم العربية، والنظر في التراكيب النحوية، والتصرّف في أساليب النظم والنثر، والتقلُّب في أفانين الخُطَب والشِّعر»[34].
وقد أفضى هذا الأمر لجملة إشكالات إزاء الأدوات التفسيرية الموظّفة في تفسير السلف؛ أبرزها:
- قلّة توظيف العديد من الأدوات، لا سيّما مرويات الأخبار بعد عصر السلف، والتي تَضْعُف الحاجة إلى الإفادة منها مع إهمال إنتاج المعنى المراد الذي يلزم فيه لحظ السياقات والطبقات المقامية الداخلية والخارجية للنصّ بصورة بالغة العمق.
- عدم الفهم المحرّر لآليات توظيف هذه الأدوات في تفسير السلف؛ خاصّة مرويات النزول والإسرائيليات، والتأصيل لها بمعزل عن صلتها بالتبيين وأثرها فيه، كما لو كان حضورها في التفسير مقصودًا لذاته وليس لتحرير المراد كما هو شائع لدى كثيرٍ من النظَّار؛ ولذا صرنا مع مرويات النزول نبحث عن عبارات السلف في إيراد المرويات ذاتها وما يمكن تلمُّسه فيها من قرائن تبيّن قصدهم السببية من عدمها، دون أن يكون المعنى ذاته هو معيار النظر في الأمر ومناط الحكم فيه. وفي الإسرائيليات انصرف النظر عن تصور عُلْقتها بتحرير المراد ودورها فيه، وصار النقاش للمرويات الإسرائيلية ذاتها وطبيعة مضامينها والمعلومات الواردة فيها، والتي هي غير مقصودة رأسًا للمفسّر المبين للمراد، والذي يوظِّف هذه المرويات توظيفًا خاصًّا يدور حول جانب معيّن في المروية بغضّ النظر عن تفاصيلها؛ كذات صنيعه في الاستدلال على المعاني بالشعر الجاهلي، وهو ما حررناه مفصلًا في غير هذا الموضع.
- رَفْض الكثير من النظّار لبعض هذه الأدوات رفضًا كليًّا ومهاجمة من استخدموها، كما وقع خاصّة مع المرويات الإسرائيلية والتي رفَض توظيفها في التفسير كثيرٌ ممن جاء بعد السلف، وهو ما يمكن تفهُّمه في ضوء غلبة التبيين اللغوي وما يولِّده من شعور بإمكان الاستقلال بعملية التبيين بعيدًا عن هذه المرويات، وهو ما بينّا غلطه وأهمية هذه المرويات في الممارسة التفسيرية من مناحٍ متعدّدة، بل وضرورتها في بعض المواطن[35].
سادسًا: ضعف التأصيل النظري لهذه الأدوات وبيان شروط توظيفها وكيفيات تعاطي التبيين من خلالها، وهو ما يجعل التفسير بذلك يكاد يكون عريًا تمامًا من أيّ سياج نظري تقنيني يضبط نسق ممارسته كما سنبين.
إننا ومن خلال ما حرّرناه من معاقد التفسير يمكننا القول بأنه قد صار لدينا عِلْمٌ متكامل النسق؛ علم له حيثية ظاهرة ومحرّرة وله مفهوم محدّد وثمرة واضحة وأدوات بيّنة لتحصيل هذه الثمرة، كما أن للمشتغل به دورًا ومهامَّ غير ملتبسة، وكذلك يمكن الحديث عن مبادئه كبقية العلوم، وفي ضوء ذلك يسهل ترتيب النظر في بقية الإشكالات في فنّ التفسير، والناجمة عن عدم انضباط نسق المجال عبر التاريخ، والتي سنكتفي هاهنا بتقديم مقاربة في التعامل مع إشكاليتين منها فقط لأهميتهما؛ وهما: الموقف من البناء النظري للتفسير، وكيفيات التعامل مع كتب التفسير التي تبدو بعيدة في واقعها التطبيقي عن نسق التفسير الذي قرّرنا[36].
الإشكالية الأولى: الموقف من البناء النظري للتفسير:
إنّ العلوم الشرعية رُكّبت تركيبًا مزدوجًا كما هو معلوم؛ فهناك جانب التطبيق وهناك جانب التأصيل الذي يقنّن نسق الممارسة، بيدَ أنّ التفسير على أهميته باتَ «عريًا من أيّ سياج نظري نقدي له نسقه الذي يحكمه، ومنطقه الذي يقنّنه ويقعّده»[37].
إنّ البناء النظري للتفسير يشتهر بضعفه بصورة عامة، وبعدم تقرّر قواعده كما أثبتته بعض الدراسات[38]، وهو أمر تظهره هاهنا النظرة العجلى لواقع البناء النظري المتّصل بتبيين المعنى المراد؛ فهذه الموارد التي أشرنا إليها لا تجد إزاءها تأسيسًا نظريًّا متكاملًا -ولا ما يقارب ذلك- لضبط كيفيات التعامل معها وطرائق التبيين من خلالها والشروط المنهجية المتصلة بذلك، وكذلك لا تجد ضبطًا لمسالك التعامل مع هذه الأدوات وحالات التقديم والتأخير لها في ممارسة التبيين أو حالات الإعمال والإهمال لها عند التعارض، والضوابط الخاصّة بالحال الأول والثاني، وغير ذلك مما يُبرِز لنا إطارًا تقنينيًّا وسياجًا نظريًّا ضابطًا لعملية تحرير المراد والأدوات التي نحتاجها للوصول إليه.
إنّ الكتابات في علوم القرآن وأصول التفسير تَدرج دومًا على ذكر جملة مصادر للتفسير؛ كالقرآن والسُّنّة واللغة وبعض الضوابط المتعلقة بالتعامل معها. وبغضّ النظر عن مناقشة فكرة المصادر هاهنا، إلا أن الناظر في الضوابط التي تذكر فيها في التآليف يجدها:
- ضوابط عامة، ويغلب عليها طرح تنظيرات بلا بيان مسوغاتها التطبيقية ولا كيفية بناء هذه الضوابط، كما يتّجه الكثير منها للاستمداد من النسق الأصولي.
- لا يَبْرُز معها الخلاف التفسيري في التعامل مع كلّ مصدر وكيفيات توظيفه والقواعد الحاكمة له عند التقائه بغيره مع المصادر، خاصّة وأن بيان المراد هو عمل تركيبي -كما أسلفنا- يقوم على التوظيف المتزامن لجملة الأدوات.
- تصلح للتنزيل بقدرٍ كبيرٍ على سياقات علوم أخرى تشتغل بالنصّ؛ كالفقه والأصول، ولا يَظهر تمايز التفسير فيها بصورة كبيرة؛ إذ لا يبرز القدر الذي يركز عليه المفسّر في تعامله مع هذه المصادر والتي تحتوي على أمور واسعة جدًّا، ولا يظهر اختصاص الدلالة التفسيرية بمسالك تناسب طبيعتها.
ومن هاهنا فإنّ الأدوات التي ذكرنا تظلّ بحاجة على الحقيقة لدرس تأصيلي استقرائي موسّع ومطوّل يقوم على دراسة توظيفها في واقع التفسير -لا سيّما تفسير السلف في المراحل الأولى- وكيفياته ومساحات الاتفاق والاختلاف فيه، ثم يتم متابعة ذلك بعدهم خاصّة عند كبار المفسرين من أمثال الطبري وابن عطية وبيان كيفيات استعمالهم لهذه الأدوات؛ سواء في فهم الأقوال المنتجة أو الموازنة بينها أو إنتاج أقوال واحتمالات تفسيرية جديدة كما نجده بصورة ظاهرة عند ابن عطية.
ويلاحظ هاهنا أن هذا النمط من الدرس الاستقرائي لكيفيات استعمال هذه الأدوات في إنتاج المعنى المراد يكفل تحقيق غايات نفيسة؛ أهمها فيما نحن بصدده:
أولًا: أن يكون لدينا بناء قاعدي منضبط للتفسير ونظريات متكاملة في هذا الصدد نستطيع معها تحويل بيان المراد إلى صناعة علمية يمكن تعلّمها وتداولها، ويكون لتدريسه وتعليمه إطاره التخصصي الصارم، وبذلك يستقيم وضع التفسير مع ما هو قائم في العلوم الشرعية الأخرى، ويمكن أن يستأنف دورة جديدة من حياته، ويتتابع فيه إنتاج المعنى المراد (السياقي التركيبي) الذي قلَّ الاشتغال به.
ثانيًا: الحسم في إشكالات مركزية في التفسير؛ كإشكال عِلْمية التفسير ذاته والجدل المتعلّق بالتشكيك فيها لعدم بروز اختصاص التفسير بنسق قاعدي متعلق بممارسته.
ثالثًا: بيان جدوى استحضار مباحث دلالات الألفاظ واستيرادها من النسق الأصولي ووضعها في ساحة التفسير، وكيف أنها قد لا تبدو ملائمة لضبط الدلالة التفسيرية التي هي دلالة سياقية بالأساس بخلاف الدلالة في المباحث الأصولية التي تقوم على رعاية البُعد اللغوي بصورة كبيرة[39].
رابعًا: تثوير بحث الدلالة في تراثنا بصورة عامة، وإعادة شغل العقل الإسلامي بأحد أبرز الهواجس المعرفية الكبرى التي انتجت قطاعًا من أهم معارفه، وهو ما يُعين على استرداد العقل الإسلامي لمسيرة الإنتاج المعرفي من جديد.
الإشكالية الثانية: كيفيات التعامل مع كتب التفسير التي تبدو بعيدة في واقعها التطبيقي عن بيان المعنى المراد:
بينّا سابقًا أنّ التفسير كثرت دلالاته وتمدّد واقعه التطبيقي تمددًا كبيرًا وفق هذه الدلالات، كما وقع اختلاف في مفهوم المعنى ذاته مع ضعف في الاشتغال بتحرير المعنى المراد والذي هو الأصل في الممارسة التفسيرية، وبالتالي فنحن -بإزاء هذا الإشكال والتعامل مع المصنفات ومنتوجها- لدينا جانبان؛ فهناك ما يتعلّق بالزيادات على المعنى التفسيري في التآليف، وهناك ما يتعلّق بوضعية هذا المعنى في التصانيف:
فأمّا الأول؛ فإنّ التآليف التي يظهر فيها توسّع في الزيادة على المعنى بينها اختلاف في هذا التوسّع وقدره وطبيعته، وبصورة عامة يمكننا أن نقول:
- بعض التآليف تهتم بالمعنى ويقع فيها ذكرٌ لمادة مختلفة تحتاج لتأمل في ضوء مدى اتصالها بالمعنى، وهل لها مساس به أم أنها من قبيل الزيادة التي لا أثر لها في هذا الأمر من أيّ جانب؛ وذلك مثلًا كتفسير الزمخشري وأبي حيان والآلوسي وابن عاشور، حيث يغلب عليها ذكر مادة لغوية وبلاغية ونحوية، وتفسير ابن كثير والذي يغلب عليه ذكر المرويات الحديثية.
- بعض التآليف يقع فيها اهتمامٌ كبيرٌ بالمعنى مع التوسّع في ذكر زيادات يظهر عدم اتصالها به؛ كتفسير الرازي والذي يتوسّع بذكر مباحث كلامية وأصولية يظهر عدم اتصالها بالمعنى.
- بعض التآليف يكون اهتمامها بالمعنى ضعيفًا جدًّا ويغلب عليها بصورة كلية الخروج عنه إلى ذكر زيادات أخرى؛ كتفسير الظلال والتفسير الحديث والتفسير القرآني للقرآن.
ويمكننا هاهنا أن نقول بأن التآليف التي يبرز فيها الاهتمام بالمعنى التفسيري مع الخروج عليه بغضّ النظر عن مساحة هذا الخروج من السائغ تصنيفها باعتبارها كتب تفسير؛ لظهور اتصالها بالمعنى التفسيري، وأمّا التآليف التي يكاد لا يلحظ لها عناية بالمعنى أصلًا وتكون رأسًا في ذكر أمور أخرى هي المقصودة لديها؛ من ذكرِ مناهج القرآن إزاء بعض القضايا وربط الآيات بالواقع...إلخ، فإن اعتبارها مصنفات تفسيرية مما لا يخلو من نظر؛ لأن مادتها تكاد لا تتصل بالتفسير إلا عرضًا؛ فالمعنى ليس سوى وسيلة لبلوغ غرض آخر تمامًا؛ ومن ثَم فالأَوْلى النظر في هذه الأغراض وأنْ نصنّفها بما يناسبها ولا نصنفها باعتبارها كتب تفسير.
أما عن إشكال وضعية المعنى التفسيري في التآليف، فقد بينّا إشكال غلبة المعنى اللغوي على عدد من التصانيف، ويمكننا القول -بصورة عامة-:
- هناك تآليف لم تهتمّ بإنتاج معنى تفسيري أصلًا، وما يأتي فيها من ذكرٍ للمعاني فهو متصل بطبيعة أغراضها النحوية واللغوية والإعرابية؛ كما نجده في كتب المعاني كالفراء والزجاج.
- هناك تآليف أخرى يظهر انطلاقها في ممارسة التفسير من التبيين اللغوي المجرد؛ كمجاز القرآن لأبي عبيدة.
- هناك تآليف وقع الاختلاط في ممارستها التفسيرية وإنْ غلَب عليها طابع التبيين اللغوي؛ وهو غالب المعاني المنتجة بعد السلف في التصنيف التفسيري.
وظاهرٌ أنّ التآليف التي لم تهتم بإنتاج معنى تفسيري فإنّ تصنيف معانيها ضمن إطار التفسير فيه نظر؛ لأنها لم تقصد لذلك. وأمّا المعاني التي نتجت عن تجربة تبيين لغوي ظاهرة كتجربة أبي عبيدة، فإنها معاني ظاهرة الإشكال منهجيًّا في تأسيسها ويجب الحذر عمومًا في البناء عليها. وأمّا المعاني التي كانت حصيلة تجارب بيانية وقع فيها الاختلاط مع غلبةٍ للتبيين اللغوي فإنها ليست كالسابقة وإن بقيت معانيها بحاجة لدراسات تجلي الموقف منها حتى يتيسر البناء عليها بشكلٍ منهجيّ محرّر.
خاتمة:
ظهر لنا من خلال ما سبق أن التفسير يعاني من إشكالات شديدة العمق، وبدَتْ لنا حالة الضبابية التي تعتري حيثيته ومفهومه؛ مما أورث التفسير عدم انضباط في معاقده الرئيسة من حيث هو فنّ له حيثية ظاهرة ومفهوم محدّد...إلخ. وقد كان لهذا الأمر آثار عديدة، كما نجَم عنه إشكالات كثيرة في ساحة الدرس التفسيري، وهو الأمر الذي حاولنا أن نقاربه ونطرح له حلولًا من خلال مناقشة المرتكزات والمعاقد الرئيسة لعلم التفسير، والتي تمثّلت في حيثيته ومفهومه وطبيعة المعنى التفسيري ومفهوم المفسِّر وأدوات التفسير، حيث اجتهدنا في مناقشة هذه المفاصل المركزية وطرحنا طرحًا اجتهاديًّا إزاءها، كما حاولنا مناقشة بعض الإشكالات الأخرى في العلم، لا سيّما الموقف من البناء النظري للتفسير وكيفية التعامل مع مصنفاته وتآليفه، وبيان جانب من كيفيات معالجة هذه الإشكالات. وصحيح أن الاجتهادات في أمثال هذه القضايا مما يعتورها إشكالات وعدم انضباط في بعض مناحيها، لكننا نعتبرها كالبيضة المارجة التي توضع للدجاجة حتى تأتي بأخرى صحيحة، ونرجو أن تكون هذه المقاربة على كلّ حال سبيلًا لتحقيق الوعي المعمّق بإشكالات التفسير وفاتحةً لتحريرها وإثراء الدرس فيها، خاصة وأن هذه المشاغل المعرفية تعاني فقرًا وإهمالًا كبيرًا في ساحة الدرس التفسيري رغم عظيم أهميتها في ضبط النظر للتفسير؛ فهمًا لواقعه وتقويمًا لحصاده وتدريسًا لمادته وتوجيهًا لدفة الجهد القابل في ميادينه، حتى يتحقق الارتقاءُ الراشد بالفنّ وسدُّ ثغراته والبلوغُ به لِما يحقق غاياته وإحداث تراكم علمي مفيد ومثمر في ساحته على صُعُد مختلفة، واللهُ الموفِّق.
[1] أشَرتُ في كتابات متفرّقة لإشكالات التفسير ومسالك معالجتها، وفي هذا القسم من المقالة تكثيف لتلك الكتابات ونَظْم لها في إطارٍ جامع ليسهل الوقوف على ملامحها مكتملة، وكذلك مراجعة وتنقيح لبعض ما أوردته فيها، وزيادة أيضًا لبعض الأمور التي ظهرت لنا من خلال البحث.
[2] يقول محمد عبده في بيان توجهات مادة التفاسير: «التفسير له وجوه شتى: (أحدها): النظر في أساليب الكتاب ومعانيه وما اشتمل عليه من أنواع البلاغة ليعرف به علوّ الكلام وامتيازه على غيره من القول، سلك هذا المسلك الزمخشري، وقد ألـمّ بشيء من المقاصد الأخرى ونحا نحوه آخرون. (ثانيها): الإعراب؛ وقد اعتنى بهذا أقوام توسّعوا في بيان وجوهه وما تحتمله الألفاظ منها. (ثالثها): تتبع القصص، وقد سلك هذا المسلك أقوام زادوا في قصص القرآن ما شاؤوا من كتب التاريخ والإسرائيليات، ولم يعتمدوا على التوراة والإنجيل والكتب المعتمدة عند أهل الكتاب وغيرهم، بل أخذوا جميع ما سمعوه عنهم من غير تفريق بين غثّ وسمين، ولا تنقيح لما يخالف الشرع ولا يطابق العقل. (رابعها): غريب القرآن. (خامسها): الأحكام الشرعية من عبادات ومعاملات والاستنباط منها. وقد جمع بعضهم آيات الأحكام وفسروها وحدها. ومن أشهرهم أبو بكر بن العربي وكلّ مَن يغلب عليهم الفقه من المفسرين، يُعْنَون بتفسير آيات أحكام العبادات والمعاملات أكثر من عنايتهم بسائر الآيات. (سادسها): الكلام في أصول العقائد ومقارعة الزائغين، ومحاجّة المختلفين. وللإمام الرازي العناية الكبرى بهذا النوع. (سابعها): المواعظ والرقائق، وقد مزجها الذين ولعوا بها بحكايات المتصوفة والعبّاد، وخرجوا ببعض ذلك عن حدود الفضائل والآداب التي وضعها القرآن. (ثامنها): ما يسمونه بالإشارة، وقد اشتبه على الناس فيه كلام الباطنية بكلام الصوفية». تفسير المنار، (1/ 17-18). ويمكن أن يضاف إليها كذلك بحث وجوه التناسب بين الآيات والسور، وكذا استقراء موضوعات السور وبيان مقاصد النصّ، وكذا إبراز منهج القرآن وتصوراته إزاء العديد من القضايا. يراجع في الإشارة لبعض ذلك: التحرير والتنوير، (1/ 8).
[3] التيسير في قواعد علم التفسير، ت: المطرودي، دار القلم-دار الرفاعي، ط: الأولى، 1410هـ-1990م، (ص124-125). وعرّف الكافيجي التفسير مرّة أخرى، فقال: «علم يُبْحَث فيه عن أحوال كلام الله المجيد من حيث إنه يدلّ على المراد بحسب الطاقة البشرية». التيسير في قواعد علم التفسير، (ص150).
[4] رجّح الدكتور مساعد الطيار أن التفسير هو: «بيان معاني القرآن». يراجع: مفهوم التفسير والتأويل والاستنباط والتدبّر والمفسر، دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية، ط: الثانية، 1427هـ، (ص51) وما بعدها.
[5] عرّف أبو حيان التفسير بقوله: «التفسيرُ: علم يُبْحَث فيه عن كيفيةِ النطق بألفاظ القرآن، ومدلولاتها وأحكامِها الإفرادية والتركيبية، ومعانيها التي تُحْمَل عليها حالة التركيب، وتَتِمَّات ذلك». البحر المحيط، ت: صدقي محمد جميل، دار الفكر - بيروت، ط: 1420هـ، (1/ 26).
[6] عرّف الزركشي التفسير بأنه: «علم يُعْرَف به فهْمُ كتاب الله المنزل على نبيه محمد -صلى الله عليه وسلم-، وبيان معانيه، واستخراج أحكامه وحِكَمِهِ». البرهان في علوم القرآن، ت: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعرفة - بيروت، 1391، (1/ 13). وعرَّفَه مرة أخرى بأنه: «علمُ نزول الآية، وسورتها وأقاصيصها، والإشارات النازلة فيها، ثم ترتيب مَكيِّها ومدَنِيِّها، ومُحكَمِها ومُتشابِهِها، وناسِخِها ومَنسوخِها، وخَاصِّها وعامِّها، ومُطلَقِها ومُقَيَّدِها، ومُجمَلِها ومُفَسَّرِها». البرهان، (2/ 148).
[7] يقول محمد عبده مبينًا مفهوم التفسير عنده: «والتفسير الذي نطلبه هو فهم الكتاب من حيث هو دِين يرشد الناس إلى ما فيه سعادتهم في حياتهم الدنيا وحياتهم الآخرة». تفسير المنار، (1/ 21).
[8] عرّف ابن عاشور التفسير بأنه: «اسم للعلم الباحث عن بيان معاني ألفاظ القرآن وما يستفاد منها باختصار أو توسع». التحرير والتنوير، محمد الطاهر بن عاشور، (1/ 11).
[9] المتأمل في تعريفات التفسير يجد أن جلّها ليست لمفسرين، كما أنها تأتي بطريقة عابرة في المصنفات -خاصة الوارد في كتب علوم القرآن- بلا أيّ تأسيس منهجي، فضلًا عما ينتاب بعضها من تباين من قِبل المعرّف الواحد، وكذلك لم تحظ هذه التعريفات بنقاش موسّع كما العادة في تعريفات اصطلاحات الفنون؛ ولذا فإن اعتبارها تعريفات معيارية ممثلة للواقع التطبيقي للتفسير وبناء أحكام على هذا الواقع من خلالها فقط ربما يكون محلّ إشكال.
[10] التبيان في أقسام القرآن، ت: حامد الفقي، دار المعرفة-بيروت، (ص79)، بدون تاريخ.
[11] بحث منشور بمجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية، العدد 192، الجزء الأول، السنة 53، رجب 1441هـ، (ص12-54).
[12] يراجع: التفسير اللغوي، مفهوم التفسير والاستنباط والتدبّر. ويلاحظ أن بعض الدارسين -ممن يرون عدم سعة مفهوم التفسير- ينسبون تعريف التفسير وأنه بيان المعاني إلى ابن عثيمين -رحمه الله- باعتباره أسبق بذكره من الدكتور مساعد، في حين أن نسبته للدكتور مساعد بنظري هي الأدقّ والتي تفرضها عناية الدكتور مساعد بالتأصيل الموسّع لمفهوم التفسير ونزعه الواضح لقصره على الاشتغال بالمعنى دون توسّع، بخلاف ابن عثيمين والذي يظهر لمن يطالع تراثه التفسيري نزعه لسعة مفهوم التفسير وعدم انتباهه أصلًا لجدل المفهوم وتحريره.
[13] كالدكتور محمد صالح في بحثه: مفهوم التفسير بين صُلْب التفسير وتوابعه، محمد صالح سليمان، ضمن بحوث المؤتمر العالمي الثالث للباحثين في القرآن الكريم وعلومه: «بناء علم أصول التفسير؛ الواقع والآفاق»، والذي عقد بالمغرب بمدينة فاس عام 1436هـ-2015م. ويلاحظ أن الدكتور محمد صالح كأنّه تراجع عن هذا النظر في بحثه السابق والذي نحا فيه لنفي القدر المشترك والمتمثّل في بيان المعنى من أن يكون سياجًا ضابطًا للعمل التفسيري كما مرّ.
[14] وهو الأمر الذي سنجتهد في تفاديه في طرحنا لمعالجة إشكالات التفسير كما سيأتي؛ إذ سنجعل تأسيس ما نختاره قائمًا على معيار منهجي ملزم من داخل العلم ذاته؛ ليكون النظر للمفاهيم والدلالات المتعلقة بالتفسير نظرًا تقويميًّا لبيان صوابها من غلطها وصحيحها من زائفها وليس مجرد اختيار لا يمنع غيره.
[15] وقد بلغ عدد صفحاته (135) صفحة شاملة المقدمة والفهارس، وقد صدر هذا الكتاب عن دار اليسر، القاهرة، 2016.
[16] التقرير للمبادئ العشرة في علم التفسير، (ص14).
[17] وهو عبارة عن مجموعة أبحاث، بتحرير د/ نايف الزهراني. والكتاب صادر عن مركز تكوين للدراسات والأبحاث، 1440هـ-2019م.
[18] ولهذا إشكالات كثيرة جدًّا؛ إذ يصور أن البناء النظري للمعنى التفسيري قائم ومقرّر، وهو خلاف الواقع كما سنبيّن.
[19] جدير بالنظر أننا قصدنا هاهنا بيان إشكال الفكرة الكلية لكتاب «صناعة التفكير في علم التفسير»، وأنها ليست كالمتوقّع في ضوء عنوان الكتاب، إلا أن سائر بحوث الكتاب -بغضّ النظر عمّا بينها من تفاوت ظاهر في الجودة والإحكام- تحوي إشكالات كثيرة في مناحٍ مختلفة، ولعلّ الله ييسر لنا الكتابة عنها لاحقًا.
[20] تفسير السلف؛ الأهمية والضرورة، خليل محمود اليماني، مقالة منشورة على موقع تفسير تحت الرابط التالي: tafsir.net/article/5274.
[21] التيسير في قواعد التفسير، ص157-158. قد أشار الكافيجي قبل (ص151) لكون علم التفسير يطلق أيضًا على «قواعد مخصوصة، كما تقول: فلان يعلم علم التفسير، تريد به قواعده. ويطلق على التصديقات بقواعده». وسواء أكان يقصد بعلم التفسير: التفسير من حيث هو علم متكامل باعتباره يختلف عن التفسير من حيث هو عملية متعلقة ببيان المعنى، أم يقصد به علم قواعد التفسير؛ فإن كلامه واضح جدًّا في الدلالة على تمايز حيثيّة التفسير عن غيره ببيان المعنى، وإلا فلو كان القصد قواعد التفسير فإن التقعيد للفنون لا يتم إلا في ضوء حيثيتها المفارقة، وبالتالي فإن تقييده له ببناء المعنى فقط يدلّ على أن هذه هي الحيثية المميزة للتفسير ذاته، والتي يجب التقعيد له في ضوئها.
[22] معايير القبول والردّ لتفسير النصّ القرآني، دار الغوثاني للطباعة والنشر، ط:1، 1428هـ-2008م. وقد ذكر الدكتور عبد القادر بعد ذلك اتفاق قواعد التفسير مع الأصول في مباحث الدلالة والبيان وكيفية استنباط الأحكام من النصّ، وقضايا التعارض والترجيح في بعض جزئياتها ومسائل النسخ. ولا يخفى أن بعض وجوه الاتفاق التي ذكرها متوقّف على مفهوم التفسير سعةً وضيقًا، ومفهوم الدلالة التفسيرية ومدى اختلافها أو اتفاقها مع مفهوم الدلالة الأصولية.
[23] للتوسع في الكلام على هاتين الدائرتين يراجع مقالتنا «معيار تقويم كتب التفسير؛ تحرير وتأصيل»، وهي منشورة على موقع تفسير على الرابط التالي: tafsir.net/article/5110.
[24] قراءة نقدية للتأصيل التيمي لتوظيف الإسرائيليات في التفسير (2)، خليل محمود اليماني، مقالة منشورة على موقع تفسير، تحت الرابط التالي: tafsir.net/article/5166.
[25] يطلق أحيانًا بعض المفسرين لفظ (السلف) على الصحابة -رضي الله عنهم-، ولفظ (الخَلَف) على التابعين، ولكن الغالب هو إطلاق لفظ السلف على الطبقات الثلاث المعروفة.
[26] اختلاف السلف في التفسير بين التنظير والتطبيق، محمد صالح سليمان، مركز تفسير، ط: الثانية، 1436هـ-2015م، (ص31).
[27] قطف الأزهار في كشف الأسرار، ت: أحمد الحمادي، إصدار وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية-الدوحة، 1414هـ-1994م، (ص91).
[28] يراجع: تفسير السلف؛ الأهمية والضرورة، خليل محمود اليماني. مقالة منشورة على موقع تفسير تحت الرابط التالي: tafsir.net/article/5274.
[29] يراجع: تفسير السلف؛ الأهمية والضرورة، خليل محمود اليماني.
[30] يراجع: تفسير السلف؛ الأهمية والضرورة.
[31] نحا الدكتور نايف الزهراني إلى تعريف التفسير ببيان المعنى المراد، وذلك منه نظر دقيق. يراجع: بحث «صناعة الدليل في علم التفسير»، وهو ضمن كتاب: صناعة التفكير في علم التفسير.
[32] ولذا فإننا درجنا في المقالة على استخدام اصطلاح التفسير وإن كان في صلاحيته على ممارسة بيان المعنى المراد نظر.
[33] الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، دار الكتاب العربي-بيروت، ط: الثالثة، 1407هـ، (1/ 2).
[34] البحر المحيط في التفسير، ت: صدقي محمد جميل، دار الفكر-بيروت، 1420هـ، (1/ 10).
[35] قمنا بكتابة مجموعة كتابات مركّزة حول هذه القضية، وهي منشورة على موقع تفسير.
[36] قد عالجنا في مقال: (تقويم كتب التفسير؛ تحرير وتأصيل) إشكالَ ضابطِ المفاضلة بين كتب التفسير وكيفية بناء معيار محرّر للتعامل مع هذه القضية.
[37] أبجديات البحث في العلوم الشرعية، فريد الأنصاري، دار السلام، ط: الأولى، 1431هـ-2010م، (ص194).
[38] يراجع: التأليف المعاصر في قواعد التفسير؛ دراسة نقدية لمنهجية الحكم بالقاعدية، محمد صالح سليمان، خليل محمود اليماني، محمود حمد السيد، مركز تفسير للدراسات القرآنية، 2020م.
[39] أشرنا إشارة موجزة للفارق بين الدلالتين وضعف جدوى توظيف مباحث الدلالة من النسق الأصولي في ساحة التفسير. يراجع: مقالتنا: تفسير السلف؛ الأهمية والضرورة.
كلمات مفتاحية
الكاتب:

خليل محمود اليماني
باحث في الدراسات القرآنية، عضو هيئة تدريس بجامعة الأزهر، له عدد من الكتابات والبحوث المنشورة.
مواضيع ذات صلة
((المعلومات والآراء المقدَّمة هي للكتّاب، ولا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع أو أسرة مركز تفسير))