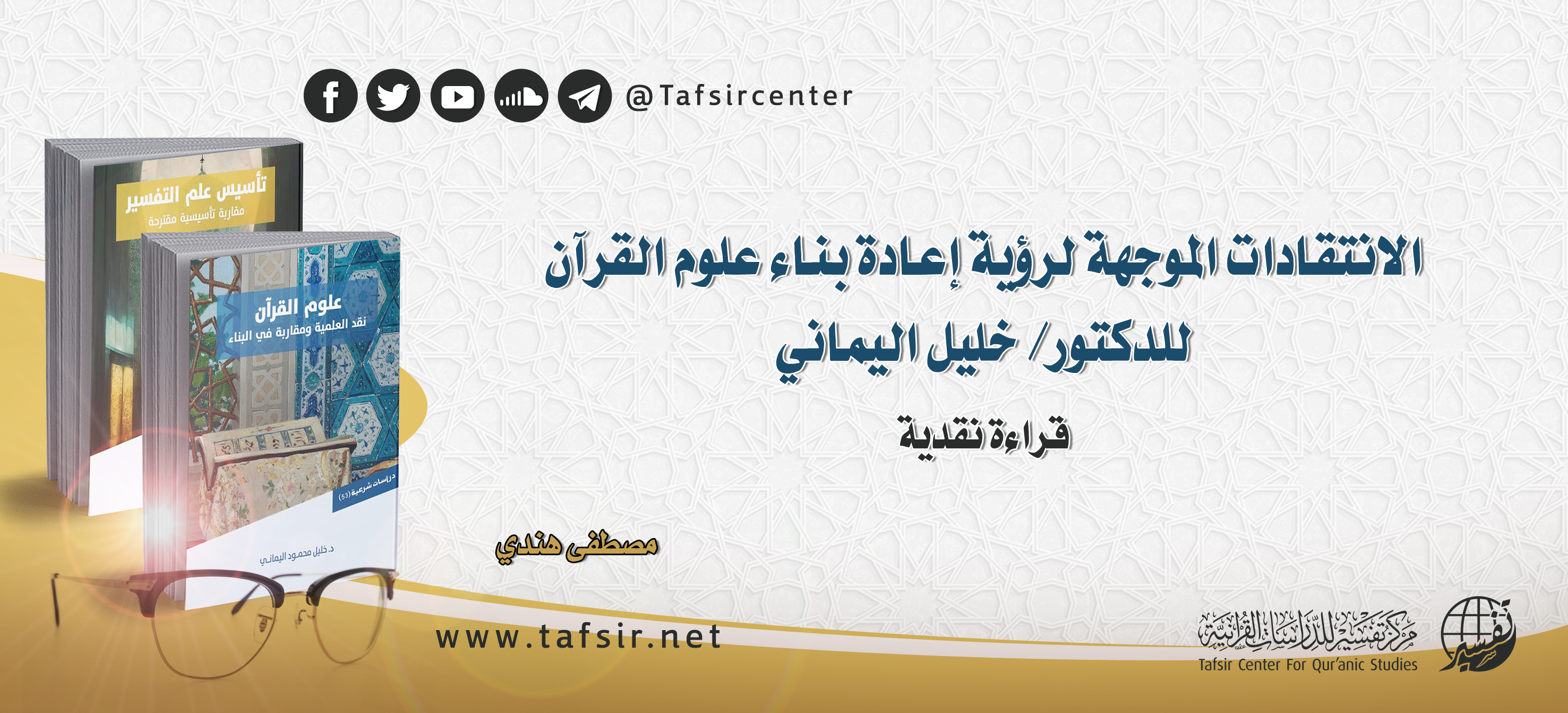قراءة نقدية لتأصيل ابن تيمية لتوظيف الإسرائيليات في التفسير (2-3)
منطلق ابن تيمية في بحث المسألة؛ مناقشة وتقويم
الكاتب: خليل محمود اليماني

سبق معنا في المقالة السابقة[1] أن منطلق طَرْح ابن تيمية لمسألة توظيف واستحضار المرويات الإسرائيلية هو أنها كانت مجالًا ينقل منه المفسِّر، وفي هذه المقالة سنحاول تقييم هذا المنطلق التيمي، وبيان مقدار وجاهة اعتماده كأصلٍ ضابطٍ للنظر لدى بحث المسألة ومناقشتها، وبيان ذلك على النحو التالي:
إنّ المتأمل في هذا المنطلق التيمي في النظر للمرويات الإسرائيلية في تفسير السلف وأنها كانت مجالًا للنقل، يجده منطلقًا مشكلًا جدًّا، ويتجلَّى غلطه من جوانب عديدة؛ أبرزها ما يلي:
أولًا: معارضته لحيثيّة التفسير:
لكي نفهم أحد المسائل والقضايا المبثوثة في رَحِمِ أحدِ الفنون والخروج بمقررات علميّة إزاءها، فإنّ علينا أن ننظر إليها من خلال حيثيّة الفنّ ذاته؛ وذلك لما لهذه الحيثيّة من أثر عظيم في طريقة النظر للمسألة وفهمها على الوجه الصحيح واللائق بها في الفنّ؛ لأننا متى أغفلنا ذلك اضطرب النظر واستغلق فهم وجه المراد من المسألة في الفنّ.
ولا شك أننا حال أردنا نظر مسألة المرويات الإسرائيلية في التفسير وَتَبَيّن طبيعة أغراض مُورِديها ومسالك توظيفهم لها، فإنّ علينا أن ننظر أولًا في حيثية التفسير وطبيعة غرضه.
حيثيّة التفسير وتحديدها:
إنّ التفسير -كما هو معلوم- يعاني مفهومه من تفاوت دلالي واسع، يمتدّ من بيان المعنى إلى استخراج الأحكام وسرد اللطائف والهدايات والمقاصد وغيرها، كما هو معلوم وظاهر من تفاوت تعريفاته ومادة التفسير في مصنفاته، إلا أننا رغم تفاوت دلالاته وتشعّبها يمكننا أن نميّز دوائرها بصورة عامّة إلى دائرتين رئيستين:
الأولى: دائرة بيان المعنى[2].
الثانية: دائرة ما فوق المعنى من استخراج الأحكام والهدايات...إلخ[3].
إننا متى نظرنا للتفسير من خلال هاتين الدائرتين فيمكننا أن نلحظ بوضوح أنّ التفسير تبعًا للدائرة الأولى ستكون حيثيته المميزة له هي بيان المعنى وتحصيله، وهي حيثيّة مفارقة لبقيّة الفنون التي تُعْنَى بالنظر للقرآن الكريم وتعمل من خلاله، وأما في الدائرة الثانية فمن الصعب الوقوف له على حيثية خاصّة؛ إذ يبدو واقعه متداخلًا بصورة بيِّنة مع حيثيات العديد من الفنون الأخرى كالفقه والأصول وغيرها[4].
يقول الكافيجي: «لكلّ علم من العلوم المخصوصة كالفقه والأصول والنحو والصّرف إلى غير ذلك موضوع يبحث فيه عن أحواله، فيكون لعلم التفسير موضوع يبحث فيه عن أحواله، فموضوعه كلام الله العزيز، من حيث إنه يدلّ على المراد؛ وإنما قُيِّد بهذه الحيثية ليكون ممتازًا عن موضوع العلم الآخر؛ فإنّ الكتاب داخل -إن لم يقيَّد بها- تحت موضوع علم الأصول، من حيث إنه يستفاد منه الأحكام إجمالًا، ويندرج أيضًا -إن لم يتقيَّد بها- تحت موضوعات علوم أُخَر، بحسب اعتبار حيثيّات أُخَر»[5].
يقول عبد القادر الحسين: «علم أصول الفقه جاء لبيان كيفية التعامل مع النصوص وكيفية تفسيرها سواء أكانت قرآنية أو غيرها... إلَّا أنَّ علمَ أصول الفقه ألصقُ بالأحكام وأفعال المكلَّفِين؛ فهو يدرس الحاكم الذي هو الله، والحُكم الذي هو خطابه، والمحكوم الذي هو المكلَّف... فهو أخصّ من قواعد التفسير من هذه الجهة، فالتفسير شامل للقرآن الكريم بما فيه من عقائد أو أحكام أو أخبار وقصص. كما أنه من جهة أخرى أعمّ من قواعد التفسير؛ إذ يدرس قضايا الرواية وأخبار الآحاد وقضايا التكليف والافتراضات العقلية كمسائل التكليف بما لا يطاق ونحوها... وقواعد التفسير أعمّ من أصول الفقه؛ إِذْ لا تختص بالأحكام وأفعال المكلَّفِين، ومن ناحية أخرى هي أخصّ؛ هي منصبَّة على النصّ القرآني بشكلٍ خاصّ فلا تدرس القياس ولا الاستحسان... وإنْ تعرضَتْ لشيء من ذلك فليس لذاته إنما يكون مساعدًا لتفسير النصّ القرآني»[6].
إننا عند محاولة استكشاف التوظيف الواقع من قِبل مَن أورد المرويات الإسرائيلية في التفسير فلا بد من النظر في مفهوم التفسير عنده وفي أيّ الدائرتين وقع؛ لأننا تبعًا للدائرة الأولى سيكون متمايزًا لدينا موضوع بيان المعنى (كشف مدلولات الألفاظ والدلالة على المراد من التراكيب)، والذي يمثّل حيثية مؤثِّرة في بحث المسألة تستأهل النظر الخاصّ، وإلا فبحثها تبعًا للدائرة الثانية التي يوجد فيها استخراج الأحكام، فإنه سيتقاطع حتمًا مع بعض الفنون الأخرى لا سيما الأصول؛ لاعتنائها بهذه المساحة، وبالتالي استحضار مقرّراتها غالبًا عند النظر بصورة أو بأخرى في النظر؛ لعدم ظهور تمايز التفسير بحيثيّة خاصّة عنهما غالبًا.
واقع حضور المرويات الإسرائيلية في دوائر التفسير:
إنّ الناظر للتفسير الذي مثَّلَت المرويات الإسرائيلية حضورًا فيه سيجد أنه يقع بصورة رئيسة في مرويات السلف في التفسير، وبطبيعة الحال التفاسير التي اعتنَتْ بإيراد هذه المرويات وعملَتْ من خلالها؛ كتفسير الطبري وغيره من الكتب الناقلة للوارد عنهم كما هو معلوم.
والناظر في مفهوم التفسير في تفسير السلف يجد أنّ جُلّه ينحو لبيان المعنى وما يرتبط به من امتدادات، لا التوسّع فيما وراء ذلك من استخراج الأحكام والحِكَم، وهو أمرٌ له شواهد عديدة؛ أبرزها:
أولًا: مطالعة مروياتهم في التفسير: فالناظر في مقولاتهم التفسيرية يجد أن جلَّها ينحو لبيان المعنى وفكِّ دلالاته وتأكيده ودَعْمه، لا التوسّع في سرد الأحكام والنّكات واللطائف...إلخ، مما تجد له حضورًا في التفاسير الموسِّعة للمفهوم.
ثانيًا: اشتغال الطبري بمقولاتهم في التفسير: إنّ تفسير الطبري يعدُّ على طوله أبرز التفاسير التي اعتنت بتحرير المعاني وعدم الاستطراد فيما وراءها مما تجده في كثير من التفاسير الموسِّعة للمفهوم، فالطبري صرَّح في مقدمته بجلاء برغبته في استيعاب الكلام على المعاني، حيث قال: «ونحن -في شرح تأويله، وبيان ما فيه من معانيه- مُنشِئُون -إن شاء الله ذلك- كتابًا مستوعِبًا لكلّ ما بالناس إليه الحاجة من علمه جامعًا... ومخبرون في كلّ ذلك بما انتهى إلينا من اتفاق الحُجّة فيما اتفقَتْ عليه منهُ، واختلافها فيما اختلفَتْ فيه منهُ، ومُبيِّنو عِلَلَ كلّ مذهب من مذاهبهم، ومُوَضِّحو الصحيح لدينا من ذلك، بأوجز ما أمكن من الإيجاز في ذلك»[7]. فالطبري رغب أن يكون جامعًا للمعاني التفسيرية ومحررًا لصحيحها من ضعيفها، وهو ما أعطاه مركزيّة في التفسير بتمامه كون تبيين المعنى هو صلب التفسير، وهو ما قررناه على نحوٍ خاصّ في مقالتنا: «تفسير الطبري؛ قراءة في أسباب مركزيته في التفسير»[8].
والمتأمّل في مادة كتاب الطبري يجد أنّ قوامها هو مرويات السلف التفسيرية لا غير، وهو الأمر الذي يبرز بجلاء وضوحَ عملية التبيين للمعنى في مروياتهم ودوران مقولاتهم عليها رأسًا؛ ولهذا لمّا رغب الطبري في عَقْد كتاب لاستيعاب المعاني والكلام عليها وتحرير القول فيها كما ذَكر في مقدمته، قام بجمع مرويّات السلف في التفسير ووازن بينها.
وإذا كان مفهوم التفسير لدى المفسِّرين من السلف مرتكزًا على تبيين المعاني وكشف مدلولات الألفاظ وما يتعلق بذلك بصورة رئيسة، فلا شك أننا صِرنا إزاء الحيثيّة المميّزة للتفسير، والتي سيكون من المهمّ استحضارها عند النظر لمسألة المرويات الإسرائيلية؛ لِمَا لها من أثرٍ فارق في فهم طبيعة الإفادة منها واستحضارها وكيفيات توظيفها.
النظر للمرويّات الإسرائيلية في تفسير السلف وفقًا لحيثيّة التفسير:
إنّ المفسِّر المشتغل بتبيين المعنى يكون النظر معقودًا لسائر المادة التي يستحضرها إبّان تبيينه للمعاني على أنها أدوات لتحصيل المعنى والوصول إليه، وبالتالي فإنّ منطلق النظر للمرويات الإسرائيلية في تفسير السلف سيكون منبنيًا على هذا الاعتبار لا غير؛ فَبِغَضّ النظر عن تقييمنا لجدوَى التبيين الذي ترتّب على حضورها في التفسير، وهل كان مفيدًا أم لا؟ إلا أنّ منطلق النظر الحاكم لها في التفسير لدى الدرس يجب أن يكون مقيدًا باعتبارها أداةَ تبيين لا مصدرًا للنقل كما هو الحال مع الأشعار الجاهلية وغيرها مما يورده المفسّر ليستدلّ به على معاني الآيات لا لينقله منها، وهو الأمر الذي انتبه له شاكر وحرَّره بجلاء، حيث قال في أحد حواشيه النفيسة على تفسير الطبري: «تبيَّنَ لي مما راجعته من كلام الطبري، أن استدلال الطبري بهذه الآثار التي يرويها بأسانيدها، لا يراد به إلا تحقيق معنى لفظ، أو بيان سياق عبارة... وهذا مذهب لا بأس به في الاستدلال، ومثله أيضًا ما يسوقه من الأخبار والآثار التي لا يشكُّ في ضعفها، أو في كونها من الإسرائيليات، فهو لم يسُقْها لتكون مهيمنة على تفسير آي التنزيل الكريم، بل يسوق الطويل الطويل، لبيان معنى لفظ، أو سياق حادثة، وإن كان الأثر نفسه مما لا تقوم به الحجة في الدّين، ولا في التفسير التامِّ لآي كتاب الله.
فاستدلال الطبري بما ينكره المنكِرون، لم يكن إلا استظهارًا للمعاني التي تدلّ عليها ألفاظ هذا الكتاب الكريم، كما يستظهر بالشّعر على معانيها، فهو إذن استدلال يكاد يكون لغويًّا؛ ولما لم يكن مستنكَرًا أن يُستدلّ بالشعر الذي كذب قائله ما صحَّت لغته؛ فليس بمستنكَر أن تُساق الآثار التي لا يرتضيها أهل الحديث، والتي لا تقوم بها الحُجّة في الدين؛ للدلالة على المعنى المفهوم من صريح لفظ القرآن، وكيف فهمه الأوائل، سواء كانوا من الصحابة أو مَن دونهم»[9].
وكلامه بيِّن في كون منطلق النظر عنده للمرويات الإسرائيلية من خلال تتبُّعه لحضورها في تفسير الطبري أنها أداة من الأدوات الموظَّفة في تبيين المعنى كما الأشعار الجاهلية، وأنها تُفهم في هذا الإطار.
إننا في ضوء ما مرّ معنا يمكننا القول بوضوح أنّ منطلق النظر النقلي للمرويات في التفسير يتعارض جذريًّا مع حيثية التفسير ومهمّة المفسِّر المشتغل بالتبيين؛ إذ يجعل ميدان التفسير قريبًا من ميدان التاريخ، حيث تسرد فيه منقولات وروايات لذات الرواية، والمفسِّر أقرب لإخباري منه لمفسِّر حيث ينقل معلومات ومضامين ويسردها لمجرد النقل والرواية لا أنه يبيّن نصًّا قرآنيًّا لألفاظه دلالات لغوية وسياقات لا يمكنه الانفلات منها، وكذلك له جملة مقاصد وأنساق لا يسعه معارضتها، وغير ذلك من القرائن التي تحكم العمل التفسيري؛ ومن ثَمّ فإنّ ما يرجع إليه المفسِّر من أدوات إبّان التفسير فإنه رجوع توظيفي واستدلالي في ضوء القرائن اللغوية والسياقية الحاكمة للتفسير ومعطياتها، وإن مقولته حتى لو كانت في ظاهرها مستمدّة من هذه الأدوات فإنّ هذا لا يخرجها ألبتة عن كونها مقولة تفسيرية أنتجها تبعًا لقرائن استدلالية معيَّنة ترتبط بالنصّ المفسَّر وليست نقلًا، وبالتالي يُبحث معه في وجاهة قوله من عدمه في قرائن التبيين عنده لا الأدوات التي ساقها، وإلَّا فإنّ النظر النقلي يجعلنا لا نعتبر قوله تفسيرًا واجتهادًا وإنما هو نَقْل، ونحاكم قوله لا تبعًا لقرائن التبيين؛ وإنما بالنظر في مضمون المرويات ذاتها ومدى موافقتها للشرع من عدمه، ونؤصِّل للمسألة عنده لا بناءً على قرائن التوظيف ومستنداته وعِلَله؛ وإنما لمضامين المرويات ودرجات الاحتجاج بها في الدِّين كما سيأتي، وهو أمر يخرج بنا تمامًا عن سياق التفسير وعمل المفسِّر.
ثانيًا: خطورة لوازمه وعدم إمكان القول بها:
إنّ النظر النقلي عن المرويات الإسرائيلية في تفسير السلف يثير عددًا من اللوازم الخطيرة التي لا يمكن القول بها، أهمها ما يلي:
أولًا: عودُه على حُجِّيّة السّلَف بالإبطال:
إنّ المرويات الإسرائيلية ليست من جنس الأدلة الشرعية التي يُستعان بها في تقرير أمور داخل الشريعة والدِّين وبها العديد والعديد مما يخالف الشرع، فإذا تصوّرنا مع ذلك أنَّ مَن لجأ إليها وتتابع على إيرادها هم طبقة السلف -رضوان الله عليهم-، وأنَّ لجوءهم كان نقليًّا عن هذه المرويات في التفسير لا توظيفيًّا لها في سياق التبيين فإنّ ذلك سيُفضي بنا حتمًا إلى اعتبار السلف قد استمدوا ونقلوا أمورًا مشكلة ومعارضة لصحيح الدِّين من مصدر أجنبي مشكلٍ ودسُّوها في التفسير، وهو قول لازمه بداهةً الطعن في حجيّة السلف؛ إِذْ هم حمَلة الشرع ونقَلته إلينا، واعتبارهم كانوا عرضة لرواية ما لا يجوز روايته والتتابع على ذكره ونَقْله على اختلاف طبقاتهم رغم مخالفته الشرعية يطعن -بلا ريب- في حجيتهم بصورة بالغة؛ لأنَّ بصرهم بما هو شرع ودين غير منضبط ويجوز وقوع الخطأ فيه على جميعهم، وأنْ يقع منهم التتابع عليه، كما أنه ينزع عنهم أحد أهم خصائصهم -كحِقبة تمثّل النّبْع الصافي- في إدراك التصوّر الشرعي قبل ظهور المؤثِّرات الأجنبية على الأفكار...إلخ، وهو ما يوجب أن يكون الموقف منهم كغيرهم ممن يحتمل تأثرهم بمؤثرات أجنبية معارضة للشرع والدّين، وأن تكون أقوالهم بحاجة للحَذَر عند التعامل معها ويتوجب مراجعة مضامينها في ضوء مقررات الشرع واعتبارها مما يستدلّ له لا به في تأسيس المسائل، وهو الأمر الذي يفضي عند طرد حِبَال النظر معه إلى التشغيب على الدِّين ذاته؛ ولهذا تجد أنّ مَن جاء بعد ابن تيمية تنبَّه لهذا الإشكال وحاول تحييد أثر هذه المرويات عَبْر القول بأنها لم تَلِج أبواب العقائد والأحكام لدى السلف، وأنّ نقلها انحصر في جوانب القصص التي لا خشية على الدِّين منها، وهي محاولة مشكلة سنعرض لبيان ما في طياتها من أخطاء في مقالة قادمة بإذن الله؛ كون هذا القصص به العديد من الأمور المتصلة بالعقائد.
ثانيًا: عَوْده على مقولات السّلف في التفسير بالردّ:
وذلك أنّ المقولات لن تغدو مقولات ومعاني تفسيرية معبّرة عن رأي السلف وثمرة اجتهاد لهم من خلال نظرهم في النصّ وتبيينه، وحجة شرعية يستدلّ بها في تأسيس الشرع؛ وإنما ستغدو مجردَ معلومات ومنقولات مستمدّة من مصدر أجنبي، وبالتالي يجري محاكمتها وتقويمها في ضوء مقررات الشرع وتأخذ حكم مصدرها؛ قبولًا حال لم يكن فيها معارضة لهذه المقررات، أو توقفًا حال لم يتيسر البتّ في شأن مضمونها، أو ردًّا حال ظهر فيها ما يخالف ديننا، ولا شك أن هذا سيجعل أقوال السَّلَف عرضة لاجتهادات عديدة في الحكم عليها والأخذ بها، فضلًا عن أن المرويات الإسرائيلية بها العديد من التفاصيل والأمور التي لا يقرّها الشرع، والتي ستلزم حتمًا ردّ الأقوال في كثيرٍ من المواضع.
ثالثًا: عَوْده على السّلف باللّمز والتشنيع:
إنّ المرويات الإسرائيلية تحوي الكثيرَ من التفاصيل التي لا فائدة من معرفتها، وكذلك تحوي العديدَ من المضامين المشكلة والمخالفة لديننا من مناحٍ متعددة، ولا شكّ أن المستصحِب لتلك النظرة النقليّة عن هذه المرويات في تفسير السلف فإنه سيندفع تلقائيًّا لما يلي:
- لمز السّلف بأنهم انشغلوا بما لا فائدة فيه وضيّعوا أزمانهم فيما لا يفيد؛ وذلك حين تكون مادة المرويات من قِبَلِ المسكوت عنه في ديننا؛ لأنها وإن جازت روايتها، إلا أن إيرادها في مجال له خصوصية كالتفسير يبدو بلا معنى ولا قيمة، بل وفيه تطويل وحشو لمادة التفسير خاصّة، وأن هذه المرويات فيها العديد والعديد من التفاصيل التي لا حاجة ولا ضرورة في معرفتها ولا يعود على قارئها أيّ فائدة.
- نقد السّلف والتشنيع عليهم بطريقة غير مباشرة، وذلك حين تكون مادة المرويات مما لا يقرُّه ديننا؛ لأنه لا يمكن السكوت عن بيان خطأ مضامين المرويّات وإبراز إشكالاتها الشرعية، وكذلك يتعذّر إيقاع النقد المباشر على السّلف بأنهم رووا ما لا تحلّ روايته عن بصيرة، وإلا لتعاظم الخطب وعُدْنَا لإشكال الطعن في الدِّين ذاته؛ ومن ثَمّ يُجتهد في إيجاد أيّة تبريرات لواقع رواية السّلف لهذه المرويات عَبْر الكلام على روايتهم لها دون تبصّر، وأنهم لم ينتبهوا لمضامينها المشكلة، أو أنهم ربما اعتبروها من القِسْم الثالث الذي تجوز روايته، أو أنهم وقعوا ضحية للكذب عليهم واستُغفلوا من قِبَل مَن حدَّثهم... إلى آخر تلك التبريرات التي لازمها تسفيه السلف ورميهم بالغفلة والسذاجة كما سنبيِّن.
وظاهرٌ شناعة هذه اللوازم وخطورتها وعدم إمكان القول بها، وهو ما يدلّل على إشكال منطلق النظر النقلي عن المرويات الإسرائيلية لا التوظيفي في التفسير، وهذه اللوازم رغم خطورتها وظهور إشكالها إلا أن واقع الدّرس التيمي سيقع في مثلها؛ نظرًا لتبنِّيه لذلكم المنطلَق المشكل كما سنبيِّن في مقالتنا التالية.
ثالثًا: انحراف التأصيل من خلاله للمسألة:
إنّ محاولة التأصيل لمسألة عَبْر منطلق يجافي روح الفنّ المتعلّق بها أمرٌ ظاهر الاستحالة؛ كون هذا المنطلق يحرف البصر تمامًا عن الرؤية الصحيحة لوضعية المسألة في الفنّ، وبالتالي يجعل التأصيل ينصبُّ على زوايا لا شأن لتوظيف المسألة بها في الفنّ.
إنّ المرويات الإسرائيلية قد ورد بشأنها إذْنٌ نبويّ صريح بإباحة التحديث بها، ولا شك أن استحضار النظرة النقليّة يجعلنا نؤصِّل لمضمون تم نَقْله والإفادة منه، وبالتالي ضبط ذلك بالمقررات الأصولية اللازمة لضبط الاستدلال بالمصادر الأجنبية؛ إذ المفسر استحال فقيهًا بذلك، وهو تأصيل شديدُ البُعد عن واقعِ المسألة في التفسير وتعامُلِ المفسّرين المشتغِلين بالتبيين كما هو بَيِّن.
وتأمَّل كيف أنّ ابن تيمية لمّا بدَا له أن السّلف في التفسير نقلوا مضامينها ورووها لا أنهم كانوا موظِّفين لها في بيان المعنى فقط؛ صارت المرويات عنده بذلك تحمل مضمونًا وإفادة، ومِن ثَمّ صار همُّه الأكبر في التأصيل لها لا يحكمه الحسّ التفسيري لبيان مسالك الاستدلال والتوظيف لها وقرائنه وضوابطه، وإنما الهاجس الأصولي والفقهي المجتهِد في ضبط مسالك التعامل الشرعي معها وبيان كيفيات الإفادة منها[10]، ولهذا تجده يقرّر أنها للاستشهاد لا الاعتقاد أولًا؛ إذ غاية هذه المرويات الاستشهاد لا الاستدلال، كونها ليست من جنس الأدلة الشرعية، وكذلك هي في ذاتها مرويات لا تُعتقَد مضامينها لعدم إمكان البتّ في تلك المضامين قَبولًا أو ردًّا[11]، وكذلك يقسمها قسمة مضمونية تبعًا لطبيعة الموقف الذي يجب اتخاذه منها؛ إقرارًا ومخالفةً وتوقفًا، وأيضًا يحكم على أن نقلها مما لا فائدة منه في الدّين ولا الدنيا؛ لكفاية الدّين الإسلامي والشرع في ذاته وعدم حاجته لمتمّمات تنقل من مصادر أجنبية عنه[12].
وكلّ هذا تأصيل للمسألة من جوانب لا صلة بها لوضعيتها في التفسير ألبتة، ومِنْ ثَمّ فلا جدوى ولا فائدة له في ضبط مسالكها بأيّ سبيل من السُّبل كما سنبيِّن في مقالتنا التالية، وقد أدَّى لوقوعه على هذا النحو المشكل المنطلق الذي جرى تبنِّيه في النظر للمرويات في التفسير.
رابعًا: مصادمته لتطبيقات كبار المفسّرين ممن اشتغلوا بتفسير السلف[13]:
يعدُّ الطبري وابن تيمية مِن أكثر مَن توارَدَا على الاشتغال بالسّلف ومقولاتهم، إلا أنّ الناظر في تعامل كلّ منهما مع مسألة المرويات الإسرائيلية عندهم يجده مختلفًا بل شديد الاختلاف، فالطبري يناقش مقولات السّلف التي وُظِّفت فيها المرويات الإسرائيلية ويجتهد في استكناه قرائنهم في ذلك، كما أنه لا يستشكل أبدًا إيرادهم لهذه المرويات الإسرائيلية ألبتة كما هو معلوم لمن يطالع تفسيره، ولا يراهم أتعبوا أنفسهم في إيراد ما لا فائدة له ولا طائل من ورائه، بل إنه يفسر تبعًا لتفسيرهم الذي وُظِّفت فيه المرويات الإسرائيلية في العديد والعديد من المواطن؛ ولهذا كان صنيعه محلَّ نقدٍ مِن قِبَلِ كثير من الدارسين -لا سيما المعاصرين- مِن نقَدَة هذه المرويات.
وهذا التباين في التعامل مع المرويات الإسرائيلية في تفسير السلف بين الطبري وابن تيمية سببه افتراق منطلق النظر؛ فالطبري يتعامل مع مقولات السلف التي وُظِّفت فيها المرويات باعتبارها مقولات تفسيرية لا أنها مادة منقولة عن الإسرائيليات كابن تيمية، ولهذا تراه -لبصره بحيثية بيان المعنى عند السلف- ينزع دومًا لاستكناه قرائن التبيين عندهم بالمرويات -كما هو بيِّن لمن يطالع تفسيره-؛ ليؤسس نقده وترجيحه تبعًا لها قوةً وضعفًا، وبالتالي يفسر تبعًا لتفسيرهم الموظَّفة فيه هذه المرويات متى اتجهت عنده قوة القرائن، لا أنه يعتبرهم نقَلة لمضامين المرويات كابن تيمية، وبالتالي فلا وجه لتبيُّن أسباب صنيعهم أصلًا واعتبار أن ما نقلوه بلا كبير فائدة في التفسير ويجب محاكمته للمقرر في الدّين بصفة عامّة.
وصحيح أنّ الطبري وقع منه نقد لبعض مقولات السّلف التي تَرِد في سياق تبيين بعض المبهمات من نحو ما ذكر ابن تيمية وأن المعرفة بها لا فائدة منها، ومن ذلك تعليقه مثلًا على المقولات في بيان البعض الذي ضُرِبَ به القتيل في قصة بقرة بني إسرائيل، حيث قال: «والصواب من القول في تأويل قوله عندنا: {فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا}[البقرة: 73] أن يقال: أمَرَهم اللهُ -جلّ ثناؤه- أن يضربوا القتيل ببعض البقرة ليحيا المضروب، ولا دلالة في الآية ولا خبر تقوم به حُجّة على أيّ أبعاضها التي أُمِر القوم أن يضربوا القتيل به، وجائز أن يكون الذي أُمِروا أن يضربوه به هو الفخذ، وجائز أن يكون ذلك الذّنَب وغُضروف الكتِف وغير ذلك من أبعاضها، ولا يضرّ الجهل بأيّ ذلك ضَربوا القتيل، ولا ينفع العلم به مع الإقرار بأن القوم قد ضربوا القتيل ببعض البقرة بعد ذبحها، فأحياه الله»[14].
إلا أن الفارق بين صنيعه وصنيع ابن تيمية ظاهرٌ؛ فنَقْد الطبري هو نقد لما يراه خارجًا عن حدِّ تبيين المعاني ولا أثر له فيه، وليس طعنًا في أصل رجوعهم للمرويات الإسرائيلية في التفسير وتسفيهه والتقليل من جدواه، وهو ظاهر.
وأما تجويزه لأقوال السلف فهو مفارق تمامًا لمنطق تجويزها لدى ابن تيمية؛ فتجويز الطبري للأقوال راجعٌ رأسًا لافتقاده كمفسِّر -يبغي الترجيح والنقد- لقرائن ودلالات تدفعه لقبول القول أو ردِّه؛ ومن ثَمّ يُبقيه في حيِّز الإمكان، لا أنه يرى أنّ مادة القول ذاته منقولة عن بني إسرائيل، وبالتالي يُجوِّزه لأن المروية الإسرائيلية التي نُقل عنها مما لا يُصَدَّق ولا يُكَذَّب، ولهذا تجد الطبري يقول قبل أن يُجوِّز الأقوال: «...ولا دلالة في الآية ولا خبر تقوم به حُجّة على أيّ أبعاضها التي أُمِر القوم أن يَضربوا القتيل به».
إنّ السلف نظَروا في المرويات الإسرائيلية ووظفوها في بيان المعاني، وقد تلقى الطبري مقولاتهم باعتبارها أقوالًا تفسيرية يوازن بينها؛ ولهذا يجوِّزها ويسرّحها لحيّز الإمكان متى تعذّر عليه الظفر بدليل قاطع في قبولها أو ردِّها، وهو مسلك علمي منهجي في التعامل مع الأقوال التفسيرية المنتجة بصورة عامّة، وقد نصّ عليه الطوفي وحرّر القول فيه بجلاء في صدر كتابه «الإكسير في قواعد التفسير»[15]، وهو يخالف تمامًا من يجوِّز الوارد عن السّلف باعتباره منقولًا عن مرويات لا تُصَدَّق ولا تُكَذَّب في ذاتها، لا مقولة تفسيرية[16].
وحاصلُ ما مَرّ معنا يبرز خطأ منطلق النظر التيمي لدراسة المرويات الإسرائيلية في التفسير، وأنه منطلق مشكلٌ جدًّا وغير صحيحٍ ولا يتناسب مع بحث المسألة، ويتعارض مع صنيع كبار المفسرين؛ كونه غير مؤسس على حيثية التفسير وليس له أدنى علَقة بها، كما أننا ظهر معنا كيف أن هذا المنطلق يدفع لِلَمْز السّلف وردِّ مقولاتهم، وهي أمورٌ وإن بدَا في ظاهرها البُعد عن الحضور التطبيقي في واقعِ مُنَظِّرٍ كابن تيمية له عنايته التي لا تخفى بالسّلف وإطالة النّفَس في تأسيس الاحتجاج لمقالتهم، إلا أنه لم يَسْلَم منها، وستظهر عنده بعض آثارها بشكلٍ أو بآخر، وكذلك لدى مَنْ جاء بعده وَبَنَى على نظره وتأصيله كما سنبيِّن في المقالة التالية.
[1] منشورة على موقع تفسير على الرابط التالي: tafsir.net/article/5165
[2] من يقصرون التفسير على هذا الدائرة يعرِّفونه ببيان المعنى كما تجده عند الدكتور مساعد الطيار وغيره، ويلاحظ هاهنا أن استخدام لفظ البيان في التعريف فيه إشكال لأمور؛ منها: الأول: أن لفظ البيان يحتاج لبيان يميّز حدوده ولا يتحصّل منه الضبط التام لتصوّر المفهوم المراد صوغه من الوقوف عند حدّ تحصيل وتقرير مرادات الألفاظ دون الخوض فيما وراء ذلك من استنباط الأحكام والهدايات وغيرها، وبهذا يصبح لفظ التعريف غير دقيق في ضبط حدود المعرّف وبيان المفهوم المراد تصويره، والذي لا يتجلى بذلك إلا بشرح له أو مقابلته بالمفهوم المتّسع...إلخ مما يعدّ عيبًا في التعريف. الثاني: البيان مصطلح له مركزيته وعمقه في التاريخ الإسلامي واعتورته دلالات عديدة كما هو معلوم، كما أنه عَلَم في البلاغة -بحسب تقسيمها الثلاثي الشهير- على أحد أركانها، وبالتالي فإنّ البعد عن استعماله -حتى لو كان ضابطًا لمفهوم التفسير- قد يكون أجدى؛ لكثرة ما يشتجر في الذّهن من دلالات عند ذكره، فكيف وهو ليس ضابطًا لحدود التفسير كما أسلفنا. ومن هاهنا فإنّ التعبير عن المفهوم الضيق في التفسير يمكن أن يدور -وإن كان القصد ليس متجهًا لتحرير لفظ التعريف- على كشف مدلولات الألفاظ والتراكيب. على أننا سنستخدم التعريف (بيان المعنى) في مقالتنا غالبًا لشهرته، وسوف نفرد لمناقشة مصطلح التفسير وتعريفاته مقالًا خاصًّا بإذن الله.
[3] هاتان الدائرتان لهما حظّ بَيِّن -بِغَضّ النظر عن تفاوتهما قلَّة وكثرة- في واقع مصنفات التفسير، والتي ينشغل بعضها بصورة ظاهرة بتقرير المعاني ولا يزيد عن ذلك، وبعضها يتوسّع -على تفاوت بينها في ذلك- فيستخرج الأحكام واللطائف والهدايات...إلخ. للتوسع في الكلام على هاتين الدائرتين يراجع مقالتنا: «معيار تقويم كتب التفسير؛ تحرير وتأصيل»، وهي منشورة على موقع تفسير على الرابط التالي: tafsir.net/article/5110
[4] وإن كان القطع بذلك يحتاج لمزيد تأمُّل في واقع مادة هذه الدائرة في التفاسير ومقارنتها مع بقية الفنون التي تتقاطع معها عسى أن تتكشّف فيها وجوه تمايز وافتراق، وإلا فظاهرها المشابهة لا سيما في استخراج الأحكام، والذي يتقاطع رأسًا مع الفقه والأصول.
[5] التيسير في قواعد التفسير، ص(157، 158). قد أشار الكافيجي قبل كلامه هذا إلى كون علم التفسير يدلّ على قواعد التفسير كذلك، وسواء أكان يقصد بـ«علم التفسير» التفسير أم علم قواعد التفسير، فإن كلامه واضح جدًّا في الدلالة على تمايز حيثيّة التفسير عن غيره ببيان المعنى، وإلا فالتقعيد للفنون لا يتمُّ إلَّا في ضوء حيثيتها المفارقة، فلو كان القصد قواعد التفسير، فهو تقعيد للتفسير الذي ينصبّ على المعنى وبيانه فقط.
[6] معايير القبول والردّ لتفسير النصّ القرآني، دار الغوثاني للطباعة والنشر، ط:1، 1428هـ-2008م، ص(84). ويلاحَظ هاهنا أمران: أولًا: ذَكر الدكتور عبد القادر حسين بعد ذلك اتفاق قواعد التفسير مع الأصول في مباحث الدلالة والبيان وكيفية استنباط الأحكام من النصّ، وقضايا التعارض والترجيح في بعض جزئياتها ومسائل النسخ. ولا يخفى أنّ بعض وجوه الاتفاق التي ذكرها متوقف على مفهوم التفسير سعةً وضيقًا. ثانيًا: في ضوء النظر لحيثية التفسير يمكننا دراسة العديد من قضايا التفسير والحكم فيها، منها مسألة تقويم كتب التفسير كما عالجناها في مقالتنا «معيار تقويم كتب التفسير؛ تحرير وتأصيل»، وكذلك تحديد المفسِّر ومن يستأهل ذلكم اللقب، فكلما كان المفسر مشتغلًا بتقرير مدلولات الألفاظ والتراكيب كان أحقّ باسم المفسِّر وخليقًا به من غيره. فنحن إن جاوزنا طبقة السلف على الحقيقة يتعذّر علينا الظفر بمن يقوم بذلك على ذات النحو الذي كان عندهم، وإنما يدور الأمر على النظر فيما أنتجوه من أقوال كما الحال عند الطبري، وأما الاشتغال بذات اشتغالهم فهو إن وُجِد لدى البعض بعدهم فإنه يكون محدودًا جدًّا، ولهذا فإن إطلاق وسم المفسِّر في ضوء حيثيّة التفسير على مَنْ بعد السلف يكون لاعتبارات خارجة عن حيثيّة التفسير غالبًا.
[7] تفسير الطبري، ط: هجر، (7/1).
[8] وهي منشورة على موقع تفسير على الرابط التالي: tafsir.net/article/5139
[9] تفسير الطبري، ت: شاكر، (453/1). وربما يلاحَظ على كلام شاكر أنه يتنزّل على مفسري السلف أكثر ما يتنزّل على الطبري، فهم من استدلوا بالمرويات وساقوها رأسًا ليقرِّروا المعاني التي أتوا بها وأنتجوها، وأما الطبري فموازن بين مقولاتهم التفسيرية بالأساس وليس منتجًا للمعنى، وبالتالي فإنه لا يسوق المرويات ليؤسِّس من خلالها المعنى في ذاته أو يستظهر بها عليه باعتبارها مما يفيد في بيان بعض الألفاظ وتوضيح سياقاتها فهذا فعل المنتِج للمعنى أصالة، وإنما نظَره يكون لتوجيه المعاني -التي كانت هذه المرويات أحد دلائل إنتاجها- وبيان مسالكها وأدلتها أو لترجيحها وتضعيفها. إن فهم صنيع الطبري وتعامله مع المرويات باعتباره مؤسِّس للمعنى يُحْمَل على اعتبار مآله فقط، لا سيما وأن السلف لا يعلِّلون مقولاتهم وإنما تكون هي المرويات الإسرائيلية مباشرة، ولرغبة الطبري في الموازنة بينها يكشف عن مكامن استدلالها بالمروية، وبالتالي يكون صنيعه استدلالًا لها، وإلا فإنه لا ينحصر في ذلك.
[10] ويلاحظ أن كلامنا عن استعمال التقرير الأصولي لا يعني أنّ المرويات الإسرائيلية كانت مبحوثة في علم أصول الفقه؛ لأن الدرس الأصولي يتعامل مع شرع مَنْ قبلنا الوارد في شرعنا لا المعتمِد على ما في كتب أصحاب الشرائع السابقة فهي غير موثوقة كما هو معلوم، وإنما الغرض هو محاولة استيحاء منازع ضبط الاستدلال بالمصادر الأجنبية في الطرح الأصولي وتوظيفه في التعامل مع المسألة.
[11] وهو ما يقرّره ابن تيمية نفسه، حيث يقول في معرض جوابه عن إشكال قد يَرِد عليه في منع التشبّه بأهل الكتاب: «أما المعارضة بكون شرع مَنْ قبلنا شرع لنا ما لم يَرِد شرعنا بخلافه، فذاك مبنيّ على مقدمتَيْن، كلتاهما منفيةٌ في مسألة التشبه بهم: إحداهما: أن يثبت أن ذلك شرع لهم، بنقل موثوق به، مثل أن يخبرنا اللهُ في كتابه، أو على لسان رسوله، أو ينقل بالتواتر، ونحو ذلك، فأمّا مجرد الرجوع إلى قولهم، أو إلى ما في كتبهم، فلا يجوز بالاتفاق،... وقد ثبت في الصحيح عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدِّقوهم، ولا تكذِّبوهم». المقدمة الثانية: أن لا يكون في شرعنا بيان خاصّ لذلك، فأمّا إذا كان فيه بيان خاصّ: إما بالموافقة، أو بالمخالفة، استغني عن ذلك فيما ينهى عنه من موافقته، ولم يثبت أنه شرع لمَن كان قبلنا، وإن ثبت فقد كان هدي نبينا -صلى الله عليه وسلم- بخلافه...». اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أهل الجحيم، ص(464).
[12] يلاحظ انسجام التأصيل التيمي مع منطلقه في النظر، وهو من دلائل براعة ابن تيمية ودقّته في التأصيل كما لا يخفى، حيث لا يتعارض تأصيله مع منطلقه كما يقع أحيانًا عند كثير من النظّار.
[13] سوف نكتفي هاهنا ببيان موقف الإمام الطبري فقط من المفسّرين وموازنته بابن تيمية وبيان ما بينهما من فروق جوهرية في منطلق النظر للمرويات الإسرائيلية؛ وذلك تطلبًا للاختصار من جانب، ولكفاية ذكر الطبري في المسألة من وجهة نظرنا من جانب آخر؛ كونه مِن أبرز مَن اعتنى مِن المفسرين بمقولات السلف في التفسير تصنيفًا وموازنةً، كما أن له مكانة لا تخفى عند ابن تيمية في التفسير؛ حيث يَعتبِر تفسيرَه من أصحّ التفاسير كما نصّ على ذلك في مقدمته، وله اهتمامٌ واضح به وتأثُّر به في العديد من المسائل التي تتعلّق بالتفسير؛ كحجية السلف فيه، ومَنْع الخروج عن أقوالهم ومناقضتها، وغير ذلك.
[14] تفسير الطبري، ط: هجر، (127/2).
[15] يراجع، الإكسير، ت: عبد القادر حسين، مكتبة الآداب- القاهرة، ص(41)، وما بعدها.
[16] تجدر الإشارة لأمور:
أولًا: من المؤسِف أنّ كثيرًا من الدراسات لا تنتبه لمنهج الطبري، فتراها تأتي لنقده لمقولات السلف الموظّفة للمرويات الإسرائيلية في بعض المواضع وتعتبره ناقدًا لأصل التوظيف والرجوع للمرويات؛ ومن ثَمّ تمدح صنيعه باعتباره موافقًا لمسلكها في ذمّ المرويات، وأما المواطن التي اعتمد فيها مقولاتهم الموظّفة للمرويات فتراها مخالفة منه للقاعدة المقرّرة لديهم سلفًا، وهذا تخليط ظاهر -تجده كذلك لدى العديد من الكَتَبة في قواعد التفسير- نابع من عدم فهم صنيع الطبري وتأمُّله، والانطلاق في التعامل مع تفسيره من مقرّرات سابقة لا محاولة بحث قواعده هو على نحوٍ خاصّ.
ثانيًا: ربما يكون من احتمالات أسباب غلط المنطلق عند ابن تيمية في بحث المرويات الإسرائيلية في تفسير السلف هو عدم هضمه لمنطق التجويز عند الطبري، لا سيما وأن ابن تيمية معظِّم للطبري كما هو معلوم وله احتفاء بتفسيره، فربما اعتبر تجويزه لأقوال السلف -والذي يكثر في المواطن التي يظهر فيها توظيف المرويات الإسرائيلية- راجع لاعتبار أنها منقولة عن الإسرائيليات، وأن هذا المنطق الواجب إزاءها تبعًا للحديث النبوي الشهير بمنع تصديقهم أو تكذيبهم، وهو أمر بحاجة لبحث، خاصّة وأن منطق تجويز الأقوال عند الطبري يحتاج لتدقيق واستقراء واسع حتى يستوعب، وقد خفي أمره على كثيرٍ من النظّار كما يظهر لمن يتأمل مواطن تجويزه وكيفية فهم مَنْ بعده لها، وقد يسَّر اللهُ لنا تتبُّع مسألة التجويز عند الطبري في بحث خاصّ، ولعلَّ الله ييسر إخراجه قريبًا.
ثالثًا: منطق التجويز عند الطبري هو مسلك يتعامل به مع مختلف أقوال السلف التفسيرية التي لا يجد لها دليلًا يقطع بها قبولًا أو ردًّا وليس ما وظّف فيها المرويات الإسرائيلية فقط، راجِعْ مثلًا استعماله لذلك في الأقوال في قوله تعالى: {وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ}[البقرة: 205]. تفسير الطبري، ط: هجر، (3/ 584).
كلمات مفتاحية
الكاتب:

خليل محمود اليماني
باحث في الدراسات القرآنية، عضو هيئة تدريس بجامعة الأزهر، له عدد من الكتابات والبحوث المنشورة.
مواضيع ذات صلة
((المعلومات والآراء المقدَّمة هي للكتّاب، ولا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع أو أسرة مركز تفسير))