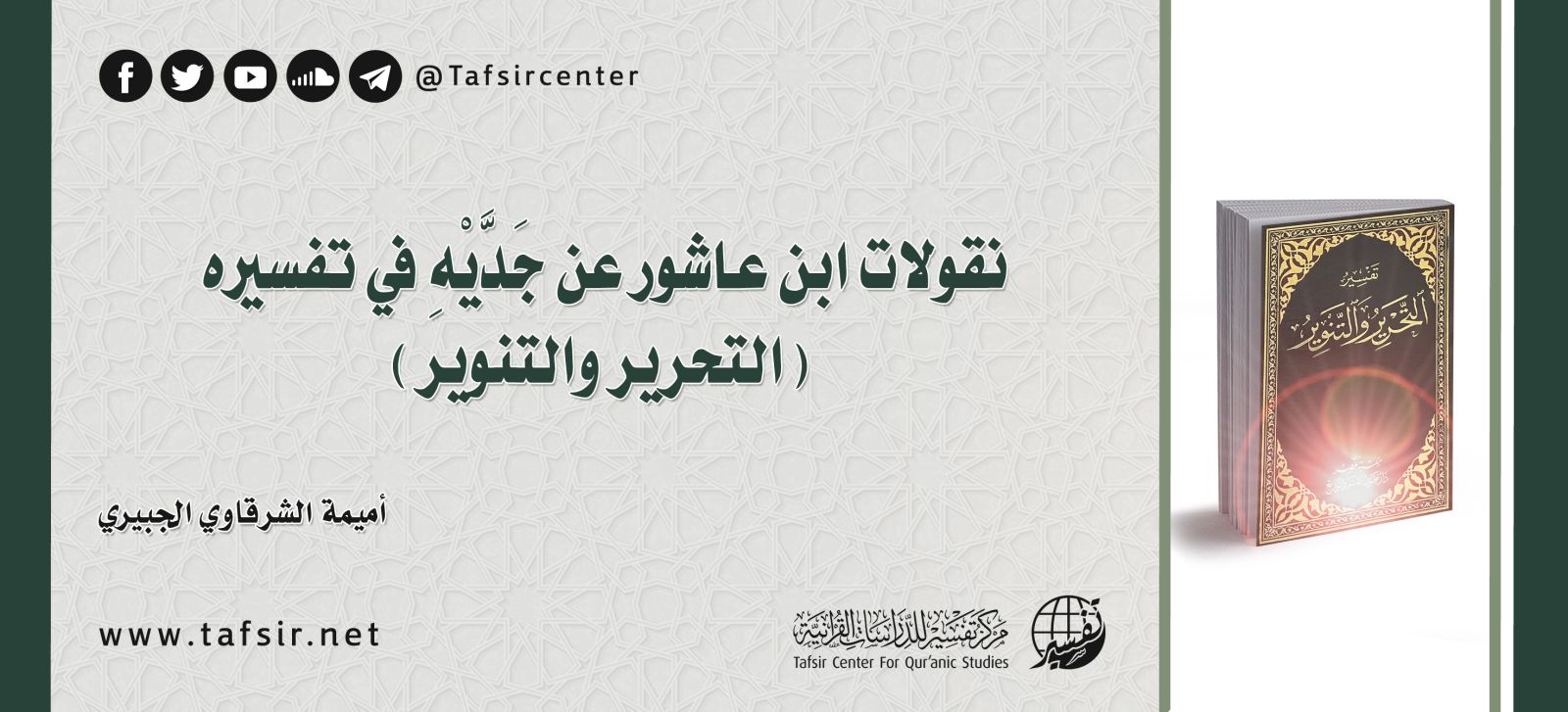قراءة نقدية لتأصيل ابن تيمية لتوظيف الإسرائيليات في التفسير (3-3)
منطلق ابن تيمية في بحث المسألة؛ الآثار والنتائج
الكاتب: خليل محمود اليماني

بيَّنّا قبلُ[1] أن المنطلق التيمي في مقاربة الإسرائيليات في التفسير هو أنها كانت مجالًا للنقل لا التوظيف في سياق تبيين المعاني، وكيف أنّ هذا المنطلق خطأ محض ومؤسّس بعيدًا عن التفسير وحيثيّته، وفي هذه المقالة نحاول تتبّع آثار هذا المنطلق عند ابن تيمية ومَنْ جاء بعده ممن تبنَّى منطلقه وتأصيله للمسألة، وبيانه كالتالي:
للمنطلق التيمي النقلي عن المرويات الإسرائيلية في التفسير العديد من الآثار السلبية؛ أبرزها ما يلي:
أولًا: تناقض البناء النظري الكلّي لابن تيمية إزاء السَّلَف وحجيتهم:
لابن تيمية عناية كبيرة بالسّلف وبيان مركزيّتهم في الدّين وضرورة مَنْع جواز الخروج على أقوالهم ومعارضتها ومخالفتها خلاف تضاد كما هو معلوم، وقد اعتنى في سبيل تأسيس ذلك الأصل المنهجي بإقامة الدلائل على ما للسلف -لا سيما الصحابة رضوان الله عليهم- وفهمهم للسياقات اللغوية والمقامية للنصّ القرآني من خصوصية لا تتوفّر لغيرهم؛ ككونهم أهل اللسان العربي الفصيح، ولأنهم عاصروا التنزيل وتلقَّوا بيانه من النبي -صلى الله عليه وسلم-، وكذلك طول اشتغالهم بالقرآن وقيامهم بتفسيره كلّه، وغير ذلك مما أصّل له ابن تيمية في غير ما موضع من كتبه؛ ومن نصوصه في بيان ذلك قوله: «يجب أن يُعلم أن النبي -صلى الله عليه وسلم- بَيَّنَ لأصحابه معاني القرآن كما بَيّنَ لهم ألفاظه، فقوله تعالى: {لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ}[النحل: 44] يتناول هذا وهذا، وقد قال أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا يقرئوننا القرآن كعثمان بن عفان، وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي -صلى الله عليه وسلم- عشر آيات لم يجاوزوها حتى يتعلّموا ما فيها من العلم والعمل، قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعًا؛ ولهذا كانوا يبقون مدة في حفظ السورة... وذلك أن الله -تعالى- قال: {كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِّيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ}[ص: 29]،... وتدبر الكلام بدون فهم معانيه لا يمكن، وكذلك قال -تعالى-: {إِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ}[يوسف: 2]، وعقل الكلام متضمن لفهمه، ومن المعلوم أنّ كلّ كلام فالمقصود منه فهم معانيه دون مجرّد ألفاظه، فالقرآن أولى بذلك، وأيضًا فالعادة تمنع أن يقرأ قوم كتابًا في فنّ من العلم كالطبّ والحساب ولا يستشرحوه، فكيف بكلام الله الذي هو عصمتهم؟!... ومن التابعين من تلقَّى جميع التفسير عن الصحابة، كما قال مجاهد: عرضتُ المصحف على ابن عباس أُوقفه عند كلّ آية منه وأسأله عنها،... والمقصود أنّ التابعين تلقَّوا التفسير عن الصحابة، كما تلقوا عنهم علم السُّنة»[2]، وكذلك قوله أنَّ العلم الضروري يقتضي أن الصحابة: «كانوا أعلم بمعاني القرآن منّا، وإن ادَّعَى مدَّعٍ تقدُّمه في الفلسفة عليهم فلا يمكنه أن يدَّعي تقدمه في معرفة ما أريد به القرآن عليهم، وهم الذين تعلموا من الرسول لفظَه ومعناه، وهم الذين أدَّوا ذلك إلى مَن بعدهم...»[3].
وبرغم ظهور ذلك في الفكر والمنهج التيمي، إلا أن تبنِّيه لمنطلق النظر النقلي عن المرويات الإسرائيلية في التفسير أفضى به لمخالفة تلك الأُسس المركزية في الاستدلال لحجية مقولات السلف ونقضها، وذلك من جوانب؛ أبرزها اثنان:
الجانب الأول: تشغيبه على البيان النبوي للقرآن للصحابة، وحسن فهمهم للقرآن، وتفسيره كاملًا لِمَن تلاهم:
أَسَّسَ ابن تيمية كثيرًا على خصوصية وتفرُّد الصحابة بتلقي البيان النبوي، وأن النبي -صلى الله عليه وسلم- هو من بيَّن القرآن للصحابة وأوضحه لهم، وأنهم فهموه حقَّ الفهم وفسَّروه كاملًا لِمَن بعدهم، إلا أنه بتبنِّيه للنظر النقلي عن المرويات فإنه سيخالف ذلك ويعارضه؛ فقد تتابع السلف مثلًا على القول بأنَّ هَمَّ يوسف هو حَلُّه لسراويله وإقدامه على مواقعة امرأة العزيز، كما أنهم تتابعوا كذلك قاطبةً على أن قوله: {ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ... وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ}[يوسف: 52، 53]، هو من قول يوسف، وأنه بيَّن في أوله أنه لم يَخُنْ سيده في بيته، ثم قال {وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي} بعدها لما ذُكِّر بالهَمِّ الذي كان منه وإقدامه على مواقعة امرأة العزيز.
وليس هذا القول لبعض السلف دون بعض في الآيات ولكنه قولهم قاطبةً على اختلاف طبقاتهم ولا يُعْرَف لهم غيره فيها[4]، إلا أننا حين نتأمّل كيف تعامل ابن تيمية مع هاتين الآيتين والوارد عن السلف فيهما، فإننا نجد أنه أبطل ما أورده السلف وردَّه بعبارة صريحة، حيث قال: «وأما ما ينقل من أنه حَلَّ سراويله وجلس مجلس الرجل من المرأة، وأنه رأى صورة يعقوب عاضًّا على يده وأمثال ذلك؛ فكُلُّه مما لم يخبر اللهُ به ولا رسوله، وما لم يكن كذلك فإنما هو مأخوذ عن اليهود الذين هم من أعظم الناس كذبًا على الأنبياء وقدحًا فيهم، وكلّ مَنْ نقَله من المسلمين فعنهم نقَله، لم ينقل من ذلك أحدٌ عن نبيّنا حرفًا واحدًا»[5].
وكذلك نحا إلى خلاف ما أوردوه تمامًا مرجحًا أنَّ الهَمَّ هو هَمُّ خطرات لا إصرار، وأنه ليس ذنبًا بل حسَنة ليوسف كما سيأتي[6]، وكذلك رجّح خلافهم بأنّ الآيتين من قول المرأة لا يوسف، وانتقد كلامهم بأنهما من قول يوسف بعبارة ثقيلة جدًّا، حيث قال: «وهو قول في غاية الفساد ولا دليل عليه، بل الأدلة على نقيضه»[7].
ويظهر هاهنا بوضوح أثر المنطلَق النقلي عن المرويات الإسرائيلية في التفسير عند ابن تيمية وكيف أنه كان سببًا في دفعه لمثل هذا الموقف شديدِ الإِشكال في موقفه المنهجي من حجّية السّلف ومسوغاتها العلميّة والمنهجية عنده؛ ذلك أنه دعاه لاعتبار مقولة السّلف من المنقول عن بني إسرائيل، وبالتالي سهّل عليه ردّها وإبطالها؛ كون أصْلها الذي نُقِلَت عنه يتوجّب علينا محاكمته في ضوء الوارد عندنا لا التأسيس من خلاله، وأنه متى ظهرت مخالفته لما عندنا رفَضْناه وما قام عليه ولا كرامة؛ إذ هذا هو الموقف الذي تؤيّده الشريعة ذاتها في شأن المرويات الإسرائيلية والتعامل مع مضامينها؛ ومن ثَمّ فلا حرج من الردّ والإبطال، إلا أنّ هذا الفعل منه يشغب في ذات الوقت على منطلقاته الكلية إزاء حجيّة السلف، وأن النبي -صلى الله عليه وسلم- بيَّن القرآن كاملًا للصحابة، وأنهم أحسنوا فهم القرآن وفسّروه كاملًا لمَن تلاهم، وأنهم الأعلم بلسان القرآن؛ لأننا بذلك سنكون أمام مواضع في القرآن بلا تفسير واضح، وفي بعضها تتابع على نقل معارض تمامًا للآيات ودلالتها اللغوية، ومباين لمنطق القرآن ذاته الذي من المفترض أنهم أفضل من فهمه، وأن النبي -صلى الله عليه وسلم- هو مَن تولَّى بيانه لهم.
ويلاحَظ أنّ سبب هجوم ابن تيمية على ما نقله السلف -من وجهة نظره- عن المرويات في هَمِّ يوسف تحديدًا، واعتباره مخالفًا للشرع دون غيره من مواضع أخرى من مثل الوارد في فتنة داوود وسليمان؛ هو موقفه من مسألة عصمة الأنبياء من الذنوب كما سبق وبيَّنّا، فابن تيمية ذهب إلى أن عصمة الأنبياء تكون في عدم الإقرار على الذنوب مطلقًا لا في عدم فِعلها منهم، حيث يرى أن: «القول الذي عليه جمهور الناس وهو الموافق للآثار المنقولة عن السلف؛ إثبات العصمة من الإقرار على الذنوب مطلقًا»[8]؛ ومن ثَمّ لم يكن مستنكَرًا عنده من حيث المنطلق ما نقله السلف في بعض المواطن مما فيه نسبة ذنوب لبعض الأنبياء، كما الحال في شأن داوود وسليمان -عليهما السلام-؛ لثبوت نِسبة الذنب لهما في القرآن وأنهما تابَا منه، بينما وقع الإشكال عنده فقط فيما نقلوه مما يثبت ذنبًا لنبيٍّ لم يُثْبِت له القرآن ذلك كما هو الحال مع سيدنا يوسف، حيث رأى ابن تيمية أنه لم يُذْكَر عنه ذنب في الشرع واستغفار من وقوعه، ومن ثَمّ فلا يسوغ نسبة ذلك إليه اعتمادًا على النقل عن مصدر كالمرويات الإسرائيلية والتي يجب أن تحاكَم لما عندنا قَبولًا وردًّا وتوقفًا، ولا تؤسِّس بذاتها نظرًا شرعيًّا.
يقول ابن تيمية: «وأما يوسف الصدِّيق فلم يَذْكُر اللهُ عنه ذنبًا؛ فلهذا لم يذكر اللهُ عنه ما يناسب الذنب من الاستغفار، بل قال: {كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ}[يوسف: 24]، فأخبر أنه صَرَف عنه السوء والفحشاء، وهذا يدلّ على أنه لم يَصدر منه سوءٌ ولا فحشاء»[9].
إِنّ ابن تيمية لما رأى عدم نسبة وقوع الذنب ليوسف في القرآن لم يرتضِ نقل السلف والذي يُثبِت له ذنبًا، وفَسّر الهمَّ تفسيرًا يلتقي مع نظرته في أنه لم يكن ذنبًا أبدًا، وأنه كان مجرد خطرات لا إصرار وعزم، فقال: «وأما قوله: {وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ}[يوسف: 24]، فالهمّ اسم جنس تحته نوعان كما قال الإمام أحمد: الهمُّ همَّان؛ همُّ خطرات وهمُّ إصرار. وقد ثبت في الصحيح عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنّ العبد إذا هَمَّ بسيئة لم تكتب عليه، وإذا تركها لله كُتبت له حسنة، وإن عملها كُتبت له سيئة واحدة، وإن تركها من غير أن يتركها لله لم تُكتب له حسنة ولا تُكتب عليه سيئة، ويوسف همَّ همًّا تَرَكَهُ لله؛ ولذلك صرف اللهُ عنه السوء والفحشاء لإخلاصه، وذلك إنما يكون إذا قام المقتضى للذنب وهو الهمُّ وعارضه الإخلاص الموجب لانصراف القلب عن الذنب لله؛ فيوسف -عليه السلام- لم يصدر منه إلا حسنة يثاب عليها، وقال تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ}[الأعراف: 201]»[10]، ومن ثَمّ كَرّ على نقل السلف بالردّ والإبطال وبأنه معارض للأدلة.
وَبِغَضّ النظر عن إمكان تخريج ما نقله السلف -جريًا مع ابن تيمية وإلا فهو قول تفسيري- بذات ما ذكره ابن تيمية نفسه في كلامه على سيدنا يونس وأن تأخير استغفاره وتوبته كانت سببًا في عقابه[11]، أو غير ذلك مما قد يتأمّل وليس غرضنا تحريره، إلا أن ما منع ابن تيمية من محاولة ذلك وَحَدَا به مباشرة لرفض القول بلا تحرّج هو نظرته النقلية عن المرويات الإسرائيلية في التفسير، وأنّ أقوال السلف في هذا الموطن ليست أقوالًا تؤسِّس نظرًا شرعيًّا للعصمة يتوجب علينا مراعاته بشدّة عند بناء نظرتنا للمسألة بصورة كليّة، والعناية بتخريجه في ضوء الإطار العام للقاعدة الشرعيّة الظاهرة التي تدلّ عليها النصوصُ، حال بَدَا هناك نوعُ خلافٍ في الظاهر حتى لا تكون القاعدة الشرعية غير متّسقة في ذاتها، وإنما هي محضُ نقل واجترار لمعلومات من مصدرٍ يتوجّب علينا محاكمته في ضوء الوارد عندنا لا التأسيس من خلاله، وأنه متى ظهرت مخالفته لما عندنا رفضناه اتِّباعًا للموقف الذي تؤيّده الأدلة الشرعية ذاتها في شأن المرويات الإسرائيلية؛ ومن ثَمّ فلا حاجة لإيجاد تخريجات أصلًا[12].
إنّ هذه النظرة النقلية عن المرويات الإسرائيلية في تفسير السلف دعت ابن تيمية بكلّ وضوح للتشغيب على منطلقاته التأسيسيّة لحجيّة السلف ومعارضتها؛ ذلك أنه ردَّ ما تتابع السّلف على إيراده في التفسير، وهو ما يعني أنهم قد يَرِدُ عليهم التتابع على الغلط، وعدم فهم بعض دلالات ألفاظ القرآن وكذلك المقاصد العامة له، وفي أمور تتصل بالمفاصل كالموقف من عصمة الأنبياء وحكاية ما يعارضها ونَقْله، وأنّ القرآن لم يُبَيَّن لهم على التمام، وأنهم لم يُفَسِّروه كلَّه لمَن تلاهم.
وإذا كان ابن تيمية لم يقع منه التوسّع في ردّ منقولات السلف من وجهة نظره؛ كونه لم يتعاطَ التفسير كاملًا، إلا أن هذا الأثر سيزداد بصورة واسعة جدًّا عند مَن جاء بعده وانشغل بالتفسير كاملًا وحاول التعامل مع المرويات الإسرائيلية في التفسير من خلال منطلقاته وتأصيلاته لها.
وتأمّلْ موقف ابن كثير[13] -تلميذ ابن تيمية وأبرز مَنْ بنَى على التقرير التيمي في النظر للموضوع في التفسير- وكيفية نزوعه لرفض مقولات السلف، حيث قال معلِّقًا بعدما أورد روايات السلف في قصة هاروت وماروت: «وقد رُوي في قصة هاروت وماروت عن جماعة من التابعين، كمجاهد والسدي والحسن البصري وقتادة وأبي العالية والزهري والربيع بن أنس ومقاتل ابن حيان وغيرهم، وقصّها خلقٌ من المفسرين من المتقدمين والمتأخرين، وحاصلها راجع في تفصيلها إلى أخبار بني إسرائيل؛ إِذْ ليس فيها حديثٌ مرفوعٌ صحيحٌ متصلُ الإسناد إلى الصادق المصدوق المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى، وظاهر سياق القرآن إجمال القصة من غير بسط ولا إطناب فيها، فنحن نؤمن بما ورد في القرآن على ما أراده الله تعالى، والله أعلم بحقيقة الحال»[14].
وفي قصة داوود عزف كذلك عن ذكر مقولات السلف بالكلية، وقال: «قد ذكر المفسرون هاهنا قصة أكثرها مأخوذ من الإسرائيليات، ولم يثبت فيها عن المعصوم حديث يجب اتِّباعه، ولكن روَى ابن أبي حاتم هنا حديثًا لا يصح سنده؛ لأنه من رواية يزيد الرقاشي عن أنس، ويزيد وإن كان من الصالحين لكنه ضعيف الحديث عند الأئمة؛ فالأَولى أن يقتصر على مجرد تلاوة هذه القصة، وأن يُرَدّ عِلْمُها إلى اللهِ -عزّ وجلّ-؛ فإنّ القرآن حقٌّ، وما تضمَّن فهو حقٌّ أيضًا»[15].
الجانب الثاني: تشغيبه على فهم السلف للدّين وإفضاؤه لِلَمْزِهم والتشنيع عليهم:
إنّ من أبرز إشكالات النظر النقلي عن المرويات الإسرائيلية في التفسير أنه يفتح بابًا واسعًا للطعن في صحة فهم السّلف للدّين وضرورة التشنيع عليهم كما بيّنّا؛ فمن يَلِج تفسير السّلف باعتبارهم نقَلة عن المرويات فإنه سينظر لمضامين المرويات التي يوردونها، ويقوم بتصنيفها تبعًا للموقف الشرعي منها قبولًا ورًّدا وتوقفًا كما ذكر ابن تيمية نفسه، فمتى رأى قبول الشرع فإنه سيقرّها، وأما ظهور الطعن في حجية فهمهم وضرورة التشنيع عليهم فسيكون عنده فيما قد يراه جائزًا أو مردودًا:
- فحين يتقرّر لدى الناظر أنّ المروية من قِبَلِ المسكوت عنه فإنه وإن جوَّز روايتها، إلا أنه سيكون مضطرًا لِلَمْزِ مَنْ رواها بأنه انشغل بما لا فائدة فيه وضيَّع أزمانه فيما لا طائل من تحته ولا نفع فيه في الدّين والدنيا، خاصّة وأن هذه المرويات فيها العديد والعديد من التفاصيل التي لا حاجة لنا فيها ولا ضرورة في معرفتها واستحضارها، وهو عين ما فعله ابن تيمية -فيما نقلنا عنه قبلُ، إبّان تقسيمه الثلاثي للمرويات- والذي لم يكن أمامه بُدّ غير هذا في ضوء نظرته النقلية؛ لأن الدين تامّ لا يحتاج لتكميل من مرويات أجنبيّة، ومن عدم الجدوَى بديهيًّا الانشغال بروايات لا فائدة حقيقية منها ولا تأسيس قائم عليها، ونقل تفاصيل لا أهمية لمعرفتها والاستغناء عنها ظاهر كما بيَّنّا.
وتأمَّلْ كذلك قولَ ابن كثير وكيفية لَمْزِه لإيراد السلف في أحد المواطن، حيث يقول: «...وما قصَّهُ كثير من المفسّرين وغيرهم فعامَّتها أحاديث بني إسرائيل، فما وافق منها الحقّ مما بأيدينا عن المعصوم قبِلْناه لموافقته الصحيح، وما خالف شيئًا من ذلك ردَدْناه، وما ليس فيه موافقة ولا مخالفة لا نصدِّقه ولا نكذِّبه، بل نجعله وقفًا، وما كان من هذا الضّرب منها فقد ترخّص كثيرٌ من السلف في روايتها، وكثيرٌ من ذلك ما لا فائدة فيه، ولا حاصل لهمما ينتفع به في الدّين، ولو كانت فيه فائدة تعود على المكلَّفِين في دينهم لبيَّنتْه هذه الشريعة الكاملة الشاملة، والذي نسلكه في هذا التفسير الإعراض عن كثيرٍ من الأحاديث الإسرائيلية، لِما فيها من تضييع الزمان»[16].
- وأما حين يقع على مرويات فيها أمورٌ مما لا يقرُّه ديننا فإنّه حتمًا سيضعها ضِمْن القسم الثاني باعتبارها من المردود الذي لا يجوز روايته، ثم إذا أعاد النظر ثانية فسيجد أنّ السلف هم من رَوَوْها، فيُشكل عليه الأمرُ بسبب ذلك؛ فهو لا يستطيع إجازة المرويات؛ كون مضامينها مخالفة للشّرع، ولا يستطيع تغليط السلف والتشنيع عليهم فيقع في حيرة في المسألة والتعامل معها، ويحاول أن يجد تسويغًا لواقع تفسير السلف عَبْر الكلام على إشكال الإسناد عنهم في المرويات، أو أنّ الروايات كانت عند التابعين وأتباعهم لا الصحابة، أو أنها تسللتْ على حين غفلة منهم وأنهم لم ينتبهوا لمضامينها المشكلة، أو أنهم ربما اعتبروها من القسم الثالث الذي تجوز روايته، أو أنهم وقعوا ضحيةً للكذب عليهم واستُغفِلوا من قِبل مَن حدَّثهم...إلى آخر تلك التبريرات التي لازمها كذلك تسفيه السلفِ ورَمْيهم بالغفلة والسذاجة.
إنّ ابن تيمية وإن لم يخُضْ في مثل هذه التبريرات إلا أنها لازمة للسلف في ضوء تعامله مع مقولتهم، فحين يكون السّلف تتابعوا جميعًا على نقل أمر ووضعه في ثنايا التفسير وهو مخالف للشّرع ولا تقرُّه الملّة؛ فلا بدّ أن يكونوا فعلوا ذلك لعدم تفطّنهم للمخالفة، أو غير ذلك من التبريرات التي ظهرت عند مَنْ تَبَنَّوا النظر التيمي وتعاملوا مع المسألة من خلاله بشكلٍ أكثر صراحة.
يقول ابن كثير معلِّقًا على أحد المرويات المسندة عن ابن عباس: «إسناده إلى ابن عباس قوي، ولكن الظاهر أنه إنما تلقّاه ابن عباس -إن صح عنه- من أهل الكتاب، وفيهم طائفة لا يعتقدون نبوَّة سليمان -عليه السلام- فالظاهر أنهم يكذبون عليه»[17].
ولا شك أنّ الناظر في العديد من الدراسات المعاصرة والتي تتبنى النظر التيمي للمسألة يجد شدّة ظهور هذين الأثرين لديها؛ حيث يغلب لدى الدارسين فيها الجراءة على رَدّ كلام السّلف والتشنيع عليهم وتسفيههم واتهامهم بالسذاجة؛ إذ راجت عليهم هذه المنقولات الخبيثة...إلخ، مما يحمل تشنيعًا من جانب، وتبريرًا من جانب لإيجاد مخرج للدّين ذاته من المسألة؛ كون السلف هم رواة الشرع وتأثرهم بمصدر أجنبي مشكلٌ، وهو ما سنفصل القول فيه في مقالة خاصة بإذن الله[18].
وحاصل ما سبق يُبرز لنا كيف أن تبنِّي ابن تيمية لمنطلق النظر النقلي عن المرويات الإسرائيلية أوقعه في تعارض منهجي إزاء السلف وما لهم من حجيّة في الدّين، وجعله يكرّ على ذلك الأصل الأصيل عنده بالإبطال والنقض، كما أنه كذلك كان داعية لوقوعه في أخطاء في بحث المسألة كما سنبيّن في النقطة التالية.
ثانيًا: خطأ التأصيل التيمي للمسألة:
اجتهد ابن تيمية في التأصيل للمرويات الإسرائيلية في تفسير السلف وأصدر بشأنها بعض المقررات النظرية الكليّة، إلا أن التأصيل التيمي لارتهانه لمنطلقه النقلي عن المرويات صار مشكلًا، ومن ذلك ما يلي:
1- الإسرائيليات تروَى للاستشهاد لا للاعتماد والاعتقاد (التأسيس والتأنيس/ الاعتضاد لا الاعتماد):
إنّ هذا التقرير لا معنى له نهائيًّا ولا قيمة له ألبتة في مجال توظيف المرويات الإسرائيلية في التفسير؛ لأن الذي يوظِّف رواية في بيان المعنى لا تبحث المسألة معه من جانب عدم الاعتقاد بمضمون ما يستدلّ به فهذا غير لازم بداهة، وكذلك لا تبحث معه من جانب جعل المادة التي يرجع إليها مجرد شاهد فقط لا دليل، وإنما يبحث معه في كيفيات التبيين ذاته عبر المروية التي وظّفها.
إنّ من ينشغل بتقرير المعنى وضبطه فإنّ غرضه مباين تمامًا لغرض الإخباري مثلًا، فهو لا ينقل معلومات ومضامين؛ ومن ثَمّ يُعتنى بالنظر معه في أهمية عدم اعتقاد المضمون، وكذلك هو مباين لغرض الفقيه الذي يحاول تأسيس الأحكام؛ ومن ثَمّ يعتنى معه بتقريرات مثل بيان حجية الاستدلال بهذه المرويات ومسالك التقرير من خلالها والكيفيات الضابطة لذلك من خلالها، ويقال له: إنّ هذه المرويات للاستشهاد فقط لا للاعتماد، وإنما هو يَبحث عن معنى يريد تبيينه وكشف الغطاء عنه، وبالتالي فهذه المرويات تمثّل عنده دلائل للبيان كالشعر الجاهلي وغيره من الأدوات التي تُورَد ويستعان بها في كشف المعنى فقط بِغَضّ النظر عن الموقف مما تحمله من مضامين قد لا تكون مقبولة في ذاتها وغير متّسقة مع تعاليم الإسلام في شيء.
كما أنّ المبين للمعنى لا يخاطَب بثنائية التأنيس والتأسيس والاعتضاد والاعتماد في موارده التي يوظّفها في البيان؛ فالمبيّن للمعنى غايته تقرير المعنى وبناؤه، وبالتالي فقد يكون إيراده للمرويات -ومنها الإسرائيليات- تارة من قِبَل التأسيس وتارة من قِبَل التأنيس بحسب وضوح القرائن التي دعته لجَلْبها والاستدلال بها.
2- التقسيم الثلاثي للمرويات الإسرائيلية:
هذا التقسيم الثلاثي للمرويات الإسرائيلية متّسق مع أساس النظر التيمي النقلي عن المرويات؛ ذلك أنه حال كانت المرويات مجالًا لنقل المعلومات والمضامين وللاستشهاد لا الاعتقاد فلا بد أن تخضع في نقلها واستدخال مادتها للمقرّر عندنا في الشرع، فما وافقنا منها فهو مقبول وتجوز روايته، وما خالفنا مردود ولا يجوز روايته والاستشهاد به، وما لا يُصدَّق أو يُكذَّب منها فلا بأس بروايته، وإن كان التخفّف من ذلك أولى؛ كونه غير مفيد في الدِّين بصورة عامّة ولا حاجة لنقله بالأساس.
إنّ هذا التقسيم للمرويات الإسرائيلية في تفسير السّلف لا معنى له ولا جدوى كذلك؛ لأن المبين للمعنى لا صلة له بالمضمون -كما الحال في الاستدلال بالشعر الجاهلي- حتى تنعقد معه القسمة تبعًا لهذا الاعتبار، وإنما الأصل أن تكون القسمة معه لا على المضامين التي تحملها أدوات التبيين وإنما في كيفيات الاستدلال والتبيين عبرها وغير ذلك مما يعتلق بالتبيين ودورها فيه.
ثالثًا: ضعف جدوى التأصيل التيمي لضبط الخلاف في التفسير:
اعتنى ابن تيمية بتقسيم الخلاف في التفسير والكلام على الضوابط الحاكمة لكلّ قسم، إلا أنه لصدوره عن المنطلق النقلي عن المرويات وبُعده عن حيثية التفسير فَقَدَ تأصيلُه جدواه بصورة كبيرة في ضبط التعامل مع الاختلاف التفسيري، وصار الناظر في الخلاف التفسيري قبل التأصيل التيمي كناظره بعده من حيث عدم امتلاكه لأطر وضوابط لها أثر ظاهر في ضبط التعامل معه؛ ومن ذلك:
1- قِسْمته للاختلاف في التفسير:
قسَم ابن تيمية مرجع الخلاف في التفسير إلى قسمين: نقلي واستدلالي، حيث قال: «الاختلاف في التفسير على نوعين: منه ما مستنده النقل فقط، ومنه ما يعلم بغير ذلك؛ إذ العلم إما نقل مصدّق وإما استدلال محقّق،...وأمّا النوع الثاني من مستندي الاختلاف، وهو ما يعلم بالاستدلال لا بالنقل...».
وهذه القسمة لا تعبِّر عن واقع التفسير؛ فعَدا ما يُنقل عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في التفسير -وهو شديد الندرة كما هو معلوم-[19]، فإنّ جلّ المادة التفسيرية مردودة للمفسِّرين ومتعلقة باجتهادهم أنفسهم؛ فسائر ما يذكره المفسّرون من معانٍ استنادًا لتوظيف أدوات كالسُّنة النبوية أو مرويات النزول، فإنه يبقى عملًا استدلاليًّا منهم ومحض اجتهاد ينظر في قرائنه ومستنداته، ولا تعتبر أبدًا هذه المعاني مجرد منقولات نقلها المفسّر عن تلك الأدوات وقاموا باستيرادها منها استيرادًا محضًا؛ ولهذا يناقشها أئمة التفسير من أمثال الطبري وابن عطية باعتبارها مقولات تفسيرية لا منقولات ويتأملون دلائلها وقرائنها؛ ومن ثَمّ فلا وجه لمثل هذه المقابلة التي ذكرها ابن تيمية في التفسير؛ لأن الخلاف في التفسير وتبيين المعاني مرجعه الرئيس للاستدلال وقرائنه فقط، وبالتالي فإنّ مَنازع الاستدلال وتغايرها بين المفسِّرين هي أساس قسمة الخلاف في التفسير.
إنّ ما دعا ابن تيمية لهذه القِسْمة غير الواقعية في التفسير هو صدوره عن النظر النقلي عن المرويات الإسرائيلية وأن المفسرين الأوائل من السّلف كانوا ناقلين لمضامين من المرويات الإسرائيلية لا أنّ هذه المرويات كانت من أدوات التبيين عندهم، وبالتالي استحال عنده التفسير لمادة نقلية لها موارد عديدة وكثيرة وأخرى هي رأي واجتهاد، وبالتالي صحّت عنده المقابلة بينهما وقسمة الاختلاف في التفسير وسببه تبعًا لذلك.
2- تأصيله لضبط الاختلاف في التفسير:
فابن تيمية قسم الخلاف الذي مرجعه النقل لقسمين: «ما يمكن معرفة الصحيح منه والضعيف، ومنه ما لا يمكن معرفة ذلك فيه»، ويلاحَظ هاهنا أمران:
الأول: إنّ ابن تيمية جعل معيار ضبط هذا الخلاف الذي سببه النقل هو القدرة على التحقّق من الصحّة والضعف في المرويات المنقول عنها، ولكن لما كان هذا على خلاف حيثيّة التفسير كما بيَّنّا صار هذا التأصيل لا فائدة له في ضبط التعامل مع اختلاف التفسير؛ كون المعنى التفسيري هو عمل استدلالي ينتجه المفسّر بقرائن معينة من خلال رجوعه لأدوات كالشِّعْر والمرويات الإسرائيلية ومرويات النزول وغيرها، والحكم على المعنى التفسيري الذي أنتجه المفسر يقتضي النظر في مجموع قرائن الاستدلال الحافّة بالمعنى عنده، ولا يتم البَتّ فيه بمجرد النظر في صحة أو ضعف روايات المادة التي استثمرها في التبيين، والتي غايتها أن تكون أحد القرائن التي يلتفت إليها أحيانًا في بعض الأقوال لا أكثر.
الثاني: تكلّم ابن تيمية على القسم الأول الذي يمكن مَيْز صحيحه من ضعيفه، فقال: «وأما القسم الأول، الذي يمكن معرفة الصحيح منه، فهذا موجود فيما يحتاج إليه ولله الحمد، فكثيرًا ما يوجد في التفسير والحديث والمغازي أمور منقولة عن نبيّنا -صلى الله عليه وسلم- وغيره من الأنبياء -صلوات الله عليهم وسلامه-(والنقل الصحيح يدفع ذلك، بل هذا موجود فيما مستنده النقل، وفيما قد يعرف بأمور أخرى غير النقل)[20]، فالمقصود أنّ المنقولات التي يحتاج إليها في الدّين قد نصب اللهُ الأدلة على بيان ما فيها من صحيح وغيره، ومعلوم أنّ المنقول في التفسير أكثره كالمنقول في المغازي والملاحم؛ ولهذا قال الإمام أحمد: ثلاثة أمور ليس لها إسناد: التفسير، والملاحم، والمغازي. ويروى: ليس لها أصل، أي: إسناد؛ لأن الغالب عليها المراسيل...والمراسيل إذا تعدَّدَت طُرُقها وخَلَتْ عن المواطأة قصدًا أو الاتفاق بغير قصد كانت صحيحة قطعًا... وهذا الأصل ينبغي أن يُعرف، فإنه أصلٌ نافعٌ في الجزم بكثيرٍ من المنقولات في الحديث والتفسير والمغازي وما ينقل من أقوال الناس وأفعالهم وغير ذلك»[21]. ولدينا هاهنا نقطتان:
الأولى: إنّ ابن تيمية لرغبته في ضبط منقولات التفسير التي يمكن مَيْز صحيحها من ضعيفها -والتي تأتي في مقابل ما لا يعرف فيه ذلك- فإنه أسّسَ تبعًا لمقولة الإمام أحمد حول إشكال أسانيد التفسير والمغازي والملاحم، أنّ هذه الفنون الثلاثة نظرًا لغلبة المراسيل عليها فإن الطريق لضبط التحقّق من مضمامين مروياتها يكون عبر اعتبار قاعدة أنّ المراسيل «إذا تعدَّدت طُرُقها وخَلَتْ عن المواطأة قصدًا أو الاتفاق بغير قصد كانت صحيحة قطعًا»، وأنّ «تعدُّد الطرق مع عدم التشاعر أو الاتفاق في العادة يُوجِب العلم بمضمون المنقول»[22]، إلا أن تأسيسه هذا وإن كان مفيدًا في المغازي والملاحم فإن إفادته في التفسير قليلة؛ فالمغازي والملاحم عمادها النقل؛ ومن ثَمّ فإن تفعيل قاعدة تعاضد المراسيل يفيد -بلا ريب- في صحة أصل مضمونها، إلا أنّ التفسير هو عمل استدلالي ينتجه المفسّر بقرائن عديدة ولا يصحّ بمجرد صحة أصلِ مضمون المعنى في الأداة الموظّفة فيه كما بيّنا.
الثانية: يبدو أن ابن تيمية فهم من مقولة الإمام أحمد: «ثلاثة أمور ليس لها إسناد: التفسير، والملاحم، والمغازي»، أنّ هذه الفنون الثلاثة تدور حول فكرة النّقل والرواية، وبالتالي فهي توجّه في ضوء إشكال الإسناد في ثلاثتها لأثر تعاضد الروايات في جميعها وما له من دورٍ في تصحيح أصل المضامين، وهذا النظر التيمي لمقولة الإمام أحمد يلتقي مع فهوم سابقة لها لدى بعض أرباب الحديث وغيرهم، وأن غرضها التنبيه على أنّ هذه الفنون الثلاثة ليس لها إسناد مرفوع للنبي -صلى الله عليه وسلم- كما هو معلوم ومشهور، إلا أن هذا الفهم قد لا تعطيه مقولة الإمام أحمد، والتي لا تعدو كونها مطلق توصيف لإشكالِ انقطاع الإسناد الذي يلفّ هذه الفنون وأهمية مراعاته في النظر إليها وترتيب التعامل معها، لا أنها تساوي بينها في اعتبار أصلها النقلي عن النبي -صلى الله عليه وسلم-؛ لأن هذه الفنون الثلاثة غير متساوية في هذا الاعتبار كما هو ظاهر في طبيعتها، فالمغازي والملاحم أحداث ووقائع ترجع للنبي -صلى الله عليه وسلم- أو تتصل بزمانه، وأما التفسير فهو فُهوم السّلَف واجتهاداتهم في بيان القرآن بالأساس، ومعلوم أنّ الرواية المرفوعة فيه شديدة الندرة. إن اعتبار هذه الفنون الثلاثة عمادها الرواية والنقل عن النبي -صلى الله عليه وسلم- يجعلنا:
- نتصور أنّ إشكال انقطاع الإسناد في تفاسير السّلف مرجعه عدم الرفع كما في المغازي والملاحم، وهو أمرٌ ظاهرُ البُعْد ولا يتّسق وإشكال الانقطاع في مرويات التفسير، والذي يرتبط بروايتها عن مفسري السلف أصلًا لا النبي -صلى الله عليه وسلم-.
- نعتبر أنّ قاعدة تعاضد المراسيل هي حلّ إشكال انقطاع الإسناد في جميعها، وذلك هو عينُ ما فعله ابن تيمية، وهو غلطٌ ظاهر؛ لأن تفعيل قاعدة المراسيل وتعاضدها في الجزم بأصلِ المنقول نافعة في المغازي والملاحم باعتبار طبيعتها، والتي يوجد فيها واقعة تروى بطرائق متعددة بينها اختلاف في بعض التفاصيل، ويكون التعاضد هاهنا مثبتًا لأصل الواقعة بِغَضّ النظر عن تفاصيلها، وأما التفسير فهو معانٍ تختلف خلافَ تضادّ أو تنوّع، والتنوع ليس خلافًا أصلًا وإنما هو تعبير عن المعنى الواحد بطرائق متغايرة كبيان لازمه أو جزئه وغير ذلك، وبالتالي فلا تفاصيل هاهنا أصلًا تحتفّ بالمعنى كما هو الحال في الوقائع التي توجد في المغازي والملاحم. كما أنّ المعنى التفسيري في غالبه لا يرجع في تقريره لمرويات كالإسرائيليات ومرويات النزول حتى نُفَعّل هذه القاعدة -والتي لا تفيد في تصحيحه بالكليَة كما بيَّنّا-، وإنما المعاني التي عمادها اللغة وهي أكثر المعاني كما هو معلوم لا مدخل لذلك فيها.
رابعًا: عزوف التأصيل التيمي عن بيان منهج توظيف المرويّات في التفسير:
لعلّ من أَشْكَل آثار النّظر النقلي عن المرويات الإسرائيلية أنه يعطّل بحثَ استكشاف منهج توظيف هذه المرويات في التفسير، ذلك أنه يجعل النّظَر يبتعد عن حيثيّة حضور المرويات في التفسير وبحث منهج توظيفها واستثمارها لينشغل بالمرويات ذاتها والتعامل معها بشكلٍ مباشر باعتبارها المجال الرئيس الذي انتزعت من بين ثناياه المعلومات وجرى نقلها منه. وهذا ما تجده باديًا في تأصيل ابن تيمية -رحمه الله-، ذلك أنه يحاول ضبط الإفادة من المرويات ببيان الموقف الشرعي من المرويات ذاتها، وكيفيات التعامل معها، ووجوه الاستدلال الشرعي بها كما لو كان المفسّر فقيهًا لا مبيِّنًا للمعنى؛ ولهذا ابتعد التأصيل التيمي عن إنتاج شيء ذي بالٍ في استكشاف منهج حضور هذه المرويات في التفسير، وانصبّ على زوايا لا علاقة لها بالمسألة في التفسير، وكذا مَن التزم هذا التأصيل ممّن جاء بعده في درس المسألة.
وحاصل ما مرّ معنا يبرز لنا كثرة الآثار السلبية التي احتفَّت بالدرس التيمي على أكثرِ من صعيدٍ؛ نظرًا لصدوره عن النظر النقلي عن المرويات لا التوظيفي والاستدلالي بها في التفسير، وهكذا الشأن في المنطلقات المشكلة؛ فإن التأصيل من خلالها للمسائل يَبقى حاملًا للإشكال ولا يمكن أن يتحصّل من خلاله نظر منضبط حتى لو كانت براعة المؤصّل كابن تيمية، كما أنه يكون كذلك منتِجًا للإشكال حالَ ممارسة التعامل مع المسألة من خلاله.
خاتمة:
ظهر معنا من خلال ما سبق أن دراسة ابن تيمية لمسألة المرويات الإسرائيلية في التفسير لم تكن وليدة استيعاب دقيق لمسالك توظيف هذه المرويات في تفسير السلف، وكذلك لم تكن منبنية على هضم محرّر لتعامل كبار المفسرين من أمثال الطبري معها، وأنها صدرت عن منطلقٍ مفارقٍ لحيثية التفسير الذي استُحضرت في ساحته هذه المرويات ومعارض لها، وهو ما جعل التأصيل القائم عليها مشكلًا كلّه، وفاقدًا لجدواه في بحثها، وغير قادر على استكشاف أبعادها المنهجية في واقع مدونة التفسير والتأصيل لضبط التعامل معها، بل إنه مدعاة لاستشكال صنيعِ السّلف ممن أوردوا هذه المرويات ونقدهم وتغليطهم وَرَدّ مقولاتهم.
ومن هاهنا يمكننا القول بأنّ بحث ابن تيمية للمرويات الإسرائيلية في التفسير بحثٌ مشكلٌ، وأنه وإن بقي بحاجة لدراسة تجلي أسباب انحرافه عن حيثيّة التفسير وتتبع آثاره في بعض التفاسير والدراسات التي تبنَّتْه وعالجَتْ المسألة من خلاله[23]، إلا أنّ هذا المنطلق النقلي عن المرويات الذي تبنّاه ابن تيمية ومعمار التأصيل القائم عليه مما يجب استبعاده في بحث المرويّات الإسرائيلية في التفسير؛ حتى يمكن للبحث أن يكون مثمرًا ومفيدًا في ضبط تصوّر المسألة، وأن قضية المرويّات الإسرائيلية في التفسير -لغلبة النظر إليها من خلال التأصيل التيمي- فإنها تظلّ بحاجة إلى إعادة درس في ضوء حيثيّة التفسير ذاته باعتبارها أداة تبيين كما الحال مع الشعر الجاهلي وغيره من أدوات التفسير، حتى تتكشّف الأُطر والأنساق المنهجيّة الحاكمة لتوظيفها والاستدلال بها في التفسير، والله الموفِّق.
[1] رابط المقالة الأولى: tafsir.net/article/5165.
رابط المقالة الثانية: tafsir.net/article/5166.
[2] مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية ص(9-11). ومسألة بيان النبي -صلى الله عليه وسلم- للقرآن لا تشمل بيان الألفاظ لفظًا لفظًا كما قد يتصوّر خطأ عن ابن تيمية. يراجع الكلام على ذلك في الدراسة التي سعدتُ بمشاركتها مع بعض الفضلاء: أصول التفسير في المؤلفات؛ دراسة وصفية موازنة، مركز تفسير، ط:1، 1437هـ-2015م، ص(235)، وما بعدها. وقد ناقشها كذلك بتوسّع الفاضل أحمد فتحي البشير في بحثه: «القول بتوقف تفسير القرآن على أقوال السلف؛ دراسة في استدلالات ابن تيمية من خلال كتابه "جواب الاعتراضات المصرية على الفتيا الحموية"»، وهو منشور على موقع تفسير على هذا الرابط: tafsir.net/research/12.
[3] بيان تلبيس الجهمية (220/1).
[4] فقد ورد تفسير الهمّ بما ذكَرْنا عن علي بن أبي طالب، وابن عباس، وسعيد بن جبير، ومجاهد بن جبر، والضحاك، والحسن البصري، وابن أبي مليكة، والسدي، ومقاتل بن سليمان، ومحمد بن إسحاق. وأمّا أنّ قوله: {ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب... وما أبرئ نفسي} من كلام يوسف، فقد ورد عن ابن عباس، وابن أبي الهذيل، وحكيم بن جابر، وسعيد بن جبير، ومجاهد بن جبر، والضحاك بن مزاحم، وعكرمة، والحسن، وأبي صالح باذام، وقتادة بن دعامة، والسدي، وكذلك ورد عن مقاتل بن سليمان، وابن جريج، وابن إسحاق. ولم يَحْكِ الطبري ولا غيره من الكتب المعتنية بذكر المأثور عن السلف غير هذا القول عنهم.
[5] مجموع الفتاوى، (10/ 297).
[6] هذا القول الذي ذكره ابن تيمية أشار الطبري لقريب منه وعدَّه من القول المخالف للسلف، حيث قال بعد أن أورد تفسير السلف لِهَمّ يوسف: «وأمّا آخرون ممن خالف أقوال السلف وتأوَّلوا القرآن بآرائهم، فإنهم قالوا في ذلك أقوالًا مختلفة...»، وبعد أن ذكر هذه الأقوال ونقدها بمخالفتها لـ«جميع أهل العلم بتأويل القرآن الذين عنهم يؤخذ تأويله»، وغير ذلك مما أورد، قال: «وقال آخرون منهم: بل قد همَّت المرأة بيوسف وهمَّ يوسف بالمرأة، غير أن همّهما كان تمثيلًا منهما بين الفعل والتَّرْك، لا عزمًا ولا إرادة؛ قالوا: ولا حرج في حديث النفس، ولا في ذِكر القلب إذا لم يكن معهما عزم ولا فعل». تفسير الطبري، ط: هجر، (13/ 86). وتأمَّل كيف أن الطبري يعتبر كلام السلف مقولات تفسيرية لا منقولات كما يقول ابن تيمية، وكيف أنه اعتبر تفسير الهَمِّ بأنه هَمّ خطرات وحديث نفس مخالف لما قاله السلف.
[7] مجموع الفتاوى (10/ 298).
[8] مجموع الفتاوى (10/ 293)
[9] مجموع الفتاوى (10/ 296).
[10] مجموع الفتاوى (10/ 297).
[11] قال ابن تيمية بعد إفاضته في بيان تفضيل التائب وكمال موقفه: «... وبهذا يظهر جواب شبهة من يقول إنّ اللهَ لا يبعث نبيًّا إلا مَن كان معصومًا قبل النبوة، كما يقول ذلك طائفة من الرافضة وغيرهم، وكذلك من قال إنه لا يبعث نبيًّا إلا مَن كان مؤمنًا قبل النبوة؛ فإنّ هؤلاء توهَّموا أنّ الذنوب تكون نقصًا وإن تاب التائب منها، وهذا منشأ غلطهم، فمَن ظنّ أن صاحب الذنوب مع التوبة النصوح يكون ناقصًا فهو غالط غلطًا عظيمًا، فإنّ الذمّ والعقاب الذى يلحق أهل الذنوب لا يلحق التائب منه شيء أصلًا، لكن إن قدّم التوبة لم يلحقه شيء، وإن أخّر التوبة فقد يلحقه ما بين الذنوب والتوبة من الذمّ والعقاب ما يناسب حاله، والأنبياء -صلوات الله عليهم وسلامه- كانوا لا يؤخّرون التوبة، بل يسارعون إليها ويسابقون إليها لا يؤخّرون ولا يُصِّرون على الذّنب، بل هم معصومون من ذلك، ومن أخَّر ذلك زمنًا قليلًا كفَّر الله ذلك بما يبتليه به، كما فعل بذي النون -صلى الله عليه وسلم- هذا على المشهور أن إلقاءه كان بعد النبوة، وأما مَنْ قال إن إلقاءه كان قبل النبوة فلا يحتاج إلى هذا». مجموع الفتاوى (10/ 309)
[12] تجدر الإشارة إلى أمرين:
الأول: المتأمِّل للموقف التيمي من عصمة الأنبياء يجده الأكثر ظهورًا من غيره من المواقف التي حاولَتْ نفي الذنب عنهم، واجتهدت في طرح تفسيرات لنسبة الذنوب للأنبياء في القرآن لا تخلو من نظر، إلا أننا نرى أن ما يزيده رسوخًا وتقريرًا -إضافة لما ذكره ابن تيمية من دلائل- هو موافقته الظاهرة لإجماع السلف في التفسير وتتابعهم على طرح تفسيرات تثبت وقوع الذنب من الأنبياء.
الثاني: سيدنا يوسف شأنه كشأن غيره من الأنبياء في وقوع الذنب منه، وليس كما يقول ابن تيمية مِن نفي ذلك عنه؛ لأن إثبات وقوع الذنب منه هو ما أجمع عليه السلف في التفسير، وهم أدرى بذلك من غيرهم، كما أن عدم تصريح القرآن بإثبات الذّنب له وما يناسبه من الاستغفار وقبول توبته الذي بنى عليه ابن تيمية فيما ذهب إليه، فيمكن تخريجه بما سبق وذكره ابن تيمية في كلامه عن سيدنا يونس أو بغيره مما قد يتأمّل في المسألة مما ليس غرضنا تحريره هاهنا؛ إذ الغرض هو فقط بيان الموقف العام من وقوع الذنب من سيدنا يوسف في ضوء تفسير السلف لا غير.
لعلّ من المشروعات البحثية التي قد تتأمّل عند ابن تيمية وغيره، هو أثر النظر النقلي عن المرويات الإسرائيلية في تفسير السلف، وما ترتّب عليه في بناء بعض المسائل العقدية لا سيما عصمة الأنبياء وما يتعلق بهم.
[13] سنهتم في بيان أثر التأصيل التيمي على مَنْ بعده بالاعتماد على ابن كثير بشكلٍ خاصّ؛ لاشتهارة بعنايته بنقل التأصيل التيمي في تفسيره في غير ما موطنٍ، وكذلك العمل من خلاله، كما هو معلوم.
[14] تفسير ابن كثير، ت: سلامة (1/ 360).
[15] تفسير ابن كثير (7/ 60). ويلاحَظ هاهنا أمران:
الأول: موقف ابن كثير هاهنا مخالف لابن تيمية، وذلك إمّا لأنه لم يستوعب الأصل الذي بنى عليه ابن تيمية في النظر لمسألة العصمة وسبب عدم ردّه للوارد عن السلف في مثل هذا مما رآه نقلًا في ضوء ما تقرُّه النظرة الشرعية، أو لأنه يخالفه فيه، والأمر بحاجة إلى بحث.
الثاني: من الأمور التي تحتاج إلى بحث هو نقد أقوال السلف وتوهينها بدعوى نكارتها اعتمادًا على تفاصيل المرويات الإسرائيلية التي يذكرونها كما يفعل ابن كثير وغيره، فهذا النقد إنْ تغيَّر منطلق النظر النقلي عن المرويات في التفسير، وأن المفسِّر ليس ناقلًا وإنما هو موظِّف للمروية ومستدِلّ بها؛ فإنه سيبدو بتمامه لا محلّ لذِكره أصلًا في التعامل مع الأقوال والحُكم عليها.
[16] تفسير ابن كثير، (4/ 347-348). ليس غرضنا هنا تحرير الكلام في المسألة التي يعالجها ابن كثير وإنما الغرض بيان أثر تبنِّي النظرة النقلية عن المرويات في التعامل معها في تفسير السلف لا غير.
[17] تفسير ابن كثير، ت: سلامة (7/ 68، 69).
[18] وهي مقالة سوف تنشر -بإذن الله- قريبًا ضمن ذات الملف (ملف المرويات الإسرائيلية في كتب التفسير) على موقع تفسير.
[19] يقول السيوطي معلقًا على الوارد من التفسير النبوي: «الذي صحّ من ذلك قليل جدًّا، بل أصل المرفوع منه في غاية القِلَّة». الإتقان في علوم القرآن، (4/ 208).
[20] يبدو أن في كلام ابن تيمية مما وضعناه بين قوسين سقطًا أورث العبارة قلقًا ظاهرًا.
[21] المقدمة، ص(20- 26). بتصرف يسير.
[22] المقدمة، ص(29).
[23] لعلّ من الحلقات المتمّمة لتناولنا للدرس التيمي للمرويات الإسرائيلية في تفسير السلف هي الكلام على منشأ المنطلق النقلي عن المرويات لديه وتفسير أسبابه، ونحن وإن كنا أشرنا لطرفٍ يسير منه إبّان الكلام عن الطبري ومنطلقه في التجويز، إلا أننا ارتأينا إرجاء الكلام فيه وتأخيره لمقالات أخرى نتوسّع فيها في الطرح، لا سيما وأنها مسألة تتّصل بأسباب كثيرة وتحتاج إلى تفصيل كثير، ولعلّ الله ييسر إخراجها قريبًا.
كلمات مفتاحية
الكاتب:

خليل محمود اليماني
باحث في الدراسات القرآنية، عضو هيئة تدريس بجامعة الأزهر، له عدد من الكتابات والبحوث المنشورة.
مواضيع ذات صلة
((المعلومات والآراء المقدَّمة هي للكتّاب، ولا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع أو أسرة مركز تفسير))